فضائح الباطنية
فضائح الباطنية وفضائل المستظهرية
للغزالي
المستظهري في الرد على الباطنية
==========
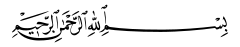
الحمد لله الحي القيوم الذي لا يستولي على كنه قيامه وصف واصف الجليل الذي لا يحيط بصفة جلاله معرفة عارف العزيز الذي لا عزيز إلا وهو بقدم الصغار على عتبة عزه عاكف الماجد الذي لا ملك إلا وهو حول سرادق مجده طائف الجبار الذي لا سلطان إلا وهو لنفحات عفوه راج وسطوات سخطه خائف المتكبر الذي لا ولي إلا وقلبه على محبته وقف وقالبه لخدمته واقف الرحيم الذي لا شئ إلا وهو ممتط متن الخطر في هول المواقف لولا ترصده لرحمته بوعده السابق السالف المنعم الذي إن يردك بخير فليس لفضله راد ولا صارف المنتقم الذي إن يمسسك بضر فما له سواه كاشف جل جلاله وتقدست أسماؤه فلا يغره موالف ولا يضره مخالف وعز سلطانه فلا يكيده مراوغ ولا يناوئه مكاشف خلق الخلق أحزابا وأحسابا ورتبهم في زخارف الدنيا أرذالا وأشرافا وقربهم في حقائق الدين ارتباطا وانحرافا وجهلة وعرافا وفرقهم في قواعد العقائد فرقا وأصنافا يتطابقون ائتلافا ويتقاطعون اختلافا فافترقوا في المعتقدات جحودا واعترافا وتعسفا وإنصافا واعتدالا وإسرافا كما تباينوا أصلا وأوصافا هذا غني يتضاعف كل يوم ما له أضعافا وهو يأخذ جزافا وينفق جزافا وهذا ضعيف يعول ذرية ضعافا يعوزه قوت يوم حتى سأل الناس إلحافا وهذا مقبول في القلوب لا يلقى في حاجته إلا إجابة وإسعافا وهذا مبغض للخلق تهتضم حقوقه ضيما وإجحافا وهذا تقي موفق يزداد كل يوم في ورعه وتقواه إسرافا وإشراقا وهذا مخذول يزداد على مر الأيام في غيه وفساده تماديا واعتسافا ذلكم تقدير ربكم القادر الحكيم الذي لا يستطيع سلطان عن قهره انحرافا القاهر العليم الذي لا يملك أحد لحكمه خلافا رغما لأنف الكفرة الباطنية الذين أنكروا أن يجعل الله بين أهل الحق اختلافا ولم يعلموا أن الاختلاف بين الأمة يتبعه الرحمة كما تتبع العبرة اختلافهم مراتب وأوصافا وشكرا لله الذي وفقنا للاعتراف بدينه إعلانا وإسرارا وسددنا للانقياد لحكمه إظهارا وإضمارا ولم يجعلنا من ضلال الباطنية الذين يظهرون باللسان إقرارا ويضمرون في الجنان تماديا وإصرارا ويحملون من الذنوب أوقارا ويعلنون في الدين تقوى ووقارا ويحتقبون من المظالم أوزارا لأنهم لا يرجون لله وقارا ولو خاطبهم دعاة الحق ليلا ونهارا لم يزدهم دعاؤهم إلا فرارا فإذا أطل عليهم سيف أهل الحق آثروا الحق إيثارا وإذا انقشع عنهم ظله أصروا واستكبروا استكبارا فنسأل الله أن لا يدع على وجه الأرض منهم ديارا. ونصلي على رسوله المصطفى وعلى آله وخلفائه الراشدين من بعده صلوات بعدد قطر السحاب تهمي مدرارا وتزداد على ممر الأيام استمرارا وتتجدد على توالي الأعوام تلاحقا وتكرارا.
أما بعد، فإني لم أزل مدة المقام بمدينة السلام متشوفا إلى أن أخدم المواقف المقدسة النبوية الإمامية المستظهرية ضاعف الله جلالها ومد على طبقات الخلق ظلالها بتصنيف كتاب في علم الدين أقضي به شكر النعمة وأقيم به رسم الخدمة وأجتني بما أتعاطاه من الكلفة ثمار القبول والزلفة، لكني جنحت إلى التواني لتحري في تعيين العلم الذي أقصده بالتصنيف وتخصيص الفن الذي يقع موقع الرضا من الرأي النبوي الشريف، فكانت هذه الحيرة تغبر في وجه المراد وتمنع القريحة عن الإذعان والانقياد حتى خرجت الأوامر الشريفة المقدسة النبوية المستظهرية بالإشارة إلى الخادم في تصنيف كتاب في الرد على الباطنية مشتمل على الكشف عن بدعهم وضلالاتهم وفنون مكرهم واحتيالهم ووجه استدراجهم عوام الخلق وجهالهم وإيضاح غوائلهم في تلبيسهم وخداعهم وانسلالهم عن ربقة الإسلام وانسلاخهم وانخلاعهم وإبراز فضائحهم وقبائحهم بما يفضي إلى هتك أستارهم وكشف أغوارهم، فكانت المفاتحة بالاستخدام في هذا المهم في الظاهر نعمة أجابت قبل الدعاء ولبت قبل النداء، وإن كانت في الحقيقة ضالة كنت أنشدها وبغية كنت أقصدها، فرأيت الامتثال حتما والمسارعة إلى الارتسام حزما. وكيف لا أسارع إليه وإن لاحظت جانب الآمر ألفيته أمرا مبلغه زعيم الأمة وشرف الدين ومنشؤه ملاذ الأمم أمير المؤمنين وموجب طاعته خالق الخلق رب العالمين إذ قال الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} وإن التفت إلى المأمور به فهو ذب عن الحق المبين ونضال دون حجة الدين وقطع لدابر الملحدين وإن رجعت إلى نفسي وقد شرفت بالخطاب به من بين سائر العالمين رأيت المسارعة إلى الإذعان والامتثال في حقي من فروض الأعيان إذ يقل على بسيط الأرض من يستقل في قواعد العقائد بإقامة الحجة والبرهان بحيث يرقيها من حضيض الظن والحسبان إلى يفاع القطع والاستيقان، فإنه الخطب الجسيم والأمر العظيم الذي لا تستقل بأعيانه بضاعة الفقهاء ولا يضطلع بأركانه إلا من تخصص بالمعضلة الزباء لما نجم في أصول الديانات من الأهواء واختلط بمسالك الأوائل من الفلاسفة والحكماء، فمن بواطن غيهم كان استمداد هؤلاء فإنهم بين مذاهب الثنوية والفلاسفة يترددون وحول حدود المنطق في مجادلاتهم يدندنون، ولقد طال تفتيشي عن شبه خصمه لما تقدر على قمعه وخصمه وفي مثل ذلك أنشد:
عرفت الشر لا للشر ** لكن لتوقيه
ومن لا يعرف الشر ** من الناس يقع فيه
تظاهرت علي أسباب الإيجاب والإلزام واستقبلت الآتي بالاعتناق والالتزام وبادت إلى الامتثال والارتسام وانتدبت لتصنيف هذا الكتاب مبنيا على عشرة أبواب سائلا من الله سبحانه التوفيق لشاكله والصواب وسميته (فضائح الباطنية وفضائل المستظهرية) والله تعالى الموفق لإتمام هذه النية وهذا ثبت الأبواب.
الباب الأول في الإعراب عن المنهج الذي استنهجته في سياق هذا الكتاب.
الباب الثاني في بيان ألقابهم والكشف عن السبب الباعث لهم على نصب هذه الدعوة المضلة.
الباب الثالث في بيان درجات حيلهم في التلبيس والكشف عن سبب الإغترار بحيلهم مع ظهور فسادها.
الباب الرابع في نقل مذهبهم جملة وتفصيلا.
الباب الخامس في تأويلاتهم لظواهر القرآن واستدلالهم بالأمور العددية.
وفيه فصلان الفصل الأول في تأويلهم للظواهر والفصل الثاني في استدلالالتهم بالأعداد والحروف.
الباب السادس في إيراد أدلتهم العقيلة على نصرة مذهبهم والكشف عن تلبيساتهم التي زوقوها بزعمهم في معرض البرهان على إبطال النظر العقلي.
الباب السابع في إبطال استدلالهم بالنص على نصب الإمام المعصوم.
الباب الثامن في مقتضى فتوى الشرع في حقهم من التكفير والتخطئة وسفك الدم.
الباب التاسع في إقامة البرهان الفقهي الشرعي على أن الإمام الحق في عصرنا هذا هو الإمام المستظهر بالله حرس الله ظلاله.
الباب العاشر في الوظائف الدينية التي بالمواظبة عليها يدوم استحقاق الإمامة.
هذه ترجمة الأبواب. والمقترح على الرأي الشريف النبوي مطالعة الكتاب جملة ثم تخصيص الباب التاسع والعاشر لمن يريد استقصاء ليعرف من الباب التاسع قدر نعمة الله تعالى عليه وليستبين من الباب العاشر طريق القيام بشكر تلك النعمة ويعلم أن الله تعالى إذا لم يرض أن يكون له على وجه الأرض عبد أرفع رتبة من أمير المؤمنين فلا يرضى أمير المؤمنين ان يكون لله على وجه الأرض عبد أعبد وأشكر منه نسأل الله تعالى أن يمده بتوفيقه ويسدده لسواء طريقه هذه جملة الكتاب والله المستعان على سلوك جادة الحق واستنهاج مسلك الصدق.
الباب الأول في الإعراب عن المنهج الذي استنهجته في هذا الكتاب
لتعلم أن الكلام في التصانيف يختلف منهجه بالإضافة إلى المعنى غوصا وتحقيقا وتساهلا وتزويقا وبالاضافة إلى اللفظ إطنابا وإسهابا واختصارا وايجازا وبالاضافة إلى المقصد تكثيرا وتطويلا واقتصارا وتقليلا فهذه ثلاثة مقامات ولكل واحد من الأقسام فائدة وآفة.
وأما المقام الأول فالغرض في الغوص والتحقيق والتعمق في أسرار المعاني إلى أقصى الغايات التوقي من إزراء المحققين وقدح الغواصين فانهم إذا تأملوه فلم يصادفوه على مطابقة أوضاع الجدال وموافقة حدود المنطق عند النظار استركوا عمل المصنف واستغثوا كلامه واعتقدوا فيه التقاعد عن شأو التحقيق في الكلام والإنخراط في سلك العوام ولكن له آفة وهي قلة جدواه وفائدته في حق الأكثرين فإن الكلام إذا كان على ذوق المراء والجدال لا على مساق الخطاب المقنع لم يستقل بدركه إلا الغواصون ولم يتفطن لمغاصاته إلا المحققون وأما سلوك مسلك التساهل والاقتصار على فن من الكلام يستحسن في المخاطبات ففائدته أن يستلذ وقعه في الأسماع ولا تكل عن فهمه والتفطن لمقاصده أكثر الطباع ويحصل به الإقناع لكل ذي حجى وفطنة وان لم يكن متبحرا في العلوم.
وهذا الفن من جوالب المدح والإطراء ولكن من الظاهريين وآفته أنه من دواعي القدح والإزراء ولكن من الغواصين فرأيت أن أسلك المسلك المقتصد بين الطرفين ولا أخلى الكتاب عن أمور برهانية يتفطن لها المحققون ولا عن كلمات إقناعية يستفيد منها المتوهمون فان الحاجة إلى هذا الكتاب عامة في حق الخواص والعوام وشاملة جميع الطبقات من أهل الإسلام وهذا هو الأقرب إلى المنهج القويم فلطالما قيل: كلا طرفي قصد الأمور ذميم.
المقام الثاني في التعبير عن المقاصد إطنابا وإيجازا
وفائدة الإطناب الشرح والايضاح المغني عن عناء التفكر وطول التأمل وآفته الإملال وفائدة الايجاز جمع المقاصد وترصيفها وايصالها إلى الأفهام على التقارب وآفته الحاجة إلى شدة التصفح والتأمل لاستخراج المعاني الدقيقة من الألفاظ الوجيزة الرشيقة والرأى في هذا المقام الاقتصاد بين طرفي التفريط والإفراط فإن الإطناب لا ينفك عن إملال والإيجاز لا يخلو عن إخلال فالأولى الميل إلى الاختصار فلرب كلام قل ودل وما أمل.
المقام الثالث في التقليل والتكثير
ولقد طالعت الكتب المصنفة في هذا الفن فصادفتها مشحونة بفنين من الكلام فن في تواريخ أخبارهم وأحوالهم من بدء أمرهم إلى ظهور ضلالهم وتسمية كل واحد من دعاتهم في كل قطر من الأقطار وبيان وقائعهم فيما انقرض من الأعصار فهذا فن أرى التشاغل به اشتغالا بالأسمار وذلك أليق بأصحاب التواريخ والأخبار فأما علماء الشرع فليكن كلامهم محصورا في مهمات الدين وإقامة البرهان على ما هو الحق المبين فلكل عمل رجال.
والفن الثاني في إبطال تفصيل مذاهبهم من عقائد تلقوها من الثنوية والفلاسفة وحروفها عن اوضاعها وغيروا ألفاظها قصدا للتغطية والتلبيس هذا أيضا لا أرى التشاغل به لان الكلام عليها وكشف الغطاء عن بطلانها بايضاح حقيقة الحق وبرهانها ليس يختص بالطائفة الذين هم نابتة الزمان فتجريد القصد إلى نقل خصائص مذاهبهم التي تفردوا باعتقادها عن سائر الفرق هو الواجب المتعين فلا ينبغي أن يؤم المصنف في كتابه إلا المقصد الذي يبغيه والنحو الذي يرومه وينتحيه فمن حسن إسلام المرء ترك مالا يعنيه وذلك مما لا يعنيه في هذا المقام وان كان الخوض فيه على الجملة ذبا عن الإسلام ولكن لكل مقال مقام فلنقتصر في كتابنا على القدر الذي يعرب عن خصائص مذهبهم وينبه على مدارج حيلهم ثم نكشف عن بطلان شبههم بما لا يبقى للمستبصر ريب فيه فتنجلي عن وجه الحق كدورة التمويه.
ثم نختم الكتاب بما هو السر واللباب وهو إقامة البراهين الشرعية على صحة الإمامة للمواقف القدسية النبوية المستظهرية بموجب الأدلة العقلية والفقهية على ما أفصح عن مضمونه ترجمة الأبواب.
الباب الثاني في بيان ألقابهم والكشف عن السبب الداعي لهم على نصب هذه الدعوة
وفيه فصلان.
الفصل الأول في ألقابهم التي تداولتها الألسنة على اختلاف الأعصار والأزمنة
وهي عشرة ألقاب الباطنية والقرامطة والقرمطية والخرمية والحرمدينية والإسماعيلية والسبعية والبابكية والمحمرة والتعليمية. ولكل لقب سبب.
أما الباطنية فانما لقبوا بها لدعواهم أن لظواهر القرآن والأخبار بواطن تجرى في الظواهر مجرى اللب من القشر وأنها بصورها توهم عند الجهال الأغبياء صورا جلية وهي عند العقلاء والأذكياء رموز وإشارات إلى حقائق معينة وأن من تقاعد عقله عن الغوص على الحفايا والأسرار والبواطن والأغوار وقنع بظواهرها مسارعا إلى الاغترار كان تحت الأواصر والأغلال معنى بالأوزار والأثقال وأرادوا ب الأغلال التكليفات الشرعية فإن من ارتقى إلى علم الباطن انحط عنه التكليف واستراح من أعبائه وهم المرادون بقوله تعالى: {ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم} الآية وربما موهوا بالاستشهاد عليه بقولهم إن الجهال المنكرين للباطن هم الذين اريدوا بقوله تعالى: {فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب} وغرضهم الأقصى إبطال الشرائع فإنهم إذا انتزعوا عن العقائد موجب الظواهر قدروا على الحكم بدعوى الباطن على حسب ما يوجب الإنسلاخ عن قواعد الدين إذا سقطت الثقة بموجب الألفاظ الصريحة فلا يبقى للشرع عصام يرجع إليه ويعول عليه.
وأما القرامطة فانما لقبوا بها نسبة إلى رجل يقال له حمدان قرمط كان أحد دعاتهم في الابتداء فاستجاب له في دعوته رجال فسموا قرامطة وقرمطية وكان المسمى حمدان قرمط رجلا من أهل الكوفة مائلا إلى الزهد فصادفه أحد دعاة الباطنية في طريق وهو متوجه إلى قريته وبين يديه بقر يسوقها فقال حمدان لذلك الداعي وهو لا يعرفه ولا يعرف حاله أراك سافرت عن موضع بعيد فأين مقصدك فذكر موضعا هو قرية حمدان فقال له حمدان اركب بقرة من هذه البقر لتستريح عن تعب المشي فلما رآه مائلا إلى الزهد والديانة اتاه من حيث رآه مائلا إليه فقال اني لم اومر بذلك فقال حمدان وكأنك لا تعمل إلا بامر قال نعم قال حمدان وبأمر من تعمل فقال الداعي بامر مالكي ومالكك ومن له الدنيا والآخرة فقال حمدان ذلك إذن هو رب العالمين فقال الداعي صدقت ولكن الله يهب ملكه لمن يشاء قال حمدان وما غرضك في البقعة التي انت متوجه اليها قال امرت أن ادعو اهلها من الجهل إلى العلم ومن الضلال إلى الهدى ومن الشقاوة إلى السعادة وان استنقذهم من ورطات الذل والفقر واملكهم ما يستغنون به عن الكد والتعب فقال له حمدان انقذني انقذك الله وافض علي من العلم ما يحببني به فما اشد احتياجي إلى مثل ما ذكرته فقال الداعي وما امرت بان اخرج السر المخزون لكل أحد إلا بعد الثقة به والعهد عليه فقال حمدان وما عهدك فاذكره لي فاني ملتزم له فقال الداعي ان تجعل لي وللإمام على نفسك عهد الله وميثاقه ان لا يخرج سر الإمام الذي ألقيته اليك ولا تفشي سري أيضا. فالتزم حمدان سره ثم اندفع الداعي في تعليمه فنون جهله حتى استدرجه واستغواه واستجاب له في جميع ما دعاه ثم انتدب حمدان للدعوة وصار اصلا من أصول هذه الدعوة فسمي أتباعه القرمطية.
وأما الخرمية فلقبوا بها نسبة لهم إلى حاصل مذهبهم وزبدته فانه راجع إلى طي بساط التكليف وحط أعباء الشرع عن المتعبدين وتسليط الناس على اتباع اللذات وطلب الشهوات وقضاء الوطر من المباحات والمحرمات وخرم لفظ اعجمي ينبئ عن الشئ المستلذ المستطاب الذي يرتاح الإنسان إليه بمشاهدته ويهتز لرؤيته وقد كان هذا لقبا للمزدكية وهم أهل الإباحة من المجوس الذين نبغوا في أيام قباذ وأباحوا النساء وان كن من المحارم وأحلوا كل محظور وكانوا يسمون خرمدينية فهؤلاء أيضا لقبوا بها لمشابهتهم اياهم في اخر المذهب وان خالفوهم في المقدمات وسوابق الحيل في الاستدراج وأما البابكية فاسم لطائفة منهم بايعوا رجلا يقال له بابك الخرمي وكان خروجه في بعض الجبال بناحية أذربيجان في أيام المعتصم بالله واستفحل أمرهم واشتدت شوكتهم وقاتهلم افشين صاحب حبس المعتصم مداهنا له في قتاله ومتخاذلا عن الجد في قمعه إضمارا لموافقته في ضلاله فاشتدت وطأة البابكية على جيوش المسلمين حتى مزقوا جند المسلمين وبددوهم منهزمين إلى أن هبت ريح النصر واستولى عليهم المعتصم المترشح للإمامة في ذلك العصر فصلب بابك وصلب أفشين بإزائه وقد بقي من البابكية جماعة يقال إن لهم ليلة يجتمع فيها رجالهم ونساؤهم ويطفئون سرجهم وشموعهم ثم يتناهبون النساء فيثب كل رجل إلى إمرأة فيظفر بها ويزعمون ان من استولى على امرأة استحلها بالاصطياد فإن الصيد من أطيب المباحات ويدعون مع هذه البدعة نبوة رجل كان من ملوكهم قبل الإسلام يقال له شروين ويزعمون أنه كان افضل من نبينا ﷺ ومن سائر الأنبياء قبله.
وأما الإسماعيلية فهي نسبى لهم إلى ان زعيمهم محمد بن إسماعيل ابن جعفر ويزعمون ان أدوار الإمامية انتهت به إذ كان هو السابع من محمد ﷺ وأدوار الإماميه سبعة سبعة عندهم فأكبرهم يثبتون له منصب النبوة وإن ذلك يستمر في نسبه وأعقابه وقد اورد أهل المعرفه بالنسب في كتاب الشجره أنه مات ولا عقب له وأما السبعيه فإنما لقبوا بها لأمرين أحدهما اعتقادهم أن أدوار الإمامة سبعة وأن الإنتهاء إلى السابع هو أخر الدور وهو المراد بالقيامة وأن تعاقب هذه الادوار لا آخر لها قط والثاني قولهم إن تدابير العالم السفلي اعني ما يحويه مقعر فلك القمر منوطة بالكواكب السبعة التي اعلاها زحل ثم المشتري ثم المريخ ثم الشمس ثم الزهرة ثم عطارد ثم القمر وهذا المذهب مسترق من ملحدة المنجمين وملتفت إلى مذهب الثنوية في أن النور يدبر اجزاؤه الممتزجة بالظلمة بهذه الكواكب السبعة فهذا سبب هذا التقليب.
وأما المحمرة فقيل انهم لقبوابه لانهم صبغوا الثياب بالحمرة أيام بابك ولبسوها وكان ذلك شعارهم وقيل سببه انهم يقررون ان كل من خالفهم من الفرق وأهل الحق حمير والأصح هو التأويل الأول.
وأما التعليمية فانهم لقبوا بها لأن مبدأ مذاهبهم إبطال الرأي وإبطال تصرف العقول ودعوة الخلق إلى التعليم من الإمام المعصوم وانه لا مدرك للعلوم إلا التعليم ويقولون في مبتدأ مجادلتهم الحق اما ان يعرف بالرأي وإما ان يعرف بالتعلم وقد بطل التعويل على الرأي لتعارض الاراء وتقابل الاهواء واختلاف ثمرات نظر العقلاء فتعين الرجوع إلى التعليم والتعلم وهذا اللقب هو الاليق بباطنية هذا العصر فان تعويلهم الاكثر على الدعوة إلى التعليم وإبطال الرأي وإيجاب اتباع الإمام المعصوم وتنزيله في وجوب التصديق والاقتداء به منزلة رسول الله ﷺ.
الفصل الثاني في بيان السبب الباعث لهم على نصب هذه الدعوة وإفاضة هذه البدعة
مما تطابق عليه نقلة المقالات قاطبة ان هذه الدعوة لم يفتتحها منتسب إلى ملة ولا معتقد لنحلة معتضد بنبوة فان مساقها ينقاد إلى الانسلال من الدين كانسلال الشعرة من العجين ولكن تشاور جماعة من المجوس والمزدكية وشرذمة من الثنوية الملحدين وطائفة كبيرة من ملحدة الفلاسفة المتقدمين وضربوا سهام الرأي في استنباط تدبير يخفف عنهم ما نابهم من استيلاء أهل الدين وينفس عنهم كربة ما دهاهم من أمر المسلمين حتى اخرسوا السنتهم عن النطق بما هو معتقدهم من إنكار الصانع وتكذيب الرسل وجحد الحشر والنشر والمعاد إلى الله في آخر الأمر وزعموا انا بعد أن عرفنا ان الانبياء كلهم ممخرقون ومنمسون فانهم يستعبدون الخلق بما يخيلونه اليهم فنون الشعبذة والزرق وقد تفاقم ام محمد واستطارت في الأقطار دعوته واتسعت ولايته واتسقت اسابه وشوكته حتى استولوا على ملك اسلافنا وانهمكوا في التنعم في الولايات مستحقرين عقولنا وقد طبقوا وجه الارض ذات الطول والعرض ولا مطمع في مقاومتهم بقتال ولا سبيل إلى استنزالهم عما اصروا عليه إلا بمكر واحتيال ولو شافهناهم بالدعاء إلى مذهبنا لتنمروا علينا وامتنعوا من الإصغاء الينا فسبيلنا ان ننتحل عقيدة طائفة من فرقهم هم اركهم عقولا واسخفهم رأيا وألينهم عريكة لقبول المحالات واطوعهم للتصديق بالأكاذيب المزخرفات وهم الروافض ونتحصن بالانتساب إليهم والاعتزاء إلى أهل البيت عن شرهم ونتودد اليهم بما يلائم طبعهم من ذكر ما تم على سلفهم من الظلم العظيم والذل الهائل ونتباكى لهم على ما حل بآل محمد ﷺ ونتوصل به إلى تطويل اللسان في أئمة سلفهم الذين هم أسوتهم وقدوتهم حتى إذا قبحنا أحوالهم في أعينهم وما ينقل إليهم شرعهم بنقلهم وروايتهم اشتد عليهم باب الرجوع إلى الشرع وسهل علينا استدراجهم إلى الانخلاع عن الدين وان بقي عندهم معتصم من ظواهر القرآن ومتواتر الأخبار أوهمنا عندهم ان تلك الظواهر لها أسرار وبواطن وان امارة الاحمق الانخداع بظواهرها وعلامة الفطنة اعتقاد بواطنها ثم نبث ايهم عقائدنا ونزعم انها المراد بظواهر القرآن ثم إذا تكثرنا بهؤلاء سهل علينا استدراج سائر الفرق بعد التحيز إلى هؤلاء والتظاهر بنصرهم.
ثم قالوا طريقنا ان نختار رجلا ممن يساعدنا على المذهب ونزعم انه من أهل البيت وانه يجب على كافة الخلق مبايعته وتتعين عليهم طاعته فانه خليفة رسول الله ومعصوم عن الخطأ والزلل من جهة الله تعالى. ثم لا نظهر هذه الدعوة على القرب من جوار الخليفة الذي وسمناه بالعصمة فان قرب الدار ربما يهتك هذه الاستار وإذا بعدت الشقة وطالت المسافة فمتى يقدر المستجيب إلى الدعوة ان يفتش عن حاله وان يطلع على حقيقة أمره ومقصدهم بذلك كله الملك والاستيلاء والتبسط في أموال المسلمين وحريمهم والانتقام منهم فيما اعتقدوا فيهم وعاجلوهم به من النهب والسفك وافاضوا عليهم من فنون البلاء.
فهذه غاية مقصدهم ومبدأ أمرهم ويتضح لك مصداق ذلك بمال سنجليه من خبائث مذهبهم وفضائح معتقدهم.
الباب الثالث في درجات حيلهم وسبب الاغترار بها مع ظهور فسادها
وفيه فصلان
الفصل الأول في درجات حيلهم
وقد نظموها على تسع درجات مرتبة ولكل مرتبة اسم اولها الزرق والتفرس ثم التأنيس ثم التشكيك ثم التعليق ثم الربط ثم التدليس ثم التلبيس ثم الخلع ثم السلخ ولنبين الآن تفصيل كل مرتبة من هذه المراتب ففي الاطلاع على هذه الحيل فوائد جمة لجماهير الأمة.
أما الزرق والتفرس فهو أنهم قالوا ينبغي أن يكون الداعي فطنا ذكيا صحيح الحدس صادق الفراسة متفطنا للبواطن بالنظر إلى الشمائل والظواهر وليكن قادرا على ثلاثة أمور الأول وهو اهمها ان يميز بين من يجوز ان يطمع في استدراجه ويوثق بلين عريكته لقبول ما يلقى إليه على خلاف معتقده فرب رجل جمود على ما سمعه لا يمكن ان ينتزع من نفسه ما يرسخ فيه فلا يضيعن الداعي كلامه مع مثل هذا وليقطع طمعه منه وليلتمس من فيه انفعال وتأثر بما يلقى إليه من الكلام وهم الموصوفون بالصفات التي سنذكرها في الفصل الذي يلي هذا الفصل. وينبغي ان نتقي بكل حال بث البذر في السبخ والدخول إلى بيت فيه سراج يعني به الزجر عن دعوة العباسية مد الله دولتهمم إرغاما لأنوف أعدائها فان ذلك لا ينغرس أبد الدهر في نفوسهم كما لا ينغرس البذر في الأرض السبخة بزعمهم ويزجرون أيضا عن دعوة الأذكياء من الفضلاء وذوي البصائر بطرق الجدال ومكامن الاحتيال وبه يعنون الزجر عن بيت فيه سراج.
الثاني أن يكون مشتعل الحدس ذكي الخاطر في تعبير الظواهر وردها إلى البواطن اما اشتقاقا من لفظها أو تلقيا من عددها أو تشبيها لها بما يناسبها وبالجملة فإذا لم يقبل المستجيب منه تكذيب القرآن والسنة فينبغي ان يستخرج من قلبه معناه الذي فهمه ويترك معه اللفظ منزلا على معنى يناسب هذه البدعة فانه لو شافهه بالتكذيب لم يقبل منه.
الثالث من الزرق والتفرس ألا يدعو كل أحد إلى مسلك واحد بل يبحث أولا عن معتقده وما إليه ميله في طبعه ومذهبه فاما طبعه فان رآه مائلا إلى الزهد والتقشف والتقوى والتنظف دعاه إلى الطاعة والانقياد واتباع الأمر من المطاع وزجره عن اتباع الشهوات وندبه إلى وظائف العبادات وتأدية الامانات من الصدق وحسن المعاملة والأخلاق الحسنة وخفض الجناح لذوي الحاجات ولزوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وان كان طبعه مائلا إلى المجون والخلاعة قرر في نفسه ان العبادة بله وان الورع حماقة وان هؤلاء المعذبين بالتكاليف مثالهم مثال الحمر المعناة بالأحمال الثقيلة وانما الفطنة في اتباع الشهوة ونيل اللذة وقضاء الوطر من هذه الدنيا المنقضية التي لا سبيل إلى تلافي لذاتها عند انقضاء العمر وأما حال المدعو من حيث المذهب فان كان من الشيعة فلنفاتحه بان الأمر كله في بغض بني تيم وبني عدي وبني امية وبني العباس وأشياعهم وفي التبري منهم ومن اتباعهم وفي تولي الأئمة الصالحين وفي انتظار خروج المهدي وان كان المدعو ناصبيا ذكر له ان الأمة انما اجمعت على أبي بكر وعمر ولا يقدم إلا من قدمته الأمة حتى إذا اطمأن إليه قلبه ابتدأ بعد ذلك يبث الأسرار على سبيل الاستدراج المذكور بعد وكذلك ان كان من اليهود والمجوس والنصارى حاوره بما يضاهي مذهبهم من معتقداته فان معتقد الدعاة ملتقط من فنون البدع والكفر فلا نوع من البدعة إلا وقد اختاروا منه شيئا ليسهل عليهم بذلك مخاطبة تلك الفرق على ما سنحكي من مذهبهم.
أما حيلة التأنيس فهو ان يوافق كل من هو بدعوته في أفعال يتعطاها هو ومن تميل إليه نفسه واول ما يفعل الانس بالمشاهدة على ما يوافق اعتقاد المدعو في شرعه وقد رسموا للدعاة والمأذونين ان يجعلوا مبيتهم كل ليلة عند واحد من المستجيبين ويجتهدون في استصحاب من له صوت طيب في قراءة القرآن ليقرأ عندهم زمانا ثم يتبع الداعي ذلك كله بشئ من الكلام الرقيق واطراف من المواعظ اللطيفة الآخذه بمجامع القلوب ثم يردف ذلك بالطعن في السلاطين وعلماء الزمان وجهال العوام ويذكر ان الفرج منتظر من كل ذلك ببركة أهل بيت رسول الله ﷺ وهو فيما بين ذلك يبكي احيانا ويتنفس الصعداء وإذا ذكر آية أو خبرا ذكر ان لله سرا في كلماته لا يطلع عليها إلا من اجتباه الله من خلقه وميزه بمزيد لطفه فان قدر على أن يتهجد بالليل مصليا وباكيا عند غيبة صاحب البيت بحيث يطلع عليه صاحب البيت ثم إذا احس بانه اطلع عليه عاد إلى مبيته واضطجع كالذي يقصد اخفاء عبادته وكل ذلك ليستحكم الانس به ويميل القلب إلى الاصغاء إلى كلامه فهذه هي مرتبة التأنيس.
وأما حيلة التشكيك فمعناه ان الداعي ينبغي له بعد التأنيس ان يجتهد في تغيير اعتقاد المستجيب بان يزلزل عقيدته فيما هو مصمم عليه وسبيله ان يبتدئه بالسؤال عن الحكمة في مقررات الشرائع وغوامض المسائل وعن المتشابه من الايات وكل ما لا ينقدح فيه معنى معقول فيقول في معنى المتشابه ما معنى الر وكهيعص وحم عسق إلى غير ذلك من اوائل السور ويقال أترى ان تعيين هذه الحروف جرى وفقا بسبق اللسان أو قصد تعيينها لاسرار هي مودعة تحتها لم تصادف في غيرها وما عندي ان ذلك يكون هزلا وعبثا بلا فائدة ويشكك في الأحكام. ما بال الحائض تقضي الصوم دون الصلاة ما بال الاغتسال يجب من المني الطاهر ولا يجب من البول النجس ويشككه في أخبار القرآن فيقول ما بال أبواب الجنة ثمانية وأبواب النار سبعة وما معنى قوله {ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية} وقوله تعالى: {عليها تسعة عشر} أفترى ضاقت القافية فلم يكمل العشرين أو جرى ذلك وفاقا بحكم سبق اللسان أو قصدا لهذا التقييد ليخيل أن تحته سرا وأنه في نفسه لسر ليس يطلع عليه إلا الأنبياء والأئمة الراسخون في العلم ما عندي أن ذلك يخلو عن سر وينفك من فائدة كامنة والعجب من غفلة الخلق عنها لا يثمرون عن ساق الجد في طلبها ثم يشككه في خلقة العالم وجسد الآدمي ويقول لم كانت السموات سبعا دون ان تكون ستة أو ثماني ولم كانت الكواكب السيارة سبعة والبروج اثني عشر ولم كان في رأس الآدمي سبع ثقب العينان والاذنان والمنخران والفم وفي بدنه ثقبان فقط ولم جعل رأس الآدمي على هيئة الميم ويداه إذا مدها على هيئة الحاء والعجز على هيئة الميم والرجلان على هيئة الدال بحيث إذا جمع الكل يشكل بصورة محمد أفترى أن فيه تشبيها ورمزا ما أعظم هذه العجائب وما أعظم غفلة الخلق عنها ولا يزال يورد عليه هذا الجنس حتى يشككه وينقدح في نفسه أن تحت هذه الظواهر أسرارا سدت عنه وعن أصحابه وينبعث منه شوق إلى طلبه وأما حيلة التعليق فبأن يطوي عنه جوانب هذه الشكوك إذا هو استكشفه عنها ولا ينفس عنه أصلا بل يتركه معلقا ويهول الأمر عليه ويعظمه في نفسه ويقول له لا تعجل فان الدين اجل من ان يبعث به أو ان يوضع في غير موضعه ويكشف لغير أهله هيهات هيهات!
جئتماني لتعلما سر سعدي ** تجداني بسر سعدي شحيحا
ثم يقول له لا تعجل ان ساعدتك السعادة سنبث اليك سر ذلك أما سمعت قول صاحب الشرع: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وهكذا لا يزال يسوقه ثم يدافعه حتى إن رآه أعرض عنه واستهان به وقال مالي ولهذا الفضول وكان لا يحيك في صدره حرارة هذه الشكوك قطع الطمع عنه وان رآه متعطشا إليه وعده في وقت معين وأمره بتقديم الصوم والصلاة والتوبة قبله وعظم أمر هذا السر المكتوم حتى إذا وافى الميعاد قال له ان هذه الأسرار مكتومة لا تودع إلا في سر محصن فحصن حرزك واحكم مداخله حتى اودعه فيه فيقول المستجيب وما طريقه فيقول ان آخذ عهد الله وميثاقه على كتمان هذا السر ومراعاته عن التضييع فانه الدر الثمين والعلق النفيس وادنى درجات الراغب فيه صيانته عن التضييع وما اودع الله هذه الأسرار أنبياءه إلا بعد أخذه عهدهم وميثاقهم وتلا قوله تعالى: {وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح} الاية وقال تعالى: {من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه} وقال تعالى: {ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها} وأما النبي ﷺ فلم يفشه إلا بعد أخذ العهد على الخلفاء واخذ البيعة على الانصار تحت الشجرة فان كنت راغبا فاحلف لي على كتمانه وانت بالخيرة بعده فان وفقت لدرك حقيقته سعدت سعادة عظيمة وان اشمأزت نفسك عنه فلا غرو فان كلا ميسر لما خلق له ونحن نقدر كانك لم تسمع ولم تحلف ولا ضير عليك في يمين صادقة فان أبى الحلف خلاه وإن انعم وأجاب فيه وجه الحلف واستوفاه.
وأما حيلة الربط فهو ان يربط لسانه بأيمان مغلظة وعهود مؤكدة لا يجسر على المخالفة لها بحال وهذه نسخة العهد:
يقول الداعي للمستجيب: جعلت على نفسك عهد الله وميثاقه وذمة رسوله عليه السلام وما أخذ الله على النبيين من عهد وميثاق أنك تسر ما سمعته مني وتسمعه وعلمته وتعلمه من أمري وأمر المقيم بهذه البلدة لصاحب الحق الإمام المهدي وأمور إخوانه وأصحابه وولده وأهل بيته وأمور المطيعين له على هذا الدين ومخالصة المهدي ومخالصة شيعته من الذكور والإناث والصغار والكبار ولا تظهر من ذلك قليلا ولا كثيرا تدل به عليه إلا ما أطلقت لك أن تتكلم به أو اطلق لك صاحب الأمر المقيم في هذا البلد أو غيره فتعمل حينئذ بمقدار ما نرسمه لك ولا تتعداه جعلت على نفسك الوفاء بما ذكرته لك وألزمته نفسك في حال الرغبة والرهبة والغضب والرضا وجعلت على نفسك عهد الله وميثاقه أن تتبعني وجميع من أسميه لك وأبينه عندك مما تمنع منه نفسك وان تنصح لنا وللإمام ولي الله نصحا ظاهرا وباطنا وألا تخون الله ولا وليه ولا أحدا من إخوانه وأوليائه ومن يكون منه ومنا بسبب من أهل ومال ونعمة وانه لا رأي ولا عهد تتناول على هذا العهد بما يبطله. فان فعلت شيئا من ذلك وانت تعلم انك قد خالفته فانت برئ من الله ورسله الأولين والآخرين ومن ملائكته المقربين ومن جميع ما انزل من كتبه على انبيائه السابقين وانت خارج من كل دين وخارج من حزب الله وحزب اوليائه وداخل في حزب الشيطان وحزب اوليائه وخذلك الله خذلانا بينا يعجل لك بذلك النقمة والعقوبة ان خالفت شيئا مما حلفتك عليه بتأويل أو بغير تأويل فان خالفت شيئا من ذلك فلله عليك ان تحج إلى بيته ثلاثين حجة نذرا واجبا ماشيا حافيا وان خالفت ذلك فكل ما تملكه في الوقت الذي تحلف فيه صدقة على الفقراء والمساكين الذين لا رحم بينك وبينهم وكل مملوك يكون لك في ملكك يوم تخالف فيه فهم أحرار وكل امرأة تكون لك أو تتزوجها في قابل فهي طالق ثلاثا بتة ان خالفت شيئا من ذلك وان نويت أو اضمرت في يميني هذه خلاف ما قصدت فهذه اليمين من أولها إلى آخرها لازمة لك والله الشاهد على صدق نيتك وعقد ضميرك وكفى بالله شهيدا بيني وبينك، قل: نعم، فيقول نعم. فهذا هو الربط.
وأما حيلة التدليس فهو انه بعد اليمين وتأكيد العهد لا يسمح ببث الأسرار إليه دفعة واحدة ولكن يتدرج فيه ويراعى أمورا الأول انه يقتصر في أول وهلة على ذكر قاعدة المذهب ويقول منار الجهل تحكيم الناس عقولهم الناقصة وآرائهم المتناقضة واعراضهم عن الاتباع والتلقي من اصفياء الله وائمته واوتاد أرضه والذين هم خلفاء رسوله من بعده فمنهم الذي اودعه الله سره المكنون ودينه المخزون وكشف لهم بواطن هذه الظواهر واسرار هذه الامثلة وان الرشد والنجاة من الضلال بالرجوع إلى القران وأهل البيت ولذلك قال عليه السلام لماقيل ومن أين يعرف الحق بعدك فقال الم اترك فيكم القرآن وعترتي وأراد به اعقابه فهم الذين يطلعون على معاني القرآن ويقتصر في أول وهلة على هذا القدر ولا يفصح عن تفصيل ما يقوله الإمام.
الثاني ان يحتال لإبطال المدرك الثاني من مدارك الحق وهو ظواهر القرآن فان طالب الحق إما أن يفزع إلى التفكر والتأمل والنظر في مدارك العقول كما أمر الله سبحانه وتعالى به فيفسد نظر العقل عليه بإيجاب التعلم والاتباع أو يفزع إلى ظواهر القرآن والسنة ولو صرح له بانه تلبيس ومحدث لم يسمع منه فليسلم له لفظه ولينزع عن قلبه معناه بان يقول هذا الظاهر له باطن هو اللباب والظاهر قشر بالاضافة إليه يقنع به من تقاعد به القصور عن درك الحقائق حتى لا يبقى له معتصم من عقل ومستروح من نقل.
الثالث ألا يظهر من نفسه انه مخالف للأمة كلهم وانه منسلخ عن الدين والنحلة إذ تنفر القلوب عنه ولكن يعتزي إلى ابعد الفرق عن المسلك المستقيم وأطوعهم لقبول الخرافات ويتستر بهم ويتجمل بحب أهل البيت وهم الروافض.
الرابع هو أن يقدم في أول كلامه أن الباطل ظاهر جلي والحق دقيق بحيث لو سمعه الأكثرون لأنكروه ونفروا عنه وان طلاب الحق والقائلين به من بين طلاب الجهل أفراد وآحاد ليهون عليه التميز عن العامة في إنكار نظر العقل وظواهر ما ورد به النقل.
الخامس إن رآه نافرا عن التفرد عن العامة فيقول له إني مفش إليك سرا وعليك حفظه فإذا قال نعم قال إن فلانا وفلانا يعتقدون هذا المذهب ولكنهم يسرونه ويذكر له من الأفاضل من يعتقد المستجيب فيه الذكاء والفطنة وليكن ذلك المذكور بعيدا عن بلده حتى لا يتيسر له المراجعة كما جعلوا الدعوة بعيدة عن مقر امامهم ووطنه فانهم لو أظهروها في جواره لافتضحوا بما يتواتر من أخباره وأحواله.
السادس ان يمنيه بظهور شوكة هذه الطائفة وانتشار أمرهم وعلو رأيهم وظفر ناصريه بأعدائهم واتساع ذات يدهم ووصول كل واحد منهم إلى مراده حتى تجتمع لهم سعادة الدنيا والآخرة ويعزى بعض ذلك إلى النجوم وبعضه إلى الرؤيا في المنام إن امكنه وضع منامات تنتهي إلى المستجيب على لسان غيره.
السابع ألا يطول الداعي إقامته ببلد واحدة فانه ربما اشتهر أمره وسفك دمه فينبغي ان يحتاط في ذلك فيلبس على الناس أمره ويتعرف إلى كل قوم باسم واخر وليغير في بعض الاوقات هيئته ولبسته خوف الآفات ليكون ذلك ابلغ في الاحتياط.
ثم بعد هذه المقدمات يتدرج قليلا قليلا في تفصيل المذهب للمستجيب وذكره له على ما سنحكي من معتقده.
وأما حيلة التلبيس فهو ان يواطئه على مقدمات يتسلمها منه مقبولة الظاهر مشهورة عند الناس ذائعة ويرسخ ذلك في نفسه مدة ثم يستدرجه منها بنتائج باطلة كقوله ان أهل النظر لهم أقاويل متعارضة الأحوال متساوية وكل حزب بما لديهم فرحون والمطلع على الجوهر الله ولا يجوز أن يخفي الله الحق ولا يوجد أحد كل الأمر إلى الخلق يتخبطون فيه خبط العشواء ويقتحمون فيه العماية العمياء إلى غير ذلك من مقدمات يت... مستعضلة.
وأما حيلة الخلع والسلخ وهي هما متفقان وانما يفترقان في أن الخلع يختص بالعمل فإذا أفضوا بالمستجيب إلى ترك حدود الشرع وتكاليفه يقولون وصلت إلى درجة الخلع أما السلخ فيختص بالاعتقاد الذي هو خلع الدين فإذا انتزعوا ذلك من قلبه دعوا ذلك سلخا. وسميت هذه الرتبة البلاغ الأكبر.
فهذا تفصيل تدريجهم الخلق واستغوائهم. فلينظر الناظر فيه وليستغفر الله من الضلال في دينه.
الفصل الثاني في بيان السبب في رواج حيلتهم وانتشار دعوتهم مع ركاكة حجتهم وفساد طريقتهم.
فإن قيل ما جليتموه من العظائم لا يتصور ان يخفى على عاقل وقد رأينا خلقا كثيرا وجما غفيرا من الناس يتابعونهم في معتقدهم وتابعوهم في دينهم فلعلكم ظلمتموهم بنقل هذه المذاهب عنهم في خلاف ما يعتقدونه. وهذا هو القريب الممكن فانهم لو أظهروا هذه الأسرار نفرت القلوب عنهم واطلعت النفوس على مكرهم وما باحوا بها إلا بعد العهود والمواثيق وصانوها إلا عن موافق لهم في الاعتقاد فمن اين وقع لكم الاطلاع عليها وهم يسترون ديانتهم ويستنبطون بعقائدهم قلت أما الإطلاع على ذلك فانما عثرنا عليه من جهة خلق كثير تدينوا بدينهم واستجابوا لدعوتهم ثم تنبهوا لضلالهم فرجعوا عن غوايتهم إلى الحق المبين فذكروا ما ألقوا اليهم من الأقاويل واما سبب انقياد الخلق اليهم في بعض أقطار الأرض فانهم لا يفشون هذا الأمر إلا إلى بعض المستجيبين لهم ويوصون الداعي ويقولون له إياك ان تسلك بالجميع مسلكا واحدا فليس كل من يحتمل قبول هذه المذاهب يحتمل الخلع والسلخ ولا كل من يحتمل الخلع يحتمل السلخ فليخاطب الداعي الناس على قدر عقولهم. فهذا هو السبب في تعلق هذه الحيل ورواجها.
فإن قيل هذا أيضا مع الكتمان ظاهر البطلان فكيف ينخدع بمثله عاقل قلنا لا ينخدع به إلا المائلون عن اعتدال الحال واستقامة الرأي فللعقلاء عوارض تعمى عليهم طرق الصواب وتقضي عليهم بالانخداع بلامع السراب وهي ثمانية أصناف.
الصنف الأول طائفة ضعفت عقولهم وقلت بصائرهم وسخفت في أمور الدين آراؤهم لما جبلوا عليه من البله والبلادة مثل السواد وأفجاج العرب والأكراد وجفاة الأعاصم وسفهاء الأحداث ولعل هذا الصنف هم أكبر الناس عددا وكيف يستبعد قبولهم لذلك ونحن نشاهد جماعة في بعض المدائن القريبة من البصرة يعبدون أناسا يزعمون أنهم ورثوا الربوبيه من آبائهم المعروفين بالشباسية وقد اعتقدت طائفة في علي رضي الله عنه انه إله السموات والارض رب العالمين وهم خلق كثير لا يحصرهم عدد ولا يحويهم بلد فلا ينبغي أن يكثر التعجب من جهل الإنسان إذا استحوذ عليه الشيطان واستولى عليه الخذلان.
الصنف الثاني طائفة انقطعت الدولة عن أسلافهم بدولة الإسلام كأبناء الأكاسرة والدهاقين وأولاد المجوس المستطيلين فهؤلاء موتورون قد استكن الحقد في صدورهم كالداء الدفين فإذا حركته تخاييل المبطلين اشتعلت نيرانه في صدورهم فأذعنوا لقبول كل محال تشوقا إلى درك ثأرهم وتلافي أمورهم.
الصنف الثالث طائفة لهم همم طامحة إلى العلياء متطلعة إلى التسلط والاستيلاء إلا انه ليس يساعدهم الزمان بل يقصر بهم عن الأتراب والأقران طوارق الحدثان فهؤلاء إذا وعدوا بنيل امانيهم وسول لهم الظفر بأعاديهم سارعوا إلى قبول ما يظنونه مفضيا إلى مآربهم وسالكا إلى أوطارهم ومطالبهم فلطالما قيل حبك الشيئ يعمي ويصم ويشترك في هذا كل من دهاه من طبقة الإسلام آمر يلم به وكان لا يتوصل إلى الانتصار ودرك الثأر إلا بالاستظهار بهؤلاء الاغبياء الأغمار فتتوفر دواعيه على قبول ما يرى الأمنية فيه.
الصنف الرابع طائفة جبلوا على حب التميز عن العامة والتخصص عنهم ترفعا عن مشابهتهم وتشرفا بالتحيز إلى فئة خاصة تزعم انها مطلعة على الحقائق وان كافة الخلق في جهالتهم كالحمر المستنفرة والبهائم المسيبة وهذا هو الداء العضال المستولي على الأذكياء فضلا عن الجهال الاغبياء وكل ذلك حب للنادر الغريب ونفرة عن الشائع المستفيض وهذه سجية لبعض الخلق على ما شهدت به التجربة وتدل عليه المشاهدة.
الصنف الخامس طائفة سلكوا طرق النظر ولم يستكملوا فيه رتبة الاستقلال وان كانوا قد ترقوا عن رتبة الجهال فهم أبدا متشوقون إلى التكاسل والتغافل وإظهار التفطن لدرك أمور تتخيل العامه بعدها وينفرون عنها لا سيما إذا نسب الشئ إلى مشهور بالفضل فيغلب على الطبع التشوق إلى التشبه به فكم من طوائف رأيتهم اعتقدوا محض الكفر تقليدا لافلاطن وأرسططاليس وجماعة من الحكماء قد اشتهروا بالفضل وداعيهم إلى ذلك التقليد وحب التشبه بالحكماء والتحيز إلى غمارهم والتحيز عمن يعتقد انه في الذكاء والفضل دونهم فهؤلاء يستجرون إلى هذه البدعة بإضافتها إلى من يحسن اعتقاد المستجيب فيه فيبادر إلى قبوله تشفعا بالتشبه بالذي ذكر انه من منتحليه.
الصنف السادس طائفة اتفق نشؤوهم بين الشيعة والروافض واعتقدوا التدين بسب الصحابة ورأوا هذه الفرقة تساعدهم عليها فمالت نفوسهم إلى المساعدة لهم والاستئناس بهم وانجرت معهم إلى ما وراء ذلك من خصائص مذهبهم.
الصنف السابع طائفة من ملحدة الفلاسفة والثنوية والمتحيرة في الدين اعتقدوا أن الشرائع نواميس مؤلفة وان المعجزات مخاريق مزخرفة فإذا رأوا هؤلاء يكرمون من ينتمي إليهم ويفيضون ذخائر الأموال عليهم انتدبوا لمساعدتهم طلبا لحطام الدنيا واستحقارا لامر العقبى وهذه الطائفة هم الذين لفقوا لهم الشبه وزينوا لهم بطريق التمويه الحجج وسووها على شروط الجدل وحدود المنطق من حيث الظاهر وغبوا مكامن التلبيس والمغالطة فيها تحت ألفاظ مجملة وعبارات كلية مبهمة قلما يهتدي الناظر الضعيف إلى فك تعقيدها وكشف الغطاء عن مكمن تدليسها على ما سنورد ما لفقوه وننبه على المسلك الذي سلكوه ونهجوه ونكشف عن فساده من عدة وجوه.
الصنف الثامن طائفة استولت عليهم الشهوات فاستدرجتهم متابعة اللذات واشتد عليهم وعيد الشرع وثقلت عليهم تكاليفه فليس يتهنأ عيشهم إذا قرفوا بالفسق والفجور وتوعدوا بسوء العاقبة في الدار الآخرة فإذا صادفوا من يفتح لهم الباب ويرفع عنهم الحجز والحجاب ويحسن لهم ما هم مستحسنون له بالطبع تسارعوا إلى التصديق بالرغبة والطوع وكل انسان مصدق لما يوافق هواه ويلائم غرضه ومناه فهؤلاء ومن يجري مجراهم هم الذين عدموا التوفيق فانخدعوا بهذه المخاريق وزاغوا عن سواء الطريق وحدود التحقيق.
الباب الرابع في نقل مذاهبهم جملة وتفصيلا
أما الجملة فهو أنه مذهب ظاهره الرفض وباطنه الكفر المحض ومفتتحه حصر مدارك العلوم في قول الإمام المعصوم وعزل العقول عن أن تكون مدركة للحق لما يعتريها من الشبهات ويتطرق إلى النظار من الاختلافات وإيجاب لطلب الحق بطريق التعليم والتعلم وحكم بان المعلم المعصوم هو المستبصر وانه مطلع من جهة الله على جميع أسرار الشرائع يهدي إلى الحق ويكشف عن المشكلات وان كل زمان فلا بد فيه من امام معصوم يرجع إليه فيما يستبهم من أمور الدين.
هذا مبدأ دعوتهم ثم انهم بالآخرة يظهرون ما يناقض الشرع وكأنه غاية مقصدهم لان سبيل دعوتهم ليس بمتعين في فن واحد بل يخاطبون كل فريق بما يوافق رأيه بعد أن يظفروا منهم بالانقياد لهم والموالاة لامامهم فيوافقون اليهود والنصارى والمجوس على جملة معتقداتهم ويقرونهم عليها فهذه جملة المذاهب.
وأما تفصيله فيتعلق بالإلهيات والنبوات والإمامة والحشر والنشر. وهذه أربعة أطراف وأنا مقتصر في كل طرف على نبذة يسيرة من حكاية مذهبهم فإن النقل عنهم مختلف وأكثر ما حكي عنهم إذا عرض عليهم أنكروه وإذا روجع فيه الذين استجابوا لدعوتهم جحدوه والذي قدمناه في جملة مذهبهم يقتضي لا محالة ان يكون النقل عنهم مختلفا مضطربا فانهم لا يخاطبون الخلق بمسلك واحد بل غرضهم الاستتباع والاحتيال فلذلك تختلف كلمتهم ويتفاوت نقل المذهب عنهم فان ما حكي عنهم في الخلع والسلخ لا يظهرونه إلا مع من بلغ الغاية القصوى بل ربما يخاطبون بالخلع من ينكرون معه السلخ فلنرجع إلى بيان أطراف المذهب.
الطرف الأول في معتقدهم في الإلهيات
وقد اتفقت أقاويل نقله المقالات من غير تردد انهم قائلون بإلهين قديمين لا أول لوجودهما من حيث الزمان إلا ان أحدهما علة لوجود الثاني واسم العلة السابق واسم المعلول التالي وان السابق خلق العالم بواسطة التالي لا بنفسه وقد يسمى الأول عقلا والثاني نفسا ويزعمون ان الأول هو التام بالفعل والثاني بالاضافة إليه ناقص لانه معلوله وربما لبسوا على العوام مستدلين بآيات من القرآن عليه كقوله تعالى: {إنا نحن نزلنا} و {نحن قسمنا} وزعموا ان هذه إشارة إلى جمع لا يصدر عن واحد ولذلك قال {سبح اسم ربك الأعلى} إشارة إلى السابق من الالهين فانه الاعلى ولولا ان معه إلها آخر له العلو أيضا لما انتظم إطلاق الأعلى وربما قالوا الشرع سماهما باسم القلم واللوح والأول هو القلم فان القلم مفيد واللوح مستفيد متأثر والمفيد فوق المستفيد وربما قالوا اسم التالي قدر في لسان الشرع وهو الذي خلق الله به العالم حيث قال {إنا كل شيء خلقناه بقدر} ثم قالوا السابق لا يوصف بوجود ولا عدم فان العدم نفى والوجود سببه فلا هو موجود ولا هو معدوم ولا هو معلوم ولا هو مجهول ولا هو موصوف ولا غير موصوف وزعموا أن جميع الأسامي منتفية عنه وكأنهم يتطلعون في الجملة لنفي الصانع فانهم لو قالوا إنه معدوم لم يقبل منهم بل منعوا الناس من تسميته موجودا وهو عين النفي مع تعيير العبارة لكنهم تحذقوا فسموا هذا النفي تنزيها وسموا مناقضه تشبيها حتى تميل القلوب إلى قبوله ثم قالوا العالم قديم أي وجوده ليس مسبوقا بعدم زماني بل حدث من السابق التالي وهو أول مبدع وحدث من المبدع الأول النفس الكلية الفاشية جزئياتها في هذه الابدان المركبة وتولد من حركة النفس الحرارة ومن سكونها البرودة ثم تولد منهما الرطوبة واليبوسة ثم تولدت من هذه الكيفيات الاستقصات الأربع وهي النار والهواء والماء والأرض ثم إذا امتزجت على اعتدال ناقص حدثت منها المعادن فإن زاد قربها من الاعتدال وانهدم صرفية التضاد منها تولد منها النبات وان زاد تولد الحيوان فان ازداد قربا تولد الإنسان وهو منتهى الاعتدال.
فهذا ما حكي من مذهبهم إلى أمور اخر هي أفحش مما ذكرناه لم نر تسويد البياض بنقلها ولا تبيان وجه الرد عليها لمعنيين أحدهما أن المنخدعين بخداعهم وزورهم والمتدلين بحبل غرورهم في عصرنا هذا لم يسمعوا هذا منهم فينكرون جميع ذلك إذا حكي من مذهبهم ويحدثون في أنفسهم أن هؤلاء انما خالفوا لانه ليس عندهم حقيقة مذهبنا ولو عرفوها لوافقونا عليها فنرى ان نشتغل بالرد عليهم فيما اتفقت كلمتهم وهو إبطال الرأي والدعوة إلى التعلم من الإمام المعصوم فهذه عمدة معتقدهم وزبدة مخضهم فلنصرف العناية إليه وما عداه فمنسقم إلى هذيان ظاهر البطلان وإلى كفر مسترق من الثنوية والمجوس في القول بالالهين مع تبديل عبارة النور والظلمة ب السابق والتالي إلى ضلال منتزع من كلام الفلاسفة في قولهم ان المبدأ الأول علة لوجود العقل على سبيل اللزوم عنه لا على سبيل القصد والاختيار وانه حصل من ذاته بغير واسطة سواه نعم يثبتون موجودات قديمة يلزم بعضها عن بعض ويسمونها عقولا ويحيلون وجود كل فلك على عقل من تلك العقول في خبط لهم طويل قد استقصينا وجه الرد عليهم في ذك في فن الكلام ولسنا نشتغل في هذا الكتاب إلا يما يخص هذه الفرقة وهو إبطال الرأي وإثبات التعليم.
الطرف الثاني في بيان معتقدهم في النبوات
والمنقول عنهم قريب من مذهب الفلاسفة وهو أن النهي عبارة عن شخص فاضت عليه من السابق بواسطة التالي قوة قدسية صافية مهيأة لأن تنتقش عند الاتصال بالنفس الكلية بما فيها من الجزئيات كما قد يتفق ذلك لبعض النفوس الزكية في المنام حتى تشاهد من مجاري الأحوال في المستقبل إما صريحا بعينه أو مدرجا تحت مثال يناسبه مناسبة ما فتفتقر فيه إلى التعبير إلا أن النبي هو المستعد لذلك في اليقظة فلذلك يدرك النبي الكليات العقلية عند شروق ذلك النور وصفاء القوة النبوية كما ينطبع مثال المحسوسات في القوة الباصرة من العين عند شروق نور الشمس على سطوح الأجرام السفلية وزعموا أن جبريل عبارة عن العقل الفائض عليه ورمز إليه لا انه شخص متجسم متركب عن جسم لطيف أو كثيف يناسب المكان حتى ينتقل من علو إلى سفل واما القرآن فهو عندهم تعبير محمد عن المعارف التي فاضت عليه من العقل الذي هو المراد باسم جبريل ويسمى كلام الله تعالى مجازا فانه مركب من جهته وانما الفائض عليه من الله بواسطة جبريل بسيط لا تركيب فيه وهو باطن لا ظهور له وكلام النبي وعبارته عنه ظاهر لا بطون له وزعموا ان هذه القوة القدسية الفائضة على النبي لا تستكمل في أول حلولها كما لا تستكمل النطفة الحالة في الرحم إلا بعد تسعة أشهر فكذلك هذه القوة كمالها في أن تنتقل من الرسول الناطق إلى الاساس الصامت وهكذا تنتقل إلى أشخاص بعضهم بعد بعض فيكمل في السابع كما سنحكي معنى قولهم في الناطق والاساس والصامت.
وهذه المذاهب مستخرجة من مذاهب الفلاسفة في النبوات مع تحريف وتغيير ولسنا نخوض في الرد عليهم فيه فإن بعضهم يمكن أن يتأول على مجه لاننكره والقدر الذي ننكره قد استقصينا وجه الرد فيه على الفلاسفة ولسنا في هذا الكتاب نقصد إلا الرد على نابغة الزمان في خصوص مذهبهم الذي انفردوا به عن غيرهم وهو إيجاب التعليم وإبطال الرأي.
الطرف الثالث بيان معتقدهم في الإمامة
وقد اتفقوا على أنه لا بد في كل عصر من إمام معصوم قائم بالحق يرجع إليه في تأويل الظواهر وحل الإشكالات في القرآن والأخبار والمعقولات واتفقوا على أنه المتصدي لهذا الأمر وان ذلك جار في نسبهم لا ينقطع أبد الدهر ولا يجوز أن ينقطع إذ يكون فيه إهمال الحق وتغطيته على الخلق وإبطال قوله عليه السلام كل سبب ونسب ينقطع إلا سببي ونسبي وقوله ألم أترك فيكم القرآن وعترتي واتفقوا على أن الإمام يساوي النبي في العصمة والاطلاع على حقائق الحق في كل الأمور إلا انه لا ينزل إليه الوحي وانما يتلقى ذلك من النبي فانه خليفته وبإزاء منزلته ولا يتصور في زمان واحد امامان كما لايتصور نبيان تختلف شريعتهما نعم يستظهر الإمام بالحجج والمأذونين والاجنحة والحجج هم الدعاة فقالوا لا بد للإمام في كل وقت من اثنى عشر حجة ينتدبون في الأقطار متفرقين في الأمصار وليلازم أربعة من جملة الاثنى عشر حضرته فلا يفارقونه ولا بد لكل حجة من معاونين له على أمره فانه لا ينفرد بالدعوة بنفسه واسم المعاون المأذون عندهم ولا بد للدعاة من رسل إلى الإمام يرفعون إليه الأحوال ويصدرون عنه اليهم واسم الرسول الجناح. ولا بد للداعي من أن يكون بالغا في العلم والمأذون وإن كان دونه فلا بأس بعد أن يكون عالما على الجملة وكذلك الجناح.
ثم انهم قالوا كل نبي لشريعته مدة فإذا انصرمت مدته بعث الله نبيا آخر ينسخ شريعته ومدة شريعة كل نبي سبعة أعمار وهو سبعة قرون فأولهم هو النبي الناطق ومعنى الناطق أن شريعته ناسخة لما قبله. ومعنى الصامت ان يكون قائما على ما أسسه غيره ثم أنه يقوم بعد وفاته ستة أئمة إمام بعد إمام فإذا انقضت أعمارهم ابتعث الله نبيا أخر ينسخ الشريعة المتقدمة وزعموا أن أمر آدم جرى على هذا المثال وهو أول نبي ابتعثه الله في فتح باب الجسمانيات وحسم دور الروحانيات. ولكل نبي سوس والسوس هو الباب إلى علم النبي في حياته والوصي بعد وفاته والإمام لمن هو في زمانه كما قال عليه السلام أنا مدينة العلم وعلي بابها وزعموا أن آدم كان سوسة شيث وهو الثاني ويسمى من بعده متما ولاحقا وإماما وإنما كان استتمام دور آدم سبعة لان استتمام دور العالم العلوي بسبعة من النجوم ولما استتم دور آدم ابتعث الله نوحا ينسخ شريعته وكان سوسه سام فلما استتم دوره بمضي ستة سواه وسبعة معه ابتعث الله إبراهيم ينسخ شريعته وكان سوسه اسحق ومنهم من يقول لا بل أسماعيل فلما استتم دوره بالسابع معه ابتعث الله موسى ينسخ شريعته وكان سوسه هارون فمات هارون في حياة موسى فصار سوسه يوشع بن نون فلما استتم دوره بالسابع معه ابتعث الله عيسى ينسخ شريعته وسوسه شمعون ولما استتم دوره بالسابع ابتعث الله محمدا ﷺ وسوسه علي عليه السلام وقد استتم دوره بجعفر بن محمد فإن الثاني من الأئمة الحسن بن علي والثالث الحسين بن علي والرابع علي بن الحسين والخامس محمد بن علي والسادس جعفر بن محمد عليه السلام وقد استتموا سبعة معه وصارت شريعته ناسخة وهكذا يدور الأمر أبد الدهر.
هذا ما نقل عنهم مع خرافات كثيرة أهملنا ذكرها ضنة بالبياض أن يسود بها.
الطرف الرابع بيان مذهبهم في القيامة والمعاد
وقد اتفقوا عن آخرهم على إنكار القيامة وان هذا النظام المشاهد في الدنيا من تعاقب الليل والنهار وحصول الإنسان من نطفة والنطفة من انسان وتولد النبات وتولد الحيوانات لا يتصرم أبدا الدهر وان السموات والأرض لا يتصور انعدام اجسامهما وأولوا القيامة وقالوا إنها رمز إلى خروج الإمام وقيام قائم الزمان وهو السابع الناسخ للشرع المغير للأمر وربما قال بعضهم ان للفلك أدوارا كلية تتبدل أحوال العالم تبدلا كليا بطوفان عام أو سبب من الأسباب فمعنى القيامة انقضاء دورنا الذي نحن فيه واما المعاد فانكروا ما ورد به الأنبياء ولم يثبتوا الحشر والنشر للاجساد ولا الجنة والنار ولكن قالوا معنى المعاد عود كل شئ إلى أصله والإنسان متركب من العالم الروحاني الجسماني اما الجسماني منه وهو جسده فمتركب من الاخلاط الأربعة الصفراء والسوداء والبلغم والدم فينحل الجسد ويعود كل خلط إلى الطبيعة العالية أما الصفراء فتصير نارا وتصير السوداء ترابا ويصير الدم هواء ويصير البلغم ماء وذلك هو معاد الجسد وأما الروحاني وهو النفس المدركة العاقلة من الإنسان فانها ان صفيت بالمواظبة على العبادات وزكيت بمجانبة الهوى والشهوات وغذيت بغذاء العلوم والمعارف المتلقاة من الأئمة الهداة اتحدت عند مفارقة الجسم بالعالم الروحاني الذي منه انفصالها وتسعد بالعود إلى وطنها الأصلي ولذلك سمي رجوعا فقيل {ارجعي إلى ربك راضية مرضية} وهي الجنة وإليه وقع الرمز بقصة آدم وكونه في الجنة ثم انفصاله عنها ونزوله إلى العالم السفلاني ثم عوده اليها بالآخرة وزعموا ان كمال النفس بموتها إذ به خلاصها من ضيق الجسد والعالم الجسماني كما أن النطفة في الخلاص من ظلمات الرحم والخروج إلى فضاء العالم والإنسان كالنطفة والعالم كالرحم والمعرفة كالغذاء فإذا نفذت فيه صارت بالحقيقة كاملة وتخلصت فإذا استعدت لفيض العلوم الروحانية باكتساب العلوم من الأئمة وسلوك طرقها المفيدة بإرشادهم استكملت عند مفارقة الجسد وظهر لها ما لم يظهر ولذلك قال عليه السلام الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا وكلما ازدادت النفس عن عالم الحسيات بعدا ازدادت للعلوم الروحانية استعدادا وكذلك إذا ركدت الحواس بالنوم اطلعت على عالم الغيب واستشعرت ما سيظهر في المستقبل إما بعينه فيغنى عن المعبر أو بمثال فيحتاج إلى التعبير فالنوم اخو الموت وفيه يظهر علم ما لم يكن في اليقظة فكذا الموت تنكشف أمور لم تخطر على قلب بشر في الحياة وهذا للنفوس التي قدستها الرياضة العملية والعلمية فأما النفوس المنكوسة المغمورة في عالم الطبيعة المعرضة عن رشدها من الأئمة المعصومين فانها تبقى أبد الدهر في النار على معنى انها تبقى في العالم الجسماني تتناسخها الأبدان فلا تزال تتعرض فيها للألم والاسقام فلا تفارق جسدا إلا ويتلقاها آخر ولذلك قال تعالى: {كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب} فهذا مذهبهم في المعاد وهو بعينه مذهب الفلاسفة وانما شاع فيهم لما انتدب لنصرة مذهبهم جماعة من الثنوية والفلاسفة فكل واحد نصر مذهبهم طمعا في أموالهم وخلعهم واستظهارا باتباعهم لما كان قد ألفه في مذهبه فصار أكثر مذهبهم موافقا للثنوية والفلاسفة في الباطن وللروافض والشيعة في الظاهر وغرضهم بهذه التأويلات انتزاع المعتقدات الظاهرة عن نفوس الخلق حتى تبطل به الرغبة والرهبة ثم ما اوهموه وهذوا به لا يفهم في نفسه ولا يؤثر في ترغيب وترهيب وسنشير إلى كلام وجيز في الرد عليهم في هذا الفن وأخباره في آخر الفصل.
الطرف الخامس في اعتقادهم في التكاليف الشرعية
والمنقول عنهم الإباحة المطلقة ورفع الحجاب واستباحة المحظورات واستحلالها وإنكار الشرائع إلا انهم بأجمعهم ينكرون ذلك إذا نسب اليهم وانما الذي يصح من معتقدهم فيه انهم يقولون لا بد من الانقياد للشرع في تكاليفه على التفصيل الذي يفصله الإمام من غير متابعة الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما وان ذلك واجب على الخلق والمستجيبين إلى ان ينالوا رتبة الكمال في العلوم فإذا أحاطوا من جهة الإمام بحقائق الأمور واطلعوا على بواطن هذه الظواهر انحلت عنهم هذه القيود وانحطت عنهم هذه التكاليف العملية فان المقصود من أعمال الجوارج تنبيه القلب لينهض الطب العلم فإذا ناله استعد للسعادة القصوى فيسقط عنه تكليف الجوارح وانما تكليف الجوارح في حق من يجري بجهله مجرى الحمر التي لا يمكن رياضتها إلا بالأعمال الشاقة وأما الأذكياء والمدركون للحقائق فدرجتهم ارفع من ذلك وهذا فن من الإغواء شديد على الأذكياء وغرضهم هدم قوانين الشرع ولكن يخادعون كل ضعيف بطريق يغويه ويليق به وهذا من الإضلال البارد وهو في حكم ضرب المثال كقول القائل إن الاحتماء عن الاطعمه المضرة انما يجب على من فسد مزاجه فأما من اكتسب اعتدال المزاح فليواظب على أكل ما شاء أي وقت شاء فلا يلبث المصغي الي هذا الضلال ان يمعن في المطعومات المضرة إلي أن تتداعى به إلى الهلاك.
فإن قيل قد نقلتم مذاهبهم وما ذكرتم وجه الإبطال فما السبب فيه قلنا إن ما نقلناه عنهم ينقسم إلى أمور يمكن تنزيلها على وجه لا ننكره والى ما يتعين من الشرع إنكاره والمنكر هو مذهب الثنوية والفلاسفة والرد عليهم فيه يطول فليس ذلك من خصائص مذهب هؤلاء حتى نتشاغل به وانما نرد عليهم في خصوص مذهبهم من إبطال الرأي وإثبات التعليم من الإمام المعصوم ولكنا مع ذلك نذكر مسلكا واحدا هو على التحقيق قاصم الظهر نعني في إبطال مذهبهم في جميع ما سنحكي عنهم وما حكيناه وهو أنا نقول لهم في جميع دعاويهم التي تميزوا بها عنا كإنكار القيامة وقدم العالم وإنكار بعث الأجساد وإنكار الجنة والنار على ما دل عليه القرآن مع غاية الشرح في وصفها من أين عرفتم ما ذكرتموه أعن ضرورة أو عن نظر أو عن نقل عن الإمام المعصوم وسماع فان عرفتموه ضرورة فكيف خالفكم فيه ذوو العقول السليمة لان معنى كون الشئ ضروريا مستغنيا عن التأمل اشتراك كافة العقلاء في دركه ولو ساغ أن يهذي الإنسان بدعوى الضرورة في كل ما يهواه لجاز لخصومهم دعوى الضرورة في نقيض ما ادعوه وعند ذلك لا يجدون مخلصا بحال من الأحوال. وان زعموا أنا عرفنا ذلك بالنظر فهو باطل من وجهين أحدهما أن النظر عندهم باطل فانه تصرف بالعقل لا بالتعليم وقضايا العقول متعارضه وهي غير موثوق بها ولذلك أبطلوا الرأي بالكلية ولم نصنف هذا الكتاب قصدا لإبطال هذا المذهب فكيف يمكن ذلك منهم الثاني أن يقال للفلاسفة والمعترفين بمسالك النظر بم عرفتم عجز الصانع عن خلق الجنة والنار وبعث الأجساد كما ورد به الشرع وهل معكم إلا استبعاد محض لو عرض مثله على من لم يشاهد النشأة الأولى لاستبعده وعرض له ذلك الإنكار فالرد عليهم بالحجة المنطوية تحت قوله تعالى: {قل يحييها الذي أنشأها أول مرة} ومن تأمل عجائب الصنع في خلق الآدمي من نطفة قذرة لم يستبعد من قدرة الله شيئا وعرف أن الإعادة اهون من الابتداء.
فإن قيل الإعادة غير معقولة والابتداء معقول إذ ما عدم كيف يعود قلنا لنفهم الابتداء حتى نبني عليه الإعادة ورأى المتكلمين فيه أن الابتداء يخلق الحياة في جسم من الأجسام مع ان الحياة عرض يتجدد ساعة فساعة بخلق الله تعالى فلا يستحيل على أصلهم الإمساك عن خلق الحياه مدة في الجسم ثم يعود إلى خلق الحياة كما لا يستحيل خلق الحركة بعد السكون والسواد بعد البياض ورأى الفلاسفة أن قوام الحياة استعداد جسم مخصوص بنوع من الاعتدال إلى الانفعال عن النفس التي هي جوهر قائم بنفسه غير متحيز ولا متجسم ولا هو منطبع في جسم لا علاقة بينه وبين الجسم إلا بالفعل فيه ولا علاقة بين الجسم وبينه إلا بالانفعال عنه ومعنى الموت انقطاع هذه العلاقة الفعلية ببطلان استعداد الجسم فانه لا يستعد للاننفعال إلا إذا كان على مزاج مخصوص كما لا يستعد الحديد لانطباع الصورة المحسوسة فيه أو انعكاس الاشعة عنه إلا إذا كان على هيئة مخصوصة فإذا بطلت تلك الهيئة لم ينفعل الحديد عن الصورة المحاذية له ولم ينطبع فيه فإذا كان هذا مذهبهم فالقادر على إحداث العلاقة بين نفس لا تتجسم ولا تختص بمكان ولا توصف بانها متصلة بالجسم ولا بأنها منفصلة عنه وبين الجسم الذي لا تناسبه بحقيقتها ولا تتصل به اتصالا محسوسا كيف يعجز عن إعادة تلك العلاقة والعجب أن أكثرهم جوزوا إثبات تلك العلاقة مع جسد آخر على طريق التناسخ فلم لا يجوز عودها إلى جسدها فان الجسد الذي فسد مزاجه لابعد في أن يصلح مزاجه وتعاد تلك العلاقة ايه فيكون هو المراد بالإعادة ويضاهي التيقظ بعد المنام فانه يعيد حركة الحواس وتذكر الأمور السالفة.
فان قيل المزاج إذا فسد لا يعود معتدلا إلا بان تنحل اجزاء الجسم إلى العناصر ثم تتركب ثانيا ثم يصير حيوانا ثم يصير نطفة فهذا الإعتدال للنطفة على الخصوص قلنا ومن أين عرفتم انه ليس في مقدور الله جبر الخلل الواقع بطريق سوى هذا الطريق ومن أين عرفتم أن هذا الذي ذكرتموه طريق فهل لكم مستند سوى مشاهدة الأحوال وهل لكم في إبطال غيره مستند سوى عدم المشاهدة ولو لم تشاهدوا خلق الإنسان من نطفة لنفرت عقولكم عن التصديق به ففي الأسباب المغيره لأحوال الأجسام عجائب يستنكرها من لا يشاهدها فمن منكر ينكر الخواص وآخر ينكر السحر وآخر ينكر المعجزة وآخر ينكر الأخبار عن الغيب وكل يعول في إقراره على قدر مشاهدته لا على طريق معقول في إثبات الاستحالة ثم من لم يشاهده ويستيقنه ينبئ أن نفرة طبعه عن التصديق كان لعدم المشاهدة وفي مقدورات الله عجائب لم يطلع عليها بشر فلم يستحل ان يكون لإعادة تلك الاجسام وإعادة مزاجها سبب عند الله ينفرد بمعرفته وإذا اعاده عادت النفس متصرفه فيه كما كان بزعمهم في الحياة والعجب ممن يدعي الحذق في المعقولات ثم يشاهد ما في العالم من العجائب والآيات ثم تضيق حوصلته عن قبول ذلك في قدرة الله وإذا نسب ما لم يشاهده إلى ما شاهده لم ير أعجب منه نعم لو قال القائل هذا أمر لا يدل العقل على إحالته ولكن لا يدل أيضا على جوازه بل يتوقف عن الحكم فيه ويجوز ان يكون ثم محيل لا يطلع عليه أو مجوز لا يطلع عليه فهذا أقرب من الأول ويلزم بحكمه تصديق النبي ﷺ إذا أخبر عنه فانه أخبر عما لا يستحيل في العقل وجوده وعلى الجملة فقد اشتمل على أطوار الخلق ودرجاته قوله تعالى: {ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين} إلى قوله {تبعثون} فأطبق الخلق على التصديق بجملة المقدمات إلا البعث لانهم شاهدوا جميع ذلك سوى البعث ولو لم يشاهدوا قط موتا لانكروا إمكان الموت ولو لم يشاهدوا خلق آدمي من نطفة لانكروا إمكانه فالبعث مع ما قبله في ميزان العقل على وتيرة واحدة فلنصدق الأنبياء فيما جاءوا به فإنه لا يمتنع وهذا كله كلام مع فلاسفة النظار اما الباطنية المنكرون للنظر فلا يمكنهم التمسك بالنظر نعم لو قال الباطني أخبرني الإمام المعصوم ان البعث مستحيل فصدقته قيل له وما الذي دعاك إلى تصديق الإمام المعصوم بزعمك ولا معجزة له وصرفك عن تصديق محمد بن عبد الله مع المعجزات والقرآن من أوله إلى آخره دال على جواز ذلك ووقوعه فهل لك من مانع سوى ان عصمته علمت بمعجزته وعصمة من يدعيه علمت بهذيانك وشهوتك فان قال ان ما في القرآن ظواهر هي رموز إلى بواطن لم يفهموها وقد فهمها الإمام المعصوم فتعلمنا منه قلنا تعلمتم منه بمشاهدة ذلك في قلبه بالعين أو سماعا من لفظه ولا يمكن دعوى المشاهدة ولا بد من الاستناد إلى سماع لفظه قلنا وما يؤمنك أن لفظه له باطن لم تطلع عليه فلا تثق بما فهمته من ظاهر لفظه فإن زعمت أنه صرح معك وقال ما ذكرته هو ظاهر لا رمز فيهوالمراد ظاهره قلنا وبم عرفت أن قوله هذا وهو أنه ظاهر لا رمز فيه أيضا ظاهر وفيه رمز إلى ما لم تطلع عليه فلايزال يصرح بلفظه ونحن نقول لسنا ممن يغتر بالظواهر فلعل تحته رمزا وان أنكر الباطن فنقول تحت إنكاره رمز وان حلف بالطلاق الثلاث على أنه ما قصد إلا الظاهر فنقول في طلاقه رمز وانما هو مظهر شيئا ومضمر غيره فان قلت فذلك يؤدي إلى حسم باب التفهيم قلنا فأنتم حسمتم باب التفهيم على الرسول فان ثلثي القرآن في وصف الجنة والنار والحشر والنشر مؤكد بالقسم والايمان وانتم تقولون لعل تحت ذلك رمزا وانتم تقولون وأي فرق بين ان يطول في تفهم الأمور التطويل الذي عرف في القرآن والأخبار وبين أن تقول ما أريد إلا الظاهر فإن جاز عليه ان يفهم الظاهر ويكون مراده غير ما علم قطعا انه ما وصل إلى افهام الخلق ويكون كاذبا في جميع ما قال لاجل مصلحة وسر فيه جاز انيكون امامكم المعصوم بزعمكم يضمر معكم خلاف ما يظهره وضد ما يفهمه ونقيض ما يتيقن انه الواصل إلى افهامكم ويؤكد ذلك بالايمان المغلظة لمصلحة له وسر فيه وهذا لا جواب عنه أبد الدهر وعند هذا ينبغي أن يعرف الإنسان ان رتبة هذه الفرقة أخس من رتبة كل فرقة من فرق الضلال إذ لا نجد فرقة ينقض مذهبها بنفس المذهب سوى هذه إذ مذهبها إبطال النظر وتغيير الألفاظ عن موضوعاتها بدعوى الرموز وكل ما يتصور ان ينطلق به لسانهم اما نظر أو نقل اما النظر فقد ابطلوه وأما اللفظ فقد جوز ان يراد باللفظ غير موضوعه فلا يبقى لهم معتصم فإن قيل فهذا ينقلب عليكم فأنتم تجوزون أيضا تأويل الظواهر كما اولتم آية الاستواء وخبر النزول وغيرهما قلنا ما ابعد هذا القلب فإن لنا معيارا في التأويل وهو أن ما دل نظر العقل ودليله على بطلان ظاهره علمنا ضرورة أن المراد غير ذلك بشرط ان يكون اللفظ مناسبا له بطريق التجوز والاستعارة فقد دل الدليل على بطلان الاستواء والنزول فإن ذلك من صفات الحوادث فحمل على الاستيلاء وهو مناسب للغة واما الحشر والنشر والجنة والنار فليس في العقل دليل على إبطاله ولا مناسبة بين الألفاظ الواردة فيه وبين المعنى الذي أولوه عليه حتى يقال انه المراد بل التأويل في تكذيب محض فأي مناسبة بين قوله {فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة} وقوله {في سدر مخضود وطلح منضود} إلى قوله {لا مقطوعة} وبين ما اعتقدوه من اتصال الجواهر الروحانية بالأمور الروحانية العقلية التي لا مدخل فيها للمحسوسات فإن جاز أن يكذب صاحب المعجزة بهذه التأويلات التي لم تخطر قط ببال من سمعها فلم لا يجوز تكذيب معصومكم الذي لا معجزة له بتأويله على أمور ليس تخطر ببالهم لمصلحة أو لمسيس حاجة فإن غاية لفظه التصريح والقسم وهذه الآلفاظ في القرآن صريحة ومؤيدة بالقسم وزعموا ان ذلك ذكر لمصلحة والمراد غير ما سبق إلى الأفهام منها وهذا لا مخلص عنه.
الباب الخامس في إفساد تأويلاتهم للظواهر الجلية واستدلالاتهم بالأمور العددية
وفيه فصلان.
الفصل الأول في تأويلاتهم للظواهر
والقول الوجيز فيه انهم لما عجزوا عن صرف الخلق عن القرآن والسنة صرفوهم عن المراد بهما إلى مخاريق زخرفوها واستفادوا بما انتزعوه من نفوسهم من مقتضى الألفاظ إبطال معاني اشرع وبما زخرفوه من التأويلات تنفيذ انقيادهم للمبايعة والموالاة وانهم لو صرحوا بالنفي المحض والتكذيب المجرد لم يحظوا بموالاة الموالين وكانوا أول المقصودين المقتولين.
ونحن نحكي من تأويلاتهم نبدة لنستدل بها على مخازيهم فقد قالوا كل ما ورد من الظواهر في التكاليف والحشر والنشر والأمور الإلهية فكلها أمثلة ورموز إلى بواطن اما الشرعيات فمعنى الجنابة عندهم مبادرة المستجيب بإفشاء سر إليه قبل أن ينال رتبة استحقاقه ومعنى الغسل تجديد العهد على فعل ذلك ومجامعة البهيمة معناها عندهم معالجة من لا عهد عليه ولم يؤد شيئا من صدقة النجوى وهي مائة وتسعة عشر درهما عندهم فلذلك اوجب الشرع القتل على الفاعل والمفعول به والا فالبهيمة متى وجب القتل عليها والزنا هو القاء نطفة العلم الباطن في نفس من لم يسبق معه عقد العهد الاحتلام هو أن يسبق لسانه إلى إفشاء السر في غير محله فعليه الغسل أي تجديد المعاهدة الطهور هو التبري والتنظف من اعتقاد كل مذهب سوى مبايعة الإمام الصيام هو الامساك عن كشف السر الكعبة هي النبي والباب علي الصفا هو النبي والمروة علي والميقات هو الاساس والتلبية إجابة الداعي والطواف بالبيت سبعا هو الطواف بمحمد إلى تمام الأئمة السبعة والصلوات الخمس أدلة على الاصول الأربعة وعلى الإمام فالفجر دليل السابق والظهر دليل التالي والعصر دليل للأساس والمغرب دليل الناطق والعشاء دليل الإمام. وكذلك زعموا أن المحرمات عبارة عن ذوي الشر من الرجال وقد تعبدنا باجتنابهم كما أن العبادات عبارة عن الاخيار الأبرار الذين أمرنا باتباعهم.
فأما المعاد فزعم بعضهم أن النار والاغلال عبارة عن الأوامر التي هي التكاليف فانها موظفة على الجهال بعلم الباطن فما داموا مستمرين عليها فهم معذبون فإذا نالوا علم الباطن وضعت عنهم أغلال التكاليف وسعدوا بالخلاص عنها واخذوا يؤولون كل لفظ ورد في القرآن والسنة فقالوا أنهار من لبن أي معادن الدين العلم الباطن يرتضع بها أهلها ويتغذى بها تغذيا تدوم بها حياته اللطيفة فإن غذاء الروح اللطيفة بارتضاع العلم من المعلم كما ان حياة الجسم الكثيف بارتضاع اللبن من ثدي الام وأنهار من خمر هو العلم الظاهر وأنهار من عسل مصفى هو علم الباطن المأخوذ من الحجج والأئمة.
أما المعجزات فقد أولوا جميعها وقالوا الطوفان معناه طوفان العلم اغرق به المتمسكون بالسنة والسفينة حرزه الذي تحصن به من استجاب لدعوته ونار إبراهيم عبارة عن غضب نمرود لا عن النار الحقيقية وذبح اسحق معناه اخذ العهد عليه عصا موسى حجته التي تلقفت ما كانوا يأفكون من الشبه لا الخشب انفلاق البحر افتراق علم موسى فيهم على أقسام والبحر هو العالم والغمام الذي أظلهم معناه الإمام الذي نصبه موسى لإرشادهم وإفاضة العلم عليهم الجراد والقمل والضفادع هي سؤالات موسى وإلزاماته التي سلطت عليهم والمن والسلوى علم نزل من السماء لداع من الدعاة هو المراد بالسلوى تسبيح الجبال معناه تسبيح رجال شداد في الدين راسخين في اليقين. الجن الذي ملكهم سليمان بن داود باطنية ذلك الزمان والشياطين هم الظاهرية الذي كلفوا بالأعمال الشاقة عيسى له أب من حيث الظاهر وإنما أراد بالأب الإمام إذ لم يكن له إمام بل استفاد العلم من الله بغير واسطة وزعموا لعنهم الله أن أباه يوسف النجار كلامه في المهد اطلاعه في مهد القالب قبل التخلص منه على ما يطلع عليه غيره بعد الوفاة والخلاص من القالب إحياء الموتى من عيسى معناه الاحياء بحياة العلم عن موت الجهل الباطن وابراؤه الاعمى معناه عن عمي الضلال وبرص الكفر ببصيرة الحق المبين ابليس وآدم عبارة عن أبي بكر وعلي إذ أمر ابوبكر بالسجود لعلي والطاعة له فأبى واستكبر الدجال زعموا انه أبو بكر وكان اعور إذ لم يبصر إلا بعين الظاهر دون عين الباطن ويأجوج ومأجوج هم أهل الظاهر.
هذا من هذيانهم في التأويلات حكيناها ليضحك منها ونعوذ بالله من صرعة الغافل وكبوة الجاهل.
ولسنا نسلك في الرد عليهم إلا بمسالك ثلاثة إبطال ومعارضة وتحقيق.
أما الإبطال
فهو أن يقال بم عرفتم أن المراد من هذه الألفاظ ما ذكرتم فإن اخذتموه من نظر العقل فهو عندكم باطل وان سمعتموه من لفظ الإمام المعصوم فلفظه ليس بأشد تصريحا من هذه الألفاظ التي أولتموها فلعل مراده أمر آخر اشد بطونا من الباطن الذي ذكرتموه ولكنه جاوز الظاهر بدرجة فزعم ان المراد بالجبال الرجال فما المراد بالرجال لعل المراد به أمر آخر والمراد بالشياطين أهل الظاهر فما أهل الظاهر والمراد باللبن العلم فما معنى العلم فإن قلت العلم والرجال أهل الظاهر صريحة في مقتضياتها بوضع اللغة ان كنت ناظرا بالعين العوراء إلى أحد الجانبين فأنت المراد إذا بالدجال فإنه أعور لانك أبصرت باحدى العينين فإن الرجال ظاهر وعميت بالعين الاخرى الناظرة إلى الجبال وانها أيضا ظاهر فإن قلت يمكن ان يكنى بالجبال عن الرجال قلنا ويمكن ان يكنى بالرجال عن غيرهم كما عبر الشاعر بالرجلين اللذين أحدهما خياط والآخر نساج عن أمور فلكية وأسباب علوية فقال:
رجلان خياط وآخر حائك ** متقابلان على السماك الأعزل
لا زال ينسج ذاك خرقة مدبر ** ويخيط صاحبه ثياب المقبل
وهكذا في كل فن وإذا نزل تسبيح الجبال على تسبيح الرجال فلينزل معنى الرجال في قوله تعالى: {رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله} على الجبال فإن المناسبة قائمة من الجانبين ثم إذا نزل الجبال على الرجال ونزل الرجال أيضا على غيره أمكن تنزيل ذلك الباطن الثالث على رابع وتسلسل إلى حد يبطل التفاهم والتفهيم ولا يمكن التحكم بأن الحائز الرتبة الثانية دون الثالثة أو الثالثة دون الرابعة.
المسلك الثاني معارضة الفاسد بالفاسد
وهو أن يتناول جميع الأخبار على نقيض مذهبهم مثلا يقال قوله لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أى لا يدخل العقل دماغا فيه التصديق بالمعصوم وقوله إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أى إذا نكح الباطني بنت أحدكم فليغسلها عن درن الصحبة بماء العلم وصفاء العمل بعد أن يعفرها بتراب الإذلال أو يقول قائل النكاح لا ينعقد بغير شهود وولى وأما قوله كل نكاح لا يحضره أربعة فهو سفاح معناه أن كل اعتقاد لم يشهد له الحلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فهو باطل وقوله لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل أي لا وقاع إلا بذكر وأنثيين إلى غير ذلك من الترهات والمقصود من ذكر هذا القدر معارضة الفاسد بالفاسد وتعريف الطريق في فتح هذا الباب حتى إذا اهتديت إليه لم تعجز عن تنزيل كل لفظة من كتاب أو سنة على نقيض معتقدهم فإن زعموا أنكم أنزلتم الصورة على المعصوم في قوله لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة فأي مناسبة بينهما قلت وأنتم نزلتم الثعبان على البرهان والأب في حق عيسى على الإمام واللبن على العلم في أنهار اللبن في الجنة والجن على الباطنية والشياطين على الظاهرية والجبال على الرجال فما المناسبة فإن قلت البرهان يقضم الشبه كما يقضم الثعبان غيره والإمام يفيد الوجود العلمي كما يفيد الأب الوجود الشخصي واللبن يغذي الشخص كما يغذي العلم الروح والجن باطن كالباطنيه فيقال لهم فإذا اكتفيتم بهذا القدر من المشاركة فلم يخلق الله شيئين إلا وبينهما مشاركة في وصف ما فإنا نزلنا الصورة على الإمام لان الصورة مثال لا روح فيها كما أن الإمام عندكم معصوم ولا معجزة له والدماغ مسكن العقل كما ان البيت مسكن العاقل والملك شئ روحاني كما أن العقل كذلك فثبت أن المراد بقوله لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة معناه لا يدخل العقل دماغا فيه اعتقادا عصمة الإمام فإذا عرفت هذا فخذ كل لفظ ذكروه وخذ ما تريده واطلب منهما المشاركة بوجه ما وتأوله عليه فيكون دليلا بموجب قولهم كما عرفتك في المناسبة بين الملك والعقل والدماغ والبيت والصورة والإمام وإذا انفتح لك الباب اطلعت على وجه حيلهم في التلبيس بنزع موجبات الألفاظ وتقدير الهوسات بدلا عنها للتوصل إلى إبطال الشرع وهذا القدر كاف في إبطال تأويلهم.
المسلك الثالث وهو التحقيق
أن تقول هذه البواطن والتأويلات التي ذكرتموها لو سامحناكم أنها صحيحة فما حكمها في الشرع أيجب إخفاؤها أم يجب إفشاؤها فإن قلتم يجب إفشاؤها إلى كل أحد قلنا فلم كتمها محمد ﷺ فلم يذكر شيئا من ذلك للصحابة ولعامة الخلق حتى درج ذلك العصر ولم يكن لأحد من هذا الجنس خبر وكيف استجاز كتمان دين الله وقد قال تعالى: {لتبيننه للناس ولا تكتمونه} تنبها على أن الدين لا يحل كتمانه وإن زعموا أنه يجب إخفاؤه فنقول ما أوجب الرسول ﷺ إخفاؤهمن سر الدين كيف حل لكم إفشاؤه والجناية في السر بالإفشاء ممن اطلع عليه من أعظم الجنايات فلولا أن صاحب الشرع عرف سرا عظيما ومصلحة كلية في إخفاء هذه الأسرار لما أخفاها ولما كرر هذه الظواهر على أسماع الخلق ولما تكررت في كلمات القرآن صفة الجنة والنار بألفاظ صريحة مع علمه بأن الناس يفهمون منه خلاف الباطن الذي هو حق ويعتقدون هذه الظواهر التي لا حقيقة لها فإن نسبتموه إلى الجهل بما فهمه الخلق منه فهو نسبة إلى الجهل بمعنى الكلام إذ كان النبي ﷺ يعلم قطعا أن الخلق ليس يفهمون من قوله وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة إلا المفهوم منه في اللغة فكذا سائر الألفاظ ثم مع علمه بذلك كان يؤكده عليهم بالتكرير والقسم ولم يفش إليهم الباطن الذي ذكرتموه لعلمه بأنه سر الله المكتوم فلم أفشيتم هذا السر وخرقتم هذا الحجاب وهل هذا إلا خروج عن الدين ومخالفة لصاحب الشرع وهدم لجميع ما أسسه إن سلم لكم جدلا أن ما ذكرتموه من الباطن حق عند الله وهذا لا مخرج لهم عنه فإن قيل هذا سر لا يجوز إفشاؤه إلى عوام الخلق فلهذا لم يفشه رسول الله ﷺ ولكن حق النبي أن يفشيه إلى سوسه الذي هو وصية وخليفته من بعده وقد أفشاه إلى علي دون غيره قلنا وعلي هل أفشاه إلى غير سوسه وخليفته أم لا فإن لم يفشه إلا إلى سوسه وكذا سوس سوسه وخليفة خليفته إلى الآن فكيف انتهى إلى هؤلاء الجهال من العوام حتى تناطقوا به وشحنت التصانيف بحكايته وتداولته الألسنة فلا بد أن يقال إن واحدا من الخلفاء عصى وأفشى السر إلى غير أهله فانتشر وعندهم أنهم معصومون لا يتصور عليهم العصيان فإن قيل السوس لا يذكره إلا مع من تعاهده عليه قلنا وما الذي منع الرسول من أن يعاهد ويذكره إن كان يجوز إفشاؤه مع العهد فإن قيل لعله عاهد وذكر ولكن لم ينقل لأجل العهد الذي أخذ ممن أفشى إليه قلنا ولم انتشر ذلك فيكم وأئمتكم لا يظهرون ذلك إلا مع من أخذ العهد عليه وما الذي عصم عهد أولئك دون عهد هؤلاء ثم يقال إذا جاز إفشاء هذا السر بالعهد فالعهد يتصور نقضه فهل يتصور أن يفشيه إلى من يعلم الإمام المعصوم أنه لا ينقضه أو يكفى أن يظنه بفراسته واجتهاده واستدلاله بالأمارات فإن قلتم لا يجوز إلا إلى من علم الإمام المعصوم أنه لا ينقضه بتعريف من جهة الله فكيف انتشرت هذه الأسرار إلى كافة الخلق ولم تنتشر إلا ممن سمع فإما ان يكون المبلغ ناقصا للعهد أو لم يعاهدأصلاوفي أحدهما نسبة المعصوم إلى الجهل وفي الاخر نسبته إلى المعصية ولا سبيل إلى واحد منهما عندهم وان زعمتم أنه يحل الإفشاء بالعهد عند شهادة الفراسة في المأخوذ عليه عهده انه لا ينقصه استدلالا بالأمارات ففي هذا نقض اصل مذهبهم لانهم زعموا انه لا يجوز اتباع أدلة العقل ونظره لان العقلاء مختلفون في النظر ففيه خطر الخظأ فكيف حكموا بالفراسة والامارة التي الخطأ أغلب عليها من الصواب وفي ذلك إفشاء سر الدين وهو أعظم الأشياء خطرا وقد منعوا التمسك بالظن والاجتهاد في الفقهيات التي هي حكم بين الخلق على سبيل التوسط في الخصومات ثم ردوا افشاء سر الدين إلى الخيالات والفراسات وهذا مسلك متين يتفطن له الذكي ويتبجح به المشتغل بعلوم الشرع إذ يتيقن قطعا ان القائل قائلان قائل يقول لا باطن لهذه الظواهر ولا تأويل لها فالتأويل باطل قطعا وقائل ينقدح له ان ذلك يمكن ان يكون كنايات عن بواطن لم يأذن الله لرسول الله ﷺ بان يصرح بالبواطن بل ألزمه النطق بالظواهر فصار النطق بالباطن حراما باطلا وفجورا محظورا ومراغمة لواضع الشرع وهذه التأسيسة بالاتفاق فليس أهل عصرنا مع بعد العهد بصاحب الشرع وانتشار الفساد واستيلاء الشهوات على الخلق وإعراض الكافة عن أمور الدين أطوع للحق ولا اقبل للسر ولا آمن عليه ولا أحرى بفهمه والانتفاع به من أهل عصر رسول الله ﷺ وهذه الأسرار والتأويلات ان كان لها حقيقة فقد أقفل أسماعهم عنها وألجم أفواه الناطقين عن اللهج بها ولنا في رسول الله أسوة حسنة في قوله وفعله فلا نقول إلا ما قال ولا نظهر إلا ما يظهر ونسكت عما سكت عنه وفي الافعال نحافظ على العبادات بل على التهجد والنوافل وأنواع المجاهدات ونعلم أن ما لم يستغن عنه صاحب الشرع فنحن لا نستغني عنه ولا ننخدع بقول الحمقى إن نفوسنا إذا صفت بعلم الباطن استغنينا عن الاعمال الظاهرة بل نستهزئ بهذا القائل المغرور ونقول له يا مسكين أتعتقد ان نفسك اصغي وأزكي من نفس رسول الله ﷺ وقد كان يقوم ليلا يصلى حتى تنتفخ قدماه أو يعتقد انه كان يتنمس به على عائشة ليخيل إليها أن الدين حق وقد كان عالما ببطلانه فان اعتقدت الأول فما احمقك ولا نزيدك عليه وان اعتقدت الثاني فما أكفرك واجحدك ولسنا نناظرك عليه لكنا نقول إذا أخذنا بأسوأ الأحوال وقصرت أدلة عقولنا مثلا عن درك ضلالك وجهلك وعن الاحاطة بصدق رسول الله ﷺ فإنا نرى بدائه عقولنا تقضي بأن الخسران في زمرة محمد ﷺ وموافقته والقناعة بما رضي هو لنفسه اولى من الفوز معك أيها المخذول الجاهل بل المعتوه المخبل فلينظر الآن المنصف في آخر هذا وأوله فآخره يقنع العوام بل العجائز وأوله يفيد البرهان الحقيقي لكل محقق آنس بعلوم الشرع وناهيك بكلام ينتفع به كافة الخلق على اختلاف طبقاتهم في العلم والجهل.
الفصل الثاني في استدلالهم بالأعداد والحروف
هذا فن من الجهالة اختصت به هذه الفرقة من بين الفرق فإن طوائف الضلال مع انشعاب كلامهم وانتشار طرقهم في نظم الشبهات لم تتطلخ طائفة منهم بهذا الجنس واستركوها وعلم عوامهم وجهالهم بالضرورة بطلانها فاجتووها وتشبث بها هؤلاء ولا غرو فالغريق بكل شئ يتمسك والغبي بكل ايهام يتزلزل ويتشكك ونحن نذكر شيئا يسيرا منه ليشكر الناظر فيه ربه على سلامة العقل واعتدال المزاج وصحة الفطرة فإن الانخداع بمثل ذلك لا ينبعث إلا من العته والخبل في العقل.
فقد قالوا ان الثقب على رأس الآدمي سبعة والسموات سبعة والارضون سبع والنجوم سبعة أعني السيارة وأيام الاسبوع سبعة فهذا يدل على أن دور الأئمة يتم بسبعة وزعموا ان الطبائع أربع وان فصول السنة أربعة فهذا يدل على الاصول الأربعة وهي السابق والتالي الإلآهان والناطق والأساس الإمامان. وزعموا ان البروج اثنا عشر فتدل على الحجج الاثنى عشر كما نقلناه في مذهبهم وربما استثاروا من شكل الحيوانات دلالات فقالوا الآدمي على شكل حروف محمد فان رأسه مثل ميم ويداه مبسوطتان كالحاء وعجزه ك الميم ورجلاه ك الدال وبهذا الجنس يتكلمون على شكل الطيور والبهائم وربما تأولوا من الحروف واعدادها فقالوا قد قال النبي ﷺ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها قيل وما حقها قال معرفة حدودها. وزعموا أن حدودها معرفة أسرار حروفها وهي ان لا إله إلا الله أربع كلمات وسبعة فصول وهي قطع لا إله إلا الله وثلاثة جواهر فإن لا حرف يبقى إله وإلا الله فهي ثلاثة جواهر والجملة اثنا عشر حرفا وزعموا ان الكلمات الأربع دالة على المدبرين العلوين السابق والتالي والمدبرين السفليين الناطق والاساس هذه دلالته على الروحانيات فأما على الجسمانيات فانها الطبائع الأربع واما الجواهر الثلاثة فدالة على جبريل وميكائيل وإسرافيل من الروحانيات ومن الجسمانيات على الطول والعرض والعمق إذ بها ترى الاجسام والفصول السبعة تدل من الروحانيات على الانبياء السبعة ومن الجسمانيات على الكواكب السبعة لأنه لو الأنبياء السبعة لما اختلفت الشرائع كما أنه لولا الكواكب السبعة لما اختلفت الأزمنة والحروف الاثنا عشر تدل على الحجج الاثني عشر ( وفي الجسمانيات على البروج الاثني عشر ) وهكذا تصرفوا في قول محمد رسول الله وفي الحروف وفي اوائل السور وأبرزوا ضروبا من الحماقات تضحك المجانين فضلا عن العقلاء وناهيك خزيا بطائفة هذا منهج استدلالهم.
ولسنا نكثر حكاية هذا الجنس عنهم اكتفاء بهذا القدر في تعريف مخازيهم، وهذا فن يعرف بضرورة العقل بطلانه فلا يحتاج إلى إبطاله إلا انا نعلمك في إفحام الغبي والمعاند منهم مسلكين مطالبة ومعارضة
أما المطالبة
فهو أن يقال ومن أين عرفتم هذه الدلالات ولو حكم الإنسان بها لحكم على نفسه بانه من سوء مزاجه أثار عليه الاخلاط فأورث اضغاث الأحلام وقد اضلكم الله إلى هذا الحد حتى لم يستحيوا منها أعرفتم صحتها بضرورة العقل أو نظر أو سماع من إمامكم المعصوم فإن ادعيتم الضرورة باهتم عقولكم واخترعتم ثم لم تسلموا من معارض يدعى انه عرف بالضرورة بطلانه ثم يكون مقامه من تعارض الحق بالفاسد مقام من يعارض الفاسد بالفاسد وان عرفتم بنظر العقل فنظر العقل عندكم باطل لاختلاف العقلاء في نظرهم وإن صدقتم به فأفيدونا وجه النظر وسياقه وما به الاستدلال على هذه الحماقات وان عرفتم ذلك من قول الإمام المعصوم فبينوا ان الناقل عنه معصوم أو بلغ الناقلون عنه حد التواتر ثم صححوا ان الإمام المعصوم لا يخطئ ثم بينوا انه يستحيل ان يفهم ما يعرف بطلانه فلعله خدعكم بهذه الحماقات وهويعلم بطلانها كما زعمتم أن النبي ﷺ خدع الخلق بصفة الجنة والنار وبما يحكي عن الأنبياء من إحياء الموتى وقلب العصا ثعبانا وقد كذب في جميعها وذكرها مع علمه بأنها لم يكن منها شئ وان الناس يفهمون منها على القطع ظواهرها وانه كان يقصد تفهيم الظواهر ويعلم انهم يفهمون ما يفهمهم من الظواهر وهو خلاف الحق ولكن رأى فيه مصلحة فلعل إمامكم المعصوم رأى من المصلحة ان يستهزئ بعقولكم ويضحك من أذقانكم فألقى اليكم هذه الترهات إظهارا لغاية الاستيلاء عليكم والاستعباد لكم وافتخارا بغاية الدهاء والكياسة في التلبيس عليكم فليت شعري بماذا أمنتم الكذب عليه لمصلحة رآها وقد صرحتم بذلك عن النبي ﷺ وهل بينهما فرق إلا أن النبي ﷺ مؤيد بالمعجزة الدالة على صدقه والذي إليه استرواحكم لا معجزة له سوى حماقتكم هذا سبيل المطالبة.
وأما المعارضة
فلسنا نقصد لتعيين الصور ولكن نعلمك طريقا يعم كل ما في العالم من الاشكال والحروف فان كل موجود فهو من الواحد إلى العشرة فما فوقها لا محالة فمهما رأيت شيئا واحدا فاستدل به على محمد ﷺ وإذا رأيت اثنين فقل هو دلالة على الشيخين أبي بكر وعمر وان كان ثلاثة فمحمد ﷺ وابوبكر وعمر إن كان أربعة فالخلفاء الأربعة وان كان خمسة فعلى محمد مع الخلفاء والأربعة وقل اما تعرفون السر ان الثقب على رأس الآدمي خمس ما هو الواحد وهو الفم يدل على النبي محمد ﷺ فانه واحد والعينان والمنخران على الخلفاء الأربعة ونقول اما تعرفون السر في اسم محمد وانه أربعة حروف ما هو فإذا قالوا لا فنقول هو السر الذي لا يطلع عليه إلا ملك مقرب فانه يبنيه على أن اسم خليفته أربعة حروف وهو عتيق دون علي الذي اسمه ثلاثة احرف فإذا وجدت سبعة فاستدل به على سبعة من خلفاء بني أمية مبالغة في إرغامهم وإجلالا لبني العباس عن المعارضة بهم وقل عدد السموات السبع والنجوم والاسبوع دال على معاوية ويزيد ثم مروان ثم عبد الملك ثم الوليد ثم عمر بن عبد العزيز ثم هشام ثم السابع المنتظر وهو الذي يقال له السفياني وهو قول الأموية من الإمامية أو قابلهم بمذهب الراوندية وقل إنه يدل على العباس ثم عبد الله ابن العباس ( ثم علي بن عبد الله ) ثم محمد بن علي ثم إبراهيم ثم أبو العباس السفاح ثم المنصور وكذلك ما تجده من عشرة أو اثنى عشر فعد من خلفاء بني العباس بعددهم ثم انظر هل تجد بين الكلامين فصلا وبه يتبين فساد كلامهم وافتضاحهم وإلزامهم باستدلالهم وهذا الجنس من الكلام لا يليق بالمحصل فيه الإكثار منه فلنعدل عنه إلى غيره.
الباب السادس في الكشف عن تلبيساتهم التي زوقوها بزعمهم في معرض البرهان على إبطال النظر العقلي وإثبات وجوب التعلم من الإمام المعصوم
وطريقنا ان نرتب شبههم على أقصى الإمكان ثم نكشف عن مكمن التلبيس فيها وآخر دعواهم ان العارف بحقائق الأشياء هو المتصدي للإمامة بمصر وانه يجب على كافة الخلق طاعته والتعلم منه لينالوا به سعادة الدنيا والآخرة ودليلهم عليه قولهم ان كل ما يتصور الخبر عنه بنفي وإثبات ففيه حق وباطل والحق واحد والباطل ما يقابله إذ ليس الكل حقا ولا الكل باطلا فهذه مقدمة. ثم تمييز الحق عن الباطل لا بد منه فهو أمر واجب لا يستغنى عنه أحد في صلاح دينه ودنياه فهذه مقدمة ثانية ثم درك الحق لا يخلو اما ان يعرفه الإنسان بنفسه من عقله بنظره دون تعلم أو يعرفه من غيره بتعلم فهذه مقدمة ثالثة وإذا بطلت معرفته بطريق الاستقلال بالنظر وتحكيم العقول فيه وجب التعلم من الغير ضرورة. ثم المعلم إما أن يشترط كونه معصوما من الخطأ والزلل مخصوصا بهذه الخاصية واما ان يجوز التعلم من كل أحد وإذا بطل التعلم من كل أحد أي واحد كان لكثرة القائلين المعلمين وتعارض اقوالهم ثبت وجوب التعلم من شخص مخصوص بالعصمة من سائر الناس فهذه مقدمة رابعة ثم العالم لا يخلو إما أن يجوز خلوه من ذلك المعصوم أو يستحيل خلوه وباطل تجويز خلوه لانه إذ اثبت انه مدرك الحق ففي اخلاء العالم عنه تغطية الحق وحسم السبيل عن إدراكه وفيه فساد أمور الخلق في الدين والدنيا وهو عين الظلم المناقض للحكمة فلا يجوز ذلك من الله سبحانه وهو الحكيم المقدس عن الظلم والقبائح فهذه مقدمة خامسة ثم ذلك المعصوم الذي لا بد من وجوده في العالم لا يخلو اما ان يحل له ان يخفي نفسه فلا يظهر ولا يدعو الخلق إلى الحق أو يجب عليه التصريح وباطل ان يحل له الإخفاء فإنه كتمان للحق وهو ظلم يناقض العصمة فهذه مقدمة سادسة وقد ثبت أن في العالم معصوما مصرحا بهذه الدعوى وبقي النظر في تعيينه فان كان في العالم مدعيان التبس علينا تمييز المحق عن المبطل وان لم يكن إلا مدع واحد في محل الالتباس كان ذلك هو المعصوم قطعيا ولم يفتقر إلى دليل ومعجزة ويكون مثاله ما إذا علم أن في بيت في الدار رجلا هو عالم ثم رأينا في بيت رجلا فإن كان في الدار بيت اخر بقي لنا شك في الذي رأيناه انه ذلك العالم أو غيره فإذاعرفنا أنه لا بيت في الدار سوى هذا البيت علمنا ضرورة انه العالم فكذلك القول في الإمام المعصوم فهذه مقدمة سابعة وقد علم قطعا انه لا أحد في عالم الله يدعي انه الإمام الحق والعارف بأسرار الله في جميع المشكلات النائب عن رسول الله في جميع المعقولات والمشروعات العالم بالتنزيل والتأويل علما قطعيا لا ظنيا إلا المتصدي للأمر بمصر فهذه مقدمة ثامنة.
فإذا هو الإمام المعصوم الذي يجب على كافة الخلق تعلم حقائق الحق وتعرف معاني الشرع منه وهي النتيجة التي كنا نطلبها.
وعند هذا يقولون إن من لطف الله وصنعه مع الخلق ألا يترك أحدا في الخلق يدعي العصمة سوى الإمام الحق إذ لو ظهر مدع آخر لعسر تمييز المحق عن المبطل وضل الخلق فيه فمن هذا لا نرى قط لإمام خصما بل نرى له منكرا كما أن النبي ﷺ لم يكن له خصم قط والخصم هو الذي يقول لست أنت نبيا وإنما أنا النبي والمنكر هو الذي لا يدعي لنفسه وانما ينكر نبوته فهكذا يكون أمر الإمام قالوا واما بنو العباس وان لم ينفك الزمان عن معارضتهم فلم يكن فيهم من يدعي لنفسه العصمة والاطلاع من جهة الله تعالى على حقائق الأمور وأسرار الشرع والاستغناء عن النظر والاجتهاد بالظن فهذه الخاصية هي المطلوبة وقد تفرد بهذه الدعوى عترة رسول الله ﷺ وذريته وصرف الله دواعي الخلق عن معارضتهم في الدعوى لمثلها ليستقر الحق في نصابه وينجلي الشك عن قلوب المؤمنين رحمة من الله ولطفا حتى ان فرض شخص يدعى لنفسه ذلك فلا يذكره إلا في معرض هزل أو مجادلة فأما أن يستمر عليه معتقدا أو يعمل بموجبه فلا.
وهذه مقدمات واضحة لم نهمل من جملتها إلا الدليل على إبطال نظر العقل حيث قلنا الحق اما ان يعرفه الإنسان بنفسه من عقله أو يتعلمه من غيره.
ونحن الآن ندل على بطلان نظر العقل بأدلة عقلية وشرعية وهي خمسة.
أما الأول وهي دلالة عقلية ان من يتبع موجب العقل ويصدقه ففي تصديقه تكذيبه وهو غافل عنه لانه ما من مسئلة نظرية يعتقدها بنظره العقلي إلا وله فيها خصم اعتقد بنظر العقل نقيضها فإن كان العقل حاكما صادقا فقد صدق عقل خصمك أيضا فإن قلت لم يصدق خصمي فقد تناقض كلامك إذا صدقت عقلا وكذبت مثله فان قلت صدق خصمي فخصمك يقول انت كاذب مبطل وان زعمت انه لا عقل لخصمي وانما العقل لي فهذه أيضا دعوى خصمك فبماذا تتميز عنه أبطول اللحية ام ببياض الوجه ام بكثرة السعل أو الحدة في الدعاء وعند هذا يطلقون لسان الاستهزاء والإستخفاف معتقدين ان لهم بكلامهم اليد البيضاء التي لا جواب عنها.
الدلالة الثانية قولهم إذا حاكم مسترشد تشكك في مسئلة شرعية أو عقلية وزعم انه عاجز عن معرفة دليلها فماذا تتقولون له أفتحيلونه على عقله ولعله العامي الجلف الذي لا يعرف أدلة العقول أو هو الذكي الذي ضرب سهام الرأي على حسب امكانه فلم تنكشف له المسئلة وبقي متشككا افتردونه إلى عقله الذي هو معترف بقصوره وهذا محال أو تقولون له تعلم طريق النظر ودليل المسئلة مني فان قلتم ذلك فقد ناقضتم قولكم بإبطال التعليم إذ امرتم بالتعليم وجعلتم التعليم طريقا وهو مذهبنا إلا انكم أبيتم لانفسكم منصب التعليم ولم يستحيوا من خصمكم المعارض لكم المماثل في عقله لعقلكم إن هذا المتعلم يقول قد دعاني إلى التعلم منه خصمك وقد تحيرت في تعيين المعلم أيضا وليس يدعى واحدا منكم العصمة لنفسه ولا له معجزة تميزه ولا هو منفرد بأمر يفارق به غيره فلا أدرى أتبع الفلسفي أو الأشعري أو المعتزلى وأقاويلهم متعارضة وعقولهم متماثلة ولست أجد في نفسي الترجيح بطول اللحية وببياض الوجوه ولا أرى افتراقا إلا فيه إن اتفق فأما العقل والدعوى واغترار كل بنفسه في أنه المحق وصاحبه المبطل كاغترار صاحبه فما أشد تناقض هذا الكلام عند من يعرفه.
الدلالة الثالثة قولهم الوحدة دليل الحق والكثرة دليل الباطل فإنا إذا قلنا كم الخمسة مع الخمسة فالحق واحد وهو أن يقال عشرة والباطل كثير لا حصر له وهو كل ما سوى العشرة مما فوقها أو تحتها والوحدة لازمة مذهب التعليم فانه اجتمع الف الف على هذا الاعتقاد واتحدت كلمتهم ولم يتصور بينهم اختلاف وأهل الرأي لا يزال الاختلاف والكثرة تلازمهم فدل ان الحق في الفرقة التي تلازم الوحدة كلمتها وعليه دل قوله تعالى: {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا}.
الدلالة الرابعة قولهم الناظر ان كان لا يدرك المماثلة بين نفسه وبين خصمه فيسحن الظن بنفسه ويسئ بخصمه فلا غرو فإن هذا الغرور مما يستولي على الخلق وهو شغفهم بآرائهم وجودة عقولهم وان كان ذلك من من أدلة الحماقة وانما العجب أنه لا يدرك المماثلة بين حالتيه وكم رأى نفسه في حالة واحدة وقد تحولت حالته فاعتقد الشئ مدة وحكم بانه الحق الذي يوجبه العقل الصادق ثم يخطر له خاطر فيعتقد نقيضه ويزعم انه الآن تنبه للحق وما كان يعتقد من قبل فخيال انخدع به ويرى نفسه على اعتقاد قاطع في الحالة الثانية تساوي اعتقاده السابق فانه كان قاطعا بمثل قطعه الآن فليت شعري من أين يأمن الانخداع وانه سيتنبه لأمر يتبين به ان ما يعتقده الآن باطل وما من ناظر إلا ويعتقد مثله مرارا ثم لا يزال يعتز آخرا بمعتقده الذي يماثل سائر معتقداته التي تركها وعرف بطلانها بعد التصميم عليها والقطع بها.
الدلالة الخامسة وهي شرعية قولهم قال رسول الله ﷺ ستفترق امتي نيفا وسبعين فرقة الناجية منها واحدة فقيل ومن هم فقال أهل السنة والجماعة فقيل وما السنة والجماعة قال ما أنا الآن عليه وأصحابي قالوا وما كانوا إلا على الاتباع والتعليم في كل ما شجر بينهم وتحكيم الرسول ﷺ فيه لا على اتباع رأيهم وعقولهم فدل ان الحق في الاتباع لا في نظر العقول.
وهذا تحرير أدلتهم على أقوى وجه في الايراد وربما يعجز معظمهم عن الإتقان في تحقيقه إلى هذا الحد.
فنقول وبالله التوفيق الكلام عليه منهجان جملي وتفصلي.
المنهج الأول وهو الجملي
انا نقول هذه العقيدة التي استنتجتموها من ترتيب هذه المقدمات ونظمها بطريق النظر والتأمل فإن ادعيتم معرفتها ضرورة كنتم معاندين ولم يعجز خصومكم عن دعوى الضرورة في معرفتهم بطلان مذهبكم وان ادعوا ذلك كانوا اقوم قيلا عند المنصف وان ادعيتم إدراكها بالنظر في ترتيب هذه المقدمات ونظمها على شكل المقاييس المنتجة فقد اعترفتم بصحة النظر العقلي ويدعى بطلانه فهذا الكلام مفحم له وكاشف عن خزايته أو يقال له عرفت بطلان النظر ضرورة أو نظرا ولا سبيل إلى دعوى الضرورة فان الضروري ما يشترك في معرفته ذوو العقول السليمة كقولنا الكل اعظم من الجزء والاثنان اكبر من الواحد والشئ الواحد لا يكون قديما محدثا والشئ الواحد لا يكون في مكانين وان زعم انه أدرك بطلان النظر بالنظر فقد تناقض كلامه وهذا لا مخرج منه أبد الدهر وهو وارد على كل باطني يدعى معرفة شئ يختص به. فانه اما ان يدعي الضرورة أو النظر أو السماع من معصوم صادق يدعى معرفة صدقه وعصمته أيضا اما ضرورة أو نظرا. ولا سبيل إلى دعوى الضرورة وفي دعوى النظر إبطال عين المذهب فلتتعجب من هذا التناقض البين وغفلة هؤلاء المغرورين عنه.
فإن قال قائل من منكري النظر هذا ينقلب عليكم إذ يقال لكم وبم عرفتم صحة النظر إن ادعيتم الضرورة اقتحمتم مااستبعدتموه وتورطتم في عين ما أنكرتموه وان زعمتم أنا ادركناه نظرا فالنظر الذي به الادراك بم عرفتم صحته والخلاف قائم فيه فان ادعيتم معرفة ذلك بنظر ثالث لزم ذلك في الرابع والخامس إلى غير نهاية قلنا نعم كان هذا الكلام ينقلب إن كانت المعقولات بالموازنات اللفظية وليس الأمر كذلك فلتتأمل دقيقة الفرق فإنا نقول عرفنا كون النظر العقلي دليلا إلى العلم بالمنظور فيه بسلوك طريق النظر والوصول إليه فمن سلكه وصل ومن وصل عرف أن ما سلكه هو الطريق ومن استراب قبل السلوك فيقال طريق رفع هذه الاسترابة السلوك.
ومثاله ما إذا سئلنا عن طريق الكعبة فدللنا على طريق معين فقيل لنا من أين عرفتم كونه طريقا قلنا عرفناه بالسلوك بأنا سلكناه فوصلنا إلى الكعبة فعرفنا كونه طريقا ومثاله الثاني أنا إذا قيل لنا بم عرفتم ان النظر في الأمور الحسابيه من الهندسة والمساحة وغيرها طريق إلى معرفة ما لا يعرف اضطرارا قلنا سلوك طريق الحساب إذ سلكناه فأفادنا علما بالمنظور فيه فعلمنا ان نظر العقل دليل في الحساب وكذلك في العقليات سلكنا الطريق النظرية فوصلنا إلى العلم بالمعقولات فعرفنا أن النظر طريق. فهذا لا تناقض فيه فان قيل وبم عرفتم ان ما وصلتم إليه علم متعلق بالمعلوم على ما هو به بل هو جهل ظننتموه علما قلنا ولو أنكر العلوم الحسابية منكر فماذا يقال له أو ليس يسفه في عقله ويقال له هذا يدل على قلة بصيرتك بالحسابيات فإن الناظر في الهندسة إذا حصر المقدمات ورتبها على الشكل الواجب يحصل العلم بالنتيجة ضرورة على وجه لا يتمارى فيه فهكذا جوابنا في المعقولات فان المقدمات النظرية إذا رتبت على شروطها افادت العلم بالنتيجة على وجه الارض لا يتمارى فيه ويكون العلم المستفاد من المقدمات بعد حصولها ضروريا كالعلم بالمقدمات الضرورية المنتجه له وإن اردنا أن نكشف ذلك لمن قلت بضاعته في العلوم فنضرب له مثالا هندسيا ثم نضرب له مثالا عقليا لينكشف له الغطاء وينجلي عن عقيدته الخفاء. اما المثال الهندسي فهو ان إقليدس رسم في مصنفه في الشكل الأول من المقالة الأولى مثلثا وادعى انه متساوي الاضلاع ولا يعرف ذلك ببديهة العقل ولكنه ادعى انه يعرف بالبرهان نظرا وبرهانه بمقدمات (الأولى) ان الخطوط المستقيمة الخارجة من مركز الدائرة إلى المحيط متساوية من كل جانب وهذه المقدمة ضرورية إذ الدائرة ترسم بالبركار على فتح واحد وانما الخط المستقيم من المركز إلى الدائرة هوفتح البركار وهو واحد في الجوانب. (المقدمة الثانية) إذا تساوت دائرتان بالخطوط المستقيمة من مركزهما إلى محيطهما فالخطوط أيضا متساوية وهذه أيضا ضرورية. (المقدمة الثالثة) أن المساوي للمساوي مساو وهذه أيضا ضرورية ثم الآن نشتغل بالمثلث ونشير إلى خطين منه ونقول إنهما متساويان لانهما خطان مستقيمان خرجا من مركز دائرة إلى محيطها والخط الثالث مثل لاحدهما لانه خرج أيضا من مركز الدائرة إلى محيطها مع ذلك الخط وإذا ساوى أحد الخطين فقد ساوى الآخر فإن المساوي للمساوي مساو فبعد هذا النظر نعلم قطعا تساوي أضلاع المثلث المفروض كما عرف سائر المقدمات مثل قولنا الخطوط المستقيمة من مركز الدائرة إلى المحيط متماثلة وغيرها من المقدمات.
المثال العقلي الإلهي
وهو أنا إذا أردنا أن ندل على واجب الوجود القائم بنفسه المستغني عن غيره الذي منه يستفيد كل موجود وجوده لم ندرك ثبوت موجود واجب الوجود مستغنيا عن غيره بالضرورة بل بالنظر ومعنى النظر هو أنا نقول لا شك في أصل الوجود وانه ثابت فإن من قال لاموجود اصلا في العالم فقد باهت الضرورة والحس فقولنا لا شك في اصل الوجود مقدمة ضرورية ثم نقول والوجود المعترف به من الكل إما واجب وإما جائز فهذه المقدمة أيضا ضرورية فإنها حاصرة بين النفي والإثبات مثل قولنا الموجود إما ان يكون قديما أو حادثا فيكون صدقه ضروريا وهكذا كل تقسيم دائر بين النفي والإثبات ومعناه ان الموجودات إما ان تكون استغنت أو لم تستغن والاستغناء عن السبب هو المراد بالوجوب وعدم الاستغناء هو المراد بالجواز فهذه مقدمة ثالثة ثم نقول ان كان هذا الموجود المعترف به واجبا فقد ثبت واجب الوجود وان كان جائزا فكل جائز مفتقر إلى واجب الوجود ومعنى جوازه أنه أمكن عدمه ووجوده على حد واحد وما هذا وصفه لا يتميز وجوده عن عدمه إلا بمخصص وهذا أيضا ضروري فقد ثبت بهذه المقدمات الضرورية واجب الوجود وصار العلم بعد حصوله ضروريا لا يتمارى فيه فان قيل فيه موضع شك إذ يقول المعترف به جائز ويقول قولكم إنه يفتقر إلى واجب كل جائز وجوده غير مسلم بل يفتقر إلى سبب ثم ذلك السبب يجوز أن يكون جائز الوجود قلنا في تلك المقدمات ما اشتمل على رفع هذا بالقوة فان كل ما ثبت له الجواز فافتقاره إلى سبب ضروري فإن قدر السبب جائزا دخل في الجملة التي سميناها كلا ونحن نعلم بالضرورة ان كل الجائزات تفتقر إلى سبب فإن فرضت السبب جائزا فافرضه داخلا في الجملة واطلب سببه إذ يستحيل ان يسند ذلك جائزا آخر وهكذا إلى غير نهاية فانه يكون عند ذلك حميع الأسباب والمسببات جملة جائزة ووصف الجواز يصدق على آحادها وعلى مجموعها فيفتقر المجموع إلى سبب خارج عن وصف الجواز المخرج وفيه ضرورة إثبات واجب الوجود ثم بعد ذلك نتكلم في صفته ونبين أنه لا يجوز ان يكون واجب الوجود جسما ولا منطبعا في جسم ولا متغيرا ولا متحيزا إلى سائر ما يتبع ذلك ويثبت كل واحد منها بمقدمات لا شك فيها وتكون النتيجة بعد حصولها من المقدمات في الظهور على ذوق المقدمات.
فإن قيل العلوم الحسابية معترف بها لانها ضرورية ولذلك لم يختلف فيها واما النظريات العقلية فان كانت مقدماتها كذلك فلم وقع الاختلاف فيها فوقوع الاختلاف فيها يقطع الامان قلنا هذا باطل من وجهين (أحدهما) أن العلوم الحسابية اختلف فيها تفصيلا وجملة من وجهين أحدهما ان الأوائل قد اختلفوا في كثير من هيئات الفلك ومعرفة مقاديرها وهي مثبتة على مقدمات حسابية ولكن متى كثرت المقدمات وتسلسلت ضعف الذهن عن حفظها فربما تزل واحدة عن الذهن فيغلظ في النتيجة وامكان ذلك لا يشككنا في الطريق نعم الخلاف فيها اندر لانها اظهر وفي العقليات أكثر لانها اخفى واستر ومن النظريات ما ظهر فاتفقوا عليه وهو أن القديم لا يعدم فهذه مسألة نظرية ولم يخالف فيها أحد البته فلا فرق بين الحسابية والعقلية. الثاني ان من حصر مدارك العلوم في الحواس وانكر العلوم النظرية جملة الحسابية وغير الحسابية فخلاف هؤلاء هل يشككنا في علمنا بأن العلوم الحسابية صادقة حقيقة فإن قلتم نعم اتضح ميلكم على الانصاف وان قلتم لا فلم وقع الخلاف فيه فان قلتم خلافه لم يشككنا في المقدمات فلم يشككنا في النتيجة فكذلك خلاف من خالفنا في تفصيل ماعرفناه من الدلالة على ثبوت واجب الوجود لم يشككنا في مقدمات الدليل فلم يشككنا في النتيجة.
والوجه الآخر من الجواب هو أن السوفسطائية أنكروا الضروريات وخالفوا فيها وزعموا انها خيالات لا أصل لها واستدلوا عليه بان أظهرها المحسوسات ولا ثقة بقطع الإنسان بحسه ومهما شاهد انسانا وكلمه فقوله اقطع بحضوره وكلامه فهو خطأ فلعله يراه في المنام فكم من منام يراه الإنسان ويقطع به ولا يتمارى مع نفسه في تحققه ثم ينتبه على الفور فيبين انه لا وجود له حتى يرى في المنام يد نفسه مقطوعة ورأسه مفصولا ويقطع به ولا وجود لما يقطع به ثم خلاف هؤلاء لا يشككنا في الضروريات وكذلك النظريات فانها بعد حصولها من المقدمات تبقى ضرورية لايتمارى فيها كما في الحسابيات.
وهذا كله كلام على من ينكر النظر جملة اما التعليمية فلا يقدرون على إطلاق القول بإبطال النظر جملة فانهم يسوقون الادلة والبراهين على إثبات التعليم ويرتبون المقدمات كما حكيناه فكيف ينكرون ذلك فمن هنا قالوا نظر العقل باطل فيقال وبم عرفتم بطلانه وثبوت التعليم أبنظر أم ضرورة ولا بد أن يقال بنظر ومهما استدل بالخلاف في النظريات على فساد النظريات فقابله بالخلاف من السوفسطائية في الضروريات ولا فرق بين المقامين فإذا قالوا وبم أمنت الخطأ وكم من مرة اعتدت الشئ نظرا ثم بان خلافه فيقال له وبم عرفت حضورك بهذا البلد الذي أنت فيه وكم من كرة اعتقدت نفسك ورأيتها ببلد آخر لم تكن فيه فيم تميز بين النوم واليقظة وبم تأمن على نفسك فلعلك الآن في هذا الكلام نائم فان زعم اني ادرك التفرقة ضرورة فيقال وأنا أدركت التفرقة بين ما يجوز الغلط فيه من المقدمات ومالا يجوز أيضا ضرورة ولا فرق وكذلك كم يغلط الإنسان في الحساب ثم ينتبه وإذا تنبه ادرك التفرقة ضرورة بين حالة الاصابة والخطأ فان قال قائل من الباطنية نحن ننكر النظر جملة وما ذكرتم ليس من النظريات في شئ بل هي مقدمات ضرورية قطعية رتبناها قلنا فأنتم الآن لم تفهموا معنى النظر اذي نقول به فلسنا نقول إلا بمثل ما نظمتموه من المقدمات الضرورية الحقيقية كما سنبينها فكل قياس لم يكن بنظم مقدمات ضرورية أو بنظم مقدمات مستنتجة من ضرورية فلا حجة فيه فهذا هو القياس المعقول وانما ينتظم أبدا من مقدمتين إما مطلقة وإما تقسيمية وقد تسمى حملية وشرطية أما المطلقة فكقولنا العالم حادث وكل حادث فله سبب فهاتان مقدمتان الأولى حسية والثانية ضرورية عقلية ونتجيته ان لحوادث العالم إذا سببا. وأما التقسيمية فهو أنا نقول إذا ثبت ان لحوادث العالم سببافالسبب المفروض اما حادث واما قديم فان بطل كونه حادثا ثبت كونه قديما ثم نبطل كونه حادثا بمثل هذه المقاييس فيثبت بالآخرة ان لوجود العالم سببا قديما فهذا هو النظر المقول به فان كنتم متشككين في صحته فبم تنكرون من يمتنع من قبول مقدماتكم التي نظمتموها ويقول انا متشكك في صحتها فان نسبتموه إلى إنكار الضرورة نسبناكم إلى مثله فيما ادعينا معرفته بالنظر ولا فرق.
هذا هو المنهج الجملي في الرد عليهم إذا أبطلوا نظر العقول وهو الجزم الواجب في إفحامهم فلا ينبغي ان نخوض معهم في التفصيل بل نقتصر على أن نقول لهم كل ما عرفتموه من مذهبكم من صدق الإمام وعصمته وبطلان الرأي ووجوب التعليم بماذا عرفتموه ودعوى الضرورة غير ممكنة فيبقى النظر والسماع وصدق السمع أيضا لا يعرف ضرورة فيبقى النظر وهذا لا مخرج عنه فان قال قائل لا يظن بعاقل يدعي مذهبا ليس ضروريا ثم ينكر النظر فلعلهم يعترفون بالنظر إلا انهم يقولون تعلم طريق النظر واجب فان الإنسان لا يسستقل بنفسه في النظريات. فان أنكرتم ذلك فقد أنكرتم العقول بديهة إذ لم يترشح المدرسون والمعلمون إلا للتعليم فلم تصدوا مع الاستغناء عنهم وان اعترفتم بذلك فقد اعترفتم بوجوب المعلم وان العقول ليس في مجردها غنية فبقي انكم جوزتم التعلم من كل أحد وهم اوجبوا التعلم من معصوم لان مذاهب المعلمين مختلفة ومتعارضة ولا ترجيح للبعض على البعض. قلنا وهذا السؤال أيضا فاسد فانا لا ننكر الحاجة إلى التعلم بل العلوم منقسمة إلى ثلاثة أقسام:
قسم لا يمكن تحصيله إلا بالسماع والتعلم كالإخبار عما مضى من الوقائع ومعجزات الانبياء وما يقع في القيامة وأحوال الجنة والنار فهذا لا يعرف إلا بالسماع من النبي المعصوم أو بالخبر المتواتر عنه فان سمع بقول الآحاد حصل به علم ظني لا يقيني هذا قسم
والقسم الآخر من العلوم النظرية العقلية فليس في الفطرة ما يرشد إلى الأدلة فيه بل لا بد فيه من التعلم لا ليقلد المعلم فيه بل لينبهه المعلم على طريقه ثم يرجع العاقل فيه إلى نفسه فيدركه بنظره وعند هذا فليكن المعلم من كان ولو افسق الخلق واكذبهم فإنا لسنا نقلده بل نتنبه بتنبيهه فلا نحتاج فيه إلى معصوم وهي كالعلوم الحسابية والهندسية لا تعلم بالفطرة وتحتاج إلى المعلم ونستغني عن معلم معصوم بل يتعلم طريق البرهان ويساوي المتعلم المعلم بعد النظر في العقليات عندنا فالحسابيات عندهم وكم من شخص يغلط في الحسابيات ثم يتنبه بالآخرة بعد زمان وذلك لا يشكك في الادلة والبراهين الحسابية ولا يحتمل الافتقار فيها إلى معلم معصوم.
القسم الثالث العلوم الشرعية الفقهية وهو معرفة الحلال والحرام والواجب والندب وأصل هذا العلم السماع من صاحب الشرع والسماع منه يورث العلم إلا ان هذالا يمكن تحصيل العلم القطعي فيه على الإطلاق في حق كل شخص وفي كل واقعة بل لابد من الاكتفاء بالظن فيه ضرورة في طريقين أحدهما في المستمعين فان الخلق في عصر النبي ﷺ انقسموا أى من شاهد فسمع وتحقق وعرف والى من غاب فسمع من المبلغين وآحاد الامراء والولاة فاستفادوا ظنا من قولة الآحاد ولكن وجب عليهم العمل بالظن للضرورة فان النبي ﷺ عجز عن أسماع كل واحد بنفسه من غير واسطة ولم يشترط ان تتواتر عنه كل كلمة في كل واقعة لتعذره والعلم يحصل باحد هذين المسلكين وهو متعذر قطعا. والطرف الثاني في نفس الصورة الفقهية والحوادث الواقعة إذن ما من واقعة إلا وفيها تكليف والوقائع لا حصر لها بل هي في الامكان غير متناهية والنصوص لا تفرض إلا محصورة متناهية ولا يحيط قط ما يتناهى بما لا يتناهى وغاية صاحب الشرع مثلا ان ينص على حكم كل صورة اشتمل عليها تصنيف المصنفين في الفقه إلى عصرنا هذا ولو فعل ذلك واستوفاه كانت الوقائع الممكنة الخارجة عن التصانيف أكثر من المسطورات فيها بل لا نسبة لها اليها فان المسطورات محصورة والممكنات لا حصر لها فكيف يستوفي ما لا يتناهى بالنص فبالضرورة لا بد من تحكيم الظن في التعلق بصيغ العمومات وان كان يحتمل انها اطلقت لإرادة الخصوص إذ عليها أكثر العمومات ولذلك لما بعث رسول الله ﷺ معاذا إلى اليمن وقال له بم تحكم فقال بكتاب الله قال فان لم تجد قال فبسنة رسول الله قال فان لم تجد قال اجتهد رأيي فقال ﷺ الحمد لله الذي وفق رسول رسوله لما يرضاه رسوله فانما رخص له في اجتهاد الرأي لضرورة العجز عن استيعاب النصوص للوقائع.
هذا بيان هذا القسم ولا حاجة فيه إلى إمام معصوم بل لا يغني الإمام المعصوم شيئا فانه لا يزيد على صاحب الشرع وهو لم يغن في كلا الطرفين فلا قدرة على استيعاب الصور بالنصوص ولا قدرة على مشافهة جميع الخلق ولا على تكليفهم اشتراط التواتر في كل ما ينقل عنه عليه السلام فليت شعري معلمهم المعصوم ماذا يغني في هذين الطرفين أيعرف كافة الخلق نصوص أقاويله وهم في أقصى الشرق والغرب بقول آحاد هؤلاء الدعاة ولا عصمة لهم حتى يوثق بهم أو يشترط التواتر عنه في كل كلمة وهو في نفسه محتجب لا يلقاه إلا الاحاد والشواذ هذا لو سلم انه مطلع على الحق بالوحي في كل واقعة كما كان صاحب الشرع فكيف والحال كما نعرفه ويعرفه خواص أشياعه المحدقين به في بلده وولايته.
فقد انكشف بهذا الكلام انهم يلبّسون ويقولون ان قلتم لا حاجة إلى التعليم فقد أنكرتم العادات وان اعترفتم فقد وافقتمونا على إثبات التعليم فيأخذون التعليم لفظا مجملا مسلما ثم يفصلونه بأن فيه اعترافا بوجوب التعلم من المعصوم فقد فهمت أي علم يستغنى فيه عن المعلم واي علم يحتاج فيه إليه وإذا احتيج فما الذي يستفاد من المعلم طريقه ولا يقلد في نفسه فيستغني عن عصمته وما الذي يقلد في نفسه فيحتاج فيه إلى عصمته وان ذلك المعصوم هو النبي ﷺ وان ما يؤخذ منه كيف ينقسم إلى ما يعلم تحقيقا والى ما يظن وان كافة الخلق كيف يضطرون إلى القناعة بالظن في صدق مبلغ الخبر عن صاحب الشرع وفي الحاق غير المنصوص إلى النصوص وإذا ايقنت هذه القاعدة استوليت على كشف تلبيساتهم كلها فان عادتهم ابدا إطلاق مقدمات مهملة بنوا عليها النتيجة الفاسدة كقولهم انكم إذا اعترفتم بالحاجة إلى التعليم فقد اعترفتم بمذهبنا فنقول اعترافنا بالتعلم في النظريات كاعترافكم به في الحسابيات. هذا منهج الكلام الجملي عليهم.
المنهج الثاني في الرد عليهم تفصيلا
وسبيلنا أن نتكلم على كل مقدمة من مقدماتهم الثماني التي نظمناها فنقول.
المقدمة الأولى وهي قولكم إن كل شىء يتكلم فيه بنفي وإثبات ففيه حق وباطل والحق واحد والباطل ما يقابله فهذه مقدمة صادقة لا نعتقد نزاعا فيها ولكن لا يصح منكم استعمالها فانا نقول من الناس من أنكر حقائق الأشياء وزعم انه لا حق ولا باطل وان الأشياء تابعة للإعتقادات فما يعتقد فيه الوجود فهو موجود في حق ذلك المعتقد وما يعتقد فيه العدم فهو معدوم في حق المعتقد وهذه مقالة فرقة من فرق السوفسطائية وربما يقولون الأشياء لا حقيقة لها فنقول هل هذه المقدمة مقدمة يقطعون بها وأنتم ترونها في المنام ولا حقيقة لها فبماذا أمنتم الغلط فيها وكم رأيتم أنفسكم في المنام قاطعين بأمر لا حقيقة له وما الذي آمنكم من اصابة خصومكم وخطئكم ولا نزال نورد عليهم ما يوردونه على أهل النظر للتشكيك فيه فلا يجدون فصلا فان زعموا أنا نعرف ضرورة خطأ من يخالفنا من السوفسطائية ونعلم ضرورة صدق هذه المقدمة قيل لهم فبم تنكرون على أهل النظر إذا ادعو ذلك في مذهبهم وفي تفريقهم بين ما غالطوا فيه وبين مالم يغالطوا فيه وفرقهم بين أنفسهم ومخالفيهم فإن زعموا ان ذلك يفتقر فيه إلى تأمل وما نحن فيه بديهي فنقول والحسابيات يحتاج فيها إلى أدق تأمل فإن غلط في مسئلة عرفتموها من الحساب رجل قصر نظره أو ضعف ذكاؤه فهل يشكككم ذلك في أن العلوم الحسابية صادقة فإن قلتم لا قيل فهكذا حال النظار المحققين إذا خالفهم المخالفون وهذا ينبغي ان يكون عليهم في كل مقام لان تبجحهم الاكثر باختلاف النظار وان ذلك ينبغي ان يسقط الامان وخلافنا لهم لم يسقط امانهم عن مقدماتهم التي نظموها ثم طمعوا مع ذلك ان يسقط اماننا عن النظريات بخلاف المخالف فيها وهذا من الطمع البارد والظن الركيك الذي لا ينخدع بمثله عاقل.
أما المقدمة الثانية وهي قولهم إذا ثبت في كل واقعة حق وباطل فلابد من معرفة الحق فيه فهذه مقدمة كاذبة إذ تسلموها جملة وفيها تفصيل وهذه عادتهم في التلبيس فلا يغفلن عنها المحصل فنقول قول القائل الحق لا بد من معرفته كقول القائل المسئلة لا بد من معرفتها أو المسائل لا بد من معرفتها فيقال هذا خطأ بل المسئلة اسم جنس يتناول ما لا بد من معرفته وما عن معرفته بد فلابد من تفصيل وكذلك الحق بنا غنية عن معرفته في أكثر الأمور فإن جملة التواريخ والأخبار التي كانت وستكون إلى منقرض العالم أو هي كائنة واقعة اليوم في العالم يتكلم فيها بنص وإثبات والحق واحد ولا حاجة بنا إلى معرفته وهذا كقول القائل ملك الروم الآن قائم ام لا والحق أحدهما لا محالة ما تحت قدمي من الارض بعد مجاوزة خمسة اذرع حجر أو تراب وفيه دود ام لا والحق أحدهما لا محالة ومقدار كرة الشمس أو زحل ومسافتهما مائة فرسخ ام لا والحق أحدهما وهكذا مساحات الجبال والبلاد وعدد الحيوانات في البر والبحر وعدد الرمل فهذه كلها فيها حق وباطل ولا حاجة إلى معرفتها بل العلوم المشهورة من النحو والشعر والطب والفلسفة والكلام وغيرها فمنها حق وباطل ولا حاجة بنا إلى أكثر ما قيل فيها بل الذي نسلم انه لا بد من معرفته مسألتان وجود الصانع تعالى وصدق الرسول ﷺ وهذا لا بد منه ثم إذا اثبت صدق الرسول فالباقي يتعلق به تقليدا أو علما بخبر المتواتر أو ظنا بخبر الواحد وذلك من العلوم كاف في الدنيا والآخرة وما عداه مستغنى عنه أما وجود الصانع وصدق الرسول فطريق معرفته النظر في الخلق حتى يستدل به على الخالق وفي المعجزة حتى يستدل بها على صدق الرسول وهذان لا حاجة فيهما إلى معلم معصوم فان الناس فيه قسمان قسم اعتقدوا ذلك تقليدا وسماعا من ابويهم وصمموا عليه العقد قاطعين به وناطقين بقولهم لا اله إلا الله محمد رسول الله ﷺ من غيربحث عن الطرق البرهانية وهؤلاء هم المسلمون حقا وذلك الاعتقاد يكفيهم وليس عليهم طلب طرق البراهين وعرفنا ذلك قطعا من صاحب الشرع فانه كان يقصده اجلاف العرب واغمار أهل السواد والجملة طائفة لو قطعوا ارابا لم يدركوا شيئا من البراهين العقلية بل لا يبين تمييزهم عن البهائم إلا بالنطق وكان يعرض عليهم كلمة الشهادتين ثم يحكم لهم بالايمان ويقنع منهم به وامرهم بالعبادات فعلم قطعا ان الاعتقاد المصمم كاف وان لم يكن عن برهان بل كان عن تقليد وربما كان يتقدم إليه الاعرابي فيحلفه انه رسول الله وانه صادق فيما يقول فيحلف له ويصدقه فيحكم بإسلامه فهؤلاء اعني المقلدين يستغنون عن الإمام المعصوم.
القسم الثاني من اضطرب عليه تقليده إما بتفكر وإما بتشكيك غيره إياه أو بتأمله بأن الخطأ جائز على آرائه فهذا لا ينجيه إلا البرهان القاطع الدال على وجود الصانع وهو النظر في الصنع وعلى صدق الرسول وهو النظر في المعجزة وليت شعري ماذا يغني عنهم إمامهم المعصوم أيقول له اعتقد ان للعالم صانعا وان محمدا ﷺ صادق تقليدا لي من غير دليل فاني الإمام المعصوم أو يذكر له الدليل فينبهه على وجه دلالته فان كان سومه التقليد فمن أي وجه يصدقه بل من اين يعرف عصمته وهو ليس يعرف عصمة صاحبه الذي يزعم انه خليفته بعد درجات كبيرة وان ذكر الدليل افتقر المسترشد إلى ان ينظر في الدليل ويتأمل في ترتيبه ووجه دلالته ام لا فان لم يتأمل فكيف يدرك دون النظر والتأمل وهذه العلوم ليست ضرورية وان تأمل وادرك نتاج المقدمات الضرورية المنتجة المطلوبة بتأمله وخرج به عن حد التقليد هـ فما الفرق بين ان يكون المنبه له على وجه الدلالة ونظم المقدمات هو هذا المشار إليه المعصوم أو داعية أو عالم آخر من علماء الزمان فان كل واحد ليس يدعوه إلى تقليده وانما يقوده إلى مقتضى الدليل ولا يدرك مقتضى الدليل إلا بالتأمل فإذا تأمل وادرك لم يكن مقلدا لمعلمه بل كان كمتعلم للأدلة الحسابية ولا فرق في ذلك بين أفسق الخلق وبين اورعهم كمعلم الحساب فلا يحتاج فيه إلى الورع فضلا عن العصمة لانه ليس مقلدا وانما الدليل هو المتبع فإذا لا يعدو الخلق هذين القسمين فالأول مستغن عن المعصوم والثاني لا يغني عنه المعصوم شيئا فقد بطلت مقدمتان إحداهما أن كل حق فلا بد من معرفته والاخرى انه لا يعرف الحق إلا من معصوم.
فإن قيل لا تكفي معرفة الله ورسوله بل لا بد من معرفة صفات الله ومعرفة الأحكام الشرعية قلنا أما صفات الله تعالى فقسمان قسم لا يمكن معرفة صدق الرسول وبعثته إلا بعد معرفته ككونه عالما وقادرا على الارسال فهذا يعرف عندنا بالأدلة العقلية كما ذكرناه والمعصوم لا يغني لان المعتقد له تقليدا أو سماعا من ابويه مستغن عن المعلم كما سبق والمتردد فيه ماذا يغني عنه المعصوم أفيقول له قلدني في انه تعالى قادر عالم فيقول له كيف أقلدك ولم تسمح نفسي بتقليد محمد بن عبد الله ﷺ وهو صاحب المعجزة وإن ذكر له وجه الدليل اعاد القول فيه إلى ما مضى في اصل وجود الصانع وصدق الرسول من غير فرق. واما الأحكام الشرعية فلا بد لكل واحد من معرفة ما يحتاج إليه في واجباته وهي قسمان.
القسم الأول ما يمكن معرفته قطعا وهو الذي اشتمل عليه نص القرآن وتواتر عنه الخبر من صاحب الشرع كعدد ركعات الصلوات الخمس ومقادير النصب في الزكوات وقوانين العبادات وأركان الحج أو ما اجمعت عليه الأمة فهذا القسم لا حاجة فيه إلى امام معصوم أصلا.
القسم الثاني ما لا يمكن معرفته قطعا بل يتطرق الظن إليه كما كان يجب على الخلق في زمان رسول الله ﷺ في سائر الأقطار. واما صورة لا نص فيها فيحتاج إلى تشبيهها بالنصوص عليه وتقريبها منه بالاجتهاد وهو الذي قال معاذ فيه أجتهد رأيي وكون هذا مظنونا ضروري في الطرفين جميعا إذ لا يمكن شرط التواتر في الكل ولا يمكن استيعاب جميع الصور بالنص فلا يغني المعصوم في هذا شيئا فانه لا يقدر على أن يجعل ما نقله الواحد متواترا بل لو تيقنه لم يقدر على مشافهة كافة الخلق به ولا تكليفهم السماع عنه تواترا فيقلد اشياعه دعاة المعصوم وهم غير معصومين بل يجوز عليهم الخطأ والكذب فنحن نقلد علماء الشرع وهو دعاة محمد ﷺ المؤيد بالمعجزات الباهرة فأي حاجة إلى المعصوم فيه وأما الصورة التي ليست منصوصة فيجتهد فيها الرأي إذ المعصوم لا يغني عنها شيئا فإنه بين ان يعترف بانه أيضا ظان والخطأ جائز في كل ذي ظن ولا يختلف ذلك بالأشخاص فما الذي يميز ظنه من ظن غيره وهو مجوز للخطأعلى نفسه وإن ادعى المعرفة فيه أيدعيها عن وحي أو عن سماع نص فيه أو عن دليل عقلي فإن ادعى تواتر الوحي إليه في كل واقعة فإذا هو مدع للنبوة فيفتقر إلى معجزة كيف ولا يتصور تقدير المعجزة إذ بان لنا أن محمدا ﷺ خاتم الانبياء فإن جوزنا الكذب على محمد في قوله أنا خاتم الانبياءمع إقامة المعجزة فكيف نأمن الكذب هذا المعصوم وإن أقام المعجزة وان ادعى معرفته عن نص بلغه فكيف لا يستحي من دعوى نص صاحب الشرع على وقائع لايتصور حصرها وعدها بل لو عمر الإنسان عمر نوح ولم يشتغل إلا بعد الصور والنصوص عليها لم يستوعب عشر عشرها ففي أي عمر استوعب الرسول ﷺ جميع الصور بالنص فان ادعى المعرفة بدليل عقلي فما اجهله بالفقهيات والعقليات جميعا إذ الشرعيات أمور وضعية اصطلاحية تختلف بأوضاع الانبياء والاعصار والامم كما نرى الشرائع مختلفة فكيف تجوز فيها الادلة العقلية القاطعة وان ادعاها عن دليل عقلي مفيد للنظر فالفقهاء كلهم لهم هذه الرتبة.
فاستبان أن ما ذكروه تلبيس بعيد عن التحقيق وان العامي المنخدع به في غاية الحمق لانهم يلبسون على العوام بان يتبعوا الظن وان الظن لا يغني عن الحق شيئا والفقهيات لا بد فيها من اتباع الظن فهو ضروري كما في التجارات والسياسات وفصل الخصومات للمصالح فان كل الأمور المصلحية تبنى على الظن والمعصوم كيف يغني عن هذا الظن وصاحب الشريعة لم يغن عنه ولم يقدر عليه بل أذن في الاجتهاد وفي الاعتماد على قول آحاد الرواة عنه وفي التمسك بعمومات الألفاظ وكل ذلك ظن عمل به في عصره مع وجوده فكيف يستقبح ذلك بعد وفاته.
فان قيل فإذا اختلف المجتهدون لاختلاف مسالك الظنون فماذا ترون وإن قلتم كل مجتهد مصيب تناقض كلامكم فان خصومكم مهما أصابوا في اعتقادهم يقولون إنكم اخطأتم أفلستم مصيبين إذا فكيف وفي الفرق من يستبيح سفك دمائكم فإن كانوا مصيبين أيضا فنحن في سفك دمائكم ونهب أموالكم مصيبون فلم تنكرون علينا وان قلتم ان المصيب واحد فبم نميز المصيب من المخطئ وكيف نتخلص من خطر الخطأ والظن قلنا فيه رأيان فان قلنا كل مجتهد مصيب لم نتناقض إذ نريد به أنه مصيب حكم الله في حق نفسه ومقلديه إذ حكم الله عليه ان يتبع غالب ظنه في كل واقعة وقد اتبع وهذا حكم الله على خصمه وقولهم انه مصيب إذا في سفك الدم فهو كلام جاهل بالفقهيات فان ما افترق فيه الفرق مما يرى فيه سفك الدماء مسائل قطعية عقلية المصيب فيها واحد والمسائل الظنية الفقهية المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفة ومالك لا تفضي إلى التقاتل وسفك الدماء بل كل فريق يعتقد احترام الفريق الاخر حتى يحكم بانه لا ينقض حكمه إذا قضى به وانه يجب على المخالف الاتباع نعم اختلفوا في انه هل يطلق اسم الخطأ على الفرقة الأخرى في غير إنكار واعتراض ام لا وقولهم ان خصمك يقول انت مخطئ فإن كان هو مصيبا فإذا انت مخطئ قلنا ان قال خصمي انت مخطئ أي أظن خطأك فهو صادق وأنا أيضا صادق في قولي اني مصيب ولا تناقض وان قال اقطع بانك مخطئ فليس مصيبا في هذا القول بل بطلان قول من يقطع بالخطأ في المجتهدات ليس مظنونا بل هو مقطوع به في جملة المسائل القطعية الأصولية فالقول ان المصيب من المجتهدين كلاهما أو أحدهما مسألة اصولية قطعية لا ظنية وقد التبست عليهم الاصوليات بالفقهيات الظنية ومهما كشف الغطاء لم يتناقض الكلام فان قيل فإذا رأيتم كل واحد مصيبا فليجز للمجتهد ان يأخذ بقول خصمه ويعمل به لانه مصيب وليجز للمقلد ان يتبع من شاء من الأئمة المجتهدين قلنا أما اتباع المجتهد لغيره فخطأ فإن حكم الله عليه ان يتبع ظن نفسه وهذا مقطوع به فإذا اتبع ظن غيره فقد أخطأ في مسئلة قطعيه اصولية وعرف ذلك بالاجماع القاطع وأما بخبر المقلدين الأئمة فقد قال به قائلون ولكن المختار عندنا انه يجب ان يقلد من يعتقد انه افضل القوم واعرفهم ومستند اعتقاده إما تقليد سماعي من الأبوين وإما بحث عامي عن أحواله وإما تسامع عن ألسنة الفقهاء وبالجملة يحصل له ظن غالب من هذه المستندات فعليه اتباع ظن نفسه كما على المجتهد اتباع ظن نفسه وهذا ليس بكلي في الشرع لان الشرع يشتمل على مصلحة جزئية في كل مسألة وعلى مصلحة كلية في الجملة أما الجزئية فما يعرف عنها دليل كل حكم وحكمته اما المصلحة الكلية فهي ان يكون كل مكلف تحت قانون معين من تكاليف الشرع في جميع حركاته وأقواله وإعتقاداته فلا يكون كالبهيمة المسيبة تعمل بهواها حتى يرتاض بلجام التقوى وتأديب الشرع وتقسيمه إلى ما يطلقه والى ما يحجر عليه فيه فيقدم حتى يطلق الشرع ويمتنع حيث يمنع ولا يتخذ إلهه هواه ويتبع فيه مناه ومهما خبرنا المقدين في مذاهب الأئمة ليستمد منها أطيبها عنده اضطراب القائلون في حقه فلا يبقى له مرجع إلا شهوته في الاختيار وهو مناقض للغرض الكلي فرأينا أن نحصره في قالب وان نضبطه بضابط وهو رأي شخص واحد لهذا المعنة ولهذا اختلفت قوانين الأنبياء في الاعصار بالإضافة إلى التفصيل ولم تختلف في اصل التكليف ودعوة الخلق عن اتباع الهوى إلى طاعة قانون الشرع فهذا ما نراه مختارا في حق آحاد المقلدين هذا أحد الرأيين وهوان كل مجتهد مصيب ومن رأى أن المصيب واحد فلا تناقض أيضا في كلامه وقوله بم يأمن من إمكان الخطأ قلنا أولا تعارضهم فمن كان مسكنه بعيدا عن رسول الله ﷺ وكان يعول على قول الواحد وكذا من مسكنه بعيد عن معصومكم بينه وبينه البحار الحاجزة والمهامة المهلكة بم يأمن الخطأ على المبلغ وهو غير معصوم فسيقولون يحكم بالظن وليس عليه أكثر من ذلك فهذا جوابنا فإن قلتم إن له طريقا إلى الخلاص من الظن وهو أن يقصد النبي ﷺ فان التوجه إليه من الممكنات فكذا يقصد للإمام المعصوم في كل زمان قلنا وهل يجب قصد ذلك مهما جوز الخطأ فإن قلتم لا فأي فائدة في امكانه وقد جاز له اقتحام متن الخطر فيما جوز فيه الخطأ فإذا جاز ذلك فلا بأس بفوات الامكان كيف ولا يقدر كل زمن مدبر لا مال له على أن يقطع الف فرسخ ليسأل عن مسألة فقهية واقعة كيف ولو قطعها فكيف يزول ظنه بإمامكم المعصوم وان شافهه به إذ لا معجزة له على صدقه فبأي وجه يثق بقوله وكيف يزول ظنه به ثم يقول لا خلاص له عن احتمال الخطأ ولكن لا ضرر عليه وغاية ما في هذا الباب ان يكون في درك الصواب مزية فضيلة والإنسان في جميع مصالحه الدنيوية من التجارة والحرب مع العدو والزراعة يقول على ظنون فلا يقدر على الخلاص من إمكان الخطأ فيه ولا ضرر عليه بل لو أخطأ صريحا في مسألة شرعية فليس عليه ضرر بل الخطأ في تفاصيل الفقهيات معفو عنه شرعا بقوله ﷺ من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله اجر واحد فما هولوا من خطر الخطأ مستحقر في نفسه عند المحصلين من أهل الدين وانما يعظم به الأمر على العوام الغافلين عن أسرار الشرع فليس الخطأ في الفقهيات من المهلكات في الآخرة بل ليس ارتكاب كبيرة موجبا لتخليد العقاب ولا للزومه على وجه لا يقبل العفو أما المجتهدات فلا مأثم على من يخطئ فيها والحنفي يقول يصلي المسافر ركعتين والشافعي يقول يصلي أربعا وكيفما فعل في فالتفاوت قريب ولو قدر فيه خطأ فهو معفو عنه فإنما العبادات مجاهدات ورياضات تكسب النفوس صفاء وتبلغ في الآخرة مقاما محمودا كما أن تكرار المنفعة لما يتعلمه يجعله فقيه النفس ويبلغه رتبة العلماء ومصلحته تختلف بكثرة التكرار وقلته ورفعه صوته فيه وخفضه فإن اخطأ في الاقتصار على التكرار لدرس واحد مرتين وكانت الثلاث أكثر تأثيرا في نفسه في علم الله تعالى أو أخطأ في الثلاث وكان الاقتصار على الاثنين أكثر تأثيرا في صيانته على التبرم المبلد أو أخطأ في خفض الصوت وكان الجهر اوفق لطبعه وللتأثير في تنبيه نفسه أو كان الخفض أدعى له إلى التأمل في كنه معناه لم يكن الخطأ في شئ من ذلك في ليلة أو ليال مؤيسا عن رتبة الإمامة ونيل فقه النفس وهو في جميع ما يخمن ويرتب في مقادير التكرار من حيث الكمية والكيفية والوقت مجتهد فيه وظان وسالك إلى طريق الفوز بمقصوده ما دام مواظبا على الأصل وان كان قد تيقن له الخطأ احيانا في التفاصيل وانما الخطر في التغليط والاعتراض والاغترار بالفطنة الفطرية ظنا بان فيها غنية عن الاجتهاد كما ظن فريق من الباطنية ان نفوسهم زكية مرتاضة مستغنية عن الرياضات بالعبادات الشرعية فاهملوها وتعرضوا بسببها للعقاب الاليم في دار الآخرة فليعتقد المسترشد ان إفضاء المجاهدات الشرعية إلى المقامات المحمودة السنية في دار الآخرة كإفضاء الاجتهاد في ضبط العلوم والمواظبة عليها إلى مقام الأئمة وعند هذا نستحقر ما عظم الباطنية الأمر فيه من خطر الخطأ على المجتهدين في الجهر بالبسملة وتثنية الإقامة وأمثالها فالتفاوت فيه بعد المواظبة على الأصول المشهورة كالتفاوت في الجهر بالتكراراو الخفض به من غيرفرق وكيف وقد نبه الشرع على تمهيد عذر المخطئ فيه كما تواتر ذلك من صاحب الشرع. هذا تمام الكلام على المقدمة الثانية.
وأما المقدمة الثالثة وهي قولهم إذا ثبت وجوب معرفة الحق فلا يخلو إما أن يعرفه الإنسان من نفسه أو من غيره فهذه مقدمة صادقة لا نزاع فيها نعم المجادلة عليها بما يفحم الباطنية ويمنعهم من استعمالها كما ذكرنا في المقدمة الأولى وهي جارية في كل مقدمة صادقة.
وأما المقدمة الرابعة وهي قولهم إذا بطلت معرفته من نفسه بطريق النظر ثبت وجوب التعلم من غيره فهذه صادقة على تقدير بطلان النظر وتسليم معرفة الحق ولكنا لا نسلم بطلان النظر كما سبق وكما سنذكر في إفساد شبههم المزخرفة لإبطال النظر ولا نسلم وجوب معرفة الحق لأن من جملته ما بنا مندوحة عنه والمحتاج إليه معرفة الصانع وصدق الرسول والناس قد اعتقدوها سماعا وتقليدا لابويهم وفي ذلك ما يغنيهم فلا حاجة بهم إلى استئناف تعلم من معلم معصوم فإن قنعوا بالتعليم من الأبوين فنحن نسلم حاجة الصبيان في مبدأ النشوء إلى ذلك ولا ننكره ولا مستروح لهم في هذا التسليم ومن هذه المقدمة قولهم إذا ثبتت الحاجة إلى المعلم فليكن المعلم معصوما وهذا متنازع فيه فإن المعلم أن كان يعلم ويذكر معه الدليل العقلي وينبه على وجه الدلالة ليتأمل المتعلم فيه بمبلغ عقله ويجوز له الثقة بمقتضى عقله بعد تنبيه المعلم فليكن المعلم لو أفسق الخليقة فلم يحتاج إلى عصمته وليس يتلقف المتعلم منه تقليد ما يتلقفه بل هو كالحساب لا بد من معرفة الحق فيه لمصالح المعاملات ولا يعرفه الإنسان من نفسه ويفتقر إلى معلم ولا يحتاج إلى عصمته لانه ليس علما تقليدا بل هو برهاني وان زعمتم أن المتعلم ليس يتعلم بالبرهان والدليل لأن ذلك يدركه بنظر عقله ولا ثقة بعقله مع ضعف عقول الخلق وتفاوتها فلذلك يحتاج إلى معصوم فهذا الآن حماقة لانه إما ان يعرف عصمته ضرورة أو تقليدا ولا سبيل إلى دعوى شئ منه فلا بد ان يعرفه نظرا إذ لا شخص في العالم يعرف عصمته ضرورة أو يوثق بقوله مهما قال أنا معصوم وإذا لم يعرف عصمته كيف يقلده وإذا لم يثق بنظره كيف يعرف عصمته فان كان الأمر كما ذكرتموه فقد وقع الناس عن تعلم الحق وصار ذلك من المستحيلات فإذا قالوا لا بد من تعلم الحق لا بطريق النظر كان كمن يقول لا بد من الجمع بين البياض والسواد لانه ان تعلم من غيره بتأمل دليل المسألة التي يتعلمها كان ناظرا مقتحما خطر الخطأ وإن قلده لكونه معصوما كان مدركا عصمته بالنظر في دليل العصمة وان لم يعتقد العصمة ويعلم ممن كان فقد رجع الأمر بالآخرة إلى ما استبعدوه وهو التعلم ممن لم تعرف عصمته وفيهم كثرة واقوالهم متعارضة كما ذكروه وهذا لا مخلص عنه أبد الدهر.
وأما المقدمة الخامسة وهي قولهم إن العالم لا يخلو إما أن يشتمل على ذلك المعصوم المضطر إليه أو يخلو عنه ولا وجه لتقدير خلو العالم عنه فان ذلك يؤدي إلى تغطية الحق وذلك ظلم لا يليق بالحكمة فهو أيضا مقدمة فاسدة لانا إن سلمنا سائر المقدمات وسلمنا ضرورة الخلق إلى معلم معصوم فنقول لا يستحيل خلو العالم عنه بل عندنا يجوز خلو العالم عن النبي أبدا بل يجوز لله ان يعذب جميع خلقه وان يضطرهم إلى النار فانه بجميع ذلك متصرف في ملكه بحسب إرادته ولا معترض على المالك من حيث العقل في تصرفاته وانما الظلم وضع الشيء في غير موضعه والتصرف في غير ما يستحقه المتصرف وهذا لا يتصور من الله فلعل العالم خال عنه على معنى ان الله لم يخلقه.
فإن قيل مهما قدر الله على ارشاد الخلق إلى سبيل النجاة ونيل السعادات بعثة الرسل ونصب الأئمة ولم يفعل ذلك كان إضرارا بالخلق مع انتفاء المنفعة عن الله تعالى في هذا الإضرار وهو في غاية القبح المناقض لأوصاف الكمال من حكمته وعدله ولا يليق ذلك بالصفات الإلهية قلنا هذا الكلام مختل وغطاء ينخدع به العامي ويستحقره الغواص في العلوم وقد انخدع به طوائف من المعتزلة واستقصاء وجه الرد عليهم في فن الكلام وانا الآن مقتصر على مثال واحد يبين قطعا أن الله تعالى ليس يلزمه في نعوت كماله ان يرعى مصلحة خلقه وهو أنا نفرض ثلاثة من الاطفال مات أحدهم طفلا وبلغ أحدهم مسلما ثم مات وبلغ الآخر وكفر ثم مات فيجازي الله كل أحد بما يستحقه فيكون مقيما للعدل فينزل الذي بلغ وكفر في دركات لظى والذي بلغ واسلم في درجات العلا والذي مات طفلا من غير إسلام ومقاساة عبادة بعد البلوغ في درجة دون درجة الذي بلغ واسلم فيقول الذي مات طفلا يا رب لم اخرتني عن اخي المسلم الذي بلغ ومات ولا يليق بكرمك إلا العدل وقد منعتني من مزايا تلك الرتبة ولو انعمت علي بها لانتفعت بها ولم تضرك فكيف يليق بالعدل ذلك فيقول له بزعم من يدعي الحكمة انه بلغ واسلم وتعب وقاسى شدائد العبادات فكيف يقتضي العدل التسوية بينك وبينه فيقول الطفل يا رب انت الذي احييته وامتنى وكان ينبغي ان تمد حياتي وتبلغني إلى رتبة الاستقلال وتوفقني للآسلام كما وفقته فكان التأخير عنه في الحياة هو الميل عن العدل فيقول له بزعم من يدعي الحكمة كانت مصلحتك في إماتتك في صباك فإنك لو بلغت لكفرت واستوجبت النار فعند ذلك ينادى الكافر الذي مات بعد بلوغه من دركات لظى فيقول يا رب قد عرفت مني أني إذا بلغت كفرت فهلا امتني في صباي فإني قانع بالدرجة النازلة التي انزلت فيها الصبي المتشوق إلى درجات العلا وعند هذا لا يبقى لمن يدعي الحكمة في التسوية إلا الانقطاع عن الجواب والاجتراء وبهذا التفاوت يستبين أن الأمر أجل مما يظنون فان صفات الربوبيه لا توزن بموازين الظنون وان الله يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وبهذا يستبين انه لا يجب بعث نبي ولا نصب امام فقد بطل قولهم انه لا بد أن يشتمل العالم عليه.
وأما المقدمة السادسة وهي قولهم إذا ثبت ان المعصوم موجود في العالم فلا يخلو إما ان يصرح بالدعوى ويدعي العصمة أو يخفيه وباطل اخفاؤه لأن ذلك واجب عليه والكتمان معصية تناقض العصمة فلا بد أن يصرح بها فهذه مقدمة فاسدة لانه لا يبعد إلا يصرح به لكونه محفوفا بالأعداء مستششعرا في نفسه خائفا على روحه فيخفي ذلك تقية وذلك مما اتفقوا على جوازه واليه ذهبت الإمامية باجمعهم وزعموا ان الإمام حي قائم موجود والعصمة حاصلة له ولكنه يتربص تصرم دولة الباطل وانقراض شوكة الاعداء وإنما هو الآن متحصن بجلباب الخفاء حارس نفسه عن الهلاك لصيانة السر عن الإفشاء إلى ان يحضر أوانه وينقرض امام الباطل وزمانه فما جواب هؤلاء الباطنية عن مذهب الإمامية وما الذي يمنع احتمال ذلك فانهم ساعدوهم على جميع مقدماتهم إلا على هذه المقدمة وذلك لما شاهدوا من اختلال حال من وسمه هؤلاء بالعصمة وتحققوا من الأسباب المناقضة للورع والصيانة فاستحيوا من دعوى العصمة لمن يشاهدون من أحواله نقيضها فزعموا ان المعصوم مختف وانا ننتظر ظهوره في اوانه. وعند هذا نقول بم عرفت الباطنية بطلان مذهب الإمامية في هذه القضية فان عرفوها ضرورة فكيف قام الخلاف في الضروريات وان عرفوها نظرا فما الذي اوجب صحة نظرهم دون نظر خصومهم وتزكية عقولهم دون عقولهم أيعرف ذلك بطول اللحى أو ببياض الوجه وهلم جرا إلى عين المسلك الذي نهجوه وهذا لا محيص عنه بحال من الأحوال.
وأما المقدمة السابعة وهي قولهم إذا ثبت ان المعصوم لا بد أن يصرح فإذا لم يكن في العالم إلا مصرح واحد كان هو ذلك المعصوم لانه لا خصم له ولا ثاني له في الدعوى حتى يعسر التمييز فهذه فاسدة من وجهين أحدهما انهم بماذا عرفوا انه لا مدعي للعصمة ولا مصرح بها في أقطار العالم سوى شخص واحد فلعل في أقصى الصين أو في أطراف المغرب من يدعي شيئا من ذلك وانتفاء ذلك مما لا يعرف ضرورة ولا نظرا فان قيل يعرف ذلك ضرورة إذ لو كان لانتشر لان مثل هذا تتوافر الدواعي على نقله قلنا يحتمل انه كان ولم ينتشر إلى بلادنا مع بعد المسافة لان المدعي له ليس يتمكن من ذكره إلا مع سوسه وصاحب سره وحوله جماعة من اعدائه فيفزع من إظهار السر وإفشائه ويرى المصلحة في اخفائه أو هو مفش له ولكن المستمعين له ممنوعون عن الانتشار في البلاد واخبار العباد به لانهم محاصرون من جهة الاعداء مضطرون إلى ملازمة الوطن خوفا من نكاية المستولين عليهم فما الذي يبطل هذا الاحتمال وهو أمر قدر قريبا أو بعيدا فهو ممكن ليس من قبيل المحالات وانتم تدعون القطع فيما توردون فكيف يصفو القطع مع هذا الاحتمال.
الوجه الثاني في إفساد هذه المقدمة هو أنكم ظننتم أنه لا يدعي العصمة في العالم سوى شخص واحد وهو خطأ فإنا بالتواتر نتسامع بمدعيين أحدهما في جيلان فانها لا تنفك قط عن رجل يلقب نفسه بناصر الحق ويدعى لنفسه العصمة وانه نازل منزلة الرسول ويستعبد الحمقى من سكان ذلك القطر إلى حد يقطعهم جوانب الجنة مقدرا بالمساحة ويضايق في بعضهم إلى حد لا يبيع دراعا من الجنة لا بمائة دينار وهم يحملون إليه ذخائر الأموال ويشترون منه مساكن في الجنة فهذا أحد الدعاة فبم عرفتم انه مبطل وإذ قد تعدد المدعي ولا مرجح إذ لا معجزة فلا تظنوا ان الحماقة مقصورة عليكم وان هذه الكلمة لا ينطق بها لسان غيركم بل التعجب من ظنكم ان هذه الحماقة مقصورة عليكم في الحال أكثر من العجب في أصل هذه الحماقة فأما المدعي الثاني فرجل في جزائر البصرة يدعي الربوبيه وقد شرع دينار ورتب قرآنا ونصب رجلا يقال له على بن كحلا وزعم انه بمنزلة محمد ﷺ وانه رسوله إلى الخلق وقد احدق به طائفة من الحمقى زهاء عشرة الاف نفس ولعله يزيد عددهم على عددكم وهو يدعى لنفسه العصمة وما فوقها فما جوابكم عن رجل من الشاباسية يسوق هذه المقدمات إلى هذه المقدمة ثم يقول إذا لم يكن بد من معلم معصوم ولا معجزة للمعصوم وانما يعرف بالدعوى وصاحب الباطنية لا يدعي الربوبيه كيف وصاحب الشاباسية يدعي الربوبيه فأتباعه اولى فان قلتم من يدعي الربوبيه يعرف بطلان قوله ضرورة فالجواب من وجهين أحدهما أنه إنما يدعى ذلك بطريق الحلول ويزعم ان ذلك توارث في نسبهم وقد استمر ذلك في بيتهم عصرا طويلا والمدعي الآن كان جده مدعيا لذلك. والحلول قد ذهب إليه طوائف كثيرة فليس بطلان مذهب الحلولية ضروريا فكيف يكون ضروريا وفيه من الخلاف المشهور ما لا يكاد يخفى حتى مال إلى ذلك طائفة كبيرة من محققي الصوفيه وجماعة من الفلاسفة واليه اشار الحسين بن منصور الحلاج الذي صلب ببغداد حيث كان يقول أنا الحق أنا احق وكان يقرأ في وقت الصلب وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم واليه أشار أبوزيد البسطامي بقوله سبحاني سبحاني ما أعظم شأني وقد سمعت انا شيخا من مشايخ الصوفية تعقد عليه الخناصر ويشار إليه بالأصابع في متانة دين وغزارة علم حكى لي عن شيخه المرموق في الدين والورع انه قال ما تسمعه من أسماء الله الحسنى التي هي تسعة وتسعون كلها يصير وصفا للصوفي السالك بطريقه إلى الله وهو يعد من جملة السائرين إلى الله لا من زمرة الواصلين وكيف ينكر هذا وعليه مذهب النصارى في اتحاد اللاهوت بناسوت عيسى عليه السلام حتى سماه بعضهم إلها وبعضهم ابن الإله وبعضهم قالوا هو نصف الإله واتفقوا على أنه لما قتل انما قتل منه الناسوت دون اللاهوت كيف وقد تخيل جماعة من الروافض ذلك في علي رضي الله عنه وزعموا أنه الإله وكان ذلك في زمانه حتى أمر باحراقهم بالنار فلم يرجعوا وقالوا بهذا يبين صدقنا في قولنا أنه الإله لأن رسول الله ﷺ قال لا يعذب بالنار إلا ربها فبهذا يبين ان بطلان هذا المذهب ليس بضروري ولكنه ضرب من الحماقة ويعرف بطلانه بالنظر العقلي كما يعرف بطلان مذهبهم فإذا قد بطل قولهم لا مدعي للعصمة سوى صاحبنا بل قد ظهر من يدعي العصمة وزيادة.
الوجه الثاني في الجواب عن قولهم ان بطلان مذهبهم معلوم ضرورة ولا فرق بين ما يعرف بطلانه ضرورة وبين ما يعرف بطلانه مشاهدة أو تواترا وعدم العصمة فيمن ادعيتم عصمته معلوم بمشاهدة ما يناقض الشرع من وجوه اولها جمع الأموال واخذ الضرائب والمواصير واستئداء الخراجات الباطلة وهو الأمر المتواتر في جميع الأقطار ثم الترفه في العيش والإستكثار من أسباب الزينة والإسراف في وجوه التجمل واستعمال الثياب الفاخرة من الإبريسم وغيرها وعدالة الشهادة فتحرم بعشر عشر ذلك فكيف العصمة فان أنكروا هذه الأحوال أنكروا ما شاهده خلق كثير من تلك الأقطار وتواتر على سانهم إلى سائر الأمصار ولذلك لا ترى لاحد من أهل تلك البلاد اغترارا وانخداعا بهذه التلبيسات لمشاهدتهم ما يناقضها ومن وجوه حيلهم أنهم لا يبثون الدعوة إلا في بلاد نائية يحتاج المستجيب إلى قطع مسافة شاسعة لو اعترضت له ريبة فيها حتى تدفعه العوائق عن النهضه والرحلة فإنهم لو شاهدوا لانكشف لهم عوار تلك التلبيسات المزخرفة والحيل الملفقة.
أما المقدمة الثانية وهي قولهم إذا بان ان المدعى للعصمة مهما كان واحدا وقع الاستغناء عن الاستدلال على كونه معصوما فصاحبنا إذا هو المدعى للعصمة وحده فإذا هو الإمام المعصوم فهذه مقدمة نكذبهم فيها ولا نسلم ان صاحبهم يدعى لنفسه العصمة فانا لم نسمعه البته ولم يتواتر الينا من لسان من سمعه منه بل انما سمع ذلك من آحاد دعاتهم وليسوا معصومين ولاهم بالغون حد التواتر ولو انهم بلغوا حد التواتر فلا يحصل العلم بقولهم وخبرهم لوجهين أحدهما ان المشافهين لهذه الدعوة من جهة صاحبهم قليل فانه محتجب لا يظهر إلا للخواص ثم لا يشافه بالخطاب إلا خواص الخواص ثم لا يفشي هذه الدعوة إلا مع خاص من جملة خواص الخواص فالذين يسمعون عنه لا يبلغون عدد التواتر وان بلغوا فكلهم إن انتشروا لم يكن في بلدة منهم إلا واحد وأكثر البلاد أيضا يخلو عن آحادهم.
الوجه الثاني أنهم وإن بلغوا حد التواتر فقد فقد شرط التواتر في خبرهم إذ شرط ذلك الخبر إلا يتعلق بواقعة ينتشر التواطؤ فيها من طائفة كبيرة لمصلحة جامعة لهم كما يتعلق بالسياسات فان أهل معسكر واحد قد يجمعهم غرض واحد فيحدثون على التطابق بشئ واحد ولا يورث ذلك العلم ورب واحد أو اثنين يخبر عن أمر فيعلم أنه لا يجمعهما غرض فيحصل له العلم وهؤلاء الدعاة لعلهم قد تواطئوا على هذا الاختراع ليتوصلوا به إلى استتباع العوام واستباحة أموالهم فيتوصلون بها إلى أمالهم وعلى الجملة فحسن الظن بصاحبهم يقتضي تكذيبهم فإنهم لو حدثوا بذلك عن مريض في دار المرضى لاعتقدنا كذبه إلا ان يعتقد الجنون في ذلك المريض إذ لا يدعي عاقل العصمة عن المحرمات وتناول المحظورات مع مشاهدة أهل العلم تناوله لها ومباشرته لها فاقل آثار العقل الحياء عن فضيحة الاجتراء ومن تحلى بغير ما هو فيه وكان ذلك جليا ظاهرا لمن يتأمل فيه استدل به على اختلال عقله فإذا ليس يبين لنا صدقهم في نسبتهم هذه الدعوة إلى صاحبهم وهي مقدمتهم الاخيرة.
فإن قيل لو أنكر الناس في أطراف العالم في عصر رسول الله ﷺ صدق الدعاة من رسول الله وقالوا لانصدقكم في قولكم إن محمدا يدعي الرسالة بل لا يظن بعقله ذلك ماذا كان يقال لهم قلنا بئس ما شبهتم الملائكة بالحدادين إذ لا مساواة فإنه ﷺ كان ظاهرا بنفسه وأشياعه مبرزا للقتال مترددا في الأقطار مظهرا للدعوة على ملأ من الناس غير محتجب ولا متسستر ثم كان يظهر المعجزات الخارقة للعادة فانتشرت دعوته لانتشار خروجه ومقاتلته وانتتشار وجوده وليس الآن في صاحبكم كذلك نعم تواتر وجوده وترشحه مع آبائه للخلافة ودواعهم انهم اولى بها من غيرهم اما دعواه ودعوى من سبق من آبائه العصمة على المعاصي وعن الخطأ والزلل والسهو ومعرفة الحق في جميع أسرار العقليات والشرعيات فلم يظهر ذلك لنا بل لم تظهر دعواه العلم اصلا بفن من الفنون كالفقه أو الكلام أو الفلسفة على الوجه الذي يدعيه آحاد العلماء في البلاد فكيف ظهرت دعواه معرفة أسرار النبوة والاطلاع على علوم الدنيا والآخرة وهذا ما تواطأ على اختراعه توصلا إلى استدراج المستجيب وخداعه.
هذا تمام الرد عليهم في المقدمات تفصيلا مع أن في المنهج الأول المنطوي على الرد عيهم جملة كافية ومقنعا. ولم يبق إلا القول في إفساد أدلتهم المذكورة لإبطال النظر.
أما الدلالة الأولى وهي قولهم من صدق عقله فقد كذبه إذ صدق عقل خصمه وخصمه يصرح بتكذيبه فنقول هذا تخييل باطل من وجوه الأول المعارضة بمثال وهو أنا نقول نحن صدقنا العقول في نظرياتها وانتم صدقتموها في ضرورياتها وخصومكم من السوفسطائية يكذبونكم فيها فإن إقتضى ذلك لزوم الاعتراف بكذب العلوم الضرورية لزمنا من خلافكم الاعتراف بكذب العلوم النظرية فان العقل إن صدق في الضروريات فما بال عقل السوفسطائية كذب وما الفرق بين عقلكم وعقلهم أفتقولون ان ذلك منهم حماقة وسوء مزاج قلنا وكذلك حالكم في إنكار النظريات وهو كمن ينكر الحسابيات من العلوم فانه لا يشككنا في البراهين الحسابية وان كان البليد لا يفهم ومنكر النظر اصلا يجحده ولكن طريقنا معه أن نورد عليه المقدمات وهي ضرورية فإذا أدركها ادرك النتيجة فكذلك خصمنا إذا كذبنا في مسألة من المسائل كإنكار ثبوت واجب الوجود عرضنا عليه مقدمات القياس الدالة عليه وقلنا أتماري في قولنا لا شك في أصل الوجود أو في قولنا ان كل موجود إما جائز واما واجب ام في قولنا ان كان واجبا فقد ثبت واجب الوجود ام في قولنا إن كان جائزا فكل جائز مستند إلى واجب الوجود في آخر الأمر لا محالة وإذا لم يمكنه التشكك في المقدمات لم يمكنه التشكك في النتيجة وانما يختلف الناس فيها لان الفطرة غير كافية في تعريف الترتيب لهذه المقدمات بل لا بد من تعلمها من الافاضل وذلك الفاضل لا بد ان يكون تعلم أكثرها أو إستأثر باستنباط بعضها وهكذا حتى ينتهي الأمر إلى معلم معصوم هو نبي موحى ايه من جهة الله تعالى هكذا تكون العلوم كلها فان زعموا أنكم اعترفتم بالحاجة إلى المعلم ومن لم يعترف فهو معاند للمشاهدة فالافتقار إليه معترف به ولكنه كالافتقار إليه في علم الحساب فانه لا يحتاج فيه إلى معصوم إذ لا تقليد فيه ولكن يحتاج إلى حاسب ينبه على طريق النظر فإذا تننبه المعلم ساوى المعلم في العلم الضروري المستفاد من المقدمات بعضها على بعض ولا شك في أن معلم الحساب أيضا يعلم أكثر مما يعلم وان استقل باستنباط ترتيب البعض وكذا القول في معلم المعلم إلى ان ينتهي مبدأ العلم الحسابي إلى نبي من الانبياء مؤيد بالوحي والمعجزة ولكن بعد إفاضة الله علم الحساب فيما بين الخلق استغنى في تعلمه عن معلم معصوم فكذلك العلوم العقلية النظرية ولا فرق.
الاعتراض الثاني ان يقال لهم أنكرتم من خصومكم تصديق العقل في نظره واخترتم تكذيبه فبماذا تعرفون الحق وتميزون بينه وبين الباطل أبضرورة العقل ولا سبيل إلى دعواها أو بنظره فتضطرون إلى الرجوع إلى النظر فقد صدقتموه إذا بعد تكذيبه فتناقض كلامكم فان قلتم نحن نأخذه من الإمام المعصوم قلنا وبم تعرفون صدقه فان قلتم لانه معصوم قلنا وبم تعرفون عصمته فان قلتم بضرورة العقل لم يخف عليكم خزيكم وعرفتم في الباطن من أنفسكم خلاف ما أظهرتم فان عصمة رسول الله ﷺ مع معجزته لم تعرف بضرورة العقل حتى أنكر رسالته طوائف بل أنكر بعثة الرسل جميع البراهمة وانكر الاكثرون من المسلمين عصمة الانبياء واستدلوا بقوله تعالى: {وعصى آدم ربه فغوى} إلى غير ذلك مما اشتمل القرآن على حكايته من أحوال الانبياء فإذا لم تعرف عصمة صاحب المعجزة ضرورة فكيف تعرف عصمة صاحبكم ضرورة فان قيل نحن نعرفه بالنظر ولكن النظر تعلم منه والنظر ينقسم إلى صحيح وفاسد وتمييز صحيحه على فاسده ممتنع عن كافة الخلق إلا على الإمام الحق فهذا الميزان الموضح للفرقان بين الشبهه والبرهان فقد عرفنا صحة النظر الذي استفدنا منه فاطمأنت نفوسنا إليه بتزكيته وتعليمه قلنا والنظر الذي علمكموه هل افتقرتم في فهمه إلى تأمل ام هو مدرك على البديهة فان ادعيتم البديهة فما أشد جهلكم إذ يرجع حاصله إلى أن معرفة عصمته عرفت بالبديهة وهو كذب صريح وان افتقرتم إلى التأمل فذلك التأمل يعرف بالعقل ام لا ولا بد أن يقال إنه بالعقل فنقول والعقل إذا قضى عند التأمل بقضية فهو صادق ام لا فان قالوا لا فلم صدقوه وان قالوا نعم هو صادق فقد ابطلوا اصل مذهبهم وهو قولهم ان العقول لا سبيل إلى تصديقها فان قيل الإمام يعرف من بواطن أسرار الله أمورا إذا ذكرها حصل للمتعلم عند سماعها علم بديهي ضروري بصدقة ويستغنى به عن تدقيق النظر والتأمل فنقول ورسول الله ﷺ هل عرف ذلك ام لا فان قلتم لا فقد فضلتم الخليفة على الاصل وان قلتم نعم فلم اخفاها وهلا اظهرها وافشاها حتى كانت العقول تضطر على البديهة إلى ذكرها وكانت تتسارع إلى التصديق له في دعاويه ولم ترك طوائف الخلق مضطربين في مغاصات الشبه متعثرين في أذيال الضلالات مجاهدين بأموالهم وانفسهم في نصرة الخيالات الباطلة كيف وانتم إذا تعلمتم من إمامكم ذلك وقدرتم على ذكره حتى يعرف بالبديهة صدقه فتلك الدقيقة لماذا اخفيت ولأي يوم أجلت وكتمان الدين من أكبر الكبائر ثم كيف انقسم المستمعون فنون ضلالكم إلى قائل مستمع وراد ومنخدع ومنتبهه وهلا اسلك الكل في ربقة التصديق والانقياد وعلى الجملة فدعوى مثل هذا الكلام لا تدل إلا على الوقاحة وقلة الحياء والا فنحن بالضرورة نعلم انكم على البديهة لم تدركوا صدق امامكم وعصمته ولكنكم ربما تضطرون في تمشية التلبيس إلى خلع جلباب الحياء وكذلك يفعل الله بذوي الضلال والامراء فنعوذ بالله من سقطة الأغبياء فما هذه الكذبة الصادرة منكم قولة تتقال أو عثرة تقال أو خدعة يسبق اليها الجهال فضلا عن أفاضل الرجال.
الاعتراض الثالث وهو أن نقول للمسترشد مثلا إذا شك في صحة النظر واستدل بالاختلاف المجمل ينبغي ان تعين المسألة التي تشك فيها فان المسائل منقسمة إلى ما لا يمكن ان يعلم بنظر العقل والى ما يمكن ان يعلم علما ظنيا والى ما يعلم علما يقينيا ولا معنى لقبول السؤال المجمل بل لا بد من تعيين المسألة التي فيها الاشكال حتى يكشف الغطاء عنها وينبه السائل على أن المخالف فيها جهل وجه ترتيب المقدمات المنتجة له ونحن لا ندعي الآن المعرفة إلا في مسئلتين احداهما وجودالصانع الواجب الوجود المستغني عن الصانع والمدبر والثانية صدق الرسول ويكفينا في باقي المسائل ان نتلقاها تقليدا من الرسول ﷺ فهذا القدر الذي لا بد منه في الدين وباقي العلوم لا يتعين تحصليها بل الخلق مستغنون عنها وان كان ذلك ممكنا كالعلوم الحسابية والطبية والنجومية والفلسفية وهاتان المسألتان نعرفهما يقينا اما ثبوت واجب الوجود فبالمقدمات التي عرفناها واما صدق الرسول فبمقدمات تماثلها ومن احاط بها لم يشك فيها وعلم غلط المخالف منها كما يعلم غلط المحاسب في الحساب وخصومنا أيضا مضطرون أى معرفة هاتين المسألتين بالنظر والا فقول النبي لا يغني فيهما فيكف يغني فيهما قول المعصوم فإن قيل معرفة صفات الله ومعرفة الشرائع ومعرفة الحشر والنشر كل ذلك لا بد منه فمن اين يعرف قلنا يتعلم من النبي ﷺ المعصوم المؤيد بالمعجزة ونصدقه فيما يخبر عنه كما تقلدون انتم صاحبكم الذي لا عصمة له ولا معجزة فان قيل وبم تفهمون كلامه قلنا بما نفهم به كلامكم هذا في اسئلتكم وتفهمون كلامنا في اجوبتنا وهو معرفة اللغة وموضوع الألفاظ كما تفهمون انتم من المعصوم عندكم فان قيل ففي كلام الرسول وفي القرآن المشكلات والمجملات كحروف أوائل السور والمتشابه كأمر القيامة فمن يطلعكم على تأويله والعقل لا يدل عليه قلنا للآلفاظ الشرعية ثلاثة اقسام ألفاظ صريحة لا يتطرق اليها الاحتمال فلا حاجة فيها إلى معلم بل نفهمها كما تفهمون أنتم كلام المعلم المعصوم إذ لو اقتصر صريح كلام الشارع أى معلم ومؤول لاقتصر صريح كلام المعلم المعصوم إلى مؤول ومعلم آخر ولتسلسل إلى غير نهاية.
الثاني ألفاظ مجملة ومتشابهة كحرووف اوائل السور فمعانيها لا يمكن ان تدرك بالعقل إذ اللغات تعرف بالاصطلاح ولم يسبق اصطلاح من الخلق على حروف التهجي وان الر وحم عسق عبارة عماذا فالمعصوم أيضا لايفهمه وانما يفهم ذلك من الله تعالى إذا بين المراد به على لسان رسوله فيفهم ذلك سماعا وذلك لا يخلو إما أن لم يذكره الرسول لانه لا حاجة إلى معرفته ولم يكلف الخلق به فالمعصوم شريك في انه لا يعرفه إذ لم يسمعه من الرسول وان عرفه وذكره فقد ذكر ما بالخلق مندوحة عن معرفته فانهم لن يكلفوه وان ذكره الرسول فقد اشترك في معرفته من بلغه الخبر متواترا كان أو آحادا وفيه عن ابن عباس وجماعة من المفسرين نقل فإن كان متواترا افاد علما وإلا افاد ظنا والظن فيه كاف بل لا حاجة إلى معرفته فانه لا تكليف فيه واما وقت القيامة فلم يذكره الله تعالى ولا ذكره رسلوه عليه السلام وانما يجب التصديق بأصل القيامة وولا يجب معرفة وقتها بل مصلحة الخلق في إخفائها عنهم ولذلك طوى منهم فالمعصوم من أين عرف ذلك الكلام ولم يذكره الله ولا رسوله ولا مجال لضرورة العقل ولا لنظره في تعيين الوقت ثم لنقدر انه عرف ذلك وزعم انه ﷺ ذكره سرا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وذكره كل امام مع سوسه فأي فائدة للخلق فيه وهو سر لا يجوز ان يذكر إلا مع الأئمة فإن ذكره معصومكم وأفشى هذا السر الذي أمر الله تعالى بكتمانه إذ قال تعالى أكاد اخفيها كان معاندا لله ورسوله وان كان لا يفشيه فكيف يتعلم منه ما لا يجوز تعليمه فدل على أن الأمور العقلية محتاجة إلى التعليم ولكن المعلم أن كان ينبه على طريق النظر فيه فلا يشترط عصمته وان كان يقلد من غير دليل فلا بد أن تعرف بالمعجزة عصمته وهو النبي وناهيك به معلما فلا حاجة إلى غيره.
القسم الثالث الألفاظ التي ليست مجملة ولا صريحة ولكنها ظاهرة فانها تثير ظنا ويكتفى بالظن في ذلك القبيل والفن وسواء كان ذلك في الفقهيات وأمور الآخرة أو صفات الله فليس يجب على الخلق إلا أن يعتقدوا التوحيد والألفاظ فيه صريحة وأن يعتقدوا أنه قادر عليم سميع بصير ليس كمثله شيء وكل ذلك اشتمل القرآن عليه وهو مصرح به أما النظر في كيفية هذه الصفات وحقيقتها وأنها تساوي قدرتنا وعلمنا وبصرنا أم لا فقوله ليس كمثله شيء دال على نفي المماثلة لسائر الموجودات وهذا قد اكتفى من الخلق به فلا حاجة بهم إلى معصوم نعم الناظر فيه والمستدل عليه بالأدلة العقلية قد يتوصل إلى اليقين في بعض ما ينظر فيه وإلى الظن في بعضه ويختلف ذلك باختلاف الذكاء والفطنة واختلاف العوائق والبواعث ومساعدة التوفيق في النظر والعارف يذوق اليقين وإذا تيقن لم يتمار فيه ولم يشككه قصور غيره عن الدرك وربما تضعف نفسه ويشككه خلاف غيره ز كل ذلك لا مضرة له لأنه ليس مأمورا به والمعصوم لا يغنى عنه شيئا لو تابعه فإن محض التقليد لا يكفيه وإن ذكر وجه الدليل فذلك لا يختلف صدوره عن معصوم أو غيره كما سبق.
وأما الدلالة الثانية وهي قو لهم إذا جاءكم مسترشد متحير وسألكم عن العلوم الدينية أفتحيلونه على عقله ليستقل بالنظر وهو عاجز أو تأمرونه باتباعكم في مذهبكم وينازعكم المعتزلى والفلسفي وكذا سائر الفرق فبماذا يتميز مذهب عن مذهب وفرقة عن فرقة فالجواب من وجهين الأول هو أنا نقول لهم لو جاءكم متحير في أصل وجود الصانع وصدق الأنبياء انقلب عليكم هذا الإشكال فماذا تقولون إن ذكرتم دليلا عقليا لم نثق بنظره وإن رددتموه إلى عقله فكمثل فعساكم تشفون غليله بالحوالة على المعصوم فما أبرد هذا الشفاء فإنه يقول قدروني قد جئت مسترشدا في زمان محمد بن عبد الله ومعه معجزته فمعصومكم لا يقدر على معجزة أو قدروا إني شاهدت معصومكم قلب العصا ثعبانا أو أحيا الموتى أو أبرأ الأكمة والأبرص وأنا أشاهده فلا يبين لي صدقه بضرورة العقل ولا أثق بالنظر وكم من أصناف الخلائق شاهدوا ذلك وأنكروه فحمله بعضهم على السحر والمخرقة وبعضهم على غيره فلعلكم تشبعون غصته بان تقولوا له قلد الإمام المعصوم ولا تسأل عن السبب فيقول ولم لا اقلد المخالفين لكم في إنكار النبوة والعصمة وهل بينهما فرق من طول لحية أو بياض وجه إلى غير ذلك مما هذوا به وهذا قلب لو اجتمع أولهم مع آخرهم على الخلاص منه دون الأمر بالتفكر والنظر في الدليل لم يجدوا إليه سبيلا.
الجواب الثاني وهو التحقيق هو أنا نقول للمسترشد ماذا تطلب فإن كنت تطلب العلوم كلها فما اشد فضولك واعظم خطبك وأطول أملك فاشتغل من العلوم ما يهمك وان قال اريد ما يهمني قلنا ولا مهم إلا معرفة الله ورسوله وهذا معنى قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله فهاتان مسألتان يسهل علينا تعليمك اياهما وعند ذلك ذكر له المقدمات الضرورية التي ذكرناها في إثبات واجب الوجود ثم مثلها في دلالة المعجزة على صدق الرسول فإن زعم أن خلاف المخالفين هو الذي يشككني في هذه المعرفة أفأتبعكم أو أتبع مخالفيكم فنقول له لا تتبعنا ولا تتبع مخالفينا فان تعلم طريق التقليد مباح والتقليد في النتيجة غير موثوق به فشكك في أي مقدمة من مقدماتنا أفي قولنا إن أصل الوجود معترف به فان كان كذلك فعلاجك في دار المرضى فإن هذا من سوء المزاج فان من شك في أصل الوجود فقد شك أولا في وجود نفسه وإن قلت لا أشك في هذا بخلاف السوفسطائية قلنا فقد تيقنت مقدمة واحدة فهل تشك في الثانية وهي قولنا ان كان هذا الوجود واجبا فقد ثبت واجب الوجود فنقول هذا أيضا ضروري قلنا فهل تشك في قولنا إن كان جائزا فلا يتخصص أحد طرفي الجواز من الطرف المماثل له إلا بمخصص فهذه أيضا مقدمة ضرورية عند من يدرك معنى اللفظ وإن كان فيه توقف فالتوقف في درك مراد المتكلم من لفظه فان قال نعم لا شك فيه قلنا فذلك المخصص المفتقر إليه إن كان جائزا فالقول في ذلك لا كالقول فيه فيفتقر إلى مخصص غير جائز وهو المراد بواجب الوجود ففيماذا تتشكك فإن قال قد بقي لي شك عرف به بلادته وسوء فهمه وقطع الطمع عن رشده وليس هذا بأول بليد لا يدرك الحقائق فنخليه وهو كمن يطلب علم الحساب فذكرنا له الغوامض من مقدمات الحساب من الشكل (القطاع) الذي هو في آخر كتاب إقليدس فلم يفهمه لبلادته بل في الشكل الأول الذي مضمونه إقامة البراهين على مثلث متساوي الأضلاع فلم يدركه عرفنا ان مزاجه ليس يحتمل هذا العلم الدقيق فليس كل خلقه يحتمل العلوم بل الصناعات والحرف فهذا لا يدل على فساد هذا الأصل فإن قال المسترشد لست أشك في هذه المقدمات ولا في النتيجة ولكن لم يخالفكم من يخالفكم قلنا لجهله ترتيب هذه المقدمات أو لعناده أولبلادته وينكشف الغطاء بأن نشافه واحدا منهم يميل إلى الإنصاف ونراجعه في هذه المقدمات حتى يتبين لك أنه بين أن يفهم ويصف ويعترف أو لا يفهم لبلادته أو يمنعه التعصب والتقليد عن حسن الإصغاء إليه فلا يدركه وعند ذلك يطلع على خطئه وكذلك يصنع به في كل مسألة وينظر فيه إلى ما تحتمله حاله ويقبله ذكاؤه وفطنته ولا يحمله مالا يطيقه بل ربما يقنعه بما يورث له إعتقادا في الحق مصمما فإن أكثر عوام الخلق قنع منهم الشرع بذلك ولا يكشف له عن وجه البراهين فربما لا يفهمها.
وأما الدلالة الثالثة وهي قولهم الوحدة دليل الحق والكثرة دليل الباطل ومذهب التعليم تلزمه الوحدة ومذهبكم تلزمه الكثرة إذ لا تزال الفرقة المخالفة للتعليم يكثر اختلافهم ولا تزال الفرقة ألقابلة للتعليم يتحد طريقهم.
فالجواب من وجوه أحدها المعارضه والاخر الإبطال والثالث التحقيق أما المعارضة فتقول والصائرون إلى الافتقار إلى معلم معصوم اختلفوا في ذلك المعصوم فقالت الإمامية إنه ليس بظاهر وليس يعرف عينه ولكن أخفى نفسه تقية وقال آخرون ليس موجودا ولكنه منتظر الوجود وسيوجد إذا احتمل الزمان إظهار الحق ولو كان يحتمل الزمان إظهاره لوجد فانه لا فائدة في كونه موجودا مع تعذر الإظهار للتقية وقال آخرون في بعض الخلفاء الذين مضوا لسبيلهم إنهم أحياء وسيظهرون في أوانه واختلفوا في تعيينه حتى اعتقد فريق ان الملقب بالحاكم هو حي بعد وقال آخرون ذلك في غيره إلى نوع من الخبط طويل فان قيل هؤلاء جماعة من الحمقى غير معدودين في زمرتنا فإذا ضممتموهم الينا وجمعتم بيننا وبينهم تطرقت الكثرة الينا فلم تجمعون الينا من يخالفنا كما يخالفكم بل الإنصاف أن تنظروا الينا وحدنا ونحن لا تختلف كلمتنا اصلا قلنا ونحن أيضا إذا إعتبرنا وحدنا فنحن لا نخالف أنفسنا وقد يرد هذا الاعتراض لا محالة من يعتقد مذهبا في جميع المسائل لا يخالف نفسه ومعه جماعة من الخلق يوافقونه في معتقده في الجميع فإذا اعتبرتموه مع فرقته ولم تجمعوا اليهم من يخالفهم فبالحماقة والبلادة وقصور النظر ألفيت كلمتهم متحده فلا يدل على أن الحق فيهم فإن قلتم وبم عرفتم حماقة مخالفيكم انقلب ذلك عليكم من مخالفتكم القائلين بوجوب التعليم من المعصوم وإن زعمتم ان القائلين بأن النظر صحيح فرقة واحدة وإن اختلفوا في تفاصيل المذهب قلنا والقائلون بأن الإمام المعصوم لا بد منه فرقة واحدة وإن اختلفوا في التفصيل هذا ولا محيص عنه أبد الدهر.
الجواب الثاني وهو أنا نقول قولكم الوحدة أمارة الحق والكثرة أمارة الباطل باطل في الطرفين فرب واحد باطل ورب كثير لا ينفك عن الحق فإناإذا قلنا العالم حادث أو قديم فالحادث واحد والقديم واحد فقد اشتركا في لزوم الوحدة وانقسما في الحق والباطل وإذا قلنا الخمسة والخمسة عشرة ام لا فقولنا لا نفي واحد كقولنا عشرة إثبات واحد ثم اختلفا فكان أحدهما حقا والآخر باطلا فإن قلتم إن قولكم عشرة لا يمكنكم ان تقسم وتفصل إلا بواحد وقولكم لا يفصل بالتسعة والسبعة وسائر الاعداد ففيه الكثرة قلنا ولزوم الكثرة في مثل هذا التفصيل لا يدل على البطلان فإنا إذا عمدنا إلى جسمين متقاربين قلنا إنهما متساويان ام لا فقولنا متساويان واحد وهو باطل ولا يمكن ان يفصل إلا بواحد وقولنا لا إذ قلنا متفاوتان حق وهو واحد ويقبل التفصيل بما ينقسم إلى الحق والباطل إذ يقال هذا الجسم مفاوت لذلك الجسم أي هو أكبر أو يفسر بأنه أصغر والحق أحدهما والباطل يقابله في كونه واحدا وفي مشاركته في الاندراج تحت لفظ واحد هو حق يدل على أن ما ذكروه تلبيس.
الجواب الثالث عن قولهم إن الكثرة أمارة الباطل فمذهبنا واحد لا كثرة فيه وانما الكثرة في الأشخاص الذين اجتمعوا على مسألة ثم افترقوا في مسائل فلم قابلوا هذا بكثرة في جواب المسألة وهو في قولنا كم الخمسة والخمسة بل ورأيه في المذهب أن يفتي في مسألة واحدة بفتاوي كثيرة متناقضة فعند ذلك يقال الكثرة دليل الباطل ولسنا نفتي في كل مسألة إلا بواحد فإنا نقول الله واحد ومحمد ﷺ رسوله وهو صادق ومؤيد بالمعجزة فهذه فتوى واحدة فلتكن حقا وان كان باطلا فهو موافق لمذهبهم وقولنا ان نظر العقل طريق يوصل إلى درك ما لا يدرك اضطرارا مذهب واحد لا كثرة فيه فليكن حقا كما أن قولنا العلوم الحسابية علوم صادقة قول واحد وكان حقا وليتعجب من ابعادهم في التلبيس إذ أخذوا لفظة الكثرة وهي لفظة مضافة مشتركة تارة يراد بها الكثرة في الأجوبة عن مسألة واحدة كالجواب عن الخمسة والخمسة والسبعة والستة وغيرها وتارة تطلق ويراد كثرة الأشخاص المتفقين في مذهب والمختلفين فيه فرأوا مفارقة الباطل للكثرة المضافة إلى عدد الاجوبة في مسألة واجدة فاستدلوا به على بطلان قول واحد في مسألة واحدة اجتمع عليها جماعة كثيرة اختلفت كلمتهم في مسائل سوى تلك المشكلة لكن هذا وان كان تلبيسا بعيدا عن المحصل فمقصود واضعه التلبيس على العوام وذلك مما يتوقع رواجه فالحيلة على العوام في استدراجهم ليست ممتنعة على جماعة من الحمقى قد ادعوا الربوبيه فكيف تتعسر عن غيرها واما قوله تعالى: {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا} فهو من هذا الطراز في التلبيس فإن المراد به تناقض الكلمات في المتكلم الواحد إذا تناقض كلامه فسد ونحن لم يتناقض كلام الواحد منا في مسألة بل اجتمع طائفة على مسألة وهي إثبات النظر كما اجتمع طائفة على التعليم وإثباته ثم اختلفوا في مسائل اخرى فأين هذا من اختلاف الكلام الواحد.
فإن قيل المتعلمون إذا اجمعوا على التعليم وعلى معلم واحد وأصغوا بأجمعهم إليه لم يكن بينهم خلاف وإن كانوا ألف ألف قلنا والناظرون إن اجمعوا على النظر في الدليل وعلى تعيين دليل واحد في كل مسألة ووقفوا عليها لم يتصور بينهم خلاف فإن قلتم فكم من ناظر في ذلك الدليل بعينه قد خالف قلنا وكم من مصغ إلى معلمكم وقد خالف فان قلتم لانه لم يصدقه في كونه معصوما قلنا ولأن الناظر لم يعرف هذا وجه دلالة الدليل فان قلتم ربما يعرف وجه الدلالة ثم ينكر قلنا هذا لا يتصور إلا عنادا كما يعتقد واحد كون الإمام المعصوم حقا ثم يخالفه فلا يكون ذلك إلا عن عناد ولا فرق بين المسلكين.
وأما الدلالة الرابعة وهي قولهم ان كان لا يدرك الناظر المساواه بينه وبين خصمه في الاعتقاد فلم يدرك المساواه بين حالتيه وكم من مسألة اعتقدها نظرا ثم تغير اعتقاده فيم يعرف ان الثاني ليس كالأول قلنا يعرف ذلك معرفة ضرورية لا يتمارى فيها وهذا معتقدكم أيضا في مثالين ولا كلام أقوى من القلب والمعارضه في مثل هذه المقالات فان عادتهم مد يد الاعتصام إلى إشكالات لا تختص بمذهب فريق فيحيرون عقول العوام به ويخيلون انه من خاصة مذهب مخالفيهم والعامي المسكين متى ينتبه لانقلاب ذلك عليه في مذهبه فنقول هذا القائل اعتقد مذهب التعليم وإبطال النظر تتقليدا سماعا من أبويه أو سمع من الأبوين مذهبا ثم تنبه بعد ذلك لبطلانه فإن قال اعتقدته سماعا من الأبوين قلنا وأولاد النصارى واليهود المجوس وأولاد مخالفيكم في مسألة النظر وقع نشوؤهم على خلاف معتقدكم فبماذا تفرقون به بين أنفسكم وبينهم أبطول اللحى أو سواد الوجوه أم بسبب غيره والتقليد شامل وإن قلتم لا بل اعتقدنا مذهبكم ثم تركنا التقليد وتنبهنا لصحة مذهب التعليم قلنا تنبهتم لبطلان مذهبنا على البديهة أو بنظر العقل فإن كان على البديهة فكيف خفي عليكم البديهي في أول امركم وعلى أبائكم وعلينا ونحن العقلاء وقد طبقنا وجه الارض ذات الطول والعرض وان عرفتم ذلك بنظركم فلم وثقتم بالنظر ولعل حالكم اللاحقة كالحال السابقة فما الفارق فإن قلتم عرفنا من المعلم قلنا إن كان تقليدا فما الفرق بين التقليد للأخير والتقليد للأول وبين تقليدكم وتقليد طوائف المخالفين من اليهود والنصارى والمجوس والمسلمين وان فهمتم بالنظر فما الفرق بينكم وبين سائر النظار وهذا مما لا جواب عنه إلا أن يقال بالضرورة ندرك التفرقة بين ماعلم يقينا لا يمكن فيه الخطأ وبين ما يمكن فهكذا جوابنا.
المثال الثاني إن من غلط في مسألة حسابية ثم تنبه لها هل يتصور ان يزول شكه بعد التنبيه نجيب يعلم انه ليس مخطئا وأن الخطأ غير جائز عليه وانما كان الخطأ فيما تقدم لمقدمة شذت عنه فإن قلتم لا فقد أنكرتم المشاهدة وإن قلتم نعم فبماذا تدرك التفرقة إلا بالضرورة وقد انقلب الإشكال بعينه وكيف تنكر ذلك وقد رأيت من يدعي الذكاء والفطنه في علم الحساب حكم بأن التيامن في القبلة واجب ببلد نيسابور وأنه لا بد من الميل عن محرابها المتفق عليه إلى اليمين واستدل عليه بمقدمة مسلمة وهي ان الشمس تقف وسط السماء على سمت الرأس بمكة في اطول النهار وقت الزوال ثم قال ترى الشمس في اطول النهار وقت الزوال بنيسابور مائلة قليلا إلى يمين المستقبل في محاربها فيعلم انه على سمت رأس الواقف بمكة وأن مكة مائلة إلى اليمين فتابعه على ذلك جماعة من الحساب واعتقدوا ان ذلك هو الواجب بحكم هذا الدليل حتى تنبهوا على محل الغلط فيه وإحلالهم بمقدمة اخرى وهي أن ذلك انما يلزمه لو كان وقت الزوال بنيسابور هو وقت الزوال بمكة وليس كذلك بل يقع بعد ساعة وتكون الشمس قد أخذت إلى صوب المغرب في جانب اليمن عرضا فيرى وقت الزوال مائلا عن قبلة نيسابور لانه ليس وقت الزوال والغروب في جميع المواضع متفقا ويعرف ذلك باختلاف ارتفاع القطبين وانخفاضهما بل باستتارهما وانكشافهما في البقاع المختلفة فهذا الغلط وامثاله في الحساب أفيدل ذلك على أن النظر في الحساب ليس طريقا موصلا إلى معرفة الحق أو يتشكك المتنبه بعدها فيقول لعله شذت عني مقدمة أخرى وأنا غافل عنها كما في الأول هذا لو فتح بابه فهو السفسطة المحضة وندعو ذلك إلى بطلان العلوم والاعتقادات كلها فكيف يبقى معه وجوب التعلم ومعرفة العصمة ومعرفة إبطال النظر.
أما الدلالة الخامسة وهي قولهم ان صاحب الشرع ﷺ قال الناجي من الفرق واحدة وهم أهل السنة والجماعة ثم قال ما أنا الآن عليه وأصحابي فهذا من عجيب الاستدلالات فانهم أنكروا النظر في الأدلة العقلية لاحتمال الخطأ فيه وأخذوا يتمسكون بأخبار الآحاد والزيادات الشاذة فيها فأصل الخبر من قبيل الآحاد وهذه الزيادة شاذة فهو ظن على ظن ثم هو لفظ محتمل من وجوه التأويل ما لا حصر له فإن ما كان عليه هو وأصحابه إن اشترط جميعه في الأقوال والأفعال والحركات والصناعات كان محالا وإن أخذ بعضه فذلك البعض من يعينه ويقدره وكيف يدرك ضبطه وهل يتصور ذلك إلا بظن ضعيف وربما لا يرتضى مثله في الفقهيات مع خفة أمرها فكيف يستدل على القطعيات بمثلها على أنا نقول هم كانوا على اتباع نبي مؤيد بالمعجزة فلستم إذن من الفرقة الناجية فإنكم اتبعتم من ليس هو نبيا ولا مؤيدا بالمعجزة فسيقولون ليس تجب مساواته من كل وجه قلنا فنحن على مساواتهم من كل وجه فإنا نأمر باتباع الكتاب والسنة والاجتهاد عند العجز عن التمسك بهما كما أمر معذا به وكما استمر عليه الصحابة بعد وفاته من المشاورة والاجتهاد في الأمور فالحديث قاض لنا بالنجاة ولكم بالهلاك فإنكم إنحرفتم عن اتباع النبي المعصوم إلى غيره فان قيل ومعاني الكتاب والسنة كيف تفهمونها قلنا قد بينا أنها ثلاثة اقسام صريحة وظاهرة ومجملة وبينا لأن معرفتنا لها كمعرفة سائر الصحابة وكمعرفة من تدعون له العصمة من غير فرق فان قيل وانتم تدعون إلى نظر العقل وما كان هذا من دأب الصحابة قلنا هيهات فإنا ندعو إلى الاتباع وإلى تصديق رسول الله ﷺ في قول لا إله إلا الله محمد رسول الله فمن صدق بذلك سبقا إليه من غير منازعة ومجادلة قنعنا منه كما يقنع رسول الله ﷺ به من أجلاف العرب والناس على ثلاثة أقسام قسم هم العوام المقلدون نشئوا على اعتقاد الحق سماعا من آبائهم فهم مقرون عليه بصحة إسلامهم، الثاني الكفار الذين نشئوا على ضد الحق سماعا عن آبائهم وتقليدا فهم مدعوون عندنا إلى تقليد النبي المعصوم المؤيد بالمعجزة واتباع سنته وكتابه وأنتم تدعونه إلى معصومكم فليت شعري أينا أشبه بصحابة رسول الله ﷺ أمن يدعو إلى النبي المؤيد بالمعجزة أم من يدعو إلى من يدعى العصمة بشهوته من غير معجزة القسم الثالث من فارق حيز المقلدين وعرف ان في التقليد خطر الخطأ فصار لا يقنع به فنحن ندعوه إلى النظر في خلق السموات والأرض ليعرف به الصانع والى التفكر في معجزات النبي ﷺ ليعرف به صدقة وانتم تدعونه إلى تقليد المعصوم وتكذبون نظر العقل وتزخرفونه فليت شعري أي الدعوتين اوفق لدعوة أصحاب رسول الله ﷺ فمتى قالوا للمسترشد المتشكك إياك ونظر العقل وتأمله فإن فيه خطر الخطأ ولذلك اختلف الناظرون. بل عليك ان تقلد ما تسمعه منا من غير بصيرة وتأمل هذا لو صدر من مجنون لضحك منه ولقيل له لم نقلدك ولا نقلد من يكذبك فإذا طوى بساط الدليل المفرق بطريق النظر بينك وبين خصمك ولم يمكن درك التفرقة بالضرورة فبم تميز عن مخالفك المكذب فليت شعري من فتح باب النظر الذي يسوق إلى معرفة الحق متبعا فيه ما اشتمل عليه القرآن من الحث على التدبر والتفكر في الايات وفي القرآن وعجز الخلق عن الإتيان بمثله واستدلاله به هو أقرب إلى موافقة الصحابة وأهل السنة والجماعة أو من يؤيس الخلق عن النظر في الأدلة بالتكذيب حتى لا يبقى للدين عصام يتمسك بنه إلا الدعاوي المتعارضه وهل هذا إلا صنع من يريد ان يطفئ نور الله ويغطي شرع رسول الله صلى اللهس عليه وسلم بسد طريقه المفضى إليه فان قيل فنراكم تميلون تارة إلى الاتباع وتارة إلى النظر قلت هكذا تعتقده ولكنه في حق شخصين فالذين سعدوا بالولادة بين المسلمين فأخذوا الحق تقليدا مستغنون عن النظر وكذا الكفار إذا تيسر لهم تصديق رسول الله ﷺ تقليدا كما كان يتيسر لاجلاف العرب والذي يتشكك ويعرف غرر التقليد فلا بد له من معرفة صدقنا في قولنا لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم بعد هذا قدر على اتباع رسول الله ﷺ ولن يعرف التوحيد والنبوة إلا بالنظر في دليله الذي دل عليه الصحابة ودعا الرسول الخلق به فانه ما دعاهم بالتحكم المحض والقهر المجرد بل بكشف سبل الأدلة. فهذا صورة القول مع كل متشكك وإلا فليبرز الباطني معتقده في حقه وانه كيف ينجو عن شكه إذا حسم عليه باب التأمل والنظر.
فهذا حل هذه الشبهات وهي أرك عند المحصل من أن يفتقر في حلها إلى كل هذا الإطناب ولكن اغترار بعض الخلق به وظهور التلبيس في هذا الزمان يتقاضى هذا الكشف والإيضاح والله تعالى يوفقنا للعلم والعمل والرشد والإرشاد بمنه ولطفه.
الباب السابع في إبطال تمسكهم بالنص في إثبات الإمامة والعصمة
وفيه فصلان.
الفصل الأول في تمسكهم بالنص على الإمامة
وقد عجزت طائفة منهم عن التمسك بطريق النظر لمناقضة ذلك مسلكهم في إبطال نظر العقل وإيجاب الإتباع فعدلوا إلى منهج الإمامية بحيث استدلوا على إمامة علي رضي الله عنه بالنص وزعموا أنها مطردة في عترته فطمع هؤلاء في التمسك بالنص مع مخالفة مذهبهم مذهب الإمامية فزعموا انه عليه السلام نص على علي ونص علي على ولده حتى انتهى إلى الذي هو الآن متصد للإمامة بكونه منصوصا عليه ممن كان قبله وهذا غير ممكن لهذه الفرقة فإنهم بين التعلق فيه بأخبار آحاد لا تورث العلم ولا تفيد اليقين وثلج الصدر بل يحتمل فيه تعمد الكذب تارة والغلط فيه اخرى.
ولمنهج هؤلاء اجتووا طرق النظر في العقليات احترازا عما فيها من الخطأ فكيف يستتب لهم التمسك بأخبار الآحاد فيضطرون إلى دعوى خبر متواتر فيه من صاحب الشرع صلوات الله عليه تجري في الوضوح مجرى الخبر المتواتر في بعثته ودعوته وتحديه بالنبوة وشرعه الصلوات الخمس والحج والصوم وسائر الوقائع المستفيضة ومهما راجع العاقل بصيرته استغنى في معرفة استحالة هذه الدعوى عن مرشد يرشده ويسدد منهجه على وجه الاستحالة كيف وقد استحالت هذه الدعوى وتعذرت على الامامية في دعوى إمامة علي فقط فكيف تستتب لهؤلاء دعوى إمامة صاحبهم مع تضاعف الشغل عليهم وكثرة دعاويهم إلى أن ينساقوا إلى إثبات الإمامة لمن إعتقدوا إمامته اليوم ولكنا مع الاستغناء عن الايضاح لفساد دعواهم ننبه على ما فيه من العسر والاستحالة ونقول مدعي الإمامة اليوم لشخص معين من عترة رسول الله ﷺ يفتقر إلى نص متواتر عن رسول الله على علي رضي الله عنه ينتهي في الوضوح إلى حد الخبر المتواتر عن وجود علي ومعاوية وعمرو بن العاص فإنا بالتواتر عرفنا وجودهم ومهما ادعى تواتر هذا الخبر في زمان رسول الله ﷺ افتقر إلى حد التواتر بعده في كل عصر ينقرض حتى لا يزال النقل متواترا على تناسخ الأعصار وانقراض القرون بحيث يستوي في بلوغ المخبرين حد التواتر طرف الخبر وواسطته وهذا ممتنع يفتقر في كل واحد من علي وأولاده رضي الله عنه إلى يومنا هذا أربعة أمور الأول أن يثبت أنه مات عن ولده ولم يمت أبتر لا ولد له حتى يعرف ولده كما عرف علي رضي الله عنه وتعرف صحة انسابهم كما عرف صحة انساب علي الثاني أن يثبت أن كل واحد منهم نص على ولده قبل وفاته وجعله ولي عهده وعينه من بين سائر أولاده فانتصب للإمامة بتوليته ولم يمت واحد إلا بعد التنصيص والتعيين على ولي عهده الثالث ان ينقل أيضا خبرا متواترا انه ﷺ جعل نص جميع أولاده بمنزلة نصه في وجوب الطاعة ومصادفته لمنظنة الاستحقاق ووقوعه على المستحق للمنصب من جهة الله تعالى حتى لا يتصور وقوع الخطأ لواحد منهم في التعيين الرابع أن ينقل أيضا بقاء العصمة والصلاح للإمامة من وقت نصه على من نص عليه إلى ان توفي هو بعد نصه على غيره فلو انخرمت رتبة من هذه الرتب لم تستمر دعاويهم ولو اثبتوا تواتر نص كل واحد منهم ووجود ولده في العصر الأول فلا يغنيهم حتى يثبتوا تواتره كذلك في سائر الأعصار المتوالية بعده عصرا بعد عصر وهذه أمور لو ثبت التواتر فيها لعلمت كما يعلم وجود الانبياء ووجود الأقطار التي لم تشاهد كالصين وقيروان المغرب ووجود الوقائع كحرب بدر وصفين ولا يشترك الناس في دركه حتى كان لا يقدر أحد على أن يشكك فيه نفسه وليس يخفى أن الأمر في هذه الدعاوى بالضد إذ لو كلف الإنسان ان يتسع لتجويز ما قالوه وإمكانه لم يتمكن بل علم قطعا خلافه فكيف يتصور الطمع في إثباته وكيف يتواقحون على دعواه وقد اختلف القائلون بوجوب الإمام المعصوم في جماعة من الأئمة بزعمهم انه خلف ولدا أو لم يخلف واختلفوا في تعيين الإمامة في بعضهم واختلفوا في ظهوره فقال قائلون الإمام موجود ولكنه ليس يظهر تقية وقال آخرون هوظاهر فكيف خالفهم أصحابهم وان كانوا قد عرفوا ذلك بنص متواتر فكيف قبلوه من الآحاد ان لم يكن متواتر وقول الآحاد لا يورث إلا الظن فاستبان ان ما ذكروه طمع في غير مطمع وفزع إلى غير مفزع ومثالهم في الفرار من مسلك النظر إلى مسلك النص مثال من يميل من البلل إلى الغرق فإن المسلك الأول أقرب إلى التلبيس من هذا المسلك.
فإن قال قائل قد طولتم الأمر عليهم وأحرجتموهم إلى إثبات النص على علي ثم إثبات النص من كل واحد من أعقابه ولدا ولدا ثم صحة نسبه ثم استفاضة هذه الأخبار أولا ووسطا وآخرا وهم يستغنون عن جميع ذلك بخبر واحد وهو أن رسول الله ﷺ قال الإمامة بعدي لعلي وبعده لأولاده لا تخرج من نسبي ولا ينقطع نسبي أصلا ولا يموت واحد منهم قبل توليته العهد لولده. وهذا القدر يكفيهم قلنا نعم يكفيهم هذا القدر إن كان كل ما يخطر بالبال ويوافق شهوة الضلال يمكن اختراعه ونقله متواترا ولكن هذا على هذا الوجه لم يقع ولا نقل ولا إدعى مدع وقوعه معتقدا بالباطل ولا على سبيل العناد فضلا عن أن ينطق به عن الإعتقاد ونقل هذا النص ودعوى التواتر فيه كدعوى من نقل مضاده وهو أن الإمامة ليست لعلي بعدي وإنما هي لابي بكر وانما تكون بعده بالاختيار والشورى وان من ادعى النص أو اختصاص الإمامة بأولاده من سائر قريش فهو كاذب مبطل فكما نعلم أن هذا الخبر لم يكن ولم ينقل لاآحادا ولا تواترا نعلم ذلك فما يناقضه ومهما فتح باب الاختراع اشترك في الاقتدار عليه كل من يحاول اللجاج والنزاع وذلك مما لا يستحله ذوو الدين أصلا.
فإن قال قائل هذه الدعاوي لا تستتب لهؤلاء فهل تستتب للإمامية في دعوى النص على علي رضي الله عنه قلنا لا انما الذي يستتب لهم دعوى ألفاظ محتملة نقلها الآحاد فأما اللفظ الذي هو نص صريح فلا ودعوى التواتر أيضا لا يمكن وتيك الألفاظ كما رووا أنه قال من كنت مولاه فعلي مولاه وقوله أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلى غير ذلك من الألفاظ المحتملة لا تجري مجرى النصوص الصريحة فأما دعوى النص الصريح المتواتر فمحال من وجوه موضع استقصائها في كتاب الإمامة من علم الكلام وليس من غرضنا الآن ولكنا نذكر استحالته بمسلكين أحدهما انه لو كان ذلك متواتر لما شككنا فيه كما لم يشك في وجود علي رضي الله عنه ولا في انتصابه للخلافة بعد رسول الله ﷺ ولا في أمر رسول الله ﷺ بالصلاة والصيام والزكاة والحج فان قوله عليه السلام في التنصيص على الخلافة بعده على ملأ من الناس ليس قولا يستحقر فيستر ولا يتساهل في سماعه فيهمل بل تتوفر الدواعي على اشاعته ولا تسمح النفوس بإخفائه والسكوت عنه ولم تسمح بالسكوت عن أخبار وأحوال تقع دون ذلك في الرتبة فهذا قاطع في بطلان دعواهم الخبر المتواتر وعلى هذه الجملة فلا تتميز دعواهم عن دعوى البكرية حيث قالوا إن النبي ﷺ نص على أبي بكر رضي الله عنه نصا صريحا متواترا ولا عن دعوى الروندية إذ قالوا إنه نص على العباس نصا متواترا وهذه الأقاويل متعارضة لانها لم تعرف ولم تظهر بعد وفاة رسول الله ﷺ عند الخوض في الإمامة. فلا تبقى بعد ذلك ريبة في بطلان هذه الدعوى.
المسلك الثاني أن الذين نازعوا في إمامة أبي بكر وتصدوا للنضال عن علي رضي الله عنهما تمسكوا في نصرته بألفاظ محتملة نقلها آحاد كقوله عليه السلام من كنت مولاه فعلي مولاه وقوله أنت مني بمنزلة هارون من موسى. وكيف سكتوا عن النص المتواتر الذي لا يتطرق التأويل إلى متنه والطعن على سنده ومعلوم ان النفوس في مثل هذه المثارات تضطرب بأقصى الإمكان ولاتتعلق بالشبه إلا عند العجز عن البرهان فهذا أيضا يعرف المنصف ضرورة كذب المخترعين لهذه الأمور وإنما هداهم إلى اختراع دعوى النص المتواتر طائفة من الملحدين أرادو الطعن على الدين وهم الذين لقنوا اليهود أن ينقلوا عن موسى نصا بانه خاتم النبين وانه قال لليهود عليكم بالسبت ما دامت السموات والارضون وكان سسبيلنا في الرد عليهم ان اليهود مع ما جرى عليهم من الذل والإرقاق والسبى للذراري والأولاد وتخريب البلاد وسفك الدماء في طول زمان رسول الله ﷺ كانوا يحتالون بكل حيلة في طمس شريعته وتطفئة نوره ودفع استيلائه فلم لم ينقلوا عن موسى عليه السلام ذلك ولم لم يقولوا له ما جئت إلا بتصديق موسى وانه قال أنا خاتم النبين ومعلوم ان الدواعي تتوافر على نقل مثل ذلك توافرا لا يطاق السكوت معه وقد كان فيهم الأحبار والمتقدمون وكلهم كانوا مضطرين تحت القهر والذل متعطشين إلى دفع حجته بأقصى الجد وهذا بعينه هو الذي يكشف عن اختراع هؤلاء وتهجمهم على الإختلاق والتخرص.
فإن قيل لعله تمسك به المتمسكون إلا أنه اندرس ولم ينقل إلينا قلنا كيف نقل إلينا التمسك بالألفاظ الظاهرة ونقل المنازعة في الإمامة من الأنصار وقول قائلهم أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب والدواعي على نقل النص أوفر ولو جاز فتح هذا الباب لجاز لكل ملحد إذا احتججنا عليه بالقرآن وعجز الخلق عن معارضته وبينا به صدق محمد ﷺ أن يقول لعله عورض ولكنه لم ينقل وتعاطى المسلمون إخفاءه. فإن قيل أنتم مضطرون إلى معرفة هذا الخبر المتواتر ولكنكم تعاندون في إخفائه تعصبا قلنا ولم تنكرون على من يقلب عليكم ويقول انتم تعرفون بطلان ما ينقلون ضرورة ولكنكم تعاندون في الإختراع وبم تنفصلون عن البكرية والروندية إذا ادعوا ذلك في النص على أبي بكر والعباس رضي الله عنهما فإن قيل ألستم تدعون في معجزات الرسول ﷺ انشقاق القمر وكلام الذئب وحنين الجذع وتكثير الطعام القليل إلى غير ذلك مما أنكره كافة الكفار وطوائف من المسلمين ولم يكن خلافهم مانعا لكم من دعوى التواتر قلنا نحن لا ندعي التواتر الذي يوجب العلم الضروري إلا في القرآن أما ما عداه من هذه المعجزات فلو نقلها خلق كثير بلغوا حد التواتر لما تصوروا الشك فيها وانما نقلها جماعة دون تلك الكثرة يعرف صدقهم بضروب من الأدلة النظرية والاستدلال بالقرائن الخالية من رواتيهم ذلك وسكوت الآخرين عن الإنكار إلى غير ذلك من الأمور التي يتوصل إلى استفادة العلم منها عند إمعان النظر فيها بدقيق الفكر ومن أعرض عن النظر في تيك الدلائل والقرائن ولم يتأملها حق التأمل لم يحصل له العلم وأما انتم فلا تقنعون في خبركم بالنقل من عدد دون عدد التواتر ولا بالحاجة فيه إلى النظر والاستدلال والتأمل فانكم تبطلون طرق النظر فلا تستقيم هذه المقابلة منكم فان قيل انشقاق القمر من الآيات العلوية والبراهين السماوية فكيف يتصور ان يختص بمشاهدته عدد دون عدد التواتر قلنا ولو شاهده عدد التواتر كيف كان يتصور التردد فيه والإنكار له وهل ترى أحدا يتردد في وجود مكة ووجود أبي حنيفة والشافعي وسائر المشهورين وهي من الأمور الأرضية وهل ترى أن أحدا يتردد في أن الشمس كانت تطلع في أيام نوح عليه السلام ضربا للمثل فإن ذلك لما كان من الأمور المتواترة لم تتصور الاسترابة فيه يبقى قولكم إنه كيف اختص بمشاهدة انشقاق القمر طائفة فقد قال العلماء الأصوليون المنكرون لالتباس ما يتواتر من الأخبار هذه آية ليلية في وقت كان الناس فيه نياما أو كانوا تحت السقوف والظلال والأستار والمصحرون منهم المنتبهون لا تستحيل عليهم الغفلة في لحظة فيكون ذلك مثل انقضاض كوكب تختص بمشاهدته شرذمة قليلة وذلك ممكن فلم يكن الانشقاق أمرا دائما زمانا طويلا فليس يمتنع أن يختص بمشاهدته من حدق إليه بصره ممن كان حول رسول الله ﷺ حيث احتج على قريش بانشقاق القمر وقال قائلون أيضا يحتمل أن يكون الله تعالى خصص برؤية ذلك من حاج النبي ﷺ في تلك الساعة وناظره حيث قال ﷺ آيتي أنكم ترفعون روؤسكم فترون القمر منشقا وحجب الله أبصار سائر الخلق عن رؤيته بحجاب أو سحاب أو تسليط عقله وصرف داعية النظر لمصلحة الخلق فيه حتى لا يتحدى لنفسه بعض الكذابين في الأمصار فيستدل به على صدق نفسه أو يكون معجزة للنبي ﷺ من وجهين خارقين للعادة أحدهما إظهاره لهم والآخر اخفاؤه عن غيرهم وهذه الاحتمالات ذكرها العلماء حتى قال بعضهم ان انشقاق القمر ثبت بالقرآن وهو قوله تعالى: {اقتربت الساعة وانشق القمر} والكلام فيه طويل وعلى الأحوال كلها فما بلغ حد التواتر لا يتصور التشكك فيه هذه قاعدة معلومة عليها تبنى جميع قواعد الدين ولولاه لما حصلت الثقة بأخبار التواتر ولما عرفنا شيئا من أقوال رسول الله ﷺ إلا بالمشاهدة والكلام في هذا يحتمل الإطناب ولكنه بعيد عن مقصود الكتاب فرأيت الإيجاز فيه أولى.
الفصل الثاني في إبطال قولهم إن الإمام لا بد أن يكون معصوما من الخطأ والزلل والصغائر والكبائر
فنقول لهم وبماذا عرفتم صحة كونه معصوما ووجود عصمته أبضرورة العقل أو بنظره أو سماع خبر متواتر عن رسول الله ﷺ يورث العلم الضروري ولا سبيل إلى دعوى الضرورة ولا إلى دعوى الخبر المتواتر المفيد للعلم الضروري لان كافة الخلق تشترك في دركه وكيف يدعي ذلك وأصل وجود الأمام لا يعرف ضرورة بل نازع منازعون فيه فكيف تعلم عصمته ضرورة وان ادعيتم ذلك بنظر العقل فنظر العقل عندكم باطل وان سمعتم من قول إمامكم أن العصمة واجبة للإمام فلم صدقتموه قبل معرفة عصمته بدليل آخر وكيف يجوز أن تعرف إمامته وعصمته بمجرد قوله.
على أنا نقول أي نظر عرفكم وجوب عصمة الإمام فلا بد من الكشف عنه فإن قيل الدليل عليه وجوب الاتفاق على كون النبي ﷺ معصوما ولم نحكم بوجوب عصمته إلا لأنا بواسطته نعرف الحق ومنه نتلقفه ونستفيده ولو جوزنا عليه الخطأ والمعصية سقطت الثقة بقوله فما من قول يصدر عنه إلا ونتصور أن يقال لعله أخطأ فيه أو تعتمد الكذب فإن المعصية ليست مستحلية عليه وذلك مما لا وجه له فكذلك الإمام منه نلتقي الحق واليه نرجع في المشكلات كما كنا نرجع إلى رسول الله ﷺ فانه خليفته وبه نستضئ في مشكلات التأويل والتنزيل وأحوال القيامة والحشر والنشر. فإن لم تثبت عصمته فكيف يوثق به قلنا مثار غلطكم ظنكم أنا نحتاج إلى الإمام لنستفيد منه العلوم ونصدقه فيها وليس كذلك فإن العلوم منقسمة إلى عقلية وسمعية أما العقلية فتنقسم إلى قطعية وظنية ولكل واحد من القطع والظن مسلك يفضي إليه ويدل عليه وتعلم ذلك ممن يعلمه ولو من افسق الخلق ممكن فانه لا تقليد فيه وانما المتبع وجه الدليل وأما السمعيات فمسندها سماع اما متواتر وإما آحاد والمتواتر تشترك الكافة في دركه ولا فرق بين الإمام وبين غيره والآحاد لا تفيد إلا ظنا سواء كان المبلغ إليه أو المبلغ الإمام أو غيره والعمل بالظن فيما يتعلق بالعمليات واجب شرعا والوصول إلى العلم فيه ليس بشرط ولذلك يجب عندهم تصديق الدعاة المنتشرين في أقطار الأرض مع أنه لا عصمة لهم أصلا وكذلك كان ولاة رسول الله ﷺ في زمانه فإذا لا حاجة إلى عصمة الإمام فإن العلوم يشترك في تحصيلها الكل والإمام لا يولد عالما ولا يوحي إليه ولكنه متعلم وطريق تعلم غيره كتعلمه من غير فرق.
فإن قيل فلماذا نحتاج إلى الإمام إذ كان يستغنى عنه في التعليم قلنا ولماذا يحتاج في كل بلد إلى قاض وهل يدل الاحتياج إليه على أنه لا بد أن يكون معصوما فيقولون انما نحتاج إليه لدفع الخصومات وجمع شتات الأمور وجزم القول في المجتهدات وإقامة حدود الله تعالى واستيفاء حقوقه وصرفها إلى مستحقيها إذ لا سبيل إلى تعطيلها ولا سبيل إلى تفويضها إلى كافة الخلق فيتزاحمون عليها متقاتلين ويتكاسلون عنها متواكلين ومتخاذلين فتعطل الأمور فجملة الدنيا في حق الإمام كبلدة واحدة في حق القاضي فكما يستغنى عن عصمة القاضي في البلد ويحتاج إلى قضائه فكذلك يستغنى عن عصمة الإمام ويحتاج إليه كما يحتاج إلى القضاة ولأمور أخر كلية سياسية من حراسة الإسلام والذب عن بيضته والنضال دون حوزته وحشد العساكر والجنود إلى أهل الطغيان والعناد وتطهير وجه الأرض عن الطغاة والبغاة والساعين في الأرض بالفساد وملاحظة أطراف البلاد بالعين الكالئة حتى إذا ثارت فتنة بادر إلى الأمر بتطفئتها وإذا نبغت نابغة تقدم عى الفور بإزالتها قبل أن تسحكم غائلتها وتستطير في الأرض نائرتها هذا وما يجري مجراه هو الذي يراد لاجله الإمام وذلك يحتاج إلى عدالة وعلم ونجدة وكفاية وصرامة وشرائط آخر سنذكرها في الباب التاسع.
فأما العصمة فيستغنى عنها كما في حق القضاة والولاة فإن منعوا وإدعوا العصمة للقضاة والولاة وكل مترشح لإمر من الأمور من جهة الإمام وهذا ما اعتقده الإمامية حتى اورد عليهم الحارس والمتعسس والبواب ويرتبط بكل واحد منهم أمر فأجابوا بأن هذه الأمور إنا كانت أمورا دينية شرطت العصمة في المتكفلين بها والمنتصب لها بنصب الإمام لا يكون إلا معصوما ونعوذ بالله من اعتقاد مذهب يضطر ناصره والذاب عنه إلى ان يجاحد ما يشاهده ويدركه على البديهة والضرورة فالظلم على طبقات الناس مشاهد من أحوال المتصبين من جهة إمامهم ولا ينفك أورع متدين منهم عن استحلال الأموال المغصوبة باسم الخراج والضريبة من أموال المسلمين العلم بتحريمه ومهما انتهى كلام الخصم إلى مجاحدة الضرورة فلا وجه إلا الكف عنه والاقتصار على تعزيته فيما اصيب به من عقله.
الباب الثامن في الكشف عن فتوى الشرع في حقهم من التفكير وسفك الدم
ومضمون هذا الباب فتاوى فقهية ونحصر مقصوده في فصول أربعة
الفصل الأول في تكفيرهم أو تضليلهم أو تخطئتهم
ومهما سئلنا عن واحد منهم أو عن جماعتهم وقيل لنا هل تحكمون بكفرهم لم نتسارع إلى التكفير إلا بعد السؤال عن معتقدهم ومقالتهم ونراجع المحكوم عليه أو نكشف عن معتقدهم بقول عدول يجوز الاعتماد على شهادتهم فإذا عرفنا حقيقة الحال حكمنا بموجبه.
ولمقالتهم مرتبتان إحداهما توجب التخطئة والتضليل والتبديع والأخرى توجب التكفير والتبري.
فالمرتبة الأولى وهي التي توجب التخطئة والتضليل والتبديع هي أن تصادف عاميا يعتقد أن استحقاق الإمامة في أصل البيت وأن المستحق اليوم المتصدي لها منهم وأن المستحق لها في العصر الأول كأن هو على رضي الله عنه فدفع عنها بغير استحقاق وزعم مع ذلك أن الإمام معصوم عن الخطأ والزلل فانه لا بد أن يكون معصوما ومع ذلك فلا يستحل سفك دمائنا ولا يعتقد كفرنا ولكنه يعتقد فينا أنا أهل البغى زلت بصائرنا عن درك الحق خطأ إذ عدلنا عن اتباعه عنادا ونكدا فهذا الشخص لا يستباح سفك دمه ولا يحكم بكفره لهذه الاقاويل بل يحكم بكونه ضالا مبتدعا فيزجر عن ضلاله وبدعته بما يقتضيه رأي الإمام فأما أن يحكم بكفره ويستباح دمه بهذه المقالات فلا وهذا انما يقتصر على تضليله وتبديعه إذ لم يعتقد شيئا مما حكينا من مذهبهم في الإلهيات وفي أمور الحشر والنشر ولكنه لم يعتقد في جميع ذلك إلا ما نعتقده وانما تميز عنا بالقدرالذي حكيناه الآن فأن قيل هلا كفر تموهم بقولهم أن مستحق الإمامة في الصدر الأول كان عليا دون أبي بكر وعمر ومن بعده وأنه دفع بالباطل وفي ذلك خرق الإجماع أهل الدين قلنا لا ننكر ما فيه من القحوم على خرق الإجماع ولذلك ترقينا من التخطئة المجردة (التي نطلقها ونقتصر عليها في الفروع في بعض المسائل) إلى التضليل والتفسيق والتبديع ولكن لا تنتهي إلى التكفير فلم يبن لنا أن خارق الإجماع كافر بل الخلاف قائم بين المسلمين في أن الحجة هل تقوم بمجرد الإجماع (وقد ذهب النظام وطائفته إلى إنكار الإجماع وأنه لا تقوم به حجة أصلا) فمن التبس عليه هذا الأمر لم نكفره بسببه واقتصرنا على تخطئته وتضليله فأن قيل وهلا كفرتموهم لقولهم أن الإمام معصوم والعصمة عن الخطأ والزلل وصغير المآثم وكبيرها من خاصية النبوة فكأنهم أثبتوا خاصية النبوة لغير النبي ﷺ قلنا هذا لا يوجب الكفر وإنما الموجب له أن يثبت النبوة لغيره بعده وقد ثبت أنه خاتم النبيين أو يثبت لغيره منصب النسخ لشريعته فأما العصمة فليست خاصية النبوة ولا إثباتها كإثبات النبوة فلقد قالت طوائف من أصحابنا العصمة لا تثبت للنبي من الصغائر واستدلوا عليه بقوله تعالى: {وعصى آدم ربه فغوى} وبجملة من حكايات الأنبياء فمن يعتقد في فاسق أنه مطيع ومعصوم عن الفسق لا يزيد على من يعتقد في مطيع أنه فاسق ومنهمك في الفساد ولو اعتقد إنسان في عدل أنه فاسق لم يزد على تخطئة من اعتقد في غير معصوم أنه معصوم كيف يحكم بكفره نعم يحكم بحماقته واعتقاده أمرا يكاد يخالف المشاهد من الأحوال وأمرا لا يدل عليه نظر العقل ولا ضرورته.
فإن قيل فلو اعتقد معتقد فسق أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وطائفة من الصحابة فلم يعتقد كفرهم فهل تحكمون بكفره قلنا لا نحكم بكفره وإنما نحكم بفسقه وضلاله ومخالفته لإجماع الأمة وكيف نحكم بكفره ونحن نعلم أن الله تعالى لم يوجب على من قذف محصنا بالزنا إلا ثمانين جلدة ونعلم أن هذا الحكم يشتمل كافة الخلق ويعمهم على وتيرة واحدة وأنه لو قذف قاذف أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بالزنا لما زاده على إقامة حد الله المنصوص عليه في كتابه ولم يدعوا لأنفسهم التمييز بخاصية في الخروج عن مقتضى العموم فإن قيل فلو صرح مصرح بكفر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ينبغي أن ينزل منزلة من لو كفر شخصا آخر من آحاد المسلمين أو القضاة والأئمة من بعدهم قلنا هكذا نقول فلا يفارق تكفيرهم تكفير غيرهم من آحاد الأمة والقضاة بل أفراد المسلمين المعروفين بالإسلام إلافي شئين أحدهما في مخالفة الإجماع وخرقه فأن مكفر غيرهم ربما لا يكون خارقا لإجماع معتد به الثاني أنه ورد في حقهم من الوعد بالجنة والثناء عليهم والحكم بصحة دينهم وثبات يقينهم وتقدمهم على سائر الخلق أخبار كثيرة فقائل ذلك إن بلغته الأخبار واعتقد مع ذلك كفرهم فهو كافر لا بتكفيره إياهم ولكن بتكذيبه رسول الله ﷺ فمن كذبه بكلمة من أقاويله فهو كافر بالإجماع ومهما قطع النظر عن التكذيب في هذه الأخبار وعن خرق الإجماع نزل تكفيرهم منزله سائر القضاة والأئمة وآحاد المسلمين فإن قيل فما قولكم فيمن يكفر مسلما أهو كافر أم لا قلنا إن كان بعرف أن معتقده التوحيد وتصديق الرسول ﷺ إلى سائر المعتقدات الصحيحة فمهما كفره بهذه المعتقدات فهو كافر لأنه رأى الدين الحق كفرا وباطلا فأما إذا ظن أنه يعتقد تكذيب الرسول أو نفى الصانع أو تثنيته أو شيئا مما يوجب التفكير فكفره بناء على هذا الظن فهو مخطئ في ظنه المخصوص بالشخص صادق في تكفير من يعتقد ما يظن أنه معتقد هذا الشخص وظن الكفر بمسلم ليس بكفر كما أنظن الإسلام بكافر ليس بكفر فمثل هذه الظنون قد تخطئ وتصيب وهو جهل بحال شخص من الأشخاص وليس من شرط دين الرجل أن يعرف إسلام كل مسلم وكفر كل كافر بل ما من شخص يفرض إلا ولو جهله لم يضره في دينه بل إذا آمن شخص بالله ورسوله وواظب على العبادات ولم يسمع باسم أبي بكر وعمر ومات قبل السماع مات مسلما فليس الإيمان بهما من أركان الدين حتى يكون الغلط في صفاتهما موجبا للانسلاخ من الدين وعند هذا ينبغى أن يقبض عنان الكلام فإن الغوص في هذه المغاصة يفضي إلى إشكالات وإثارة تعصبات وربما لا تذعن جميع الأذهان لقبول الحق المؤيد بالبرهان لشدة ما يرسخ فيها من المعتقدات المألوفة التي وقع النشوء عليها والتحق بحكم استمرار الاعتياد بالأخلاق الغريزية التي يتعذر إزالتها وبالجملة لقول فيما يوجب الكفر والتبرى وما لا يوجبه لا يمكن استيفاؤه في أقل من مجلدة وذلك عند إيثار الاختصار فيه فلنقتصر في هذا الكتاب على الغرض المهم.
المرتبة الثانية المقالات الموجبة للتكفير
وهي أن يعتقد ما ذكرناه ويزيد عليه فيعتقد كفرنا واستباحة أموالنا وسفك دمائنا فهذا يوجب التكفير لا محالة لأنهم عرفوا أننا نعتقد أن للعالم صانعا واحدا قادرا عالما مريدا متكلما سميعا بصيرا حيا ليس كمثله شيءوأن رسوله محمد بن عبد الله ﷺ صادق في كل ما جاء به من الحشر والنشر والقيامة والجنة والنار وهذه الاعتقادات هي التي تدور عليها صحة الدين فمن رآها كفرا فهو كافر لا محالة فإن أنصاف إلى هذا شيء مما حكى من معتقداتهم من إثبات إلهين وإنكار الحشر والنشر وجحود الجنة والنار والقيامة فكل واحد من هذه المعتقدات موجب للتكفير صدر منهم أو من غيرهم فأن قيل لو اعتقد معتقد وحدانية الإله ونفى الشرك ولكنه تصرف في أحوال النشر والحشر والجنة والنار بطريق التأويل للتفصيل دون إنكار الأصل بل اعترف بأن الطاعة وموافقة الشرع وكف النفس عن المحرمات والهوى سبب يفضي إلى السعادة وأن الاسترسال على الهوى ومخالفة الشرع فيما أمر ونهى يسوق صاحبه إلى الشقاوة ولكنه زعم أنا لسعادة عبارة عن لذة روحانية تزيد لذتها على اللذة الجسمانية الحاصلة من المطعم والمنكح اللذين تشترك فيهما البهائم وتتعالى عنهما رتبة الملكية وانما تلك السعادة اتصال بالجواهر العقلية الملكية وابتهاج بنيل ذلك الكمال واللذات الجسمانية محتقرة بالإضافة إليها وأنا لشقاوة عبارة عن كون الشخص محجوبا عن ذلك الكمال العظيم محله الرفيع شأنه مع التشوق إليه والشغف به وأن ألم ذلك يستحقر معه ألم النار الجسمانية وأن ما ورد في القرآن مثله ضرب لعوام الحلق لما قصر فهمهم عن درك تلك اللذات فانه لو تعدى النبي في ترغيبه وترهيبه إلى ما ألفوه وتشوقوا إليه وفزعوا منه لم تنبعث دواعيهم للطلب والهرب فذكر من اللذات أشرفها عندهم وهي المدركات بالحواس من الحور والقصور إذ تحظى بها حاسة البصر ومن المطاعم والمناكح إذ لحظى بها القوة الشهوانية وما عند الله لعباده الصالحين خير من جميع ما اعربت عنه العبارات ونبهت عليه ولذلك قال تعالى فيما حكى عنه النبي ﷺ أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وكل ما يدرك من الجسمانيات فقد خطر على قلب بشر أو يمكن إخطاره بالقلب وزعم هذا القائل أن المصلحة الداعية إلى التمثيل للذات والآلام بالمالوف منها عند العوام كالمصلحة في الألفاظ الدالة على التشبيه في صفات الله تعالى وأنه لو كشف لهم الغطاء ووصف لهم جلال الله الذي لا تحيط به الصفات والاسماء وقيل لهم صانع العالم موجود ليس بجوهر ولا عرض ولا جسم ولا هو متصل بالعالم ولا هو منفصل عنه ولا هو داخل فيه ولا خارج عنه وأن الجهات محصورة في ست وأنسائر الجهات فارغة منه وليس شاغلا لواحد منها فلا داخل العالم به مشغول ولا خارج العالم عنه مشغول لبادر الخلق إلى إنكار وجود فإن عقولهم لا تقوى على التصديق بوجود موجود ترده الاوهام والحواس فذكر لهم ما يشير إلى ضروب التمثيل ليرسخ في نفوسهم التصديق باصل الوجود فيسارعون إلى امتثال الأوامر تعظيما له إلى الانزجار عن المعاصي مهابة منه فيمن هذا منهاجه.
قلنا اما القول بالهين فكفر صريح لا يتوقف فيه واما هذا فربما يتوقف فيه الناظر ويقول إذا اعترفوا باصل السعادة والشقاوة وكون الطاعة والمعصية سبيلا اليهما فالنزاع في التفصيل كالنزاع في مقادير الثواب والعقاب وذلك لا يوجب تكفيرا فكذلك النزاع في التفصيل والذي نختاره ونقطع به انه لا يجوز التوقف في تكفير من يعتقد شيئا من ذلك لانه تكذيب صريح لصاحب الشرع ولجميع كلمات القرأن من اولها إلى اخرها فوصف الجنة والنار لم يتفق ذكره مرة واحدة أو مرتين ولا جرى بطريق كناية أو توسع وتجوز بل بألفاظ صريحة لا يتمارى فيها ولا يستراب وأن صاحب الشرع اراد بها المفهوم من ظاهرها فالمصير إلى ما أشار إليه هذا القائل تكذيب وليس بتاويل فهو كفر صريح لا يتوقف فيه اصلا ولذلك نعلم على القطع انه لو صرح مصرح بإنكار الجنة والنار والحور والقصور فيما بين الصحابة لبادروا إلى قتله واعتقدوا ذلك منه تكذيبا لله ولرسوله فإن قيل لعلهم كانوا يفعلون ذلك ويبالغون فيه حسما لباب التصريح به إذ مصلحة العامة تقتضي أن لا يجرى الخطاب معهم إلا بما يليق بافهامهم ويؤثر في نفوسهم واثارة دواعيهم وإذا رفعت عن نفوسهم هذه الظواهر وقصرت عقولهم عن درك اللذات العقلية أنكروا الاصل وجحدوا الثواب والعقاب وسقط عندهم تمييز الطاعة عن العصيان والكفر عن الايمأن قلنا فقد اعترفت باجماع الصحابة على تكفير هذا الرجل وقتله لانه مصرح به ونحن لم نزرد على أن المصرح به كافر نجب قتله وقد وقع الاتفاق عليه وبقى قولكم أن سبب تكفيرهم مراعاة مصلحة العوام وهذا وهم وظن محض لا يعنى عن الحق شيئا بل نعلم قطعا انهم كانوا يعتقدون ذلك تكذيبا لله تعالى ولرسوله وردا لما ورد به الشرع ولم يدفعه العقل فان قيل فهلا سلكتم هذا المسلك في التمثيلات الواردة في صفات الله تعالى من آية الاستواء وحديث النزول ولفظ القدم ووضع الجبار قدمه في النار ولفظ الصورة في قوله عليه السلام أن الله خلق آدم عليه السلام على صورته إلى غير ذلك من أخبار لعلها تزيد على الف وانتم تعلمون أن السلف الصالحين ما كانوا يؤولون هذه الظواهر بل كانوا يجرونها على الظاهر ثم انكم لم تكفروا منكر الظواهر ومؤولها بل اعتقدتم التأويل وصرحتم به قلنا كيف تستتب هذه الموازنة والقرآن مصرح بانه {ليس كمثله شيء} والأخبار الدالة عليه أكثر من أن تحصى ونحن نعلم انه لو صرح مصرح فيما بين الصحابة بأن الله تعالى لا يحويه مكان ولا يحده زمان ولا يماس جسما ولا ينفصل عنه بمسافة مقدرة وغير مقدرة ولا يعرض له انتقال وجيئة وذهاب وحضور وأفول وأنه يستحيل أن يكون من الآفلين والمنتقلين والمتمكنين إلى غير ذلك من نفي صفات التشبيه لرأوا ذلك عين التوحيد والتنزيل ولوأنكر الحور والقصور والأنهار والأشجار والزبانية والنار لعد ذلك من أنواع الكذب والإنكار ولا مساواة بين الدرجتين وقد نبهنا على الفرق في باب الرد عليهم في مذهبهم بوجهين آخرين أحدهما أنالألفاظ الواردة في الحشر والنشر والجنة والنار صريحة لا تأويل لها ولا معدل عنها إلا بتعطيلها وتكذيبها والألفاظ الواردة في مثل الاستواء والصورة وغيرهما كتايات وتوسعات على اللسان تحتمل التأويل في وصفه والآخر ان البراهين العقليه يدفع اعتقاد التشبيه والنزول والحركه والتمكن من المكان وتدل على استحالتها دلاله لا يتمارى فيها ودليل العقل لا يحيل وقوع ما وعد به من الجنه والنار في الآخره بل القدره الأزليه محيطه بها مستوليه عليها وهي أمور ممكنه في نفسها ولا تتقاصر القدرة الأزلية عما له نعت الإمكان في ذاته فكيف يشبه هذا بما ورد من صفات الله تعالى ومساق هذا الكلام يتقاضى بث جملة من أسرار الدين أن شرعنا في استقصائها ورغبنا في كشف غطائها وإذ ورد ذلك معترضا في سياق الكلام غير مقصود في نفسه فلنقتصر على هذا القدر الذي انطوى في هذا الفصل ولنشتغل بما هو الأهم من مقاصد هذا الكتاب وقد بينا في هذا الفصل من يكفر منهم ومن لا يكفر ومن يضل ومن لا يضل.
الفصل الثاني في أحكام من قضي بكفره منهم
والقول الوجيز فيه أنه يسلك مسلك المرتدين في النظر في الدم والمال والنكاح والذبيحة ونفوذ الأقضية وقضاء العبادات أما الأرواح فلا يسلك بهم مسلك الكافر الأصلي إذ يتخير الإمام في الكافر الأصلي بين أربع خصال بين المن والفداء والاسترقاق والقتل ولا يتخير في حق المرتد بل لا سبيل إلى استرقاقهم ولا إلى قبول الجزية منهم ولا إلى المن والفداء وإنما الواجب قتلهم وتطهير وجه الأرض منهم هذا حكم الذين يحكم بكفرهم من الباطنية وليس يختص جواز قتلهم ولا وجوبه بحالة قتالهم بل نغتالهم ونسفك دماءهم فإنهم مهما اشتغلوا بالقتال جاز قتلهم وأن كانوا من الفرقة الأولى التي لم يحكم فيهم بالكفر وهو أنهم عند القتال يلتحقون بأهل البغي والباغي يقتل ما دام مقبلا على القتال وإن كان مسلما إلا أنه إذا أدبر وولى لم يتبع مدبرهم ولم يوقف على جريحهم أما من حكمنا بكفرهم فلا يتوقف في قتلهم إلى تظاهرهم بالقتال وتظاهرهم على النضال.
فان قيل هل يقتل صبيانهم ونساؤهم قلنا أما الصبيان فلا فإنه لا يؤاخذ الصبي وسيأتي حكمهم وأما النسوان فإنا نقتلهم مهما صرحن بالاعتقاد الذي هو كفر على مقتضى ما قررناه فإن المرتدة مقتولة عندنا بعموم قوله ﷺ من بدل دينه فاقتلوه نعم للإمام أن يتبع فيه موجب اجتهاده فإن رأى أن يسلك فيهم مسلك أبي حنيفة ويكف عن قتل النساء فالمسألة في محل الاجتهاد ومهما بلغ صبيانهم عرضنا الإسلام عليهم فإن قبلوا قبل إسلامهم وردت السيوف عن رقابهم إلى قربها وإن أصروا على كفرهم متبعين فيه آباءهم مددنا سيوف الحق إلى رقابهم وسلكنا بهم مسلك المرتدين وأما الأموال فحكمها حكم أموال المرتدين فما وقع الظفر به من غير إيجاف الخيل والركاب فهو فيء كمال المرتد فيصرفه إمام الحق على مصارف الفيء على التفصيل الذي اشتمل عليه قوله تعالى: {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول} الآية وما استولينا عليه بإيجاف خيل وركاب فلا يبعد أن يسلك به مسلك الغنائم حتى يصرف إلى مصارفها كما اشتمل عليه قوله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه} الآية وهذا أحد مسالك الفقهاء في المرتدين وهو أولى ما يقضى به في حق هؤلاءوأن كانت الأقاويل مضطربة فيه.
ومما يتعلق بالمال أنهم إذا ماتوا لا يتوارثون فلا يرث بعضهم بعضا ولا يرثون من المحقين ولا يرث المحق ما لهم إذا كان بينهم قرابة بل ولاية الوراثة منقطعة بين الكفار والمسلمين.
وأما أبضاع نسائهم فإنها محرمة فكما لا يحل نكاح مرتدة لا يحل نكاح باطنية معتقدة لما حكمنا بالتكفير بسببه من المقالات الشنيعة التي فصلناها ولو كانت متدينة ثم تلقفت مذهبهم أنفسخ النكاح في الحال أن كان قبل المسيس ويوقف على انقضاء العدة بعد المسيس فان عادت إلى الدين الحق وانسلخت عن المعتقد الباطل قبل تصرم العدة بقضاء مدتها استمر النكاح على وجهه وأن اصرت واستمرت حتى انقضت المدة وتصرمت العدة تبين أنفساخ النكاح من وقت الردة ومهما تزوج الباطني المحكوم بكفره بامرأة من أهل الحق أو من أهل دينه فالنكاح باطل غير منعقد بل تصرفه في ماله بالبيع وسائر العقود مردود فإن الذي اخترناه في الفتوى الحكم بزوال ملك المرتدين بالردة.
ويتصل بتحريم المناكحة تحريم الذبائح فلا تحل ذبيحة واحد منهم كما لا تحل ذبيحة المجوسي والزنديق فان الذبيحة والمناكحة تتحاذيان فهما محرمتان في حق سائر أصناف الكفار إلا اليهود والنصارى لأن ذلك تخفيف في حقهم لانهم أهل كتاب انزله الله تعالى على نبي صادق ظاهر الصدق مشهور الكتاب. واما اقضية حكامهم فباطلة غير نافذة وشهادتهم مردودة فإن هذه أمور يشترط الإسلام في جميعها فمن حكم بكفره من جملتهم لم تصح منه هذه الأمور بل لا تصح عبادتهم ولا ينعقد صيامهم وصلاتهم ولا يتأدى حجهم وزكاتهم ومهما تابوا وتبرءوا عن معتقداتهم وحكمنا بصحة توبتهم وجب عليهم قضاء جميع العبادات التي فاتت والتي اديت في حالة الكفر كما يجب ذلك على المرتد.
فهذا هو القدر الذي أردنا أن ننبه عليه من جملة أحكامهم.
فإن قيل ولماذا حكمتم بإلحاقهم بالمرتدين والمرتد من التزم بالدين الحق وتطوقه ثم نزع عنه مرتدا ومنكرا له وهؤلاء لم يلزموا الحق قط بل وقع نشوؤهم على هذا المعتقد فهلا ألحقتموهم بالكافر الاصلي قلنا ما ذكرناه واضح في الذين انتحلوا أديانهم وتحولوا اليها معتقدين لها بعد اعتقاد نقيضها أو بعد الانفكاك عنها وأما الذين نشئوا على هذا المعتقد سماعا من آبائهم فهم أولاد المرتدين لأن آباءهم وآباء آبائهم لابد أن يفرض في حقهم تنحل هذا الدين بعد الانفكاك عنه فإنه ليس معتقدا يستند إلى نبي وكتاب منزل كاعتقاد اليهود والنصارى بل هي البدع المحدثة من جهة طوائف من الملحدة والزنادقة في هذه الاعصار القريبة المتراخية وحكم الزنديق أيضا حكم المرتد لا يفارقه في شيء أصلا وانما يبقى النظر في أولاد المرتدين وقد قيل فيهم إنهم أتباع في الردة كأولاد الكفار من أهل الحرب وأهل الذمة وعلى هذا فأن بلغ طولب بالإسلام وإلا قتل ولم يرض منه بالجزية ولا الرق وقيل إنهم كالكفار الأصليين إذ ولدوا على الكفر فإذا بلغوا وآثروا الاستمرار على كفر آبائهم جاز تقريرهم بالجزية وضرب الرق عليهم وقيل إنه يحكم بإسلامهم لأن المرتد مؤاخذ بعلائق الإسلام فإذا بلغ ساكتا فحكم الإسلام يستمرإلى أن يعرض عليه الإسلام فأن نطق به فذاك وأن أظهر كفر أبويه عند ذلك حكمنا بردته في الحال وهذا هو المختار عندنا في صبيان الباطنية فإن علقة من علائق الإسلام كافية للحكم بإسلام الصبيان وعلقة الإسلام باقية على كل مرتد فإنه مؤاخذ بأحكام الإسلام في حال ردته وقد قال ﷺ كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. فيحكم بإسلام هؤلاء ثم إذا بلغوا كشف لهم عن وجه الحق ونهوا عن فضائح مذهب الباطنية وذلك بكشف للمصغى إليه في أوحى ما يقدر وأسرع ما ينتظر فإن أبى إلا دين آبائه فعند ذلك يحكم بردته من وقته ويسلك به مسلك المرتدين.
الفصل الثالث في قبول توبتهم وردها
وقد ألحقنا هؤلاء بالمرتدين في سائر الأحكام وقبول التوبة من المرتد لابد منه بل الأول ألا يبادر إلى قتله إلا بعد استتابته وعرض الإسلام عليه وترغيبه فيه وأما توبة الباطنية وكل زنديق مستتر بالكفر يرى التقية دينا ويعتقد النفاق واظهار خلاف المعتقد عند استشعار الخوف حقا ففي هذا خلاف بين العلماء ذهب ذاهبون إلى قبولها لقوله ﷺ: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. ولأن الشرع إنما بنى الدين على الظاهر فنحن لا نحكم إلا بالظاهر والله يتولى السرائر والدليل عليه أن المكره إذا أسلم تحت ظلال السيوف وهو خائف على روحه نعلم بقرينة حاله انه مضمر غير ما يظهره فنحكم بإسلامه ولا نلتفت إلى المعلوم بالقرائن من سريرته ويدل عليه أيضا ما روي أن أسامة قتل كافرا فسل عليه السيف بعد أن تلفظ بكلمة الإسلام فاشتد ذلك على رسول الله ﷺ فقال أسامة إنما فعل ذلك فرقا من السيف فقال ﷺ: هلا شققت عن قلبه. منبها به على أن البواطن لا تطلع عليها الخلائق وإنما مناط التكليف الأمور الظاهرة ويدل عليه أيضا أن هذا صنف من أصناف الكفار وسائر أصناف الكفار لا يسد عليهم طريق التوبة والرجوع إلى الحق فكذلك هاهنا.
وذهب ذاهبون إلى أنه لا تقبل توبته وزعموا أن هذا الباب لو فتح لم يمكن حسم مادتهم وقمع غائلتهم فإن من سر عقيدتهم التدين بالتقية والاستسرار بالكفر عند استشعار الخوف فلو سلكنا هذا المسلك لم يعجزوا عن النطق بكلمة الحق واظهار التوبة عند الظفر بهم فيلهجون بذلك مظهرين ويستهزئون بأهل الحق مضمرين وأما الخبر فانما ورد في اصناف من الكفار دينهم انه لايجوز التصريح بما يخالفه وأن من التزام الإسلام ظاهرا صار تاركا للتهود والتنصر هذا معتقدهم ولذلك تراهم يقطعون اربا اربا بالسيوف وهم مصرون على كفرهم ولا يسمحون في موافقة المسلمين بكلمة فاما من كان دينه أن النطق بكلمة الإسلام غير ترك لدينه بل دينه أن ذلك عين دينه فكيف نعتقد بتوبته مما هو عين دينه والتصريح به وفاء لشرط دينه كيف يكون تركا للدين.
هذا ما ذكر من الخلاف في قبول توبتهم وقد استقصينا ذلك في كتاب شفاء العليل في اصول الفقه ونحن الآن نقتصر على ذكر ما نختاره في هذه الفرقة التي فيهم الكلام فنقول للنائب من هذه الضلالة أحوال الحالة الأولى أن يتسارع إلى اظهار التوبة واحد منهم من غير قتال ولا ارهاق واضطرار ولكن على سبيل الايثار والاختيار متبرعا به ابتداء من غير خوف واستشعار هذا ينبغي أن يقطع بقبول توبته فإنا أن نظرنا إلى ظاهر كلمته صدقناها موافقة لعين الإسلام وأن نظرنا إلى سريرته كان الغالب أنها على مطابقة اللسان وموافقته فإنا لم نعرف الآن له باعثا على التقية وإنما المباح عندهم إظهار نقيض المعتقد تقية عند تحقيق الخوف فأما في حالة الاختيار فهو من أفحش الكبائر ويعضد ذلك بأمر كلي وهو أنه لا سبيل إلى حسم باب الرشد عليهم فكم من عامي ينخدع بتخيل باطل ويغتر برأي قائل ثم ينتبه من نفسه أو ينبهه منبه لما هو الحق فيؤثر الرجوع إليه والشروع فيه بعد النزوع عنه فلا سبيل إلى حسم مسلك الرشاد على ذوي الضلال والعناد.
الحالة الثانية الذي يسلم تحت ظلال السيوف ولكنه من جملة عوامهم وجهالهم لا من جملة دعاتهم وضلالهم فهذا أيضا تقبل توبته فمن لم يكن مترشحا للدعوة فضرر كفره مقصور عليه في نفسه ومهما أظهر الدين احتمل كونه صادقا في إسراره وإظهاره ولعامي الجاهل يظن أن التلبيس بالأديان والعقائد مثل المواصلات والمعاقدات الاختبارية فيصلها مدة بحكم المصلحة ويقطعها أخرى وباطنه يوافق الظاهر فيما يتعاطاه من التزام وإعراض ولذلك ترى من يسبي من العبيد والإماء من بلاد الكفر إلى دارالإسلام يدينون بدينهم معتقدين وشاكرين لله على ما أتاح لهم من الرشد ورحض عنهم من وضر الكفر والغي ولو سئلوا عن السبب في تبديل الدين وإيثار الحق المبين على الباطل لم يعرفوا له سببا إلا موافقة السادة على وفق مصلحة الحال ثم ذلك يؤثر في باطن عقائدهم كما نرى ونشاهد فإذا عرف أن العامي سريع التقلب فنصدقه في انقلابه إلى الحق كما نصدقه في إضرابه عنه إذا ظهر من معتقده خلاف الحق فإنا بين أن نغضى عن كافر مستسر ولا نقتله بل نتعامى عنه أو نهجم على قتل مسلم ظاهرا أو باطنا أن كان مضمرا لما يظهر وليس في التغاضي عن كفر كافر ليست له دعوه تنتشر وليس فيه شر يتعدى كبير محظور فكم مننا على الكفار وأغضينا عنهم ببذل الدينار فليس ذلك ممتنعا أما اقتحام الخطر في قتل من هو مسلم ظاهرا ويحتمل ان يكون مسلما باطنا احتمالا قويا فمحظور.
الحاله الثالثة أن ننظر بواحد من دعاتهم ممن يعرف منه أنه يعتقد بطلان مذهبه ولكنه ينتحله غير معتقد له ليتوصل إلى استمالة الخلق وصرف وجوههم إلى نفسه طلبا للرياسة وطمعا في حطام الدنيا هذا هو الذي يتقي شره والأمر فيه منوط برأي الإمام ليلاحظ قرائن أحواله ويتفرس من ظاهره في باطنه ويستبين أن ما ذكره يكون إذعانا للحق واعترافا به بعد التحقق والكشف أو هو نفاق وتقية وفي قرائن الأحوال ما يدل عليه والأولى ألا يوجب على الإمام قتله لا محالة ولا أنيحرم قتله بل يفوض إلى اجتهاده فإن غلب على ظنه أنه سالك منهج التقية فيما أداه قتله وأن غلب على ظنه أنه تنبه للحق وظهر له فساد الأقاويل المزخرفة التي كان يدعو اليها قبل توبنه وأغضى عنه في الحال وأن بقيت به ريبة وكل به من يراقب أحواله ويتفقده في بواطن أمره ويحكم فيه بموجب ما يتضح له منه فهذا هو المسلك القصد القريب من الإنصاف والبعيد من التعصب والاعتساف.
الفصل الرابع في حيلة الخروج عن إيمانهم وعهودهم إذا عقدوها على المستجيب
فإن قال لنا قائل ما قولكم في عهودهم ومواثيقهم وأيمانهم المعقودة على المستجيبين هل تنعقد وهل يجوز الحنث فيها أم يجب الحنث أو يحرم وأن حنث الحالف يلزمه بسببه معصية وكفارة أم لا يلزم وكم من شخص عقد عليه العهد وأكدت عليه اليمين فتطوقه اغترارا بتخيلهم ثم لما انكشف له ضلالهم تمنى افتضاحهم والكشف عن عوراتهم ولكن منعته الأيمان المغلظة المؤكدة عليه فالحاجة ماسة إلى تعليم الحيلة في الخروج عن تلك الأيمان فنقول الخلاص من تلك الأيمان ممكن ولها طرق تختلف باختلاف الأحوال والألفاظ.
الأول أن يكون الحالف قد تنبه لخطر اليمين وإمكان اشتماله على تلبيس وخداع فذكر في نفسه عقيب ذلك الاستثناء وهو قوله إن شاء الله فلا ينعقد ولا يمتنع عليه الحنث وإذا حنث لم يلزمه بالحنث حكم أصلا وهذا حكم كل يمين أردف بكلمة الاستثناء كقوله والله لأفعلن كذا أن شاء الله وكقوله أن فعلت كذا فزوجتي طالق إن شاء الله وما جرى مجراه.
الثاني أن يؤدي في يمينه أمرا وينوي خلاف ما يلتمس منه ويضمر خلاف ما يظهر ويكون الإضمار على وجه يحتمله اللفظ فيدبر بينه وبين الله عز وجل فله أن يخالف ظاهر كلامه ويتبع فيه موجب ضميره ونيته فإن قيل الاعتماد في اليمين على نية المستحلف إذ لو عول على نية الحالف واستثنائه لبطلت الأيمان في مجالس القضاة ولم يعجز المحلف بين أيديهم عن إضمار نية وإسرار استثناء وذلك يؤدي إلى إبطال الحقوق. قلنا القياس أن يكون التعويل على نية الحالف واستثنائه فإنه الحالف والمحلف عارض عليه اليمين ولكنه حكم باتباع نية المستحلف مراعاة للحقوق وصيانة لها بحكم الضرورة الداعية إليه وذلك في المحق في التحليف الموافق للشرع وموارد التوقيف فيه فأما المكره ظلما والمخادع عدوانا وغشما فلا ويعتبر أمر الحالف معه في القانون القياسي في الاعتبار بجانب الحالف لأن سبب العدول إلى اعتبار جانب المستحلف شدة الحاجة وأي حاجة بنا إلى تسليط الظلمة على تأكيد اليمين على ضعفاء المسلمين بأنواع الخداع والتلبيس فيجب الرجوع فيه إلى القانون.
الثالث أن ينظر إلى لفظ الحلف فإن قال عليك عهد الله وميثاقه وما أخذ على النبيين والصديقين من العهود وإن أظهرت السر فأنت بريء من الإسلام والمسلمين أو كافر بالله رب العالمين أو جميع أموالك صدقة لا ينعقد بهذه الألفاظ يمين أصلا فإنه أن قال أن فعلت كذا فأنا بريء من الإسلام ومن الله ورسوله لم تكن هذه يمينا لقوله ﷺ من حلف فليحلف بالله أو فليصمت الحلف بالله أن يقول تالله ووالله وما يجري مجراه وقد استقصينا صريح الإيمان في فن الفقه وهذه الألفاظ ليست من جملتها وكذا قوله على عهد الله وميثاقه وما أخذه الله على النبيين فإنه إذا لم يأخذ الله ميثاقهم وعهده لا ينعقد ذلك بقول غيره والله تعالى لم يأخذ ميثاقهم على كتمان سر الكفار والضلال ولا هذا العهد مماثل عهد الله فلا يلزم به شيء وكذلك لو قال الإنسان أن فعلت كذا فأموالي صدقة لا يلزمه شيء إلا أن يقول فلله على إن أتصدق بمالي وهو يمين الغضب واللجاج ويخلصه على الرأي المختار كفارة يمين.
الرابع أن ينظر إلى المحلوف عليه فإن كان لفظ المخلف فيه ما حكيناه في نسخة عهودهم وهو قولهم تكتم سر ولى الله وتنصره ولا تخالفه فليظهر السر مهما اراد ولا يكون حانثا لانه حلف على كتمان سر ولى الله تعالى وقد كتمه وانما الذي افشاه سر عدو الله وكذا قولهم تنصر اقاربه واتباعه فكل ذلك يرجع إلى ولى الله ولا يرجع إلى من قصده المحلف لانه عدو الله لا وليه فاما إذا عين شخصا بالاشارة أو عرفه باسمه الذي يعرف به قال تكتم سرى أو قال تكتم سر فلان ولى الله أو سر هذا الشخص الذي هو ولى الله فقد قال قائل لا يحنث عند افشاء السر نظرا إلى الصفة واعراضا عن الاشارة وقالوا هو كما لو قال بعت منك هذه النعجة والمشار إليه رمكة فإنه لا يصح والمختار عندنا أن الحنث يحصل والاشارة المعرفة المعينة التي لا يتطرق اليها الكذب بحال اعلى واغلب من الوصف المذكور كذبا على وجه الفضول مع الاستغناء وليس هذا كما لو قال والله لأشربن ماء هذه الإداوة ولا ماء فيها أن اليمين لا تعنقد لانه لا وجود لمتعلق اليمين وكذلك لو ترك الاضافة إلى الاداوة وذكر قوله هذا الماء واشار باليد لم ينعقد لفقد المتعلق ها هنا ولو اقتصر على قوله لا يفشى سر هذا الشخص أو سر زيد انعقد وأن سكت عن قوله انه ولى الله ومهما انعقدت اليمين على هذا الوجه فيباح افشاء السر بل يجب افشاء السر ثم تلزم الكفارة كفارة يمين ويكفيه أنيطعم عشرة مساكين كل مسكين مدا من الطعام فإن عجز عن هذا صام ثلاثة أيام وما اهون الخطب في ذلك ولا حاجة إلى التانق في طلب الحيلة للخلاص من هذا القدر فإنه قريب محتمل ثم لا يعصي بالحنث لقوله ﷺ من حلف على يمين فراى غيرها خيرا منها فليات الذي هو خير وليكفر عن يمينه ومن حلف أن يزني ولا يصلي وجب عليه الحنث ولزمته الكفارة فهذا جار مجرى ذلك.
الخامس إذا ترك الحالف النية والاستثناء وترك المحلف لفظ العهد والميثاق ولفظ ولي الله وأتى بأيمان صريحة بالله وبتعليق الطلاق والعتاق في مماليكه الموجودين وزوجاته وفيما سيملك من بعد إلى آخر عمره وعلق بالحنث لزوم مائة حجة وصيام مائة سنة وصلاة الف الف ركعة والتصدق بالف دينار وما جرى هذا المجرى فطريقه في اليمين بالله أن يطعم عشرة مساكين أو يصوم عند العجز كما سبق وهذا أيضا يخلصه عن تعليق الصدقة والحج والصيام والصلاة بالحنث لأنذلك يمين غضب ولحاج لا يلزم الوفاء بموجبه واما تعليق الطلاق والعتق فيما سيملك من النساء والعبيد والاماء فباطل غير منعقد فيلحنث ولينكح من شاء متى شاء إذ لا طلاق قبل نكاح ولا عتاق فبل ملك وإن كان في ملكه رقيق وخاف من عنقه فطريقه أن بيعه من اهله أو من ولده أو من صديقه ثم يفشى السر ثم يستعيده إلى ملكه بالشراء أو الاستيهاب أو بما شاء ولا يعجز أحد عن صديق يثق بصداقته وامانته فيبيعه منه ثم يرده عليه مهما اراد واما زوجته إن حلف بطلاقها فيخالعها بدرهم معها أو مع اجنبي ويفشى السر ثم يجدد نكاحها فيا لحوق الطلاق بعده فإن قبل إن كان قد طلق قبل ذلك تطليقتين ولم تبق له إلا طلقة واحدة وفي الخلع ما يحرمها عليه إلى أن تنكح زوجا غيره فما سبيله قلنا سبيله أن يقول مهما وقع عليك طلاقي فانت طالق قبله ثلا ثا فمهما حنث لا يقع طلاقه وهذه هي اليمين الدائرة التي تخلص من الحنث وتمنع وقوع الطلاق فإن قيل فقد اختلف العلماء في ذلك وربما لا يرتضى المتورع اقتحام شبهة الطلاق قلنا السائل إن كان مقلدا فعليه تقليد المفتي ومتابعته وعهدة الطلاق يختص بتطوقها المفتى دون المقلد وأن كان المفتى مجتهدا فعليه موجب اجتهاده فإن أدى اجتهاده إلى ذلك لم يمنع وقوع الطلاق فهو مخير بين أن يستبدل بها غيرها أو يسكت عن إفشاء سرهم فيترك معتقدهم وليس في السكوت عن إفشاء ما قالوه موافقة لهم في الدين بل الموافقة في أن يعتقد ما اعتقدوه وأن يعرب عن اعتقاده ويدعو إليه فأن صرف ضلالهم ظاهرا وباطنا فليس يلزمه أن ينطق بما سمعه منهم إذ ليس يتعين حكاية الكفر عن كل كافر فهذه طرق الحيل في الخروج عن اليمين وذهب بعض الخائضين في هذا الفن إلى أن الأيمان الصادرة منهم لا تنعقد بحال وهو كلام يصدر عن قلة البصيرة بالأحكام الفقهية وإنما الموافق لتصرف الفقة وأحكام الشرع الذي ذكرناه والسلام.
الباب التاسع في إقامة البراهين الشرعية على أن الإمام القائم بالحق الواجب على الخلق طاعته في عصرنا هذا هو الإمام المستظهر بالله حرس الله ظلاله
والمقصود من هذا الباب بيان إمامته على وفق الشرع وأنه يجب على كافة علماء الدهر الفتوى على البت والقطع بوجوب طاعته على الخلق ونفوذ أقضيته بمنهج الحق وصحة توليته للولاة وتقليده للقضاة وبراءة ذمة المكلفين عند صرف حقوق الله تعالى إليه وأنه خليفة الله على الخلق وأن طاعته على كافة الخلق فرض.
فهذا باب يتعين من حيث الدين صرف العناية إلى تحقيقه وإقامة البرهان على منهج الحق وطريقه فإن الذي يسير إليه الكلام أكثر المصنفين في الإمامة يقتضي ألا نعتقد في عصرنا هذا وفي أعصار منقضية خليفة غير مستجمع لشرائط الإمامة متصف بصفاتهم فتبقى الإمامة معطلة لا قائم بها ويبقى المتصدي لهامتعدياعن شروط الإمامة غير مستحق لها ولا متصف بها وهذا هجوم عظيم على الأحكام الشرعية وتصريح بتعطيلها وإهمالها ويتداعى إلى التصريح بفساد جميع الولايات وبطلان قضاء القضاة وضياع حقوق الله تعالى وحدوده وإهدار الدماء والفروج والأموال والحكم ببطلان الأنكحة الصادرة من القضاة في أقطار الأرض وبقاء حقوق الله تعالى في ذمم الخلق فإن جميع ذلك لا يتأدى على وفق الشرع إلا إذا صدر استيفاؤها من القضاة ومصدر القضاة تولية الإمام فإن بطلت الإمامة بطلت التولية وانحلت ولاية القضاة والتحقوا بآحاد الخلق وامتنعت التصرفات في النفوس والدماء والفروج والأموال وانطوى بساط الشرع بالكلية في هذه المهمات العظيمة فالكشف عن فساد كل مذهب يتداعى إلى هذه العظائم من مهمات الدين وفرائضه إلا أن تقرير ذلك متوعر وترتيبه مع الاحتراز عن التهدف للاشكالات والاعتراضات متعسر ونحن بتوفيق الله نكشف الغطاء عنه فنقول ندعى أن الإمام المستظهر بالله حرس الله أيامه هو الإمام الحق الواجب الطاعة فإن طولنا باقامة البرهان عليه تدرجنا في تحقيقه وتلطفنا في تفهيمه إلى أن يعترف المستريب فيه بالحق ويلوح له وجه الصواب والصدق ونقول لابد من امام في كل عصر ولا مترشح للإمامة سواه فهو الإمام الحق إذا فهذه نتيجة بنيناها على مقدمتين احداهما قولنا لا بد من الإمام والاخرى قولنا لا يترشح للإمامة سواه ففي ايهما النزاع فإن قيل بم تنكرون على من لا يسلم انه لا بد من امام بل يقول لنا غنية عنه قلنا هذا سؤال اتفقنا نحن والباطنية وسائر اصناف المسلمين على بطلانه فإنهم أجمعوا وتطابقوا على أنه لا بد من إمام وإنما نزاعهم في التعيين لا في الأصل ولم يذهب أحد إلى أن الأمام لا يجب نصبه وأنه يستغنى عنه إلا رجل يعرف بعبد الرحمن بن كيسان ولا يستريب محصل في بطلان مذهبه وفساد معتقده وكأننا ننبه المسترشد بمسكين الأول هو أن ابن كيسان مسوق فيما يدعيه باجماع الأمة قاطبة ولقد هجم بما انتحل من المذهب على خرق الاجماع وتضمخ برذيلة العدول عن سنن الاتباع فليلاحظ العصر الأول كيف تسارع الصحابة بعد وفاة رسول الله ﷺ إلى نصب الإمام وعقد البيعة وكيف اعتقدوا ذلك فرضا محتوما وحقا واجبا على الفور والبدار وكيف اجتنبوا فيه التوانى والاستئخار حتى تركوا بسبب الاشتغال به تجهيز رسول الله ﷺ وعلموا انه لو تصرم عليهم لحظة لاامام لهم فربما هجم عليهم حادثة ملمة وارتكبوا في حادثة عظيمة تتشتت فيها الآراء وتختلف متبوعا مطاعا يجمع شتات الآراء لا نخرم النظام وبطل العصام وتداعت بالانفصام عرى الأحكام فلاجل ذلك اثروا البدار إليه ولم يعرجوا في الحال إلا عليه وهذا قاطع في أن نصب الإمام أمر ضروري في حفظ الإسلام.
المسلك الثاني هو أن نقول لا يتمارى متدين في أن الذب عن حوزة الدين والنضال دون بيضته والانتداب لنصرته وحراسته بالمحافظة على نظام أمور جند الإسلام وعدته أمر ضروري واجب لابد منه وان النظام لا يستمر على الدوام إلا بمترصد يكلا الخلق بالعين الساهرة فمهما شرابت فئة للثوران وكشرت عن نابها واشرفت على الاستحكام بادر إلى تطفئتها وحسم غائلتها فانها لو تركت حتى إذا ثارت اشتغل بتطفئتها العوام والطغام والافراد والاحاد لأفضى ذلك إلى التعادي والتضاد وصارت الأمور شورى وبقي الناس فوضى مهملين سدى متهافتين على ورطات الردى مقتحمين فيه مسالك الهوى ومناهج المنى وعند ذلك تتناقض الارادات وتتنازع الشهوات وتفضي بالآخرة إلى استيلاء الرذائل على الفضائل وتوثب الطغام علماء الإسلام والاماثل وتمتد الأيدي إلى الأموال والفروج وأصبحت الأيدي السافلة عالية وليس يخفى ما في ذلك من حل عصام الأمور الدينية والدنيوية فيتبين بهذا للناظر البصير أن الإمام ضرورة الخلق لا غنية لهم عنه في دفع الباطل وتقرير الحق فقد ثبتت هذه المقدمة وهي أن الإمام لا بد منه.
فإن قيل وبم تنكرون على من ينازع في المقدمة الثانية وهي قولكم لا يترشح للإمامة سواه فإن الباطنية يدعون الخلق إلى مترشح لها غير ما إليه دعوتكم فكيف تستنب لكم هذه الدعوى. قلنا لا تنكر دعوى بعض المدعين للإمامة بغير استحقاق ولكنا نقول إذا بطل ما تدعيه الباطنية تعينت الإمامة لم يدعيهاوحصل ما نرومه ونبتغيه فانه إذا لم يكن بد من امام وفاقا وثبت ان الإمامة لا تعدو شخصين وثبت بطلان الإمامة في حق واحد لم تبق ريبة في ثبوتها للثاني والمسالك الدالة على إبطال الإمامة التي تدعيها الباطنية وترجيح الإمامة التي ندعيها أكثر من ان تدخل تحت الحصر فلسنا نسلك فيه مسلك الاستقصاء ولكنا نقتصر على دليلين واقعين قاطعين تقربهما كل عين ويشترك في دركهما الفطن والغبي والمحنك والصبي والمعاند والمنصف والمقتصد والمتعسف.
الأول هو أن عصام شرائط صحة العقيدة وسلامة الدين ولقد حكينا عن مذهب الباطنية وصاحبهم ما اقتضى ادنى درجاته التبديع والتضليل واعلاه التكفير والتبرى وذلك في إثباتهم الهين قديمين على ما اطبق عليه جميع فرقهم.
والثاني في إنكارهم الحشر والنشر والجنة والنار وجملة ما اشتمل عليه وعد القران ووعيده بفنون من التاويلات باطلة وذلك مما نعلم انه لو ذكر شيء منه في زمان رسول الله ﷺ وعصر الصحابة بعده لبادروا إلى حز الرقبة ولم يتماروا انه صريح التكذيب لله ورسوله فمن كذب الله في وحدانيته ولم يصدق بالايات الواردة في التوحيد ولم يصدق بالقيامة والبعث والنشور كيف يصلح ان ينتصب منصب الإمامة وان يناط به عرى الإسلام وهذا المسلك يتحققه الناظر إذا تصفح ثم رجع إلى مذاهبهم التي ذكرناها في إبطالها فيصح له بمجموع النظرين ما ذكرناه من اختلال الدين وفساد العقيدة واني يصلح للإمامة من فيه مثل هذه الرذيلة.
المسلك الثاني ان نسلم جدلا على سبيل التبرع والتقرير لمورد هذا السؤال ان صاحب الباطنية صالح للإمامة بصفاء الاعتقاد وصحة الدين وحصول سائر الشروط فمسلك الترجيح غير منحسم فان الإمامة التي ندعيها اجمع عليها ائمة العصر وعلماء الدهر بل جماهير الخلق واقاليم الارض في أقصى المشرق وفي أقصى المغرب حتى تطوق الطاعة له والانقيادلامره كل من على بسيط الارض الاشر ذمة الباطنية ولو جمع قضهم وقضيضهم وصغيرهم وكبيرهم لم يبلغ عددهم عدد أهل بلدة واحدة من متبعي الإمامة العباسية فكيف إذا قيسوا باهل ناحية أو باهل اقليم أو بكافة من على وجه الارض من منتحلي الإمام أفيتمارى المنصف في أن الغلاة من الباطنية على أهل الحق لو جمع منهم الصغير والكبير لم يبلغ عشر العشير من ناصري هذه الدولة القاهرة ومتبعي هذه العصابة المحقة وإذا كانت الإمامة تقوم بالشوكة وانما تقوى الشوكة بالمظاهرة والمناصرة والكثرة في الاتباع والاشياع وتناصر أهل الاتفاق والاجتماع فهذا اقوى مسلك من مسالك الترجيح وهذا بعد أن اعطيناهم بطريق المسامحة والتبرع صحة دينهم ووجود شروط الإمامة في صاحبهم.
فإن قيل ليس ينكر منكر كثرة هذه العصابة بالاضافة اليهم ولكن الحق لا يتبع الكثرة فان الحق خفى لا يستقل بدركه إلا الاقلون والباطل جلى يبادر إلى الانقياد له الاكثرون وانتم فقد بنيم الترجيح على قيام الشوكة بكثرة الانصار والاشباع وهذا انما يستقيم لو كانت الإمامة في اصلها تنعقد باجتماع الخلق على الطاعة فان ذلك لايرجح عند التجويز والاختلاف بالكثرة وليس الأمر كذلك بل الإمامة انما تنعقد عند الباطنية بالنص والمنصوص عليه محق بويع أو لم يبايع قل مبايعوه أو كثروا والمخالف له مبطل ساعدته دولته فكثر بسببها اتباعه أو لم تساعده فمن أي وجه يصح الاستدلال بكثرة الاتباع قلنا انما يستبين وجه دلالة الكثرة من فهم ماخذ الإمامة وقد بان انها ليست ماخوذة من النص كما قدرناه في الباب السابع ونبهنا على حماقة من يدعى تواتر النص من كل واحد منهم على ولده بل بينا جهل من يدعى ذلك في على رضي الله عنه فان ذلك لو كان لاستدل به على ولم يعجز عن اظهاره ولا رضى به فخو الذي جر العساكر والجنود في زمان معاوية حتى قتل من إبطال الإسلام في تلك المعارك الوف ولم يكترث بقتلهم فما الذي كان نزعه واشياعه عن الاستدلال بنص رسول الله ﷺ وقد بينا ان ذلك يقابله دعوى البكرية في النص على أبي بكر رضي الله عنه ودعوى الروندية في النص على العباس رضي الله عنه فإذا بطل تلقى الإمامة من النص لم يبق إلا الاختيار من أهل الإسلام والاتفاق على التقديم والانقياد وعند ذلك يبين انه مهما وقع الاتفاق على نصب واحد كما اتفقوا في بداية امامة العباسية فمن طمح إلى طلبها لنفسه كان باغيا فانهم لو اختلفوا في مبدأ الأمر وجب الترجيح بالكثرة في ذلك عند تقابل العدد وتقاربهم فكيف إذا اطبق كل من شرقت عليهم الشمس شارقة وغاربة لم يخالفهم إلا فئة معدودة وشرذمة يسيرة لا يؤبه ولا يعبأ بهم لشذوذهم بالاضافة إلى الخلق الكثير والجم الغفير الذين هم في مقابلتهم (ولا عشر العشر من أعشارهم وما هم إلا كالحسوة في البحر الزاخر والموج المتلاطم).
فان قيل وبم تنكرون على من يقول لا ماخذ للإمامة إلا لنص أو الاختيار فإذا بطل الاختيار ثبت النص ويدل على بطلان الاختيار انه لايخلو اما ان يعتبر فيه اجماع كافة الخلق أو اجماع كافه أهل الحل والعقد من جملة الخلق في جميع أقطار الأرض أو يعتبر إجماع أهل البلد الذي يسكنه الإمام ويقدر باجماع عشرة أو خمسة أو عدد مخصوص أو يكتفي بمبايعة شخص واحد وباطل ان يعتبر فيه اجماع كافة الخلق في جميع أقطار الارض فان ذلك غير مكن ولا مقدور لاحد من الأئمة ولا فرض ذلك أيضا في الاعصار الخالية للائمة الماضين وباطل ان تعتبر اجماع جميع أهل الحل والعقد في جميع افطار الارض لان ذلك مما يمتنع أو يتعذر تعذرا يفتقر فيه إلى انتظار مدة عساها تزيد على عمر الإمام فتبقى الأمور في مدة الانتظار مهملة ولانه لما عقدت البيعة لابي بكر رضي الله عنه لم ينتظر انتشار الأخبار إلى سائر الامصار ولا تواتر كنب البيعة من اقاصي الأقطار بل اشتغل بالإمامة وخاض في القيام بموجب الزعامة محتكما في أوامره ونواهيه على الخاصة والعامة وإذا بطل اشتراط اجماع كافة الخلق وكافة أهل الحل والعقد فالتخصيص بعد ذلك تحكم إذ ليس من يشترط باتفاق أهل بلدة بأولى ممن يكتفي بأهل محلة أو قرية أو لم يشترط اتفاق أهل ناحية أو اقليم ومن لا يشترط اجماع أربعين أو خمسة أو أربعة أو اثنين بأولى من غيره من الاعداد وهذه المقدرات قد ذهب إلى التحكم بها ذاهبون بمجرد التشهى من غير مستند فلا يبقى إلا الاكتفاء ببيعة شخص واحد وفي الأشخاص كثرة وأحوالهم متعارضة ولا يترجح شخص على شخص إلا بالعصمة فيجب ان يكون إذا مولى العهد واحد وليكن ذلك الشخص معصوما وهو معتقدنا وعند هذا لا تنفع الكثرة في المخالفين لذلك الواحد المتميز بخاصية عن غيره فإذا لا معتصم في الكثرة التي تعلقتم بها قلنا نعم لا ماخذ للإمامة إلا النص أو الاختيار ونحن نقول مهما بطل النص ثبت الاختيار وقولهم ان الاختيار باطل لانه لايمكن اعتبار كافة الخلق ولا الاكتفاء بواحد ولا التحكم بتقدير عدد معين بين الواحد والكل فهذا جهل بمذهبنا الذي نختاره ونقيم البرهان على صحته والذي نختاره انه يكتفي بشخص واحد يعقد البيعة للامام مهما كان ذلك الواحد مطاعا ذا شوكة لا تطال ومهما كان مال إلى جانب مال بسببه الجماهير ولم يخالفه إلا من لا يكرث بمخالفته فالشخص الواحد المتبوع المطاع الموصوف بهذه الصفة إذا بايع كفى إذ في موافقته الجماهير فان لم يحصل هذا الغرض إلا لشخصين أو ثلاثة فلابد من اتفاقهم وليس المقصود اعيان المبايعين وانما الغرض قيام شوكة الإمام بالاتباع والاشياع وذلك يحصل بكل مستول مطاع ونحن نقول لما بايع عمر ابا بكر رضي الله عنهما انعقدت الإمامة له بمجرد بيعته ولكن لتتابع الايدي إلى البيعة بسبب مبادرته ولو لم يبايعه غير عمر وبقى كافة الخلق مخالفين أو انقسموا انقساما متكافئا لا يتميز فيه غالب عن مغلوب لما انعقدت الإمامة فان شرط ابتداء الانعقاد قيام الشوكة وانصراف القلوب إلى المشايعة ومطابقة البواطن والظواهر على المبايعة فان المقصود الذي طلبنا له الإمام جمع شتات الاراء في مصطدم تعارض الاهواء ولا تتفق الارادات المتنافضة والشهوات المتباينة المتنافرة على متابعة راى واحد إلا إذا ظهرت شوكته وعظمت نجدته وترسخت في النفوس رهبته ومهابته ومدار جميع ذلك على الشوكة ولا تقوم الشوكة إلا بموافقة الاكثرين من معتبري كل زمان.
فإذا بان أن هذا مأخذ الإمامة فليس يتمارى في أن الجهة الشريفة التي ننصرها قد صرف الله وجوه كافة الخلق اليها وجبل قلوبهم على حبها ولذلك قامت الشوكة له في أقطار الارض حتى لو ظهر باغ يظهر خلافا في هذا الجناب الكريم ولو بأقصى الصين أو المغرب لبادروا إلى اختطافه وتطهير وجه الارض منه متقربين إلى الله تعالى.
وقد لاح لك الآن كيف ترقينا من هذه المغاصة المظلمة وكيف دفعنا ما أشكل على جميع جماهير النظار من تعيين المقدار في عدد أهل الأخيار إذا لم نعين له عددا بل اكتفينا بشخص واحد يبايع وحكمنا بانعقاد الإمامة عند بيعته لا لتفرده في عينه ولكن لكون النفوس محموله على متابعة ومبايعة من أذعن هو لطاعته وكان في متابعته قيام قوة الإمام وشوكته وانصراف قلوب الخلائق إلى شخص واحد أو شخصين أو ثلاثة على ما تقتضيه الحال في كل عصر ليس أمرا اختيارا يتوصل إليه بالحيلة البشرية بل هو رزق إلهي يؤتيه الله من يشاء فكانا في الظاهر رددنا تعيين الإمامة إلى اختيار شخص واحد وفي الحقيقة رددناها إلى اختيار الله تعالى ونصبه إلا أنه يظهر اختيار الله عقيب متابعة شخص واحد أو أشخاص وإنما المصحح لعقد الإمامة انصراف قلوب الخلق لطاعته والانقياد له في أمره ونهيه وهذه نعمة وهدية من الله تعالى فإذا أتاحها لعبد من عباده وصرف إلى محبته وجوه أكثر خلقه وكان ذلك من الله تعالى لطفا في اختياره لخلافته وتعيينه للاقتداء بأوامره في تفقد عباده وذلك أمر لا يقدر كل البشر على الاحتيال لتحصيله.
فلينظر الناظر إلى مرتبة الفريقين إذا نسيت الباطنية أنفسها إلى أن نصب الإمام عندهم من الله تعالى وعند خصومهم من العباد ثم لم يقدروا على بيان وجه نسبة ذلك إلى الله تعالى إلا بدعوى الاختراع على رسوله في النص على على ودعوى بقاء ذلك في ذريته بقاء كل خلف لكل واحد ودعوى تنصيصه على أحد أولاده بعد موته إلى ضروب من الدعاوى الباطلة ولما نسبونا إلى أنا ننصب الإمام بشهوتنا واختيارنا ونقموا ذلك منا كشفنا لهم بالآخرة أنا لسنا نقدم إلا من قدمه الله فان الإمامة عندنا تنعقد بالشوكة والشوكة تقوم بالمبايعة والمبايعة لا تحصل إلا بصرف الله تعالى القلوب قهرا إلى الطاعة والموالاة وهذا لا يقدر عليه البشر ويدلك عليه انه لو اجمع خلق كثير لا يحصى عددهم على أن يصرفوا وجوه الخلق وعقائدهم عن الموالاة للإمامة العباسية عموما وعن المشايعة للدولة المستظهرية أيدها الله بالدوام خصوصا لافنوا اعمارهم في الحيل والوسائل وتهيئة الأسباب والوصائل ولم يحصلوا في اخر الأمور إلا على الخيبة والحرمان.
فهذا طريق إقامة البرهان على أن الإمام الحق هو أبا العباس أحمد المستظهر بالله حرس الله ظلاله في هذا العصر ولم يبق الاحسم مطاعن المنكرين في دعواهم اختلال شرائط الإمامة وفوات صفات الأئمة وها نحن نبين وجه الحق فيه في معرض سؤال وجواب.
فإن قال قائل ما ذكرتموه من الترجيح وتعيين هذه الجهة الكريمة لمن يستحق الإمامة انما يستتب إذا أظهر تم وجود شرائط الإمامة وصفات الأئمة ولها شروط كثيرة لا تنعقد دون شروطها بل لو تطرق الخلل إلى شرط من شرائطها امتنع انعقادها ففصلوا الشروط وبينوا تحققها حتى نسلم لكم ثبوت الإمامة ونبطل مذهب القائلين بأن هذا العصر والأعصار الخالية القربية كانت خالية عن الإمام لفقد شروط الإمامة في المترشحين لها.
الجواب إن الذي عده علماء الإسلام من صفات الأئمة وشروط الإمامة تحصرها عشر صفات ست منها خلقية لا تكتسب وأربع منها تكتسب أو يفيد الاكتساب فيها مزيدا فأما الست الخلقية فلا شك في حضورها ولا تتصور المجاحدة في وجودها الأولى البلوغ فلا تنعقد الإمامة لصبي لم يبلغ الثانية العقل فلا تنعقد لمجنون فإن التكليف ملاك الأمر وعصامه ولا تكليف على صبي ومجنون الثالثة الحرية فلا تنعقد الإمامة لرقيق فإن منصب الإمامة يستدعي استغراق الأوقات في مهمات الخلق فكيف ينتدب لها من هو كالمفقود في حق نفسه الموجود لمالك يتصرف تحت تدبيره وتسخيره كيف وفي اشتراط نسب قريش ما يتضمن هذا الشرط إذ ليس يتصور الرق في نسب قريش بحال من الأحوال الرابعة الذكورية فلا تنعقد الإمامة لامرأة وان اتصفت بجميع خلال الكمال وصفات الاستقلال وكيف تترشح امرأة لمنصب الإمامة وليس لها منصب القضاء ولا منصب الشهادة في أكثر الحكومات الخامسة نسب قريش لا بد منه لقوله ﷺ الأئمة من قريش واعتبار هذا مأخوذ من التوقيف ومن اجماع أهل الاعصار الخالية على أن الإمامة ليست إلا في هذا النسب ولذلك لم يتصد لطلب الإمامة غير قرشي في عصر من الاعصار مع شغف الناس بالاستيلاء والاستعلاء وبذلهم غاية الجهد والطاقة في الترقي إلى منصب العلا ولذلك لما هم المخالفون بمصر لطلب هذا الأمر ادعوا أولا لانفسهم الاعتزاء إلى هذا النسب علما منهم بان الخلق متطابقون على اعتقادهم لانحصار الإمامة فيهم السادسة سلامة حاسة السمع والبصر إذ لا يتمكن الاعمى والاصم من تدبير نفسه فكيف يتقلد عهدة العالم ولذلك لم يستصلحا لمنصب القضاء واضاف مصنفون إلى هذا اشتراط السلامة من البرص والجذام والزمانة وقطع الاطراف وسائر العيوب الفاحشة المنفرة وانكره منكرون وقالوا لا حاجة إلى وجود السلامة من هذه الامراض فان التكفل بامور الخلق والقيام بمصالحهم لا تستدعيها ولم يرد من الشارع توقيف وتعبد فيها وليس من غرضنا بيان الصحيح من المذهبين وانما المقصود ان هذه الصفات الست غريزية لا يمكن اكتسابها وهي بجملتها حاضرة حاصلة فلا تثور منها شبهة المعاندة أما الصفات الأربع المكتسبة وهي النجدة والكفاية والعلم والورع فقد اتفقوا على اعتبارها ونحن نبين وجود القدر المشروط لصحة الإمامة في الإمام المستظهر بالله امير المؤمنين ثبت الله دولته وان امامته على وفق الشرع وانه يجب على كل مفت من علماء الدهر ان يفني على القطع بوجوب طاعته على الخلق ونفوذ اقضيته بالحق وبصحة توليته للولاة وتقليده للقضاة وصرف حقوق الله إليه ليصرفها إلى مصارفها وبوجهها إلى مظانها ومواقعها ونتكلم في هذه الصفات الأربع على الترتيب.
القول في الصفة الأولى وهي النجدة
فنقول مراد الأئمة بالنجدة ظهور الشوكة وموفور العدة والاستظهار بالجنود وعقد الالوية والبنود والاستمكان بتضافر الاشياع والاتباع من قمع البغاة والطغاة ومجاهدة الكفرة والعتاة وتطفئة نائرة الفتن وحسم مواد المحن قبل أن يستظهر شررها وينتشر ضررها هذا هو المراد بالنجدة وهي حاصلة لهذه الجهة المقدسة فالشوكة في عصرنا هذا من اصناف الخلائق للترك وقد اسعدهم الله تعالى بموالاته ومحبته حتى انهم يتقربون إلى الله بنصرته وقمع اعداء دولته ويتدينون باعتقاد خلافته وامامته ووجوب طاعته كما يندينون بوجوب أوامر الله وبتصديق رسله في رسالته فهذه نجدة لم يثبت مثلها لغيره فكيف يتمارى في نجدته.
فإن قيل كيف تحصل نجدته بهم وانا نراهم يتهجمون على مخالفة أوامره ونواهيه ويتعدون الحدود المرسومة لهم فيه وانما تحصل الشوكة بمن يتردد تحت الطاعة على حسب الاستطاعة وهؤلاء في حركاتهم لا يترددون إلا خلف شهواتهم وإذا هاج لهم غضب أو حركتهم شهوة أو أوغر صدورهم ضغينة لم يبالوا بالاتباع ولم يعرفوا إلا الرجوع إلى ما جبلوا عليه من طباع السباع فكيف تقوم الشوكة بهم.
قلنا هذا سؤال في غاية الركاكة فإن الطاعة المشروطة في حق الخلق لقيام شوكة الإمام لا تزيد على الطاعة المشروطة على الارقاء والعبيد في حق ساداتهم ولا على الطاعة المفروضة على المكلفين لله ورسوله وأحوال العبيد في طاعة سيدهم وأحوال العباد في طاعة ربهم لا تنفك عن الانقسام إلى موافقة ومخالفة فلما انقسم المكلفون إلى المطيعين والعصاة ولم ينسلخوا به عن اهاب الإسلام ولا انسلوا به عن ربقته ما داموا معتقدين ان الطاعة لله مفروضة وان المخالفة محرمة ومكروهة فهذا حال الجد في الطاعة لصاحب الأمر فانهم وان خالفوا امرا من الأوامر الواجبة الطاعة اعتقدوا المخالفة اساءة والموافقة حسنة ولذلك تراهم لا يغيرون العقيدة عن الموالاة ولو قطعوا إربا وما من شخص يقدر مخالفته في أمر من الأمور إلا وهو بعينه إذا انتهى إلى العتبة الشريفة صفع الأرض خاضعا وعفر خده في التراب متواضعا ووقف وقوف أذل العبيد على بابه وانتهض مائلا على رجليه عند سماع خطابه ولو نبغت نابغة في طرف من أطراف الأرض على معاداة هذه الدولة الزاهرة لم يكن فيهم أحد إلا ويرى النضال دون حوزتها جهادا في سبيل الله نازلا منزلة جهاد الكفار فأية طاعة في عالم الله تزيد على هذه الطاعة وأية شوكة في الدنيا تقابل هذه الشوكة وليت شعري لم لا يتذكر الباطنية عند إيراد هذا السؤال ما جرى لعلي رضي الله عنه من اضطراب الأحوال وتخلف أشياعه عنه في القتال ومخالفتهم لاستصوابه في أكثر الأقوال والأفعال حتى كان لا تنفك خطبة من خطبه عن شكايتهم في الإعراض عنه والاستبداد برأيهم حتى كان يقول لا رأى لمن لا يطاع فإذا كانت تقوم شوكته باتباع الاكثر من اتباعه من انتصاب من انتصب لمخالفته فكيف لا تقوم الشوكة في زماننا هذا والحال على ما ذكرنا فان قيل كان علي رضي الله عنه يتولى الأمر بنفسه ويباشر الحروب ويتبرج للخلق ولا يحتجب عنهم قلنا ومن الذي شرط في الإمامة مباشرة الأمور وتعاطيها بنفسه نعم لا حرج عليه لو باشر بنفسه فإذا استغنى بجنوده وأتباعه عن المقاساة للحرب بنفسه جاز له الاقتصار على مجرد الرأي والتدبير إذا روجع في الأمور القريبة منه ومن قطره والتفويض إلى ذوي الرأي الموثوق ببصيرتهم في الأمور البعيدة عنه وهذا الآن في عصرنا مستغنى عنه فقد سخر الله رجال العالم وأبطالهم لموالاة هذه الحضرة وطاعتها حتى تبددوا في أقطار الدنيا كما نشاهد ونرى فليس وراء هذه الشوكة أمر يشترط وجوده لصحة الإمامة فإن قيل وما بالكم تنظرون إلى هؤلاء ولا تنظرون إلى جنود المخالفين وهم أيضا مستظهرين بشوكة على مخالفة هذه الشوكة قلنا مهما كانت الكثرة من هذا الجانب لم تقدح مخالفة المخ الفين أفترى لم لم ينظر الباطني إلى شوكة معاوية وعدته ومقاومته لعلى بجنوده وأنصاره فكيف لمم يشترط في صحة الإمامة أن تصفو له جوانب الدنيا عن قذى المخالفة ولو شرط هذافي الإمانة لم تنعقد الأمامة لأحد قط من مبدأالامرإلى زماننا هذا فقد اتضح أن المشروط من هذه الصفة موجود وزيادة.
القول في الصفة الثانية وهي الكفاية
ومعناها التهدى لحق المصالح في معضلات الأمور والاطلاع على المسلك المقتصد عند تعارض الشرور كالعقل الذي يميز الخير عن الشر وينصف به الجمهور وإنما العزيز المعون عقل يعرف خير الخيرين وشر الشريرين وذلك أيضا في الأمور العاجلة وهي هينة قريبة وإنما الملتبس عواقب الأمور المخطرة ولن يستقل بها إلا مسدد للتوفيق من جهة الله تعالى ونحن نقول إن هذه الصفة حاصلة فإن أسبابها متوافرة فإنها مهما حصل من غريزة العقل وانفك عن العته والخبل كان الوصول إلى درك عواقب الأمور بطريق الظن والحدس مبنيا على ركنين أحدهما الفكر والتدبير وشرطه الفطنة والذكاء وهذه خصلة تميز فيها المنصور إمامته والمفروض طاعته عن النظراء بمزيد النفاذ والمضاء حتى صار أكابر العقلاء يتعجبون في معضلات الوقائع من رأيه الصائب وعقله الثاقب وتفطنه للدقائق يشذ عن درك المحنكين من ذوي التجارب وهذه صفة غريزية وهي من الله تحفة وهدية.
والركن الثاني الاستضاءة بخاطر ذوى البصائر واستطلاع راى اولى التجارب على طريق المشاورة وهي الخصلة التي أمر الله بها نبيه إذ قال {وشاورهم في الأمر} ثم شرطه أن يكون المستشير مميزا بين المراتب عارفا للمناصب معولا على راى من يوثق بدهائه وكفايته ومضائه وصرامته وشفقته وديانته وهذا هو الركن الاعظم في تدبير الأمور فان الاستبداد بالرأي وان كان من ذوى البصائر مذموم ومحذور وقد وفق الله الإمام بتفويض مقاليد أمره إلى وزيره الذي لم يقطع ثوب الوزارة إلا على قده حتى استظهر بآرائه السديدة في نوائب الزمان ومعضلات الحدثان ومراعاة مصالح الخلق في حفظ نظام الدين والملك وهو الجامع للصفات التي شرطها الشرع والعقل في المدبر والمشير من متانة الدين ونقاية الرأى وممارسة الخطوب ومقاساة الشدائد في طوارق الأيام ورزانة العقل والعطف على الخلق والتلطف بالرعية وبمجموع هذين الامرين يفهم مطلوب الكفاية فان مقصودها اقامة تناظم الأمور الدينية والدنيوية وهذه قضية يستدل على وجودها بمشاهدة الأحوال والافعال فلينظر المنصف كيف عالج معضلات الزمان بحسن رايه لما استاثر الله بروح الإمام المقتدى وامتع كافة الخلق بالإمامة الزاهرة المستظهرية وقد وافق وفاته احداق العساكر بمدينة السلام وازدحام اصناف الجند على حافتها والزمان زمان الفترة والدنيا طافحة بالمحن متموجة بالفتن والسيوف مسلولة في أقطار الارض والاضطراب عام في سائر البلاد لا يسكن فيها اوار الحرب ولا تنفك عن الطعن والضرب وامتدت اطماع الجند إلى الذخائر ففغروا أفواههم نحو الخزائن وكان يتداعى إلى تغيير الضمائر وثور الاحقاد والضغائن فلم يزل بدهائه وذكائه وحسن نظره ورايه مراعيا لنظام الأمر مترددا بين اللطف والعنف حتى انعقدت البيعة وانتشرت الطاعة واذعنت الرقاب واتسقت الأسباب وانطفات الفتن الثائرة وظل ظل الخلافة بحسن تدبيره وبراى وزيره ممدودا واصبح لواء النصر بحسن مساعيه معقودا وطريق الفساد بهيبته مسدودا واضحت الرعايا في رعايته وادعة وصارت عين الحوادث بحسن كلاءته عن مديته السلام هاجعة فليت شعري هل تكسب مثل هذه العظائم إلا بكمال الكفاية ونباهة الحزم والهداية وهل يستدل على كفاية الملوك بشيء سوى انتظام التدبير وحسن الراى في اختيار المشير والوزير فليس يعتبر في صحة الإمامة صفة الكفاية إلا ما يسر الله سبحانه له اضعاف ذلك فليقطع بوجود هذه الشريطة أيضا مضمومة إلى سائر الشرائط.
القول في الصفة الثالثة وهي الورع.
وهذه هي أعز الصفات وأجلها وأولاها بالرعايات وأجدرها وهو وصف ذاتي لا يمكن استعارته ولا الوصل إلى تحصيله من جهة الغير اما النجدة فتحصيلها من الغير لا محالة والهداية وان اعتمدت على غزارة العقل ففوائدها يمكن فيها الاستعارة بطريق المراجعة والاستشارة والعلم أيضا يمكنه تحصيله بالاستفتاء واستطلاع رأى العلماء والورع هو الاساس والاصل وعليه يدور الأمر كله ولا يغني فيه ورع الغير وهو رأس المال ومصدر جملة الخصال ولو اختل هذا والعياذ بالله لم يبق معتصم في تحقيق الإمامة فالحمد لله الذي زين أحوال الإمام الحق المنصور امامته بالورع والتقوى حتى اوفي فيه على الغية القصوى فتميز بمتانة الدين وصفاء العقل واليقين في جماهير الخلفاء حتى ظهر من أحواله منذ تجمل صدر الخلافة بجماله من إفاضة الخيرات والعطف على الرعايا وذوى الحاجات وقطع العمارات التي كانت العادة جارية بالمواظبة عليها كل ذلك اضرابا عن عمارة الدنيا واكبابا على ما ظهر من عمارة الدين هذا مع ما ظهر من سيرته في خاصة حالته من لبس الثياب الخشنة واجتناب الترفه والدعة والمواظبة على العبادات ومهاجرة الشهوات واللذات استحقارا لزخارف الدنيا وتوقيا من ورطات الهوى والتفاتا إلى حسن الماب في العقبى فهو على التحقيق الشاب الذي نشأ في عبادة الله هذا كله في عنفوان السن وغرة من الشباب وبداية الأمر ينبه العقلاء لما سينتهي إليه الحال إذا قارب سن الكمال.
إن الهلال إذا رأيت نموه أيقنت أن سيصير بدرا كاملا
والله تعالى يمده باطول الاعمار وينشر أعلامه في اقاصي الديار.
فان قال قائل كيف تجاسرتم على دعوى التقوى والورع ومن شرطه التجرد عن الأموال حتى لاياخذ قيراطا إلا من حله ولا يدعه إلا في مظنة استحقاقه وقد قال رسول الله ﷺ اتقوا النار ولو بشق تمرة وليس يتم الورع بالمواظبة على الفرائض واجتناب الموبقات والكبائر بل عماد هذا الأمر العدل واجتناب الظلم في طرفي الاعطاء والاخذ فان ادعيتم حصول هذا الشرط نفرت القلوب عن التصديق وان اعترفتم باختلال الأمر فيه انخرم ما ادعيتموه من حصول الورع والتقوى قلنا هذا السؤال نكسر أولا سورته ثم ننبه على سر هو منتهى الانصاف فنقول ان صدر الاعتراض عن باطني فلعله لو راجع صاحبه الذي يواليه واستقرى ما شاهده من هذه الأحوال فيه افتضح في دعاويه وكان الحياء خيرا له مما يورده ويبديه وان صدر السؤال عن أحد علماء العصر الذين يعتقدون خلو الزمان عن الإمام لفقد شرطه فيقال له هون على نفسك فان دعوى وجود هذا الشريط غير مستبعدة فان الأموال المنصبة إلى الخزائن المعمورة أربعة اصناف الصنف الأول ارتفاع المستغلات وهي ماخوذة من أموال موروثة له والصنف الثاني أموال الجزية وهي من اطيب ما يؤخذ والصنف الثالث أموال التركات ولم يعهد منه قط إلى الآن الطمع في تركة تعين لاستحقاقها وارث ومن لا وارث له فمنصبه بيت المال الصنف الرابع أموال الخراج الماخوذة من ارض العراق ومذهب الشافعي وطوائف من العلماء أن أرض العراق وقف وهي من عبادان إلى الموصل طولا ومن القادسية إلى حلوان عرضا انما وقفهخا عمر رضي الله عنه على المسلمين ليكون جميع خراجها منصبا إلى بيت المال ومصالح المسلمين فهذه هي الأموال الماخوذة واخذها جائز ويبقى النظر في مصارفها وهي مع اختلاف جهاتها أربع جهات وفيها تنحصر مصالح الإسلام والمسلمين.
الجهة الأولى المرتزقة من جند الإسلام إذ لابد من كفايتهم واكثرهم في هذا العصر مكفيون بثروتهم واستظهارهم ومقتدرون على كفاية غيرهم ومع ذلك فقد امدهم الراى الشريف النبوي في هذه الأيام مدة مقام العسكر بمدينة السلام بأموال استفرغ فيها الخزائن وافاض عليهم من ضروب التشريفات والإنعام ما يخلد ذكره على مكر الأيام والاعوام.
الجهة الثانية علماء الدين وفقهاء المسلمين القائمون بعلوم الشريعة فانهم حراس الدين بالدليل والبرهان كما ان الجنود حراسه بالسيف والسنان وما من واحد منهم إلا وهو مكفى من جهته برسم وادرار ومخصوص بانعام وايثار والمستحق لهم أيضا على بيت المال قدر الكفاية وهو مبذول لكل من يتشبه باهل العلم فضلا عمن يتلحى بتحقيقه.
الجهة الثالثة محاويج الخلق الذين قصرت بهم ضرورة الحال وطوارق الزمان عن اكتساب قدر الكفاية وليس ينتهى إليه الخبر في حاجة إلا سدها ولا يرتفع إليه قصد ذي فاقة إلا تداركها ومواظبته على الصدقات في نوب متواليات في السر والعلانية كافية جميع الحاجات.
الجهة الرابعة المصالح العامة من عمارة الرباطات والقناطر والمساجد والمدارس فيصرف لا محالة إلى هذه الجهة عند الحاجة قدر من بيت مال المسلمين فلا ترى هذه المواضع في أيامه إلا معمورة وملحوظة بالتعاهد من القوام بها والمتكفلين لها وهذا وجه الدخل والخرج.
ونختم الكلام بما يقطع مادة الخصام وتبين فيه غاية الانصاف فنقول لا يظنن ظان انا نشترط في الإمامة العصمة فان العلماء اختلفوا في حصولها للانبياء والاكثرون على انهم لم يعصموا من الصغائر ولو اعتبرت العصمة من كل زلة لتعذرت الولايات وانعزلت القضاة وبطلت الإمامة وكيف يحكم باشتراط التنقى من كل معصية والاستمرار على سمت التقوى من غير عدول ومعلوم ان الجبلات متقاضية للذات والطباع محرضة على نيل الشهوات والتكاليف يتضمنها من العناء ما يتقاعد عن احتمالها الاقوياء ووساوس الشيطان وهواجس النفس مستحثة على حب العاجلة واستحقار الاجلة والجبلة الإنسانية بالسوء امارة والتقى في ارجوحة الهوى يغلب تارة ويعجز تارة والشيطان ليس يفتر عن الوساوس والزلات تكاد تجرى على الانفاس فكيف يتخلص البشر عن اقتحام محظور والتورط في محظور ولذلك قال الشافعي رضي الله عنه في شرط عدالة الشهادة لايعرف أحد بمحض الطاعة حتى لا يتضمخ بمعصية ولا أحد بمحض المعصية حتى لا يقدم على طاعة ولا ينفك أحد عن تخليط ولكن من غلبت الطاعات في حقه المعاصي وكانت تسووه سيئته وتسره حسنته فهو مقبول الشهادة ولسنا نشترط في عدالة القضاء إلا ما نشترطه في الشهادة ولا نشترط في الإمامة إلا ما نشترطه في القضاء وهذا ذكرناه إذا لج ملاح أو الح ملح ولازم اللدد في تصوير أمر من الأمور لا يوافق ظاهر الشرع وارادته الطعن في الإمامة والقدح فيها عرف ان ذلك غير قادح في اصل الإمامة بحال من الأحوال.
القول في الصفة الرابعة وهي العلم.
فإن قال قائل اتفق راي العلماء على أن الإمامة لا تنعقد إلا لمن نال رتبة الاجتهاد والفتوى في علوم الشرع ولا يمكنكم دعوى وجود هذه الشريطة ولو ادعيتم أن ذلك لا يشترط كان انسلالا عن وفاق العلماء قاطبة فما رأيكم في هذه الصفة.
قلنا لو ذهب ذاهب إلى أن بلوغ درجة الاجتهاد لا يشترط في الإمامة لم يكن في كلامه إلا الاعزاب عن العلماء الماضين والا فليس فيه ما يخالف مقتضى الدليل وسياق النظر فان الشروط التي تدعى للإمامة شرعا لابد من دليل يدل عليها والدليل اما نص من صاحب الشرع واما النظر في المصلحة التي طلبت الإمامة لها ولم يرد النص من شرائط الإمامة في شيء إلا في النسب إذ قال أن الأئمة من قريش فاما ما عداه فانما اخذ من الضرورة والحاجة الماسة في مقصود الإمامة اليها فهذا كما شرطنا العقل والحرية وسلامة الحواس والهداية والنجدة والورع فان هذه الأمور لو قدر عدمها لم ينتظم أمر الإمامة بحال من الأحوال وليست رتبة الاجتهاد مما لا بد منه في الإمامة ضرورة بل الورع الداعي إلى مراجعة أهل العلم فيه كاف فإذا كان المقصود ترتيب الإمامة على وفق الشرع فاى فرق بين ان يعرف حكم الشرع بنظره أو يعرفه باتباع افضل أهل زمانه وإذا جاز للمجتهد ان يعول على قول واحد ويروى له حديثا فيحكم به إماما كان أو قاضيا فما المانع من ان يحكم بما يتفق عليه العلماء في كل واقعة وان اختلف فيتبع فيه قوله الافضل الاعلم ولم لا يكون مكملا بافضل أهل الزمان مقصود العلم كما كمل باقوى أهل الزمان مقصود الشوكة وبادهى أهل الزمان وأكفاهم رأيا ونظرا مقصود الكفاية فلا تزال دولته محفوفة بملك من الملوك قوى يمده بشوكته وكاف من كفاة الزمان يتصدى لوزارته فيمده برايه وهدايته وعالم مقدم في العلوم يفيض ما يلوح من قضايا الشرع في كل واقعة إلى حضرته هذا لو قال به قائل لكان مستمدا من قواطع الادلة والبراهين التى يجوز استعمالها في مظان القطع واليقين فكيف في مواقع الظن والتخمين واكثر مسائل الإمامة واحكامها مسائل فقهية ظنية يحكم فيها بموجب الراى الاغلب وما ذكرته مسلك واضح فيه ولكنى لا اوثر الاعزاب عن الماضين ولا الانحراف عن جادة الأئمة المنقرضين فان الانفراد بالراى والانسلال عن موافقة الجماهير لا ينفك عن اثارة نفرة القلوب لكني استميح مسلكا مقتبسا من كلام الأئمة المذكورين واقول اختلف الناس في أن أهل الاختيار لو عقدوا عقد البيعة للمفضول واعرضوا عن الافضل هل تنعقد الإمامة مع الاتفاق على أن تقديم الافضل عند القدرة واجب متعين ثم ذهب الاكثرون إلى انها إذا عقدت للمفضول مع حضور الافضل انعقدت ولم يجز خلعه لسبب الافضل وانا من هذا انشئ واقول أن رددناها في مبدا التولية بين مجتهد في علوم الشرع وبين متقاصر عنها فيتعين تقديم المجتهد لان اتباع الناظر علم نفسه له مزية رتبة على اتباع علم غيره بالتقليد والمزايا لا سبيل إلى إهمالها مع القدرة على مراعاتها أما إذا انعقدت الإمامة بالبيعة أوتولية العهد لمنفك عن رتبة الاجتهاد وقامت له شوكة واذعنت له الرقاب ومالت إليه القلوب فان خلا الزمان عن قرشي مجتهد يستجمع جميع الشروط وجب الاستمرار على الإمامة المعقودة ان قامت له الشوكة وهذا حكم زماننا وان قدر ضربا للمثل حضور قرشي مجتهد مستجمع للورع والكفاية وجميع شرائط الإمامة واحتاج المسلمون في خلع الأول إلى تعرض لاثارة فتن واضطراب أمور لم يجز لهم خلعه والاستبدال به بل تجب عليهم الطاعة له والحكم بنفوذ ولايته وصحة إمامته لأنا نعلم بأن العلم مزية روعيت في الإمامة تحسينا للأمر وتحصيلا لمزيد المصلحة في الاستقلال بالنظر والاستغناء عن التقليد وان الثمرة المطلوبة من الإمامة تطفئة الفتن الثائرة في تفرق الآراء المتنافرة فكيف يستجيز العاقل تحريك الفتنة وتشويش نظام الأمور وتفويت أصل المصلحة في الحال تشوفا إلى مزيد دقيقة في الفرق بين النظر والتقليد وعند هذا ينبغي أن يقيس الإنسان ما ينال الخلق بسبب عدول الإمام عن النظر إلى تقليد الأئمة بما ينالهم لو تعرضوا لخلعه واستبداله أو حكموا إمامته غير منعقدة وإذا أحسن إيراد هذه المقالة علم أن التفاوت بين اتباع الشرع نظرا واتباعه تقليدا قريب هين وانه لا يجوز أن تخرم بسببه قواعد الإمامة وهذا تقدير تسامحنا به من وجهين أحدهما تقدير قرشي مجتهد مستجمع الصفات متصد لطلب الإمامة وهذا لا وجود له في عصرنا والثاني تقدير اقتدارالخلق على الاستبدال بالإمام والتصرف فيه بالخلع والانتقال وهذا محال في زماننا إذ لو أجمع أهل الدهر وتألبوا على أن يصرفوا الوجوه والقلوب عن الحضرة المقدسة المستظهرية لم يجدوا اليها سبيلا فيتعين على كافة علماء العصر الفتوى بصحة هذه الإمامة وانعقادها بالشرع ولكن بعد هذا شرطان أحدهما أن لا يمضي كل قضية مشكلة إلا بعد استنتاج قرائح العلماء والاستظهار بهم وأن يختار لتقليده عند التباس الأمر واختلاف الكلمة أفضل أهل الزمان واغزرهم علما وقلما تنفك مدينة السلام عن شخص يعترف له بالتقدم في علم الشرع فلا بد من تعرف الشرع في الوقائع منه لينوب ذلك عن الاجتهاد والثاني أن يسعى لتحصيل العلم وحيازة رتبة الاستقلال بعلوم الشرع فإن الإمامة وان كانت صحيحة منعقدة في الحال فخطاب الله تعالى قائم بإيجاب العلم وافتراض تحصيله وإذا ساعدت القدرة عليه لم يكن للتواني فيه عذر لا سيما والسن سن التحصيل وريعان الشباب معين على الغرض والقدر الواجب تحصيله شرعا إذا صرف إليه الهمة الشريفة حصل في قدر يسير من الزمان ولا يليق تطلب غايات الكمال إلا بالحضرة المقدسة الشريفة النبوية المحقوقة بالعز والجلال.
وإذا اتضح في هذا الباب بهذه البراهين اللائحة أن مقتضى أمر الله أن الإمام الحق المستظهر بالله هو المتعين لخلافة الله فما أجدر هذه النعمة أن تقابل بالشكر وإنما الشكر بالعلم وبالعمل وبالمواظبة على ما أودعته في الباب الآخر من الكتاب وعلى الجملة فشكر هذه النعمة ألا يرضي أمير المؤمنين أن يكون لله على وجه الأرض عبد أعبد وأشكر منه كما أن الله تعالى لم يرض أن يكون له على وجه الأرض عبد أعز واكرم من أمير المؤمنين فهذا هو الشكر الموازي لهذه النعمة. والله ولي التوفيق بمنه ولطفه.
الباب العاشر في الوظائف الدينية التي بالمواظبة عليها يدوم استحقاق الإمامة
ومن فرائض الدين على امير المؤمنين زاده الله توفيقا المداومة على مطالعة هذا الباب والاستقصاء على تأمله وتصفحه ومطالبة النفس الكريمة حتى تستمر عليه فإن ساعد التوفيق للمجاهدة في الاقتدار على وظيفة من هذه الوظائف ولو في سنة فهي السعادة القصوى وهذه الوظائف بعضها علمية وبعضها عملية فتقدم العلمية فإن العلم هو الأصل والعمل فرع له إذ العلوم لا حصر لها ولكنا نذكر أربعة أمورهن أمهات وأصول.
الأول أن يعرف أن الإنسان في هذا العالم لم خلق وإلى أي مقصد وجه ولأي مطلب رشح وليس يخفى على ذي بصيرة أن هذه الدار ليست دار مقر وإنما هي دار ممر والناس فيها على صورة المسافرين ومبدأ سفرهم بطون أمهاتهم والدار الآخرة مقصد سفرهم وزمان الحياة مقدار المسافة وسنوه منازله وشهوره فراسخه وأيامه أمياله وأنفاسه خطاه ويصار بهم عبر السفينة براكبها ولكل شخص عند الله عمر مقدر لا يزيد ولا ينقص ولهذا قال عيسى صلوات الله عليه وسلم الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها وقد دعى الخلق إلى لقاء الله في دار السلام وسعادة الأبد فقال الله تعالى: {والله يدعو إلى دار السلام} وهذا السفر لا يفضى إلى المقصد إلا بزاد وهو التقوى ولذلك قال تعالى: {وتزودوا فإن خير الزاد التقوى} فمن لم يتزود في دنياه لآخرته بالمواظبة على العبادة فسيرجع منه عند الموت ما اغتر من جسده وماله فيتحسر حيث لا يغنيه التحسر ويقول {يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين} ويقول {فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل} فحينئذ {لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا} وهذا الإنسان من وجه آخرفي دنياه حارث وعمله حرثه ودنياه محترثه ووقت الموت وقت حصاده ولذلك قال ﷺ الدنيا مزوعة الآخرة وانما البذر هو العمر فمن انقضى عليه نفس من انفاسه ولم يعبد الله فيه بطاعة فهو مغبون لضياع ذلك النفس فإنه لا يعود قط ومثال الإنسان في عمره مثال رجل كان يبيع الثلج وقت الصيف ولم تكن له بضاعة سواه فكان ينادي ويقول ارحموا من رأس ماله يذوب فرأس مال الإنسان عمره الذي هو وقت طاعته وانه ليذوب على الدوام فكلما زاد سنه نقص بقية عمره فزيادته نقصانه على التحقيق ومن لم ينتهز في انفاسه حتى يقتنص بها الطاعات كلها كان مغبونا ولذلك قال ﷺ من استوى يوماه فهو مغبون ومن كان يومه شرا من أمسه فهو ملعون فكل من صرف عمره إلى ديناه فقد خاب سعيه وضاع عمله كما قال تعالى: {من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم} الآية ومن عمل لآخرته فهو الذي أنجح سعيه كما قال تعالى: {ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا}.
الوظيفة الثانية أنه مهما عرف أن زاد السفر إلى الآخرة التقوى فليعلم أن التقوى محلها ومنبعها القلب لقوله ﷺ التقوى ها هنا وأشار إلى صدره وينبغي أن يكون الاجتهاد في إصلاح القلب أولا إذ صلاح الجوارح تابع له لقوله ﷺ إن في بدن ابن آدم لبضعة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب وإصلاح القلب شرطه تقدم تطهيره عليه وطهارته في أن يطهر عن حب الدنيا لقوله ﷺ حب الدنيا رأس كل خطيئة وهذا هو الداء الذي أعجز الخلق ومن ظن أنه يقدر على الجمع بين التنعم في الدنيا والحرص على ترتيب أسبابها وبين سعادة الآخرة فهو مغرور كمن يطمع في الجمع بين الماء والنار لقوله أمير المؤمنين رضي الله عنه الدنيا والآخرة ضرتان مهما أرضيت إحداهما أسخطت الأخرى نعم لو كان الإنسان يشتغل بالدنيا لأجل الدين لا لأجل شهوته كمن يصرف عمره إلى تدبير مصالح الخلق شفقة عليهم أو يصرف بعض أوقاته إلى كسب القوت ونيته في كسب القوت إلى أن يتقوى بتناوله على الطاعة والتقوى فهذا من عين الدين وعلى هذا المنهاج جرى حرص الأنبياء والخلفاء الراشدين في أمور الدنيا ومهما ثبت أن الزاد هو التقوى وأن التقوى شرطها خلو القلب عن حب الدنيا فليكن الجهد في تخليته عن حبها وطريقه أن يعرف الإنسان عيب الدنيا وآفتها ويعرف شرف السعادة في الدار الآخرة وزينتها ويعلم أن في مراعاة الدنيا الحقيرة فوت الآخرة الخطيرة وأقل آفات الدنيا وهي مستيقنة لكل عاقل وجاهل أنها منقضية على القرب وسعادة الآخرة لا آخر لها هذا إذا سلمت الدنيا صافية عن الشوائب والأقذاء خالية عن المؤذيات والمكدرات وهيهات هيهات فلم يسلم أحد في الدنيا من طول الأذى ومقاساة الشدائد ومهما عرف تصرم الدنيا وتأبد السعادة في العقبى فليتأمل أنه لو شغف إنسان بشخص واستهتر به وصار لا يطبق فراقه وخير بين أن يعجل لقاءه ليلة واحدة بين أن يصبر عنه تلك الليلة مجاهدا نفسه ثم يخلى بينه وبينه ألف ليلة فكيف لا يسهل عليه الصبر ليلة واحدة لتوقع التلذذ بمشاهدته ألف ليلة ولو استعجل تلك الليلة وعرض نفسه لعناء المفارقة ألف ليلة لعد سفيها خارجا عن حزب العقلاء فالدنيا معشوقة كلفنا الصبر عنها مدة يسيرة ووعدنا أضعاف هذه اللذات مدة لا آخر لها وترك الألف بالواحد ليس من العقل واختيار الألف على الواحد المعجل ليس بمتعذر على العاقل وعند هذا ينبغي أن يقيس الإنسان أقصى مدة مقامه في الدنيا وهي مائة سنة مثلا ومدة مقامه في الآخرة ولا آخر لها بل لو طلبنا مثالا لطول مدة الأبد لعجزنا عنه إلا أن نقول لو قدرنا الدنيا كلها إلى منتهى السموات ممتلئة بالذرة وقدرنا طائرا يأخذ بمنقاره في كل ألف سنة حبة واحدة فلا يزال يعود حتى لا يبقى من الذرة حبة واحدة فتنقضي هذه المدة وقد بقى من الذرة اضعافها فكيف لا يقدر العاقل إذا حقق على نفسه هذا الأمر على أن يستحقر الدنيا ويتجرد لله تعالى هذا لو قد قدر بقاء العمر مائة سنة وقدرت الدنيا صافية عن الاقذاء فكيف والموت بالمرصاد في كل لحظة والدنيا غير صافية من ضروب التعب والعناء وهذا أمر ينبغي أن يطول التامل فيه حتى يترسخ في القلب ومنه تنبعث التقوى وما لم يظهر للإنسان حقارة الدنيا لا يتصور منه أن يسعى للدار الاخرى وينبغي أن يستعان على معرفة ذلك بالاعتبار بمن سلف من أبناء الدنيا كيف تعبوا فيها ثم ارتحلوا عنها بغير طائل ولم تصحبهم إلا الحسرة والندامة ولقد صدق من قال من الشعراء حيث قال أشد الغم عندي في سرور تيقن عنه صاحبه انتقالا وهذه حال لذات الدنيا.
الوظيفة الثالثة أن معنى خلافة الله على الخلق اصلاح الخلق ولن يقدر على اصلاح أهل الدنيا من لا يقدر على اصلاح أهل بلده ولن يقدر على اصلاح أهل البلد من لايقدر على اصلاح أهل منزله ولا يقدر على اصلاح أهل منزله من لايقدر على اصلاح نفسه ومن لا يقدر على اصلاح نفسه فينبغي أن تقع البداية باصلاح القلب وسياسة النفس ومن لم يصلح نفسه وطمع في اصلاح غيره كان مغرور كما قال الله تعالى: {أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم} وفي الحديث ان الله تعالى قال لعيسى بن مريم عظ نفسك فان اتعظت فعظ الناس والا فاستحي مني ومثال من عجز عن اصلاح نفسه وطمع في اصلاح غيره مثال الاعمى إذا اراد يهدي العميان وذلك لا يستتب له قط وانما يقدر على اصلاح النفس بمعرفة النفس ومثل معرفة الإنسان في بدنه كمثل وال في بلده وجوارحه وحواسه واطرافه بمنزلة صناع وعملة والشرع له كمشير ناصح ووزير مدبر والشهوة فيه كعبد سوء جالب للميرة والطعام والعصب له كصاحب شرطة والعبد الجالب للميرة خبيث ماكر يتمثل للإنسان بصورة الناصح وفي نصحة دبيب العقرب فهو يعارض الوزير في تدبيره ولا يغفل ساعة من منازعته ومعارضته فكان الوالى في مملكته متى استشار في تدبيراته وزيره دون هذا العبد السوء الخبيث وادب صاحب شرطته وجعله مؤتمرا لوزيره وسلطه على هذا العبد الخبيث واتباعه حتى يكون هذا العبد مسوسا لا سائسا ومدبرا لا مدبرا استقام أمر بلده وكذا النفس متى استعانت في تدبيراتها بالشرع والعقل وادبت الحمية والغضب حتى لا يهتاج إلا باشارة الشرع والعقل وسلطته على الشهوة واستتب أمرها والا فسدت واتبعت الهوى ولذات الدنيا كما قال الله تعالى: {ولا تتبع الهوى} الأية وقال تعالى: {أفرأيت من اتخذ إلهه هواه} {وقال} {أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب} وقال تعالى في مدح من عصاها {وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى} الآية وعلى الجملة فينبغي ان يكون العبد طول عمره في مجاهدة غضبه وشهوته ومتشمرا لمخالفتها كما يتشمر لمخالفة اعدائه فانهما عدوان كما قال ﷺ اعدى عدو نفسك التي بين جنبيك ومثال من اشتغل بالتلذذ عندالشهوات والانتقام عند الغضب مثل رجل فارس صياد له فرس وكلب غفل عن صيده واشتغل بتعهد فرسه وطعمة كلبه وضيع فيه جميع وقته فإن شهوة الإنسان كفرسه وغضبه ككلبه فإن كان الفارس حاذقا والفرس مروضا والكلب مؤدبا ومعلما فهو قمين بإدراك حاجته من الصيد ومتى كان الفارس أخرق وفرسه جموحا أو حرونا وكلبه عقورا فلا فرسه ينبعث تحته منقادا ولا كلبه يسترسل باشارته مطيعا فهو قمين أن يعطب فضلا أن يدرك ما طلب ومهما جاهد الإنسان فيها هواه فله ثلاثة أحوال الأول أن يغلبه الهوى فيتبعه ويعرض عن الشرع كما قال تعالى: {أفرأيت من اتخذ إلهه هواه} الثاني أن يغالبه فيقهره مرة ويقهره الهوى أخرى فله أجر المجاهدين وهو المرد بقوله ﷺ جاهدوا هواكم كما تجاهدو أعداءكم الثالث أن يغلب هواه ككثير من الأنبياء وصفوه الأولياء لقوله ﷺ ما من أحد إلا وله شيطان وإن الله قد أعانني على شيطاني حتى ملكته وعلى الجملة فالشيطان يتسلط على الإنسان بحسب وجوده الهوى فيه وإنما مثلت الشهوة بالفرس والغضب بالكلب لأنه لولاهما لما تصورت العبادة المؤدية إلى السعادة الآخرة فإن الإنسان يحتاج في عبادته إلى بدنه ولا قيام إلا بالقوت ولا يقدر على الاقتيات إلا بشهوة وهو محتاج إلى أن يحرس نفسه عن الهلكات بدفعها ولا يدفع المؤذى إلا بداعية الغضب فكأنهما خادمان لبقاء البدن والبدن مركب النفس وبواسطتها يصل إلى العبادة والعبادة طريقه إلى النجاة.
الوظيفة الرابعة أن يعرف أن الإنسان مركب من صفات ملكية وصفات بهيمية فهو حيران بين الملك والبهيمة فمشابهته للملك بالعلم والعبادة والعفة والعدالة والصفات المحمودة ومشابهته للبهائم بالشهوة والغضب والحقد والصفات المذمومة فمن صرف همته إلى العلم والعمل والعبادة فخليق أن يلحق بالملائكة فيسمى ملكا وربانيا كما قال تعالى: {إن هذا إلا ملك كريم} ومن صرف همته إلى إتباع الشهوات واللذات البدنية يأكل كما تأكل البهائم فخليق أن يلحق بالبهائم فيصير إما غمرا كثور وإما شرها كخنزير وإما ضرعا ككلب أو حقودا كجمل أو متكبرا كنمر أو ذا روغان ونفاق كثعلب أو يجمع ذلك فيصير كشيطان مريد وعلى ذلك دل قوله تعالى: {وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت} {وقال} {كالأنعام بل هم أضل} {وقال} {إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون} وهذه الصفات الذميمة تجتمع في الآدمي في هذا العالم وهو في صورة الإنسان فتكون الصفة باطنة والصورة ظاهرة وفي الآخرة تتحد الصورة والصفات فيصور كل شخص بصفته التي كانت غالبة عليه في حياته فمن غلب عليه الشر حشر في صورة خنزير ومن غلب عليه الغضب حشر في صورة سبع ومن غلب عليه الحمق حشر في صورة حمار ومن غلب عليه التكبر حشر بصورة نمر وهكذا جميع الصفات ومن غلب عليه العلم والعمل واستولى بهما على هذه الصفات حشر في صورة الملائكة والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
وهذه الوظائف التي ذكرناها علمية يجب التأمل فيها حتى تتمثل في القلب فتكون نصب العين في كل لحظة وإنما تترسخ هذه العلوم في النفس إذا أكدت بالعمل كما سنذكره في الوظائف العملية بعد.
القول في الوظائف العملية
وهي كثيرة أولاها وهي من الأمور الكلية أن كل من تولى عملا على المسلمين فينبغي أن يحكم نفسه في كل قضية يبرمها فما لا يرتضيه لنفسه لا يرتضيه لغيره فالمؤمنون كنفس واحدة فقد روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال من سره أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فليدركه موته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه وروى أنس بن مالك عن رسول الله ﷺ أنه قال من أصبح وهمه غير الله تعالى فليس من الله في شيء ومن أصبح لا يهتم بالمسلمين فليس من المسلمين.
ومنها أن يكون والى الأمر متعطشا إلى نصيحة العلماء ومتبجحا بها إذا سمعها وشاكرا عليها فقد روى أن أبا عبيدة ومعاذا كتبا إلى عمر رضي الله عنهم أما بعد فإنا عهدناك وشأن نفسك لك مهم وأصبحت وقد وليت بأمر هذه الأمة أسودها وأحمرها يجلس بين يديك الشريف والوضيع والصديق والعدو ولكل حصته من العدل فانظر كيف أنت عند ذلك يا عمر وانا نحذرك مما حذرت الأمم قبلك يوم تعنو فيه الوجوه وتجب فيه القلوب وتقطع فيه الحجة لعز ملك قهرهم جبروته والخلق داخرون له ينتظرون قضاءه ويخافون عقابه وانه ذكر لنا أنه سياتي على الناس زمان يكون اخوان العلانية أعداء السريرة فانا نعوذ بالله ان ينزل كتابنا من قبلك سوى المنزل الذى نزل من قلوبنا وإنا كتبنا اليك نصيحة والسلام فكاتبهما بجوابه وذكر في آخر ما كتب إنكما كتبتما إلى نصيحة فتعهداني منكما بكتاب فإني لا غنى بي عنكما والسلام عليكما.
ومنها ألا يستحقر الوالى انتظار ارباب الحاجات ووقوفهم بالباب في لحظة واحدة فان الاهتمام بأمر المسلمين أهم له وأعود عليه مما هو متشاغل به من نوافل العبادات فضلا عن اتباع الشهوات فقد روى أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه جلس يوما للناس فلما انتصف النهار ضجر ومل فقال للناس مكانكم حتى أعود اليكم فدخل يستريح ساعة فجاء ابنه عبد الملك فاستأذن فدخل عليه فقال يا أمير المؤمنين ما سبب دخولك قال أردت ان استريح ساعة فقال أأمنت أن يأتيك الموت ورعيتك على الباب ينتظرونك وانت محتجب عنهم فقال عمر صدقت فقام من ساعته وخرج إلى الناس.
ومنها أن يترك الوالي للأمر الترفه والتلذذ بالشهوات في المأكولات والملبوسات فقد روى أن عمر رضي الله عنه كتب إلى سلمان الفارسي يستزيره فلما قدم عليه سلمان تلقاه في أصحابه فالتزمه وضمه إليه وصار إلى المدينة فلما خلا به عمر قال له يا أخي هل بلغك مني ما تكرهه فقال لا قال عزمت عليك إن كان بلغك مني ما تكرهه ألا أخبرتني فقال لولا ما عزمت على أولا ما أخبرتك بلغني أنك تجمع بين السمن واللحم على مائدتك وبلغني أن لك حلتين حلة تلبسها مع أهلك وحلة تخرج فيها إلى الناس فقال عمر هل بلغك غير هذا فقال لا فقال أما هذان فقد كفيتهما فلا أعود إليهما
ومنها أن يعلم والي الأمر أن العبادة تيسر للولاة مالا يتيسر لآحاد الرعايا فلتغتنم الولاية لتعبد الله بها وذلك بالتواضع والعدل والنصح للمسلمين والشفقة عليهم فقد روى عن أبي بكر رضي الله عنه وهو على المنبر قال سمعت رسول الله ﷺ يقول الوالي العدل المتواضع ظل الله ورمحه في أرضه فمن نصحه في نفسه وفي عباد الله حشره الله تعالى في وقده يوم لا ظل إلا ظله وفي غشه في نفسه وفي عباد الله خذله الله تعالى يوم القيامة ويرفع للوالي العدل المتواضع في كل يوم وليلة عمل ستين صديقا كلهم عبد مجتهد في نفسه فهذه رتبة عظيمة لا تسلم في كل عصر إلا لواحد وانما تنال هذه الرتبة بالعدل والتواضع وقد روى أبو سعيد الخدرى عن رسول الله ﷺ أنه قال سبعة يظلهم الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه متعلق بالمسجد إذا خرج من حتى يعود إليه ورجلان تحابا في الله فاجتمعا على ذلك وتفرقا عليه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال إلى نفسها فقال أني أخاف الله رب العالمين ورجل تصدق بصدقة وأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه فهذه سبع لا يتصور اجتماعها إلا في أمير المؤمنين وإنما يقدر غيره من الخلق على آحادها دون مجموعها فليجتهد في نيل رتبة لم تدخر إلا له ولن يقوم بها سواه فقد روى أيضا أبو سعيد الخدرى أنه قال إن أحب العباد إلى الله تعالى وأقربهم منه مجلسا إمام عادل وإن أبغض الناس إلى الله وأشدهم عذابا يوم القيامة إمام جائر وقد روى أبو هريرة عن النبي ﷺ قال ثلاثة لا يرد الله لهم دعوة الإمام العادل والصائم حتى يفطر والمظلوم يقول الله وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي لأنتصرن لك ولو بعد حين وقد روى عبد الله بن مسعود أنه قال ﷺ عدل ساعة خير من عبادة سنة وإنما قامت السموات والأرض بالعدل وقد روى عن ابن عباس أنه ﷺ قال والذي نفس محمد بيده إن الوالي العدل ليرفع الله له كل يوم مثل عمل رعيته وصلواته في اليوم تعدل تسعين ألف صلاة. وروى ابن عباس أيضا أنه ﷺ قال الإسلام والسلطان أخوان توأمان لا يصلح أحدهما إلا بصاحبه فالإسلام أس والسلطان حارس فمالا أس له منهدم ومالا حارس له ضائع وقد روى أنس أنه ﷺ قال ما من أحذ أفضل منزلة عند الله من إمام إن قال صدق وإن حكم عدل وإن استرحم رحم والقصد من رواية هذه الأخبار التنبيه على عظم قدر الإمامة وأنها إذا ترتبت بالعدل كانت أعلى العبادات وإنما يعرف العدل من الظلم بالشرع فليكن دين الله وشرع رسول الله ﷺ هو المفزع والمرجع في كل ورد وصدر وتفصيل العدل مما يطول ولعل الوظائف التي تأتي يشتمل عليه طرف منها.
ومنها أن يكون الرفق في جميع الأمور أغلب من الغلطة وأن يوصل كل مستحق إلى حقه فقد روت عائشة رضي الله عنها عن رسول الله ﷺ أنه قال أيما وال ولي فلانا ورفق به رفق به يوم القيامة وروت عائشة أيضا أنه قال اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به ولمن شفق عليهم فأشفق عليه هذا دعاء رسول الله ﷺ وإنه يستجاب لا محالة وقد روى عن زيد بن ثابت أنه قال عند النبي ﷺ نعم الشيء الإمارة فقال ﷺ نعم الشيء الإمارة لمن أخذها بحقها وحلها وبئس الشيء الإمارة لمن أخذها بغير حقها فتكون حسرة عليه يوم القيامة وكل أمير عدل عن الشرع في أحكامه فقد أخذ إمارة بغير حقها.
وروى أبو هريرة عنه ﷺ أنه قال إن بني إسرائيل كان يسوسهم الأنبياء عليهم السلام فكلما هلك نبي قام بني مكانه وإنه لا نبي بعدي وإنه يكون بعدي خلفاء قبل يا رسول الله ما تأمرنا فيهم قال اعطوهم حقهم واسألوا الله تعالى حقكم فإن الله تعالى سائلهم عما استرعاهم هو قد حكى أن هشام ابن عبد الملك قال لأبي حازم وكان من مشايخ الدين كيف النجاة من هذا الأمر يعنى من الإمارة قال ألا تأخذ الدرهم إلا من حله ولا تضعه إلا في حقه قال ومن يطيق ذلك قال من طلب الجنة وهرب من النار.
ومنها أن يكون أهم المقاصد عنده تحصيل مرضاه الخلق ومحبتهم بطريق يوافق الشرع ولا يخالفه فقد روى عوف بن مالك عنه ﷺ أنه قال إن خيار أئمتكم الذين تحبونهم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشر أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنوهم ويلعنوكم قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة إلا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معاصي الله تعالى فليكره ما أتي من معاصي الله تعالى ولا ينزع يدا عن طاعة الله وقد روى عبد الله بن عمر عن النبي ﷺ أنه قال لخليفتي على الناس السمع والطاعة ما استرحموا فرحموا وحكموا فعدلوا وعاهدوا فوفوا ومن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
ومنها أن يعلم أن رضا الخلق لا يحسن تحصيله إلا في موافقة الشرع وأن طاعة الإمام لا تجب على الخلق إلا إذا دعاهم إلى موافقة الشرع كما روى عن محمد بن علي أنه قال إني لا علم قبيلتين تعبدان من دون الله قالوا من هم قال بنو هاشم وبنو أمية أما والله ما نصبوهم ليسجدوا لهم ولا ليصلوا لهم ولكن أطاعوهم واتبعوهم على ما أمدوهم والطاعة عبادة وقد روى ابن عباس أنه ﷺ قال لا تسخطن الله برضا أحد من خلقه ولا تقربوا إلى أحد من الخلق بتباعد من الله إن الله تعالى ليس بينه وبين أحد من خلقه قرابة يعظمهم بها ولا يصرف عن أحد شرا إلا بطاعته واتباع مرضاته واجتناب سخطه وان الله تعالى يعصم من أطاعه ولا يعصم من عصاه ولا يجد الهارب منه مهربا وقد روى عمر بن الحكم أن رسول الله ﷺ بعث سرية وأمر عليهم رجلا من أصحابه فأمر ذلك الرجل عبد الله بن حذاقة وكان ذا دعابة فاوقد نارا وقال ألستم سامعين مطيعين لأميركم قالوا بلى قال عزمت عليكم إلا وقعتم فيها ثم قال إنما كنت ألعب معكم فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال من أمركم من الأمراء بشيء من معصية الله فلا تطيعوه وقد روى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه صعد المنبر بعد وفاة رسول الله ﷺ بسبعة أيام فحمد الله وأثنى عليه وصلى على رسول الله صلى الله عليه ثم قال أيها الناس انكم وليتموني أمركم ولست بخيركم فان أحسنت فأعينوني وإن ضعفت أو عدلت عن الحق فقوموني ولا تخافوا في الله أحدا إن اكيس الكيس التقى وان احمق الحمق الفجور ثم اني أخبركم أني سمعت رسول الله ﷺ وهو يقول في الغار إن الصدق أمانة وإن الكذب خيانة ألا إن الضعيف منكم القوى عندنا حتى يعطي الحق غير متعتع ولا مقهور والقوى هو الضعيف عندنا حتى نأخذ منه الحق طائعا أو كارها ثم قال أطيعونا ما أطعنا الله ورسوله فإذا عصينا الله ورسوله فلا طاعة لنا عليكم فقوموا إلى صلاتكم رحمكم الله وقد روى عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة أنه قال انتهيت إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه وهو جالس في ظل الكعبة والناس حوله مجتمعون فسمعته يقول قام رسول الله ﷺ فقال إنه لم يكن شيء إلا كان حقا على الله أن يدل أمته على ما يعلمه خيرالهم وينذرهم ما يعلمه شرالهم وان أمتكم هذه جعلت عاقبتها في أولها وإلى آخرها سيصيبهم بلاء.
وأمور ينكرونها وتجيء سنه ألفين فيقول المؤمن هذه هذه ثم تنكشف فمن سره منكم أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه موتته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتي إليه ومن تابع إماما وأعطاه صفية قلبه وثمرة فؤاده فليعطه ما استطاع فقلت أناشدك الله أنت سمعته من رسول الله قال سمعت أذناي ووعى قلبي فقلت هذا ابن عمك يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل وان قيل أنفسنا فقال قال الله تعالى: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} الآية قال فجمع يديه فوضعهما على جبهته ثم نكس رأسه فقال أطعه في طاعة الله واعصه في معصية الله. فبهذه الأحاديث يتبين أن الطاعة واجبة للأئمة ولكن في طاعة الله لا في معصيته.
ومنها أن يعرف أن خطر الإمامة عظيم كما أن فوائدها في الدنيا والآخرة عظيمة وأنها إن روعيت على وجهها فهي سعادة وان لم تراع على وجهها فهي شقاوة ليس فوقها شقاوة فقد روى ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه انه أقبل وفي البيت رجال من قريش فأخذ بعضادتي الباب ثم قال الأئمة من قريش ما قاموا فيكم بثلاث ما إن استرحموا رحموا وإن حكموا عدلوا وان قالوا أوفوا ومن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا الصرف النافلة والعدل الفريضة وهذا قول رسول الله ﷺ وما أعظم الخطر في أمر ينتهي إلى ألا يقبل بسببه فريضة ولا نافلة وقد روى أيضا انه ﷺ قال من حكم بين اثنين فجار وظلم فلعنة الله على الظالمين وقد روى أبو هريرة أنه ﷺ قال ثلاثة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة الإمام الكذاب الشيخ الزاني والعائل المزهو وروى الحسن عن رسول الله ﷺ أنه قال يفتح عليكم مشارق الارض ومغاربها وعمالها كلهم في النار إلا من اتقى الله تعالى وأدى الامانة وقد روى عن الحسن أنه قال عاد عبيد الله بن الحسن معقلا في مرضه الذي قبض فيه فقال له معقل إني محدثك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه يقول ما من عبد يستر عنه الله تعالى رعيته يموت يوم يموت غاشا لرعيته إلا حرم الله تعالى عليه الجنة وروى زياد بن أبيه عن رسول الله ﷺ أنه قال من ولى من أمر المسلمين شيئا ولم يحطهم بالنصيحة كما يحوط على أهل بيته فليتبوأ مقعده من النار وقد حكى عن سفيان الثوري أنه عاتب رجلا من إخوانه قد كان هم أن يتلبس بشيء من أمر الولاية فقال يا أبا عبد الله إن على عيالا فقال له لأن تجعل في عنقك مخلاة تسأل على الأبواب خير لك من أن تدخل في شيء من أمور الناس وقد روى معقل بن يسار عنه ﷺ أنه قال رجلان من أمتي لا تنالهما شفاعتي إمام ظلوم غشوم وغال في الدين مارق منه وروى أبو سعيد الخدري أنه ﷺ قال أشد الناس عذابا يوم القيامة إمام جائر وروى عن النبي ﷺ أنه قال خمسة غضب الله تعالى عليهم إن شاء أمضى غضبه عليهم في الدنيا وإلا فمأواهم في الآخرة النار أمير قوم يأخذ حقه من رعيته ولا ينصفهم من نفسه ولا يدفع المظالم عنهم وزعيم قوم يطيعونه فلا يسوي بين الضعيف والقوي ويتكلم بالهوى ورجل لا يأمر أهله وولده بطاعة الله ولا يعلمهم أمور دينهم ولا يبالي ما أخذوا من دنياهم وما تركوا ورجل استأجر أجيرا فيستعمله ولا يوفيه أجره ورجل ظلم امرأة مهرها وقد روى أن عمر بن الخطاب خرج في جنازة ليصلي عليها فلما وضعت فإذا برجل قد سبق إلى الصلاة ثم لما وضع الرجل في قبره تقدم الرجل فوضع يده على التراب وقال اللهم إن تعذبه فربما عصاك وإن ترحمه فإنه فقير إلى رحمتك طوبى لك إن لم تكن أميرا أو عريفا أو كاتبا أو شرطيا أو جابيا قال ثم ذهب الرجل فلم يقدر عليه فأخبر عمر به فقال لعله الخضر ﷺ وروى عن مالك بن دينار أنه قال قرأت في بعض الكتب ما من مظلوم دعا بقلب محترق إلا لم تنته دعوته حتى تصعد بين يدي الله فتنزل العقوبة على من ظلمه أو استطاع أن يأخذ له فلم يأخذ له وروى أبو هريرة أنه ﷺ قال ويل للأمراء ويل للعرفاء ويل للأمناء ليتمنين قوم يوم القيامة أن ذوائبهم كانت معلقة بالثريا يتدلون بين السماء والأرض وأنهم لم يلوا عملا وروى أبو بريدة عنه ﷺ أنه قال لا يؤمر رجل على عشيرة فما فوقهم إلا جئ به يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه فإن كان محسنا فك عنه غله وإن كان مسيئا زيد غلا إلى غله. وهذا الخطر ثابت في أن يفرق الأمير بين نفسه وبين رعيته في الترفه بالمباحات فقد روى أن رسول الله ﷺ جلس يوم بدر في الظل فنزل جبريل فقال يا محمد أنت في الظل وأصحابك في الشمس وروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال ويل لديان أهل الأرض من ديان أهل السماء يوم يلقونه إلا من أمر بالعدل وقضى بالحق ولم يقض بهوى ولا قرابة ولا رهبة ولا رغبة ولكن جعل كتاب الله مرآة بين عينيه وأقل الأمور حاجة الإمام إلى تخويف بحكم السياسة وقد روى ابن عمر أن النبي ﷺ قال من نظر إلى مؤمن نظرة يخيفه بها في غير حق أخافه الله تعالى بها يوم القيامة وروى أنس بن مالك أنه ﷺ قال يؤتى بالولاة يوم القيامة فيقول الرب تعالى أنتم كنتم رعاة غنمي وخزان أرضى فيقول لهم ما حملكم على أن جلدتم فوق ما أمرتم فيقول أي رب غضبت لك فيقول أينبغي لك أن تكون أشد غضبا مني ويقول للآخر ما حملك على أن جلدت دون ما أمرت فيقول أي رب رحمته فيقول أينبغي لك أن تكون أرحم مني خذوا المقصر عن أمري والزائد على أمري فسدوا بهما أركان جهنم وبهذا الحديث يتبين أنه لا ينبغي أن نفزع إلا إلى الشرع وأنه لا شيء أهم للأئمة من معرفة أحكام الشرع وروى عن حذيفة أنه قال ما أنا بمثن على وال خيرا عادلهم وجائرهم فقيل له لم قال سمعت رسول الله ﷺ يقول يؤتى بالولاة يوم القيامة عادلهم وجائرهم فيقفون على الصراط فيوحي الله تعالى إلى الصراط فيزحف بهم زحفه يبقي جائر في حكمه ولا مرتش في قضائه ولا ممكن سمعه لأحد الخصمين مالم يمكن للأخر إلا زالت قدماه سبعين عاما في جهنم وروى أن النبي ﷺ كان يخرج متنكرا يطوف في الافاق يسأل داود فيهم فتعرض له جبريل ﷺ على صورة آدمي فسأله عن سيرته فقال جبريل نعم الرجل داود ونعم السيرة سيرته غير أنه يأكل من بيت مال المسلمين ولا ياكل من كد يده فرجع باكيا متضرعا إلى محرابه يسأل ربه تعالى أن يعلمه صنعة يأكل منها فعلمه صنعة الدروع وألان له الحديد فذلك قوله تعالى: {وعلمناه صنعة لبوس لكم}.
هذا خطر الإمامة وفيها أحاديث كثيرة يطول إحصاؤها وهذا القدر كاف للبصير المعتبر وعلى الجملة فيكفي من معرفة خطرها سيرة عمر رضي الله عنه فأنه كان يتجسس ويتعسس ليلا ليعرف أحوال الناس وكان يقول لو تركت حربه على ضفة الفرات لم بطلا بالهنا فأنا المسئول عنها يوم القيامة ومع ذلك فقد روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال دعوت الله تعالى اثنتى عشرة سنة اللهم أرني عمر بن الخطاب في منامي فرأيته بعد اثنى عشرة سنة كانما اغتسل واشتمل بالازار فقلت يا أمير المؤمين كيف وجدت الله تعالى قال يا أبا عبد الله كم منذ فارقتكم قلت منذ اثنتى عشرة سنه قال كنت في الحساب إلى الآن ولقد كادت تزل سريرتي لولا اني وجدت ربا رحيما فهذه حال عمر ولم يملك من الدنيا سوى درة فليعتبر به.
وقد حكى عن يزدجرد بن شهريار آخر ملوك العجم أنه بعث رسولا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأمره أن ينظر في شمائله فلما دخل المدينة قال أين ملككم قالوا ليس لنا ملك لنا أمير خرج برا فخرج الرجل في أثره فوجده نائما في الشمس ودرته تحت راسه وقد عرق جنبه حتى ابتلت منه الأرض فلما رآه على حالته قال عدلت فأمنت فنمت وصاحبنا جار فخاف فسهر أشهد أن الدين دينكم ولولا أني رسول لأسلمت وسأعود بإذن الله تعالى.
ومنها أن يكون الوالي متعطشا إلى نصيحة علماء الدين متعظا بمواعظ الخلفاء الراشدين ومتصفحا في مواعظ مشايخ الدين للامراء المنقرضين ونحن نورد الآن بعض تلك المواعظ فأنه قد روى ان عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الاشعري أما بعد فإن أسعد الرعاة عند الله من سعدت به رعيته وإن اشقى الرعاة عند الله من شقيت به رعيته وإياك أن ترتع فترتع عمالك فيكون مثلك عند الله مثل بهيمة نظرت إلى خضرة من الأرض فرتعت فيها تبتغي في ذلك السمن وإنما حتفها في سمنها وإنما قال ذلك لأن الوالي مأخوذ بظلم عماله وظلم جميع حواشيه فكل ذلك في جريدته وينسب إليه وقد روى انه أنزل في التوراة على موسى عليه السلام انه ليس على الإمام من ظلم العامل وجوره مالم يبلغه ذلك من ظلمه وجوره فإذا بلغه فاقره شركه في ظلمه وجوره.
وقد روي أن شقيق البلخي دخل على هارون الرشيد فقال له أنت شقيق الزاهد فقال له أما شقيق فنعم واما الزاهد فيقال فقال له عظني فقال له إن الله تعالى أنزلك منزلة الصديق وهو يطلب منك الصدق كما تطلبه منه وأنزلك منزلة الفاروق وهو يطلب منك الفرق بين الحق والباطل كما تطلبه منه وأنزلك منزلة ذي النورين وهو يطلب منك الحياء والكرامة كما تطلبه منه وانزلك منزلة علي بن أبي طالب وهو يطلب منك العلم كما تطلبه منه ثم سكت فقال له زدني قال نعم ان لله دارا سماها جهنم وجعلك بوابا لها واعطاك بيت مال المسلمين وسيفا قاطعا وسوطا موجعا وامرك ان ترد الخلق من هذه الدار بهذه الثلاث فمن أتاك من أهل الحاجة فاعطه من هذا البيت ومن تقدم على نهى الله فأوجعه بهذا السوط ومن قتل نفسا بغير حق فاقتله بهذا السيف بأمر ولى المقتول فإنك إن لم تفعل ذلك فأنت السابق والخلق تابع لك إلى النار قال زدني قال نعم أنت العين والعمال الأنهار إن صفت العين لم يصر كدر الأنهار وإن كدرت العين لم يرج صفاء الأنهار وقد حكى أن هارون الرشيد قصد الفضيل بن عياض ليلا مع العباس في داره فلما وصل إلى بابه سمع قراءته وهو يقرأ {أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون} فقال هارون للعباس إن انتفعنا بشيء فبهذا فدق العباس الباب وقال أجب أمير المؤمنين قال وما يعمل عندي أمير المؤمنين فقال أجب إمامك ففتح الباب وأطفأ سراجه وجلس في وسط البيت في الظلمة فجعل هارون يطوف حتى وقعت عليه يده فقال آه من يد ما ألينها إن نجت من عذاب الله يوم القيامة فجلس وقال يا أمير المؤمنين استعد لجواب الله تعالى يوم القيامة فإنك تحتاج أن تتقدم مع كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة فجعل هارون يبكي فقال العباس اسكت فقد قتلت أمير المؤمنين فقال يا هامان تقتله أنت وأصحابك وتقول لي أنت قتلته فقال هارون ما سماك هامان إلا وجعلني فرعون فقال له هارون هذا مهر والدتي ألف دينار تقبلها مني فقال يا أمير المؤمنين لا جزاك الله إلا جزاءك أقول لك ردها على من أخذتها منه وتقول لى خذها أنت فقام وخرج وقد حكى عن محمد بن كعب القرظى أنه قال عمر بن عبد العزيز صف لى العدل فقال يا أمير المؤمنين كن لصغير المسلمين أبا وللكبير منهم ابنا وللمثل أخا وعاقب كل واحد منهم بقدر ذنبه على قدر جسمه وإياك أن تضرب بغضبك سوطا واحدا فتدخل النار وقد حكى عن الحسن أنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز أما بعد فإن الهول الأعظم ومقطعات الأمور كلهن أمامك لم تقطع منهن شيئا فلذلك فاعدد ومن شرها فاهرب والسلام عليك وقد حكى أن بعض الزهاد دخل على بعض الخلفاء فقال له عظني فقال له يا أمير المؤمنين كنت أسافر الصين فقدمتها مدة وقد أصيب ملكها بسمعه فبكى بكاء شديدا وقال أما إني لست ابكي على البلية النازلة ولكني أبكي لمظلوم على الباب يصرخ فلا يؤذن له ولا أسمع صوته ولكني إن ذهب سمعي فإن بصري لم يذهب نادوا في الناس لا يلبس أحد ثوبا أحمر إلا متظلم ثم كان يركب الفيل في نهاره حتى يرى حمرة بباب المظلومين فهذا يا أمير المؤمنين مشترك بالله تعالى غلبت عليه رأفته ورحمته على المشركين وأنت مؤمن بالله تعالى من أهل بيت نبيه ﷺ كيف لا تغلب رأفتك بالمؤمنين وحكى أيضا أن سليمان بن عبد الملك قدم المدينة وهو يريد مكة فأقام بها أياما فأرشد إلى أبي حازم فدعاه فلما دخل عليه قال له سليمان يا أبا حام ما لنا نكره الموت ونحب الحياة {فقال} لأنكم خربتم آخرتكم وعمرتم الدنيا فكرهتم أن تنقلوا من العمران إلى الخراب فقال يا أبا حازم كيف القدوم على الله تعالى غدا فقال يا أمير المؤمنين أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله واما المسيء فكالآبق يقدم على مولاه فبكى سليمان وقال ليت شعري ما لي عند الله غدا قال أبو حازم اعرض عملك على كتاب الله تعالى حيث يقول إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم قال سليمان فأين رحمة الله قال {قريب من المحسنين} ثم قال سليمان يا أبا حازم أي عباد الله أكرم قال أهل المروءة والتقى قال أي الأعمال أفضل قال أداء الفرائض مع اجتناب المحارم قال فأي الدعاء اسمع قال دعاء المحسن إليه للمحسنين قال فأي الصدقة أزكى قال صدقة على السائل الناس وجهد المقل ليس فيها من ولا أذى قال فأي القول اعدل قال قول الحق عند من يخاف ويرجو قال فأي المؤمنين أكيس قال رجل عمل بطاعة الله تعالى وذكر الناس عليها قال فأي المؤمنين أفسق قال رجل أخطأ في هوى أحبه وهو ظالم باع آخرته بدنيا غيره قال سليمان فما تقول فيما نحن فيه فقال يا أمير المؤمنين أو تعفيني قال لا ولكن نصيحة تلقيها إلي قال يا امير المؤمنين إن آباءك قهروا الناس بالسيف وأخذوا هذا الملك عنوة من غير مشورة من المسلمين ولا رضا أحد حتى قتلوا وقد قتلوا قتلة عظيمة وقد ارتحلوا فلو شعرت ما قالوا وما قيل لهم فقال له رجل من جلسائه بئس ما قلت قال أبو حازم إن الله تعالى أخذ الميثاق على العلماء ليبيننه للناس ولا يكتمونه فقال كيف لنا أن نصلح هذا الفساد فقال أن تأخذه من حله وتضعه في حقه فقال ادع لي قال أبو حازم اللهم إن كان سليمان وليك فيسره لخير الدنيا والآخرة وإن كان عدوك فخذ بناصيته إلى ما تحب وترضى فقال سليمان أوصني قال أوصيك وأوجز عظم ربك ونزهه أن يراك حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك وقد حكى عن أبي قلابة أنه دخل على عمر بن عبد العزيز فقال له يا أبا قلابة عظني فقال يا أمير المؤمنين إنه لم يبق من لدن آدم ﷺ إلى يومنا هذا خليفة غيرك قال له زدني قال أنت أول خليفة يموت قال زدني قال إذا كان الله معك فمن تخاف وإذا كان عليك فمن ترجو قال حسبي. وحكي عن سليمان بن عبد الملك أنه تفكر يوما فقال كيف تكون حالي وقد ترفهت في هذه الدنيا فأرسل إلى أبي حازم وقال تبعث إلى بذلك الذي تفطر عليه بالعشاء فأنفذ إليه شيئا من النخالة المقلية قال أبل هذا بالماء فأفطر به فهو طعامي فبكى سليمان وعمل ذلك في قلبه وصام ثلاثة أيام ما ذاق شيئا حتى فرع بطنه من مأكولاته ثم أفطر في اليوم الثالث بتلك النخالة فقضى أن قارب اهله تلك الليلة فولد له عبد العزيز بن سليمان ومن عبد العزيز عمر فهو واحد زمانه وذلك من بركة تلك النية الصادقة وحكي أنه قيل لعمر بن عبد العزيز ما كان بدء توبتك قال أردت ضرب غلام فقال لي يا عمر اذكر ليلة صحبتها يوم القيامة وحكى أن زاهدا كتب إلى عمر ابن عبد العزيز وقال في كتابه اعتصم بالله يا عمر اعتصام الغريق بما ينجيه من الغرق وليكن دعاؤك دعاء المنقطع المشرف على الهلكة فانك قد أصبحت عظيم الحاجة شديد الاشراف على المعاطب وقد حكي عن هارون الرشيد أنه قال للفضيل عظني قال بلغني أن عمر ابن عبد العزيز شكى إليه بغض عماله فكتب إليه يا أخي اذكر سهر أهل النار في النار مع خلود الأبد بعد النعيم والظلال فإن ذلك يطرد بك إلى ربك نائما ويقظان واياك أن يتصرف بك من عند الله فتكون آخر العهد منقطع الرجاء فلما قرأ الكتاب قدم على عمر فقال له ما أقدمك قال خلع قلبي كتابك لا وليت ولاية حتى ألقى الله تعالى وقد حكى عن إبراهيم بن عبد الله الخراساني أنه قال حججت مع أبي سنة حج الرشيد فإذا نحن بالرشيد وهو واقف حاسر حاف على الحصباء وقد رفع يديه وهو يرتعد ويبكي ويقول يا رب أنت أنت وأنا أنا أنا العواد إلى الذنب وأنت العواد إلى المغفرة اغفر لي فقال لي يا بني انظر إلى جبار الأرض كيف يتضرع إلى جبار السماء وحكى أنه دخل رجل على عبد الملك بن مروان وكان يوصف بحسن العقل والأدب فقال له عظني فقال يا أمير المؤمنين إن للناس في القيامة جولة لا ينجو من غصص مرارتها ومعاينة الردى فيها إلا من أرضى الله بسخط نفسه قال فبكى عبد الملك ابن مروان ثم قال لا جرم لأجعلن هذه الكلمات مثالا نصب عيني ما عشت أبدا وحكى عن عمر بن عبد العزيز أنه قال لأبي حازم عظني قال أضطجع ثم اجعل الموت عند راسك ثم انظر ما تحب أن يكون فيك تلك الساعة فخذ به الآن وما تكره أن يكون فيك تلك الساعة فدعه الآن فلعل الساعة قريبة وحكى أن أعرابيا دخل على سليمان بن عبد الملك فقال له تكلم يا أعرابي فقال يا أمير المؤمنين إني لمكلمك بكلام فاحتمله وان كرهته فإن وراءه ما تحب أن قبلته فقال يا أعرابي إنا لنجود بسعة الاحتمال على من نرجو نصحه ونأمن غشه فقال الأعرابي إنه قد تكنفك رجال أساءوا الاختيار لأنفسهم فابتاعوا دنياهم بدينهم ورضاك بسخط ربهم خافوك في الله ولم يخافوا الله فيك حرب للاحرة سلم للدنيا فلا تأمنهم على ما امتحنك الله عليه فإنهم لن بألوا في الامانة تضييعا وفي الأمة خسفا وعسفا وانت مسئول عما اجترحوا وليسوا بمسئولين عما اجترحت فلا تصلح دنياهم بفساد آخرتك فإن أعظم الناس غبنا من باع آخرته بدنيا غيره فقال سليمان أما أنك يا عرابي قد سللت لسانك وهو اقطع من سيفك قال أجل يا أمير المؤمنين ولكن عليك لا لك وقد حكى أن صالح بن بشير دخل على المهدي وجلس معه على الفراش فقال له المهدي عظني قال أليس قد جلس هذا المجلس أبوك وعمك قبلك قال نعم قال فكانت لهم أعمال ترجولهم بها النجاة من الله تعالى قال نعم قال وأعمال تخاف عليهم بها الهلكة قال نعم قال فانظر ما رجوت لهم فأته وما خفت عليهم فاجتنبه قال قد أبلغت وأوجزت. وقد حكي أن أبا بكرة دخل على معاوية فقال اتق الله يا معاوية واعلم أنك في كل يوم يخرج عنك وفي كل ليلة تأتي عليك لا تزداد من الدنيا إلا بعدا ومن الآخرة الإ قربا وعلى أثرك طالب لا تفوته وقد نصب لك علم لا تجوزه فما أسرع ما يبلغ العلم وما أقرب ما يلحق بك الطالب وما نحن فيه زائل والذي نحن صائرون إليه باق أن خيرا فخير وإن شرا فشر.
ومنها أن تكون العادة الغالبة على والي الأمر العفو والحلم وحسن الخلق وكظم الغيظ مع القدرة فقد حكي أنه حمل إلى أبي جعفر رجل قد جنى جناية فأمر بقتله فقال المبارك بن فضالة وكان حاضرا يا أمير المؤمنين ألا أحدثك حديثا سمعته من الحسن قال وما هو قال سمعت الحسن رحمه الله يقول إذا كان يوم القيامة جمع الناس في صعيد واحد فيقوم مناد ينادي من له عند الله يد فليقم فلا يقوم إلا من عفا فقال خلوا عنه وحكى عن عيسى ابن مريم ﷺ أنه قال ليحيى بن زكريا ﷺ إذا قيل لك ما فيك فأحدث لله شكرا وإذا قيل ما ليس فيك فأحدث لله شكرا أعظم منه إذ تيسرت لك حسنة لم يكن لك فيها عمل وروى أبو هريرة أنه ﷺ قال ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وحكي أن رجلا أتى إلى رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله إن خادمي يسيء ويظلم أفأ ضربه قال تعفو عنه كل يوم سبعين مرة وروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ أنه قال ألا أدلك على خير أخلاق الأولين والآخرين قال قلت بلى يا رسول الله قال تعطي من حرمك وتعفوا عمن ظلمك وتصل من قطعك وروى عن عمر بن عبيد الله أنه قال ثلاث من كن فيه استكمل الإيمان إذا غضب لم يخرجه غضبه إلى الباطل وإذا رضى لم يخرجه رضاه عن الحق وإذا قدر لم يأخذ ما ليس له وقد روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لا يغرنك خلق امرئ حتى يغضب ولا دينه حتى يطمع فانظر على أي جنبيه يقع وقد روى عن علي بن الحسين رضي الله عنهما انه خرج من المسجد فلقيه رجل فسبه فثارت إليه العبيد والموالي فقال علي ابن الحسين مهلا عن الرجل ثم اقبل عليه وقال ما ستر عنك من امرنا لكثير الك حاجة نعينك عليها فاستحيا الرجل ورجع إلى نفسه فألقى أليه خميصة كانت عليه وأمر له بألف درهم فكان الرجل بعد ذلك يقول أشهد انك من أولاد الرسل وقد روى عنه أيضا انه دعا مملوكا له مرتين فلم يجبه ثم اجابه في الثالثة فقال له اما سمعت صوتي قال بلى قال فما بالك لم تجبني قال أمنتك قال الحمد لله الذي جعل مملوكي بحيث يأمنني وقد حكى أنه جاء غلام لأبي ذر بشاة له قد كسر رجلها فقال له أبو ذر من كسر رجل هذه الشاة قال أنا قال ولم فعلت ذلك قال عمدا لأغضبك فتضربني فتأثم قال أبو ذر لأغيظن من حضك على غيظي فأعتقه وروى عنه أنه شتمه رجل فقال يا هذا إن بيني وبين الجنة عقبة فإن أنا جزتها فوالله ما أبالي بقولك وإن قصرت دونها فأنا أهل لأشر مما قلت وروى ابن عباس عن رسول الله ﷺ أنه قال ثلاث من لم تكن فيه واحدة منهن فلا يعتدن بشيء من عمله من لم تكن فيه تقوى تحجزه عن معاصي الله أو حلم يكفه عن السفه أو خلق يعيش به في الناس وثلاث من كان فيه واحدة منهن زوج من الحور العين رجل اؤتمن على أمانة خفية شهية فأداها من مخافة الله تعالى ورجل عفا عن قاتله ورجل قرأ قل هو الله أحد في دبر كل صلاة وثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن أكن خصمه أخصمه رجل أستأجر أجيرا فظلمه ولم يوفه أجره ورجل حلف بي ثم غدر ورجل باع حرا وأكل ثمنه ومن كفل ثلاثة أيتام كان كالذي قام ليله وصام نهاره وعدا وراح شاهرا سيفه في سبيل الله وكنت أنا وهو في الجنة كهاتين وأشار إلى السبابة والوسطى وقد روى عن علي رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال إن الرجل المسلم ليدرك بالحلم درجة الصائم القائم وإنه ليكتب حبارا وما يهلك إلآ أهل بيته وروى ابن عباس عن علي رضي الله عنهما أنه قال أوصاني رسول الله ﷺ حين زوجني فاطمة رضي الله عنها خصوصا دون غيري فكان مما أوصاني به أن قال يا علي لا تغضب وإذا غضبت فاقعد واذكر قدرة الله تعالى على العباد وحلمه عنهم وإذا قيل لك اتق الله فاترك غضبك عنك وأرجع بحلمك وقد روى ابن عباس عنه ﷺ إن لجهنم بابا لا يدخله إلا من شفى غيظه بمعصية الله وروى أن إبليس اللعين ظهر لموسى ﷺ فقال له يا موسى إنك الليلة تناجي ربك ولى إليك حاجة فاقضها وأنا أعلمك خصالا ثلاثا فيهن الدنيا والآخرة فقال له موسى ما هذه الخصال قال إياك والحدة فاني ألعب بالرجل الحديد كما تلعب الصبيان بالكرة (يا موسى اياك والنساء فاني لم أنصب قط فخأ اثبت في نفسي من فخ انصبه بامرأة) يا موسى اياك والشح فإني أفسد على الشحيح الدنيا والآخرة وروى عن رسول الله ﷺ أنه قال من كظم غيظا وهو يقدر على انفاذه ملأه الله ايمانا وأمنا ومن وضع ثوب جمال تواضعا لله وهو يقدر عليه كساه الله تعالى حلة الكرامة وحكي أن ذا القرنين لقى ملكا من الملائكة فقال له علمني عملا أزداد به إيمانا ويقينا فقال لا تغضب فإن الشيطان أقدر ما يكون على ابن آدم إذا غضب وإذا غضبت فرد الغضب بالكظم وسكنه بالتؤدة وإياك والعجلة فإنك إذا عجلت أخطأت حظك وكن سهلا لينا للقريب والبعيد ولا تكن جبارا عنيدا وقد روى أبو هريرة عن النبي ﷺ أنه قال الويل لمن يغضب وينسى غضب الله تعالى عباد الله إياكم والغضب والظلم فإن عقوبتهما شديدة ومن غضب في غير ذات الله جاء يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه وروى أبو هريرة أيضا أن رجلا جاء إلى رسول الله ﷺ وقال يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة قال لا تغضب ولك الجنة قال زدني قال استغفر الله تعالى دبر صلاة العصر سبعين مرة بغفر الله لك ذنب سبعين سنة ليس لي ذنوب سبعين سنة قال فلآمك قال ولا لأمي قال فلأبيك قال ولا لأبي قال فلإخوانك وقد روى عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله وسلم قسم قسما فقال رجل من الأنصار هذه قسمة ما أريد بها وجه الله قال ابن مسعود يا عدو الله لأخبرن رسول الله ﷺ قال فأخبرته فأحمر وجهه وقال رحمة الله على موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر.
وهذا القدر الذي روى من الآثار والأخبار وسير الخلفاء وأئمة الأعصار كاف للمتعظ به وللمصغي إليه في تهذيب (الأخلاق ومعرفة) وظائف الخلافة فالعامل به مستغن عن المزيد والله ولي التوفيق.

تم الكتاب والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين. وقع الفراغ منه يوم السبت لسبعة عشر يوما خلت من شهر ربيع الآخر سنة خمس وستين وستمائة.
نهاية مخطوط جامع القرويين بفاس: نجز بحمد الله تعالى وقوته كتاب المستظهري في فضائح الباطنية على يد الفقير المذنب الراجي عفو ربه أبو الحسن علي بن سعيد بن مسعود التملي اللهم اغفر له ولوالديه ولعشيرته ولجميع المسلمين يوم الجمعة الأول من ربيع الثاني عام واحد وثمانين وتسعمائة بمدينة فاس أدام الله خيرها وعمرها بالإسلام وصلى الله على نبينا وشفيعنا غدا محمد ﷺ وشرف وكرم وعز وعظم.
محتويات
1 الباب الأول في الإعراب عن المنهج الذي استنهجته في هذا الكتاب
1.1 المقام الثاني في التعبير عن المقاصد إطنابا وإيجازا
1.2 المقام الثالث في التقليل والتكثير
2 الباب الثاني في بيان ألقابهم والكشف عن السبب الداعي لهم على نصب هذه الدعوة
2.1 الفصل الأول في ألقابهم التي تداولتها الألسنة على اختلاف الأعصار والأزمنة
2.2 الفصل الثاني في بيان السبب الباعث لهم على نصب هذه الدعوة وإفاضة هذه البدعة
3 الباب الثالث في درجات حيلهم وسبب الاغترار بها مع ظهور فسادها
3.1 الفصل الأول في درجات حيلهم
4 الباب الرابع في نقل مذاهبهم جملة وتفصيلا
4.1 الطرف الأول في معتقدهم في الإلهيات
4.2 الطرف الثاني في بيان معتقدهم في النبوات
4.3 الطرف الثالث بيان معتقدهم في الإمامة
4.4 الطرف الرابع بيان مذهبهم في القيامة والمعاد
4.5 الطرف الخامس في اعتقادهم في التكاليف الشرعية
5 الباب الخامس في إفساد تأويلاتهم للظواهر الجلية واستدلالاتهم بالأمور العددية
5.1 الفصل الأول في تأويلاتهم للظواهر
5.2 الفصل الثاني في استدلالهم بالأعداد والحروف
6 الباب السادس في الكشف عن تلبيساتهم التي زوقوها بزعمهم في معرض البرهان على إبطال النظر العقلي وإثبات وجوب التعلم من الإمام المعصوم
6.1 المنهج الأول وهو الجملي
6.2 المنهج الثاني في الرد عليهم تفصيلا
7 الباب السابع في إبطال تمسكهم بالنص في إثبات الإمامة والعصمة
7.1 الفصل الأول في تمسكهم بالنص على الإمامة
7.2 الفصل الثاني في إبطال قولهم إن الإمام لا بد أن يكون معصوما من الخطأ والزلل والصغائر والكبائر
8 الباب الثامن في الكشف عن فتوى الشرع في حقهم من التفكير وسفك الدم
8.1 الفصل الأول في تكفيرهم أو تضليلهم أو تخطئتهم
8.2 الفصل الثاني في أحكام من قضي بكفره منهم
8.3 الفصل الثالث في قبول توبتهم وردها
8.4 الفصل الرابع في حيلة الخروج عن إيمانهم وعهودهم إذا عقدوها على المستجيب
9 الباب التاسع في إقامة البراهين الشرعية على أن الإمام القائم بالحق الواجب على الخلق طاعته في عصرنا هذا هو الإمام المستظهر بالله حرس الله ظلاله
10 الباب العاشر في الوظائف الدينية التي بالمواظبة عليها يدوم استحقاق الإمامة
========
أيها الولد
اقرأ عن أيها الولد في ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
أيها الولد
للغزالي
أيها الولد المحب
اعلم أيها الولد المحب العزيز أطال الله تعالى بقائك بطاعته وسلك بك سبيل أحباؤه أن منشور النصيحة يكتب من معدن الرسالة عليه الصلاة والسلام إن كان قد بلغك منه نصيحة فأي حاجة لك في نصيحتي ، وإن لم يبلغك فقل لي : ماذا حصلت في هذه السنين الماضية ؟!
أيها الولد
من جملة ما نصح به رسول الله ﷺ أمته قوله " علامة إعراض الله تعالى عن العبد اشتغاله بما لا يعنيه ، وإن امرأ ذهبت ساعة من عمره في غير ما خلق له لجدير أن تطول عليه حسرته ، ومن جاوز الأربعين ، ولم يغلب خيره شره فليتجهز للنار".
وفى هذه النصيحة كفاية لأهل العلم.
أيها الولد
النصيحة سهلٌ ، والمُشْكِلُ قَبولُها ، لأنَّها في مذاقِ متَّبعِي الهوى مرٌّ ؛ إذِ المناهي محبوبةٌ في قلوبِهِم، على الخصوص مَنْ كانَ طالبَ العلمِ الرسميِّ ، مشتغلَ في فضلِ النفسِ ومناقب الدنيا ؛ فإِنَّهُ يَحْسَبُ أَنَّ العِلْمَ المُجَرَّدَ لَهُ وسيلةٌ ، سَيَكُونُ نَجَاتُهُ وَخَلَاصُهُ فِيهِ ، وأَنَّهُ مُسْتَغْن عَنْ العَمَلَ ، و هذا اعْتِقَادُ الفَلَاسِفَةِ. سبحان الله العظيم !! لا يَعْلَمُ هذَا القّدْرَ أَنَّهُ حين حصَّل العلمَ إذا لم يعمل به .. تكون الحُجَّةُ عليه آكدَ ؛ كما قال رسول الله ﷺ : " إنَّ أشدَّ النَّاسِ عَذاباً يومَ القِيامَةِ .. عالمٌ لمْ ينْفَعْهُ اللهُ بِعِلْمِهِ"
وروى : أن الجنيد - رحمه الله - رئى في المنام بعد موته ، فقيل له: ما الخبر يا أبا القاسم؟ قال: طاحت العبارات، وفنيت الإشارات ، وما نفعنا إلا ركعات ركعناها في جوف الليل.
أيها الولد
لا تكنْ مِنَ الأَعْمالِ مُفْلِساً ، ولا مِنَ الأَحْوالِ خَالِياً ، وتَيَقَّنْ أَنَّ العِلْمَ المُجَرَّدَ لا يَأخُذُ بِاليَدِ . مِثَالُهُ : لَوْ كانَ على رَجُلٍ في بَرِّيَّةٍ عَشْرَةُ أَسْيافٍ هِنْدِيَّةٍ مَعَ أَسْلِحَةٍ أُخْرَى ، وَكَاَن الرَّجُلُ شُجَاعاً وأَهْلَ حَرْب ، فَحَمَلَ عَلَيْهِ أَسَدٌ عَظِيمٌ مَهيبٌ فَمَا ظَنُّكَ ؟ هَلْ تَدْفَعُ الأَسْلِحَةُ شَرَّهُ عَنْهُ بِلا اسْتِعْمالِها وضَرْبِها ؟! ومِنَ المَعْلُومِ أَنَّهَا لَا تَدْفَعُ إِلَّا بالتَّحْرِيكِ والضَّرْبِ . فَكَذَا لَوْ قَرأَ رَجُلُ مِائَةَ أَلْفِ مَسْأَلَةٍ عِلْمِيَّةٍ وتَعَلَّمَهَا ولم يَعْمَلْ بِهَا ، لا تُفِيدُهُ إِلَّا بِالعَمَلِ.
ومِثَالُهُ أيضاً : لَوْ كَان لرَجُلٍ حَرَارَةٌ و مَرَضٌ صَفْرَاوِي يَكُونُ عِلاجُهُ بالسَّكَنْجَبِينِ و الكَشكَاب فَلا يَحْصُلُ البُرْءُ إلَّا باسْتِعْمَالِهِمَا.
كَرْ مَيْ دُو هَزَار رِطْل بَيْمايي … تا مَيْ نَخُوري نبا شَدَتْ شيدايي. "ملاحظة : معناه : إن كِلْتَ ألفي رِطْلِ خَمْراً …. لا تكون سكرانَ ومجنونا ما لم تشربها"
أيها الولد
أيها الولد لو قرأت العلم مائة سنة ، وجمعت ألف كتاب ، لا تكون مستعدا لرحمة الله إلا بالعمل لقوله تعالى : "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى" وقوله تعالى " فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا " وقوله "جزاء بما كانوا يكسبون " وقوله "إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات" .
أيها الولد ما لم تعمل لن تجد أجرا.
حكي أن رجلا من بني إسرائيل عبد الله تعالى سبعين سنة ، فأراد الله تعالى أن يجلوه على الملائكة فأرسل الله إليه ملكا يخبره أنه مع تلك العبادة لا يليق به دخول الجنة، فلما بلغه قال العابد : نحن خلقنا للعبادة ، فينبغي لنا أن نعبده . فلما رجع الملك قال الله تعالى: ماذا قال عبدي؟ قال : إلهي ، أنت أعلم بما قال، فقال الله تعالى : إذا هو لم يعرض عن عبادتنا ، فنحن – مع الكرم- لا نعرض عنه، أشهدوا يا ملائكتي أنى قد غفرت له.
وقال الحسن رحمه الله: طلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب.
أيها الولد
عش ما شئت فإنك ميت ، وأحبب من شئت فإنك مفارقه ، وأعمل ما شئت فإنك مجزى به.
أيها الولد
إني رأيت في الإنجيل أن عيسى عليه السلام قال : من ساعة يوضع الميت على الجنازة إلى أن يوضع على شفير القبر يسأل الله بعظمته منه أربعين سؤالا ، أوله : يقول "عبدي طهرت منظر الخلق سنين وما طهرت منظري ساعة".
أيها الولد
العلم بلا عمل جنون ، والعمل بغير علم لا يكون .
أيها الولد
اجعل الهمة في الروح، والهزيمة في النفس ، والموت في البدن ، لأن منزلك القبر وأهل المقابر ينتظرونك في كل لحظة متى تصل إليهم ، إياك إياك أن تصل إليهم بلا زاد . وقال أبو بكر الصديق : هذه الأجساد قفص طيور وإصطبل الدواب ، فتفكر في نفسك من أيهما أنت؟
إن كنت من الطيور العلوية فحين تسمع طنين طبل ربك "أرجعى إلى ربك " تصير صاعدا إلى أن تقعد في أعالي بروج الجنان ، كما قال رسول الله ﷺ : "واهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ ".
والعياذ بالله إن كنت من الدواب كما قال الله تعالى " أولئك كالأنعام بل هم أضل" فلا تأمن انتقالك من زاوية الدار إلى هاوية النار.
وروى أن الحسن البصري رحمه الله تعالى أعطى شربة ماء بارد ، فلما أخذ القدح غشي عليه وسقط من يده ، فلما أفاق قيل له : مالك يا أبا سعيد ؟ قال: ذكرت أمنية أهل النار حيث يقولون لأهل الجنة : " أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله".
أيها الولد
لو كان العلم المجرد كافيا لك ، ولا تحتاج إلى عمل سواه لكان نداء الله تعالى : "هل من سائل ؟ هل من مستغفر ؟ هل من تائب ؟ " ضائعا بلا فائدة .
وروى أن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ذكروا عبد الله بن عمر عند رسول الله ﷺ فقال : " نعم الرجل هو لو كان يصلى بالليل ".
وقال رسول الله ﷺ لرجل من أصحابه : "يا فلان ….لا تكثر النوم بالليل فإن كثرة النوم بالليل تدع صاحبه فقيرا يوم القيامة" .
أيها الولد
"ومن الليل فتهجد به" أمر ، "وبالأسحار هم يستغفرون" شكر ، "والمستغفرون بالأسحار" ذكر.
قال رسول الله ﷺ: " ثلاثة أصوات يحبها الله تعالى صوت الديك ، وصوت الذي يقرأ القرآن ، وصوت المستغفرين بالأسحار " .
وقال سفيان الثوري : ان لله تعالى ريحا تهب بالأسحار تحمل الأذكار والاستغفار إلى الملك الجبار .
وقال أيضا " إذا كان أول الليل ينادى مناد من تحت العرش : ألا ليقم العابدون ، فيقومون ويصلون ما شاء الله ، ثم ينادى مناد في شطر الليل : إلا ليقم القانتون ، فيقومون ويصلون إلى السحر ، فإذا كان السحر ينادى مناد : ألا ليقم المستغفرون ، فيقومون ويستغفرون ، فإذا طلع الفجر ينادى مناد :ألا ليقم الغافلون ، فيقومون من فرشهم كالموتى نشروا من قبورهم.
أيها الولد
روى فى بعض وصايا لقمان الحكيم لابنه أنه قال: يا بنى .. لايكونن الديك أكيس منك، ينادى بالأسحار وأنت نائم.
ولقد أحسن من قال شعرا
لقد هتفت فى جنح ليل حمامة
على فنن وهنا وإنى لنائم
كذبت وبيت الله لو كنت عاشقا
لما سبقتنى بالبكاء الحمائم
وأزعم أنى هائم ذو صبابة
لربى فلا أبكى وتبكى البهائم
أيها الولد
خلاصة العلم : أن تعلم أن الطاعة والعبادة هى؟
اعلم أن الطاعة والعبادة متابعة الشارع فى الأوامر والنواهى بالقول والفعل، يعنى : كل ما تقول وتفعل، وتترك قوله وفعله يكون بأوامر الشرع، كما لو صمت يوم العيد وأيام التشريق تكون عاصيا، أو صليت فى ثوب مغصوب- وان كانت فى صورة عبادة- تأثم.
أيها الولد
ينبغى لك أن يكون قولك وفعلك موافقا للشرع، إذ العلم والعمل بلا اقتداء الشرع ضلالة، وينبغى لك ألا تغتر بشطح الصوفية وطاماتهم، لأن سلوك هذا الطريق يكون بالمجاهدة وقطع شهوة النفس وقتل هواها بسيف الرياضة ، لا بالطامات والترهات.
وأعلم ان اللسان المطلق والقلب المطبق المملوء بالغفلة والشهوة علامة الشقاوة، فإذا لم تقتل النفس بصدق المجاهدة لن يحيى قلبك بأنوار المعرفة .
ولقد وجب على السالك أربعة أمور:
أول الأمر: اعتقاد صحيح لا يكون فيه بدعة.
والثانى: توبة نصوح لا يرجع بعده إلى الذلة.
والثالث: استرضاء الخصوم حتى لا يبقى لأحد عليك حق.
والرابع: تحصيل علم الشريعة قدر ما تؤدى به أوامر الله تعالى.
ثم من العلوم الآخرة ما يكون به النجاة.
قال الشبلى أن الرسول قال: " اعمل لدنياك بقدر مقامك فيها واعمل لآخرتك بقدر بقائك فيها ، واعمل لله بقدر حاجتك إليه، واعمل للنار بقدر صبرك عليها"
أيها الولد
إن حاتم الأصم كان من أصحاب شقيق البلخى رحمة الله تعالى عليهما، فسأله يوما قال : صاحبتنى منذ ثلاثين سنة ما حصلت؟
قال : حصلت ثمانى فوائد من العلم ، وهى تكفينى منه لأنى أرجو خلاصى ونجاتى فيها. فقال شقيق ما هى؟
قال حاتم:
الفائدة الأولى:
أنى نظرت إلى الخلق فرأيت لكل منهم محبوبا ومعشوقا يحبه ويعشقه، وبعض ذلك المحبوب يصاحبه إلى مرض الموت وبعضه يصاحبه إلى شفير القبر، ثم يرجع كله ، ويتركه فريدا وحيدا، ولا يدخل معه فى قبره منهم أحد فتفكرت وقلت: أفضل محبوب المرء ما يدخل معه فى قبره، ويؤنسه فيه، فما وجدته غير الأعمال الصالحة ، فأخذتها محبوبه لى ، لتكون لى سراجا فى قبرى، وتؤنسنى فيه ، ولا تتركنى فريدا.
الفائدة الثانية:
أنى رأيت الخلق يقتدون أهواءاهم، ويبادرون إلى مرادات أنفسهم، فتأملت قوله تعالى ( واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ، فإن الجنه هى المأوى). وتيقنت أن القرآن حق صادق فبادرت إلى خلاف النفس وتشمرت بمجاهدتها ، وما متعتها بهواها ، حتى ارتاضت بطاعة الله تعالى وانقادت.
الفائدة الثالثة:
أنى رأيت كل واحد من الناس يسعى فى جمع حطام الدنيا ، ثم يمسكه قابضا يده عليه فتأملت فى قوله تعالى : ( ما عندكم ينفد وما عند الله باق ) فبذلت محصولى من الدنيا لوجه الله تعالى ففرقته بين المساكينليكون ذخرا لى عند الله تعالى.
الفائدة الرابعة :
أنى رأيت بعض الخلق يظن أن شرفه وعزه فى كثرة الأقوام والعشائر فاعتز بهم. وزعم آخرون أنه فى ثروة الأموال وكثرة الأولاد ، فافتخروا بها. وحسب بعضهم أن العز والشرف فى غصب أموال الناس وظلمهم وسفك دمائهم. واعتقدت طائفة أنه فى اتلاف المال واسرافه وتبذيره، فتأملت قوله تعالى : ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم) فاخترت التقوى واعتقدت أن القرآن حق صادق، وظنهم وحسبانهم كلها باطل زائل.
الفائدة الخامسة :
أنى رأيت الناس يذم بعضهم بعضا ، ويغتاب بعضهم بعضا ، فوجدت أصل ذلك من الحسد فى المال والجاه والعلم، فتأملت فى قوله تعالى : ( نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا) فعلمت أن القسمة كانت من الله تعالى فى الأزل، فما حسدت أحدا ورضيت بقسمة الله تعالى .
الفائدة السادسة :
أنى رأيت الناس يعادى بعضهم بعضا لغرض وسبب ، فتأملت فى قوله تعالى : ( إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا) ، فعلمت أنه لا يجوز عداوة احد غير الشيطان .
الفائدة السابعة :
أنى رأيت كل أحد يسعى بجد ، ويجتهد بمبالغة لطلب القوت والمعاش، بحيث يقع فى شبهة وحرام ويذل نفسه وينقص قدره فتأملت فى قوله تعالى : ( وما من دابه فى الأرض إلا على الله رزقها) فعلمت أن رزقى على الله تعالى وقد ضمنه ، فاشتغلت بعبادته ، وقطعت طمعى عمن سواه .
الفائدة الثامنة :
أنى رأيت كل واحد معتمدا على شىء مخلوق ، بعضهم على الدينار والدرهم ، وبعضهم على المال والملك ، وبعضهم على الحرفة والصناعة ، وبعضهم على مخلوق مثله، فتأملت فى قوله تعالى : ( ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شىء قدرا) ، فتوكلت على الله تعالى فهو حسبى ونعم الوكيل. .
فقال شقيقي : وفقك الله تعالى إنى قد نظرت التوراة والانجيل والزبور والفرقان ، فوجدت الكتب الأربعة تدور على هذه الفوائد الثمانى ، فمن عمل بها كان عاملا بهذه الكتب الأربعة.
أيها الولد
قد علمت من هاتين الحكاتين أنك لا تحتاج إلى تكثير العلم .
إنى أنصحك بأشياء ، اقبلها منى لئلا يكون علمك خصمك يوم القيامة ، تعمل منها ، وتدع منها:
أما اللواتى تدع:
فأحدها: ألا تناظر أحدا فى مسألة ما استطعت لأن فيها آفات كثيرة ، فإثمها أكبر من نفعها. نعم لو وقع مسأله بينك وبين شخص أو قوم وكانت ارادتك فيها أن تظهر الحق ولا يضيع، جاز البحث، لكن لتلك الارادة علامتان:
إحداهما : ألا تفرق بين أن ينكشف الحق على لسانك أو على لسان غيرك. والثانية: أن يكون البحث فى الخلاء، أحب إليك من أن يكون فى الملأ.
والثانى مما تدع: وهو أن تحذر وتحترز من أن تكون واعظا ومذكرا ، لأن آفته كثيرة إلا أن تعمل بما تقول أولا، ثم تعظ به الناس فتفكر فيما قيل لعيسى عليه السلام: يا ابن مريم عظ نفسك ، فان اتعظت فعظ الناس، وإلا فاستح من الله.
والثالث مما تدع: أنه لا تخالط الأمراء والسلاطين ولا ترهم لأن رؤيتهم ومجالستهم ومخالطتهم آفه عظيمة، ولو ابتليت بها دع عنك مدحم وثنائهم، لأن الله تعالى يغضب إذا مدح الفاسق والظالم، ومن دعا لطول بقائهم فقد أحب أن يعصى الله فى أرضه.
والرابع مما تدع: ألا تقبل شيئا من عطايا الأمراء وهداياهم وأن علمت أنها من الحلال ، لأن الطمع منهم يفسد الدين لأنه يتولد منه المداهنة ، ومراعاة جانبهم والموافقة فى ظلمهم ، وهذا كله فساد فى الدين، وأقل مضرته أنك إذا قبلت عطاياهم ، وانتفعت من دنياهم أحببتهم ، ومن أحب أحدا يحب طول عمره ، وبقاءه بالضرورة، وفى محبة بقاء الظالم إرادة فى الظلم على عباد الله تعالى، وإرادة خراب العالم ، فأى شىء يكون أضر من هذا على الدين والعاقبة.
وأما الأمور التى ينبغى لك فعلها:
الأول: أن تجعل معاملتك مع الله تعالى، بحيث لو عامل معك بها عبدك ترضى بها منه، ولا يضيق خاطرك عليه ولا تغضب، والذى لا ترضى به لنفسك من عبدك المجازى فلا ترضى أيضا لله تعالى وهو سيدك الحقيقى.
الثانى: كلما عملت بالناس اجعله كما ترضى لنفسك منهم، لأنه لا يكمل إيمان عبد حتى يحب لسائر الناس ما يحب لنفسه.
الثالث: إذا قرأت العلم أو طالعته ، ينبغى أن يكون علمك علما يصلح قلبك ويزكى نفسك.
أيها الولد
الآن تفكر إلى ما أشرت به فإنك فهم، والكلام الفرد يكفى الكيس.
وأما الدعاء الذى سألت منى فاطلبه من دعوات الصحاح ، واقرا هذا الدعاء فى أوقاتك ، خصوصا فى أعقاب صلواتك:
اللهم إنى أسألك من النعمة تمامها ، ومن العصمة دوامها، ومن الرحمة شمولها، ومن العافية حصولها، ومن العيش أرغده، ومن العمر أسعده ومن الاحسان أتمه ، ومن الانعام أعمه، ومن الفضل أعذبه ، ومن اللطف أقربه. تصنيف: الغزالي
==============
الاقتصاد في الاعتقاد
الاقتصاد في الاعتقاد
أبو حامد الغزالي
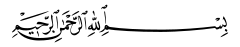
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اجتبى من صفوة عباده عصابة الحق وأهل السنة، وخصهم من بين سائر الفرق بمزايا اللطف والمنة، وأفاض عليهم من نور هدايته ما كشف به عن حقائق الدين، وأنطق ألسنتهم بحجته التي قمع بها ضلال الملحدين، وصفى سرائرهم من وساوس الشياطين، وطهر ضمائرهم عن نزغات الزائغين، وعمر أفئدتهم بأنوار اليقين حتى اهتدوا بها إلى أسرار ما أنزله على لسان نبيه وصفيه محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين، واطلعوا على طريق التلفيق بين مقتضيات الشرائع وموجبات العقول؛ وتحققوا أن لا معاندة بين الشرع المنقول والحق المعقول. وعرفوا أن من ظن من الحشوية وجوب الجمود على التقليد، واتباع الظواهر ما أتوا به إلا من ضعف العقول وقلة البصائر. وإن من تغلغل من الفلاسفة وغلاة المعتزلة في تصرف العقل حتى صادموا به قواطع الشرع، ما أتوا به إلا من خبث الضمائر. فميل أولئك إلى التفريط وميل هؤلاء إلى الافراط، وكلاهما بعيد عن الحزم والاحتياط. بل الواجب المحتوم في قواعد الاعتقاد ملازمة الاقتصاد والاعتماد على الصراط المستقيم؛ فكلا طرفي قصد الأمور ذميم. وأنى يستتب الرشاد لمن يقنع بتقليد
الأثر والخبر، وينكر مناهج البحث والنظر، أو لا يعلم انه لا مستند للشرع إلا قول سيد البشر صلى الله عليه وسلم، وبرهان العقل هو الذي عرف به صدقه فيما أخبر، وكيف يهتدي للصواب من اقتفى محض العقل واقتصر، وما استضاء بنور الشرع ولا استبصر؟ فليت شعري كيف يفزع إلى العقل من حيث يعتريه العي والحصر؟ أو لا يعلم ان العقل قاصر وأن مجاله ضيق منحصر؟ هيهات قد خاب على القطع والبتات وتعثر بأذيال الضلالات من لم يجمع بتأليف الشرع والعقل هذا الشتات. فمثال العقل البصر السليم عن الآفات والاذاء. ومثال القرآن الشمس المنتشرة الضياء. فاخلق بأن يكون طالب الاهتداء. المستغني إذا استغني بأحدهما عن الآخر في غمار الأغبياء، فالمعرض عن العقل مكتفياً بنور القرآن، مثاله المتعرض لنور الشمس مغمضاً للأجفان، فلا فرق بينه وبين العميان. فالعقل مع الشرع نور على نور، والملاحظ بالعين العور لأحدهما على الخصوص متدل بحبل غرور. وسيتضح لك أيها المشوق إلى الاطلاع على قواعد عقائد أهل السنة، المقترح تحقيقها بقواطع الأدلة، أنه لم يستأثر بالتوفيق للجمع بين الشرع والتحقيق فريق سوى هذا الفريق. فاشكر الله تعالى على إقتفائك لآثارهم وانخراطك في سلك نظامهم وعيارهم واختلاطك بفرقتهم؛ فعساك أن تحشر يوم القيامة في زمرتهم. نسأل الله تعالى أن يصفي أسرارنا عن كدورات الضلال، ويغمرها بنور الحقيقة، وأن يخرس ألسنتنا عن النطق بالباطل، وينطقها بالحق والحكمة إنه الكريم الفائض المنة الواسع الرحمة. باب ولنفتح الكلام ببيان اسم الكتاب، وتقسيم المقدمات والفصول والأبواب. أما اسم الكتاب فهو الاقتصاد في الاعتقاد. وأما ترتيبه فهو مشتمل على أربع تمهيدات تجري مجرى التوطئة والمقدمات، وعلى أربع أقطاب تجري مجرى المقاصد والغايات. التمهيد الأول: في بيان أن هذا العلم من المهمات في الدين. التمهيد الثاني: في بيان أنه ليس مهماً لجميع المسلمين بل لطائفة منهم مخصوصين. التمهيد الثالث: في بيان أنه من فروض الكفايات لا من فروض الأعيان. التمهيد الرابع: في تفصيل مناهج الأدلة التي أوردتها في هذا الكتاب. وأما الأقطاب المقصودة فأربعة وجملتها مقصورة على النظر في الله تعالى. فإنا إذا نظرنا في العالم لم ننظر فيه من حيث أنه عالم وجسم وسماء وأرض، بل من حيث
أنه صنع الله سبحانه. وإن نظرنا في النبي عليه السلام لم ننظر فيه من حيث أنه انسان وشريف وعالم وفاضل؛ بل من حيث أنه رسول الله. وان نظرنا في أقواله لم ننظر من حيث أنها أقوال ومخاطبات وتفهيمات؛ بل من حيث أنها تعريفات بواسطته من الله تعالى، فلا نظر إلا في الله ولا مطلوب سوى الله وجميع أطراف هذا العلم يحصرها النظر في ذات الله تعالى وفي صفاته سبحانه وفي أفعاله عز وجل وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاءنا على لسانه من تعريف الله تعالى. فهي إذن أربعة أقطاب: القطب الأول: النظر في ذات الله تعالى. فنبين فيه وجوده وانه قديم وأنه باق وأنه ليس بجوهر ولا جسم ولا عرض ولا محدود بحد ولا هو مخصوص بجهة، وأنه مرئي كما أنه معلوم وأنه واحد؛ فهذه عشرة دعاوى نبينها في هذا القطب. القطب الثاني: في صفات الله تعالى. ونبين فيه أنه حي عالم قادر مريد سميع بصير متكلم وأن له حياة وعلماً وقدرة وإرادة وسمعاً وبصراً وكلاماً، ونذكر أحكام هذه الصفات ولوازمها وما يفترق فيها وما يجتمع فيها من الأحكام، وأن هذه الصفات زائدة على الذات وقديمة وقائمة بالذات ولا يجوز أن يكون شيء من الصفات حادثاً. القطب الثالث: في أفعال الله تعالى. وفيه سبعة دعاوى وهو انه لا يجب على الله تعالى التكليف ولا الخلق ولا الثواب على التكليف ولا رعاية صلاح العباد ولا يستحيل منه تكليف ما لا يطاق ولا يجب عليه العقاب على المعاصي ولا يستحيل منه بعثه الأنبياء عليهم السلام؛ بل يجوز ذلك. وفي مقدمة هذا القطب بيان معنى الواجب والحسن والقبيح. القطب الرابع: في رسل الله، وما جاء على لسان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم من الحشر والنشر والجنة والنار والشفاعة وعذاب القبر والميزان والصراط، وفيه أربعة أبواب: الباب الأول: في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. الباب الثاني: فيما ورد على لسانه من أمور الآخرة. الباب الثالث: في الإمامة وشروطها. الباب الرابع: في بيان القانون في تكفير الفرق المبتدعة.
التمهيد الأول في بيان أن الخوض في هذا العلم مهم في الدين اعلم أن صرف الهمة إلى ما ليس بمهم، وتضييع الزمان بما عنه بد هو غاية الضلال ونهاية الخسران سواء كان المنصرف إليه بالهمة من العلوم أو من الأعمال، فنعوذ بالله من علم لا ينفع. وأهم الأمور لكافة الخلق نيل السعادة الأبدية واجتناب الشقاوة الدائمة، وقد ورد الأنبياء وأخبروا الخلق بأن لله تعالى على عباده حقوقاً ووظائف في أفعالهم وأقوالهم وعقائدهم. وأن من لم ينطق بالصدق لسانه ولم ينطو على الحق ضميره ولم تتزين بالعدل جوارحه فمصيره إلى النار وعاقبته للبوار. ثم لم يقتصروا على مجرد الإخبار بل استشهدوا على صدقهم بأمور غريبة وأفعال عجيبة خارقة للعادات خارجة عن مقدورات البشر، فمن شاهدها أو سمع أحوالها بالأخبار المتواترة سبق إلى عقله إمكان صدقهم، بل غلب على ظنه ذلك بأول السماع قبل أن يمعن النظر في تمييز المعجزات عن عجائب الصناعات. وهذا الظن البديهي أو التجويز الضروري ينزع الطمأنينة عن القلب ويحشوه بالاستشعار والخوف ويهيجه للبحث والافتكار ويسلب عنه الدعة والقرار ويحذره مغبة التساهل والإهمال ويقرر عنده أن الموت آت لا محالة وأن ما بعد الموت منطو عن أبصار الخلق وأن ما أخبر به هؤلاء غير خارج عن حيز الإمكان. فالحزم ترك التواني في الكشف عن حقيقة هذا الأمر. فما هؤلاء مع العجائب التي أظهروها في إمكان صدقهم قبل البحث عن تحقيق قولهم بأقل من شخص واحد يخبرنا عن خروجنا من دارنا ومحل استقرارنا بأن سبعاً من السباع قد دخل الدار فخذ حذرك واحترز منه لنفسك جهدك، فإنا بمجرد السماع إذا رأينا ما أخبرنا عنه في محل الامكان والجواز لم نقدم على الدخول وبالغنا في الاحتراز فالموت هو المستقر والوطن قطعاً، فكيف لا يكون الاحتراز لما بعده مهماً؟ فإذن أهم الممات أن نبحث عن قوله الذي قضى الذهن في بادئ الرأي وسابق النظر بامكانه أهو محال في نفسه على التحقيق أو هو حق لا شك فيه؟ فمن
قوله ان لكم رباً كلفكم حقوقاً وهو يعاقبكم على تركها ويثيبكم على فعلها وقد بعثني رسولاً إليكم لأبين ذلك لكم، فيلزمنا لا محالة أن نعرف أن لنا رباً أم لا. وإن كان فهل يمكن أن يكون حياً متكلماً حتى يأمر وينهى ويكلف ويبعث الرسل، وإن كان متكلماً فهل هو قادر على أن يعاقب ويثيب إذا عصيناه أو أطعناه، وإن كان قادراً فهل هذا الشخص بعينه صادق في قوله أنا الرسول إليكم. فإن اتضح لنا ذلك لزمنا لا محالة، إن كنا عقلاء، أن نأخذ حذرنا وننظر لأنفسنا ونستحقر هذه الدنيا المنقرضة بالاضافة إلى الآخرة الباقية فالعاقل من ينظر لعاقبته ولا يغتر بعاجلته. ومقصود هذا العلم إقامة البرهان على وجود الرب تعالى وصفاته وأفعاله وصدق الرسل كما فصلناه في الفهرست. وكل ذلك مهم لا محيص عنه لعاقل. فإن قلت اني لست منكراً هذا الانبعاث للطلب من نفسي ولكني لست أدري أنه ثمرة الجبلة والطبع وهو مقتضى العقل أو هو موجب الشرع إذ للناس كلام في مدارك الوجوب؛ فهذا انما تعرفه في آخر الكتاب عند تعرضنا لمدارك الوجوب. والاشتغال به الآن فضول بل لا سبيل بعد وقوع الانبعاث إلى الانتهاض لطلب الخلاص. فمثال الملتفت إلى ذلك مثال رجل لدغته حية أو عقرب وهي معاودة اللدغ والرجل قادر على الفرار ولكنه متوقف ليعرف ان الحية جاءته من جانب اليمين أو من جانب اليسار، وذلك من أفعال الأغبياء الجهال نعوذ بالله من الاشتغال بالفضول مع تضييع المهمات والأصول.
التمهيد الثاني في بيان الخوض في هذا العلم وإن كان مهماً فهو في حق بعض الخلق ليس بمهم بل المهم لهم تركه إعلم أن الأدلة التي نحررها في هذا العلم تجري مجرى الأدوية التي يعالج بها مرض القلوب. والطبيب المستعمل لها إن لم يكن حاذقاً ثاقب العقل رصين الرأي كان ما يفسده بدوائه أكثر مما يصلحه. فليعلم المحصل لمضمون هذا الكتاب والمستفيد لهذه العلوم أن الناس أربع فرق: الفرقة الأولى: آمنت بالله وصدقت رسوله واعتقدت الحق وأضمرته واشتغلت إما بعبادة وإما بصناعة؛ فهؤلاء ينبغي أن يتركوا وما هم عليه ولا تحرك عقائدهم بالاستحثاث على تعلم هذا العلم، فإن صاحب الشرع صلوات الله عليه لم يطالب العرب في مخاطبته إياهم بأكثر من التصديق ولم يفرق بين أن يكون ذلك بإيمان وعقد تقليدي أو بيقين برهاني. وهذا مما علم ضرورة من مجاري أحواله في تزكيته إيمان من سبق من أجلاف العرب إلى تصديقه ببحث وبرهان؛ بل بمجرد قرينة ومخيلة سبقت إلى قلوبهم فقادتها إلى الإذعان للحق والانقياد للصدق فهؤلاء مؤمنون حقاً فلا ينبغي أن تشوش عليهم عقائدهم، فإنه إذا تليت عليهم هذه البراهين وما عليها من الاشكالات وحلها لم يؤمن أن تعلق بأفهامهم مشكلة من المشكلات وتستولي عليها ولا تمحى عنها بما يذكر من طرق الحل. ولهذا لم ينقل عن الصحابة الخوض في هذا الفن لا بمباحثة ولا بتدريس ولا تصنيف، بل كان شغلهم بالعبادة والدعوة إليها وحمل الخلق على مراشدهم ومصالحهم في أحوالهم وأعمالهم ومعاشهم فقط. الفرقة الثانية: طائفة مالت عن اعتقاد الحق كالكفرة والمبتدعة. فالجافي الغليظ منهم الضعيف العقل الجامد على التقليد الممتري على الباطل من مبتدأ النشوء إلى كبر السن لا ينفع معه إلا السوط والسيف. فأكثر الكفرة أسلموا تحت ظلال السيوف إذ يفعل الله بالسيف والسنان ما لا يفعل بالبرهان واللسان. وعن هذا إذا استقرأت تواريخ الأخبار لم تصادف ملحمة بين المسلمين والكفار إلا انكشفت عن جماعة من أهل الضلال مالوا إلى الانقياد، ولم تصادف مجمع مناظرة ومجادلة انكشفت إلا عن زيادة إصرار وعناد. ولا تظنن أن هذا الذي ذكرناه غض من منصب العقل وبرهانه
ولكن نور العقل كرامة لا يخص الله بها إلا الآحاد من أوليائه، والغالب على الخلق القصور والاهمال، فهم لقصورهم لا يدركون براهين العقول كما لا تدرك نور الشمس أبصار الخفافيش. فهؤلاء تضر بهم العلوم كما تضر رياح الورد بالجعل. وفي مثل هؤلاء قال الامام الشافعي رحمه الله: فمن منح الجهال علماً أضاعه ... ومن منع المستوجبين فقد ظلم الفرقة الثالثة: طائفة اعتقدوا الحق تقليداً وسماعاً ولكن خصوا في الفطرة بذكاء وفطنة فتنبهوا من أنفسهم لإشكالات تشككهم في عقائدهم وزلزلت عليهم طمأنينتهم، أو قرع سمعهم شبهة من الشبهات وحاكت في صدورهم. فهؤلاء يجب التلطف بهم في معالجتهم باعادة طمأنينتهم وإماطة شكوكهم بما أمكن من الكلام المقنع المقبول عندهم ولو بمجرد إستبعاد وتقبيح أو تلاوة آية أو رواية حديث أو نقل كلام من شخص مشهور عندهم بالفضل. فإذا زال شكه بذلك القدر فلا ينبغي أن يشافه بالأدلة المحررة على مراسم الجدال، فإن ذلك ربما يفتح عليه أبواباً أخر من الإشكالات. فإن كان ذكياً فطناً لم يقنعه إلا كلام يسير على محك التحقيق. فعند ذلك يجوز أن يشافه بالدليل الحقيقي وذلك على حسب الحاجة وفي موضع الاشكال على الخصوص. الفرقة الرابعة: طائفة من أهل الضلال يتفرس فيهم مخائل الذكاء والفطنة ويتوقع منهم قبول الحق بما اعتراهم في عقائدهم من الريبة أو بما يلين قلوبهم لقبول التشكيك بالجبلة والفطرة. فهؤلاء يجب التلطف بهم في استمالتهم إلى الحق وإرشادهم إلى الاعتقاد الصحيح لا في معرض المحاجة والتعصب، فإن ذلك يزيد في دواعي الضلال ويهيج بواعث التمادي والإصرار. وأكثر الجهالات إنما رسخت في قلوب العوام بتعصب جماعة من جهال أهل الحق أظهروا الحق في معرض التحري والادلاء، ونظروا إلى ضعفاء الخصوم بعين التحقير والإزراء. فثارت من بواطنهم دواعي المعاندة والمخالفة ورسخت في نفوسهم الاعتقادات الباطلة وعسر على العلماء المتلطفين محوها مع ظهور فسادها، حتى انتهى التعصب بطائفة إلى أن اعتقدوا أن الحروف التي نظروا بها في الحال بعد السكوت عنها طول العمر قديمة. ولولا استيلاء الشيطان بواسطة العناد والتعصب للأهواء لما وجد مثل هذا الاعتقاد مستقراً في قلب مجنون فضلاً عمن له قلب عاقل. والمجادلة والمعاندة داء محض لا دواء له، فليتحرز المتدين منه جهده وليترك الحقد والضغينة وينظر إلى كافة خلق الله بعين الرحمة، وليستعن بالرفق واللطف في ارشاد من ضل من هذه الأمة، وليتحفظ من النكد الذي يحرك داعية الضلال، وليتحقق أن مهيج داعية الاصرار بالعناد والتعصب معين على الاصرار على البدعة ومطالب بعهده اعانته في القيامة.
التمهيد الثالث في بيان الاشتغال بهذا العلم من فروض الكفايات إعلم أن التبحر في هذا العلم والاشتغال بمجامعه ليس من فروض الأعيان وهو من فروض الكفايات. فأما أنه ليس من فروض الأعيان فقد إتضح لك برهانه في التمهيد الثاني. إذ تبين أنه ليس يجب على كافة الخلق إلا التصديق الجزم وتطهير القلب عن الريب والشك في الإيمان. وإنما تصير إزالة الشك فرض عين في حق من اعتراه الشك. فإن قلت فلم صار من فروض الكفايات وقد ذكرت أن أكثر الفرق يضرهم ذلك ولا ينفعهم؟ فاعلم أنه قد سبق أن ازالة الشكوك في أصول العقائد واجبة، واعتوار الشك غير مستحيل وإن كان لا يقع إلا في الأقل، ثم الدعوة إلى الحق بالبرهان مهمة في الدين. ثم لا يبعد أن يثور مبتدع ويتصدى لإغواء أهل الحق بإفاضة الشبهة فيهم فلا بد ممن يقاوم شبهته بالكشف ويعارض إغواءه بالتقبيح، ولا يمكن ذلك إلا بهذا العلم. ولا تنفك البلاد عن أمثال هذه الوقائع، فوجب أن يكون في كل قطر من الأقطار وصقع من الأصقاع قائم بالحق مشتغل بهذا العلم يقاوم دعاة المبتدعة ويستميل المائلين عن الحق ويصفي قلوب أهل السنة عن عوارض الشبهة. فلو خلا عنه القطر خرج به أهل القطر كافة، كما لو خلا عن الطبيب والفقيه. نعم من أنس من نفسه تعلم الفقه أو الكلام وخلا الصقع عن القائم بهما ولم يتسع زمانه للجمع بينهما واستفتي
في تعيين ما يشتغل به منهما؛ أوجبنا عليه الاشتغال بالفقه فإن الحاجة إليه أعم والوقائع فيه أكثر فلا يستغني أحد في ليله ونهاره عن الاستعانة بالفقه. واعتوار الشكوك المحوجة إلى علم الكلام باد بالإضافة إليه كما أنه لو خلا البلد عن الطبيب والفقيه كان التشاغل بالفقه أهم؛ لأنه يشترك في الحاجة إليه الجماهير والدهماء. فأما الطب فلا يحتاج إليه الأصحاء، والمرضى أقل عدداً بالإضافة إليهم. ثم المريض لا يستغني عن الفقه كما لا يستغني عن الطب وحاجته إلى الطب لحياته الفانية وإلى الفقه لحياته الباقية وشتان بين الحالتين. فإذا نسبت ثمرة الطب إلى ثمرة الفقه علمت ما بين الثمرتين. ويدلك على أن الفقه أهم العلوم اشتغال الصحابة رضي الله عنهم بالبحث عنه في مشاورتهم ومفاوضاتهم. ولا يغرنك ما يهول به من يعظم صناعة الكلام من أنه الأصل والفقه فرع له فإنها كلمة حق ولكنها غير نافعة في هذا المقام، فإن الأصل هو الاعتقاد الصحيح والتصديق الجزم وذلك حاصل بالتقليد والحاجة إلى البرهان ودقائق الجدل نادرة. والطبيب أيضاً قد يلبس فيقول وجودك ثم وجودك ثم وجود بدنك موقوف على صناعتي وحياتك منوطة بي فالحياة والصحة أولاً ثم الاشتغال بالدين ثانياً. ولكن لا يخفى ما تحت هذا الكلام من التمويه وقد نبهنا عليه.
التمهيد الرابع في بيان مناهج الأدلة التي انتهجناها في هذا الكتاب إعلم أن مناهج الأدلة متشعبة وقد أوردنا بعضها في كتاب محك النظر وأشبعنا القول فيها في كتاب معيار العلم. ولكنا في هذا الكتاب نحترز عن الطرق المتغلقة والمسالك الغامضة قصداً للايضاح وميلاً إلى الإيجاز واجتناباً للتطويل. ونقتصر على ثلاثة مناهج: المنهج الأول: السبر والتقسيم وهو ان نحصر الأمر في قسمين ثم يبطل أحدهما فيلزم منه ثبوت الثاني. كقولنا: العالم إما حادث وإما قديم، ومحال أن يكون قديماً فيلزم منه لا محالة أن يكون حادثاً أنه حادث وهذا اللازم هو مطلوبنا وهو علم مقصود إستفدناه من علمين آخرين أحدهما قولنا: العالم إما قديم أو حادث فإن الحكم بهذا الانحصار علم. والثاني: قولنا ومحال أن يكون قديماً فإن هذا علم آخر. والثالث: هو اللازم منهما وهو المطلوب بأنه حادث. وكل علم مطلوب، فلا يمكن أن يستفاد الا من علمين هما أصلان ولا كل أصلين، بل إذا وقع بينهما إزدواج على وجه مخصوص وشرط مخصوص، فإذا وقع الازدواج على شرطه أفاد علماً ثالثاً وهو المطلوب، وهذا الثالث قد نسميه دعوى إذا كان لنا خصم، ونسميه مطلوباً إذا كان لم يكن لنا خصم، لأنه مطلب الناظر ونسميه فائدة وفرعاً بالاضافة إلى
الأصلين فإنه مستفاد منهما. ومهما أقر الخصم بالأصلين يلزمه لا محالة الاقرار بالفرع المستفاد منهما وهو صحة الدعوى. المنهج الثاني: أن نرتب أصلين على وجه آخر مثل قولنا: كل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث وهو أصل، والعالم لا يخلو عن الحوادث فهو أصل آخر، فيلزم منهما صحة دعوانا وهو أن العالم حادث وهو المطلوب فتأمل. هل يتصور أن يقر الخصم بالأصلين ثم يمكنه إنكار صحة الدعوى فتعلم قطعاً أن ذلك محال. المنهج الثالث: أن لا نتعرض لثبوت دعوانا، بل ندعي إستحالة دعوى الخصم بأن نبين أنه مفض إلى المحال وما يفضي إلى المحال فهو محال لا محالة. مثاله: قولنا إن صح قول الخصم أن دورات الفلك لا نهاية لها لزم منه صحة قول القائل أن ما لا نهاية له قد انقضى وفرغ منه، ومعلوم أن هذا اللازم محال فيعلم منه لا محالة أن المفضي إليه محال وهو مذهب الخصم. فههنا أصلان: أحدهما قولنا إن كانت دورات الفلك لا نهاية لها فقد انقضى ما لا نهاية له، فإن الحكم بلزوم إنقضاء ما لا نهاية له - على القول بنفي النهاية عن دورات الفلك - علم ندعيه ونحكم به. ولكن يتصور فيه من الخصم إقراراً وإنكار بأن يقول: لا أسلم أنه يلزم ذلك. والثاني قولنا إن هذا اللازم محال فإنه أيضاً أصل يتصور فيه إنكار بأن يقول: سلمت الأصل الأول ولكن لا أسلم هذا الثاني وهو إستحالة إنقضاء ما لا نهاية له، ولكن لو أقر بالأصلين كان الاقرار بالمعلوم الثالث اللازم منهما واجباً بالضرورة؛ وهو الاقرار باستحالة مذهبه المفضي إلى هذا المحال. فهذه ثلاث مناهج في الاستدلال جلية لا يتصور إنكار حصول العلم منها، والعلم الحاصل هو المطلوب والمدلول، وازدواج الأصلين الملتزمين لهذا العلم هو الدليل. والعلم بوجه لزوم هذا المطلوب من ازدواج الأصلين علم بوجه دلالة الدليل، وفكرك الذي هو عبارة عن إحضارك الأصلين في الذهن وطلبك التفطن لوجه لزوم العلم الثالث من العلمين الأصلين هو النظر؛ فإذن عليك في درك العلم المطلوب وظيفتان؛ إحداهما: إحضار الأصلين في الذهن وهذا يسمى فكراً، والآخر: تشوقك إلى التفطن لوجه لزوم المطلوب من ازدواج الأصلين وهذا يسمى طلباً. فلذلك قال من جرد التفاته إلى الوظيفة الأولى حيث أراد حد النظر أنه الفكر. وقال من جرد التفاته إلى الوظيفة الثانية في حد النظر أنه طلب علم أو غلبة ظن. وقال من التفت إلى الأمرين جميعاً أنه الفكر الذي يطلب به من قام به علماً أو غلبة ظن.
فهكذا ينبغي أن تفهم الدليل والمدلول ووجه الدلالة وحقيقة النظر ودع عنك ما سودت به أوراق كثيرة من تطويلات وترديد عبارات لا تشفي غليل طالب ولا تسكن نهمة متعطش ولن يعرف قدر هذه الكلمات الوجيزة إلا من انصرف خائباً عن مقصده بعد مطالعة تصانيف كثيرة. فإن رجعت الآن في طلب الصحيح إلى ما قيل في حد النظر دل ذلك على انك تخص من هذا الكلام بطائل ولن ترجع منه إلى حاصل، فإنك إذا عرفت أنه ليس ههنا إلا علوم ثلاثة: علمان هما أصلان يترتبان ترتباً مخصوصاً، وعلم ثالث يلزم منهما وليس عليك فيه الا وظيفتان: إحداهما إحضار العلمين في ذهنك، والثانية التفطن لوجه العلم الثالث منهما. والخيرة بعد ذلك اليك في اطلاق لفظ النظر في ان تعبر به عن الفكر الذي هو احضار العلمين، أو عن التشوف الذي هو طلب التفطن لوجه لزوم العلم الثالث، أو عن الأمرين جميعاً، فإن العبارات مباحة والاصطلاحات لا مشاحة فيها. فان قلت غرضي أن أعرف اصطلاح المتكلمين وأنهم عبروا بالنظر عماذا، فاعلم أنك إذا سمعت واحداً يجد النظر بالفكر، وآخر بالطلب، وآخر بالفكر الذي هو يطلب به، لم تسترب في اختلاف اصطلاحاتهم على ثلاثة أوجه. والعجب ممن لا يتفطن هذا ويفرض الكلام في حد النظر. مسألة خلافية: ويستدل بصحة واحد من الحدود وليس يدري أن حظ المعنى المعقول من هذه الأمور لا خلاف فيه وأن الأصطلاح لا معنى للخلاف فيه. وإذا أنت امعنت النظر واهتديت السبيل عرفت قطعاً أن أكثر الأغاليط نشأت من ضلال من طلب المعاني من الألفاظ، ولقد كان من حقه أن يقدر المعاني أولاً ثم ينظر في الألفاظ ثانياً، ويعلم أنها اصطلاحات لا تتغير بها المعقولات. ولكن من حرم التوفيق استدبر الطريق، ونكل عن التحقيق. فإن قلت: إني لا استريب في لزوم صحة الدعوى من هذين الأصلين إذا أقر الخصم بهما على هذا الوجه، ولكن من أين يجب على الخصم الاقرار بهما ومن أين تقتضي هذه الأحوال المسلمة الواجبة التسليم؟ فاعلم أن لها مدارك شتى ولكن الذي نستعمله في هذا الكتاب نجتهد أن لا يعد ستة: الأول منها: الحسيات، أعني المدرك بالمشاهدة الظاهرة والباطنة، مثاله أنا إذا قلنا مثلاً كل حادث فله سبب، وفي العالم حوادث فلا بد لها من سبب. فقولنا: في العالم حوادث، أصل واحد يجب الإقرار به، فإنه يدرك بالمشاهدة الظاهرة حدوث أشخاص الحيوانات والنباتات والغيوم والامطار ومن الأعراض والأصوات
والألوان. وان تخيل أنها منتقلة، فالانتقال حادث ونحن لم ندع إلا حادثاً ولم نعين أن ذلك الحادث جوهر أو عرض أو انتقال أو غيره. وكذلك يعلم بالمشاهدة الباطنة حدوث الآلام والافراح والغموم في قلبه فلا يمكنه انكاره. الثاني: العقل المحض، فإنا إذا قلنا: العالم أما قديم مؤخر، وإما حادث مقدم، وليس وراء القسمين قسم ثالث، وجب الاعتراف به على كل عاقل. مثاله أن
تقول: كل ما لا يسبق الحوادث فهو حادث، والعالم لا يسبق الحوادث فهو حادث، فأحد الأصلين قولنا أن ما لا يسبق الحوادث فهو حادث. ويجب على الخصم الإقرار به، لأن ما لا يسبق الحادث إما أن يكون مع الحادث أو بعده ولا يمكن قسم ثالث، فإن ادعى قسماً ثالثاً كان منكراً لما هو بديهي في العقل، وإن انكر أن ما هو مع الحادث أو بعده ليس بحادث فهو أيضاً منكر للبديهة. الثالث: التواتر، مثاله أنا نقول محمد صلوات الله وسلامه عليه صادق لأن كل من جاء بالمعجزة فهو صادق، وقد جاء هو بالمعجزة فهو إذاً صادق، فإن قيل أنا لا نسلم أنه جاء بالمعجزة فنقول: قد جاءنا بالقرآن والقرآن معجزة، فإذاً قد جاء بالمعجزة. فإن سلم الخصم أحد الأصلين وهو أن القرآن معجزة، أما بالطوع أو بالدليل، وأراد إنكار الأصل الثاني وهو أنه قد جاء بالقرآن، وقال لا أسلم أن القرآن مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم تسليماً، لم يمكنه ذلك لأن التواتر يحصل العلم به كما حصل لنا العلم بوجوده وبدعواه النبوة وبوجود مكة ووجود موسى وعيسى وسائر الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. الرابع: أن يكون الأصل مثبتاً بقياس آخر يستند بدرجة واحدة أو درجات كثيرة إما إلى الحسيات أو العقليات أو المتواترات، فإن ما هو فرع الأصلين يمكن أن يجعل أصلاً في قياس آخر. مثاله أنا بعد أن نفرغ من الدليل على حدوث العالم يمكننا أن نجعل حدوث العالم أصلاً في نظم قياس، مثلاً أن نقول كل حادث فله سبب والعالم حادث فإذا له سبب، فلا يمكنهم انكار كون العالم حادثاً بعد أن اثبتنا بالدليل حدوثه. الخامس: السمعيات، مثاله انا ندعي مثلاً ان المعاصي بمشيئة الله تعالى، ونقول كل كائن فهو بمشيئة الله تعالى والمعاصي كائنة فهي إذاً بمشيئة الله تعالى؛ فأما قولنا هي كائنة فمعلوم وجودها بالحس، وكونها معصية بالشرع، وأما قولنا كل كائن بمشيئة الله تعالى فإذا أنكر الخصم ذلك منعه الشرع مهما كان مقراً بالشرع
أو كان قد أثبت عليه بالدليل فإنا نثبت هذا الأصل بإجماع الأمة على صدق قول القائل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فيكون السمع مانعاً من الانكار. السادس: أن يكون الأصل مأخوذاً من معتقدات الخصم ومسلماته. فإنه وإن لم يقم لنا عليه دليل أو لم يكن حسياً ولا عقلياً، انتفعنا باتخاذه إياه أصلاً في قياسنا وامتنع عليه الإنكار الهادم لمذهبه. وأمثلة هذا مما تكثر فلا حاجة إلى تعيينه. فإن قلت: فهل من فرق بين هذه المدارك في الانتفاع بها في المقاييس النظرية؟ فاعلم أنها متفاوتة في عموم الفائدة، فإن المدارك العقلية والحسية عامة مع كافة الخلق إلا من لا عقل له ولا حس له وكان الأصل معلوماً فالحس الذي فقده كالأصل المعلوم بحاسة البصر إذا استعمل مع الأكمه فإنه لا ينفع، والأكمه إذا كان هو الناظر لم يمكنه أن يتخذ ذلك أصلاً، وكذلك المسموع في حق الأصم. وأما المتواتر فإنه نافع ولكن في حق من تواتر إليه، فأما من لم يتواتر إليه ممن وصل إلينا في الحال من مان بعيد لم تبلغه الدعوة فأردنا أن نبين له بالتواتر أن نبينا وسيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم تسليماً وعلى آله وصحبه تحدى بالقرآن، لم يقدر عليه ما لم يمهله مدة من يتواتر عنده، ورب شيء يتواتر عند قوم دون قوم، فقول الشافعي رحمه الله تعالى في مسألة قتل المسلم بالذمي متواتر عند الفقهاء من أصحابه دون العوام من المقلدين وكم من مذهب له في أحاد المسائل لم يتواتر عند أكثر الفقهاء وأما الأصل المستفاد من قياس آخر فلا ينفع إلا مع من قدر معه ذلك القياس. وأما مسلمات المذاهب فلا تنفع الناظر وإنما تنفع المناظر مع من يعتقد ذلك المذهب. وأما السمعيات فلا تنفع إلا من يثبت السمع عنه، فهذه مدارك علوم هذه الأصول المفيدة بترتيبها ونظمها العلم بالأمور المجهولة المطلوبة وقد فرغنا من التمهيدات فلنشتغل بالأقطاب التي هي مقاصد الكتاب.
القطب الأول في النظر في ذات الله تعالى وفيه عشر دعاوى الدعوى الأولى: وجوده تعالى وتقدس، برهانه أنا نقول كل حادث فلحدوثه سبب، والعالم حادث فيلزم منه إن له سبباً، ونعني بالعالم كل موجود سوى الله تعالى. ونعني بكل موجود سوى الله تعالى الأجسام كلها وأعراضها، وشرح ذلك بالتفصيل أنا لا نشك في أصل الوجود، ثم نعلم أن كل موجود اما متحيزاً أو غير متحيز، وأن كل متحيز إن لم يكن فيه ائتلاف فنسميه جوهراً فرداً، وإن ائتلف إلى غيره سميناه جسماً، وإن غير المتحيز أما أن يستدعي وجوده جسماً يقوم به ونسميه الأعراض، أو لا يستدعيه وهو الله سبحانه وتعالى، فأما ثبوت الأجسام وأعراضها، فمعلوم بالمشاهدة، ولا يلتفت إلى من ينازع في الأعراض وإن طال فيها صياحه وأخذ يلتمس منك دليلاً عليه، فإن شغبه ونزاعه والتماسه وصياحه، وإن لم يكن موجوداً فكيف نشتغل بالجواب عنه والإصغاء إليه، وإن كان موجوداً فهو لا محالة غير جسم المنازع إذ كان جسماً موجوداً من قبل، ولم يكن التنازع موجوداً فقد عرفت أن الجسم والعرض مدركان بالمشاهدة. فإما موجود ليس
بجسم ولا جوهر متحيز ولا عرض فيه فلا يدرك بالحس ونحن ندعي وجوده وندعي أن العالم موجود به، وبقدرته، وهذا يدرك بالدليل لا بالحس، والدليل ما ذكرناه، فلنرجع إلى تحقيقه. فقد جمعنا فيه أصلين فلعل الخصم ينكرهما، فنقول له: في أي الأصلين تنازع؟ فإن قال إنما أنازع في قولك إن كل حادث فله سبب فمن أين عرفت هذا، فنقول: إن هذا الأصل يجب الاقرار به، فإنه أولي ضروري في العقل، ومن يتوقف فيه فإنما يتوقف لأنه ربما لا ينكشف له ما نريده بلفظ الحادث، ولفظ السبب، وإذا فهمهما صدق عقله بالضرورة بأن لكل حادث سبباً، فانا نعني بالحادث ما كان معدوماً ثم صار موجوداً فنقول وجوده قبل أن وجد كان محالاً أو ممكناً، وباطل أن يكون محالاً لأن المحال لا يوجد قط، وإن كان ممكناً فلسنا نعني بالممكن إلا ما يجوز أن يوجد ويجوز أن لا يوجد ولكن لم يكن موجوداً لأنه ليس يجب وجوده لذاته إذ لو وجد وجوده لذاته لكان واجباً لا ممكناً، بل قد افتقر وجوده إلى مرجح لوجوده على العدم حتى يتبدل العدم بالوجود. فإذا كان استمرار عدمه من حيث أنه لا مرجح للوجود على العدم، فمن لم يوجد المرجح لا يوجد الوجود، ونحن لا نريد بالسبب إلا المرجح: والحاصل أن المعدوم المستمر العدم لا يتبدل عدمه بالوجود ما لم يتحقق أمر من الأمور يرجح جانب الوجود على استمرار العدم، وهذا إذا حصل في الذهن معنى لفظه كان العقل مضطراً إلى التصديق به. فهذا بيان اثبات هذا الأصل وهو على التحقيق شرح للفظ الحادث والسبب لاقامة دليل عليه. فإن قيل لم تنكرون على من ينازع في الأصل الثاني، وهو قولكم أن العالم حادث، فنقول: إن هذا الأصل ليس بأولي في العقل، بل نثبته ببرهان منظوم من أصلين آخرين هو أنا نقول إذ قلنا أن العالم حادث أردنا بالعالم الآن، الأجسام والجواهر فقط، فنقول كل جسم فلا يخلو عن الحوادث وكل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث، فيلزم منه أن كل جسم فهو حادث ففي أي الأصلين النزاع؟ فإن قيل لم قيل أن كل جسم أو متحيز فلا يخلو عن الحوادث؟ قلنا: لأنه لا يخلو عن الحركة والسكون وهما حادثان، فإن قيل: ادعيتم وجودهما ثم حدوثهما، فلا نسلم الوجود ولا الحدوث،
قلنا هذا سؤال قد طال الجواب عنه في تصانيف الكلام، وليس يستحق هذا التطويل فإنه لا يصدر قط من مسترشد إذ لا يستريب عاقل قط في ثبوت الأعراض في ذاته من الآلام والأسقام والجوع والعطش وسائر الأحوال، ولا في حدوثها. وكذلك إذا نظرنا إلى أجسام العالم لم نسترب في تبدل الأحوال عليها، وإن تلك التبديلات حادثة، وإن صدر من خصم معاند فلا معنى للاشتغال به، وإن فرض فيه خصم معتقد لما نقوله فهو فرض محال إن كان الخصم عاقلاً، بل الخصم في حدوث العالم الفلاسفة وهم مصرحون بأن أجسام العالم تنقسم إلى السموات، وهي متحركة على الدوام، وآحاد حركاتها حادثة ولكنها دائمة متلاحقة على الاتصال أزلاً وأبداً وإلى العناصر الأربعة التي يحويها مقعر فلك القمر، وهي مشتركة في مادة حاملة لصورها وأعراضها وتلك المادة قديمة والصور والأعراض حادثة متعاقبة عليها أزلاً وأبداً وإن الماء ينقلب بالحرارة هواء، والهواء يستحيل بالحرارة ناراً، وهكذا بقية العناصر، وإنها تمتزج امتزاجات حادثة فتتكون منهما المعادن والنبات والحيوان، فلا تنفك العناصر عن هذه الصور الحادثة ولا تنفك السموات عن الحركات الحادثة أبداً، وإنما ينازعون في قولنا أن ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث، فلا معنى للإطناب في هذا الأصل، ولكنا لإقامة الرسم نقول: الجوهر بالضرورة لا يخلو عن الحركة والسكون، وهما حادثان. أما الحركة فحدوثها محسوس وإن فرض جوهر ساكن كالأرض، ففرض حركته ليس بمحال بل نعلم جوازه بالضرورة، وإذا وقع ذلك الجائز كان حادثاً وكان معدماً للسكون، فيكون السكون أيضاً قبله حادثاً لأن القديم لا ينعدم كما سنذكره في إقامة الدليل على بقاء الله تعالى، وإن أردنا سياق دليل على وجود الحركة زائدة على الجسم، قلنا: إنا إذا قلنا هذا الجوهر متحرك أثبتنا شيئاً سوى الجوهر متحرك أثبتنا شيئاً سوى الجوهر بدليل أنا إذا قلنا هذا الجوهر ليس بمتحرك، صدق قولنا وإن كان الجوهر باقياً ساكناً، فلو كان المفهوم من الحركة عين الجوهر لكان نفيها نفي عين الجوهر. وهكذا يطرد الدليل في إثبات السكون ونفيه، وعلى الجملة. فتكلف الدليل على الواضحات يزيدها غموضاً ولا يفيدها وضوحاً. فإن قيل: فبم عرفتم أنها حادثة فلعلها كانت كامنة فظهرت، قلنا: لو كنا نشتغل في هذا الكتاب بالفضول الخارج عن المقصود لأبطلنا القول بالكمون والظهور في الأعراض رأساً، ولكن ما لا يبطل مقصودنا فلا نشتغل به، بل نقول: الجوهر لا يخلو عن كمون الحركة فيه أو ظهورها، وهما حادثان فقد ثبت أنه لا يخلو عن الحوادث.
فإن قيل: فلعلها انتقلت إليه من موضع آخر، فبم يعرف بطلان القول، بانتقال الأعراض؟ قلنا: قد ذكر في إبطال ذلك أدلة ضعيفة لا نطول الكتاب بنقلها ونقضها، ولكن الصحيح في الكشف عن بطلانه أن نبين أن تجويز ذلك لا يتسع له عقل من لم يذهل عن فهم حقيقة العرض وحقيقة الانتقال، ومن فهم حقيقة العرض تحقق استحالة الانتقال فيه. وبيانه أن الانتقال عبارة أخذت من انتقال الجوهر من حيز إلى حيز، وذلك يثبت في العقل بأن فهم الجوهر وفهم الحيز وفهم اختصاص الجوهر بالحيز زائد على ذات الجوهر، ثم علم أن العرض لا بد له من محل كما لا بد للجوهر من حيز، فتتخيل أن إضافة العرض إلى المحل كإضافة الجوهر إلى الحيز فيسبق منه إلى الوهم إمكان الانتقال عنه، كما في الجوهر، ولو كانت هذه المقايسة صحيحة لكان اختصاص العرض بالمحل كوناً زائداً على ذات العرض والمحل كما كان اختصاص الجوهر بالحيز كوناً زائداً على ذات الجوهر والحيز، ولصار يقوم بالعرض عرض، ثم يفتقر قيام العرض بالعرض إلى إختصاص آخر يزيد على القائم والمقوم به، وهكذا يتسلل ويؤدي إلى أن لا يوجد عرض واحد ما لم توجد أعراض لا نهاية لها، فلنبحث عن السبب الذي لأجله فرق بين اختصاص العرض بالمحل وبين اختصاص الجوهر بالحيز في كون أحد الاختصاصيين زائداً على ذات المختص ودون الآخر، فمنه يتبين الغلط في توهم الانتقال. والسر فيه، أن المحل وإن كان لازماً للعرض كما أن الحيز لازم للجوهر، ولكن بين اللازمين فرق: إذ رب لازم ذاتي للشيء، ورب لازم ليس بذاتي للشيء، وأعني بالذاتي ما يجب ببطلانه بطلان الشيء، فإن بطل الوجود بطل به وجود الشيء، وإن بطل في العقل بطل وجود العلم به في العقل، والحيز ليس ذاتياً للجوهر فإنا نعلم الجسم والجوهر أولاً ثم ننظر بعد ذلك في الحيز، أهو أمر ثابت أم هو أمر موهوم ونتوصل إلى تحقيق ذلك بدليل وندرك الجسم بالحس في المشاهدة من غير دليل. فلذلك لم يكن الحيز المعين مثلاً لجسم زيد ذاتياً لزيد، ولم يلزم من فقد ذلك الحيز وتبدله بطلان جسم زيد، وليس كذلك طول زيد مثلاً لأنه عرض في زيد لا نعقله في
نفسه دون زيد بل نعقل زيداً الطويل، فطول زيد يعلم تابعاً لوجود زيد ويلزم من تقدير عدم زيد بطلان طول زيد، فليس لطول زيد قوام في الوجود وفي العقل دون زيد. فاختصاصه بزيد ذاتي له، أي هو لذاته لا لمعنى زائد عليه هو اختصاص، فإن بطل ذلك الاختصاص بطلت ذاته والانتقال يبطل الاختصاص فتبطل ذاته، إذ ليس اختصاصه بزيد زائداً على ذاته، أعني ذات العرض، بخلاف اختصاص الجوهر بالحيز فإنه زائد عليه فليس في بطلانه، بالانتقال ما يبطل ذاته، ورجع الكلام إلى أن الانتقال يبطل الاختصاص بالمحل، فإن كان الاختصاص زائداً على الذات لم تبطل به الذات، وإن لم يكن معنى زائداً بطلت ببطلانه الذات، فقد انكشف هذا وآل النظر إلى أن اختصاص العرض بمحله لم يكن زائداً على ذات العرض كاختصاص الجوهر بحيزه، وأما العرض فإنه عقل بالجوهر لا بنفسه فذات العرض وكونه للجوهر المعين وليس له ذات سواه. فإذا قدرنا مفارقته لذلك الجوهر المعين فقد قدرنا عدم ذاته، وإنما فرضنا الكلام في الطول لتفهيم المقصود فإنه وإن لم يكن عرضاً ولكنه، عبارة عن كثرة الأجسام في جهة واحدة، ولكنه مقرب لغرضنا إلى الفهم، فإذا فهم فلننقل البيان إلى الأعراض. وهذا التوفيق والتحقيق وإن لم يكن لائقاً بهذا الإيجاز ولكن افتقر إليه لأن ما ذكر فيه غير مقنع ولا شاف. فقد فرغنا من إثبات أحد الأصلين، وهو أن العالم لا يخلو عن الحوادث، فإنه لا يخلو عن الحركة والسكون وهما حادثات وليسا بمنتقلين، مع أن الإطناب ليس في مقابلة خصم معتقد، إذ أجمع الفلاسفة على أن أجسام العالم لا تخلو عن الحوادث، وهم المنكرون لحدوث العالم، فإن قيل: فقد بقي الأصل الثاني وهو قولكم إن ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث فما الدليل عليه؟ قلنا: لأن العالم لو كان قديماً مع أنه لا يخلو عن الحوادث، لثبتت حوادث لا أول لها وللزم أن تكون دورات الفلك غير متناهية الاعداد، وذلك محال لأن كل ما يفضي إلى المحال فهو محال، ونحن نبين أنه يلزم عيه ثلاثة محالات: الأول - أن ذلك لو ثبت لكان قد انقضى ما لا نهاية له، ووقع الفراغ منه وانتهى، ولا فرق بين قولنا انقضى ولا بين قولنا انتهى ولا بين قولنا تناهى، فيلزم أن يقال قد تناهى ما لا يتناهى، ومن المحال البين أن يتناهى ما لا يتناهى وأن ينتهي وينقضي ما لا يتناهى. الثاني - أن دورات الفلك إن لم تكن متناهية فهي إما شفع وإما وتر، وإما لا شفع ولا وتر، وإما شفع ووتر معاً. وهذه الأقسام الأربعة محال؛ فالمفضي إليها
محال إذ يستحيل عدد لا شفع ولا وتر، أو شفع ووتر، فإن الشفع هو الذي ينقسم إلى متساويين كالعشرة مثلاً، والوتر هو أحد الذي لا ينقسم إلى متساويين كالتسعة، وكل عدد مركب من آحاد إما أن ينقسم بمتساويين، أو لا ينقسم بمتساويين، وأما أن يتصف بالانقسام وعدم الانقسام، أو ينفك عنهما جميعاً فهو محال، وباطل أن يكون شفعاً لأن الشفع إنما لا يكون وتراً لأنه يعوزه واحد، فإذا انضاف إليه واحد صار وتراً، فكيف أعوز الذي لا يتناهى واحد؟ ومحال أن يكون وتراً. لأن الوتر يصير شفعاً بواحد، فيبقى وتراً لأنه يعوزه ذلك الواحد، فكيف أعوز الذي لا يتناهى واحد؟ الثالث - أنه يلزم عليه أن يكون عددان، كل واحد منهما لا يتناهى، ثم أن أحدهما أقل من الآخر، ومحال أن يكون ما لا يتناهى أقل مما لا يتناهى لأن الأقل هو الذي يعوزه شيء لو أضيف إليه لصار متساوياً، وما لا يتناهى كيف يعوزه شيء؟ وبيانه أن زحل عندهم يدور في كل ثلاثين سنة دورة واحدة، والشمس في كل سنة دورة واحدة، فيكون عدد دورات زحل مثل ثلث عشر دورات الشمس، إذ الشمس تدور في ثلاثين سنة ثلاثين دورة، وزحل يدور دورة واحدة، والواحد من الثلاثين ثلث عشر. ثم دورات زحل لا نهاية لها وهي أقل من دورات الشمس، إذ يعلم ضرورة أن ثلث عشر الشيء أقل من الشيء، والقمر يدور في السنة اثنتي عشرة مرة، فيكون عدد دورات الشمس مثلاً نصف سدس دورات القمر، وكل واحد لا نهاية له وبعضه أقل من بعض، فذلك من المحال البين. فإن قيل: مقدورات الباري تعالى عندكم لا نهاية لها وكذا معلوماته، والمعلومات أكثر من المقدورات إذ ذات القديم تعالى وصفاته معلومة له وكذا الموجود المستمر الوجود، وليس شيء من ذلك مقدوراً. قلنا نحن: إذا قلنا لا نهاية لمقدوراته، لم نرد به ما نريد بقولنا لا نهاية لمعلوماته بل نريد به أن لله تعالى صفة يعبر عنها بالقدرة، يتأتى بها الايجاد، وهذا الثاني لا ينعدم قط. وليس تحت قولنا - هذا الثأني لا ينعدم - إثبات أشياء فضلاً من أن توصف بأنها متناهية أو غير متناهية، وإنما يقع هذا الغلط لمن ينظر في المعاني من الألفاظ فيرى توازن لفظ المعلومات والمقدورات من حيث التصريف في اللغة، فيظن أن المراد بهما واحد. هيهات لا مناسبة بينهما البتة. ثم تحت قولنا المعلومات لا نهاية لها أيضاً سر يخالف السابق منه إلى الفهم، إذ السابق منه إلى الفهم إثبات أشياء تسمى معلومات لا نهاية لها، وهو محال، بل الأشياء هي الموجودات، وهي متناهية، ولكن بيان ذلك يستدعي تطويلا.
وقد اندفع الإشكال بالكشف عن معنى نفي النهاية عن المقدورات، فالنظر في الطرف الثاني وهو المعلومات مستغنى عنه في دفع الالزام، فقد بانت صحة هذا الأصل بالمنهج الثالث من مناهج الأدلة المذكورة في التمهيد الرابع من الكتاب وعند هذا يعلم وجود الصانع إذ بان القياس الذي ذكرناه، وهو قولنا أن العالم حادث وكل حادث فله سبب فالعالم له سبب. فقد ثبتت هذه الدعوى بهذا المنهج، ولكن بعد لم يظهر لنا إلا موجود السبب، فأما كونه حادثاً أو قديماً وصفاً له فلم يظهر بعد فلنشتغل به. الدعوى الثانية: ندعي أن السبب الذي أثبتناه لوجود العالم قديم فإنه لو كان حادثاً لافتقر إلى سبب آخر، وكذلك السبب الآخر ويتسلسل إما إلى غير نهاية وهو محال، وإما أن ينتهي إلى قديم لا محالة يقف عنده وهو الذي نطلبه ونسميه صانع العالم. ولا بد من الاعتراف به بالضرورة ولا نعني بقولنا قديم إلا أن وجوده غير مسبوق بعدم، فليس تحت لفظ القديم إلا إثبات موجود ونفي عدم سابق. فلا تظنن أن القدم معنى زائد على ذات القديم، فيلزمك أن تقول ذلك المعنى أيضاً قديم بقدم زائد عليه، ويتسلسل القوم إلى غير نهاية. الدعوى الثالثة: ندعي أن صانع العالم مع كونه موجوداً لم يزل فهو باق لا يزال لأن ما ثبت قدمه استحال عدمه. وإنما قلنا ذلك لأنه لو العدم لافتقر عدمه إلى
سبب فإنه طارئ بعد استمرار الوجود في القدم. وقد ذكرنا ان كل طارئ فلا بد له من سبب من حيث انه طارئ لا من حيث أنه موجود، وكما افتقر تبدل العدم بالوجود إلى مرجح للوجود على العدم، فكذلك يفتقر تبدل الوجود بالعدم إلى مرجح للعدم على الوجود، وذلك المرجح إما فاعل بعدم القدرة، أو ضد انقطاع شرط من شروط الوجود. ومحال أن يحال على القدرة؛ إذ لوجود شيء ثابت يجوز أن يصدر عن القدرة، فيكون القادر باستعماله فعل شيئاً والعدم ليس بشيء، فيستحيل أن يكون فعلاً واقعاً بأثر القدرة. فإنا نقول: فاعل العدم هل فعل شيئاً؟ فإن قيل نعم، كان محالاً، لأن النفي ليس بشيء. وإن قال المعتزلي أن المعدوم شيء وذات، فليس ذلك الذات من أثر القدرة، فلا يتصف أن يقول الفعل الواقع بالقدرة فعل ذلك الذات فإنها أزلية، وإنما فعله نفي وجود الذات، ونفي وجود الذات ليس شيئاً، فاذاً ما فعل شيئاً. وإذا صدق قولنا ما فعل شيئاً صدق قولنا أنه لم يستعمل القدرة في أثر البتة، فبقي كما كان ولم يفعل شيئاً. وباطل أن يقال أنه يعدمه ضده لأن الضد إن فرض حادثاً اندفع وجوده بمضادة القديم، وكان ذلك أولى من أن ينقطع به وجود القديم. ومحال أن يكون له ضد قديم كان موجوداً معه في القدم ولم يعدمه وقد أعدمه الآن، وباطل أن يقال انعدم لانعدام شرط وجوده، فإن الشرط إن كان حادثاً استحال أن يكون وجود القديم مشروطاً بحادث، وإن كان قديماً فالكلام في استحالة عدم الشرط كالكلام في استحالة عدم المشروط فلا يتصور عدمه. فإن قيل فبما إذاً تفنى عندكم الجواهر والأعراض؟ قلنا: أما الأعراض فبأنفسها، ونعني بقولنا بأنفسها أن ذواتها لا يتصور لها بقاء. ويفهم المذهب فيه بأن يفرض في الحركة، فإن الأكوان المتعاقبة في أحيان متواصلة لا توصف بأنها حركات إلا بتلاحقها على سبيل دوام التجدد ودوام الانعدام، فإنها إن فرض بقاؤها كانت سكوناً لا حركة، ولا تعقل ذات الحركة ما لم يعقل معها العدم عقيب الوجود. وهذا يفهم في الحركة بغير برهان. وأما الألوان وسائر الأعراض، فإنما تفهم بما ذكرناه من أنه لو بقي لاستحال عدمه بالقدرة وبالضد كما سبق في القديم، ومثل هذا العدم محال في حق الله تعالى فإنا بينا قدمه أولاً واستمرار وجوده فيما لم يزل، فلم يكن من ضرورة وجوده حقيقة فناؤه عقيبه، كما كان من ضرورة وجود الحركة حقيقة أن تفنى عقيب الوجود. وأما الجواهر فانعدامها بان لا تخلق فيها الحركة والسكون فينقطع شرط وجودها فلا يعقل بقاؤها.
الدعوى الرابعة: ندعي أن صانع العالم ليس بجوهر متحيز لأنه قد ثبت قدمه، ولو كان متحيزاً لكان لا يخلو عن الحركة في حيزه أو السكون فيه، وما لا يخلو عن الحوادث، فهو حادث كما سبق. فإن قيل: بم تنكرون على من يسميه جوهراً، ولا يعتقده متحيزاً؟ قلنا العقل عندنا لا يوجب الامتناع من اطلاق الألفاظ وإنما يمنع عنه إما لحق اللغة وإما لحق الشرع. أما حق اللغة فذلك إذا ادعى أنه موافق لوضع اللسان فيبحث عنه، فإن ادعى واضعه له أنه اسمه على الحقيقة، أي واضع اللغة وضعه له، فهو كاذب على اللسان وإن زعم أنه استعاره نظراً إلى المعنى الذي به شارك المستعار منه، فإن صلح للاستعارة لم ينكر عليه بحق اللغة وإن لم يصلح قيل له أخطأت على اللغة ولا يستعظم ذلك إلا بقدر استعظام صنيع من يبعد في الاستعارة، والنظر في ذلك لا يليق بمباحث العقول. وأما حق الشرع وجواز ذلك وتحريمه، فهو بحث فقهي يجب طلبه على الفقهاء إذ لا فرق بين البحث عن جواز اطلاق الألفاظ من غير إرادة معنى فاسد وبين البحث عن جواز الأفعال. وفيه رأيان: أحدهما، أن يقال: لا يطلق اسم في حق الله تعالى إلا بالاذن، وهذا لم يرد فيه إذن فيحرم. وأما أن يقال لا يحرم إلا بالنهي وهذا لم يرد فيه نهي فينظر: فإن كان يوهم خطأ فيجب الاحتراز منه لأن إيهام الخطأ في صفات الله تعالى حرام. وإن لم يوهم خطأ يحكم بتحريمه، فكلا الطريقين محتمل. ثم الايهام يختلف باللغات وعادات الاستعمال فرب لفظ يوهم عند قوم ولا يوهم عند غيرهم. الدعوى الخامسة: ندعي أن صانع العالم ليس بجسم، لأن كل جسم فهو متألف من جوهرين متحيزين، وإذا استحال أن يكون جوهراً استحال أن يكون جسماً، ونحن لا نعني بالجسم إلا هذا. فإن سماه جسماً ولم يرد هذا المعنى كانت المضايقة معه بحق اللغة أو بحق الشرع لا بحق العقل فإن العقل لا يحكم في اطلاق الألفاظ ونظم الحروف والأصوات التي هي اصطلاحات، ولأنه لو كان جسماً لكان مقداراً بمقدار مخصوص ويجوز أن يكون أصغر منه أو أكبر، ولا يترجح أحد الجائزين عن الآخر إلا بمخصص ومرجح، كما سبق، فيفتقر إلى مخصص يتصرف فيه فيقدره بمقدار مخصوص، فيكون مصنوعاً لا صانعاً ومخلوقاً لا خالقاً. الدعوى السادسة: ندعي أن صانع العالم ليس بعرض، لأنا نعني بالعرض ما
يستدعي وجوده ذاتاً تقوم به، وذلك الذات جسم أو جوهر، ومهما كان الجسم واجب الحدوث كان الحال فيه أيضاً حادثاً لا محالة، إذ يبطل انتقال الأعراض، وقد بينا أن صانع العالم قديم فلا يمكن أن يكون عرضاً، وإن فهم من العرض ما هو صفة لشيء من غير أن يكون ذلك الشيء متحيزاً، فنحن لا ننكر وجود هذا فانا نستدل على صفات الله تعالى نعم يرجع النزاع إلى إطلاق اسم الصانع والفاعل، فإن إطلاقه على الذات الموصوفة بالصفات أولى من إطلاقه على الصفات. فإذا قلنا الصانع ليس بصفة، عنينا به أن الصنع مضاف إلى الذات التي تقوم بها الصفات لا إلى الصفات، كما أنا إذا قلنا النجار ليس بعرض ولا صفة، عنينا به أن صنعة النجارة غير مضافة إلى الصفات بل إلى الذات الواجب وصفها بجملة من الصفات حتى يكون صانعاً. فكذا القول في صانع العالم، وإن أراد المنازع بالعرض أمراً غير الحال في الجسم وغير الصفة القائمة بالذات كان الحق في منعه للغة أو الشرع لا للعقل. الدعوى السابعة: ندعي أنه ليس في جهة مخصوصة من الجهات الست، ومن عرف معنى لفظ الجهة ومعنى لفظ الاختصاص فهم قطعاً استحالة الجهات على غير الجواهر والأعراض، إذ الحيز معقول وهو الذي يختص الجوهر به، ولكن الحيز إنما يصير جهة إذا أضيف إلى شيء آخر متحيز. فالجهات ست فوق وأسفل وقدام وخلف ويمين وشمال. فمعنى كون الشيء فوقنا هو أنه في حيز يلي جانب الرأس. ومعنى كونه تحتاً أنه في حيز يلي جانب
الرجل. وكذا سائر الجهات؛ فكل ما قيل قيه أنه في جهة فقد قيل أنه في حيز مع زيادة إضافة. وقولنا الشيء في حيز، يعقل بوجهين أحدهما: أنه يختص به بحيث يمنع مثله من أن يوجد بحيث هو، وهذا هو الجوهر، والآخر أن يكون حالاً في الجوهر فإنه قد يقال إنه بجهة، ولكن بطريق البتيعة للجوهر، فليس كون العرض في جهة ككون الجوهر، بل الجهة للجوهر أولى، وللعرض بطريق التبعية للجوهر، فهذان وجهان معقولان في الاختصاص بالجهة. فإن أراد الخصم أحدهما دل على بطلانه ما دل على بطلان كونه جوهراً أو عرضاً. وإن أراد أمراً غير هذا فهو غير مفهوم فيكون الحق في إطلاق لفظه لم ينفك عن معنى غير مفهوم للغة والشرع لا العقل، فإن قال الخصم إنما أُريد بكونه بجهة معنى سوى هذا فلم ننكره، ونقول له: أما لفظك فإنما ننكره من حيث أنه يوهم المفهوم الظاهر منه وهو ما يعقل الجوهر والعرض وذلك كذب على الله تعالى. وأما مرادك منه فلست أنكره فإن ما لا أفهمه كيف أنكره! وعساك تريد به علمه وقدرته وأنا لا أنكر كونه بجهة على معنى أنه عالم وقادر، فإنك إذا فتحت هذا الباب، وهو أن تريد باللفظ غير ما وضع اللفظ له ويدل عليه في التفاهم لم يكن لما تريد به حصر فلا أنكره ما لم تعرب عن مرادك بما أفهمه من أمر يدل على الحدوث، فإن كان ما يدل على الحدوث فهو في ذاته محال ويدل أيضاً على بطلان القول بالجهة، لأن ذلك يطرق الجواز إليه ويحوجه إلى مخصص يخصصه بأحد وجوه الجواز وذلك من وجهين، أحدهما: أن الجهة التي تختص به لا تختص به لذاته، فإن سائر الجهات متساوية بالاضافة إلى المقابل للجهة، فاختصاصه ببعض الجهات المعينة ليس بواجب لذاته بل هو جائز فيحتاج إلى مخصص يخصصه، ويكون الاختصاص فيه معنى زائداً على ذاته وما يتطرق الجواز إليه استحال قدمه بل القديم عبارة عما هو واجب الوجود من جميع الجهات. فإن قيل اختص بجهة فوق لأنه أشرف الجهات، قلنا أي إنما صارت الجهة جهة فوق بخلقه العالم في هذا الحيز الذي خلقه فيه. فقيل خلق العالم لم يكن فوق ولا تحت أصلاً. إذ هما مشتقان من الرأس والرجل ولم يكن إذ ذاك حيوان فتسمى الجهة التي تلي رأسه فوق والمقابل له تحت. والوجه الثاني أنه لو كان بجهة لكان محاذياً لجسم العالم، وكل محاذ فإما أصغر منه وإما أكبر وإما مساو، وكل ذلك يوجب التقدير بمقدار، وذلك المقدار يجوز في العقل أن يفرض أصغر منه أو أكبر فيحتاج إلى مقدار ومخصص.
فإن قيل: لو كان الاختصاص بالجهة يوجب التقدير لكان العرض مقدراً، قلنا: العرض ليس في جهة بنفسه، بل بتبعيته للجوهر فلا جرم هو أيضاً مقدر بالتبعية. فإنا نعلم أنه لا توجد عشرة أعراض إلا في عشرة جواهر، ولا يتصور أن يكون في عشرين، فتقدير الأعراض عشرة لازم بطريق التبعية لتقدير الجواهر، كما لزم كونه بجهة بطريق التبعية. فإن قيل: فإن لم يكن مخصوصاً بجهة فوق، فما بال الوجوه والأيدي ترفع إلى السماء في الأدعية شرعاً وطبعاً، وما باله صلى الله عليه وسلم قال للجارية التي قصد إعتاقها فأراد أن يستيقن إيمانها أين الله فأشارت إلى السماء فقال إنها مؤمنة؟ فالجواب عن الأول أن هذا يضاهي قول القائل: إن لم يكن الله تعالى في الكعبة وهو بيته فما بالنا نحجه ونزوره، وما بالنا نستقبله في الصلاة؟ وإن لم يكن في الأرض، فما بالنا نتذلل بوضع وجوهنا على الأرض في السجود؟ وهذا هذيان. بل يقال: قصد الشرع من تعبد الخلق بالكعبة في الصلاة ملازمة الثبوت في جهة واحدة، فإن ذلك لا محالة أقرب إلى الخشوع وحضور القلب من التردد على الجهات، ثم لما كانت الجهات متساوية من حيث إمكان الاستقبال خصص الله بقعة مخصوصة بالتشريف والتعظيم وشرفها بالإضافة إلى نفسه واستمال القلوب إليها بتشريفه ليثيب على استقبالها، فكذلك السماء قبلة الدعاء، كما أن البيت قبلة الصلاة، والمعبود بالصلاة والمقصود بالدعاء منزه عن الحلول في البيت والسماء ثم في الاشارة بالدعاء إلى السماء سر لطيف يعز من يتنبه لأمثاله، وهو أن نجاة العبد وفوزه في الآخرة، بأن يتواضع لله تعالى ويعتقد التعظيم لربه، والتواضع والتعظيم عمل القلب، وآلته العقل. والجوارح إنما استعملت لتطهير القلب وتزكيته، فإن القلب خلق خلقه يتأثر بالمواظبة على أعمال الجوارح، كما خلقت الجوارح متأثرة لمعتقدات القلوب، ولما كان المقصود أن يتواضع في نفسه بعقله وقلبه، بأن يعرف قدره ليعرف بخسة رتبته في الوجود لجلال الله تعالى وعلوه، وكان من أعظم الأدلة على خسته الموجبة لتواضعه أنه مخلوق من تراب، كلف أن يضع على التراب، الذي هو أذل الأشياء، وجهه الذي هو أعز الأعضاء، ليستشعر قلبه التواضع بفعل الجبهة في مماستها الأرض، فيكون البدن متواضعاً في جسمه وشخصه وصورته بالوجه الممكن فيه وهو معانقة التراب الوضيع الخسيس ويكون العقل متواضعاً لربه بما
يليق به، وهو معرفة الضعة وسقوط الرتبة وخسة المنزلة عند الالتفات إلى ما خلق منه. فكذلك التعظيم لله تعالى وضيعة على القلب فيها نجاته، وذلك أيضاً ينبغي أن تشترك فيه الجوارح، وبالقدر الذي يمكنه أن تحمل الجوارح، وتعظيم القلب بالإشارة إلى علو الرتبة على طريق المعرفة والاعتقاد وتعظيم الجوارح بالإشارة إلى جهة العلو الذي هو أعلى الجهات وأرفعها في الاعتقادات؛ فإن غاية تعظيم الجارحة استعمالها في الجهات، حتى أن من المعتاد المفهوم في المحاورات أن يفصح الإنسان عن علو رتبة غيره وعظيم ولايته فيقول: أمره في السماء السابعة، وهو إنما ينبه على علو الرتبة ولكن يستعير له علو المكان، وقد يشير برأسه إلى السماء في تعظيم من يريد تعظيم أمره، أي أمره في السماء، أي في العلو وتكون السماء عبارة عن العلو، فانظر كيف تلطف الشرع بقلوب الخلق وجوارحهم في سياقهم إلى تعظيم الله وكيف جهل من قلت بصيرته ولم يلتفت إلا إلى ظواهر الجوارح والأجسام وغفل عن أسرار القلوب واستغنائها في التعظيم عن تقدير الجهات، وظن أن الأصل ما يشار إليه بالجوارح ولم يعرف أن المظنة الأولى لتعظيم القلب وأن تعظيمه باعتقاد علو الرتبة لا باعتقاد علو المكان، وأن الجوارح في ذلك خدم وأتباع يخدمون القلب على الموافقة في التعظيم بقدر الممكن فيها، ولا يمكن في الجوارح إلا الإشارة إلى الجهات، فهذا هو السر في رفع الوجوه إلى السماء عند قصد التعظيم، ويضاف إليه عند الدعاء أمر آخر وهو أن الدعاء لا ينفك عن سؤال نعمة من نعم الله تعالى، وخزائن نعمه السموات، وخزان أرزاقه الملائكة ومقرهم ملكوت السموات وهم الموكلون بالأرزاق. وقد قال الله تعالى: " وفي السماء رزقكم وما توعدون ". والطبع يتقاضى الإقبال بالوجه على الخزانة التي هي مقر الرزق المطلوب، فطلاب الأرزاق من الملوك إذا أخبروا بتفرقة الأرزاق على باب الخزانة مالت وجوههم وقلوبهم إلى جهة الخزانة، وإن لم يعتقدوا أن الملك في الخزانة فهذا هو محرك وجوه أرباب الدين إلى جهة السماء طبعاً وشرعاً. فأما العوام فقد يعتقدون أن معبودهم في السماء، فيكون ذلك أحد أسباب إشاراتهم، تعالى رب الأرباب عما اعتقد الزائغون علواً كبير. وأما حكمه صلوات الله عليه بالإيمان للجارية لما أشارت إلى السماء، فقد انكشف به أيضاً إذ ظهر أن لا سبيل للأخرس إلى تفهم علو المرتبة إلا بالإشارة إلى جهة العلو، فقد كانت خرساء كما حكي، وقد كان يظن بها أنها من عبدة الأوثان، ومن يعتقد اله في بيت الأصنام فاستنطقت عن معتقدها فعرفت بالإشارة إلى السماء أن معبودها ليس في بيوت الأصنام كما يعتقدوه أولئك.
فإن قيل فنفي الجهة يؤدي إلى المحال، وهو إثبات موجود تخلو عنه الجهات الست ويكون لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصلاً به، ولا منفصلاً عنه، وذلك محال، قلنا: مسلم أن كل موجود يقبل الاتصال فوجوده لا متصلاً ولا منفصلاً محال، وإن كان موجود يقبل الاختصاص بالجهة فوجوده مع خلو الجهات الست عنه محال، فإما موجود لا يقبل الاتصال، ولا الاختصاص بالجهة فخلو عن طرفي النقيض غير محال، وهو كقول القائل يستحيل موجود لا يكون عاجزاً ولا قادراً ولا عالماً ولا جاهلاً فإن أحد المتضادين لا يخلو الشيء عنه، فيقال له إن كان ذلك الشيء قابلاً للمتضادين فيستحيل خلوه عنهما وأما الجماد الذي لا يقبل واحداً منهما لأنه فقد شرطهما وهو الحياة، فخلوه عنهما ليس بمحال. فكذلك شرط الاتصال والاختصاص بالجهات التحيز والقيام بالمتحيز. فإذا فقد هذا لم يستحل الخلق عن متضادته فرجع النظر إذاً إلى أن موجوداً ليس بمتحيز، ولا هو في متحيز، بل هو فاقد شرط الاتصال، والاختصاص هل هو محال أم لا؟ فإن زعم الخصم أن ذلك محال وجوده فقد دللنا عليه بأنه مهما بان، أن كل متحيز حادث وأن كل حادث يفتقر إلى فاعل ليس بحادث فقد لزم بالضرورة من هاتين المقدمتين ثبوت موجود ليس بمتحيز. أما الأصلان فقد أتبتناهما وأما الدعوى اللازمة منهما فلا سبيل إلى جحدها مع الإقرار بالأصلين. فإن قال الخصم إن مثل هذا الموجود الذي ساق دليلكم إلى إثباته غير مفهوم، فيقال له ما الذي أردت بقولك غير مفهوم فإن أردت به أنه غير متخيل ولا متصور ولا داخل في الوهم فقد صدقت، فإنه لا يدخل في الوهم والتصور والخيال إلا جسم له لون وقدر، فالمنفك عن اللون والقدر لا يتصوره الخيال، فإن الخيال قد أنس بالمبصرات فلا يتوهم الشيء إلا على وفق مرآه ولا يستطيع أن يتوهم ما لا يوافقه. وإن أراد الخصم أنه ليس بمعقول، أي ليس بمعلوم بدليل العقل فهو محاذ إذا قدمنا الدليل على ثبوته ولا معنى للمعقول إلا ما اضطر العقل إلى الأذعان للتصديق به بموجب الدليل الذي لا يمكن مخالفته. وقد تحقق هذا، فإن قال الخصم فما لا يتصور في الخيال لا وجود له، فلنحكم بأن الخيال لا وجود له في نفسه، فإن الخيال نفسه لا يدخل في الخيال والرؤية لا تدخل في الخيال وكذلك العلم والقدرة، وكذلك الصوت والرائحة ولو كلف الوهم أن يتحقق ذاتاً للصوت لقدر له لوناً ومقداراً وتصوره كذلك. وهكذا جميع أحوال النفس، من الخجل والوجل والفسق والغضب والفرح والحزن والعجب، فمن يدرك بالضرورة هذه الأحوال من نفسه ويسوم خياله أن يتحقق
ذات هذه الأحوال فنجده يقصر عنه إلا بتقدير خطأ ثم ينكر بعد ذلك وجود موجود لا يدخل في خياله فهذا سبيل كشف الغطاء عن المسألة. وقد جاوزنا حد الاختصار ولكن المعتقدات المختصرة في هذا الفن أراها مشتملة على الاطناب في الواضحات والشروع في الزيادات الخارجة عن المهمات مع التساهل في مضايق الاشكالات فرأيت نقل الاطناب من مكان الوضوح، إلى مواقع الغموض أهم وأولى. الدعوى الثامنة: ندعي أن الله تعالى منزه عن أن يوصف بالاستقرار على العرش، فإن كل متمكن على جسم ومستقر عليه مقدر لا محالة فإنه أما أن يكون أكبر منه أو أصغر أو مساوياً وكل ذلك لا يخلو عن التقدير، وأنه لو جاز أن يماسه جسم من هذه الجهة لجاز أن يماسه من سائر الجهات فيصير محاطاً به والخصم لا يعتقد ذلك بحال وهو لازم على مذهبه بالضرورة، وعلى الجملة يستقر على الجسم إلا جسم ولا يحل فيه إلا عرض وقد بان أنه تعالى ليس بجسم ولا عرض، فلا يحتاج إلى إقران هذه الدعوى بإقامة البرهان. فإن قيل فما معنى قوله تعالى: " الرحمن على العرش استوى "؟ وما معنى قوله عليه السلام: " ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا " قلنا الكلام على الظواهر الواردة في هذا الباب طويل ولكن نذكر منهجاً في هذين الظاهرين يرشد إلى ما عداه وهو أنا نقول: الناس في هذا فريقان عوام وعلماء، والذي نراه اللائق بعوام الخلق أن لا يخاض بهم في هذه التأويلات بل ننزع عن عقائدهم كل ما يوجب التشبيه ويدل على الحدوث ونحقق عندهم أنه موجود ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وإذا سألوا عن معاني هذه الآيات زجروا عنها، وقيل ليس هذا بعشكم فادرجوا فلكل علم رجال. ويجاب بما أجاب به مالك بن أنس رضي الله عنه، بعض السلف حيث سئل عن الاستواء، فقال: الاستواء معلوم والكيفية مجهولة، والسؤال عنه بدعة، والايمان به واجب، وهذا لأن عقول العوام لا تتسع لقبول المعقولات ولا إحاطتهم باللغات ولا تتسع لفهم توسيعات العرب في الاستعارات. وأما العلماء فاللائق بهم تعريف ذلك وتفهمه، ولست أقول أن ذلك فرض عين إذ لم يرد به تكليف بل التكليف التنزيه عن كل ما تشبهه بغيره. فأما معاني القرآن، فلم يكلف الأعيان فهم جميعها أصلاً ولكن لسنا نرتضي قول من يقول، أن ذلك من المتشابهات كحروف أوائل السور، فإن حروف أوائل السور ليست موضوعة باصطلاح
سابق للعرب للدلالة على المعاني، ومن نطق بحروف وهن كلمات لم يصطلح عليها، فواجب أن يكون معناه مجهولاً إلا أن يعرف ما أردته، فإذا ذكره صارت تلك الحروف كاللغة المخترعة من جهته. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: " ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا "، فلفظ مفهوم ذكر للتفهم وعلم أنه يسبق إلى الإفهام منه المعنى الذي وضع له أو المعنى الذي يستعار، فكيف يقال إنه متشابه بل هو مخيل معنى خطأ عند الجاهل ومفهم معنى صحيحاً عند العالم، وهو كقوله تعالى: " وهو معكم أينما كنتم ". فإنه يخيل عند الجاهل اجتماعاً مناقصاً لكونه على العرش، وعند العالم يفهم أنه مع الكل بالاحاطة والعلم، وكقوله صلى الله عليه وسلم: " قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن "، فإنه عند الجاهل يخيل عضوين مركبين من اللحم والعظم والعصب مشتملين على الأنامل والأظفار، نابتين من الكف، وعند العالم يدل على المعنى المستعار له دون الموضوع له وهو ما كان الاصبع له، وكان سر الاصبع وروحه وحقيقته وهو القدرة على التقليب كما يشاء، كما دلت المعية عليه في قوله وهو معكم على ما تراد المعية له وهو العلم والاحاطة ولكن من شائع عبارات العرب العبارة بالسبب عن المسبب، واستعارة السبب للمستعار منه وكقوله تعالى: " من تقرَّب إليَّ شبراً تقربت إليه ذراعاً ومن أتاني بمشي أتيته بهرولة " فإن الهرولة عند الجاهل تدل على نقل الأقدام وشدة العدو وكذا الاتيان يدل على القرب في المسافة.؟ وعند العاقل يدل على المعنى المطلوب من قرب المسافة بين الناس وهو قرب الكرامة والانعام وإن معناه أن رحمتي ونعمتي أشد انصباباً إلى عبادي من طاعتهم إلي وهو كما قال: " لقد طال شوق الأبرار إلى لقائي وأنا إلى لقائهم لأشد شوقاً " تعالى الله عما يفهم من معنى لفظ الشوق بالوضع الذي هو نوع ألم وحاجة إلى استراحة، وهو عين النقص ولكن الشوق سبب لقبول المشتاق إليه والإقبال عليه وإفاضة النعمة لديه فعبر به عن المسبب، وكما عبر بالغضب والرضى عن إرادة الثواب والعقاب الذين هما ثمرتا الغضب والرضى ومسبباه في العادة. وكذا لما قال في الحجر الأسود إنه يمين الله في الأرض يظن الجاهل انه أراد به اليمين
المقابل للشمال التي هي عضو مركب من لحم ودم وعظم منقسم بخمسة أصابع، ثم إنه إن فتح بصيرته علم أنه كان على العرش ولا يكون يمينه في الكعبة ثم لا يكون حجراً أسود فيدرك بأدنى مسكة أنه استعير للمصافحة، فإنه يؤمر باستلام الحجر وتقبيله كما يؤمر بتقبيل يمين الملك، فاستعير اللفظ لذلك. والكامل العقل البصير لا تعظم عنده هذه الأمور، بل يفهم معانيها على البديهة، فلنرجع إلى معنى الاستواء والنزول؛ أما الاستواء فهو نسبه للعرش لا محالة، ولا يمكن أن يكون للعرش إليه نسبة إلا بكونه معلوماً، أو مراداً، أو مقدوراً عليه، أو محلاً مثل محل العرض، أو مكاناً مثل مستقر الجسم. ولكن بعض هذه النسبة تستحيل عقلاً وبعضها لا يصلح اللفظ للاستعارة به له، فإن كان في جملة هذه النسبة، مع أنه لا نسبة سواها، نسبة لا يخيلها العقل ولا ينبو عنها اللفظ، فليعلم أنها المراد إما كونه مكاناً أو محلاً، كما كان للجوهر والعرض، إذاً اللفظ يصلح له ولكن العقل يخيله كما سبق، وإما كونه معلوماً ومراداً فالعقل لا يخيله، ولكن اللفظ لا يصلح له، وإما كونه مقدوراً عليه وواقعاً في قبضة القدرة ومسخراً له مع أنه أعظم المقدورات ويصلح الاستيلاء عليه لأن يمتدح به وينبه به على غيره الذي هو دونه في العظم، فهذا مما لا يخيله العقل ويصلح له اللفظ، فأخلق بأن يكون هو المراد قطعاً، أما صلاح اللفظ له فظاهر عند الخبير بلسان العرب، وإنما ينبو عن فهم مثل هذا أفهام المتطفلين على لغة العرب الناظرين إليها من بعد الملتفتين إليها التفات العرب إلى لسان الترك حيث لم يتعلموا منها إلا أوائلها، فمن المستحسن في اللغة أن يقال استوى الأمير على مملكته، حتى قال الشاعر: قد استوى بشير على العراق ... من غير سيف ودم مهراق ولذلك قال بعض السلف رضي الله عنهم: يفهم من قوله تعالى " الرحمن على العرش استوى " ما فهم من قوله تعالى " ثم استوى إلى السماء وهي دخان ". وأما قوله صلى الله عليه وسلم " ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا " فللتأويل فيه مجال من وجهين: أحدهما، في اضافة النزول إليه وأنه مجاز، وبالحقيقة هو مضاف إلى ملك من الملائكة كما قال تعالى " واسأل القرية " والمسؤول بالحقيقة أهل القرية. وهذا أيضاً من المتداول في الألسنة، أعني إضافة أحوال التابع إلى المتبوع، فيقال: ترك الملك على باب البلد، ويراد عسكره، فإن المخبر بنزول الملك على باب البلد قد يقال له هلا خرجت لزيارته فيقول لا، لأنه عرج في طريقه على الصيد ولم ينزل بعد، فلا يقال له فلم نزل الملك والآن تقول لم ينزل بعد؟ فيكون المفهوم
من نزول الملك نزول العسكر، وهذا جلي واضح. والثاني، أن لفظ النزول قد يستعمل للتلطف والتواضع في حق الخلق كما يستعمل الارتفاع للتكبر، يقال فلان رفع رأسه إلى عنان السماء، أي تكبر، ويقال ارتفع إلى أعلى عليين، أي تعظم؛ وإن علا أمره يقال: أمره في السماء السابعة؛ وفي معارضته إذا سقطت رتبته يقال: قد هوى به إلى أسفل السافلين؛ وإذا تواضع وتلطف له تطامن إلى الأرض ونزل إلى أدنى الدرجات. فإذا فهم هذا وعلم أن النزول عن الرتبة بتركها أو سقوطها وفي النزول عن الرتبة بطريق التلطف وترك العقل الذي يقتضيه علو الرتبة وكمال الاستغناء، فبالنظر إلى هذه المعاني الثلاثة التي يتردد اللفظ بينها ما الذي يجوزه العقل؟ أما النزول بطريق الانتقال فقد أحاله العقل كما سبق، فإن ذلك لا يمكن إلا في متحيز، وأما سقوط الرتبة فهو محال لأنه سبحانه قديم بصفاته وجلاله ولا يمكن زوال علوه، وأما النزول بمعنى اللطف والرحمة وترك الفعل اللائق بالاستغناء وعدم المبالاة فهو ممكن، فيتعين التنزيل عليه، وقيل إنه لما نزل قوله تعالى: " رفيع الدرجات ذو العرش " استشعر الصحابة رضوان الله عليهم من مهابة عظيمة واستبعدوا الانبساط في السؤال والدعاء مع ذلك الجلال، فأخبروا أن الله سبحانه وتعالى مع عظمة جلاله وعلو شأنه متلطف بعباده رحيم بهم مستجيب لهم مع الاستغناء إذا دعوه، وكانت استجابة الدعوة نزولاً بالاضافة إلى ما يقتضيه ذلك الجلال من الاستغناء وعدم المبالاة، فعبر عن ذلك بالنزول تشجيعاً لقلوب العباد على المباسطة بالأدعية بل على الركوع والسجود، فإن من يستشعر بقدر طاقته مبادئ جلال الله تعالى استبعد سجوده وركوعه، فإن تقرب العباد كلهم بالاضافة إلى جلال الله سبحانه أحس من تحريك العبد أصبعاً من أصابعه على قصد التقرب إلى ملك من ملوك الأرض، ولو عظم به ملكاً من الملوك لاستحق به التوبيخ، بل من عادة الملوك زجر الأرزال عن الخدمة والسجود بين أيديهم والتقبيل لعتبة دورهم استحقاراً لهم عن الاستخدام وتعاظماً عن استخدام غير الأمراء والأكابر، كما جرت به عادة بعض الخلفاء. فلولا النزول عن مقتضى الجلال باللطف والرحمة والاستجابة لاقتضى ذلك الجلال أن يبهت القلوب عن الفكر، ويخرس الألسنة عن الذكر، ويخمد الجوارح عن الحركة، فمن لاحظ ذلك الجلال وهذا اللطف استبان له على القطع أن عبارة النزول مطابقة للجلال ومطلقة في موضوعها لا على ما فهمه الجهال؛ فإن قيل فلم خصص السماء الدنيا؟ قلنا: هو عبارة عن الدرجة الأخيرة التي لا درجة بعدها، كما يقال سقط إلى
الثرى وارتفع إلى الثريا، على تقدير أن الثريا أعلى الكواكب والثرى أسفل المواضع. فإن قيل: فلم خصص بالليالي، فقال ينزل كل ليلة؟ قلنا: لأن الخلوات مظنة الدعوات والليالي أعدت لذلك، حيث يسكن الخلق وينمحي عن القلوب ذكرهم، ويصفوا لذكر الله تعالى قلب الداعي، فمثل هذا الدعاء هو المرجو الاستجابة لا ما يصدر عن غفلة القلوب عند تزاحم الاشتغال. الدعوى التاسعة: ندعي أن الله سبحانه وتعالى مرئي، خلافاً للمعتزلة، وإنما أوردنا هذه المسألة في القطب الموسوم بالنظر في ذات الله سبحانه وتعالى لأمرين: أحدهما أن ننفي الرؤية عما يلزم على نفي الجهة، فأردنا أن نبين كيف يجمع بين نفي الجهة وإثبات الرؤية. والثاني أنه سبحانه وتعالى عندنا مرئي لوجوده ووجود ذاته، فليس ذلك إلا لذاته، فإنه ليس لفعله ولا لصفة من الصفات، بل كل موجود ذات فواجب أن يكون مرئياً، كما أنه واجب أن يكون معلوماً، ولست أعني به أنه واجب أن يكون معلوماً ومرئياً بالفعل بل بالقوة، أي هو من حيث ذاته له، فإن امتنع وجود الرؤية فلأمر آخر خارج عن ذاته، كما نقول: الماء الذي في النهر مرو، والخمر الذي في الدن مسكر، وليس كذلك لأنه يسكر ويروي عند الشرب ولكن معناه أن ذاته مستعدة لذلك فإذا فهم المراد منه فالنظر في طرفين: أحدهما في الجواز العقلي، والثاني في الوقوع الذي لا سبيل إلى دركه إلا بالشرع، ومهما دل الشرع على وقوعه فقد دل أيضاً لا محالة على جوازه ولكنا ندل بمسلكين واقعين عقليين على جوازه. المسلك الأول، هو أنا نقول أن الباري سبحانه موجود وذات، وله ثبوت وحقيقة، وإنما يخالف سائر الموجودات في استحالة كونه حادثاً أو موصوفاً بما يدل على الحدوث، أو موصوفاً بصفة تناقض صفات الالهية من العلم والقدرة وغيرهما. فكل ما يصح لموجود فهو يصح في حقه تعالى إن لم يدل على الحدوث ولم يناقض صفة من صفاته. والدليل عليه تعلق العلم به؛ فإنه لما لم يؤد إلى تغير في ذاته ولا إلى مناقضة صفاته ولا إلى الدلالة على الحدوث، سوى بينه وبين الأجسام والأعراض في جواز تعلق العلم بذاته وصفاته. والرؤية نوع علم لا يوجب تعلقه بالمرئي تغير صفة ولا يدل على حدوث، فوجب الحكم بها على كل موجود،
فإن قيل: فكونه مرئياً يوجب كونه بجهة وكونه بجهة يوجب كونه عرضاً أو جوهراً وهو محال، ونظم القياس أنه إن كان مرئياً فهو بجهة من الرأي وهذا اللازم محال فالمفضي إلى الرؤية محال. قلنا: أحد الأصلين من هذا القياس مسلم لكم، وهو أن هذا اللازم محال، ولكن الأصل الأول وهو ادعاء هذا اللازم على اعتقاد الرؤية ممنوع. فنقول لم قلتم إنه إن كان مرئياً فهو بجهة من الرأي، أعلمتم ذلك بضرورة، أم بنظر؟ ولا سبيل إلى دعوى الضرورة، وأما النظر فلا بد من بيانه، ومنتهاهم أنهم لم يروا إلى الآن شيئاً إلا وكان بجهة من الرأي مخصوصة، فيقال: وما لم ير فلا يحكم باستحالته، ولو جاز هذا لجاز للمجسم أن يقول إنه تعالى جسم، لأنه فاعل، فإننا لم نر إلى الآن فاعلاً إلا جسماً. أو يقول إن كان فاعلاً وموجوداً فهو إما داخل العالم وإما خارجه، وإما متصل وإما منفصل، ولا تخلو عنه الجهات الست، فإنه لم يعلم موجود إلا وهو كذلك فلا فضل بينكم وبين هؤلاء. وحاصله يرجع إلى الحكم بأن ما شوهد وعلم ينبغي أن لا يعلم غيره إلا على وفقه، وهو كمن يعلم الجسم وينكر العرض ويقول: لو كان موجوداً لكان يختص بحيز ويمنع غيره من الوجود بحيث هو كالجسم. ومنشأ هذا إحالة موجودات اختلاف الموجودات في حقائق الخواص مع الاشتراك في أمور عامة. وذلك بحكم لا أصل له، على أن هؤلاء لا يغفل عن معارضتهم بأن الله يرى نفسه ويرى العالم وهو ليس بجهة من نفسه ولا من العالم، فإذا جاز ذلك فقد بطل هذا الخيال. وهذا مما يعترف به أكثر المعتزلة ولا نخرج عنه لمن اعترف به ومن أنكر منهم فلا يقدر على انكار رؤية الانسان نفسه في المرآة، ومعلوم أنه ليس في مقابلة نفسه فإن زعموا أنه لا يرى نفسه وإنما يرى صورة محاكية لصورته منطبعة في المرآة انطباع النفس في الحائط، فيقال إن هذا ظاهر الاستحالة: فإن من تباعد عن مرآة منصوبة في حائط بقدر ذراعين يرى صورته بعيدة عن جرم المرآة بذراعين، وإن تباعد بثلاثة أذرع فكذلك. فالبعيد عن المرآة بذراعين كيف يكون منطبعاً في المرآة وسمك المرآة ربما لا يزيد على سمك شعيرة؟ فإن كانت الصورة في شيء وراء المرآة فهو محال، إذ ليس وراء المرآة إلا جدار أو هواء أو شخص آخر هو محجوب عنه، وهو لا يراه. وكذا عن يمين المرآة ويسارها وفوقها وتحتها وجهات المرآة الست، وهو يرى صورة بعيدة عن المرآة بذراعين، فلنطلب هذه الصورة من جوانب المرآة: فحيث وجدت فهو المرئي ولا وجود لمثل هذه الصورة المرئية في الأجسام المحيطة بالمرآة إلا في جسم والناظر، فهو المرئي إذاً بالضرورة. وقد تطلب المقابلة والجهة ولا ينبغي
أن تستحقر هذا الإلزام فإنه لا مخرج للمعتزلة عنه، ونحن نعلم بالضرورة أن الانسان لو لم يبصر نفسه قط ولا عرف المرآة وقيل له أن يمكن أن تبصر نفسك في مرآة الحكم بأنه محال، وقال لا يخلو إما أن أرى نفسي وأنا في المرآة فهو محال، أو أرى مثل صورتي في جرم المرآة وهو محال، أو في جرم وراء المرآة وهو محال، أو المرآة في نفسها صورة وللأجسام المحيطة بها جسم صور، ولا تجتمع صورتان في جسم واحد إذ محال أن يكون في جسم واحد صورة إنسان وديد وحائط وإن رأيت نفسي حيث أنا فهو محال، إذ لست في مقابلة نفسي فكيف أرى نفسي، ولا بد بين المقابلة بين الرائي والمرئي وهذا التقسيم صحيح عند المعتزلي ومعلوم أنه باطل، وبطلانه عندنا لقوله إني لست في مقابلة نفسي فلا أراها وإلا فسائر أقسام كلامه صحيحة، فبهذا يستبين ضيق حوصلة هؤلاء عن التصديق بما لم يألفوه ولم تأنس به حواسهم. المسلك الثاني، وهو الكشف البالغ أن تقول إنما أنكر الخصم الرؤية لأنه لم يفهم ما تريده بالرؤية ولم يحصل معناها على التحقيق، وظن أنا نريد بها حالة تساوي الحالة التي يدركها الرأي عند النظر إلى الأجسام والألوان وهيهات! فنحن نعترف باستحالة ذلك في حق الله سبحانه، ولكن ينبغي أن نحصل معنى هذا اللفظ في الموضع المتفق، ونسبكه ثم نحذف منه ما يستحيل في حق الله سبحانه وتعالى، فإن نفي من معانيه معنى لم يستحل في حق الله سبحانه وتعالى وأمكن أن يسمى ذلك المعنى رؤية حقيقة، أثبتناه في حق الله سبحانه وقضينا بأنه مرئي حقيقة، وإن لم يكى إطلاق اسم الرؤية عليه إلا بالمجاز أطلقنا اللفظ عليه بإذن الشرع واعتقدنا المعنى كما دل عليه العقل. وتحصيله، أن الرؤية تدل على معنى له محل وهو العين، وله متعلق وهو اللون والقدر والجسم وسائر المرئيات، فلننظر إلى حقيقة معناه ومحله، وإلى متعلقه ولنتأمل أن الركن من جملتها في إطلاق هذا الاسم ما هو، فنقول: أما المحل فليس بركن في صحة هذه التسمية، فإن الحالة التي ندركها بالعين من المرئي لو أدركناها بالقلب أو بالجبهة مثلاً لكنا نقول قد رأينا الشيء وأبصرناه وصدق كلامنا، فإن العين محل وآلة لا تراد لعينها بل لتحل فيه هذه الحالة، فحيث حلت الحالة تمت الحقيقة وصح الاسم. ولنا أن نقول علمنا بقلبنا أو بدماغنا إن أدركنا الشيء بالقلب، أو بالدماغ إن أدركنا الشيء بالدماغ، وكذلك إن أبصرنا بالقلب أو بالجبهة أو بالعين. وأما المتعلق بعينه فليس ركناً في إطلاق هذا الاسم وثبوت هذه الحقيقة. فإن الرؤية لو كانت رؤية لتعلقها بالسواد لما كان المتعلق بالبياض رؤية، ولو كان لتعلقها
باللون لما كان المتعلق بالحركة رؤية، ولو كان لتعلقها بالعرض لما كان المتعلق بالجسم رؤية، فدل أن خصوص صفات المتعلق ليس ركناً لوجود هذه الحقيقة، وإطلاق هذا الاسم، بل الركن فيه من حيث أنه صفة متعلقة أن يكون لها متعلق موجود؛ أي موجود كان وأي ذات كان. فإذاً الركن الذي الاسم مطلق عليه هو الأمر الثالث وهو حقيقة المعنى من غير التفات إلى محله ومتعلقه، فلنبحث عن الحقيقة ما هي، ولا حقيقة لها إلا أنها نوع إدراك هو كمال ومزيد كشف بالاضافة إلى التخيل، فإنا نرى الصديق مثلاً ثم نغمض العين فتكون صورة الصديق حاضرة في دماغنا على سبيل التخيل والتصور، ولكنا لو فتحنا البصر أدركنا تفرقته ولا ترجع تلك التفرقة إلى إدراك صورة أخرى مخالفة لما كانت في الخيال بل الصورة المبصرة مطابقة للمتخيلة من غير فرق وليس بينهما افتراق، إلا أن هذه الحالة الثانية كالاستكمال لحالة التخيل، وكالكشف لها، فتحدث فيها صورة الصديق عند فتح البصر حدوثاً أوضح وأتم وأكمل من الصورة الجارية في الخيال. والحادثة في البصر بعينها تطابق بيان الصورة الحادثة في الخيال، فإذاً التخيل نوع إدراك على رتبة، ووراءه رتبة أخرى هي أتم منه في الوضوح والكشف، بل هي كالتكميل له، فنسمي هذا الاستكمال بالاضافة إلى الخيال رؤية وإبصاراً، وكذا من الأشياء ما نعلمه ولا نتخيله وهو ذات الله سبحانه وتعالى وصفاته، وكل ما لا صورة له، أي لا لون له ولا قدر مثل القدرة والعلم والعشق والإبصار والخيال؛ فإن هذه أمور نعلمها ولا نتخيلها والعلم بها نوع إدراك فلننظر هل يحيل العقل أن يكون لهذا الادراك مزيد استكمال نسبته إليه نسبة الإبصار إلى التخيل؛ فإن كان ذلك ممكناً سمينا ذلك الكشف والاستكمال بالاضافة إلى العلم رؤية، كما سميناه بالاضافة إلى التخيل رؤية. ومعلوم أن تقدير هذا الاستكمال في الاستيضاح والاستكشاف غير محال في الموجودات المعلومة التي ليست متخيلة كالعلم والقدرة وغيرهما، وكذا في ذات الله سبحانه وصفاته، بل نكاد ندرك ضرورة من الطبع أنه يتقاضى طلب مزيد استيضاح في ذات الله وصفاته وفي ذوات هذه المعاني المعلومة كلها. فنن نقول إن ذلك غير محال فإنه لا محيل له بل العقل دليل على إمكانه بل على استدعاء الطبع له. إلا أن هذا الكمال في الكشف غير مبذول في هذا العالم، والنفس في شغل البدن وكدورة صفائه، فهو مجوب عنه. وكما لا يبعد أن يكون الجفن أو الستر أو سواد ما في العين سبباً بحكم اطراد العادة لامتناع الإبصار للمتخيلات فلا يبعد أن تكون كدورة النفس وتراكم حجب الاشغال بحكم اطراد العادة مانعاً من إبصار المعلومات. فإذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، وزكيت القلوب بالشراب الطهور، وصفيت بأنوع التصفية والتنقية، لم يمتنع أن تشتغل بسببها
لمزيد استكمال واستيضاح في ذات الله سبحانه أو في سائر المعلومات، يكون ارتفاع درجته عن العلم المعهود كارتفاع درجة الإبصار عن التخيل، يعبر عن ذلك بلقاء الله تعالى ومشاهدته أو رؤيته أو إبصاره أو ما شئت من العبارات. فلا مشاحة فيها وبعد إيضاح المعاني. وإذا كان ذلك ممكناً بأن خلقت هذه الحالة في العين، كان اسم الرؤية بحكم وضع اللغة عليه أصدق وخلقه في العين غير مستحيل. كما أن خلقها في القلب غير مستحيل فإذا فهم المراد بما أطلقه أهل الحق من الرؤية، علم أن العقل لا يحيله بل يوجبه، وأن الشرع قد شهد له فلا يبقى للمنازعة وجه إلا على سبيل العناد أو المشاحنة في إطلاق عبارة الرؤية أو القصور عن درك هذه المعاني الدقيقة التي ذكرناها. ولنقتصر في هذا الموجز على هذا القدر. الطرف الثاني في وقوعه شرعاً. وقد دل الشرع على وقوعه ومداركه كثيرة، ولكثرتها يمكن دعوى الإجماع على الأولين في ابتهالهم إلى الله سبحانه في طلب لذة النظر إلى وجهه الكريم. ونعلم قطعاً من عقائدهم أنهم كانوا ينتظرون ذلك وأنهم كانوا قد فهموا جواز انتظار ذلك وسؤاله من الله سبحانه، بقرائن أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجملة من ألفاظه الصريحة التي لا تدخل في الحضر، بالاجماع الذي يدل على خروج المدارك عن الحصر. ومن أقوى ما يدل عليه سؤال موسى صلى الله عليه وسلم أرني أنظر إليك فإنه يستحيل أن يخفى عن نبي من أنبياء الله تعالى انتهى منصبه إلى أن يكلمه الله سبحانه شفاهاً أن يجهل من صفات ذاته تعالى ما عرفه المعتزلة. وهذا معلوم على الضرورة، فإن الجهل بكونه ممتنع الرؤية عند الخصم يوجب التفكير أو التضليل وهو جهل بصفة ذاته لأن استحالتها عندهم لذاته ولأنه ليس بجهة فكيف لم يعرف موسى عليه أفضل الصلاة أنه ليس بجهة، أو كيف عرف أنه ليس بجهة ولم يعرف أن رؤية ما ليس بجهة محال؟ فليت شعري ماذا يضمر الخصم ويقدره من ذهول موسى صلى الله عليه وسلم، أيقدره معتقداً أنه جسم في جهة ذو لون، واتهام الأنبياء صلوات الله سبحانه وتعالى عليهم وسلامه كفر صراح، فإنه تكفير للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن القائل بأن الله سبحانه جسم وعابد الوثن والشمس واحد! أو يقول علم استحالة كونه بجهة، ولكنه لم يعلم أن ما ليس بجهة فلا يرى، وهذا تجهيل للنبي عليه أفضل السلام لأن الخصم يعتقد أن ذلك من الجليات لا من النظريات. فأنت الآن أيها المسترشد مخير من أن تميل إلى تجهيل النبي صلى الله عليه وسلم تسليماً، أو إلى تجهيل المعتزلي، فاختر لنفسك ما أليق بك والسلام. فإن قيل: إن دل هذا لكم فقد دل عليكم، لسؤاله الرؤية في الدنيا ودل عليكم قوله تعالى " لن تراني " ودل قوله سبحانه " لا تدركه الأبصار ".
قلنا: أما سؤاله الرؤية في الدنيا فهو دليل على عدم معرفته بوقوع وقت ما هو جائز في نفسه، والأنبياء كلهم عليهم أفضل السلام لا يعرفون من الغيب إلا ما عرفوا، وهو القليل، فمن أين يبعد أن يدعو النبي عليه أفضل السلام كشف غمة وإزالة بلية وهو يرتجي الإجابة في وقت لم تسبق في علم الله تعالى الإجابة فيه. وهذا من ذلك الفن. وأما قوله سبحانه " لن تراني " فهو دفع لما التمسه، وإنما التمس في الآخرة، فلو قال أرني انظر إليك في الآخرة، فقال لن تراني، لكان ذلك دليلاً على نفي الرؤية، ولكن في حق موسى صلوات الله سبحانه وسلامه عليه في الخصوص لا على العموم. وما كان أيضاً دليلاً على الاستحالة، فكيف وهو جواب عن السؤال في الحال؟ وأما قوله لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به ولا تكتنفه من جوانبه كما تحيط الرؤية بالأجسام، وذلك حق، أو هو عام فأريد بة في الدنيا، وذلك أيضاً حق، وهو ما أراده بقوله سبحانه " لن تراني " في الدنيا. ولنقتصر على هذا القدر في مسألة الرؤية، ولينظر المنصف كيف افترقت الفرق وتحزبت إلى مفرط ومفرط. أما الحشوية فإنهم لم يتمكنوا من فهم موجود إلا في جهة، فأثبتوا الجهة حتى ألزمتهم بالضرورة الجسمية والتقدير والاختصاص بصفات الحدوث. وأما المعتزلة وفانهم نفوا الجهة ولم يتمكنوا من إثبات الرؤية دونها، وخالفوا به قواطع الشرع، وظنوا أن في إثباتها إثبات الجهة، فهؤلاء تغلغلوا في التنزيه محترزين من التشبيه، فأفرطوا. والحشوية أثبتوا الجهة احترازاً من التعطيل فشبهوا، فوقف الله سبحانه أهل السنة للقيام بالحق، فتفطنوا للمسلك القصد وعرفوا أن الجهة منقية لأنها للجسمية تابعة وتتمة، وأن الرؤية ثابتة لأنها رديف العلم وفريقه، وهي تكملة له؛ فانتفاء الجسمية أوجب انتفاء الجهة التي من لوازمها. وثبوت العلم أوجب ثبوت الرؤية التي هي من روادفه وتكملاته ومشاركة له في خاصيته، وهي أنها لا توجب تغييراً في ذات المرئي، بل تتعلق به على ما هو عليه كالعلم. ولا يخفى عن عاقل أن هذا هو الاقتصاد في الاعتقاد. الدعوى العاشرة: ندعي أنه سبحانه واحد. فإن كونه واحداً يرجع إلى ثبوت ذاته ونفي غيره، فليس هو نظر في صفة زائدة على الذات، فوجب ذكره في هذا القطب. فنقول: الواحد قد يطلب ويراد به أنه لا يقبل القسمة، أي لا كمية له ولا جزء
ولا مقدار، والباري تعالى واحد بمعنى سلب الكمية المصححة للقسمة عنه؛ فإنه غير قابل للانقسام. إذ الانقسام لما له كمية، والتقسيم تصرف في كمية بالتفريق والتصغير، وما لا كمية له لا بتصور انقسامه. وقد يطلق ويراد أنه لا نظير له في رتبته كما تقول الشمس واحدة، والباري تعالى أيضاً بهذا المعنى واحد؛ فإنه لا ند له. فأما انه لا ضد له فظاهراً، إذ المفهوم من الضد هو الذي يتعاقب مع الشيء على محل واحد ولا تجامع وما لا محل له فلا ضد له، والباري سبحانه لا محل له فلا ضد له. وأما قولنا لا ند له، نعني به أن ما سواه هو خالقه لا غير، وبرهانه أنه لو قدر له شريك لكان مثله في كل الوجوه أو أرفع منه أو كان دونه. وكل ذلك محال. فالمفضي إليه محال، ووجه استحالة كونه مثله من كل وجه أن كل اثنين هما متغايران، فإن لم يكن تغاير لم تكن الإثنينية معقولة، فإنا لا نعقل سوادين إلا في محلين، أو في محل واحد في وقتين، فيكون أحدهما مفارقاً للآخر ومبايناً له ومغايراً إما في المحل وإما في الوقت، والشيئان تارة يتغايران بتغاير الحد والحقيقة، كتغاير الحركة واللون فإنهما وإن اجتمعا في محل واحد في وقت واحد فهما اثنان، إذ أحدهما مغاير للآخر بحقيقته، فإن استوى اثنان في الحقيقة والحد كالسوادين، فيكون الفرق بينهما إما في المحل أو في الزمان؛ فإن فرض سوادان مثلاً في جوهر واحد في حالة واحدة كان محالاً إذ لم تعرف الاثنينية. ولو جاز أن يقال هما اثنان ولا مغايرة، لجاز أن يشار إلى إنسان واحد ويقال أنه انسانان بل عشرة وكلها متساوية متماثلة في الصفة والمكان وجميع العوارض واللوازم، من غير فرقان، وذلك محال بالضرورة، فإن كان ند الله سبحانه متساوياً له في الحقيقة والصفات استحال وجوده، إذ ليس مغايره بالمكان إذ لا مكان ولا زمان فإنهما قديمان، فإذاً لا فرقان، وإذا ارتفع كل فرق ارتفع العدد بالضرورة، ولزمت الوحدة. ومحال أن يقال يخالفه بكونه أرفع منه. فإن الأرفع هو الإله والإله عبارة عن أجل الموجودات وأرفعها، والآخر المقدر ناقص ليس بالإله. ونحن إنما نمنع العدد في الإله، والإله هو الذي يقال فيه بالقول المطلق أنه أرفع الموجودات وأجلها. وإن كان أدنى منه كان محالاً، لأنه ناقص ونحن نعبر بالاله عن أجل الموجودات فلا يكون الأجل إلا واحداً، وهو الإله ولا يتصور اثنان متساويان في صفات الجلال، إذ يرتفع عند ذلك الافتراق ويبطل العدد كما سبق. فإن قيل: بم تنكرون على من لا ينازعكم في إيجاد من يطلق عليه اسم الإله، مهما كان الإله، عبارة عن أجل الموجودات، ولكنه يقول العالم كله بجملته ليس بمخلوق خالق واحد، بل هو مخلوق خالقين، أحدهما مثلاً خالق السماء والآخر خالق الأرض، أو أحدهما خالق الجمادات والآخر خالق الحيوانات وخالق النبات: فما
المحيل لهذا؟ فإن لم يكن على استحالة هذا دليل، فمن أين ينفعكم قولكم أن اسم الإله لا يطلق على هؤلاء؟ فإن هذا القائل يعبر بالإله عن الخالق، أو يقول أحدهما خالق الخير والآخر خالق الشر، أو أحدهما خالق الجواهر والآخر خالق الأعراض، فلا بد من دليل على استحالة ذلك. فنقول: يدل على استحالة ذلك أن هذه التوزيعات للمخلوقات على الخالقين في تقدير هذا السائل لا تعدو قسمين: إما أن تقتضي تقسيم الجواهر والأعراض جميعاً حتى خلق أحدهما بعض الأجسام والأعراض دون البعض، أو يقال كل الأجسام من واحد وكل الأعراض من واحد، وباطل أن يقال إن بعض الأجسام بخلقها واحد كالسماء مثلاً دون الأرض؛ فإنا نقول خالق السماء هل هو قادر على خلق الأرض أم لا، فإن كان قادراً كقدرته، لم يتميز أحدهما في القدرة عن الآخر، فلا يتميز في المقدور عن الآخر فيكون المقدور بين قادرين ولا تكون نسبته إلى أحدهما بأولى من الآخر، وترجع الاستحالة إلى ما ذكرناه من تقدير تزاحم متماثلين من غير فرق، وهو محال. وإن لم يكن قادراً عليه فهو محال لأن الجواهر متماثلة وأكوانها التي هي اختصاصات بالأحياز متماثلة، والقادر على الشيء قادر على مثله إذ كانت قدرته قديمة بحيث يجوز أن يتعلق بمقدورين وقدرة كل واحد منهما تتعلق بعدة من الأجسام والجواهر، فلم تتقيد بمقدور واحد. وإذا جاوز المقدور الواحد على خلاف القدرة الحادثة، لم يكن بعض الأعداد بأولى من بعض، بل يجب الحكم بنفي النهاية عن مقدوراته ويدخل كل جوهر ممكن وجوده في قدرته. والقاسم الثاني أن يقال: أحدهما يقدر على الجوهر والآخر على الأعراض وهما مختلفان، فلا تجب من القدرة على أحدهما القدرة على الآخر، وهذا محال، لأن العرض لا يستغني عن الجوهر، والجوهر لا يستغني عن العرض، فيكون فعل كل واحد منهما موقوفاً على الآخر، فكيف يخلقه وربما لا يساعده خالق الجوهر على خلق الجوهر عند إرادته لخلق العرض، فيبقى عاجزاً متحيراً والعاجز لا يكون قادراً. وكذلك خالق الجوهر إن أراد خلق الجوهر بما خالفه خالق العرض فيمتنع على الآخر خلق الجوهر فيؤدي ذلك إلى التمانع. فإن قيل: مهما أراد واحد منهما خلق جوهر ساعده الآخر على العرض وكذا بالعكس. قلنا: هذه المساعدة هل هي واجبة لا يتصور في العقل خلافها فإن أوجبتموها فهو تحكم، بل هو أيضاً مبطل للقدرة، فإن خلق الجوهر من واحد كأنه يضطر الآخر إلى خلق العرض، وكذا بالعكس؛ فلا تكون له قدرة على الترك ولا تتحقق القدرة مع
هذا. وعلى الجملة فترك المساعدة إن كان ممكناً فقد تعذر العقل وبطل معنى المقدرة والمساعدة إن كانت واجبة صار الذي لا بد له من مساعدة مضطراً لا قدرة له. فإن قيل. فيكون أحدهما خالق الشر والآخر خالق الخير، قلنا: هذا هوس، لأن الشر ليس شراً لذاته، بل هو من حيث ذاته مساو للخير ومماثل له، والقدرة على الشيء قدرة على مثله، فإن إحراق بدن المسلم بالنار شر، وإحراق بدن الكافر خير ودفع شر، والشخص الواحد إذا تكلم بكلمة الإسلام انقلب الإحراق في حقه شراً، فالقادر على إحراق لحمه بالنار عند سكوته عن كلمة الإيمان لا بد أن يقدر على إحراقه عند النطق بها، لأن نطقه بها صوت ينقضي لا يغير ذات اللحم، ولا ذات النار، ولا ذات الاحتراق، ولا يغلب جنساً فتكون الاحتراقات متماثلة، فيجب تعلق القدرة بالكل ويقتضي ذلك تمانعاً وتزاحماً. وعلى الجملة: كيفما فرض الأمر تولد منه اضطراب وفساد وهو الذي أراد الله سبحانه بقوله " لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا " فلا مزيد على بيان القرآن. ولنختم هذا القطب بالدعوى العاشرة فلم يبق مما يليق بهذا الفن إلا بيان استحالة كونه سبحانه محلاً للحوادث، وسنشير إليه في أثناء الكلام في الصفات رداً على من قال بحدوث العلم والإرادة وغيرهما.
القطب الثاني في الصفات وفيه سبعة دعاوى إذ ندعى أنه سبحانه قادر عالم حي مريد سميع بصير متكلم، فهذه سبعة صفات. ويتشعب عنها نظر في أمرين أحدهما ما به تخص آحاد الصفات، والثاني ما تشترك فيه جميع الصفات. فلنفتح البداية بالقسم الأول وهو اثآت أصل الصفات وشرح خصوص أحكامها. القسم الأول أصل الصفات الصفة الأولى القدرة ندعي أن محدث العالم قادر، لأن العالم فعل محكم مرتب متقن منظوم مشتمل على أنواع من العجائب والآيات، وذلك يدل على القدرة. ونرتب القياس فنقول: كل فعل محكم فهو صادر من فاعل قادر، والعالم فعل محكم فهو إذاً صادر من فاعل قادر، ففي أي الأصلين النزاع؟ فإن قيل فلم قلتم أن العالم فعل محكم، قلنا: عنينا بكونه محكماً ترتبه ونظامه وتناسبه، فمن نظر في أعضاء نفسه الظاهرة والباطنة ظهر له من عجائب الاتقان ما يطول حصره، فهذا أصل تدرك معرفته بالحس والمشاهدة فلا يسع جحده. فإن قيل: فبم عرفتم الأصل الآخر وهو أن كل فعل مرتب محكم ففاعله قادر؟ قلنا: هذا مدركه ضرورة العقل؛ فالعقل يصدق به بغير دليل ولا يقدر العاقل على جحده، ولكنا مع هذا نجرد دليلاً يقطع دابر الجحود والعناد، فنقول: نعني بكونه قادراً أن الفعل الصادر منه لا يخلو إما أن يصدر عنه لذاته أو لزائد عليه، وباطل أن يقال صدر عنه لذاته، إذ لو كان كذلك لكان قديماً مع الذات فدل أنه صدر لزائد على
ذاته، والصفة الزائدة التي بها تهيأ للفعل الموجود نسميها قدرةً، إذ القدرة في وضع اللسان عبارة عن الصفة التي يتهيأ الفعل للفاعل وبها يقع الفعل، فإن قيل ينقلب عليكم هذا في القدرة فإنها قديمة والفعل ليس بقديم، قلنا سيأتي جوابه في أحكام الإرادة فيما يقع الفعل به، وهذا الوصف مما دل عليه التقسيم القاطع الذي ذكرناه. ولسنا نعني بالقدرة إلا هذه الصفة، وقد أثبتناها فلنذكر أحكامها. ومن حكمها أنها متعلقة بجميع المقدورات، وأعني بالمقدورات الممكنات كلها التي لا نهاية لها. ولا يخفى أن الممكنات لا نهاية لها فلا نهاية إذاً للمقدورات، ونعني بقولنا لا نهاية للممكنات أن خلق الحوادث بعد الحوادث لا ينتهي إلى حد يستحيل في العقل حدوث حادث بعده، فالإمكان مستمر أبداً والقدرة واسعة لجميع ذلك، وبرهان هذه الدعوى وهي عموم تعلق القدرة أنه قد ظهر أن صانع كل العالم واحد، فإما أن يكون له بإزاء كل مقدور قدرة والمقدورات لا نهاية لها فتثبت قدرة متعددة لا نهاية لها وهو محال كما سبق في إبطال دورات لا نهاية لها، وإما أن تكون القدرة واحدة كما سبق في إبطال دورات لا نهاية لها، وإما أن تكون القدرة واحدة فيكون تعلقها مع اتحادها بما يتعلق به من الجواهر والأعراض مع اختلافها لأمر تشترك فيه ولا يشترك في أمر سوى الامكان، فيلزم منه أن كل ممكن فهو مقدور لا محالة وواقع بالقدرة. وبالجملة، إذا صدرت منه الجواهر والأعراض استحال أن لا يصدر منه أمثالها، فإن القدرة على الشيء قدرة على مثله إذ لم يمتنع التعدد في المقدور لنسبته إلى الحركات كلها والألوان كلها على وتيرة واحدة فتصلح لخلو حركة بعد حركة على الدوام، وكذا لون بعد لون وجوهر بعد جوهر وهكذا.. وهو الذي عنيناه بقولنا إن قدرته تعالى متعلقة بكل ممكن فإن الإمكان لا ينحصر في عدد. ومناسبة ذات القدرة لا تختص بعدد دون عدد ولا يمكن أن يشار إلى حركة فيقال أنها خارجة عن إمكان تعلق القدرة بها، مع أنها تعلقت بمثلها إذ بالضرورة تعلم أن ما وجب للشيء وجب لمثله ويتشعب عن هذا ثلاثة فروع. الفرع الأول: إن قال قائل هل تقولون أن خلاف المعلوم مقدور؟ قلنا: هذا مما اختلف فيه، ولا يتصور الخلاف فيه إذا حقق وأزيل تعقيد الألفاظ وبيانه أنه قد ثبت أن كل ممكن مقدور وأن المحال ليس بمقدور. فانظر أن خلاف المعلوم محال أو ممكن ولا تعرف ذلك إلا إذا عرفت معنى المحال والممكن وحصلت حقيقتهما وإلا فإن تساهلت في النظر، ربما صدق على خلاف المعلوم أنه محال وأنه ممكن وأنه ليس بمحال، فإذاً صدق أنه محال وأنه ليس بمحال والنقيضان لا يصدفان معاً.
فاعلم أن تحت اللفظ اجمالاً وإنما ينكشف لك ذلك بما أقوله وهو أن العالم مثلاً يصدق عليه أنه واجب وأنه محال وأنه ممكن. أما كونه واجباً فمن حيث أنه إذا فرضت إرادة القديم موجودة وجوداً واجباً كان المراد أيضاً واجباً بالضرورة لا جائزاً، إذ يستحيل عدم المراد مع تحقق الإرادة القديمة وأما كونه محالاً فهو أنه لو قدر عدم تعلق الارادة بايجاده فيكون لا محالة حدوثه محالاً إذ يؤدي إلى حدوث حادث بلا سبب وقد عرف أنه محال. وأما كونه ممكناً فهو أن تنظر إلى ذاته فقط، ولا تعتبر معه لا وجود الإرادة ولا عدمها، فيكون له وصف الإمكان، فإذاً الاعتبارات ثلاثة: الأول أن يشترط فيه وجود الإرادة وتعلقها فهو بهذا الاعتبار واجب. الثاني أن يعتبر فقد الإرادة فهو بهذا الاعتبار محال. الثالث أن نقطع الالتفات عن الإرادة والسبب فلا نعتبر وجوده ولا عدمه ونجرد النظر إلى ذات العالم فيبقى له بهذا الاعتبار الأمر الثالث وهو الإمكان. ونعني به أنه ممكن لذاته، أي إذا لم نشترط غير ذاته كان ممكناً فظهر منه أنه يجوز أن يكون الشيء الواحد ممكناً محالاً، ولكن ممكناً باعتبار ذاته محالاً باعتبار غيره، ولا يجوز أن يكون ممكناً لذاته محالاً لذاته، فهما متناقضان فنرجع إلى خلاف المعلوم فنقول: إذا سبق في علم الله تعالى إماتة زيد صبيحة يوم السبت مثلاً فنقول: خلق الحياة لزيد صبيحة يوم السبت ممكن أم ليس بممكن؟ فالحق فيه أنه ممكن ومحال؛ أي هو ممكن باعتبار ذاته إن قطع الالتفات إلى غيره، ومحال لغيره لا لذاته وذلك إذا اعتبر معه الالتفات إلى تعلق ذاتها وهو ذات العلم، إذ ينقلب جهلاً، ومحال أن ينقلب جهلاً فبان أنه ممكن لذاته محال للزوم استحالة في غيره. فإذا قلنا حياة زيد في هذا الوقت مقدورة، لم نرد به إلا أن الحياة من حيث أنها حياة ليس بمحال، كالجمع بين السواد والبياض. وقدرة الله تعالى من حيث أنها قدرة لا تنبو عن التعلق بخلق الحياة ولا تتقاصر عنه لفتور ولا ضعف ولا سبب في ذات القدرة، وهذان أمران يستحيل إنكارهما، أعني نفي القصور عن ذات القدرة وثبوت الإمكان لذات الحياة من حيث أنها حياة فقط من غير التفات إلى غيرها، والخصم إذا قال غير مقدور على معنى أن وجوده يؤدي إلى استحالة فهو صادق في هذا المعنى، فإنا لسنا ننكره ويبقى النظر في اللفظ هل هو صواب من حيث اللغة إطلاق هذا الاسم عليه أو سلبه، ولا يخفى أن الصواب إطلاق اللفظ فإن الناس يقولون فلان قادر على الحركة والسكون، إن شاء تحرك وإن شاء سكن، ويقولون إن له في كل وقت قدرة على الضدين ويعلمون أن الجاري في علم الله تعالى وقوع أحدهما، فالاطلاقات
شاهدة لما ذكرناه وحظ المعنى فيه ضروري لا سبيل إلى جحده. الفرع الثاني: إن قال قائل إذا ادعيتم عموم القدرة في تعلقها بالممكنات، فما قولكم في مقدورات الحيوان وسائر الأحياء من المخلوقات، أهي مقدورة لله تعالى أم لا؟ فإن قلتم ليست مقدورة، فقد نقضتم قولكم إن تعلق القدرة عام، وإن قلتم إنها مقدورة له لزمكم إثبات مقدور بين قادرين وهو محال، وإنكار كون الإنسان وسائر الحيوان قادراً فهو مناكرة للضرورة ومجاحدة لمطالبات الشريعة، إذ تستحيل المطالبة بما لا قدرة عليه ويستحيل أن يقول الله لعبده ينبغي أن تتعاطى ما هو مقدور لي وأنا مستأثر بالقدرة عليه ولا قدرة لك عليه. فنقول: في الانفصال قد تحزب الناس في هذا أحزاباً؛ فذهبت المجبرة إلى انكار قدرة العبد فلزمها إنكار ضرورة التفرقة بين حركة الرعدة والحركة الاختيارية، ولزمها أيضاً استحالة تكاليف الشرع، وذهبت المعتزلة إلى انكار تعلق قدرة الله تعالى بأفعال العباد من الحيوانات والملائكة والجن والإنس والشياطين وزعمت أن جميع ما يصدر منها من خلق العباد واختراعهم لا قدرة لله تعالى عليها بنفي ولا إيجاب فلزمتها شناعتان عظيمتان: إحداهما انكار ما أطبق عليه السلف رضي الله عنهم من أنه لا خالق إلا الله ولا مخترع سواه، والثانية نسبة الاختراع والخلق إلى قدرة من لا يعلم ما خلقه من الحركات، فإن الحركات التي تصدر من الإنسان وسائر الحيوان لو سئل عن عددها وتفاصيلها ومقاديرها لم يكن عنده خبر منها، بل الصبي كما ينفصل من المهد يدب إلى الثدي باختياره ويمتص، والهرة كما ولدت تدب إلى ثدي أمها وهي مغمضة عينها، والعنكبوت تنسج من البيوت أشكالاً غريبة يتحير المهندس في استدارتها وتوازي أضلاعها وتناسب ترتيبها وبالضرورة تعلم انفكاكها عن العلم بما تعجز المهندسون عن معرفته، والنحل تشكل بيوتها على شكل التسديس فلا يكون فهيا مربع ولا مدور ولا مسبع ولا شكل آخر وذلك لتميز شكل المسدس بخاصية دلت عليها البراهين الهندسية لا توجد في غيرها، وهو مبني على اصول أحدها، أن أحوى الأشكال وأوسعها الشكل المستدير المنفك عن الزوايا الخارجة عن الاستقامة، والثاني، أن الأشكال المستديرة إذا وضعت متراصة بقيت بينها فرج معطلة لا محالة، والثالث، أن أقرب الأشكال القليلة الأضلاع إلى المستديرة في الاحتواء هو شكل المسدس،
والرابع أن كل الأشكال القريبة من المستديرة كالمسبع والمثمن والمخمس إذا وضعت جملة متراصة متجاورة بقيت بينها فرج معطلة ولم تكن متلاصقة، وأما المربعة فإنها متلاصقة ولكنها بعيدة عن احتواء الدوائر لتباعد زواياها عن أوساطها، ولما كان النحل محتاجاً إلى شكل قريب من الدوائر ليكون حاوياً لشخصه فإنه قريب من الاستدارة، وكان محتاجاً لضيق مكانه وكثرة عدده إلى أن لا يضيع موضعاً بفرج تتخلل بين البيوت ولا تتسع لأشخاصها ولم يكن في الأشكال مع خروجها عن النهاية شكل يقرب من الاستدارة وله هذه الخاصية وهو التراص والخلو عن بقاء الفرج بين أعدادها إلا المسدس، فسخرها الله تعالى لاختيار الشكل المسدس في صناعة بيتها؛ فليت شعري أعرف النحل هذه الدقائق التي يقصر عن دركها أكثر عقلاء الإنس أم سخره لنيل ما هو مضطر إليه الخالق المنفرد بالجبروت وهو في الوسط مجري فتقدير الله تعالى يجري عليه وفيه، وهو لا يدريه ولا قدرة له على الامتناع عنه، وإن في صناعات الحيوانات من هذا الجنس عجائب لو أوردت منها طرفاً لامتلأت الصدور من عظمة الله تعالى وجلاله، فتعساً للزائغين عن سبيل الله المغترين بقدرتهم القاصرة ومكنتهم الضعيفة الظانين أنهم مساهمون الله تعالى في الخلق والاختراع وإبداع مثل هذه العجائب والآيات. هيهات هيهات! ذلت المخلوقات وتفرد بالملك والملكوت جبار الأرض والسموات فهذه أنواع الشناعات اللازمة على مذهب المعتزلة فانظر الآن إلى أهل السنة كيف وفقوا للسداد ورشحوا للاقتصاد في الاعتقاد. فقالوا: القول بالجبر محال باطل، والقول بالاختراع اقتحام هائل، وإنما الحق إثبات القدرتين على فعل واحد. والقول بمقدور منسوب إلى قادرين فلا يبقى إلا استبعاد توارد القدرتين على فعل واحد وهذا إنما يبعد إذا كان تعلق القدرتين على وجه واحد، فإن اختلفت القدرتان واختلف وجه تعلقهما فتوارد التعلقين على شيء واحد غير محال كما سنبينه. فإن قيل فما الذي حملكم على اثبات مقدور بين قادرين؟ قلنا: البرهان القاطع على أن الحركة الاختيارية مفارقة للرعدة، وإن فرضت الرعدة مراد للمرتعد ومطلوبة له أيضاً ولا مفارقة إلا بالقدرة، ثم البرهان القاطع على أن كل ممكن تتعلق به قدرة الله تعالى وكل حادث ممكن وفعل العبد حادث فهو إذاً ممكن فإن لم تتعلق به قدرة الله تعالى فهو محال، فإنا نقول: الحركة الاختيارية من حيث أنها حركة حادثة ممكنة مماثلة لحركة الرعدة فيستحيل أن تتعلق قدرة الله تعالى بإحداهما وتقصر عن الأخرى وهي مثلها، بل يلزم عليه محال آخر وهو أن الله
تعالى لو أراد تسكين يد العبد إذا أراد العبد تحريكها فلا يخلو إما أن توجد الحركة والسكون جميعاً أو كلاهما لا يوجد فيؤدي إلى اجتماع الحركة والسكون أو إلى الخلو عنهما، والخلو عنهما مع التناقض يوجب بطلان القدرتين، إذ القدرة ما يحصل بها المقدور عند تحقق الإرادة وقبول المحل، فإن ظن الخصم أن مقدور الله تعالى يترجح لأن قدرته أقوى فهو محال، لأن تعلق القدرة بحركة واحدة لا تفضل تعلق القدرة الأخرى بها، إذ كانت فائدة القدرتين الاختراع وإنما قوته باقتداره على غيره واقتداره على غيره غير مرجح في الحركة التي فيها الكلام، إذ حظ الحركة من كل واحدة من القدرتين أن تصير مخترعة بها والاختراع يتساوى فليس فيه أشد ولا أضعف حتى يكون فيه ترجيح، فإذاً الدليل القاطع على إثبات القدرتين ساقنا إلى إثبات مقدور بين قادرين. فإن قيل: الدليل لا يسوق إلى محال لا يفهم وما ذكرتموه غير مفهوم. قلنا: علينا تفهيمه وهو أنا نقول اختراع الله سبحانه للحركة في العبد معقول دون أن تكون الحركة مقدورة للعبد، فمهما خلق الحركة وخلق معها قدرة عليها كان هو المستبد بالاختراع للقدرة والمقدور جميعاً، فخرج منه أنه منفرد بالاختراع وأن الحركة موجودة وأن المتحرك عليها قادر وبسبب كونه قادراً فارق حاله حال المرتعد فاندفعت الإشكالات كلها. وحاصله أن القادر الواسع القدرة هو قادر على الاختراع للقدرة والمقدور معاً، ولما كان اسم الخالق والمخترع مطلقاً على من أوجد الشيء بقدرته وكانت القدرة والمقدور جميعاً بقدرة الله تعالى، سمي خالقاً ومخترعاً. ولم يكن المقدور مخترعاً بقدرة العبد وإن كان معه فلم يسم خالقاً ولا مخترعاً ووجب أن يطلب لهذا النمط من النسبة اسم آخر مخالف فطلب له اسم الكسب تيمناً بكتاب الله
تعالى، فإنه وجد إطلاق ذلك على أعمال العباد في القرآن وأما اسم الفعل فتردد في إطلاقه ولا مشاحة في الأسامي بعد فهم المعاني. فإن قيل: الشأن في فهم المعنى وما ذكرتموه غير مفهوم، فإن القدرة المخلوقة الحادثة إن لم يكن لها تعلق بالمقدور لم تفهم؛ إذ قدرة لا مقدور لها محال، كعلم لا معلوم له. وإن تعلقت به فلا يعقل تعلق القدرة بالمقدور إلا من حيث التأثير والايجاد وحصول المقدور به. فالنسبة بين المقدور والقدرة نسبة المسبب إلى السبب وهو كونه به، فإذا لم يكن به لم تكن علاقة فلم تكن قدرة، إذ كل ما لا تعلق له فليس بقدرة إذ القدرة من الصفات المتعلقة. قلنا: هي متعلقة، وقولكم أن التعلق مقصور على الوقوع به يبطل بتعلق الارادة والعلم، وإن قلتم أن تعلق القدرة مقصور على الوقوع بها فقط فهو أيضاً باطل، فإن القدرة عندكم تبقى إذا فرضت قبل الفعل، فهل هي متعلقة أم لا؟ فإن قلتم لا فهو محال، وإن قلتم نعم فليس المعني بها وقوع المقدور بها، إذ المقدور بعد لم يقع فلا بد من إثبات نوع آخر من التعلق سوى الموقوع بها، إذ التعلق عند الحدوث يعبر عنه بالوقوع به والتعلق قبل ذلك مخالف له فهو نوع آخر من التعلق، فقولكم إن تعلق القدرة به نمط واحد خطأ وكذلك القادرية القديمة عندهم فإنها متعلقة بالعلم في الأزل وقبل خلق العالم، فقولنا أنها متعلقة صادق وقولنا أن العالم واقع بها كاذب، لأنه لم يقع بعد فلو كانا عبارتين عن معنى واحد لصدق أحدهما حيث يصدق الآخر. فإن قيل: معنى تعلق القدرة قبل وقوع المقدور أن المقدور إذا وقع بها. قلنا: فليس هذا تعلقاً في الحال بل هو انتظار تعلق، فينبغي أن يقال القدرة موجودة وهي صفة لا تعلق لها ولكن ينتظر لها تعلق إذا وقع وقع المقدور بها، وكذا القادرية ويلزم عليه محال، وهو أن الصفة التي لم تكن من المتعلقات صارت من المتعلقات وهو محال. فإن قيل: معناه أنها متهيئة لوقوع المقدور بها. قلنا: ولا معنى للتهيؤ إلا انتظار الوقوع بها، وذلك لا يوجب تعلقاً في الحال. فكما عقل عندكم قدرة موجودة متعلقة بالمقدور والمقدور غير واقع بها عقل عندنا أيضاً قدرة كذلك والمقدور غير واقع بها ولكنه واقع بقدرة الله تعالى، فلم يخالف مذهبنا ههنا مذهبكم إلا في قولنا أنها وقعت بقدرة الله تعالى، فإذا لم يكن من ضرورة وجود القدرة ولا تعلقها بالمقدور وجود المقدور بها؛ فمن أين يستدعي عدم وقوعها بقدرة الله تعالى ووجوده بقدرة الله تعالى لا فضل له على عدمه من حيث انقطاع النسبة عن القدرة الحادثة إذ النسبة، إذا لم تمتنع بعدم المقدور، فكيف تمتنع
بوجود المقدور؟ وكيف ما فرض المقدور موجوداً أو معدوماً فلا بد من قدرة متعلقة لا مقدور لها في الحال. فإن قيل: فقدرة لا يقع بها مقدور، والعجز، بمثابة واحدة، قلنا: إن عنيتم به أن الحالة التي يدركها الإنسان عند وجودها مثل ما يدركها عند العجز في الرعدة فهو مناكرة للضرورة وإن عنيتم أنها بمثابة العجز في أن المقدور لم يقع بها فهو صدق ولكن تسميته عجزاً خطأ وإن كان من حيث القصور إذا نسبت إلى قدرة الله تعالى ظن أنه مثل العجز، وهذا كما أنه لو قيل القدرة قبل الفعل، على أصلهم، مساوية للعجز من حيث أن المقدور غير واقع بها لكان اللفظ منكراً من حيث أنها حالة مدركة يفارق إدراكها في النفس إدراك العجز، فكذلك هذا، ولا فرق وعلى الجملة فلا بد من إثبات قدرتين متفاوتتين، إحداهما أعلى والأخرى بالعجز أشبه مهما أضيفت إلى الأعلى، وأنت بالخيار بين أن تثبت للعبد قدرة توهم نسبة العجز للعبد من وجه، وبين أن تثبت لله سبحانه ذلك تعالى الله عما يقول الزائغون. ولا تستريب إن كنت منصفاً في أن نسبة القصور والعجز بالمخلوقات أولى بل لا يقال أولى لاستحالة ذلك في حق الله تعالى فهذا غاية ما يحتمله هذا المختصر من هذه المسألة. الفرع الثالث: فإن قال قائل: كيف تدعون عموم تعلق القدرة بجملة الحوادث وأكثر ما في العالم من الحركات وغيرها متولدات يتولد بعضها من بعض
بالضرورة، فإن حركة اليد مثلاً بالضرورة تولد حركة الخاتم، وحركة اليد في الماء تولد حركة الماء، وهو مشاهد، والعقل أيضاً يدل عليه إذ لو كانت حركة الماء والخاتم بخلق الله تعالى لجاز أن يخلق حركة اليد دون الخاتم وحركة اليد دون الماء، وهو محال، وكذا في المتولدات مع انشعابها. فنقول: ما لا يفهم لا يمكن التصرف فيه بالرد والقبول، فإن كون المذهب مردوداً أو مقبولاً بعد كونه معقولاً. والمعلوم عندنا من عبارة التولد أن يخرج جسم من جوف جسم كما يخرج الجنين من بطن الأم والنبات من بطن الأرض، وهذا محال في الأعراض؛ إذ ليس لحركة اليد جوف حتى تخرج منه حركة الخاتم ولا هو شيء حاو لأشياء حتى يرشح منه بعض ما فيه، فحركة الخاتم إذا لم تكن كامنة في ذات حركة اليد فما معنى تولدها منها؟ فلا بد من تفهيمه، وإذا لم يكن هذا مفهوماً فقولكم إنه مشاهد حماقة، إذ كونها حادثة معها مشاهد لا غير، فأما كونها متولد منها فغير مشاهد، وقولكم إنه لو كان بخلق الله تعالى لقدر على أن يخلق حركة اليد دون الخاتم وحركة اليد دون الماء فهذا هوس يضاهي قول القائل لو لم يكن العلم متولداً من الإرادة لقدر على أن يخلق الارادة دون العلم أو العلم دون الحياة، ولكن نقول: المحال غير مقدور ووجود المشروط دون الشرط غير معقول، والارادة شرطها العلم والعلم شرطه الحياة وكذلك شرط شغل الجوهر لحيز فراغ ذلك الحيز، فإذا حرك الله تعالى اليد فلا بد أن يشغل بها حيزاً في جوار الحيز الذي كانت فيه، فما لم يفرغه كيف يشغله به؟ ففراغه شرط اشتغاله باليد، إذ لو تحرك ولم يفرغ الحيز من الماء بعدم الماء أو حركته لاجتمع جسمان في حيز واحد وهو محال، فكان خلو أحدهما شرطاً للآخر فتلازما فظن أن أحدهما متولد من الآخر وهو خطأ فأما اللازمات التي ليست شرطاً فعندنا يجوز أن تنفك عن الاقتران بما هو لازم لها، بل لزومه بحكم طرد العادة كاحتراق القطن عند مجاورة النار وحصول البرودة في اليد عند مماسة الثلج، فإن كل ذلك مستمر بجريان سنة الله تعالى، وإلا فالقدرة من حيث ذاتها غير قاصرة عن خلق البرودة في الثلج والمماسة في اليد مع خلق الحرارة في اليد بدلاً عن البرودة. فإذاً ما يراه الخصم متولداً قسمان: أحدهما شرط فلا يتصور فيه إلا الاقتران، والثاني ليس بشرط فيتصور فيه غير الاقتران إذ خرقت العادات. فإن قال قائل لم تدلوا على بطلان التولد ولكن أنكرتم فهمه وهو مفهوم، فإنا لا نريد به ترشح الحركة من الحركة بخروجها من جوفها ولا تولد برودة من برودة الثلج بخروج البرودة من الثلج وانتقالها أو بخروجها من ذات البرودة، بل نعني به
وجود موجود عقيب موجود وكونه موجوداً وحادثاً به فالحادث نسميه متولداً والذي به الحدوث نسميه مولداً وهذه التسمية مفهومة فما الذي يدل على بطلانه؟ قلنا: إذا أقررتم بذلك دل على بطلانه ما دل على بطلان كون القدرة الحادثة موجودة فإنا إذا أحلنا أن نقول حصل مقدور بقدرة حادثة فكيف لا يخيل الحصول بما ليس بقدرة واستحالته راجعة إلى عموم تعلق القدرة، وإن خروجه عن القدرة مبطل لعموم تعلقها وهو محال ثم هو موجب للعجز والتمانع كما سبق. نعم، وعلى المعتزلة القائلين بالتولد مناقضات في تفصيل التولد لا تحصى، كقولهم إن النظر يولد العلم، وتذكره لا يولده إلى غير ذلك مما لا نطول بذكره، فلا معنى للإطناب فيما هو مستغنى عنه، وقد عرفت من جملة هذا أن الحادثات كلها، جواهرها وأعراضها الحادثة منها في ذات الأحياء والجمادات، واقعة بقدرة الله تعالى، وهو المستبد باختراعها، وليس تقع بعض المخلوقات ببعض بل الكل يقع بالقدرة وذلك ما أردنا أن نبين من إثبات صفة القدرة لله تعالى وعموم حكمها وما اتصل بها من الفروع واللوازم. الصفة الثانية العلم ندعي أن الله تعالى عالم بجميع المعلومات الموجودات والمعدومات؛ فإن الموجودات منقسمة إلى قديم وحادث، والقديم ذاته وصفاته ومن علم غيره فهو بذاته وصفاته أعلم، فيجب ضرورة أن يكون بذاته عالماً وصفاته إن ثبت أنه عالم بغيره. ومعلوم أنه عالم بغيره لأن ما ينطلق عليه اسم الغير فهو صنعه المتقن وفعله المحكم المرتب وذلك يدل على قدرته على ما سبق؛ فإن من رأى خطوطاً منظومة تصدر على الاتساق من كاتب ثم استراب في كونه عالماً بصنعة الكتابة كان سفيهاً في استرابته، فإذاً قد ثبت أنه عالم بذاته وبغيره. فإن قيل فهل لمعلوماته نهاية؟ قلنا: لا؛ فإن الموجودات في الحال وإن كانت متناهية فالممكنات في الاستقبال غير متناهية، ونعلم أن الممكنات التي ليست بموجودة أنه سيوجدها أولا يوجدها، فيعلم إذاً ما لا نهاية له بل لو أردنا أن نكثر على شيء واحد وجوهاً من النسب والتقديرات لخرج عن النهاية والله تعالى عالم بجميعها. فإنا نقول مثلاً ضعف الاثنين أربعة، وضعف الأربعة ثمانية، وضعف الثمانية ستة عشر، وهكذا نضعف ضعف الإثنين وضعف ضعف الضعف ولا يتناهى، والإنسان لا يعلم من مراتبها إلا ما يقدره بذهنه، وسينقطع عمره ويبقى من التضعيفات
ما لا يتناهى. فإذاً معرفة أضعاف أضعاف الإثنين، وهو عدد واحد، يخرج عن الحصر وكذلك كل عدد، فكيف غير ذلك من النسب والتقديرات، وهذا العلم مع تعلقه بمعلومات لا نهاية لها واحد كما سيأتي بيانه من بعد مع سائر الصفات. الصفة الثالثة الحياة ندعي أنه تعالى حي وهو معلوم بالضرورة، ولم ينكره أحد ممن اعترف بكونه تعالى عالماً قادراً. فإن كون العالم القادر حياً ضروري إذ لا يعني بالحي إلا ما يشعر بنفسه ويعلم ذاته وغيره، والعالم بجميع المعلومات والقادر على جميع المقدورات كيف لا يكون حياً، وهذا واضح والنظر في صفة الحياة لا يطول. الصفة الرابعة الإرادة ندعي أن الله تعالى مريد لأفعاله وبرهانه أن الفعل الصادر منه مختص بضروب من الجواز لا يتميز بعضها من البعض إلا بمرجح، ولا تكفي ذاته للترجيح، لأن نسبة الذات إلى الضدين واحدة فما الذي خصص أحد الضدين بالوقوع في حال دون حال؟ وكذلك القدرة لا تكفي فيه، إذ نسبة القدرة إلى الضدين واحدة، وكذلك العلم لا يكفي خلافاً للكعبي حيث اكتفى بالعلم عن الإرادة لأن العلم يتبع المعلوم ويتعلق به على ما هو عليه ولا يؤثر فيه ولا يغيره. فإن كان الشيء ممكناً في نفسه مساوياً للممكن الآخر الذي في مقابلته فالعلم يتعلق به على ما هو عليه ولا يجعل أحد الممكنين مرجحاً على الآخر، بل نعقل الممكنين ويعقل تساويهما، والله سبحانه وتعالى يعلم أن وجود العالم في الوقت الذي وجد فيه كان ممكناً، وأن وجوده بعد ذلك وقبل ذلك كان مساوياً له في الإمكان لأن هذه الامكانات متساوية، فحق العلم أن يتعلق بها كما هو عليه فإن اقتضت صفة الإرادة
وقوعه في وقت معين تعلق العلم بتعيين وجوده في ذلك الوقت لعلة تعلق الارادة به فتكون الإرادة للتعيين علة ويكون العلم متعلقاً به تابعاً له غير مؤثر فيه، ولو جاز أن يكتفى بالعلم عن الارادة لاكتفي به عن القدرة، بل كان ذلك يكفي في وجود أفعالنا حتى لا نحتاج إلى الإرادة، إذ يترجح أحد الجانبين بتعلق علم الله تعالى به وكل ذلك محال. فإن قيل: وهذا ينقلب عليكم في نفس الارادة، فإن القدرة كما لا تناسب أحد الضدين فالارادة القديمة أيضاً لا تتعين لأحد الضدين، فاختصاصها بأحد الضدين ينبغي أن يكون بمخصص ويتسلسل ذلك إلى غير نهاية، إذ يقال الذات لا تكفي للحدوث، إذ لو حدث من الذات لكان مع الذات غير متأخر فلا بد من القدرة والقدرة لا تكفي إذ لو كان للقدرة لما اختص بهذا الوقت وما قبله وما بعده في النسبة إلى جواز تعلق القدرة بها على وتيرة، فما الذي خصص هذا الوقت فيحتاج إلى الارادة؟ فيقال: والارادة لا تكفي، فإن الإرادة القديمة عامة التعلق كالقدرة، فنسبتها إلى الأوقات واحدة ونسبتها إلى الضدين واحدة، فإن وقع الحركة مثلاً بدلاً عن السكون لأن الارادة تعلقت بالحركة لا بالسكون. فيقال: وهل كان يمكن أن يتعلق بالسكون؟ فإن قيل: لا، فهو محال؛ وإن قيل: نعم، فهما متساويان؛ أعني الحركة والسكون في مناسبة الإرادة القديمة فما الذي أوجب تخصيص الإرادة القديمة بالحركة دون السكون فيحتاج إلى مخصص ثم يلزم السؤال في مخصص المخصص ويتسلسل إلى غير نهاية.. قلنا: هذا سؤال غير معقول حير عقول الفرق ولم يوفق للحق إلا أهل السنة فالناس فيه أربع فرق:
قائل يقول إن العالم وجد لذات الله سبحانه وتعالى وإنه ليس للذات صفة زائدة البتة، ولما كان الذات قديمة كان العالم قديماً وكانت نسبة العالم إليه كنسبة المعلول إلى العلة، ونسبة النور إلى الشمس، والظل إلى الشخص؛ وهؤلاء هم الفلاسفة. وقائل يقول إن العالم حادث ولكن حدث في الوقت الذي حدث فيه لا قبله ولا بعده لإرادة حادثة حدثت له لا في محل فاقتضت حدوث العالم، وهؤلاء هم المعتزلة. وقائل يقول حدث بإرادة حادثة حدثت في ذاته، وهؤلاء هم القائلون بكونه محلاً للحوادث. وقائل يقول حدث العالم في الوقت الذي تعلقت الارادة القديمة بحدوثه في ذلك الوقت، من غير حدوث إرادة ومن غير تغير صفة القديم، فانظر إلى الفرق وانسب مقام كل واحد إلى الآخر، فإنه لا ينفك فريق عن إشكال لا يمكن حله إلا إشكال أهل السنة فإنه سريع الانحلال. أما الفلاسفة فقد قالوا بقدم العالم، وهو محال، لأن الفعل يستحيل أن يكون قديماً؛ إذ معنى كونه فعلاً أنه لم يكن ثم كان، فإن كان موجوداً مع الله أبداً فكيف يكون فعلاً؟ بل يلزم من ذلك دورات لا نهاية لها على ما سبق، وهو محال من وجوه، ثم إنهم مع اقتحام هذا الإشكال لم يتخلصوا من أصل السؤال وهو أن الإرادة لم تعلقت بالحدوث في وقت مخصوص لا قبله ولا بعده، مع تساوي نسب الأوقات إلى الإرادة، فإنهم إن تخلصوا عن خصوص الوقت لم يتخلصوا عن خصوص الصفات، إذ العالم مخصوص بمقدار مخصوص ووضع مخصوص، وكانت نقايضها ممكنة في العقل، والذات القديمة لا تناسب بعض الممكنات دون بعض، ومن أعظم ما يلزمهم فيه، ولا عذر لهم عنه أمران أوردناهما في كتاب تهافت الفلاسفة ولا محيص لهم عنهما البتة: أحدهما، أن حركات الأفلاك بعضها مشرقية أي من المشرق إلى المغرب، وبعضها مغربية أي من مغرب الشمس إلى المشرق، وكان عكس ذلك في الإمكان مساوياً له، إذ الجهات في الحركات متساوية، فكيف لزم من الذات القديمة أو من دورات الأفلاك وهي قديمة عندهم أن تتعين جهة عن جهة تقابلها وتساويها من كل وجه؟ وهذا لا جواب عنه. الثاني، أن الفلك الأقصى الذي هو الفلك التاسع عندهم المحرك لجميع السماوات بطريق القهر في اليوم والليلة مرة واحدة يتحرك على قطبين شمالي وجنوبي، والقطب عبارة عن النقطتين المتقابلتين على الكرة الثابتتين عند حركة الكرة
على نفسها، والمنطقة عبارة عن دائرة عظيمة على وسط الكرة بعدها من النقطتين واحد. فنقول: جرم الفلك الأقصى متشابه، وما من نقطة إلا ويتصور أن تكون قطباً. فما الذي أوجب تعيين نقطتين من بين سائر النقط التي لا نهاية لها عندهم، فلا بد من وصف زائد على الذات من شأنه تخصيص الشيء عن مثله وليس ذلك إلا الإرادة. وقد استوفينا تحقيق الالتزامين في كتاب التهافت. وأما المعتزلة فقد اقتحموا أمرين شنيعين باطلين: أحدهما، كون الباري تعالى مريداً بإرادة حادثة لا في محل، وإذا لم تكن الإرادة قائمة به فقول القائل إنه مريدها هجر من الكلام، كقوله إنه مريد بإرادة قائمة بغيره. والثاني، أن الإرادة لم حدثت في هذا الوقت على الخصوص، فإن كانت بإرادة أخرى فالسؤال في الإرادة الأخرى لازم، ويتسلسل إلى غير نهاية، وإن كان ليس بإرادة فليحدث العالم في هذا الوقت على الخصوص لا بارادة، فإن افتقار الحادث إلى الارادة لجوازه لا لكونه جسماً أو اسماً أو إرادة أو علماً. والحادثات في هذا متساوية، ثم لم يتخلصوا من الإشكال إذ يقال لهم لم حدثت الإرادة في هذا الوقت على الخصوص ولم حدثت إرادة الحركة دون إرادة السكون، فإن عندهم يحدث لكل حادث إرادة حادثة متعلقة بذلك الحادث فلم لم تحدث إرادة تتعلق بضده؟ وأما الذين ذهبوا إلى حدوث الإرادة في ذاته تعالى لا متعلقة بذلك الحادث فقد دفعوا أحد الإشكالين وهو كونه مريداً بإرادة في غير ذاته ولكن زادوا إشكالاً آخر وهو كونه محلاً للحوادث، وذلك يوجب حدوثه. ثم قد بقيت عليهم بقية الإشكال ولم يتخلصوا من السؤال. وأما أهل الحق فإنهم قالوا إن الحادثات تحدث بإرادة قديمة تعلقت بها فميزتها عن أضدادها المماثلة لها، وقول القائل إنه لم تعلقت بها وأضدادها مثلها في الامكان، هذا سؤال خطأ فإن الإرادة ليست إلا عبارة عن صفة شأنها تمييز الشيء على مثله. فقول القائل لم ميزت الإرادة الشيء عن مثله، كقول القائل لم أوجب العلم انكشاف المعلوم، فيقال: لا معنى للعلم إلا ما أوجب انكشاف المعلوم، فقول القائل لم أوجب الانكشاف كقوله لم كان العلم علماً، ولم كان الممكن ممكناً، والواجب واجباً، وهذا محال؛ لأن العلم علم لذاته وكذا الممكن والواجب وسائر الذوات، فكذلك الإرادة وحقيقتها تمييز الشيء عن مثله.
فقول القائل لم ميزت الشيء عن مثله كقوله لم كانت الإرادة إرادة والقدرة قدرة، وهو محال، وكل فريق مضطر إلى اثبات صفة شأنها تمييز الشيء عن مثله وليس ذلك إلا الإرادة، فكان أقوم الفرق قيلاً وأهداهم سبيلاً من أثبت هذه الصفة ولم يجعلها حادثة، بل قال هي قديمة متعلقة بالأحداث في وقت مخصوص، فكان الحدوث في ذلك الوقت لذلك، وهذا ما لا يستغني عنه فريق من الفرق وبه ينقطع التسلسل في لزوم هذا السؤال. والآن فكما تمهد القول في أصل الإرادة فاعلم انها متعلقة بجميع الحادثات عندنا من حيث أنه ظهر أن كل حادث فمخترع بقدرته، وكل مخترع بالقدرة محتاج إلى ارادة تصرف القدرة إلى المقدور وتخصصها به، فكل مقدور مراد، وكل حادث مقدور، فكل حادث مراد والشر والكفر والمعصية حوادث، فهي إذاً لا محالة مرادة. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فهذا مذهب السلف الصالحين ومعتقد أهل السنة أجمعين وقد قامت عليه البراهين. وأما المعتزلة فإنهم يقولون إن المعاصي كلها والشرور حادثة بغير إرادته، بل هو كاره لها. ومعلوم أن أكثر ما يجري في العالم المعاصي فإذاً ما يكرهه أكثر مما يريده فهو إلى العجز والقصور أقرب بزعمهم، تعالى رب العالمين عن قول الظالمين. فإن قيل: فكيف يأمر بما لا يريد؟ وكيف يريد شيئاً وينهى عنه؟ وكيف يريد الفجور والمعاصي والظلم والقبيح ومريد القبيح سفيه؟ قلنا: إذا كشفنا عن حقيقة الأمر وبينا أنه مباين للإرادة وكشفنا عن القبيح والحسن وبينا أن ذلك يرجع إلى موافقة الأعراض ومخالفتها، وهو سبحانه منزه عن الأعراض فاندفعت هذه الإشكالات وسيأتي ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. الصفة الخامسة والسادسة في السمع والبصر ندعي ان صانع العالم سميع بصير، ويدل عليه الشرع والعقل. أما الشرع فيدل عليه آيات من القرآن كثيرة كقوله " وهو السميع البصير " وكقول إبراهيم عليه السلام لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يعني عنك شيئاً ونعلم أن الدليل غير منقلب عليه في معبوده وأنه كان يعبد سميعاً بصيراً ولا يشاركه في الإلزام. فإن قيل: إنما أريد به العلم. قلنا: إنما تصرف ألفاظ الشارع عن موضوعاتها المفهومة السابقة إلى الأفهام إذا كان يستحيل تقديرها على الموضوع، ولا استحالة في كونه سميعاً بصيراً، بل يجب أن
يكون كذلك، فلا معنى للتحكم بإنكار ما فهمه أهل الإجماع من القرآن. فإن قيل: وجه استالته إنه إن كان سمعه وبصره حادثين كان محلاً للحوادث، وهو محال، وإن كانا قديمين فكيف يسمع صوتاً معدوماً وكيف يرى العالم في الأزل والعالم معدوم والمعدوم لا يرى؟ قلنا: هذا السوال يصدر عن معتزلي أو فلسفي. أما المعتزلي فدفعه هين، فإنه سلم أنه يعلم الحادثات، فنقول: يعلم الله الآن إن العالم كان موجوداً قبل هذا فكيف علم في الأزل أنه يكون موجوداً وهو بعد لم يكن موجوداً؟ فإن جز إثبات صفة تكون عند وجود العالم علما بأنه كائن، وفعله بأنه سيكون وبعده بأنه كان وقبله بأنه سيكون، وهو لا يتغير عبر عنه بالعلم بالعالم والعلمية، جاز ذلك في السمع والسمعية والبصر والبصرية. وإن صدر من فلسفي فهو منكر لكونه عالماً بالحادثات المعينة الداخلة في الماضي والحال والمستقبل، فسبيلنا أن ننقل الكلام إلى العلم ونثبت عليه جواز علم قديم متعلق بالحادثات كما سنذكره، ثم إذا ثبت ذلك في العلم قسنا عليه السمع والبصر. وأما المسلك العقلي، فهو أن نقول: معلوم أن الخالق أكمل من المخلوق، ومعلوم أن البصير أكمل ممن لا يبصر، والسميع أكمل ممن لا يسمع، فيستحيل أن يثبت وصف الكمال للمخلوق ولا نثبته للخالق. وهذان أصلان يوجبان الإقرار بصحة دعوانا ففي أيهما النزاع؟ فإن قيل: النزاع في قولكم واجب أن يكون الخالق أكمل من المخلوق. قلنا: هذا مما يجب الاعتراف به شرعاً وعقلاً، والأمة والعقلاء مجمعون عليه، فلا يصدر هذا السؤال من معتقد. ومن اتسع عقله لقبول قادر يقدر على اختراع ما هو أعلى وأشرف منه فقد انخلع عن غريزة البشرية ونطق لسانه بما ينبو عن قبوله قلبه إن كان يفهم ما يقوله، ولهذا لا نرى عاقلاً يعتقد هذا الاعتقاد. فإن قيل: النزاع في الأصل الثاني، وقو قولكم إن البصير أكمل وإن السمع والبصر كمال. قلنا: هذا أيضاً مدرك ببديهة العقل، فإن العلم كمال والسمع والبصر كمال ثان للعلم، فإنا بينا أنه استكمال للعلم والتخيل، ومن علم شيئاً ولم يره ثم رآه استفاد مزيد كشف وكمال فكيف يقال إن ذلك حاصل للمخلوق وليس بحاصل للخالق أو يقال إن ذلك ليس بكمال، فإن لم يكن كمالاً فهو نقص أو لا هو نقص ولا هو كمال، وجميع هذه الأقسام محال، فظهر ان الحق ما ذكرناه.
فإن قيل: هذا يلزمكم في الإدراك الحاصل بالشم والذوق واللمس لأن فقدها نقصان ووجودها كمال في الإدراك، فليس كمال علم من علم الرائحة ككمال علم من أدرك بالشم، وكذلك بالذوق فأين العلم بالطعوم من إدراكها بالذوق. والجواب إن المحققين من أهل الحق صرحوا بإثبات أنواع الإدراكات مع السمع والبصر والعلم الذي هو كمال في الإدراك دون الأسباب التي هي مقترنة بها في العادة من المماسة والملاقاة، فإن ذلك محال على الله تعالى. كما جوزوا ادراك البصر من غير مقابلة بينه وبين المبصر، وفي طرد هذا القياس دفع هذا السؤال ولا مانع منه ولكن لما لم يرد الشرع إلا بلفظ العلم والسمع والبصر فلم يمكن لنا إطلاق غيره. وأما ما هو نقصان في الإدراك فلا يجوز في حقه تعالى البتة، فإن قيل يجر هذا إلى إثبات التلذذ والتألم، فالخدر الذي لا يتألم بالضرب ناقص، والعنين الذي لا يتلذذ بالجماع ناقص، وكذا فساد الشهوة نقصان، فينبغي أن نثبت في حقه شهوة، قلنا هذه الأمور تدل على الحدوث وهي في أنفسها إذا بحث عنها نقصانات، وهي محوجة إلى أمور توجب الحدوث، فالألم نقصان، ثم هو محوج إلى سبب هو ضرب، والضرب مماسة تجري بين الأجسام، واللذة ترجع إلى زوال الألم إذا حققت أو ترجع إلى درك ما هو محتاج إليه ومشتاق إليه، والشوق والحاجة نقصان، فالموقوف على النقصان ناقص، ومعنى الشهوة طلب الشيء الملائم ولا طلب إلا عند فقد المطلوب ولا لذة إلا عند نيل ما ليس بموجود، وكل ما هو ممكن وجوده لله فهو موجود فليس يفوته شيء حتى يكون بطلبه مشتهياً وبنيله ملتذاً، فلم تتصور هذه الأمور في حقه تعالى وإذا قيل إن فقد التألم والإحساس بالضرب نقصان في حق الخدر، وإن إدراكه كمال وإن سقوط الشهوة من معدته نقصان، وثبوتها كمال أريد به أنه كمال بالإضافة إلى ضده الذي هو مهلك في حقه، فصار كمالاً بالإضافة إلى الهلاك لأن النقصان خير من الهلاك فهو إذاً ليس كمالاً في ذاته بخلاف العلم وهذه الادراكات. الصفة السابعة الكلام ندعي أن صانع العالم متكلم كما أجمع عليه المسلمون، واعلم أن من أراد إثبات الكلام بأن العقل يقضي بجواز كون الخلق مرددين تحت الأمر والنهي وكل صفة جائزة في المخلوقات تستند إلى صفة واجبة في الخالق، فهو في شطط، إذ يقال له: إن أردت جواز كونهم مأمورين من جهة الخلق الذين يتصور منهم الكلام، فمسلم، وإن أردت جوازه على العموم من الخلق والخالق فقد أخذت محل النزاع مسلماً في نفس الدليل وهو غير مسلم، ومن أراد إثبات الكلام بالإجماع أو بقول الرسول فقد سام نفسه خطة خسف لأن الإجماع يستند إلى قول الرسول عليه السلام ومن أنكر كون
الباري متكلماً فبالضرورة ينكر تصور الرسول، إذ معنى الرسول المبلغ لرسالة المرسل، فإن لم يكن للكلام متصور في حق من ادعى أنه مرسل كيف يتصور الرسول؟ ومن قال أنا رسول الأرض أو رسول الجبل إليكم فلا يصغى إليه لاعتقادنا استحالة الكلام والرسالة من الجبل والأرض، ولله المثل الأعلى، ولكن من يعتقد استحالة الكلام في حق الله تعالى استحال منه أن يصدق الرسول إذ المكذب بالكلام لا بد أن يكذب بتبليغ الكلام، والرسالة عبارة عن تبليغ الكلام، والرسول عبارة عن المبلغ، فلعل الأقوم منهج ثالث وهو الذي سلكناه في اثبات السمع والبصر في أن الكلام للحي أما أن يقال هو كمال أو يقال هو نقص، أو يقال لا هو نقص ولا هو كمال، وباطل أن يقال هو نقص أو هو لا نقص ولا كمال فثبت بالضرورة أنه كمال، وكل كمال وجد للمخلوق فهو واجب الوجود للخالق بطريق الأولى كما سبق. فإن قيل: الكلام الذي جعلتموه منشأ نظركم هو كلام الخلق، وذلك إما أن يراد به الأصوات والحروف أو يراد به القدرة على ايجاد الأصوات والحروف في نفس القادر أو يراد به معنى ثالث سواهما، فإن أريد به الأصوات والحروف فهي حوادث ومن الحوادث ما هي كمالات في حقنا ولكن لا يتصور قيامها في ذات الله سبحانه وتعالى، وإن قام بغيره لم يكن هو متكلماً به بل كان المتكلم به المحل الذي قام به؛ وإن أريد به القدرة على خلق الأصوات فهو كمال ولكن المتكلم ليس متكلماً باعتبار قدرته على خلق الأصوات فقط بل باعتبار خلقه للكلام في نفسه، والله تعالى قادر على خلق الأصوات فله كمال القدرة ولكن لا يكون متكلماً به إلا إذا خلق الصوت في نفسه، وهو محال إذ يصير به محلاً للحوادث فاستحال أن يكون متكلماً؛ وإن أريد بالكلام أمر ثالث فليس بمفهوم وإثبات ما لا يفهم محال. قلنا: هذا التقسيم صحيح والسؤال في جميع أقسامه معترف به إلا في إنكار القسم الثالث، فإنا معترفون باستحالة قيام الأصوات بذاته وباستحالة كونه متكلماً بهذا الاعتبار. ولكنا نقول الإنسان يسمى متكلماً باعتبارين أحدهما بالصوت والحرف والآخر بكلام النفس الذي ليس بصوت وحرف، وذلك كمال وهو في حق الله تعالى غير محال، ولا هو دال على الحدوث. ونحن لا نثبت في حق الله تعالى إلا كلام النفس، وكلام النفس لا سبيل إلى إنكاره في حق الإنسان زائداً على القدرة والصوت حتى يقول الانسان زورت البارحة في نفسي كلاماً ويقال في نفس فلان كلام وهو يريد أن ينطق به ويقول الشاعر: لا يعجبنك من أثير خطه ... حتى يكون مع الكلام أصيلا إن الكلام لفي الفؤاد وإنما ... جعل اللسان على الفؤاد دليلاً
وما ينطق به الشعراء يدل على أنه من الجليات التي يشترك كافة الخلق في دركها فكيف ينكر. فإن قيل: كلام النفس بهذا التأويل معترف به ولكنه ليس خارجاً عن العلوم الإدراكات وليس جنساً برأسه البتة، ولكن ما يسميه الناس كلام النفس وحديث النفس هو العلم بنظم الألفاظ والعبارات وتأليف المعاني المعلومة على وجه مخصوص فليس في القلب إلا معاني معلومة وهي العلوم وألفاظ مسموعة هي معلومة بالسماع، وهو أيضاً علم معلوم اللفظ. وينضاف إليه تأليف المعاني والألفاظ على ترتيب. وذلك فعل يسمى فكراً وتسميه القدرة التي عنها يصدر الفعل قوة مفكرة. فإن أثبتم في النفس شيئاً سوى نفس الفكر الذي هو ترتيب الألفاظ والمعاني وتأليفها، وسوى القوة المفكرة التي هي قدرة عليا وسوى العلم بالمعاني مفترقها ومجموعها، وسوى العلم بالألفاظ المرتبة من الحروف مفترقها ومجموعها فقد أثبتم أمراً منكراً لا نعرفه. وإيضاحه أن الكلام إما أمر أو نهي أو خبر أو استخبار. أما الخبر فلفظ يدل على علم في نفس المخبر، فمن علم الشيء وعلم اللفظ الموضوع للدلالة على ذلك الشيء كالضرب مثلاً فإنه معنى معلوم يدرك بالحس، ولفظ الضرب الذي هو مؤلف من الضاد والراء والباء الذي وضعته العرب للدلالة على المعنى المحسوس وهي معرفة أخرى، فكان له قدرة على اكتساب هذه الأصوات بلسانه، وكانت له إرادة للدلالة وإرادة لاكتساب اللفظ ثم منه قوله ضرب ولم يفتقر إلى أمر زائد على هذه الأمور. فكل أمر قدرتموه سوى هذا فنحن نقدر نفيه، ويتم مع ذلك قولك ضرب ويكون خبراً وكلاماً، وأما الاستخبار فهو دلالة على أن في النفس طلب معرفة، وأما الأمر فهو دلالة على أن في النفس طلب فعل المأمور وعلى هذا يقاس النهي وسائر الأقسام من الكلام ولا يعقل أمر آخر خارج عن هذا وهذه الجملة، فبعضها محال عليه كالأصوات وبعضها موجود لله كالارادة والعلم والقدرة، وأما ما عدا هذا فغير مفهوم. والجواب أن الكلام الذي نريده معنى زائد على هذه الجملة ولنذكره في قسم واحد من أقسام الكلام وهو الأمر حتى لا يطول الكلام. فنقول: قول السيد لغلامه قم، لفظ يدل على معنى، والمعنى المدلول عليه في نفسه هو كلام، وليس ذلك شيئاً مما ذكرتموه، ولا حاجة إلى الإطناب في التقسيمات وإنما بتوهم رده ما أراد إلى الأمر أو إلى إرادة الدلالة ومحال أن يقال إنه إرادة الدلالة، لأن الدلالة تستدعي مدلولاً والمدلول غير الدليل وغير إرادة الدلالة، ومحال أن يقال إنه إرادة الآمر.. لأنه قد يأمر وهو لا يريد الامتثال بل يكرهه، كالذي يعتذر
عند السلطان الهام بقتله توبيخاً له على ضرب غلامه، بأنه إنما ضربه لعصيانه، وآيته أنه يأمره بين يدي الملك فيعصيه، فإذا أراد الاحتجاج به وقال للغلام بين يدي الملك قم فإني عازم عليك بأمر جزم لا عذر لك فيه ولا يريد أن تقوم فهو في هذا الوقت آمر بالقيام قطعاً، وهو غير مريد للقيام قطعاً، فالطلب الذي قام بنفسه الذي دل لفظ الأمر عليه هو الكلام وهو غير إرادة القيام وهذا واضح عند المصنف. فإن قيل هذا الشخص ليس بآمر على الحقيقة ولكنه موهم أنه أمر، قلنا: هذا باطل من وجهين: أحدهما، أنه لو لم يكن آمراً لما تمهد عذره عند الملك ولقيل له أنت في هذا الوقت لا يتصور منك الأمر لأن الأمر هو طلب الامتثال ويستحيل أن تريد الآن الامتثال وهو سبب هلاكك، فكيف تطمع في أن تحتج بمعصيتك لأمرك وأنت عاجز عن أمره إذ أنت عاجز عن إرادة ما فيه هلاكك وفي امتثاله هلاكك؟ ولا شك في أنه قادر على الاحتجاج وأن حجته قائمة وممهدة لعذره، وحجته بمعصية الأمر، فلو تصور الأمر مع تحقق كراهة الامتثال لما تصور احتجاج السيد بذلك البتة، وهذا قاطع في نفسه لمن تأمله. والثاني، هو أن هذا الرجل لو حكى الواقعة للمفتيين وحلف بالطلاق الثلاث إني أمرت العبد بالقيام بين يدي الملك بعد جريان عقاب الملك فعصى، لأفتى كل مسلم بأن طلاقه غير واقع وليس للمفتي أن يقول أنا أعلم أن يستحيل أن تريد في مثل هذا الوقت امتثال الغلام وهو سبب هلاكك، والأمر هو إرادة الامتثال فإذا ما أمرت هذا لو قاله المفتي فهو باطل بالاتفاق، فقد انكشف الغطاء ولاح وجود معنى هو مدلول اللفظ زائداً على ما عداه من المعاني، ونحن نسمي ذلك كلاماً وهو جنس مخالف للعلوم والإرادات والاعتقادات، وذلك لا يستحيل ثبوته لله تعالى بل يجب ثبوته فإنه نوع كلام فإذا هو المعني بالكلام القديم. وأما الحروف فهي حادثة وهي دلالات على الكلام والدليل غير المدلول ولا يتصف بصفة المدلول، وإن كانت دلالته ذاتية كالعالم فإنه حادث ويدل على صانع قديم فمن أين يبعد أن تدل حروف حادثة على صفة قديمة مع أن هذه دلالة بالاصطلاح؟ ولما كان كل كلام النفس دقيقاً زل عى ذهن أكثر الضعفاء فلم يثبتوا إلا حروفاً وأصواتاً ويتوجه لهم على هذا المذهب أسئلة واستبعادات نشير إلى بعضها ليستدل بها على طريق الدفع في غيرها. الاستبعاد الأول: قول القائل كيف سمع موسى كلام الله تعالى؛ أسمع صوتاً وحرفاً؟ فإن قلتم ذلك فإذا لم يسمع كلام الله فإن كلام الله ليس بحرف، وإن لم
يسمع حرفاً ولا صوتاً فكيف يسمع ما ليس بحرف ولا صوت؟ قلنا: سمع كلام الله تعالى وهو صفة قديمة قائمة بذات الله تعالى ليس بحرف ولا صوت، فقولكم كيف سمع كلام الله تعالى كلام من لا يفهم المطلوب من سؤال كيف، وإنه ماذا يطلب به وبماذا يمكن جوابه فلتفهم ذلك حتى تعرف استحالة السؤال. فنقول: السمع نوع إدراك، فقول القائل كيف سمع كقول القائل كيف أدركت بحاسة الذوق حلاوة السكر، وهذا السؤال لا سبيل إلى شفائه إلا بوجهين أحدهما أن نسلم سكراً إلى هذا السائل حتى يذوقه ويدرك طعمه وحلاوته، فنقول أدركت أنا كما أدركته أنت الآن وهذا هو الجواب الشافي والتعريف التام. والثاني أن يتعذر ذلك إما لفقد السكر أو لعدم الذوق في السائل للسكر، فنقول: أدركت طعمه كما أدركت أنت حلاوة العسل فيكون هذا جواباً صواباً من وجه وخطأ من وجه. أما وجه كونه صواباً فإنه تعريف بشيء يشبه المسؤول عنه من وجه، وإن كان لا يشبهه من كل الوجوه وهو أصل الحلاوة، فإن طعم العسل يخالف طعم السكر وإن قاربه من بعض الوجوه وهو أصل الحلاوة، وهذا غاية الممكن. فإن لم يكن السائل قد ذاق حلاوة شيء أصلاً تعذر جوابه وتفهيم ما سأل عنه وكان كالعنين يسأل عن لذه الجماع وقط ما أدركه فيمتنع تفهيمه، إلا أن نشبهه له الحالة التي يدركها المجامع بلذة الأكل فيكون خطأ من وجه إذ لذة الجماع والحالة التي يدركها المجامع لا تساوي الحالة التي يدركها الآكل إلا من حيث أن عموم اللذة قد شملها فإن لم يكن قد التذ بشيء قط تعذر أصل الجواب. وكذلك من قال كيف سمع كلام الله تعالى فلا يمكن شفاؤه في السؤال إلا بأن نسمعه كلام الله تعالى القديم وهو متعذر، فإن ذلك من خصائص الكليم عليه السلام، فنحن لا نقدر على إسماعه أو تشبيه ذلك بشيء من مسموعاته وليس في مسموعاته ما يشبه كلام الله تعالى، فإن كل مسموعاته التي ألفها أصوات والأصوات لا تشبه ما ليس بأصوات فيتعذر تفهيمه، بل الأصم لو سأل وقال كيف تسمعون أنتم الأصوات وهو ما سمع قط صوتاً لم نقدر على جوابه، فإنا إن قلنا كما تدرك أنت المبصرات فهو إدراك في الاذن كإدراك البصر في العين كان هذا خطأ، فإن إدراك الأصوات لا يشبه إبصار الألوان، فدل أن هذا السؤال محال بل لو قال القائل كيف يرى رب الأرباب في الآخرة، كان جوابه محالاً لا محالة لأنه يسأل عن كيفية ما لا كيفية له، إذ معنى قول القائل كيف هو أي مثل أي شيء هو مما عرفناه، فإن كان ما يسأل عنه غير مماثل لشيء مما عرفه، كان الجواب محالاً ولم يدل ذلك على عدم ذات الله تعالى، فكذلك تعذر هذا لا يدل على عدم كلام الله تعالى بل ينبغي أن يعتقد أن كلامه سبحانه
صفة قديمة ليس كمثلها شي، كما أن ذاته ذات قديمة ليس كمثلها شيء، وكما ترى ذاته رؤية تخالف رؤية الأجسام والأعراض ولا تشبهها فيسمع كلامه سماعاً يخالف الحروف والأصوات ولا يشبهها. الاستبعاد الثاني: أن يقال كلام الله سبحانه حال في المصاحف أم لا، فإن كان حالاً فكيف حمل القديم في الحادث؟ فإن قلتم لا، فهو خلاف الإجماع، إذ احترام المصحف مجمع عليه حتى حرم على المحدث مسه وليس ذلك إلا لأن فيه كلام الله تعالى. فنقول: كلام الله تعالى مكتوب في المصاحف محفوظ في القلوب مقروء بالألسنة، وأما الكاغد والحبر والكتابة والحروف والأصوات كلها حادثة لأنها أجسام وأعراض في أجسام فكل ذلك حادث. وإن قلنا إنه مكتوب في المصحف، أعني صفة تعالى القديم، لم يلزم أن تكون ذات القديم في المصحف، كما أنا إذا قلنا النار مكتوبة في الكتاب لم يلزم منه أن تكون ذات النار حالة فيه، إذ لو حلت فيه لاحترق المصحف، ومن تكلم بالنار فلو كانت ذات النار بلسانه لاحترق لسانه، فالنار جسم حار وعليه دلالة هي الأصوات المقطعة تقطيعاً يحصل منه النون والألف والراء، فالحار المحرق ذات المدلول عليه لا نفس الدلالة، فكذلك الكلام القديم القائم بذات الله تعالى هو المدلول لا ذات الدليل والحروف أدلة وللأدلة حرمة إذ جعل الشرع لها حرمة فلذلك وجب احترام المصحف لأن فيه دلالة على صفة الله تعالى.
الاستبعاد الثالث: إن القرآن كلام الله تعالى أم لا؟ فإن قلتم لا فقد خرقتم الإجماع، وإن قلتم نعم فما هو سوى الحروف والأصوات، ومعلوم أن قراءة القارئ هي الحروف والأصوات. فنقول: ها هنا ثلاثة ألفاظ: قراءة، ومقروء، وقرآن. أما المقروء فهو كلام الله تعالى، أعني صفته القديمة القائمة بذاته، وأما القراءة: فهي في اللسان عبارة عن فعل القارئ الذي كان ابتدأه بعد أن كان تاركاً له، ولا معنى للحادث إلا أنه ابتدأ بعد أن لم يكن، فإن كان الخصم لا يفهم هذا من الحادث فلنترك لفظ الحادث والمخلوق، ولكن نقول: القراءة فعل ابتدأه القارئ بعد أن لم يكن يفعله وهو محسوس. وأما القرآن، فقد يطلق ويراد به المقروء فإن أريد به ذلك فهو قديم غير مخلوق وهو الذي أراده السلف رضوان الله عليهم بقولهم القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق، أي المقروء بالألسنة، وإن أريد به القراءة التي هي فعل القارئ ففعل القارئ لا يسبق وجود القارئ وما لا يسبق وجود الحادث فهو حادث. وعلى الجملة: من يقول ما أحدثته باختياري من الصوت وتقطيعه وكنت ساكتاً عنه قبله فهو قديم، فلا ينبغي أن يخاطب ويكلف بل ينبغي أن يعلم المسكين أنه ليس يدري ما يقوله، ولا هو يفهم معنى الحرف، ولا هو يعلم معنى الحادث، ولو علمهما لعلم أنه في نفسه إذا كان مخلوقاً كان ما يصدر عنه مخلوقاً، وعلم أن القديم لا ينتقل إلى ذات حادثة. فلنترك التطويل في الجليات فإن قول القائل بسم الله إن لم تكن السين فيه بعد الباء لم يكن قرآناً بل كان خطأ، وإذا كان بعد غيره ومتأخراً عنه فكيف يكون قديماً ونحن نريد بالقديم ما لا يتأخر عن غيره أصلاً. الاستبعاد الرابع: قولهم: أجمعت الأمة على أن القرآن معجزة للرسول عليه السلام وأنه كلام الله تعالى، فإنه سور وآيات ولها مقاطع ومفاتح؟ وكيف يكون للقديم مقاطع ومفاتح؟ وكيف ينقسم بالسور والآيات؟ وكيف يكون القديم معجزة للرسول عليه السلام والمعجزة هي فعل خارق للعادة؟ وكل فعل فهو مخلوق فكيف يكون كلام الله تعالى قديماً؟ قلنا: أتنكرون أن لفظ القرآن مشترك بين القراءة والمقروء أم لا؟ فإن اعترفتم به فكل ما أورده المسلمون من وصف القرآن بما هو قديم، كقولهم القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق، أرادوا به المقروء وكل ما وصفوه به مما لا يحتمله القديم، ككونه سوراً وآيات ولها مقاطع ومفاتح، أرادوا به العبارات الدالة على الصفة القديمة التي هي قراءة، وإذا صار الاسم مشتركاً امتنع التناقض، فالاجماع منعقد على أن لا قديم إلا الله تعالى، والله تعالى يقول حتى عاد كالعرجون القديم. ولكن نقول:
اسم القديم مشترك بين معنيين، فإذا ثبت من وجه لم يستحل نفيه من وجه آخر، فكذا يسمى القرآن وهو جواب عن كل ما يوردونه من الإطلاقات المتناقضة فإن أنكروا كونه مشتركاً، فنقول: أما إطلاقه لإرادة المقروء دل عليه كلام السلف رضي الله عنهم إن القرآن كلام الله سبحانه غير مخلوق، مع علمهم بأنهم وأصواتهم وقراءاتهم وأفعالهم مخلوقة وأما إطلاقه لإرادة القراءة فقد قال الشاعر: ضحوا بأشمط عنوان السجود به ... يقطّع الليل تسبيحاً وقرآنا يعني القراءة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي حسن الترنم بالقرآن والترنم يكون بالقراءة. وقال كافة السلف: القرآن كلام الله غير مخلوق. وقالوا: القرآن معجزة، وهي فعل الله تعالى إذ علموا أن القديم لا يكون معجزاً فبان أنه اسم مشترك. ومن لم يفهم اشتراك اللفظ ظن تناقضاً في هذه الاطلاقات. الاستبعاد الخامس: أن يقال: معلوم أنه لا مسموع الآن إلا الأصوات، وكلام الله مسموع الآن بالإجماع وبدليل قوله تعالى " وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله " فنقول: إن كان الصوت المسموع للمشرك عند الإجارة هو كلام الله تعالى القديم القائم بذاته فأي فضل لموسى عليه السلام في اختصاصه بكونه كليماً لله على المشركين وهم يسمعون؟ ولا يتصور عن هذا جواب إلا أن نقول: مسموع موسى عليه السلام صفة قديمة قائمة بالله تعالى، ومسموع المشرك أصوات دالة على تلك الصفة. وتبين به على القطع الاشتراك إما في اسم الكلام وهو تسمية الدلالات باسم المدلولات، فإن الكلام هو كلام النفس تحقيقاً، ولكن الألفاظ لدلالتها عليه أيضاً تسمى كلاماً كما تسمى علماً؛ إذ يقال سمعت علم فلان وإنما نسمع كلامه الدال على علمه. وأما في اسم المسموع فإن المفهوم المعلوم بسماع غيره قد يسمى مسموعاً، كما يقال: سمعت كلام الأمير على لسان رسوله ومعلوم أن كلام الأمير لا يقوم بلسان رسوله بل المسموع كلام الرسول الدال على كلام الأمير. فهذا ما أردنا أن نذكره في إيضاح مذهب أهل السنة في كلام النفس المعدود من الغوامض، وبقية أحكام الكلام نذكرها عند التعرض لأحكام الصفات.
القسم الثاني من هذا القطب في أحكام الصفات عامة ما يشترك فيها أو يفترق وهي أربعة أحكام الحكم الأول إن الصفات السبعة التي دللنا عليها ليست هي الذات بل هي زائدة على الذات، فصانع العالم تعالى عندنا عالم بعلم وحي بحياة وقادر بقدرة، هكذا في جميع الصفات، وذهبت المعتزلة والفلاسفة إلى إنكار ذلك. وقالوا: القديم ذات واحدة قديمة ولا يجوز إثبات ذوات قديمة متعددة، وإنما الدليل يدل على كونه عالماً قادراً حياً لا على العلم والقدرة والحياة. ولنعين العلم من الصفات حتى لا نحتاج إلى تكرير جميع الصفات، وزعموا أن العلمية حال للذات وليست بصفة، لكن المعتزلة ناقضوا في صفتين إذ قالوا إنه مريد بإرادة زائدة على الذات ومتكلم بكلام هو زائد على الذات، إلا أن الإرادة يخلقها في غير محل والكلام يخلقه في جسم جماد ويكون هو المتكلم به. والفلاسفة طردوا قياسهم في الإرادة. وأما الكلام فإنهم قالوا إنه متكلم بمعنى أنه يخلق في ذات النبي عليه السلام سماع أصوات منظومة، إما في النوم وإما في اليقظة، ولا يكون لتلك الأصوات وجود من خارج البتة، بل في سمع النبي، كما يرى النائم أشخاصاً لا وجود لها، ولكن تحدث صورها في دماغه، وكذلك يسمع أصواتاً لا وجود لها حتى أن الحاضر عند النائم لا يسمع، والنائم قد يسمع، ويهوله الصوت الهائل ويزعجه وينتبه خائفاً مذعوراً. وزعموا أن النبي إذا كان عالي الرتبة في النبوة ينتهي صفاء نفسه إلى أن يرى في اليقظة صوراً عجيبة ويسمع منها أصواتاً منظومة فيحفظها، ومن حواليه لا يرون ولا يسمعون. وهذا المعني عندهم برؤيه الملائكة وسماع القرآن منهم، ومن ليس في الدرجة العالية في النبوة فلا يرى ذلك إلا في المنام. فهذا تفصيل مذاهب الضلال، والغرض إثبات الصفات والبرهان القاطع هو أن من ساعد على أنه تعالى عالم فقد ساعد على أن له علماً، فإن المفهوم من قولنا عالم ومن له علم واحد، فإن العاقل يعقل ذاتاً ويعقلها على حالة وصفة بعد ذلك، فيكون قد عقل صفة وموصوفاً والصفة علم مثلاً. وله عبارتان: إحداهما طويلة وهي أن نقول هذه الذات قد قام بها علم والأخرى وجيزة أوجزت بالتصريف والاشتقاق. وهي أن الذات عالمة كما نشاهد الانسان شخصاً ونشاهد نعلاً ونشاهد دخول رجله في النعل، فله عبارة طويلة
وهو أن نقول هذا الشخص رجله داخلة في نعله أو نقول هو منتعل ولا معنى لكونه منتعلاً إلا أنه ذو نعل وما يظن من أن قيام العلم بالذات يوجب للذات حالة تسمى عالمية، هوس محض، بل العلم هي الحالة، فلا معنى لكونه عالماً إلا كون الذات على صفة وحال تلك الصفة الحال وهي العلم فقط، ولكن من يأخذ المعاني من الألفاظ فلا بد أن يغلط. فإذا تكررت الألفاظ بالاشتقاقات فاشتقاق صفة العالم من لفظ العلم أورث هذا الغلط، فلا ينبغي أن يغتر به. وبهذا يبطل جميع ما قيل وطول من العلة والمعلول وبطلان ذلك جلي بأول العقل لمن لم يتكرر على سمعه ترديد تلك الألفاظ، ومن علق ذلك بفهمه فلا يمكن نزعه منه إلا بكلام طويل لا يحتمله هذا المختصر. والحاصل هو أنا نقول للفلاسفة والمعتزلة: هل المفهوم من قولنا عالم عين المفهوم من قولنا موجوداً وفيه إشارة إلى وجود وزيادة. فإن قالوا لا، فإذاً كل من قال هو موجود عالم، كأنه قال هو موجود وهذا ظاهر الاستحالة، وإذا كان في مفهومه زيادة فتلك الزيادة هل هي مختصة بذات الموجود أم لا؟ فإن قالوا لا فهو محال إذ يخرج به عن أن يكون وصفاً له وإن كان مختصاً بذاته فنحن لا نعني بالعلم إلا ذلك وهي الزيادة المختصة بالذات الموجودة الزائدة على الوجود التي يحسن أن يشتق للموجود بسببه منه اسم العالم، فقد ساعدتم على المعنى وعاد النزاع إلى اللفظ، وإن أردت إيراده على الفلاسفة قلت: مفهوم قولنا قادر مفهوم قولنا عالم أم غيره؟ فإن كان هو ذلك بعينه فكأنا قلنا قادر قادر، فإنه تكرار محض، وإن كان غيره فإذا هو المراد فقد أثبتم مفهومين أحدهما يعبر عنه بالقدرة والآخر بالعلم ورجع الإنكار إلى اللفظ. فإن قيل: قولكم أمر مفهومه عين المفهوم من قولكم آمر وناه ومخبر أو غيره، فإن كان عينه فهو تكرار محض، وإن كان غيره فليكن له كلام هو أمر وآخر هو نهي وآخر هو خبر. وليكن خطاب كل شيء مفارقاً لخطاب غيره. وكذلك مفهوم قولكم إنه عالم بالأعراض أهو عين مفهوم قولكم إنه عالم بالجواهر أو غيره؟ فإن كان عينه فليكن الإنسان العالم بالجوهر عالماً بالعرض بعين ذلك العلم، حتى يتعلق علم واحد بمتعلقات مختلفة لا نهاية لها، وإن كان غيره فليكن لله علوم مختلفة لا نهاية لها وكذلك الكلام والقدرة والإرادة وكل صفة لا نهاية لمتعلقاتها ينبغي أن لا يكون لأعداد تلك الصفة نهاية، وهذا محال، فإن جاز أن تكون صفة واحدة تكون هي الأمر وهي النهي وهي الخبر وتنوب عن هذه المختلفات جاز أن تكون صفة واحدة تنوب عن العلم والقدرة والحياة وسائر الصفات. ثم إذا جاز ذلك جاز أن تكون الذات بنفسها
كافية ويكون فيها معنى القدرة والعلم وسائر الصفات من غير زيادة وعند ذلك يلزم مذهب المعتزلة والفلاسفة. والجواب أن نقول: هذا السؤال يحرك قطباً عظيماً من اشكالات الصفات ولا يليق حلها بالمختصرات. ولكن إذا سبق القلم إلى إيراده فلنرمز إلى مبدأ الطريق في حله، وقد كع عنه أكثر المحصلين وعدلوا إلى التمسك بالكتاب والإجماع، وقالوا هذه الصفات قد ورد الشرع بها، إذ دل الشرع على العلم وفهم منه الواحد لا محالة والزائد على الواحد لم يرد فلا يعتقده. وهذا لا يكاد يشفي فإنه قد ورد بالأمر والنهي والخبر والتوراة والإنجيل والقرآن فما المانع من أن يقال: الأمر غير النهي والقرآن غير التوراة وقد ورد بأنه تعالى يعلم السر والعلانية والظاهر والباطن والرطب واليابس وهلم جرا إلى ما يشتمل القرآن عليه.. فلعل الجواب ما نشير إلى مطلع تحقيقه وهو أن كل فريق من العقلاء مضطر إلى أن يعترف بأن الدليل قد دل على أمر زائد على وجود ذات الصانع سبحانه، وهو الذي يعبر عنه بأنه عالم وقادر وغيره. والاحتمالات فيه ثلاثة: طرفان وواسطة، والاقتصاد أقرب إلى السداد. أما الطرفان فأحدهما في التفريط وهو الاقتصار على ذات واحدة تؤدي جميع هذه المعاني وتنوب عنها كما قالت الفلاسفة. والثاني طرف الإفراط وهو إثبات صفة لا نهاية لآحادها من العلوم والكلام والقدرة، وذلك بحسب عدد متعلقات هذه الصفات؛ وهذا إسراف لا صائر إليه إلا بعض المعتزلة وبعض الكرامية. والرأي الثالث هو القصد والوسط. وهو أن يقال: المختلفات لاختلافها درجات في التقارب والتباعد؛ فرب شيين مختلفين بذاتيهما كاختلاف الحركة والسكون واختلاف القدرة والعلم الجوهر والعرض، ورب شيئين يدخلان تحت حد وحقيقة واحدة ولا يختلفان لذاتيهما وإنما يكون الاختلاف فيهما من جهة تغاير التعلق؛ فليس الاختلاف بين القدرة والعلم كالاختلاف بين العلم بسواد والعلم بسواد آخر أو بياض آخر، ولذلك إذ حددت العلم تجد دخل فيه العلم بالمعلومات كلها، فنقول: الاقتصاد في الاعتقاد أن يقال: كل اختلاف يرجع إلى تباين الذوات بأنفسها فلا يمكن أن يكفي الواحد منها، وينوب عن المختلفات. فوجب أن يكون العلم غير القدرة وكذلك الحياة وكذا الصفات
السبعة، وأن تكون الصفات غير الذات من حيث أن المباينة بين الذات الموصوفة وبين الصفة أشد من المباينة بين الصفتين. وأما العلم بالشيء فلا يخالف العلم بغيره إلا من جهة تعلقه بالمتعلق، فلا يبعد أن تتميز الصفة القديمة بهذه الخاصية وهو أن لا يوجب تباين المتعلقات فيها تبايناً وتعدداً. فإن قيل فليس في هذا قع دابر الإشكال، لأنك إذ اعترفت باختلاف ما بسبب اختلاف المتعلق، فالإشكال قائم، فما لك وللنظر في سبب الاختلاف بعد وجود الاختلاف.. فأقول: غاية الناصر لمذهب معين أن يظهر على القطع ترجيح اعتقاده على اعتقاد غيره، وقد حصل هذا على القطع، إذ لا طريق إلا واحد من هذه الثلاث، أو اختراع رابع لا يعقل. وهذا الواحد إذا قوبل بطرفيه المتقابلين له علم على القطع رجحانه، وإذ لم يكن بد من اعتقاد ولا معتقد إلا هذه الثلاث، وهذا أقرب الثلاث، فيجب اعتقاده وإن بقي ما يحبك في الصدر من اشكال يلزم على هذا. واللازم على غيره أعظم منه وتعليل الإشكال ممكن إما قطعه بالكلية والمنظور فيه هي الصفات القديمة المتعالية عن افهام الخلق فهو أمر ممتنع إلا بتطويل لا يحتمله الكتاب، هذا هو الكلام العام. وأما المعتزلة فإنا نخصهم بالاستفراق بين القدرة والإرادة. ونقول لو جاز أن يكون قادراً بغير قدرة جاز أن يكون مريداً بغير إرادة ولا فرقان بينهما. فإن قيل: هو قادر لنفسه فلذلك كان قادراً على جميع المقدورات ولو كان مريداً لنفسه لكان مريداً لجملة المرادات، وهو محال، لأن المتضادات يمكن إرادتها على البدل لا على الجمع، وأما القدرة فيجوز أن تتعلق بالضدين. والجواب أن نقول: قولوا إنه مريد لنفسه ثم يختص ببعض الحادثات المرادات كما قلتم قادر لنفسه ولا تتعلق قدرته إلا ببعض الحادثات، فإن جملة أفعال الحيوانات والمتولدات خارجة عن قدرته وإرادته جميعاً عندكم، فإذا جاز ذلك في القدرة جاز في الإرادة أيضاً. وأما الفلاسفة فإنهم ناقضوا في الكلام وهو باطل من وجهين. أحدهما قولهم إن الله تعالى متكلم مع انهم لا يثبتون كلام النفس ولا يثبتون الأصوات في الوجود، وإنما يثبتون سماع الصوت بالحلق في اذن النبي من غير صوت من خارج. ولو جاز أن يكون ذلك بما يحدث في دماغ غيره موصوفاً بأنه متكلم لجاز أن يكون موصوفاً بأنه مصوت ومتحرك لوجود الصوت والحركة في غيره، وذلك محال،
والثاني أن ما ذكروه رد للشرع كله؛ فإن ما يدركه النائم خيال لا حقيقة له، فإذا رددت معرفة النبي لكلام الله تعالى إلى التخيل الذي يشبه اضغاث أحلام فلا يثق به النبي ولا يكون ذلك علماً. وبالجملة هؤلاء لا يعتقدون الدين والاسلام وإنما يتجملون بإطلاق عبارات احتراز من السيف والكلام معهم في أصل الفعل، وحدث العالم والقدرة فلا تشتغل معهم بهذه التفصيلات. فإن قيل أفتقولون إن صفات الله تعالى غير الله تعالى؟ قلنا: هذا خطأ فإنا إذا قلنا الله تعالى، فقد دللنا به على الذات مع الصفات لا على الذات بمجردها، إذ اسم الله تعالى لا يصدق على ذات قد أخلوها عن صفات الالهية، كما لا يقال الفقه غير الفقيه ويد زيد غير زيد ويد النجار غير النجار، لأن بعض الداخل في الاسم لا يكون عين الداخل في الاسم، فيد زيد ليس هو زيد ولا هو غير زيد بل كلا اللفظين محال، وهكذا كل بعض فليس غير الكل ولا هو بعينه الكل، فلو قيل الفقه غير الانسان فهو تجوز ولا يجوز أن يقال غير الفقيه، فإن الانسان لا يدل على صفة الفقه، فلا جرم يجوز أن يقال الصفة غير الذات التي تقوم بها الصفة، كما يقال العرض القائم بالجوهر هو غير الجوهر على معنى ان مفهوم اسمه غير مفهوم اسم الآخر، وهذا حصر جائز بشرطين: أحدهما، أن لا يمنع الشرع من اطلاقه، وهذا مختص بالله تعالى، والثاني، أن لا يفهم من الغير ما يجوز وجوده دون الذي هو غيره بالإضافات إليه، فإنه إن فهم ذلك لم يمكن أن يقال سواد زيد غير زيد، لأنه لا يوجد دون زيد، قد انكشف بهذا ما هو حظ المعنى وما هو حظ اللفظ فلا معنى للتطويل في الجليات. الحكم الثاني في الصفات: ندعي أن هذه الصفات كلها قائمة بذاته لا يجوز أن يقوم شيء منها بغير ذاته، سواء كان في محل أو لم يكن في محل. وأما المعتزلة فإنهم حكموا بأن الإرادة لا تقوم بذاته تعالى، فإنها حادثة وليس هو محلاً للحوادث، ولا يقوم بمحل آخر لأنه يؤدي إلى أن يكون ذلك المحل هو المريد به، فهي توجد لا في محل، وزعموا أن الكلام لا يقوم بذاته لأنه حادث ولكن يقوم بجسم هو جماد حتى لا يكون هو المتكلم به، بل المتكلم به هو الله سبحانه، أما البرهان على أن الصفات ينبغي أن تقوم بالذات فهو عند من فهم ما قدمناه مستغنى عنه، فإن الدليل لما دل على وجود الصانع سبحانه دل بعده على أن الصانع
تعالى بصفة كذا ولا نعني بأنه تعالى على صفة كذا، إلا أنه تعالى على تلك الصفة، ولا فرق بين كونه على تلك الصفة وبين قيام الصفة بذاته. وقد بينا أن مفهوم قولنا عالم واحد وبذاته تعالى علم واحد، كمفهوم قولنا مريد، وقامت بذاته تعالى إرادة واحدة، ومفهوم قولنا لم تقم بذاته إرادة وليس بمريد واحد. فتسميته الذات مريدة بإرادة لم تقم به كتسميته متحركاً بحركة لم تقم به. وإذا لم تقم الارادة بة فسواء كانت موجودة أو معدومة فقول القائل إنه مريد لفظ خطأ، لا معنى له، وهكذا المتكلم، فإنه متكلم باعتبار كونه محلاً للكلام، إذ لا فرق بين قولنا هو متكلم وبين قولنا قام الكلام به، ولا فرق بين قولنا ليس بمتكلم وقولنا لم يقم بذاته كلام، كما في كونه مصوتاً ومتحركاً. فإن صدق على الله تعالى قولنا لم يقم بذاته كلام صدق قولنا ليس بمتكلم لأنهما عبارتان عن معنى واحد. والعجب من قولهم إن الإرادة توجد لا في محل، فإن جاز وجود صفة من الصفات لا في محل فليجز وجود العلم والقدرة والسواد والحركة، بل الكلام فلم قالوا يخلق الأصوات في محل فلتخلق في غير محل. وإن لم يعقل الصوت إلا في محل لأنه عرض وصفة فكذا الارادة. ولو عكس هذا لقيل إنه خلق كلاماً لا في محل وخلق إرادة في محل لكان العكس كالطرد. ولكن لما كان أول المخلوقات يحتاج إلى الإرادة، والمحل مخلوق، لم يمكنهم تقدير محل الارادة موجوداً قبل الإرادة؛ فإنه لا محل قبل الإرادة إلا ذات الله تعالى ولم يجعلوه محلاً للحوادث. ومن جعله محلاً للحوادث أقرب حال منهم فإن استحالة وجود إرادة في غير محل، واستحالة كونه مريداً بإرادة لا تقوم به، واستحالة حدوث إرادة حادثة به بلا إرادة تدرك ببديهة العقل أو نظره الجلي فهذه ثلاثة استحالات جلية. واما استحالة كونه محلاً للحوادث فلا يدرك إلا بنظر دقيق كما سنذكر. الحكم الثالث إن الصفات كلها قديمة، فإنها إن كانت حادثة كان القديم سبحانه محلاً للحوادث، وهو محال. أو كان يتصف بصفة لا تقوم به وذلك أظهر استحالة، كما سبق، ولم يذهب أحد إلى حدوث الحياة والقدرة وإنما اعتقدوا ذلك في العلم بالحوادث وفي الإرادة وفي الكلام ونحن نستدل على استحالة كونه محلاً للحوادث من ثلاثة أوجه: الدليل الأول: إن كل حادث فهو جائز الوجود، والقديم الأزلي واجب الوجود، ولو تطرق الجواز إلى صفاته لكان ذلك مناقضاً لوجوب وجوده فإن الجواز والوجوب يتناقضان. فكل ما هو واجب الذات فمن المحال أن يكون جائز
الصفات وهذا واضح بنفسه. الدليل الثاني: وهو الأقوى، أنه لو قدر حلول حادث بذاته لكان لا يخلو إما أن يرتقي الوهم إلى حادث يستحيل قبله حادث، أو لا يرتقي إليه، بل كان حادث، فيجوز أن يكون قبله حادث، فإن لم يرتق الوهم إليه لزم جواز اتصافه بالحوادث أبداً، ولزم منه حوادث لا أول لها. وقد قام الدليل على استحالته. وهذا القسم ما ذهب إليه أحد من العقلاء وإن ارتقى الوهم إلى حادث استحال قبله حدوث حادث فتلك الاستحالة لقبول الحادث في ذاته، لا تخلو إما أن تكون لذاته أو لزائد عليه. وباطل أن يكون لزائد عليه، فإن كل زائد يفرض ممكن تقدير عدمه، فيلزم منه تواصل الحوادث أبداً وهو محال، فلم يبق إلا أن استحالته من حيث أن واجب الوجود يكون على صفة يستحيل معها قبول الحوادث لذاته. فإذا كان ذلك مستحيلاً في ذاته أزلاً. فإن ذلك يبقى فيما لا يزال لأنه لذاته لا يقبل اللون باتفاق العقلاء. ولم يجز أن تتغير تلك الاستحالة إلى الجواز فكذلك سائر الحوادث. فإن قيل: هذا يبطل يحدث العالم، فإنه كان ممكناً قبل حدوثه ولم يكن الوهم يرتقي إلى وقت يستحيل حدوثه قبله ومع ذلك يستحيل حدوثه أزلاً ولم يستحل على الجملة حدوثه. قلنا هذا الإلزام فاسد؛ فإنا لم نحل إثبات ذات تنبو عن قبول حادث لكونها واجبة الوجود، ثم تتقلب إلى جواز قبول الحوادث. والعالم ليس له ذات قبل الحدوث موصوفة بأنها قابلة للحدوث أو غير قابلة حتى ينقلب إلى قبول جواز الحدوث، فيلزم ذلك على مساق دليلنا، نعم، يلزم ذلك المعتزلة حيث قالوا للعالم ذات في العدم قديمة، قابلة للحدوث، يطرأ عليها الحدوث بعد أن لم يكن، فأما على أصلنا فغير لازم، وإنما الذي نقوله في العالم أنه فعل وقدم الفعل محال، لأن القديم لا يكون فعلاً. الدليل الثالث: هو أنا نقول: إذا قدرنا قيام حادث بذاته فهو قبل ذلك إما أن يتصف بضد ذلك الحادث أو بالانفكاك عن ذلك الحادث. وذلك الضد أو ذلك الانفكاك إن كان قديماً استحال بطلانه وزواله لأن القديم لا يعدم وإن كان حادثاً كان قبله حادث لا محالة، وكذا قبل ذلك الحادث حادث يؤدي إلى حوادث لا أول لها وهو محال، ويتضح ذلك بأن تفرض في صفة معينة كالكلام مثلاً، فإن الكرامية قالوا إنه في الأزل متكلم، على معنى أنه قادر على خلق الكلام في ذاته. ومهما أحدث شيئاً في غير ذاته أحدث في ذاته قوله كن ولا بد أن يكون قبل إحداث هذا
القول ساكتاً، ويكون سكوته قديماً. وإذا قال جهم أنه يحدث في ذاته علماً فلا بد أن يكون قبله غافلاً وتكون غفلته قديمة. فنقول: السكوت القديم والغفلة القديمة يستحيل بطلانهما لما سبق من الدليل على استحالة عدم القديم. فإن قيل السكوت ليس بشيء إنما يرجع إلى عدم الكلام، والغفلة ترجع إلى عدم العلم والجهل وأضداده، فإذا وجد الكلام لم يبطل شيء إذ لم يكن شيء إلا الذات القديمة، وهي باقية، ولكن انضاف إليها موجود آخر وهو الكلام والعلم. فأما أن يقال: انعدم شيء فلان ويتنزل ذلك منزلة وجود العالم، فإنه يبطل العدم القديم ولكن العدم ليس بشيء حتى يوصف بالقدم ويقدر بطلانه. والواجب من وجهين أحدهما أن قول القائل السكوت هو عدم الكلام وليس بصفة والغفلة عدم العلم وليست بصفة، كقوله البياض هو عدم السواد وسائر الألوان وليس بلون. والسكون هو عدم الحركة وليس بعرض، وذلك محال. والدليل الذي دل على استحالته بعينه يدل على استحالة هذا، والخصوم في هذه المسألة معترفون بأن السكون وصف زائد على عدم الحركة، فإن كل من يدعي أن السكون هو عدم الحركة لا يقدر على اثبات حدوث العالم. فظهور الحركة بعد السكون إذاً دل على حدوث المتحرك، فكذلك ظهور الكلام بعد السكوت يدل على حدوث المتكلم، من غير فرق. إذ المسلك الذي به يعرف كون السكون معنى هو مضاد للحركة بعينه يعرف به كون السكوت معنى يضاد الكلام، وكون الغفلة معنى يضاد العلم، وهو أنا إذا أدركنا تفرقة بين حالتي الذات الساكنة والمتحركة فإن الذات مدركة على الحالتين. والتفرقة مدركة بين الحالتين ولا نرجع التفرقة إلى زوال أمر وحدوث أمر فإن الشيء لا يفارق نفسه، فدل ذلك على أن كل قابل للشيء فلا يخلو عنه، أو عن ضده وهذا مطرد في الكلام، وفي العلم. ولا يلزم على هذا الفرق بين وجود العلم وعدمه، فإن ذلك لا
يوجب ذاتين. فإنه لم تدرك في الحالتين ذات واحدة يطرأ عليها الوجود بل لا ذات للعالم قبل الحدوث، والقديم ذات قبل حدوث الكلام، علم على وجه مخالف للوجه الذي علم عليه بعد حدوث الكلام، يعبر عن ذلك الوجه بالسكوت وعن هذا بالكلام، فهما وجهان مختلفان أدركت عليهما ذات مستمرة الوجود في الحالتين وللذات هيئة وصفة وحالة بكونه ساكتاً، كما أن له هيئة بكونه متكلماً، وكما له هيئة بكونه ساكتاً ومتحركاً وأبيض وأسود وهذه الموازنة مطابقة لا مخرج منها. الوجه الثاني في الانفصال هو أن يسلم أيضاً أن السكوت ليس بمعنى، وإنما يرجع ذلك إلى ذات منفكة عن الكلام، فالانفكاك عن الكلام حال للمنفك لا محالة ينعدم بطريان الكلام، فحال الانفكاك تسمى عدماً أو وجوداً أو صفة أو هيئة، فقد انتفى الكلام والمنتفي قديم. وقد ذكرنا أن القديم لا ينتفي سواء كان ذاتاً أو حالاً أو صفة، وليست الاستحالة لكونه ذاتاً فقط بل لكونه قديماً، ولا يلزم عدم العالم، فإنه انتفى مع القديم لأن عدم العالم ليس بذات ولا حصل منه حال لذات حتى يقدر تغيرها وتبدلها على الذات والفرق بينهما ظاهر. فإن قيل الأعراض كثيرة والخصم لا يدعي كون الباري محل حدوث شيء منها كالألوان والآلام واللذات وغيرها، وإنما الكلام في الصفات السبعة التي ذكرتموها ولا نزاع من جملتها في الحياة والقدرة، وإنما النزاع في ثلاثة: في القدرة والإرادة والعلم، وفي معنى العلم السمع والبصر عند من يثبتهما. وهذه الصفات الثلاثة لا بد أن تكون حادثة، ثم يستحيل أن تقوم بغيره، لأنه لا يكون متصفاً بها فيجب أن تقوم بذاته فيلزم منه كونه محلاً للحوادث. أما العلم بالحوادث فقد ذهب جهم إلى أنها علوم حادثة وذلك لأن الله تعالى الآن عالم بأن العالم كان قد وجد قبل هذا، وهو في الأزل إن كان عالماً بأنه كان قد وجد كان هذا جهلاً لا علماً، وإذا لم يكن عالماً بأنه قد وجد كان جهلاً لا علماً، وإذا لم يكن عالماً وهو الآن عالم فقد ظهر حدوث العلم بأن العالم كان قد وجد قبل هذا. وهكذا القول في كل حادث. وأما الإرادة فلا بد من حدوثها فإنها لو كانت قديمة لكان المراد معها. فإن القدرة والارادة مهما تمتا وارتفعت العوائق منها وجب حصول المراد، فكيف يتأخر المراد عن الإرادة والقدرة من غير عائق؟ فلهذا قالت المعتزلة بحدوث إرادة في غير محل وقالت الكرامية بحدوثها في ذاته وربما عبروا عنه بأنه يخلق ايجاداً في ذاته عند وجود كل موجود وهذا راجع إلى الارادة.
وأما الكلام فكيف يكون قديماً وفيه إخبار عما مضى، فكيف قال في الأزل " إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه " ولم يكن قد خلق نوحاً بعد، وكيف قال في الأزل لموسى " فاخلع نعليك " ولم يخلق بعد موسى، فكيف أمر ونهى من غير مأمور ولا منهي. وإذا كان ذلك محالاً ثم علم بالضرورة أنه آمر وناه، واستحال ذلك في القدم، علم قطعاً أنه صار آمراً ناهياً بعد أن لم يكن، فلا معنى لكونه محلاً للحوادث إلا هذا. والجواب أنا نقول: مهما حللنا الشبهة في هذه الصفات الثلاثة انتهض منه دليل مستقل على إبطال كونه محلاً للحوادث، إذ لم يذهب إليه ذاهب إلا بسبب هذه الشبهة، وإذا انكشف كان القول بها باطلاً كالقول بأنه محل للألوان وغيرها مما لا يدل دليل على الاتصاف بها. فنقول: الباري تعالى في الأزل علم بوجود العالم في وقت وجوده وهذا العلم صفة واحدة مقتضاها في الأزل العلم بأن العالم يكون من بعد، وعند الوجود العلم بأنه كائن وبعده العلم بأنه كان، وهذه الأحوال تتعاقب على العالم ويكون مكشوفاً لله تعالى تلك الصفة وهي لم تتغير. وإنما المتغير أحوال العالم، وإيضاحه بمثال وهو أنا إذا فرضنا للواحد منا علماً بقدوم زيد عند طلوع الشمس وحصل له هذا العلم قبل طلوع الشمس ولم ينعدم بل بقي ولم يخلق له علم آخر عند طلوع الشمس فما حال هذا الشخص عند الطلوع،. أيكون عالماً بقدوم زيد أو غير عالم؟ ومحال أن يكون غير عالم لأنه قدر بقاء العلم بالقدوم عند الطلوع، وقد علم الآن الطلوع فيلزمه بالضرورة أن يكون عالماً بالقدوم، فلو دام عند انقضاء الطلوع فلا بد أن يكون عالماً بأن كان قد قدم والعلم الواحد أفاد الاحاطة بأنه سيكون وإنه كائن وأنه قد كان فهكذا ينبغي أن يفهم علم الله القديم الموجب بالاحاطة بالحوادث، وعلى هذا ينبغي أن يقال السمع والبصر، فإن كل واحد منهما صفة يتصف بها المرئي والمسموع عند الوجود من غير حدوث تلك الصفة ولا حدوث أمر فيها، وإنما الحادث المسموع والمرئي. والدليل القاطع على هذا هو أن الاختلاف بين الأحوال شيء واحد في انقسامه إلى الذي كان ويكون وهو كائن لا يزيد على الاختلاف بين الذوات المختلفة. ومعلوم أن العلم لا يتعدد بتعدد الذوات فكيف يتعدد بتعدد أحوال ذات واحدة. وإذا كان علم واحد يفيد الإحاطة بذوات مختلفة متباينة فمن أين يستحيل أن يكون علم واحد يفيد إحاطة بأحوال ذات واحدة بالاضافة إلى الماضي والمستقبل، ولا شك أن جهماً ينفي النهاية عن معلومات الله تعالى ثم لا يثبت علوماً لا نهاية لها فيلزمه أن يعترف بعلم واحد يتعلق بمعلومات مختلفة فكيف يستبعد ذلك في أحوال معلوم واحد يحققه أنه لو حدث له علم بكل حادث لكان ذلك العلم لا يخلو إما أن
يكون معلوماً أو غير معلوم، فإن لم يكن معلوماً فهو محال، لأنه حادث، وإن جاز حادث لا يعلمه مع أنه في ذاته أولى بأن يكون متضحاً له فبان يجوز ألا يعلم الحوادث المباينة لذاته أولى، وإن كان معلوماً فإما أن يفتقر إلى علم آخر وكذلك العلم يفتقر إلى علوم أخر لا نهاية لها، وذلك محال. وإما أن يعلم الحادث والعلم بالحادث نفس ذلك العلم فتكون ذات العلم واحدة ولها معلومان: أحدهما ذات، والآخر ذات الحادث، فيلزم منه لا محالة تجويز علم واحد يتعلق بمعلومين مختلفين فكيف لا يجوز علم واحد يتعلق بأحوال معلوم واحد مع اتحاد العلم وتنزهه عن التغير، وهذا لا مخرج منه؛ فأما الإرادة فقد ذكرنا أن حدوثها بغير إرادة أخرى محال، وحدوثها بإرادة بتسلسل إلى غير نهاية، وإن تعلق الإرادة القديمة بالأحداث غير محال. ويستحيل أن تتعلق الإرادة بالقديم فلم يكن العالم قديماً لأن الإرادة تعلقت باحداثه لا بوجوده في القدم. وقد سبق إيضاح ذلك. وكذلك الكرامي إذا قال يحدث في ذاته إيجاداً في حال حدوث العالم بذلك يحصل حدوث العالم في ذلك الوقت، فيحتاج إلى مخصص آخر فيلزمهم في الإيجاد ما لزم المعتزلة في الإرادة الحادثة، ومن قال منهم إن ذلك الإيجاد هو قوله كن، وهو صوت، فهو محال من ثلاثة أوجه، أحدها: استحالة قيام الصوت بذاته، والآخر: أن قوله كن حادث أيضاً، فإن حدث من غير أن يقول له كن فليحدث العالم من غير أن يقال له كن، فإن افتقر قوله كن في أن يكون، إلى قول آخر، افتقر القول الآخر إلى ثالث، والثالث إلى رابع، ويتسلسل إلى غير نهاية. ثم لا ينبغي أن يناظر من انتهى عقله إلى أن يقول يحدث في ذاته بعدد كل حادث في كل وقت، قوله كن فيجتمع آلاف آلاف أصوات في كل لحظة. ومعلوم أن النون والكاف لا يمكن النطق بهما في وقت واحد بل ينبغي أن تكون النون بعد الكاف لأن الجمع بين الحرفين محال وإن جمع ولم يرتب لم يكن قولاً مفهوماً ولا كلاماً، وكما يستحيل الجمع بين حرفين مختلفين فكذلك بين حرفين متماثلين، ولا يعقل في أوان ألف ألف كاف كما لا يعقل الكاف والنون فهؤلاء حقهم أن يسترزقوا الله عقلاً وهو أهم لهم من الاشتغال بالنظر. والثالث: أن قوله كن خطاب مع العالم في حالة العدم أو في حالة الوجود، فإن كان في حالة العدم فالمعدوم لا يفهم الخطاب، فكيف يمتثل بأن يتكون بقوله كن؟ وإن كان في حالة الوجود فالكائن كيف يقال له كن؟ فانظر ماذا يفعل الله تعالى بمن ضل عن سبيله فقد انتهى ركاكة عقله إلى أن لا يفهم المعني بقوله تعالى " إذا أردناه أن نقول له كن فيكون " وأنه كناية عن نفاذ القدرة وكمالها حتى انجر بهم إلى هذه المخازي، نعوذ بالله من الخزي والفضيحة يوم الفزع الأكبر يوم تكشف الضمائر وتبلى السرائر فيكشف إذ ذاك ستر الله عن خبائث الجهال، ويقال للجاهل الذي اعتقد في الله تعالى وفي صفاته غير الرأي السديد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. انتهى عقله إلى أن يقول يحدث في ذاته بعدد كل حادث في كل وقت، قوله كن فيجتمع آلاف آلاف أصوات في كل لحظة. ومعلوم أن النون والكاف لا يمكن النطق بهما في وقت واحد بل ينبغي أن تكون النون بعد الكاف لأن الجمع بين الحرفين محال وإن جمع ولم يرتب لم يكن قولاً مفهوماً ولا كلاماً، وكما يستحيل الجمع بين حرفين مختلفين فكذلك بين حرفين متماثلين، ولا يعقل في أوان ألف ألف كاف كما لا يعقل الكاف والنون فهؤلاء حقهم أن يسترزقوا الله عقلاً وهو أهم لهم من الاشتغال بالنظر. والثالث: أن قوله كن خطاب مع العالم في حالة العدم أو في حالة الوجود، فإن كان في حالة العدم فالمعدوم لا يفهم الخطاب، فكيف يمتثل بأن يتكون بقوله كن؟ وإن كان في حالة الوجود فالكائن كيف يقال له كن؟ فانظر ماذا يفعل الله تعالى
بمن ضل عن سبيله فقد انتهى ركاكة عقله إلى أن لا يفهم المعني بقوله تعالى " إذا أردناه أن نقول له كن فيكون " وأنه كناية عن نفاذ القدرة وكمالها حتى انجر بهم إلى هذه المخازي، نعوذ بالله من الخزي والفضيحة يوم الفزع الأكبر يوم تكشف الضمائر وتبلى السرائر فيكشف إذ ذاك ستر الله عن خبائث الجهال، ويقال للجاهل الذي اعتقد في الله تعالى وفي صفاته غير الرأي السديد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وأما الكلام فهو قديم، وما استبعدوه من قوله تعالى " فاخلع نعليك " ومن قوله تعالى " إنا أرسلنا نوحاً " استبعاد مستنده تقديرهم الكلام صوتاً وهو محال فيه، وليس بمحال إذ فهم كلام النفس. فإنا نقول يقوم بذات الله تعالى خبر عن إرسال نوح العبارة عنه قبل إرساله: إنا نرسله، وبعد إرساله: إنا أرسلنا، واللفظ يختلف باختلاف الأحوال والمعنى القائم بذاته تعالى لا يختلف، فإن حقيقته أنه خبر متعلق بمخبر ذلك الخبر هو إرسال نوح في الوقت المعلوم وذلك لا يختلف باختلاف الأحوال كما سبق في العلم، وكذلك قوله اخلع نعليك لفظة تدل على الأمر والأمر اقتضاء وطلب يقوم بذات الأمر وليس شرط قيامه به أن يكون المأمور موجوداً ولكن يجوز أن يقوم بذاته قبل وجود المأمور، فإذا وجد المأمور كان مأموراً بذلك الاقتضاء بعينه من غير تحدد اقتضاء آخر. وكم من شخص ليس له ولد ويقوم بذاته اقتضاء طلب العلم منه على تقدير وجوده، إذ يقدر في نفسه أن يقول لولده اطلب العلم وهذا الاقتضاء يتنجز في نفسه على تقدير الوجود، فلو وجد الولد وخلق له عقل وخلق له علم بما في نفس الأب من غير تقدير صياغة لفظ مسموع، وقدر بقاء ذلك الاقتضاء على وجوده لعلم الابن أنه مأمور من جهة الأب بطلب العلم في غير استئناف اقتضاء متجدد في النفس، بل يبقى ذلك الاقتضاء نعم العادة جارية بأن الابن لا يحدث له علم إلا بلفظ يدل على الاقتضاء الباطن، فيكون قوله بلسانه أطلب العلم، دلالة على الاقتضاء الذي في ذاته سواء حدث في الوقت أو كان قديماً بذاته قبل وجود ولده. فهكذا ينبغي أن يفهم قيام الأمر بذات الله تعالى فتكون الألفاظ الدالة عليه حادثة والمدلول قديماً ووجود ذلك المدلول لا يستدعي وجود المأمور بل تصور وجوده مهما كان المأمور مقدر الوجود، فإن كان مستحيل الوجود ربما لا يتصور وجود الاقتضاء ممن يعلم استحالة وجوده. فلذلك لا نقول إن الله تعالى يقوم بذاته اقتضاء فعل ممن يستحيل وجوده، بل ممن علم وجوده، وذلك غير محال. فإن قيل أفتقولون إن الله تعالى في الأزل آمر وناه، فإن قلتم أنه آمر فكيف يكون آمر لا مأمور له؟ وإن قلتم لا فقد صار آمراً بعد أن لم يكن.
قلنا: واختلف الأصحاب في جواب هذا، والمختار أن تقول هذا نظر يتعلق أحد طرفيه بالمعنى والآخر بإطلاق الاسم من حيث اللغة. فأما حظ المعنى فقد انكشف وهو أن الاقتضاء القديم معقول وإن كان سابقاً على وجود المأمور كما في حق الولد ينبغي أن يقال اسم الأمر ينطلق عليه بعد فهم المأمور ووجوده أم ينطلق عليه قبله؟ وهذا أمر لفظي لا ينبغي للناظر أن يشتغل بأمثاله، ولكن الحق أنه يجوز اطلاقه عليه كما جوزوا تسمية الله تعالى قادراً قبل وجود المقدور، ولم يستبعدوا قادراً ليس له مقدور موجود بل قالوا القادر يستدعي مقدوراً معلوماً لا موجوداً فكذلك الآمر يستدعي مأموراً معلوماً موجوداً والمعدوم معلوم الوجود قبل الوجود، بل يستدعي الأمر مأموراً به كما يستدعي مأموراً ويستدعي آمراً أيضاً والمأمور به يكون معدوماً ولا يقال إنه كيف يكون آمر من غير مأمور به، بل يقال له مأمور به هو معلوم وليس يشترط كونه موجوداً، بل يشترط كونه معدوماً بل من أمر ولده على سبيل الوصية بأمر ثم توفي فأتى الولد بما أوصي به يقال امتثل أمر والده والأمر معدوم والأمر في نفسه معدوم ونحن مع هذا نطلق اسم امتثال الأمر، فإذا لم يستبعد كون المأمور ممتثلاً للأمر ولا وجود للأمر ولا للآمر ولم يستبعد كون الأمر أمراً قبل وجود المأمور به، فمن أين يستدعي وجود المأمور؟ فقد انكشف من هذا حظ اللفظ والمعنى جميعاً ولا نظر إلا فيهما. فهذا ما أردنا أن نذكره في استحالة كونه محلاً للحوادث إجمالاً وتفصيلاً. الحكم الرابع إن الأسامي المشتقة لله تعالى من هذه الصفات السبعة صادقة عليه أزلاً وأبداً، فهو في القدم كان حياً قادراً عالماً سميعاً بصيراً متكلماً، وأما ما يشتق له من الأفعال كالرازق والخالق والمعز والمذل فقد اختلف في أنه يصدق في الأزل أم لا. وهذا إذا كشف الغطاء عنه تبين استحالة الخلاف فيه. والقول الجامع أن الأسامي التي يسمى بها الله تعالى أربعة: الأول: أن لا يدل إلا على ذاته كالموجود، وهذا صادق أزلاً وأبداً. الثاني: ما يدل على الذات مع زيادة سلب كالقديم، فإنه يدل على وجود غير مسبوق بعدم أزلاً، والباقي فإنه يدل على الوجود وسلب العدم عنه آخراً وكالواحد فإنه يدل على الوجود وسلب الشريك، وكالغنى فإنه يدل على الوجود وسلب الحاجة فهذا أيضاً يصدق أزلاً وأبداً لأن ما يسلب عنه يسلب لذاته فيلازم الذات على الدوام.
الثالث: ما يدل على الوجود وصفة زائدة من صفات المعنى كالحي والقادر والمتكلم والمريد والسميع والبصير والعالم وما يرجع إلى هذه الصفات السبعة كالآمر والناهي والخبير ونظائره، فذلك أيضاً يصدق عليه أزلاً وأبداً عند من يعتقد قدم جميع الصفات. الرابع: ما يدل على الوجود مع إضافة إلى فعل من أفعاله كالجواد والرزاق والخالق والمعز والمذل وأمثاله، وهذا مختلف فيه، فقال قوم هو صادق أزلاً إذ لو لم يصدق لكان اتصافه به موجباً للتغير وقال قوم لا يصدق إذ لا خلق في الأزل فكيف خالقاً. والكاشف للغطاء عن هذا أن السيف في الغمد يسمى صارماً وعند حصول القطع به وفي تلك الحالة على الاقتران يسمى صارماً، وهما بمعنيين مختلفين، فهو في الغمد صارم بالقوة وعند حصول القطع صارم بالفعل وكذلك الماء في الكوز يسمى مروياً وعند الشرب يسمى مروياً وهما إطلاقان مختلفان فمعنى تسمية السيف في الغمد صارماً أن الصفة التي يحصل بها القطع في الحال لقصور في ذات السيف وحدته واستعداده بل لأمر آخر وراء ذاته. فبالمعنى الذي يسمى السيف في الغمد صارماً يصدق اسم الخالق على الله تعالى في الأزل فإن الخلق إذ أجري بالفعل لم يكن لتجدد أمر في الذات لم يكن، بل كل ما يشترط لتحقيق الفعل موجود في الأزل. وبالمعنى الذي يطلق حالة مباشرة القطع للسيف اسم الصارم لا يصدق في الأزل فهذا حظ المعنى. فقد ظهر أن من قال إنه لا يصدق في الأزل هذا الاسم فهو محق وأراد به المعنى الثاني، ومن قال يصدق في الأزل فهو محق وأراد به المعنى الأول. وإذا كشف الغطاء على هذا الوجه ارتفع الخلاف. فهذا تمام ما أردنا ذكره في قطب الصفات وقد اشتمل على سبعة دعاو، وتفرع عن صفة القدرة ثلاثة فروع، وعن صفة الكلام خمسة استبعادات، واجتمع من الأحكام المشتركة بين الصفات أربعة أحكام، فكان المجموع قريباً من عشرين دعوى هي أصول الدعاوى وإن كان تنبني كل دعوى على دعاوى بها يتوصل إلى اثباتها فلنشتغل بالقطب الثالث من الكتاب إن شاء الله تعالى.
القطب الثالث في أفعال الله تعالى وجملة أفعال جائزة لا يوصف شيء منها بالوجوب وندعي في هذا القطب سبعة أمور: ندعي أنه يجوز لله تعالى أن لا يكلف عباده، وأنه يجوز أن يكلفهم ما لا يطاق، وأنه يجوز منه إيلام العباد بغير عوض وجناية؛ وأنه لا يجب رعاية الأصلح لهم، وأنه لا يجب عليه ثواب الطاعة وعقاب المعصية، وأن العبد لا يجب عليه شيء بالعقل بل بالشرع، وأنه لا يجب على الله بعثه الرسل، وأنه لو بعث لم يكن قبيحاً ولا محالاً بل أمكن اظهار صدقهم بالمعجزة، وجملة هذه الدعاوى تنبني على البحث عن معنى الواجب والحسن والقبيح، ولقد خاض الخائضون فيه وطولوا القول في أن العقل هل يحسن ويقبح وهل يوجب. وإنما كثر الخبط لأنهم لم يحصلوا معنى هذه الألفاظ واختلافات الاصطلاحات فيها وكيف تخاطب خصمان في أن العقل واجب وهما بعد لم يفهما معنى الواجب، فهما محصلاً متفقاً عليه بينهما، فلنقدم البحث عن الاصطلاحات ولا بد من الوقوف على معنى ستة ألفاظ وهي: الواجب، والحسن، والقبيح، والعبث، والسفه، والحكمة؛ فإن هذه الألفاظ مشتركة ومثار الأغاليط إجمالها، والوجه في أمثال هذه المباحث أن نطرح الألفاظ ونحصل المعاني في العقل بعبارات أخرى ثم نلتفت إلى الألفاظ المبحوث عنها وننظر إلى تفاوت الاصطلاحات فيها، فنقول: أما الواجب فإنه يطلق على فعل لا محالة، ويطلق على القديم إنه واجب، وعلى الشمس إذا غربت إنها واجبة، وليس من غرضنا. وليس يخفى أن الفعل الذي لا يترجح فعله على تركه ولا يكون صدوره من صاحبه أولى من تركه لا يسمى واجباً وإن ترجح وكان أولاً لا يسميه أيضاً بكل ترجيح بل لا بد من خصوص ترجيح. ومعلوم أن الفعل قد يكون بحيث يعلم أنه يعلم أنه نستعقب تركه ضرراً، أو يتوهم، وذلك الضرر إما عاجل في الدنيا وإما آجل في العاقبة، وهو إما قريب محتمل وإما عظيم لا يطاق مثله. فانقسام الفعل ووجوه ترجحه لهذه الأقسام ثابت في العقل من غير لفظ
فلنرجع إلى اللفظ فنقول: معلوم أن ما فيه ضرر قريب محتمل لا يسمى واجباً؛ إذ العطشان إذا لم يبادر إلى شرب الماء تضرر تضرراً قريباً ولا يقال إن الشرب عليه واجب. ومعلوم أن ما لا ضرر فيه أصلاً ولكن في فعله فائدة لا يسمى واجباً، فإن التجارة واكتساب المال والنوافل فيه فائدة ولا يسمى واجباً، بل المخصوص باسم الواجب ما في تركه ضرر ظاهر فإن كان ذلك في العاقبة أعني الآخرة، وعرف بالشرع فنحن نسميه واجباً، وإن كان ذلك في الدنيا وعرف بالعقل فقد يسمى أيضاً ذلك واجباً، فإن من لا يعتقد الشرع قد يقول واجب على الجائع الذي يموت من الجوع أن يأكل إذا وجد الخبز ونعني بوجوب الأكل ترجح فعله على تركه بما يتعلق من الضرر بتركه، ولسنا نحرم هذا الاصطلاح بالشرع فإن الاصطلاحات مباحة لا حجر فيها للشرع ولا للعقل، وإنما تمنع منه اللغة إذا لم يكن على وفق الموضوع المعروف فقد تحصلنا على معنيين للواجب ورجع كلاهما إلى التعرض للضرر وكان أحدهما أعم لا يختص بالآخرة، والآخر أخص وهو اصطلاحنا، وقد يطلق الواجب بمعنى ثالث وهو الذي يؤدي عدم وقوعه إلى أمر محال، كما يقال: ما علم وقوعه فوقوعه واجب، ومعناه أنه إن لم يقع يؤدي إلى أن ينقلب العلم جهلاً وذلك محال، فيكون معنى وجوبه أن ضده محال، فليسم هذا المعنى الثالث الواجب. وأما الحسن فحظ المعنى منه أن الفعل في حق الفاعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام أحدها أن توافقه أي تلائم غرضه، والثاني أن ينافر غرضه، والثالث أن لا يكون له في فعله ولا في تركه غرض. وهذا الانقسام ثابت في العقل؛ فالذي يوافق الفاعل يسمى حسناً في حقه ولا معنى لحسنه إلا موافقته لغرضه، والذي ينافي غرضه يسمى قبيحاً ولا معنى لقبحه إلا منافاته لغرضه، والذي لا ينافي ولا يوافق يسمى عبثاً أي لا فائدة فيه أصلاً، وفاعل العبث يسمى عابثاً وربما يسمى سفيهاً، وفاعل القبيح أعني الفعل الذي ينضر به يسمى سفيهاً واسم السفيه أصدق منه على العابث، وهذا كله إذا لم يلتفت إلى غير الفاعل أو لم يرتبط الفعل بغرض غير الفاعل، فإن ارتبط بغير الفاعل وكان موافقاً لغرضه سمي حسناً في حق من وافقه وإن كان منافياً سمي قبيحاً، وإن كان موافقاً لشخص دون شخص سمي في حق أحدهما حسناً وفي حق الآخر قبيحاً إذ اسم القبيح والحسن بأن الموافقة والمخالفة، وهما أمران إضافيان، مختلفان بالأشخاص ويختلف في حق شخص واحد بالأحوال ويختلف في حال واحد بالأعراض؛ فرب فعل يوافق الشخص من وجه ويخالفه من وجه فيكون حسناً من وجه قبيحاً من وجه، فمن لا ديانة له
يستحسن الزنا بزوجة الغير ويعد الظفر بها نعمة ويستقبح فعل الذي يكشف عررته ويسميه غمازاً قبيح الفعل والمتدين يسميه محتسباً حسن الفعل، وكل بحسب غرضه يطلق اسم الحسن والقبح بل يقتل ملك من الملوك فيستحسن فعل القاتل جميع أعدائه ويستقبحه جميع أوليائه، بل هذا القاتل في الحسن المخصوص جار، ففي الطباع ما خلق مايلاً من الألوان الحسان إلى السمرة، فصاحبه يستحسن الأسمر ويعشقه، والذي خلق مايلاً إلى البياض المشرب بالحمرة يستقبحه ويستكرهه ويسفه عقل المستحسن المستهتر به؛ فبهذا يتبين على القطع أن الحسن والقبيح عبارتان عن الخلق كلهم عن أمرين إضافيين يختلفان بالإضافات عن صفات الذوات التي لا تختلف بالإضافة. فلا جرم جاز أن يكون الشيء حسناً في حق زيد قبيحاً في حق عمرو ولا يجوز أن يكون الشيء أسود في حق زيد أبيض في حق عمرو لما لم تكن الألوان من الأوصاف الإضافية؛ فإذا فهمت المعنى فافهم أن الاصطلاح في لفظ الحسن أيضاً ثلاثة: فقائل يطلقه على كل ما يوافق الغرض عاجلاً كان أو آجلاً؛ وقائل يخصص بما يوافق الغرض في الآخر وهو الذي حسنه الشرع أي حث عليه ووعد بالثواب عليه وهو اصطلاح أصحابنا، والقبيح عند كل فريق ما يقابل الحسن، فالأول أعم وهذا أخص، وبهذا الاصطلاح قد يسمي بعض من لا يتحاشى فعل الله تعالى قبيحاً إذ كان لا يوافق غرضهم، ولذلك تراهم يسبون الفلك والدهر ويقولون خرف الفلك وما أقبح أفعاله ويعلمون إن الفاعل خالق الفلك؛ ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر، فإن الله هو الدهر؛ وفيه اصطلاح ثالث إذ قد يقال فعل الله تعالى حسن كيف كان مع إنه لا غرض في حقه؛ ويكون معناه أنه لا تبعة عليه فيه ولا لائمة وأنه فاعل في ملكه الذي لا يساهم فيه ما يشاء. وأما الحكمة فتطلق على معنيين: أحدهما الاحاطة المجردة بنظم الأمور ومعانيها الدقيقة والجليلة والحكم عليها بأنها كيف ينبغي أن تكون حتى تتم منها الغاية المطلوبة بها، والثاني أن تنضاف إليه القدرة على إيجاد الترتيب والنظام واتقانه وإحكامه
فيقال حكيم من الحكمة، وهو نوع من العلم، ويقال حكيم من الأحكام وهو نوع من الفعل، فقد اتضح لك معنى هذه الألفاظ في الأصل ولكن ههنا ثلاث غلطات للوهم يستفاد من الوقوف عليها الخلاص من إشكالات تغتر بها طوائف كثيرة: الغلطة الأولى: أن الإنسان قد يطلق اسم القبيح على ما يخالف غرضه وإن كان يوافق غرض غيره، ولكنه لا يلتفت إلى الغير، فكل طبع مشغوف بنفسه ومستحقر ما عداه ولذلك يحكم على الفعل مطلقاً بأنه قبيح وقد يقول أنه قبيح في عينه، وسببه أنه قبيح في حقه بمعنى أنه مخالف لغرضه، ولكن أغراضه كأنه كل العالم في حقه فيتوهم أن المخالف لحقه مخالف في نفسه، فيضيف القبح إلى ذات الشيء ويحكم بالاطلاق؛ فهو مصيب في أصل الاسقباح ولكنه مخطيء في حكمه بالقبح على الاطلاق؛ وفي إضافة القبح إلى ذات الشيء ومنشؤه غفلته عن الالتفات إلى غيره، بل عن الالتفات إلى بعض أحوال نفسه، فإنه قد يستحسن في بعض أحواله غير ما يستقبحه مهما انقلب موافقاً لغرضه. الغلطة الثانية فيه: أن ما هو مخالف للأغراض في جميع الأحوال إلا في حالة نادرة، فقد يحكم الإنسان عليه مطلقاً بأنه قبيح لذهوله عن الحالة النادرة ورسوخ غالب الأحوال في نفسه واستيلائه على ذكره، فيقضي مثلاً على الكذب بأنه قبيح مطلقاً في كل حال وأن قبحه لأنه كذب لذاته فقط لا لمعنى زائد، وسبب ذلك غفلته عن ارتباط مصالح كثيرة بالكذب في بعض الأحوال، ولكن لو وقعت تلك الحالة ربما نفر طبعه عن استحسان الكذب لكثرة إلفه باستقباحه، وذلك لأن الطبع ينفر عنه من أول الصبا بطريق التأديب والاستصلاح، ويلقي إليه أن الكذب قبيح في نفسه وأنه لا ينبغي أن يكذب قط، فهو قبيح ولكن بشرط يلازمه في أكثر الأوقات وإنما يقع نادراً، فلذلك لا ينبه على ذلك الشرط ويغرس في طبعه قبحه والتنفير عنه مطلقاً. الغلطة الثالثة: سبق الوهم إلى العكس، فإن ما رئي مقروناً بالشيء يظن أن الشيء أيضاً لا محالة يكون مقروناً به مطلقاً ولا يدري أن الأخص أبداً يكون مقروناً بالأعم، وأما الأعم فلا يلزم أن يكون مقروناً بالأخص. ومثاله ما يقال من أن السليم، أعني الذي نهشته الحية، يخاف من الحبل المبرقش اللون، وهو كما قيل، وسببه أنه أدرك المؤذي وهو متصور بصورة حبل مبرقش، فإذا أدرك الحبل سبق الوهم إلى العكس وحكم بأنه مؤذ فينفر الطبع تابعاً للوهم والخيال وإن كان العقل مكذباً به، بل الانسان قد ينفر عن أكل الخبيض الأصفر لشبهه بالعذرة، فيكاد يتقيأ عند قول القائل إنه عذرة، يتعذر عليه تناوله مع كون العقل مكذباً به، وذلك لسبق الوهم إلى العكس فإنه أدرك المستقذر رطباً أضفر فإذا رأى الرطب الأصفر حكم بأنه
مستقذر، بل في الطبع ما هو أعظم من هذا فإن الأسامي التي تطلق عليها الهنود والزنوج لما كان يقترن قبح المسمى به يؤثر في الطبع ويبلغ إلى حد لو سمى به أجمل الأتراك والروم لنفر الطبع عنه، لأنه أدرك الوهم القبيح مقروناً بهذا الاسم فيحكم بالعكس، فإذا أدرك الأسم حكم بالقبح على المسمى ونفر الطبع. وهذا مع وضوحه للعقل فلا ينبغي أن يغفل عنه لأن إقدام الخلق وإحجامهم في أقوالهم وعقائدهم وأفعالهم تابع لمثل هذه الأوهام. وأما اتباع العقل الصرف فلا يقوى عليه إلا أولياء الله تعالى الذين أراهم الله الحق حقاً وقواهم على اتباعه، وإن أردت أن تجرب هذا في الاعتقادات فأورد على فهم العامي المعتزلي مسألة معقولة جلية فيسارع إلى قبولها، فلو قلت له إنه مذهب الأشعري رضي الله عنه لنفر وامتنع عن القبول وانقلب مكذباً بعين ما صدق به مهما كان سيء الظن بالأشعري، إذ كان قبح ذلك في نفسه منذ الصبا. وكذلك تقرر أمراً معقولاً عند العامي الأشعري ثم تقول له إن هذا قول المعتزلي فينفر عن قبوله بعد التصديق ويعود لي التكذيب. ولست أقول هذا طبع العوام بل طبع أكثر من رأيته من المتوسمين باسم العلم؛ فإنهم لم يفارقوا العوام في أصل التقليد بل أضافوا إلى تقليد المذهب تقليد الدليل فهم في نظرهم لا يطلبون الحق بل يطلبون طريق الحيلة في نصرة ما اعتقدوه حقاً بالسماع والتقليد، فإن صادفوا في نظرهم ما يؤكد عقائدهم قالوا قد ظفرنا بالدليل، وإن ظهر لهم ما يضعف مذهبهم قالوا قد عرضت لنا شبهة، فيضعون الاعتقاد المتلقف بالتقليد أصلاً وينبزون بالشبهة كل ما يخالفه، وبالدليل كلى ما يوافقه، وإنما الحق ضده؛ وهو أن لا يعتقد شيئاً أصلاً وينظر إلى الدليل ويسمي مقتضاه حقاً ونقيضه باطلاً وكل ذلك منشؤه الاستحسان والاستقباح بتقديم الإلفه والتخلق بأخلاق منذ الصبا. فإذا وقفت على هذه المثارات سهل عليك دفع الاشكالات. فإن قيل: فقد رجع كلامكم إلى أن الحسن والقبيح يرجعان إلى الموافقة والمخالفة للأغراض، ونحن نرى العاقل يستحسن ما لا فائدة له فيه ويستقبح ما له فيه فائدة. أما الاستحسان فمن رأى إنساناً أو حيواناً مشرفاً على الهلاك استحسن إنقاذه ولو بشربة ماء معأنه ربما لا يعتقد الشرع ولا يتوقع منه غرضاً في الدنيا ولا هو بمرآى من الناس حتى ينتظر عليه ثناء بل يمكن أن يقدر انتفاء كل غرض ومع ذلك يرجح جهة الانقاذ على جهة الاهمال بتحسين هذا وتقبيح ذلك. وأما الذي يستقبح مع الأغراض، كالذي يحمل على كلمة الكفر بالسيف والشرع قد رخص له في اطلاقها، فإنه قد يستحسن منه الصبر على السيف وترك النطق به. أو الذي لا يعتقد الشرع وحمل بالسيف على نقض عهد، ولا ضرر عليه في نقضه وفي
الوفاء به هلاكه، فإنه يستحسن الوفاء بالعهد والامتناع من النقض. فبان أن الحسن والقبح معنى سوى ما ذكرتموه. والجواب أن في الوقوف على الغلطات المذكورة ما يشفي هذا الغليل. أما ترجيح الانقاذ على الاهمال في حق من لا يعتقد الشرع فهو دفع للأذى الذي يلحق الانسان في رقة الجنسية، وهو طبع يستحيل الانفكاك عنه. ولأن الانسان يقدر نفسه في تلك البلية ويقدر غيره قادراً على انقاذه مع الإعراض عنه، ويجد من نفسه استقباح ذلك فيعود عليه ويقدر ذلك من المشرف على الهلاك في حق نفسه فينفره طبعه عما يعتقده من أن المشرف على الهلاك في حقه، فيندفع ذلك عن نفسه بالانقاذ، فإن فرض ذلك في بهيمة لا يتوهم استقباحها أو فرض في شخص لا رقة فيه ولا رحمة فهذا مجال تصوره، إذ الانسان لا ينفك عنه فإن فرض على الاستحالة فيبقى أمر آخر وهو الثناء بحسن الخلق والشفقة على الخلق، فإن فرض حيث لا يعلمه أحد فهو ممكن أن يعلمه، فإن فرض في موضع يستحيل أن يعلم فيبقى أيضاً ترجيح في نفسه وميل يضاهي نفرة طبع السليم عن الخبل، وذلك أنه رأى الثناء مقروناً بمثل هذا الفعل على الاطراد، وهو يميل إلى الثناء فيميل إلى المقرون به. وإن علم بعقله عدم الثناء. كما إنه لما رأى الأذى مقروناً بصورة الخبل. وطبعه ينفر عن الأذى فينفر عن المقرون به، وإن علم بعقله عدم الأذى بل الطبع إذا رأى من يعشقه في موضع وطال معه أنسه فيه فإنه يحس من نفسه تفرقة بين ذلك الموضع وحيطانه وبين سائر المواضع ولذلك قال الشاعر: تصوره، إذ الانسان لا ينفك عنه فإن فرض على الاستحالة فيبقى أمر آخر وهو الثناء بحسن الخلق والشفقة على الخلق، فإن فرض حيث لا يعلمه أحد فهو ممكن أن يعلمه، فإن فرض في موضع يستحيل أن يعلم فيبقى أيضاً ترجيح في نفسه وميل يضاهي نفرة طبع السليم عن الخبل، وذلك أنه رأى الثناء مقروناً بمثل هذا الفعل على الاطراد، وهو يميل إلى الثناء فيميل إلى المقرون به. وإن علم بعقله عدم الثناء. كما إنه لما رأى الأذى مقروناً بصورة الخبل. وطبعه ينفر عن الأذى فينفر عن المقرون به، وإن علم بعقله عدم الأذى بل الطبع إذا رأى من يعشقه في موضع وطال معه أنسه فيه فإنه يحس من نفسه تفرقة بين ذلك الموضع وحيطانه وبين سائر المواضع ولذلك قال الشاعر: أمر على جدار ديار ليلى ... أقبل ذا الجدار وذا الجدارا وما تلك الديار شغفن قلبي ... ولكن حب من سكن الديارا وقال ابن الرومي منبهاً على سبب حب الناس الأوطان ونعم ما قال: وحبّب أوطان الرجال إليهم ... مآرب قضاها الشباب هنالكا إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم ... عهود الصبا فيها فحنوا لذلكا وإذا تتبع الانسان الأخلاق والعادات رأى شواهد هذا خارجة عن الحصر، فهذا هو السبب الذي هو غلط المغترين بظاهر الأمور، الذاهلين عن أسرار أخلاق النفوس، الجاهلين بأن هذا الميل وأمثاله يرجع إلى طاعة النفس بحكم الفطرة والطبع بمجرد الوهم. والخيال الذي هو غلط يحكم العقل ولكن خلقت قوى النفس مطيعة للأوهام والتخيلات بحكم اجراء العادات، حتى إذا تخيل الإنسان طعاماً طيباً بالتذكر أو بالرؤية سال في الحال لعابه وتحلبت أشداقه، وذلك بطاعة القوة التي سخرها الله تعالى لإفاضة اللعاب المعين على المضغ للتخيل والوهم، فإن شأنها أن تنبعث بحسب التخيل وإن
كان الشخص عالماً بأنه ليس يريد الإقدام على الأكل بصوم أو بسبب آخر وكذلك يتخيل الصورة الجميلة التي يشتهي مجامعتها، فكما ثبت ذلك في الخيال انبعثت القوة الناشرة لآلة الفعل وساقت الرياح إلى تجاويف الأعصاب وملأتها، وثارت القوة المأمورة بصب المذي الرطب المعين على الوقاع، وذلك كله مع التحقيق بحكم العقل للامتناع عن الفعل في ذلك الوقت. ولكن الله تعالى خلق هذه القوى بحكم طرد العادة مطيعة مسخرة تحت حكم الخيال، والوهم ساعد العقل الوهم أو لم يساعده، فهذا وأمثاله منشأ الغلط في سبب ترجيح أحد جانبي الفعل على الآخر. وكل ذلك راجع إلى الأغراض، فأما النطق بكلمة الكفر وإن كان كذلك فلا يستقبحه العاقل تحت السيف البتة بل ربما يستقبح الاصرار، فإن استحسن الاصرار فله سببان: أحدهما، اعتقاده أن الثواب على الصبر والاستسلام أكثر، والآخر، ما ينتظر من من الثناء عليه بصلابته في الدين، فكم من شجاع يمتطي متن الخطر ويتهجم على عدد يعلم أنه لا يطيقهم ويستحقر ما يناله بما يعتاضه عنه من لذة الثناء والحمد بعد موته وكذلك الامتناع عن نقض العهد بسببه ثناء الخلق على من يفي بالعهد، وتواصيهم به على مر الأوقات لما فيها من مصالح الناس. فإن قدر حيث لا ينتظر ثناء فسببه حكم الوهم من حيث أنه لم يزل مقروناً بالثناء الذي هو لذيذ، والمقرون باللذيذ لذيذ، كما أن المقرون بالمكروه مكروه كما سبق في الأمثلة، فهذا ما يحتمله هذا المختصر من بث أسرار هذا الفصل، وإنما يعرف قدره من طال في المعقولات نظره، وقد استفدنا بهذه المقدمة إيجاز الكلام في الدعاوى فلنرجع إليها. الدعوى الأولى: ندعي أنه يجوز لله تعالى أن لا يخلق الخلق، وإذا خلق فلم يكن ذلك واجباً عليه، وإذا خلقهم فله أن لا يكلفهم، وإذا كلفهم فلم يكن ذلك واجباً عليه. وقالت طائفة من المعتزلة يجب عليه الخلق والتكليف واجب، غير مفهوم؛ فإنا بينا أن المفهوم عندنا من لفظ الواجب ما ينال تاركه ضرر، إما عاجلاً وإما آجلاً، أو ما يكون نقيضه محال، والضرر محال في حق الله تعالى. وليس في ترك التكليف وترك الخلق لزوم محال، إلا أن يقال كان يؤدي ذلك إلى خلاف ما سبق به العلم في الأزل وما سبقت به المشيئة في الأزل، فهذا حق وهو بهذا التأويل واجب، فإن الإرادة
إذا فرضت موجودة، أو العلم إذا فرض متعلقاً بالشيء، كان حصول المراد والمعلوم واجباً لا محالة. فإن قيل: إنما يجب عليه ذلك لفائدة الخلق لا لفائدة ترجع إلى الخالق سبحانه وتعالى، قلنا: الكلام في قولكم لفائدة الخلق للتعليل، والحكم المعلل هو الوجوب، ونحن نطالبكم بتفهيم الحكم فلا يعنيكم ذكر العلة؛ فما معنى قولكم إنه يجب لفائدة الخلق وما معنى الوجوب ونحن لا نفهم من الوجوب إلا المعاني الثلاثة، وهي منعدمة، فإن أردتم معنى رابعاً ففسروه أولاً ثم اذكروا علته، فإنا ربما لا ننكر أن للخلق في الخلق فائدة، وكذا في التكليف، ولكن ما فيه فائدة غيره لم يجب عليه إذا لم يكن له فائدة في فائدة غيره. وهذا لا مخرج عنه أبداً، على أنا نقول إنما يستقيم هذا الكلام في الخلق لا في التكليف، ولا يستقيم في هذا الخلق الموجود بل في أن يخلقهم في الجنة متنعمين، من غير هم وضرر وغم وألم، وأما هذا الخلق الموجود فالعقلاء كلهم قد تمنوا العدم، وقال بعضهم: ليتني كنت نسياً منسياً، وقال آخر ليتني لم أك شيئاً، وقال آخر ليتني كنت تبنة رفعها من الأرض، قال آخر يشير إلى طائر ليتني كنت ذلك الطائر. وهذا قول الأنبياء والأولياء وهم العقلاء، فبعضهم يتمنى عدم الخلق وبعضهم يتمنى عدم التكليف بأن يكون جماداً أو طائراً، فليت شعري كيف يستجيز العاقل في أن يقول: للخلق في التكليف فائدة وإنما معنى الفائدة نفي الكلفة، والتكليف في عينه إلزام كلفة وهو ألم، وإن نظر إلى الثواب فهو الفائدة، وكان قادراً على إيصاله إليهم بغير تكليف، فإن قيل: الثواب إذا كان باستحقاق كان ألذ وأوقع من أن يكون بالامتنان والابتداء، والجواب: أن الاستعاذة بالله تعالى من عقل ينتهي إلى التكبر على الله عز وجل والترفع من احتمال منته وتقدير اللذة في الخروج من نعمته أولى من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم؛ وليت شعري كيف يعد من العقلاء من يخطر بباله مثل هذه الوساوس، ومن يستثقل المقام أبد الآباد في الجنة من غير تقدم تعب وتكليف أخس من أن يناظر أو يخاطب. هذا لو سلم أن الثواب بعد التكليف يكون مستحقاً، وسنبين نقيضه. ثم ليت شعري الطاعة التي بها يستحق الثواب من أين وجدها العبد؟ وهل لها سبب سوى وجوده وقدرته وإرادته وصحة أعضائه وحضور أسبابه؟ وهل لكل ذلك مصدر إلا فضل الله ونعمته؛ فنعوذ بالله من الانخلاع عن غريزة العقل بالكلية، فإن هذا الكلام من هذا النمط، فينبغي أن يسترزق الله تعالى عقلاً لصاحبه ولا يشتغل بمناظرته.
الدعوى الثانية: إن لله تعالى أن يكلف العباد ما يطيقونه وما لا يطيقونه، وذهب المعتزلة إلى انكار ذلك، ومعتقد أهل السنة أن التكليف له حقيقة في نفسه وهو أنه كلام وله مصدر وهو المكلف، ولا شرط فيه إلا كونه متكلماً، وله مورد وهو المكلف وشرطه أن يكون فاهماً للكلام فلا يسمى الكلام مع الجماد والمجنون خطاباً ولا تكليفاً، والتكليف نوع خطاب وله متعلق وهو المكلف به وشرطه أن يكون مفهوماً فقط، وأما كونه ممكناً فليس بشرط لتحقيق الكلام فإن التكليف كلام، فإذا صدر ممن يفهم مع من يفهم فيما يفهم وكان المخاطب دون المخاطب سمي تكليفاً، وإن كان مثله سمي التماساً، وإن كان فوقه سمي دعاء وسؤالاً، فالاقتضاء في ذاته واحد وهذه الأسامي تختلف عليه باختلاف النسبة، وبرهان جواز ذلك أن استحالته لا تخلو إما أن تكون لامتناع تصور ذاته، كاجتماع السواد والبياض، أو كان لأجل الاستقباح، وباطل أن يكون امتناعه لذاته، فإن السواد والبياض لا يمكن أن يفرض مجتمعاً، وفرض هذا ممكن إذ التكليف لا يخلو إما أن يكون لفظاً وهو مذهب الخصم وليس بمستحيل أن يقول الرجل لعبده الزمن قم، فهو على مذهبهم أظهر وأما نحن فإنا نعتقد أنه اقتضاء يقوم بالنفس. وكما يتصور أن يقوم اقتضاء القيام بالنفس من قادر فيتصور ذلك من عاجز بل ربما يقوم ذلك بنفسه من قادر ثم يبقى ذلك الاقتضاء ونظر الزمانة والسيد لا يدري. ويكون الاقتضاء قائماً بذاته وهو اقتضاء قائم من عاجز في علم الله تعالى، وإن لم يكن معلوماً عند المقتضي فإن علمه لا يحيل بقاء الاقتضاء مع العلم بالعجز عن الوفاء وباطل أن يقال بطلان ذلك من جهة الاستحسان، فإن كلامنا في حق الله تعالى، وذلك باطل في حقه لتنزهه عن الأغراض ورجوع ذلك إلى الأغراض. أما الانسان العاقل المضبوط بغالب الأمر فقد يستقبح ذلك وليس ما يستقبح من العبد يستقبح من الله تعالى. فإن قيل: فهو مما لا فائدة فيه وما لا فائدة فيه فهو عبث والعبث على الله تعالى محال. قلنا: هذه ثلاث دعاوى: الأولى: إنه لا فائدة فيه، ولا نسلم، فلعل فيه فائدة لعباد اطلع الله عليها. وليست الفائدة هي الامتثال والثواب عليه بل ربما يكون في إظهار الأمر وما يتبعه من اعتقاد التكليف فائدة، فقد ينسخ الأمر قبل الامتثال كما أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده ثم نسخه قبل الامتثال، وأمر أبا جهل بالايمان وأخبر أنه لا يؤمن وخلاف خبره محال.
الدعوى الثانية: إن ما لا فائدة فيه فهو عبث، فهذا تكرير عبارة؛ فإنا بينا أنه لا يراد بالعبث إلا ما لا فائدة فيه فإن أريد به غيره فهو غير مفهوم. الدعوى الثالثة: إن العبث على الله تعالى محال، وهذا فيه تلبيس، لأن لأن العبث عبارة عن فعل لا فائدة فيه ممن يتعرض للفوائد، فمن لا يتعرض لها فتسميته عابثاً مجاز محض لا حقيقة له يضاهي قول القائل الريح عابثة بتحيكها الأشجار إذ لا فائدة لها فيه، ويضاهي قول القائل الجدار غافل أي هو خال عن العلم والجهل وهذا باطل لأن الغافل يطلق على القابل للجهل والعلم إذا خلا عنهما، فاطلاقهما على الذي لا يقبل العلم مجاز لا أصل له، وكذلك اطلاق اسم العابث على الله تعالى واطلاق العبث على أفعاله سبحانه وتعالى، والدليل الثاني في المسألة، ولا محيص لأحد عنه، أن الله تعالى كلف أبا جهل أن يؤمن وعلم أنه لا يؤمن، وأخبر عنه بأنه لا يؤمن، فكأنه أمر بأن يؤمن بأنه لا يؤمن، إذ كان من قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لا يؤمن وكان هو مأموراً بتصديقه، فقد قيل له صدق بأنك لا تصدق، وهذا محال. وتحقيقه أن خلاف المعلوم محال وقوعه ولكن ليس محالاً لذاته، بل هو محال لغيره، والمحال لغيره في امتناع الوقوع كالمحال لذاته، ومن قال إن الكفار الذين لم يؤمنوا ما كانوا مأمورين بالايمان فقد جحد الشرع، ومن قال كان الايمان منهم متصوراً مع علم الله سبحانه وتعالى بأنه لا يقع، فقد اضطر كل فريق إلى القول بتصور الأمر بما لا يتصور امتثاله، ولا يغني عن هذا قول القائل إنه كان مقدوراً عليه وكان للكافر عليه قدرة، أما على مثلنا فلا قدرة قبل الفعل ولم تكن لهم قدرة إلا على الكفر الذي صدر منهم، وأما عند المعتزلة فلا يمتنع وجود القدرة ولكن القدرة غير كافية لوقوع المقدور بل له شرط كالارادة وغيرها، ومن شروطه أن لا ينقلب علم الله تعالى جهلاً. والقدرة لا تراد لعينها بل لتيسيير الفعل بها، فكيف يتيسر فعل يؤدي إلى انقلاب العلم جهلاً؟ فاستبان أن هذا واقع في ثبوت التكليف بما هو محال لغيره، فكذا يقاس عليه ما هو محال لذاته إذ لا فرق بينهما في إمكان التلفظ ولا في تصور الاقتضاء ولا في الاستقباح والاستحسان. الدعوى الثالثة: ندعي أن الله تعالى قادر على إيلام الحيوان البريء عن الجنايات ولا يلزم عليه ثواب. وقالت المعتزلة إن ذلك محال لأنه قبيح، ولذلك لزمهم المصير إلى أن كل بقة وبرغوث أو ذي بعرة أو صدمة فإن الله عز وجل يجب عليه أن يحشره ويثيبه عليه
بثواب، وذهب ذاهبون إلى أن أرواحها تعود بالتناسخ إلى أبدان أُخر وينالها من اللذة ما يقابل تعبها؛ وهذا مذهب لا يخفى فساده، ولكنا نقول: أما إيلام البريء عن الجناية من الحيوان والأطفال والمجانين فمقدور بما هو مشاهد محسوس، فيبقى قول الخصم إن ذلك يوجب عليه الحشر والثواب بعد ذلك فيعود إلى معنى الواجب، وقد بان استحالته في حق الله تعالى، وإن فسروه بمعنى رابع فهو غير مفهوم، وإن زعموا أن تركه يناقض كونه حكيماً فنقول: إن الحكمة إن اريد بها العلم بنظام الأمور والقدرة على ترتيبها كما سبق فليس في هذا ما يناقضه، وإن أريد بها أمراً آخر فليس يجب له عندنا من الحكم إلا ما ذكرناه، وما وراء ذلك لفظ لا معنى له. فإن قيل فيؤدي إلى أن يكون ظالماً وقد قال: " وما ربك بظلام للعبيد " قلنا: الظلم منفي عنه بطريق السلب المحض كما تسلب الغفلة عن الجدار والعبث عن الريح، فإن الظلم إنما يتصور ممن يمكن أن يصادف فعله ملك غيره، ولا يتصور ذلك في حق الله تعالى أو يمكن أن يكون عليه أمر فيخالف فعله أمر غيره، ولا يتصور من الانسان أن يكون ظالماً لما في ملك نفسه بكل ما يفعله إلا إذا خالف أمر الشرع فيكون ظالماً بهذا المعنى، فمن لا يتصور منه أن يتصرف في ملك غيره ولا يتصور منه أن يكون تحت أمر غيره كان الظلم مسلوباً عنه لفقد شرطه المصحح له لا لفقده في نفسه، فلتفهم هذه الدقيقة فإنها مزلة القدم، فإن فسر الظلم بمعنى سوى ذلك فهو غير مفهوم ولا يتكلم فيه بنفي ولا إثبات. الدعوى الرابعة: ندعي أنه لا يجب عليه رعاية الأصلح لعباده، بل له أن يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد، خلافاً للمعتزلة فإنهم حجروا على الله تعالى في أفعاله وأوجبوا عليه رعاية الأصلح. ويدل على بطلان ذلك ما دل على نفي الوجوب على الله تعالى كما سبق وتدل عليه المشاهدة والوجود، فإنا نريهم من أفعال الله تعالى ما يلزمهم الاعتراف به بأنه لا صلاح للعبيد فيه، فإنا نفرض ثلاثة أطفال مات أحدهم وهو مسلم في الصبا، وبلغ الآخر وأسلم ومات مسلماً بالغاً، وبلغ الثالث كافراً ومات على الكفر، فإن العدل عندهم أن يخلد الكافر البالغ في النار، وأن يكون للبالغ المسلم في الجنة رتبة فوق رتبة الصبي المسلم، فإذا قال الصبي المسلم: يا رب لم حططت رتبتي عن رتبته؟ فيقول: لأنه بلغ فأطاعني وأنت لم تطعني بالعبادات بعد البلوغ، فيقول: يا رب لأنك
أمتني قبل البلوغ فكان صلاحي في أن تمدني بالحياة حتى أبلغ فأطيع فأنال رتبته فلم حرمتني هذه الرتبة أبد الآبدين وكنت قادراً على أن توصلني لها؟ فلا يكون له جواب إلا أن يقول: علمت أنك لو بلغت لعصيت وما أطعت وتعرضت لعقابي وسخطي فرأيت هذه الرتبة النازلة أولى بك وأصلح لك من العقوبة، فينادي الكافر البالغ من الهاوية ويقول: يا رب أو ما علمت أني إذا بلغت كفرت فلو أمتني في الصبا وأنزلتني في تلك المنزلة النازلة لكان أحب إلي من تخليد النار وأصلح لي، فلم أحييتني وكان الموت خيراً لي؟ فلا يبقى له جواب البتة، ومعلوم أن هذه الأقسام الثلاثة موجودة، وبه يظهر على القطع أن الأصلح للعباد كلهم ليس بواجب ولا هو موجود. الدعوى الخامسة: ندعي أن الله تعالى إذا كلف العباد فأطاعوه لم يجب عليه الثواب، بل إن شاء أثابهم وإن شاء عاقبهم وإن شاء أعدمهم ولم يحشرهم، ولا يبالي لو غفر لجميع الكافرين وعاقب جميع المؤمنين، ولا يستحيل ذلك في نفسه ولا يناقض صفة من صفات الإلهية، وهذا لأن التكليف تصرف في عبيده ومماليكه، أما الثواب ففعل آخر على سبيل الابتداء، وكونه واجباً بالمعاني الثلاثة غير مفهوم ولا معنى للحسن والقبيح، وإن أريد له معنى آخر فليس بمفهوم إلا أن يقال إنه يصير وعده كذباً وهو محال، ونحن نعتقد الوجوب بهذا المعنى ولا ننكره. فإن قيل: التكليف مع القدرة على الثواب وترك الثواب قبيح، قلنا: إن عنيتم بالقبح أنه مخالف غرض المكلف فقد تعالى المكلف وتقدس عن الأغراض، وإن عنيتم به أنه مخالف غرض المكلف مسلم لكن ما هو قبيح عند المكلف لم يمتنع عليه فعله إذا كان القبيح والحسن عنده وفي حقه بمثابة واحدة. على أنا لو نزلنا على فاسد معتقدهم فلا نسلم أن من يستخدم عبده يجب عليه في العادة ثواب، لأن الثواب يكون عوضاً عن العمل فتبطل فائدة الرق وحق على العبد أن يخدم مولاه لأنه عبده، فإن كان لأجل عوض فليس ذلك خدمة، ومن العجائب قولهم: إنه يجب الشكر على العباد لأنهم عباد، قضاءً لحق نعمته، ثم يجب عليه الثواب على الشكر وهذا محال؛ لأن المستحق إذا وفى لم يلزمه فيه عوض، ولو جاز ذلك للزم على الثواب شكر مجدد وعلى هذا الشكر ثواب مجدد ويتسلسل إلى غير نهاية، ولم يزل العبد والرب كل واحد منهما أبداً مقيداً بحق الآخر، وهو محال. وأفحش من هذا قولهم: إن كل من كفر فيجب على الله تعالى أن يعاقبه أبداً ويخلده في النار، بل كل من قارف كبيرة ومات قبل التوبة يخلد في النار،
وهذا جهل بالكرم والمروءة والعقل والعادة والشرع وجميع الأمور، فإنا نقول: العبادة قاضية والعقول مشيرة إلى أن التجاوز والصفح أحسن من العقوبة، والانتقام وثناء الناس على العافي أكثر من ثنائهم للمنتقم، واستحسانهم للعفو أشد، فكيف يستقبح العفو والإنعام ويستحسن طول الانتقام! ثم هذا في حق من أذته الجناية وغضت من قدره المعصية، والله تعالى يستوي في حقه الكفر والايمان والطاعات والعصيان فهما في حق إلاهيته وجلاله سيان، ثم كيف يستحسن أن سلك طريق المجازاة واستحسن ذلك تأييد العقاب خالداً مخلداً في مقابلته العصيان بكلمة واحدة في لحظة. ومن انتهى عقله في الاستحسان إلى هذا الحد كانت دار المرضى أليق به من مجامع العلماء. على أنا نقول: لو سلك سالك ضد هذا الطريق بعينه كان أقوم قيلا وأجرى على قانون الاستحسان والاستقباح الذي تقضي به الأوهام والخيالات كما سبق، وهو أن نقول: الانسان يقبح منه أن يعاقب على جناية سبقت وجناية تداركها إلا لوجهين: أحدهما، أن يكون في العقوبة زجر ورعاية مصلحة في المستقبل فيحسن ذلك خيفة من فوات غرض في المستقبل، فإن لم يكن فيه مصلحة في المستقبل أصلاً فالعقوبة بمجرد المجازاة على ما سبق قبيح لأنه لا فائدة فيه للمعاقب ولا لأحد سواه، والجاني متأذ به ودفع الأذى عنه أحسن، وإنما يحسن الأذى لفائدة ولا فائدة، وما مضى فلا تدارك له فهو في غاية القبح. والوجه الثاني، أن نقول: إنه إذا تأذى المجني عليه واشتد غيظه فذلك الغيظ مؤلم وشفاء الغيظ مريح من الألم، والألم بالجاني أليق، ومهما عاقب الجاني زال منه ألم الغيظ واختص بالجاني فهو أولى، فهذا أيضاً له وجه ما وإن كان دليلاً على نقصان العقل وغلبة الغضب عليه. فأما إيجاب العقاب حيث لا يتعلق بمصلحة في المستقبل لأحد في عالم الله تعالى ولا فيه دفع أذى عن المجني عليه ففي غاية القبح، فهذا أقوم من قول من يقول إن ترك العقاب في غاية القبح، والكل باطل واتباع الموجب الأوهام التي وقعت بتوهم الأغراض، والله تعالى متقدس عنها ولكنا أردنا معارضة الفاسد ليتبين به بطلان خيالهم. الدعوى السادسة: ندعي أنه لو لم يرد الشرع لما كان يجب على العباد معرفة الله تعالى وشكر نعمته، خلافاً للمعتزلة، حيث قالوا إن العقل بمجرده موجب، وبرهانه أن نقول: العقل يوجب النظر وطلب المعرفة لفائدة مرتبة عليه أو مع الاعتراف بأن وجوده وعدمه
في حق الفوائد عاجلاً وآجلاً بمثابة واحدة، فإن قلتم: يقتضي بالوجوب مع الاعتراف بأنه لا فائدة فيه قطعاً عاجلاً وآجلاً فهذا حكم الجهل لا حكم العقل، فإن العقل لا يأمل بالعبث، وكلما هو خال عن الفوائد كلها فهو عبث، وإن كان لفائدة فلا يخلو إما أن ترجع إلى المعبود تعالى وتقدس عن الفوائد، وإن رجعت إلى العبد فلا يخلو أن يكون في الحال أو في المآل، أما في الحال فهو تعب لا فائدة فيه وأما في المآل فالمتوقع الثواب. ومن أين علمتم أنه يثاب على فعله بل ربما يعاقب على فعله، فالحكم عليه بالثواب حماقة لا أصل لها.. فإن قيل: يخطر بباله أن له رباً إن شكره أثابه وأنعم عليه وإن كفر أنعمه عاقبه عليه، ولا يخطر بباله البتة جواز العقوبة على الشكر والاحتزاز عن الضرر الموهوم في قضية العقل كالاحتراز عن العلوم. قلنا: نحن لا ننكر أن العاقل يستحثه طبعه عن الاحتراز من الضرر موهوماً ومعلوماً، فلا يمنع من إطلاق اسم الايجاب على هذا الاستحثاث فإن الاصطلاحات لا مشاحة فيها، ولكن الكلام في ترجيح جهة الفعل على جهة الترك في تقرير الثواب بالعقاب مع العلم بأن الشكر وتركه في حق الله تعالى سيان لا كالواحد منا فإنه يرتاح بالشكر والثناء ويهتز له ويستلذه ويتآلم بالكفران ويتأذى به، فإذا ظهر استواء الأمرين في حق الله تعالى فالترجيح لأحد الجانبين محال، بل ربما يخطر بباله نقيضه وهو أنه يعاقب على الشكر لوجهين: أحدهما، أن اشتغاله به تصرف في فكره وقلبه باتعابه صرفه عن الملاذ والشهوات وهو عبد مربوب خلق له شهوة ومكن من الشهوات، فلعل المقصود أن يشتغل بلذات نفسه واستيفاء نعم الله تعالى وأن لا يتعب نفسه فيما لا فائدة لله فيه فهذا الاحتمال أظهر. الثاني، أن يقيس نفسه على من يشكر ملكاً من الملوك بأن يبحث عن صفاته وأخلاقه ومكانه وموضع نومه مع أهله وجميع أسراره الباطنة مجازاة على إنعامه عليه، فيقال له أنت بهذا الشكر مستحق لحز الرقبة، فما لك ولهذا الفضول ومن أنت حتى تبحث عن أسرار الملوك وصفاتهم وأفعالهم وأخلاقهم، ولماذا لا تشتغل بما يهمك، فالذي يطلب معرفة معرفة الله تعالى كأنه إن تعرف دقائق صفات الله تعالى وأفعاله وحكمته وأسراره في أفعاله وكل ذلك مما لا يؤهل له إلا من له منصب فمن أين عرف العبد أنه مستحق لهذا المنصب؟ فاستبان أن ما أخذهم أنهام رسخت منهم من العادات، تعارضها أمثالها ولا محيص عنها. فإن قيل: فإن لم يكن مدركاً لوجوب مقتضى العقول أدى ذلك إلى إفحام
الرسول، فإنه إذا جاء بالمعجزة وقال انظروا فيها، فللمخاطب أن يقول إن لم يكن النظر واجباً فلا اقدم عليه وإن كان واجباً فيستحيل أن يكون مدركه العقل، والعقل لا يوجب، ويستحيل أن يكون مدركه الشرع، والشرع لا يثبت إلا بالنظر في المعجزة ولا يجب النظر قبل ثبوت الشرع فيؤدي إلى أن لا يظهر صحة النبوة أصلاً. والجواب أن هذا السؤال مصدره الجهل بحقيقة الوجوب، وقد بينا أن معنى الوجوب ترجيح جانب الفعل على الترك بدفع ضرر موهوم في الترك أو معلوم، وإذا كان هذا هو الوجوب فالموجب هو المرجح وهو الله تعالى، فإنه إذا ناط العقاب بترك النظر ترجح فعله على تركه، ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه واجب مرجح بترجح الله تعالى في ربطه العقاب بأحدهما. وأما المدرك فعبارة عن جهة معرفة الوجوب لا عن نفس الوجوب، وليس شرط الواجب أن يكون وجوبه معلوماً، بل أن يكون علمه متمكناً لمن أراده. فيقول النبي إن الكفر سم مهلك والإيمان شفاء مسعد بأن جعل الله تعالى أحدهما مسعداً والآخر مهلكاً، ولست أوجب عليك شيئاً، فزن الايجاب هو الترجيح والمرجح هو الله تعالى وإنما أنا مخبر عن كونه سم ومرشد لك إلى طريق تعرف به صدقي وهو النظر في المعجزة، فإن سلكت الطريق عرفت ونجوت؛ وإن تركت هلكت. ومثاله مثال طبيب انتهى إلى مريض وهو متردد بين دوائين موضوعين بين يديه، فقال له أما هذا فلا تتناوله فإنه لهلك للحيوان وأنت قادر على معرفته بأن تطعمه هذا السنور فيموت على الفور فيظهر لك ما قلته. وأما هذا ففيه شفاؤك وأنت قادر على معرفته بالتجربات وهو إن تشربه فتشفى فلا فرق في حقي ولا في حق أُستاذي بين أن يهلك أو يشفى فإن أُستاذي غني عن بقائك وأنا أيضاً كذلك، فعند هذا لو قال المريض هذا يجب علي بالعقل أو بقولك وما لم يظهر لي هذا لم أشتغل بالتجربة كان مهلكاً نفسه ولم يكن عليه ضرر، فكذلك النبي قد أخبره الله تعالى بأن الطاعة شفاء والمعصية داء وأن الإيمان مسعد والكفر مهلك وأخبره بأنه غني عن العالمين سعدوا أم شقوا فإنما شأن الرسول أن يبلغ ويرشد إلى طريقة المعرفة وينصرف، فمن نظر فلنفسه ومن قصر فعليها، وهذا واضح. فإن قيل: فقد رجع الأمر إلى أن العقل هو الموجب من حيث أنه بسماع كلامه ودعواه يتوقع عقاباً فيحمله العقل على الحذر ولا يحصل إلا بالنظر فيوجب عليه النظر، قلنا: الحق الذي يكشف الغطاء في هذا من غير اتباع وهم وتقليد أمر هو أن الوجوب كما بأن عبارة عن نوع رجحان في الفعل، والموجب هو الله تعالى لأنه هو المرجح، والرسول مخبر عن الترجيح، والمعجزة دليل على صدقه في الخبر، والنظر
سبب في معرفة الصدق، والعقل آلة النظر والفهم معنى الخبر، والطبع مستحث على الحذر بعد فهم المحذور بالعقل، فلا بد من طبع يخالفه العقوبة للدعوة ويوافقه الثواب الموعود ليكون مستحثاً، ولكن لا يستحث ما لم يفهم المحذور ولم يقدره ظناً أو علماً، ولا يفهم إلا بالعقل والعقل لا يفهم الترجيح بنفسه بل بسماعه من الرسول، والرسول لا يرجح الفعل على الترك بنفسه بل الله هو المرجح والرسول مخبر، وصدق الرسول لا يظهر بنفسه بل المعجز، والمعجزة لا تدل ما لم ينظر فيها، والنظر بالعقل، فإذاً قد انكشفت المعاني، والصحيح في الألفاظ أن يقال: الوجوب هو الرجحان والموجب هو الله تعالى، والمخبر هو الرسول، المعرف للمحذور وصدق الرسول هو العقل، والمستحث على سلوك سبب الخلاص وهو الطبع، وكذلك ينبغي أن يفهم الحق في هذه المسألة ولا يلتفت إلى الكلام المعتاد الذي لا يشفي الغليل ولا يزيل الغموض. لفهم معنى الخبر، والطبع مستحث على الحذر بعد فهم المحذور بالعقل، فلا بد من طبع يخالفه العقوبة للدعوة ويوافقه الثواب الموعود ليكون مستحثاً، ولكن لا يستحث ما لم يفهم المحذور ولم يقدره ظناً أو علماً، ولا يفهم إلا بالعقل والعقل لا يفهم الترجيح بنفسه بل بسماعه من الرسول، والرسول لا يرجح الفعل على الترك بنفسه بل الله هو المرجح والرسول مخبر، وصدق الرسول لا يظهر بنفسه بل المعجز، والمعجزة لا تدل ما لم ينظر فيها، والنظر بالعقل، فإذاً قد انكشفت المعاني، والصحيح في الألفاظ أن يقال: الوجوب هو الرجحان والموجب هو الله تعالى، والمخبر هو الرسول، المعرف للمحذور وصدق الرسول هو العقل، والمستحث على سلوك سبب الخلاص وهو الطبع، وكذلك ينبغي أن يفهم الحق في هذه المسألة ولا يلتفت إلى الكلام المعتاد الذي لا يشفي الغليل ولا يزيل الغموض. الدعوى السابعة: ندعي أن بعثة الأنبياء جائز، وليس بمحال ولا واجب، وقالت المعتزلة إنه واجب، وقد سبق وجه الرد عليهم. وقالت البراهمة إنه محال، وبرهان الجواز أنه مهما قام الدليل على أن الله تعالى متكلم وقام الدليل على أنه قادر لا يعجز على أن يدل على كلام النفس بخلق ألفاظ وأصوات ورقوم أو غيرها من الدلالات، وقد قام دليل على جواز إرسال الرسل، فإنا لسنا نعني به إلا أن يقوم بذات الله تعالى خبر عن الأمر النافع في الآخرة والأمر الضار بحكم إجراء العادة، ويصدر منه فعل هو دلالة الشخص على ذلك الخبر وعلى أمره بتبليغ الخبر، ويصدر منه فعل خارق للعادة مقروناً
بدعوى ذلك الشخص الرسالة، فليس شيء من ذلك محالاً لذاته، فإنه يرجع إلى كلام النفس وإلى اختراع ما هو دلالة على الكلام وما هو مصدق للرسول وإن حكم باستحالة ذلك من حيث الاستقباح والاستحسان، فقد استأصلنا هذا الأصل في حق الله تعالى ثم لا يمكن أن يدعي قبح إرسال الرسول على قانون الاستقباح، فالمعتزلة مع المصير إلى ذلك لم يستقبحوا هذا فليس إدراك قبحه ولا إدراك امتناعه في ذاته ضرورياً فلا بد من ذكر سببه. وغاية ما هو به ثلاثة شبه: الأولى: قولهم: إنه لو بعث النبي بما تقتضيه العقول ففي العقول غنية عنه وبعثة الرسول عبث، وذلك وعلى الله محال، وإن بعث بما يخالف العقول استحال التصديق والقبول. الثانية: إنه يستحيل العبث لأنه يستحيل تعريف صدقه، لأن الله تعالى لو شافه الخلق بتصديقه وكلمهم جهاراً فلا حاجة إلى رسول، وإن لم يشافه به فغايته الدلالة على صدقه بفعل خارق للعادة، ولا يتميز ذلك عن السحر والطلسمات وعجائب الخواص وهي خارقة للعادات عند من لا يعرفها، وإذا استويا في خرق العادة لم يؤمن ذلك فلا يحصل العلم بالتصديق. الثالثة: إنه إن عرف تمييزها عن السحر والطلسمات والتخيلات فمن أين يعرف الصدق؟ ولعل الله تعالى أراد إضلالنا وإغواءنا بتصديقه ولعل كل ما قال النبي إنه مسعد فهو مشقي، وكلما قال مشقي فهو مسعد، ولكن الله أراد أن يسوقنا إلى الهلاك ويغوينا بقول الرسول، فإن الإضلال والإغواء غير محال على الله تعالى عندكم، إذ العقل لا يحسن ولا يقبح؛ وهذه أقوى شبهة ينبغي أن يجادل بها المعتزلي عند رومه إلزام القول بتقبيح العقل، إذ يقول: إن لم يكن الاغواء قبيحاً فلا يعرف صدق الرسل قط ولا يعلم أنه ليس باضلال. والجواب أن نقول: أما الشبهة الأولى فضعيفة؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم يرد مخبراً بما لا تشتغل العقول بمعرفته، ولكن تستقل بفهمه إذا عرف، فإن العقل لا يرشد إلى النافع والضار من الأعمال والأقوال والأخلاق والعقائد، ولا يفرق بين المشقى والمسعد، كما لا يستقل بدرك خواص الأدوية والعقاقير، ولكنه إذا عرف فهم وصدق وانتفع بالسماع فيجتنب الهلاك ويقصد المسعد، كما ينتفع بقول الطبيب في معرفة الداء والدواء، ثم كما يعرف صدق الطبيب بقرائن الأحوال وأمور أُخر، فكذلك يستدل على صدق الرسول عليه السلام بمعجزات وقرائن وحالات فلا فرق. فأما الشبهة الثانية، وهو عدم تمييز المعجزة عن السحر والتخيل، فليس كذلك. فإن أحداً من العقلاء لم يجوز انتهاء السحر إلى إحياء الموتى، وقلب العصا ثعباناً،
وفلق القمر، وشق البحر، وإبراء الأكمه والأبرص، وأمثال ذلك. والقول الوجيز إن هذا القائل إن ادعى أن كل مقدور لله تعالى فهو ممكن تحصيله بالسحر فهو قول معلوم الاستحالة بالضرورة، وإن فرق بين فعل قوم وفعل قوم فقد تصور تصديق الرسول بما يعلم أنه ليس من السحر ويبقى النظر بعده في أعيان الرسل عليهم السلام وآحاد المعجزات وأن ما أظهروه من جنس ما يمكن تحصيله بالسحر أم لا، ومهما وقع الشك فيه لم يحصل التصديق به ما لم يتحد به النبي على ملأ من أكابر السحرة ولم يمهلهم مدة المعارضة ولم يعجزوا عنه، وليس الآن من غرضنا آحاد المعجزات. وأما الشبهة الثالثة، وهو تصور الإغواء من الله تعالى والتشكيك لسبب ذلك، فنقول: مهما علم وجه دلالة المعجزة على صدق النبي، علم أن ذلك مأمون عليه، وذلك بأن يعرف الرسالة ومعناها ويعرف وجه الدلالة فنقول: لو تحدى إنسان بين يدي ملك على جنده أنه رسول الملك إليهم وأن الملك أوجب طاعته عليهم في قسمة الأرزاق والاقطاعات، فطالبوه بالبرهان والملك ساكت، فقال: أيها الملك إن كنت صادقاً في ما ادعيته فصدقني بأن تقوم على سريرك ثلاث مرات على التوالي وتقعد على خلاف عادتك؛ فقام الملك عقيب التماسه على التوالي ثلاث مرات ثم قعد، حصل للحاضرين على ضروري بأنه رسول الملك قبل أن يخطر ببالهم أن هذا الملك من عادته الإغواء أم يستحيل في حقه ذلك. بل لو قال الملك صدقت وقد جعلت رسولاً ووكيلاً لعلم أنه وكيل ورسول، فإذا خالف العادة بفعله كان ذلك كقوله أنت رسولي، وهذا ابتداءً نصب وتولية وتفويض، ولا يتصور الكذب في التفويض وإنما يتصور في الإخبار، والعلم يكون هذا تصديقاً وتفويضاً ضرورياً، ولذلك لم ينكر أحد صدق الأنبياء من هذه الجهة، بل أنكروا كون ما جاء به الأنبياء خارقاً للعادة وحملوه على السحر والتلبيس أو أنكروا وجود رب متكلم آمر ناه مصدق مرسل، فأما من اعترف بجميع ذلك واعترف بكون المعجزة فعل الله تعالى حصل له العلم الضروري بالتصديق. فإن قيل: فهب أنهم رأوا الله تعالى بأعينهم وسمعوه بآذانهم وهو يقول هذا رسولي ليخبركم بطريق سعادتكم وشقاوتكم، فما الذي يؤمنكم أنه أغوى الرسول والمرسل إليه وأخبر عن المشقى بأنه مسعد وعن المسعد بأنه مشقى فإن ذلك غير محال إذا لم تقولوا بتقبيح العقول؟ بل لو قدر عدم الرسول ولكن قال الله تعالى شفاهاً وعياناً ومشاهدة: نجاتكم في الصوم والصلاة والزكاة وهلاككم في تركها، فبم نعلم صدقه؟ فلعله يلبس علينا ليغوينا ويهلكنا، فإن الكذب عندكم ليس قبيحاً لعينه وإن كان قبيحاً فلا يمتنع على الله تعالى ما هو قبيح وظلم، وما فيه فيه هلاك الخلق أجمعين.
والجواب: إن الكذب مأمون عليه، فإنه إنما يكون في الكلام وكلام الله تعالى ليس بصوت ولا حرف حتى يتطرق إليه التلبيس بل هو معنى قائم بنفسه سبحانه، فكل ما يعلمه الإنسان يقوم بذاته خبر عن معلومه على وفق علمه ولا يتصور الكذب فيه، وكذلك في حق الله تعالى. وعلى الجملة: الكذب في كلام النفس محال وفي ذلك الأمن عما قالوه. وقد اتضح بهذا أن الفعل مهما علم أنه فعل الله تعالى وأنه خارج عن مقدور البشر واقترن بدعوى النبوة حصل العلم الضروري بالصدق وكان الشك من حيث الشك في أنه مقدور البشر أم لا، فأما بعد معرفته كونه من فعل الله تعالى لا يبقى للشك مجال أصلاً البتة. فإن قيل فهل تجوزون الكرامات؟ قلنا: اختلف الناس فيه، والحق ذلك جائز فإنه يرجع إلى خرق الله تعالى العادة بدعاء إنسان أو عند حاجته وذلك مما لا يستحيل في نفسه لأنه ممكن، ولا يؤدي إلى محال آخر، فإنه لا يؤدي إلى بطلان المعجزة لأن الكرامة عبارة عما يظهر من غير اقتران التحدي به، فإن كان مع التحدي فإنا نسميه معجزة ويدل بالضرورة على صدق المتحدي؛ وإن لم تكن دعوى فقد يجوز ظهور ذلك على يد فاسق لأنه مقدور في نفسه؛ فإن قيل: فهل من المقدور إظهار معجزة على يد كاذب؟ قلنا: المعجزة مقرونة بالتحدي منه سبحانه نازلة منزلة قوله صدقت وأنت رسول، وتصديق الكاذب محال لذاته وكل من قال له أنت رسولي صار رسولاً وخرج عن كونه كاذباً، فالجمع بين كونه كاذباً وبين ما ينزل منزلة قوله أنت رسولي محال لأن معنى كونه كاذباً أنه ما قيل له أنت رسولي، ومعنى المعجزة أنه قيل له أنت رسولي؛ فإن فعل الملك على ما ضربنا من المثال كقوله أنت رسولي بالضرورة، فاستبان أن هذا غير مقدور لأنه محال والمحال لا قدرة عليه. فهذا تمام هذا القطب ولنشرع في إثبات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإثبات ما اخبر هو عنه والله أعلم.
القطب الرابع إثبات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإثبات ما أخبر هو عنه وفيه أربعة أبواب: الباب الأول: في اثبات نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. الباب الثاني: في بيان إن ما جاء به من الحشر والنشر والصراط والميزان وعذاب القبر حق، وفيه مقدمة وفصلان. الباب الثالث: فيه نظر في ثلاثة أطراف. الباب الرابع: في بيان من يجب تكفيره من الفرق ومن لا يجب، والاشارة إلى القوانين التي ينبغي أن يعول عليها في التكفير، وبه اختتام الكتاب.
الباب الأول في اثبات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإنما نفتقر إلى إثبات نبوته، على الخصوص، وعلى ثلاثة فرق: الفرقة الأولى، العيسوية: حيث ذهبوا إلى أنه رسول إلى العرب فقط لا إلى غيرهم، وهذا ظاهر البطلان فإنهم اعترفوا بكونه رسولاً حقاً، ومعلوم أن الرسول لا يكذب، وقد ادعى هو أنه رسول مبعوث إلى الثقلين، وبعث رسوله إلى كسرى وقيصر وسائر ملوك العجم وتواتر ذلك منه فما قالوه محال متناقض. الفرقة الثانية، اليهود: فإنهم انكروا صدقه لا بخصوص نظر فيه وفي معجزاته، بل زعموا أنه لا نبي بعد موسى عليه السلام، فأنكروا نبوة محمد وعيسى عليهما السلام. فينبغي أن تثبت عليهم نبوة عيسى لأنه ربما يقصر فهمهم عن درك إعجاز القرآن ولا يقصرون عن درك إعجاز إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص فيقال لهم ما الذي حملكم على التفريق بين من يستدل على صدقه بإحياء الموتى وبين من يستدل بقلب العصا ثعباناً؟ ولا يجدون إليه سبيلاً البتة، إلا أنهم ضلوا بشبهتين: إحداهما، قولهم: النسخ محال في نفسه لأنه يدل على البدء والتغيير وذلك محال على الله تعالى، والثانية لفهم بعض الملحدة أن يقولوا: قد قال موسى عليه السلام: عليكم بديني ما دامت السموات والأرض، وإنه قال إني خاتم الأنبياء. أما الشبهة الأولى فبطلانها بفهم النسخ، وهو عبارة عن الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت المشروط استمراره بعد لحقوق خطاب يرفعه، وليس من المحال أن يقول السيد لعبده قم مطلقاً، ولا يبين له مدة القيام، وهو يعلم أن القيام مقتضى منه إلى وقت بقاء مصلحته في القيام، ويعلم مدة مصلحته ولكن لا ينبه عليها، ويفهم العبد أنه مأمور بالقيام مطلقاً وأن الواجب الاستمرار عليه أبداً إلا أن يخاطبه السيد بالقعود؛ فإذا خاطبه بالقعود قعد ولم يتوهم بالسيد أنه بدا له أو ظهرت له مصلحة كان لا يعرفها، والآن قد عرفها، بل يجوز أن يكون قد عرف مدة مصلحة القيام وعرف أن الصلاح في أن لا ينبه العبد عليها ويطلق الأمر له إطلاقاً حتى يستمر على الامتثال، ثم إذا تغيرت مصلحته أمره بالقعود، فهكذا ينبغي أن يفهم اختلاف
أحكام الشرائع. فإن ورود النبي ليس بناسخ لشرع من قبله بمجرد بعثته، ولا في معظم الأحكام، ولكن في بعض الأحكام كتغير قبلة وتحليل محرم وغير ذلك، وهذه المصالح تختلف بالأعصار والأحوال فليس فيه ما يدل على التغير ولا على الاستبانة بعد الجهل ولا على التناقض. ثم هذا إنما يستمر لليهود إذ لو اعتقدوا أنه لم يكن شريعة من لدن آدم إلى زمن موسى لم ينكروا وجود نوح وإبراهيم وشرعهما، ولا يتميزون فيه عمن ينكر نبوة موسى وشرعه وكل ذلك إنكار ما علم على القطع بالتواتر. وأما الشبهة الثانية فسخيفة من وجهين. أحدهما، أنه لو صح ما قالوه عن موسى لما ظهرت المعجزات على يد عيسى، فإن ذلك تصديق بالضرورة، فكيف يصدق الله بالمعجزة من يكذب موسى وهو أيضاً مصدق له، أفتنكرون معجزة عيسى وجوداً أو تنكرون إحياء الموتى دليلاً على صدق المتحدي؟ فإن أنكروا شيئاً منهم لزمهم في شرع موسى لزوماً لا يجدون عنه محيصاً، وإذا اعترفوا به لزمهم تكذيب من نقل إليهم من موسى عليه السلام قوله إني خاتم الأنبياء. والثاني: أن هذه الشبهة إنما لقنوها بعد بعثة نبينا محمد عليه السلام وبعد وفاته، ولو كانت صحيحة لاحتج اليهود بها وقد حملوا بالسيف على الاسلام، وكان رسولنا عليه السلام مصدقاً بموسى عليه السلام وحاكماً على اليهود بالتوراة في حكم الرجم وغيره، فلا عرض عليه من التوارة ذلك، وما الذي صرفهم عنه ومعلوم قطعاً أن اليهود لم يحتجوا به لأن ذلك لو كان لكان مفحماً لا جواب عنه ولتواتر نقله، ومعلوم أنهم لم يتركوه مع القدرة عليه ولقد كانوا يحرصون على الطعن في شرعه بكل ممكن حمايةً لدمائهم وأموالهم ونسائهم، فإذا ثبت عليهم نبوة عيسى أثبتنا نبوة نبينا عليه السلام بما نثبتها على النصارى. الفرقة الثالثة، وهم يجوزون النسخ ولكنهم ينكرون نبوة نبينا من حيث أنهم ينكرون معجزته في القرآن. وفي إثبات نبوته بالمعجزة طريقتان: الطريقة الأولى، التمسك بالقرآن، فإنا نقول: لا معنى للمعجزة إلا ما يقترن بتحدي النبي عند استشهاده على صدقه على وجه يعجز الخلق عن معارضته، وتحديه على العرب مع شغفهم بالفصاحة وإغراقهم فيها متواتر، وعدم المعارضة معلوم، إذ لو كان لظهر، فإن أرذل الشعراء لما تحدوا بشعرهم وعورضوا ظهرت المعارضات والمناقضات الجارية بينهم، فإذاً لا يمكن إنكار تحديه بالقرآن ولا يمكن إنكار اقتدار العرب على طريق الفصاحة ولا يمكن انكار حرصهم على دفع نبوته بكل ممكن حماية لدينهم ودمهم ومالهم وتخلصاً من سطوة المسلمين وقهرهم، ولا يمكن إنكار عجزهم
لأنهم لو قدروا لفعلوا، فإن العادة قاضية بالضرورة بأن القادر على دفع الهلاك عن نفسه يشتغل بدفعه، ولو فعلوا لظهر ذلك ونقل. فهذه مقدمات بعضها بالتواتر وبعضها بجاري العادات وكل ذلك مما يورث اليقين فلا حاجة إلى التطويل. وبمثل هذا الطريق تثبت نبوة عيسى ولا يقدر النصراني على إنكار شيء من ذلك؛ فإنه يمكن أن يقابل بعيسى فينكر تحديه بالنبوة أو استشهاده باحياء الموتى أو وجود إحياء الموتى أو عدم المعارضة أو يقال عورض ولم يظهر، وكل ذلك مجاحدات لا يقدر عليها المعترف بأصل النبوات، فإن قيل: ما وجه إعجاز القرآن؟ قلنا الجزالة والفصاحة مع النظم العجيب والمنهاج الخارج عن مناهج كلام العرب في خطبهم وأشعارهم وسائر صنوف كلامهم، والجمع بين هذا النظم وهذه الجزالة معجز خارج عن مقدور البشر، نعم ربما يرى للعرب أشعار وخطب حكم فيها بالجزالة، وربما ينقل عن بعض من قصد المعارضة مراعاة هذا النظم بعد تعلمه من القرآن، ولكن من غير جزالة بل مع ركاكة كما يحكى عن ترهات مسيلمة الكذاب حيث قال: الفيل وما أدراك ما الفيل له ذنب وثيل وخرطوم طويل. فهذا وأمثاله ربما يقدر عليه مع ركاكة يستغثها الفصحاء ويستهزؤون بها، وأما جزالة القرآن فقد قضى كافة العرب منها العجب ولم ينقل عن واحد منهم تشبث بطعن في فصاحته، فهذا إذاً معجز وخارج عن مقدور البشر من هذين الوجهين، أعني من اجتماع هذين الوجهين، فإن قيل: لعل العرب اشتغلت بالمحاربة والقتال فلم تعرج على معارضة القرآن ولو قصدت لقدرت عليه، أو منعتها العوائق عن الاشتغال به، والجواب أن ما ذكروه هوس، فإن دفع تحدي المتحدي بنظم كلام أهون من الدفع بالسيف مع ما جرى على العرب من المسلمين بالأسر والقتل والسبي وشن الغارات، ثم ما ذكروه غير دافع غرضنا، فإن انصرافهم عن المعارضة لم يكن إلا بصرف من الله تعالى، والصرف عن المقدور المعتاد من أعظم المعجزات، فلو قال نبي آية صدقي أني في هذا اليوم أحرك أصبعي ولا يقدر أحد من البشر على معارضتي، فلم يعارضه أحد في ذلك اليوم، ثبت صدقه، وكان فقد قدرتهم على الحركة مع سلامة الأعضاء من أعظم المعجزات. وإن فرض وجود القدرة ففقد داعيتهم وصرفهم عن المعارضة من أعظم المعجزات، مهما كانت حاجتهم ماسةً إلى الدفع باستيلاء النبي على رقابهم وأموالهم، وذلك كله معلوم على الضرورة. فهذا طريق تقدير نبوته على النصارى، ومهما تشبثوا بانكار شيء من هذه الأمور الجليلة فلا تشتغل إلا بمعارضتهم بمثله في معجزات عيسى عليه السلام.
الطريقة الثانية: أن تثبت نبوته بجملة من الأفعال الخارقة للعادات التي ظهرت عليه، كانشقاق القمر، ونطق العجماء، وتفجر الماء من بين أصابعه، وتسبيح الحصى في كفه، وتكثير الطعام القليل، وغيره من خوارق العادات، وكل ذلك دليل على صدقه. فإن قيل: آحاد هذه الوقائع لم يبلغ نقلها مبلغ التواتر. قلنا: ذلك أيضاً إن سلم فلا يقدح في العرض مهما كان المجموع بالغاً مبلغ التواتر، وهذا كما أن شجاعة علي رضوان الله عليه وسخاوة حاتم معلومان بالضرورة على القطع تواتراً، وآحاد تلك الوقائع لم تثبت تواتراً، ولكن يعلم من مجموع الآحاد على القطع ثبوت صفة الشجاعة والسخاوة، فكذلك هذه الأحوال العجيبة بالغة جملتها مبلغ التواتر، لا يستريب فيها مسلم أصلاً. فإن قال قائل من النصارى: هذه الأمور لم تتواتر عندي لا جملتها ولا آحادها. فيقال: ولو انحاز يهودي إلى قطر من الأقطار ولم يخالط النصارى وزعم أنه لم تتواتر عنده معجزات عيسى، وإن تواترت فعلى لسان النصارى وهم مهتمون به، فبماذا ينفصلون عنه؟ ولا انفصال عنه إلا أن يقال: ينبغي أن يخالط القوم الذين تواتر ذلك بينهم حتى يتواتر ذلك إليك، فإن الأصم لا تتواتر عنده الأخبار، وكذا المتصامم، فهذا أيضاً عذرنا عند إنكار واحد منهم التواتر على هذا الوجه.
الباب الثاني في بيان وجوب التصديق بأمور ورد بها الشرع وقضى بجوازها العقل وفيه مقدمة وفصلان، أما المقدمة: فهو أن ما لا يعلم بالضرورة ينقسم إلى ما يعلم بدليل العقل دون الشرع، وإلى ما يعلم بالشرع دون العقل، وإلى ما يعلم بهما. أما المعلوم بدليل العقل دون الشرع فهو حدث العالم ووجود المحدث وقدرته وعلمه وارادته، فإن كل ذلك ما لم يثبت لم يثبت الشرع، إذ الشرع يبنى على الكلام فإن لم يثبت كلام النفس لم يثبت الشرع. فكل ما يتقدم في الرتبة على كلام النفس يستحيل إثباته بكلام النفس وما يستند إليه ونفس الكلام أيضاً فيما اخترناه لا يمكن اثباته بالشرع. ومن المحققين من تكلف ذلك وادعاه كما سبقت الاشارة إليه. وأما المعلوم بمجرد السمع فتخصيص أحد الجائزين بالوقوع فإن ذلك من موافق العقول، وإنما يعرف من الله تعالى بوحي والهام ونحن نعلم من الوحي إليه بسماع كالحشر والنشر والثواب والعقاب وأمثالهما، وأما المعلوم بهما فكل ما هو واقع في مجال العقل ومتأخر في الرتبة عن إثبات كلام الله تعالى كمسألة الرؤية وانفراد الله تعالى بخلق الحركات والأغراض كلها وما يجري هذا المجرى، ثم كلما ورد السمع به ينظر، فإن كان العقل مجوزاً له وجب التصديق به قطعاً إن كانت الأدلة السمعية قاطعة في متنها ومستندها لا يتطرق إليها احتمال، وجب التصديق بها ظناً إن كانت ظنية، فإن وجوب التصديق باللسان والقلب عمل يبنى على الأدلة الظنية كسائر الأعمال فنحن نعلم قطعاً إنكار الصحابة على من يدعي كون العبد خالقاً لشيء من الأشياء وعرض من الأعراض، وكانوا ينكرون ذلك بمجرد قوله تعالى " خالق كل شيء " ومعلوم أنه عام قابل للتخصيص فلا يكون عمومه إلا مظنوناً، إنما صارت المسألة قطعية بالبحث على الطرق العقلية التي ذكرناها، ونعلم أنهم كانوا ينكرون ذلك قبل البحث عن الطرق العقلية ولا ينبغي أن يعتقد بهم أنهم لم يلتفتوا إلى المدارك الظنية إلا في الفقهيات بل اعتبروها أيضاً في التصديقات الاعتقادية والقولية.
وأما ما قضى العقل باستحالته فيجب فيه تأويل ما ورد السمع به ولا يتصور أن يشمل السمع على قاطع مخالف للمعقول، وظواهر أحاديث التشبيه أكثرها غير صحيحة، والصحيح منها ليس بقاطع بل هو قابل للتأويل، فإن توقف العقل في شيء من ذلك فلم يقض فيه باستحالة ولا جواز وجب التصديق أيضاً لأدلة السمع فيكفي في وجوب التصديق انفكاك العقل عن القضاء بالإحالة، وليس يشترط اشتماله على القضاء لتجويز، وبين الرتبتين فرق ربما يزل ذهن البليد حتى لا يدرك الفرق بين قول القائل: اعلم أن الأمر جائز، وبين قوله: لا أدري إنه محال أم جائز، وبينهما ما بين السماء والأرض، إذ الأول جائز على الله تعالى والثاني غير جائز، فإن الأول معرفة بالجواز والثاني عدم معرفة بالاحالة، ووجوب التصديق جائز في القسمين جميعاً فهذه هي المقدمة. أما الفصل الأول ففي بيان قضاء العقل بما جاء الشرع به من الحشر والنشر وعذاب القبر والصراط والميزان أما الحشر فيعنى به إعادة الخلق وقد دلت عليه القواطع الشرعية، وهو ممكن بدليل الابتداء. فإن الاعادة خلق ثان ولا فرق بينه وبين الابتداء وإنما يسمى إعادة بالاضافة إلى الابتداء السابق، والقادر على الانشاء والابتداء قادر على الاعادة وهو المعني بقوله: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة فإن قيل فماذا تقولون: أتعدم الجواهر والأعراض ثم يعادان جميعاً، أو تعدم الأعراض دون الجواهر وإنما تعاد الأعراض؟ قلنا: كل ذلك ممكن وليس في الشرع دليل قاطع على تعيين أحد هذه الممكنات. وأحد الوجهين أن تنعدم الأعراض ويبقى جسم الانسان متصوراً بصورة التراب مثلاً، فتكون قد زالت منه الحياة واللون والرطوبة والتركيب والهيئة وجملة من الأعراض، ويكون معنى إعادتها أن تعاد إليها تلك الأعراض بعينها وتعاد إليها أمثالها، فإن العرض عندنا لا يبقى والحياة عرض والموجود عندنا في كل ساعة عرض آخر، والانسان هو ذلك الانسان باعتبار جسمه فإنه واحد لا باعتبار أعراضه، فإن كل عرض يتجدد هو غير الآخر، فليس من شرط الإعادة فرض إعادة الأعراض، وإنما ذكرنا هذا لمصير بعض الأصحاب إلى استحالة إعادة الأعراض، وذلك باطل، ولكن القول في إبطاله يطول ولا حاجة إليه في غرضنا هذا. والوجه الآخر أن تعدم الأجسام أيضاً ثم تعاد الأجسام بأن تخترع. مرة ثانية،
فإن قيل: فيم يتميز المعاد عن مثل الأول؟ وما معنى قولكم أن المعاد هو عين الأول ولم يبق للمعدوم عين حتى تعاد؟ قلنا: المعدوم منقسم في علم الله إلى ما سبق له وجود وإلى ما لم يسبق له وجود، كما أن العدم في الأزل ينقسم إلى ما سيكون له وجود وإلى ما علم الله تعالى أنه لا يوجد؛ فهذا الانقسام في علم الله لا سبيل إلى انكاره، والعلم شامل والقدرة واسعة، فمعنى الإعادة أن نبذل بالوجود العدم الذي سبق له الوجود، ومعنى المثل أن يخترع الوجود لعدم لم يسبق له وجود، فهذا معنى الإعادة، ومهما قدر الجسم باقياً ورد الأمر إلى تجديد أعراض تماثل الأول حصل تصديق الشرع ووقع الخلاص عن إشكال الإعادة وتمييز المعاد عن المثل، وقد أطنبنا في هذه المسألة في كتاب التهافت، وسلكنا في إبطال مذهبهم تقرير بقاء النفس التي هي غير متحيز عندهم وتقدير عود تدبيرها إلى البدن سواء كان ذلك البدن هو عين جسم الانسان أو غيره، وذلك إلزام لا يوافق ما نعتقده؛ فإن ذلك الكتاب مصنف لابطال مذهبهم لا لاثبات المذهب الحق، ولكنهم لما قدروا أن الانسان هو ما هو باعتبار نفسه وأن اشتغاله بتدبير كالعارض له والبدن آلة لهم، ألزمناهم بعد اعتقادهم بقاء النفس وجوب التصديق بالاعادة وذلك برجوع النفس إلى تدبير بدن من الأبدان، والنظر الآن في تحقيق هذا الفصل ينجر إلى البحث عن الروح والنفس والحياة وحقائقها، ولا تحتمل المعتقدات التغلغل إلى هذه الغايات في المعقولات، فما ذكرناه كاف في بيان الاقتصاد في الاعتقاد للتصديق بما جاء به الشرع، وأما عذاب القبر فقد دلت عليه قواطع الشرع إذ تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم بالاستعاذة منه في الأدعية واشتهر قوله عند المرور بقبرين: إنهما ليعذبان ودل عليه قوله تعالى " وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدواً وعشياً " الآية، وهو ممكن، فيجب التصديق به. ووجه إمكانه ظاهر، وإنما تنكره المعتزلة من حيث يقولون إنا نرى شخص الميت مشاهدة وهو غير معذب وإن الميت ربما تفترسه السباع وتأكله، وهذا هوس؛ أما
مشاهدة الشخص فهو مشاهدة لظواهر الجسم والمدرك للعقاب جزء من القلب أو من الباطن كيف كان وليس من ضرورة العذاب ظهور حركة في ظاهر البدن، بل الناظر إلى ظاهر النائم لا يشاهد ما يدركه النائم من اللذة عند الاحتلام ومن الألم عند تخيل الضرب وغيره، ولو انتبه النائم وأخبر عن مشاهداته وآلامه ولذاته من لم يجر له عهد بالنوم لبادر إلى الانكار اغتراراً بسكون ظاهر جسمه، كمشاهدة إنكار المعتزلة لعذاب القبر وأما الذي تأكله السباع فغاية ما في الباب أن يكون بطن السبع قبراً، فاعادة الحياة إلى جزء يدرك العذاب ممكن، فما كل متألم يدرك الألم من جميع بدنه، وأما سؤال منكر ونكير فحق، والتصديق به واجب لورود الشرع به وامكانه، فإن ذلك لا يستدعي منهما إلا تفهيماً بصوت أو بغير صوت، ولا يستدعي منه إلا فهماً، ولا يستدعي الفهم إلا حياة، والإنسان لا يفهم بجميع بدنه بل بجزء من باطن قلبه، واحياء جزء يفهم السؤال ويجيب ممكن مقدور عليه، فيبقى قول القائل إنا نرى الميت ولا نشاهد منكراً ونكيراً ولا نسمع صوتهما في السؤال ولا صوت الميت في الجواب، فهذا يلزمه منه أن ينكر مشاهدة النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام وسماعه كلامه وسماع جبريل جوابه ولا يستطيع مصدق الشرع أن ينكر ذلك، إذ ليس فيه إلا أن الله تعالى خلق له سماعاً لذلك الصوت ومشاهدة لذلك الشخص، ولم يخلق للحاضرين عنده ولا لعائشة رضي الله تعالى عنها وقد كانت تكون عنده حاضرة في وقت ظهور بركات الوحي، فانكار هذا مصدره الإلحاد وإنكار سعة القدرة، وقد فرغنا عن إبطاله ويلزم منه أيضاً إنكار ما يشاهده النائم ويسمعه من الأصوات الهائلة المزعجة، ولولا التجربة لبادر إلى الانكار كل من سمع من النائم حكاية أحواله، فتعساً لمن ضاقت حوصلته عن تقدير اتساع القدرة لهذه الأمور المستحقرة بالاضافة إلى خلق السموات والأرض وما بينهما، مع ما فيهما من العجائب. والسبب الذي ينفر طباع أهل الضلال عن التصديق بهذه الأمور بعينه منفر عن التصديق بخلق الانسان من نطفة قذرة مع ما فيه من العجائب والآيات أولاً أن المشاهدة تضطره إلى التصديق فإذاً ما لا برهان على إحالته لا ينبغي أن ينكر بمجرد الاستبعاد. والإنسان لا يفهم بجميع بدنه بل بجزء من باطن قلبه، واحياء جزء يفهم السؤال ويجيب ممكن مقدور عليه، فيبقى قول القائل إنا نرى الميت ولا نشاهد منكراً ونكيراً ولا نسمع صوتهما في السؤال ولا صوت الميت في الجواب، فهذا يلزمه منه أن ينكر مشاهدة النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام وسماعه كلامه وسماع جبريل جوابه ولا يستطيع مصدق الشرع أن ينكر ذلك، إذ ليس فيه إلا أن الله تعالى خلق له سماعاً لذلك الصوت ومشاهدة لذلك الشخص، ولم يخلق للحاضرين عنده ولا لعائشة رضي الله تعالى عنها وقد كانت تكون عنده حاضرة في وقت ظهور بركات الوحي، فانكار هذا مصدره الإلحاد وإنكار سعة القدرة، وقد فرغنا عن إبطاله ويلزم منه أيضاً إنكار ما يشاهده النائم ويسمعه من الأصوات الهائلة المزعجة، ولولا التجربة لبادر إلى الانكار كل من سمع من النائم حكاية أحواله، فتعساً لمن ضاقت حوصلته عن تقدير اتساع القدرة لهذه الأمور المستحقرة بالاضافة إلى خلق السموات والأرض وما بينهما، مع ما فيهما من العجائب. والسبب الذي ينفر طباع أهل الضلال عن التصديق بهذه الأمور بعينه منفر عن التصديق بخلق الانسان من نطفة قذرة مع ما فيه من العجائب والآيات أولاً أن المشاهدة تضطره إلى التصديق فإذاً ما لا برهان على إحالته لا ينبغي أن ينكر بمجرد الاستبعاد. وأما الميزان فهو أيضاً حق وقد دلت عليه قواطع السمع، وهو ممكن فوجب التصديق به. فإن قيل: كيف توزن الأعمال وهي أعراض وقد انعدمت، والمعدوم لا يوزن؟ وإن قدرت إعادتها وخلقها في جسم الميزان كان محالاً لاستحالة إعادة الأعراض. ثم كيف تخلق حركة يد الانسان وهي طاعته في جسم الميزان؟ أيتحرك بها الميزان فيكون ذلك حركة الميزان لا حركة يد الانسان أم لا تتحرك فتكون الحركة قد فاتت بجسم
ليس هو متحركاً بها، وهو محال؟ ثم إن تحرك فيتفاوت من الميزان بقدر طول الحركات وكثرتها لا بقدر مراتب الأجور، فرب حركة بجرء من البدن يزيد إثمها على حركة جميع البدن فراسخ فهذا محال. فنقول: قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا فقال: " توزن صحائف الأعمال فإن الكرام الكاتبين يكتبون الأعمال في صحائف هي أجسام، فإذا وضعت في الميزان خلق الله تعالى في كفتها ميلاً بقدر رتبة الطاعات وهو على ما يشاء قدير ". فإن قيل: فأي فائدة في هذا؟ وما معنى المحاسبة؟ قلنا: لا نطلب لفعل الله تعالى فائدة: " لا يسأل عما يفعل وهو يسألون ". تم قد دللنا على هذا. ثم أي بعد في أن تكون الفائدة فيه أن يشاهد العبد مقدار أعماله ويعلم أنه مجزي بها بالعدل أو يتجاوز عنه باللطف، ومن يعزم على معاقبة وكيله بجنايته في أمواله أو يعزم على الإبراء فمن أين يبعد أن يعرفه مقدار جنايته بأوضح الطرق ليعلم أنه في عقوبته عادل وفي التجاوز عنه متفضل. هذا إن طلبت الفائدة لأفعال الله تعالى، وقد سبق بطلان ذلك. وأما الصراط فهو أيضاً حق، والتصديق به واجب، لأنه ممكن. فإنه عبارة عن جسر ممدود على متن جهنم يرده الخلق كافة، فإذا توافوا عليه قيل للملائكة " وقفوهم إنهم مسؤولون " فإن قيل: كيف يمكن ذلك وفيما روى أدق من الشعر وأحد من السيف، فكيف يمكن المرور عليه؟ قلنا هذا إن صدر ممن ينكر قدرة الله تعالى، فالكلام معه في إثبات عموم قدرته وقد فرغنا عنها. وإن صدر من معترف بالقدرة فليس المشي على هذا بأعجب من المشي في الهواء، والرب تعالى قادر على خلق قدرة عليه، ومعناه أن يخلق له قدرة المشي على الهواء ولا يخلق في ذاته هوياً إلى أسفل، ولا في الهواء انحراف، فإذا أمكن هذا في الهواء فالصراط أثبت من الهواء بكل حال. الفصل الثاني: في الاعتذار عن الإخلال بفصول شحنت بها المعتقدات فرأيت الإعراض عن ذكرها أولى لأن المعتقدات المختصرة حقها أن لا تشتمل إلا على المهم الذي لا بد منه في صحة الاعتقاد.
أما الأمور التي لا حاجة إلى إخطارها بالبال، وإن خطرت بالبال فلا معصية في عدم معرفتها وعدم العلم بأحكامها، فالخوض فيها بحث عن حقائق الأمور وهي غير لائقة بما يراد منه تهذيب الاعتقاد، وذلك الفن تحصره ثلاثة فنون: عقلي، ولفظي، وفقهي. أما العقلي، فالبحث عن القدرة الحادثة أنها تتعلق بالضدين أم لا، وتتعلق بالمختلفات أم لا، وهل يجوز قدرة حادثة تتعلق بفعل مباين لمحل القدرة وأمثال له. وأما اللفظي فكالبحث عن المسمى باسم الرزق ما هو، ولفظ التوفيق والخذلان والايمان ما حدودها ومسبباتها. وأما الفقهي فكالبحث عن الأمر بالمعروف متى يجب، وعن التوبة ما حكمها، إلى نظائر ذلك. وكل ذلك ليس بمهم في الدين، بل المهم أن ينفي الانسان الشك عن نفسه في ذات الله تعالى، على القدر الذي حقق في القطب الأول، وفي صفاته وأحكامها كما حقق في القطب الثاني، وفي أفعاله بأن يعتقد فيها الجواز دون الوجوب كما في القطب الثالث، وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يعرف صدقه ويصدقه في كل ما جاء به كما ذكرناه في القطب الرابع، وما خرج عن هذا فغير مهم. ونحن نورد من كل فن مما أهملناه مسألة ليعرف بها نظائرها ويحقق خروجها عن المهمات المقصودات في المعتقدات. أما المسألة الأولى العقلية: فكاختلاف الناس في أن من قتل هل يقال إنه مات بأجله؟ ولو قدر عدم قتله هل كان يجب موته أم لا؟ وهذا فن من العلم لا يضر تركه، ولكنا نشير إلى طريق الكشف فيه. فنقول: كل شيئين لا ارتباط لأحدهما بالآخر، ثم اقترنا في الوجود، فليس يلزم من تقدير نفي أحدهما انتفاء الآخر. فلو مات زيد وعمرو معاً ثم قدرنا عدم موت زيد لم يلزم منه لا عدم موت عمرو ولا وجود موته، وكذلك إذا مات زيد عند كسوف القمر مثلاً، فلو قدرنا عدم الموت لم يلزم عدم الكسوف بالضرورة، ولو قدرنا عدم الكسوف لم يلزم عدم الموت إذ لا ارتباط لأحدهما بالآخر، فأما الشيئان اللذان بينهما علاقة وارتباط فهما ثلاثة أقسام: أحدها: أن تكون العلاقة متكافئة كالعلاقة بين اليمين والشمال والفوق والتحت، فهذا مما يلزم فقد أحدهما عند تقدير فقد الآخر لأنهما من المتضايفان
التي لا يتقوم حقيقة أحدهما إلا مع الآخر. الثاني: أن لا يكون على التكافؤ، لكن لأحدهما رتبة التقدم كالشرط مع المشروط. ومعلوم أنه يلزم عدم الشرط، فإذا رأينا علم الشخص مع حياته وإرادته مع علمه فيلزم لا محالة من تقدير انتفاء الحياة انتفاء العلم، ومن تقدير انتفاء العلم انتفاء الارادة، ويعبر عن هذا بالشرط وهو الذي لا بد منه لوجود الشيء ولكن ليس وجود الشيء به بل عنه ومعه. الثالث: العلاقة التي بين العلة والمعلول. ويلزم من تقدير عدم العلة عدم المعلول إن لم يكن للمعلول إلا علة واحدة، وإن تصور أن تكون له علة أخرى فيلزم من تقدير نفي كل العلل نفي المعلول، ولا يلزم من تقدير نفي علة بعينها نفي المعلول مطلقاً، بل يلزم نفي معلول تلك العلة على الخصوص. فإذا تمهد هذا المعنى رجعنا إلى القتل والموت؛ فالقتل عبارة عن حز الرقبة وهو راجع إلى أعراض هي حركات في يد الضارب والسيف وأعراض هي افتراقات في أجزاء رقبة المضروب، وقد اقترن بها عرض آخر وهو الموت، فإن لم يكن بين الحز والموت ارتباط لم يلزم من تقدير نفي الحز نفي الموت فإنهما شيئان مخلوقان معاً على الاقتران بحكم إجراء العادة لا ارتباط لأحدهما بآخر، فهو كالمقترنين اللذين لم تجر العادة باقترانهما وإن كان الحز علة الموت ومولده، وإن لم تكن علة سواه لزم من انتفائه انتفاء الموت، ولكن لا خلاف في أن للموت عللاً من أمراض وأسباب باطنة سوى الحز عند القائلين بالعلل، فلا يلزم من نفي الحز نفي الموت مطلقاً ما لم يقدر مع ذلك إنتفاء سائر العلل، فنرجع إلى غرضنا فنقول: من اعتقد من أهل السنة أن الله مستبد بالاختراع بلا تولد، ولا يكون مخلوق علة مخلوق، فنقول: الموت أمر استبد الرب تعالى باختراعه مع الحز، فلا يجب من تقدير عدم الحز عدم الموت وهو الحق؛ ومن اعتقد كونه علة وانضاف إليه مشاهدته صحة الجسم وعدم مهلك من خارج اعتقد أنه لو انتفى الحز وليس ثم علة أخرى وجب انتفاء المعلول لانتفاء جميع العلل، وهذا الاعتقاد صحيح لو صح اعتقاد التعليل وحصر العلل فيما عرف انتفاؤه فإذاً هذه المسألة يطول النزاع فيها، ولم يشعر أكثر الخائضين فيها بمثارها فينبغي أن نطلب هذا من القانون الذي ذكرناه في عموم قدرة الله تعالى وإبطال التولد. ويبنى على هذا أن منق تل ينبغي أن يقال إنه مات بأجله لأن الأجل عبارة عن الوقت الذي خلق الله تعالى فيه موته سواء كان معه حز رقبة أو كسوف قمر أو نزول مطر أو لم يكن، لأن كل هذه عندنا مقترنات وليست مؤثرات ولكن اقتران بعضها
يتكرر بالعادة، وبعضها لا يتكرر، فأما من جعل الموت سبباً طبيعياً من الفطرة وزعم أن كل مزاج فله رتبة معلومة في القوة إذا خليت ونفسها تمادت إلى منتها مدتها، ولو فسدت على سبيل الاحترام كان ذلك استعجالاً، بالإضافة إلى مقتضى طباعها، والأجل عبارة عن المدة الطبيعية، كما يقال الحائط مثلاً يبقى مائة سنة بقدر إحكام بنائه، ويمكن أن يهدم بالفأس في الحال، والأجل يعبر به عن مدته التي له بذاته وقوته، فيلزم من ذلك أن يقال إذا هدم بالفأس لم ينهدم بأجله وإن لم يتعرض له من خارج حتى انحطت أجزاؤه فيقال انهدم بأجله، فهذا اللفظ ينبيء على ذلك الأصل. المسألة الثانية وهي اللفظية: فكاختلافهم في أن الايمان هل يزيد وينقص أم هو على رتبة واحدة. وهذا الاختلاف منشؤه الجهل بكون الاسم مشتركاً، أعني اسم الايمان، وإذا فصل مسميات هذا اللفظ ارتفع الخلاف. وهو مشترك بين ثلاثة معان: إذ قد يعبر به عن التصديق اليقين البرهاني، وقد يعبر به عن الاعتقاد التقليدي إذا كان جزماً، وقد يعبر به عن تصديق معه العمل بموجب التصديق ودليل اطلاقه على الأول أن من عرف الله تعالى بالدليل ومات عقيب معرفته فإنا نحكم بأنه مات مؤمناً. ودليل اطلاقه على التصديق التقليدي أن جماهير العرب كانوا يصدقون رسول الله تعالى صلى الله عليه وسلم بمجرد إحسانه إليهم وتلطفه بهم ونظرهم في قوانين أحواله من غير نظر في أدلة الواحدانية ووجه دلالة المعجزة، وكان يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيمانهم وقد قال تعالى " وما أنت بمؤمن لنا " أي بمصدق، ولم يفرق بين تصديق وتصديق، ودليل إطلاقه على الفعل، قوله عليه السلام: لا يزني الزاني وهو مؤمن حين يزني وقوله عليه السلام: الايمان بضعة وسبعون باباً أدناها إماطة الأذى عن الطريق فنرجع إلى المقصود ونقول: إن أطلق الإيمان بمعنى التصديق البرهاني لم يتصور زيادته ولا نقصانه، بل اليقين إن حصل بكماله فلا مزيد عليه. وإن لم يحصل بكماله فليس بيقين، وهي خطة واحدة ولا يتصور فيها زيادة ونقصان إلا أن يراد به زيادة وضوح أي زيادة طمأنينة النفس إليه بأن النفس تطمئن إلى اليقينيات النظرية في الابتداء إلى حل ما، فإذا تواردت الأدلة على شيء واحد أفاد بظاهر الأدلة زيادة طمأنينة. وكل من مارس العلوم أدرك تفاوتاً في طمأنينية نفسه إلى العلم الضروري،
وهو العلم بأن الاثنين أكثر من الواحد وإلى العلم يحدث العالم وإن محدثه واحد، ثم يدرك أيضاً تفرقة بين آحاد المسائل بكثرة أدلتها وقلتها. فالتفاوت في طمأنينية النفس مشاهد لكل ناظر من باطنه، فإذا فسرت الزيادة به لم يمنعه أيضاً في هذا التصديق. أما إذا أطلق بمعنى التصديق التقليدي فذلك لا سبيل إلى جحد التفاوت فيه؛ فإنا ندرك بالمشاهدة من حال اليهودي في تصميمه على عقده ومن حال النصراني والمسلم تفاوتاً، حتى أن الواحد منهم لا يؤثر في نفسه وحل عقد لمبه التهويلات والتخويفات ولا التحقيقات العلمية ولا التخيلات الإقناعية، والواحد منهم مع كونه جازماً في اعتقاده تكون نفسه أطوع لقبول اليقين، وذلك لأن الاعتقاد على القلب مثل عقدة ليس فيها انشراح وبرد يقين. والعقدة تختلف في شدتها وضعفها فلا ينكر هذا التفاوت منصف وإنما ينكره الذين سمعوا من العلوم والاعتقادات أساميها ولم يدركوا من أنفسهم ذوقها، ولم يلاحظوا اختلاف أحوالهم وأحوال غيرهم فيها. وأما إذا أطلق بالمعنى الثالث وهو العمل مع التصديق، فلا يخفى بطرق التفاوت إلى نفس العمل، وهل يتطرق بسبب المواظبة على العمل تفاوت إلى نفس التصديق، هذا فيه نظر، وترك المداهنة في مثل هذا المقام أولى والحق أحق ما قيل. فأقول: إن المواظبة على الطاعات لها تأثير في تأكيد طمأنينة النفس إلى الاعتقاد التقليدي ورسوخه في النفس، وهذا أمر لا يعرفه إلا من سبر أحوال نفسه وراقبها في وقت المواظبة على الطاعة وفي وقت الفترة ولاحظ تفاوت الحال في باطنه، فإنه يزداد بسبب المواظبة على العمل أنسة لمعتقداته، ويتأكد به طمأنينته، حتى أن المعتقد الذي طالت منه المواظبة على العمل بموجب اعتقاده أعصا نفساً على المحاول تغييره وتشكيكه ممن لم تطل مواظبته، بل العادات تقضي بها، فإن من يعتقد الرحمة في قلبه على يتيم فإن أقدم على مسح رأسه وتفقد أمره صادف في قلبه عند ممارسة العمل بموجب الرحمة زيادة تأكيد في الرحمة، ومن يتواضع بقلبه لغيره فإذا عمل بموجبه ساجداً له أو مقبلاً يده ازداد التعظيم والتواضع في قلبه ولذلك تعبدنا بالمواظبة على أفعال هي مقتضى تعظيم القلب من الركوع والسجود ليزداد بسببها تعظيم القلوب، فهذه أمور يجحدها المتحذلقون في الكلام الذين أدركوا ترتيب العلم بسماع الألفاظ ولم يدركوها بذوق النظر. فهذه حقيقة المسألة، ومن هذا الخبر اختلافهم في معنى الرزق. وقول المعتزلة: إن ذلك مخصوص بما يملكه الإنسان حتى ألزموا أنه لا رزق لله تعال على البهائم، فربما قالوا هو مما لم يحرم تناوله، فقيل لهم فالظلمة ماتوا وقد عاشوا عمرهم لم يرزقوا، وقد قال أصحابنا إنه
عبارة عن المنتفع به كيف كان، ثم هو منقسم إلى حلال وحرام، ثم طولوا في حد الرزق وحد النعمة وتضييع الوقت بهذا وأمثاله دأب من لا يميز بين المهم وغيره ولا يعرف قدر بقية عمره، وإنه لا قيمة له فينبغي أن يضيع العمر إلا بالمهم وبين يدي الأنظار أمور مشكلة البحث عنها أهم من البحث عن موجب الألفاظ ومقتضى الإطلاقات، فنسأل الله أن يوفقنا للاشتغال لما يعنينا. المسألة الثالثة الفقهية: فمثل اختلافهم في أن الفاسق هل له أن يحتسب؟ وهذا نظر فقهي، فمن أين يليق بالكلام ثم بالمختصرات. ولكنا نقول الحق أن له أن يحتسب وسبيله التدرج في التصوير؛ وهو أن نقول: هل يشترط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كون الآمر والناهي معصوماً عن الصغائر والكبائر جميعاً؟ فإن شرط ذلك كان خرقاً للاجماع، فإن عصمة الأنبياء عن الكبائر إنما عرفت شرعاً، وعن الصغائر مختلف فيها، فمتى يوجد في الدنيا معصوم؟ وإن قلتم إن ذلك لا يشترط حتى يجوز للابس الحرير مثلاً وهو عاص به أن يمنع من الزنى وشرب الخمر، فنقول: وهل لشارب الخمر أن يحتسب على الكافر ويمنعه من الكفر ويقاتله عليه؟ فإن قالوا لا، خرقوا الاجماع إذ جنود المسلمين لم تزل مشتملة على العصاة والمطيعين ولم يمنعوا من الغزو لا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عصر الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، فإن قالوا نعم، فنقول: شارب الخمر هل له أن يمنع من القتل أم لا؟ فإن قيل لا، قلنا: فما الفرق بين هذا وبين لابس الحرير إذا منع من الخمر والزاني إذا منع من الكفر؟ وكما أن الكبيرة فوق الصغيرة فالكبائر أيضاً متفاوتة، فإن قالوا نعم، وضبطوا ذلك بأن المقدم على شيء لا يمنع من مثله ولا فيما دونه وله أن يمنع مما فوقه، فهذا الحكم لا مستند له إذ الزنى فوق الشرب ولا يبعد أن يزني ويمنع من الشراب ويمنع منه، ربما يشرب ويمنع غلمانه وأصحابه من الشرب، ويقول: ترك ذلك واجب عليكم وعلي والأمر بترك المحرم واجب علي مع الترك فلي أن أتقرب بأحد الواجبين، ولم يلزمني مع ترك أحدهما ترك الآخر، فإذن كما يجوز أن يترك الآمر بترك الشرب وهو بتركه يجوز أن يشرب ويأمر بالترك فهما واجبان فلا يلزم بترك أحدهما ترك الآخر.
فإن قيل: فيلزم على هذا أمور شنيعة وهو أن يزني الرجل بامرأة مكرهاً إياها على التمكين، فإن قال لها في أثناء الزنى عند كشفها وجهها باختيارها لا تكشفي وجهك فاني لست محرماً لك، والكشف لغير المحرم حرام، وأنت مكرهة على الزنى مختارة في كشف الوجه فأمنعك من هذا، فلا شك من أن هذه حسبة باردة شنيعة لا يصير إليها عاقل؛ وكذلك قوله إن الواجب علي شيئان العمل والأمر للغير، وأنا أتعاطى أحدهما وإن تركت الثاني كقوله: إن الواجب علي الوضوء دون الصلاة وأنا أصلي وإن تركت الوضوء، والمسنون في حقي الصوم والتسحر وأنا أتسحر وإن تركت الصوم، وذلك محال، لأن السحور للصوم والوضوء للصلاة، وكل واحد شرط الآخر وهو متقدم في الرتبة على المشروط، فكذلك نفس المرء مقدمة على غيره، فليهذب نفسه أولا ثم غيره أما إذا أهمل نفسه واشتغل بغيره كان ذلك عكس الترتيب الواجب، بخلاف ما إذا هذب نفسه وترك الحسبة وتهذيب غيره، فإن ذلك معصية ولكنه لا تناقض فيه. وكذلك الكافر ليس له ولاية الدعوة إلى الاسلام ما لم يسلم هو بنفسه، فلو قال الواجب علي شيئان ولي أن أترك أحدهما دون الثاني لم يكن منه، والجواب أن حسبة الزاني بالمرأة عليها ومنعها من كشفها وجهها جائزة عندنا، وقولكم إن هذه حسبة باردة شنيعة فليس الكلام في أنها حارة أو باردة مستلذة أو مستبشعة، بل الكلام في أنها حق أو باطل وكم من حق مستبرد مستثقل وكم من باطل مستحلى مستعذب، فالحق غير اللذيذ والباطل غير الشنيع، والبرهان القاطع فيه هو أنا نقول: قوله لها لا تكشفي وجهك فإنه حرام، ومنعه إياها بالعمل قول وفعل، وهذا القول والفعل إما أن يقال هو حرام أو يقال واجب أو يقال هو مباح، فإن قلتم إنه واجب فهو المقصود، وإن قلتم إنه مباح فله أن يفعل ما هو مباح، وإن قلتم إنه حرام فما مستند تحريمه؟ وقد كان هذا واجباً قبل اشتغاله بالزنى فمن أين يصير الواجب حراماً باقتحامه محرماً، وليس في قوله الأخير صدق عن الشرع بأنه حرام، وليس في فعله إلا المنع من اتحاد ما هو حرام، والقول بتحريم واحد منهما محال. ولسنا نعني بقولنا للفاسق ولاية الحسبة إلا أن قوله حق وفعله ليس بحرام، وليس هذا كالصلاة والوضوء فإن الصلاة هي المأمور بها وشرطها الوضوء، فهي بغير وضوء معصية وليست بصلاة، بل تخرج عن كونها صلاة وهذا القول لم يخرج عن كونه حقاً ولا الفعل خرج عن كونه منعاً من الحرام، وكذلك السحور عبارة عن الاستعانة على الصوم بتقديم الطعام ولا تعقل الاستعانة من غير العزم على ايجاد المستعان عليه. وأما قولكم أن تهذيبه نفسه أيضاً شرط لتهذيبه غيره، فهذا محل النزاع. فمن أين عرفتم ذلك؟ ولو قال قائل: تهذيب نفسه عن المعاصي شرط للغير ومنع الكفار، وتهذيبه نفسه عن الصغائر شرط للمنع عن الكبائر كان قوله مثل قولكم، وهو خرق للاجماع. وأما الكافر فإن حمل كافراً آخر بالسيف على الإسلام فلا يمنعه منه، ويقول عليه أن يقول لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأن يأمر غيره به ولم يثبت أن قوله شرط لأمره، فله أن يقول وأن يأمر وإن لم ينطق. فهذا غور هذه المسألة، وإنما أردنا إيرادها لتعلم أن أمثال هذه المسائل لا تليق بفن الكلام ولا سيما بالمعتقدات المختصرة والله أعلم بالصواب. يجاد المستعان عليه. وأما قولكم أن تهذيبه نفسه أيضاً شرط لتهذيبه غيره، فهذا محل النزاع. فمن أين عرفتم ذلك؟ ولو قال قائل: تهذيب نفسه عن المعاصي شرط للغير ومنع الكفار، وتهذيبه نفسه عن
الصغائر شرط للمنع عن الكبائر كان قوله مثل قولكم، وهو خرق للاجماع. وأما الكافر فإن حمل كافراً آخر بالسيف على الإسلام فلا يمنعه منه، ويقول عليه أن يقول لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأن يأمر غيره به ولم يثبت أن قوله شرط لأمره، فله أن يقول وأن يأمر وإن لم ينطق. فهذا غور هذه المسألة، وإنما أردنا إيرادها لتعلم أن أمثال هذه المسائل لا تليق بفن الكلام ولا سيما بالمعتقدات المختصرة والله أعلم بالصواب.
الباب الثالث في الامامة النظر في الإمامة أيضاً ليس من المهمات، وليس أيضاً من فن المعقولات فيها من الفقهيات، ثم إنها مثار للتعصبات والمعرض عن الخوض فيها أسلم من الخائض بل وإن أصاب، فكيف إذا أخطأ! ولكن إذا جرى الرسم باختتام المعتقدات به أردنا أن نسلك المنهج المعتاد فإن القلوب عن المنهج المخالف للمألوف شديدة النفار، ولكنا نوجز القول فيه ونقول: النظر فيه يدور على ثلاثة أطراف: الطرف الأول: في بيان وجوب نصب الإمام. ولا ينبغي أن تظن أن وجوب ذلك مأخوذ من العقل، فإنا بينا أن الوجوب يؤخذ من الشرع إلا أن يفسر الواجب بالفعل الذي فيه فائدة وفي تركه أدنى مضرة، وعند ذلك لا ينكر وجوب نصب الإمام لما فيه من الفوائد ودفع المضار في الدنيا، ولكنا نقيم البرهان القطعي الشرعي على وجوبه ولسنا نكتفي بما فيه من إجماع الأمة، بل ننبه على مستند الإجماع ونقول: نظام أمر الدين مقصود لصاحب الشرع عليه السلام قطعاً، وهذه مقدمة قطعية لا يتصور النزاع فيها، ونضيف إليها مقدمة أخرى وهو أنه لا يحصل نظام الدين إلا بإمام مطاع فيحصل من المقدمتين صحة الدعوى وهو وجوب نصب الإمام. فإن قيل: المقدمة الأخيرة غير مسلمة وهو أن نظام الدين لا يحصل إلا بإمام مطاع، فدلوا عليها. فنقول: البرهان عيه أن نظام الدين لا يحصل إلا بنظام الدنيا، ونظام الدنيا لا يحصل إلا بإمام مطاع، فهاتان مقدمتان ففي أيهما النزاع؟ فإن قيل لم قلتم إن نظام الدين لا يحصل إلا بنظام الدنيا، بل لا يحصل إلا بخراب الدنيا، فإن الدين والدنيا ضدان والاشتغال بعمارة أحدهما خراب الآخر، قلنا: هذا كلام من لا يفهم ما نريده بالدنيا الآن، فإنه لفظ مشترك قد يطلق على فضول التنعم والتلذذ والزيادة على الحاجة والضرورة، وقد يطلق على جميع ما هو محتاج إليه قبل الموت. وأحدهما ضد الدين والآخر شرطه، وهكذا يغلط من لا يميز
بين معاني الألفاظ المشتركة. فنقول: نظام الدين بالمعرفة والعبادة لا يتوصل إليهما إلا بصحة البدن وبقاء الحياة وسلامة قدر الحاجات من الكسوة والمسكن والأقوات، والأمن هو آخر الآفات، ولعمري من أصبح آمناً في سربه معافى في بدنه وله قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، وليس يأمن الإنسان على روحه وبدنه وماله ومسكنه وقوته في جميع الأحوال بل في بعضها، فلا ينتظم الدين إلا بتحقيق الأمن على هذه المهمات الضرورية، وإلا فمن كان جميع أوقاته مستغرقاً بحراسة نفسه من سيوف الظلمة وطلب قوته من وجوه الغلبة، متى يتفرغ للعلم والعمل وهما وسيلتاه إلى سعادة الآخرة، فإذن بان نظام الدنيا، أعني مقادير الحاجة شرط لنظام الدين. وأما المقدمة الثانية وهو أن الدنيا والأمن على الأنفس والأموال لا ينتظم إلا بسلطان مطاع فتشهد له مشاهدة أوقات الفتن بموت السلاطين والأئمة، وإن ذلك لو دام ولم يتدارك بنصب سلطان آخر مطاع دام الهرج وعم السيف وشمل القحط وهلكت المواشي وبطلت الصناعات، وكان كل غلب سلب ولم يتفرغ أحد للعبادة والعلم إن بقي حياً، والأكثرون يهلكون تحت ظلال السيوف، ولهذا قيل: الدين والسلطان توأمان، ولهذا قيل: الدين أس والسلطان حارس وما لا أس له فمهدوم وما لا حارس له فضائع. وعلى الجملة لا يتمارى العاقل في أن الخلق على اختلاف طبقاتهم وما هم عليه من تشتت الأهواء وتباين الآراء لو خلوا وراءهم ولمي كن رأي مطاع يجمع شتاتهم لهلكوا من عند آخرهم، وهذا داء لا علاج له إلا بسلطان قاهر مطاع يجمع شتات الآراء، فبان أن السلطان ضروري في نظام الدنيا، ونام الدنيا ضروري في نظام الدين، ونظام الدين ضروري في الفوز بسعادة الآخرة وهو مقصود الأنبياء قطعاً، فكان وجوب نصب الإمام من ضروريات الشرع الذي لا سبيل إلى تركه فاعلم ذلك. الطرف الثاني: في بيان من يتعين من سائر الخلق لأن ينصب إماماً. فنقول: ليس يخفى أن التنصيص على واحد نجعله إماماً بالتشهي غير ممكن، فلا بد له من تميز بخاصية يفارق سائر الخلق بهذا، فتلك خاصية في نفسه وخاصية من جهة غيره. أما من نفسه فأن يكون أهلاً لتدبير الخلق وحملهم على مراشدهم. وذلك بالكفاية والعلم والورع، وبالجملة خصائص القضاة تشترط فيه مع زيادة نسب قريش؛ وعلم هذا الشرط الرابع بالسمع حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش فهذا تميزه عن أكثر الخلق ولكن ربما يجتمع في قريش جماعة موصوفون بهذه الصفة فلا بد من خاصية أخرى
تميزه، وليس ذلك إلا التولية أو التفويض من غيره، فإنما يتعين للإمامة مهما وجدت التولية في حقه على الخصوص من دون غيره، فيبقى الآن النظر في صفة المولى فإن ذلك لا يسلم لكل أحد بل لا بد فيه من خاصية وذلك لا يصدر إلا من أحد ثلاثة: إما التنصيص من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، وإما التنصيص من جهة إمام العصر بأن يعين لولاية العهد شخصاً معيناً من أولاده أو سائر قريش، وإما التفويض من رجل ذي شوكة يقتضي انقياده وتفويضه متابعة الآخرين ومبادرتهم إلى المبايعة، وذلك قد يسلم في بعض الأعصار لشخص واحد مرموق في نفسه مرزوق بالمتابعة مسؤول على الكافة، ففي بيعته وتفويضه كفاية عن تفويض غيره لأن المقصود أن يجتمع شتات الآراء لشخص مطاع وقد صار الإمام بمبايعة هذا المطاع مطاعاً، وقد لا يتفق ذلك لشخص واحد بل لشخصين أو ثلاثة أو جماعة فلا بد من اجتماعهم وبيعتهم واتفاقهم على التفويض حتى تتم الطاعة. بل أقول: لو لم يكن بعد وفاة الإمام الاقرشي واحد مطاع متبع فنهض بالإمامة وتولاها بنفسه ونشأ بشوكته وتشاغل بها واستتبع كافة الخلق بشوكته وكفايته وكان موصوفاً بصفات الأئمة فقد انعقدت إمامته ووجبت طاعته، فإنه تعين بحكم شوكته وكفايته، وفي منازعته إثارة الفتن إلا أن من هذا حاله فلا يعجز أيضاً عن أخذ البيعة من أكابر الزمان وأهل الحل والعقد، وذلك أبعد من الشبهة فلذلك لا يتفق مثل هذا في العادة إلا عن بيعة وتفويض. فإن قيل: فإن كان المقصود حصول ذي رأي مطاع يجمع شتات الآراء ويمنع الخلق من المحاربة والقتال ويحملهم على مصالح المعاش والمعاد، فلو انتهض لهذا الأمر من فيه الشروط كلها سوى شروط القضاء ولكنه مع ذلك يراجع العلماء ويعمل بقولهم فماذا ترون فيه، أيجب خلعه ومخالفته أم تجب طاعته؟ قلنا: الذي نراه ونقطع أنه يجب خلعه إن قدر على أن يستبدل عنه من هو موصوف بجميع الشروط من غير إثارة فتنة وتهييج قتال، وإن لم يكن ذلك إلا بتحريك قتال وجبت طاعته وحكم بإمامته لأن ما يفوتنا من المصارفة بين كونه عالماً بنفسه أو مستفتياً من غيره دون ما يفوتنا بتقليد غيره إذا افتقرنا إلى تهييج فتنة لا ندري عاقبتها. وربما يؤدي ذلك إلى هلاك النفوس والأموال، وزيادة صفة العلم إنما تراعى مزية وتتمة للمصالح فلا يجوز أن يعطل أصل المصالح في التشوق إلى مزاياها وتكملاتها، وهذه مسائل فقهية فيلون المستعبد لمخالفته المشهود على نفسه استبعاده ولينزل من غلوائه فالأمر أهون مما يظنه، وقد استقضينا تحقيق هذا المعنى في الكتاب الملقب بالمستظهري المصنف في الرد على الباطنية،
فإن قيل فإن تسامحتم بخصلة العلم لزمكم التسامح بخصلة العدالة وغير ذلك من الخصال، قلنا: ليست هذه مسامحة عن الاختيار ولكن الضرورات تبيح المحظوارت، فنحن نعلم أن تناول الميتة محظور ولكن الموت أشد منه، فليت شعري من لا يساعد على هذا ويقضي ببطلان الإمامة في عصرنا لفوات شروطها وهو عاجز عن الاستبدال بالمتصدي لها بل هو فاقد للمتصف بشروطها، فأي أحواله أحسن: أن يقول القضاة معزولون والولايات باطلة والأنكحة غير منعقدة وجميع تصرفات الولاة في أقطار العالم غير نافذة، وإنما الخلق كلهم مقدمون على الحرام، أو أن يقول الإمامة منعقدة والتصرفات والولايات نافذة بحكم الحال والاضطرار، فهو بين ثلاثة أمور إما أن يمنع الناس من الأنكحة والتصرفات المنوطة بالقضاة وهو مستحيل ومؤدي إلى تعطيل المعايش كلها ويفضي إلى تشتيت الآراء ومهلك للجماهير والدهماء أو يقول إنهم يقدمون على الأنكحة والتصرفات ولكنهم مقدمون على الحرام، إلا أنه لا يحكم بفسقهم ومعصيتهم لضرورة الحال، وإما أن نقول يحكم بانعقاد الإمامة مع فوات شروطها لضرورة الحال ومعلوم أن البعيد مع الأبعد قريب، وأهون الشرين خير بالاضافة، ويجب على العاقل اختياره، فهذا تحقيق هذا الفصل وفيه غنية عند البصير عن التطويل ولكن من لم يفهم حقيقة الشيء وعلته وإنما يثبت بطول الألفة في سمعه فلا تزال النفرة عن نقيضه في طبعه إذ فطام الضعفاء عن المألوف شديد عجز عنه الأنبياء فكيف غيرهم. أبعد قريب، وأهون الشرين خير بالاضافة، ويجب على العاقل اختياره، فهذا تحقيق هذا الفصل وفيه غنية عند البصير عن التطويل ولكن من لم يفهم حقيقة الشيء وعلته وإنما يثبت بطول الألفة في سمعه فلا تزال النفرة عن نقيضه في طبعه إذ فطام الضعفاء عن المألوف شديد عجز عنه الأنبياء فكيف غيرهم. فإن قيل: فهلا قلتم إن التنصيص واجب من النبي والخليفة كي يقطع ذلك دابر الاختلاف كما قالت بعض الإمامية إذ ادعوا أنه واجب، قلنا: لأنه لو كان واجباً لنص عليه الرسول عليه السلام، ولم ينص هو ولم ينص عمر أيضاً بل ثبتت إمامة أبو بكر وإمامة عثمان وإمامة علي رضي الله عنهم بالتفويض، فلا تلتفت إلى تجاهل من يدعي أنه صلى الله عليه وسلم نص على علي لقطع النزاع ولكن الصحابة كابروا النص وكتموه، فأمثال ذلك يعارض بمثله ويقال: بم تنكرون على من قال إنه نص على أبي بكر فأجمع الصحابة على موافقته النص ومتابعته، وهو أقرب من تقدير مكابرتهم النص وكتمانه، ثم إنما يتخيل وجوب ذلك لتعذر قطع الاختلاف وليس ذلك بمعتذر، فإن البيعة تقطع مادة الاختلاف والدليل عليه عدم الاختلاف في زمان أبي بكر وعثمان رضي الله عنهم، وقد توليا البيعة، وكثرته في زمان علي رضي الله عنه ومعتقد الإمامية أنه تولى بالنص.
الطرف الثالث: في شرح عقيدة أهل السنة في الصحابة والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. اعلم أن للناس في الصحابة والخلفاء إسراف في أطراف؛ فمن مبالغ في الثناء حتى يدعي العصمة للأئمة، ومنهم متهجم على الطعن بطلق اللسان بذم الصحابة. فلا تكونن من الفريقين واسلك طريق الاقتصاد في الاعتقاد. واعلم أن كتاب الله مشتمل على الثناء على المهاجرين والأنصار وتواترت الأخبار بتزكية النبي صلى الله عليه وسلم إياهم بألفاظ مختلفة، كقوله أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وكقوله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم وما من واحد إلا وورد عليه ثناء خاص في حقه يطول نقله، فينبغي أن تستصحب هذا الاعتقاد في حقهم ولا تسيء الظن بهم كما يحكى عن أحوال تخالف مقتضى حسن الظن، فأكثر ما ينقل مخترع بالتعصب في حقهم ولا أصل له وما ثبت نقله فالتأويل متطرق إليه ولم يجز ما لا يتسع العقل لتجويز الخطأ والسهو فيه، وحمل أفعالهم على قصد الخير وإن لم يصيبوه. والمشهور من قتال معاوية مع علي ومسير عائشه رضي الله عنهم إلى البصرة والظن بعائشة أنها كانت تطلب تطفئة الفتنة ولكن خرج الأمر من الضبط، فأواخر الأمور لا تبقى على وفق طلب أوائلها، بل تنسل عن الضبط، والظن بمعاوية أنه كان على تأويل وظن فيما كان يتعاطاه وما يحكى سوى هذا من روايات الآحاد فالصحيح منه مختلط بالباطل والاختلاف أكثره اختراعات الروافض والخوارج وأرباب الفضول الخائضون في هذه الفنون. فينبغي أن تلازم الإنكار في كل ما لم يثبت، وما ثبت فيستنبط له تأويلاً. فما تعذر عليك فقل: لعل له تأويلاً وعذراً لم أطلع عليه. واعلم أنك في هذا المقام بين أن تسيء الظن بمسلم وتطعن عليه وتكون كاذباً أو تحسن الظن به وتكف لسانك عن الطعن وأنت مخطئ مثلاً، والخطأ في حسن الظن بالمسلم أسلم من الصواب بالطعن فيهم، فلو سكت إنسان مثلاً عن لعن ابليس أو لعن أبي جهل أو أبي لهب أو من شئت من الأشرار طول عمره لم يضره السكوت، ولو هفا هفوة بالطعن في مسلم بما هو بريء عند الله تعالى منه فقد تعرض
للهلاك، بل أكثر ما يعلم في الناس لا يحل النطق به لتعظيم الشرع الزجر عن الغيبة، مع أنه إخبار عما هو متحقق في المغتاب. فمن يلاحظ هذه الفصول ولم يكن في طبعه ميل إلى الفضول آثر ملازمته السكوت وحسن الظن بكافة المسلمين وإطلاق اللسان بالثناء على جميع السلف الصالحين. هذا حكم الصحابة عامة. فأما الخلفاء الراشدون فهم أفضل من غيرهم، وترتيبهم في الفضل عند أهل السنة كترتيبهم في الإمامة، وهذا لمكان أن قولنا فلان أفضل من فلان أن معناه إن محله عند الله تعالى في الآخرة أرفع، وهذا غيب لا يطلع عليه إلا الله ورسوله إن أطلعه عليه، ولا يمكن أن يدعي نصوص قاطعة من صاحب الشرع متواترة مقتضية للفضيلة على هذا الترتيب، بل المنقول الثناء على جميعهم. واستنباط حكم الترجيحات في الفضل من دقائق ثنائه عليهم رمي في عماية واقتحام أمر آخر أغنانا الله عنه، ويعرف الفضل عند الله تعالى بالأعمال مشكل أيضاً وغايته رجم ظن، فكم من شخص متحرم الظاهر وهو عند الله بمكان ليس في قلبه وخلق خفي في باطنه، وكم من مزين بالعبادات الظاهرة وهو في سخط الله لخبث مستكن في باطنه فلا مطلع على السرائر إلا الله تعالى. ولكن إذا ثبت أنه لا يعرف الفضل إلا بالوحي ولا يعرف من النبي إلا بالسماع وأولى الناس بالسماع ما يدل على تفاوت الفضائل الصحابة الملازمون لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وهم قد أجمعوا على تقديم أبي بكر، ثم نص أبو بكر على عمر، ثم أجمعوا بعده على عثمان، ثم على علي رضي الله عنهم. وليس يظن منهم الخيانة في دين الله تعالى لغرض من الأغراض، وكان إجماعهم على ذلك من أحسن ما يستدل به على مراتبهم في الفضل، ومن هذا اعتقد أهل السنة هذا الترتيب في الفضل ثم بحثوا عن الأخبار فوجدوا فيها ما عرف به مستند الصحابة وأهل الإجماع في هذا الترتيب. فهذا ما أردنا أن نقتصر عليه من أحكام الإمامة والله أعلم وأحكم.
الباب الرابع بيان من يجب تكفيره من الفرق اعلم أن للفرق في هذا مبالغات وتعصبات، فربما انتهى بعض الطوائف إلى تكفير كل فرقة سوى الفرقة التي يعزى إليها، فإذا أردت أن تعرف سبيل الحق فيه فاعلم قبل كل شيء أن هذه مسألة فقهية، أعني الحكم بتكفير من قال قولاً وتعاطى فعلاً، فإنها تارة تكون معلومة بأدلة سمعية وتارة تكون مظنونة بالاجتهاد، ولا مجال لدليل العقل فيها البتة، ولا يمكن تفهيم هذا إلا بعد تفهيم قولنا: إن هذا الشخص كافر والكشف عن معناه، وذلك يرجع إلى الإخبار عن مستقره في الدار الآخرة وأنه في النار على التأبيد، وعن حكمه في الدنيا وأنه لا يجب القصاص بقتله ولا يمكن من نكاح مسلمة ولا عصمة لدمه وماله، إلى غير ذلك من الأحكام، وفيه أيضاً إخبار عن قول صادر منه وهو كذب، أو اعتقاد وهو جهل، ويجوز أن يعرف بأدلة العقل كون القول كذباً وكون الاعتقاد جهلاً، ولكن كون هذا الكذب والجهل موجباً للتكفير أمر آخر، ومعناه كونه مسلطاً على سفك دمه وأخذ أمواله، ومعنى كونه مسلطاً على سفك دمه وأخذ أمواله ومبيحاً لإطلاق القول بأنه مخلد في النار؛ وهذه الأمور شرعية ويجوز عندنا أن يرد الشرع بأن الكذاب أو الجاهل أو المكذب مخلد في الجنة وغير مكترث بكفره، وإن ماله ودمه معصوم ويجوز أن يرد بالعكس أيضاً نعم ليس يجور أن يرد بأن الكذب صدق وأن الجهل علم، وذلك ليس هو المطلوب بهذه المسألة بل المطلوب أن هذا الجهل والكذب هل جعله الشرع سبباً لإبطال عصمته والحكم بأنه مخلد في النار؟ وهو كنظرنا في أن الصبي إذا تكلم بكلمتي الشهادة فهو كافر بعد أو مسلم؟ أي هذا اللفظ الذي صدر منه وهو صدق، والاعتقاد الذي وجد في قلبه وهو حق، هل جعله الشرع سبباً لعصمة دمه وماله أم لا؟ وهذا إلى الشرع. فأما وصف قوله بأنه كذب أو اعتقاده بأنه جهل، فليس إلى الشرع، فإذاً معرفة الكذب والجهل يجوز أن يكون عقلياً وأما معرفة كونه كافر أو مسلماً فليس إلا شرعياً، بل هو كنظرنا في الفقه في أن هذا الشخص رقيق أو حر، ومعناه أن السبب الذي جرى هل نصبه الشرع مبطلاً
لشهادته وولايته ومزيلاً لأملاكه ومسقطاً للقصاص عن سيده المستولي عليه، إذا قتله، فيكون كل ذلك طلباً لأحكام شرعية لا يطلب دليلها إلا من الشرع. ويجوز الفتوى في ذلك بالقطع مرة وبالظن والاجتهاد أخرى، فإذا تقرر هذا الأصل فقد قررنا في أصول الفقه وفروعه أن كل حكم شرعي يدعيه مدع فإما أن يعرفه بأصل من أصول الشرع من إجماع أو نقل أو بقياس على أصل، وكذلك كون الشخص كافراً إما أن يدرك بأصل أو بقياس على ذلك الأصل، والأصل المقطوع به أن كل من كذب محمداً صلى الله عليه وسلم فهو كافر أي مخلد في النار بعد الموت، ومستباح الدم والمال في الحياة، إلى جملة الأحكام. إلا أن التكذيب على مراتب. الرتبة الأولى: تكذيب اليهود والنصارى وأهل الملل كلهم من المجوس وعبدة الأوثان وغيرهم، فتكفيرهم منصوص عليه في الكتاب ومجمع عليه بين الأمة، وهو الأصل وما عداه كالملحق به. الرتبة الثانية: تكذيب البراهمة المنكرين لأصل النبوات، والدهرية المنكرين لصانع العالم. وهذا ملحق بالمنصوص بطريق الأولى، لأن هؤلاء كذبوه وكذبوا غيره من الأنبياء، أعني البراهمة، فكانوا بالتكفير أولى من النصارى واليهود، والدهرية أولى بالتكفير من البراهمة لأنهم أضافوا إلى تكذيب الأنبياء إنكار المرسل ومن ضرورة إنكار النبوة، ويلتحق بهذه الرتبة كل من قال قولاً لا تثبت النبوة في أصلها أو نبوة نبينا محمد على الخصوص إلا بعد بطلان قوله. الرتبة الثالثة: الذين يصدقون بالصانع والنبوة ويصدقون النبي، ولكن يعتقدون أموراً تخالف نصوص الشرع ولكن يقولون أن النبي محق، وما قصد بما ذكره إلا صلاح الخلق ولكن لم يقدر على التصريح بالحق لكلال أفهام الخلق عن دركه، وهؤلاء هم الفلاسفة. ويجب القطع بتكفيرهم في ثلاثة مسائل وهي: إنكارهم لحشر الأجساد والتعذيب بالنار، والتنعيم في الجنة بالحور بالعين والمأكول والمشروب والملبوس. والأخرى: قولهم إن الله لا يعلم الجزئيات وتفصيل الحوادث وإنما يعلم الكليات، وإنما الجزئيات تعلمها الملائكة السماوية.
والثالثة: قولهم إن العالم قديم وإن الله تعالى متقدم على العالم بالرتبة مثل تقدم العلة على المعلول، وإلا فلم تر في الوجود إلا متساويين. وهؤلاء إذا أوردوا عليهم آيات القرآن زعموا أن اللذات العقلية تقصر الأفهام عن دركها، فمثل لهم ذلك باللذات الحسية وهذا كفر صريح، والقول به إبطال لفائدة الشرائع وسد لباب الاهتداء بنور القرآن واستبعاد للرشد من قول الرسل، فإنه إذا جاز عليهم الكذب لأجل المصالح بطلت الثقة بأقوالهم فما من قول يصدر عنهم إلا ويتصور أن يكون كذباً، وإنما قالوا ذلك لمصلحة. فإن قيل: فلم قلتم مع ذلك بأنهم كفرة؟ قلنا لأنه عرف قطعاً من الشرع أن من كذب رسول الله فهو كافر وهؤلاء مكذبون ثم معالمون للكذب بمعاذير فاسدة وذلك لا يخرج الكلام عن كونه كذباً. الرتبة الرابعة: المعتزلة والمشبهة والفرق كلها سوى الفلاسفة، وهم الذين يصدقون ولا يجوزون الكذب لمصلحة وغير مصلحة، ولا يشتغلون بالتعليل لمصلحة الكذب بل بالتأويل ولكنهم مخطئون في التأويل، فهؤلاء أمرهم في محل الاجتهاد. والذي ينبغي أن يميل المحصل إليه الاحتراز من التكفير ما وجد إليه سبيلاً. فإن استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة المصرحين بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله خطأ، والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وهذه الفرق منقسمون إلى مسرفين وغلاة، وإلى مقتصدين بالإضافة إليهم، ثم المجتهد يرى تكفيرهم وقد يكون ظنه في بعض المسائل وعلى بعض الفرق أظهر.
وتفصيل آحاد تلك المسائل يطول ثم يثير الفتن والأحقاد، فإن أكثر الخائضين في هذا إنما يحركهم التعصب واتباع تكفير المكذب للرسول، وهؤلاء ليسوا مكذبين أصلاً ولم يثبت لنا أن الخطأ في التأويل موجب للتكفير، فلا بد من دليل عليه، وثبت أن العصمة مستفادة من قول لا إله إلا الله قطعاً، فلا يدفع ذلك إلا بقاطع. وهذا القدر كاف في التنبيه على أن إسراف من بالغ في التكفير ليس عن برهان فإن البرهان إما أصل أو قياس على أصل، والأصل هو التكذيب الصريح ومن ليس بمكذب فليس في معنى الكذب أصلاً فيبقى تحت عموم العصمة بكلمة الشهادة. الرتبة الخامسة: من ترك التكذيب الصريح ولكن ينكر أصلاً من أصول الشرعيات المعلومة بالتواتر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقول القائل: الصلوات الخمس غير واجبة، فإذا قرئ عليه القرآن والأخبار قال: لست أعلم صدر هذا من رسول الله، فلعله غلط وتحريف. وكمن يقول: أنا معترف بوجوب الحج ولكن لا أدري أين مكة وأين الكعبة، ولا أدري أن البلد الذي تستقبله الناس ويحجونه هل هي البلد التي حجها النبي عليه السلام ووصفها القرآن. فهذا أيضاً ينبغي أن يحكم بكفره لأنه مكذب ولكنه محترز عن التصريح، وإلا فالمتواترات تشترك في دركها العوام والخواص وليس بطلان ما يقوله كبطلان مذهب المعتزلة فإن ذلك يختص لدركه اؤلوا البصائر من النظار إلا أن يكون هذا الشخص قريب العهد بالاسلام ولم يتواتر عنده بعد هذه الأمور فيمهله إلى أن يتواتر عنده، ولسنا نكفره لأنه أنكر أمراً معلوماً بالتواتر، وإنه لو أنكر غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم المتواترة أو أنكر نكاحه حفصة بنت عمر، أو أنكر وجود أبي بكر وخلافته لم يلزم تكفيره لأنه ليس تكذيباً في أصل من أصول الدين مما يجب التصديق به بخلاف الحج والصلاة وأركان الإسلام، ولسنا نكفره بمخالفة الاجماع، فإن لنا نظرة في تكفير النظام المنكر لأصل الاجماع، لأن الشبه كثيرة في كون الاجماع حجة قاطعة وإنما الاجماع عبارة عن التطابق على رأي نظري وهذا الذي نحن فيه تطابق على الأخبار غير محسوس، وتطابق العدد الكبير على الأخبار غير محسوس على سبيل التواتر الموجب للعلم الضروري، وتطابق أهل الحق والعقد على رأي واحد نظري لا يوجب العلم إلا من جهة الشرع ولذلك لا يجوز أن يستدل على حدوث العالم بتواتر الأخبار من النظار الذين حكموا به، بل لا تواتر إلا في المحسوسات.
الرتبة السادسة: أن لا يصرح بالتكذيب ولا يكذب أيضاً أمراً معلوماً على القطع بالتواتر من أصول الدين ولكن منكر ما علم صحته إلا الاجماع، فأما التواتر فلا يشهد له كالنظام مثلاً، إذ أنكر كون الاجماع حجة قاطعة في أصله. وقال: ليس يدل على استحالة الخطأ على أهل الاجماع دليل عقلي قطعي ولا شرعي متواتر لا يحتمل التأويل، فكلما تستشهد به من الأخبار والآيات له تأويل بزعمه، وهو في قوله خارق لإجماع التابعين؛ فإنا نعلم إجماعهم على أن ما أجمع عليه الصحابة حق مقطوع به لا يمكن خلافه فقد أنكر الإجماع وخرق الإجماع وهذا في محل الاجتهاد، ولي فيه نظر، إذ الاشكالات كثيرة في وجه كون الاجماع حجة فيكاد يكون ذلك الممهد للعذر ولكن لو فتح هذا الباب انجر إلى أمور شنيعة وهو أن قائلاً لو قال: يجوز أن يبعث رسول بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيبعد التوقف في تكفيره ومستند استحالة ذلك عند البحث تستمد من الاجماع لا محالة فإن العقل لا يحيله وما نقل فيه من قوله: لا نبي بعدي ومن قوله تعالى: خاتم النبيين فلا يعجز هذا القائل عن تأويله فيقول: خاتم النبيين أراد به أولي العزم من الرسل، فإن قالوا النبيين عام، فلا يبعد تخصيص العام. وقوله لا نبي بعدي لم يرد به الرسول، وفرق بين النبي والرسول والنبي أعلى رتبة من الرسول إلى غير ذلك من أنواع الهذيان. فهذا وأمثاله لا يمكن أن ندعي استحالته من حيث مجرد اللفظ فإنا في تأويل ظواهر التشبيه قضينا باحتمالات أبعد من هذه ولم يكن ذلك مبطلاً للنصوص، ولكن الرد على هذا القائل أن الأمة فهمت بالإجماع من هذا اللفظ ومن قرائن أحواله أنه أفهم عدم نبي بعده أبداً وعدم رسول الله أبداً وأنه ليس فيه تأويل ولا تخصيص فمنكر هذا لا يكون إلا منكر الإجماع، وعند هذا يتفرع مسائل متقاربة مشتبكة يفتقر كل واحد منها إلى نظر، والمجتهد في جميع ذلك يحكم بموجب ظنه يقيناً وإثباتاً والغرض الآن تحرير معاقد الأصول التي ياتي عليها التكفير وقد نرجع إلى هذه المراتب السلتة ولا يعترض فرع إلا ويندرج تحت رتبة من هذه الرتب، فالمقصود التأصيل دون التفصيل. فإن قيل: السجود بين يدي الصنم كفر، وهو فعل مجرد لا يدخل تحت هذه الروابط، فهل هو أصل آخر؟ قلنا: لا، فإن الكفر في اعتقاده تعظيم الصنم، وذلك تكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم
والقرآن ولكن يعرف اعتقاده تعظيم الصنم تارة بتصريح لفظه، وتارةً بالإشارة إن كان أخرساً، وتارة بفعل يدل عليه دلالة قاطعة كالسجود حيث لا يحتمل أن يكون السجود لله وإنما الصنم بين يديه كالحائط وهو غافل عنه أو غير معتقد تعظيمه، وذلك يعرف بالقرائن. وهذا كنظرنا أن الكافر إذا صلى بجماعتنا هل يحكم باسلامه، أي هل يستدل على اعتقاد التصديق؟ فليس هذا إذن نظراً خارجاً عما ذكرناه. ولنقتصر على هذا القدر في تعريف مدارك التكفير وإنما أوردناه من حيث أن الفقهاء لم يتعرضوا له والمتكلمون لم ينظروا فيه نظراً فقهياً، إذ لم يكن ذلك من فنهم، ولم ينبه بعضهم بها لقرب المسألة من الفقهيات، لأن النظر في الأسباب الموجبة للتكفير من حيث أنها أكاذيب وجهالات نظر عقلي، ولكن النظر من حيث أن تلك الجهالات مقتضية بطلان العصمة وإنما الخلود في النار نظر فقهي وهو المطلوب. ولنختم الكتاب بهذا، فقد أظهرنا الاقتصاد في الاعتقاد وحذفنا الحشو والفضول المستغنى عنه، الخارج من أمهات العقائد، وقواعدها، واقتصرنا من أدلة ما أوردناه على الجلي الواضح الذي لا تقصر أكثر الأفهام عن دركه، فنسأل الله تعالى ألا يجعله وبالاً علينا، وأن يضعه في ميزان الصالحات إذا ردت إلينا أعمالنا، والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً آمين.
==========
المنقذ من الضلال
المنقذ من الضلال
الإمام أبي حامد الغزالي
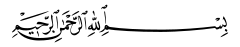
الحمد لله الذي يفتتح بحمده كل رسالة ومقالة ، والصلاة على محمد المصطفى صاحب النبوة والرسالة ، وعلى آله وأصحابـه الهادين من الضلالة.
أما بعد: فقد سألتني أيها الأخ في الدين ، أن أبثّ إليك غاية العلوم وأسرارها ، وغائلة المذاهب وأغوارها ، وأحكي لك ما قاسيته في استخلاص الحق من بين اضطراب الفرق ، مع تباين المسالك والطرق ، وما استجرأت عليه من الارتفاع عن حضيض التقليد ، إلى يفَاعٍ الاستفسار ، وما استفدته أولاً من علم الكلام ، وما اجَتَوْيـُته ثانياً من طرق أهل التعليم القاصرين لَدرك الحق على تقليد الإمام ، وما ازدريته ثالثاً من طرق التفلسف ، وما ارتضيته آخراً من طريقة التصوف ، وما انجلى لي في تضاعيف تفتيشي عن أقاويل الخلق ، من لباب الحق ، وما صرفني عن نشر العلم ببغداد ، مع كثرة الطلبة ، وما دعاني إلى معاودته بنيْسابورَ بعد طول المدة ، فابتدرت لإجابتك إلى مطلبك ، بعد الوقوف على صدق رغبتك ، وقلت مستعيناً بالله ومتوكلاً عليه ، ومستوثقاً منه ، وملتجئاً إليه:
اعلموا - أحسن الله ( تعالى ) إرشادكم ، وألاَنَ للحق قيادكم - أن اختلاف الخلق في الأديان والملل ، ثم اختلاف الأئمة في المذاهب ، على كثرة الفرق وتباين الطرق ، بحر عميق غرق فيه الأكثرون ، وما نجا منه إلا الأقلون ، وكل فريق يزعم أنه الناجي ، و ﴿ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾ [الروم: 32] هو الذي وعدنا بـه سيد المرسلين ، صلوات الله عليه ، وهو الصادق الصدوق حيث قال: « ستفترق أمتي ثلاثاً وسبعين فرقة الناجية منـها واحدة » فقد كان ما وعد أن يكون.
ولم أزل في عنفوان شبابي ( وريعان عمري ) ، منذ راهقت البلوغ قبل بلوغ العشرين إلى الآن ، وقد أناف السن على الخمسين ، أقتحم لجّة هذا البحر العميق ، وأخوض غَمرَتهُ خَوْضَ الجَسُور ، لا خَوْضَ الجبان الحذور ، وأتوغل في كل مظلمة ، وأتـهجّم على كل مشكلة ، وأتقحم كل ورطة ، وأتفحص عن عقيدة كل فرقة ، وأستكشف أسرار مذهب كل طائفة ؛ لأميز بين مُحق ومبطل ، ومتسنن ومبتدع ، لا أغادر باطنيًّا إلا وأحب أن أطلع على باطنيته ، ولا ظاهريّاً إلا وأريد أن أعلم حاصل ظاهريته ، ولا فلسفياً إلا وأقصد الوقوف على كنـه فلسفته ، ولا متكلماً إلا وأجتهد في الإطلاع على غاية كلامه ومجادلته ، ولا صوفياً إلا وأحرص على العثور على سر صوفيته ، ولا متعبداً إلا وأترصد ما يرجع إليه حاصل عبادته ، ولا زنديقاً معطلاً إلا وأتجسس وراءه للتنبه لأسباب جرأته في تعطيله وزندقته. وقد كان التعطش إلى درك حقائق الأمور دأبي وديدني من أول أمري وريعان عمري ، غريزة وفطرة من الله وضُعتا في جِبِلَّتي ، لا باختياري وحيلتي ، حتى انحلت عني رابطة التقليد وانكسرت علي العقائد الموروثة على قرب عهد سن الصبا ؛ إذ رأيت صبيان النصارى لا يكون لهم نشوءٌ إلا على التنصُر ، وصبيان اليهود لا نشوء لهم إلا على التهود ، وصبيان المسلمين لا نشوء لهم إلا على الإسلام. وسمعت الحديث المروي عن رسول الله ﷺ حيث قال : « كل مولودٍ يولدُ على الفطرةِ فأبواهُ يُهودأنه وينُصرأنه ويُمجِّسَأنه »
فتحرك باطني إلى ( طلب ) حقيقة الفطرة الأصلية ، وحقيقة العقائد العارضة بتقليد الوالدين والأستاذين ، والتمييز بين هذه التقليدات ، وأوائلها تلقينات ، وفي تمييز الحق منها عن الباطل اختلافات ، فقلت في نفسي:أولاً إنما مطلوبي العلم بحقائق الأمور ، فلا بُد من طلب حقيقة العلم ما هي؟ فظهر لي أن العلم اليقيني هو الذي ينكشف فيه المعلوم انكشافاً لا يبقى معه ريب ، ولا يقارنه إمكان الغلط والوهم ، ولا يتسع القلب لتقدير ذلك ؛ بل الأمان من الخطأ ينبغي أنا يكون مقارناً لليقين مقارنة لو تحدى بإظهار بطلأنه مثلاً من يقلب الحجر ذهباً والعصا ثعباناً ، لم يورث ذلك شكاً وإنكاراً ؛ فإني إذا علمت أن العشرة أكثر من الثلاثة ، فلو قال لي قائل: لا ، بل الثلاثة أكثر [ من العشرة ] بدليل أني أقلب هذه العصا ثعباناً ، وقلبها ، وشاهدت ذلك منه ، لم أشك بسببه في معرفتي ، ولم يحصل لي منه إلا التعجب من كيفية قدرته عليه! فأما الشك فيما علمته ، فلا. ثم علمت أن كل ما لا أعلمه على هذا الوجه ولا أتيقنه هذا النوع من اليقين ، فهو علم لا ثقة به ولا أمان معه ، وكل علم لا أمان معه ، فليس بعلم يقيني.
محتويات
1 مَدَاخِلُ السَفْسَطة وجَحْد العُلوم
2 القَولُ في أصْنَافِ الطَّالبْين
2.1 عِلْمُ الكَلاَم: مَقْصُوده وحَاصِله
2.2 الفَلسْفَة
2.3 القَولُ ِفي مَذْهَبِ التَّعلِيم وغَائِلَته
2.4 طرُق الصُّوفِيَّة
3 حَقيقَة النُبُوَّة: واضطِرار كَافةِ الخَلق إليهَا
4 سَبَب نشر العِلْم بعَدْ الإعرَاضِ عَنـه
مَدَاخِلُ السَفْسَطة وجَحْد العُلوم
ثم فتشت عن علومي فوجدت نفسي عاطلاً من علم موصوف بـهذه الصفة إلا في الحسيات والضروريات. فقلت: الآن بعد حصول اليأس ، لا مطمع في اقتباس المشكلات إلا من الجليَّات ، وهي الحسيات والضروريات ، فلا بد من إحكامها أولاً لأتيقن أن ثقتي بالمحسوسات ، وأماني من الغلط في الضروريات ، من جنس أماني الذي كان من قَبلُ في التقليديات ، ومن جنس أمان أكثر الخلق في النظريات ، أم هو أمان محققٌ لا غدر فيه ولا غائلة له؟ فأقبلت بجد بليغ أتأمل المحسوسات والضروريات ، وأنظر هل يمكنني أن أشكك نفسي فيها ، فانتهي بي طول التشكك إلى أن لم تسمح نفسي بتسليم الأمان في المحسوسات أيضاً ، وأخذت تتسع للشك فيها وتقول : من أين الثقة بالمحسوسات ، وأقواها حاسة البصر؟ وهي تنظر إلى الظل فتراه واقفاً غير متحرك ، وتحكم بنفي الحركة ، ثم ، بالتجربة والمشاهدة ، بعد ساعة ، تعرف أنه متحرك وأنه لم يتحرك دفعة ( واحدة ) بغتة ، بل على التدريج ذرة ذرة ، حتى لم يكن له حالة وقوف. وتنظر إلى الكوكب فتراه صغيراً في مقدار دينار ، ثم الأدلة الهندسية تدل على أنه أكبر من الأرض في المقدار. وهذا وأمثاله من المحسوسات يحكم فيها حاكم الحس بأحكامه ، ويكذبـه حاكم العقل ويخونـه تكذيباً لا سبيل إلى مدافعته.
فقلت: قد بطلت الثقة بالمحسوسات أيضاً ، فلعله لا ثقة إلا بالعقليات التي هي من الأوليات ، كقولنا: العشرة أكثر من الثلاثة ، والنفي والإثبات لا يجتمعان في الشيء الواحد ، والشيء الواحد لا يكون حادثاً قديماً ، موجوداً معدوماً ، واجباً محالاً. فقالت المحسوسات: بم تأمن أن تكون ثقتك بالعقليات كثقتك بالمحسوسات ، وقد كنت واثقاً بي ، فجاء حاكم العقل فكذبني ، ولولا حاكم العقل لكنت تستمر على تصديقي ، فلعل وراء إدراك العقل حاكماً آخر ، إذا تجلى ، كذب العقل في حكمه ، كما تجلى حاكم العقل فكذب الحس في حكمه ، وعدم تجلي ذلك الإدراك ، لا يدل على استحالته. فتوقفت النفس في جواب ذلك قليلاً ، وأيدت إشكالها بالمنام ، وقالت: أما تراك تعتقد في النوم أموراً ، وتتخيل أحوالاً ، وتعتقد لها ثباتاً واستقراراً ، ولا تشك في تلك الحالة فيها ، ثم تستيقظ فتعلم أنه لم يكن لجميع متخيلاتك ومعتقداتك أصل وطائل ؛ فبم تأمن أن يكون جميع ما تعتقده في يقظتك بحس أو عقل هو حق بالإضافة إلى حالتك [ التي أنت فيها ] ؛ لكن يمكن أن تطرأ عليك حالة تكون نسبتها إلى يقظتك ، كنسبة يقظتك إلى منامك ، وتكون يقظتك نوماً بالإضافة إليها! فإذا وردت تلك الحالة تيقنت أن جميع ما توهمت بعقلك خيالات لا حاصل لها ، ولعل تلك الحالة ما تدعيه الصوفية أنـها حالتهم ؛ إذ يزعمون أنـهم يشاهدون في أحوالهم التي ( لهم ) ، إذا غاصوا في أنفسهم ، وغابوا عن حواسهم ، أحوالاً لا توافق هذه المعقولات. ولعل تلك الحالة هي الموت ، إذ قال رسول الله ﷺ: « الناسُ نيامٌ فإذا ماتوا انتبـهوا »
فلعل الحياة الدنيا نوم بالإضافة إلى الآخرة. فإذا مات ظهرت له الأشياء على خلاف ما يشاهده الآن ، ويقال له عند ذلك: ﴿ فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴾ [ق: 22]
فلما خطرت لي هذه الخواطر وانقدحت في النفس ، حاولت لذلك علاجاً فلم يتيسر ، إذ لم يكن دفعه إلا بالدليل ، ولم يمكن نصب دليل إلا من تركيب العلوم الأولية ، فإذا لم تكن مسلمة لم يمكن تركيب الدليل. فأعضل هذا الداء ، ودام قريباً من شهرين أنا فيهما على مذهب السفسطة بحكم الحال ، لا بحكم النطق والمقال ، حتى شفى الله تعالى من ذلك المرض ، وعادت النفس إلى الصحة والاعتدال ، ورجعت الضروريات العقلية مقبولة موثوقاً بـها على أمن ويقين ؛ ولم يكن ذلك بنظم دليل وترتيب كلام ، بل بنور قذفه الله تعالى في الصدر وذلك النور هو مفتاح أكثر المعارف ، فمن ظن أن الكشف موقوف على الأدلة المحررة فقد ضيق رحمة الله [ تعالى ] الواسعة ؛ ولما سئل رسول الله ﷺ عن ( الشرح ) ومعناه في قوله تعالى: ﴿ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ﴾ [الأنعام: 125]
قال: « هو نور يقذفه الله تعالى في القلب » فقيل: (وما علامته ؟) قال: « التجافي عن دار الغُرُورِ والإنابة إلى دارِ الخُلُود » . وهو الذي قال ﷺ فيه: « إن الله تعالى خلق الخلقَ في ظُلْمةٍ ثم رشَّ عليهمْ من نُورهِ »
فمن ذلك النور ينبغي أن يطلب الكشف ، وذلك النور ينبجس من الجود الإلهي في بعض الأحايين ، ويجب الترصد له كما قال ﷺ: « إن لربكم في أيامِ دهركم نفحاتٌ ألا فتعرضُوا لها » والمقصود من هذه الحكايات أن يعمل كمال الجد في الطلب ، حتى ينتهي إلى طلب ما لا يطلب. فإن الأوليات ليست مطلوبة ، فأنـها حاضرة. والحاضر إذا طلب فقد واختفى. ومن طلب ما لا يطلب ، فلا يتهم بالتقصير في طلب ما يطلب.
القَولُ في أصْنَافِ الطَّالبْين
ولما شفاني الله من هذا المرض بفضله وسعة جوده ، أنحصرت أصناف الطالبين عندي في أربع فرق:
المتكلمون: وهم يدَّعون أنـهم أهل الرأي والنظر.
الباطنية: وهم يزعمون أنـهم أصحاب التعليم والمخصوصون بالاقتباس من الإمام المعصوم.
الفلاسفة: وهم يزعمون أنـهم أهل المنطق والبرهان.
الصوفية: وهم يدعون أنـهم خواص الحضرة وأهل المشاهدة والمكاشفة.
فقلت في نفسي : الحق لا يعدو هذه الأصناف الأربعة ، فهؤلاء هم السالكون سبل طلب الحق ، فإن شذَّ الحق عنهم ، فلا يبقى في درك الحق مطمع ، إذ لا مطمع في الرجوع إلى التقليد بعد مفارقته ؛ و( من ) شرط المقلد أن لا يعلم أنه مقلد ، فإذا علم ذلك انكسرت زجاجة تقليده ، وهو شعب لا يرأب ، وشعث لا يلم بالتلفيق والتأليف ، إلا أن يذاب بالنار ، ويستأنف له صنعة أخرى مستجدة. فابتدرت لسلوك هذه الطرق ، واستقصاء ما عند هذه الفرق. مبتدئاً بعلم الكلام. ومثنياً بطريق الفلسفة ، ومثلثاً بتعلم الباطنية ، ومربعاً بطريق الصوفية.
* *
عِلْمُ الكَلاَم: مَقْصُوده وحَاصِله
ثم إني ابتدأت بعلم الكلام ، فحصَّلته وعقلته ، وطالعت كتب المحققين منهم ، وصنفت فيه ما أردت أن أصنف ، فصادفته علماً وافياً بمقصوده ، غير وافٍ بمقصودي ؛ وإنما المقصود منه حفظ عقيدة أهل السنة [ على أهل السنة ] وحراستها عن تشويش أهل البدعة. فقد ألقى الله ( تعالى ) إلى عباده على لسان رسوله عقيدة هي الحق ، على ما فيه صلاح دينهم ودنياهم ، كما نطق بمعرفته القرآن والأخبار ، ثم ألقى الشيطان في وساوس المبتدعة أموراً مخالفة للسنة ، فلهجوا بـها وكادوا يشوشون عقيدة الحق على أهلها. فأنشأ الله تعالى طائفة المتكلمين ، وحرك دواعيهم لنصرة السنة بكلام مرتب ، يكشف عن تلبيسات أهل البدع المحدثة ، على خلاف السنة المأثورة ؛ فمنه نشأ علم الكلام وأهله. ولقد قام طائفة منهم بما ندبـهم الله ( تعالى ) إليه ، فأحسنوا الذب عن السنة ، والنضال عن العقيدة المتلقاة بالقبول من النبوة ، والتغيير في وجه ما أحدث من البدعة ؛ ولكنهم اعتمدوا في ذلك على مقدمات تسلموها من خصومهم ، واضطرهم إلى تسليمها: إما التقليد ، أو إجماع الأمة ، أو مجرد القبول من القرآن والأخبار. وكان أكثر خوضهم في استخراج مناقضات الخصوم ، ومؤاخذتهم بلوازم مسلماتهم. وهذا قليل النفع في حق من لا يسلم سوى الضروريات شيئاً ( أصلاً ) ، فلم يكن الكلام في حقي كافياً ، ولا لدائي الذي كنت أشكوه شافياً. نعم ، لما نشأت صنعة الكلام وكثر الخوض فيه وطالت المدة ، تشوق المتكلمون إلى محاولة الذبّ ( عن السنة ) بالبحث عن حقائق الأمور ، وخاضوا في البحث عن الجواهر والأعراض وأحكامها. ولكن لما لم يكن ذلك مقصود علمهم ، لم يبلغ كلامهم فيه الغاية القصوى ، فلم يحصل منه ما يمحق بالكلية ظلمات الحيرة في اختلافات الخلق ؛ ولا أبعدُ أن يكون قد حصل ذلك لغيري! بل لست أشك في حصول ذلك لطائفة ولكن حصولاً مشوباً بالتقليد في بعض الأمور التي ليست من الأوليات! والغرض الآن حكاية حالي ، لا الإنكار على من استشفى به ، فإن أدوية الشفاء تختلف باختلاف الداء. وكم من دواء ينتفع به مريض ويستضر بـه آخر!
* *
الفَلسْفَة
· محصولها. · المذموم منها وما لا يذم. · وما يكفر به قائلة وما لا يكفر به. · وما يبتدع فيه وما لا يبتدع. · وبيان ما سرقه الفلاسفة من كلام أهل الحق. · وبيان ما مزجوه بكلام أهل الحق لترويج باطلهم في درج ذلك. · وكيفية عدم قبول البشر وحصول نفرة النفوس من ذلك الحق الممزوج بالباطل. · وكيفية استخلاص الحق الخالص من الزيف والبهرج من جملة كلامهم. ثم إني ابتدأت ، بعد الفراغ من علم الكلام ، بعلم الفلسفة وعلمت يقيناً ، أنه لا يقف على فساد نوع من العلوم ، من لا يقف على منتهى ذلك العلم ، حتى يساوي أعلمهم في أصل [ ذلك ] العلم ، ثم يزيد عليه ويجاوز درجته ، فيطلع على ما لم يطلع عليه صاحب العلم من غور وغائله ، وإذا ذاك يمكن أن يكون ما يدعيه من فساده حقّاً. ولم أر أحداً من علماء الإسلام صرف عنايته وهمته إلى ذلك. ولم يكن في كتب (( المتكلمين )) من كلامهم ، حيث اشتغلوا بالرد عليهم ، إلا كلمات معقدة مبددة ، ظاهرة التناقض والفساد ، لا يظن الاغترار بـها بعاقل عامي ، فضلاً عمن يدعي دقائق العلوم. فعلمت أن رد المذهب قبل فهمه والإطلاع على كنهه رمى في عماية ، فشمرت عن ساق الجد ، في تحصيل ذلك العلم من الكتب ، بمجرد المطالعة من غير استعانة بأستاذ ، وأقبلت على ذلك في أوقات فراغي من التصنيف والتدريس في العلوم الشرعية ، وأنا ممنو بالتدريس والإفادة لثلاثمائة نفر من الطلبة ببغداد. فأطلعني الله سبحأنه [ وتعالى ] بمجرد المطالعة في هذه الأوقات المختلسة ، على منتهى علومهم في أقل من سنتين. ثم لم أزل أواظب على التفكر فيه بعد فهمه قريباً من سنة ، أعاوده وأردده وأتفقد غوائله وأغواره ، حتى اطَّلعت على ما فيه من خداع وتلبيس ، وتحقيق وتخييل ، اطلاعاً لم أشك فيه. فاسمع الآن حكايتهم وحكاية حاصل علومهم ؛ فإني رأيتهم أصنافاً ، ورأيت علومهم أقساماً ؛ وهم على كثرة أصنافهم يلزمهم وصمة الكفر والإلحاد ، وإن كان بين القدماء منهم والأقدمين ، وبين الأواخر منهم والأوائل ، تفاوت عظيم في البعد عن الحق والقرب منه. * * *
أَصْناَف الفَلاَسِفةَ وشُمول وَصْمَة الكُفِر َكافَّتهمُ اعلم: أنـهم ، على كثرة فرقهم واختلاف مذاهبـهم ، ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: الدهريون ، والطبيعيون ، والإلهيون. الصنف الأول: الدهريون:- وهم طائفة من الأقدمين جحدوا الصانع المدبر ، العالم القادر ، وزعموا أن العالم لم يزل موجوداً كذلك بنفسه بلا صانع ، ولم يزل الحيوان من النطفة ، والنطفة من الحيوان ، كذلك كان ، وكذلك يكون أبداً وهؤلاء هم الزنادقة. والصنف الثاني: الطبيعيون:- وهم قوم أكثروا بحثهم عن عالم الطبيعة ، وعن عجائب الحيوان والنبات ، وأكثروا الخوض في علم تشريح أعضاء الحيوانات ، فرأوا فيها من عجائب صنع الله تعالى وبدائع حكمته ، مما اضطروا معه إلى الاعتراف بفاطر حكيم ، مطلع على غايات الأمور ومقاصدها. ولا يطالع التشريح وعجائب منافع الأعضاء مطالع ، إلا ويحصل له هذا العلم الضروري بكمال تدبير الباني لبنية الحيوان ؛ لا سيما بنية الإنسان. إلا أن هؤلاء ، لكثرة بحثهم عن الطبيعة ، ظهر عندهم - لاعتدال المزاج - تأثير عظيم في قوام قوى الحيوان بـه. فظنوا أن القوة العاقلة من الإنسان تابعة لمزاجه أيضاً ، وأنـها تبطل ببطلان مزاجه فتنعدم . ثم إذا انعدمت ، فلا يعقل إعادة المعدوم كما زعموا. فذهبوا إلى أن النفس تموت ولا تعود ، فجحدوا الآخرة ، وأنكروا الجنة والنار ، [ والحشر والنشر ] ، والقيامة والحساب ، فلم يبق عندهم للطاعة ثواب ، ولا للمعصية عقاب ، فانحل عنهم اللجام وأنـهمكوا في الشهوات أنـهماك الأنعام. وهؤلاء أيضاً زنادقة لأن أصل الإيمان هو الإيمان بالله واليوم الآخر. وهؤلاء جحدوا اليوم الآخر ، وإن آمنوا بالله وصفاته. والصنف الثالث: الإلهيون :- وهم المتأخرون منهم ، [ مثل ]: سقراط ، وهو أستاذ أفلاطون ، وأفلاطون أستاذ أرسطاطاليس ، وأرسطاطاليس هو الذي رتب [ لهم ] المنطق ، وهذَّب لهم العلوم ، وحرّر لهم ما لم يكن محرراً من قبلُ ، وأنضَجَ لهم ما كان فِجّاً من علومهم ، وهم بجملتهم ردوا على الصنفين الأولين من الدهرية والطبيعية ، وأوردوا في الكشف عن فضائحهم ما أغنوا بـه غيرهم. (( وكفى الله المؤمنين القتال )) بتقاتلهم. ثم رد أرسطاطاليس على أفلاطون وسقراط ، ومن كان قبلهم من الإلهيين ، ردّاً لم يقصر فيه حتى تبرأ عن جميعهم ؛ إلا أنه استبقى أيضاً من رذائل كفرهم وبدعتهم بقايا لم يوفق للنـزوع عنها ، فوجب تكفيرهم ، وتكفير شيعتهم من المتفلسفة الإسلاميين ، كابن سينا والفارابي و غيرهم . على أنه لم يقم بنقل علم أرسطاطاليس أحد من متفلسفة الإسلاميين كقيام هذين الرجلين. وما نقله غيرهما ليس يخلو من تخبيط وتخليط يتشوش فيه قلب المطالع حتى لا يفهم. وما لا يُفهم كيف يُرد أو يقبل؟ ومجموع ما صح عندنا من فلسفة أرسطاطاليس ، بحسب نقل هذين الرجلين ، ينحصر في ثلاثة أقسام: - 1. قسم يجب التفكير به. 2. وقسم يجب التبديع به. 3. وقسم لا يجب إنكاره أصلاً فلنفصله .
* *
أَقْسَامِ عُلومِهم أعلم: أن علومهم - بالنسبة إلى الغرض الذي نطلبه - ستة أقسام: رياضية ، ومنطقية ، وطبيعية ، وإلهية ، وسياسية ، وخلقية. 1 - أما الرياضية: فتتعلق بعلم الحساب والهندسة وعلم هيئة العالم ، وليس يتعلق شيء منها بالأمور الدينية نفياً وإثباتاً ، بل هي أمور برهانية لا سبيل إلى مجاحدته بعد فهمها ومعرفتها. وقد تولدت منها آفتان: احداهما الأولى: ان من ينظر فيها يتعجب من دقائقها ومن ظهور براهينها ، فيحسن بسبب ذلك اعتقاده في الفلاسفة ، ويحسب أن جميع علومهم في الوضوح [ وفي ] وثاقة البرهان كهذا العلم. ثم يكون قد سمع من كفرهم وتعطيلهم وتـهاونـهم بالشرع ما تناولته الألسن فيكفر بالتقليد المحض ويقول: لو كان الدين حقاً لما اختفى على هؤلاء مع تدقيقهم في هذا العلم! فإذا عرف بالتسامع كفرهم وجحدهم استدل على أن الحق هو الجحد والإنكار للدين. وكم رأيت ممن يضل عن الحق بـهذا العذر ولا مستند له سواه! وإذا قيل له: الحاذق في صناعة واحدة ليس يلزم أن يكون حاذقاً في كل صناعة ، فلا يلزم أن يكون الحاذق في الفقه والكلام حاذقاً في الطب ، ولا أن يكون الجاهل بالعقليات جاهلاً بالنحو ، بل لكل صناعة أهل بلغوا فيها [ رتبة ] البراعة والسبق. وإن كان الحمق والجهل ( قد ) يلزمهم في غيرها. فكلام الأوائل في الرياضيات برهاني ، وفي الإلهيات تخميني ؛ لا يعرف ذلك إلا من جرّبه وخاض فيه. فهذا إذا قرر على هذا الذي ألحَدَ بالتقليد ، لم يقع منه موقع القبول ، بل تحمله غلبة الهوى ، والشهوة الباطلة ، وحب التكايس ، على أن يصر على تحسين الظن بـهم في العلوم كلها. فهذه آفة عظيمة لأجلها يجب زجر كل من يخوض في تلك العلوم ، فأنها وإن لم تتعلق بأمر الدين ، ولكن لما كانت من مبادئ علومهم ، سرى إليه شرهم وشؤمهم ، فقل من يخوض فيها إلا وينخلع من الدين وينحل عن رأسه لجام التقوى. الآفة الثانية: نشأت من صديق للإسلام جاهل ، ظن أن الدين ينبغي أن ينصر بإنكار كل علم منسوب إليهم: فأنكر جميع علومهم وادعى جهلهم فيها ، حتى أنكر قولهم في الكسوف والخسوف ، وزعم أن ما قالوه على خلاف الشرع. فلما قرع ذلك سمع من عرف ذلك بالبرهان القاطع ، لم يشك في برهأنه ، ولكن اعتقد أن الإسلام مبني على الجهل وإنكار البرهان القاطع ، فيزداد للفلسفة حبّاً وللإسلام بغضاً. ولقد عظم على الدين جناية من ظن أن الإسلام ينصر بإنكار هذه العلوم ، وليس في الشرع تعرض لهذه العلوم بالنفي والإثبات ، ولا في هذه العلوم تعرض للأمور الدينية. وقوله صلى الله عليه وسلّم: (( إن الشمس والقمر آيتان من آياتِ الله تعالى لا ينخسفانِ لموتِ أحدٍ ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله تعالى وإلى الصلاة )) . وليس في هذا ما يوجب إنكار علم الحساب المعرف بمسير الشمس والقمر واجتماعهما أو مقابلهما على وجه مخصوص. أما قوله ( عليه السلام ): (( لكن الله إذا تجلى لشيءْ خضع لهُ )) فليس توجد هذه الزيادة في الصحاح أصلاً. فهذا حكم الرياضيات وآفتها. 2 – وأما المنطقيات: فلا يتعلق شيء منها بالدين نفياً وإثباتاً ، بل هي النظر في طرق الأدلة والمقاييس وشروط مقدمات البرهان وكيفية تركيبها ، وشروط الحد الصحيح وكيفية ترتيبه. وأن العلم إما تصور وسبيل معرفته الحد ، وإما تصديق وسبيل معرفته البرهان ؛ وليس في هذا ما ينبغي أن ينكر ، بل هو ( من ) جنس ما ذكره المتكلمون وأهل النظر في الأدلة ، وإنما يفارقونـهم بالعبارات والاصطلاحات ، بزيادة الاستقصاء في التعريفات والتشعيبات ، ومثال كلامهم فيها قولهم: إذا ثبت أن كل (( أ )) (( ب )) لزم أن بعض (( ب )) (( أ )) أي إذا ثبت أن كل إنسان حيوان ، لزم أن بعض الحيوان إنسان. ويعبرون عن هذا بأنه الموجبة الكلية تنعكس موجبة جزئية. وأي تعلق لهذا بمهمات الدين حتى يجحد وينكر؟ فإذا أنكر لم يحصل من إنكاره عند أهل المنطق إلا سوء الاعتقاد في عقل المنكر ، بل في دينه الذي يزعم أنه موقوف على مثل هذا الإنكار. نعم ، لهم نوع من الظلم في هذا العلم ، وهو أنـهم يجمعون للبرهان شروطاً يعلم أنها تورث اليقين لا محالة ، لكنهم عند الانتهاء إلى المقاصد الدينية ما أمكنهم الوفاء بتلك الشروط ، بل تساهلوا غاية التساهل ، وربما ينظر في المنطق أيضاً من يستحسنه ويراه واضحاً ، فيظن أن ما ينقل عنهم من الكفريات مؤيد بمثل تلك البراهين ، فاستعجل بالكفر قبل الانتهاء إلى العلوم الإلهية. فهذه الآفة أيضاً متطرقة إليه. 3 - وأما ( علم ) الطبيعيات: فهو بحث عن عالم السماوات وكواكبها وما تحتها من الأجسام المفردة: كالماء والهواء والتراب والنار ، وعن الأجسام المركبة: كالحيوان والنبات والمعادن ، وعن أسباب تغيرها واستحالتها وامتزاجها. وذلك يضاهي بحث الطب عن جسم الإنسان وأعضائه الرئيسة والخادمة ، وأسباب استحالة مزاجه. وكما ليس من شرط الدين إنكار علم الطب ، فليس من شرطه أيضاً إنكار ذلك العلم ، إلا في مسائل معينة ، ذكرناها في كتاب (( تـهافت الفلاسفة )). وما عداها مما يجب المخالفة فيها ؛ فعند التأمل يتبين أنها مندرجة تحتها ، وأصل جملتها: أن تعلم أن الطبيعة مسخرة لله تعالى ، لا تعمل بنفسها ، بل هي مستعملة من جهة فاطرها. والشمس والقمر والنجوم والطبائع مسخرات بأمره لا فعل لشيءٍ منها بذاته عن ذاته . 4 – وأما الإلهيات: ففيها أكثر أغاليطهم ، فما قدروا على الوفاء بالبرهان على ما شرطوه في المنطق ، ولذلك كثر الاختلاف بينهم فيها. ولقد قرب مذهب أرسطاطاليس فيها من مذاهب الإسلاميين ، على ما نقله الفارابي وابن سينا. ولكن مجموع ما غلطوا فيه يرجع إلى عشرين أصلاً ، يجب تكفيرهم في ثلاثة منها ، وتبديعهم في سبعة عشر. ولإبطال مذهبهم في هذه المسائل العشرين ، صنفنا كتاب ( التهافت ). أما المسائل الثلاث ، فقد خالفوا فيها كافة الإسلاميين وذلك في قولهم: 1 - إن الأجساد لا تحشر ، وإنما المثاب والمعاقَب هي الأرواح المجردة ، ( والمثوبات ) والعقوبات روحانية لا جسمانية ؛ ولقد صدقوا في إثبات الروحانية ، فأنها ثابتة أيضاً ، ولكن كذبوا في إنكار الجسمانية ، وكفروا بالشريعة فيما نطقوا به. 2 - ومن ذلك قولهم: (( إن الله تعالى يعلم الكليات دون الجزئيات )) ؛ وهذا أيضاً كفر صريح ، بل الحق أنه: (( لا يعزب عنـه مثقال ذرةٍ في السمواتِ ولا في الأرضِ )).(سبأ: 3) 3 - ومن ذلك قولهم بقدم العالم وأزليته فلم يذهب أحد من المسلمين إلى شيء من هذه المسائل. وأما ما وراء ذلك من نفيهم الصفات ، وقولهم إنه عالم بالذات ، لا بعلم زائد (على الذات) وما يجري مجراه ، فمذهبهم فيها قريب من مذهب المعتزلة ولا يجب تكفير المعتزلة بمثل ذلك. وقد ذكرنا في كتاب (( فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة )) ما يتبين به فساد رأي من يتسارع إلى التكفير في كل ما يخالف مذهبه. 4 - وأما السياسيات: فجميع كلامهم فيها يرجع إلى الحكم المصلحية المتعلقة بالأمور الدنيوية ( والإيالة ) السلطانية ، وإنما أخذوها من كتب الله المنـزلة على الأنبياء ، ومن الحكم المأثورة عن سلف الأنبياء [ عليهم السلام ]. 5 - وأما الخلقية: فجميع كلامهم ( فيها ) يرجع إلى حصر صفات النفس وأخلاقها ، وذكر أجناسها وأنواعها وكيفية معالجتها ومجاهدتها ، وإنما أخذوها من كلام الصوفية ، وهم المتألهون المواظبون على ذكر الله تعالى ، وعلى مخالفة الهوى وسلوك الطريق إلى الله تعالى بالإعراض عن ملاذِّ الدنيا. وقد انكشف لهم في مجاهدتهم من أخلاق النفس وعيوبـها ، وآفات أعمالها ما صرحوا بـها ، فأخذها الفلاسفة ومزجوها بكلامهم ، توسلاً بالتجمل بـها إلى ترويج باطلهم. ولقد كان في عصرهم ، بل في كل عصر ، جماعة من المتأهلين ، لا يُخلي الله [ سبحانه ] العالم عنهم ، فأنـهم أوتاد الأرض ، ببركاتـهم تنـزل الرحمة على أهل الأرض كما ورد في الخبر حيث قال صلى الله عليه وسلّم: (( بـهم تمطرون وبـهم ترزقون ومنـهم كان أصحاب الكهف )) . وكانوا في سالف الأزمنة ، على ما نطق بـه القرآن ، فتولد من مزجهم كلام النبوة وكلام الصوفية بكتبهم آفتان: آفة في حق القابل وآفة في حق الراد: 1 - أما الآفة التي في حق الراد فعظيمة: إذ ظنت طائفة من الضعفاء أن ذلك الكلام إذا كان مُدوَّناً في كتبهم ، وممزوجاً بباطلهم ، ينبغي أن يُهجر ولا يُذكر بل يُنكر على [ كل ] من يذكره ، إذ لم يسمعوه أولاً إلا منهم ، فسبق إلى عقولهم الضعيفة أنه باطل ، لأن قائله مُبطل ؛ كالذي يسمع من النصراني قوله: (( لا إله إلا الله عيسى رسول الله )) فينكره ويقول: (( هذا كلام النصارى )) ولا يتوقف ريثما يتأمل أن النصراني كافر باعتبار هذا القول ، أو باعتبار إنكاره نبوة محمد عليه الصلاة والسلام!؟ فإن لم يكن كافراً إلا باعتبار إنكاره ، فلا ينبغي أن يخالف في غير ما هو به كافر مما هو حق في نفسه ، وإن كان أيضاً حقاً عنده. وهذه عادة ضعفاء العقول ، يعرفون الحق بالرجال ، لا الرجال بالحق. والعاقل يقتدي بسيد العقلاء علي ، رضي الله عنه حيث قال: (( لا تعرف الحق بالرجال ( بل ) اعرف الحق تعرف أهله )) و ( العارف ) العاقل يعرف الحق ، ثم ينظر في نفس القول: فإن كان حقاً ، قبله سواء كان قائله مبطلاً أو محقاً ؛ بل ربما يحرص على انتزاع الحق من أقاويل أهل الضلال ، عالماً بأن معدن الذهب الرغام. ولا بأس على الصراف إن أدخل يده في كيس القلاب ، وانتزع الإبريز الخالص من الزيف والبهرج ، مهما كان واثقاً ببصيرته ؛ وانما يزجر عن معاملة القلاب القرويُّ ، دون الصيرفي ( البصير ) ؛ ويمنع من ساحل البحر الأخرقُ ، دون السباح الحاذق ؛ ويُصد عن مس الحية الصبي دون المعزِّم البارع. ولعمري! لما غلب على أكثر الخلق ظنهم بأنفسهم الحذاقة والبراعة ، وكمال العقل ( وتمام الآلة ) في تمييز الحق عن ( الباطل ، والهدى عن ) الضلالة ، وجب حسم الباب في زجر الكافة عن مطالعة كتب أهل الضلال ما أمكن ، إذ لا يسلمون عن الآفة الثانية التي سنذكرها ( أصلاً ) وإن سلموا عن ( هذه ) الآفة التي ذكرناها. ولقد اعترض على بعض الكلمات المبثوثة في تصانيفنا في أسرار علوم الدين ، طائفة من الذين لم تستحكم في العلوم سرائرهم ، ولم تنفتح إلى أقصى غايات المذاهب بصائرهم ، وزعمت أن تلك الكلمات من كلام الأوائل ، مع أن بعضها من مولدات الخواطر - ولا يبعد أن يقع الحافر على الحافر - وبعضها يوجد في الكتب الشرعية ، وأكثرها موجود معناه في كتب الصوفية. وهب أنها لم توجد إلا في كتبهم ، فإذا كان ذلك الكلام معقولاً في نفسه ، مؤيداً بالبرهان ، ولم يكن على مخالفة الكتاب والسنة ، فلمَ ينبغي أن يهجر ويترك؟ فلو فتحنا هذا الباب ، وتطرقنا إلى أن يهجر كل حق سبق إليه خاطر مبطل ، للزمنا أن نـهجر كثيراً من الحق ، ولزمنا أن نـهجر جملة آيات من آيات القرآن وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلّم وحكايات السلف وكلمات الحكماء والصوفية ، لأن صاحب كتاب (( إخوان الصفا )) أوردها في كتابـه مستشهداً بـها ومستدرجاً قلوب الحمقى بواسطتها إلى باطله ؛ ويتداعى ذلك إلى أن يستخرج المبطلون الحق من أيدينا بإيداعهم إياه كتبهم. وأقل درجات العالم: أن يتميز عن العامي الغُمر ، فلا يعاف العسل ، وإن وجده في محجمة الحجَّام ، ويتحقق أن المحجمة لا تغير ذات العسل ، فإن نفرة الطبع عنه مبنية على جهل عامي منشؤه أن المحجمة ، إنما صنعت للدم المستقذَر ، فيظن أن الدم مستقذر لكونه في المحجمة ، ولا يدري أنه مستقذر لصفة في ذاته ؛ فإذا عدمت ( هذه ) الصفة في العسل فكونـه في ظرفه لا يكسبه تلك الصفة ، فلا ينبغي أن يوجب له الاستقذار ، وهذا وهم باطل ، وهو غالب على أكثر الخلق. فإذا نسبت الكلام وأسندته إلى قائل حسن فيه اعتقادهم ، قبلوه وإن كان باطلاً ؛ وإن أسندته إلى من ساء فيه اعتقادهم ردوه وإن كان حقاً. فأبداً يعرفون الحق بالرجال ولا يعرفون الرجال بالحق ، وهو غاية الضلال! هذه آفة الرد. 2 - والآفة الثانية آفة القبول: فإن من نظر في كتبهم (( كإخوان الصفا )) وغيره ، فرأى ما مزجوه بكلامهم من الحكم النبوية ، والكلمات الصوفية ، ربما استحسنها وقبلها ، وحسن اعتقاده فيها ، فيسارع إلى قبول باطلهم الممزوج بـه ، لحسن ظن حصل فيما رآه واستحسنه ، وذلك نوع استدراج إلى الباطل. ولأجل هذه الآفة يجب الزجر عن مطالعة كتبهم لما فيها من الغدر والخطر. وكما يجب صون من لا يحسن السباحة على مزالق الشطوط ، يجب صون الخلق عن مطالعة تلك الكتب. وكما يجب صون الصبيان عن مس الحيَّات ، يجب صون الأسماع عن مختلط الكلمات وكما يجب على المعزِّم أن لا يمس الحية بين يدي ولده الطفل ، إذا علم أن سيقتدي به ويظن أنه مثله ، بل يجب عليه أن يحذّره [ منه ] ، بأن يحذر هو [ في ] نفسه [ ولا يمسها ] بين يديه ، فكذلك يجب على العالم الراسخ مثله. وكما أن المعزِّم الحاذق إذا أخذ الحية وميز بين الترياق والسم ، واستخرج منها الترياق وأبطل السم فليس له أن يشح بالترياق على المحتاج إليه. وكذا الصراف الناقد البصير إذا أدخل يده في كيس القَلاّب ، وأخرج منه الإبريز الخالص ، واطّرح الزيف والبهرج ، فليس له أن يشح بالجيد المرضي على من يحتاج إليه ؛ فكذلك العالم. وكما أن المحتاج إلى الترياق ، إذا اشمأزت نفسه منه ، حيث علم أنه مستخرج من الحية التي هي مركز السم [ وجب تعريفه ] ، والفقير المضطر إلى المال ، إذا نفر عن قبول الذهب المستخرج من كيس القلاّب ، وجب تنبيهه على أن نفرته جهل محض ، هو سبب حرمأنه الفائدة التي هي مطلبه ، وتحتم تعريفه أن قرب الجوار بين الزيف والجيد لا يجعل الجيد زيفاً ، كما لا يجعل الزيف جيداً ، فكذلك قرب الجوار بين الحق الباطل ، لا يجعل الحق باطلاً ، كما لا يجعل الباطل حقاً. فهذا ( مقدار ) ما أردنا ذكره من آفة الفلسفة وغائلتها.
* *
القَولُ ِفي مَذْهَبِ التَّعلِيم وغَائِلَته
ثم إني لما فرغت من علم الفلسفة وتحصيله وتفهمه وتزييف ما يزيف منه ، علمت أن ذلك أيضاً غير وافٍ بكمال الغرض ، وأن العقل ليس مستقلاً بالإحاطة بجميع المطالب ، ولا كاشفاً للغطاء عن جميع المعضلات. وكان قد نبغت نابغة التعليمية ، وشاع بني الخلق تحدثهم بمعرفة معنى الأمور من جهة الإمام المعصوم القائم بالحق ، فعنّ لي أن أبحث في مقالاتـهم ، لأطّلع على ما في كنانتهم. ثم اتفق أن ورد عليّ أمر جازم من حضرة الخلافة ، بتصنيف كتاب يكشف [ عن ] حقيقة مذهبهم. فلم يسعني مدافعته وصار ذلك مستحثاً من خارج ، ضميمة للباعث من الباطن ، فابتدأت بطلب كتبهم وجمع مقالاتـهم. وكذلك قد بلغني بعض كلماتـهم المستحدثة التي ولدتـها خواطر أهل العصر ، لا على المنهاج المعهود من سلفهم. فجمعت تلك الكلمات ، ( ورتبتها ) ترتيباً محكماً مقارناً للتحقيق ، واستوفيت الجواب عنها ، حتى أنكر بعض أهل الحق ( مني ) مبالغتي في تقرير حجتهم ، فقال: (( هذا سعي لهم ، فأنـهم كانوا يعجزون عن نصرة مذهبهم بـمثل هذه الشبهات لولا تحقيقك لها ، وترتيبك إياها )). وهذا الإنكار من وجه حق ، فقد أنكر أحمد بن حنبل على الحارث المحاسبي ( رحمهما الله ) ، تصنيفه في الرد على المعتزلة ؛ فقال الحارث: (( الرد على البدعة فرض)) فقال أحمد: (( نعم ، ولكن حكيت شبهتهم أولاً ثم أجبت عنها ؛ فبمَ تأمن أن يطالع الشبهة من يعلق ذلك بفهمه ، ولا يلتفت إلى الجواب ، أو ينظر في الجواب ولا يفهم كنهه؟ )). وما ذكره أحمد بن حنبل حق ، ولكن في شبهة ( لم تنتشر ) ولم تشتهر. فأما إذا انتشرت ، فالجواب عنها واجب ولا يمكن الجواب [ عنها ] إلا بعد الحكاية. نعم ، ينبغي أن لا يتكلف لهم شبهة لم [ يتكلفوها ] ؛ ولم أتكلف أنا ذلك ، بل كنت قد سمعت تلك الشبهة من واحد من أصحابي المختلفين إلي ، بعد أن كان قد التحق بـهم ؛ وانتحل مذهبـهم ، وحكى أنـهم يضحكون على تصانيف المصنفين في الرد عليهم ، بأنـهم لم يفهموا بعد حجتهم. ثم ذكر تلك الحجة وحكاها عنهم ، فلم أرض لنفسي أن يظن في الغفلة عن اصل حجتهم ، فلذلك أوردتـها ، ولا أن يظن بي أني - وإن سمعتها – لم أفهمها فلذلك قررتها. والمقصود ، أني قررت شبهتهم إلى أقصى الإمكان ، ثم أظهرت فسادها [ بغاية البرهان ]. والحاصل: أنه لا حاصل عند هؤلاء ، ولا طائل لكلامهم. ولولا سوء نصرة الصديق الجاهل ، لما انتهت تلك البدعة - مع ضعفها - إلى هذه الدرجة ؛ ولكن شدة التعصب ، دعت الذابين عن الحق إلى تطويل النـزاع معهم في مقدمات كلامهم ، وإلى مجاحدتـهم في كل ما نطقوا به ، فجاحدوهم في دعواهم: (( الحاجة إلى التعليم والمعلم. )) وفي دعواهم أنه: (( لا يصلح كل معلم ، بل لا بد من معلم معصوم. )) وظهرت حجتهم في إظهار الحاجة إلى التعليم والمعلم ، وضعف قول المنكرين في مقابلته ، فاغتر بذلك جماعة وظنوا أن ذلك من قوة مذهبهم وضعف مذهب المخالفين لهم ، ولم يفهموا أن ذلك لضعف ناصر الحق وجعله بطريقه ؛ بل الصواب الاعتراف بالحاجة إلى المعلم ، وأنه لا بد وأن يكون ( المعلم ) معصوماً ، ولكن معلمنا المعصوم ( هو ) محمد صلى الله عليه وسلّم فإذا قالوا: (( هو ميت )) ، فنقول: (( ومعلمكم غائب )) ، فإذا قالوا: (( معلمنا قد علم الدعاة وبثهم في البلاد ، وهو ينتظر مراجعتهم إن اختلفوا أو أشكل عليهم مشكل )). فنقول: (( ومعلمنا قد علم الدعاة وبثهم في البلاد وأكمل التعليم إذ قال الله تعالى: (( اليوم أكملتُ لكم دينكم [ وأتممتُ عليكمْ نعمتي ] )) (المائدة: 3) وبعد كمال التعليم لا يضر موت المعلم كما لا يضر غيبته. فبقي قولهم: (( كيف تحكمون فيما لم تسمعوه؟ أبالنص ولم تسمعوه ، أم بالإجتهاد والرأي وهو مظنة الخلاف؟ )) فنقول: (( نفعل ما فعله معاذ إذ بعثه رسول الله عليه [ الصلاة ] والسلام إلى اليمن: أن نحكم بالنص ، عند وجود النص وبالإجتهاد عند عدمه . ( بل ) كما يفعله دعاتهم إذا بعدوا عن الإمام إلى أقاصي البلاد ، إذ لا يمكنـه أن يحكم بالنص فإن النصوص المتناهية لا تستوعب الوقائع الغير المتناهية ، ولا يمكنـه الرجوع في كل واقعة إلى بلدة الإمام ، وأن يقطع المسافة ويرجع فيكون المستفتي قد مات ، وفات الانتفاع بالرجوع. فمن أشكلت عليه القبلة ليس له طريق إلا أن يصلي بالاجتهاد ، إذ لو سافر إلى بلدة الإمام لمعرفة القبلة ، فيفوت وقت الصلاة. فإذن جازت الصلاة إلى غير القبلة بناء على الظن. ويقال: (( إن المخطيء في الاجتهاد له أجرٌ واحدٌ وللمُصيبِ أجران )) . فكذلك في جميع المجتهدات ، وكذلك أمر صرف الزكاة إلى الفقير ، فربما يظنـه فقيراً باجتهاده وهو غني باطناً بإخفائه ماله ، فلا يكون مؤاخذاً بـه وإن أخطأ ، لأنه لم يؤاخذ إلا بموجب ظنه. فإن قال: (( ظن مخالفهِ كظنه )) فأقول: (( هو مأمور باتباع ظن نفسه ، كالمجتهد في القبلة يتبع ظنه وإن خالفه غيره. )) فإن قال: (( فالمقلد يتبع أبا حنيفة والشافعي ( رحمهما الله ) أم غيرهما. )) فأقول: (( فالمقلد في القبلة عند الاشتباه ، في معرفة الأفضل الأعلم بدلائل القبلة ، فيتبع ذلك الاجتهاد ؛ فكذلك في المذاهب. )) فردّ الخلق إلى الاجتهاد - ضرورة - الأنبياءُ والأئمة مع العلم بأنـهم ( قد ) يخطئون ، بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: (( أنا أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر )) . أي أنا أحكم بغالب الظن الحاصل من قول الشهود ، وربما أخطأوا فيه. ولا سبيل إلى الأمن من الخطأ للأنبياء في مثل هذه المجتهدات ، فيكف يطمع في ذلك؟ ولهم ها هنا سؤالان: أحدهما قولهم: (( هذا وإن صح في المجتهدات فلا يصح في قواعد العقائد ، إذ المخطئ فيه غير معذور ، فكيف السبيل إليه؟ )) فأقول: (( قواعد العقائد يشتمل عليها الكتاب والسنة ؛ وما وراء ذلك من التفصيل ، والمتنازع فيه ، يعرف الحق فيه بالوزن بالقسطاس المستقيم. وهي الموازين التي ذكرها الله ( تعالى ) في كتابه ، وهي خمسة ذكرتـها في كتاب (( القسطاس المستقيم )). فإن قال: (( خصومك يخالفونك في ذلك الميزان. )) فأقول: (( لا يتصور أن يفهم ذلك الميزان ثم يخالف فيه [ إذ لا يخالف فيه ] أهل التعليم ، لأني استخرجته من القرآن وتعلمته منه ، ولا يخالف فيه أهل المنطق ، لأنه موافق لما شرطوه في المنطق ، وغير مخالف له ؛ ولا يخالف فيه المتكلم لأنه موافق لما يذكره في أدلة النظريات ، وبه يعرف الحق في الكلاميات. )) فإن قال: (( فإن كان في يدك مثل هذا الميزان فلمَ لا ترفع الخلاف بين الخلق؟ )) فأقول: (( لو أصغوا إلي لرفعت الخلاف بينهم ؛ وذكرت طريق رفع الخلاف في كتاب (( القسطاس المستقيم )) ، فتأمله لتعلم أنه حق وأنه يرفع الخلاف قطعاً لو أصغوا ولا يصغون [ إليه ] بأجمعهم! بل قد أصغى إلي طائفة ، فرفعت الخلاف بينهم. وإمامك يريد رفع الخلاف بينهم مع عدم إصغائهم ، فلمَ لم يرفع إلى الآن؟ ولمَ لم يرفع علي رضي الله عنـه ، وهو رأس الأئمة؟ أو يدعي أنه يقدر على حمل كافتهم على الإصغاء قهراً ، فلمَ لم يحملهم إلى الآن؟ ولأي يوم أجله؟ وهل حصل بين الخلق بسبب دعوته إلا زيادة خلاف وزيادة مخالف؟ نعم! كان يخشى من الخلاف نوع الضرر لا ينتهي إلى سفك الدماء ، وتخريب البلاد وأيتام الأولاد ، وقطع الطرق ، والإغارة على الأموال. وقد حدث في العالم من بركات رفعكم الخلاف [ من الخلاف ] ما لم يكن بمثله عهد. )) فإن قال: (( ادعيت أنك ترفع الخلاف بين الخلق ولكن المتحير بين المذاهب المتعارضة ، والاختلافات المتقابلة ، لم يلزمه الإصغاء إليك دون خصمك ، وأكثر الخصوم يخالفونك ، ولا فرق بينك وبينهم. )) وهذا هو سؤالهم الثاني فأقول: (( هذا أولاً ينقلب عليك ، فإنك إذا دعوت هذا المتحير إلى نفسك فيقول المتحير ، بما صرت أولى من مخالفيك ، وأكثر أهل العلم يخالفونك؟ فليت شعري! بماذا تجيب ، أتجيب بأن تقول: إمامي منصوص عليه؟ فمن يصدقك في دعوى النص ، وهو لم يسمع النص من الرسول؟ وإنما يسمع دعواك مع تطابق أهل العلم على اختراعك وتكذيبك. ثم هب أنه سلم لك النص ، فإن كان متحيراً في أصل النبوة ، فقال: هب أن إمامك يدلي بمعجزة عيسى عليه السلام فيقول: الدليل على صدقي أني أحيي أباك ، فأحياه ، فناطقني بأنه محق ، فبماذا أعلم صدقه؟ ولم يعلم كافة الخلق صدق عيسى عليه السلام بـهذه المعجزة ، بل عليه من الأسئلة المشكلة ما لا يدفع إلا بدقيق النظر العقلي ؛ والنظر العقلي لا يوثق به عندك ، ولا يعرف دلالة المعجزة على الصدق ما لم يعرف السحر والتمييز بينه وبين المعجزة ، وما لم يعرف أن الله لا يضل عباده. - وسؤال الإضلال وعسر [ تحرير ] الجواب عنه مشهور- فبماذا تدفع جميع ذلك؟ ولم يكن إمامك أولى بالمتابعة من مخالفه! )) فيرجع إلى الأدلة النظرية التي ينكرها ، وخصمه يدلي بمثل تلك الأدلة وأوضح منها. وهذا السؤال قد انقلب عليهم انقلاباً عظيما ، لو اجتمع أولهم وآخرهم على أن يجيبوا عنه جواباً لم يقدروا عليه. وإنما نشأ الفساد من جماعة من الضعفة ناظروهم ، فلم يشتغلوا بالقلب ، بل بالجواب. وذلك مما يطول فيه الكلام ، وما لا يسبق سريعاً إلى الإفهام ، فلا يصلح للإفحام. فإن قال قائل: (( فهذا هو القلب ، فهل عنه جواب؟ )) فأقول: (( نعم! جوابه أن المتحير لو قال: أنا متحير ، ولم يعين المسألة التي هو متحير فيها ، يقال له: أنت كمريض يقول: أنا مريض ولا يعين مرضه ، ويطلب علاجه. فيقال له: ليس في الوجود علاج للمرض المطلق ، بل لمرض معين: من صداع أو إسهال أو غيرهما. فكذلك المتحير ينبغي أن يعين ما هو متحير فيه ؛ فإن عين المسألة عرّفته الحق فيها بالوزن بالموازين الخمسة ، التي لا يفهمها أحد إلا ويعترف بأنه الميزان الحق ، الذي يوثق بكل ما يوزن به ، فيفهم الميزان ، ويفهم منه أيضاً صحة الوزن ، كما يفهم متعلم علم الحساب نفس الحساب ، وكون المحاسب المعلم عالماً بالحساب وصادقاً فيه )). وقد أوضحت ذلك في كتاب (( القسطاس المستقيم )) في مقدار عشرين ورقة ؛ فليتأمل. وليس المقصود الآن بيان فساد مذهبهم ، فقد ذكرت ذلك في كتاب (( المستظهري )) أولاً ؛ وفي كتاب (( حجة الحق )) ثانياً ، وهو جواب كلام لهم عُرض علي ببغداد ؛ وفي كتاب (( مفصل الخلاف )) الذي هو اثنا عشر فصلاً ثالثاً ؛ وهو جواب كلام عُرض علي بـهمدان ؛ وفي كتاب (( الدرج )) المرقوم (( بالجداول )) رابعاً ، وهو من ركيك كلامهم الذي عُرض علي بطوس ؛ وفي كتاب (( القسطاس المستقيم )) خامساً ، وهو كتاب مستقل بنفسه مقصوده بيان ميزان العلوم وإظهار الاستغناء عن الامام [ المعصوم ] لمن أحاط به. بل المقصود أن هؤلاء ليس معهم شيء من الشفاء المنجي من ظلمات الآراء ، بل هم ، مع عجزهم عن إقامة البرهان على تعيين الإمام ، طال ما جاريناهم فصدقناهم في الحاجة إلى التعليم وإلى المعلم المعصوم وأنه الذي عينوه ، ثم سألناهم عن العلم الذي تعلموه من هذا المعصوم وعرضنا عليهم إشكالات فلم يفهموها ، فضلاً عن القيام بحلّها! فلما عجزوا أحالوا [ على ] الإمام الغائب ، وقالوا: (( ( أنه ) لا بد من السفر إليه. )) والعجب أنـهم ضيعوا عمرهم في طلب المعلم وفي التبجح بالظفر به ، ولم يتعلموا منه شيئاً أصلاً ، كالمتضمّخ بالنجاسة ، يتعب في طلب الماء حتى إذا وجده لم يستعمله ، وبقي متضمخاً بالخبائث. ومنهم من ادعى شيئاً من علمهم ، فكان حاصل ما ذكره شيئاً من ركيك فلسفة فيثاغورس: وهو رجل من قدماء الأوائل ، ومذهبـه أرك مذاهب الفلسفة ، وقد رد عليه أرسطاطاليس ، بل استركَّ كلامه واسترذله ، وهو المحكي في كتاب (( إخوان الصفا )) ، وهو على التحقيق حشو الفلسفة. فالعجب ممن يتعب طول العمر في تحصيل العلم ثم يقنع بمثل ذلك العلم الركيك المستغث ، ويظن بأنه ظفر بأقصى مقاصد العلوم! فهؤلاء أيضاً جربناهم وسبرنا ظاهرهم وباطنهم ؛ فرجع حاصلهم إلى استدراج العوام ، وضعفاء العقول ببيان الحاجة إلى المعلم ، ومجادلتهم في إنكارهم الحاجة إلى التعليم بكلام قوي مفحم ، حتى إذا ساعدهم على الحاجة إلى المعلم مساعد ، وقال: (( هات علمه وأفدنا من تعليمه! )) وقف وقال: (( الآن إذا سلمت لي هذا فاطلبه ، فإنما غرضَي هذا القدر فقط. )) إذ علم أنه لو زاد على ذلك لافتضح ولعجز عن حل أدنى الإشكالات ، بل عجز عن فهمه ، فضلاً عن جوابـه. فهذه حقيقة حالهم فأخبرهم تَقْلُهم فلما خبرناهم نفضنا اليد عنهم ( أيضاً ).
* *
طرُق الصُّوفِيَّة
ثم إني ، لما فرغت من هذه العلوم ، أقبلت بـهمتي على طريق الصوفية وعلمت أن طريقتهم إنما تتم بعلم وعمل ؛ وكان حاصل علومهم قطع عقبات النفس. والتنـزه عن أخلاقها المذمومة وصفاتها الخبيثة ، حتى يتوصل ( بـها ) إلى تخلية القلب عن غير الله ( تعالى ) وتحليته بذكر الله. وكان العلم أيسر عليّ من العمل. فابتدأت بتحصيل علمهم من مطالعة كتبهم مثل: (( قوت القلوب )) لأبي طالب المكي ( رحمه الله ) وكتب (( الحارث المحاسبي )) ، والمتفرقات المأثورة عن ((الجنيد)) و (( الشبلي )) و (( أبي يزيد البسطامي )) [ قدس الله أرواحهم ] ، وغيرهم من المشايخ ؛ حتى اطلعت على كنه مقاصدهم العلمية ، وحصلت ما يمكن أن يحصل من طريقهم بالتعلم والسماع. فظهر لي أن أخص خواصهم ، ما لا يمكن الوصول إليه بالتعلم بل بالذوق والحال وتبدل الصفات. وكم من الفرق بين أن تعلم حد الصحة وحد الشبع وأسبابـهما وشروطهما ، وبين أن تكون صحيحاً وشبعان؟ وبين أن تعرف حد السكر ، وأنه عبارة عن حالة تحصل من استيلاء أبخرة تتصاعد من المعدة على معادن الفكر ، وبين أن تكون سكران! بل السكران لا يعرف حدّ السكر وعِلمه وهو سكران وما معه من علمه شيء! والصَّاحي يعرف حدّ السُكر واركأنه ومَا معه من السكر شيء. والطبيب في حالة المرض يعرف حدّ الصحة وأسبابـها وأدويتها ، وهو فاقد الصحة. فكذلك فرقٌ بين أن تعرف حقيقة الزهد وشروطه وأسبابه ، وبين أن تكون حالك الزهد وعزوف النفس عن الدنيا! فعلمت يقيناً أنـهم أرباب الأحوال ، لا أصحاب الأقوال. وأن ما يمكن تحصيله بطريق العلم فقد حصلته ، ولم يبقَ إلا ما لا سبيل إليه بالسماع والتعلم ، بل بالذوق والسلوك. وكان ( قد ) حصل معي - من العلوم التي مارستها والمسالك التي سلكتها ، في التفتيش عن صنفي العلوم الشرعية والعقلية- إيمانٌ يقينيٌ بالله تعالى ، وبالنبُوّة وباليوم الآخر. فهذه الأصول الثلاثة من الإيمان كانت قد رسخت في نفسي ، لا بدليل معين محرر بل بأسبابٍ وقرائن وتجارب لا تدخل تحت الحصر تفاصيلُها. وكان قد ظهر عندي أنه لا مطمع ( لي ) في سعادة الآخرة إلا بالتقوى ، وكف النفس عن الهوى ، وأن رأس ذلك كله ، قطعُ علاقة القلب عن الدنيا بالتجافي عن دار الغرور ، والإنابة إلى دار الخلود ، والإقبال بكُنه الهمة على الله تعالى. وأن ذلك لا يتم إلا بالإعراض عن الجاه والمال ، والهرب من الشواغل والعلائق. ثم لاحظت أحوالي ؛ فإذا أنا منغمس في العلائق ، وقد أحدقت بي من الجوانب ؛ ولاحظت أعمالي – وأحسنها التدريس والتعليم - فإذا أنا فيها مقبل على علوم غير مهمة ولا نافعة في طريق الآخرة. ثم تفكرت في نيتي في التدريس فإذا هي غير خالصة لوجه الله تعالى ، بل باعثها ومحركها طلب الجاه وانتشار الصيت ؛ فتيقنت أني على شفا جُرُف هار ، وأني قد أشفيت على النار ، إن لم أشتغل بتلافي الأحوال. فلم أزل أتفكر فيه مدة ، وأنا بعدُ على مقام الاختيار ، أصمم العزم على الخروج من بغداد ومفارقة تلك الأحوال يوماً ، وأحل العزم يوماً ، وأقدم فيه رجلاً وأؤخر عنه أخرى. لا تصدق لي رغبة في طلب الآخرة بكرة ، إلا ويحمل عليها جند الشهوة حملة فيفترها عشية. فصارت شهوات الدنيا تجاذبني بسلاسلها إلى المقام ، ومنادي الإيمان ينادي: الرحيل! الرحيل! فلم يبق من العمر إلا قليل ، وبين يديك السفر الطويل ، وجميع ما أنت فيه من العلم والعمل رياء وتخييل! فإن لم تستعد الآن للآخرة فمتى تستعد؟ وإن لم تقطع الآن [ هذه العلائق ] فمتى تقطع؟ فعند ذلك تنبعث الداعية ، وينجزم العزم على الهرب والفرار. ثم يعود الشيطان ويقول: (( هذه حال عارضة ، إياك أن تطاوعها ، فأنـها سريعة الزوال ؛ فإن أذعنت لها وتركت هذا الجاه العريض ، والشأن المنظوم الخالي عن التكدير والتنغيص ، والأمر المسلم الصافي عن منازعة الخصوم ، ربما التفتت إليه نفسك ، ولا يتيسر لك المعاودة. )) فلم أزل أتردد بين تجاذب شهوات الدنيا ، ودواعي الآخرة ، قريباً من ستة أشهر أولها رجب سنة ثمان وثمانين وأربع مائة. وفي هذا الشهر جاوز الأمر حد الاختيار إلى الاضطرار ، إذ أقفل الله على لساني حتى اعتقل عن التدريس ، فكنت أجاهد نفسي أن أدرس يوماً واحداً تطييباً لقلوب المختلفة [ إلي ] ، فكان لا ينطق لساني بكلمة [ واحدة ] ولا أستطيعها البتة ، حتى أورثت هذه العقلة في اللسان حزناً في القلب ، بطلت معه قوة الهضم ومراءة الطعام والشراب: فكان لا ينساغ لي ثريد ، ولا تنهضم ( لي ) لقمة ؛ وتعدى إلى ضعف القوى ، حتى قطع الأطباء طمعهم من العلاج وقالوا: (( هذا أمر نـزل بالقلب ، ومنه سرى إلى المزاج ، فلا سبيل إليه بالعلاج ، إلا بأن يتروح السر عن الهم الملم )). ثم لما أحسست بعجزي ، وسقط بالكلية اختياري ، التجأت إلى الله تعالى التجاء المضطر الذي لا حيلة له ، فأجابني الذي (( يجيب المضطر إذا دعاه )) ، وسهل على قلبي الإعراض عن الجاه والمال ( والأهل والولد والأصحاب ) ، وأظهرت عزم الخروج إلى مكة وأنا أدبّر في نفسي سفر الشام حذراً أن يطلع الخليفة وجملة الأصحاب على عزمي على المقام في الشام ؛ فتلطفت بلطائف الحيل في الخروج من بغداد على عزم أن لا أعاودها أبداً. واستهدفت لأئمة أهل العراق كافة ، إذ لم يكن فيهم من يجوز أن يكون للإعراض عما كنت فيه سبب دينيّ ، إذ ظنوا أن ذلك هو المنصب الأعلى في الدين ، وكان ذلك مبلغهم من العلم. ثم ارتبك الناس في الاستنباطات ، وظن من بعُد عن العراق ، أن ذلك كان لاستشعار من جهة الولاة ؛ ( وأما من قرب من الولاة ) : كان يشاهد إلحاحهم في التعلق بي والانكباب عليَّ ، وإعراضي عنهم ، وعن الالتفات إلى قولهم ، فيقولون: (( هذا أمر سماوي ، وليس له سبب إلا عين أصابت أهل الإسلام وزمرة أهل العلم )). ففارقت بغداد ، وفرقت ما كان معي من المال ، ولم أدخر إلا قدر الكفاف ، وقوت الأطفال ، ترخصاً بأن مال العراق مرصد للمصالح ، ولكونه وقفاً على المسلمين. فلم أر في العالم مالاً يأخذه العالم لعياله أصلح منه. ثم دخلت الشام ، وأقمت به قريباً من سنتين لا شغل لي إلا العزلة والخلوة ؛ والرياضة والمجاهدة ، اشتغالاً بتزكية النفس ، وتـهذيب الأخلاق ، وتصفية القلب لذكر الله ( تعالى ) ، كما كنت حصلته من كتب الصوفية. فكنت أعتكف مدة في مسجد دمشق ، أصعد منارة المسجد طول النهار ، وأغلق بابـها على نفسي. ثم رحلت منها إلى بيت المقدس ، أدخل كل يوم الصخرة ، وأغلق بابـها على نفسي. ثم تحركت فيَّ داعية فريضة الحج ، والاستمداد من بركات مكة والمدينة. وزيارة رسول الله ﷺ بعد الفراغ من زيارة الخليل صلوات الله وسلامه عليه ؛ فسرت إلى الحجاز. ثم جذبتني الهمم ، ودعوات الأطفال إلى الوطن ، فعاودته بعد أن كنت أبعد الخلق عن الرجوع إليه. فآثرت العزلة [ به ] أيضاً حرصاً على الخلوة ، وتصفية القلب للذكر. وكانت حوادث الزمان ، ومهمات العيال ، وضرورات المعاش ، تغير فيَّ وجه المراد ، وتشوش صفوة الخلوة. وكان لا يصفو [ لي ] الحال إلا في أقوات متفرقة. لكني مع ذلك لا أقطع طمعي منها ، فتدفعني عنها العوائق ، وأعود إليها. ودمت على ذلك مقدار عشر سنين ؛ وانكشفت لي في أثناء هذه الخلوات أمور لا يمكن إحصاؤها واستقصاؤها ، والقدر الذي أذكره لينتفع به: إني علمت يقيناً أن الصوفية هم السالكون لطريق الله ( تعالى ) خاصة ، وأن سيرتهم أحسن السير ، وطريقهم أصوب الطرق ، وأخلاقهم أزكى الأخلاق. بل لو جُمع عقل العقلاء ، وحكمة الحكماء ، وعلم الواقفين على أسرار الشرع من العلماء ، ليغيروا شيئاً من سيرهم وأخلاقهم ، ويبدلوه بما هو خير منه ، لم يجدوا إليه سبيلاً. فإن جميع حركاتـهم وسكناتـهم ، في ظاهرهم وباطنهم ، مقتبسة من ( نور ) مشكاة النبوة ؛ وليس وراء نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به. وبالجملة ، فماذا يقول القائلون في طريقة ، طهارتـها - وهي أول شروطها - تطهير القلب بالكلية عما سوى الله ( تعالى ) ، ومفتاحها الجاري منها مجرى التحريم من الصلاة ، استغراق القلب بالكلية بذكر الله ، وآخرها الفناء بالكلية في الله؟ وهذا آخرها بالإضافة إلى ما يكاد يدخل تحت الاختيار والكسب من أوائلها. وهي على التحقيق أول الطريقة ، وما قبل ذلك كالدهليز للسالك إليه. ومن أول الطريقة تبتدئ المكاشفات ( والمشاهدات ) ، حتى أنـهم في يقظتهم يشاهدون الملائكة ، وأرواح الأنبياء ويسمعون منهم أصواتاً ويقتبسون منهم فوائد. ثم يترقى الحال من مشاهدة الصور والأمثال ، إلى درجات يضيق عنها نطاق النطق ، فلا يحاول معبر أن يعبر عنها إلا اشتمل لفظه على خطأ صريح لا يمكنه الاحتراز عنه. وعلى الجملة. ينتهي الأمر إلى قرب يكاد يتخيل منه طائفة الحلول ، وطائفة الاتحاد ، وطائفة الوصول ، وكل ذلك خطأ. وقد بينا وجه الخطأ فيه في كتاب (( المقصد الأسنى )) ؛ بل الذي لابسته تلك الحالة لا ينبغي أن يزيد على أن يقول : وكان ما كان مما لستُ أذكره فظنَّ خيراً ولا تسأل عن الخبرِ! وبالجملة ، فمن لم يرزق منه شيئاً بالذوق ، فليس يدرك من حقيقة النبوة إلا الاسم ، وكرامات الأولياء ، [ هي ] على التحقيق ، بدايات الأنبياء ، وكان ذلك أول حال رسول الله ﷺ ، حين أقبل إلى جبل (( حراء )) ، حيث كان يخلو فيه بربه ويتعبد ، حتى قالت العرب : (( إن محمداً عشق ربه!)). وهذه حالة ، يتحققها بالذوق من يسلك سبيلها. فمن لم يرزق الذوق ، فيتيقنها بالتجربة والتسامع ، إن أكثر معهم الصحبة ، حتى يفهم ذلك بقرائن الأحوال يقيناً. ومن جالسهم ، استفاد منهم هذا الإيمان. فهم القوم لا يشقى جليسهم. ومن لم يرزق صحبتهم ، فليعلم إمكان ذلك يقيناً بشواهد البرهان ، على ما ذكرناه في كتاب (( عجائب القلب )) من كتب (( إحياء علوم الدين )). والتحقيق بالبرهان علم ، وملابسة عين تلك الحالة ذوق ، والقبول من التسامع والتجربة بحسن الظن إيمان. فهذه ثلاث درجات : (( يرفعِ الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجاتٍ )) (المجادلة: 58: 11) ووراء هؤلاء قوم جهال ، هم المنكرون لأصل ذلك ، المتعجبون من هذا الكلام ، يستمعون ويسخرون ، ويقولون : العجب ! أنـهم كيف يهذون ! وفهيم قال الله تعالى : (( ومنـهم من يستمع إليكَ حتى إذا خرجوا من عِندك قالوا للذين أُوتوا العلم ماذا قال آنفاً أولئك الذين طبع الله على قلوبـهم واتبعوا أهواءهم )) ( فأصمهُم وأعمى أبصارهم ) (محمد : 47: 16) ومما بان لي بالضرورة من ممارسة طريقتهم ، (( حقيقة النبوة وخاصيتها )). ولا بد من التنبيه على أصلها لشدة مسيس الحاجة إليها.
حَقيقَة النُبُوَّة: واضطِرار كَافةِ الخَلق إليهَا
اعلم: أن جوهر الإنسان في أصل الفطرة ، خلق خالياً ساذجاً لا خبر معه من عوالم الله ( تعالى )! والعوالم كثيرة لا يحصيها إلا الله تعالى كما قال: (( وما يعلم جنودُ ربك إلا هو )) (المدثر : 74: 31) وإنما خبره من العوالم بواسطة الإدراك ، وكل إدراك من الإدراكات خلق ليطلع الإنسان به على عالم من الموجودات ، ونعني بالعوالم ، أجناس الموجودات. فأول ما يخلق في الإنسان حاسة اللمس ، فيدرك بـها أجناساً من الموجودات: كالحرارة ، والبرودة ، والرطوبة واليبوسة ، واللين والخشونة ، وغيرها. واللمس قاصر عن الألوان والأصوات قطعاً ، بل هي كالمعدوم في حق اللمس. ثم تخلق له [ حاسة ] البصر ، فيدرك بـها الألوان والأشكال ، وهو أوسع عوالم المحسوسات. ثم ينفخ فيه السمع ، فيسمع الأصوات والنغمات. ثم يخلق له الذوق. وكذلك إلى أن يجاوز عالم المحسوسات ، فيخلق فيه التمييز ، وهو قريب من سبع سنين ، وهو طور آخر من أطوار وجوده : فيدرك فيه أموراً زائدة على ( عالم ) المحسوسات ، لا يوجد منها شيء في عالم الحس. ثم يترقى إلى طور آخر ، فيخلق له العقل ، فيدرك الواجبات والجائزات والمستحيلات ، وأموراً لا توجد في الأطوار التي قبله. ووراء العقل طور آخر تنفتح فيه عين أخرى يبصر بـها الغيب وما سيكون في المستقبل ، وأموراً أُخر ، العقل معزول عنها كعزل قوة التمييز عن إدراك المعقولات وكعزل قوة الحس عن مدركات التمييز. وكما أن المميز لو عرضت عليه مدركات العقل لأباها واستبعدها ، فكذلك بعض العقلاء أبوا مدركات النبوة واستبعدوها ، وذلك عين الجهل : إذ لا مستند لهم إلا أنه طور لم يبلغه ولم يوجد في حقه ، فيظن أنه غير موجود في نفسه. والأكمه ، لو لم يعلم بالتواتر والتسامع الألوان والأشكال وحكي له ذلك ابتداءً ، لم يفهمها ولم يقرّ بـها. وقد قرب الله تعالى على خلقه بأن أعطاهم نموذجاً من خاصية النبوة ، وهو النوم : إذ النائم يدرك ما سيكون من الغيب ، إما صريحاً وإما في كسوة مثال يكشف عنـه التعبير. وهذا لو لم يجربه الإنسان من نفسه - وقيل له: (( إن من الناس من يسقط مغشياً عليه كالميت ، ويزول ( عنه ) إحساسه وسمعه وبصره فيدرك الغيب. )) – لأنكره ، وأقام البرهان على استحالته ، وقال: (( القوى الحساسة أسباب الإدراك ، فمن لا يدرك الأشياء مع وجودها وحضورها ، فبأن لا يدرك مع ركودها أولى وأحق. )) وهذا نوع قياس يكذبه الوجود والمشاهدة. فكما أن العقل طور من أطوار الآدمي ، يحصل فيه عين يبصر بـها أنواعاً من المعقولات ، والحواس معزولة عنها ، فالنبوة أيضاً عبارة عن طور يحصل فيه عين لها نور يظهر في نورها الغيب ، وأمور لا يدركها العقل. والشك في النبوة ، إما أن يقع: في إمكأنـها ، أو في وجودها ووقوعها ، أو في حصولها لشخص معين. ودليل إمكأنـها وجودها. ودليل وجودها وجود معارف في العالم لا يتصور أن تنال بالعقل ، كعلم الطب والنجوم ؛ فإن من بحث عنها علم بالضرورة أنها لا تدرك إلا بإلهام إلهي وتوفيق من جهة الله ( تعالى ) ، ولا سبيل إليها بالتجربة. فمن الأحكام النجومية ما لا يقع إلا في كل ألف سنة مرة ، فكيف ينال ذلك بالتجربة ؟ وكذلك خواص الأدوية. فتبين بـهذا البرهان أن في الإمكان وجود طريق لإدراك هذه الأمور التي لا يدركها العقل - وهو المراد بالنبوة - لا أن النبوة عبارة عنها فقط ، بل إدراك هذا الجنس الخارج عن مدركات العقل إحدى خواص النبوة ، ولها خواص كثيرة سواها. وما ذكرنا ، فقطرة من بحرها ؛ إنما ذكرناها لأن معك أُنموذجاً منها ، وهو مدركاتك في النوم ؛ ومعك علوم من جنسها في الطب والنجوم ، وهي معجزات الأنبياء ( عليهم الصلاة والسلام ) ، ولا سبيل إليها للعقلاء ببضاعة العقل أصلاً. وأما ما عدا هذا من خواص النبوة ، فإنما يدرك بالذوق ، من سلوك طريق التصوف ؛ لأن هذا إنما فهمته بأنموذج رزقته وهو النوم ، ولولاه لما صدقت به. فإن كان للنبي خاصة ليس لك منها أنموذج ، ولا تفهمها أصلاً ، فكيف تصدق بـها ؟ وإنما التصديق بعد الفهم: وذلك الأنموذج يحصل في أوائل طريق التصوف فيحصل به نوع من الذوق بالقدر الحاصل ونوع من التصديق بما لم يحصل بالقياس ( إليه ). فهذه الخاصية الواحدة تكفيك للإيمان بأصل النبوة. فإن وقع لك الشك في شخص معين ، أنه نبي أم لا ، فلا يحصل اليقين إلا بمعرفة أحواله ، إما بالمشاهدة ، أو بالتواتر والتسامع ؛ فإنك إذا عرفت الطب والفقه ، يمكنك أن تعرف الفقهاء والأطباء بمشاهدة أحوالهم ، وسماع أقوالهم ، وإن لم تشاهدهم ؛ ولا تعجز أيضاً عن معرفة كون الشافعي ( رحمه الله ) فقيهاً ، وكون جالينوس طبيباً ، معرفة بالحقيقة لا بالتقليد عن الغير ، [ بل ] بأن تتعلم شيئاً من الفقه والطب وتطالع كتبهما وتصانيفهما ، فيحصل لك علم ضروري بحالهما. فكذلك إذا فهمت معنى النبوة فأكثرت النظر في القرآن والأخبار ، يحصل لك العلم الضروري بكونه ﷺ على أعلى درجات النبوة ، وأعضد ذلك بتجربة ما قاله في العبادات وتأثيرها في تصفية القلوب ، وكيف صدق ﷺ في قوله: (( من عمل بما علم ورثهُ الله علم ما لم يعلم )) وكيف صدق في قوله:
(( من أعان ظالماً سلطهُ الله عليهِ )) وكيف صدق في قوله:
(( من اصبح وهُمُومُهُ همٌّ واحدٌ كفاه الله ( تعالى ) هُمُومَ الدنيا والآخرةِ )) . فإذا جربت ذلك في ألف وألفين وآلاف ، حصل لك علم ضروري لا تتمارى فيه. فمن هذا الطريق اطلب اليقين بالنبوة ، لا من قلب العصا ثعباناً ، وشق القمر ، فإن ذلك إذا نظرت إليه وحده ، ولم تنضم إليه القرائن الكثيرة الخارجة عن الحصر ، وربما ظننت أنه سحر وتخييل ، وأنه من الله تعالى إضلال فأنه (( يُضِلُّ من يَشَاءُ ويَهدي من يشاءُ )) (فاطر:8). وترد عليك أسئلة المعجزات ، فإذا كان مستند إيمانك إلى كلام منظوم في وجه دلالة المعجزة ، فينجزم إيمانك بكلام مرتب في وجه الإشكال والشبهة عليها ، فليكن مثل هذه الخوارق إحدى الدلائل والقرائن في جملة نظرك ، حتى يحصل لك علم ضروري لا يمكنك ذكر مستنده على التعيين كالذي يخبره جماعة بخبر متواتر لا يمكنه أن يذكر أن اليقين مستفاد من قول واحد معين ، بل من حيث لا يدري ، ولا يخرج عن جملة ذلك ولا بتعيين الآحاد. فهذا هو الإيمان القوي العلمي. وأما الذوق فهو كالمشاهدة والأخذ باليد ، ولا يوجد إلا في طريق الصوفية. فهذا القدر من حقيقة النبوة ، كاف في الغرض الذي أقصده الآن ، وسأذكر وجه الحاجة إليه.
سَبَب نشر العِلْم بعَدْ الإعرَاضِ عَنـه
ثم إني ، لما واظبت على العزلة والخلوة قريباً من عشر سنين ، بان لي في أثناء ذلك على الضرورة من أسباب لا أحصيها ، مرة بالذوق ، ومرة بالعلم البرهاني ، ومرة بالقبول الإيماني : أن الإنسان خلق من بدن وقلب - وأعني بالقلب حقيقة روحه التي هي محل معرفة الله ، دون اللحم والدم الذي يشارك فيه الميت والبهيمة - ، وأن البدن له صحة بـها سعادته ومرض فيه هلاكه ؛ وأن القلب كذلك له صحة وسلامة ، ولا ينجو (( إلا من أتى الله بقلب سليم )) (الشعراء:89) ؛ وله مرض فيه هلاكه الأبدي الأخروي ، كما قال تعالى : (( في قلوبـهم مرضٌ )) (البقرة:10) وأن الجهل بالله سم مهلك ؛ وأن معصية الله ، بمتابعة الهوى ، داؤه الممرض ، وأن معرفة الله تعالى ترياقه المحيي ، وطاعته بمخالفة الهوى ، دواؤه الشافي ؛ وأنه لا سبيل إلى معالجتة بازالة مرضه وكسب صحته ، الا بأدوية ؛ كما لا سبيل إلى معالجة البدن إلا بذلك. وكما أن أدوية البدن تؤثر في كسب الصحة بخاصية فيها ، لا يدركها العقلاء ببضاعة العقل ، بل يجب فيها تقليد الأطباء الذين أخذوها من الأنبياء ، الذين اطلعوا بخاصية النبوة على خواص الأشياء ، فكذلك بان لي ، على الضرورة ، بأن أدوية العبادات بحدودها ومقاديرها المحدودة المقدرة من جهة الأنبياء ، لا يدرك وجه تأثيرها ببضاعة عقل العقلاء ، بل يجب فيها تقليد الأنبياء الذين أدركوا تلك الخواص بنور النبوة ، لا ببضاعة العقل. وكما أن الأدوية تركب من ( أخلاط مختلفة ) النوع والمقدار وبعضها ضعف البعض في الوزن والمقدار ، فلا يخلو اختلاف مقاديرها عن سر هو من قبيل الخواص ، فكذلك العبادات التي هي أدوية داء القلوب ، مركبة من أفعال مختلفة النوع والمقدار ، حتى أن السجود ضعف الركوع ، وصلاة الصبح نصف صلاة العصر في المقدار ؛ ولا يخلو عن سر من الاسرار ، هو من قبيل الخواص التي لا يطلع عليها الا بنور النبوة. ولقد تحامق وتجاهل جداً من أراد أن يستنبط ، بطريق العقل ، لها حكمة ، أو ظن أنـها ذكرت على الاتفاق ، لا عن سر إلهي فيها ، يقتضيها بطريق الخاصية. وكما أن في الأدوية أصولاً هي أركأنـها ، وزوائد هي متمماتها ، لكل واحد منها خصوص تأثير في أعمال أصولها ، كذلك النوافل والسنن متممات لتكميل آثار أركان العبادات. وعلى الجملة : فالأنبياء عليهم السلام أطباء أمراض القلوب ، وإنما فائدة العقل وتصرفه أن عرّفنا ذلك وشهد للنبوة بالتصديق ولنفسه بالعجز عن درك ما يدرك بعين النبوة ، وأخذ بأيدينا وسلمنا ( إليها ) تسليم العميان إلى القائدين ، وتسليم المرضى المتحيرين إلى الأطباء المشفقين. فإلى ههنا مجرى العقل ومخطاه وهو معزول عما بعد ذلك ، إلا عن تفهم ما يلقيه الطبيب إليه. فهذه أمور عرفناها بالضرورة الجارية مجرى المشاهدة ، في مدة الخلوة والعزلة. ثم رأينا فتور الاعتقادات في أصل النبوة ، ثم في حقيقة النبوة ، ثم في العمل بما شرحته النبوة ، وتحققنا شيوع ذلك بين الخلق ؛ فنظرت إلى أسباب فتور الخلق ، وضعف إيمأنـهم ، فإذا هي أربعة : 1 - سبب من الخائضين في علم الفلسفة ؛ 2 - وسبب من الخائضين في طريق التصوف ؛ 3 - وسبب من المنتسبين إلى دعوى التعليم ؛ 4- وسبب من معاملة الموسومين بالعلم فيما بين الناس. فإني تتبعت مدةً آحاد الخلق ، أسألُ من أن يقصر منهم في متابعة الشرع ( واسأله ) عن شبهته وأبحث عن عقيدته وسره وقلت له: (( ما لك تقصر فيها فإن كنت تؤمن بالآخرة ولست تستعد لها وتبيعها بالدنيا ، فهذه حماقة! فإنك لا تبيع الاثنين بواحد ، فكيف تبيع ما لا نـهاية له بأيام معدودة؟ وإن كنت لا تؤمن ، فأنت كافر! فدبر نفسك في طلب الإيمان ، وانظر ما سبب كفرك الخفي الذي هو مذهبك باطناً ، وهو سبب جرأتك ظاهراً ، وإن كنت لا تصرح به تجملاً بالإيمان وتشرفاً بذكر الشرع ! )). فقائل يقول: (( إن هذا أمر لو وجبت المحافظة عليه ، لكان العلماء أجدر بذلك ؛ وفلان من المشاهير بين الفضلاء لا يصلي ، وفلان يشرب الخمر ، وفلان يأكل أموال الأوقاف وأموال اليتامى ، وفلان يأكل إدرار السلطان ولا يحترز عن الحرام ، وفلان يأخذ الرشوة على القضاء والشهادة ! وهلم جراً إلى أمثاله. )) وقائل ثان: يدعي ( علم ) التصوف ، ويزعم أنه قد بلغ مبلغاً ترقّى عن الحاجة إلى العبادة!. وقائل ثالث: يتعلل بشبهة أخرى من شبهات أهل الإباحة! وهؤلاء هم الذين ضلوا عن التصوف. وقائل رابع لقي أهل التعليم فيقول: (( الحق مشكل ، والطريق إليه متعسر ، والاختلاف فيه كثير ، وليس بعض المذاهب أولى من بعض ، وأدلة العقول متعارضة ، فلا ثقة برأي أهل الرأي ، والداعي إلى التعليم متحكم لا حجة له ، فكيف أدع اليقين بالشك ؟ )). وقائل خامس يقول: (( لست أفعل هذا تقليداً ، ولكني قرأت علم الفلسفة وأدركت حقيقة النبوة ، وإن حاصلها يرجع إلى الحكمة والمصلحة ، وأن المقصود من تعبداتـها: ضبط عوام الخلق وتقييدهم عن التقاتل والتنازع والاسترسال في الشهوات ، فما أنا من العوام الجهال حتى أدخل في حجر التكليف ، وإنما أنا من الحكماء أتبع الحكمة وأنا بصير بـها ، مستغن فيها عن التقليد ! )). هذا منتهى إيمان من قرأ ( مذهب ) فلسفة الإلهيين منهم ؛ وتعلم ذلك من كتب ابن سينا وأبي نصر الفارابي. وهؤلاء هم المتجملون بالإسلام. وربما ترى الواحد منهم يقرأ القرآن ، ويحضر الجماعات والصلوات ، ويعظم الشريعة بلسأنه ، ولكنه مع ذلك لا يترك شرب الخمر ، وأنواعاً من الفسق والفجور! وإذا قيل له: ((إن كانت النبوة غير صحيحة ، فلم تصلي ؟ )) فربما يقول: (( لرياضة الجسد ، ولعادة أهل البلد ، وحفظ المال والولد! )). وربما قال: ((الشريعة صحيحة ، والنبوة حق! )) فيقال: (( فلمَ تشرب الخمر؟ )) فيقول: (( إنما نـهي عن الخمر لأنـها تورث العداوة والبغضاء ، وأنا بحكمتي محترز عن ذلك ، وإني أقصد به تشحيذ خاطري.)) حتى أن ابن سينا ذكر في وصية له كتب فيها: أنه عاهد الله تعالى على كذا وكذا ، وأن يعظم الأوضاع الشرعية ، ولا يقصر في العبادات الدينية ، ولا يشرب تلهياً بل تداوياً وتشافياً ؛ فكان منتهى حالته في صفاء الإيمان ، والتزام العبادات ، أن استثنى شرب الخمر لغرض التشافي. فهذا إيمان من يدعي الإيمان منهم. وقد انخدع بـهم جماعة ، وزادهم انخداعاً ضعف اعتراض المعترضين عليهم ، إذ اعترضوا بمجاهدة علم الهندسة والمنطق ، وغير ذلك مما هو ضروري لهم ، على ما بينا علته من قبل. فلما رأيت أصناف الخلق قد ضعف إيـمأنـهم إلى هذا الحد بـهذه الأسباب ، ورأيت نفسي ملبة بكشف هذه الشبهة ، حتى كان إفضاح هؤلاء أيسر عندي من شربة ماء ، لكثرة خوضي في علومهم [ وطرقهم ] - أعني [ طرق ] الصوفية والفلاسفة والتعليمية والمتوسمين من العلماء- ، انقدح في نفسي أن ذلك متعين في هذا الوقت ، محتوم. فماذا تغنيك الخلوة والعزلة ، وقد عم الداء ، ومرض الأطباء ، وأشرف الخلق على الهلاك؟ ثم قلت في نفسي: (( متى تشتغل أنت بكشف هذه الغمة ومصادمة هذه الظلمة ، والزمان زمان الفترة ، والدور دور الباطل ، ولو اشتغلت بدعوة الخلق ، عن طرقهم إلى الحق ، لعاداك أهل الزمان بأجمعهم ، وأنـَّى تقاومهم فكيف تعايشهم ، ولا يتم ذلك إلا بزمان مساعد ، وسلطان متدين قاهر؟ )) فترخصت بيني وبين الله تعالى بالاستمرار على العزلة تعللاً بالعجز عن إظهار الحق بالحجة. فقدر الله تعالى أن حرك داعية سلطان الوقت من نفسه ، لا بتحريك من خارج. فأمر أمر إلزام بالنهوض إلى نيسابور ، لتدارك هذه الفترة. وبلغ الإلزام حداً كان ينتهي ، لو أصررت على الخلاف ، إلى حد الوحشة. فخطر لي أن سبب الرخصة قد ضعف ، فلا ينبغي أن يكون باعثك على ملازمة العزلة الكسل والاستراحة ، وطلب عز النفس وصونها عن أذى الخلق ، ولم ترخص لنفسك عُسْرَ معاناة الخلق ، والله سبحأنه وتعالى يقول: (( بسم الله الرحمن الرحيم: الم. أحَسِبَ الناسُ أن يُتركوا أن يقولوا آمناً وهم لا يُفَتَنونَ ولقد فتنّا الذينَ من قبلهم )) الآية (العنكبوت: 1-3 ) ويقول عز وجل لرسوله وهو أعز خلقه: (( ولقدَ كُذّبَتْ رُسلٌ من قبلكَ فصَبروا على ما كُذّبوا وأُوذوا ، حتى أتاهم نصرُنا ؛ ولا مبَدّلَ لكلماتِ الله ، ولقد جاءك من نبأ المرسلين )) ( الأنعام:34 ) ويقول عز وجل: (( بسم الله الرحمن الرحيم : يس والقرآن الحكيم... )) إلى قوله (( إنما تنذرُ من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيبِ )). ( يس:1-11 ) فشاورت في ذلك جماعة من أرباب القلوب والمشاهدات ، فاتفقوا على الإشارة بترك العزلة ، والخروج من الزاوية ؛ وانضاف إلى ذلك منامات من الصالحين كثيرة متواترة ، تشهد بأن هذه الحركة مبدأ خير ورشد قدّرها الله سبحأنه على رأس هذه المائة ؛ فاستحكم الرجاء ، وغلب حسن الظنّ بسبب هذه الشهادات وقد وعد الله سبحأنه بإحياء دينه على رأس كل مائة. ويسّر الله تعالى الحركة إلى نيسابور ، للقيام بـهذا المهم في ذي القعدة ، سن تسع وتسعين وأربع مائة. وكان الخروج من بغداد في ذي القعدة سنة ثمان وثمانين وأربع مائة. وبلغت مدة العزلة إحدى عشر سنة. وهذه حركة قدّرها الله تعالى ، ( وهي ) من عجائب تقديراته التي لم يكن لها انقداح في القلب في هذه العزلة ، كما لم يكن الخروج من بغداد ، والنـزوع عن تلك الأحوال مما خطر إمكأنه أصلاً بالبال ؛ والله تعالى مقلب القلوب والأحوال و (( قلب المؤمن بين إصبعين من أصابعِ الرحمن )) . وأنا أعلم أني ، وإن رجعت إلى نشر العلم ، فما رجعت! فإن الرجوع عَودٌ إلى ما كان ، وكنت في ذلك الزمان أنشر العلم الذي به يكتسب الجاه ، وأدعو إليه بقولي وعملي ، وكان ذلك قصدي ونيتي. وأما الآن فأدعو إلى العلم الذي به يُترك الجاه ، ويعرف بـه سقوط رتبة الجاه. هذا هو الآن نيتي وقصدي وأمنيتي ؛ يعلم الله ذلك مني ؛ وأنا أبغي أن أصلح نفسي وغيري ، ولست أدري أأصِل مرادي أم أُخترم دون غرضي؟ ولكني اؤمن إيمان يقين ومشاهدة أنه لا حول ولا قوة إلا بالله ( العلي العظيم ) ؛ وأني لم أتحرك ، لكنه حركني ؛ وإني لم أعمل ، لكنه استعملني ؛ فأسأله أن يصلحني أولاً ، ثم يُصلح بي ، ويهديني ، ثم يهدي بي ؛ وأن يريني الحق حقاً ، ويرزقني اتباعه ، ويريني الباطل باطلاً ، ويرزقني اجتنابه.
* *
ونعود الآن إلى ما ذكرناه من أسباب ضعف الإيمان بذكر طريق إرشادهم وإنقاذهم من مهالكهم: أما الذين ادعوا الحيرة بما سمعوه من أهل التعليم ، فعلاجهم ما ذكرناه في كتاب (( القسطاس المستقيم )) ولا نطول بذكره ( في ) هذه الرسالة. وأما ما توهمه أهل الإباحة ، فقد حصرنا شبههم في سبعة أنواع وكشفناها في كتاب (( كيمياء السعادة )). وأما من فسد إيمأنه بطريق الفلسفة ، حتى أنكر أصل النبوة ، فقد ذكرنا حقيقة النبوة ووجودها بالضرورة ، بدليل وجود ( علم ) خواص الأدوية والنجوم وغيرهما. وإنما قدمنا هذه المقدمة لأجل ذلك. وأنـما أوردنا الدليل من خواص الطب والنجوم ، لأنه من نفس علمهم. ونحن نبين لكل عالم بفن من العلوم ، كالنجوم والطب والطبيعة والسحر والطلسمات ، مثلاً من نفس علمه ، برهان النبوة. وأما من أثبت النبوة بلسأنه ، وسوى أوضاع الشرع على الحكمة ، فهو على التحقيق كافر بالنبوة ، وإنما هو مؤمن بحكم له طالع مخصوص ، يقتضي طالعه أن يكون متبوعاً ؛ وليس هذا من النبوة في شيء. بل الإيمان بالنبوة: أن يقر بإثبات طور وراء العقل ، تنفتح فيه عين يدرك بـها مدركات خاصة ، والعقل معزول عنها ، كعزل السمع عن إدراك الألوان ، والبصر عن إدراك الأصوات ، وجميع الحواس عن إدراك المعقولات. فإن لم يجوّز هذا ، فقد أقمنا البرهان على إمكأنه ، بل على وجوده. وإن جوز هذا ، فقد أثبت ، أن ههنا أموراً تسمى خواص ، لا يدور تصرف العقل حواليها أصلاً ، بل يكاد العقل يكذبـها ويقضي باستحالتها. فإن وزن دانق من الأفيون ، سم قاتل لأنه يجمد الدم في العروق لفرط برودته. والذي يدعي علم الطبيعة ، يزعم أنه ما يبرد من المركبات ، إنما يبرد بعنصري الماء والتراب ؛ فهما العنصران الباردان. ومعلوم أن أرطالاً من الماء والتراب لا يبلغ تبريدها في الباطن إلى هذا الحد. فلو أخبر طبيعي بـهذا ولم يجربـه ، لقال: (( هذا محال ، والدليل على استحالته أن فيه نارية وهوائية ، والهوائية والنارية لا تزيدها برودة ؛ فنقدر الكل ماء وتراباً ، فلا يوجب هذا الإفراط في التبريد. فإن انضم إليه حارّان فبأن لا يوجب ذلك أولى. )) ويقدر هذا برهاناً! وأكثر براهين الفلاسفة في الطبيعيات والإلهيات ، مبني على هذا الجنس! فأنـهم تصوروا الأمور على قدر ما وجدوه وعقلوه ، وما لم يألفوه قدروا استحالته ، ولو لم تكن الرُؤْيا الصادقة مألوفة ، وادعى مدعٍ ، أنه عند ركود الحواس ، يعلم الغيب ، لأنكره المتصفون بمثل هذه العقول. ولو قيل لواحد: هل يجوز أن يكون في الدنيا شيء ، هو بمقدار حبة ، يوضع في بلدة فيأكل تلك البلدة بجملتها ثم يأكل نفسه فلا يُبقي [ شيئاً ] من البلدة وما فيها ، ولا يبقى هو نفسه؟ )) لقال: (( هذا لمحال وهو من جملة الخرافات! )) وهذه حالة النار ، ينكرها من لم يرَ النار إذا سمعها. وأكثر [ إنكار ] عجائب الآخرة هو من هذا القبيل. فنقول للطبيعي: (( قد اضطررت إلى أن تقول : في الأفيون خاصية في التبريد ، ليست على قياس المعقول بالطبيعة. فلمَ لا يجوز أن يكون في الأوضاع الشرعية من الخواص ، في مداواة القلوب وتصفيتها ، ما لا يدرك بالحكمة العقلية ، بل لا يبصر ذلك إلا بعين النبوة؟ )) بل قد اعترفوا بخواص هي أعجب من هذا فيما أوردوه في كتبهم ، وهي من الخواص العجيبة المجربة في معالجة الحامل التي عسر عليها الطلق ، بـهذا الشكل: 4 9 2 د ط ب 3 5 7 ج هـ ز 8 1 6 ح ا و
يكتب على خرقتين لم يصبهما ماء ، وتنظر إليهما الحامل بعينها ، وتضعهما تحت قدميها ، فيسرع الولد في الحال إلى الخروج. وقد أقروا بإمكان ذلك وأوردوه في (( عجائب الخواص )) ؛ وهو شكل فيه تسعة بيوت ، يرقم فيها رقوم مخصوصة ، يكون مجموع ما في جدول واحد خمسة عشر ، قرأته في طول الشكل أو في عرضه أو على التأريب .
فيا ليت شعري! من يصدق بذلك ، ثم لا يتسع عقله للتصديق ، بأن تقدير صلاة الصبح بركعتين ، والظهر بأربع ، والمغرب بثلاث ، هو لخواص غير معلومة بنظر الحكمة؟ وسببها اختلاف هذه الأوقات. وإنما تدرك هذه الخواص بنور النبوة. والعجب أنـَّا لو غيرنا العبارة إلى عبارة المنجمين ، لعقلوا اختلاف هذه الأوقات ، فنقول: (( أليس يختلف الحكم في الطالع ، بأن تكون الشمس في وسط السماء ، أو في الطالع ، أو في الغارب ، حتى يبنوا على هذا في تسييراتـهم اختلاف العلاج ، وتفاوت الأعمار والآجال ، ولا فرق بين الزوال وبين كون الشمس في وسط السماء ، ولا بين المغرب وبين كون الشمس في الغارب ، فهل لتصديق ذلك سبب؟ )) إلا أن ذلك يسمعه بعبارة منجم ، لعله جرب كذبه مائة مرة. ولا يزال يعاود تصديقه ، حتى لو قال المنجم [ له ]: (( إذا كانت الشمس في وسط السماء ، ونظر إليها الكوكب الفلاني ، والطالع هو البرج الفلاني ، فلبست ثوباً جديداً في ذلك الوقت قتلت في ذلك الثوب! )) فأنه لا يلبس الثوب في ذلك الوقت ، وربما يقاسي فيه البرد الشديد ، وربما سمعه من منجم وقد عرف كذبـه مرات!. فليت شعري! من يتسع عقله لقبول هذه البدائع ويضطر إلى الاعتراف بأنـها خواص -معرفتها معجزة لبعض الأنبياء- فيكف ينكر مثل ذلك ، فيما يسمعه من قول نبي صادق مؤيد بالمعجزات ، لم يعرف قط بالكذب! ( ولم لا يتسع لإمكأنه! ). فإن أنكر فلسفي إمكان هذه الخواص في أعداد الركعات ، ورمي الجمار ، وعدد أركان الحج ، وسائر تعبدات الشرع ، لم يجد بينها وبين خواص الأدوية والنجوم فرقاً أصلاً. فإن قال: (( قد جربت شيئاً من النجوم وشيئاً من الطب ، فوجدت بعضه صادقاً ، فانقدح في نفسي تصديقه وسقط من قلبي استبعاده ونفرته ؛ وهذا لم أجربه ، فبم أعلم وجوده وتحقيقه؟ )) وإن أقررت بإمكأنه ، فأقول: (( إنك لا تقتصر على تصديق ما جربته بل سمعت أخبار المجربين وقلدتـهم ، فاسمع أقوال الأنبياء فقد جربوا وشاهدوا الحق في جميع ما ورد بـه الشرع ، واسلك سبيلهم تدرك بالمشاهدة بعض ذلك.)) على أني أقول: (( وإن لم تجربه ، فيقضي عقلك بوجوب التصديق والإتباع قطعاً. فإنا لو فرضنا رجلاً بلغ وعقل ولم يجرب ( المرض ) ، فمرض ، وله والد مشفق حاذق بالطب ، يسمع دعواه في معرفة الطب منذ عقل ، فعجن له والده دواء ، فقال: (( هذا يصلح لمرضك ويشفيك من سقمك. )) فماذا يقتضيه عقله ، إن كان الدواء مراً كريه المذاق ، أن يتناول؟ أوَ يَكذب ويقول: (( أنا [ لا ] أعقل مناسبة هذا الدواء لتحصيل الشفاء ، ولم أجربه! )) فلا شك أنك تستحمقه إن فعل ذلك! وكذلك يستحمقك أهل البصائر في توقفك! فإن قلت: (( فبَم أعرف شفقة النبي ﷺ ومعرفته بـهذا الطب؟ )) فأقول: (( وبم عرفت [ شفقة أبيك ] وليس ذلك أمراً محسوساً؟ بل عرفتها بقرائن أحواله وشواهد أعماله في مصادره وموارده علماً ضرورياً لا تتمارى فيه. )) ومن نظر في أقوال رسول الله ﷺ ، وما ورد من الأخبار في اهتمامه بإرشاد الخلق ، وتلطفه في جرّ الناس بأنواع الرفق واللطف ، إلى تحسين الأخلاق وإصلاح ذات البين ، وبالجملة إلى ما يصلح به دينهم ودنياهم ، حصل له علم ضروري ، بأن شفقته ﷺ على أمته أعظم من شفقة الوالد على ولده. وإذا نظر إلى عجائب ما ظهر عليه من الأفعال ، وإلى عجائب الغيب الذي أخبر عنه القرآن على لسأنه وفي الأخبار ، وإلى ما ذكره في آخر الزمان ، فظهر ذلك كما ذكره ، علم علماً ضرورياً أنه بلغ الطور الذي وراء العقل ، وانفتحت له العين التي ينكشف منها الغيب الذي لا يدركه إلا الخواص ، والأمور التي لا يدركها العقل. فهذا هو منهاج تحصيل العلم الضروري بتصديق النبي ﷺ . فجرب وتأمل القرآن وطالع الأخبار ، تعرف ذلك بالعيان. وهذا القدر يكفي في تنبيه المتفلسفة ، ذكرناه لشدة الحاجة إليه في هذا الزمان.
وأما السبب الرابع - وهو ضعف الإيمان بسبب سيرة العلماء- فيداوي هذا المرض بثلاثة أمور: أحدها: أن تقول: (( إن العالم الذي تزعم أنه يأكل الحرام ومعرفته بتحريم ذلك الحرام كمعرفتك بتحريم الخمر [ ولحم الخنـزير ] والربا ، بل بتحريم الغيبة والكذب والنميمة ، وأنت تعرف ذلك وتفعله ، لا لعدم إيمانك بأنه معصية ، بل لشهوتك الغالبة عليك ؛ فشهوته كشهوتك ، وقد غلبته كما غلبتك ، فعلمه بمسائل وراء هذا يتميز به عنك ، لا يناسب زيادة زجر عن هذا المحظور المعين. (( وكم من مؤمن بالطب لا يصبر عن الفاكهة وعن الماء البارد ، وإن زجره الطبيب عنه! ولا يدل ذلك على أنه غير ضار ، أو على ان الإيمان بالطب غير صحيح ، فهذا محمل هفوات العلماء. )) الثاني: أن يقال للعامي: (( ينبغي أن تعتقد أن العالم اتخذ علمه ذخراً لنفسه في الآخرة ، ويظن أن علمه ينجيه ، ويكون شفيعاً له حتى يتساهل معه في أعماله ، لفضيلة علمه. وإن جاز أن يكون زيادة حجة عليه ، فهو يجوز أن يكون زيادة درجة له ، وهو ممكن. فهو ، وإن ترك العمل ، يدلي بالعلم. وأما أنت أيها العامي! إذا نظرت إليه وتركت العمل وأنت عن العلم عاطل ، فتهلك بسوء عملك ولا شفيع لك! )) الثالث: وهو الحقيقة ، أن العالم الحقيقي ، لا يقارف معصية إلا على سبيل الهفوة ، ولا يكون مصراً على المعاصي أصلاً. إذ العلم الحقيقي ما يعرّف أن المعصية سمٌ مهلك ، وأن الآخرة خير من الدنيا. ومن عرَف ذلك ، لا يبيع الخير بما هو أدنى [ منه ]. وهذا العلم لا يحصل بأنواع العلوم التي يشتغل بـها أكثر الناس. فلذلك لا يزيدهم ذلك العلم إلا جرأة على معصية الله تعالى. وأما العلم الحقيقي ، فيزيد صاحبه خشية وخوفاً [ ورجاءً ] ، وذلك يحول بينه وبين المعاصي إلا الهفوات التي لا ينفك عنها البشر في الفترات ، وذلك لا يدل على ضعف الإيمان. فالمؤمن مفتنٌ توّابٌ ، وهو بعيدٌ عن الإصرار والإكباب.
* *
هذا ما أردت أن أذكره في ذم الفلسفة والتعليم وآفاتـهما وآفات من أنكر عليهما ، لا بطريقه. نسأل الله العظيم أن يجعلنا ممن آثره واجتباه ، وأرشده إلى الحق وهداه ، وألهمه ذكره حتى لا ينساه ، وعصمه عن شر نفسه حتى لم يؤثر عليه سواه ، واستخلصه لنفسه حتى لا يعبد إلا إياه.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبـه وسلم.
تم كتاب "المنقذ من الضلال والموصل إلى رب العزة والجلال" لحجة الإسلام الغزالي رضي الله عنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى المصطفين من عباده وإمائه.
=====
معيار العلم في فن المنطق
معيار العلم في فن المنطق
أبو حامد الغزالي
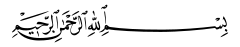
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما. اللهم أرنا الحق حقا ووفقنا إلى اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وأعنا على اجتنابه. آمين. اعلم وتحقق أيها المقصور على درك العلوم حرصه وإرادته الممدود نحو أسرار الحقائق العقلية همته، المصروف، عن زخارف الدنيا ونيل لذاتها الحقيرة سعيه وكده، الموقوف على درك السعادة بالعلم والعبادة جده وجهده، بعد حمد الله الذي يقدم على كل أمر ذي بال حمده، والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسوله وعبده. إن الباعث على تحرير هذا الكتاب الملقب بمعيار العلم غرضان مهمان: أحدهما تفهيم طرق الفكر والنظر، وتنوير مسالك الأقيسة والعبر؛ فإن العلوم النظرية لما لم تكن بالفطرة والغريزة مبذولة وموهوبة كانت لا محالة مستحصلة مطلوبة، وليس كل طالب يحسن الطلب، ويهتدي إلى طريق المطلب، ولا كل سالك يهتدي إلى الإستكمال، ويأمن الإغترار بالوقوف دون ذروة الكمال ولا كل ظان الوصول إلى شاكلة الصواب آمن من الإنخداع بلا مع السراب. فلما كثر في المعقولات مزلة الأقدام، ومثارات الضلال، ولم تنفك مرآة العقل عما يكدرها من تخليطات الأوهام وتلبيسات الخيال، رتبنا هذا الكتاب معيارا للنظر والإعتبار، وميزانا للبحث والإفتكار، وصيقلا للذهن، ومشحذا لقوة الفكر والعقل، فيكون بالنسبة إلى أدلة العقول كالعروض بالنسبة إلى الشعر،
والنحو بالإضافة إلى الإعراب. إذ كما لا يعرف منزحف الشعر عن موزونه إلا بميزان العروض ولا يميز صواب الإعراب عن خطئه إلا بمحك النحو، كذلك لا يفرق بين فاسد الدليل وقويمه وصحيحه وسقيمه إلا بهذا الكتاب. فكل نظر لا يتزن بهذا الميزان ولا يعيار بهذا المعيار فاعلم أنه فاسد العيار غير مأمون الغوائل والأغوار. والباعث الثاني الإطلاع على ما أودعناه كتاب تهافت الفلاسفة، فإنا ناظرناهم بلغتهم وخاطبناهم على حكم اصطلاحاتهم التي تواطأوا عليها في المنطق وفي هذا الكتاب تنكشف معاني تلك الإصطلاحات؛ فهذا اخص الباعثين والأول أعمهما وأهمهما. أما كونه أهم فلا يخفى عليك وجهه، وأما كونه أعم فمن حيث يشمل جدواه جميع العلوم النظرية: العقلية منها والفقهية، فإنا سنعرفك أن النظر في الفقهيات لا يباين النظر في العقليات، في ترتيبه وشروطه وعياره، بل في مآخذ المقدمات فقط. ولما كانت الهمم في عصرنا مائلة من العلوم إلى الفقه بل مقصورة عليه حتى حدانا ذلك إلى أن صنفنا في طرق المناظرة فيها مأخذ الخلاف أولا، ولباب النظر ثانيا، وتحصين المآخذ ثالثا، وكتاب المبادي والغايات رابعا، وهو الغاية القصوى في البحث الجاري على منهاج النظر العقلي في ترتيبه وشروطه، وأن فارقه في مقدماته
رغبنا ذلك أيضا في أن نورد في منهاج الكلام في هذا الكتاب أمثلة فقهية فتشمل فائدته وتعم سائر الأصناف جدواء وعائدته. ولعل الناظر بالعين العوراء نظر الطعن والإزراءِ، ينكر انحرافنا عن العادات في تفهيم العقليات القطعية، بالأمثلة الفقهية الظنية فليكف عن غلوائه في طعنه وإزرائه، وليشهد على نفسه بالجهل بصناعة التمثيل وفائدتها، فإنها لم توضع إلا لتفهيم الأمر الخفي بما هو الأعرف عند المخاطب المسترشد، ليقيس مجهوله إلى ما هو معلوم عنده فيستقر المجهول في نفسه. فإن كان الخطاب مع نجار لا يحسن إلا النجر وكيفية استعمال آلاته، وجب على مرشده ألا يضرب له المثل إلا من صناعة النجارة، ليكون ذلك أسبق إلى فهمه وأقرب إلى مناسبة عقله وكما لا يحسن إرشاد المتعلم إلا بلغته لا يحسن إيصال المعقول إلى فهمه إلا بأمثلة هي أثبت في معرفته؛ فقد عرفناك غاية هذا الكتاب وغرضه تعريفا مجملا فلنزد له شرحا وإيضاحا لشدة حاجة النظار إلى هذا الكتاب. لعلك تقول أيها المنخدع بما عندك من العلوم الذهنية المستهتر بما يسوق إليه البراهين العقلية، ما هذا التفخيم والتعظيم وأي حاجة بالعاقل إلى معيار وميزان، فالعقل هو القسطاس المستقيم والمعيار القويم، فلا يحتاج العاقل بعد كمال عقله إلى تسديد وتقويم، فلتتئد ولتتثبت فيما تستخف به من غوائل الطرق العقلية، ولتتحقق قبل كل شيء أن فيك
حاكما حسيا وحاكما وهميا وحاكما عقليا، والمصيب من هؤلاء الحكام هو الحاكم العقلي، والنفس في أول الفطرة أشد إذعانا وإنقيادا للقبول من الحاكم الحسي والوهمي، لأنهما سبقا في أول الفطرة إلى النفس وفاتحاها بالإحتكام عليها، فألفت احتكامهما وأنست بهما قبل أن أدركها الحاكم العقلي، فاشتد عليها الفطام عن مألوفها والإنقياد لما هو كالغريب من مناسبة جبلتها، فلا تزال تخالف حاكم العقل وتكذبه وتوافق حاكم الحس والوهم وتصدقهما إلى أن تضبط بالحيلة التي سنشرحها في الكتاب. وإن أردت أن تعرف مصداق ما تقوله في تخرص هذين الحاكمين واختلالهما، فانظر إلى حاكم الحس كيف يحكم إذا نظرت إلى الشمس عليها بأنها في عرض مجر، وفي الكواكب بأنها كالدانير المنثورة على بساط أزرق، وفي الظل الواقع على الأرض للأشخاص المنتصبة بأنه واقف بل على شكل الصبي في مبدأ نشئه بأنه واقف، وكيف عرف العقل ببراهين لم يقدر الحس على المنازعة فيها، إن قرص الشمس أكبر من كرة الأرض بأضعاف مضاعفة، وكذلك الكواكب، وكيف هدانا إلى أن الظل الذي نراه واقفا هو متحرك على الدوام لا يفتر، وأن طول الصبي في مدة النشء غير واقف بل هو في النمو على الدوام والإستمرار، ومترق إلى الزيادة ترقيا خفي التدريج يكل الحس عن دركه ويشهد العقل به.
وأغاليط الحس من هذا الجنس تكثر فلا تطمع في استقصائها، واقنع بهذه النبذة اليسيرة من أنبائه لتطلع به على أغوائه. وأما الحاكم الوهمي فلا تغفل عن تكذيبه بموجود لا إشارة إلى جهته. وأما الحاكم الوهمي فلا تغفل عن تكذيبه بموجود لا إشارة إلى جهته، وإنكاره شيئا لا يناسب أجسام العالم بانفصال واتصال، ولا يوصف بأنه داخل العالم ولا خارجه. ولولا كفاية العقل شر الوهم في تضليله هذا لرسخ في نفوس العلماء من الإعتقادات الفاسدة في خالق الأرض والسماءن مارسخ في قلوب العوام والأغبياء. ولا نفتقر إلى هذا الأبعاد في تمثيل تضليله وتخييله، فإنه يكذب فيما هو أقرب إلى المحسوسات مما ذكرناه، لأنك إن عرضت عليه جسما واحدا فيه حركة وطعم ولون ورائحة واقترحت عليه أن يصدق بوجود ذلك في محل واحد على سبيل الإجتماع، كاع عن قبوله وتخيل أن بعض ذلك مضام للبعض ومجاور له. وقدر التصاق كل واحد بالآخر في مثال ستر رقيق ينطبق على ستر آخر، ولم يمكن في جبلته أن يفهم تعدده المكان، فإن الوهم إنما يأخذ من الحس، والحس في غاية الأمر يدرك التعدد والتباين بتباين المكان أو الزمان؛ فإذا رفعا جميعا عسر عليه التصديق بأعداد متغايرة بالصفة والحقيقة حالة فيما هو في حيز واحد. فهذا وأمثاله من أغاليط الوهم يخرج عن حد الإحصاء والحصر، والله تعالى هوالمشكور على ما وهب من العقل الهادي من الضلالة، المنجي عن ظلمات الجهالة، المخلص بضياء البرهان، عن ظلمات وساوس الشيطان. فإن أردت مزيد إستظهار في الإحاطة بخيانة هذين الحاكمين، فدونك وإستقراء ما ورد في الشرع من نسبة هذه التمويهات إلى الشيطان وتسميتها وسواسا
وإحالتها عليه، وتسمية ضياء العقل هداية ونورا ونسبته إلى الله تعالى وملائكته في قوله (الله نُورُ السَمَواتِ وَالأَرض) ولما كان مظنة الوهم والخيال الماغ وهما منبعا الوسواس، قال أبو بكر رحمة الله عليه لمن كان يقيم الحد على بعض الجناة: اضرب الرأس فإن الشيطان في الرأس، ولما كانت الوساوس الخيالية والوهمية ملتصقة بالقوة المفكرة التصاقا يقل من يستقل بالخلاص منها حتى كان ذلك كامتزاج الدم بلحومنا وأعضائنا، قال صلى الله عليه وسلم: {إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم} وإذا لاحظت بعين العقل هذه الأسرار التي نبهتك عليها استيقنت شدة حاجتك إلى تدبير حيلة في الخلاص عن ضلال هذين الحاكمين. فإن قلت: فما الحيلة في الإحتياط مع ما وصفتمونه من شدة الرباط بهذه المغويات؛ فتأمل لطف حيل العقل فيه فإنه استدرج الحس والوهم إلى أمور يساعدانه على دركها من المشاهدات الموافقة للموهوم والمعقول، وأخذ منها مقدمات يساعده الوهم عليها ورتبها ترتيبا لا ينازع فيه، واستنتج منها بالضرورة نتيجة لم يسع الوهم التكذيب بها، إذ كانت مأخوذة من الأمور التي لا يتخلف الوهم والعقل عن القضاء بها، وهي العلوم التي لم يختلف فيها الناس من الضروريات والحسيات وأستسلمها من الحس والوهم وارتهنها منهما، فصدقا بأن النتيجة اللازمة منها صادقة حقيقة، ثم نقلها العقل بعينها على ترتيبها إلى ما ينازع الوهم فيه وأخرى منها نتائج. فلما كذب الوهم بها وامتنع عن قبولها هان على العقل مؤونته، فإن المقدمات التي وضعها كان الوهم يصدق بها على الترتيب الذي رتبه لانتاج النتيجة، فكأن الوهم قد سلم لزوم النتيجة منها فتحقق الناظر أن آباء الوهم عن قبول النتيجة بعد
التصديق بالمقدمات، والتصديق بصحة الترتيب المنتج لقصور في طباعه وجبلته عن درك هذه النتيجة، لا لكون هذه النتيجة كاذبة لأن ترتيب المقدمات منقول من موضع ساعد الوهم على التصديق بها، فإذن غرضنا في هذا الكتاب أن نأخذ من المحسوسات والضروريات الجبلية معيارا للنظر، حتى إذا نقلناه إلى الغوامض لم نشك في صدق ما يلزم منها. ولعلك الآن تقول: فإن تم للنظار ما ذكرتموه فلم اختلفوا في المعقولات، وهلا اتفقوا عليها اتفاقهم على النظريات الهندسية والحسابية التي يساعد الوهم العقل فيها؟ فجوابك من وجهين: أحدهما أن ما ذكرناه أحد مثارات الضلال لا كلها، ووراء ذلك في النظر في العقليات عقبات مخطرة يعز في العقلاء من يتخطاها فيسلم منها. وإذا أحطت بمجامع شروط البرهان المنتج لليقين، لم تستبعد أن تقصر قوة أكثر البشر عن درك حقائق المعقولات الخفية. الثاني: ان القضايا الوهمية لما انقسمت إل ما يصدق وإلى ما يكذب وكانت الكاذبة منها شديدة الشبه بالصادقة، اعترض فيها قضايا إعتاض على النفس تمييزها عن الكاذبة، ولم يقو عليها إلا من أيده الله بتوفيقه وأكرمه بسلوك منهاج الحق بطريقه، فانقسمت العقليات إلى ما هان دركها على الأكثر، وإلى ما استعصى على عقول الجماهير إلا على الشذاذ من أولياء الله تعالى المؤيدين بنور الحق الذين لا تسمح الإعصار الطويلة بوجود الآحاد منهم، فضلا عن العدد الكثير الجم.
ولعلك الآن تحسب نفسك واحدا من غمار الناس فتتلو على نفسك سورة اليأس، وتزعم أني متى أكون واحد الدهر، فريد العصر، مؤيدا بنور الحق متخلصا عن نزغات الشيطان مستوليا على وصفته من شروط البرهان؛ فالركون إلى الدعة أولى بي والقناعة بالإعتقاد الموروث من الآباء أسلم لي من أن أركب متن الخطر ولست أثق بنيل قاصية الوطر، فيقال في مثالك، إن خطر هذا ببالك: ما أنت إلا كإنسان لاحظ رتبة سلطان الزمان وما ساعده من الشوكة والعدة والنجدة والثروة والأشياع والأتباع، والأمر المتبع المطاع، واستبعد أن ينال رتبته أو يقارب درجته، والأمر المتبع المطاع، واستبعد أن ينال رتبته أو يقارب درجته، ولكن اقتدر أن ينال رتبة الوزارة أو رتبة الرئاسة أو منزلة أخرى دونها فقال: الصواب لي بعد العجز عن الغاية القصوى، والذروة العليا التي هي درجة سلطان الدنيا أن أقنع بصناعة الكنس التي هي صناعة آبائي، فالكناس ليس يعجز عن خبز يتناوله وثوب يستره إقتداء بقول الشاعر: دع المكارم لا ترحل لبغيتها ... واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي وهذا الخسيس القاصر النظر، لو أنعم الفكر وتأمل واعتبر علم أن بين درجة الكناس والسلطان منازل فلا كل من يعجز عن الدرجات العلي ينبغي أن يقنع بالدركات السفلى، بل إذا انتهض مترقيا عن رتبة الخساسة، فما يترقى إليه بالإضافة إلى ما يترقى عنه رياسة - فهكذا ينبغي أن تعتقد درجات السعادة بين العلماء، فما منا إلا له مقام معلوم لا يتعداه، وطور محدود لا يتخطاه، ولكن ينبغي أن يشوف إلى أقصى
مرقاه، وأن يخرج من القوة إلى الفعل كل ما تحتمله قواه. فإن قلت: إني فهمت الآن شدة الحاجة إلى هذا الكتاب بما أوضحته من التحقيق، ثم اشتدت رغبتي بما أوردته من التشويق، واتضح لي غايته وثمرته فأوضح لي مضمونه. فاعلم أن مضمونه تعليم كيفية الإنتقال من الصور الحاصلة في ذهنك إلى الأمور الغائبة عنك. فإن هذا الإنتقال له هيئة وترتيب إذا روعيت أفضت إلى المطلوب، وإن أهملت قصرت عن المطلوب، والصواب من هيئته وترتيبه شديد الشبه بما ليس بصواب. فمضمون هذا العلم على سبيل الإجمال هذا، وأما على سبيل التفصيل فهو أن المطلوب هو العلم، والعلم ينقسم إلى العلم بذوات الأشياء، كعلمك بالإنسان والشجر والسماء وغير ذلك. ويسمى هذا العلم تصورا، وغلى العلم بنسبة هذه الذوات المتصورة بعضها إلى بعض إما بالسلب أو بالإيجاب، كقولك الإنسان حيوان والإنسان ليس بحجر، فإنك تفهم الإنسان والحجر فهما تصوريا لذاتهما، ثم تحكم بأن أحدهما مسلوب عن الآخر أو ثابت له، ويسمى هذا تصديقا لأنه يتطرق إليه التصديق والتكذيب.
فالبحث النظري بالطالب إما أن يتجه إلى تصو أو إلى تصديق، والموصل إلى التصور يسمى قولا شارحا فمنه حد ومنه رسم، والموصل إلى التصديق يسمى حجة فمنه قياس ومنه استقراء وغيره. ومضمون هذا الكتاب تعريف مبادىء القول الشارح لما أريد تصوره حدا كان أو رسما، وتعريف مبادىء الحجة الموصلة إلى التصديق قياسا كانت أوغيره مع لا تنبيه على شروط صحتها ومثار الغلط فيهما. فإن قلت: كيف يجهل الإنسان العلم التصوري حتى يفتقر إلى الحد؟ قلنا بأن يسمع الإنسان إسما لا يفهم معناه كمن قال: ما الخلاء وما الملاء وما الملك وما الشيطان وما العقار؟ فتقول: العقار هو الخمر، فإن لم يفهمه باسمه المعروف أفهمه بحده. وقيل: إن الخمر شراب معتصر من العنب مسكر، فيحصل له علم تصوري بذات الخمر. وأما العلم التصديقي فبأن يجهل الإنسان مثلا أن للعالم صانعا، فيقول: هل للعالم صانع؟ فتقول: نعم للعالم صانع. وتعرفه صدق ذلك بالحجة والبرهان على ما سنوضحه، فهذا مضمون الكتاب.
وإن أردت أن تعلم فهرست الأبواب. فاعلم أنا قسمنا القول في مدارك العلوم إلى كتب أربعة: كتاب مقدمات القياس، وكتاب القياس، وكتاب الحد، وكتاب أقسام الوجود وأحكامه.
الكتاب الأول في مقدمات القياس، ولنذكر مقدمة يعرف بها وجه إنقسام النظر في القياس إلى أدنى وإلى أقصى فنقول: المطلب الأقصى في هذا القسم هو البرهان المحصل للعلم اليقيني والبرهان نوع من القياس إذ القياس إسم عام، والبرهان إسم خاص لنوع منه، والقياس لا ينتظم إلا بمقدمتين، وكل مقمدة لا تنتظم إلا بمخبر عنه يسمى موضوعا وخبر يسمى محمولا، وكل موضوع أو محمول يذكر في قضية فهو لفظ نيدل لا محالة على معنى، فالقياس مركب، وكل ناظر في شيء مركب، فطريقه أن يحلل المركب إلى المفردات ويبتدىء بالنظر في الآحاد، ثم في المركب، فلزم من النظر في القياس النظر فيما ينحل إليه القياس من المقدماتنومن النظر في المقدمات النظر في المحمولن والموضوع اللذين منهما تتألف المقدمات، ومن النظر في المحمول والموضوع النظر في الألفاظ والمعاني المفردة التي بها يتم المحمول والموضوع،
ولزم من النظر في المقدمات النظر في شروطها؛ فإن كل مركب من مادة وصورة يجب النظر في مادته وصورته. وما هذا إلا كمن يريد بناء بيت فحقه أن يهتم بإفراز المواد التي منها يتركب كاللبن والطين والخشب، ثم يشتغل بالتنصوير وكيفية التنضيد والتركيب؛ فكذلك النظر في القياس، فهذا بيان الحاجة إلى هذه الأقسام، ولنأخذ بعده في المقصود.
الفن الأول: من كتاب مقدمات في دلالة الألفاظ وبيان وجوه دلالتهاونسبتها إلى المعاني وبيانه بسبعة تقسيمات: القسمة الأولى: أن نقول: الألفاظ تدل على المعاني من ثلاثة أوجه متباينة: الوجه الأول الدلالة من حيث المطابقة كالإسم الموضوع بإزاء الشي، وذلك كدلالة لفظ الحائط على الحائط. والآخر أن تكون بطريق التضمن وذلك كدلالة لفظ البيت على الحائط ودلالة لفظ الإنسان على الحيوان، وكذلك دلالة كل وصف أخص على الوصف الأعم الجوهري. الثالث: الدلالة بطريق الإلتزام والإستتباع كدلالة لفظ السقف على الحائط؛ فإنه مستتبع له إستتباع الرفيق اللازم الخارج عن ذاته، ودلالة الإنسان على قابل صنعة الخياطة وتعلمها، والمعتبر في التعريفات دلالة المطابقة والتضمن. فأما دلالة الإلتزام فلا لأنها ما وضعها واضع اللغة بخلافهما، لأن المدلول فيها غير محدود ولا محصور، إذ لوازم الأشياء ولوازم لوازمها لا تنضبط ولا تنحصر فيؤدي إلى أن يكون اللفظ دليلا على مالا يتناهى من المعاني وهو محال.
القسمة الثانية: للفظ بالنسبة إلى عموم المعنى وخصوصه، واللفظ ينقسم إلى جزئي وكلي، والجزئي ما يمنع نفس تصور معناه عن وقوع الشركة في مفهومه، كقولك زيد وهذا الشجر وهذا الفرس، فإن المتصور من لفظ زيد شخص معين لا يشاركه غيره في كونه مفهوما من لفظ زيد. والكلي هو الذي لا يمنع نفس تصور معناه عن وقوع الشركة فيه، فإن امتنع امتنع بسبب خارج عن نفس مفهومه ومقتضى لفظه، كقولك الإنسان والفرس والشجر وهي أسماء الأجناس والأنواع والمعاني الكلية العامة، وهو جار في لغة العرب في كل إسم أدخل عليه الألف واللام لا في معرض الحوالة على معلوم معين سابق، كالرجل فهو إسم جنس، فإنك قد تطلق وتريد به رجلا معينا عرفه المخاطب من قبل، فتقول: أقبل الرجل فتكون الألف واللام فيه للتعريف أي الرجل الذي جاءني من قبل. فإذا لم تكن مثل هذه القرينة، كان إسم الرجل إسما كليا يشترك في الإندراج تحته كل شخص من أشخاص الرجال.
فإن قلت: فإذا قلنا الشكل الكروي المحيط بإثني عشر برجا فذلك، ولم يكن في الوجود شكل بهذه الصفة غلا واحد فكيف يكون الإسم كليا والمسمى واحد، وقد دخل الألف واللام المقتضى لإستغراق الجن عليه؟ فيقال لك: إن هذا كلي لأنا لسنا نشترط أن يكون الداخل تحته موجودا بالفعل، بل يجوز أن يكون موجودا بالقوة والإمكان، ولو قدر وجوده لكان داخلا فيه لا محالة، وهو قبل الوجود داخل لا كإسم زيد فإنه يمتنع وقوع الشركة فيه بالفعل والقوة جميعا. فإن قلت: فإذا قلنا الإله الحق هكذا فكيف يكون هذا كليا ويمنع وقوع الشركة فيه بالفعل والقوة جميعا، وكذلك قولنا: الشمس على أصل من لا يجوز وجود شمس أخرى فإنه يتعين الداخل تحته تعين شخص زيد في التصور من لفظ زيد؟ فيقال لك: اللفظ كلي وإمتناع وقوع الشركة فيه ليس لنفس مفهوم اللفظ وموضوعه بل لمعنى خارج عنه، وهو إستحالة وجود إلهين للعالم، ولم نشترط في كون اللفظ كليا إلا أن لا يمنع من وقوع الشركة فيه نفس مفهوم اللفظ وموضوعه، فقد حصل لك من السؤالين وجوابهما أن الكلي ثلاثة أقسام: قسم توجد فيه الشركة بالفعل كقولنا الإنسان إذا كانت الأشخاص منه موجودة، وقسم توجد الشركة فيه بالقوة كقولنا الإنسان إذا اتفق إن لم يبق في الوجود إلا شخص واحد، والكرة المحيطة بإثني عشر برجا إذ ليس في الوجود غلا واحد، وقسم لا شركة فيه لا بالفعل ولا بالقوة كالإله، وهو مع ذلك كلي لأن المنع ليس هو من موضوع لالفظ ومحموله بخلاف لفظ زيد.
فائدة فقهية قد اختلف الأصوليون في أن الإسم المفرد إذا اتصل به الألف واللام هل يقتضي الإستغراق، وهل ينزل منزلة العموم كقول القائل الدينار أفضل من الدرهم والرجل خير من المرأة، فظن الظانون أنه من حيث كونه اسما فردا لا يقتضي الإستغراق لمجرده، ولكن فهم العموم بقرينة التسعير وقرينة التفضيل للذكر على الأنثى، إنما هو لعلمنا بنقصان الدرهمية عن الدينارية ونقصان الأنوثة عن الذكورة. وأنت إذا تأملت ما ذكرناه في تحقيق معنى الكلي، فهمت زلل هؤلاء بجهلهم أن اللفظ الكي يقتضي الإستغراق بمجرده ولا يحتاج إلى قرينة زائدة فيه. فإن قلت: ومن أين وقع لهم هذا الغلط؟ فستفهم ذلك من القسمة الثالثة. القسمة الثالثة في بيان رتبة الألفاظ من مراتب الوجود إعلم أن المراتب فيما نقصده أربعة واللفظ في الرتبة الثالثة، فإن للشيء وجودا في الأعيان ثم في الأذهان، ثم في الألفاظ ثم في الكتابة. فالكتابة دالة على اللفظ واللفظ دال على المعنى الذي في النفس، والذي في النفس هو مثال الموجود في الأعيان،
فما لم يكن للشيء ثبوت في نفسه لم يرتسم في النفس مثاله. ومهما ارتسم في النفس مثاله فهو العلم به، إذ لا معنى للعلم إلا مثال يحصل في النفس مطابق لما هو مثال له في الحس وهو المعلوم، وما لم يظهر هذا الأثر في النفس لا ينتظم لفظ يدل به على ذلك الأثر، وما لم ينتظم اللفظ الذي ترتب فيه الأصوات والحروف لا ترتسم كتابة للدلالة عليه. والوجود في الأعيان دالتان بالوضع والإصطلاح. وعند هذا نقول: من زعم أن الإسم المفرد لا يقتضي الإستغراق ظن انه موضوع بإزاء الموجود في الأعيان فإنها أشخاص معينة إذ الدينار الموجود شخص معين، فإن جمعت أشخاص سميت دنانير، ولم يعرف أن الدينار الشخصي المعين يرتسم منهفي النفس أثر هو مثاله وعلم به وتصور له، وذلك المثال يطابق ذلك الشخص وسائر اشخاص الدنانير الموجودة والممكن وجوها، فتكون الصورة الثابتة في النفس من حيث مطابقتها لكل دينار يفرض صورة كلية لا شخصية؛
فإن اعتقدت أن إسم الدينار دليل على الأثر في النفس لا على المؤثر وذلك الأثر كلي، كان الإسم كليا لا محالة، وما قدمناه من الترتيب يعرفك أن الألفاظ لها دلالات على في النفوس، وما في النفوس مثال لما في الأعيان وسيأتي مزيد للعاني الكلية المرتسمة في النفوس بسبب مشاهدة الأشخاص الجزئية في كتاب أحكام الوجود ولواحقه. القسمة الرابعة للفظ قسمته من حيث إفراده وتركيبه اعلم أن اللفظ ينقسم إلى مفرد ومركب، والمركب ينقسم إلى مركب ناقص وغلى مركب تام، فهي ثلاثة أقسام: الأول هو المفرد وهو الذي لا يراد بالجزء منه دلالة على شيء أصلا حين هو جزؤه كقولك عيسى وإنسان، فإن جزئي عيسى وهما " عي وسا " وجزئي إنسان وهما " إن وسان " مايراد بشيء منهما الدلالة على شيء أصلا. فإن قلت: فما قولك في عبد الملك؟ فاعلم أنه أيضا مفرد إذا جعلته إسما علما كقولك زيد، وعند ذلك لا تريد بعبد دلالة على معنى ولا بالملك دلالة على معنى. فكل منهما من حيث هو جزؤه لا يدل على شيء فيكونان كأجزاء
إسم زيد وهما إسمان في الصورة جعلا إسما واحدا كبعلبك ومعد يكرب، فإن اتفق أن يكون المسمة به عبدا للملك تحقيقا فيكون هذا الإسم مطلقا عليه من وجهين: احدهما في تعريف ذاته فيكون الإسم مطلقا عليه من وجهين: أحدهما في تعريف ذاته فيكون الإسم مفرادا، والآخر في تعيف صفته في عبودية الملك فيكون قولك عبد الملك وصفا له فيكون مركبا لا مفردا، فافهم هذه الدقائق فإن مثار الأغاليط في النظريات تنشأ من إهمالها. والمركب التام هو الذي كل لفظ منه يدل على معنى والمجموع بدل دلالة تامة بحيث يصح السكوت عليه، فيكون من إسمين ويكون من إسم وفعل. والمنطقي يسمى الفعل كلمة والمركب الناقص بخلافه. فقولك: زيد يمشي والناطق حيوان؛ مركب تام، وقولك: في الدار أو انسان؛ مركب ناقص لأنه مركب من إسم وأداة لا من إسمين ولامن إسم وفعل، فإن مجرد قولك " زيد في " أو " زيد لا " لا يدل على المعنى الذي يراد الدلالة عليه في المحاورة ما لم يقل زيد في الدار أو زيد لا يظلم، فإنه بذلك الإقتران والتتميم يدل دلالة تامة بحيث يصح السكوت عليه.
القسمة الخامسة للفظ المفرد في نفسه اللفظ إما إسم أو فعل أو حرف. ولنذكر حدّ كل واحد على شرط المنطقيين لتنكشف أقسامه، فنقول: الإسم صوت دال بتواطؤ مجرد عن الزمان والجزء من أجزائه لا يدل على إنفراده ويدل على معنى محصل، ولما كان الحد، مكربا من الجنس والفصول وتذكر الفصول للاحترازات، كان قولنا صوت جنسا، وقولنا دال فصلا يفصله عن العطاس والنحنحنة والسعال وأمثالها، وقولنا بتواطؤ يفصله عن نباح الكلبح فإنه صوت دال على ورود وارد لكن لا بتواطؤ، وقولنا مجرد عن الزمان نحو قولنا يقوم وقام وسيقوم، فإن كل واحد صوت دال بتواطؤ، وقولنا الجزء من أجزائه لا يدل على إنفراده احترازا عن المركب التام كقولنا زيد حيوان، فإن هذا يسمى خبرا وقولا لا إسما، وقولنا يدل على معنى محصل احترازا عن الأسماء التي ليست محصلة كقولنا لا إنسان، فإنه محصل احترازا عن الأسماء التي ليست محصلة كقولنا لا إنسان، فإنه لا يسمى إسما مع وجود جميع أجزاء الحد فيه سوى هذا الإحتراز. فإن قولنا لا إنسان قد يدل على الحجر والسماء والبقر، وبالجملة على كل شيء ليس بإنسان
فليس له معنى محصل، إنما هو دليل على نفي الإنسان لا على إثبات شيء. وأما الفعل وهو الكلمة فإنه صوت دال بتواطؤ على الوجه الذي ذكرناه في الإسم، إنما يباينه في أنه يدل على معنى وقوعه في زمان كقولنا قام ويقوم، وليس يكفي في كونه فعلا أن يدل على الزمان فحسب؛ فإن قولنا أمس واليوم وغدا وعام أول ومضرب الناقة ومقدم الحاج يدل على الزمان، وليس بفعل، حيث أن الفعل يدل على معنى وزمان يقع فيه المعنى فيكون الفعل أبدا دليلا على معنى محمول على غيره، فإذن الفرق بين الإسم والفعل تضمن معنى الزمان فقط. وأما الحرف وهو الأداة فهو كل ما يدل على معنى لا يمكن أن يفهم بنفسه ما لم يقدر اقتران غيره به، مثل من وعلى وما أشبه ذلك. وقد أوجز هذه الحدود فقيل في الإسم: إنه لفظ مفرد يدل على معنى من غير أن يدل على زمان وجود ذلك المعنى من الأزمنة الثلاثة، ثم منه ما هو محصل كزيد ومنه ما هو غير محصل، كما إذا اقترن به حرف سلب فقيل لا إنسان. والكلمة هي لفظة مفردة تدل على معنى وعلى الزمان الذي ذلك المعنى موجود فيه لموضوع ما غير معين، والحرف أو الأداة ما لا يدل على معنى باقترانه بغيره.
القسم السادسة في نسبة الألفاظ إلى المعاني إعلم أن الألفاظ من المعاني على أربعة منازل: المشتركة والمتواطئة والمترادفة والمتزايلة. أما المشتركة فهي اللفظ الواحد الذي يطلق على موجودات مختلفة بالحد والحقيقة إطلاقا متساويا كالعين تطلق على العين الباصرة، وينبوع الماء وقرص الشمس وهذه مختلفة الحدود والحقائق. وأما المتواطئة فهي التي تدل على أعيان متعددة بمعنى واحد مشترك بينها، كدلالة إسم الإنسان على زيد وعمرو، ودلالة إسم الحيوان على الإنسان والفرس والطير لأنها متشاركة في معنى الحيوانية والإسم بإزاء ذلك المعنى المشترك المتواطىء، بخلاف العين الباصرة وينبوع الماء. وأما المترادفة: فهي الأسماء المختلفة الدالة على معنى يندرج تحت حد واحد كالخمر والراح والعقار؛ فإن المسمة بهذه يجمعه حد واحد وهو المائع المسكر المعتصر من العنب والأسامي مترادفة عليه. وأما المتزايلة: فهي الأسماء المتباينة التي ليس بينها شيء من هذه النسب كالفرس والذهب والثياب؛ فإنها ألفاظ مختلفة تدل على معان مختلفة بالحد والحقيقة، والمشترك ينبغي أن يجتنب إستعامله في المخاطبات فضلا عن البراهين، وأما المتواطئة فتستعلم في الجميع لا سيما البراهين.
إرشاد إلى مزلة قدم في الفرق بين المشتركة والمتواطئة والتباس إحداهما بالأخرى فإن المشتركة في الإسم هي المختلفان في المعنى المتفقان في الإسم، حيث لا يكونبينهما إتفاق وتشابه في المعنى البتة، وتقابلها المتواطئة وهي المشتركان في الحد والرسم المتساويان فيه بحيث لا يكون الإسم لأحدهما بمعنى إلا وهو للآخر بذلك المعنى، فلا يتفاوتان بالأولى والأحرى والتقدم والتأخر والشدة والضعف كإسم الإنسان لزيد وعمرو، وإسم الحيوان للفرس والثور؛ وربما يدل إسم واحد على شيئين بمعنى واحد في نفسه، ولكن يختلف ذلك المعنى بينهما من جهة أخرى ولنسميه إسما مشككا، وقد لا يكون المعنى واحدا ولكن يكون بينهما مشابهة ولنسمه متشابها. أما الأول فالكالوجود للموجودات؛ فإنه معنى واحد في الحقيقة ولكن يختلف بالإضافة إلى المسميات، فإنه للجوهر قبل ما هو للعرض ولبعض الأعراض قبله لبعض آخر، فهذا بالتقدم والتأخر. وأما المقول بالأولى والأحرى فالكالوجود أيضا فإنه لبعض الأشياء من ذاته ولبعضها من غره، وما له الوجود من ذاته أولى وأحرى بالإسم، واما المقول بالشدة والضعف فيتصور فيما يقبل الشدة والضعف كالبياض للعاج والثلج، فإنه لا يقال عليهما بالتواطؤ المطلق المتساوي بل أحدهما أشد فيه من الآخر.
أما الحيوان لزيد وعمرو، والفرس والثور فلا يتطرق إليه شيء من هذا التفاوت بحال، فقد ظهر بهذا الفرق انه قسم آخر، والمشكك قد يكون مطلقا كما سبق، وقد يكون بحسب النسبة إلى مبدأ واحد كقولنا طبي للكتاب والمبضع والدواء، أو لانتسابه إلى غاية واحدة كقولنا صحي للدواء والرياضة والفصد. وقد يكون إلى مبدأ وغاية واحدة كقولنا لجميع الأشياء أنها الإلهية. وأما الذي لا يجمعهما معنى واحد، ولكن بينهما تشابه ما كالإنسان على صورة متشكلة من الطين بصورة الإنسان وعلى الإنسان الحقيقي، فليس هذا بالتواطؤ إذ يخلفان بالحد فحد هذا حيوان ناطق مائت، وحد ذلك شكل صناعي يحاكي به صورة حيوان ناطق مائت؛ وكذلك القائمة للحيوان وللسرير حده في أحدهما أنه عضو طبيعي يقوم عليه الحيوان ويمشي به، وفي الآخر أنه جسم صناعي مسدير في أسفل السرير ليقله ولكن نجد بينهما شبها في شكل أو حال. ومثل هذا الإسم يكون موضوعا في أحدهما وضعا متقدما ويكون منقولا إلى الآخر، فإن أضيف إليهما سمي متشابه الإسم، وإن أضيف إلى المتقدم منهما سمي موضوعا، وإن أضيف إلى الأخير سمي منقولا؛ ثم هذا الضرب من التشابه على ثلاثة أقسام: الأول أن يكون في صفة قارة ذاتية كصورة الإنسان. والثاني أن يكون في صفة إضافية غير ذاتية كإسم المبدأ لطرف الخط والعلة.
والثالث أن يكون التشابه جاريا في أمر بعيد كالكلب لنجم مخصوص ولحيوان، إذ لا تشابه بينهما إلا في أمر بعيد مستعار لأن النجم رئي كالتابع للصورة التي كالإنسان، ثم وجد الكلب أتبع الحيوانات للإنسان فسمي باسمه. ومثل هذا ينبغي أن يلحق بالمشترك المحض، فإنه لا عبرة بمثل هذا الإشتباه فقد صارت الأسامي بهذه القسمة ستة: متباينة، ومترادفة، ومتواطئة، ومشتركة، ومشككة، ومتشابهة؛ لأن العقل إذا قسم الشيء إلى ستة أقسام فيحتاج إلى ست عبارات في التفهيم. إرشاد إلى مزلة قدم المتباينات ولا يخفى أن الموضوعات إذ تباينت مع تباين الحدود فالأسامي متباينة متزايلة كالفرس والحجر، ولكن قد يتحد الموضوع ويتعدد الإسم بحسب اختلاف إعتبارات، فيظن أنها مترادفة ولا تكون كذلك؛ فمن ذلك أن يكون أحد الإسمين له من حيث موضوعه، والآخر من حيث له وصفن كقولنا سيف وصارم؛ فإن الصارم دل على موضوع موصوف بصفة الحدة بخلاف السيف، ومن ذلك أن يدل كل واحد على وصف للموضوع الواحد كالصارم والمهند، فإن
أحدهما يدل على حدته والآخر على نسبته، ومن ذلك أن يكون أحدهما بسبب وصف، والآخر بسبب وصف الوصف كالناطق والفصيح. ومن المتباينة المشتق والمنسوب مع المشتق منه والمنسوب إليه كالنحو والنحوي، والحديد والحداد، والمال والمتمول، والعدل والعادل، فإن العادل لو سمي عدلا كما سميت العدالة عدلا كان ذلك من قبيل ما يقال باشتباه افسم، ولكن غيرت الصيغة وبقيت المادة والمعنى الأول زيد فيه ما دل على زيادة المعنى فسمي مشتقا. القسمة السابعة للف المطلق بالإشتراك على مختلفات إعلم أن اللفظ المطلق على معان مختلفة ثلاثة أقسام: مستعارة ومنقولة ومخصوصة باسم باسم المشترك. أما المستعارة فهي أن يكون إسم دالا على ذات الشيء بالوضع ودائما من أول الوضع إلى الآن، ولكن يلقب به في بعض الأحوال لا على الدوام شيء آخر لمناسبته للأول على وجه من وجوه المناسبات، من غير أن يجعل ذاتيا للثاني وثابتا عليه ومنقولا إليه
كلفظ الأم، فإنه موضوع للوالدة ويستعار للأرض يقال إنها أم البشر، بل ينقل إلى العناصر الأربعة فتسمى أمهات على معنى أنها أصول. والأم أيضا أصل للولد فهذه المعاني التي استعير لها لفظ الأم لها أسماء خاصة بها. وإنما تسمى بهذه الأسامي في بعض الأحوال على طريق الإستعارة، وخصص باسم المستعار لأن العارية لاتدوم وهذا أيضا يستعار في بعض الأحوال. وأما المنقول فهو أن ينقل الإسم عن موضوعه إلى معنى آخر ويجعل إسما له ثابتا دائما، ويستعمل أيضا في الأول فيصير مشتركا بينهما كإسم الصلاة والحج ولفظ الكافر والفاسق، وهذا يفارق المستعار بأنه صار ثابتا في المنقول إليه دائما ويفارق المخصوص باسم المشترك بأن المشترك هو الذي وضع بالوضع الأول مشتركا للمعنيين لا على أنه استحقه أحد المسميين، ثم نقل عنه إلى غيره إذ ليس لشيء من ينبوع الماء والدينار وقرص الشمس والعضو الباصر سبق إلى استحقاق إسم العين، بل وضع للكل وضعا متساويا بخلاف المستعار والمنقول. والمستعار ينبغي أن يجتنب في البراهين دون المواعظ والخطابيات والشعر، بل هي أبلغ باستعماله فيها. وأما المنقول فيستعمل في العلوم كلها لمسيس الحاجة إليها إذ واضع اللغة لما لم يتحقق عنده جميع المعاني لم يفردها بالأسامي، فاضطر غيره إلى النقل. فالجوهر وضعه واضع اللغة لحجر يعرفه الصيرفي والمتكلم نقله إلى معنى حصله في نفسه، وهو أحد أقسام الموجودات وهذا مما يكثر إستعماله في العلوم والصناعات. وأما المشتركة فلا يؤتى بها في البراهين خاصة ولا في الخطابيات إلا إذا كانت معها قرينة،
وهي أيضا أقسام: فمنها ما يقع في أحوال الصيغة كالإسم الذي يتحد فيه بناء الفاعل والمفعول نحو المختار فإنك تقول زيد مختار والعلم مختار، وأحدهما بمعنى الفاعل، والآخر بمعنى المفعول وكالمضطر وأشباهه. ومنها ما يقع على عدة أمور متشابهو في الظاهر مختلفة في الحقيقة لا يكاد يوقف على وجه مخالفتها كالحي الذي يطلق على الله وعلى الإنسان وعلى النبات والنور الذي يطلق على المدرك بالبصر المضاد للظلام، وعلى العقل الهادي إلى غوامض الأمور. فإن قال قائل: فما مثال المستعار؟ قلنا: مثاله استعارة أطراف الحيوان لغير الحيوان كقولهم: رأس المال، وجه النهار، عين الماء، حاجب الشمس، أنف الجبل، ريق المزن، يد الدهر، جناح الطريق، كبد السماء، وكقولهم: بيه سمع الأرض وبصرها، وكقولهم: أيد للشر ناجذيه، ودارت رحى الحرب، وشابت مفارق الجبال، وكقولهم: الشيب عنوان الموت، والرشوة رشا الحاجة، العيال سوس المال، الوحدة قبر الحي، الإرجاف زند الفتنة، الشمس قطيفة مباحة للمساحين. ومن إستعارات القرآن: (وَأَنّهُ في أُم الكِتابِ لِتُنذِرَ بِهِ أُمَّ القُرى وَمَن حَولَها) (وَاخفِض لَهُمَا جُناحَ الذُلِّ مِنَ الرَحمَة) (وَالصُبحِ إِذا تَنَفَس)) (فَأذاقَها الله لِباسَ الجُوعِ وَالخَوفِ) (كُلَّما أَوقَدوا نَاراً لِلحَربِ أَطفَأَها الله) (أَحاطَ بِهِم سُرادِقُها) (فَما بَكَت عَلَيهِمُ السماء والأرض) (واشتعل الرأس شيبا) (فصب عليهم ربك سوط عذاب) (ولما سكت عن موسى الغضب) ونظائره مما يكثر، وهذه الإستعارات بنوع مناسبة بين المستعار والمستعار منه،
فإن قيل: فما معنى المجاز؟ قلنا قد يراد به المستعار فالمعنى أنه قد تجوز عن وضعه، وقد يراد به ما يقتضي الحقيقة، وفي الإطلاق خلافه كقوله: (وأسأل القرية) إذ المسؤول بالحقيقة أهل القرية لا نفس القرية؛ فهذه أمور لفظية من أهملها ولم يحكمها في مبدأ نظره كثر غلطه ولم يدر من أين أتى.
الفن الثاني في مفردات المعاني الموجودة ونسبة بعضها إلى بعض والفرق بين هذا الفن والذي قبله أن الأول نظر في اللفظ من حيث يدل على المعاني - وهذا نظر في المعنى من حيث هو ثابت في نفسه، وإن كان يدل عليه باللفظ إذ لا يمكن تعريف المعاني إلا بذكر الألفاظ. ويتضح الغرض من هذا الفن بأنواع من القسمة. القسمة الأولى في نسبة الموجودات إلى مدراكنا فليعلم أن نظرنا في حصر الموجودات وحقائقها وهي منقسمة إلى محسوسة وإلى معلومة بالإستدلال لا تباشر ذاته بشيء من لاحواس، فالمحسوسات هي المدركات بالحواس لخمس كالألوان، ويتبعها معرفة الشكال والمقادير وذلك بحاسة البصر، وكالأصوات بالسمع، وكالطعوم
بالذوق، والروائح بالشم، والخشونة والملاسة، واللين والصلابة، والبرودة والحرارة، والرطوبة واليبوسة بحاسة اللمس، فهذه الأمور ولواحقها تباشر بالحس أي تتعلق بها القوة المدركة من الحواس في ذاتها. ومنها ما يعلم وجوده ويستدل عليه بآثاره ولا تدركه الحواس الخمس: السمع والبصر والشم والذوق واللمس، ولا تناله. ومثاله هذه الحواس نفسها فإن معنى أي واحدة منها هي القوة المدركة، والقوة المدركة لا تحس بحاسة من الحواس، ولا يدركها الخيال أيضا. وكذلك القدرة والعلم والإردادة بل الخوف والخجل والعشق والغضب، وسائر هذه الصفات نعرفها من غيرنا معرفة يقينية بنوع من الإستدلال لا بتعلق شيء من حواسنا بها. فمن كتب بين أيدينا عرفنا قطعا قدرته وعلمه بنوع من الكتابة وإرادته إستدلالا بفعله، ويقيننا الحاصل بوجود هذه المعاني كيقيننا الحاصل بحركات يده المحسوسة وانتظام سواد الحروف على البياض، إن كان هذا مبصرا وتلك المعاني غير مبصرة بل أكثر الموجودات معلوم بالإستدلال عليها بآثارها ولا تحس، فلا ينبغي أن يعظم عندك الإحساس وتظن أن العلم المحقق هو الإحساس والتخيل وأن ما لا يتخيل لا حقيقة له، فإنك لو طالبت نفسك بالنظر إلى ذات القدرة والعلم وجدت الخيال يتصرف فيه بتشكيل وتلوين وتقدير، وأنت تعلم أن تصرف الخيال خطأ وأن حقيقة القدرة المستدل عليها بالفعل أمر مقدس عن الشكل واللون والتحيز والقدر، ولا ينبغي أن تنك دلالة العقل على أمور يأباها الخيال. وننبهك الآن على منشأ هذا الإلتباس؛ فتأمل أن المدركات الأول للإنسان في مبدأ فطرته حواسه فكانت مستولية عليه،
ثم الأغلب من جملتها الأبصار الذي يدرك الألوان بالقصد الأول والأشكال على سبيل الإستتباع، ثم الخيال يتصرف في المحسوسات وأكثر تصرفه في المبصرات فيركب من المرئيات أشكالا مختلفة آحادها مرئية، والتركيب من جهته، فإنك تقدر أن تتخيل فرسا له راس إنسان وطائرا له رأس فرس، ولكن لا يمكن أن تصور آحادا سوى ما شاهدته البتة حتى أنك لو أردت أن تتخيل فاكهة لم تشاهد لها نظيرا لم تقدر عليه، وإنما غايتك أن تأخذ شيئا مما شاهدته فتغير لونه مثلا كتفاحة سوداء، فإنك قد رأيت شكل التفاحة والسواد فركبتهما أو ثمرة كبيرة مثل بطيخة، فلا تزال تركب من آحاد ما شاهدت لأن الخيال يتبع الإبصار ولكنه يقدر على التركيب والتفصيل فقط، ولا يزال الخيال متحركا في التركيب والتفصيل مستوليا عليك بذلكن فمهما حصل لك معلوم بالإستدلال انبعث الخيال محدقا نظره نحوه طالبا حقيقة الأشياء عنده، ولا حقيقة عنده إلا للون أو الشكل فيطلب الشكل واللون، وهو ما يدركه البصر من الموجودات حتى لو تأملت في ذات الرائحة تأملا خياليا طلب الخيال للرائحة ولونا ووضعا وقدرا، كاذبا فيه وجاريا على مقتضى جبلته. والعجب أنك إذ تأملت في شكل متلون لم يطلب الخيال منه طعمه ورائحته وهما حظا الشم والذوق، وإذا تأملت في ذات الطعم والرائحة طلب الخيال حظ البصر وهو اللون والشكل، مع أن الخيال يتصرف في مدركات الحواس الخمس جميعا ولكن لما كان ألفه لمدركات البصر أشد وأكثر، صار طلبه لحظ البصر أغلب وأبلغ. فإذا عرضت على نفسك عملك بصانع العالم وأنه موجود لا في جهة، طلب الخيال له لونا وقدر له قربا وبعدا واتصالا بالعالم وانفصالا إلى غير ذلك مما شاهده في الأشكال المتلونة، ولم يطلب له طعما ورائحة. ولا فرق بين الطعم والرائحة واللون والشكل، فالكل من مدركات الحواس. فإذا عرفت إنقسام الموجودات
إلى محسوسات وإلى معلومات بالعقل ولا تباشر بالحس والخيال، فاعرض عن الخيال رأسا وعوّل على مقتضى العقل فيه، فقد ظهر لك إنقسام الموجود إلى محسوس وغيره. ؟؟؟ القسمة الثانية للموجودات باعتبار نسبه ؟؟؟ بعضها إلى بعض بالعموم والخصوص إعلم أن معنى من المعاني الموجودة، وحقيقة من الحقائق الثابتة إذا نسبتها إلى غيرها من تلك المعاني والحقائق، وجدتها بالإضافة إليه إما أعم وإما أخص وإما مساويا، وإما أعم من وجه وأخص من وجه، فإنك إذا أضفت الإنسان إلى الحيوان وجدته أخص منه، وإن أضفت الحيوان إلى الإنسان وجدته أعم منه، وإن أضفت الحيوان إلى الحساس وجدته مساويا له لا أعم ولا أخص، وإن نسبت الأبيض إلى الحيوان وجدته أعم من وجه فإنه يشمل الجص والكافور وجملة من الجمادات، وأخص من وجه فإنه يقصر عن تناول الغراب والزنوج وجملة من الحيوانات. فإذن جملة الحقائق تناسبها بهذا الإعتبار لا تعدو هذه الوجوه الأربعة، فقس على ما ذكرناه ما لم نذكره.
؟ القسمة الثالثة للموجودات تنقسم إلى موجودات شخصية معينة وتسمى أعيانا إعلم أن الموجودات تنقسم إلى موجودات شخصية معينة وتسمى أعيانا وأشخاصا وجزئيات، وإلى أمور غير متعينة وتسمى الكليات والأمور العامة. فأما الأعيان الشخصية فهي الأمور المدركة أولا بالحواس كزيد وعمرون وهذا الفرس وهذه الشجرة وهذه السماء وهذا الكوكب وأمثالها، وكذا هذا البياض وهذه القدرة، فإن التعين يدخل على الأعراض والجواهر جميعا. ثم هذه الأشخاص كزيد وهذا الفرس وهذه الشجرة وهذا البياض لا تشترك في أعيانها، إذ عين هذا الشخص ليس هو عين الشخص الآخر، إلا أنها تتشابه بأمور كتشابه هذه الثلاثة في الجسمية وتشابه الفرس والإنسان دون الشجر في الحيوانية، فما به التشابه للأشياء يسمة الكليات والأمور العامة، وقد يتشابه زيد وعمرو بعد التشابه في الجسمية والحيوانية والإنسانية في الطول والبياض أيضا، فيكون الطول الذي به التشابه وكذا البياض أمرا عاما شاملا لهما شمولا واحدا، لا على أن بياض هذا هو بياض ذاك وطول هذا طول ذاك بعينه، ولكن على معنى سنبه عليه عند تحقيقنا لمعنى الكلي وثبوته في العقل، وهو من أدق ما ينبغي أن يدرك في المعقولات. ؟
القسمة الرابعة في نسبة بعض المعاني إلى بعض إعلم أنك تقول: هذا الإنسان أبيض وهذا الإنسان حيوان، وهذا الإنسان ولدته أنثى، فقد حملت عليه البياض والحيوانية والولادة وجعلته موصوفا بهذه الأوصاق الثلاثة، ونسبة هذه الثلاثة إليه متفاوتة: فإن البياض يتصور ان يبطل من الإنسان ويبقى إنسانا فليس وجوده شرطا لإنسانيته ولنسم هذا عرضيا مفارقا. وأما الحيوانية فضرورية للإنسان، فإنك إن لم تفهم الحيوان وامتنعت عن فهمه لم تفهم الإنسان بل مهما فهمت الإنسان فقد فهمت حيوانا مخصوصا، فكانت الحيوانية داخلة في مفهومك بالضرورة ويلقب هذا بلقب آخر للتمييز وهو الذاتي المقوم. وأما كونه مولودا من أنثى وكونه متلونا مثلا فليس نسبته إليه كنسبة الحيوانيةن إذ يجوزن أن يحصل في العقل معنى الإنسان بحده وحقيقته مع الغفلة عن كونه مولودا، أو مع اعتقاد أنه ليس بمولود خطأ، فليس من شرط فهم الإنسان الإمتناع عن اعتقاد كونه غير مولود، ومن شرطه الإمتناع عن اعتقاد كونه غير حيوان.
وأما تميزه عن البياض فهو أن البياض قد يفارق وكونه مولودا لا يفارقه قط، وكذلك كونه متلونا بالجملة لا يفارقه وإن فارقه كونه أبيض على الخصوص، فالمتلونية ليست داخلة في ماهية الإنسان دخول الحيوانية، فلنخصص هذا القسم بلقب وهو اللازم؛ فإن الذاتي المقوم وإن كان أيضا لازما ولكن له خاصية التقويم، فيخصص إسم اللازم بهذا القسم. فقد استفدت من هذا التحقيق إنّ كلّ معنى ينسب إلى شيء، فإما أن يكون ذاتيا له مقوما لذاته أي قوام ذاته به، وإما ان يكون غير ذاتي مقوم ولكنه لازم غير مفارق، وأما أن يكون لا ذاتيا ولا لازما ولكن عرضيا. ولعلك تقول: الفرق بين العرضي المفارق وبين الذاتي واضح ولكن الفرق بين الذاتي المقوم وبين اللازم الذي ليس بمقوم ربما يشكل فهل لك معيار يرجع إليه؟ فنقول: المتكلمون سموا اللوازم توابع الذات وربما سموها توابع الحدوث، حتى زعمت منهم أن توابع الحدوث لا تتعلق بها قدرة القادر، ولكنها تتبع الحدوث وربما مثلوا ذلك بتحيز ولسنا نخوض فيه، والغرض إظهار معيار لإدراك الفرق بين الذاتي واللازم وله معياران: الأول أن كل ما يلزم ولا يرتفع في الوجود إن أمكن أن يرتفع بالوهم
والتقدير وبقي الشيء معه مفهوما فهو لازم، فأنا نفهم كون الإنسان إنسانا وكون الجسم جسما وإن رفعنا من وهمنا كون الإنسان إنسانا وكون الجسم جسما وإن رفعنا من وهمنا اعتقاد كونهما مخلوقين مثلا وكونهما مخلوقين لازم لهما، ولو رفعنا من وهمنا كون الإنسان حيوانا لم نقدر على فهم الإنسان. فمن ضرورة فهم الإنسان أن لا يسلب الحيوانية وليس من ضرورته أن لا يسلب المخلوقية، فإذن ما لا يرتفع في الوجود والوهم جميعا فهو ذاتي، وما يرفع في الوجود والوهم فهوعرضي، وما يقبل الإرتفاع في الوهم دون الوجود فهو لازم غير ذاتي، إلا أن هذا المعيار مع أنه كثير النفع في أغلب المواضع غير مطرد في الجميع فإن من اللوازم ما هو ظاهر اللزوم للشيء، بحيث لا يقدر على رفعه في الوهم أيضا، فإن الإنسان يلازمه كونه متلونا ملازمة ظاهرة لا يقدر الإنسان على رفعه في الوهم وهو لازم لا ذاتي، ولذلك إذا حددنا الإنسان لم يدخل فيه التلون مع أن الحد لا يخلو عن جميع الذاتيات المقومة كما سيأتي في كتاب الحدود. وكذلك كون كل عدد إما مساو لغيره أو مفاوت فإنه لازم ليس بذاتي، وربما لا يقدر الإنسان على رفعه في الوهم، نعم من اللوازم ما يقدر على رفعه ككون المثلث مساوي الزوايا القائمتين فإنه لازم لا يعرف لزومه للمثلث بغير وسط بل بوسط، فلم يكن هذا مطردا فنعدل إلى المعيار الثاني عند العجز عن الأول ونقول: إن كل معنى إذا أحضرته في الذهن مع الشيء الذي شككت في أنه لازم له أو ذاتي، فإن لم يمكنك أن تفهم ذات الشيء إلا أن يكون قد فهمت له ذلك المعنى أولا، مساوية لقائمتين فهو كالحيوان وانسان
فإنك إذا فهمت ما الإنسان وما الحيوان فلا تفهم الإنسان إلا وقد فهمت أولا أنه حيوان فاعلم أنه ذاتي. وإن أمكنك أن تفه ذات الشيء دون أن تفهم المعنى أو أمكنك الغفلة عن المعنى بالتقدير، فاعلم أنه غير ذاتي. ثم إن كان يرتفع وجوده إما سريعا كالقيام والقعود للإنسان أو بطيئا شابا فاعلم أنه عرضي مفارق، وإن كان لا يفارقه أصلا ككون الزوايا من المثلث لازم، ورب لازم للشخص كأزرق العين أو أسود البشرة في الزنجي، فهو لا يفارق في الوجود للإنسان الزنجي فهو بالإضافة إلى ذلك الشخص لا يبعد أن يسمى لازما، وإن كان لزومه بالإتفاق لا بالضرورة في الجنس إذ يمكن وجود إنسان ليس كذلك، ولو أمكنت حيلة في إزالة زرقة العين وسواد البشرة لبقي هذا الإنسان إنسانا، ولو قدرت حيلة لإخراج زوايا المثلث عن كونها مساوية لقائمتين لم يبق المثلث وبطل وجوده، فلتدرك هذه الدقيقة في الفرق بين اللازم الضروري وبين اللازم الوجودي.
القسمة الخامسة للذاتي في نفسه وللعرضي في نفسه لما كان المقوم مخصوصا باسم الذاتي في اصطلاح النظار صار ما يقابله يسمى عرضيا، مفارقا كان أو لازما، فيقال عرضي لازم وعرضي مفارق؛ فالعرضي بهذا المعنى وهو الذي ليس بمقوم ينقسم بالإضافة إلى ماهو عرضي له إلى ما يعمه وغيره وإلى ما يختص به ولا يوجد لغيره فيسمى خاصة، سواء كان لازما أو لم يكن وسواء كان ما نسب إليه نوعا أخيرا أو لم يكن، وسواء عم جميع ذلك الجنس أو وجد لبعضه كالمشي والأكل، فإنه بالإضافة إلى الحيوان خاصة، إذ لا يوجد لغير الحيوان، وإن كان لا يوجد كل وقت للحيوان فإن أضفته إلى الإنسان كان عرضا عاما، وكذلك الصهيل للفرس والضحك للإنسان من الخواص، فما ليس مخصوصا بما نسب إليه بل وجد له ولغيره سمي عرضا عاما، ولا تظن أنانريد بالعرض ما نريد بالعرض الذي يقابل الجوهر، فإن هذا العرض قد يكون جوهرا كالأبيض للإنسان، فإن معنى الأبيض هنا جوهر ذو بياض ومدلول اللفظ جوهر لا كالبياض، فإنه عرض فلا تغفل عن هذه الدقيقة فتغلط فينقسم العرضي قسمة أخرى إلى ما يسمى أعراضا ذاتية
وإلى ما لا يسمى ذاتية، فإن الموجود يتحرك والجسم يتحرك والإنسان يتحرك، ولكنا نقول الموجود ليس يتحرك لكونه موجودا بل لمعنى أخص منه وهو الجسمية، والإنسان لا تعتريه الحركة لأنه إنسان بل لمعنى أعم منه وهو كونه جسما، فإذن الحركة من الأعراض الذاتية للجسم أي تلحقه وتعتريه من حيث أنه جسم لا لمعنى أعم منه ولا أخص منه بل لذاته، والصحة والسقم يوسف بكل منهما الحيوان وهو من الأعراض الذاتية للحيوان، إذ لا يلحقه لمعنى أعم منه فإنه لا يعتريه من حيث أنه موجود أو جسم، ولا لما هو أخص منه لأنه لا يعتريه من حيث أنه فرس أو ثور أو إنسان، بل لما هو أعم منها وهو كونه حيوانا. وكذلك الزوجية والفردية للعدد فما يجري هذا المجرى يسمى أعراضا ذاتية، فلا ينبغي أن يلتبس عليك الذاتي بالمعنى الأول وهو المقوم بالذاتي بالمعنى الثاني وهوغير مقوم، فهذه قسمة العرضي. أما الذاتي المقوم فينقسم إلى ما لا يوجد شيء أعم منه وهو داخل في الماهية، أي يمكن
أن يذكر في جواب ما هو ويسمى جنسا وإلى ما يوجد أعم منه دون ما هو أخص منه، ويمكن أن يذكر في جواب ما هو ويسمى نوعا وإلى ما يذكر في جواب أي شيء هو ويسمى فصلا. فإذن إنقسم الذاتي إلى الجنس والنوع والفصل، والعرضي إلى الخاصة والعرض العام بالقسمة المذكورة، فتكون الجملة خمسة، فإذن الكليات بهذا الإعتبار خمسة ويسميها المنطقيون الخمسة المفردة، والأقسام الثلاثة للذاتي فيها مواضع إشتباه فلنوردها في معرض الأسئلة. فإن قال قائل: إذا كان الأعم من الذاتيات يسمى جنسا، والأخص يسمى نوعا، فالذي هو بين الأخص والأعم كالحيوان الذي هو بين الجسم، فإنه أعم من الحيوان وبين الإنسان فإنه أخص من الحيوان ما إسمه؟ قلناك هذا يسمى نوعا بالإضافة إلى ما فوقه وجنسا بالإضافة إلى ما تحته. فإن قلت: فإسم النوع للمتوسط وللنوع الأخير الذي هو الإنسان بالتواطؤ أو بإشتراك الإسم؟ فاعلم أنه بالإشتراك، فإن الإنسان يسمى نوعا بمعنى أنه لا يقبل التقسيم بعد ذلك إلا بالشخص والعدد كزيد وعمرو، أو بالأحوال العرضية كالطويل والقصير وغيره. وأما الحيوان فتسميته نوعا بمعنى آخر وهو أنه يوجد ذاتي أعم منه، والإنسان سمي نوعا بمعنى أنه لا يوجد ذاتي أخص منه، بل كل ما أوردته مما هو أخص فهو عرضي لا ذاتي فهما معنيان متباينان.
فإن قال قائل: فالموجود والشيء أعم من الجسم والحيوان فهل تسمونه جنسا؟ قلنا: لا حجر في التسميات والإصطلاحات بعد فهم المعاني، والأولى في الإصطلاحات النزول على عادة من سبق من النظار، وقد خصصوا إسم الجنس بمعنى داخل في الماهية يجوز أن يجاب به عن سؤال السائل عن الماهية، فيذكر في جواب ما هو، وإذا أشير إلى الشيء وقيل ما هو، لم يحسن ان يقال أنه موجود أو شيء بل الوجود كالعرضي بالإضافة إلى الماهية المعقولة، إذ يجوز أن تحصل ماهية الشيء في العقل مع الشك في أن تلك الماهية هل لها وجود في الأعيان أم لا، فإن ماهية المثلث أنه شكل يحيط به ثلاثة أضلاع، ويجوز أن يحصل في نفوسنا هذه الماهية ولا يكون للمثلث وجود، ولو كان الوجود داخلا في الماهية مقوما لحقيقة الذات لما تصور فهم المثلث وحصول ماهيته في العقل مع عدمه، فكمالا يتصور أن تحصل صورة الإنسان وحده في العقل إلا أن يكون كونه موجودا حاضرا في العقل، إن كان الوجود مقوما للذات كالحيوانية للإنسان والشكلية للمثلث، وليس الأمر كذلك. وعلى الجملة وجود الشيء أما في الأعيان فيستدعي حضور جميع الذاتيات المقومة، وأما في الأذهان وهو مثال الوجود في الأعيان مطابق له وهو معنى العلم إذ لا معنى للعلم بالشيء إلا بثبوت صورة الشيء وحقيقته ومثاله في النفس، كما تثبت صورة الشيء في المرآة مثلا إلا أن المرآة لا تثبت فيها إلا أمثلة المحسوسات، والنفس مرآة تثبت فيها أمثلة المعقولات فيستدعي حضور
جميع الذاتيات المقومة مرة أخرى. فإن قال قائل: فقد عرفت الفرق بين الجنس وبين ما هو عام عام عمومالجنس وليس بجنس، فبماذا يعرف الفرق بين الفصل والنوع؟ قلنا: الفصل ذاتي لا يذكر في جواب ما هو بل يذكر في جواب أي شيء هو، فإنه يشار إلى الخمر فيقال: ماهو؟ فيذكر في الجواب: شراب؛ فلا يحسن بعده أن يقال: ما هو؟ بل: أي شراب هو؟ فيقال: مسكر؛ فالمسكر فصل أي يفصله عن غيره وهو الذي يسميه الفقهاء احترازا، إلا أن الإحتراز قد يكون بالذاتي وقد يكون بغير الذاتي، وقد يخصص إسم الفصل عند الإطلاق بالذاتي. فلو قيل: أي شيء هو؟ وأجيب بأنه أحمر يقذف بالزبد، فربما انفصل به عن غيره وحصل به الإحتراز ولكن يكون ذلك فصلا غير ذاتي. وأما المسكر ففصل ذاتي للشراب وكذلك الناطق للحيوان. وعلى الجملة الجنس والفصل عبارة عن الحقيقة نفسها تفصيلا كقولك شراب مسكر وحيوان ناطق؛ والنوع عبارة عنها إجمالا كقولك إنسان وفرس وجمل سواء النوع الإضافي والحقيقي، والفصل عبارة عن شيء ذي حقيقة كقولك ناطق وحساس ومسكر أي شيء ذو نطق وذو حس وذو إسكار، فكان الشيء الذي ورد عليه الوصف بذو وما بعدها لم يذكر بالفصول القائلة ناطق وحساس ومسكر. وسيأتي لهذا مزيد بيان في كتاب الحد الموصل إلى تصور الأشياء، إذ لا يتم الحدّ إلا بذكر الجنس والفصل.
القسمة السادسة في أصناف الحقائق المذكورة في جواب السائل عن الماهية إعلم أن قول القائل في الشيء ما هو طلب لماهية الشيء، ومن عرف الماهية وذكرها فقد أجاب. والماهية إنما تتحقق بمجموع الذاتيات المقومة للشيء، فينبغي أن يذكر المجيب جميع الذاتيات المقومة للشيء حتى يكون مجيبا، وذلك بذكر حده فلو ترك بعض الذاتيات لم يتم جوابه. فإذا أشار إلى خمر وقال ما هو؟ فقولك شراب ليس بجواب مطابق لأنك أخللت ببعض الذاتيات وأتيت بما هو الأعم، بل ينبغي أن تذكر المسكر. وإذا أشار إلى إنسان وقال: ما هو؟ قتقول: إنه إنسان؛ فإن قال: ما هو الإنسان؟ فجوابك: إنه حيوان ناطق مائت؛ وهو تمام حده، والمقصود إنه يجب أن تذكر ما يعمه وغيره وما يخصه، لأن الشيء هو بإجتماع ذلك وبه تتحصل ذاته، فإذا ثبت هذا الأصل فالمذكور في جواب ما هو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أحدها هو بالخصوصية المطلقة وذلك بذكر الحد لتعريف ماهية الشيء المذكور كما إذا قيل لك: ما الخمر؟ فتقول: شراب مسكر معتصر من العنب، وهذا يختص بالخمر ويطابقه ويساويه فلا هو أعم منه ولا هو أخص منه، بل ينعكس كل واحد منهما على الآخر وهو مع المساواة جامع لجميع الذاتيات المقومة من الجنس والفصول، وهكذا نسبة كل حد لشيء إلى إسمه.
الثاني ما هو بالشركة المطلقة مثل ما إذا سئلت عن جماعة فيها فرس وإنسان وثور: ماهي؟ فعند ذلك لا يحسن إلا أن تقول حيوان؛ فأما الأعم من ذلك وهوالجسم فليس تمام الماهية المشتركة بينها، بل هو جزء الماهية فإن الجسم جزء من ماهية الحيوان، إذ الحيوان هو جسم ذو نفس حساس متحرك، هذا حده وإنما الإنسان والفرس ونحوه أخص دلالة مما يشمل الجملة، وقد جعل الجملة كشيء واحد فأخص ماهية مشتركة لها الحيوان. الثالث ما يصلح أن يذكر على الخصوصية والشركة جميعا، فإنك إذا سئلت عن جماعة هم زيد وعمرو وخالد: ما هم؟ كان الذي يصلح أن يجاب به على الشرط المذكور: إنهم أناس. وكذلك إذا سئل عن زيد وحده: ما هو؟ لا أن يقال: من هو؟ كان الجواب الصحيح: إنه إنسان، لأن الذي يفضل في زيد على كونه إنسانا من كونه طويلا أبيض ابن فلان، أو كونه رجلا أو إمرأة أو صحيحا أو سقيما أو كاتبا أوعالما أو جاهلا، كل ذلك أعراض ولوازم لحقته لأمور اقترنت به في أول خلقته أو طرأت عليه بعد نشوه، ولا يمتنع علينا أن نقدر أضدادها بل زوالها منه، ويكون هو ذلك الإنسان بعينه. وليس كذلك نسبة الحيوانية إلى الإنسانية، ولا نسبة الإنسانية إلى الحيوانية، إذ لا يمكن أن يقال قد اقترن به في رحم أمه سبب جعله إنسانا لو لم يكن لكان فرسا أو حيوانا آخر، وهو ذلك الحيوان بعينه، بل إن لم يكن إنسانالم يكن أصلا حيوانا لا ذاك بعينه ولا غيره، فإذن هو الذاتي الأخير وهوالذي يسمى نوعا أخيرا. فإن قال قائل: لم لا يجوز في القسم الثاني أن يقال حساس ومتحرك بالإرادة بدل الحيوان وهو ذاتي مساو للحيوان؟ قلنا: ذلك غير سديد على الشرط المطلوب، لأن المفهوم من الحساس والمتحرك على سبيل المطابقة هو مجرد أنه شيء له قوة حس أو حركة، كما أن مفهوم الأبيض أنه شيء له بياض؛
فأما ما ذلك الشيء وما حقيقة ذاته فغير داخل في مفهوم هذه الألفاظ إلا على سبيل الإلتزام حتى لا يعلم من اللفظ بل من طريق عقلي يدل على أن هذا لا يتصور إلا لجسم ذي نفس. فإذا سئل عن جسم: ما هو؟ فقلت: أبيض؛ لم تكن مجيبا وإن كنا نعلم من وجه آخر أن البياض لا يحل إلا جسما، ولكن نقول دلالة الأبيض على الجسم بطريق الإلتزام، وقد قدمنا أن المعتبر في دلالة الألفاظ طريق المطابقة والتضمن، ولذلك لا يجوز الجواب عن الماهية بالخواص البعيدة وإن كانت تدل بطريق الإلتزام فلا يحسن أن يقال في جواب من يسأل عنماهية الإنسان أنه الضحاك، وأن كان يدل بطريق الإلتزام. فإن قال قائل: قد ادعيتم أن الماهية مهما حضرت في العقل كان جميع أجزائها حاضرا، وليس كذلك، فإنا إذا علمنا الحادث فإنما نعلم شيئا واحدا مع أن أجزاء ذاته كثيرة، إذ معناه وجود بعد العدم ففيه العلم بالوجود وبعدم ذلك الوجود، وبكون العدم سابقا، وكون الوجود متأخرا وفيه العلم بالتقدم والتأخر وفيه العلم بالزمان لا محالة، فهذه المعلومات كلها لا بد من حضورها في الذهن حتى يتم أجزاء حد الحادث والناظر في الحادث لا تخطر له هذه التفاصيل وهو عالم به. فالجواب أن جميع الذاتيات المقومة للماهية لا بد أن تدخل مع الماهية في التصور، ولكن قد لا تخطر بالبال مفصلة فكثير من المعلومات لا تخطر بالبال مفصلة، ولكنها إذا اخطرت تمثلت وعلم أنها كانت حاصلة، فإن العالم بالحادث أن لم يكن عالما بهذه الأجزاء وقدر أنه لم يعلم إلا الحادث ثم قيل له: هل علمت وجودا أو عدما أو تقدما أو تأخرا؟ فلو قال: ما علمت؛ كان كاذبا فيه.
ومن عرف الإنسان فقيل له: هل عرفت حيوانا أوجسما أو حساسا أو شيئا ذا طول وعرض وعمق وهو حد الجسم؟ فقال: ما عرفته؛ كان كاذبا. فنفهم من هذا أن هذه المعاني معلومة حاضرة في الذهن إلا أنها لا تتفصل غلا إذا أخطرت مفصلة، وإذا فصلت علم أن المعاني كانت معلومة من قبل؛ فافهم هذا فإنه دقيق في نفسه فقد نبهنا على مثارين للشبهة في هذه القسم بصيغة السؤال والجواب. تكملة لهذه الجملة برسوم المفردات الخمس وترتيبها أما الرسوم الجارية مجرى الحدود فالجنس يرسم بأنه كلي يحمل على أشياء مختلفة الذوات والحقائق في جواب ما هو، والفصل يرسم بأنه كلي يحمل على الشيء في جواب أي شيء هو في جوهره. والنوع بأحد المعنيين يرسم بأنه كلي يحمل على أشياء لا تختلف إلا بالعدد في جواب ما هو وبالمعنىالثاني يرسم بأنه كلي يحمل عليه الجنس وعلى غيره حملا ذاتيا، والخاصة ترسم بأنها كلية تحمل على ما تحت حقيقة واحدة فقط حملا غير ذاتي،
والعرض العام يرسم بأنه كلي يطلق على حقائق مختلفة. ثم إعلم أن هذه الذاتيات التي هي أجناس وأنواع تترتب متصاعدة إلى أن تنتهي إلى جنس الأجناس، وهو الجنس العالم الذي ليس فوقه جنس وتترتب متنازلة حتى تنحط إلى النوع الأخير الذي إن نزلت منه انتهت والأعراض، ولا بد من انتهاء الجنس العالي في التنازل إلى نوع أخير إذ ليس يخرج عن النهاية، ولا بد من إرتفاع النوع الأخير في التصاعد إلى جنس عال لا يمكن مجاوزته إلا بذكر العوارض واللوازم. فأما الذاتيات فتنتهي لا محالة والأنواع الأخيرة كثيرة، والأجناس العالية التي هي أعلى الأجناس زعم المنطقيون أنها عشرة: واحد جوهر وتسعة أعراض وهي: (الكم والكيف والمضاف والين ومتى والوضع وله وأن يفعل وأن ينفعل) فالجوهر مثل قولنا إنسان وحيوان وجسم، والكم مثل قولنا ذو ذراع وذو ثلاثة أذرع، والكيف مثل قولنا أبيض واسود، والمضاف مثل قولنا ضعف ونصف وابن واب، والاين مثل قولنا في السوق وفي الدار، ومتى مثل قولنا في زمان كذا ووقت كذا، والوضع مثل قولنا متكىء وجالس، وأن يفعل مثل قولنا يحرق ويقطع، وأن ينفعل مثل قولنا يحترق ويتقطع، وله مثل قولنا متنعل ومتطلس ومتسلح.
وقد تجتمع هذه العشرة في شخص واحد في سياق كلام واحد كما تقول أن الفقيه الفلاني الطويل الأسمر ابن فلان الجالس في بيته في سنة كذا يعلم ويتعلم وهو متطلس. فهذه أجناس الموجودات والألفاظ الدالة عليها بواسطة آثارها في النفس، أعني ثبوت صورها في النفس وهي العلم بها فلا معلوم إلا وهو داخل في هذه الأقسام، ولا لفظ إلا وهو دال على شيء من هذه الأقسام. فأما الأعم من جميعها فهو الموجودة، وقد ذكرنا أنه ليس جنسا وينقسم بالقسمة الأولى إلى الجوهر والعرض، والعرض ينقسم إلى هذه الأقسام التسعة، فيكون المجموع عشرة، ولهذا مزيد تفصيل وتحقيق سيساق إليك في كتاب أقسام الوجود وأحكامه، فإنه بحث عن إنقسام الموجودات، والله أعلم.
؟؟ الفن الثاني في تركيب المعاني المفردة إعلم أن المعاني إذا ركبت حصل منها أصناف كالإستفهام والإلتماس والتمني والترجي والتعجب والخبر. وغرضنا من جملة ذلك الصنف الأخير وهو الخبر، لأن مطلبنا البراهين المرشدة إلىالعلوم وهي نوع من القياس المركب من المقدمات التي كل مقدمة منها خبر واحد يسمى قضية. والخبر هو الذي يقال لقائله أنه صادق أو كاذب فيه بالذات لا بالعرض وبه يحصل الإحتراز عن سائر الأقسام إذ المستفهم عما يعلمه قد يقال له لا تكذب، فإنه يعرض به إلى التباس الأمر عليه. وكذلك من يقول يا زيد ويريد غيره لأن8هـ يعتقد أن زيدا في الدار، فإذا قيل له لا تكذب لم يكن ذلك تكذيبا في النداء بل في خبر اندرج تحت النداء ضمنا، فإذا نظرنا في هذا الفن في القضية وبيانها بذكر أحكامها وأقسامها:؟ القسمة الأولى: إن القضية باعتبار ذاتها تنقسمب إلى جزئين مفردين: أحدهما خبر والآخر مخبر عنه
كقولك زيد قائم، فإن زيدا مخبر عنه والقائم خبر، وكقولك العالم حادث، فالعالم مخبر عنه والحادث خبر وقد جرت عادة المنطقيين بتسمية الخبر محمولا والمخبر عنه موضوعا، فلننزل على اصطلاحهم فلا مشاحة في الألفاظ. ثم إذا قلنا الشكل محمول على المثلث، فإن كل مثلث شكل فلسنا نعني به أن حقيقة المثلث حقيقة الشكل، ولكن معناه أن الشيء الذي يقال له مثلث فهو بعينه يقال له شكل، سواء كان حقيقة ذلك الشيء كونه مثلنا أو كونه شكلا أو كونه أمرا ثالثا، فإنا إذا أشرنا إلى إنسان وقلنا هذا الأبيض طويل، فحقيقة المشار إليه كونه إنسانا لا هذا الموضوع وهو الأبيض ولا هذا المحمول وهو الطويل. وإذا قلنا هذا الإنسان أبيض فالموضوع هو الحقيقة فإذن لسنا نعني بالمحمول إلا القدر الذي ذكرناه من غير اشتراط، فالنفهم حقيقته فهذا أقل ما تنقسم إليه القضية الحملية. والقضايا باعتبار وجوه تركيبها ثلاثة أصناف: الأول الحملي وهو الذي حكم فيه بأن معنى محمول على معنى أو ليس بمحمول عليه كقولنا: العالم حادث - العالم ليس بحادث؛ فالعالم موضوع والحادث محمول يسلب مرة ويثبت أخرى. وقولنا: ليس هو حرف سلب، إذا زيد على مجرد ذكر ذات الموضوع والمحمول صار المحمول مسلوبا عن الموضوع. الصنف الثاني ما يسمى شرطيا متصلا كقولنا: إن كان العالم حادثا فله محدث، سمي شرطيا لأنه شرط وجود المقدم لوجود التالي بكلمة الشرط، وهو أن وإذا وما يقوم مقامهما. فقولنا: إن كان العالم حادثا يسمى مقدما،
وقولنا: فله محدث، يسمى تاليا، وهو الذي قرن به حرف الجزاء الموازي للشرط. والتالي يجري مجرى المحمول ولكن يفارق من وجه، وهو أن المحمول ربما يرجع في الحقيقة إلى نفس الموضوع، ولا يكون شيئا مفارقا له ولا متصلا به على سبيل اللزوم والتبعية، كقولنا الإنسان حيوان والحيوان محمول وليس مفارقا ولا ملازما تابعا. وأما قولنا فله محدث فهو شيء آخر لزم اتصاله وأقرانه بوصف الحدوث، لا إنه يرجع إلى نفس العالم والشرطية المتصلة إذا حللتها رجعت بعد حذف حرفي الجزاء والشرط منها إلى حمليتين، ثم ترجع كل حملية إلى محمول مفرد وموضوع مفرد، فالشرطية أكثر تركيبا لا محالة إذ لا تنحل في أول الأمر إلى البسائط، بل تنحل إلى الحمليات أولا ثم إلى البسائط ثانيا. ؟ الصنف الثالث: ما يسمى شرطيا منفصلا كقولنا العالم إما حادث وإما قديم، فهما قضيتان حمليتان جمعتا وجعلت إحداهما لازمة الإتصال ولأجله سمي منفصلا. والمتكلمون يسمون هذا سبرا وتقسيما. ثم هذا المنفصل قد يكون محصورا في جزئين كما ذكرنا، وقد يكون في ثلاثة أو أكثر كقولنا هذاالعدد إما مثل هذا العدد أو أقل أو أكثر، فهو مع كونه ذا ثلاثة محصور. وربما تكثر الأجزاء بحيث لا يكون داخلا في الحصر كقولنا هذا إما أسود أو أبيض وفلان إما بمكة أو ببغداد.
ثم ينقسم إلى ثلاثة أقسام الأول ما يمنع الجمع والخلو جميعا كقولنا العالم إما حادث أو قديم، فإنه يمنع إجتماع القدم والحدوث والخلو من أحدهما أي لا يجوز كلاهما، ويجب أحدهما لا محالة. والثاني ما يمنع الجمع دون الخلو. كما إذا قال قائل هذا حيوان وشجر، فتقول هو إما حيوان وإما شجر أي لا يجمتعان جميعا وإن جاز إن يخلو عنهما بأن يكون حمارا مثلا. والثالث: مايمنع الخلو ولا يمنع الجمع كما إذا أخذت بدل أحد الجزئين لازمه لا نفسه، بأن قلت مثلا إما أن يكون زيد في البحر وأما ألا يغرقن فإن هذا يمنع الخلو ولا يمنع الجمع إذ يجوز أن يكون في البحر ولا يغرق، ولا يجوز أن يخلو من أحد القسمين، وسببه أنك أخذت نفي الغرق الذي هو لازم كونه في البر وهو أعم منه، فإن الذي في البحر وإما أن يكون في البر، فكان يمتنع به الجمع والخلو جميعا، ولكن عدم الغرق لازم لكونه في البر ثم ليس مساويا بل هو أعم فلم يبعد أن يتناول كونه في البحر فيؤدي إلى الإجتماع. فهذه أمور متشابهة لا بد من تحقيق الفرق بينها، فلا معنى لنظر العقل إلا درك انقسام الأمور المتشابهة في الظاهر، ودرك إجتماع الأمور المفترقة في الظاهر، فإن الأشياء تختلف في أمور وتشترك في أمور، وإنما شأن العقل أن يميز بين مايشترك فيه وما يفترق فيه، وذلك بهذه التقسيمات التي نحن في سياقها، فهذا وجه قسمة القضايا باعتبار أجزائها في الحل والتركيب إلى أصنافها من الحمل والإتصال والإنفصال.
؟ القسمة الثانية للقضية باعتبار نسبة محمولها إلى موضوعها بنفي أو إثبات إعلم أن كل قضية من هذه الأصناف الثلاثة تنقسم إلى سالبة وموجبة، ونعني بهما النافية والمثبتة، فالإيجاب الحملي مثل قولنا الإنسان حيوان، ومعناه أن الشيء الذي نفرضه في الذهن إنسانا، سواء كان موجودا أو لم يكن موجودا، يجب أن نفرضه حيوانا ونحكم عليه بأنه حيوان من غير زيادة وقت وحال، بل على ما يعم الموقت ومقابله والمقيد ومقابله، بل قولنا إنه حيوان في كل حال أو حيوان في بعض الأحوال كلامان متصلان بزيادتين على مطلق قولنا أنه حيوان، هذا ما اللفظ صريح فيه وإن كان لا يبعد أن يسبق إلى الفهم العموم بحكم العادة، لا سيما إذا انضمت إليه قرينة حال الموضوع. وأما السلب الحملي فهو مثل قولنا الإنسان ليس بحيوان. وأما الإيجاب المتصل فهو مثل قولنا إن كان العالم حادثا فله محدث، والسلب ما يسلب هذا اللزوم، والإتصال كقولنا ليس إن كان العالم حادثا فله محدث. والإيجاب المنفصل مثل قولنا هذا العدد إمامساو لذلك العدد أو مفاوت له، والسلب ما يسلب هذا الإتصال وهو قولنا ليس هذا العدد إما مساويا لذلك العدد أو مفاوتا له.
ومقصود هذا التقسيم منع الخلو فالسلب له هوالذي يسلب منع الخلو ويشير إلى إمكانه. فإن قال قائل: قولنا زيد غير بصير سالبة أو موجبة؛ فإن كانت موجبة فما الفرق بينه وبين قولنا زيد ليس بصيرا؛ وإن كانت سالبة فما الفرق بينه وبين قولنا زيد ليس بصيرا؛ وإن كانت سالبة فما الفرق بينه وبين قولنا زيد أعمى وهي موجبة: ولا معنى لقولنا غير بصير إلا معنى هذا الإيجاب، ولذلك لا يتبين في الفارسية فرق بين قولنا: زيد كوراست " وبين قولنا " زيد نابيناست " وكذا قولنا " زيد نادانست " إذ المفهوم منه أنه جاهل والصيغة صيغة النفي. قلنا: هنا موضع مزلة قدم والإعتناء ببيانه واجب، فإن من لا يميز بين السالب والموجب كثر غلطه في البراهين، فإنا سنبين أن القياس لا ينتظم من مقدمتين سالبتين بل لا بد أن يكون إحداهما موجبة حتى ينتج. ومن القضايا ما صيغتها صيغة السلب ومعناها معنى الإيجاب فلا بد من تحقيقها؛ فنقول: قولنا زيد غير بصير قضية موجبة كترجمته بالفارسية، وكأن الغير مع البصير جعلا شيئا واحدا وعبر به عن الأعمى، فالغير بصير بجملته معنى واحدا يوجب مرة فيقال زيد غير بصير، ويسلب أخرى فيقال زيد ليس غير بصير، ولنخصص هذا الجنس من الموجبة باسم آخر، وهو المعدولة أو غير المحصلة وكأنها عدل بها عن قانونها فابرزت في صيغة سلب وهي إيجاب، وتصير حرف السلب مع المسلوب ككلمة واحدة كثير في الفارسية، مثل " نادان ونابينا وناتوان " بدل عن الأعمى والجاهل والعاجز. وإمارة كونها موجبة في الفارسية إنها تردف بصيغة الإثباتت، فيقال فلان: " نابيناست " وإذا سلبت قيل " بينانيست " فيكون الحكم بصيغة السلب، وكانت المطابقة بين اللفظ والمعنى في اللغة تقتضي ثلاثة ألفاظ في كل قضية: واحد للموضوع وواحد للمحمول، وواحد لربط المحمول بالموضوع كما في الفارسية، مثل " نادان ونابينا وناتوان " بدل عن الأعمى والجاهل والعاجز. وإمارة كونها موجبة في الفارسية إنها تردف بصيغة الإثبات، فيقال فلان " نابيناست "
وإذا سلبت قيل " بينانيست " فيكون الحكم بصيغة السلب، وكانت المطابقة بين اللفظ والمعنى في اللغة تقتضي ثلاثة ألفاظ في كل قضية: واحد للموضوع وواحد للمحمول، وواحد لربط المحمول بالموضوع كما في الفارسية، لكن في اللغة العربية اقتصر كثيرا على لفظين فقيل ملا زيد بصير، والأصل أن يقال زيد هو بصير بزيادة حرف الرابطة، فإذا قدم حرف الرابطة على غير فقيل زيد هو غير بصير، صار زيد من جانب موضوعا وغير بضير من جانب آخر محمولا، ولفظ هو متخلل بيهما رابطال لأحدهما بالآخر فيكون إيجابا؛ فإن أردت السلب قلت زيد ليس هو بين السلب والمحمول، وكذلك تقول زيد ليس هو غير بصير فتكون الرابطة قبل أجزاء المحمول متصلة به، فهذا وجه التنبيه على هذه الدقيقة. فإن قيل: فقولنا غير بصير وقولنا أعمى متساويان، أو أحدهما أعم من الآخر.
قلنا: هذا يختلف باللغات، وربما يظن أن قولنا غير بصير أعم حتى يصح أن يوصف به الجماد، وأما الأعمى فلا يمكن أن يوصف به إلا من يمكن أن يكون له البصر، وبيان ذلك محال على اللغة، فلا يخلط بالفن الذي نحن بصدده وإنما غرضنا تمييز السلب عن الإيجاب، فإن الإيجاب لا يمكن إلا على ثابت متمثل في وجود أو وهم. وأما النفي فيصح عن غير الثابت سواء كان كونه غير ثابت واجبا أو غير واجب. القسمة الثالثة للقضية باعتبار عموم موضعها أو خصوصه إعلم أن موضوع القضايا إما شخصي فتكون شخصية كقولنا زيد كاتب زيد ليس بكاتب، وإما كلي فتكون كلية، والكلية إما مهملة كقولنا الإنسان في خسر الإنسان في خسر. وسميناها مهملة لأنه لم يتبين فيها وجود المحمول لكية الموضوع أو لبعضه، وإما محصورة وهي التي بين فيها أن الحكم لكله كقولنا كل إنسان حيوان، أو ذكر إنه لبعضه كقولنا بعض الحيوان إنسان، فإذن القضية بهذا الإعتبار أربعة: شخصيةن ومهملة، ومحصورة كلية، ومحصورة جزئية.
والقضية تقسم إلى هذه الأقسام، سالبة كانت أو موجبة، شرطية كانت أو حملية، متصلة كانت الشرطية أو منفصلة، واللفظ الحاصر يسمى سورا كقولنا في الموجبة الكلية كل إنسان حيوان، وقولنا في الموجبة الجزئية بعض الحيوان إنسان، وكقولنا في السالبة الكلية لا واحد من الناس بحجر، وكقولنا في السالبة الجزئية ليس بعض الناس كاتبا، أو ليس كل إنسان كاتب، فإن فحواهما واحد. فإن قلت: فالألف واللام إذا كانتا للاستغراق فقول القائل الإنسان في خسر كلية فكيف سميناها مهملة؟ فاعلم أنه إن ثبت ذلك في لغة العرب وجب طلب المهمل من لغة أخرى، وإن لم يثبت فهو مهمل إذ يحتمل الكل ويحتمل الجزء، وتكون قوة المهمل قوة الجزئي لأنه بالضرورة يشتمل عليه. وأما العموم فمشكوك فيه، وليس من ضرورة ما يصدق جزئيا إلا يصدق كليا، فليحذر عن المهملات في الأقيسة إذا كان المطلوب منها نتيجة كلية، كما يقول الفقيه مثلا المكيل ربوي والجص مكيل
فكان ربويا، فيقال قولك المكيل مهمل، فإن أردت الكل فممنوع وإن أردت به الجزء فينتج أن بعض المكيل ربوي، فإذا قلت بعض المكيل ربوي والجص مكيل فكان ربويا، لم يلزمه النتيجة إذ يحتمل أن يكون من البعض الآخر الذي ليس بربوي. فإن قلت: فكيف يكون الحصر والإهمال في الشرطيات فافهم أنك مهما قلت كلما كان الشيء حادثا أو قديما، فقد حصرت الحصر الكلي الموجب. وإذا قلت ليس البتة إذا كان الشيء موجودا فهو في جهة وليس البتة إذا كان البيع صحيحا فهو لازم، فقد سلبت الإتصال وحصرت. وسائر نظائر هذا يمكنك قياسها عليه. القسمة الرابعة للقضية باعتبار جهة نسبة المحمول إلى الموضوع بالوجوب أو الجواز أو الإمتناع إعلم أن المحمول في القضية لا يخلو إما أن تكون نسبته إلى الموضوع نسبة الضروري الوجود في نفس الأمر، كقولك
الإنسان حيوان، فإن الحيوان محمول على الإنسان ونسبته إليه نسبة الضروري الوجود، وأما أن يكون نسبته إليه نسبة الضروري العدم كقولنا الإنسان حجر فإن الحجرية محمولة، ونسبتها إلى الإنسان نسبة الضروري العد، وأما ألا يكون ضروريا لا وجوده ولا عدمه كقولنا الإنسان كاتب الإنسان ليس بكاتب، ولنسم هذه النسبة مادة الحمل، فالمادة ثلاثة: الوجوب والإمكان والإمتناع. والقضية بهذا الإعتبار أما مطلقة وإما مقيدة، والمقيدة ما نص فيها بأن المحمول للموضوع ضروري أو ممكن أو موجود على الدوام لا بالضرورة. والمطلق ما لم يتعرض فيه إلى شيء من ذلك، فإن هذه الأمور زائدة على ما يقتضيه مجرد الحمل، والقضية الضرورية تنقسم إلى ما لا شرط فيه كقولنا الله حي، فإنه لم يزل ولا يزال كذلك، وإلى ما شرط فيه وجود الموضوع كقولنا الإنسان حي، فإنه ما دام موجودا فهو كذلك، فوجود الموضوع مشروط فيه ولا يفارق هذا المشروط الضروري الأول في جهة الضرورة، وإنما يفارق في دوام الموضوع لذاته أزلا وأبدا ووجوب وجوده لنفس حقيقته، ولنسم هذا بالضروري المطلق. فأما الضروري المشروط فثلاثة: الأول ما يشترط فيه دوام وجود الموضوع ما تقدم.
الثاني ما شرط فيه دوام كون الموضوع موصوفا بعنوانه كقولنا كل متحرك متغير، فإنه متغير ما دام متحركا لا مادام ذات المتحرك موجودا فحسب. والفرق بين هذا وبين قولنا الإنسان حي إن الشرط في ذات الإنسان، والشرط ههنا ليس هو ذات المتحرك فقط، بل ذات المتحرك بصفة تلحق الذات وهو وهو كونه متحركا فإن المتحرك له ذات وجوهر من كونه فرسا أو سماء أو ما شئت أن تسميه ويلحقه إنه متحرك، وذاك الذات هو غير المتحرك، وليس الإنسان كذلك. الثالث ما يشترط فيه وقت مخصوص إما معين أو غير معين، فإن قولنا القمر بالضرورة منخسف مقيد بوقت معين، وهو وقت وقوعه في ظل الأرض محجوبا بذلك عن ضوء الشمس، وقولنا الإنسان بالضرورة متنفس فمعناه أنه في بعض الأوقات، وذلك الوقت غير متعين. فإن قال قائل: وهل يتصور دائم غير ضروري؟ قلنا: نعم. أما في الأشخاص فظاهر كالزنجي، فإنك قد تقول أنه أسود البشرة ما دام موجود البشرة وليس السواد لبشرته ضروريا ولكنه قد اتفق وجوده لها على الدوام، ولنسم هذه القضية وجودية. وأما في الكليات فكقولنا كل كوكب إما شارق أو غارب،
فإنه في كل ساعة كذلك وليس ذلك ضروريا في وجود ذاته إذ ليس كالحيوان للإنسان، فافهم. القسمة الخامسة للقضية باعتبار نقيضها إعلم أن فهم النقيض في القضية تمس إليه الحاجة في النظر، فربما لا يدل البرهان على شيء ولكن يدل على إبطال نقيضه، فيكون كأنه قد دل عليهي. وربما يوضع في مقدمات القياس شيء فلا يعرف وجه دلالته، ما لم يرد إلى نقيضه، فإذا لم يكن النقيض معلوما لم تحصل هذه الفوائد، وربما يظن أن معرفة ذلك ظاهرة وليس كذلك، فإن التساهل فيه مثار الغلط في أكثر النظريات. والقضيتان المتناقضتان هما المختلفتان بالإيجاب والسلب، على وجه يقتضي لذاته أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة، فإنا إذا قلنا العالم حادث وكان صادقا كان قولنا العالم ليس بحادث كاذبا، وكذا قولنا قديم إذا عنينا بالقديم نفي الحادث؛ فمهما دلننا على أحدهما فقد دللنا على الآخر، ومهما قلنا أحدهما فكأنا قد قلنا الآخر،
فهما متلازمان على هذا الوجه ولكن للتناقض شروط ثمانية، فإذا لم تراع الشروط لم يحصل التناقض: الأول أن تكون إحدى القضيتين سالبة والأخرى موجبة، كقولنا العالم حادث، العالم ليس بحادث، فإنا إن قلنا العالم حادث العالم حادث، فلا يتناقضان. الثاني: أن يكون موضوع المقدمتين واحدا فإذا تعدد لم يتناقضا، كقولنا العالم حادث والباري ليس بحادث، فإنهما لا يتناقضان وإنما يشكل هذا في لفظ مشترك، فإنا نقول العين أصفر، العين ليس بأصفر، ونريد بأحدهما الدينار وبالآخر العضو الباصر. ونقول في الفقه: " الصغيرة مولى عليها في بعضها " الصغيرة ليس مولى عليها في بعضها ونريد بإحداهما الثيب وبالأخرى البكر على منهاج إرادة الخاص بالعام، ويكون الموضوع متعددا فلا يحصل التناقض. الثالث: أن يكون المحمول واحدا، فإن قولنا الإنسان مخلوق، الإنسان ليس بحجر لا يتناقضات، ويشكل ذلك في المحمول المشترك، كقولنا المكره على القتل مختار والمكره على القتل ليس بمختار ولكنه مضطر، ولا يتناقضان فإن المختار يطلق على معنيين مختلفين فهو مشترك، فقد يراد به القادر على الترك وقد يراد به الذي يقدم على الشيء لشهوته وانبعاث داعية من ذاته. ومهما كان اللفظ مشتركا كان الموضوع أو المحمول أكثر من واحد
في الحقيقة، وفي الظاهر يظن أنه واحد، والعبرة للحقيقة لا لظاهر اللفظ. الرابع: ألا يكون المحمول في جزئين مختلفين من الموضوع كقولنا النوبي أبيض، النوبي ليس بأبيض أي هو أبيض الأسنان وليس بأبيض البشرة. وفي الفقه نقول " السارق مقطوع ليس بمقطوع " أي مقطوع اليد ليس بمقطوع الرجل والأنف. الخامس: ألا يختلف ما إليه الإضافة في المضافات، كقولنا الأربعة نصف الأربعة ليست نصفا أي هي نصف الثمانية وليست نصف العشرة، فلا تناقض. وكذلك قولنا زيد أب زيد ليس بأب، أي أب لعمرو، وليس بأب لخالد. وفي الفقه نقول " المرأة مولى عليها المرأة ليس مولى عليها " أي مولى عليها في البضع لا في المال، وقد يضاف إلى البضع كلاهما ولا تناقض من جهة اشتراك لفظ المحمول، فإن أبا حنيفة يقول: مولى عليها إذ يتولى الولي نكاحها شرعا استحبابا أو إيجابا، وليس مولى عليها أي تستقل بنفسها ولا تجبر على العقد. وهذه المعاني يجب مراعاتها لا للنقيض فقط، ولكن لجميع أنواع القياس أيضا. وعلى ذلك فقول بعض فقهاء الشافعية: المرأة مولى عليها فلا تلي أمر نفسها، نتيجة غير لازمة فإن أبا حنيفة يقول:
قولكم أنها مولى عليها أن أردتم به أنها لا تلي أمر نفسها أو الولي يجبرها، فهذا عين المطلوب في محل النزاع، فجعله مقدمة في القياس مصادرة وأن أريد به أن الولي يتولى عقدها استحبابا او إيجابا، فلا يلزم من هذا إلا ينعقد عقدها إذا تعاطته على خلاف الإستحباب. السادس ألا يكون نسبة المحمول إلى الموضوع على جهتين مختلفتين، كقولنا الماء في الكوز مرو مطهر وليس بمرو ولا مطهر، ونريد أنه مرو بالقوة وليس بمرو بالفعل، ولإختلاف جهة الحمل لم يتناقض الحكمان ومن ذلك قوله تعالى: (وَما رَميتَ إِذ رَمَيتَ وَلَكِنَّ الله رَمَى) وهو نفي للرمي وإثبات له، ولكن ليست جهة النفي جهة الإثبات فلم يتناقضا، وهذا أيضا مما يغلط كثيرا في الفقهيات. السابع: ألا يكون في زمانين مختلفة كقولنا الصبي له أسنان، ونعني به بعد الفطام، والصبي لا أسنان له ونعني به في أول الأمر. ونقول في الفقه: الخمر كانت حراما، نعني به في الأعصار السابقة، وكانت حلالا، ونعني به قبل نزول التحريم. وبالجملة ينبغي ألا تخالف إحدى القضيتين الأخرى إلا في الكيف فقط، فتسلب إحداهما ما أوجبته الأخرى على الوجه الذي أوجبته. وعن الموضوع الذي وضعه بعينه على ذلك النحو وفي ذلك الوقت
وبتلك الجهة فإذا ذاك يقتسمان الصدق والكذب، فإن تخلف شرط جاز أن يشتركا في الصدق أو في الكذب. الثامن: وهذا في القضية التي موضوعها كلي على الخصوص، فإنه يزيد في التي موضوعها كلي أن يختلف القضيتان بالجزئية والكلية مع الإختلاف في السلب والإيجاب، حتى يلزم التناقض لا محالة، وإلا أمكن أن يصدقا جميعا كالجزئيتين في مادة الإمكان مثل قولنا بعض الناس كاتب بعض الناس ليس بكاتب، وربما كذبتا جميعا كالكليتين في مادة الإمكان كقولنا كل إنسان كاتب وليس واحد من الناس كاتبا؛ فالتناقض إنما يتم في المحصورات بعد الشروط التي ذكرناها إن كانت إحدى القضيتين كلية والأخرى جزئيتين في مادة الإمكان مثل قولنا بعض الناس كاتب بعض الناس ليس بكاتب، وربما كذبتا جميعا كالكليتين في مادة الإمكان كقولنا كل إنسان كاتب وليس واحد من الناس كاتبا؛ فالتناقض إنما يتم في المحصورات بعد الشروط التي ذكرناها إن كانت إحدى القضيتين كلية والأخرى جزئية، ليكون تناقضها ضروريا ولنمتحن المواد كلها ولنضع الموجبة أولا كلية فنقول: كل إنسان حيوان، ليس بعض الناس بحيوان؛ كل إنسان كاتب، ليس بعض الناس بكاتب؛ كل إنسان حجر، ليس بعض الناس بحجر؛ فنجد لا محالة إحدى القضيتين صادقة والأخرى كاذبة. ولنمتحن السالبة الكلية فنقول: ليس واحد من الناس حيوانا، بعض الناس حيوان؛ ليس واحد من الناس بحجر، بعض الناس حجر؛ ليس واحد من الناس بحجر، بعض الناس حجر؛ ليس واحد من الناس بكاتب، بعض الناس كاتب؛ فبالضرورة يقتسمان الصدق والكذب في جميع المواد. فإن قيل: فالكليتان في مادة الوجوب والإمتناع أيضا يقتسمان الصدق والكذب
قلنا: نعم ولكن لا يعرف ذلك إلا بعد معرفة نسبة المحمول إلى الموضوع إنه ضروري أم لا. وإذا راعيت الشرط الذي ذكرناه علمت التناقض قطعا، وإن لم تعرف تلك النسبة فإنه كيفما كان الأمر يلزم التناقض. القسمة السادسة للقضية باعتبار عكسها إعلم أنا نعني بالعكس إن يجعل المحمول من القضية موضوعا والموضوع محمولا مع حفظ الكيفية وبقاء الصدق بحاله، فإن لم يبق الصدق سمي إنقلابا لا إنعكاسا والقضايا في عنصرها أربعة: الأولى السالبة الكلية وتنعكس مثل نفسها بالضرورة فإنك تقول لا إنسان واحد طائر ويلزم أنه لا طائر واحد إنسان، ونقول لا طاعة واحدة معصية فيلزم أنه لا معصية واحدة طاعة، ولزوم هذا ظاهر ولكن تحريره إنه إن لم يلزم أنه لا طائر واحد إنسان، فإنما لا يلزم لأنه يمكن أن يكون بعض الطائر إنسانا، فإن أمكن ذلك بطل قولنا
لا إنسان واحد طائر لأن ذلك الطائر يكون إنسانا، فيكون ذلك الإنسان طائرا فيرتفع الصدق من قولنا لا إنسان واحد طائر، وقد وضعتها صادقة. والثانية الموجبة الكلية وتنعكس موجبة جزئية، فقولنا كل لإنسان حيوان ينعكس إلى أن بعض الحيوان إنسان، ولا ينعكس كليا لأن المحمول وهو الحيوان يمكن أن يكون أعم من الموضوع، فيفضل طرف منه عن الموضوع الذي هو الإنسان في مثالنا، فلا يمكن أن يقال كل حيوان إنسان إذ من الحيوانات غير الإنسان كالفرس ونحوه من سائر الأنواع الأخرى. والثالثة السالبة الجزئية، وهي لا تنعكس أصلا، فإنا نقول حيوان ما ليس بإنسان فهو صادق وعكسه إنسان ما ليس بحيوان غير صادق، ولا قولنا كل إنسان ليس بحيوان يصح أن يكون عكسا لهذه، فلا تنعكس لا إلى كلية ولا إلى جزئية. والرابعة الموجبة الجزئية
وتنعكس مثل نفسها أعني موجبة جزئية، فقولنا بعض الناس كاتب يلزم منه أن بعض الكاتب إنسان. فإن قلت: إنه يلزم منه إن كل كاتب إنسان؛ فاعلم إن ذلك ليس يلزم من الإيجاب الجزئي من حيث أنه إيجاب جزئي، بل من حيث عرفت من خارج إنه لا كاتب سوى الإنسان، وإلا فمن الموجبة الجزئية مالا يصدق انعكاسه كليا إذ تقول بعض الإنسان أبيض ولا يمكنك أن تقول كل أبيض إنسان، بل اللازم بعض الأبيض إنسان ولأجل كون الأمثلة مغلطة في ذلك عدل المنطقيون من الأمثلة المكشوفة إلى المبهمات وأعلموها بالحروف المعجمة وجعلوا المحمول معرفا بالباء والموضوع بالألف، وقالوا كل " اب " أي هما شيئان مبهمان مختلفان سميناهما بهذين الإسمين، فيلزم منه بعض (ب ا) فقولنا لا شيء من (اب) يلزم منه بعض (ب أ) وإيضاح ذلك بين فلسنا نطنب. وإنما افتقرنا إلى معرفة العكس، فإن
بعض المقاييس يظهر وجه انتاجها بالعكس، وربما ينتج القياس شيئا ومطلوبنا عكسه، فيستبين بهذا أنه مهما أنتج القياس لنا سالبة كلية فقد أنتج أيضا عكسها، وكذا في سائر الأقسام، والله أعلم بالصواب.
كتاب القياس إعلم انا إذا فرغنا من مقدمات القياس وهو بيان المعاني المفردة ووجوه دلالة الألفاظ عليها، وكيفية تأليف المعاني بالتركيب الخبري المشتمل على الموضوع والمحمول المسمة قضية وأحكامها وأقسامها، فجدير بنا أن نخوض في بيان القياس فإنه التركيب الثاني، لأنه نظر في تركيب القضايا ليصير قياسا كما كان الأول نظرا في تركيب المعاني ليصير قضية. وهذا هوالتركيب الواجب في المركبات. فباني البيت ينبغي له أن يعى أولا للجمع بين المفردات اعني الماء والتراب والتبن، فيجمعها على شكل مخصوص ليصير لبنا ثم يجمع اللبنات فيركبها والتبن، فيجمعها على شكل مخصوص ليصير لبنا ثم يجمع اللبنات فيركبها تركيبا ثانيا؛ كذلك ينبغي أن يكون صنيع الناظر في كل مركب، وكما أن اللبن لا يصير لبنا إلا بمادة وصورة، المادة التراب وما فيه، والصورة هو التربيع الحاصل بحصره في قالبه، كذلك القياس المركب له مادة وصورة، الحاصل بحصره في قالبه، المادة التراب وما فيه، والصورة هو الرتبيع الحاصل بحصره في قالبه، كذلك القياس المركب له مادة وصورة، المادة هي المقدمات اليقينية الصادقة فلا بد من طلبها ومعرفة مداركها، والصورة هي تأليف المقدمات على نوع من الترتيب مخصوص ولا بد من معرفته؛ فانقسم النظر فيه إلى أربعة فنون: المادة والصورة والمغلطات في القياس، وفصول متفرقة هي من اللواحق.
النظر الأول في صورة القياس والقياس أحد أنواع الحجج، والحجة هي التي يؤتى بها في إثبات ما تمس الحاجة إلى إثباته من العلوم التصديقية، وهي ثلاثة أقسام: قياس وإستقراء وتمثيل. والقياس أربعة أنواع: حملي وشرطي متصل وشرطي منفصل وقياس خلف، ولنسم الجميع أصناف الحجة. وحد القياس أنه قول مؤلف إذا سلم ما أورد فيه من القضايا لزم عنه لذاته قول آخر إضطرارا وإذا أوردت القضايا في الحجة سميت عند ذلك مقدمات. وتسمى قضايا قبل الوضع كما أن القول اللازم عنه يسمى قبل اللزوم مطلوبا وبعد اللزوم نتيجة. وليس من شرط في أن يسمى قياسا أن يكون مسلم القضايا بل من شرطه أن يكون بحيث إذا سلمت قضاياه لزم منها النتيجة، وربما تكون القضايا غير واجبة التسليم ونحن نسميه قياسا لكوه بحيث لو سلم للزمت النتيجة، وربما تكون القضايا غير واجبة التسليم ونحن نسميه قياسا لكونه بحيث لو سلم للزمت النتيجة. فلنبدأ بالحملي من أنواع القياس والحجج. الصنف الأول القياس الحملي الذي قد يسمى قياسا اقترانيا وقد يسمى جزميا وهو مركب من مقدمتين مثل قولنا
كل جسم مؤلف، وكل مؤلف محدث فيلزم منه أن كل جسم محدث؛ فهذا القياس مركب من مقدمتين وكل مقدمة تشتمل على موضوع ومحمول، فيكون مجموع الآحاد التي تنحل إليه هذه المقدمات أربعة، إلا أن واحدا منها يتكرر، فالمجموع إذن ثلاثة وهو أقل ما ينحل إليه قياس، إذ أقل مايلتئم منه القياس مقدمتان، وأقل ما ينتظم منه المقدمة معنيان: أحدهما موضوع والآخر محمول. ولا بد أن يكون واحد مكررا مشتركا في المقدمتين، فإنه إن لم يكن كذلك تباينت المقدمتان ولم تتكلم في المقدمة الثانية عن الجسم ولا عن المؤلف، بل قلت مثلا كل إنسان حيوان لم تلزم نتيجة من المقدمتين. فإذا عرفت انقسام كل قياس إلى ثلاثة أمور مفردة فاعلم أن هذه المفردات تسمى حدودا، ولكل واحد من الحدود الثلاث إسم مفرد ليتميز عن غيره. أما الحد المشترك فيسمى الحد الأوسط، وأما الآخران فيسمى أحدهما الحد الأكبر والآخر الأصغر. والأصغر هو الذي يكون موضوعا في النتيجة، والأكبر هو الذي يكون محمولا فيها. وإنما سمي أكبر لأنه يمكن أن يكون أعم من الموضوع وإن أمكن أن يكون مساويا. وأما الموضوع فلا يتصور أن يكون أعم من المحمول، وإذا وضع كذلك كان الحكم كاذبا كقولك كل حيوان إنسان، فإنه كاذب وعكسه صادق.
ثم لما مست الحاجة إلى تعريف المقدمتين باسمين ولم يمكن أن يشتق إسمهما من الحد الأوسط، والجسم هو الأصغر، والمحدث هو الحد الأكبر. وقولنا كل جسم مؤلف هي المقدمة الصغرى، وقولنا كل مؤلف محدث هي المقدمة الكبرى، واللازم عنه هو التقاء الحدين الواقعين على الطرفين وهو المطلوب أولا والنتيجة آخرا، وهو قولنا فكل جسم محدث؛ ومثاله من الفقه: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، فكل مسكر حرام، فالمسكر والخمر والحرام حدود القياس، والخمر هو الحد الأوسط،
والمسكر هوالحد الأصغر، والحرام هوالحد الأكبر. وقولنا كل خمر حرام هي المقدمة الكبرى، فهذه قسمة للقياس باعتبار أجزائه المفردة. القسمة الثانية لهذا القياس باعتبار كيفية وضع الحد الأوسط عند الطرفين الآخرين وهذه الكيفية تسمى شكلا. والحد الأوسط إما أن يكون محمولا في إحدى المقدمتين موضوعا في الأخرى كما أوردناه من المثال، فيسمى شكلا أولا، وإما أن يكون محمولا في المقدمتين جميعا ويسمى الشكل الثاني، وإما أن يكون موضوعا فيهما ويسمى الشكل الثالث. الشكل الأول مثاله ما أوردناه، وحصول النتيجة منه بين، وحاصله يرجع إلى أن الحكم علىالمحمول حكم على الموضوع بالضرورة، فمهما حكم على الجسم بالمؤلف فكل حكم يثبت للمؤلف فقد ثبت لا محالة للجسم، فإن الجسم داخل في المؤلف،
وإذا ثبت الحكم بالحدوث على المؤلف فقد ثبت بالضرورة على الجسم. وإنما احتيج إلى هذا من حيث أن الحكم بالحدوث على الجسم قد لا يكون بينا بنفسه، ولكن يكون الحكم به على المؤلف بيتنا بنفسه والحكم بالمؤلف على الجسم أيضا بينا، فيتعدى الحكم الذي ليس بينا للجسم إليه بواسطة المؤلف الذي هو بين له، فيكون الوسط سبب التقاء الطرفين وهو تعدي الحكم إلى المحكوم عليه. ومهما عرفت أن الحكم على المحمول حكم على الموضوع، فلا فرق بين أن يكون الموضوع جزئيا أو كليا، ولا أن يكون المحمول سالبا أو موجبا، فإنك لو أبدلت قولك كل جسم مؤلف بقولك بعض الموجود مؤلف لزم من قياسك أن بعض الموجود محدث. ولو أبدلت قولك كل مؤلف محدث بقولك كل مؤلف محدث ليس بأزلي، تعدى نفي الأزلية أيضا إلى موضوع المؤلف، كما تعدى إثبات الحدوث من غير فرق؛ فيكون المنتج من هذا الشكل بحسب هذا الإعتبار أربع تركيبات:؟؟ الأول موجبتان كليتان كما سبق. الثاني جوجبتان والصغرى جزئية، كما إذا أبدلت قولك كل جسم مؤلف بقولك بعض الموجودات مؤلف.
الثالث موجبة كلية صغرى وسالبة كلية كبرى، وهو أن تبدل قولك محدث بقولك ليس بأزلي. الرابع موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى وهو أن تبدل الصغرى بالجزئية والكبرى بالسالبة، فتقول مثلا موجود ما مؤلف ولا مؤلف واحد أزلي. فأما ما عدا هذه التركيبات فلا تنتج أصلا لأنك إن فرضت سالبتين فقط لا ينتظم منهما قياس، لأن الحد الأوسط إذا سلبته عن شيء فالحكم عليه بالنفي أو بالإثبات لا يتعدى إلى المسلوب عنه، لأن السلب أوجب المباينة والثابت على المسلوب لا يتعدى إلى المسلوب عنه، فإنك إن قلت لا إنسان واحد حجر ولا حجر واحد طائر فلا إنسان واحد طائر، فيرى هذه النتيجة صادقة، وليس صدقها لازما عن هذا القياس فإنك لو قلت لا إنسان واحد بياض ولا بياض واحد حيوان فلا إنسان واحد حيوان، لم تكن النتيجة صادقة. والشكل هو ذلك الشكل بعينه،
ولكن إذا سلبت الإتصال بين البياض والإنسان - لا أن بين الأبيض والإنسان مباينة - فالحكم على البياض لا يتعدى إلى الإنسان بحال، فإذن لا بد أن يكون في كل قياس موجبة أو ما في حكمها وإن كانت الصيغة صيغة السلب مثلا. ولكن في هذا الشكل على الخصوص يشترك أن تكون الصغرى موجبة ليثبت الحد الأوسط للأصغر، فيكون الحكم على الأوسط حكما على الأصغر، ويجب أن تكون الكبرى كلية حتى ينطوي تحت الأكبر الحد الأصغر لعمومه جميع ما يدخل في الأوسط، فإنك إذا قلت كل إنسان حيوان وبعض الحيوان فرس، فلا يلزم أن يكون كل إنسان فرس، بل إن حكمت على الحيوان بحكم كلي ككونه جسما فقلت وكل حيوان جسم، تعدى ذلك إلى الأصغر وهو الإنسان. ولما كانت الأمثلة المفصلة ربما غلطت الناظر عدل المنطقيون إلى وضع المعاني المختلفة المبهمة، وعبروا عنها بالحروف المعجمة ووضعوا بدل الجسم والمؤلف المحدث في المثال الذي أوردناه الألف والباء والجيم، وهي أوائل حروف أبجد، ووضعوا الجيم الذي هو الثالث حدا أصغر محكوما عليه، والباء حدا اوسط يحكم به على الجيم، والألف حدا أكبر يحكم به على الباء ليتعدى إلى الجيم فقالوا: كل ج ب وكل (ب ا) فكل جيم ألف،
وكذا سائر الضروب. وأنت إذا أحطت بالمعاني التي حصلناها لم تعجز عن ضرب المثال من الفقهيات والعقليات المفصلة أو المبهمة. ؟ الشكل الثاني وهو ما كان الحد الأوسط فيه محمولا على الطرفين، لكن إنما ينتج إذا كان محمولا على أحدهما بالسلب وعلى الآخر بالإيجاب، فيشترط اختلاف المقدمتين في الكيفية أعني في السلب والإيجاب ثم لا تكون النتيجة إلا سالبة، وإذا تحقق ذلك فوجه إنتاجه إنك إذا وجدت شيئين ثم وجدت شيئا ثالثا محمولا على أحد الشيشئين بالإيجاب وعلى الآخر بالسلب، فيعلم التباين بين الشيئين بالضرورة، فإنهما لو لم يتباينا لكان يكون أحدهما محمولا على الآخر ولكان الحكم على المحمول حكما على الموضوع، كما سبق في الشكل الآخر، فإذن كل شيئين هذا صفتهما فهما متباينان أي يسلب هذا عن ذاك وذاك عن هذا؛ وتنتظم في هذا الشكل أيضا أربع تركيبات: الأول أن تقول كل جسم مؤلف كما سبق في الأول، ولكن تعكس المقدمة الثانية السالبة من ذلك الشكل، فتقول ولا أزلي واحد مؤلف بدل قولك
ولا مؤلف واحد أزلين فيلزم ما لزم منه لأنا قد قدمنا أن السالبة الكلية تنعكس كنفسها، فلا فرق بين قولك لا مؤلف واحد أزلي، فيلزم ما لزم منه لأنا قد قدمنا أن السالبة الكلية تنعكس كنفسها، فلا فرق بين قولك لا مؤلف واحد أزلي، وهو المذكور في الشكل الأول، وبين قولك ولا أزلي واحد مؤلف، فينتج هذا أنه لا جسم واحد أزلي ومحصله المباينة بين الجسم والأزلي، إذ وجد المؤلف محمولا على أحدهما مسلوبا على الآخر، فدل ذلك على التباين بالطريق الذي ذكرناه مجملا. وتفصيله أن تنعكس المقدمة الكبرى فيرجع إلى الشكل الأول، وإنما سميت هذه مقاييس الشكل الثاني لأنه يحتاج في بيانها إلى الرد للشكل الأول. الضرب الثاني هذا هو بعينه ولكن المقدمة الصغرى جزئية، وهو قولك موجود ما مؤلف ولا أزلي واحد مؤلف، فإذن موجود ما ليس بأزلي وبيانه بعكس المقدمة الكبرى كما سبق. وأما الثالث والرابع فإن تكون الصغرى سالبة إما جزئية وإما كلية وتكون الكبرى موجبة، ولا يمكن تفهيم ذلك بما ضربناه مثلا للشكل الأول إذ لم تكن فيه مقدمة صغرى إلا موجبة، إذ كان هذا شرطا في ذلك الشكل فنغير المثال ونقول:
مثال الضرب الثالث قولك: لا جسم واحد منفك عن الأعراض وكل أزلي منفك عن الأعراض، فإذن لا جسم واحد أزلي فالقياس مؤلف من كليتين صغراهما سالبة وكبراهما موجبة، والنتيجة سالبة كلية والحد الأوسط هو المنفك عن الأعراض، فإنه محمول على الجسم بالسلب وعلى الأزلي بالإيجاب، فأوجب التباين وبيانه بعكس الصغرى فإنها سالبة كلية تنعكس مثل نفسها، وإذا عكست صار المحمول موضوعا وعاد إلى الشكل الأول الذي الحد المشترك فيه موضوع لإحدى المقدمتين محمول للأخرى. الضرب الرابع هو الثالث بعينه لكن الصغرى سالبة جزئية كقولك: موجود ما ليس بجسم وكل متحرك جسم، فبعض الموجودات ليس بمتحرك. ولما كانت السالبة جزئية وهي لا تنعكس لم يمكن أن يرد هذا الضرب إلى الأول بطريق العكس، لكن يرد بطريق الإفتراض، وهو أن تحول هذا الجزئي كليا فإذا كان موجود ما ليس بجسم فقد حصل أن بعض الموجودات ليس بجسم، فلنفرضه سوادا مثلا فنقول
كل سواد ليس بجسم فيصير كالضرب الثالث من هذا الشكل، وكان قد رجع الثالث إلى الشكل الأول بالعكس، فكذا هذا فالمنتج إذن من هذا الشكل هذه التركيبات الأربع وما عداها فلا، إذ لا ينتج سالبتان ولا موجبتان في هذا الشكل ينتجان لأن كل شيئين وجد شيء واحد محمولا عليهما لم يوجب ذلك بينهما، لا إتصالا ولا تباينا، إذ الحيوان يوجد محمولا على الفرس والإنسان، ولا يوجب كون الإنسان فرسا وهو الإتصال. ويوجد محمولا على الكاتب والإنسان ولا يوجب بينهما تباينا حتى لا يكون الإنسان كاتبا والكاتب إنسانا، فإذن لهذا الشكل شرطان: أحدهما أن يختلفا أعني المقدمتين في الكيفية، والآخر أن تكون الكبرى كلية كما في الشكل الأول. ؟؟ الشكل الثالث هو أن يكون الحد المشترك موضوعا في المقدمتين وهذا يوجب نتيجة جزئية، فإنك مهما وجدت شيئا واحدا ثم وجدا شيئين كليهما يحملان على ذلك الشيء الواحد، فبين المحمولين اتصال والتقاء لا محالة على ذلك الواحد، فيمكن لا محالة أن يحمل كل واحد منهما على بعض الآخر بكل حال إن لم يمكن حمله على كله، فلذلك كانت النتيجة جزئية، فإنك حال إن لم يمكن حمله على كله،
فلذلك كانت النتيجة جزئية، فإنك مهما وجدت إنسانا ما وهو شيء واحد، يحمل عليه الجسم والكاتب فإنك مهما وجدت إنسانا ما هو شيء واحد يحمل عليه الجسم والكاتب دل ذلك على أن بين الجسم والكاتب اتصال، حتى يمكن أن يقال لبعض الأجسام كاتب ولبعض الكاتب جسم. وإن كان الكل كذلك ولكن الجزئية لازمة بكل حال وهذا طريق كاف في التفهيم، ولكن نتبع العادة في التفصيل ببيان الأضرب والتعريف بوجه لزوم النتيجة بالرد إلى الشكل الأول، وينتظم في هذا الشكل ستة أضرب منتجة: الضرب الأول من موجبتين كليتين كقولك كل متحرك جسم وكل متحرك محدث، فبعض الجسم بالضرورة محدث، وبيانه بعكس الصغرى فانها تنعكس جزئية ويصير قولنا كل متحرك محدث فيلزم بعض الجسم محدث لرجوعه إلى الشكل الأول، فإنه مهما عكست مقدمة واحدة صار الموضوع محمولا، وقد كان موضوعا للمقدمة الثانية، فيصير الحد الأوسط
محمولا لاحداهما موضوعا للأخرى. الضرب الثاني من كليتين كبراهما سالبة كقولك كل أزلي فاعل ولا أزلي واحد جسم، فيلزم منه ليس كل فاعل جسما لأنه يرجع إلى الأول بعكس الصغرى، وتلزم منه هذه النتيجة بعينها فتقول فاعل ما أزلي ولا أزلي واحد جسم فليس كل فاعل جسما. الضرب الثالث موجبتان صغراهما جزئية ينتج موجبة جزئية، كقولك جسم ما فاعل وكل جسم مؤلف فيلزم فاعل ما مؤلف، وبيانه بعكس الصغرى وضم العكس إلى الكبرى، فيرتد إلى الشكل الأول وتلزم النتيجة، إذ تقول فاعل ما جسم وكل جسم مؤلف فيلزم فاعل ما مؤلف.
الضرب الرابع موجبتان والكبرى جزئية ينتج موجبة جزئية، مثاله كل جسم محدث وجسم ما متحرك، فيلزم محدث ما متحرك وذلك بعكس الكبرى وجعلها صغرى، فيرجع إلى الأول ثم عكس النتيجة ليخرج لنا عين نتيجتنا، فتقول متحرك ما جسم وكل جسم محدث، فيلزم أن متحركا ما محدث وتنعكس إلى عين النتيجة الأولى وهي محدث ما متحرك، فهذا قد تبين لك أنه إنما يحقق بعكسين أحدهما عكس المقدمة والآخر عكس النتيجة. الضرب الخامس يأتلف من مقدمتين مختلفتين في الكمية والكيفية جميعا صغراهما موجبة جزئية وكبراهما سالبة كلية ينتج جزئية سالبة، ومثاله قولك جسم ما فاعل ولا جسم واحد أزلي، فيلزم ليس كل فاعل أزليا
لأن الصغرى تنعكس إلى قولك فاعل ما جسم، فتضم إلى الكبرى القائلة ولا جسم واحد أزلي فتلزم هذه النتيجة بعينها من الشكل الأول البين بنفسه. الضرب السادس من مقدمتين مختلفتين أيضا في الكمية. والكيفية، صغراهما كلية موجبة وكبراهما سالبة جزئية، مثاله كل جسم محدث وجسم ما ليس بمتحرك، فيلزم محدث ما ليس بمتحرك ولا يمكن بيانه بالعكس؛ لأن الجزئية السالبة لا تنعكس والكلية الموجبة إذا انعكست صارت جزئية، ولا قياس من جزئيتين، فبيانه ليرجع إلى الشكل الأول بتحويل الجزئية إلى كلية بالإفتراض، بأن نفرض ذلك البعض الذي ليس بمتحرك أعني بعض الجسم جبلا، ونقول لا جبل واحد متحرك، وينضاف إليه كل جبل جسم وهو صدق الوصف العنواني على ذات الموضوع، فتأخذ هذه صغرى وتضيف إليها صغرى هذا الضرب، هكذا:
كل جبل جسم وكل جسم محدث، فيلزم كل جبل محدث من أول الأول. ثم تضم هذه النتيجة إلى أولى قضيتي الإفتراض، أعني قولك لا جبل واحد متحرك لينتج من الضرب الثاني من هذا الشكل أن بعض المحدث ليس بمتحرك، وقد ذكرنا أنه يرجع إلى الشكل الأول بعكس الصغرى، فيكون هذا الضرب السادس إنما يرجع إلى الشكل الأول بمرتبتين، فهذه مقاييس هذا الشكل، وله شرطان: أحدهما أن تكون الصغرى موجبة أو في حكمها. والآخر أن تكون إحداهما كلية أيهما كانت، إذ لا ينتظم قياس من جزئيتين على الإطلاق، فإذن المنتج من التأليفات أربعة عشر تأليفا: أربعة من الشكل الأول، وأربعة من الثاني، وستة من الثالث، وذلك بعد إسقاط المهملات فإنها في قوة الجزئية، وما عدا ذلك فليس بمنتج ولا فائدة لتفصيل ما لا انتاج له ومن أراد الإرتياض بتفصيله قدر عليه إذا تأمل فيه. فإن قيل: فكم عدد الإفتراضات الممكنة في ذه الأشكال؟ قلنا: ثمانية وأربعون اقترانا في كل شكل ستة عشر، وذلك لأن المقدمتين المقترنتين
إما كليتان أو جزئيتان او إحدهما كلية والأخرى جزئية، وعلى كل حال فهما إما موجبتان أو سالبتان أو واحدة موجبة والأخرى سالبة فهذه ستة عشر اقترانا ناتجة من ضرب أربع في أربع، وهي جارية في الأشكال الثلاثة، فتكون الجملة أخيرا ثمانية وأربعين، والمنتج أربعة عشر إقترانا فيبقى أربعة وثلاثين. فإن قيل: فما خواص الأشكال؟ قلنا: أما الذي يعمل كل شكل فهوإنه لا بد في اقترانها من موجبة وكلية، فلا قياس عن سالبتين ولا عن جزئيتين. وأما خاصية الشكل الأول فإما في وسطه وهو أن يكون محمولا في المقدمة الأولى موضوعا في الثانية، وإما في نتائجه وهو أن ينتج المطالب الأربعة وهي: الأيجاب الكلي، والسلب الكلي، والإيجاب الجزئي، والسلب الجزئي. والخاصية الحقيقية التي لا يشاركه فيها شكل من الأشكال
أنه لا يكون فيها (أي مقدماته) سالبة جزئية. وأما الشكل الثاني فخاصيته في وسطه أن يكون محمولا على الطرفين، وفي مقدماته ألا يتشابها في الكيفية بل تكون أبدا إحداهما سالبة والأخرى موجبة، وأما في الإنتاج فهو أنه لا ينتج موجبة أصلا بل لا ينتج إلا السالب. وأما الشكل الثالث فخاصيته في الوسط أن يكون موضوعا للطرفين، وفي المقدمات أن تكون الصغرى موجبة وأخص خواصه أنه يجوز أن تكون الكبرى منه جزئية. وأما في الإنتاج فهي أن الجزئية هي اللازمة منه دون الكلية. فإن قيل: فلم سمي ذلك أولا وذاك ثانيا وهذا ثالثا؟ قلنا: سمي ذلك أولا لأنه بين الإنتاج وإنما يظهر الإنتاج فيما عداه بالرد إليه أما بالعكس أو بالإفتراض، وإنما كان ذاك ثانيا وهذا ثالثا لأن الثاني ينتج الكلي، والثالث إنما ينتج الجزئي، والكلي أشرف من الجزئي، فكان واليا لما هو أشرف باطلاق، وإنما كان الكلى أشرف لأن المطالب العلمية المحصلة للنفس كمالا إنسانيا مورثا للنجاة والسعادة إنما هي الكليات والجزئيات، إن أفادت علما فبالعرض.
فإن قيل: فهل لكم في تمثيل المقاييس الأربعة عشر أمثلة فقهية لتكون أقرب إلى فهم الفقهاء؟ قلنا: نعم نفعل ذلك ونكتب فوق كل مقدمة يحتاج لردها إلى الأول بعكس أو افتراض أنه بعكس أو بفرض، ونكتب على الطرف أنه إلى أي قياس يرجع إن شاء الله تعالى، وهذه هي الأمثلة: أمثلة الشكل الأول 1 - كل مسكر خمر - وكل خمر حرام - فكل مسكر حرام. 2 - كل مسكر خمر - ولا خمر واحد حلال - فلا مسكر واحد حلال. 3 - بعض الأشربة خمر - وكل خمر حرام - فبعض الأشربة حرام. 4 - بعض الأشربة خمر - ولا خمر واحد حلال - فليس كل شراب حلالا. أمثلة الشكل الثاني 1 - يرجع إلى الضرب الثاني من الأول: كل ثوب فهو مذروع - ولا ربوي واحد مذروع. بعكس هذه فلا ثوب واحد ربوي.
2 - يرجع إلى الضرب الثاني من الأول أيضا: لا ربوي واحد مذروع، بعكس هذه وجعلها صغرى ثم عكس النتيجة وكل ثوب فهو مذروع فلا ربوي واحد ثوب. 3 - يرجع إلى الضرب الرابع من الأول أيضا: متمول ما ليس بربوي " بالإفتراض " وكل مطعوم ربوي، فمتمول ما ليس بمطعوم. 4 - أمثلة الشكل الثالث 1 - يرجع إلى الضرب الثالث من الأول: كل مطعوم ربوي، بعكس هذه وكل مطعوم مكيل فبعض الربوي مكيل. 2 - يرجع إلى رابع الأول: كل ثوب متمول، بعكس هذه، ولا ثوب واحد ربوي، فليس كل متمول ربويا.
3 - يرجع إلى ثالث الأول: مطعوم ما مكيل، بعكس هذه، وكل مطعوم ربوي، فمكيل ما ربوي. 4 - يرجع إلى ثالث الأول: كل مطعوم ربوي، ومطعوم ما مكيل، بعكس هذه وجعلها صغرى ثم عكس النتيجة، فربوي ما مكيل. 5 - يرجع إلى رابع الأول: مذروع ما متمول، بعكس هذه ولا مذروع واحد ربوي، فليس كل متمول ربويا. 6 - يرجع إلى رابع الأول: كل منقول متمول ومنقول ما ليس بربوي " بالإفتراض " فليس كل متمول ربويا. 7 - هذا ما أردنا شرحه من أمثلة القياسات الحملية وأقسامها؛ ولنخض في الصنف الثاني. ؟ الشرطي المتصل يتركب من مقدمتين: إحداهما مركبة من قضيتين قرن بهما صيغة شرط، والأخرى حملية واحدة هي المذكورة في المقدمة الأولى بعينها أو نقيضها، ويقرن بها كلمة الإستثناء،
مثاله: إن كان العالم حادثا فله صانع. مركب من قضيتين حمليتين قرن بهما حرف الشرط وهو قولنا أن، وقولنا: لكن العالم حادث، قضية واحدة حملية قرن بها حرف الإستثناء، وقولنا: فله صانع، نتيجة وهذا مما يكثر نفعه في العقليات والفقهيات، فإنا نقول إن كان هذا النكاح صحيحا فهو مفيد للحل، لكنه صحيح فإذن هو مفيد للحل، وإن كان الوتر يؤدي على الراحلة فهو نفل، لكنه يؤدي على الراحلة فهو إذن نفل. والمقدمة الثانية لهذا القياس إستثناء لإحدى قضيتي المقدمة الأولى أما المقدم أو التالي، والإستثناء إما أن يكون لعين التالي أو لنقيضه أو لعين المقدم او لنقيضه،
والمنتج منه إثنان وهو عين المقدم ونقيض التالي. وأما عين التالي ونقيض المقدم فلا ينتجان، وبيانه إنا نقول إن كان الشخص الذي ظهر عن بعد إنسانا فهو حيوان، لكنه إنسان فليس يخفى أنه يلزم كونه حيوانا، وهذا إستثناء عين المقدم ونقول لكنه ليس بحيوان، وهذا إستثناء نقيض التالي، فيلزم إنه ليس بإنسان ولزوم هذا أدق مدركا وهو أن يعرف أنه إذا لم يكن حيوانا لم يكن إنسانا، إذ لو كان إنسانا لكان حيوانا كما شرطناه في الأول، ويدرك ذلك بأدنى تأمل. فأما إستثناء نقيض المقدم، وهو أنه ليس بإنسان، فلا ينتج لا نقيض التالي وهو أنه ليس بحيوان، إذ ربما يكون فرسا، ولا عين التالي وهو أنه حيوان فربما يكون حجرا.
وكذلك نقول إن كان هذا المصلي محدثا فصلاته باطلة، لكنه محدث فيلزم بطلان الصلاة، لكن الصلاة ليست باطلة وهو نقيض التالي، فيلزم أنه ليس بمحدث وهو نقيض المقدم، لكنه ليس بمحدث وهو نقيض المقدم فلا يلزم - صحة الصلاة ولا بطلانها. لكن الصلاة باطلة، وهو عين التالي، فلا يلزم لا كونه محدثا ولا كونه متطهرا، وإنما ينتج إستثناء عين التالي ونقيض المقدم، إذا ثبت أن التالي مساو للمقدم لا أعم منه ولا أخص، كقولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لكن الشمس طالعة فالنهار موجود، لكن الشمس غير طالعة فالنهار ليس بموجود، لكن النهار موجود فالشمس طالعة، لكن النهار غير موجود فالشمس غير طالعة.
واعلم أنه يتطرق إلى مقدمات هذا القياس أيضا السلب والإيجاب فإنك تقول: إن كان الإله ليس بواحد فالعالم ليس بمنتظم، لكن العالم منتظم فالإله واحد. وقد يكون المقدم أقاويل كثيرة والتالي يلزم الجملة كقولك: إن كان العلم الواحد لا ينقسم وكان كل ما لا ينقسم لا يقوم بمحل منقسم، وكان كل جسم منقسما وكان العلم حالا في النفس، فالنفس إذن ليست بجسم، لكن المقدمات نابتة ذاتية فالتالي وهو أن النفس ليست بجسم لازم، وكذلك قد يكون المقدم واحدا والتالي قضايا كثيرة إن صح إسلام الصبي فهو إما فرض وإما مباح وإما نفل، ولا يمكن شيء من هذه الأقسام فلا يمكن الصحة. وفي العقليات نقول إن كان النفس قبل البدن موجودة فيه إما كثيرة وإما واحدة، ولا يمكن لا هذا ولا ذاك فلا يمكن أن تكون قبل البدن موجودة، فهذه ضروب الشرطيات المتصلة، والله أعلم.
الصنف الثالث الشرطي المنفصل وهو الذي تسميه الفقهاء والمتكلمون السبر والتقسيم، ومثاله قولنا: العالم إما قديم وإما محدث، لكنه محدث فهو إذن ليس بقديم. فقولنا إما قديم وإما محدث مقدمه واحدة، وقولنا لكنه محدث مقدمة أخرى هي إستثناء إحدى قضيتي المقدمة الأولى بعينها، فانتج نقيض اآخر وينتج فيه أربعة إستثناءات، فإنك تقول لكن العالم محدث فيلزم عنه أنه ليس بقديم، أو تقول لكنه قديم فيلزم أنه ليس بمحدث،
أو لكنه ليس بقديم فيلزم أنه محدث وهو إستثناء النقيض، أو تقول لكنه ليس بمحدث، أو تقول لكنه ليس بمحدث فيلزم منه أنه قديم؛ فاستثناء عين إحداهما ينتج نقيض الآخر، واستثناء نقيض إحداهما ينتج الآخر. وهذا فيما لو اقتصرت أجزاء التعاند على اثنين، فإن كانت ثلاثا نأو أكثر ولكنها تامة العناد، فاستثناء عين واحدة ينتج نقيض الآخرين، كقولك لكنه مساو فيلزم أنه ليس أقل ولا أكثر، واستثناء نقيض واحدة لا ينتج إلا انحصار الحق في الجزءين الآخرين، كقولك لكنه ليس مساويا، فيلزم أن يكون إما أقل أو أكثر، فإن استثنيت نقيض الإثنين تعين الثالث، فإما إذا لم تكن الأقسام تامة العناد كقولك: هذا أما أبيض وإما أسود، أو زيد أما بالحجاز أو بالعراق،
فاستثناء عين الواحد ينتج نقيض الآخر، كقولك لكنه بالحجاز أو بالعراق، فاستثناء عين الواحد ينتج نقيض الآخر، كقولك لكنه بالحجاز أو لكنه أسود، فينتج نقيض سائر الأقسام؛ فإما استثناء نقيض الواحد فلا ينتج لا عين الآخر ولا نقيضه، فإنه لا حاصر في الأقسام، فقولنا ليس بالحجاز لا يوجب أن يكون في العراق، ولا ألا يكون به إلا إذا بان بطلان سائر الأقسام بدليل آخر، فعند ذلك يصير الباقي ظاهر الحصر تام العناد، ولا يحتاج هذا إلى مثال في الفقة فإن كثيرا نظر الفقهاء على السبر والتقسيم يدور. ولكن لا يشترط في الفقهيات الحصر القطعي بل الظني فيه كالقطعي في غيره. الصنف الرابع في قياس الخلف وصورته صورة القياس الحملي، ولكن إذا كانت المقدمتان صادقتين سمي قياسا مستقيما، وإن كانت إحدى المقدمتين ظاهرة الصدق والأخرى كاذبة أو مشكوكا فيها وأنتج نتيجة بينة الكذب ليستدل بها على أن المقدمة كاذبة، سمي قياس خلف. ومثال ذلك قولنا في الفقه: " كل ما هو فرض فلا يؤدي على الراحلة " والوتر فرض
فإذن لا يؤدي على الراحلة، وهذه النتيجة كاذبة ولا تصدر إلا من قياس في مقدماتها مقدمة كاذبة، ولكن قولنا كل واجب فلا يؤدي على الراحلة مقدمة ظاهرة الصدق، فبقي أن الكذب في قولنا أن الوتر فرض فيكون نقيضه، وهو أنه ليس بفرض، صادقا وهو المطلوب من المسألة ونظيره من العقليات قولنا: كل ما هو أزلي فلا يكون مؤلفا، والعالم أزلي فإذن لا يكون مؤلفا، لكن النتيجة ظاهرة الكذب ففي المقدمات كاذبة. وقولنا الأزلي ليس بمؤلف ظاهر الصدق، فينحصر الكذب في قولنا العالم أزلي، فإذن نقيضه وهو أن العالم ليس بأزلي صدق، وهو المطلوب؛ فطريق هذا القياس أن تأخذ مذهب الخصم وتجعله مقدمة، وتضيف إليها مقدمة أخرى ظاهرة الصدق، فينتج من القياس نتيجة ظاهرة الكذب، فتبين أن ذلك لوجود كاذبة في المقدمات.
ويجوز أن يسمى هذا قياس الخلف، لأنك ترجع من النتيجة إلىالخلف، فتأخذ مطلوبك من المقدمة التي خلفتها كأنها مسلمة ويجوز أن يسمى قياس الخلف لأن الخلف هو الكذب المناقض للصدق، وقد أدرجت في المقدمات كاذبة في معرض الصدق، ولا مشاحة في التسمية بعد فهم المعنى. الصنف الخامس الإستقراء هو أن تتصفح جزئيات كثيرة داخلة تحت معنى كلي، حتى إذا وجدت حكما في تلك الجزئيات حكمت على ذلك الكلي به. ومثاله في العقليات أن يقول قائل: فاعل العالم جسم، فيقال له:؟ فيقول له: لم؟ فيقول: لأن كل فاعل جسم، فيقال له: لم؟ فيقول تصفحت أصناف الفاعلين من خياط وبناء وإسكاف ونجار ونساج وغيرهم فوجدت كل واحد منهم جسما، فعلمت أن الجسمية حكم ملازم للفاعلية، فحكمت على كل فاعل به. وهذا الضرب من الإستدلال غير منتفع به في هذا المطلوب، فإنا نقول: هل تصفحت في جملة ذلك فاعل العالم؟ فإن تصفحته ووجدته جسما فقد عرفت المطلوب قبل أن تتصفح الإسكاف والبناء ونحوهما، فاشتغالك به إشتغال بما لا يعنيك، وإن لم تتصفح فاعل العالم ولم تعلم حاله فلم حكمت بأن كل فاعل جسم؟ وقد تصفحت بعض الفاعلين ولا يلزم منه غلا أن بعض الفاعلين جسم،
وإنما يلزم أن كل فاعل جسم إذا تصفحت الجميع تصفحا لا يشذ عنه شيء، وعند ذلك يكون المطلوب أحد أجزاء المتصفح فلا يعرف بمقدمة تبنى على التصفح. وإن قال: لم اتصفح الجميع ولكن الأكثر، قلنا: فلم لا يجوز أن يكون الكل جسما إلا واحدا، وإذا احتمل ذلك لم يحصل اليقين به، ولكن يحصل الظن، ولذلك يكتفي به في الفقهيات في أول النظر، بل يكتفي بالتمثيل على ما سيأتي، وهو حكم من جزئي واحد على جزئي آخر. والحكم المنقول ثلاثة: أما حكم من كلي على جزئي وهو الصحيح اللازم وهو القياس الصحيح الذي قدمناه، وأما حكم من جزئي واحد على جزئي واحد كاعتبار الغائب بالشاهد وهو التمثيل وسيأتي، وأما حكم من جزئيات كثيرة على جزئي واحد وهو الإستقراء وهو أقوى من التمثيل.
ومثال الإستقراء في الفقه قولنا: الوتر لو كان فرضا لما أدي على الراحلة، ويستدل به كما سبق في قياس الخلف فيقال: ولم عرفتم أن الفرض لا يؤدي على الراحلة؟ قلنا: باستقراء جزئيات الفرض من الرواتب وغيرها كصلاة الجنازة والمنذورة والقضاء وغيرها، وكذلك يقول الحنفي " الوقف لا يلزم في الحياة لأنه لو لزم لما اتبع شرط الواقف، فيقال له: ولم قلت أن كل لازم فلا يتبع فيه شرط العاقد؟ فيقول: قد استقريت جزئيات التصرفات اللازمة من البيع والنكاح والعتق والخلع وغيرها، ومن جوز التمسك بالتمثيل المجرد الذي لا مناسبة فيه يلزمه هذا، بل إذا كثرت الأصول قوي الظن، ومهما ازدادت الأصول الشاهدة أعني الجزئيات اختلافا كان الظن أقوى فيه، حتى إذا قلنا مسح الراس وظيفة أصلية في الوضوء فيستحب فيه التكرار فقيل: لم؟ فقلنا استقرينا ذلك من غسل الوجه واليدين وغسل الرجلين، ولم يكن معنا إلا مجرد هذا الإستقراء. وقال الحنفي: مسح فلا يكرر، فقيل: لم؟ فقال: استقريت مسح التيمم ومسح الخف كان ظنه أقوى لدلالة جزئين مختلفين عليه. وأما الأعضاء الثلاثة في الوضوء ففي حكم شاهد واحد لتجانسها، وهي كشهادة الوجه واليد اليمنى واليسرى في التيمم.
فإن قيل: فلم لا يقال للفقيه إستقراؤك غير كامل فإنك لم تتصفح محل الخلاف؟ فالجواب: أن قصور الإستقراء عن الكمال أوجب قصور الإعتقاد الحاصل عن اليقين، ولم يوجب بقاء الإحتمال على التعادل كما كان، بل رجح بالظن أحد الإحتمالين، والظن في الفقه كاف وإثبات الواحد على وفق الجزئيات الكثيرة أغلب من كونه مستثنى على الندور، فإذا لم يكن لنا دليل على أن الوتر واجب وأن الوقف لازم، ورأينا جواز أدائه على الراحلة ولا عهد به في فرض ووجوب اتباع شرط الواقف، ولا عهد به في تصرف لازم صار منع الغرضية ومنع اللزوم أغلب على الظن وأرجح من نقيضه، وإمكان الخلاف لا يمنع الظن ولا سبيل إلى جحد الإمكان مهما لم يكن الإستقراء تاما، ولا يكفي في تمام الإستقراء أن تتصفح ما وجدته شاهدا على الحكم إذا أمكن أن ينتقل عنه شيء، كما لو حكم إنسان بأن كل حيوان يحرك عند المضغ فكه الأسفل لأنه إستقرى أصناف الحيوانات الكثيرة، ولكنه لما لم يشاهد جميع الحيوانات لم يأمن أن يكون في البحر حيوان هو التمساح يحرك عن المضغ فكه الأعلى - على ما قيل - وإذا حكم بأن كل حيوان سوى الإنسان، فنزوانه على الأنثى من وراء بلا تقابل الوجهين لم يأمن أن يكون سفاد القنفد وهو من الحيوانات على المقابلة لكنه لم يشاهده، فإذن حصل من هذا أن الإستقراء التام يفيد الظن، فإذن لا ينتفع بالإستقراء مهما وقع خلاف في بعض الجزئيات فلا يفيد الإستقراء علما كليا بثبوت الحكم للمعنى الجامع للجزئيات، حتى يجعل ذلك مقدمة في قياس آخر لا في إثبات الحكم لبعض الجزئيات، كما إذا قلنا: كل حركة في زمان
وكل ما هو في زمان فهو محدث فالحركة محدثة، وأثبتنا قولنا كل حركة في زمان باستقراء أنواع الحركة من سباحة وطيران ومشي وغيرها. فإما إذا أردنا أن نثبت أن السباحة في زمان بهذا الإستقراء لم يكن تاما والضبط أن القضية التي عرفت بالإستقراء ان أثبت لمحمولها حكما ليتعدى إلى موضوعها فلا بأس، وأن نقل محمولها إلى بعض جزئيات موضوعها لم يجز إذ تدخل النتيجة في نفس الإستقراء فيسقط فائدة القياس. فإذا كان مطلبنا مثلا أن نبين أن القوة العقلية المدركة للمعقولات هل هي منطبعة في جسم أم لا؟ فقلنا: ليست منطبعة في جسم لأنها تدرك نفسها والقوى المنطبعة في الأجسام لا تدرك نفسها. فيقال: ولم؟ قلت: عن القوى المنطبعة في الأجسام لا تدرك نفسها. فقلنا تصفحنا القوى المدركة من الآدمي كقوة البصر والسمع والشم والذوق واللمس والخيال والوهم فرأيناها لا تدرك نفسها؟ فيقال: هل تصفحت في جملة ذلك القوة العقلية؟ فإن تصفحتها فقد عرفتها قبل هذا الدليل فلا تحتاج إلى هذا الدليل، وإن لم تعرفها بل هي المطلوب فلم تتصفح الكل بل تصفحت البعض فلم حكمت علىالكل بهذا الحكم؟ ومن أين يبعد أن تكون القوى المنطبعة كلها لا تدرك نفسها إلا واحدة، فيكون حكم واحدة منها بخلاف حكم الجملة وهو ممكن كما ذكرناه في مثال التمساح والقنفد، وفي مثال من يدعي أن صانع العالم جسم، بل من ليس له سمع ولا بصر ربما يحكم بأن الحس لا يدرك الشيء إلا بالإتصال بذلك الشيء، بدليل الذوق واللمس والشم، فلو يجري ذلك في
البصر والسمع كان مخطئا إذ يقال: لم يستحيل أن تنقسم الحواس إلى ما يفتقر فيه إلى الإتصال بالمحسوس وإلى ما لا يفتقر؟ وإذا جاز الإنقسام جاز أن يعتدل القسمان وجاز ان يكون الأكثر في أحد القسمين، ولا يبقى في القسم الآخر إلا واحد، فهذا لا يورث يقينا إنما يحرك ظنا، وربما يقنع اقناعا يسبق الإعتقاد إلى قبوله ويستمر عليه. ؟ الصنف السادس التمثيل وهو الذي تسميه الفقهاء قياسا، ويسميه المتكلمون رد الغائب إلى الشاهد، ومعناه أن يوجد حكم في جزئي معين واحد فينقل حكمه إلى جزئي آخر يشابهه بوجه ما، ومثاله في العقليات أن نقول: السماء حادث لأنه جسم قياسا على النبات والحيوان، وهذه الأجسام التي يشاهد حدوثها، وهذا غير سديد ما لم يمكن أن يتبين أن النبات كان حادثا لأنه جسم، وإن جسميته هي الحد الأوسط للحدوث، فإن ثبت ذلك فقد عرفت أن الحيوان حادث لأن الجسم حادث، فهو حكم كلي وينتظم منه قياس على هيئة الشكل الأول، وهو أن السماء جسم وكل جسم حادث، فينتج أن السماء حادث
فيكون نقل الحكم من كلي إلى جزئي داخلا تحته، وهو صحيح، وسقط أثر الشاهد المعين وكان ذكر الحيوان فضلة في الكلام كما إذا قيل لإنسان: لم ركبت البحر؟ فقال: لاستغني، فقيل له: ولم قلت إذا ركبت البحر استغنيت؟ فقال: لأن ذلك اليهودي ركب البحر فاستغنى، فيقال: وأنت لست بيهودي فلا يلزم من ثبوت الحكم فيه ثبوت الحكم فيك، فلا يخلصه إلا أن يقول: هو لم يستغن لأنه يهودي بل لأنه ركب البحر تاجرا، فنقول: إذن فذكر اليهودي حشو بل طريقك أن تقول: كل من ركب البحر أيسر، فأنا أيضا أركب البحر لأوسر، ويسقط أثر اليهودي، فاذن لا خير في رد الغائب إلى الشاهد إلا بشرط مهما تحقق سقط أثر الشاهد المعين. ثم في هذا الشرط موضع غلط أيضا فربما يكون المعنى الجامع مما يظهر أثره وغناه في الحكم، فيظن انه صالح ولا يكون صالحا لأن الحكم لا يلزمه بمجرده بل لكونه على حال خفي، وأعيان الشواهد تشتمل على صفات خفية فلذلك يجب إطراح الشاهد المعين، فإنك تقول السماء حادث لأنه مقارن للحوادث كالحيوان، فيجب عليك إطراح ذكر الحيوان لأنه يقال لك الحيوان حادث بمجرد كونه مقارنا للحوادث فقط، فاطرح الحيوان وقل كل مقارن للحوادث حادث
والسماء مقارن فكان حادثا، وعند ذلك ربما يمنع الخصم المقدمة الكبرى فلا يسلم أن كل مقارن للحوادث حادث إلا على وجه مخصوص وأن جوزت إن الموجب للحدوث كونه مقارنا على وجه مخصوص وإن جوزت إن الموجب للحدوث كونه مقارنا على وجه مخصوص فلعل ذلك الوجه وأنت لا تدريه موجود في الحيوان لا في السماء، فإن عرفت ذلك الوجه وأنت لا تدريه موجود في الحيوان لا في السماء، فإن عرفت ذلك فابرزه واضفه إلى المقارن واجعله مقدمة كلية، وقل كل مقارن للحوادث بصفة كذا فهو حادث، والسماء مقارن بصفة كذا فهو إذن حادث، فعلى جميع الأحوال لا فائدة في تعيين شاهد معين في العقليات ليقاس عليه؛ ومن هذا القبيل قولك: الله عالم بعلم لا بنفسه لأنه لو كان عالما بعلم قياسا على الإنسان، فيقال: ولم قلت أن ما ينسب للإنسان ينسب لله؟ فتقول: لأن العلة جامعة، فيقال: العلة كونه إنسانا عالما أو كونه عالما فقط فإن كان كونه إنسانا عالما فلا يلزم في حق الله مثله، وإن كانت كونه عالما فقط فاطرح الإنسان وقل: كل عالم فهوعالم بعلم والباري عالم فهو عالم بعلم، وعند ذلك إنما ينازع في قولك كل عالم فهو عالم بعلم، فإن ذلك إن لم يكن أوليا لزمك أن تبينه بقياس آخر لا محالة.
فإن قيل: فهل يمكن إثبات كون المعنى الجامع علة للحكم بأن نرى أن الحكم أجزاء العلة وشروطها، ولا يوجد بوجود ذلك البعض، فمهما ارتفع الحياة ارتفع الإنسان ومهما وجدت لم يلزم وجود الإنسان، بل ربما يوجد الفرس أو غيره ولكن الأمر بالضد من هذا، وهو أنه مهما وجد الحكم دل على وجود المعنى الجامع، فإما أن يدل وجود المعنى على وجود الحكم بمجرد كون الحكم مرتفعا بارتفاعه فلا، فمهما وجد الإنسان فقد وجدت الحياة، ومهما وجدت صحة الصلاة فقد وجد الشرط وهو الطهارة، ومهما وجدت الطهارة لم يلزم وجود الصلاة. فإن قيل: فما ذكرتموه في إبطال منفعة الشاهد في رد الغائب غليه مقطوع به، فكيف يظن بالمتكلمين مع كثرتهموسلامة عقولهم الغفلة عن ذلك؟ قلنا: معتقد الصحة في رد الغائب إلى الشاهد إما محقق يرجع عند المطالبة إلى ما ذكرناه، وإنما يذكر الشاهد المعين لتنبيه السامع على القضية الكلية به فيقول الإنسان عالم بعلم لا بنفسهس، منبها به على أن العالم لا يعقل من معناه شيء سوى أنه ذو علم فيذكر الإنسان تبنيها، وأما قاصر عن بلوغ ذروة التحقيق وهذا ربما ظن ان في ذكر الشاهد المعين دليلا، ومنشأ ظنه أمران: أحدهما أن من رأى البناء فاعلا وجسما ربما أطلق أن الفاعل جسم والفاعل بالألف واللام يوهم الإستغراق، خصوصا في لغة العرب، وهو من المهملات والمهملات قد يتسامح بها فيؤخذ على أنه قضية كلية، فيظن أنها كلية
وينظم قياسا ويقول: الفاعل جسم، وصانع العالم فاعل فهو جسم؛ وكذلك ربما نظر ناظر إلى البر فيراه مطعوما وربويا فيقول المطعوم ربوي ويبني عليه قوله أن السفرجل مطعوم فهو إذن ربوي، لإلتباس قوله المطعوم بقوله كل مطعوم، فالمحقق إذا سمعه فصل وقال قولك المطعوم عنيت به كل مطعوم أو بعضه، فإن قلت بعضه فلعل السفرجل من البعض الآخر، وإن قلت كله فمن أين عرفت ذلك، فإن قلت من البر فليس كل المطعومات، فإذا رأيته ربويا لم يلزم منه إلا أن كل البر ربوي والسفرجل ليس ببر، أو بعض المطعوم ربوي فلا يلزم منه بعض آخر، وكذا في قوله الفاعل جسم يقال له كل الفاعلين أو بعضهم على ما تقرر فلا حاجة إلى الإعادة؟ ثانيهما هو أنه ربما يستقري أصنافا كثيرة من الفاعلين حتى لا يبقى عنده فاعل آخر فيرى أنه استقرى كل الفاعلين، ويطلق القول بأن
كل فاعل فهو جسم وكان الحق أن يقول كل فاعل شاهدته وتصفحته فهو جسم، فيقال له: لم تشاهد فاعل العالم ولا يمكن الحكم عليه ولكن ألغي قوله شاهدت، وكذا يتصفح البر والشعير وسائر المطعومات الموزونة والمكيلة ويعبر عنها بالكل، وينظم في ذهنه قياسا على هيئة الشكل الأول، وهو أن كل مطعوم فأما بر أو شعير أو غيرهما، وكل بر وكل شعير أو غيرهما فهو ربوي، فإذن كل مطعوم ربوي، ثم يقول: والسفرجل مطعوم فهو ربوي، فيكون هذا منشأ غلطه وإلا فالحق ما قدمناه. ولا ينبغي أن تضيع الحق المعقول، خوفا من مخالفة العادات المشهورة، بل المشهورات أكثر ما تكون مدخولة، ولكن مداخلها دقيقة لا يتنبه لها إلا الأقلون. وعلى الجملة لا ينبغي أن تعرف الحق بالرجال، بل ينبغي أن تعرف الرجال بالحق فتعرف إلى الحق أولا، فمن سلكه فاعلم أنه محق. فأما أن تعتقد في شخص أنه محق أولا ثم تعرف الحق به، فهذا ضلال اليهود والنصارى وسائر المقلدين، أعاذك الله وإيانا منه؛ هذا كله في إبطال التمثيل في العقليات، فأما في الفقهيات، فالجزئي المعين يجوز أن ينقل حكمه إلى جزئي آخر باشتراكهما فيب وصف، وذلك الوصف المشترك إنما يوجب الإشتراك في الحكم إذا دل عليه وإداتها الجملية قبل التفصيل ستة: الأول، وهو أعلاها: أن يشير صاحب الحكم، وهو المشرع إليه، كقوله في الهرة: إنها من الطوافين عليكم، عند ذكر العفو عن سؤرها، فيقاس عليها الفأرة بجامع الطواف،
وإن افترقتا في أن هذه تنفر وتلك تأنس، وإن هذه فأرة وتيك هرة، ولكن الإشتراك فثي وصف أضيف إليه الحكم أحرى باقتضاء الإشتراك فيه (في الحكم) من الإفتراق في وصف لم يتعرض له في اقتضاء الإفتراق. وكذا قوله في بيع الرطب بالتمر: أينقص الرطب إذا جف؟ فقيل: نعم. فقال: فلا تبيعوا. فهو إذن أضاف بطلان البيع في الرطب إلى النقصان المتوقع، فيقاس عليه العنب للإشتراك في توقع النقصان. ولا يمنع جريان السؤال في الرطب عن الحاق العنب به، وإن كان هذا عنبا، وذلك رطبا، لأن هذا الإفتراق افتراق في الإسم والصورة والشرع، كثير الإلتفات إلى المعاني، قليل الإلتفات إلى الصور والأسامي. فعادة الشرع ترجح في ظننا التشريك في الحكم، عند الإشتراك في المضاف إليه ذلك الحكم، وتحقيق الظن في هذا دقيق، وموضع إستقصائه الفقه. الثاني: أن يكون ما فيه الإجتماع مناسبا للحكم، كقولنا: النبيذ مسكر فيحرم كالخمر. فإذا قيل: لم قلتم: المسكر يحرم؟ قلناك لأنه يزيل العقل، الذي هو الهادي إلى الحق، وبه يتم التكليف؛ فهذا مناسب للنظر في المصالح فيقال: لا يمتنع ان يكون الشرع قد راعى سكر ما يعتصر من العنب على الخصوص تعبدا، أو أثبت التحريم لا لعلة السكر، بل تعبدا في خمر العنب من غير التفات إلى السكر، فكم من الأحكام التي هي تعبدية غير معقولة، فيقول: نعم هذا غير ممتنع،
ولكن الأكثر في عادة الشرع اتباع المصالح. فكون هذا من قبيل الأكثر أغلب على الظن من كونه من قبيل النادر. الثالث: أن يبين للوصف الجامع تأثيرا في موضع من غير مناسبة، كما يقول الحنفي في اليتيمة أنها صغيرة، ويولى عليها كغير اليتيمة، فيقال: فلم عللت الولاية بالصغر؟ فيقول: لأن الصغر قد ظهر أثره بالإتفاق في غير اليتيمة وفي الإبن. وقدر أن الوصف غير مناسب حتى يستمر المثال، فلا ينبغي أن يقال هذه يتيمة وتيك ليست بيتيمة؛ فيقال: الإفتراق في هذا لا يقاوم الإشتراك في وصف الصغر، وقد ظهر تأثيره في موضع، واليتم لم يظهر تاثيره بالإتفاق في موضع، نعم لو ثبت أن اليتيم لا يولي عليه في المال لتقاوم الكلام. ولو قيل: ظهر أثر اليتم أيضا في دفع الولاية في موضع، كما ظهر أثر الصغر في موضع، فعند ذلك يحتاج إلى الترجيح. وإن شئت مثلت هذا القسم بقياس العنب على الرطب، وإجتماعهما في توقع النقصان. ويقدر أن ذلك لم يعرف بإضافة لفظية من الشارع، بل عرف باتفاق من الفريقين حتى لا يلتحق بمثال الإضافة. الرابع: أن يكون ما فيه الإشتراك غير معدود ولا مفصل لأنه الأكثر، وما فيه الإفتراق شيئا واحدا، ويعلم أن جنس المعنى الذي فيه الإفتراق، لا مدخل له في هذا الحكم، مهما التفت إلى الشرع كقوله: من أعتق شقصا له من عبد، قوّم عليه الباقي. فإنا نقيس الأمة عليه، لا لأنا عرفنا إجتماعهما في معنى مخيل أومؤثر أو مضاف إليه الحكم بلفظه، لأنه لم يبن لنا بعد المعنى المخيل فيه، ولا لأنا رأيناهما متقاربين فقط. فإنه لو وقع النظر في ولاية النكاح، وبان أن الأمة تجبر على النكاح، فلا يتبين لنا أن العبد في معناه. والقرب من الجانبين على وتيرة واحدة،
ولكن إذا التفتنا إلى عادة الشرع، علمنا قطعا أنه ليس يتغير حكم الرق والعتق بالذكورة والأنوثة، كما لا يتغير بالسواد والبياض، والطول والقصر، والزمان والمكان وأمثالها. الخامس: هو الرابع بعينه، غلا أن ما فيه الإفتراق لا يعلم يقينا أنه لا مدخل له في الحكم، بل يظن ظنا ظاهرا، وذلك كقياسنا إضافة العتق إلى جزء معين على إضافته إلى نصف شائع، وقياس الطلاق المضاف إلى جزء معين على المضاف، إلى نصف شائع فأنا نقول: السبب هو السبب، والحكم هو الحكم، والإجتماع شامل إلا في شيء واحد هو أن هذا معين مشار إليه، وذلك شائع. وإذا كان التصرف لا يقتصر على المضاف إليه، فيبعد أن يكون لا مكان الإشارة وعدمه مدخل في هذا الحكم، وهذا ظن ظاهر ولكن خلافه ممكن؛ فإن الشرع جعل الجزء الشائع. محلا لبعض التصرفات، ولم يجعل المعين محلا أصلا، فلا بعد في أن يجعل ما هو محل لبعض التصرفات محلا لإضافة هذا التصرف، فصار النظر بهذا الإحتمال ظنيا. وقد اختلف المجتهدون في قبول ذلك، وعندي أن في هذا الجنس ما يجوز الحكم به، ولكن يتطرق إلى مبالغ الظن، الحاصل منه تفاوت غير محدود ولا محصور، ويختلف بالوقائع والأحكام، والأمر موكول إلى المجتهد، فإن من غلب أحد ظنيه جاز له الحكم به. السادس: أن يكون المعنى الجامع أمرا معينا متحدا، وما فيه الإفتراق أيضا أمرا معينا أو أمورا معينة، ولم يكن للجامع مناسبة وتأثير، إلا أنه إن كان الجامع موهما أن المعنى المصلحي - الخفي، الملحوظ بعين الإعتبار من جهة الشرع، مودع في طيه، وإنطواؤه على ذلك المعنى، الذي هو المقتضي للحكم عند الله، أغلب من إحتواء المعنى الذي فيه المفارقة، كان الحكم بالإشتراك لذلك أولى من الحكم بالإفتراق.
مثاله قولنا: الوضوء طهارة حكمية عن حدث، فتفتقر إلى النية كالتيمم، فقد اشتركا في هذا وافترقا في أن ذاك طهارة بالماء دون التيمم، وتشبهه إزالة النجاسة. وقولنا: ظهارة حكمية جمع التيمم وأخرج إزالة النجاسة. ونحن نقول: المقتضي للنية في علم الله تعالى معنى خفي عنا، ومقارنته بكونه طهارة حكمية يعتد به موجبا في حال موجبها، أغلب من كونه مقرونا بكونه طهارة بالتراب، فيصير إلحاق الوضوء به أغلب على الظن من قطعة عنه؛ وهذا أيضا مما اختلف فيه. والرأي عندنا أن ذلك مما يتصور أن يفيد رجحان ظن على ظن، فهو موكول إلى المجتهد. ولم يبن لنا من سيرة الصحابة، في إلحاق غير المنصوص بالمنصوص، إلا إعتبار أغلب الظنون. ولا ضوابط بعد ذلك في تفصيل مدارك الظنون، بل كل مايضبط به تحكم، وربما يغلط في نصرة هذا الجنس فيقال: الوضوء قربة، ويذكر وجه مناسبة القربة للنية، وهو ترك لهذا الطريق بالعدول إلى الإضافة. وربما يغلط في نصرة جانبهم فيقال: هذه طهارة بالماء والماء مطهر بنفسه، كما أنه مروي بنفسه، ويدعى مناسبة فيكون عدولا عن الفرق الشبهي، كما أن ما ذكرناه عدول عن الجمع الشبهي. وإسم الشبه، في اصطلاح أكثر الفقهاء، مخصوص بالتشبيه بمثل هذه الأوصافن الذي لا يمكن اثباته بالمدارك السابقة، وإن كان غير التعليق بالمخيل تشبيها، ولكن خصصت العبارة اللفظية به لأنه ليس فيه إلا شبه، كما خصصوا المفهوم بفحوى الخطاب، مع أن المنظوم أيضا له مفهوم، ولكن ليس للفحوى منظوم، بل مجرد المفهوم فلقب به.
ولما رأينا التعويل على أمثال هذا الوصف الذي لا يظهر مناسبته جائزا بمجرد الظن. والظنون تختلف بأحوال المجتهدين، حتى أن شيئا واحدا يحرك ظن مجتهد، وهو بعينه لا يحرك ظن الآخر، ولم يكن له في الجدال معيار يرجع إليه المتنازعانن رأينا أن الواجب في إصطلاح المتناظرين ما اصطلح عليه السلف من مشايخ الفقه، دون ما أحدثه من بعدهم ممن ادعى التحقيق في الفقه، من المطالبة بإثبات العلة بمناسبة أو تأثير أو إخالة، بل رأينا أن يقتصر المعترض على سؤال المعلل بأن قياسك من أي قبيل؟ فإن كان من قبيل المناسب أو المؤثر أو سائر الجهات، وأنت تظن أنه ينطوي على المعنى المبهم، فلست أطالبك ولكن أقابلك للجمع، صلح مثله للفرق. وبهذا السؤال يفتضح المعلل في قياسه الذي قدّره، إن كان معناه الجامع طردا محضا، لا يناسب ولا يوهم الإشتمال على مناسب مبهم. وإن كان ما يقابل السائل به طردا محضا لا يوهم أمرا، فعلى المعلل أن يرجح جانبه، كما إذا فرق بين التيمم والوضوء، بأن التيمم على عضوين، وهذا على أربعة أعضاء، فإن هذا مما يعلم أنه لا يمكن أن يكون لمثله مدخل في الحكم، لا بنفسه ولا باستصحاب معنى له مدخل بطريق الإشتمال عليه، مع إبهامه بخلاف قولنا أنه طهارة حكمية، فهذا طريق النظر في الفقهيات. ولقد خاض في الفقه من أصحاب الرأي، من سدى أطرافا من العقليات ولم يخمرها، وأخذ يبطل أكثر أنواع هذه الأقيسة، ويقتصر منها على المؤثر، ويوجه المطالبة العقلية على كل ما يتمسك به في الفقه. وعندما ينتهي إلى نصرة مذهبه في التفصيل، يعجز عن تقريره على الشرط الذي وضعه في التأصيل، فيحتحال لنصرة الطرديات الردية بضروب من الخيالات الفاسدة، ويلقبها بالمؤثر،
وليس يتنبه لركاكة تيك الخيالات الفاسدة، ولا يرجع فينتبه لفساد الأصل الذي وضعه، فدعاه إلى الإقتصار في إثبات الحكم على طريق المؤثر أو المناسب، ولا يزال يتخبط، والرد عليه في تفصيل ما أورده في المسائل يشتمل عليه كتبنا المصنفة في خلافات الفقه، سيما: كتاب تحصين المأخذ، وكتاب المبادي والغايات. والغرض الآن من ذكره أن الإستقصاء الذي ذكرناه في العقليات، ينبغي أن يترك في الققهيات رأسا؛ فخلط ذلك الطريق السالك إلى طلب اليقين بالطريق السالك إلى طلب الظن صنيع من سدى من الطرفين طرفا، ولم يستقل بهما، بل ينبغي أن تعلم أن اليقين في النظريات أعز الأشياء وجودا، وأما الظن فأسهلها منالا وأيسرها حصولا. فالظنون المعتبرة في الفقهيات هو المرجح الذي يتيسر به عند التردد بين أمرين: إقدام أو إحجام؛ فإن إقدام الناس في طرق التجارات وإمساك السلع تربصا بها، أو بيعها خوفا من نقصان سعرها، بل في سلوك أحد الطريقين في أسفارهم، بل في كل فعل يتردد الإنسان فيه بين جهتين على ظن؛ فإنه إذا تردد العاقل بين أمرين، واعتدلا عنده في غرضه، لم يتيسر له الإختيار، إلا أن يترجح أحدهما، بأن يراه أصلح بمخيلة أو دلالة؛ فالقدر الذي يرجح أحد الجانبين ظن له، والفقهيات كلها نظر من المجتهدين في إصلاح الخلق. وهذه الظنون وأمثالها تقتنص بأدنى مخيلة وأقل قرينة، وعليه إتكال العقلاء كلهم في إقدامهم وإحجامهم على الأمور المخطرة في الدنيا، وذلك القدر كاف في الفقهيات، والمضايقة والإستقصاء فيه يشوش مقصوده بل يبطله، كما أن الإستقصاء في التجارات، ضربا للمثل، يفوت مقصود التجارة. وإذا قيل للرجل: سافر لتربح، فيقول: وبم أعلم أني إذا سافرت ربحت؟
فيقال: اعتبر بفلان وذالان. فيقول: ويقابلهما فلان وفلان وقد ماتا في الطريق أو قتلا أو قطع عليهما الطريق! فيقال: ولكن الذين ربحوا أكثر ممن خسروا أو قتلوا: فيقول: فما المانع من أن أكون من جملة من يخسر أو يقتل أو يموت؟ وماذا ينفعني ربح غيري إذا كنت من هؤلاء؟ فهذا استقصاء لطلب اليقين، والمعتبر له لا يتجر ولا يربح، وبعد مثل هذا الرجل موسوسوا أو جبانا، ويحكم عليه بأن التاجر الجبان لا يربح، فهذا مثال الإستقصاء في الفقهيات، وهو هوس محض وخرق، كما أن ترك الإستقصاء في العقليات جهل محض، فليؤخذ كل شيء من مأخذه، فليس الخرق في الإستقصاء في موضع تركه، بأقل من الحمق في تركه بموضع وجوبه، والله أعلم. الصنف السابع في الأقيسة المركبة والناقصة إعلم أن الألفاظ القياسية المستعملة في المخاطبات والتعليمات، وفي الكتب والتصنيفات، لا تكون ملخصة في غالب الأمر على الوجه الذي فصلناه، بل تكون مائلة عنه إما بنقصان، وإما بزيادة، وإما بتركيب وخلط جنس بجنس، فلا ينبغي أن يلتبس عليك الأمر، فتظن أن المائل عما ذكرناه ليس بقياس، بل ينبغي أن يكون عين عقلك مقصورة على المعنى، وموجهة إليه لا إلى الأشكال اللفظية،
فكل قول أمكن أن يحصل مقصوده، ويرد إلى ما ذكرناه من القياس، فقوته قوة قياس، وهو حجة، وإن لم يكن تأليفه ما قدمناه، إلا أنه إذا تؤمل وامتحن لمتحصل منه نتيجة، فليس بحجة. أما المائل للنقصان فبأن نترك إحدى المقدمتين أو النتيجة. أما ترك المقدمة الكبرى فمثاله قولك: هذان متساويان لأنهما قد ساويا شيئا واحدا، فقد ذكرت المقدمة الصغرى والنتيجة، وتركت الكبرى وهي قولك: والأشياء المساوية لشيء واحد متساوية، وبه تمام القياس، ولكن قد تتركب لوضوحها، وعلى هذا أكثر الأقيسة في الكتب والمخاطبات. وقد تترك الكبرى إذا قصد التلبيس ليبقى الكذب خفيا فيه، ولو صرح به لتنبه المخاطب لمحل الكذب. مثاله قولك: هذا الشخص في هذه القلعة خائن، سيسلم القلعة لأني رأيته يتكلم مع العدو، وتمام القياس أن تضيف إليه: أن كل من يتكلم مع العدو فهو خائن، وهذا يتكلم معه، فهو إذن خائن، ولكن لو صرحت بالكبرى ظهر موضع الكذب، ولم يسلم أن كل ما يتكلم مع العدو فهو خائن. وهذا مما يكثر استعماله نفي القياسات الفقهية. وأما ترك المقدمة الصغرى فمثاله قولك:
اتق مكيدة هذا. فيقال: لم؟ فتقول: لأن الحساد يكايدون. فتترك الصغرى وهو قولك: هذا حاسد، وذلك إنما يكون عند ظهور الحسدن منه. وهو كقولك: هذا يقطع لأن السارق يقطع، وتترك الصغرى، ويحسن ذلك إذا اشتهر بالسرقة عند المخاطب. وعلى هذا أكثر مخاطبة الفقهاء لا سيمافي كتب المذهب، وذلك حذرا من التطويل. ولكن في النظريات ينبغي أن يفصل حتى يعرف مكان الغلط. وأما المائل بالتركيب والخلط، فهو أن يطوى في سياق كلام تسوقه إلى نتيجة واحدة مقدمات مختلفة، أي حملية وشرطية منفصلة ومتصلة. مثاله قولك: العالم إما أن يكون قديما، وإما أن يكون محدثا، فإن كان قديما فهو ليس بمقارن للحوادث لكنه مقارن للحوادث من قبل أنه جسم، والجسم إن لم يكن مقارنا للحوادث يكون خاليا منها، والخالي من الحوادث ليس بمؤلف ولا يمكن أن يتحرك، فإذن العالم محدث؛ فهذا القياس مركب من شرطي منفصل ومن شرطي متصل،
ومن جزمي على طريق الخلف ومن جزمي مستقيم، فتأمل أمثال ذلك فإنه كثير الورود في المناظرات والمخاطبات التعليمية. ومن جملة التركيبات ما تترك فيه النتائج الواضحة وبعض المقدمات، ويذكر من كل قياس مقدمة واحدة، وتترتب بعضها على بعض وتساق إلى نتيجة واحدة كقولنا: كل جسم مؤلف، وكل مؤلف فمقارن لعرض لا ينفك عنه، وكل عرض فحادث، وكل مقارن لحادث فلا يتقدم عليه، وكل ما لا يتقدم عليه فوجوده معه، وكل ما وجوده معه فهو حادث، فإذن العالم حادث. وكل واحدة من هذه المقدمات تمامها بقياس كامل، حذفت نتائجها وما ظهر من مقمدماتها وسيقت لغرض واحد. وإلا فكان ينبغي أن يقول: كل جسم مؤلف، وكل مؤلف فمقارن لعرض لا ينفك عنه، مقدمة أخرى، وهو أن كل مقارن لعرض لا ينفك عنه. فإذن كل جسم فمقارن لعرض لا ينفك عنه، ثم يبتدىء ويضيف إليه مقدمة أخرى وهو أن كل مقارن لعرض لا ينفك عنه فهو مقارن لحادث، ثم يشتغل بما بعده على الترتيب، ولكن أغنى وضوح هذه النتائج عن التصريح بها. وربما تجري في المخاطبات كلمات لها نتائج، لكن تترك تلك النتائج إما لظهورها
وإما لأنها لا تقصد للإحتجاج، بل تذكر المقدمات تعريفا لها في أنفسها. إعتمادا على قبول المخاطب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " يموت المرء على ما عاش عليه، ويحشر على ما مات عليه " وهاتان مقدمتان نتيجتهما أن المرء يحشر علىماعاش عليه، فحالة الحياة هي الحد الأصغر، وحالة الممات هي الحد الأوسط. ومهما ساوت حالة الحشر حالة الموت، وساوت حالة الموت حالة الحياة، فقد ساوت حالة الحشر حالة الحياة. والمقصود من سياق الكلام تنبيه الخلق على أن الدنيا مزرعة الآخرة، ومنها التزود. ومن لم يكتسب السعادة وهو في الدنيا فلا سبيل له إلى اكتسابها بعد موته، فمن كان في هذه أعمى فهو عند الموت أعمى، أعني عمى البصيرة عن درك الحق والعياذ بالله. ومن كان عند الموت أعمى فهو عند الحشر أعمى كذلك، بل هو أضل سبيلا إذ ما دام الإنسان في الدنيا فله أمل في الطلب، وبعد الموت قد تحقق اليأس. والمقصود أن الكلمات الجارية في المحاورات كلها أقيسة محرفة غيرت تأليفاتها للتسهيل، فلا ينبغي أن يغفل الإنسان عنها بالنظر إلى الصور، بل ينبغي أن لا يلاحظ إلا الحقائق المعقولة دون الألفاظ المنقولة.
؟ النظر الثاني من كتاب القياس في مادة القياس قد ذكرنا ان كل مركب فهو متألف من شيئين: أحدهما كالمادة الجارية منه مجرى الخشب من السرير. والثاني كالصورة الجارية منه مجرى صورة السرير من السرير. وقد تكلمنا على صورة القياس وتركيبه ووجوه تأليفه بما يقنع، فلنتكلم في مادته، ومادته هي العلوم، لكن لا كل علم بل العلم التصديقي دون العلم التصوري، وإنما العلم التصوري مادة الحد، والعلم التصديقي هو العلم بنسبة ذوات الحقائق بعضها إلى بعض بالإيجاب أو السلب، ولا كل تصديقي بل التصديقي الصادق في نفسه، ولا كل صادق بل الصادق اليقينيز فرب شيء في نفسه صادق عند الله وليس يقينا عند الناظر، فلا يصلح أن يكون عنده مادة للقياس الذي يطلب به استنتاج اليقين، ولا كل يقيني بل اليقيني الكلي، أعني أنه يكون كذلك في كل حال. ومهما قلنا مواد القياس هي المقدمات كان ذلك مجازا من وجه، إن المقدمة عبارة عن نطق باللسان يشتمل على محمول وموضوع،
ومادة القياس هي العلم الذي لفظ الموضوع والمحمول دالان عليه لا اللفظ بل الموضوع والمحمول هي العلوم الثابتة في النفس دون الألفاظ، ولكن لا يمكن التفهيم إلا باللفظ، والمادة الحقيقية هي التي تنتهي إليه في الدرجة الرابعة بعد ثلاثة قشور: القشر الأول هو الصور المرقومة بالكتابة. الثاني هو النطق، فإنه الأصوات المرتبة التي هي مدلول الكتابة ودالة على الحديث الذي في النفس. الثالث: هو حديث النفس الذي هو علم بتريب الحروف ونظم الكلام، إما منطوقا به وإما مكتوبا. والرابع: وهو اللباب، هو العلم القائم بالنفس الذي حقيقته ترجع إلى انتقاش النفس بمثال مطابق للمعلوم؛ فهذه العلوم هي مواد القياس وعسر تجريدها في النفس دون نظم الألفاظ بحديث النفس لا ينبغي أن يخيل إليك الإتحاد بين العلم والحديث، فإن الكاتب أيضا قد يعسر عليه تصور معنى إلا أن يتمثل له رقوم الكتابة الدالة على الشيء، حتى إذا تفكر في الجدار تصور عنده لفظ الجدار مكتوبا. ولكن لما كان العلم بالجدار غير موقوف على معرفة أصل الكتابة لم يشكل عليه أن هذا مقارن لازم للعلم لا عنه، وكذلك يتصور أن إنسانا يعلم علوما كثيرة وهو لا يعرف اللغات فلا يكون في نفسه حديث نفس، أعني إشتغالا بترتيب الألفاظ، فإذن العلوم الحقيقية التصديقية هي مواد القياس، فإنها إذا احضرت في الذهن على ترتيب مخصوص استعدت النفس لأن يحدث فيها العلم بالنتيجة
من عند الله تعالى، فإذن مهما قلنا مواد القياس المقدمات اليقينية فلا تفهم منه إلا ما ذكرناه. ثم كما ان صورة الإستدارة والنقش للدينار زائد على مادة الدينار، فإن المادة للدينار هي الذهب الإبريز، فكذا في القياس، وكما أن الذهب الذي هو مادة الدينار له أربعة أحوال: أعلاها أن يكون ذهبا خالصا ابريزا لا غش فيه أصلا. والثانية أن يكون ذهبا مقاربا لا في غاية رتبته العليا، ولا كذلك الذهب الإبريز الخالص. والثالثة: أن يكون ذهبا كثير الغش لاختلاط النقرة والنحاس به. والرابعة: أن لا يكون ذهبا أصلا بل يكون جنسا على حدة مشبها بالذهب؛ فكذلك الإعتقادات التي هي مواد الأقيسة قد تكون اعتقادا مقاربا لليقين مقبولا عند الكافة في الظاهر، لا يشعر الذهن بإمكان نقيضه على القور بل بدقيق الفكر، فيسمى القياس المؤلف منه جدليا إذ يصلح لمناظرات الخصوم وقد يكون إعتقادا بحيث لا يقع به تصديق جزم، ولكن غالب ظن وقناعة نفس مع خطور نقيضه بالبال أو قبول النفس لنقيضه إن أخطر بالبال، وإن وقعت الغفلة عنه في أكثر الاحوال،
ويسمى القياس المؤلف منه خطابيا إذ يصلح لللإيراد في التعليمات والمخاطبات، وقد يكون تارة مشبها باليقين أو بالمشهور المقارب لليقين في الظاهر وليس بالحقيقة كذلك، وهو الجهل المحض، ويسمى القياس المؤلف منه مغالطيا وسوفسطائيا إذ لا يقصد بذلك إلا المغالطة والسفسطة، وهو إبطال الحقائق؛ فهذه أربعة مراتب لا بد من تمييز البعض منها عن البعض. وأما الخامس الذي يسمى قياسا شعريا فليس يدخل في غرضنا فإنه لا يذكرلإفادة علم أو ظن، بل المخاطب قد يعلم حقيقته، وإنما يذكر لترغيب أو تنفير أوتسخية أو تبخيل أو ترهيب أو تشجيع، وله تأثير في النفس، وذلك كنفرة الطبع عن الحلو الأصفر إذا شبه بالعذرة حتى يتعذر في الحال تناولها وإن علم كذب قائله، وعليه تمويل صناعة الشعر، وبه تشبث أكثر المتشدقين من الوعاظ، فإنهم يستعملون في النثر صناعة الشعر، ومثاله أن من يريد أن يحمل غيره على التهور ويصرفه عن الحزم يلقب الحزم بالجبن ويقبحه، ويذم صاحبه فيقول: يرى الجبناء أن الجبن حزم ... وتلك خديعة النفس اللئيم فتنبسط نفس المتوقف إلى التهجيم بذلك. وكقوله: إن لم أمت تحت السيوف مكرما ... أمت وأقاسي الذل غير مكرم
وكذلك إذا أراد التسخية أطنب في مدح السخي وشبهه بما يعلم انه لا يشبهه، ولكن يؤثر في نفسه كقوله:؟؟ وكذلك إذا أراد التسخية اطنب في مدح السخي وشبهه بما يعلم أنه لا يشبهه، ولكن يؤثر في نفسه كقوله: هو البحر من أي الجوانب جئته ... فلجته المعروف والجود ساحله تعوّد بسط الكف حتى لو أنه ... دعاها لقبض لم تطعه أنامله تراه إذا ما جئته متهللا ... كأنك تعطيه الذي أنت سائله ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله آمله وهذه الكلمات كلها أحاديث يعلم حقيقة كذبها، ولكنها تؤثر في النفس تأثيرا عجيبا لا ينكر. وإذ ليس يتعلق هذا الجنس بغرضنا فلنهجر الأطناب فيه ولنرجع إلى الأقسام الأربعة، وإذ قد قبحنا حال الشعر فلا ينبغي أن نتظن أن كل شعر باطل، فإن من الشعر لحكمة، وإن من البيان لسحرا، وقد يدرج الحق في وزن الشعر فلا يخرج عن كونه حقا كقول الشاعر في تهجين البخل ومن ينفق الساعات في جمع ماله ... مخافة فقر فالذي فعل الفقر. فهذا كلام حق صادق ومؤثر في النفس، والوزن اللطيف والنظم الخفيف يروجه ويزيد وقعه في النفس، فلا تنظر إلى صورة الشعر ولاحظ المعاني في الأمور كلها لتكون على الصراط المستقيم. ولنرجع إلى الغرض فنقول: المقدمات تنقسم إلى يقينيات صادقة واجبة القبول وإلى غيرها. وللقسم الأول باعتبار المدرك أربعة أصناف: الصنف الأول: ألأوليات العقلية المحضة، وهي قضايا تحدث في الإنسان من جهة قوته العقلية المجردة من غير معنى زائد عليها يوجب التصديق بها،
ولكن ذوات البسائط إذا حصلت في الذهن إما لمعونة الحس أو الخيال أو وجه آخر وجعلتها القوة المفكرة قضية بأن نسبت أحدها إلى الآخر بسلب أو إيجاب، صدق بها الذهن إضطرارا من غير أن يشعر بأنه من أين استفاد هذا التصديق، بل يقدر كأنه كان عالما به على الدوام كقولنا: إن الإثنين أكثر من الواحد، والثلاثة مع الثلاثة ستة، وان الشيء الواحد لا يكون قديما وحديثا معا، وأن السلب والإيجاب معا لا يصدقان في شيء واحد فقط إلى نظائره. وهذا الجنس من العلوم لا يتوقف الذهن في التصديق به إلا على تصور البسائط، أعني الحدود والذوات المفردة، فمهما تصور الذوات وتفطن للتركيب لم يتوقف في التصديق، وربما يحتاج توقف حتى يتفطن لمعنى الحادث والقديم، ولكن بعد معرفتهما لا يتوقف في الحكم بالتصديق. الصنف الثاني المحسوسات كقولنا: القمر مستدير والشمس منيرة والكواكب كثيرة والكافور أبيض والفحم أسود والنار حارة والثلج بارد، فإن العقل المجرد إذا لم يقترن بالحواس لم يقض بهذه القضايا، وإنما أدركها بواسطة الحواس، وهذه أوليات حسية. ومن هذا القبيل علمنا بأن لنا فكرا وخوفا وغضبا وشهوة وإدراكا وإحساسا، فإن ذلك انكشف للنفس أيضا بمساعدة قوى باطنة، فكأنه يقع متأخرا عن القضايا التي صدق بها العقل من غير حاجة إلى قوة أخرى سوى العقل.
ولا شكل في صدق المحسوسات إذا استثنيت أمور عارضة، مثل ضعف الحس وبعد المحسوس وكثافة الوسائط. الصنف الثالث المجربات وهي أمور وقع التصديق بها من الحس بمعاونة قياس خفي، كحكمنا بأن الضرب مؤلم للحيوان، والقطع مؤلم، وجز الرقبة مهلك، والسقمونيا مسهل، والخبز مشبع، والماء مرو، والنار محرقة؛ فإنالحس أدرك الموت مع جز الرقبة، وعرف التألم عند القطع بهيئات في المضروب، وتكرر ذلك على الذكر فتأكد منه عقد قوي لا يشك فيه، وليس علينا ذكر السبب في حصول اليقين بعد أن عرفنا أنه يقيني،
وربما أوجبت التجربة قضاء جزميا وربما أوجبت قضاء أكثريا، ولا تخلو عن قوة قياسية خفية تخالط المشاهداتن وهي أنه لو كان هذا الأمر اتفاقيا أوعرضيا غير لازم لما استمر في الأكثر من غير اختلاف، حتى إذا لم يوجد ذلك اللازم استبعدت النفس تأخره عنه وعدته نادرا، وطلبت له سببا عارضا مانعا. وإذا اجتمع هذا الإحساس متكررا مرة بعد أخرى، ولا ينضبط عدد
المرات كما لا ينضبط عدد المخبرين في التواتر، فإن كل واقعة ههنا مثل شاهد مخبر، وانضم إليه القياس الذي ذكرناه أذعنت النفس للتصديق. فإن قال قائل: كيف تعتقدون هذا يقينا، والمتكلمون شكوا فيه وقالوا: ليس الجز سببا للموت، ولا الأكل سببا للشبع، ولا النار علة للإحراق،
ولكن الله تعالى يخلق الإحتراق والموت والشبع عند جريان هذه الأمور لا بها؟ قلنا: قد نبهنا على غور هذا الفصل وحقيقته في كتاب تهافت الفلاسفة. والقدر المحتاج إليه الآن أن المتكلم إذا اخبره بأن ولده جزت رقبته لم يشك في موته، وليس في العقلاء من يشك فيه، وهو معترف بحصول الموت وباحث عن وجه الإقتران. وأما النظر في أنه هل هو لزوم ضروري ليس في الإمكان تغييره أو هو بحكم جريان سنة الله تعالى لنفوذ مشيئته الأزلية، التي لا تحتمل التبديل والتغيير، فهو نظر في وجه الإقتران لا في نفس الإقتران، فليفهم هذا وليعلم أن التشكك في موت من جزت رقبته وسواس مجرد، وأن اعتقاد موته يقين لا يستراب فيه، ومن قبيل المجربات الحدسيات، وهي قضايا مبدأ الحكم بها حدس من النفس يقع لصفاء الذهن وقوته وتوليه الشهادة لأمور، فتذعن النفس لقبوله والتصديق له بحيث لا يقدر على التشكك فيه، ولكن لو نازع فيه منازع معتقدا أو معاندا لم يمكن أن يعرف به ما لم يقو حدسه ولم يتول الإعتقاد الذي تولاه ذو الحدس القوي، وذلك مثل قضائنا بأن نور القمر مستفاد من للشمس، وأن انعكاس شعاعه إلى العالم يضاهي انعكاس شعاع المرآة إلى سائر الأجسام التي تقابله، وذلك لإختلاف تشكله عند اختلاف نسبته من الشمس قربا وبعدا وتوسطا. ومن تأمل شواهد ذلك لم يبق له فيه ريبة وفيه من القياس ما في المجربات، فإن هذه الإختلافات لو كانت بالإتفاق أو بأمر خارج سوى الشمس لما استمرت على نمط واحد على طول الزمن،
ومن مارس العلوم يحصل لهمن هذا الجنس على طريق الحدس والإعتبار قضايا كثيرة لا يمكنه إقامة البرهان عليها، ولا يمكنه أن يشك فيها، ولا يمكنه أن يشرك فيها غيره بالتعليم، إلا أن يدل الطالب على الطريق الذي سلكه واستنهجه، حتى إذا تولى السلوك بنفسه أفضاه ذلك السلوك إلى ذلك الإعتقاد وإن كان ذهنه في القوة والصفاء على رتبة الكمال. ولمثل هذا لا يمكن افحام كل مجادل بكلام مسكت، فلا ينبغي أن تطمع في القدرة على المجادلة في كل حق، فمن الإعتقادات اليقينية ما لا نقدر على تعريفه غيرنا بطريق البرهان إلا إذا شاركنا في ممارسته ليشاركنا في العلوم المستفادة منه، وفي مثل هذا المقام يقال: من لم يذق لم يعرف، ومن لم يصل لم يدرك. الصنف الرابع القضايا التي عرفت لا بفنسها بل بوسط ولكن لا يعزب عن الذهن أوساطها، بل مهما احضر جزئي المطلوب حضر التصديق به لحضور الوسط معه كقولنا: الإثنان ثلث الستة، فإن هذا معلوم بوسط وهو أن كل منقسم ثلاثة أقسام متساوية، فأحد الأقسام ثلث والستة تنقسم بالإثنينات ثلاثة أقسام متساوية، فالإثنان إذن ثلث الستة، ولكن هذا الوسط لا يعزب عن الذهن لمقلة هذا العدد وتعود الإنسان التأمل فيه، حتى لو قيل لك: الإثنان والعشرون هي هي ثلث ستة وستين؟ لم تبادر إليه مبادرتك إلى الحكم بأن الإثنين ثلث الستة، بل ربما افتقرت نإلى أن تقسم الستة والستين على ثلاثة،
فإذا انقسمت وحصل أن كل قسم إثنان وعشرون عرفت أن ذلك ثلثه، وهكذا كلما كثر الحساب؛ فهذا وإن كان معلوما برأي ثاني لا بالرأي الأول ولكنه ليس يحتاج فيه إلى تأمل، فهو جار مجرى الأوليات فيصلح لأن يكون من مواد الأقيسة. بل القضايا التي هي نتائج أقيسة ألفت من مقدمات هي من الأصناف الثلاثة السابقة تصلح أن تكون مواد أقيسة ومقدماتها. ؟ القسم الثاني المقدمات التي ليست يقينية ولا تصلح للبراهين، وهي نوعان: نوع يصلح للظنيات الفقهية، ونوع لا يصلح لذلك أيضا. النوع الأول وهو الصالح للفقهيات دون اليقينيات وهي ثلاثة أصناف: مشهورات ومقبولات ومظنونات. الصنف الأول المشهورات مثل حكمنا بحسن إفشاء السلام، وإطعام الطعام وصلة الأرحام وملازمة الصدق في الكلام ومراعاة العدل في القضايا والأحكام، وحكمنا بقبح إيذاء الإنسان وقتل الحيوان ووضع البهتان ورضاء الأزواج بفجور النسوان ومقابلة النعمة بالكفران والطغيان، وهذه قضايا لو خلي الإنسان وعقله المجرد ووهمه وحسه، لما قضى الذهن به قضاء بمجرد العقل والحس، ولكن إنما قضى بها لأسباب عارضة أكدت في النفس هذه القضايا وأثبتتها؛ وهي خمسة: أولها رقة القلب بحكم الغريزة وذلك في حق أكثر الناس حتى سبق إلى وهم قوم أن ذبح الحيوان قبيح عقلا، ولولا أن سياءة الشرع صرفت الناس
عن ذلك إلى تحسين الذبح وجعله قربنا، لعم هذا الإعتقاد أكثر الناس. ومن هذا أشكل على المعتزلة وأكثر الفرق وجه العدل في إيلام البهائم بالذبح والمجانين بالمرض، وزعموا بحكم رقة طباعهم أن ذلك قبيح، فمنهم من اعتذر بانها ستعوض عليها بعد الحشر في الدار الآخرة. ولم ينتبه هؤلاء لقبح صفع الملك ضعيفا ليعطيه رغيفا، مهما قدر على إعطائه دون الصفع، واعتذر فرق بأنها عقوبات على جنايات قارفوها وهم محكلفون وردوا بطريق التناسخ بعد الموت إلى هذه القوالب ليعذبوا فيها، ولم يعلموا أن عقوبة منلا يعرف أنه معاقب فينزجر بسببه قبيح. وإن زعموا أنها تعرف كونها معاقبة على جنايات سبقت كان لها قوة مفكرة، ويلزم عليه تجويز معرفة الذبان والديدان حقائق الأمور وجميع العلوم الهندسية والفلسفية، وهو مناكرة للمحسوس، ثم مهما لم يكن للمعاقب غرض في إنتقام أو تشفي أو دفع ضر في
المستقبل أو لم يكن للمعاقب مصلحة فهو أيضا قبيح، والله قادر على إفاضة النعم على الخلق من غير إيلام، ومن غير تكليف وإلزام، فايذاؤهم بالتكليف أولا وبالعقوبة آخرا أحرى بأن يكون قبيحا مما ذكروه، وجعلوه قبيحا من إيلام البريء عن الجنايات. السبب الثاني ما جبل عليه الإنسان من الحمية والأنفة، ولأجله يحكم باستقباح الرضا بفجور امرأته، ويظن أن هذا حكم ضروري للعقل مع أن جماعة من الناس يتعودون إجارة أزواجهم ليألفوا ذلك ولا ينفروا عنه، بل جميع الزناة يستحسنون الفجور بمرأة الغير ولا يستقبحونه لموافقة شهواتهم، ويستقبحون من ينبه الأزواج عليه ويعرفهم فعل الزناة، ويزعمون أن ذلك غمز وسعاية ونميمة، وهو في غاية القبح. وأهل الصلاح يقولون: هو خيانة وترك الأمانة؛ فتتناقض أحكامهم في الحسن والقبح ويزعمون أنها قضايا العقل، وإنما منشأها هذه الأخلاق التي جبل الإنسان عليها. السبب الثالث محبة التسالم والتصالح والتعاون على المعايش، ولذلك يحسن عندهم التودد بإفشاء السلام وإطعام الطعام ويقبح لديهم السب والتنفير ومقابلة النعمة بالكفران وأمثاله،
ولولا ميلهم إلى أمور تنهض هذه الأسباب وسائل إليها أو صوارف عنها، لما قضت العقول بفطرتها في هذه الأمور بحسن ولا قبح، ولذلك نرى جماعة لا يحبون التسالم ويميلون إلى التغالب، فألذ الأشياء وأحسنها عندهم الغارة والنهب والقتل والفتك. السبب الرابع التأديبات الشرعية لإصلاح الناس، فإنها لكونها تكررت على الأسماع منذ الصبا بلسان الآباء والمعلمين ووقع النشء عليها، رسخت تلك الإعتقادات رسوخا أدى إلى الظن بأنها عقلية كحسن الركوع والسجود والتقرب بذبح البهائم وإراقة دمائها، وهذه الأمور لو غوفص بها العاقل الذي لم يؤدب بقبولها منذ الصبا لكان مجرد عقله لا يقضي بحسن ولا بقبح، ولكن حسنت بتحسين الشرع فاذعن الوهم لقبولها بالتأديب منذ الصبا. السبب الخامس الإستقراء للجزئيات الكثيرة، فإن الشيء متى وجد مقرونا بالشيء في أكثر أحواله ظن أنه ملازم له على الإطلاق، كما يحكم على إفشاء السلام بالحسن مطلقا، لأنه يحسن في أكثر الأحوال ويذهل عن قبحه في وقت قضاء الحاجة، ويحكم على الصدق بالحسن لوجوده موافقا للأغراض مرغوبا في أكثر الأحوالن ويغفل عن قبحه ممن سئل عن مكان نبي أو ولي ليجده السائل فيقتله، بل ربما اعتقد قبح الكذب حينئذ بإخفاء المحل المصادفة الكذب مقرونا بالقبح في أكثر الأحوال. فهذه الأسباب وأمثالها علل قضاء النفس بهذه القضايا وليست هذه القضايا صادقة كلها ولا كاذنبةكلها، ولكن المقصود أن ما هو صادق منها فليس بين الصدق عند العقل بيانا أوليا، بل يفتقر في تحقيق صدقه إلى نظر وإن كان محمودا عند العقل الأول، والصادق غير المحمود، والكاذب غير الشنيع. ورب شنيع حق، ورب محمود كاذب،
وقد يكون المحمود صادقا لكن بشرط دقيق لا يتفطن أكثر الناس له، فيؤخذ على الإطلاق مع أنه لا يكون صادقا إلا مع ذلك الشرط كقولنا: الصدق حسن، وليس كذلك مطلقا بل بشروط، ولفقد بعض الشروط قبح الصدق الذي هو تعريف لموضع النبي المقصود قتله إلى غير ذلك من نظائره. ومهما أردت أن تعرف الفرق بين هذه القضايا المشهورات وبين الأوليات العقلية، فأعرض قولنا: قتل الإنسان قبيح وإنقاذه من الهلاك جميل، على عقلك بعد أن تقدر كأنك حصلت في الدنيا دفعة بالغا عاقلا، ولم تسمع قط تأديبا ولم تعاشر أمة ولم تعهد ترتيبا وسياسة، لكنك شاهدت المحسوسات وأخذت منها الخيالات، فيمكنك التشكيك في هذه المقدمات أو التوقف فيها ولا يمكنك التوقف في قولنا أن السلب والإيجاب لا يصدقان في حال واحدة، وأن الإثنين أكثر من الواحد، فإذن هذه المقدمات لما كانت قريبة من الصدق محتملة الكذب لم تصلح للبراهين التي يطلب منها اليقين وصلحت للفقهيات. الصنف الثاني المقبولات وهي أمور إعتقدناها بتصديق من أخبرنا بها من جماعة ينقص عددهم عن عدد التواتر، أو شخص واحد تميز عن غيره بعدالة ظاهرة أوعلم وافر، كالذي قبلناه من آبائنا وأستاذينا وأئمتنا واستمررنا على إعتقاد، وكأخبار الآحاد في الشرع، فهي تصلح للمقاييس الفقهية دون البراهين العقلية، ولها في إثارة الظن مراتب لا تكاد تخفي؛ فليس المستفيض في الكتب
الصحاح من الأحاديث كالذي ينقله الواحد، ولا ما ينقله أحد الخلفاء الراشدين كما ينقله غيره، ودرجات الظن فيه لا تحصى. الصنف الثالث المظنونات وهي أمور يقع التصديق بها لا على الثبات بل مع خطور إمكان نقيضها بالبال، ولكن النفس إليها أميل كقولنا: إن فلانا إنما يخرج بالليل لريبة، فإن النفس تميل إليه ميلا يبنى عليه التدبير للأفعال، وهي مع ذلك تشعر بإمكان نقيضه، والمشهورات والمقبولات إذا اعتبرت من حيث يشعر بنقيضها في بعض الأحوال، فيجوز أن تسمى مظنونة، وكم من مشهور في بادىء الرأي يورث اعتقادا، فإن تأملته وتعقبته عاد ذلك الإذعان لقبوله ظنا أو تكذيبا كقول القائل: ينبغي أن يمنع من ظلمه وينصر المظلوم عليه، وهو المراد بالحديث المعقول فيه، فإنه سئل عن ذلك فقيل: كيف ينصر الظالم؟ فقال: نصرته أن تمنعه من ظلمه. النوع الثاني ما لا يصلح للطقعيات ولا للظنيات بل لا يصلح إلا للتلبيس والمغالطة، وهي المشبهات أي المشبهة للأقسام الماضية في الظاهر ولا تكون منها، وهي ثلاثة أقسام: الأول الوهميات الصرفة وهي قضايا يقضي بها الوهم الإنساني قضاء جزما
بريا عن مقارنة ريب وشك، كحكمة في إبتداء فطرته بإستحالة وجود موجود لا إشارة إلى جهته، وأن موجودا قائما بنفسه لا يتصل بالعالم ولا ينفصل عنه، ولا يكون داخل العالم ولا خارجه محال، وهذا يشبه الأوليات العقلية مثل القضاء بان الشخص الواحد لا يكون في مكانين في آن واحد، والواحد أقل من الإثنين، وهي أقوى من المشهورات التي مثلناها بأن العدل جميل والجور قبيح، وهي مع هذه القوة كاذبة مهما كانت في أمور متقدمة على المحسوسات أو أعم منها، لأن الوهم إنس بالمحسوسات فيقضي لغير المحسوس بمثل ما ألفه في المحسوس. وعرف كونه كاذبا من مقدمات يصدق الوهم بآحادها لكن لا يذعن للنتيجة، إذ ليس في قوة الوهم إدراك مثلها وهذا أقوى المقدمات الكاذبة، فإن الفطرة الوهمية تحكم بها حسب حكمها في الأوليات العقلية، ولذلك إذا كانت الوهميات في المحسوسات كانت صادقة يقينية وصح الإعتماد عليها كالإعتماد على العقليات المحضة وعلى الحسيات. القسم الثاني ما يشبه المظنونات وإذا بحث عنه أمحى الظن كقول القائل: ينبغي أن تنصر أخاك ظالما كان أو مظلوما، وهو أيضا يشبه المشهورات. وقد يكون ما يشبه المشهورات أو المظنونات مما يتوافق عليه الخصمان في المناظرات من المسلمات، إما على سبيل الوضع وإما على سبيل الإعتقاد، ولكن إذا تكرر تسليمها على أسماع الحاضرين يأنسون بها وتميل نفوسهم
إلى الإذعان لها أكثر من الميل إلى التكذيب، فيعتقد أن ذلك الميل ظن لأن معنى الظن ميل في الإعتقاد، ولكنه ميل بسبب كإعتقادك أن من يخرج بالليل فيخرج لريبة، فإن ميل النفس إلى هذه التهمة لسبب. ولو كرر على سمع جماعة أن الأزرق الأشقر مثلا لا يكون إلا خائنا خبيثا فإذا رأوه كان ميل نفسهم إلى إعتقاد بل خيال محض بسبب بسبب السماع. ولذا قيل: من يسمع يخل. فبين هذا وبين الظنون المحقق فرق ويقرب من هذا المخيلات وهي تشبيه الشيء بشيء، مستقبح او مستحسن لمشاركته إياه في وصف ليس هو سبب القبح والحسن، فتميل النفس بسببه ميلا وليس ذلك من الظن في شيء، وهذا مع أنه أخس الرتب يحرك الناس إلى أكثر الأفعال، وعنه تصدر أكثر التصرفات من الخلق إقداما وإحجاما، وهي المقدمات الشعرية التي ذكرناها، فلا ترى عاقلا ينفك عن التأثر به حتى إن المرأة التي يخطبها الرجل إذا ذكر أن إسمها إسم بعض الهنود أو السودان المستقبحين نفر الطبع عنها لقبح الإسم، فيقاوم هذا الخيال الجمال ويورث محبة ما، وحتى إن علم الحساب والمنطق الذي ليس فيه تعرض للمذاهب بنفي ولا إثبات إذا قيل أنه من علوم الفلاسفة الملحدين، نفر طباع أهل الدين عنه، وهذا الميل والنفرة الصادران عن هذا الجنس ليسا بظن ولا علم، فلا يصلح ما يثيرهما أن يجعل مقدمة لا في القطعيات ولا في الظنيات والفقهيات.
ما يثيرهما ان يجعل مقدمة، لا فى القطعيات ولا فى الظنيات، والفقهيات. القسم الثالث الأغاليط الواقعة إما من لفظ المغلط أو من معنى اللفظ، كما يحصل من مقدمة صادقة في مسمة باسم مشترك فينقله الذهن عن ذلك المسمة إلى مسمى آخر بذلك الإسم عينه، حيث يدق وجه الإشتراك، كالنور إذا أخذ تارة لمعنى الضوء المبصر، وأخرى بالمعنى المراد من قوله تعالى: (الله نُورُ السَمَواتِ والأَرض) . وكذلك قد يكون من الذهول عن موضع وقف في الكلام كقوله تعالى: (وَما يَعلَمُ تَأويلَهُ إِلاّ الله وَالراسِخُونَ في العِلمِ يَقولُونَ آَمَنّا بِهِ) . فإذا أهمل الوقف على الله انعطف عليه قولهوالراسخون في العلم وحصلت مقدمة كاذبة. وقد يكون بالذهول عن الأعراب كقوله تعالى: (إِنّ الله بَريء مِنَ المُشرِكينَ ورَسُولُهُ) . فبالغفلة عن إعراب اللام من قوله ورسوله، ربما يقرأها القارىء بالكسر وتحصل مقدمة كاذبة ونظائر ذلك من حيث اللفظ كثير. وأما من حيث المعنى فمنها ما يحصل من تخيل العكس، فإنا إذا قلنا: كل قود فسببه عمد، فيظن أن كل عمد فهو سبب قود، فإن العمد رؤى ملازما للقود فظن أن القود أيضا ملازم للعمد، وهذا الجنس سباق إلى الفهم، ولا يزال الإنسان مع عدم التنبه لأصله ينخدع به ويسبق إلى تخيله من حيث لا يدري إلى أن ينبه عليه. ومنها ما سببه تنزيل لازم الشيء منزلة الشيء حتى إذا حكم على شيء بحكم ظن أنه يصح على لازمه، فإذا قيل: الصلاة طاعة وكل صلاة تفتقر إلى نية، ظن
أن كل طاعة تفتقر إلى نية من حيث ان الطاعة لازمة للصلاة وليس كذلك، فإن أصل الإيمان ومعرفة الله تعالى طاعة، ويستحيل إفتقارها إلى نية لأن نية التقرب إلى المعبود لا تتقدم على معرفة المعبود، وهذا أيضا كثير التغليط في العقليات والفقهيات، وأسباب الأغاليط مما يعسر إحصاؤها، وفيما ذكرناه تنبيه على ما لم نذكره. فإذن مجموع ما ذكرناه من أصناف هذه المقدمات التي سميناها عشرة: أربعة من القسم الأول وثلاثة من القسم الثاني، وهي مواد الفقهيات، وثلاثة من القسم الأخير وقد ذكرنا حكمها. فإن قال قائل: فبماذا تخالف العقليات الفقهيات؟ قلنا: لا مخالفة بينهما في صورة القياس وإنما يتخالفان في المادة ولا في كل مادة، بل ما يصلح أن يكون مقدمة في العقليات يصلح للفقهيات، ولكن قد يصلح للفقهيات ما لا يصلح للعقليات كالظنيات، وقد يؤخذ ما لا يصلح لهما جميعا كالمشبهات والمغلطات كما يتخالفان في كيفية ما به تصير المقدمة كلية، فإن المقدمات الجزئية في الفقه يتسامح بجعلها كلية، وإنما يدرك ذلك من أقوال صاحب الشرع وأفعاله، وأقوال أهل الإجماع وأقوال آحاد الصحابة أن رؤى ذلك من العقليات ما هو صريح في لفظه بين في طريقه، كالفظ الصريح المسموع من الشارع أو المنقول بطريق التواتر، فإن المتواتر كالمسموع.
فقوله: (ثَلاثَةَ أيامٍ في الحَجِّ وَسَبعَةٍ إذا رَجَعتُم) صريح في لفظه أعني كونه عشرة بين في طريقه، أعني أن القرآن متواتر وقد يكون بينا في طريقه ظاهرا في لفظه كالمراد من قوله: إذا رجعتم. وقد يكون صريحا في لفظه غير بين في طريقه كالنص الذي ينقله الآحاد من لفظ صاحب الشرع، وقد يكون عادما للقوتين كالظاهر الذي ينقله الآحاد. وجملة الألفاظ الشرعية في القضية الكلية والجزئية أربعة أقسام: الأول كلية أريد بها كلية كقوله كل مسكر حرام. الثاني جزئية بقيت جزئية كقوله في الذهب والإبريسم " هذان حرامان على ذكور أمتي " فإنه بقي مختصا بالذكور ولم يتعد إلى الإناث. والثالث كلية أريد بها جزئية كقوله: في سائمة الغنم زكاة، أريد بها ما بلغ نصابا. وقوله: (وَالسارِقُ وَالسارِقَةُ فاقطَعَوا أَيديَهُما) . المراد به بعض السارقين، فإذا أردنا أن نجعل هذه كلية ضممنا إليها الأوصاف التي بان إعتبارها فيه، وقلنا مثلا: كل من سرق نصابا كاملا من حرز مثله لا شبهة له فيه قطع. والنباش أو الذي يسرق الأشياء الرطبة مثلا بهذه الصفة فيقطع؛
هذا هو العادة. والصواب عندنا في مراسم جدل الفقه ان لا يفعل ذلك مهما وجد عموم لفظ، بل يتعلق بعموم اللفظ ويطالب الخصم بالمخصص، وما يدعي من ان الخصوص قد يتطرق إلىالعموم فليس مانعا من التمسك بالعموم على إصطلاح الفقهاء، وإذا اصطلحوا على هذا فالتمسك به أولى من إيراده في شكل قياس، لأنهم ليسوا يقبلون تخصيص العلة. ومهما قلت: كل من سرق نصابا كاملا من حرز مثله قطع، منع الخصم وقال: أهملت وصفا وهو أن لا يكون المسروق رطبا فما الذي عرفك أن هذا غير معتبر، فلا يبقى لك إلا أن تعود إلى العموم وتقول: هوالأصل. ومن زاد وصفا فعلهي الدليل، فإذن التمسك بالعموم أولى إذا وجد. والرابع هو الجزئي الذي أريد به الكلي، فإنا كما نعبر بالعام عن الخاص فنقول: ليس في الأصدقاء خير، ونريد به بعضهم كذلك قد يطلق الخاص ونريد به العام كقوله تعالى: (وَمِنهُم مَن إِن تَأمَنهُ بِدينارِ لا يُؤَدِهِ إليك) فإنه يراد به سائر أنواع أمواله. وكقوله: (وَمَن يَعمَل مِثقالَ ذَرَةٍ خَيراً يَرَه) فيعبر بالقليل عن الكثير، وكقوله تعالى: (وَلا تَقُل لَهُما أُفٍّ) فعبر عن كل ما فيه التبرم به. وكقوله تعالى: (وَلا تَأكلُوا أَموالَكُم بَينَكُم بِالباطِل
وَلا تَأكُلوا أَموال اليَتامى ظُلماً) . والمراد هو الإتلاف الذي أعم من الأكل، ولكن عبر بالأكل عنه. وكقول الشافعي: إذا نهشته حية أو عقرباء فإن كانت من حيات مصر أوعقارب نصيبين وجب القصاص. وليس غرضه التخصيص بل كل ما يكون قاتلا في الغالب، ولكن ذكر المشهور وعبر به عن الكل، فإذا ورد من هذا الجنس لفظ خاص ألغينا خصوصه وأخذنا المعنى الكلي المراد به وقلنا: كل تبرم بالوالدين فهو حرام، وكل إتلاف لمال اليتامى حرام؛ فيحصل معنا مقدمة كلية. فإن قيل: فالمعلوم بواقعة مخصوصة هل هو قضية كلية يفتقر تخصيصها إلى دليل أم هو جزئية فيفتقر تعميمها إلى دليل، وذلك كقوله للأعرابي: (اعتق رقبة) لما قال جامعت في نهار رمضان، وكرجمه ماعزا لما زنى، فهل ينزل ذلك منزلة قوله: كل من زنى فارجموه وكل من جامع أهله في نهار رمضان فليعتق رقبة؟ قلنا: هو كقولك: كل موصوف بصفة ماعز إذا زنى فارجموه، ولك موصوف بصفة الأعرابي إذا هلك وأهلك بجماع أهله في نهار رمضان فليعتق رقبو. ثم صفة الجماع هو الذي وصفه السائل والمعتبر من صفات الأعرابي ما عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم
حتى نزل ترك الإستفصال مع إمكان الإشكال منزلة عموم المقال، حتى إن لم يعرف أنه كان حرا أو عبدا كان هذا كالعوم في حق الحر والعبد، وإن عرف كونه حرا فالعبد ينبغي أن يتكلف الحاقه بان يظهر أنه لا يؤثر الرق بدفع موجبات العبادات، وإنما نزلنا هذا منزلة العام لأنه قد قال حكمي في الواحد حكمي في الجماعة. ولو كنا عرفنا من عاداته أنه يخصص كل شخص بحكم يخالف الآخر لما أقمنا هذا مقام العام، كمن يعلم من أصحاب الظواهر أن المراد بالجزئيات المذكورة في الربويات نفس تلك الجزئيات، ولهذا مزيد تفصيل لا يحتمله هذا الكتاب. وقد بينا عند النظر في صورة القياس، إن الحكم الخاص الجزئي إنما يجعل كليا بستة طرق، وهو بيان أن ما به الإفتراق ليس بمؤثر، وإن ما به الإجتماع هو المناسب أو المؤثر ليكون مناطا، وهو أبلغ في الكشف عن الغرض، وذلك لأن من الجزئيات ما يعلم أن المراد منها كلي، ومنها ما لا يعلم ذلك كمن لم يعلم من أصحاب الظواهر أن المراد بالجزئيات الست المذكورة في الربويات أمر أعم منها، وعرف كافة النظار أن المراد بالبر ليس هو البر بل معنى أعم منه، إذ بقي ربا البر بعد الطحن إذ صار دقيقا وفارقه إسم البر، فعلم أن المراد به وصف عام كلي اشترك فيه الدقيق والبر، ولكن الكلي العام قد يعرف بالبديهة من غير تأمل، كمعرفتنا بان المحرم هو التبرم العام دون التأفف الخاص، وقد يشك فيه كالبر، فإن الدقيق والبر يشتركان في كليات مثل الطعم والإقتيات والكيل والمالية، وإذا وقع الشك فيه لم يمكن إثباته إلا بأحد الطرق الستة التي ذكرناها، والله أعلم.
؟ النظر الثالث في المغلطات في القياس وفيه فصول ؟ الفصل الأول في حصر مثارات الغلط. إعلم أن المقدمات القياسية إذا ترتبت من حيث صورتها على ضرب منتج من الأشكال الثلاثة، وتفصلت منها الحدود الثلاثة أولا، وهي الأجزاء الأولى، إذ تميزت المقدمتان وهي الأجزاء الثواني، وكانت المقدمات صادقة وغير النتيجة واعرف منها، كان اللازم منها بالضرورة حقا لا ريب فيه، والذي لا يحصل منه الحق فإنما لا يحصل لخلل في هذه الجهات التي ذكرناها، إما لخروجه عن الأشكال أو لخروجه عن الضروب المنتجة منها، أو لعدم التمايز في الحدود أو في المقدمات أو لإدراج النتيجة في المقدمات فلا تكون غيرها، أو لأن النتيجة تكون متقدمة على إحدى المقدمات في المعرفة فلا تكون المقدمة أعرف من النتيجة فهذه سبع مثارات؛ فلنشرح كل واحد بمثال حتى يتيسر الإحتراز عنه فنقول: المثار الأول: أن لا تكون على شكل من الأشكال الثلاثة، بأن لا يكون من الحدود حد مشترك
إما موضوع فيهما أو محمول أوموضوع لأحدهما محول للآخر، فإذا انتفى الإشتراك حقيقة ولفظا لم يغلط الذهن فيه، فإن ذلك يظهر وإنما يغلط إذا وجد ما هو مشترك لفظا مع إختلاف المعنى، ولذلك وجب تحقيق القول في الألفاظ المشتركة لا سيما ما يشتبه منها بالمتواطئة، ويعسر فيها درك الفرق، وهو مثار عظيم للأغاليط. وقد ذكرنا تفصيل ذلك على الإيجاز في كتاب مقدمات القياس، إلا أنا لم نذكر ثم إلا الألفاظ التي لا يتحد معناها، وقد يكون الإشتراك سببه النظم والترتيب للألفاظ لا نفس الألفاظ ونحن نذكر من أمثلتها أربعة: ؟ الأول: ما ينشأ من مواضع الوقف والإبتداء كما ذكرنا من قوله تعالى: (إِلاّ الله وَالرَاسِخونَ في العِلم) إذ له معنيان مختلفان، فيطلق أمثاله في إحدى المقدمتين بمعنى وفي الثاني بمعنى آخر، فيبطل الحد المشترك ويظن أن ثم حد مشترك. ؟ الثاني: تردد الضمائر بين أشياء متعددة تحتمل الإنصراف إليها كقولك: كل ما علمه العاقل فهو كما علمه، والعاقل يعمل الحجر فهو كالحجر، فإن قولك: فهو متردد بين أن يكون راجعا إلى العاقل أو إلى المعقول، ويسلم في المقدمة على أنه راجع إلى المعقول، ويلبس في النتيجة فيخيل رجوعه إلى العاقل.
الثالث تردد الحروف الناسقة بين معنيين تصدق في أحدهما وتكذب في الآخر كقوله: الخمسة زوج وفرد، وهو صادق فيظن أنه يصدق قولنا أنه زوج وفرد معا، وسببه إشتباه دلالة الواو فإنه يدل على جمع الأجزاء، إذ تقول الإنسان عظم ولحم أي فيه عظم ولحم، ويدل على جمع الأوصاف كقولنا: الإنسان عظم ولحم أي فيه عظم ولحم، ويدل على جمع الأوصاف كقولنا: الإنسان حي وجسم، فإذن يصدق ما ذكرناه في الخمسة بطريق جمع الأجزاء لا بطريق جمع الصفات، واللفظ كاللفظ. الرابع تردد الصفة بين أن تكون صفة للموضوع وصفة للمحمول المذكور قبله، فإنا قد نقول: زيد بصير أي ليس بضرير. وتقول: زيد طبيب. وإذا نظمنا فقلنا زيد طبيب بصير، ظن أنه بصير في الطب، وهذه الألفاظ تصدق مفرقة وتصدق مجموعة على أحد التأويلين دون الآخر، وأمثال ذلك مما يكثر ويرتفع به شكل القياس من حيث لا يعرف وفيما ذكرناه غنية.
المثال الثاني ألا يكون على ضرب منتج من جملة ضروب الأشكال الثلاثة. مثاله قولك: قليل من الناس كاتب وكل عاقل، فقليل من الناس عاقل. وهذه النتيجة صادقة إن لم ترد بإثبات القليل نفي الكثير، فإن الكثير إذا كان عاقلا ففيه القليل، وإن أريد به أن القليل فقط هو كاتب وعاقل، اختلط نظم القياسس، إذ كان قوله قليل منالناس كاتب يشتمل على مقدمتين بالقوة: إحداهم بعض الناس كاتب، والأخرى إن ذلك البعض قليل، فهما محمولان على البعض. وقد حكم في المقدمة الثانية على أحد المحمولين وهو الكاتب دون الثاني فاختلط النظم، وكذلك إذا قلت: ممتنع أن يكون الإنسان حجرا، وممتنع أن يكون الحجر حيوانا، فممتنع أن يكون الإنسان حيوانا، لأن هذا الضرب ألف من سالبتين غير فيهما اللفظ السلبي، إذ قولك ممتنع أن يكون الإنسان حجرا
معناه لا إنسان واحد حجر، بل هذا القدر كاف لنفي النتيجة، فإن صغرى الشكل الأول مهما لم تكن موجبة لم ينتج أصلا، وإنما تكثر هذه الأغاليط إذا تشبث الذهن بالألفاظ دون أن يحصل المعاني بحقائقها. المثار الثالث: إلا تكون الحدود الثلاثة، وهي الأجزاء الأولى متمايزة متكاملة كقولك: كل إنسان بشرن وكل بشر حيوان، فكل إنسان حيوان. وقولك: كل خمر عقار، وكل عقار مسكر، فكل خمر مسكر. فإن الحد الأوسط هوالحد الأصغر بعينه، وإنما تعدد اللفظ. وهذا من إستعمال الألفاظ المترادفة وهي التي تختلف حروفها وتتساوى حدود معانيها المفهومة، وقد ذكرناها فليحترز منها أيضا. المثار الرابع: ألا تكون الأجزاء الثواني وهي المقدمات متفاضلة، وذلك لا يتفق في الألفاظ المفردة البسيطة إذ يظهر فيها محل الغلط، ولكن يتفق في الألفاظ المركبة، وكم من لفظ مركب يؤدي معنى قوته قوة الواحد أو يمكن أن يدل عليه بلفظ واحد، كما تقول:
الإنسان يمشي. ثم يمكنك أن تبدل لفظ الموضوع بالحيوان الناطق، ولفظ يمشي بأنه ينتقل بنقل قدميه من موضع إلى آخر حتى يطول اللفظ، ويمكنك أن تعين التلبيس فيه. ومن هذا القبيل قولنا: كل ما علمه المسلم، فهو كما علمه، والمسلم يعلم الكافر فهو إذن كالكافر، وهذه المقدمات متمايزة الحدود في الوضع ولكن الخلل في الإتساق، فإنه ترك التصريح بتفصيله، وإلا فقولك ما علمه المسلم موضوع، وقولك فهو كما علمه محمول، ولكن تردد معنى قولك هو، وقد يكون بحيث لا يتميز في الوضع بل يكون فيه جزء يحتمل أن يكون من الموضوع، وأن يكون من المحمول، فإنك تقول: زيد الطويل أبيض، فالمحمول هو الأبيض فقط، والطويل من الموضوع، ويمكن أن يذكر الطويل بصيغة الذي فيرجع إلى زيد بان تقول زيد الذي هو طويل أبيض؛ وإن قلت: زيد طويل أبيض، صار الطويل جزءا من المحمول، وإذا لم يذكر الذي يكون بحيث يحتمل أنيراد به الذي وألا يراد كما تقول الإنسانية من حيث هي إنسانية خاصة أو عامة،
فيحتمل أن يكون الموضوع الإنسانية المجردة والمحمول الخاصة، ويحتمل أن يكون الموضوع الإنسانية فحسب والمحمول الخاصة من حيث هي إنسانية، إذا لو قلت الإنسانية خاصة أو عامة لأخبرت عن شيء واحد. فإذا قلت: الإنسانية من حيث هي إنسانية خاصة أو عامة، أخبرت عن شيئين وكل خبر فهو محمول. ولهذا لو قلت: الإنسانية ليست من حيث هي إنسانية خاصة ولا عامة، صدق. ولو قلت: الإنسانية ليست خاصة ولا عامة، كذب ويفهم الفرق بينهما عند ذكرنا المعنى الكلي في أحكام الوجود، فيتشعب من هذه التركيبات المختلفة أغاليط يعسر حلها على حذاق النظار فضلا عن الظاهريين، ولا تخلص عن مكامن الغلط إلا بتوفيق الله فليستوفق الله تعالى الناظر في هذه العقبات حتى يسلم عن ظلماتها. المثار الخامس: أن تكون المقدمة كاذبة، وذلك لا يخلو غما أن يكون لإلتباس المعنى، فإن لم يكن ثم شيء من هذه الأسباب لم يذعن الذهن له ولم يصدق به، فليس كلام إلا فيما يغلط فيه العقلاء. فأما من يصدق بكل ما يسمع فهو فاسد المزاج، عسر كما إذا اشتركت لفظتان في معنى، وبينهما إفتراق في معنى دقيق، فيظن أن الحكم الذي ألفي صادقا على أحدهما على الآخر، ويقع الذهول عما فيه الإفتراق من زيادة معنى أو نقصانه مع اتحاد
المسمى، وذلك مما يكثر كلفظ الستر والخدر. ولا يقال خدر إلا إذا كان مشتملا على جاريةن وإلا فهو ستر، وكالبكاء والعويل ولا يقال عويل إلا إذا كان معه رفع صوت وإلا فهو بكاء، وقد يظن تساويهما، وكذا الثرى والتراب فإن الثرى هوالتراب ولكن بشرط النداوة، وكذلك المأذق والمضيق فإن المأذق هو المضيق ولكن لا يقال إلا في مواضع الحرب، وكذا الآبق والهارب فإن الآبق هو الهارب ولكن مع مزيد معنى في الهارب، وهو أن يكون من كد وخوف، فغن لم يكن سبب منفر فيسمى هاربا لا آبقا؛ وكما لا يقال لماء الفم رضاب إلا ما دام في الفم فإذا فارقه فهو بزاق، ولا يقال للشجاع كمي إلا إذا كان شاكي السلاح وإلا فهو بطل، ولا يقال للشمس الغزالة إلا عند إرتفاع النهار؛ فهذه الألفاظ متماثلة في الأصل وفيها نوع تفاوت، وقد يظن أن الحكم على أحدها حكم على الآخر فيصدق به لهذا السبب. وأما السبب المعنوي للتغليط فهو أن تكون المقدمة صادقة في البعض لا في الكل، فتؤخذ على أنها كلية وتصدق ويقع الذهول عن شرط صدقها، وأكثرها من سبق الوهم إلى العكس، فإنا إذا قلنا: " كل قود فبعمد وكل رجم فبزنا " فيظن أن كل عمد ففيه قود وإن كل زنا ففيه رجم، وهذا كثير التغليط لمن لم يتحفظ عنه، والذي يصدق في البعض دون الكل قد يكون بحيث يصدق في بعض
الموضوع كقولنا: الحيوان مكلف؛ فإنه يصدق في الإنسان دون غيره، وقد يصدق في كل الموضوع ولكن في بعض الأحوال كقولنا الإنسان مكلف، فإنه لا يصدق في حالة الصبا والجنون، وقد يصدق في بعض الأوقات كقولنا المكلف يلزمه الصلاة، فإنه لا يصدق في وقت الضحى إذ لا يجب فيه صلاة، وقد يصدق بشرط خفي كقولنا: المكلف يحرم عليه شرب الخمر، فإنه بشرط ألا يكون مكرها فيترك الشرط؛ وكذلك قولك: إذا قتل مظلوما هو مثل من قتل؛ وهو صحيح بشرط، أعني ألا يكون القاتل أبا والقتيل إبنا. فهذه الأمور لما كانت تصدق في الأكثر ولا تنتهض كلية صادقة إلا إذا قيدت بالشرط، فربما يذعن الذهن للتصديق ويسلمها على إنها كلية صادقة فيلزم منها نتائج كاذبة. المثار السادس: ان لا تكون المقدمات غير النتيجة فتصادر على المطلوب في المقدمات من حيث لا تدري، كقولك: إن المرأة مولى عليها فلا تلي عقد النكاح، وإذا طولبت بمعنى كونها مولى عليها ربما لم تتمكن من إظهار معنى سوى ما فيه النزاع.
وكذلك قول القائل: يصح التطوع بنية تنشأ نهارا لأنه صوم عين، وإذا طولب بتحقيق معنى كونه صومعين لم يستغن عن أن يجعل النتيجة جزءا منه، إذ يقال له: ما معنى كونه صوم عين؟ فيقول: إنه يصلح للتطوع. فيقال: وبهذا لا يثبت التعين إذ يصلح كل يوم قبل طلوع الفجر للقضاء، ولا يقال صوم عين. وإن قال: معناه أنه لا يصلح لغير التطوع، يقال: وبهذا لا يثبت التعين فإن الليل لا يصلح لغير التطوع، ولا يقال له عين فيضطر إلى ان يجمع بين المعنيين ويقول: معناه أنه يصلح للتطوع ولا يصلح لغيره فيقال: قوله يصلح للتطوع هو الحكم المطلوب علمه، فكيف جعله جزءا من العلة والعلة ينبغي أن تتقوم ذاتها دون الحكم؟ ثم يترتب عليها الحكم فيكون الحكم غير العلة، ونظائر هذا في العقليات تكثر فلذلك لم نذكره. المثار السابع: أن لا تكون المقدمات اعرف من النتيجة، بل تكون إما مساوية لها في المعرفة كالمتشايفات، وذلك من ينازع في كون زيد ابنا لعمرو فيقول: الدليل على أن زيدا ابن لعمرو وهو أن عمرا أبا لزيد، وهذا محال لأنهما يعلمان معا ولا يعلم أحدهما بالآخر، وكذلك من يثبت أن وصفا من الأوصاف علم بقوله: الدليل عليه أن المحل الذي قام به عالم. وهو هوس إذ لا يعلم كون المحل عالما إلا مع العلم يكون الحال في المحل علما.
وقد تكون المقدمة متأخرة في المعرفة عن النتيجة فيكون قياسا دوريان وأمثلته في العقليات كثيرة، وأما في الفقهيات فكأن يقول الحنفيك تبطل صلاة المتيمم إذا وجد الماء في خلالها لأنه قدر على الإستعمال، وكل من قدر على استعمال الماء لزمه، ومن يلزمه استعمال الماء فلا يجوز له ان يصلي بالتيمم، فيجعل القدرة على افستعمال حدا أوسط وبطلان الصلاة نتيجة فيقال: إن أردت به القدرة حسا فيبطل بما لو وجده مملوكا للغير، وإن أردت به القدرة شرعا فيقال: ما دامت الصلاة قائمة يحرم عليه الأفعال الكثيرة، فيحرم الإستعمال، فالقدرة شرعا تحصل ببطلان الصلاة، فالبطلان منتج للقدرة والقدرة سابقة عليه سبق العلة على المعلول، أعني بالذات لا بالزمان، فكيف جعل المتأخر في الرتبة علة لما هو متقدم في الرتبة وهو البطلان؟ فهذه مثارات الغلط وقد حصرناها في سبعة أقسام، ويتشعب كل قسم إلى وجوه كثيرة لا يمكن إحصاؤها. فإن قيل: فهذه مغلطات كثيرة فمن الذي يتخلص منها؟ قلنا: هذه المغلطات كلها لا تجتمع في كل قياس بل يكون مثار الغلط في كل قياس محصورا والإحتياط فيه ممكن، وكل من راعى الحدود الثلاثة وحصلها في ذهنه معاني لا ألفاظا، ثم حمل البعض على البعض وجعلها مقدمتين، وراعى توابع الحمل كما ذكرنا في شروط التناقض، وراعى شكل القياس علم قطعا أن النتيجة اللازمة حق لازم، فإن لم يثق به فليعاود المقدمات ووجه التصديق وشكل القياس وحدوده
مرة أو مرتين، كما يصنع الحساب في حسابه الذي يرتبه إذ يعاوده مرة أو مرتين، فإن فعل ذلك ولم تحصل له الثقة والطمأنينة إذ يعاوده مرة أو مرتين، فإن فعل ذلك ولم تحصل له الثقة والطمأنينة فليهجر النظر وليقنع بالتقليد، فلكل عمل رجال، وكل ميسر لما خلق له. الفصل الثاني في بيان خيال السوفسطانية فإن قال قائل: إذا كانت المقدمات ضرورية صادقة والعقول مشتملة عليها، وهذا الترتيب الذي ذكرتموه في صورة القياس أيضا واضح، فمن أين وقع للسوفسطائية إنكار العلوم والقول بتكافؤ الأدلة؟ أو من أين ثارت الإختلافات بين الناس في المعقولات؟ قلنا: أما وقوع الخلاف فلقصور أكثر الأفهام عن الشروط التي ذكرناها، ومن يتأملها لم يتعجب من مخالفة المخالف فيها، لا سيما وأدلة العقول تنساق إلى نتائج لا يذعن الوهم لها، بل يكذب بها لا كالعلوم الحسابية، فإن الوهم والعقل يتعاونان فيها، ثم من لا يعرف الأمور الحسابية يعرف أنه لا يعرفها، وإن غلط فيها، فلا يدوم غلطه بل يمكن إزالته على القرب. واما العلوم العقلية فليس كذلك، ثم من السوفسطائية من أنكر العلوم الأولية والحسية، كعلمنا بأن الإثنين أكثر من الواحد، وكعلمنا بوجودنا وأن الشيء الواحد إما أن يكون قديما او حادثا،
فهؤلاء دخلهم الخلل من سوء المزاج وفساد الذهن بكثرة التحير في النظريات. وأما الذين سلموا الضروريات وزعموا أن الأدلة متكافئة في النظريات فإنما حملهم عليه ما رأوا من تناقض أدلة فرق المتكلمين، وما اعتراهم في بعض المسائل من شبه وإشكالات عسر عليهم حلها، فظنوا أنها لا حل لها أصلا، ولم يحملوا ذلك على قصور نظرهم وضلالهم وقلة درايتهم بطريق النظر، ولم يتحققوا شرائط النظر كما قدمناه، ونحن نذكر جملة من خيالاتهم ونحلها ليعرف أن القصور ممن ليس يحسن حل الشبه، وإلا فكل أمر إما أن يعرف وجوده ويتحقق أو يعرف عدمه ويتحقق، أو يعلم أنه من جنس ما ليس للبشر معرفته ويتحقق ذلك أيضا، ومثارات خيالهم ثلاثة أقسام: الأول: ما يرجع إلى صورة القياس؛ فمنها قول القائل: إن من أظهر ما ذكرتموه قولكم أن السالبة الكلية تنعكس مثل نفسها، فإذا قلنا لا إنسان واحد حجر واحد إنسان، وتظنون أن هذا ضروري لا يتصور أنيختلف، وهو خطأ إذ حكم الحس به في موضع فظن أنه صادق في كل موضع. فإنا نقول: لا حائط واحد في وتد ولا نقول لا وتد واحد في حائط، ونقول: لا دن واحد في شراب، ولا نقول: لا شراب واحد دن، فنقول: نحن ادعينا أن ذات المحمول مهما عكس على ذات الموضوع بعينه اقتضى ما ذكرناه
كما نقول: لا دن واحد شراب فلا جرم يلزم بالضرورة إنه لا شراب واحد دن، لأن المباينة إذا وقعت فلا جرم يلزم بالضرورة إنه لا شراب واحد دن، لأن المباينة وقعت بين شيئين كلية كانت من الجانبين، إذ لو فرض الإتصال في البعض كذبت كون المباينة كلية، وهذا المثال لم يعكس على وجهه ولم يحصل المعنيات اللذان المباينة بينهما، فإذا حصل لزم العكس، فإنا إذا قلنا: لا حائط واحد في الوتد، فالمحمول قولنا في الوتد لامجرد الوتد، فإذا وقعت المباينة بين الحائط وبين الشيء الذي قدرناه في الوتد فعكسه لازم، وهو أن كل ما هو في الوتد فليس بحائط، فلا جرم نقول: لا شيء واحد مما هو في الوتد حائط ولا شيء واحد مما هو في الشراب دن، وحل هذا إنما يعسر على من يتلقى هذه الأمور من اللفظ لا من المعنى. وأكثر الأذهان يعسر عليها درك مجردات المعاني من غير التفات إلى الألفاظ. ومنها قول القائل: ادعيتم أن الموجبة الكلية تنعكس موجبة جزئية،
حتى إذا صح قولنا كل إنسان حيوان صح قولنا لا محالة بعض الحيوان إنسان. وليس كذلك فإنا نقول: كل شيخ قد كان شابا ولا نقول بعض الشبان قد كان شيخا، وكل خبز فقد كان برا ولا نقول بعض البر قد كان خبزا فنقول: مثار الغلط ترك الشرط في العكس، فإنه إذا أدخل بين الموضوع والمحمول قولنا قد كان، فإما أن يراعي في العكس وإما أن يلغى من كلتا القضيتين، فإن الغي هذا كذبت المقدمتان جميعا، وهو أن نقول كل شيخ حدث وكل حدث شيخ، وهو موضوع ومحمول مجرد، فإذا قلت: كل شيخ فقد كان شابا فعكسه بعض من كان شابا شيخ، وذلك مما يلزم لا محالة أن صدق الأول، فمن لم يتفطن لمثل هذه الأمور يضل فيحكم بلزوم الضلال في نفسه ويظن إلاّ طريق إلى معرفة الحق.
ومنها تشككهم في الشكل الأول وقولهم: أنكم ادعيتم كونه منتجا وقول القائل الإنسان وحده ضحاك وكل ضحاك حي فالإنسان وحده حي، فالنتيجة خطأ والشكل هو الشكل الأول فإنهما موجبتان كليتان، وإن جعلت قولنا الإنسان وحده ضحاك جزئية، جاز أن تكون هي الصغرى، ولا يشترط في الشكل الأول إلا كون الكبرى كلية فنقول منشأ الغلط ان قوله وحده لم يراع في المقدمة الثانية وأعيد في النتيجة، ولا يشترد في الشكل الأول إلا كون الكبرى كلية فنقول منشأ الغلط أن قوله وحده لم يراع في المقدمة الثانية وأعيد في النتيجة، فينبغي الإيعاد أيضا في النتيجة حتى يلزم أن الإنسان حي، أو يعاد في المقدمة الثانية حتى تصير كاذبة فيقال والضحاك وحده حي، فإن معنى قولنا الإنسان وحده ضحاك أن الإنسان دون غيره ضحاك، فهما على التحقيق مقدمتان: إحداهما أن الإنسان ضحاك، والأخرى أن غير الإنسان ليس بضحاك. فإذا قلت: والضحاك حي، حكمت على محمول إحدى المقدمتين، وهي قولك
الإنسان ضحاك وتركت الحكم على محمول المقدمة الثانية، وهي قولنا غير الإنسان ليس بضحاك، فإذا اقتصرت في إحدى المقدمتين على شيء فاقتصر في النتيجة عليه وقل الإنسان حي ولا تقل وحده، لأن الحكم يتعدى من الحد الأوسط إلى الأصغر مهما حكمت على الأوسط، والأوسط ههنا هو الضحاك مثبتا للإنسان منفيا عن غيره، فالحكم الذي على الضحاك ينبغي أن يكون محمول على جزئيه جميعا ولم تتعرض في المقدمة الثانية التي تذكر فيها محمول الأوسط للجزء الثاني من الأوسط؛ فمن أمثال هذا تضل الأذهان الضعيفة، والإنسان إذا تعذر عليه شيء لم تسمح نفسه بأن يحيل على عجز نفسه، فيظن أنه ممتنع في ذاته ويحكم بأن النظر ليس طريقا موصلا إلى اليقين وهو خطأ. ومنها قولهم: الإثنان ربع الثمانية، والثمانية ربع الإثنين والثلاثين، فالإثنان ربع الإثنين والثلاثين، وهذا من إهمال شرط الحمل في الإضافيات، وسببه ظاهر إذ نتيجة هذا أن الإثنين ربع ربع الإثنين والثلاثين، ثم إن صحت مقدمة أخرى وهي أن ربع الربع ربع، صح ما ذكروه.
وإذا قلنا: زيد مثل عمرو وعمرو مثل خالد، لم يلزم أن يكون زيد مثل خالد بل اللازم أن زيدا مثلا مثل مثل خالد، فإن صح لنا مقدمة أخرى وهي أن مثل المثل مثل، فعند ذلك تصح النتيجة فقد أهملوا مقدمة لا بد منها وهي كاذبة فليحترز عن مثله. ومنها قولهم: ممتنع أن يكون الإنسان حجرا وممتنع أن يكون الحجر حيان فممتنع ان يكون الإنسان حيا. وقد ذكرنا وجه الغلط فيه، وإنهما سالبتان لا ينتجان وضعا بصفة افيجاب، وكما أن الموجبة قد تظن سالبة في قولنا زيد غير بصير، فكذلك السالبة تظن موجبة في قولنا ممتنع أن يكون الإنسان حجرا؛ وكل ذلك لملاحظة الألفاظ دون تحقيق المعاني. ومنها قولهم: العظم لا في شيء من الكبد، والكبد في كل إنسان فالعظم لا في شيء من الإنسان، والنتيجة خطأ، فإذا تأملت هذا عرفت مثار الغلط فيه من الطريق الذي ذكرناه
وكذلك يتشكك في الشكل الثاني والثالث بأمثال ذلك، وبعد تعريف الطريق لا حاجة إلى تكثير الأمثلة؛ فهذه هي الشكوك في صورة القياس. القسم الثاني في الشكوك التي سببها الغلط في المقدمات. فمنها أنهم يقولون نرى أقيسة متناقضة، ولو كان القياس صحيحا لما تناقض موجبها. مثاله: من ادعى أن القوة المدبرة من الإنسان في القلب استدل عليه بأني وجدت الملك المدبر يتوطن وسط مملكته والقلب في وسط البدن. ومن ادعى أنهاف ي الدماغ استدل بأني وجدت أعالي الشيء أصفى وأحسن من أسافله والدماغ أعلى من القلب. ومثاله أيضا قول القائل: إن الرحيم لا يؤلم البريء عن الجناية، والله أرحم الراحمين فإذن لا يؤلم برئيا عن الجناية، وهذه النتيجة كاذبة إذ نرى أن الله تعالى يؤلم الحيوانات والبهائم والمجانين من غير جناية منهم، فنشك في قولنا أنه أرحم الراحمين، أو في قولن أن الريحم لا يؤلم من غير فائدة، مع القدرة على ترك الإيلام. ومثاله أيضا قول القائل: التنفس فعل إرادي كالمشي لا كالنبض، لأنا نقدر على الإمتناع منه؛ وقائل آخر يقول:
ليس بإرادي إذ لو كان إراديا لماكنا نتنفس في النوم ولكنا نقدر على الإمتناع منه في كل وقت أردنا كالمشي، ونحن لا نقدر على إمساك النفس في كل وقت فتناقض النتيجتان. ومثاله أيضا قولنا: أن كل موجود فأما متصل بالعالم وإما منفصل، وما ليس بمتصل ولا منفصل فليس بموجود، فهذا أولي. وقد ادعى جماعة بأقيسة مشهورة وأنتم منهم أن صانع العالم ليس داخل العالم ولا خارجه، فكيف يوثق بالقياس؟ وكذلك ادعى قوم أن الجوهر لا يتناهى في التجزي، ونحن نعلم ان كل ما له طرفان وهو محصور بينهما فهو متناهي، وكل جسم فله طرفان وهومحصور بينهما فهو إذن متناهي. وادعى قوم أنه يتناهى إلى جزء لا ينقسم، ونحن نعلم أن كل جوهر بين جوهرين فإنه يلاقي أحدهما بغير ما يلاقي به الآخر، فإذن فيه شيئان متغايران وهذا القياس أيضا قطعي كالأول بلا فرق ومثاله أيضا ما نعمل بالضرورة من أن الثقيل لا يقف في الهواء، وقد قال جماعة أن الأرض واقفة في الهواء والهواء محيط بها
والناس معتمدون عليها من الجوانب، حتى أن الواقفين على نقطتين متقابلتين من كرة الأرض تتقابل أخمص أقدامهما، ونحن بالضرورة نعلم ذلك؛ فهذا وأمثاله يدل على أن المقاييس ليست تورث الثقة واليقين، فنقول كما أن الأول شك نشأ من الجهل بصورة القياس فهذا نشأ من الجهل بمادة القياس، وهي المقدمات الصادقة اليقينية والفرق بينها وبين غيرها. فمهما سلم ما لا يجب أن يسلم لزم منه لا محالة نتائج متناقضة. فأما الأول من هذه الأمثلة فهو قياس ألف من مقدمات وعظيمة خطابية، إذ أخذ فيه شيء واحد ووجد على وجه فحكم به على الجميع. ونحن قد بينا ان الحكم على الجميع بجزئيات كثيرة ممتنع فكيف الحكم بجزئي واحد، بل إذا كثرت الجزئيات لم تفد إلا الظن، ثم لا يزال يزداد الظن قوة بكثرة الأمثلة ولكن لا ينتهي إلى العلم. وأما الثاني فمؤلف من مقدمات مشهورة جدلية سلم بعضها من حيث استبشع نقيضها، إما لما فيه من مخالفة الجماهير وإما لما فيه من مخالفة ظاهر لفظ القرآن، وكم من إنسان يسلم الشيء لأنه يستقبح منعه أو لأنه ينفر وهمه عن قبول نقيضه، وقد نبهنا على هذا في المقدمات. وموضع المنع فيه وصف الله بالرحمة على الوجه الظاهر الذي فهمه العامة، والله تعالى مقدس عنه، بل لفظ الرحمة والغضب مؤول في حقه كلفظ النزول والمجيء وغيرها، فإذا أخذ بالظاهر وسلم لا عن تحقيق لزمت النتيجة الكاذبة،
وكونه رحيما بالمعنى الذي تفهمه العامة مقدمة ليست أولية، وليس يدل عليها قياس بالشرط المذكور، فمحل الغلط ترك التأويل في مجل وجوبه، وعلىهذا ترى تناقض أكثر أقيسة المتكلمين، فإنهم ألفوها من مقدمات مسلمة لأجل الشهرة أو لتواضع المتعصبين لنصرة المذاهب عليها من غير برهان، ومن غير كونها أولية واجبة التسليم. وأما الثالث فاليقين والصحيح انه فعل إرادي، وقول من قال: لو كان إراديا لما كان يحصل في النوم ولكنه يحصل فيه فليس بإرادي، فهو شرطي متصل إستثنى فيه نقيض التالي واستنتج نقيض المقدم، فصورة القياس صحيحة ولكن لزوم التالي للمقدم غير مسلم، فإن الفعل الإرادي قد يحصل في النوم فكم من نائم يمشي خطوات مرتبة ويتكلم بكلمات منظومة، وقوله: لو كان إراديا لقدر على الإمتناع منه في كل وقت، فغير مسلم بل يأكل الإنسان ويبول بالإرادة ولا يقدر على الإمتناع في كل وقت، لكن يقدر علىالإمتناع في الجملة لا مقيدا بكل وقت، فإن قيد بكل وقت كان كاذبا ولم يسلم لزوم التالي للمقدم. وأما الرابع وهو أن كل موجود فأما متصل بالعالم أو منفصل، فهي مقدمة وهمية ذكرنا وجه الغلط فيها وميزنا الوهميات، وبينا أنها لا تصلح أن تجعل مقدمات في البراهين، وهو منشأ الضلال أيضا في مسألة الجزء الذي لا يتجزأ ولكن ذكر الموضع الذي يغلط الوهم فيه طويل يستقصى في كتاب غير هذا الكتاب. وأما الخامس وهووقوف الأرض في الهواء فلا استحالة فيه، وقول القائل: كل ثقيل فمائل إلى أسفل،
والأرض ثقيلى فينبغي أن تميل إلى أسفل، ومن ذلك يلزم أن تخرق الهواء ولا تقف، غلط منشأه إهمال لفظ الأسفل وأنه ما معناه، فغن الأسفل يقابله أعلى فلا بد من جهتين متقابلتين، وتقابل الجهتين إما أن يكون بالإضافة إلى رأس الآدمي ورجله حتى لو لم يكن آدمي لم يكن أسفل ولا أعلى ولو انتكس آدمي لصار جهة الأسفل أعلى وهو محال، وإما أن يكون الأسفل هو أبعد المواضع عن الفلك المحيط وهنوالمركز، والأعلى هو أقرب المواضع إلى المحيط، فإن صح هذا فالأرض إذا كانت في المركز فهي في أسفل سافلين، فلا يتصور أن تنتقل لأن أسفل سافلين غاية البعد عن المحيط وهوالمركز، ومهما جاوزت المركز في أي جانب كان، فارقت الأسفل إلى جهة الأعلى، فإن كان المعنى بالأسفل هذا فما ذكروه ليس بمحال، وأن كان المعنى بالأعلى والأسفل ما يحاذي جهة رأسنا وقدمنا فما ذكروه محالن فتأمل جدا حد الأسفل حتى يتبين لك أحد الأمرين، وإنما تعرف ذلك بالنظر في حقيقة الجهة وأنها بم تتحد أطرافها المتقابلة، ولا يمكن شرحه في هذا الكتاب. فإذن هذه الأغاليط نشأت من تسليم مقدمات ليست واجبة التسليم، ومثاراتها قد جرى التنبيه عليها، فليقس بما ذكرناه ما لم نذكره. القسم الثالث: شكوك تتعلق
بالنتيجة من وجه وبالمقدمة من وجه. منها قولهم: هذه النتائج إن حصلت من المقدمات فالمقدمات بماذا تحصل، وإن حصلت من مقدمات أخرى وجب التسلسل إلى غير النهاية وهو محال، وإن كانت حصلت من المقدمات التي تفتقر إلى مقدمات فهل هي علوم حاصلة في ذهننا منذ خلقنا، أو حصلت بعد أن لم تكن؟ فإن كانت حاصلة منذ خلقنا فكيف كانت حاصلة ولا نشعر بها، إذ ينقضي على الإنسان أطول عمره ولا يخطر بباله أن الأشياء المساوية لشيء واحد متساوية، فكيف يكون العلم بكونها متساوية حاصلا في ذهنه، وهو غافل عنه؟ وإن لم تكن حاصلة فينا أول الأمر ثم حدثت فكيف حدث علم لم يكن بغير اكتساب، وتقدم مقدمة يحصل بها وكل علم مكتسب فلا يمكن إلا بعلم قد سبق ويؤدي إلى التسلسل؟ قلناك كل علم مكتسب فبعلم قد سبق اكتسب، إذ العلم إما تصور أو تصديق، والتصور بالحد وأجزاء الحد ينبغي أن تعلم قبل الحد، فماذا ينفع قولنا في تحديد الخمر: إنه شراب مسكر معتصر من العنب لمن لا يعرف الشراب والمسكر والعنب والمعتصر؟ فالعلم بهذه الأجزاء سابق، ثم هي أيضا إن عرفت بالتحديد وجب أن يتقدمها علم بأجزاء الحد ويتسلسل، ولكن ينتهي إلى تصورات هي أوائل عرفت بالمشاهد بحس باطن أو ظاهر من غير تحديد، وعليها ينقطع. وكذلك التصديق بالنتيجة فإنه يستدعي تقدم العلم بالمقدمات لا محالة، وكذا المقدمات إلى ان يرتقي إلى أوائل حصل التصديق بها لا بالبرهان،
فيبقى قولهم: إن تلك الأوائل كيف كانت موجودة فينا ولا نشعر بها أو كيف حصلت بعد أن لم تكن من غير اكتساب ومتى حصلت؟ فنقول: تيك العلوم غير حاصلة بالفعل فينا في كل حال، ولكن إذا تمت غريزة العقل فتيك العلوم بالقوة لا بالفعل، ومعناه أن عندنا قوة تدرك الكليات المفردات بإعانة من الحس الظاهر والباطن، وقوة مفكرة حادثة للنفس شأنها التركيب والتحليل وتقدر على نسبة المفردات بعضها إلى بعض، وعندنا قوة تدرك ما أوقعت القوة المفكرة النسبة بنيهما من المفردات والنسبة بينهما بالسلب والإيجاب، فتدرك القديم والحادث وتنسب أحدهما إلى الآخر، فتسبق القوة العاقلة إلى الحكم بالسلب، وهو أن القديم لا يكون حادثا، وتنسب الحيوان إلى الإنسان فتقضي بأن النسبة بينهما الإيجاب، وهو أن الإنسان حيوان. وهذه القوة تدرك بعض هذه النسب من غير وسط، ولا تدرك بعضها فتتوقف إلى الوسط، كما تدرك العالم والحادث والنسبة بينهما، فلا تقضي بالسلب كما قضت بين القديم والحادث، ولا يالإيجاب كما قضت في الحيوان والإنسان، بل تتوقف إلى طلب وسط وهو أن تعرف انه لا يفارق الحوادث فلا يسبقها، وإن ما لا يسبق الحوادث فهو حادث. فإن قيل: فهذه التصديقات قسمتموها إلى ما يعرف بوسط وإلى ما يعرف معرفة اولية بغير وسط، ولكن هذه التصديقات يسبقها التصورات لا محالة، إذ لا يعلم أن
العالم حادث من لم يعلم الحادث مفردا والعالم مفردا، ولا يعلم الحادث إلا من علم وجودا مسبوقا بعدم، ولا يعلم الوجود المسبوق بعدم من لا يعلم العدم والوجود والتقدم والتأخر، وإن التقدم هنا هو للعدم والتأخر للوجود؛ فهذه المفردات لا بد من معرفتها، وإما مدركها فغن كان هذا الحس فالحس لا يدرك إلا شخصا واحدا فينبغي أن لا يكون التصديق إلا في شخص واحد، فإذا رأى شخصا وجملته اعظم من جزئه فلم يحكم بأن كل شخص فكله أعظم من جزئه، وهو لم يشاهد بحسه إلا شخصا معينا، فليحكخم على ذلك الشخص المعين وليتوقف في سائر الأشخاص إلى المشاهدة، وإن حكم على العموم بان كل فهو أعظم من الجزء، فمن أين له هذا الحكم وحسه لم يدرك إلا شخصا جزئيا؟ قلنا الكليات معقولة لا محسوسة والجزئيات محسوسة لا معقولة، والأحكام الكلية للعقل على الكليات المعقولة، وينكشف هذا بالفرق بين المعقول والمحسوس، فإن الإنسان معقول وهو محسوس يشاهد في شخص زيد مثلا، ونعني بكونه مدركا من وجهين أن الإنسان المحسوس قط لا يتصور أن يحس إلا مقرونا بلون مخصوص وقدر مخصوص ووضع مخصوص وقرب او بعد مخصوص، وهذه الأمور عرضية مقارنة للإنسانية ليست ذاتية فيها، فإنها لو تبدلت لكان الإنسان هو ذلك الإنسان. فأما الإنسان المعقول فهو إنسان فقط، يشترك فيه الطويل والقصير
والقريب والبعيد والأسود والبيض والأصغر والأكبر إشتراكا واحدا، فإذن عندك قوة يحضرها الإنسان مقترنا بامور غريبة عن الإنسانية، ولا يتصور أن تحضرها إلامقرونة بهذه الأمور الغريبة فتسمى تلك القوة حسا وخيالا، وعندك قوة أخرى يحضرها الإنسان مجردا عن الأمور الغريبة، وإن فرضت أضدادها لم تؤثر فيه وتسمى تلك قوة عاقلة، فقد ظهر لك أن بين إدراك الحس للشخص المعين الذي تكتنفه أعراض غريبة لا تدخل في ماهيته، وبين إدراك العقل بمجرد ماهية الشيء غير مقرون بما هو غريب عنه، غاية التباعد والأحكام الكلية على الماهية الكلية المجردة عن المواد والأعراض الغريبة. فإنقيل: وكيف حصل بمشاهدة شخص جزئي علم كلي؟ وكيف أعان الحس على تحصيل ما ليس بمحسوس؟ قلنا: الحس يؤدي إلى القوة الخيالية مثل المحسوسات وصورها حتى يرى الإنسان شيئا، ويغمض عينيه فيصادف صورة الشيء حاضرة عنده على طبق المشاهد، حتى كأنه ينظر إليه بالقوة الخيالية غير قوةالحس، وليست هذه القوة لكل الحيوانات بل من الحيوانات ما تغيب صورة المحسوس عنه بغيبة المحسوس، وإنما بقاء هذه الصور بالقوة الحافظة لما انطبع في الخيال، إذ ليس يحفظ الشيء ما يقبله بالقوة التي تقبله إذ الماء يقبل النقش ولا يحفظه، والشمع يقبل ويحفظ، فالقبول بالرطوبة والحفظ باليبوسة. ثم هذه المثالات والصور إذا حصلت في القوة الخيالية، فالقوة الخيالية
تطالعها ولا تطالع المحسوسات الخارجة، فإذا طالعتها وجدت عندها مثلا صورة شجرة وحيوان وحجر، فتجدها متفقة في الجسمية ومختلفة في الحيوانية، فتميز ما فيه الإتفاق وهو الجسمية وتجعله كليا واحدا، فتعقل الجسم المطلق وتأخذ ما فيه الإختلاف وهوالحيوانية وتجعله كليات اخرى مجردة عن غيرها من القرائن، ثم تعرف ما هو ذاتي وماهوغريب فتعلم أن الجسمية للحيوان ذاتي، إذ لو انعدم لانعدم ذاته، وأن البياض للحيوان ليس كذلك فيتميز عندها الذاتي من غير الذاتي والأعم عن الأخص، وتكون تلك مبادي التصورات النوعية؛ فهذه المفردات الكلية حاصلة بسبب الإحساس وليست محسوسة، ولا يتعجب من أن يحصل مع الإحساس ما ليس بمحسوس، فإن هذا موجود للبهائم إذ الفارة تميز السنور وتدركه بالحس وتعرف عداوته لها، والسخلة تدرك موافقة أمها لها فتتبعها. والعداوة او الموافقة ليست بمحسوس بل هي مدرك قوة عند الحيوان تسمى الوهم أو المميز، وهي للحيوان كالعقل من الجزئيات الخيالية مفردات كلية تناسب الخيال من وجه وتفارق من وجه،
وسنبين وجه مناسبته له ومفارقته في كتاب أحكام الوجود وأقسامه. وحاصل الكلام أن العلوم الأول بالمفردات تصورا وبما لها من النسب تصديقا، تحدث في النفس من الله تعالى أو من ملك من ملائكته عند حصول قوة العقل للنفس، وعند حصول مثل المحسوسات في الخيال ومطالعته لها، والقوة العقلية كأنها القوة الباصرة في العين ورؤية الجزئيات الخيالية كتحديق البصر إلى الأجسام المتلونة، وإشراق نور الملك على النفوس البشرية يضاهي إشراق نور السراج على الأجسام المتلونة أو إشراق نور الشمس عليها، وحصول العلم بنسبة تلك المفردات يضاهي حصول الأبصار بائتلاف ألوان الأجسام، ولذلك شبه الله تعالى هذا النور على طريق ضرب مثال محسوس بمشكاة فيها مصباح، وإن بان لك أن النفس جوهر قائم بنفسه ليس بجسم ولا هو منطبع في جسم كان قوله تعالى: (زيتونَةٍ لا شَرقِيَةٍ وَلا غَربِيَة) موافقة لحقيقته في براءته عن الجهات كلها، وإن لم يبين لك ذلك بطريق النظر فيكون تأويل هذا مثيل على وجه آخر. والمقصود من هذا كله أن يتضح لك وجه حصول العلوم الأولية تصورا وتصديقا، فإن معرفة ذلك من أهم الأمور وإياه قصدنا، وإن أوردناه في معرض إبطال السفسطة فهذا مدخل واحد من مداخل المتشككين وأهل الحيرة وقد كشفناه. ومنها قولهم: أن الطريق الذي ذكرتموه في الإنتاج لا ينتفع به، لأن من علم المقدمات على شرطكم فقد عرف النتيجة مع تلك المقدمات، بل في المقدمات عين النتيجة، فإن من عرف أن الإنسان حيوان
وأن الحيوان جسم، فيكون قد عرف في جملة ذلك أن الإنسان جسم، فلا يكون العلم بكونه جمسا علما زائدا مستفادا من هذه المقدمات. قلنا: العلم بالنتيجة علم ثابت زائد على العلم بالمقدمتين. وأما مثال الإنسان والحيوان فلا نورده إلا للمثال المحض، وإنما ينتفع بهب فيما يمكن أن يكون مطلوبا مشكلا، وليس هذا من هذا الجنس بل يمكن أن لا يتبين للإنسان النتيجة، وإن كان كل واحدة من المقدمتين بينة عنده فقد يعلم الإنسان أن كل جسم مؤلف، وأن كل مؤلف حادث، وهو مع ذلك غافل عن نسبة الحدوث إلى الجسم، وأن الجسم حادث فنسبة الحدوث إلى الجسم غير نسبة الحدوث إلى المؤلف، وغير نسبة المؤلف إلى الجسم بل هو علم حادث يحصل عند حصول المقدمتين وإحضارهما معا في الذهن، مع توجه النفس نحو طلب النتيجة.
فإن قال قائل: إذا عرفت ان كل اثنين زوج فهذا الذي في يدي زوج أم لا؟ فإن قلت: لا أدري فقد بطل دعواك بأن كل إثنين زوج، فإنه إثنان ولم تعرف أنه زوج، وإن قلت أعرفه فما هو؟ قلنا: قد يجاب عن هذا بأن من قال
أن كل اثنين زوج فيعني به أن كل إثنين نعرفه إثنين فهو زوج، وما في يدك لم نعرف أنه إثنان. وهذا الجواب فاسد بل كل إثنين فهو في نفسه زوج، سواء عرفناه أو لم نعرفه، لكن الجواب أن نقول: إن كان ما في يدك إثنين فهو زوج. فإن قلت: فهل هو إثنان فأقول: لا أدري. وهذا الجهل لا يضاد قولي إن كل اثنين زوج، بل ضده أن أقول: كل إثنين ليس بزوج أو بعض الإثنين ليس بزوج. فإذن ينبغي أن نتعرف أنه هل هو بزوج أو بعض الإثنين ليس بزوج. فإذن ينبغي أن نتعرف أنه هل هو إثنان، فإن عرفنا أنه إثنان علمنا انه زوج، وأخطرنا ذلك بالبال ويتصور أن تغفل عن النتيجة مع حضور المقدمتين، فكم من شخص ينظر إلى بغلة منتفخة البطن فيظن أنها حامل. ولو قيل له: أما تعلم أن هذه بغلة؟ فيقول: نعم. ولو قيل له: أما تعلم أن البغل لا يحمل؟ لقال: نعم. فلو قيل: فلم غفلت عن النتيجة وظننت ضدها؟ فيقول: لأني كنت غافلا عن تأليف المقدمتين وإحضارهما جميعا في الذهن متوجها إلى طلب
النتيجة؛ فقد انكشف بهذا أن النتيجة، وإن كانت داخلة تحت المقدمات بالقوة
دخول الجزئيات تحت الكليات، فهي علم زائد عليها بالفعل. ومنها قول بعض المتشككين: أنك لو طلبت بالتأمل علما فذلك العلم تعرفه أم لا، فإن عرفته فلم تطلبه وإن لم تعرفه فإن حصلته فمن أين تعلم أنه مطلوبك؟ وهل أنت إلا كمن يطلب عبدا آبقا لا يعرفه فإن وجده لم يعرف أنه هو أم لا؟ فنقول: العلم الذي نطلبه نعرفه من وجه ونجهله من وجه إذ نعرفه بالتصور بالفعل ونعرفه بالتصديق بالقوة، ونريد أن نعرفه بالتصديق بالفعل، فإنا إذا طلبنا العلم بأن العالم حادث فنعلم الحدوث والعالم بالتصور، وإنا قادرون على التصديق به إن ظهر حد أوسط بين العالم والحدوث، كمقارنة الحوادث أو غيرها؛ فإنا نعلم أن المقارن للحوادث حادث، فإن علمنا ان العالم مقارن للحوادث علمنا بالفعل أنه حادث، وإذا علمناه عرفنا أنه مطلوبنا إذ لو لم نعرفه بالتصور من قبل لما عرفنا أنه المطلوب، ولو كنا نصدق به بالفعل لما كنا نطلبه كالعبد الآبق نعرفه بالتصور والتخيل من وجه ونجهل مكانه، فإذا أدركه الحس في مكانه دفعة علمنا أنه المطلوب، ولو لم نكن نعرفه لما عرفناه عند الظفر به، فلو عرفناه من كل وجه أي عرفنا مكانه لما طلبناه؛ فهذا ما أردنا أن نورده من الشبه المشككة المحيرة للسوفسطائية، ولم يكن الغرض في إيراده مناظرتهم بل الكشف عن هذه الدقائق. فإن
طالب اليقين بمسالك البراهين ينتفع بمعرفتها غاية الإنتفاع، وإلا فالسوفسطائي كيف يناظر ومناظرته في نفسه إعتراف بطريق النظر، ولا ينبغي أن يتعجب من إعتقاد السفسطة والحيرة مع وضوح المعقولات، فإن ذلك لا يتفق إلا على الندور لمصاب في عقله بآفة؛ فإنا نشاهد جماعة من أرباب المذاهب هم السوفسطائية والناس غافلون عنهم، فكل من يناظر في إيجاب التقليد أو إبطال النظر سوفسطائي في الزجر عن النظر لا مستند لهم، إلا أن العقول لا ثقة بها والإختلاف فيها كثيرة، فسلوك طريق الأمن وهو التقليد أولى. فإذا قيل لهم: فهل قلدتم صدق نبيكم وتميزون بينه وبين الكاذب أم تقليدكم كتقليد اليهود والنصارى، فإن كان كتقليدهم فقد جوزتم كونكم مبطلين وهذا كفر عندكم، وإن لم تجوزوه فتعرفونه بالضرورة أو بنظر العقل، فإن عرفتموه بالنظر فقد أثبتم النظر. وقد اختلف الناس في هذا النظر وهو تصديق الأنبياء كمااختلفوا في سائر النظريات. وفي إثبات صدق الأنبياء بالمعجزات من الأغوار والأغماض ما لا يكاد يخفى على النظار، وبهذا الإعتقاد صاروا أخس رتبة من السوفسطائي فإنهم مثبتون بإنكار النظر ونافون إذ أثبتوا النظر في معرفة صدق النبي. وأما السوفسطائي فقد طرد قياسه في إنكار المعرفة الكلية، ومن هذا الجنس باطنية الزمان فإنهم خدعوا بكثرة الإختلافات بين النظار، ودعوا إلى اعتقاد بطلان نظر العقل ثم دعوا إلى تقليد أمامهم المعصوم. وإذا قيل لهم: بماذا عرفتم عصمة أمامكم وليس يمكن دعوى الضرورة فيه؟ دعوا فيه إلى أنواع من النظر يشترك إستعمالها في الظنيات، ولا تعرض على الإثنين إلا ويختلفان فيها، ولا يستدلون بكونه نظريا واقعا في محل الإختلاف على بطلانه،
ويحكمون على سائر النظريات بالبطلان لتطرق الخلاف فيها، وهذا وأمثاله سبب آفات تصيب العقل فيجري مجرى الجنون، ولكن لا يسمى جنونا والجنون فنون، والذين ينخدعون بأمثال هذه الخيالات هم أخس من أن نشتغل بمناظرتهم؛ فلنقتصر على ما ذكرناه في بيان أسباب الحيرة، والله اعلم.
؟ النظر الرابع في لواحق القياس وهي فصول متفرقة بمعرفتها تتم معرفة البراهين فصل في الفرق بين قياس العلة وقياس الدلالة إعلم أن الحد الأوسط إن كان علة للحد الأكبر سماه الفقهاء قياس العلة، وسماه المنطقيون برهان اللم أي ذكر ما يجاب به عن لم، وإن لم يكن علة سماه الفقهاء قياس الدلالة. والمنطقيون سموه برهان اأن أي هو دليل على أن الحد الأكبر موجود للأصغر من غير بيان علته. ومثال قياس العلة من المحسوسات قولك: هذه الخشبة محترقة لأنها أصابتها النار، وهذا الإنسان شبعان لأنه أكل الآن. وقياس الدلالة عكسه وهو أن يستدل بالنتيجة على المنتج فنقول: هذا شبعان فإذا هو قريب العهد بالأكل، وهذه المرأة ذات لبن فهي قريبة العهد بالولادة.
ومثاله من الفقه قولك: هذه عين نجسة فإذن لا تصح الصلاة معها، وقياس الدلالة عكسه وهو أن نقول هذه عين لا تصح الصلاة معها فإذن هي نجسة. وبالجملة الإستدلال بالنتيجة على المنتج يدل على وجوده فقط لا على علته، فإنا نستدل بحدوث العالم على وجود المحدث، وبوجود الكتابة المنظومة على علم الكاتب، ونجعل الكتابة حدا أوسط والعلم حدا أكبر، ونقول كل من كتب منظوما فهو عالم بالكتابة، والكتابة ليست علة للعلم بل العلم أولى بأن نقدر عليته. وكذلك إذا تلازمت نتيجتان بعلة واحدة جاز أن يستدل بإحدى النتيجتين على الأخرى فيكون قياس دلالة. ومثاله من الفقه قولنا: إن الزنا لا يوجب المحرمية فلا يوجب حرمة النكاح، فإن تحريم النكاح وحل النظر متلازمان، وهما نتيجتان للوطء المقتضي لحرمة المصاهرة، فإذا ثبت تلازمهما لعلة واحدة دل وجود إحداهما على وجود الأخرى، فإن اختلف شرطهما لم يمكن الإستدلال لإحتمال افتراقهما في الشرط، وكما انقسم قياس الدلالة إلى نوعين فقياس العلة أيضا ينقسم إلى قسمين: الأول: ما يكون الأوسط فيه علة للنتيجة ولا يكون علة لوجود الأكبر في نفسه، كقولنا:
كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم، فكل إنسان جسم. فالإنسان إنما كان جسما من قبل أنه حيوان والجسمية أولا للحيوان، ثم بسببه للإنسان، فإذا الحيوان علة لحمل الجسم على الإنسان لا لوجود الجسمية، فإن الجسمية تتقدم بالذات في ترتيب الأنواع والأجناس على الحيوان. واعلم أن ما ثبت للنوع من حمل الجنس عليه، وكذا جنس الجنس، وكذا الفصول والحود واللوازم إنما تكون من جهة الجنس، ويكون الجنس علة في حمله على النوع لا في وجود ذات المحمول أعني محمول النتيجة. والقسم الثاني: ما يكون علة لوجود الحد الأكبر على الإطلاق لا كهذا المثال، وقد لا يكون على الإطلاق كالشيء الذي له علل متعددة، فإن آحاد العلل لا يمكن أن تجعل علة للحد الأكبر مطلقا، بل هي علة في وقت مخصوص ومحل مخصوص، ومثاله في الفقه؛ إن العدوان علة للتأثيم على الإطلاق، والزنا علة للرجم على الإطلاق، والردة ليست علة للقتل على الإطلاق، فإن القتل يجب على سبيل القصاص وغيره، ولكن تكون علة للقتل في حق شخص مخصوص، وذلك لا يخرجه عن كونه قياس العلة. ؟ فصل في بيان اليقين البرهان الحقيقي ما يفيد شيئا لا يتصور تغيره، ويكون ذلك بحسب مقدمات البرهان فإنها تكون يقينية أبدية، لا تستحيل ولا تتغير أبدا، وأعني بذلك أن الشيء لا يتغير
وأن غفل إنسان عنه كقولنا: الكل أعظم من الجزء والأشياء المساوية لشيء واحد متساوية وأمثالها، فالنتيجة الحاصلة منها أيضا تكون يقينية، والعلم اليقيني هو أن تعرف أن الشيء بصفة كذا مقترنا بالتصديق بأنه لا يمكن ان لا يكون كذا، فإنك لو أخطرت ببالك إمكان الخطأ فيه والذهول عنه لم ينقدح ذلك في نفسك أصلا، فإن إقترن به تجوز الخطأ وإمكانه فليس بيقيني؛ فهكذا ينبغي أن تعرف نتائج البرهان، فإن عرفته معرفة على حد قولنا فقيل لك خلافه حكاية عن أعظم خلق الله مرتبة وأجلهم في النظر والعقليات درجة، وأورث ذلك عندك احتمالا، فليس اليقين تاما، بل لو نقل عن نبي صادق نقيضه فينبغي أن يقطع بكذب الناقل أو بتأويل اللفظ المسموع عنه، ولا يخطر ببالك إمكان الصدق، فإن لم يقبل التأويل فشك في نبوة من حكى عنه بخلاف ماعقلت إن كان ما عقلته يقينا فإن شككت في صدقه لم يكن يقينك تاما. فإن قلت: ربما ظهر لي برهان صدقة ثم سمعت منه ما يناقض برهانا قامعندي. فأقول: وجود هذا يستحيل كقول القائل لو تناقضت الأخبار المتواترة فما السبيل فيها كما لو تواتر وجود مكة وعدمها؟ فهذا محال، فالتناقض في البراهين الجامعة للشروط التي ذكرناها محال، فإن رأيتها متناقضة فاعلم أن أحدهما أو كلاهما لم يتحقق فيه الشروط المذكورة فتفقد مظان الغلط والمثارات السبع التي فصلناها، وأكثر الغلط يكون في المبادرة إلى تسليم مقدمات البرهان على أنها أولية ولا تكون أولية، بل ربما تكون محمودة مشهورة أو وهمية،
ولا ينبغي أن تسلم المقدمات ما لم يكن اليقين فيها على الحد الذي وصفناه. وكما يظن فيما ليست أولية أنها أولية فقد يظن بالأوليات أنها ليست أولية فيشكك فيها، ولا يتشكك في الأوليات إلا بزوال الذهن عن الفطرة السليمة، لمخالطة بعض المتكلمين المتعصبين للمذاهب الفاسدة بمجاحدة الجليات حتى تأنس النفس بسماعها فيشك في اليقيني، كما أنه قد يتكرر على سمعه ما ليس يقينا من المحمودات فتذعن للتصديق به وتظن أنه يقيني بكثرة سماعه، وهذا أعظم مثارات الغلط ويعز في العقلاء من يحسن الإحتراز من الإغترار به. فإن قلت فمثل هذا اليقين عزيز يقل وجوده فتقل به المقدمات. قلنا: ما يتساعد فيه الوهم والعقل من الحسابيات والهندسيات والحسيات كثير، فيكثر فيها مثل هذه اليقينيات، وكذا المعقولات التي لا تحاذيها الوهميات فأما العقليات الصرفة المتعلقة بالنظر في الإلهيات ففيها بعض مثل هذه اليقينيات، ولا يبلغ اليقين فيها إلى الحد الذي ذكرناه إلا بطول ممارسة العقليات، وفطام العقل عن الوهميات والحسيات وإيناسها بالعقليات المحضة، وكلما كان النظر فيها أكثر والجد في طلبها أتم كانت المعارف فيها إلى حد اليقين التام أقرب، ثم من طالت ممارسته وحصلت له ملكة بتلك المعارف لا يقدر على إفحام الخصم فيه ولا يقدر على تنزيل المسترشد منزلة نفسه، بمجرد ذكر ما عنده إلا بأن يرشده إلى أن يسلك مسلكه في ممارسة العلوم وطول التأمل حتى يصل إلى ما وصل إليه إن كان صحيح الحدس ثاقب العقل صافي الذكاء، وإن فارقه في الذكاء أو في الحدس أو تولي الإعتبار الذي تولاه لم يصل إلى ما وصل إليه، وعند ذلك يقابل ما يحكيه عن نفسه بالإنكار ويشتغل بالتهجين والإستبعاد، وسبيل العارف البصير أن يعرض عنه صفحا بل لا يبث إليه أسرار ما عنده، فإن ذلك أسلم لجانبه وأقطع لشغب الجهال، فما كل ما يرى يقال بل صدور الأحرار قبور الأسرار.
فصل في أمهات المطالب إعلم أن المطلوبات من العلوم بالسؤال عنها أربعة أقسام بسبب إنتساب كل واحد إلى الصيغة التي بها يسأل عنه: الأول: مطلب " هل " وهذا السؤال أعني صيغة هل، يتوجه نحو طلب وجود الشيء في نفسه كقولنا: الله موجود وهل الخلاء موجود؟ أو نحو وجود صفة أو حال لشيء كقولنا: هل الله مريد وهل العالم حادث؟ فيسمى الأول مطلب هل مطلقا والثاني مطلب هل مقيدا. والثاني: مطلب " ما " ويعرف به التصور دون التصديق، وذلك إما بحسب الإسم كقولك: ما الخلاء وما عنقاء مغرب؟ أي ما الذي تريد باسمه؟ وهذا يتقدم كل مطلب فإن من لم يفهم معنى العالم والحدوث لا يمكن أن يسأل: هل العالم موجود؟ ومن لم يتصور معنى الدال لا يمكنه أن يسأله عن وجود. وإما أن يكون الطلب بحسب حقيقة الذات كقولك: ما الإنسان وما العقار؟
وأنت تطلب به حده إذا عرفت أن المراد باسم العقار هو الخمر، وهذا يتأخر عن مطلب " هل " فإن من لا يعتقد للخمر وجودا لا يسأل عن حده. والثالث: مطلب " لم " وهو طلب العلة لجواب هل كقولك: لم كان العالم حادثا؟ وهو إما طلب علة التصديق كقولك: لم قلت أن الله موجود؟ فإنه لا يطلب العلة في وجوده بل العلة في وقوع التصديق بوجوده، وهو برهان الآن بلغة المنطقيين، وقياس الدلالة بلغة المتكلمين، وإما طلب علة الوجود كقولك لم حدث العالم؟ فنقول: لإرادة محدثة. والرابع مطلب: " أي " وهو الذي يطلب به تميز الشيء عما عداه، فهذه أمهات المطالب والأسئلة. فأما مطلب " أين ومتى وكيف " فليست من الأمهات فإنها داخلة بالقوة تحت مطلب " هل " المقيد إن وقع التفطن له بالسؤال بصيغة هل، وإن لم يقع كانت مطالب خارجة عما عددناها. فصل في بيان معنى الذاتي والأولي أما الذاتي فيطلق على وجهين: أحدهما أن يكون المحمول مأخوذا في حد الموضوع مقوما له داخلا في حقيقة كقولنا: الإنسان حيوان، فيقالك الحيوان ذاتي للإنسان أي هو مقوم له كما سبق بيانه.
وإما أن يكون الموضوع مأخوذا في حد المحمول كقولنا: بعض الحيوان إنسانن فإن المحمول هو الإنسان ههنا لا الحيوان، والإنسان لا يؤخذ في حد الحيوان بل الحيوان يؤخذ في حد الإنسان، فكل شيئين لا يؤخذ أحدهما في حد الآخر فليس أحدهما ذاتيا للآخر. وقد يمثل بالفطوسة في الأنف فإنه ذاتي للأنف بالمعنى الأخير، إذ لا يمكن تحديد الفطوسة إلا بذكر الأنف في حده. وأما الأولى فإنه يقال أيضا على وجهين: أحدهما ما هو أولي في العقل أي لا يحتاج في معرفته إلى وسط كقولنا: الإثنان أكثر من الواحد. والثاني أن يكون بحيث لا يمكن إيجاب المحمول أو سلبه على معنى آخر أعم من الموضوع؟ فإذا قلنا: الإنسان يمرض ويصح، لم يكن أوليا له بهذا المعنى إذ يقال على ما هو أعم منه وهو الحيوان: نعم هو للحيوان أولى، لأنه لا يقال على ما هو أعم منه، وهو الجسم؛ وكذلك قبول الإنتقال للحيوان ليس بأولى إذ يقال على ماهو أعم منه وهو الجسم، فإنه لو إرتفع الحيوان بقي قبول الإنتقال، ولو ارتفع الجسم لم يبق. فصل فيما يلتئم به أمر البراهين وهي ثلاثة: مبادي وموضوعات ومسائل. فالموضوعات نعني بها ما يبرهن فيها،
والمسائل ما يبرهن عليها، والمبادي ما يبرهن بها. والمراد بالمبادي المقدمات، وقد ذكرناها. وأما الموضوعات فهي الأمور التي توضع في العلوم وتطلب أعراضها الذاتية، أعني الذاتية بالمعنى الثاني من المعنيين المذكورين، ولكل علم موضوع: فموضوع الهندسة المقدار، وموضوع الحساب العدد، وموضوع لنحو لغة العرب منجهة ما يختلف إعرابها، وموضوع الفقه أفعال المكلفين من جهة ما ينهى عنها أو يؤمر بها أو يباح أو يندب أو يكره، وموضوع أصول الفقه أحكام الشرع، أعني الوجوب والحظر والإباحة من جهة ما تدرك به من أدلتها، وموضوع المنطق تمييز المعقولات وتلخيص المعاني. وأما المسائل فهي القضايا الخاصة بكل علم، التي يطلب المعرفة في العلوم بأحد طرفيها: إما النفي وإما الإثبات كقولنا في الحساب: هذا العدد إمازوج او فرد، وفي الهندسة: هذا المقدار مساو أو مباين، وفي الفقه: هذا الفعل حلال أوحرام أو واجب،
وفي العلم الإلهي: هذا الموجود قديم أو حادث وهذا الموجود له سبب أو ليس له سبب. والمقصود أن محمول المسائل إن كان مطلوبا بالنظر فلا يجوز أن يكون ذاتيا للموضوع بالمعنى الأول، لأنه إذا كان كذلك كان معلوما قبل العلم بالموضوع، فإن الحيوان الذي هو ذاتي للإنسان بمعنى أنه وجد في حده لا يجوز أن يكون مطلوبا فغن من عرف الإنسان فقد عرف كونه حيوانا قبله لا محالة، فإن أجزاء الحد يتقدم العلم بها على العلم بالمحدود، ولكن الذاتي بالمعنى الثاني وهو المطلوب، وأما كل محمول ليس المعنى الثاني ولا بالمعنى الأول فإنه يسمى غريبا كقولنا في الهندسة عند النظر في الخطوط: هذا الخط حسن أو قبيح، لأن الحسن والقبح لا يؤخذ في حد الخط ولا الخط في حده، بل الذاتي لذاته مستقيم أو منحني وأمثاله. وكذا قولنا في الطب: هذا الجرح مستدير أو مربع، فإنه محمول غريب للجرح إذ لا يؤخذ واحد منهما في حد الآخر، وإنما هو ذاتي للأشكال. وقد يكون المحمول ذاتيا للموضوع بالمعنى الثاني، ولكن يكون غريبا بالإضافة إلى العلم الذي يستعمل فيه كقولنا في الفقه: هذه الحركة سريعة أو بطيئة، فإن السرعة والبطء ذاتي للحركة، ولكن إنما يطلب في العلم الطبيعي، والمطلوب في الفقه ذاتي آخر وهو كونه واجبا أو محظورا أو مباحا. وإذا قلنا في العلم الطبيعي: هذا الفعل حلال أو حرام
كان غريبا من العلم. فإن قيل: فهل يجوز أن يكون المحمول في المقدمتين ذاتيا بالمعنى الأول؟ قلنا: لا، لأنه إن كان كذلك تكون النتيجة معلومة، فإذا قلنا: الإنسان حيوان والحيوان جسم فالإنسان جسم، كان العلم بالنتيجة غير مطلوب فإن منعرف الإنسان فقد عرف جميع أجزاء حده وهو الجسم والحيوان. نعم لا يبعد أن لا يكون كل واحد ذاتيا بالمعنى الثاني، بل إن كان أحدهما ذاتيا بالمعنى الثاني كفى، سواء كان هي الصغرى أو الكبرى. فإن قيل: فلم قلتم أن الذاتي بالمعنى الأول لا يكون مطلوبا، ونحن نطلب العلم بأن النفس جوهر أم لا، والجوهرية للنفس ذاتية إذ منعرف النفس فيعرف كونه جوهرا إن كان جوهرا؟ قلنا: من عرف النفس لم يتصور منه طلب كونه جوهرا، إذ معرفة جوهريته سابقة على المعرفة به، لكنا إذا طلبنا أن النفس جوهر أم لا لم يكن عرفنا من النفس إلا أمرا عارضا له وهو المحرك والمدرك، ويكون ذلك مثل الأبيض للثلج، والمطلوب جنس المعروض له وهو غير مقوم لماهية العارض، أعني الجوهرية ليس مقوما للمدرك والمحرك تقويم الذاتيات، وكذلك كلما حصل عندنا خياله أو إسمه لا حقيقته، أمكن أن نطلب جنس ذلك حصل لنا إسمه أو خياله، فأما على غير هذا الوجه فلا يمكن.
فصل في حل شبهة في القياس الدوري فإن قال قائل: فلم قضيتم ببطلان البرهان الدوري؟ ومعلوم أنه إذا سأل الإنسان عن الأسباب والمسببات على ما أجرى الله سنته بإرتباط البعض منها بالبعض ففيها ما يرجع بالدور إلى الأول إذ يقال: لم كان السحاب؟ فيقال: لأنه كان بخارا فكثف وانعقد. فقيل: لم كان البخار؟ فيقال: لأن الأرض كانت ندية فأثر الحر فيها فتبخرت أجزاء الرطوبة وتصعدت. فقيل: ولم كانت الأرض ندية؟ فقيل: لأنه كان مطر. فقيل: ولم كان المطر؟ فقيل: لأنه كان سحاب. فرجع بالدور إلى السحاب فكأنه قيل: لم كان السحاب؟ فقلت: لأنه كان سحاب. والدوري باطل سواء كان الحد المتكرر تخلله واسطة أو وسائط، أو لم يتخلل فنقول: ليس هذا هو الدوري الباطل، إنما الباطل أن يؤخذ الشيء في بيان نفسه بعينه بأن يقال: لم كان هذا السحاب؛ فيعلل بما يرجع بالآخرة إلى التعليل بهذا السحاب بعينه؛ فأما أن يرجع إلى التعليل بسحاب آخر فالعلة غير المعلول بالعدد، إلا أنه مساو له في النوع، ولا يبعد أن يكون سحاب بعينه علة لسحاب آخر بواسطة ترطيب الأرض، ثم تصعد البخار ثم انعقاده سحابا آخر.
فصل فيما يقوم فيه البرهان الحقيقي إعلم أن البرهان الحقيقي ما يفيد اليقين الضروري الدائم الأبدي الذي يستحيل تغييره كعلمك بان العالم حادث وأن له صانعا، وأمثال ذلك مما يستحيل ان يكون بخلافه على الأبد، إذ يستحيل أن يحضرنا زمان نحكم فيه على العالم بالقدم أوعلى الصانع بالنفي. فأما الأشياء المتغيرة التي ليس فيها يقين دائم فهي جميع الجزئيات التي في العالم الأرضي وأقربها إلى الثبات الجبال، وإذا قلت: هذا الجبل ارتفاعه كذا، لم يكن الحاصل علما أبديا لأن المقدمة الصغرى ليس اليقين فيها دائما، إذ ارتفاع الجبل يتصور تغيره، وكذا عمق البحار ومواضيع الجزائر، فهذه أمور لا تبقى فكيف علمك يكون زيد في الدار. وأمثال ذلك مما يتعلق بالأحوال الإنسانية العارضة لا كقولنا:
الإنسان حيوان والحيوان جسم والإنسان لا يكون في مكانين في حالة واحدة، وأمثال ذلك فإن هذه يقينيات دائمية أبدية لا يتطرق إليها التغير حتى قال بعض المتكلمين: العلم من جنس الجهل، وأراد به هذا الجنس من العلم. فإنك إذا علمت بالتواتر مثلا أن زيدا في الدار، فلو فرض دوام هذا الإعتقاد في نفسك وخروج زيد لكان هذا الإعتقاد بعينه قد صار جهلا، وهذاالجنس لا يتصور في اليقينيات الدائمة. فإن قيل: هل يتصور إقامة البرهان على ما يكن وقوعه أكثريا أو اتفاقيا؟ قلنا: أما الأكثري من الحدود الكبرى فلها لا محالة علل اكثيرة، فتلك العلل إذا جعلت حدودا وسطى أفادت علما وظنا غالبا. أما العلم فبكونه أكثريا غالبا فإنا إذا عرفنا من مجاري سنة الله تعالى أن اللحية إنما تخرج لاستحصاف البشرة ومتانة النجار، فإن عرفنا بكبر السن استحصاف البشرة ومتانة النجار حكمنا بخروج اللحية أي حكمنا بأن الغالب الخروج، وأن جهة الخروج غالبة على الجهة الأخرى، وهذا يقيني فإن ما يقع غالبا فلمرجح لا محالة، ولكن بشرط خفي لا يطلع عليه، ويكون فوات ذلك الشرط نادرا، ولذلك نحكم حكما يقينيا بأن من تزوج امرأة شابة ووطئها، فالغالب أن يكون له ولد، ولكن وجود الولد بعينه مظنون وكون الوجود غالبا على الجملة مقطوعبه، ولذلك نحكم في الفقهيات الظنية بأن العمل عند ظهور الظن واجب قطعا، فيكون العمل مظنونا ووجود الحكم مظنونا، ولكن وجوب العمل قطعي
إذ علم بدليل قطعي إقامة الشرع غالب الظن مقام اليقين في حق وجوب العمل، فكون الحكم مظنونا لم يمنعنا من القطع بما قطعنا به. وأما الأمور الإتفاقية كعثور الإنسان في مشيه على كنز فمهما لا يمكن أن يحصل به ظن ولا علم، إذ لو أمكن تحصل ظن بوجوده لصار غالبا أكثريا وخرج عن كونه إتفاقيا فقط. نعم يمكن إقامة البرهان على كونه اتفاقيا فقط، وقد اصطلح المنطقيون على تخصيص إسم البرهان بما ينتج اليقين الكلي الدايم الضروري، فإن لم تساعدهم على هذا الإصطلاح أمكنك أن تسمي جميع العلوم الحقيقية برهانية إذا جمعت المقدمات الشروط التي مضت، وأن ساعدتهم على هذا، فالبرهاني من العلوم العلم بالله وصفاته وبجميع الأمور الأزلية التي لا تتغير كقولنا: الإثنان أكثر من الواحد؛ فإن هذا صادق في الأزل، والأبد والعلم بهيئة السموات والكواكب وإبعادها ومقاديرها وكيفية مسيرها يكون برهانيا عند من رأى أنها أزلية لا تتغير، ولا تكون برهانية عند أهل الحق الذين يرون أن السموات كالأرضيات في جواز تطرق التغير إليها. وأما ما يختلف بالبقاع والأقطار كالعلوم اللغوية والسياسية إذ يختلف بالإعصار والملل، وكالأوضاع الفقهية الشرعية من تفصيل الحلال والحرام فلا يخفى أنها لا تكون من البرهانيات على هذا الإصطلاح. والفلاسفى يزعمون أن السعادة الأخروية لا معنى لها إلا بلوغ النفس كمالها الذي يمكن أن يكون لها، وإن كمالها في العلوم لا في الشهوات،
ولما كانت النفس باقية أبدا كانت نجاتها وسعادتها في علوم صادقة أبدا كالعلم بالله وصفاته وملائكته، وترتيب الموجودات وتسلسل الأسباب والمسببات. فأما العلوم التي ليست يقينية دائمة فإن طلبت لم تطلب لذاتها، بل للتوصل بها إلى غيرها، وهذا محل لا ينكشف إلا بنظر طويل، لا يحتمل هذا الكتاب استقصاؤه بل محل بيانه العلوم المفصلة. فصل في أقسام العلة العلة تطلق على أربعة معاني: الأول ما منه بذاته الحركة وهو السبب في وجود الشيء كالنجار للكرسي والأب للصبي. الثاني المادة وما لا بد من وجوده لوجود الشيء مثل الخشب للكرسي ودم الطمث والنطفة للصبي. والثالث الصورة وهي تمام كل شيء وقد تسمى علة صورية كصورة السرير من السرير وصورة البيت للبيت. الرابع الغاية الباعثة أولا المطلوب وجودها آخرا كالكن للبيت والصلوح للجلوس من السرير. واعلم أن كل واحد من هذه يقع حدودا وسطى في البراهين إذ يمكن أن يذكر كل واحد في جواب لم. أما مبدأ الحركة فمثاله من المعقولات أن يقال: لم حارب الأمير فلانا؟ فيقال: لأنه نهب ولايته،
فالنهب مبدأ الحركة. ويقال: لم اقتل فلانا؟ فيقال: لانه أكرهه السلطان عليه. ومثاله من الفقه أن يقال: لم قتل هذا الشخص؟ فيقال: لأنه زنى أوارتد، فيكون الزنا مبدأ هذا الأمر وهو الذي تسميه الفقهاء في الأكثر سببا، وأما المادة فمثالها من المعقول أني قال: لم يموت الإنسان؟ فتقول: لأنه مركب من أمور متنافرة من الحرارة والرطوبة والبرودة واليبوسة المتنازعة المتنافرة. ومثاله من الفقه أن يقال: لم انفسخ القراض والوكالة بالموت والإغماء؟ فتقول: لأنه عقد ضعيف جائز لا لزوم له، وهذه علة ماديةإذ يرد الفسخ على العقد ورود الموت على الإنسان عند جريان سبب هومبدأ الأمر في الموت والفسخ جميعا. وأما الصورة فبها قوام الشيء إذ السرير سرير بصورته لا بخشبه، والإنسان إنسان بصورته لا بجسمه، والأشياء هيآتها بالصور لا بالمواد، فلا يخفى كون القوام بها فإنه إذا قيلك لم صارت هذه النطفة إنسانا وهذا الخشب سريرا؟
فيقال: بحصول صورة الإنسانية وحصول صورة السريرية. وأما الغاية التي لأجلها الشيء فمثالها من المعقول أن يقال: لم عرضت الأضراس؟ فيقال: لأنها يراد بها الطحن. ولم قاتلوا الطبقة الفلانية؟ فيقال: ليسترقوهم. وفي الفقه يقال: لم قتل الزاني والمرتد والقاتل؟ فيقال: للزجر عن الفواحش. وهذه العلل الأربع تجتمع في كل ما له علة، وكذا في الأحكام الفقهية، والفقهاء ربما سموا المادة محلا والفاعل الذي هو كالنجار والأب أهلا، والغاية حكما، فإذا فرض النكاح فالزوج أهل والبضع محل والحل غاية وصيغة العقد كأنها الصورة، وما لم تجتمع هذه الأمور لا يتم للنكاح وجود، ولذلك قيل: النكاح الذي لا يفيد الحل لا وجود له، وكذا البيع الذي لا يفيد الملك فإن وجود الغاية لا بد منه، وكونها معقولا باعثا شرط قبل الوجود،
وكونها موجودة بالفعل واجب بعد الوجود، ومهما قدر الفاعل والمادة موجودا لم يلزم وجود الشيء في كل حال كالنجار والخشب والأب والنطفة والبايع والمبيع، ومهما وجدت الغاية بالفعل لزم وجود الشيء كالحل في النكاح والصلوح للإكتنان والجلوس في البيت، والشيء بهذه الجهات الأربع يختلف في هذا المعنى، ثم كل واحدة من هذه العلل إما بعيدة كإسلام المرأة للزوج عند ملك الزوج نصف الصداق، فإنه علة الصداق، والصداق هوالعلة القريبة للتسليم، وإما بالقوة كالإسكار للخمر قبل الشرب، وإما بالفعل كما في حال الشرب، وإما خاصة كالزنا للرجم، وإما عامة كالجناية للرجم أو العقوبة، وأما بالذات وهو المسمى علة عند الفقهاء كالزنا للرجم، وإما بالعرض كالإحصان له وهو الذي يسمى شرطا، فإن الرجم لا يجب إلا بالإحصان، وهي خصال كمال ولكن يعمل عمل العلة عنده، كما لو أرسلت الدعامة من تحت السقف فنزل فيقال نزوله بعلة الثقل، ولكن عند إشالة الدعامة فإن للهوى شرطا، وهو فراغ جهة الأسفل عن جسم صلب لا ينخرق. وأمثلة هذا في المعقولات كثيرة، فلذلك اقتصرنا على الأمثلة الفقهية، والمقصود أن المعلل في الفقه والمعقول إذا توجهت المطالبة عليه بالعلة، ينبغي أن يذكر العلة الخاصة القريبة التي بالفعل حتى تقطع المطالبة بلم، وإلا فيكون الطلب قائما.
كتاب الحد والنظر في هذا الكتاب يحصره فنان: الأول فيما يجري من الحد يجري القوانين الكلية. والثاني في الحدود المفصلة. الفن الأول في قوانين الحدود وفيه فصول الأول في بيان الحاجة إلى الحد، وقد قدمنا أن العلم قسمان: أحدهما علم بذوات الأشياء ويسمى تصورا. والثاني: علم بنسبة تلك الذوات بعضها إلى بعضها بسلب أو إيجاب ويسمى تصديقا. وأن الوصول إلى التصديق بالحجة والوصول إلى التصور التام بالحد، فإن الأشياء الموجودة تنقسم إلى أعيان شخصية كزيد ومكة وهذه الشجرة، وغلى أمور كلية كالإنسان والبلد والشجر والبر والخمر، وقد عرفت الفرق بين الكلي والجزئي؛ وغرضنا في الكليات إذ هي المستعمل في البراهين، والكلي تارة يفهم فهما جمليا كالمفهوم من مجرد إسم الجملة وسائر الأسماء والألقاب للأنواع والأجناس،
وقد يفهم فهما مخلصا مفصلا محيطا بجميع الذاتيا التي بها قوام الشيء، متميزا عنغيره في الذهن تميزا تاما، ينعكس على الإسم وينعكس عليه الإسم كما يفهم من قولنا شراب مسكر معتصر من العنب، وحيوان ناطق مايت، وجسم ذو نفس حساس متحرك بالإرادة متغذي؛ فإن هذه الحدود يفهم بها الخمر والإنسان والحيوان، فهما أشد تلخيصا وتفصيلا وتحقيقا وتمييزا مما يفهم من مجرد أساميها، وما يفهم الشيء هذا الضرب من التفهيم يسمى حدا، كما أن ما يفهم الضرب الأول من التفهيم يسمى إسما ولقبا. والفهم الحاصل من التحديد يسمى علما مخلصا مفصلا، والعلم الحاصل بمجرد الإسم يسمى علما جمليان وقد يفهم الشيء مما يتميز به عن غيره بحيث ينعكس على إسمه وينعكس الإسم عليه، ويتميز لا بالصفات الذاتية المقومة التي هي الأجناس والأنواع والفصول، بل بالعوارض والخواص فيسمى ذلك رسما كقولنا في تمييز الإنسان عن غيره: إنه الحيوان الماشي برجلين، العريض الأظفار، الضحاك، فإن هذا يميزه عن غيره كالحد، وكقولك في الخمر: إنه المائع المستحيل في الدن الذي يقذف بالزبد إلى غير ذلك من العوارض التي إذا جمعت لم توجد إلا للخمر،
وهذا إذا كان أعم من الشيء المحدود بأن يترك بعض الإحترازات سمي رسما ناقصا، كما أن الحد إذا ترك فيه بعض الفصول الذاتية فيكون سمي حدا ناقصا، ورب شيء يعسر الوقوف على جميع ذاتياته أولا يلفى لها عبارة فيعدل إلى الإحترازات العرضية بدلا عن الفصول الذاتية فيكون رسما مميزا، قائما مقام الحد في التمييز فقط لا في تفهيم جميع الذاتيات؛ والمخلصون إنما يطلبون منالحد تصور كنه الشيء وتمثل حقيقته في نفوسهم، لا لمجرد التمييزن ولكن مهما حصل التصور بكماله تبعه التمييز، ومن يطلب التمييز المجرد يقتنع بالرسم فقد عرفت ما ينتهي إليه تأثير الإسم والحد والرسم في تفهيم الأشياء، وعرفت إنقسام تصور الأشياء إلى تصور له بمعرفة ذاتياته المفصلة وإلى تصور له بمعرفة أعراضه، وإن كل واحد منهما قد يكون تاما مساويا للإسم في طرفي الحمل، وقد يكون ناقصا فيكون أعم من الإسم. واعلم أن أنفع الرسوم في تعريف الأشياء أن يوضع فيه الجنس القريب أصلا ثم تذكر الأعراض الخاصة المشهورة فصولا، فإن الخاصة الخفية إذا ذكرت لم تفد التعريف على العموم، فمهما قلت في رسم المثلث إنه الشكل الذي زواياه تساوي قائمتين لم تكن رسمته إلا للمهندس، فإذن الحد قول دال على ماهية الشيء، والرسم وهو القول المؤلف من أعراض الشيء وخواصه التي تخصه جملتها بالإجتماع وتساويه.
الفصل الثاني في مادة الحد وصورته قد قدمنا أن كل مؤلف فله مادة وصورة كما في القياس، ومادة الحد الأجناس والأنواع والفصول، وقد ذكرناها في كتاب مقدمات القياس. وأما صورته وهيئته فهو أن يراعى فيه إيراد الجنس الأقرب ويردف بالفصول الذاتية كلها، فلا يترك منها شيءس، ونعني بإيراد الجنس القريب أن لا نقول في حد الإنسان " جسم ناطق مائت، وإن كان ذلك مساويا للمطلوب بل نقول: حيوان، فإن الحيوان متوسط بين الجسم والإنسان، فهو أقرب إلى المطلوب من الجسم، ولانقول في حد الخمر: إنه مائع مسكر، بل نقول: شراب مسكر؛ فإنه أخص من المائع وأقرب منه إلى الخمر، وكذلك ينبغي أن يورد جميع الفصول الذاتية على الترتيب، وإن كان التمييز يحصل ببعض الفصول. وإذا سئل عن حد الحيوان فقال: جسم ذو نفس حساس له بعد متحرك بالإرادة،
فقد أتى بجميع الفصول ولو ترك ما بعد الحساس لكان التمييز حاصلا به، ولكن لا يكون قد تصور الحيوان بكمال ذاتياته، والحد عنوان المحدود فينبغي أن يكون مساويا له في المعنى، فإن نقص بعض هذه الفصول سمي حدا ناقصا، وإن كان التمييز حاصلا به وكان مطردا منعكسا في طريق الحمل، ومهما ذكر الجنس القريب وأتى بجميع الفصول الذاتية فلا ينبغي أن يزيد عليه. ومهما عرفت هذه الشروط في صورة الحد ومادته عرفت ان الشيء الواحد لا يكون له إلا حد واحد، وأنه لا يحتمل الإيجاز والتطويل، لأن إيجازه بحذف بعض الفصول وهو نقصان، وتطويله بذكر حد الجنس القريب بدل الجنس بكقولك في حد الإنسان: إنه جسم ذو نفس حساس متحرك بالإرادة ناطق مائت، فذكر حد الحيوان بدل الحيوان وهو فضول يستغنى عنه، فإن المقصود إن يشتمل الحد على جميع ذاتيات الشيء إما بالقوة وإما بالفعل. ومهما ذكر الحيوان فقد اشتمل على الحساس والمتحرك والجسم بالقوة أي على طريق التضمن، وكذلك قد يوجد الحد للشيء الذي هو مركب من صورة ومادة بذكر أحدهما كما يقال في حد الغضب: إنه غليان دم القلب، وهذا ذكر المادة، ويقال: إنه طلب الإنتقام، وهذا هو ذكر الصورة بل الحد التام أن يقال
هو غليان دم القلب لطلب الإنتقام. فإن قيل: فلو سهى ساهي او تعمد متعمد فطول الحد بذكر حد الجنس القريب بدل الجنس القريب، أوزاد على بعض الفصول الذاتية شيئا من الأعراض واللوازمن او نقص بعض الفصول فهل يفوت مقصود الحد كما يفوت مقصود القياس بالخطأ في صورته؟ قلنا: الناظرون إلى ظواهر الأمور ربما يستعظمون الأمر في مثل هذا الخطأ، والأمر أهون مما يظنون مهما لاحظ الإنسان مقصود الحد، لأن المقصود تصور الشيء بجميع مقوماته مع مراعاة الترتيب بمعرفة الأعم والأخص، بإيراد الأعم أولا وإردافه بالأخص الجاري مجرى الفصول، وإذا حفظ ذلك فقد حصل العلم التصوري المفصل المطلوب. أما النقصان بترك بعض الفصول فإنه نقصان في التصور. وأما زيادة بعض الأعراض فلا يقدح فيما حصل من التصور الكامل، وقد ينتفع به في بعض المواضع في زيادة الكشف والإيضاح. وأما إبدال الذاتيات باللوازم والعرضيات فذلك قادح في كمال التصور، فليعلم مبلغ تأثير كل واحد في المقصود، ولا ينبغي أن يجمد الإنسان على الرسم المعتاد المألوف في كل أمره وينسى غرضه المطلوب، فأذن مهما عرف جميع الذاتيات على الترتيب حصل المقصود، وأن زيد شيء من الأعراض أو أخذ حد الجنس القريب بدل الجنس. الفصل الثالث في ترتيب طلب الحد بالسؤال، والسائل عن الشيء بقوله: ما هو؟ لا يسأل إلا بعد الفراغ عن مطلب هل، كما أن السائل بلم لا يسأل إلا بعد الفراغ عن مطلب هل، فإن سأل عن الشيء قبل اعتقاد وجوده وقال: ما هو؟ رجع إلى طلب
شرح الإسم، كقول القائل: ما الخلا وما الكيميا؟ وهو لا يعتقد لهما وجودا، فإذا اعتقد الوجود كان الطلب متوجها إلى تصور الشيء في ذاته. وترتيبه أن يقول ما هو مشيرا إلى نخلة مثلا، فإذا أجاب المسؤول بالجنس القريب وقال شجرة، لم يقنع السائل به بل قرن بما ذكره صيغة أي وقال: أي شجرة هي؟ فإذا قال هي شجرة تثمر الرطب، فقد بلغ المقصود وانقطع السؤال إلا إذا لم يفهم معنى الرطب أو الشجر، فيعدل إلى صيغة ما ويقول: ما الرطب وما الشجر؟ فيذكر له جنسه وفصله فيقول: الشجر نبات قائم على ساق، فإن قال: ما الساق؟ فيذكر جنسه وفصله ويقول: هو جسم مغتذى نامي، فإن قال: ما الجسم؟ فيقول هو الممتد في الأقطار الثلاثة أي هو الطويل العريض العميق، وهكذا إلى أن ينقطع السؤال. فإن قيل: فمتى ينقطع؟ فإن تسلسل إلى غير نهاية فهو محال، وإن تعين توقفه فهو تحكم. فنقول: لا يتسلل إلى غير نهاية بل ينتهي إلى أجناس وفصول تكون معلومة للسائل لا محالة، فإن تجاهل أبدا لم يمكن تعريفه بالحد لأن كل تعريف وتعرف فيستدعي معرفة سابقة، فلم يعرف صورة الشيء بالحد إلا من عرف أجزاء الحد من الجنس والفصل قبله، إما بنفسه لوضوحه وإما بتحديد آخر أن يرتقي إلى أوائل عرفت بنفسها، كما أن كل تعلم تصديقي بالحجة فبعلم قد سبق لمقدمات هي أولية لم تعرف
بالقياس أو عرفت بالقياس، ولكن تنتهي بالآخرة إلى الأوليات، فآخر الحد يجري مجرى مقدمات القياس من غير فرق. والمقصود من هذا أن الحد يتركب لا محالة من جنس الشيء وفصله الذاتي ولا معنى له سواه، وما ليس له فصل وجنس فليس له حد، ولذلك إذا سئلنا عن حد الموجود لم نقد عليه، إلا أن يراد شرح الإسم فيترجم بعبارة أخرى عجمية أو تبدل في العربية بشيء، ولا يكون ذلك حدا بل هو ذكر إسم بدل إسم آخر مرادف له، فإذا سئلنا عن حد الخمر فقلنا: العقار، وعن حد العلم فقلنا: هو المعرفة، وعن حد الحركة فقلنا: هو النقلة، لم يكن حدا بل كان تكرار للأشياء المترادفة، ومن أحب أن يسميه حدا فلا حرج في الإطلاقات، ونحن نعني بالحد ما يحصل في النفس صورة موازية للمحدود مطابقة لجميع فصوله الذاتية. وإنما راعينا الفصول الذاتية لأن الشيء قد ينفصل عن غيره بالعرض الذي لا يقوم ذاته إنفصال الثوب الأحمر عن الأسود، وقد ينفصل بلازم لا يفارق إنفصال القار بالسواد عن الثلج وإنفصال الغراب عن الببغاء، وقد ينفصل بالذات إنفصال الثوب عن السيف وإنفصال ثوب من ابريسم عن درهم من قطن، ومن يسال عن ماهية الثوب طالبا حده فإنما يطلب الأمور التي بها قوام ثوبيته، لأنا لا نقوم الثوبية من اللون والطول والعرض فجوابه بما لا يقوم ذات الثوب مخل بالسؤال، فقد عرفت ان الحد مركب من الجنس والفصل، وأن ما لا يدخل تحت جنس حتى ينفصل عنه بفصل ما لا حدله مثل ما يذكر في معرض رسم أو شرح اسم، فتسميته حدا مخالف للتسمية التي اصطلحنا عليها فيكون الحد مشتركا له ولما ذكرناه.
؟؟ الفصل الرابع في أقسام ما يطلق عليه إسم الحد. والحد يطلق بالتشكيك على خمسة أشياء: الأول الحد الشارح لمعنى الإسم، ولا يلتفت فيه إلى وجود الشيء وعدمه، بل ربما يكون مشكوكا. ونذكر الحد ثم إن ظهر وجوده عرف أن الحد لم يكن بحسب الإسم المجرد وشرحه، بل هو عنوان الذات وشرحه. الثاني بحسب الذات وهو نتيجة برهان. والثالث ما هو بحسب الذات وهو مبدأ برهان. والرابع ما هو بحسب الذات. والحد التام الجامع لما هو مبدأ برهان ونتيجة برهان، كما إذا سئلت عن حد الكسوف فقلت امحاء ضوء القمر لتوسط الأرض بينه وبين الشمس، فامحاء ضوء القمر هونتيجة برهان وتوسط الأرض المبدأ، فغنك في معرض البرهان تقول: متى توسطت الأرض فانمحى النور فيكون التوسط حدا أوسط فهو مبدأ برهان، وإلا انمحى حد أكبر فهونتيجة برهان، ولذلك يتداخل البرهان والحد، فإن العلل الذاتية من هذا الجنس تدخل في حدود الأشياء كما تدخل في براهينها، فكل ما له علة فلا بد من ذكر علته الذاتية في حده لتتم صورة ذاته، وقد تدخل العلل الأربعة في حد الشيء الذي له العلل الأربعة كقوله في حد القادوم: إنه ىلة صناعية من حديد، شكله كذا يقطع به الخشب نحتا؛
فقولك: آله، جنس وصناعية تدل على المبدأ الفاعل، والشكل يدل على الصورة، والحديد يدل على المادة، والنحت على الغاية، والشكل يدل على الصورة، والحديد يدل على المادة، والنحت على الغاية، وبه الإحتراز عن المثقب والمنشار إذ لا ينحت بهما. وقد يقتصر في الحد على نتيجة البرهان إذا حصل التمييز بها فيقال: حد الكسوف انمحاء ضوء القمر، فيسمى هذا حدا هو نتيجة برهان وإن اقتصر على العلة وقال: الكسوف هو توسط الأرض بين القمر وبين الشمس، وحصل به التمييز قيل حد مبدأ برهان، والحد التام المركب منهما. ؟ القسم الخامس ما هو حد لأمور ليس لها علل وأسباب، ولو كان لها علل لكانت عللها غير داخلة في جواهرها كتحديد النقطة، والوحدة والحد، فإن الوحدة يذكر لها تعريف وليس للوحدة سبب، والحد يحد فإنه قول دال على ماهية الشيء، وللقول سبب فإنه حادث لا محالة لعلة لكن مسببه ليس ذاتيا له كانحاء ضوء القمر في الكسوف، فهذا الخامس ليس بمجرد شرح الإسم فقط، ولا هو مبدأ برهان، ولا هو مركب منهما؛ فهذه أقسام ما يطلق عليه إسم الحد، وقد يسمى الرسم حدا على أنه مميز فيكون ذلك وجها سادسا.
؟ الفصل الخامس في أن الحد لا يقتنص بالبرهان ولا يمكن إثباته به عند النزاع، لأنه إن أتيت بالبرهان افتقرت إلى حد أوسط مثل أن يقال مثلا: حد العلم المعرفة، فيقال: لم؟ فنقول: لأن كل علم اعتقاد، وكل اعتقاد معرفة، والمعرفة أكبر، وينبغي أن يكون الأوسط مساويا للطرفين إذ الحد هكذا يكون، وهذا محال لأن الأوسط عند ذلك له حالتان، وهما أن يكون حدا للأصغر أو رسما أو خاصة. الحالة الأولى أن يكون حدا وهو باطل من وجهين: أحدهما أن الشيء الواحد لا يكون له حدان تامان لأن الحد ما يجمع من الجنس والفصل، وذلك لا يقبل التبديل ويكون الموضوع حدا أوسط هو الأكبر بعينه لا غيره، وأن غايره في اللفظ وإن كان مغايرا له في الحقيقة لم يكن حدا للأصغر. الثاني أن الأوسط بم عرف كونه حدا للأصغر، فإن عرف بحد آخر فالسؤال قائم في ذلك الآخر، وذلك إما أن يتسلسل إلى غير نهاية وهو محال، وإما أن يعرف بلا وسط فليعرف الأول بلا وسط إذا أمكن معرفة الحد بغير وسط. الحالة الثانية أن لا يكون الأوسط حدا للأصغر بل كان رسما أو خاصة وهو باطل من وجهين:
أحدهما إن ما ليس بحد ولا هو ذاتي مقوم كيف صار أعرف من الذاتي المقوم، وكيف يتصور أن تعرف من الإنسان أنه ضحاك أو ماش ولا يعرف أنه جسم وحيوان. الثاني أن الأكبر بهذا الأوسط إن كان محمولا مطلقا وليس بحد فليس يلزم منه إلا كونه محمولا للأصغر، ولا يلزمه كونه حدا، وإن كان حدا فهو محال إذ حد الخاصية والعرض لا يكون حد موضوع الخاصية والعرض، فليس حد الضاحك هوبعينه حد الإنسان، وإن قيل: إنه محمول على الأوسط على معنى انه حد موضوعه، فهذه مصادرة على المطلوب، فقد تبين أن الحد لا يكتسب بالبرهان. فإن قيل: بماذا يكتسب وما طريقه؟ قلنا: طريقه التركيب وهو أن نأخذ شخصا من أشخاص المطلوب حده بحيث لا ينقسم، وننظر من أي جنس من جملة المقولات العشر، فنأخذ جميع المحمولات المقومة لها التي في ذلك الجنس ولا يلتفت إلى العرض واللازم، بل يقتصر على المقومات ثم يحذف منها ماتكرر ويقتصر من جملتها على الأخير القريب، وتضيف إليه الفصل فإن وجدناه مساويا للمحدود من وجهين فهو الحدن ونعني بأحد الوجهين الطرد والعكس، والتساوي مع الإسم في الحمل. فمهما ثبت الحد انطلق الإسم، ومهما انطلق الإسم حصل الحد. ونعني بالوجه الثاني المساواة في المعنى، وهو أن يكون دالا على كمال حقيقة الذات لا يشذ منها شيء، فكم من ذاتي متميز ترك بعض فصوله فلا يقوم ذكره في النفس صورة للمحدود مطابقة لكمال ذاته، وهذا مطلوب الحدود، وقد ذكرنا وجه ذلك. ومثال طلب الحد إنا إذا سئلنا عن حد الخمر فنشير إلى خمر معينة ونجمع صفاته المحمولة عليه، فنراه أحمر يقذف بالزبد، فهذا عرضي فنطرحه ونراه ذات رائحة حادة ومرطبا للشرب، وهذا لازم فنطرحه
ونراه جسما أو مائعا وسيالا وشرابا مسكرا ومعتصرا من العنب، وهذه ذاتيات فلا تقول: جسم مائع سيال شراب لأن المائع يغني عن الجسم، فإنه جسم مخصوص والمائع أخص منه، ولا تقول مائع لأن الشراب يغني عنه ويتضمنه وهو أخص وأقربن فتأخذ الجنس الأقرب المتضمن لجميع الذاتيات العامة وهو شراب، فنراه مساويا لغيره من الأشربة فتفصله عنه بفصل ذاتي لا عرضي كقولنا: مسكر يحفظ في الدن أو مثله، فيجتمع لنا شراب مسكر فتنظر هل يساوي الإسم في طرفي الحمل، فإن ساواه فتنظر هل تركنا فصلا آخر ذاتيا لا تتم ذاته إلا به فإن وجد معنا ضممناه إليه كما إذا وجدنا في حد الحيوان إنه جسم ذو نفس حساس، وهو يساوي الإسم في الحمل، ولكن ثم فصل آخر ذاتي وهو المتحرك بالإرادة فينبغي أن تضيفه إليه؛ فهذا طريق تحصيل الحدود لا طريق سواه. ؟ الفصل السادس مثارات الغلط في الحدود وهي ثلاثة: أحدها في الجنس، والآخر في الفصل، والثالث مشترك. المثار الأول الجنس وهي من وجوه:
فمنها أن يوضع الفصل بدل الجنس فيقال في العشق إنه إفراط المحبة، وإنما هو المحبة المفرطة فالمحبة جنس والإفراط فصل. ومنها أن توضع المادة مكان الجنس كقولك للسيف: إنه حديد يقطع، وللكرسي: إنه خشب يجلس عليه. ومنها أن تؤخذ الهيولي مكان الجنس كقولنا للرماد: إنه خشب محترق، فإنه ليس خشبا في الحال بل كان خشبا بخلاف الخشب من السرير فإنه موجود فيه على أنه مادة، وليس موجودا في الرماد، ولكن كان فصار شيئا آخر بتبدل صورته الذاتية، وهو الذي أردنا بالهيولي، ولك أن تعبر عنه بعبارة أخرى إن استبشعت هذه العبارة. ومنها أن تؤخذ الأجزاء بدل الجنس فيقال في حد العشرة، إنه خمسة وخمسة أو ستة وأربعة أو ثلاث وسبعة وأمثالها، وليس كذلك قولنا في الحيوان إنه جسم ونفس، لأن كون الجسم نفسا ما يرجع إلى فصل ذاتي له، فإن النفس صورة وكمال للجسم ولا كالخمسة للخمسة الأخرى. ومنها أن توضع الملكة مكان القوة كقولنا: العفيف هو القوي على إجتناب اللذات الشهوانية، وليس كذلك إذ الفاجر أيضا يقوى ولكنه يفعل، ولكن يكون ترك اللذات للعفيف بالملكة الراسخة وللفاجر بالقوة. وقد تشتبه الملكة بالقوة، وكقولك:
إن القادر على الظلم هو الذي من شأنه وطباعه النزوع إلى انتزاع ما ليس له من يد غيره، فقد وضع الملكة مكان القوة لأن القادر على الظلم قد يكون عادلا لا ينزع طبعه إلىالظلم. ومنها ان يوضع النوع بدل الجنس فيقال: الشر هو ظلم الناس، والظلم أحد أنواع الشر، والشر جنس عام يتناول غير الظلم. المثار الثاني من جهة الفصل وذلك بان يوضع ما هو جنس مكان الفصل، أو ما هو خاصة أو لازم او عرضي مكان الفصل، وكثيرا ما يتفق ذلك والإحتراز عنه عسر جدا. المثار الثالث ما مشترك وهو على وجوه: فمنها أن يعرف الشيء بما هو أخفى منه كمن يحد النار بأنه جسم شبيه بالنفس والنفس أخفى من النار، أو يحده بما هو مثله في المعرفة كتحديد الضد بالضد مثل قولك الزوج ما ليس بفرد، ثم تقول الفرد ما ليس بزوج، أو تقول الزوج ما يزيد على الفرد بواحد، ثم تقول الفرد ما ينقص عن الزوج بواحد،
وكذا إذا أخذ المضاف في حد المضاف. فتقول: العلم ما يكون الذات به عالما. ثم تقول: العالم منقام به العلم والمتضايفين يعلمان معا، ولا يعلم أحدهما بالآخر بل مع الآخر. فمن جهل العلم جهل العالم، ومن جهل الأب جهل الإبن، فمن القبيح أن يقال للسائل الذي يقول: ما الأب من له ابن، فإنه يقول: لو عرفت الإبن لعرفت الأب بل ينبغي أن يقال: الأب حيوان يوجد آخر من نوعه من نطفته من حيث هو كذلك، فلا يكون فيه تعريف الشيء بنفسه ولا حوالته على ما هو مثله في الجهالة. ومنها ان يعرف الشيء بنفسه أو بما هومتأخر عنه في المعرفة كقولك للشمس: كوكب يطلع نهارا، ولايمكن تعريف النهار إلا بالشمس، فإن معناه زمان طلوع الشمس فهو تابع للشمس فكيف يعرف؟ وكقولك في الكيفية: أن الكيفية ما بها تقع المشابهة وخلافها، ولا يمكن تعريف المشابهة إلا بأنها إتفاق في الكيفية، وربما يخالف المساواة فإنها إتفاق في الكمية، وتخالف المشاكلة فإنها اتفاق في النوع؛ فهذا وأمثاله مما يجب مراقبته في الحدود حتى لا يتطرق إليه الخطأ بإغفاله، وكان أمثلة هذا مما يخرج عن الحصر، وفيما ذكرنا تنبيه على الجنس.
؟؟؟ الفصل السابع في استقصاء الحد على القوة البشرية إلا عند غاية التشمير والجهد. فمن عرف ما ذكرناه في مثارات الإشتباه في الحد، عرف أن القوة البشرية لا تقوى على التحفظ عن كل ذلك إلا على الندور، وهي كثيرة وأعصاها على الذهن أربعة أمور: أحدها أنا شرطنا أن نأخذ الجنس الأقرب، ومن أين للطالب أن لا يغفل عنه فيأخذ جنسا يظن أنه أقرب، وربما يوجد ما هو أقرب منه فيحد الخمر بأنه مائع مسكر، ويذهل عن الشراب الذي هو تحته، وهو أقرب منه، ويحد الإنسان بأنه جسم ناطق مايت ويغفل عن الحيوان وأمثاله. الثاني أنا إذا شرطنا أن تكون الفصول كلها ذاتية واللازم الذي لا يفارق في الوجود، والوهم مشتبه بالذاتي غاية الإشتباه، ودرك ذلك من أغمض الأمور فمن أين له أنلا يغفل فيأخذ لازخما بدل الفصل فيظن أنه ذاتي. الثالث أنه إذا شرطنا أن نأتي بجميع الفصول الذاتية حتى لا نخل بواحد، ومن أين نأمن من شذوذ واحد عنه لا سيما إذا وجد فصلا حصل به التمييز والمساواة للإسم في الحمل، كالجسم ذي النفس الحساس في مساواته لفظ الحيوان مع إغفال التحرك بالإرادة، وهذا من أغمض ما يدرك. الرابع ان الفصل مقوم للنوع ومقسم للجنس، وإذا لم يراع شرط التقسيم
أخذ في القسمة فصولا ليست أولية للجنس، وهو عسير غير مرضي في الحد، فإن الجسم كما ينقسم إلىالنامي وغير النامي انقساما بفصل ذاتي، فكذلك ينقسم إلى الحساس وغير الحساس وإلى الناطق وغير الناطق، ولكن مهما قيل الجسم ينقسم إلى ناطق وغير ناطق، فقد قسم بما ليس الفصل القاسم أوليا، بل ينبغي أن ينقسم أولا إلى النامي وغير النامي، ثم النامي ينقسم إلى الحيوان وغير الحيوان؛ ثم الحيوان إلى الناطق وغير. وكذلك الحيوان ينقسم إلى ذي رجلين وإلى ذي أرجل، ولكن هذا التقسيم ليس بفصول أولية، بل ينبغي أن يقسم لاحيوان إلىماشي وغير ماشي، ثم الماشي ينقسمب إلى ذي رجلين أو أرجل، إذ الحيوان لم يستعد للرجلين والأرجل باعتبار كونه حيوانا بل باعتبار كونه ماشيا، واستعد لكونه ماشيا باعتبار كونه حيوانا، فرعاية الترتيب في هذه الأمور شرط للوفاء بصناعة الحدود، وهو في غاية
العسر، ولذلك لما عسر ذلك اكتفى المتكلمون بالمميز فقالوا: " الحد هو القول الجامع المانع " ولم يشترطوا فيه إلا التمييز فيلزم عليه الإكتفاء بذكر الخواص فيقال في حد الفرس: إنه الصهال، وفي الإنسان: إنه الضحاك وفي الكلب: إنه النباح. وذلك في غاية البعد عن غرض التعرف لذات المحدود. ولأجل عسر التحديد رأينا ان نورد جملة من الحدود المعلومة المحررة في الفن الثاني من كتاب الحد، وقد وقع الفراغ عن الفن الأول بحمد الله سبحانه وتعالى.
الفن الثاني في الحدود المفصلة اعلم أن الأشياء التي يمكن تحديدها لا نهاية لها، لأن العلوم التصديقية غير متناهية، وهي تابعة للتصورية، فأقل ما يشتمل عليه التصديقي تصوران، وعلىالجملة فكل ما له إسم يمكن تحرير حده أو رسمه أو شرح اسمه، وإذا لم يكن في الإستقصاء مطمع فالأولى الإقتصار على القوانين المعرفة لطريقه، وقد حصل ذلك بالفن الأول، ولكن أوردنا حدودا مفصلة لفائدتين: إحداهما أن تحصل الدربة بكيفية تحرير الحد وتأليفه، فإن الإمتحان والممارسة للشيء تفيد لفائدتين: إحداهما أن تحصل الدربة بكيفية تحرير الحد وتأليفه، فإن الإمتحان والممارسة للشيء تفيد قوة عليه لا محالة. والثاني أن يقع الإطلاع على معاني أسماء أطلقها الفلاسفة، وقد أوردناها في كتاب تهافت الفلاسفة إذ لم يمكن مناظرتهم إلا بلغتهم وعلى حكم إصطلاحهم، وإذا لم يفهم ما أرادوه لا يمكن مناظرتهم إلا بلغتهم وعلى حكم إصطلاحهم، وإذا لم يفهمما أرادوه لا يمكن مناظرتهم، فقد أوردنا حدود ألفاظ أطلقوها في الإلهيات والطبيعيات وشيئا قليلا من الرياضيات، فليؤخذ هذه الحدود على أنها شرح للإسم، فإن قام البرهان على أن ما شرحوه هو كما شرحوه اعتقد حدا، وإلا اعتقد شرحا للإسم كما نقول: حدّ الجن حيوان هوائي ناطق مشف الجرم، من شأنه أن يتشكل بأشكال مختلفة،
فيكون هذا شرحا للغسم في تفاهم الناس. فأما وجود هذا الشيء على هذا الوجه فيعرف بالبرهان، فإن دل على وجوده كان حدا بحسب الذات، وإن لم يدل عليه بل دل على أن الجن المراد في الشرع الموصوف بوصفه أمر آخر، أخذ هذا شرحا للإسم في تفاهم الناس، وكما نقول في حد الخلا: إنه بعد يمكن ان يفرض فيه أبعاد ثلاثة، قائم لا في مادة، من شأنه أن يملأه جسم ويخلو عنه. وربما يدل الدليل على أن ذلك محال وجوده، فيؤخذ على انه شرح للإسم في إطلاق النظار. وإنما قدمنا هذه المقدمة لتعلم أن ما نورده من الحدود شرحا لما أراده الفلاسفة بالإطلاق، لا حكم بأن ماذكروه هو ما ذكروه، فإن ذلك ربما يتوقف على النظر في موجب البرهان عليه. والمستعمل في الإلهيات خمسة عشر لفظا وهو: الباري تعالى المسمة بلسانهم المبدأ الأول، والعقل، والنفس، والعقل الكلي، وعقل الكل، والنفس الكلية، ونفس الكل، والملك، والعلة، والمعلول، والإبداع، والخلق، والأحداث، والقديم. أما الباري عز وجل فزعموا أنه لا حد له ولا رسم له، لأنه لا جنس له ولا فصل له ولا عوارض تلحقه. والحد يلتئم بالجنس والفصل والرسم بالجنس والعوارض الفاصلة، وكل ذلك تركيب ولكن له قول يشرح اسمه، وهو أنه
الموجود الواجب الوجود الذي لا يمكن أن يكون وجوده من غيره، ولا يكون وجود لسواه إلا فايضا عن وجوده وحاصلا به إما بواسطة أو بغير واسطة، ويتبع هذا الشرح أنه الموجود الذي لا يتكثر لا بالعدد ولا بالمقدار ولا بأجزاء القوام كتكثر الجسم بالصورة والهيولي، ولا بأجزاء الحد كتكثر الإنسان بالحيوانية والنطق، ولابأجزاء الإضافة ولا يتغير لا في الذات ولا في لواحق الذات، وما ذكروه يشتمل على نفي الصفات ونفي الكثرة فيها، وذلك مما يخالفون فيه، فهذا شرح إسم الباري والمبدأ الأول عندهم. وأما العقل فهو إسم مشترك تطلقه الجماهير والفلاسفة والمتكلمون على وجوه مختلفة لمعان مختلفة، والمشترك لا يكون له حد جامع. أما الجماهير فيطلقونه على ثلاثة أوجه: الأول يراد به صحة الفطرة الأولى في الناس، فيقال لمن صحت فطرته الأولى: إنه عاقل، فيكون حده إنه قوة بها يجود التمييز بين الأمور القبيحة والحسنة. الثاني يراد به ما يكتسبه الإنسان بالتجارب من الأحكام الكلية، فيكون حده إنه معاني مجتمعة في الذهن تكون مقدمات يستنبط بها المصالح والأغراض. الثالث معنى آخر يرجع إلى وقار الإنسان وهيئته، ويكون حده إنه هيئة محمودة للإنسان في حركاته وسكناته وهيآته وكلامه واختياره، ولهذا الإشتراك يتنازع الناس في تسمية الشخص الواحد عاقلا
فيقول واحد: هذا عاقل، ويعني به صحة الغريزة، ويقول الآخر: ليس بعاقل ويعني به عدم التجارب وهو المعنى الثاني. وأما الفلاسفة فاسم العقل عندهم مشترك يدل على ثمانية معاني مختلفة: العقل الذي يريده المتكلمون، والعقل النظري، والعقل العملي، والعقل الهيولاني، والعقل بالملكة، والعقل بالفعل، والعقل المستفاد، والعقل الفعال. فأما الأول فهو الذي ذكره أرسطاليس في كتاب البرهان وفرق بينه وبين العلم، ومعنى هذا العقل هو التصورات والتصديقات الحاصلة للنفس بالفطرة، والعلم ما يحصل للنفس بالإكتساب، ففرقوا بين المكتب والفطري فيسمى أحدهما عقلا والآخر علما، وهو اصطلاح محض. وهذا المعنى هو الذي حد المتكلمون العقل به إذ قال القاضي أبو بكر الباقلاني في حد العقل: إنه علم ضروري بجواز الجائزات واستحالة المستحيلات، كالعلم باستحالة كون الشيء الواحد قديما وحديثا، واستحالة المستحيلات كالعلم باستحالة كون الشيء الواحد قديما وحديثا، واستحال كون الشخص الواحد في مكانين. وأما سائر العقول فذكرها الفلاسفة في كتاب النفس. أما العقل النظري فهي قوة للنفس تقبل ماهيات الأمور الكلية من جهة ما هي كلية،
وهي احتراز عن الحس الذي لا يقبل إلا الأمور الجزئية وكذا الخيال، وكأن هذا هو المراد بصحة الفطرة الأصلية عند الجماهير كما سبق. وأما العقل العملي فقوة للنفس هي مبدأ التحريك للقوة الشوقية إلى ما تختاره من الجزئيات، لأجل غاية مظنونة أو معلومة، وهذه قوة محركة ليس من جنس العلوم، وإنما سميت عقلية لأنها مؤتمرة للعقل مطيعة لإشاراته بالطبع، فكم من عاقل يعرف أنه مستضر باتباع شهواته، ولكنه يعجز عن المخالفة للشهوة لا لقصور في عقله النظري بل لفتور هذه القوة التي سميت العقل العملي، وإنما تقوى هذه القوة بالرياضة والمجاهدة والمواظبة على مخالفة الشهوات. ثم للقوة النظرية أربعة أحوال: الأولى أن لا يكون لها شيء من المعلومات حاصلة، وذلك للصبي الصغير، ولكن فيه مجرد الإستعداد فيسمى هذا عقلا هيولانيا. الثانية أن ينتهي الصبي إلى حد التمييز فيصير ما كان بالقوة البعيدة بالقوة القريبة، فإنه مهما عرض عليه الضروريات وجد نفسه مصدقا بها، لا كالصبي الذي هو ابن مهد، وهذا يسمى العقل بالملكة. الرابعة: العقل المستفاد، وهو أن تكون تلك المعلومات حاضرة في ذهنه وهو يطالعها ويلابس التأمل فيها، وهو العلم الموجود بالفعل الحاضر؛ فحد العقل الهيولاني أنه قوة للنفس مستعدة لقبول ماهيات الأشياء مجردة عن المواد، وبها يفارق الصبي الفرس وسائر الحيوانات لا بعلم حاضر ولا بقوة قريبة من العلم، وحد العقل بالملكة أنه استكمال العقل الهيولاني حتى يصير بالقوة القريبة من الفعل،
وحد العقل بالفعل إنه إستكمال للنفس بصور ما أي صور معقولة حتى متى شاء عقلها أو أحضرها بالفعل، وحد العقل المستفاد أنه ماهية مجردة عن المادة مرتسمة في النفس على سبيل الحصول من خارج. وأما العقول الفعالة فهو نمط آخر، والمراد بالعقل الفعال كل ما هية مجردة عن المادة أصلا، فحد العقل الفعال أما من جهة ما هوعقل إنه جوهري صوري ذاته ماهية مجردة في ذاتها، لا بتجريد غيرها لها عن المادة وعن علائق المادة، بل هي ماهية كلية موجودة، فاما من جهة ما هو فعال فإنه جوهر بالصفة المذكورةن من شأنه أن يخرج العقل الهيولاني من القوة إلى الفعل بإشرافه عليه، وليس المراد بالجوهر المتحيز كما يريده المتكلمون، بل ما هو قائم بنفسه لا في موضوع، والصوري احتراز عن الجسم وما في المواد. وقولهم " لا بتجريد غيره " احتراز عن المعقولات المرتسمة في النفس من أشخاص الماديات، فإنها مجردة بتجريد العقل إياها لا بتجردها في ذاتها. والعقل الفعال لمخرج لنفوس الآدميين في العلوم من القوة إلى العقل نسبته إلى المعقولات، والقوة العاقلة نسبة الشمس إلى المبصرات والقوة الباصرة، إذ بها يخرج الأبصار من القوة إلى الفعل، وقد يسمون هذه العقول الملائكة، وفي وجود جوهر على هذا الوجه يخالفهم المتكلمون، إذ لا وجود لقائم بنفسه ليس بمتحيز عندهم إلا الله وحده. والملائكة أجسام لطيفة متحيزة عند أكثرهم،
وتصحيح ذلك بطريق البرهان وماذكرناه شرح الإسم. وأما النفس فهو عندهم اسم مشترك يقع على معنى يشترك فيه الإنسان والحيوان والنبات، وعلى معنى آخر يشترك فيه الإنسان والملائكة السماوية عندهم، فحد النفس بالمعنى الأول عندهم أنه كمال جسم طبيعي آلي ذي حياة بالقوة، وحد النفس بالمعنى الآخر انه جوهر غير جسم، هو كمال أول للجسم محرك له بالإختيار عن مبدأ نطقي أي عقلي بالفعل أو بالقوة، فالذي بالقوة هو فصل النفس الإنسانية والذي بالفعل هو فصل أو خاصة للنفس الملكية. وشرح الحد الأول أن حبة البذر إذا طرحت في الأرض فاستعدت للنمو والإغتذاء فقد تغيرت عما كان عليه قبل طرحه في الأرض، وذلك بحدوث صفة فيه لو لم تكن لما استعد لقبولهما من واهب الصور، وهو الله تعالى وملائكته، فتلك الصفة كمال له فلذلك قيل في الحد: إنه كمال أول الجسم، ووضع ذلك موضع الجنس، وهذا يشترك فيه البذر والنطفة للحيوان والإنسان. فالنفس صورة بالقياس إلى المادة الممتزجة، إذ هي منطبعة في المادة وهي قوة بالقياس إلى فعلها. وكمال بالقياس إلى النوع النباتي والحيواني ودلالة الكمال اتم من دلالة القوة والصورة، فلذلك عبر به في محل الجنس، والطبيعي احتراز عن الصناعي، فإن صور الصناعات أيضا كمال فيها، والآلي إحتراز عن القوى التي في العناصر الأربعة، فإنها تفعل لا بآلات
بل بذواتها، والقوى النفسانية فعلها بآلات فيها، فغنها تفعل لا بآلات بل بذواتها، والقوى النفسانية فعلها بآلات فيها. وقولهم " ذو حياة بالقوة " فصل آخر أي من شأنه أن يحيا بالنشو ويبقى بالغذاء، وربما يحيا بإحساس وحركة هما في قوته. وقولهم " كمال أول الإحتراز بالأول عن قوة التحريك والإحساس " فإنه أيضا كمال للجسم لكنه ليس كمالا أولا يقع ثانيا لوجود الكمال الذي هو نفس. وأما نفس الإنسان والإفلاك فليست منطبعة في الجسم، ولكنها كمال الجسم على معنى أن الجسم يتحرك به عن إختيار عقلي. أما الأفلاك فعلى الدوام بالفعل، وأما الإنسان فقد يكون بالقوة تحريكه. وأما العقلي الكلي وعقل الكل والنفس الكلي ونفس الكل، فبيانه أن الموجودات عندهم ثلاثة أقسام: أجسام وهي أخسها، وعقول فعالة وهي أشرفها لبراءتها عن المادة وعلاقة المادة، حتى أنها لا تحرك المواد أيضا غلا بالشوق، وأوسطها النفوس وهي التي تنفعل من العقل وتفعل في الأجسام، وهي واسطة، ويعنون بالملائكة السماوية نفوس الأفلاك فإنها حية عندهم وبالملائكة المقربين العقول الفعالة. والعقل الكلي يعنون به المعنى المعقول المقول على كثيرين مختلفين بالعدد من العقول التي لإشخاص الناس، ولا وجود لها في القوام بل في التصور، فإنك إذا قلت الإنسان الكلي أشرت به إلى المعنى المعقول من الإنسان الموجود في سائر الأشخاص، الذي هو للعقل صورة واحدة تطابق سائر أشخاص الناس، ولا وجود لإنسانية واحدة هي إنسانية زيد، وهي بعينها إنسانية عمرو، ولكن في العقل تحصل صورة الإنسان من شخص زيد مثلا، ويطابق سائر أشخاص الناس كلهم فيسمى ذلك الإنسانية الكلية،
فهذا ما يعنون بالعقل الكلي. وأما عقل الكل فيطلق على معنيين: أحدهما وهو الأوفق للفظ أن يراد بالكل جملة العالم، فعقل الكل على هذا المعنى بمعنى شرح اسمه أنه جملة الذوات المجردة عن المادة، من جميع الجهات التي لا تتحرك لا بالذات ولا بالعرض، ولا تحرك إلا بالشوق، وآخر رتبة هذه الجملة هي العقل الفعال المخرج للنفس الإنسانية في العلوم العقلية من القوة إلى الفعل، وهذه الجملة هي مبادي الكل بعد المبدأ الأول. والمبدأ الأول هو مبدع الكل، وأما الكل بالمعنى الثاني فهو الجرم الأقصى، أعني الفلك التاسع الذي يدور في اليوم والليلة مرة فيتحرك كل ما هو حشوه من السموات كلها، فيقال لجرمه جرم الكل، ولحركته حركة الكل، وهو أعظم المخلوقات، وهو المراد بالعرش عندهم. فعقل الكل بهذا المعنى هو جوهر يجرد عن المادة من كل الجهات، وهو المحرك لحركة الكل على سبيل التشويق لنفسه ووجوده أول وجود مستفاد عن الأول، ويزعمون أنه المراد بقوله عليه الصلاة والسلام: " أول ما خلق الله العقل فقال له أقبل فاقبل " الحديث إلى آخره. وأما النفس الكلي فالمراد به المعنى المعقول المقول على كثيرين مختلفين في العدد، في جواب ما هو التي كل واحدة منها نفس خاصة لشخص، كما ذكرنا في العقل الكلي. ونفس الكل على قياس عقل الكل جملة الجواهر الغير الجسمانية التي هي كمالات مدبرة للأجسام السماوية المحركة لها على سبيل الإختيار العقلي. ونسبة نفس الكل إلى عقل الكل كنسبة أنفسنا إلى العقل الفعال.
ونفس الكل هو مبدأ قريب لوجود الأجسام الطبيعية ومرتبته في نيل الوجود بعد مرتبة عقل الكل، ووجوده فايض عن وجوده. وحد الملك أنه جوهر بسيط ذو حياة ونطق عقلي غير مائت، هو واسطة بين الباري عز وجل. والأجسام الأرضية فمنه عقلي ومنه نفسي؛ هذا حده عندهم. وحد العلة عندهم أنها كل ذات وجود ذات آخر إنما هو بالفعل من وجود هذا الفعل ووجود هذا بالفعل ليس من وجود ذلك بالفعل. وأما المعلول هو كل ذات وجوده بالفعل من وجود غيره، ووجود ذلك الغير ليس من وجوده، ومعنى قولنا من وجوده غير معنى قولنا مع وجودهن فإن معنى قولنا من وجوده هوأن يكون الذات باعتبار نفسها ممكنة الوجود، وإنما يجب وجودها بالفعل لا من ذاتها، بل لأن ذاتا أخرى موجودة بالفعل يلزم عنها وجوب هذا الذات، ويكون لها في نفسها بشرط عدم العلة الإمتناع. وأما قولنا مع وجوده فهو أن يكون كل واحد من الذاتين فرض موجودا لزم أن يعلم أن الآخر موجود، وإذا فرض مرفوعا لزم أن الآخر مرفوع،
والعلة والمعلول معا بمعنى هذين اللزومين، وإن كان بين وجهي اللزومين اختلاف لأن أحدهما، وهو المعلول، إذا فرض موجودا لزم ان يكون الآخر قد كان موجودا حتى وجد هذا. وأما الآخر، وهو العلة فإذا فرض موجودا حتى وجد هذا. وأما الآخر وهو العلة فإذا فرض موجودا لزم أن يتبع وجوده وجود المعلول، وإذا كان المعلول مرفوعا لزم أن يحكم ان العلة كانت أولا مرفوعة حتى رفع، لا أن رفع المعلول أوجب رفع العلةن وأما العلة فإذا رفعناها وجب رفع المعلول بإيجاب رفع العلة. حد الإبداع هو اسم مشترك لمفهومين: أحدهما تأسيس الشيء لا عن مادة ولا بواسطة شيء، والمفهوم الثاني ان يكون للشيء وجود مطلق عن سبب بلا متوسط، وله في ذاته ان لا يكون موجودا، وقد أفقد الذي له في ذاته إفقادا تاما. وبهذا المفهوم العقل الأول مبدع في كل حال لأنه ليس وجوده من ذاته، فله من ذاته العدم، وقد أفقد ذلك إفقادا تاما. وحد الخلق هو إسم مشترك، فقد يقال خلق لإفادة وجود حاصل عن مادة وصورة كيف كان؟ وقد يقال: خلق لهذا المعنى الثاني لكن بطريق الإختراع من غير سبق مادة فيها قوة وجوده وإمكانه. حد الأحداث هو إسم مشترك يطلق على وجهين: أحدهما زماني، ومعنى الأحداث الزماني الإيجاد للشيء بعد أن لم يكن له وجود في زمان سابق، ومعنى الأحداث الغير الزماني هو إفادة الشيء وجودا، وذلك الشيء
ليس له في ذاته ذلك الوجود، لا بحسب زمان دون زمان بل بحسب كل زمان. حد القدم والقدم يقال على وجوه، يقال قدم بالقياس، وقدم مطلق، والقدم بالقياس هو شيء زمانه في الماضي أكثر من زمان شيء آخر، فهو قدم بالقياس إليه. وأما القدم المطلق فهو أيضا على وجهين يقال بحسب الزمان وبحسب الذات، فأما الذي بحسب الزمان فهو الشيء الذي وجد في زمان ماض غير متناه. وأما القديم بحسب الزمان هو الذي ليس له وجود زماني وهو موجود للملائكة والسموات وجملة أصول العالم عندهم. والقديم بحسب الذات هو الذي ليس له مبدأ علي، أي ليس له علة، وليس ذلك إلا الباري عز وجل.
القسم الثالث هو المستعمل في الطبيعيات ونذكر منها خمسة وخمسين لفظا وهي: الصورة، والهيولي، والموضوع، والمحمول، والمادة، والعنصر، والأسطقس، والركن، والطبيعة، والطبع، والجسم، والجوهر، والعرض، والنار، والهواء، والماء، والأرض، والعالم، والفلك، والكوكب، والشمس، والقمر، والحركة، والدهر، والزمان، والآن، والمكان، والخلا، والملا، والعدم، والسكون، والسرعة، والبطء، والإعتماد، والميل، والخفة، والثقل، والحرارة، والرطوبة، والبرودة، واليبوسة، والخشن، والملس، والصلب، واللين، والرخو، والمشف، والتخلخل، والإجتماع، والتجانس، والمداخل، والمتصل، والإتحاد، والتتالي، والتوالي.
حد الصورة: واسم الصورة مشترك بين ستة معان: الأول هو النوع يطلق ويراد به النوع الذي تحت الجنس، وحده بهذا المعنى حد النوع، وقد سبق في مقدمات كتاب القياس. الثاني الكمال الذي به يستكمل النوع استكماله الثاني فإنه يسمى صورة، وحده بهذا المعنى كل موجود في الشىء لا كجزء منه، ولا يصح قوامه دونه ولأجله وجد الشيء مثل العلوم والفضائل في الإنسان. الثالث ماهية الشيء كيف كان قد يسمى صورة، فحده بهذا المعنى، كل موجود في الشيء لا كجزء منه، ولا يصح قوامه دونه كيف كان. الرابع الحقيقة التي تقوم المحل بها، وحدّه بهذا المعنى أنه الموجود في شيء آخر لا كجزء منه ولا يصح وجودها مفارقا له، لكن وجوده هو بالفعل حاصل له مثل صورة الماء في هيولي الماء، إنما يقوم بالفعل بصورة الماء أو بصورة أخرى حكمها حكم سورة الماء، والصورة التي تقابل بالهيولي هي هذه الصورة. الخامس الصورة التي تقوم النوع يسمى صورة، وحده بهذا المعنى أنه الموجود في شيء لا كجزء منه نولا يصح قوامه مفارقا له، ولا يصح قوام ما فيه دونه، إلا أن النوع الطبيعي يحصل به كصورة الإنسانية والحيوانية في الجسم الطبيعي الموضوع له. السادس الكمال المفارق وقد يسمى صورة مثل النفس للإنسان، وحده بهذا المعنى أنه جزء غير جسماني مفارق يتم به، وبجزء جسماني نوع طبيعي. حد الهيولي إما الهيولي المطلقة فهي جوهر وجوده بالفعل، إنما يحصل بقبوله الصورة الجسمانية كقوة قابلة للصورة، وليس له في ذاته صورة إلا بمعنى القوة، وهو الآن عندهم قسم الجسم المنقسم بالقسمة المعنوية، لست أول بالقسمة الكمية المقدارية إلى الصورة والهيولي، والقول في إثبات ذلك طويل ودقيق،
وقد يقال هيولي لكل شيء من شأنه أني قبل كمالا وأمرا ما ليس فيه، فيكون بالقياس إلى ما ليس فيه هيولي وبالقياس إلى ما فيه موضوع، فمادة السرير موضوع لصورة السرير، هيولي الصورة الرمادية التي تحصل بالإحتراق. الموضوع قد يقال لكل شيء من شأنه أن يكون له كمال ما، وكان ذلك الكمال حاضرا، وهو الموضوع له، ويقال موضوع لكل محل متقوم بذاته مقوم لمايحله، كما يقال هيولي للمحل الغير المتقوم بذاته بل بما يحله، ويقال موضوع لكل معنى بسلب أو إيجاب وهو الذي يقابل بالمحمول. المادة قد يقال إسما مرادفا للهيولي، ويقال مادة لكل موضوع يقبل الكمال بإجتماعه إلى غيره، ووروده عليه يسيرا مثل المني والدم لصورة الحيوان، فربما كان ما يجامعه من نوعه وربما لم يكن من نوعه. العنصر إسم للأصل الأول في الموضوعات، فيقال عنصر للمحل الأول الذي باستحالته يقبل صورا تتنوع بها الكائنات الحاصلة منه، إما مطلقا وهو العقل الأول، وإما بشرط الجسمية وهوالمحل الأول من الأجسام التي تتكون عنه سائر الأجسام الكائنة لقبوله صورها. الأسطقس هوالجسم الأول الذي باجتماعه إلى أجسام أول مخالفة له في النوع يقال له أسطقس، فلذلك قيل إنه آخر ما ينتهي غليه تحليل الأجسام، فلا توجد عند الإنقسام إليه قسمة إلا إلى أجزاء متشابهة. الركن هو جوهر بسيط، وهو جزء ذاتي للعالم مثل الأفلاك والعناصر، فالشيء بالقياس إلى العالم ركن وبالقياس إلى ما يتركب منه اسطقس، وبالقياس إلى ما تكون عنه عنصر، سواء كان كونه عنه بالتركيب والإستحالة
معا أو بالإستحالة المجردة عنه، فإن الهواء عنصر السحاب بتكاثفه، وليس اسطقسا له، وهو اسطقس وعنصر للنبات. والفلك هو ركن وليس باسطقس ولا عنصر لصورة، ولصورته موضوع، وليس له عنصر مهما عني بالموضوع محل لأمر هو فيه بالفعل ولم يعن به محل متقدم. وهذه الأسماء التي هي الهيولي والموضوع والعنصر والمادة والأسطقس والركن قد يستعمل على سبيل الترادف، فيبدل بعضها مكان بعض بطريق المسامحة، حيث يعرف المراد بالقرينة. الطبيعة مبدأ أول بالذات لحركة الشيء وكمال ذاتي للشيء، فالحجر إذا هوى إلى أسفل فليس يهوي لكونه جسما بل لمعنى آخر يفارقه سائر الأجسام فيه، فهو معنى به يفارق النار التي تميل إلى فوق، وذلك المعنى مبدأ لهذا النوع من الحركة ويسمى طبيعية. وقد يسمى نفس الحركة طبيعة فيقال طبيعة الحجر الهوى. وقد يقال طبيعة للعنصر والصورة الذاتية. والأطباء يطلقون لفظ الطبيعة على المزاج وعلى الحرارة الغريزيةن وعلى هيئات الأعضاء وعلى الحركات وعلى النباتية، ولكل واحد حد آخر ليس يتعلق الغرض به، فلذلك اقتصرنا على الأول. الطبع هو كل هيئة يستكمل بها نوع من الأنواع، فعليه كانت أو انفعالية، وكأنها أعم من الطبيعة، وقد يكون الشيء عن الطبيعة وليس بالطبع مثل الأصبع الزائدة، ويشبه أن يكون هو بالطبع بحسب الطبيعة الشخصية، وليست بالطبع بحسب الطبيعة الكلية، ولعموم الطبع للفعل والإنفعال كان أعم من الطبيعة التي هي مبدأ فعلي. الجسم إسم مشترك قد يطلق على المسمى به من حيث أنه متصل محدود ممسوح في أبعاد ثلاثة بالقوة؛ أعني أنه ممسوح بالقوة وإن لم يكن بالفعل.
وقد يقال جسم لصورة يمكن أن يعرض فيها أبعاد كيف نسبت طولا وعرضا وعمقا، ذات حدود متعينة، وهذا يفارق الأول في أنه لو لم يشترط كون الجملة محدودا ممسوحا بالقوة أو بالفعل، أو اعتقد أن أجسام العالم لا نهاية لها، لكا كل جزء منها يسمى جسما بهذا الإعتبار، والفرق بين الكم وهذه الصورة أن قطعة من الماء ولاشمع كلما بدلت أشكالها تبدلت فيها الأبعاد المحدودة الممسوحة، ولم يبق واحد منها بعينه واحدا بالعدد، وبقيت الصورة القابلة لهذه الأحوال واحدة بالعدد من غير تبدل. والصورة القابلة لهذه الأحوال هي جسمية، وكذلك إذا تكاثف الجسم مثلا كانقلاب الهواء بالتكاثف سحابا أو ماء، أو تخلخل مثلا الجمد لما يستحيل صورته الجسمية، واستحال أبعاده ومقداره، ولهذا يظهر الفرق بين الصورة الجسمية التي هي من باب الكم، وبين الصورة التي هي من باب الجوهر. الجوهر إسم مشترك يقال جوهر لذات كل كالإنسان، أو كالبياض فيقال جوهر البياض وذاته، ويقال جوهر لكل موجود، وذاته لا يحتاج في الوجود إلى ذات اخرى تقارنها حتى يكون بالفعل، وهو معنى قولهم الجوهر قائم بنفسه، ويقال جوهر لما كان بهذه الصفة وكان من شأنه أن يقبل الأضداد بتعاقبها عليه، ويقال جوهر لكل ذات وجوده ليس في موضوع، وعليه اصطلاح الفلاسفة القدماء. وقد سبق الفرق بين الموضوع والمحل فيكون معنى قولهم الموجود لا في موضوع الموجود غير مقارن الوجود لمحل قائم بنفسه مقوم له، ولا بأس بأن يكون في محل لا يتقوم المحل دونه بالفعل، فإنه وإن كان في محل فليس في موضوع،
فكل موجود إن كان كالبياض والحرارة والحركة والعلم فهو جوهر بالمعنى الأول، والمبدأ الأول جوهر بالمعاني كلها إلا بالوجه الثالث وهو تعاقب الأضداد. نعم قد يتحاشى عن إطلاق لفظ الجوهر عليه تأدبا من حيث الشرع. والهيولي جوهر بالمعنى الرابع والثالث، وليس جوهرا بالمعنى الثاني، والصورة جوهر بالمعنى الرابع وليس جوهرا بالمعنى الثاني والثالث، والمتكلمون يخصصون إسم الجوهر بالجوهر الفرد المتحيز الذي لا ينقسم ويسمون المنقسم جسما لا جوهران وبحكم ذلك يمتنعون عن إطلاق إسم الجوهر على المبدأ عز وجل، والمشاحة في الأسماء بعد إيضاح المعاني دأب ذوي القصور. العرض غسم مشترك فيقال لكل موجود في محل عرض، ويقال عرض لكل موجود في موضوع، ويقال عرض للمعنى الكلي المفرد المحمول على كثيرين حملا غير مقوم، وهو العرض الذي قابلناه بالذاتي في كتاب مقدمات القياس. ويقال عرض لكل معنى موجود للشيء خارج عن طبعه، ويقال عرض لكل معنى يحمل على الشيء لأجل وجوده في آخر يفارقه، ويقال عرض لكل معنى وجوده في أول الأمر لا يكون؛ فالصورة عرض بالمعنى الأول فقط، وهو الذي يعنيه المتكلم إذا ما قابله بالجوهر والأبيض، أي الشيء ذو البياض الذي يحمل على الثلج والجص والكافور ليس هو عرضا بالوجه الأول والثاني، وهو عرض بالوجه الثالث، وذلك لأن هذا الأبيض الذي هو نوع محمول غير مقوم، وهو جوهر ليس في موضوع ولا محل، فالبياض هو الحال في محل وموضوع، والبياض لا يحمل على الثلج
فلا ثلج بياضن بل يقال أبيض، ومعناه انه شيء ذو أبيض فلا يكون هذا حملا مقوما. وحركة الحجر إلى أسفل عرض بالوجه الأول والثاني والثالث، وليس عرضا بالوجه الرابع والخامس والسادس، بل حركته إلى فوق عرض بجميع هذه الوجوه، وحركة القاعد في السفينة عرض بالوجه السادس والرابع. الفلك عندهم جسم بسيط كري غير قابل للكون والفساد، متحرك بالطبع على الوسط مشتمل عليه. الكوكب جسم بسيط كري، مكانه الطبيعي نفس الفلك، من شأنه أن يكون غير قابل للكون والفساد متحرك على الوسط غير مشتمل عليه. الشمس كوكب هو أعظم الكواكب كلها جرما وأشدها ضوءا، ومكانه الطبيعي في الكرة الرابعة. القمر هو كوكب مكانه الطبيعي في الأسفل، من شأنه أن يقبل النور من الشمس على أشكال مختلفة ولونه الذاتي إلى السواد. النار جسم بسيط طباعة أن يكون حارا يابسا متحركا بالطبع عن الوسط، يستقر تحت كرة القمر. الهواء جرم بسيط طباعه أن يكون حارا رطبا مشفا لطيفا، متحركا إلى المكان الذي تحت كرة النار فوق كرة الأرض. الماء جرم بسيط طباعه أن يكون باردا رطبا مشفا، متحركا إلى المكان الذي تحت كرة الهواء وفوق الأرض. الأرض جسم بسيط طباعه أن يكون باردا يابسا، متحركا إلى الوسط نازلا فيه. العالم هو مجموع الأجسام الطبيعية البسيطة كلها
ويقال عالمالكل جملة موجودات متجانسة، كقولهم عالم الطبيعة وعالم النفس وعالم العقل. الحركة كمال أول بالقوة من جهة ما هو بالقوة، وإن شئت قلت هو خروج من القوة إلى الفعل لا في آن واحد، كل تغير عندهم يسمى حركة. واما حركة الكل فهو حركة الجرم الأقصى على الوسط مشتملة على جميع الحركات التي على الوسط وأسرع منها. الدهر هوالمعنى المعقول من إضافة الثبات إلى النفس في الزمان كله. الزمان هومقدار الحركة موسوم من جهة التقدم والتأخر. الآن هو ظرف يشترك فيه الماضي والمستقبل من الزمان، وقد يقال أن الزمان صغير المقدار عن الوهم متصل بالآن الحقيقي من جنسه. المكان هو السطح الباطن من الجوهر الحاوي المماس للسطح الظاهر من الجسم المحوي. وقد يقال مكان للسطح الأسفل الذي يستقر عليه شيء، يقله، ويقال مكان بمعنىثالث إلا أنه غير موجود، وهو أبعاد متناهية كأبعاد المتمكن يدخل فيها أبعاد المتمكن، وإن كان يجوز أن يلفى من غير متمكن كان هو الخلا، وإن كان لا يجوز إلا أن يشغلها جسم موجود فيه فليس بخلا. الخلا بعد يمكن أن يفرض فيه أبعاد ثلاثة قوائم لا في مادة، من شأنه أن يملأه جسم وان يخلو عنه، ومهما لم يكن هذا موجودا كان هذا الحد شرحا للإسم. الملا هو جسم من جهة ما تمانع أبعاده دخول جسم آخر فيه. العدم الذي هو أحد المبادي للحوادث هو ان لا يكون في شيء ذات شيء، من شأنه أن يقبله ويكون فيه.
السكون هو عدم الحركة فيما من شأنه أن يتحرك بأن يكون هو في حالة واحدة من الكم والكيف والأين والوضع زمانا، فيوجد عليه في آنين. السرعة كون الحركة قاطعة لمسافة طويلة في زمان قصير. البطء والميل هو كيفية بها يكون الجسم مدافعا لما يمنعه عن الحركة إلى جهته. الخفة قوة طبيعية يتحرك بها الجسم عن الوسط بالطبع. الثقل قوة طبيعية يتحرك بها الجسم إلى الوسط بالطبع. الحرارة كيفية فعلية محركة لما تكون فيه إلى فوق لأحداثها الخفة، فيعترض ان تجمع المتجانسات وتفرق المخلتفات، وتحدث تخلخلا من باب الكيف في الكيفي، وتكاثفا من باب الوضع فيه بتحليله وتصعيده اللطيف. البرودة كيفية فعلية يفعل بين المتجانسات وغير المتجانسات، بحصرها الأجسام بتقليصها وعقدها اللذين من باب الكيف. الرطوبة كيفية انفعالية بها يقبل الجسم الحصر والتشكيل الغريب بسهولة، ولا يحفظ ذلك بل يرجع إلى شكل نفسه ووضعه الذي بحسب حركة جرمه في الطبع. اليبوسة كيفية انفعالية لجسم عسير الحصر والتشكيل الغريب عسر الترك والعود إلى شكله الطبيعي. الخشن هو جرم سطحه ينقسم إلى أجزاء مختلفة الوضع. الأملس هو جرم سطحه ينقسم إلى أجزاء متساوية الوضع. الصلب هو الجرم الذي لا يقبل دفع سطحه إلى داخل إلا بعسر. اللين هو الجرم الذي يقبل ذلك. الرخو جرم ليس سريع الإنفصال المشف جرم ليس له في ذاته لون، ومن شأنه يرى بتوسطه ماوراءه.
التخلخل اسم مشترك يقال تخلخل لحركة الجسم من مقدار إلى مقدار أكبر، يلزمه أن يصير قوامه أرق. ويقال تخلخل لكيفية هذا القوام. ويقال تخلخل لحركة أجزاء الجسم عن تقارب بينها إلى تباعد فيتخللها جرم أرق منها، وهذه حركة في الوضع والأول في الكم. ويقال تخلخل لنفس وضع أجزاء هذا، ويفهم حد التكاثف من حد التخلخل، ويعلم أنه مشترك يقع على أربعة معان مقابلة لتلك المعانيي: واحدة منها حركة في الكم، والآخر كيفية، والثالث حركة في الوضع، والرابع وضع. الإجتماع وجود أشياء كثيرة يعمها معنى واحد، والإفتراق مقابله. المتجانسان هما اللذان لهما تشابه معا في الوضع، وليس يجوز أن يقع بينهما ذو وضع. المداخل هو الذي يلاقي الآخر بكلية حتى يكفيهما مكان واحد. المتصل إسم مشترك يقال لثلاثة معان: أحدها هو الذي يقال له متصل في نفسه الذي هو فصل من فصول الكم، وحدّه أنه ما من شأنه أن يوجد بين أجزائه حد مشترك، ورسمه أنه القابل للإنقسام بغير نهاية. والثاني والثالث هما بمعنى المتصل،
وأولهما من عوارض الكم المتصل بالمعنى الأول من جهة ما هو كم متصل، وهو أن المتصلين هما اللذان نهايتاهما واحدة، والثالث شركة في الوضع ولكن مع وضع، وذلك أن كل ما نهايته ونهاية شيء آخر واحد بالفعل يقال إنه متصل، مثل خطي زاوية. والمعنى الثالث هو من عوارض الكم المتصل من جهة ما هو في مادة، وهو أن المتصلين بهذا المعنى هما اللذان نهاية كل واحد منهما ملازم لنهاية الآخر في الحركة، وإن كان غيره بالفعل مثل إتصال الأعضاء بعضها ببعض وإتصال الرباطات بالعظام. وبالجملة كل مماس ملازم عسير القبول للإنفصال الذي هو مقابل للماسة. الإتحاد إسم مشترك، فيقال إتحاد لإشتراك أشياء فيمحمول واحد ذاتي أو عرضي، مثل اتحاد الكافور والثلج في البياض، والإنسان والثور في الحيوانية. ويقال إتحاد لإشتراك محمولات في موضوع واحدن مثل اتحاد الطعم والرائحة في التفاح. ويقال اتحاد لإجتماع الموضوع والمحمول في ذات واحدة كجزئي الإنسان من البدن والنفس ويقال اتحاد لإجتماع أجسام كثيرة إما بالتتالي كالمائدة، وإما بالجنس كالكرسي والسرير، وإما باتصال كأعضاء الحيوان، وأحق هذا الباب بإسم الإتحاد هو حصول جسم واحد بالعدد من إجتماع أجسام كثيرة لبطلان خصوصياتها، لأجل إرتفاع حدودها المنفردة وبطلان إستقلالها بالإتصال. التتالي هو كون شيء بعد شيء بالقياس إلى مبدأ محدود، وليس بينهما شيء من بابهما.
القسم الثالث ما يستعمل في الرياضيات، ولما لم نتكلم في كتاب تهافت الفلاسفة على الرياضيات اقتصرنا من هذه الألفاظ على قدر يسير، وقد يدخل بعضها في الإلهيات والطبيعيات في الأمثلة والإستشهادات، وهي ست ألفاظ: النهاية، وما لا نهاية، والنقطة، والخط، والسطح، والبعد. النهاية هي غاية ما يصير الشيء ذو الكمية إلى حيث لا يوجد وراءه شيء منه. ما لا نهاية له هو كم ذو أجزاء كثيرة، بحيث لا يوجد شيء خارج عنه وهومن نوعه، وبيحث لا ينقضي. النقطة ذات غير منقسمة، ولها وضع وهي نهاية الخط. الخط هو مقدار لا يقبل الإنقسام إلا من جهة واحدة وهو نهاية السطح. السطح مقدار يمكن أن يحدث فيه قسمان متقاطعان على قوائم، وهو نهاية الجسم. البعد هو كل ما يكون بين نهايتين غير متلاقيتين ويمكن الإشارة إلى جهته، ومن شأنه أنه يتوهم أيضا فيه نهايات من نوع تينك النهايتين، والفرق بين البعد والمقادير الثلاثة أنه قد يكون بعد خطي من غير خط، وبعد سطحي من غير سطح. مثاله أنه إذا فرض في جسم لا إنفصال في داخله نقطتان كان بينهما بعد ولم يكن بينهما خط.
وكذلك إذا توهم فيه خطان متقابلان كان بينهما بعد ولم يكن بينهما سطح، لأنه إنما يكون بينهما سطح إذا انفصل بالفعل بأحد وجوه الإنفصال، وإنما يكون فيه خط إذا كان فيه سطح، ففرق إذا بين الطول والخط وبين العرض والسطح، لأن البعد الذي بين النقطتين المذكورتين هو طول وليس بخط، والبعد بين الخطين المذكورين هو عرض وليس بسطح، وإن كان كل خط ذا طول، وكل سطح ذا عرض وقد نجز غرضنا من كتاب الحد قانونا وتفصيلا.
كتاب أقسام الوجود وأحكامه
مقصود هذا الكتاب البحث عن أقسام الوجود، اعني الأقسام الكلية والبحث عن عوارضها الذاتية التي تلحقها من حيث الوجود، وهو المراد بأحكامه وقد سبق الفرق بين العوارض الذاتية والتي ليست بذاتية، ولواحق الشيء أعني محمولاته تنقسم إلى ما يوجد شيء أخص منه، وإلى ما لا يوجد شيء أخص منه، فالذي يوجد ما هو أخص منه ينقسم، فمنه فصول منه أعراض ذاتية، وقد سبق الفرق بينهما. وبالفصول ينقسم الشيء إلى أنواعه، وبالأعراض ينقسم إلى اختلاف أحواله، وقد سبق الفرق بين الفصول وبين الأعراض العامة، وإنقسام الوجود إلى الأقسام العشرة التي واحد منها جوهر وتسعة أعراض كما سبق، جملتها يشبه الإنقسام بالفصول وإن لم تكن بالحقيقة كذلك، إذ ذكرنا في تحقيق الفصل ودخوله في الماهية ما يخرج هذه الأمور عن الفصول، كما خرج الوجود والشيء عن الأجناس، وذلك بحكم ما سبق من الإصطلاح.
وانقسامه إلى ما هو بالقوة والفعلن وإلى الواحد والكثير والمتقدم والمتأخر والعام والخاص والكلي والجزئي، والقديم والحادث والتام والناقص والعلة والمعلول، والواجب والممكن وما يجري مجراها، يشبه الإنقسام بالعوارض الذاتية، فإن هذه الأمور لا تلحق الموجود لأمر أعم منه إذ لا أعم من الوجود، ولا لأمر أخص منه كالحركة فإنها تلحق الموجود من حيث كونه جسما لا من حيث كونه موجودا. ومقصودنا من النظر في هذا ينقسم إلى فنين: (الفن الأول) في أقسام الوجود وهي عشرة أنواع في أنفسها، ثم يكون أمرها في النفس أعني العلم بها أيضا عشرة متباينة، فإن العلم معناه مثال مطابق للمعلوم كالصورة والنقش الذي هو مثال الشيء، فيكون لها عشر عبارات إذ الألفاظ تابعة للآثار الثابتة في النفس المطابقة
للأشياء الخارجية، وتلك الألفاظ هي: الجوهر والكم والكيف والمضاف والأين، ومتى والوضع وله وأنيفعل وأن ينفعل. فهذه العبارات أوردها المنطقيون، ونحن نكشف معنى كل واحد منها، وبعد الإحاطة بالمعنى فلا مشاحة في الألفاظ. القول في الجوهر إعلم أن الموجود ينقسم بنوع من القسمة إلى الجوهر والعرض، وإسم كل من الجوهر والعرض مشترك كما سبق، ولكنا نعني الآن من جملتها شيئا واحدا فنريد بالجوهر الموجود لا في موضوع، ونريد بالموضوع المحل القريب الذي يقوم بنفسه لا بتقويم الشيء الحال فيه كاللون في الإنسان بل في الجسم، فغن ماهية الجسم لا تتقومب اللون بل اللون عارض يلحق بعد قوام ماهية الجسم بذاته، لا كصورة المائية في الماء، فإنها إذا فارقت عند إنقلاب الماء هواء، كان المفارق ما تتبدل الماهية بسببه لا كالحرارة والبرودة إذا فارقت الماء، فإن الماهية لا تبدل فإنا إذا سئلنا عن الحار والبارد: ما هو؟ قلنا: هو ماء. وإذا سئلنا عن الهواء لم نقل إنه ماء.
وإن أوردنا ثم وقلنا ماء حار أو بارد ولم نورد ههنا فنقول ماء قد تخلخل وانتشر، فإن صورة المائية قد زالت. والمتكلمون أيضا يسمون هذا أيضا عرضا، فإنهم يعنون بالعرض ما هو في محل، وهذه الصورة في محل والإصطلاح لا ينبغي أن ينازع فيه، فلكل فريق أن يصطلح في تخصيص العرض بما يريد، ولكن لا يمكن إنكار الفرق بين الحرارة بالنسبة إلى الماء التي تزول عند البرودة، وبين صورةالمائية التي تزول عند إنقلابه هواءن فإن الزائل ههنا يبدل المذكور في جواب ما هو والزائل لثم لا يبدله. والجوهر على إصطلاح المتكلمين عبارة عما ليس في محل، فصورة عندهم جوهر والمعنى المشترك بين الماء والهواء إذا استحال الماء هواء يسمى عندهم أيضا جوهرا وهو الهيولي، فإذا فهم معنى الموضوع، فالفرق بينه وبين المحمول إن الجوهر ينقسم إلى مال يس في الموضوع، ولا يمكن أن يكون محمولا، وإلى ما ليس في موضوع، ويمكن حمله على موضوع. والأول هو الجوهر الشخصي كزيد وعمرو. والثاني هو الجواهر الكلية كالإنسان والجسم والحيوان، فإنا نشير إلى موضوع مثل زيد ونحمل هذه الجواهر عليه، وتقول زيد إنسان وحيوان وجسم، فيكون المحمول جوهرا لا عرضا غلا أنه محمول عرف ذات الموضوع، وليس خارجا عن ذاته، لا كالعرض إذا حمل على الجوهر فإنه يعرف به شيء خارج عن ذاته، لا كالعرض إذا حمل على الجوهر فإنه يعرف به شيء خارج عن ذات الموضوع، إذ البياض يحملعلى الجوهر وهو خارج عن ذات الجوهر، ولذلك لا يحد هذا الموضوع بحد المحمول، إذ تقول في حد البياض: إنه لو يفرق البصر ولا يحد الموضوع.
وأما الإنسان والحيوان والجسم ونظائرها فنحملها على شخص زيد، ويحد هذه الجواهر بحد، وهو بعينه حد الموضوع، إذ نقول لزيد: إنه حيوان ناطق مائت، او هو جسم ذو نفس حساس متحرك بالإرادة؛ فبهذا يتهيأ الفرق بين الجواهر الكلية والجواهر الجزئية. وأما الأعراض فجملتها في موضوع، ولكنها تنقسم إلى ما يقال علىموضوع بطريق الحمل عليه، وإلى ما لا يحمل على موضوع، فالمحمول على موضوع هي الأعراض الكلية كاللون مثلا، فإنه يحمل على البياض والسواد وغيره، فيقال: البياض لون والسواد لون. وأما الأعراض الشخصية فلايمكن حملها ككتابة زيد وبياض شخص، إذ لا يمكن أن يحمل على شىء حتى يقال هو كتابة زيد أو بياض شخص، وإذا قلت زيد كاتب أو أبيض لم يكن ذلك حملا للبياض بل معناه هو ذو كتابة. ومهما قلنا هو ذو إنسان لم يكن الإنسان محمولا، وكذا إذا ذو بياض، فإذا الشيء إنما يمكن أن يكون محمولا باعتبار كونه كليا، عرضيا كان أو جوهرا. وسيأتي حقيقة معنىالكلي في أحكام الوجود. فإن قيل: فالجوهر الكلي أولى بمعنى الجوهرية أم الشخصي؟ قلنا: الجوهر الكلي على ما سيأتي قوامه بالشخصيات، إذ لولاها لم تكن
الكليات موجودةن فالشخص في الرتبة متقدم عليه، لكن الشخص في صيرورته معقولا يفتقر إلى الكلي ولا يفتقر ف يالوجود إليه، وتحقيق هذا عند بيان معنى الكلي. فإن قيل: فما أقسام الجوهر؟ قلنا: إذا أريد بهذا الجوهر القائم لا في محل فقط أو القائم لا في موضوع انقسم إلى جسم، أعني إلى متحيز وغير متحيز، والجسم ينقسم إلى مغتذ وغير مغتذ. والمغتذي ينقسم إلى حيوان وإلى غير حيوان. والحيوان ينقسم إلى ناطق وغير ناطق، وهذا تدخل فيه الحيوانات كلها على اختلاف أصنافها، وينفصل كل نوع بفصل يخصه وإن كنا لا نشعر به. وغير المغتذي يدخل فيه السماء والواكب والعناصر الأربعة والمعادن كلها؛ فهذه أقسام الجواهر. وذهب أكثر المتكلمين أن الجواهر المتحيزة كلها جنس واحد، وإنما تختلف بأعراضها، إذ للجسم ماهية واحدة وهو كونه متحيزا مؤتلفا، فكونه حيا معناه قيام العلم والحياة به. والفلاسفة يقولون: إن هذه الجواهر مختلفة في أنفسها بإختلاف حدودها،
وإن الصفات المقومات لها هيئات للأشياء التي بتبدل ماهيتها يتبدل جواب ما هو، ويوجب اختلافا في تحقيق الذات وتحقيق الحق في هذين المذهبين ليس من غرضنا، بل الغرض بيان معنى الجوهر وأقسامه. وقد حان القول في الكمية والمقدار. اعلم أن الكم عرض، وهو عبارة عن المعنى الذي يقبل التجزؤ والمساواة والتفاوت لذاته، فالمساواة والتفاوت والتجزؤ من لواحق الكم، فإن لحق غيره فبواسطته لا من حيث ذات ذلك الغير، وهو ينقسم إلى الكم المتصل والمنفصل. أما المتصل فهو كل مقدار يوجد لأجزائه حد مشترك يتلاقى عنده طرفاه، كالنقطة للخط والخط للسطح، والآن الفاصل، للزمان الماضي والمستقبل. والمتصل ينقسم إلى ذي وضع وإلى ما ليس بذي وضع، وذو الوضع هو الذي لأجزائه اتصال وثبات وتساوق في الوجود معا، بحيث يمكن أن يشار إلى كل واحد منهما أنه أين هو من الآخر، فمن ذلك ما يقبل القسمة في جهة واحدة فقط كالخط،
ومنه ما يقبل في جهتين متقاطعتين على قوائم وهو السطح، ومنه ما يقبل في جميعها على قوائم وهو الجسم. والمكان أيضا ذو وضع لأنه السطح الباطن من لحاوي فإنه يحيط بالمحوي فهو مكانه. وفريق يقولون: مكان الماء من الآنية الفضا الذي يقدر خلاء صرفا لو فارقه الماء ولم يخلفه غيره، وهذا أيضا عند القائل من جملة الكم المتصل فإنه مقدار يقبل الإنقسام والمساواة والتفاوت. وأما الزمان فهو مقدار الحركة إلا أنه ليس له وضع، إذ لا وجود لأجزائه معا، وإن كان له إتصال إذ ماضيه ومستقبله يتحدان بطرف الآن. وأما المنفصل فهو الذي لا يوجد لأجزائه لا بالقوة ولا بالفعل شيء مشترك يتلاقى عنده طرفاه كالعدد والقول، فإن العشرة مثلا لا إتصال لبعض أجزائها بالبعض، فلو جعلت خمسة من جانب وخمسة من جانب لم يكن بينهما حد مشترك يجري مجرى النقطة من الخط والآن من الزمان، والأقاويل أيضا من جملة ما يتعلق بالكمية فإن كل ما يمكن أن يقدر ببعض أجزائه فهو ذو أقدار، إذ العشرة يقدرها الواحد بعشر مرات والإثنين بخمسة، وما من عدد إلا ويقدر ببعض أجزائهن وكذلك الزمان فإن الساعة تقدر الليل والنهار، والنهار والليل يقدر بهما الشهر، وبالشهر السنة. وهذه الأمور تجريمجرى الأذرع من الأطوال، فكذلك الأقاويل تقدر ببعض أجزائها، كما يقدر في العروض إذ به تعرف الموازنة والمساواة والوحدة والتفاوت، فهذه أقسام الكمية.
القول في الكيفية والمعني بها الهيئات التي بها يحاب عن سؤال السائل عن آحاد الأشخاص إذا قال كيف هو، واحترزنا بالأشخاص عنالفصول فغن ذلك يذكر في السؤال عن المميز للشيء بأي شيء هو. وبالجملة هي عبارة عن كل هيئة قارة في الجسم لا يوجب اعتبار وجودها فيه نسبة للجسم إلى خارج، ولا نسبة واقعة في أجزائه. وهذان الفصلان للإحتراز عن الإضافة والوضع كما سيأتي. ثم هذه الكيفية تنقسم إلى ما يختص بالكم من جهة ما هو كم كالتربيع للسطح، والإستقامة للخط والفردية للعدد وكذا الزوجية. وأما الذي لا يختص بالكم فينقسم إلى المحسوس وغير المحسوس. أما المحسوس فهو الذي ينفعل عنه المحسوس أي يحدث فيها آثارا منها، كاللون والطعوم والحرارة والبرودة وغير ذلك مما يؤثر في الحواس الخمس، فما يكون من جملة ذلك راسخا يسمى كيفيات إنفعالية كصفرة الذهب وحلاوة العسل. وما كان سريع الزوال كحمرة الخجل وصفرة الوجل يسمى إنفعالا. وأما غير المحسوس فينقسم إلى الإستعداد لأمر آخر،
وإلى كمال لا يكون إستعدادا لغيره. أما الإستعداد فالذي للمقاومة والإنفعال يسمى قوة طبيعية كالمصحاحية والصلابة وقوة المذكرة والمصارعة، وإن كان استعدادا لعسر الفعل وسهولة الإنفعال سمي ضعفا يعني نفي القوة كالممراضية واللين. وفرق بين الصحة وبين المصحاحية، فإن المصحاح قد لا يكون صحيحا والممراض قد يكون صحيحا. وأما الكمالات التي لا يمكن أن تكون إستعدادا لكمال آخر وتكون غير محسوسة بذاتها كالعلم والصحة، فما كان منها سريع الزوال سمي حالات كغضب الحليم ومرض المصحاح، وما كان ثابتا سمي ملكة كالعلم والصحة، أعني العلم الثابت بطول الممارسة دون علوم الشادي التي هي معرضة للزوال، فإن العلم كيفية للنفس غير محسوسة. القول في الإضافة وهو المعنى الذي وجوده بالقياس إلى شيء آخر ليس له وجود غيره البتة، كالأبوة بالقياس إلى البنوة لا كالأب، فإن له وجودا يخصه كالإنسانية مثلا، وتميز هذا المعنى عن الكيف والكم لا خفاء به
فهذا أصله. وأما أقسامه فإنه ينقسم بحسب سائر المقولات التي تعرض فيها الإضافة، فإنها تعرض للجواهر والأعراض، فإن عرضت للجوهر حدث منه الأب والإبن والمولى والعبد ونظيرها، وإن عرضت في الكم حدث منه الصغير والكبير والقليل والكثير والنصف والضعف ونظيره، وإن عرضت في الكيفية كانت منه الملكة والحال والحس والمحسوس والعلم والمعلوم، وإن عرضت في الأين ظهر منه فوق وأسفل وقدام وتحت ويمين وشمال، وإذا عرضت في المتى حصل منه السريع والبطيء والمتقدم والمتأخر، وكذلك باقي المقولات.
وتنقسم بنحو آخر من القسمة إلى ما يختلف فيه إسم المتضايفين: كالأب والإبن والموالى والعبد، وإلى ما يتوافق فيهما الإسمب: كالأخ مع الأخ والصديق والجار، وإلى ما يختلف بناء الإسم مع اتحاد ما منه الإشتقاق: كالمالك والمملوك والعالم والمعلوم والحاس والمحسوس. ومهما لم يوجد المضاف من حيث هو مضاف سقطت الإضافة، فإن الأب إنسان، فهو باعتبار كونه إنسانا غير مضاف بل الدال على إضافته لفظ الأب. وأمارة اللفظ الدال على الإضافة التكافؤ من الجانبين، فإن الأب أب للإبن، والإبن ابن للأب. ولو قيل: الأب أب للإنسان لم يمكن ان يقال: الإنسان إنسان للأب. وإذا قيل: السكان سكان لذي السكان، أمكنك أن تقول: وذو السكان هو ذر سكان بالسكان، مهما لم يكن لذي السكان وهو أحد المضايفين إسما خاصا، كما تقول لليد يد لذي اليد، وذو اليد ذو يد باليد. فلو قلنا: السكان سكان للذورق، لم ينقلب لأنه ليس لكل ذورق سكان، فيكون المضاف إليه غير مذكور فيه اللفظ الدال على الإضافة.
وإذا قلت: اليد يد الإنسان، لم يمكن أن تقول: الإنسان إنسان لليد، بل ينبغي أن يقال: اليد لذي اليد حتى ينقلب بطريق التكافؤ. ومن شرائد هذا التكافؤ ان يراعة إتحاد جهة الإضافة، حتى أن يؤخذ جميعا بالفعل أو جميعا بالقوة، وإلا ظن تقدم احدهما على الآخر. ومن خواص الإضافة أنه إذا عرف أحد المضافين محصلا به عرف الآخر أيضا كذلك، فيكون وجود أحدهما مع وجود الآخر لا قبله ولا بعده، وربما يظن أن العلم والمعلوم ليسا متساويين بل المعلوم متقدم على العلم، وليس كذلك بل العلم مثال للمعلوم بكونه معلوما مع كون العلمف ي نفسه ومع كون الذات عالما بلا ترتيب، إلاّ أن يوحد المعلوم والمحسوس معلوما ومحسوسا بالقوة لا بالفعل، فيكون متقدما على العلم بالفعل، ولا يكون متقدما على العلم بالقوة. القول في الأين والمراد به نسبة الجوهر إلى مكانه الذي هو فيه، كقولك في جواب أين زيد: إنه في السوق او في الدار، ولسنا نعني به أن الأين البيت بل المفهوم من قولنا في البيت هو العرض له ولكل جسم أين، ولكن بعضها بين كما للإنسان واحد العالم، وبعضها يعلم على تأويل كما لجملة العالم، فإنه له أين على تأويل، فكل جسم له أين خاص قريب واينات مشتركة تشتمل عليه بعضها أصغر
من بعض وأقرب إلى الأول، مثل زيد وهو في البيت، فإن أينه القريب مقعد الهواء المحيط به الملاقى لسطح بدنه ثم البلد ثم المعمور من الأرض ولذلك يقال: هو في البيت وفي البلد وفي المعمور وفي الأرض وفي العالم. وأما أنواع الإين فمنها ما هو أين بذاته، ومنها ما هو أين مضاف، فالذي هو أين بذاته كقولنافي الدار وفي السوق، وما هو أين بالإضافة فهو مثل فوق وأسفل ويمنة ويسرة وحول ووسط، وما بين وما يلي وعند ومع وعلى وما أشبه ذلك، ولكن لا يكون للجسم أين مضاف ما لم يكن له أين بذاته، فما كان فوق فلا بد وأن يكون له أين بذاته، إن كان معنى كونه فوق فوقية مكانية. القول في متى وهو نسبة الشيء إلى الزمان المحدود الذي يساوق وجوده، وتنطبق نهاياته على نهاية وجوده أو زمان محدود يكون هذا الزمان جزءا منه. وبالجملة فما يقال في جواب متى والزمان المحدود هو الذي حد بحسب بعده من الآن، أما في الماضي أو المستقبل وذلك إما باسم مشهور كقولك أمس وأول من أمس وغدا والعام القابل وإلى مائة سنة وإما بحادث معلوم البعد من الآن كقولك على عهد الصحابة ووقت الهجرة، والزمان المحدود إما أول وإما ثان له؛
فزمانه الأول هو الذي يغلف وجوده وانطبق عليه غير منفصل عنه، وزمانه الثاني هوالزمان المحدود الأعظم الذي نهاية الأول جزء منه، مثل أن يكون الحرب في ست ساعات من يوم من شهر من سنة، فتلك الساعات الست هي الزمان الأول المطابق، واليوم والشهر والسنة أزمنة ثوان يضاف إليها باعتبار كون زمانه جزءا منها فيقال: وقع الحرب في السنة الفلانية ومساوقة الزمان لوجود الشيء غير تقدم الزمان له، فإنا نعني بالمساوق المنطبق، وذلك قد يكون بنهايات الزمان الذي ينقسم والمقدار جواب للسائل عن ذلك بكم، كما يقال: كم عاش فلان؟ فيقال: مائة سنة؛ فالزمان مقدار، وإذا قيل: كم دامت الحرب؟ فيقال: سنة؛ فهذا مطابق لا مقدم، فقد يكون المطابق ممتدا ولكن ليس من شرطه الإمتداد، ومن شرط الزمان المقدم الإمتداد والإنقسام. القول في الوضع وهو عبارة عن كون الجسم بحيث يكون لأجزائه بعضها إلى بعض نسبة بالإنحراف والموازاة والجهات وأجزاء المكان، إن كان في مكان يقله كالقيام والقعود والإضطجاع والإنبطاح، فإن هذا الإختلاف يرجع إلى تغاير نسبة الأعضاء إذ الساق يبعد من الفخذ في الإنتصاب وفي القعود قد تضاما، وإذا مد رجليه مستلقيا فوضع أجزائه كوضعه إذا انتصب، ولكن بالإضافة
إلى الجهة والمكان يختلف إذ كان الرأس في القيام فوق الساق وليس ذلك عند الإستلقاء، ومهما مشى الإنسان فالوضع لا يتغير عليه والمكان يتغير، فليس الوضع هو تبدل المكان. والوضع قد يكون للجسم بالإضافة إلى ذاته كأجزاء الإنسان، فغنه لو لم يكن جسم غيره لكان وضع أجزائه معقولا، وقد يكون بالإضافة إلى جسم آخر وذلك في أينه الذي يثب له بالإضافة من فوق وتحت ويمين ووسط وغيرها. ولما كانت الأمكنة ضربين: ضرب بالذات وضرب بالإضافة، صارالوضع أيضا ضربين، لكن لا يكون للشيء وضع بالإضافة ما لم يكن له وضع بذاته. ولما كان المكان الذي بذاته لا بالإضافة ضربين: ضرب هو للجسم أول خاص، وضرب هو ثان ومشترك له ولغيره، صار له وضعه أحيانا بالقياس إلى مكان الأول الخاص وأحيانا إلى مكانه الثاني المشترك له ولغيره وآفاقه، إذ لكل إنسان موضع من القطبين مثلا زمن الآفاق، ولكل جزء من السماء وضع من أجزاء الأرض في كل حالة من الأحوال، وبحركته يبدل في الوضع فقط لا في المكان. القول في العرض الذي يعبر عنه بله وقد يسمى الجده. ولما مثل هذا بالمنتعل والمتسلح والمنطلس فلا يتحصل له معنى سوى أنه نسبة الجسم إلى الجسم المنطبق على جميع بسيطه
أوعلى بعضه، إذا كان المنطبق ينتقل بانتقال المحاد به المنطبق عليه، ثم منه ما هو طبيعي كالجلد للحيوان والخف للسلحفاة، ومنها ماهو إرادي كالقميص للإنسان. وأما الماء في الإناء فليس من هذا القبيل، لأن الإناء ينتقل بانتقال الماء، بل هو بالعكس فلا تدخل تلك النسبة في هذه المقولات بل في مقولة الاين؛ والله أعلم. القول في أن يفعل ومعناه نسبة الجوهر إلى أمر موجود منه في غيره غير باقي الذات، بل لا يزال يتجدد كالتسخين والتحديد والقطع، فإن البرودة والسخونة والإنقطاع الحاصلة بالثلج والنار والأشياء الحارة في غيرها لها نسبة إلى أسبابها، عند من اعتقد أسبابا في الوجود، فتلك النسبة من جانب السبب يعر عنه بأن يفعل إذا قال يسخن ويبرد، ومعنى يسخن يفعل السخونة، ومعنى يبرد يفعل البرودة؛ فهذه النسبة هي التي عبر عنها بهذه العبارات، وقد يعتقد معتقد أن تسمية ذلك فعلا مجازا إذ كان يرى الفعل مجازا في كل من لا اختيار له، ولكن لا ينك رمع ذلك نسبة لأجلها يصدق قوله سخنته النار، فتلك النسبة جنس من الأعراض عبر عنه بالفعل أو بغيره، فلا مضايقة في العبارات. القول في الإنفعال وهو نبة الجوهر المتغير إلى السبب المغير، فإن كل منفعل فعن فاعل، وكل متسخن ومتبرد فعن مسخن ومبرد بحكم العادة المطردة عند أهل الحق،
وبحكم ضرورة الجبلة عند المعتزلة والفلاسفة. والإنفعال على الجملة تغير، والتغير قد يكون من كيفية إلى كيفية مثل تصير الشعر من السواد إلى البياض، فغنه غيره الكبر على التدريج وصيره من السواد إلى البياض، فإنه غيّره الكبر على التدريج وصيره من السواد إلى البياض قليلا قليلا بالتدريج، ومثل تصير الماء من البرودة إلى الحرارة، فإنه حين ما يتسخن الماء يحسر عنه البرودة قليلا قليلا، وتحدث فيه الحرارة قليلا قليلا على الإتصال إلا أن ينقطع سلوكه، فيقف فهو في كل وقفة على حالة واحدة تفارق ما قبلها وما بعدها، فليست حالته مستقرة في وقت السلوك. وعلى الجملة لا فرق بين قولك ينفعل وبين قولك يتغير. وأنواع التغير كثيرة وهي أنواع الإنفعال بعينه؛ فهذه هي الأجناس العالية للموجودات كلها، وقد جرى الرسم بحصرها في هذه العشرة؛ فإن قيل: فهذا الحصر أخذ تقليدا من المتقدمين أو عليه برهان؟ قلنا: التقليد شأن العميان، ومقصود هذا الكتاب أن تتهذب به طرق البرهان، فكيف يقنع فيه بالتقليد بل هو ثابت بالبرهان ووجهه أن هذا الحصر فيه ثلاث دعاوي: إحداهما أن هذه العشرة موجودة وهذا معلوم بمشاهدة العقل والحس كما فصلناه. والآخر إنه ليس في الوجود شيء خارج عنها وعرف ذلك بل إن كل ما أدركه العقل ليس يخلو من جوهر أو عرض، وكل جوهر ينطلق عليه عبارة أو يختلج به خاطر فممكن إدراجه تحت هذه الجملة وأما أنه ليس بممكن أن يقتصر على تسعة فطريق معرفته أن تعرف تباين هذه الأقسام بما ذكرناه اختلافها، فيتم العلم بهذه الدعوى بهذه الجملة.
نعم لا يبعد ان يتشكك ناظر في وجه مباينة قسم لقسم حتى يلتبس عليه وجه الفرق بين الإضافة المحضة وبين النسبة إلى المكان أو نسبة الإنفعال، لأن هذه الأمور فيها أيضا نسبة، ولكن فيها وراء النسبة شيء، ولكن إذا أمعن النظر ظهر له التباين كما لا يبعد أن يتشكك في عرض من الأعراض أنه من قبيل هذا القسم أو ذاك، كما يتشكك ناظر في الفرق بين نسبة الجوهر إلى مكانه، وبين نسبته إلى جوهر بطريق المجازاة، وذلك إنما يعرض من حيث يكون إسم صفة ويكون كونه في المكان من حيث هو مضاف، ولا يوجد له إسم يدل عليه من حيث تلكلاصفة بغير إضافة حتى يتكلف، فيوضع له إسم الاين ويوضع للوقوع فيالزمان إسم متى، فمهما كان إسمه الدال عليه منحيث هو مضاف هو الذي جعل إسمه الدال عليه من حيث هو صفة إعترض هذا الشك، ويكون هذا تقصير من واضع الأسامي، وكذلك قد يعرض في هذا أن يكون إسم جنس يدل عليه من حيث هي مضافة، فيظن أن الجنس إضافة، ويتعجب أن الجنس كيف يكون من مقولة المضاف، ويكون النوع من مقولة أخرى، وسببه ما ذكرنا. وأن تشكك في التكاثف والتخلخل أنه من مقولة الكيفية أو من مقولة الوضع وأنتشأ الشك من إشتراك الإسم ههنا، فإن التخلخل أن نتباعد أجزاء الجسم بعضها من بعض لتخللها أجسام غريبة من هذا أوغيره، والتكاثف معناه تقارب أجزائه بالتلبد حتى ينعصر ما فيه من هواء فيسيل من خلله فتتقارب أجزاؤه وتتماس.
؟؟؟ الفن الثاني ؟ في انقسام الوجود بأعراضه الذاتية إلى أصنافه وأحواله مثل كونه مبدأ وعلة ومعلولا، وانقسامه إلى ما هو بالقوة وما هو بالفعل وإلى القديم والحادث والقبل والبعد والمتقدم والمتأخر، والكلي والجزئي والتام والناقص والواحد والكثير والواجب والممكن، فإن هذه العوارض تثبت للموجود من حيث هو موجود، لا من حيث أنه شيء آخر أخص منه ككونه جسما أو عرضا أو غيرهما. ؟ القول في الإنقسام إلى العلة والمعلول ؟؟؟؟؟؟ واتصال الموجود بكونه مبدأ وعلة والمبدأ إسم لما يكون قد استتم وجوده في نفسه إما عن ذاته وإما عن غيره، ثم يحصل منه وجود شيء آخر يتقوم به، ويسمى هذا علة بالإضافة إلى ما هو مبدأ له، ثم لا يخلو
إما أن يكون؟ كالجزء من المعلول مثل الخشب وصورة السرير للسرير أو لا يكون كالجزء، فالذي يكون كالجزء قد لا يجب عن وجوده وجود المعلول بالفعل، ويسمى عنصرا وهو كالخشب للسرير، وقد يجب عن وجوده لا محالة وجود المعلول بالفعل وهو صورة السرير، ويسمى العنصر علة قابلية والصورة علة صورية، والذي ليس كالجزء ينقسم إلى مباين للمعلول وإلى ملاق. والملاقي ينقسم إلى ما يكتسب صفة من المعلول فينعت به، وهو كالموضوع للعرض إذ يقال الموضوع حار وبارد وأسود وأبيض، وإلى ما يكون بالعكس منه، وهو أن يكون المعلول يكتسب النعت من العلة فينعت المعلول بالعلة، وهو كصورة المائية للمادة المشتركة بين الماء والهواء عند الإستحالة. وقد يسمى ذلك المشترك هيولي، ولا مشاحة في إطلاق هذا الإسم وإبداله. وأما المباين فينقسم إلى ما منه الوجود وليس الوجود لاجله، وهو العلة الفاعلية كالنجار للسرير، وإلى ما لأجله وجود المعلول وهو العلة الغائية كالصلوح للجلوس للكرسي والسرير. والعلة الأولى هي الغاية، فلولاها لما صار النجار نجارا، وكونها علة سابقة سائر العلل إذ بها صارت العلل علالا ووجودها متأخرا عن وجود الكل، وإنما المتقدم عليتها،
والعلة أبدا أشرف من القابل لأن الفاعل مفيد والقابل مستفيد. ثم العلة قد تكوهن بالذات وقد تكون بالعرض، وقد تكون بالقوة وقد تكون بالفعل، وقد تكون قريبة وقد تكون بعيدة، وقد سبقت أمثلتها. القول في الإنقسام إلى ما هو بالقوة وإلى ما هو بالفعل الموجود قد يقال أنه بالفعل وقد يقال أنه بالقوة، وإسم القوة قد يطلق على معنى آخر فيلتبس بالقوة التي تقابل بالفعل، فليقدم بيانها إذ يقال قوة مبدأ التغيير إما في المنفعل وهو القوة الإنفعالية، وإما في الفاعل وهو القوة الفعلية. ويقال لما به يجوز من الشيء فعل أو انفعال وما به يصير الشيء مقوما للآخر،
ولما به يصير الشيء متغيرا أو ثابتا، فإن التغير لا يخلو من الضعف، وقوة المنفعل قد تكون محدودة متوجهة نحو شيء واحد معين، كقوة الماء على قبول الشكل دون حفظه، بخلاف الشمع الذي فيه قوة القبول والحفظ جميعا. وقد يكون في الشيء قوة إنفعالية بالإضافة إلى الضدين، كقبول الشمع للتسخين والتبريد، وكذلك قوة الفاعل تتوجه إلى شيء واحد متعينن كقوة النار على الإحراق فقط، وقد تتوجه نحو أشياء كثيرة كقوة المختاربن على الأمور المختلفة، وقد يكون في الشيء لأمور ولكن بعضها يتوسط البعض كقوة القطن على قبول صورة الغزل والثوبية، وقد يسهو الناظر في لفظ القوة ويلتبس عليه القوة بهذا المعنى بالقوة التي تذكر بإزاء الفعل، والفرق بينهما ظاهر من أوجه: الأول: أن القوة التي بإزاء الفعل تنتهي مهما صار الشيء بالفعل، والقوة الأخرى تبقى موجودة في حالة كونها فاعلة. الثاني: أن القوة الفاعلة لا يوصف بها إلا المبدأ المحرك، والقوة الثانية يوصف بها في الأكثر الأمر المنفعل. الثالث هو أن الفعل الذي بإزاء القوة الأخرى يوصف بها كل شيء من قبيل الموجودات الحاصلة، وإن كان انفعالا أو حالا لا فعلا ولا إنفعالا. فإن قيل: قولكم أن الشيء بالقوة لا بالفعل يرجع حاصله إلى الإستعداد للشيء، وقبول المحل له وهذا مفهوم،
وأما لاقوة الأخرى التي هي فاعلة كقوة النار على الإحراق وهذا مفهوم، وأما القوة الأخرى التي هي فاعلة كقوة النار على الإحراق كيف يعترف بها من يرى أن النار لا تحرق، وإنما الله تعالى يخلق الإحراق عند وقوع اللقاء بين القطن والنار مثلا، بحكم إجراء الله تعالى العادة. قلنا: غرضنا لما ذكرنا شرح معنىالإسم لا تحقيق وجود المسمى، وقد نبهنا على وجه تحقيق الحق فيه في كتاب تهافت الفلاسفة والغرض أن لا يلتبس إحداهما بالأخرى إذا استعملهما معتقد ذلك. القول في إنقسام الموجود إلى القديم وإلى الحادث والقبل والبعد أما القديم فهو إسم مشترك بين القديم بحسب الذات وبين القديم بحسب الزمان، فالذي بحسب الزمان هو الذي لا أول لزمان وجوده، وأما الذي بحسب الذات فهو الذي ليس لذاته مبدأ وعلة هو به موجود، والمشهور الحقيقي هو الأول، والثاني كأنه مستعار من الأول، وكأنه مجاز، وهو من إصطلاح الفلاسفة، وبهذا الإشتراك يشترك الحادث أيضا، فالحادث بحسب الزمان هو الذي لزمان وجوده إبتداء، وبحسب الذات هو الذي لذاته مبدأ هي به موجودة. والعالم عند الفلاسفة حادث بالمعنى الثاني قديم بالمعنى الأول،
وصانع العالم قديم على التأويلين جميعا، وتسميتهم العالم حادثا بتأولهم مجاز محض، إذ المفهوم الكائن بعد إن لم يكن، والعالم عندهم ليس كائنا بعد إن لم يكن. ومن تأويلاتهم قولهم: إن للعالم نسبة إلى طبيعة الوجود ونسبة إلى العدم، والوجود حاصل له لا من ذاته بل من غيره، وإذا قدرنا عدم ذلك الغير لكان له من ذاته العدم وما للشيء من ذاته قبل ما للشيء من غيره قبلية بالذات، فالعدم له قبل الوجود؛ فهذا هو التأويل وهو تكلف من الكلام في اطلاق اللفظ، وليس ينكر عليهم تركهم لفظ
(الحادث) حتى يتكلفوا لانفسهم وجها فى اطلاق اللفظ، بل ينكر عليهم ترك اعتقاد محل الحدوث، وإن وجود العالم ليس مسبوقا بعدم، وإذا لم يعتقد ذلك فالأسامي لا تغني ولا مشاحة فيها، والعجب أنهم يقولون: إنا باعتقاد حدوث العالم أولى؛ فإنا نقول: المعلول حادث في كل زمان، فوصف الحدوث له ثابت عندهم الدهر كله، وعندكم في حالة واحدة، وإن كان المفهوم من الحدوث ما ذكروه فهو أحق به إلا أن المفهوم من الحدوث ما ذكرناه، وقد نفوه وأطلقوا اللفظ على أمر آخر يستمر في جميع الأزمنة، وطريق بطلانه ذكرناه في تهافت الفلاسفة. وأما القبل فإنه إسم مشترك في محاورات النظار والجماهير، إذ يطلق وتراد القبلية بالطبع كما يقال الواحد قبل الإثنين، وذلك في كل شيء لا يمكن أن يوجد الآخر إلا وهو موجود، ويوجد هو وليس الآخر بموجود، فما يمكن وجوده دون الآخر فهو قبل الآخر، وذلك الآخر، قد يقال له بعد وكأنه مستعار ومجاز، بل القبلية الظاهرة المشهورة هي القبلية الزمانية، وأمرها ظاهر، ويقال قبل للتقدم في المرتبة كتقدم الجنس على النوع بالإضافة إلىالجنس الأعلى، وقد يكون بالنسبة إلى شيء معين كما يقال الصف الأول قبل الصف الثاني، إذا صار المحراب هو المنسوب، ولو نسب إلى باب المسجد ربما كان الصف الأخير موصوفا بالقبلية، وقد يقال قبل بالشرف كما يقال محمد صلى الله عليه وسلم قبل موسى، وقبل أبي بكر وعمر وقد يقال قبل للعلة بالإضافة إلى المعلول مع أنهما في الزمان معا وفي كونهما بالقوة أو بالفعل يتساويان، ولكن من حيث أن لأحدهما الوجود غير
مستفاد من الآخر ووجود الآخر مستفاد منه فهو متقدم عليه، وإذا تأملت حال المتقدم في جميع هذه المعاني رجع إلى ان المتقدم هو الذي له الوصف الذي للمتأخر بكل حال، وليس للمتأخر ذلك إلا وهو موجود للمتقدم. ؟ القول في إنقسام الموجود إلى الكلي والجزئي إعلم أن الكلي إسم مشترك ينطلق على معنيين، هو باحدهما موجود في الأعيان، وبالمعنى الثاني موجود في الأذهان لا في الأعيان. أما الأول فهو للشيء المأخوذ على الإطلاق منغير اعتبار ضم غيره إليه، واعتبار تجريده من غيره بل من غير التفات إلى أنه واحد، فإن الإنسان مثلا معقول بأنه حقيقة ما والزم شيء للإنسانية وأشده التصاقا به كونه واحدا أو كثيرا، إذ لا يتصور إلا كذلك، ولكن العقل قادر على أن يعتبر الإنسانية المطلقة من غير التفات إلى أنها واحدة أو أكثر، فإن الإنسان بما هو إنسان شيء وبما هو واحد أو أكثر، وذلك له بالقوة أم بالفعل شيء آخر، فإن الإنسان إنسان بلا شرط آخر البتة، ثم العموم أو الخصوص شرط زائد على ما هو إنسان، والوحدة والكثرة كذلك، فإن من علم الإنسان فقد علم أمرا واحدا ومن علم أن الإنسان المعلوم له وحدة فقد علم شيئين أحدهما الإنسان
والآخر الوحدة، وكذلك إذا علم الكثرة، وكذا إذا علم الخصوص والعموم، فكل ذلك زائد على المعلوم، وليس ذلك إذا فرضت هذه الأحوال بالفعل فقط بل هو كذلك، وإن فرضت بالقوة فإنك تفرض بالقوة الإنسان المطلق من غير التفات إلى الوحدة والكثرة، وتفرض الوحدة والكثرة بعده فيكون في اعتبارك إنسانية وإضافة ما للإنسانية إلى الوحدة أو الكثرة، وفرض الوحدة والكثرة زائد على أصل الإنسانية. نعم الكثرة والوحدة تلزم الإنسانية في الوجود لا محالة، وليس كل ما يلزم الشيء فهو له في ذاته، فنحن نعلم أن الإنسانية بما هي إنسانية واحدة أو كثيرة، ففرق بين قولنا: إن الإنسانية لا توجد وله إحدى الحالتين، وبين قولنا: إحدى الحالتين له بما هو إنسانية. وليس نقيض قولنا أن الإنسانية بما هي إنسانية واحدة أن الإنسانية بما هي إنسانية كثيرة، بل نقيضها أن الإنسانية ليست بما هي إنسانية واحدة، وإذا كان كذلك جاز أن توجد واحدة أو كثيرة، ولكن لا بما هي إنسانية، فالكلي قد يراد به الإنسانية المطلقة الخالية عن إشتراط الوحدة أو الكثرة قد يراد به الإنسانية المطلقة الخالية عن اشتراط الوحدة أو الكثرة أو غير ذلك من لواحقها المنفكة عن كل اعتبار، سوى الإنسانية بالنفي والإثبات جميعا، وفرق بين قولنا: إنسانية بلا شرط آخر، وبين قولنا: إنسانية بشرط أن لا يكون معه غيره،
لأن الأخير فيه زيادة اشتراط نفي، والأول نعني به الإطلاق الذي هو منقطع البتة عما وراء الإنسانية نفيا كان أو إثباتا، فالكلي بهذا المعنى موجود في الأعيان فإن وجود الوحدة أو الكثرة او غير ذلك من اللواحق مع الإنسان، وإن لم يكن بما هو إنسانية، إذ لا تخرج الإنسانية عنها في الوجود، فإن لكل موجود مع غيره لا في ذاته وجودا يخصه، وانضمام غيره إليه لا يوجب نفي وجوده من حيث ذاته وجودا يخصه، وانضمام غيره إليه لا يوجب نفي وجوده من حيث ذاته، فالإنسانية عند الإعتبار موجودة بالفعل في آحاد الناس محمول على كل واحد، لا على أنه واحد بالذات ولا على انه كثير، فإن ذلك ليس بما هو إنسانية. والمعنى الثاني للكلي هو الإنسانية مثلا بشرط أنه مقولة بوجه من الوجوه المقولية على كثيرين، وهذا غير موجود في الأعيان، إذ يستحيل وجود شيء واحد بعينه يكون محمولا على كل واحد من الآحاد في وقت واحد معين. وذلك لأن الإنسان الذي اكتنفته الأعراض المخصصة لشخص زيد لمتكتنفه أعراض عمرو، حتى تكون تلك الإنسانية بعينها موجودة في عمرو، يكون هو ذلك في العدد بعينه، وربما يكتنفهما أعراض متعاندة، ولكن هذا المعبر عنه موجود في الأذهان على معنى أنه إذا سبق إلى الحس شخص زيد، حدث في النفس أثر، وهو انطباع صورة الإنسانية فيه، وهو لا يعلم، وهذه الصورة المأخوذة من الإنسانية المجردة من غير التفات إلى العوارض المخصصة لو أضيفت إلى إنسانية عمرو لطابقته، علىمعنى أنه لو ظهر للحس فرس بعده يحدث في النفس أثر آخر، ولو ظهر عمرو لم يتجدد في نفس أثر بل سائر أشخاص الناس في ذلك مستوية، سواء الأشخاص الموجودة والتي
يمكن وجودها، لأنه استوت نسبته إلى الكل فسمي كليا بهذا الإعتبار، إذ نسبته إلى كل واحد واحدة، فلهذه الصورة نسبة إلى أحد الأشخاص وغيرها واحدة كان مثال مطابقها كذلك، لهذا قيل إنه كلي، ونسبته إلى النفس وإلى سائر الصور المرتسمة في النفس؛ وهذا هو الذي أشكل على المتكلمين وعبروا عنه بالحال، واختلفوا في إثباته ونفيه وقال قوم ليس بموجود ولا معدوم، وأنكره قوم وأشكل عليهم الإفتراق والإشتراك بين الأسماء إذ السواد والبياض يشتركان في اللونية ويفترقان في شيء فيفكيف يكون مافيه الإفتراق وما فيه الإشتراك واحدا؟ ومنشأ ذلك سوء فهم بعضم عن اعتقاد شيء له وجود في النفس لا وجود لهمن خارج، إذا ثبت في النفس صورة كلية، وليس في الوجود كونها كلية بهذا الإعتبار بل هو ثابت في الأعيان بالإعتبار الأول، ومعنى كليتها التماثل دون الإتحاد في الإنسانية الموجودة لزيد والإنسانية الموجودة لعمرو في كونها إنسانية بالعدد. وأما مثاله في النفس العاقل للانسانية فمطابق له ولإنسانيته زيد وعمرو مطابقة واحدة، والصورة في نفسها واحدة ومع وحدتها مطابقة للكثرة، كأنها بالإضافة إليه أيضا واحدة، أعني تلك الكثرة؛ فهذا تحقيق معنى الكلي، وهو من أغمض ما يدرك وأهم ما يطلب إذ جميع المعقولات فرع لتحقيق هذه المعاني فلا بد من تبيينها.
وأما التام والناقص فليس المراد بهما الجزئي والكلي، بل التام يراد به الذي يوجد له جميع ما من شأنه أن يوجد، وليس مما يمكن أن يوجد له إلا وهو موجود له إما في كمال الوجود وإما في القوة الفعليةن وإما في القوة الإنفعالية وإما في الكمية. والناقص مايقابل التام الكامل. القول في الإنقسام إلى الواحد والكثير ولواحقهما إعلم أن الواحد إسم للشيء الذي لا يقبل القسمة من الجهة التي قيل له أنه واحد، ولكن الجهات التي يمتنع بسببها الإنقسام وتثبت الوحدة بالإضافة إلهيا كثيرة. فمنها ما لا ينقسم في الجنس فيكون واحدا في الجنس كقولنا: الفرس والإنسان واحد في الحيوانية، إذ لا إختلاف بينهما إلا في العدد وفي لنوع والعوارض. أما الحيوانية فليس بينهما فيها اختلاف وإنقسام. ومنها ما لا ينقسم في النوع كقولك: الجاهل والعالم واحد بالنوع أي بالإنسانية. ومنها ما ينقسم بالعرض العام كقولنا:
الغراب والفار واحد في السواد. ومنها ما لا ينقسم بالمناسبة كقولنا: نسبة الملك إلى المدينةن ونسبة العقل إلى النفس واحدة. ومنها ما لا ينقسم في الموضوع كقولنا: النامي والذابل واحد في الموضوع، وكذلك تجتمع رائحة التفاح وطعمه ولونه في موضوع واحد فيقال: هذه الأشياء واحدة أي في الموضوع لا بكل وجه. ومنها ما لا ينقسم معناه في العدد أو ينقسم إلى أعداد مشتركة في شيء كالرأس، فإنه واحد من الشخص أي ينقسم إلى أجزاء يكون لها معنى الرأس ومنها ما لا ينقسم بالحد أي لا توجد حقيقته لغيره وليس له نظير في كمال ذاته، كما يقال الشمس واحد وأحق الأشياء باسم الواحد واحد بالعدد. ثم ينقسم إلى ما فيه كثرة بالفعل ويكون واحدا بالتركيب والإجتماع كالبيت الواحد مثلا، وإلى ما لا كثرة فيه بالفعل ولكن فيه كثرة بالقوة لا بالفعل كالجسم من حيث هو جسم أي ذو صورة جسمية اتصالية، وإلى ما لا كثرة فيه لا بالفعل ولا بالقوة وهنو كل جوهر واحد ليس بجسم عند الفلاسفة، وذات الأول الحق كذلك بالإتفاق، ويثبت هذا للجوهر الواحد الفرد المتحيز عند المتكلمين فإنه لا ينقسم لا بالقوة ولا بالفعل، وهو واحد بالعدد. والذي يقبل القسمة لا بالقوة ولا بالفعل هو الأحق باسم الواحد، فالمعنى المفهوم من الكثرة على مقابلة الوحدة في كل رتبة، والكثير على الإطلاق على مقابلة الواحد على الإطلاق، وهو ما يوجد فيه
واحد وليس واحدا من جهة ما هو فيه، أي يوجد فيه واحد ليس هو وحدة فيه، وهو الذي يجاب عنه بالحساب. وقد يكون الكثير كثيرا بالإضافة والإتحاد في الكيفية يسمى مشابهة، وفي الكمية يسمى مساواةن وفي الجنس يسمى مجانسة، وفي النوع يسمى مشاكلة، والإتحاد في الأطراف يسمى مطابقة، فيخرج من هذا بيان معنى الواحد بالجنس والواحد بالنوع، والواحد بالعدد والواحد بالعرض والواحد بالمساواة، فجملة النسب للواحد هي التشابه والمساواة والمطابقة والمجانسة والمشاكلة، وأنواع الكثير مقابلات لذلك. القول في إنقسام الوجود إلى الممكن والواجب اعلم أن الممكن إسم مشترك يطلق على معان: الأول وهو الإصلاح العامي التعبير به عما ليس بممتنع الوجودن وعلى هذا يدخل الواجب الوجود فيه، ويكون الأول الحق ممكن الوجود، أي ليس محال الوجود،
وتكون الأشياء بهذا الإعتبار قسمين: ممتنع وممكن أي ممتنع وما ليس بممتنع، ويدخل فيه الجائز والواجب. الثاني الوضع الخاصي وهو أن يراد به سلب الضرورة في الوجود والعدم جميعا، وهو الذي لا استحالة في وجوده ولا في عدمه، وخرج الواجب عنه، ويكون المذكور بهذا الإعتبار ثلاثة: ممتنع وجوده أي ضروري عدمه، وواجب وجوده أي ضروري وجوده، وشيء لا ضروري في وجوده ولا في عدمه، بل نسبته إليهما واحدة، وهو المراد بالممكن. الثالث أن يعبر عن ممكن لا ضرورة في وجوده بحال من الأحوال، وهو أخص من الذي سبق وذلك كالكتابة للإنسان لا كالتغيير للمتحرك، فإنه ضروري في حال كونه متحركا، ولا كالكسوف للقمر فإنه ضروري عند توسط الأرض بينه وبين الشمس، فيصير الأعداد على هذا الوضع أربعة: واجب وممكن وموجود له ضرورة وموجود لا ضرورة له البتة. الرابع أن يخصص الشيء المعدوم في الحال الذي لا يستحيل وجوده في الإستقبال فيقال له ممكن أي له الوجود بالقوة لا بالفعل، وعلى هذا لا يقال العالم في حال وجوده ممكن بل يقال كان قبل الوجوب ممكنا. وأما الواجب الوجود فهو الذي متى فرض معدوما غير موجود لزم منه محال، ثم الواجب وجوده ينقسم إلى ما هو واجب لذاته
وإلى ما هنو واجب لغيره لا لذاته. أما الواجب لذاته فهوالذي فرض عدمه محال لذاته لا بفرض شيء آخر به محالا فرض عدمه، فالعالم واجب الوجود مهما فرضنا المشيئة الأزلية متعلقى بوجوده، ولكن صار الوجوب له من المشيئة لا من ذاته والوجوب لله من ذاته لا من غيره، وعلى الجملة كل ما حصل وجوبه بوجوده واجب بسبب وجود سببه لا محالة وأنه ما دام ممكن الوجود لا يترجح وجوده على عدمه، ولما تساوى الوجود والعدم بقي في العدم غير موجود، فقد صح وجوده لوجوب وجوده لمصادفة علته كمال ما به صار علة لوجوده. ومن هذا تتضح أمور كثيرة: أحدهما أنه يستحيل فرض شيء هو واجب الوجود بذاته ويبقى وجوبه فلا يكون وجوب وجوده بغيره، ويكون ذلك الغير فضله. الثاني أن كل ما هوواجب الوجود بغيره فهو ممكن الوجود بذاته، لأنه إما أن يكون باعتبار ذاته ممكن الوجود أو واجب الوجود أو ممتنع الوجود، والقسمان الأخيران باطلان إذ لو كان ممتنع الوجود بذاته لما تصور له وجود بغيره، ولو كان واجب الوجود بذاته. لما كان واجب الوجود بغيرة، لما سبق
فثبت انة ممكن الوجود بذاتة. والحاصل أن كل ممكن بذاته فهو واجب بغيره، فالممكن أن اعتبرت علته وقدر وجودها كان واجب الوجود، وإن قدر عدم علته كان ممتنع الوجود، وإن لم يلتفت إلى علته لا باعتبار العدم ولا باعتبار الوجود كان له في ذاته المعنى الثالث، وهو الإمكان، فإذن كل ممكن فهو ممتنع وواجب أي ممتنع عند تقدير عدم العلة، فيكون ممتنعا بغيره لا لذاته أو ممكنا من حيث ذاته إذا لم تعتبر معه علته نفيا وإثباتا، وليس الجمع بين هذه الأمور متناقضا، بل نزيد عيه فنقول: الممتنع أيضا منقسم إلى ممتنع لذاته وإلى ممتنع لغيره، فإجتماع السواد والبياض ممتنع لذاته، وكون السلب والإثبات في شيء واحد صادقا ممتنعا لذاته، وفرض القيامة اليوم، وقد علم الله تعالى أنه لا يقيمها اليوم مستحيل، ولكن لا لذاته كاستحالة الجمع بين البياض والسواد، ولكن لسبق علم الله بأنه لا يكون وإستحالة كون العلم جهلا، فكان امتناعه لغيره لا لذاته. الثالث أنه لا يجوز أن يكون شيئان كل واحد منهما واجب الوجود لصاحبه،
لأن ما يجب لغيره فله علة أقدم منه تقدما بالذات لا بالزمان، ويستحيل أن يكون المتقدم بالذات متأخرا بالذات، وهو من حيث أنه علة يجب أن يتقدم بالذات، وهو من حيث أنه معلول يجب أن يتأخر، وذلك محال إذ يلزم منه أن يكون الشيء قبل ما هو قبله بالذات. الرابع أن واجب الوجود بذاته لا بد أن يكون واجب الوجود من جميع جهاته، حتى لا يكون محلا للحوادث ولا متغيرا، فلا يكون له إرادة منتظرة ولا علم منتظر، ولا صفة من الصفات منتظرة عن وجوده، بل كل ما يمكن أن يكون له فيجب أن يكون حاضرا بذاته متأخرا عن ذاته لازما يمكن أن يكون له ولا يكون له، فإنما يكون حيث يكون لعلة وتنتفي، وحيث ينتفي بعدم ذلك العلة فيكون وجوده في حالتي عدم تلك الصفة ووجودها متعلقا بأمر خارج منه، إما نفي وإما اثبات حتى يستحيل خلوه عنه، فلا يكون واجب الوجود بذاته بل يستحيل ذاته إلا مع نفي تلك الصفة أو وجودها. ويشترط بحالة الوجود وجود العلة، وبحال العدم إما عدم تلك العلة أو وجود علة معدومة، فلا تخلو ذاتها عن اشتراط شيء غير ذاتها لتصور ذلك بباقي ما فسرنا به واجب الوجود. هذا ما أردنا أن نذكر من أحكام الوجود وأقسامه ولنقبض عنان البيان عند هذا فإنه خوض في التفصيل، وليس وضع هذا الكتاب لبيان تفاصيل الأمور بل لبيان طريق تعرف حقائق الأمور، وتمهيد قانون النظر وتثقيف معيار العلم ليميز بينه وبين الخيال والظن القريبين منه.
وإذا كانت السعادة في الدنيا والآخرة لا تنال إلا بالعلم والعمل، وكان يشتبه العلم الحقيقي بما لا حقيقة له، وافتقر بسببه إلى معيار فكذلك يشتبه العمل الصالح النافع في الآخرة بغيره، فيفتقر إلى ميزان تدرك به حقيته. فلنصنف كتابا في ميوان العمل كما صنفناه في معيارالعلم، ولنفرد ذلك الكتاب بنفسه ليتجرد لهمن لا رغبة له في هذا الكتاب. والله يوفق متأمل الكتابين للنظر إليهما بعين العقل لا بعين التقليد، إنه ولي التأييد والتسديد. آمين.
======
فضائح الباطنية وفضائل المستظهرية
للغزالي
المستظهري في الرد على الباطنية
==========
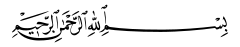
الحمد لله الحي القيوم الذي لا يستولي على كنه قيامه وصف واصف الجليل الذي لا يحيط بصفة جلاله معرفة عارف العزيز الذي لا عزيز إلا وهو بقدم الصغار على عتبة عزه عاكف الماجد الذي لا ملك إلا وهو حول سرادق مجده طائف الجبار الذي لا سلطان إلا وهو لنفحات عفوه راج وسطوات سخطه خائف المتكبر الذي لا ولي إلا وقلبه على محبته وقف وقالبه لخدمته واقف الرحيم الذي لا شئ إلا وهو ممتط متن الخطر في هول المواقف لولا ترصده لرحمته بوعده السابق السالف المنعم الذي إن يردك بخير فليس لفضله راد ولا صارف المنتقم الذي إن يمسسك بضر فما له سواه كاشف جل جلاله وتقدست أسماؤه فلا يغره موالف ولا يضره مخالف وعز سلطانه فلا يكيده مراوغ ولا يناوئه مكاشف خلق الخلق أحزابا وأحسابا ورتبهم في زخارف الدنيا أرذالا وأشرافا وقربهم في حقائق الدين ارتباطا وانحرافا وجهلة وعرافا وفرقهم في قواعد العقائد فرقا وأصنافا يتطابقون ائتلافا ويتقاطعون اختلافا فافترقوا في المعتقدات جحودا واعترافا وتعسفا وإنصافا واعتدالا وإسرافا كما تباينوا أصلا وأوصافا هذا غني يتضاعف كل يوم ما له أضعافا وهو يأخذ جزافا وينفق جزافا وهذا ضعيف يعول ذرية ضعافا يعوزه قوت يوم حتى سأل الناس إلحافا وهذا مقبول في القلوب لا يلقى في حاجته إلا إجابة وإسعافا وهذا مبغض للخلق تهتضم حقوقه ضيما وإجحافا وهذا تقي موفق يزداد كل يوم في ورعه وتقواه إسرافا وإشراقا وهذا مخذول يزداد على مر الأيام في غيه وفساده تماديا واعتسافا ذلكم تقدير ربكم القادر الحكيم الذي لا يستطيع سلطان عن قهره انحرافا القاهر العليم الذي لا يملك أحد لحكمه خلافا رغما لأنف الكفرة الباطنية الذين أنكروا أن يجعل الله بين أهل الحق اختلافا ولم يعلموا أن الاختلاف بين الأمة يتبعه الرحمة كما تتبع العبرة اختلافهم مراتب وأوصافا وشكرا لله الذي وفقنا للاعتراف بدينه إعلانا وإسرارا وسددنا للانقياد لحكمه إظهارا وإضمارا ولم يجعلنا من ضلال الباطنية الذين يظهرون باللسان إقرارا ويضمرون في الجنان تماديا وإصرارا ويحملون من الذنوب أوقارا ويعلنون في الدين تقوى ووقارا ويحتقبون من المظالم أوزارا لأنهم لا يرجون لله وقارا ولو خاطبهم دعاة الحق ليلا ونهارا لم يزدهم دعاؤهم إلا فرارا فإذا أطل عليهم سيف أهل الحق آثروا الحق إيثارا وإذا انقشع عنهم ظله أصروا واستكبروا استكبارا فنسأل الله أن لا يدع على وجه الأرض منهم ديارا. ونصلي على رسوله المصطفى وعلى آله وخلفائه الراشدين من بعده صلوات بعدد قطر السحاب تهمي مدرارا وتزداد على ممر الأيام استمرارا وتتجدد على توالي الأعوام تلاحقا وتكرارا.
أما بعد، فإني لم أزل مدة المقام بمدينة السلام متشوفا إلى أن أخدم المواقف المقدسة النبوية الإمامية المستظهرية ضاعف الله جلالها ومد على طبقات الخلق ظلالها بتصنيف كتاب في علم الدين أقضي به شكر النعمة وأقيم به رسم الخدمة وأجتني بما أتعاطاه من الكلفة ثمار القبول والزلفة، لكني جنحت إلى التواني لتحري في تعيين العلم الذي أقصده بالتصنيف وتخصيص الفن الذي يقع موقع الرضا من الرأي النبوي الشريف، فكانت هذه الحيرة تغبر في وجه المراد وتمنع القريحة عن الإذعان والانقياد حتى خرجت الأوامر الشريفة المقدسة النبوية المستظهرية بالإشارة إلى الخادم في تصنيف كتاب في الرد على الباطنية مشتمل على الكشف عن بدعهم وضلالاتهم وفنون مكرهم واحتيالهم ووجه استدراجهم عوام الخلق وجهالهم وإيضاح غوائلهم في تلبيسهم وخداعهم وانسلالهم عن ربقة الإسلام وانسلاخهم وانخلاعهم وإبراز فضائحهم وقبائحهم بما يفضي إلى هتك أستارهم وكشف أغوارهم، فكانت المفاتحة بالاستخدام في هذا المهم في الظاهر نعمة أجابت قبل الدعاء ولبت قبل النداء، وإن كانت في الحقيقة ضالة كنت أنشدها وبغية كنت أقصدها، فرأيت الامتثال حتما والمسارعة إلى الارتسام حزما. وكيف لا أسارع إليه وإن لاحظت جانب الآمر ألفيته أمرا مبلغه زعيم الأمة وشرف الدين ومنشؤه ملاذ الأمم أمير المؤمنين وموجب طاعته خالق الخلق رب العالمين إذ قال الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} وإن التفت إلى المأمور به فهو ذب عن الحق المبين ونضال دون حجة الدين وقطع لدابر الملحدين وإن رجعت إلى نفسي وقد شرفت بالخطاب به من بين سائر العالمين رأيت المسارعة إلى الإذعان والامتثال في حقي من فروض الأعيان إذ يقل على بسيط الأرض من يستقل في قواعد العقائد بإقامة الحجة والبرهان بحيث يرقيها من حضيض الظن والحسبان إلى يفاع القطع والاستيقان، فإنه الخطب الجسيم والأمر العظيم الذي لا تستقل بأعيانه بضاعة الفقهاء ولا يضطلع بأركانه إلا من تخصص بالمعضلة الزباء لما نجم في أصول الديانات من الأهواء واختلط بمسالك الأوائل من الفلاسفة والحكماء، فمن بواطن غيهم كان استمداد هؤلاء فإنهم بين مذاهب الثنوية والفلاسفة يترددون وحول حدود المنطق في مجادلاتهم يدندنون، ولقد طال تفتيشي عن شبه خصمه لما تقدر على قمعه وخصمه وفي مثل ذلك أنشد:
عرفت الشر لا للشر ** لكن لتوقيه
ومن لا يعرف الشر ** من الناس يقع فيه
تظاهرت علي أسباب الإيجاب والإلزام واستقبلت الآتي بالاعتناق والالتزام وبادت إلى الامتثال والارتسام وانتدبت لتصنيف هذا الكتاب مبنيا على عشرة أبواب سائلا من الله سبحانه التوفيق لشاكله والصواب وسميته (فضائح الباطنية وفضائل المستظهرية) والله تعالى الموفق لإتمام هذه النية وهذا ثبت الأبواب.
الباب الأول في الإعراب عن المنهج الذي استنهجته في سياق هذا الكتاب.
الباب الثاني في بيان ألقابهم والكشف عن السبب الباعث لهم على نصب هذه الدعوة المضلة.
الباب الثالث في بيان درجات حيلهم في التلبيس والكشف عن سبب الإغترار بحيلهم مع ظهور فسادها.
الباب الرابع في نقل مذهبهم جملة وتفصيلا.
الباب الخامس في تأويلاتهم لظواهر القرآن واستدلالهم بالأمور العددية.
وفيه فصلان الفصل الأول في تأويلهم للظواهر والفصل الثاني في استدلالالتهم بالأعداد والحروف.
الباب السادس في إيراد أدلتهم العقيلة على نصرة مذهبهم والكشف عن تلبيساتهم التي زوقوها بزعمهم في معرض البرهان على إبطال النظر العقلي.
الباب السابع في إبطال استدلالهم بالنص على نصب الإمام المعصوم.
الباب الثامن في مقتضى فتوى الشرع في حقهم من التكفير والتخطئة وسفك الدم.
الباب التاسع في إقامة البرهان الفقهي الشرعي على أن الإمام الحق في عصرنا هذا هو الإمام المستظهر بالله حرس الله ظلاله.
الباب العاشر في الوظائف الدينية التي بالمواظبة عليها يدوم استحقاق الإمامة.
هذه ترجمة الأبواب. والمقترح على الرأي الشريف النبوي مطالعة الكتاب جملة ثم تخصيص الباب التاسع والعاشر لمن يريد استقصاء ليعرف من الباب التاسع قدر نعمة الله تعالى عليه وليستبين من الباب العاشر طريق القيام بشكر تلك النعمة ويعلم أن الله تعالى إذا لم يرض أن يكون له على وجه الأرض عبد أرفع رتبة من أمير المؤمنين فلا يرضى أمير المؤمنين ان يكون لله على وجه الأرض عبد أعبد وأشكر منه نسأل الله تعالى أن يمده بتوفيقه ويسدده لسواء طريقه هذه جملة الكتاب والله المستعان على سلوك جادة الحق واستنهاج مسلك الصدق.
الباب الأول في الإعراب عن المنهج الذي استنهجته في هذا الكتاب
لتعلم أن الكلام في التصانيف يختلف منهجه بالإضافة إلى المعنى غوصا وتحقيقا وتساهلا وتزويقا وبالاضافة إلى اللفظ إطنابا وإسهابا واختصارا وايجازا وبالاضافة إلى المقصد تكثيرا وتطويلا واقتصارا وتقليلا فهذه ثلاثة مقامات ولكل واحد من الأقسام فائدة وآفة.
وأما المقام الأول فالغرض في الغوص والتحقيق والتعمق في أسرار المعاني إلى أقصى الغايات التوقي من إزراء المحققين وقدح الغواصين فانهم إذا تأملوه فلم يصادفوه على مطابقة أوضاع الجدال وموافقة حدود المنطق عند النظار استركوا عمل المصنف واستغثوا كلامه واعتقدوا فيه التقاعد عن شأو التحقيق في الكلام والإنخراط في سلك العوام ولكن له آفة وهي قلة جدواه وفائدته في حق الأكثرين فإن الكلام إذا كان على ذوق المراء والجدال لا على مساق الخطاب المقنع لم يستقل بدركه إلا الغواصون ولم يتفطن لمغاصاته إلا المحققون وأما سلوك مسلك التساهل والاقتصار على فن من الكلام يستحسن في المخاطبات ففائدته أن يستلذ وقعه في الأسماع ولا تكل عن فهمه والتفطن لمقاصده أكثر الطباع ويحصل به الإقناع لكل ذي حجى وفطنة وان لم يكن متبحرا في العلوم.
وهذا الفن من جوالب المدح والإطراء ولكن من الظاهريين وآفته أنه من دواعي القدح والإزراء ولكن من الغواصين فرأيت أن أسلك المسلك المقتصد بين الطرفين ولا أخلى الكتاب عن أمور برهانية يتفطن لها المحققون ولا عن كلمات إقناعية يستفيد منها المتوهمون فان الحاجة إلى هذا الكتاب عامة في حق الخواص والعوام وشاملة جميع الطبقات من أهل الإسلام وهذا هو الأقرب إلى المنهج القويم فلطالما قيل: كلا طرفي قصد الأمور ذميم.
المقام الثاني في التعبير عن المقاصد إطنابا وإيجازا
وفائدة الإطناب الشرح والايضاح المغني عن عناء التفكر وطول التأمل وآفته الإملال وفائدة الايجاز جمع المقاصد وترصيفها وايصالها إلى الأفهام على التقارب وآفته الحاجة إلى شدة التصفح والتأمل لاستخراج المعاني الدقيقة من الألفاظ الوجيزة الرشيقة والرأى في هذا المقام الاقتصاد بين طرفي التفريط والإفراط فإن الإطناب لا ينفك عن إملال والإيجاز لا يخلو عن إخلال فالأولى الميل إلى الاختصار فلرب كلام قل ودل وما أمل.
المقام الثالث في التقليل والتكثير
ولقد طالعت الكتب المصنفة في هذا الفن فصادفتها مشحونة بفنين من الكلام فن في تواريخ أخبارهم وأحوالهم من بدء أمرهم إلى ظهور ضلالهم وتسمية كل واحد من دعاتهم في كل قطر من الأقطار وبيان وقائعهم فيما انقرض من الأعصار فهذا فن أرى التشاغل به اشتغالا بالأسمار وذلك أليق بأصحاب التواريخ والأخبار فأما علماء الشرع فليكن كلامهم محصورا في مهمات الدين وإقامة البرهان على ما هو الحق المبين فلكل عمل رجال.
والفن الثاني في إبطال تفصيل مذاهبهم من عقائد تلقوها من الثنوية والفلاسفة وحروفها عن اوضاعها وغيروا ألفاظها قصدا للتغطية والتلبيس هذا أيضا لا أرى التشاغل به لان الكلام عليها وكشف الغطاء عن بطلانها بايضاح حقيقة الحق وبرهانها ليس يختص بالطائفة الذين هم نابتة الزمان فتجريد القصد إلى نقل خصائص مذاهبهم التي تفردوا باعتقادها عن سائر الفرق هو الواجب المتعين فلا ينبغي أن يؤم المصنف في كتابه إلا المقصد الذي يبغيه والنحو الذي يرومه وينتحيه فمن حسن إسلام المرء ترك مالا يعنيه وذلك مما لا يعنيه في هذا المقام وان كان الخوض فيه على الجملة ذبا عن الإسلام ولكن لكل مقال مقام فلنقتصر في كتابنا على القدر الذي يعرب عن خصائص مذهبهم وينبه على مدارج حيلهم ثم نكشف عن بطلان شبههم بما لا يبقى للمستبصر ريب فيه فتنجلي عن وجه الحق كدورة التمويه.
ثم نختم الكتاب بما هو السر واللباب وهو إقامة البراهين الشرعية على صحة الإمامة للمواقف القدسية النبوية المستظهرية بموجب الأدلة العقلية والفقهية على ما أفصح عن مضمونه ترجمة الأبواب.
الباب الثاني في بيان ألقابهم والكشف عن السبب الداعي لهم على نصب هذه الدعوة
وفيه فصلان.
الفصل الأول في ألقابهم التي تداولتها الألسنة على اختلاف الأعصار والأزمنة
وهي عشرة ألقاب الباطنية والقرامطة والقرمطية والخرمية والحرمدينية والإسماعيلية والسبعية والبابكية والمحمرة والتعليمية. ولكل لقب سبب.
أما الباطنية فانما لقبوا بها لدعواهم أن لظواهر القرآن والأخبار بواطن تجرى في الظواهر مجرى اللب من القشر وأنها بصورها توهم عند الجهال الأغبياء صورا جلية وهي عند العقلاء والأذكياء رموز وإشارات إلى حقائق معينة وأن من تقاعد عقله عن الغوص على الحفايا والأسرار والبواطن والأغوار وقنع بظواهرها مسارعا إلى الاغترار كان تحت الأواصر والأغلال معنى بالأوزار والأثقال وأرادوا ب الأغلال التكليفات الشرعية فإن من ارتقى إلى علم الباطن انحط عنه التكليف واستراح من أعبائه وهم المرادون بقوله تعالى: {ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم} الآية وربما موهوا بالاستشهاد عليه بقولهم إن الجهال المنكرين للباطن هم الذين اريدوا بقوله تعالى: {فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب} وغرضهم الأقصى إبطال الشرائع فإنهم إذا انتزعوا عن العقائد موجب الظواهر قدروا على الحكم بدعوى الباطن على حسب ما يوجب الإنسلاخ عن قواعد الدين إذا سقطت الثقة بموجب الألفاظ الصريحة فلا يبقى للشرع عصام يرجع إليه ويعول عليه.
وأما القرامطة فانما لقبوا بها نسبة إلى رجل يقال له حمدان قرمط كان أحد دعاتهم في الابتداء فاستجاب له في دعوته رجال فسموا قرامطة وقرمطية وكان المسمى حمدان قرمط رجلا من أهل الكوفة مائلا إلى الزهد فصادفه أحد دعاة الباطنية في طريق وهو متوجه إلى قريته وبين يديه بقر يسوقها فقال حمدان لذلك الداعي وهو لا يعرفه ولا يعرف حاله أراك سافرت عن موضع بعيد فأين مقصدك فذكر موضعا هو قرية حمدان فقال له حمدان اركب بقرة من هذه البقر لتستريح عن تعب المشي فلما رآه مائلا إلى الزهد والديانة اتاه من حيث رآه مائلا إليه فقال اني لم اومر بذلك فقال حمدان وكأنك لا تعمل إلا بامر قال نعم قال حمدان وبأمر من تعمل فقال الداعي بامر مالكي ومالكك ومن له الدنيا والآخرة فقال حمدان ذلك إذن هو رب العالمين فقال الداعي صدقت ولكن الله يهب ملكه لمن يشاء قال حمدان وما غرضك في البقعة التي انت متوجه اليها قال امرت أن ادعو اهلها من الجهل إلى العلم ومن الضلال إلى الهدى ومن الشقاوة إلى السعادة وان استنقذهم من ورطات الذل والفقر واملكهم ما يستغنون به عن الكد والتعب فقال له حمدان انقذني انقذك الله وافض علي من العلم ما يحببني به فما اشد احتياجي إلى مثل ما ذكرته فقال الداعي وما امرت بان اخرج السر المخزون لكل أحد إلا بعد الثقة به والعهد عليه فقال حمدان وما عهدك فاذكره لي فاني ملتزم له فقال الداعي ان تجعل لي وللإمام على نفسك عهد الله وميثاقه ان لا يخرج سر الإمام الذي ألقيته اليك ولا تفشي سري أيضا. فالتزم حمدان سره ثم اندفع الداعي في تعليمه فنون جهله حتى استدرجه واستغواه واستجاب له في جميع ما دعاه ثم انتدب حمدان للدعوة وصار اصلا من أصول هذه الدعوة فسمي أتباعه القرمطية.
وأما الخرمية فلقبوا بها نسبة لهم إلى حاصل مذهبهم وزبدته فانه راجع إلى طي بساط التكليف وحط أعباء الشرع عن المتعبدين وتسليط الناس على اتباع اللذات وطلب الشهوات وقضاء الوطر من المباحات والمحرمات وخرم لفظ اعجمي ينبئ عن الشئ المستلذ المستطاب الذي يرتاح الإنسان إليه بمشاهدته ويهتز لرؤيته وقد كان هذا لقبا للمزدكية وهم أهل الإباحة من المجوس الذين نبغوا في أيام قباذ وأباحوا النساء وان كن من المحارم وأحلوا كل محظور وكانوا يسمون خرمدينية فهؤلاء أيضا لقبوا بها لمشابهتهم اياهم في اخر المذهب وان خالفوهم في المقدمات وسوابق الحيل في الاستدراج وأما البابكية فاسم لطائفة منهم بايعوا رجلا يقال له بابك الخرمي وكان خروجه في بعض الجبال بناحية أذربيجان في أيام المعتصم بالله واستفحل أمرهم واشتدت شوكتهم وقاتهلم افشين صاحب حبس المعتصم مداهنا له في قتاله ومتخاذلا عن الجد في قمعه إضمارا لموافقته في ضلاله فاشتدت وطأة البابكية على جيوش المسلمين حتى مزقوا جند المسلمين وبددوهم منهزمين إلى أن هبت ريح النصر واستولى عليهم المعتصم المترشح للإمامة في ذلك العصر فصلب بابك وصلب أفشين بإزائه وقد بقي من البابكية جماعة يقال إن لهم ليلة يجتمع فيها رجالهم ونساؤهم ويطفئون سرجهم وشموعهم ثم يتناهبون النساء فيثب كل رجل إلى إمرأة فيظفر بها ويزعمون ان من استولى على امرأة استحلها بالاصطياد فإن الصيد من أطيب المباحات ويدعون مع هذه البدعة نبوة رجل كان من ملوكهم قبل الإسلام يقال له شروين ويزعمون أنه كان افضل من نبينا ﷺ ومن سائر الأنبياء قبله.
وأما الإسماعيلية فهي نسبى لهم إلى ان زعيمهم محمد بن إسماعيل ابن جعفر ويزعمون ان أدوار الإمامية انتهت به إذ كان هو السابع من محمد ﷺ وأدوار الإماميه سبعة سبعة عندهم فأكبرهم يثبتون له منصب النبوة وإن ذلك يستمر في نسبه وأعقابه وقد اورد أهل المعرفه بالنسب في كتاب الشجره أنه مات ولا عقب له وأما السبعيه فإنما لقبوا بها لأمرين أحدهما اعتقادهم أن أدوار الإمامة سبعة وأن الإنتهاء إلى السابع هو أخر الدور وهو المراد بالقيامة وأن تعاقب هذه الادوار لا آخر لها قط والثاني قولهم إن تدابير العالم السفلي اعني ما يحويه مقعر فلك القمر منوطة بالكواكب السبعة التي اعلاها زحل ثم المشتري ثم المريخ ثم الشمس ثم الزهرة ثم عطارد ثم القمر وهذا المذهب مسترق من ملحدة المنجمين وملتفت إلى مذهب الثنوية في أن النور يدبر اجزاؤه الممتزجة بالظلمة بهذه الكواكب السبعة فهذا سبب هذا التقليب.
وأما المحمرة فقيل انهم لقبوابه لانهم صبغوا الثياب بالحمرة أيام بابك ولبسوها وكان ذلك شعارهم وقيل سببه انهم يقررون ان كل من خالفهم من الفرق وأهل الحق حمير والأصح هو التأويل الأول.
وأما التعليمية فانهم لقبوا بها لأن مبدأ مذاهبهم إبطال الرأي وإبطال تصرف العقول ودعوة الخلق إلى التعليم من الإمام المعصوم وانه لا مدرك للعلوم إلا التعليم ويقولون في مبتدأ مجادلتهم الحق اما ان يعرف بالرأي وإما ان يعرف بالتعلم وقد بطل التعويل على الرأي لتعارض الاراء وتقابل الاهواء واختلاف ثمرات نظر العقلاء فتعين الرجوع إلى التعليم والتعلم وهذا اللقب هو الاليق بباطنية هذا العصر فان تعويلهم الاكثر على الدعوة إلى التعليم وإبطال الرأي وإيجاب اتباع الإمام المعصوم وتنزيله في وجوب التصديق والاقتداء به منزلة رسول الله ﷺ.
الفصل الثاني في بيان السبب الباعث لهم على نصب هذه الدعوة وإفاضة هذه البدعة
مما تطابق عليه نقلة المقالات قاطبة ان هذه الدعوة لم يفتتحها منتسب إلى ملة ولا معتقد لنحلة معتضد بنبوة فان مساقها ينقاد إلى الانسلال من الدين كانسلال الشعرة من العجين ولكن تشاور جماعة من المجوس والمزدكية وشرذمة من الثنوية الملحدين وطائفة كبيرة من ملحدة الفلاسفة المتقدمين وضربوا سهام الرأي في استنباط تدبير يخفف عنهم ما نابهم من استيلاء أهل الدين وينفس عنهم كربة ما دهاهم من أمر المسلمين حتى اخرسوا السنتهم عن النطق بما هو معتقدهم من إنكار الصانع وتكذيب الرسل وجحد الحشر والنشر والمعاد إلى الله في آخر الأمر وزعموا انا بعد أن عرفنا ان الانبياء كلهم ممخرقون ومنمسون فانهم يستعبدون الخلق بما يخيلونه اليهم فنون الشعبذة والزرق وقد تفاقم ام محمد واستطارت في الأقطار دعوته واتسعت ولايته واتسقت اسابه وشوكته حتى استولوا على ملك اسلافنا وانهمكوا في التنعم في الولايات مستحقرين عقولنا وقد طبقوا وجه الارض ذات الطول والعرض ولا مطمع في مقاومتهم بقتال ولا سبيل إلى استنزالهم عما اصروا عليه إلا بمكر واحتيال ولو شافهناهم بالدعاء إلى مذهبنا لتنمروا علينا وامتنعوا من الإصغاء الينا فسبيلنا ان ننتحل عقيدة طائفة من فرقهم هم اركهم عقولا واسخفهم رأيا وألينهم عريكة لقبول المحالات واطوعهم للتصديق بالأكاذيب المزخرفات وهم الروافض ونتحصن بالانتساب إليهم والاعتزاء إلى أهل البيت عن شرهم ونتودد اليهم بما يلائم طبعهم من ذكر ما تم على سلفهم من الظلم العظيم والذل الهائل ونتباكى لهم على ما حل بآل محمد ﷺ ونتوصل به إلى تطويل اللسان في أئمة سلفهم الذين هم أسوتهم وقدوتهم حتى إذا قبحنا أحوالهم في أعينهم وما ينقل إليهم شرعهم بنقلهم وروايتهم اشتد عليهم باب الرجوع إلى الشرع وسهل علينا استدراجهم إلى الانخلاع عن الدين وان بقي عندهم معتصم من ظواهر القرآن ومتواتر الأخبار أوهمنا عندهم ان تلك الظواهر لها أسرار وبواطن وان امارة الاحمق الانخداع بظواهرها وعلامة الفطنة اعتقاد بواطنها ثم نبث ايهم عقائدنا ونزعم انها المراد بظواهر القرآن ثم إذا تكثرنا بهؤلاء سهل علينا استدراج سائر الفرق بعد التحيز إلى هؤلاء والتظاهر بنصرهم.
ثم قالوا طريقنا ان نختار رجلا ممن يساعدنا على المذهب ونزعم انه من أهل البيت وانه يجب على كافة الخلق مبايعته وتتعين عليهم طاعته فانه خليفة رسول الله ومعصوم عن الخطأ والزلل من جهة الله تعالى. ثم لا نظهر هذه الدعوة على القرب من جوار الخليفة الذي وسمناه بالعصمة فان قرب الدار ربما يهتك هذه الاستار وإذا بعدت الشقة وطالت المسافة فمتى يقدر المستجيب إلى الدعوة ان يفتش عن حاله وان يطلع على حقيقة أمره ومقصدهم بذلك كله الملك والاستيلاء والتبسط في أموال المسلمين وحريمهم والانتقام منهم فيما اعتقدوا فيهم وعاجلوهم به من النهب والسفك وافاضوا عليهم من فنون البلاء.
فهذه غاية مقصدهم ومبدأ أمرهم ويتضح لك مصداق ذلك بمال سنجليه من خبائث مذهبهم وفضائح معتقدهم.
الباب الثالث في درجات حيلهم وسبب الاغترار بها مع ظهور فسادها
وفيه فصلان
الفصل الأول في درجات حيلهم
وقد نظموها على تسع درجات مرتبة ولكل مرتبة اسم اولها الزرق والتفرس ثم التأنيس ثم التشكيك ثم التعليق ثم الربط ثم التدليس ثم التلبيس ثم الخلع ثم السلخ ولنبين الآن تفصيل كل مرتبة من هذه المراتب ففي الاطلاع على هذه الحيل فوائد جمة لجماهير الأمة.
أما الزرق والتفرس فهو أنهم قالوا ينبغي أن يكون الداعي فطنا ذكيا صحيح الحدس صادق الفراسة متفطنا للبواطن بالنظر إلى الشمائل والظواهر وليكن قادرا على ثلاثة أمور الأول وهو اهمها ان يميز بين من يجوز ان يطمع في استدراجه ويوثق بلين عريكته لقبول ما يلقى إليه على خلاف معتقده فرب رجل جمود على ما سمعه لا يمكن ان ينتزع من نفسه ما يرسخ فيه فلا يضيعن الداعي كلامه مع مثل هذا وليقطع طمعه منه وليلتمس من فيه انفعال وتأثر بما يلقى إليه من الكلام وهم الموصوفون بالصفات التي سنذكرها في الفصل الذي يلي هذا الفصل. وينبغي ان نتقي بكل حال بث البذر في السبخ والدخول إلى بيت فيه سراج يعني به الزجر عن دعوة العباسية مد الله دولتهمم إرغاما لأنوف أعدائها فان ذلك لا ينغرس أبد الدهر في نفوسهم كما لا ينغرس البذر في الأرض السبخة بزعمهم ويزجرون أيضا عن دعوة الأذكياء من الفضلاء وذوي البصائر بطرق الجدال ومكامن الاحتيال وبه يعنون الزجر عن بيت فيه سراج.
الثاني أن يكون مشتعل الحدس ذكي الخاطر في تعبير الظواهر وردها إلى البواطن اما اشتقاقا من لفظها أو تلقيا من عددها أو تشبيها لها بما يناسبها وبالجملة فإذا لم يقبل المستجيب منه تكذيب القرآن والسنة فينبغي ان يستخرج من قلبه معناه الذي فهمه ويترك معه اللفظ منزلا على معنى يناسب هذه البدعة فانه لو شافهه بالتكذيب لم يقبل منه.
الثالث من الزرق والتفرس ألا يدعو كل أحد إلى مسلك واحد بل يبحث أولا عن معتقده وما إليه ميله في طبعه ومذهبه فاما طبعه فان رآه مائلا إلى الزهد والتقشف والتقوى والتنظف دعاه إلى الطاعة والانقياد واتباع الأمر من المطاع وزجره عن اتباع الشهوات وندبه إلى وظائف العبادات وتأدية الامانات من الصدق وحسن المعاملة والأخلاق الحسنة وخفض الجناح لذوي الحاجات ولزوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وان كان طبعه مائلا إلى المجون والخلاعة قرر في نفسه ان العبادة بله وان الورع حماقة وان هؤلاء المعذبين بالتكاليف مثالهم مثال الحمر المعناة بالأحمال الثقيلة وانما الفطنة في اتباع الشهوة ونيل اللذة وقضاء الوطر من هذه الدنيا المنقضية التي لا سبيل إلى تلافي لذاتها عند انقضاء العمر وأما حال المدعو من حيث المذهب فان كان من الشيعة فلنفاتحه بان الأمر كله في بغض بني تيم وبني عدي وبني امية وبني العباس وأشياعهم وفي التبري منهم ومن اتباعهم وفي تولي الأئمة الصالحين وفي انتظار خروج المهدي وان كان المدعو ناصبيا ذكر له ان الأمة انما اجمعت على أبي بكر وعمر ولا يقدم إلا من قدمته الأمة حتى إذا اطمأن إليه قلبه ابتدأ بعد ذلك يبث الأسرار على سبيل الاستدراج المذكور بعد وكذلك ان كان من اليهود والمجوس والنصارى حاوره بما يضاهي مذهبهم من معتقداته فان معتقد الدعاة ملتقط من فنون البدع والكفر فلا نوع من البدعة إلا وقد اختاروا منه شيئا ليسهل عليهم بذلك مخاطبة تلك الفرق على ما سنحكي من مذهبهم.
أما حيلة التأنيس فهو ان يوافق كل من هو بدعوته في أفعال يتعطاها هو ومن تميل إليه نفسه واول ما يفعل الانس بالمشاهدة على ما يوافق اعتقاد المدعو في شرعه وقد رسموا للدعاة والمأذونين ان يجعلوا مبيتهم كل ليلة عند واحد من المستجيبين ويجتهدون في استصحاب من له صوت طيب في قراءة القرآن ليقرأ عندهم زمانا ثم يتبع الداعي ذلك كله بشئ من الكلام الرقيق واطراف من المواعظ اللطيفة الآخذه بمجامع القلوب ثم يردف ذلك بالطعن في السلاطين وعلماء الزمان وجهال العوام ويذكر ان الفرج منتظر من كل ذلك ببركة أهل بيت رسول الله ﷺ وهو فيما بين ذلك يبكي احيانا ويتنفس الصعداء وإذا ذكر آية أو خبرا ذكر ان لله سرا في كلماته لا يطلع عليها إلا من اجتباه الله من خلقه وميزه بمزيد لطفه فان قدر على أن يتهجد بالليل مصليا وباكيا عند غيبة صاحب البيت بحيث يطلع عليه صاحب البيت ثم إذا احس بانه اطلع عليه عاد إلى مبيته واضطجع كالذي يقصد اخفاء عبادته وكل ذلك ليستحكم الانس به ويميل القلب إلى الاصغاء إلى كلامه فهذه هي مرتبة التأنيس.
وأما حيلة التشكيك فمعناه ان الداعي ينبغي له بعد التأنيس ان يجتهد في تغيير اعتقاد المستجيب بان يزلزل عقيدته فيما هو مصمم عليه وسبيله ان يبتدئه بالسؤال عن الحكمة في مقررات الشرائع وغوامض المسائل وعن المتشابه من الايات وكل ما لا ينقدح فيه معنى معقول فيقول في معنى المتشابه ما معنى الر وكهيعص وحم عسق إلى غير ذلك من اوائل السور ويقال أترى ان تعيين هذه الحروف جرى وفقا بسبق اللسان أو قصد تعيينها لاسرار هي مودعة تحتها لم تصادف في غيرها وما عندي ان ذلك يكون هزلا وعبثا بلا فائدة ويشكك في الأحكام. ما بال الحائض تقضي الصوم دون الصلاة ما بال الاغتسال يجب من المني الطاهر ولا يجب من البول النجس ويشككه في أخبار القرآن فيقول ما بال أبواب الجنة ثمانية وأبواب النار سبعة وما معنى قوله {ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية} وقوله تعالى: {عليها تسعة عشر} أفترى ضاقت القافية فلم يكمل العشرين أو جرى ذلك وفاقا بحكم سبق اللسان أو قصدا لهذا التقييد ليخيل أن تحته سرا وأنه في نفسه لسر ليس يطلع عليه إلا الأنبياء والأئمة الراسخون في العلم ما عندي أن ذلك يخلو عن سر وينفك من فائدة كامنة والعجب من غفلة الخلق عنها لا يثمرون عن ساق الجد في طلبها ثم يشككه في خلقة العالم وجسد الآدمي ويقول لم كانت السموات سبعا دون ان تكون ستة أو ثماني ولم كانت الكواكب السيارة سبعة والبروج اثني عشر ولم كان في رأس الآدمي سبع ثقب العينان والاذنان والمنخران والفم وفي بدنه ثقبان فقط ولم جعل رأس الآدمي على هيئة الميم ويداه إذا مدها على هيئة الحاء والعجز على هيئة الميم والرجلان على هيئة الدال بحيث إذا جمع الكل يشكل بصورة محمد أفترى أن فيه تشبيها ورمزا ما أعظم هذه العجائب وما أعظم غفلة الخلق عنها ولا يزال يورد عليه هذا الجنس حتى يشككه وينقدح في نفسه أن تحت هذه الظواهر أسرارا سدت عنه وعن أصحابه وينبعث منه شوق إلى طلبه وأما حيلة التعليق فبأن يطوي عنه جوانب هذه الشكوك إذا هو استكشفه عنها ولا ينفس عنه أصلا بل يتركه معلقا ويهول الأمر عليه ويعظمه في نفسه ويقول له لا تعجل فان الدين اجل من ان يبعث به أو ان يوضع في غير موضعه ويكشف لغير أهله هيهات هيهات!
جئتماني لتعلما سر سعدي ** تجداني بسر سعدي شحيحا
ثم يقول له لا تعجل ان ساعدتك السعادة سنبث اليك سر ذلك أما سمعت قول صاحب الشرع: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وهكذا لا يزال يسوقه ثم يدافعه حتى إن رآه أعرض عنه واستهان به وقال مالي ولهذا الفضول وكان لا يحيك في صدره حرارة هذه الشكوك قطع الطمع عنه وان رآه متعطشا إليه وعده في وقت معين وأمره بتقديم الصوم والصلاة والتوبة قبله وعظم أمر هذا السر المكتوم حتى إذا وافى الميعاد قال له ان هذه الأسرار مكتومة لا تودع إلا في سر محصن فحصن حرزك واحكم مداخله حتى اودعه فيه فيقول المستجيب وما طريقه فيقول ان آخذ عهد الله وميثاقه على كتمان هذا السر ومراعاته عن التضييع فانه الدر الثمين والعلق النفيس وادنى درجات الراغب فيه صيانته عن التضييع وما اودع الله هذه الأسرار أنبياءه إلا بعد أخذه عهدهم وميثاقهم وتلا قوله تعالى: {وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح} الاية وقال تعالى: {من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه} وقال تعالى: {ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها} وأما النبي ﷺ فلم يفشه إلا بعد أخذ العهد على الخلفاء واخذ البيعة على الانصار تحت الشجرة فان كنت راغبا فاحلف لي على كتمانه وانت بالخيرة بعده فان وفقت لدرك حقيقته سعدت سعادة عظيمة وان اشمأزت نفسك عنه فلا غرو فان كلا ميسر لما خلق له ونحن نقدر كانك لم تسمع ولم تحلف ولا ضير عليك في يمين صادقة فان أبى الحلف خلاه وإن انعم وأجاب فيه وجه الحلف واستوفاه.
وأما حيلة الربط فهو ان يربط لسانه بأيمان مغلظة وعهود مؤكدة لا يجسر على المخالفة لها بحال وهذه نسخة العهد:
يقول الداعي للمستجيب: جعلت على نفسك عهد الله وميثاقه وذمة رسوله عليه السلام وما أخذ الله على النبيين من عهد وميثاق أنك تسر ما سمعته مني وتسمعه وعلمته وتعلمه من أمري وأمر المقيم بهذه البلدة لصاحب الحق الإمام المهدي وأمور إخوانه وأصحابه وولده وأهل بيته وأمور المطيعين له على هذا الدين ومخالصة المهدي ومخالصة شيعته من الذكور والإناث والصغار والكبار ولا تظهر من ذلك قليلا ولا كثيرا تدل به عليه إلا ما أطلقت لك أن تتكلم به أو اطلق لك صاحب الأمر المقيم في هذا البلد أو غيره فتعمل حينئذ بمقدار ما نرسمه لك ولا تتعداه جعلت على نفسك الوفاء بما ذكرته لك وألزمته نفسك في حال الرغبة والرهبة والغضب والرضا وجعلت على نفسك عهد الله وميثاقه أن تتبعني وجميع من أسميه لك وأبينه عندك مما تمنع منه نفسك وان تنصح لنا وللإمام ولي الله نصحا ظاهرا وباطنا وألا تخون الله ولا وليه ولا أحدا من إخوانه وأوليائه ومن يكون منه ومنا بسبب من أهل ومال ونعمة وانه لا رأي ولا عهد تتناول على هذا العهد بما يبطله. فان فعلت شيئا من ذلك وانت تعلم انك قد خالفته فانت برئ من الله ورسله الأولين والآخرين ومن ملائكته المقربين ومن جميع ما انزل من كتبه على انبيائه السابقين وانت خارج من كل دين وخارج من حزب الله وحزب اوليائه وداخل في حزب الشيطان وحزب اوليائه وخذلك الله خذلانا بينا يعجل لك بذلك النقمة والعقوبة ان خالفت شيئا مما حلفتك عليه بتأويل أو بغير تأويل فان خالفت شيئا من ذلك فلله عليك ان تحج إلى بيته ثلاثين حجة نذرا واجبا ماشيا حافيا وان خالفت ذلك فكل ما تملكه في الوقت الذي تحلف فيه صدقة على الفقراء والمساكين الذين لا رحم بينك وبينهم وكل مملوك يكون لك في ملكك يوم تخالف فيه فهم أحرار وكل امرأة تكون لك أو تتزوجها في قابل فهي طالق ثلاثا بتة ان خالفت شيئا من ذلك وان نويت أو اضمرت في يميني هذه خلاف ما قصدت فهذه اليمين من أولها إلى آخرها لازمة لك والله الشاهد على صدق نيتك وعقد ضميرك وكفى بالله شهيدا بيني وبينك، قل: نعم، فيقول نعم. فهذا هو الربط.
وأما حيلة التدليس فهو انه بعد اليمين وتأكيد العهد لا يسمح ببث الأسرار إليه دفعة واحدة ولكن يتدرج فيه ويراعى أمورا الأول انه يقتصر في أول وهلة على ذكر قاعدة المذهب ويقول منار الجهل تحكيم الناس عقولهم الناقصة وآرائهم المتناقضة واعراضهم عن الاتباع والتلقي من اصفياء الله وائمته واوتاد أرضه والذين هم خلفاء رسوله من بعده فمنهم الذي اودعه الله سره المكنون ودينه المخزون وكشف لهم بواطن هذه الظواهر واسرار هذه الامثلة وان الرشد والنجاة من الضلال بالرجوع إلى القران وأهل البيت ولذلك قال عليه السلام لماقيل ومن أين يعرف الحق بعدك فقال الم اترك فيكم القرآن وعترتي وأراد به اعقابه فهم الذين يطلعون على معاني القرآن ويقتصر في أول وهلة على هذا القدر ولا يفصح عن تفصيل ما يقوله الإمام.
الثاني ان يحتال لإبطال المدرك الثاني من مدارك الحق وهو ظواهر القرآن فان طالب الحق إما أن يفزع إلى التفكر والتأمل والنظر في مدارك العقول كما أمر الله سبحانه وتعالى به فيفسد نظر العقل عليه بإيجاب التعلم والاتباع أو يفزع إلى ظواهر القرآن والسنة ولو صرح له بانه تلبيس ومحدث لم يسمع منه فليسلم له لفظه ولينزع عن قلبه معناه بان يقول هذا الظاهر له باطن هو اللباب والظاهر قشر بالاضافة إليه يقنع به من تقاعد به القصور عن درك الحقائق حتى لا يبقى له معتصم من عقل ومستروح من نقل.
الثالث ألا يظهر من نفسه انه مخالف للأمة كلهم وانه منسلخ عن الدين والنحلة إذ تنفر القلوب عنه ولكن يعتزي إلى ابعد الفرق عن المسلك المستقيم وأطوعهم لقبول الخرافات ويتستر بهم ويتجمل بحب أهل البيت وهم الروافض.
الرابع هو أن يقدم في أول كلامه أن الباطل ظاهر جلي والحق دقيق بحيث لو سمعه الأكثرون لأنكروه ونفروا عنه وان طلاب الحق والقائلين به من بين طلاب الجهل أفراد وآحاد ليهون عليه التميز عن العامة في إنكار نظر العقل وظواهر ما ورد به النقل.
الخامس إن رآه نافرا عن التفرد عن العامة فيقول له إني مفش إليك سرا وعليك حفظه فإذا قال نعم قال إن فلانا وفلانا يعتقدون هذا المذهب ولكنهم يسرونه ويذكر له من الأفاضل من يعتقد المستجيب فيه الذكاء والفطنة وليكن ذلك المذكور بعيدا عن بلده حتى لا يتيسر له المراجعة كما جعلوا الدعوة بعيدة عن مقر امامهم ووطنه فانهم لو أظهروها في جواره لافتضحوا بما يتواتر من أخباره وأحواله.
السادس ان يمنيه بظهور شوكة هذه الطائفة وانتشار أمرهم وعلو رأيهم وظفر ناصريه بأعدائهم واتساع ذات يدهم ووصول كل واحد منهم إلى مراده حتى تجتمع لهم سعادة الدنيا والآخرة ويعزى بعض ذلك إلى النجوم وبعضه إلى الرؤيا في المنام إن امكنه وضع منامات تنتهي إلى المستجيب على لسان غيره.
السابع ألا يطول الداعي إقامته ببلد واحدة فانه ربما اشتهر أمره وسفك دمه فينبغي ان يحتاط في ذلك فيلبس على الناس أمره ويتعرف إلى كل قوم باسم واخر وليغير في بعض الاوقات هيئته ولبسته خوف الآفات ليكون ذلك ابلغ في الاحتياط.
ثم بعد هذه المقدمات يتدرج قليلا قليلا في تفصيل المذهب للمستجيب وذكره له على ما سنحكي من معتقده.
وأما حيلة التلبيس فهو ان يواطئه على مقدمات يتسلمها منه مقبولة الظاهر مشهورة عند الناس ذائعة ويرسخ ذلك في نفسه مدة ثم يستدرجه منها بنتائج باطلة كقوله ان أهل النظر لهم أقاويل متعارضة الأحوال متساوية وكل حزب بما لديهم فرحون والمطلع على الجوهر الله ولا يجوز أن يخفي الله الحق ولا يوجد أحد كل الأمر إلى الخلق يتخبطون فيه خبط العشواء ويقتحمون فيه العماية العمياء إلى غير ذلك من مقدمات يت... مستعضلة.
وأما حيلة الخلع والسلخ وهي هما متفقان وانما يفترقان في أن الخلع يختص بالعمل فإذا أفضوا بالمستجيب إلى ترك حدود الشرع وتكاليفه يقولون وصلت إلى درجة الخلع أما السلخ فيختص بالاعتقاد الذي هو خلع الدين فإذا انتزعوا ذلك من قلبه دعوا ذلك سلخا. وسميت هذه الرتبة البلاغ الأكبر.
فهذا تفصيل تدريجهم الخلق واستغوائهم. فلينظر الناظر فيه وليستغفر الله من الضلال في دينه.
الفصل الثاني في بيان السبب في رواج حيلتهم وانتشار دعوتهم مع ركاكة حجتهم وفساد طريقتهم.
فإن قيل ما جليتموه من العظائم لا يتصور ان يخفى على عاقل وقد رأينا خلقا كثيرا وجما غفيرا من الناس يتابعونهم في معتقدهم وتابعوهم في دينهم فلعلكم ظلمتموهم بنقل هذه المذاهب عنهم في خلاف ما يعتقدونه. وهذا هو القريب الممكن فانهم لو أظهروا هذه الأسرار نفرت القلوب عنهم واطلعت النفوس على مكرهم وما باحوا بها إلا بعد العهود والمواثيق وصانوها إلا عن موافق لهم في الاعتقاد فمن اين وقع لكم الاطلاع عليها وهم يسترون ديانتهم ويستنبطون بعقائدهم قلت أما الإطلاع على ذلك فانما عثرنا عليه من جهة خلق كثير تدينوا بدينهم واستجابوا لدعوتهم ثم تنبهوا لضلالهم فرجعوا عن غوايتهم إلى الحق المبين فذكروا ما ألقوا اليهم من الأقاويل واما سبب انقياد الخلق اليهم في بعض أقطار الأرض فانهم لا يفشون هذا الأمر إلا إلى بعض المستجيبين لهم ويوصون الداعي ويقولون له إياك ان تسلك بالجميع مسلكا واحدا فليس كل من يحتمل قبول هذه المذاهب يحتمل الخلع والسلخ ولا كل من يحتمل الخلع يحتمل السلخ فليخاطب الداعي الناس على قدر عقولهم. فهذا هو السبب في تعلق هذه الحيل ورواجها.
فإن قيل هذا أيضا مع الكتمان ظاهر البطلان فكيف ينخدع بمثله عاقل قلنا لا ينخدع به إلا المائلون عن اعتدال الحال واستقامة الرأي فللعقلاء عوارض تعمى عليهم طرق الصواب وتقضي عليهم بالانخداع بلامع السراب وهي ثمانية أصناف.
الصنف الأول طائفة ضعفت عقولهم وقلت بصائرهم وسخفت في أمور الدين آراؤهم لما جبلوا عليه من البله والبلادة مثل السواد وأفجاج العرب والأكراد وجفاة الأعاصم وسفهاء الأحداث ولعل هذا الصنف هم أكبر الناس عددا وكيف يستبعد قبولهم لذلك ونحن نشاهد جماعة في بعض المدائن القريبة من البصرة يعبدون أناسا يزعمون أنهم ورثوا الربوبيه من آبائهم المعروفين بالشباسية وقد اعتقدت طائفة في علي رضي الله عنه انه إله السموات والارض رب العالمين وهم خلق كثير لا يحصرهم عدد ولا يحويهم بلد فلا ينبغي أن يكثر التعجب من جهل الإنسان إذا استحوذ عليه الشيطان واستولى عليه الخذلان.
الصنف الثاني طائفة انقطعت الدولة عن أسلافهم بدولة الإسلام كأبناء الأكاسرة والدهاقين وأولاد المجوس المستطيلين فهؤلاء موتورون قد استكن الحقد في صدورهم كالداء الدفين فإذا حركته تخاييل المبطلين اشتعلت نيرانه في صدورهم فأذعنوا لقبول كل محال تشوقا إلى درك ثأرهم وتلافي أمورهم.
الصنف الثالث طائفة لهم همم طامحة إلى العلياء متطلعة إلى التسلط والاستيلاء إلا انه ليس يساعدهم الزمان بل يقصر بهم عن الأتراب والأقران طوارق الحدثان فهؤلاء إذا وعدوا بنيل امانيهم وسول لهم الظفر بأعاديهم سارعوا إلى قبول ما يظنونه مفضيا إلى مآربهم وسالكا إلى أوطارهم ومطالبهم فلطالما قيل حبك الشيئ يعمي ويصم ويشترك في هذا كل من دهاه من طبقة الإسلام آمر يلم به وكان لا يتوصل إلى الانتصار ودرك الثأر إلا بالاستظهار بهؤلاء الاغبياء الأغمار فتتوفر دواعيه على قبول ما يرى الأمنية فيه.
الصنف الرابع طائفة جبلوا على حب التميز عن العامة والتخصص عنهم ترفعا عن مشابهتهم وتشرفا بالتحيز إلى فئة خاصة تزعم انها مطلعة على الحقائق وان كافة الخلق في جهالتهم كالحمر المستنفرة والبهائم المسيبة وهذا هو الداء العضال المستولي على الأذكياء فضلا عن الجهال الاغبياء وكل ذلك حب للنادر الغريب ونفرة عن الشائع المستفيض وهذه سجية لبعض الخلق على ما شهدت به التجربة وتدل عليه المشاهدة.
الصنف الخامس طائفة سلكوا طرق النظر ولم يستكملوا فيه رتبة الاستقلال وان كانوا قد ترقوا عن رتبة الجهال فهم أبدا متشوقون إلى التكاسل والتغافل وإظهار التفطن لدرك أمور تتخيل العامه بعدها وينفرون عنها لا سيما إذا نسب الشئ إلى مشهور بالفضل فيغلب على الطبع التشوق إلى التشبه به فكم من طوائف رأيتهم اعتقدوا محض الكفر تقليدا لافلاطن وأرسططاليس وجماعة من الحكماء قد اشتهروا بالفضل وداعيهم إلى ذلك التقليد وحب التشبه بالحكماء والتحيز إلى غمارهم والتحيز عمن يعتقد انه في الذكاء والفضل دونهم فهؤلاء يستجرون إلى هذه البدعة بإضافتها إلى من يحسن اعتقاد المستجيب فيه فيبادر إلى قبوله تشفعا بالتشبه بالذي ذكر انه من منتحليه.
الصنف السادس طائفة اتفق نشؤوهم بين الشيعة والروافض واعتقدوا التدين بسب الصحابة ورأوا هذه الفرقة تساعدهم عليها فمالت نفوسهم إلى المساعدة لهم والاستئناس بهم وانجرت معهم إلى ما وراء ذلك من خصائص مذهبهم.
الصنف السابع طائفة من ملحدة الفلاسفة والثنوية والمتحيرة في الدين اعتقدوا أن الشرائع نواميس مؤلفة وان المعجزات مخاريق مزخرفة فإذا رأوا هؤلاء يكرمون من ينتمي إليهم ويفيضون ذخائر الأموال عليهم انتدبوا لمساعدتهم طلبا لحطام الدنيا واستحقارا لامر العقبى وهذه الطائفة هم الذين لفقوا لهم الشبه وزينوا لهم بطريق التمويه الحجج وسووها على شروط الجدل وحدود المنطق من حيث الظاهر وغبوا مكامن التلبيس والمغالطة فيها تحت ألفاظ مجملة وعبارات كلية مبهمة قلما يهتدي الناظر الضعيف إلى فك تعقيدها وكشف الغطاء عن مكمن تدليسها على ما سنورد ما لفقوه وننبه على المسلك الذي سلكوه ونهجوه ونكشف عن فساده من عدة وجوه.
الصنف الثامن طائفة استولت عليهم الشهوات فاستدرجتهم متابعة اللذات واشتد عليهم وعيد الشرع وثقلت عليهم تكاليفه فليس يتهنأ عيشهم إذا قرفوا بالفسق والفجور وتوعدوا بسوء العاقبة في الدار الآخرة فإذا صادفوا من يفتح لهم الباب ويرفع عنهم الحجز والحجاب ويحسن لهم ما هم مستحسنون له بالطبع تسارعوا إلى التصديق بالرغبة والطوع وكل انسان مصدق لما يوافق هواه ويلائم غرضه ومناه فهؤلاء ومن يجري مجراهم هم الذين عدموا التوفيق فانخدعوا بهذه المخاريق وزاغوا عن سواء الطريق وحدود التحقيق.
الباب الرابع في نقل مذاهبهم جملة وتفصيلا
أما الجملة فهو أنه مذهب ظاهره الرفض وباطنه الكفر المحض ومفتتحه حصر مدارك العلوم في قول الإمام المعصوم وعزل العقول عن أن تكون مدركة للحق لما يعتريها من الشبهات ويتطرق إلى النظار من الاختلافات وإيجاب لطلب الحق بطريق التعليم والتعلم وحكم بان المعلم المعصوم هو المستبصر وانه مطلع من جهة الله على جميع أسرار الشرائع يهدي إلى الحق ويكشف عن المشكلات وان كل زمان فلا بد فيه من امام معصوم يرجع إليه فيما يستبهم من أمور الدين.
هذا مبدأ دعوتهم ثم انهم بالآخرة يظهرون ما يناقض الشرع وكأنه غاية مقصدهم لان سبيل دعوتهم ليس بمتعين في فن واحد بل يخاطبون كل فريق بما يوافق رأيه بعد أن يظفروا منهم بالانقياد لهم والموالاة لامامهم فيوافقون اليهود والنصارى والمجوس على جملة معتقداتهم ويقرونهم عليها فهذه جملة المذاهب.
وأما تفصيله فيتعلق بالإلهيات والنبوات والإمامة والحشر والنشر. وهذه أربعة أطراف وأنا مقتصر في كل طرف على نبذة يسيرة من حكاية مذهبهم فإن النقل عنهم مختلف وأكثر ما حكي عنهم إذا عرض عليهم أنكروه وإذا روجع فيه الذين استجابوا لدعوتهم جحدوه والذي قدمناه في جملة مذهبهم يقتضي لا محالة ان يكون النقل عنهم مختلفا مضطربا فانهم لا يخاطبون الخلق بمسلك واحد بل غرضهم الاستتباع والاحتيال فلذلك تختلف كلمتهم ويتفاوت نقل المذهب عنهم فان ما حكي عنهم في الخلع والسلخ لا يظهرونه إلا مع من بلغ الغاية القصوى بل ربما يخاطبون بالخلع من ينكرون معه السلخ فلنرجع إلى بيان أطراف المذهب.
الطرف الأول في معتقدهم في الإلهيات
وقد اتفقت أقاويل نقله المقالات من غير تردد انهم قائلون بإلهين قديمين لا أول لوجودهما من حيث الزمان إلا ان أحدهما علة لوجود الثاني واسم العلة السابق واسم المعلول التالي وان السابق خلق العالم بواسطة التالي لا بنفسه وقد يسمى الأول عقلا والثاني نفسا ويزعمون ان الأول هو التام بالفعل والثاني بالاضافة إليه ناقص لانه معلوله وربما لبسوا على العوام مستدلين بآيات من القرآن عليه كقوله تعالى: {إنا نحن نزلنا} و {نحن قسمنا} وزعموا ان هذه إشارة إلى جمع لا يصدر عن واحد ولذلك قال {سبح اسم ربك الأعلى} إشارة إلى السابق من الالهين فانه الاعلى ولولا ان معه إلها آخر له العلو أيضا لما انتظم إطلاق الأعلى وربما قالوا الشرع سماهما باسم القلم واللوح والأول هو القلم فان القلم مفيد واللوح مستفيد متأثر والمفيد فوق المستفيد وربما قالوا اسم التالي قدر في لسان الشرع وهو الذي خلق الله به العالم حيث قال {إنا كل شيء خلقناه بقدر} ثم قالوا السابق لا يوصف بوجود ولا عدم فان العدم نفى والوجود سببه فلا هو موجود ولا هو معدوم ولا هو معلوم ولا هو مجهول ولا هو موصوف ولا غير موصوف وزعموا أن جميع الأسامي منتفية عنه وكأنهم يتطلعون في الجملة لنفي الصانع فانهم لو قالوا إنه معدوم لم يقبل منهم بل منعوا الناس من تسميته موجودا وهو عين النفي مع تعيير العبارة لكنهم تحذقوا فسموا هذا النفي تنزيها وسموا مناقضه تشبيها حتى تميل القلوب إلى قبوله ثم قالوا العالم قديم أي وجوده ليس مسبوقا بعدم زماني بل حدث من السابق التالي وهو أول مبدع وحدث من المبدع الأول النفس الكلية الفاشية جزئياتها في هذه الابدان المركبة وتولد من حركة النفس الحرارة ومن سكونها البرودة ثم تولد منهما الرطوبة واليبوسة ثم تولدت من هذه الكيفيات الاستقصات الأربع وهي النار والهواء والماء والأرض ثم إذا امتزجت على اعتدال ناقص حدثت منها المعادن فإن زاد قربها من الاعتدال وانهدم صرفية التضاد منها تولد منها النبات وان زاد تولد الحيوان فان ازداد قربا تولد الإنسان وهو منتهى الاعتدال.
فهذا ما حكي من مذهبهم إلى أمور اخر هي أفحش مما ذكرناه لم نر تسويد البياض بنقلها ولا تبيان وجه الرد عليها لمعنيين أحدهما أن المنخدعين بخداعهم وزورهم والمتدلين بحبل غرورهم في عصرنا هذا لم يسمعوا هذا منهم فينكرون جميع ذلك إذا حكي من مذهبهم ويحدثون في أنفسهم أن هؤلاء انما خالفوا لانه ليس عندهم حقيقة مذهبنا ولو عرفوها لوافقونا عليها فنرى ان نشتغل بالرد عليهم فيما اتفقت كلمتهم وهو إبطال الرأي والدعوة إلى التعلم من الإمام المعصوم فهذه عمدة معتقدهم وزبدة مخضهم فلنصرف العناية إليه وما عداه فمنسقم إلى هذيان ظاهر البطلان وإلى كفر مسترق من الثنوية والمجوس في القول بالالهين مع تبديل عبارة النور والظلمة ب السابق والتالي إلى ضلال منتزع من كلام الفلاسفة في قولهم ان المبدأ الأول علة لوجود العقل على سبيل اللزوم عنه لا على سبيل القصد والاختيار وانه حصل من ذاته بغير واسطة سواه نعم يثبتون موجودات قديمة يلزم بعضها عن بعض ويسمونها عقولا ويحيلون وجود كل فلك على عقل من تلك العقول في خبط لهم طويل قد استقصينا وجه الرد عليهم في ذك في فن الكلام ولسنا نشتغل في هذا الكتاب إلا يما يخص هذه الفرقة وهو إبطال الرأي وإثبات التعليم.
الطرف الثاني في بيان معتقدهم في النبوات
والمنقول عنهم قريب من مذهب الفلاسفة وهو أن النهي عبارة عن شخص فاضت عليه من السابق بواسطة التالي قوة قدسية صافية مهيأة لأن تنتقش عند الاتصال بالنفس الكلية بما فيها من الجزئيات كما قد يتفق ذلك لبعض النفوس الزكية في المنام حتى تشاهد من مجاري الأحوال في المستقبل إما صريحا بعينه أو مدرجا تحت مثال يناسبه مناسبة ما فتفتقر فيه إلى التعبير إلا أن النبي هو المستعد لذلك في اليقظة فلذلك يدرك النبي الكليات العقلية عند شروق ذلك النور وصفاء القوة النبوية كما ينطبع مثال المحسوسات في القوة الباصرة من العين عند شروق نور الشمس على سطوح الأجرام السفلية وزعموا أن جبريل عبارة عن العقل الفائض عليه ورمز إليه لا انه شخص متجسم متركب عن جسم لطيف أو كثيف يناسب المكان حتى ينتقل من علو إلى سفل واما القرآن فهو عندهم تعبير محمد عن المعارف التي فاضت عليه من العقل الذي هو المراد باسم جبريل ويسمى كلام الله تعالى مجازا فانه مركب من جهته وانما الفائض عليه من الله بواسطة جبريل بسيط لا تركيب فيه وهو باطن لا ظهور له وكلام النبي وعبارته عنه ظاهر لا بطون له وزعموا ان هذه القوة القدسية الفائضة على النبي لا تستكمل في أول حلولها كما لا تستكمل النطفة الحالة في الرحم إلا بعد تسعة أشهر فكذلك هذه القوة كمالها في أن تنتقل من الرسول الناطق إلى الاساس الصامت وهكذا تنتقل إلى أشخاص بعضهم بعد بعض فيكمل في السابع كما سنحكي معنى قولهم في الناطق والاساس والصامت.
وهذه المذاهب مستخرجة من مذاهب الفلاسفة في النبوات مع تحريف وتغيير ولسنا نخوض في الرد عليهم فيه فإن بعضهم يمكن أن يتأول على مجه لاننكره والقدر الذي ننكره قد استقصينا وجه الرد فيه على الفلاسفة ولسنا في هذا الكتاب نقصد إلا الرد على نابغة الزمان في خصوص مذهبهم الذي انفردوا به عن غيرهم وهو إيجاب التعليم وإبطال الرأي.
الطرف الثالث بيان معتقدهم في الإمامة
وقد اتفقوا على أنه لا بد في كل عصر من إمام معصوم قائم بالحق يرجع إليه في تأويل الظواهر وحل الإشكالات في القرآن والأخبار والمعقولات واتفقوا على أنه المتصدي لهذا الأمر وان ذلك جار في نسبهم لا ينقطع أبد الدهر ولا يجوز أن ينقطع إذ يكون فيه إهمال الحق وتغطيته على الخلق وإبطال قوله عليه السلام كل سبب ونسب ينقطع إلا سببي ونسبي وقوله ألم أترك فيكم القرآن وعترتي واتفقوا على أن الإمام يساوي النبي في العصمة والاطلاع على حقائق الحق في كل الأمور إلا انه لا ينزل إليه الوحي وانما يتلقى ذلك من النبي فانه خليفته وبإزاء منزلته ولا يتصور في زمان واحد امامان كما لايتصور نبيان تختلف شريعتهما نعم يستظهر الإمام بالحجج والمأذونين والاجنحة والحجج هم الدعاة فقالوا لا بد للإمام في كل وقت من اثنى عشر حجة ينتدبون في الأقطار متفرقين في الأمصار وليلازم أربعة من جملة الاثنى عشر حضرته فلا يفارقونه ولا بد لكل حجة من معاونين له على أمره فانه لا ينفرد بالدعوة بنفسه واسم المعاون المأذون عندهم ولا بد للدعاة من رسل إلى الإمام يرفعون إليه الأحوال ويصدرون عنه اليهم واسم الرسول الجناح. ولا بد للداعي من أن يكون بالغا في العلم والمأذون وإن كان دونه فلا بأس بعد أن يكون عالما على الجملة وكذلك الجناح.
ثم انهم قالوا كل نبي لشريعته مدة فإذا انصرمت مدته بعث الله نبيا آخر ينسخ شريعته ومدة شريعة كل نبي سبعة أعمار وهو سبعة قرون فأولهم هو النبي الناطق ومعنى الناطق أن شريعته ناسخة لما قبله. ومعنى الصامت ان يكون قائما على ما أسسه غيره ثم أنه يقوم بعد وفاته ستة أئمة إمام بعد إمام فإذا انقضت أعمارهم ابتعث الله نبيا أخر ينسخ الشريعة المتقدمة وزعموا أن أمر آدم جرى على هذا المثال وهو أول نبي ابتعثه الله في فتح باب الجسمانيات وحسم دور الروحانيات. ولكل نبي سوس والسوس هو الباب إلى علم النبي في حياته والوصي بعد وفاته والإمام لمن هو في زمانه كما قال عليه السلام أنا مدينة العلم وعلي بابها وزعموا أن آدم كان سوسة شيث وهو الثاني ويسمى من بعده متما ولاحقا وإماما وإنما كان استتمام دور آدم سبعة لان استتمام دور العالم العلوي بسبعة من النجوم ولما استتم دور آدم ابتعث الله نوحا ينسخ شريعته وكان سوسه سام فلما استتم دوره بمضي ستة سواه وسبعة معه ابتعث الله إبراهيم ينسخ شريعته وكان سوسه اسحق ومنهم من يقول لا بل أسماعيل فلما استتم دوره بالسابع معه ابتعث الله موسى ينسخ شريعته وكان سوسه هارون فمات هارون في حياة موسى فصار سوسه يوشع بن نون فلما استتم دوره بالسابع معه ابتعث الله عيسى ينسخ شريعته وسوسه شمعون ولما استتم دوره بالسابع ابتعث الله محمدا ﷺ وسوسه علي عليه السلام وقد استتم دوره بجعفر بن محمد فإن الثاني من الأئمة الحسن بن علي والثالث الحسين بن علي والرابع علي بن الحسين والخامس محمد بن علي والسادس جعفر بن محمد عليه السلام وقد استتموا سبعة معه وصارت شريعته ناسخة وهكذا يدور الأمر أبد الدهر.
هذا ما نقل عنهم مع خرافات كثيرة أهملنا ذكرها ضنة بالبياض أن يسود بها.
الطرف الرابع بيان مذهبهم في القيامة والمعاد
وقد اتفقوا عن آخرهم على إنكار القيامة وان هذا النظام المشاهد في الدنيا من تعاقب الليل والنهار وحصول الإنسان من نطفة والنطفة من انسان وتولد النبات وتولد الحيوانات لا يتصرم أبدا الدهر وان السموات والأرض لا يتصور انعدام اجسامهما وأولوا القيامة وقالوا إنها رمز إلى خروج الإمام وقيام قائم الزمان وهو السابع الناسخ للشرع المغير للأمر وربما قال بعضهم ان للفلك أدوارا كلية تتبدل أحوال العالم تبدلا كليا بطوفان عام أو سبب من الأسباب فمعنى القيامة انقضاء دورنا الذي نحن فيه واما المعاد فانكروا ما ورد به الأنبياء ولم يثبتوا الحشر والنشر للاجساد ولا الجنة والنار ولكن قالوا معنى المعاد عود كل شئ إلى أصله والإنسان متركب من العالم الروحاني الجسماني اما الجسماني منه وهو جسده فمتركب من الاخلاط الأربعة الصفراء والسوداء والبلغم والدم فينحل الجسد ويعود كل خلط إلى الطبيعة العالية أما الصفراء فتصير نارا وتصير السوداء ترابا ويصير الدم هواء ويصير البلغم ماء وذلك هو معاد الجسد وأما الروحاني وهو النفس المدركة العاقلة من الإنسان فانها ان صفيت بالمواظبة على العبادات وزكيت بمجانبة الهوى والشهوات وغذيت بغذاء العلوم والمعارف المتلقاة من الأئمة الهداة اتحدت عند مفارقة الجسم بالعالم الروحاني الذي منه انفصالها وتسعد بالعود إلى وطنها الأصلي ولذلك سمي رجوعا فقيل {ارجعي إلى ربك راضية مرضية} وهي الجنة وإليه وقع الرمز بقصة آدم وكونه في الجنة ثم انفصاله عنها ونزوله إلى العالم السفلاني ثم عوده اليها بالآخرة وزعموا ان كمال النفس بموتها إذ به خلاصها من ضيق الجسد والعالم الجسماني كما أن النطفة في الخلاص من ظلمات الرحم والخروج إلى فضاء العالم والإنسان كالنطفة والعالم كالرحم والمعرفة كالغذاء فإذا نفذت فيه صارت بالحقيقة كاملة وتخلصت فإذا استعدت لفيض العلوم الروحانية باكتساب العلوم من الأئمة وسلوك طرقها المفيدة بإرشادهم استكملت عند مفارقة الجسد وظهر لها ما لم يظهر ولذلك قال عليه السلام الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا وكلما ازدادت النفس عن عالم الحسيات بعدا ازدادت للعلوم الروحانية استعدادا وكذلك إذا ركدت الحواس بالنوم اطلعت على عالم الغيب واستشعرت ما سيظهر في المستقبل إما بعينه فيغنى عن المعبر أو بمثال فيحتاج إلى التعبير فالنوم اخو الموت وفيه يظهر علم ما لم يكن في اليقظة فكذا الموت تنكشف أمور لم تخطر على قلب بشر في الحياة وهذا للنفوس التي قدستها الرياضة العملية والعلمية فأما النفوس المنكوسة المغمورة في عالم الطبيعة المعرضة عن رشدها من الأئمة المعصومين فانها تبقى أبد الدهر في النار على معنى انها تبقى في العالم الجسماني تتناسخها الأبدان فلا تزال تتعرض فيها للألم والاسقام فلا تفارق جسدا إلا ويتلقاها آخر ولذلك قال تعالى: {كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب} فهذا مذهبهم في المعاد وهو بعينه مذهب الفلاسفة وانما شاع فيهم لما انتدب لنصرة مذهبهم جماعة من الثنوية والفلاسفة فكل واحد نصر مذهبهم طمعا في أموالهم وخلعهم واستظهارا باتباعهم لما كان قد ألفه في مذهبه فصار أكثر مذهبهم موافقا للثنوية والفلاسفة في الباطن وللروافض والشيعة في الظاهر وغرضهم بهذه التأويلات انتزاع المعتقدات الظاهرة عن نفوس الخلق حتى تبطل به الرغبة والرهبة ثم ما اوهموه وهذوا به لا يفهم في نفسه ولا يؤثر في ترغيب وترهيب وسنشير إلى كلام وجيز في الرد عليهم في هذا الفن وأخباره في آخر الفصل.
الطرف الخامس في اعتقادهم في التكاليف الشرعية
والمنقول عنهم الإباحة المطلقة ورفع الحجاب واستباحة المحظورات واستحلالها وإنكار الشرائع إلا انهم بأجمعهم ينكرون ذلك إذا نسب اليهم وانما الذي يصح من معتقدهم فيه انهم يقولون لا بد من الانقياد للشرع في تكاليفه على التفصيل الذي يفصله الإمام من غير متابعة الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما وان ذلك واجب على الخلق والمستجيبين إلى ان ينالوا رتبة الكمال في العلوم فإذا أحاطوا من جهة الإمام بحقائق الأمور واطلعوا على بواطن هذه الظواهر انحلت عنهم هذه القيود وانحطت عنهم هذه التكاليف العملية فان المقصود من أعمال الجوارج تنبيه القلب لينهض الطب العلم فإذا ناله استعد للسعادة القصوى فيسقط عنه تكليف الجوارح وانما تكليف الجوارح في حق من يجري بجهله مجرى الحمر التي لا يمكن رياضتها إلا بالأعمال الشاقة وأما الأذكياء والمدركون للحقائق فدرجتهم ارفع من ذلك وهذا فن من الإغواء شديد على الأذكياء وغرضهم هدم قوانين الشرع ولكن يخادعون كل ضعيف بطريق يغويه ويليق به وهذا من الإضلال البارد وهو في حكم ضرب المثال كقول القائل إن الاحتماء عن الاطعمه المضرة انما يجب على من فسد مزاجه فأما من اكتسب اعتدال المزاح فليواظب على أكل ما شاء أي وقت شاء فلا يلبث المصغي الي هذا الضلال ان يمعن في المطعومات المضرة إلي أن تتداعى به إلى الهلاك.
فإن قيل قد نقلتم مذاهبهم وما ذكرتم وجه الإبطال فما السبب فيه قلنا إن ما نقلناه عنهم ينقسم إلى أمور يمكن تنزيلها على وجه لا ننكره والى ما يتعين من الشرع إنكاره والمنكر هو مذهب الثنوية والفلاسفة والرد عليهم فيه يطول فليس ذلك من خصائص مذهب هؤلاء حتى نتشاغل به وانما نرد عليهم في خصوص مذهبهم من إبطال الرأي وإثبات التعليم من الإمام المعصوم ولكنا مع ذلك نذكر مسلكا واحدا هو على التحقيق قاصم الظهر نعني في إبطال مذهبهم في جميع ما سنحكي عنهم وما حكيناه وهو أنا نقول لهم في جميع دعاويهم التي تميزوا بها عنا كإنكار القيامة وقدم العالم وإنكار بعث الأجساد وإنكار الجنة والنار على ما دل عليه القرآن مع غاية الشرح في وصفها من أين عرفتم ما ذكرتموه أعن ضرورة أو عن نظر أو عن نقل عن الإمام المعصوم وسماع فان عرفتموه ضرورة فكيف خالفكم فيه ذوو العقول السليمة لان معنى كون الشئ ضروريا مستغنيا عن التأمل اشتراك كافة العقلاء في دركه ولو ساغ أن يهذي الإنسان بدعوى الضرورة في كل ما يهواه لجاز لخصومهم دعوى الضرورة في نقيض ما ادعوه وعند ذلك لا يجدون مخلصا بحال من الأحوال. وان زعموا أنا عرفنا ذلك بالنظر فهو باطل من وجهين أحدهما أن النظر عندهم باطل فانه تصرف بالعقل لا بالتعليم وقضايا العقول متعارضه وهي غير موثوق بها ولذلك أبطلوا الرأي بالكلية ولم نصنف هذا الكتاب قصدا لإبطال هذا المذهب فكيف يمكن ذلك منهم الثاني أن يقال للفلاسفة والمعترفين بمسالك النظر بم عرفتم عجز الصانع عن خلق الجنة والنار وبعث الأجساد كما ورد به الشرع وهل معكم إلا استبعاد محض لو عرض مثله على من لم يشاهد النشأة الأولى لاستبعده وعرض له ذلك الإنكار فالرد عليهم بالحجة المنطوية تحت قوله تعالى: {قل يحييها الذي أنشأها أول مرة} ومن تأمل عجائب الصنع في خلق الآدمي من نطفة قذرة لم يستبعد من قدرة الله شيئا وعرف أن الإعادة اهون من الابتداء.
فإن قيل الإعادة غير معقولة والابتداء معقول إذ ما عدم كيف يعود قلنا لنفهم الابتداء حتى نبني عليه الإعادة ورأى المتكلمين فيه أن الابتداء يخلق الحياة في جسم من الأجسام مع ان الحياة عرض يتجدد ساعة فساعة بخلق الله تعالى فلا يستحيل على أصلهم الإمساك عن خلق الحياه مدة في الجسم ثم يعود إلى خلق الحياة كما لا يستحيل خلق الحركة بعد السكون والسواد بعد البياض ورأى الفلاسفة أن قوام الحياة استعداد جسم مخصوص بنوع من الاعتدال إلى الانفعال عن النفس التي هي جوهر قائم بنفسه غير متحيز ولا متجسم ولا هو منطبع في جسم لا علاقة بينه وبين الجسم إلا بالفعل فيه ولا علاقة بين الجسم وبينه إلا بالانفعال عنه ومعنى الموت انقطاع هذه العلاقة الفعلية ببطلان استعداد الجسم فانه لا يستعد للاننفعال إلا إذا كان على مزاج مخصوص كما لا يستعد الحديد لانطباع الصورة المحسوسة فيه أو انعكاس الاشعة عنه إلا إذا كان على هيئة مخصوصة فإذا بطلت تلك الهيئة لم ينفعل الحديد عن الصورة المحاذية له ولم ينطبع فيه فإذا كان هذا مذهبهم فالقادر على إحداث العلاقة بين نفس لا تتجسم ولا تختص بمكان ولا توصف بانها متصلة بالجسم ولا بأنها منفصلة عنه وبين الجسم الذي لا تناسبه بحقيقتها ولا تتصل به اتصالا محسوسا كيف يعجز عن إعادة تلك العلاقة والعجب أن أكثرهم جوزوا إثبات تلك العلاقة مع جسد آخر على طريق التناسخ فلم لا يجوز عودها إلى جسدها فان الجسد الذي فسد مزاجه لابعد في أن يصلح مزاجه وتعاد تلك العلاقة ايه فيكون هو المراد بالإعادة ويضاهي التيقظ بعد المنام فانه يعيد حركة الحواس وتذكر الأمور السالفة.
فان قيل المزاج إذا فسد لا يعود معتدلا إلا بان تنحل اجزاء الجسم إلى العناصر ثم تتركب ثانيا ثم يصير حيوانا ثم يصير نطفة فهذا الإعتدال للنطفة على الخصوص قلنا ومن أين عرفتم انه ليس في مقدور الله جبر الخلل الواقع بطريق سوى هذا الطريق ومن أين عرفتم أن هذا الذي ذكرتموه طريق فهل لكم مستند سوى مشاهدة الأحوال وهل لكم في إبطال غيره مستند سوى عدم المشاهدة ولو لم تشاهدوا خلق الإنسان من نطفة لنفرت عقولكم عن التصديق به ففي الأسباب المغيره لأحوال الأجسام عجائب يستنكرها من لا يشاهدها فمن منكر ينكر الخواص وآخر ينكر السحر وآخر ينكر المعجزة وآخر ينكر الأخبار عن الغيب وكل يعول في إقراره على قدر مشاهدته لا على طريق معقول في إثبات الاستحالة ثم من لم يشاهده ويستيقنه ينبئ أن نفرة طبعه عن التصديق كان لعدم المشاهدة وفي مقدورات الله عجائب لم يطلع عليها بشر فلم يستحل ان يكون لإعادة تلك الاجسام وإعادة مزاجها سبب عند الله ينفرد بمعرفته وإذا اعاده عادت النفس متصرفه فيه كما كان بزعمهم في الحياة والعجب ممن يدعي الحذق في المعقولات ثم يشاهد ما في العالم من العجائب والآيات ثم تضيق حوصلته عن قبول ذلك في قدرة الله وإذا نسب ما لم يشاهده إلى ما شاهده لم ير أعجب منه نعم لو قال القائل هذا أمر لا يدل العقل على إحالته ولكن لا يدل أيضا على جوازه بل يتوقف عن الحكم فيه ويجوز ان يكون ثم محيل لا يطلع عليه أو مجوز لا يطلع عليه فهذا أقرب من الأول ويلزم بحكمه تصديق النبي ﷺ إذا أخبر عنه فانه أخبر عما لا يستحيل في العقل وجوده وعلى الجملة فقد اشتمل على أطوار الخلق ودرجاته قوله تعالى: {ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين} إلى قوله {تبعثون} فأطبق الخلق على التصديق بجملة المقدمات إلا البعث لانهم شاهدوا جميع ذلك سوى البعث ولو لم يشاهدوا قط موتا لانكروا إمكان الموت ولو لم يشاهدوا خلق آدمي من نطفة لانكروا إمكانه فالبعث مع ما قبله في ميزان العقل على وتيرة واحدة فلنصدق الأنبياء فيما جاءوا به فإنه لا يمتنع وهذا كله كلام مع فلاسفة النظار اما الباطنية المنكرون للنظر فلا يمكنهم التمسك بالنظر نعم لو قال الباطني أخبرني الإمام المعصوم ان البعث مستحيل فصدقته قيل له وما الذي دعاك إلى تصديق الإمام المعصوم بزعمك ولا معجزة له وصرفك عن تصديق محمد بن عبد الله مع المعجزات والقرآن من أوله إلى آخره دال على جواز ذلك ووقوعه فهل لك من مانع سوى ان عصمته علمت بمعجزته وعصمة من يدعيه علمت بهذيانك وشهوتك فان قال ان ما في القرآن ظواهر هي رموز إلى بواطن لم يفهموها وقد فهمها الإمام المعصوم فتعلمنا منه قلنا تعلمتم منه بمشاهدة ذلك في قلبه بالعين أو سماعا من لفظه ولا يمكن دعوى المشاهدة ولا بد من الاستناد إلى سماع لفظه قلنا وما يؤمنك أن لفظه له باطن لم تطلع عليه فلا تثق بما فهمته من ظاهر لفظه فإن زعمت أنه صرح معك وقال ما ذكرته هو ظاهر لا رمز فيهوالمراد ظاهره قلنا وبم عرفت أن قوله هذا وهو أنه ظاهر لا رمز فيه أيضا ظاهر وفيه رمز إلى ما لم تطلع عليه فلايزال يصرح بلفظه ونحن نقول لسنا ممن يغتر بالظواهر فلعل تحته رمزا وان أنكر الباطن فنقول تحت إنكاره رمز وان حلف بالطلاق الثلاث على أنه ما قصد إلا الظاهر فنقول في طلاقه رمز وانما هو مظهر شيئا ومضمر غيره فان قلت فذلك يؤدي إلى حسم باب التفهيم قلنا فأنتم حسمتم باب التفهيم على الرسول فان ثلثي القرآن في وصف الجنة والنار والحشر والنشر مؤكد بالقسم والايمان وانتم تقولون لعل تحت ذلك رمزا وانتم تقولون وأي فرق بين ان يطول في تفهم الأمور التطويل الذي عرف في القرآن والأخبار وبين أن تقول ما أريد إلا الظاهر فإن جاز عليه ان يفهم الظاهر ويكون مراده غير ما علم قطعا انه ما وصل إلى افهام الخلق ويكون كاذبا في جميع ما قال لاجل مصلحة وسر فيه جاز انيكون امامكم المعصوم بزعمكم يضمر معكم خلاف ما يظهره وضد ما يفهمه ونقيض ما يتيقن انه الواصل إلى افهامكم ويؤكد ذلك بالايمان المغلظة لمصلحة له وسر فيه وهذا لا جواب عنه أبد الدهر وعند هذا ينبغي أن يعرف الإنسان ان رتبة هذه الفرقة أخس من رتبة كل فرقة من فرق الضلال إذ لا نجد فرقة ينقض مذهبها بنفس المذهب سوى هذه إذ مذهبها إبطال النظر وتغيير الألفاظ عن موضوعاتها بدعوى الرموز وكل ما يتصور ان ينطلق به لسانهم اما نظر أو نقل اما النظر فقد ابطلوه وأما اللفظ فقد جوز ان يراد باللفظ غير موضوعه فلا يبقى لهم معتصم فإن قيل فهذا ينقلب عليكم فأنتم تجوزون أيضا تأويل الظواهر كما اولتم آية الاستواء وخبر النزول وغيرهما قلنا ما ابعد هذا القلب فإن لنا معيارا في التأويل وهو أن ما دل نظر العقل ودليله على بطلان ظاهره علمنا ضرورة أن المراد غير ذلك بشرط ان يكون اللفظ مناسبا له بطريق التجوز والاستعارة فقد دل الدليل على بطلان الاستواء والنزول فإن ذلك من صفات الحوادث فحمل على الاستيلاء وهو مناسب للغة واما الحشر والنشر والجنة والنار فليس في العقل دليل على إبطاله ولا مناسبة بين الألفاظ الواردة فيه وبين المعنى الذي أولوه عليه حتى يقال انه المراد بل التأويل في تكذيب محض فأي مناسبة بين قوله {فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة} وقوله {في سدر مخضود وطلح منضود} إلى قوله {لا مقطوعة} وبين ما اعتقدوه من اتصال الجواهر الروحانية بالأمور الروحانية العقلية التي لا مدخل فيها للمحسوسات فإن جاز أن يكذب صاحب المعجزة بهذه التأويلات التي لم تخطر قط ببال من سمعها فلم لا يجوز تكذيب معصومكم الذي لا معجزة له بتأويله على أمور ليس تخطر ببالهم لمصلحة أو لمسيس حاجة فإن غاية لفظه التصريح والقسم وهذه الآلفاظ في القرآن صريحة ومؤيدة بالقسم وزعموا ان ذلك ذكر لمصلحة والمراد غير ما سبق إلى الأفهام منها وهذا لا مخلص عنه.
الباب الخامس في إفساد تأويلاتهم للظواهر الجلية واستدلالاتهم بالأمور العددية
وفيه فصلان.
الفصل الأول في تأويلاتهم للظواهر
والقول الوجيز فيه انهم لما عجزوا عن صرف الخلق عن القرآن والسنة صرفوهم عن المراد بهما إلى مخاريق زخرفوها واستفادوا بما انتزعوه من نفوسهم من مقتضى الألفاظ إبطال معاني اشرع وبما زخرفوه من التأويلات تنفيذ انقيادهم للمبايعة والموالاة وانهم لو صرحوا بالنفي المحض والتكذيب المجرد لم يحظوا بموالاة الموالين وكانوا أول المقصودين المقتولين.
ونحن نحكي من تأويلاتهم نبدة لنستدل بها على مخازيهم فقد قالوا كل ما ورد من الظواهر في التكاليف والحشر والنشر والأمور الإلهية فكلها أمثلة ورموز إلى بواطن اما الشرعيات فمعنى الجنابة عندهم مبادرة المستجيب بإفشاء سر إليه قبل أن ينال رتبة استحقاقه ومعنى الغسل تجديد العهد على فعل ذلك ومجامعة البهيمة معناها عندهم معالجة من لا عهد عليه ولم يؤد شيئا من صدقة النجوى وهي مائة وتسعة عشر درهما عندهم فلذلك اوجب الشرع القتل على الفاعل والمفعول به والا فالبهيمة متى وجب القتل عليها والزنا هو القاء نطفة العلم الباطن في نفس من لم يسبق معه عقد العهد الاحتلام هو أن يسبق لسانه إلى إفشاء السر في غير محله فعليه الغسل أي تجديد المعاهدة الطهور هو التبري والتنظف من اعتقاد كل مذهب سوى مبايعة الإمام الصيام هو الامساك عن كشف السر الكعبة هي النبي والباب علي الصفا هو النبي والمروة علي والميقات هو الاساس والتلبية إجابة الداعي والطواف بالبيت سبعا هو الطواف بمحمد إلى تمام الأئمة السبعة والصلوات الخمس أدلة على الاصول الأربعة وعلى الإمام فالفجر دليل السابق والظهر دليل التالي والعصر دليل للأساس والمغرب دليل الناطق والعشاء دليل الإمام. وكذلك زعموا أن المحرمات عبارة عن ذوي الشر من الرجال وقد تعبدنا باجتنابهم كما أن العبادات عبارة عن الاخيار الأبرار الذين أمرنا باتباعهم.
فأما المعاد فزعم بعضهم أن النار والاغلال عبارة عن الأوامر التي هي التكاليف فانها موظفة على الجهال بعلم الباطن فما داموا مستمرين عليها فهم معذبون فإذا نالوا علم الباطن وضعت عنهم أغلال التكاليف وسعدوا بالخلاص عنها واخذوا يؤولون كل لفظ ورد في القرآن والسنة فقالوا أنهار من لبن أي معادن الدين العلم الباطن يرتضع بها أهلها ويتغذى بها تغذيا تدوم بها حياته اللطيفة فإن غذاء الروح اللطيفة بارتضاع العلم من المعلم كما ان حياة الجسم الكثيف بارتضاع اللبن من ثدي الام وأنهار من خمر هو العلم الظاهر وأنهار من عسل مصفى هو علم الباطن المأخوذ من الحجج والأئمة.
أما المعجزات فقد أولوا جميعها وقالوا الطوفان معناه طوفان العلم اغرق به المتمسكون بالسنة والسفينة حرزه الذي تحصن به من استجاب لدعوته ونار إبراهيم عبارة عن غضب نمرود لا عن النار الحقيقية وذبح اسحق معناه اخذ العهد عليه عصا موسى حجته التي تلقفت ما كانوا يأفكون من الشبه لا الخشب انفلاق البحر افتراق علم موسى فيهم على أقسام والبحر هو العالم والغمام الذي أظلهم معناه الإمام الذي نصبه موسى لإرشادهم وإفاضة العلم عليهم الجراد والقمل والضفادع هي سؤالات موسى وإلزاماته التي سلطت عليهم والمن والسلوى علم نزل من السماء لداع من الدعاة هو المراد بالسلوى تسبيح الجبال معناه تسبيح رجال شداد في الدين راسخين في اليقين. الجن الذي ملكهم سليمان بن داود باطنية ذلك الزمان والشياطين هم الظاهرية الذي كلفوا بالأعمال الشاقة عيسى له أب من حيث الظاهر وإنما أراد بالأب الإمام إذ لم يكن له إمام بل استفاد العلم من الله بغير واسطة وزعموا لعنهم الله أن أباه يوسف النجار كلامه في المهد اطلاعه في مهد القالب قبل التخلص منه على ما يطلع عليه غيره بعد الوفاة والخلاص من القالب إحياء الموتى من عيسى معناه الاحياء بحياة العلم عن موت الجهل الباطن وابراؤه الاعمى معناه عن عمي الضلال وبرص الكفر ببصيرة الحق المبين ابليس وآدم عبارة عن أبي بكر وعلي إذ أمر ابوبكر بالسجود لعلي والطاعة له فأبى واستكبر الدجال زعموا انه أبو بكر وكان اعور إذ لم يبصر إلا بعين الظاهر دون عين الباطن ويأجوج ومأجوج هم أهل الظاهر.
هذا من هذيانهم في التأويلات حكيناها ليضحك منها ونعوذ بالله من صرعة الغافل وكبوة الجاهل.
ولسنا نسلك في الرد عليهم إلا بمسالك ثلاثة إبطال ومعارضة وتحقيق.
أما الإبطال
فهو أن يقال بم عرفتم أن المراد من هذه الألفاظ ما ذكرتم فإن اخذتموه من نظر العقل فهو عندكم باطل وان سمعتموه من لفظ الإمام المعصوم فلفظه ليس بأشد تصريحا من هذه الألفاظ التي أولتموها فلعل مراده أمر آخر اشد بطونا من الباطن الذي ذكرتموه ولكنه جاوز الظاهر بدرجة فزعم ان المراد بالجبال الرجال فما المراد بالرجال لعل المراد به أمر آخر والمراد بالشياطين أهل الظاهر فما أهل الظاهر والمراد باللبن العلم فما معنى العلم فإن قلت العلم والرجال أهل الظاهر صريحة في مقتضياتها بوضع اللغة ان كنت ناظرا بالعين العوراء إلى أحد الجانبين فأنت المراد إذا بالدجال فإنه أعور لانك أبصرت باحدى العينين فإن الرجال ظاهر وعميت بالعين الاخرى الناظرة إلى الجبال وانها أيضا ظاهر فإن قلت يمكن ان يكنى بالجبال عن الرجال قلنا ويمكن ان يكنى بالرجال عن غيرهم كما عبر الشاعر بالرجلين اللذين أحدهما خياط والآخر نساج عن أمور فلكية وأسباب علوية فقال:
رجلان خياط وآخر حائك ** متقابلان على السماك الأعزل
لا زال ينسج ذاك خرقة مدبر ** ويخيط صاحبه ثياب المقبل
وهكذا في كل فن وإذا نزل تسبيح الجبال على تسبيح الرجال فلينزل معنى الرجال في قوله تعالى: {رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله} على الجبال فإن المناسبة قائمة من الجانبين ثم إذا نزل الجبال على الرجال ونزل الرجال أيضا على غيره أمكن تنزيل ذلك الباطن الثالث على رابع وتسلسل إلى حد يبطل التفاهم والتفهيم ولا يمكن التحكم بأن الحائز الرتبة الثانية دون الثالثة أو الثالثة دون الرابعة.
المسلك الثاني معارضة الفاسد بالفاسد
وهو أن يتناول جميع الأخبار على نقيض مذهبهم مثلا يقال قوله لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أى لا يدخل العقل دماغا فيه التصديق بالمعصوم وقوله إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أى إذا نكح الباطني بنت أحدكم فليغسلها عن درن الصحبة بماء العلم وصفاء العمل بعد أن يعفرها بتراب الإذلال أو يقول قائل النكاح لا ينعقد بغير شهود وولى وأما قوله كل نكاح لا يحضره أربعة فهو سفاح معناه أن كل اعتقاد لم يشهد له الحلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فهو باطل وقوله لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل أي لا وقاع إلا بذكر وأنثيين إلى غير ذلك من الترهات والمقصود من ذكر هذا القدر معارضة الفاسد بالفاسد وتعريف الطريق في فتح هذا الباب حتى إذا اهتديت إليه لم تعجز عن تنزيل كل لفظة من كتاب أو سنة على نقيض معتقدهم فإن زعموا أنكم أنزلتم الصورة على المعصوم في قوله لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة فأي مناسبة بينهما قلت وأنتم نزلتم الثعبان على البرهان والأب في حق عيسى على الإمام واللبن على العلم في أنهار اللبن في الجنة والجن على الباطنية والشياطين على الظاهرية والجبال على الرجال فما المناسبة فإن قلت البرهان يقضم الشبه كما يقضم الثعبان غيره والإمام يفيد الوجود العلمي كما يفيد الأب الوجود الشخصي واللبن يغذي الشخص كما يغذي العلم الروح والجن باطن كالباطنيه فيقال لهم فإذا اكتفيتم بهذا القدر من المشاركة فلم يخلق الله شيئين إلا وبينهما مشاركة في وصف ما فإنا نزلنا الصورة على الإمام لان الصورة مثال لا روح فيها كما أن الإمام عندكم معصوم ولا معجزة له والدماغ مسكن العقل كما ان البيت مسكن العاقل والملك شئ روحاني كما أن العقل كذلك فثبت أن المراد بقوله لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة معناه لا يدخل العقل دماغا فيه اعتقادا عصمة الإمام فإذا عرفت هذا فخذ كل لفظ ذكروه وخذ ما تريده واطلب منهما المشاركة بوجه ما وتأوله عليه فيكون دليلا بموجب قولهم كما عرفتك في المناسبة بين الملك والعقل والدماغ والبيت والصورة والإمام وإذا انفتح لك الباب اطلعت على وجه حيلهم في التلبيس بنزع موجبات الألفاظ وتقدير الهوسات بدلا عنها للتوصل إلى إبطال الشرع وهذا القدر كاف في إبطال تأويلهم.
المسلك الثالث وهو التحقيق
أن تقول هذه البواطن والتأويلات التي ذكرتموها لو سامحناكم أنها صحيحة فما حكمها في الشرع أيجب إخفاؤها أم يجب إفشاؤها فإن قلتم يجب إفشاؤها إلى كل أحد قلنا فلم كتمها محمد ﷺ فلم يذكر شيئا من ذلك للصحابة ولعامة الخلق حتى درج ذلك العصر ولم يكن لأحد من هذا الجنس خبر وكيف استجاز كتمان دين الله وقد قال تعالى: {لتبيننه للناس ولا تكتمونه} تنبها على أن الدين لا يحل كتمانه وإن زعموا أنه يجب إخفاؤه فنقول ما أوجب الرسول ﷺ إخفاؤهمن سر الدين كيف حل لكم إفشاؤه والجناية في السر بالإفشاء ممن اطلع عليه من أعظم الجنايات فلولا أن صاحب الشرع عرف سرا عظيما ومصلحة كلية في إخفاء هذه الأسرار لما أخفاها ولما كرر هذه الظواهر على أسماع الخلق ولما تكررت في كلمات القرآن صفة الجنة والنار بألفاظ صريحة مع علمه بأن الناس يفهمون منه خلاف الباطن الذي هو حق ويعتقدون هذه الظواهر التي لا حقيقة لها فإن نسبتموه إلى الجهل بما فهمه الخلق منه فهو نسبة إلى الجهل بمعنى الكلام إذ كان النبي ﷺ يعلم قطعا أن الخلق ليس يفهمون من قوله وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة إلا المفهوم منه في اللغة فكذا سائر الألفاظ ثم مع علمه بذلك كان يؤكده عليهم بالتكرير والقسم ولم يفش إليهم الباطن الذي ذكرتموه لعلمه بأنه سر الله المكتوم فلم أفشيتم هذا السر وخرقتم هذا الحجاب وهل هذا إلا خروج عن الدين ومخالفة لصاحب الشرع وهدم لجميع ما أسسه إن سلم لكم جدلا أن ما ذكرتموه من الباطن حق عند الله وهذا لا مخرج لهم عنه فإن قيل هذا سر لا يجوز إفشاؤه إلى عوام الخلق فلهذا لم يفشه رسول الله ﷺ ولكن حق النبي أن يفشيه إلى سوسه الذي هو وصية وخليفته من بعده وقد أفشاه إلى علي دون غيره قلنا وعلي هل أفشاه إلى غير سوسه وخليفته أم لا فإن لم يفشه إلا إلى سوسه وكذا سوس سوسه وخليفة خليفته إلى الآن فكيف انتهى إلى هؤلاء الجهال من العوام حتى تناطقوا به وشحنت التصانيف بحكايته وتداولته الألسنة فلا بد أن يقال إن واحدا من الخلفاء عصى وأفشى السر إلى غير أهله فانتشر وعندهم أنهم معصومون لا يتصور عليهم العصيان فإن قيل السوس لا يذكره إلا مع من تعاهده عليه قلنا وما الذي منع الرسول من أن يعاهد ويذكره إن كان يجوز إفشاؤه مع العهد فإن قيل لعله عاهد وذكر ولكن لم ينقل لأجل العهد الذي أخذ ممن أفشى إليه قلنا ولم انتشر ذلك فيكم وأئمتكم لا يظهرون ذلك إلا مع من أخذ العهد عليه وما الذي عصم عهد أولئك دون عهد هؤلاء ثم يقال إذا جاز إفشاء هذا السر بالعهد فالعهد يتصور نقضه فهل يتصور أن يفشيه إلى من يعلم الإمام المعصوم أنه لا ينقضه أو يكفى أن يظنه بفراسته واجتهاده واستدلاله بالأمارات فإن قلتم لا يجوز إلا إلى من علم الإمام المعصوم أنه لا ينقضه بتعريف من جهة الله فكيف انتشرت هذه الأسرار إلى كافة الخلق ولم تنتشر إلا ممن سمع فإما ان يكون المبلغ ناقصا للعهد أو لم يعاهدأصلاوفي أحدهما نسبة المعصوم إلى الجهل وفي الاخر نسبته إلى المعصية ولا سبيل إلى واحد منهما عندهم وان زعمتم أنه يحل الإفشاء بالعهد عند شهادة الفراسة في المأخوذ عليه عهده انه لا ينقصه استدلالا بالأمارات ففي هذا نقض اصل مذهبهم لانهم زعموا انه لا يجوز اتباع أدلة العقل ونظره لان العقلاء مختلفون في النظر ففيه خطر الخظأ فكيف حكموا بالفراسة والامارة التي الخطأ أغلب عليها من الصواب وفي ذلك إفشاء سر الدين وهو أعظم الأشياء خطرا وقد منعوا التمسك بالظن والاجتهاد في الفقهيات التي هي حكم بين الخلق على سبيل التوسط في الخصومات ثم ردوا افشاء سر الدين إلى الخيالات والفراسات وهذا مسلك متين يتفطن له الذكي ويتبجح به المشتغل بعلوم الشرع إذ يتيقن قطعا ان القائل قائلان قائل يقول لا باطن لهذه الظواهر ولا تأويل لها فالتأويل باطل قطعا وقائل ينقدح له ان ذلك يمكن ان يكون كنايات عن بواطن لم يأذن الله لرسول الله ﷺ بان يصرح بالبواطن بل ألزمه النطق بالظواهر فصار النطق بالباطن حراما باطلا وفجورا محظورا ومراغمة لواضع الشرع وهذه التأسيسة بالاتفاق فليس أهل عصرنا مع بعد العهد بصاحب الشرع وانتشار الفساد واستيلاء الشهوات على الخلق وإعراض الكافة عن أمور الدين أطوع للحق ولا اقبل للسر ولا آمن عليه ولا أحرى بفهمه والانتفاع به من أهل عصر رسول الله ﷺ وهذه الأسرار والتأويلات ان كان لها حقيقة فقد أقفل أسماعهم عنها وألجم أفواه الناطقين عن اللهج بها ولنا في رسول الله أسوة حسنة في قوله وفعله فلا نقول إلا ما قال ولا نظهر إلا ما يظهر ونسكت عما سكت عنه وفي الافعال نحافظ على العبادات بل على التهجد والنوافل وأنواع المجاهدات ونعلم أن ما لم يستغن عنه صاحب الشرع فنحن لا نستغني عنه ولا ننخدع بقول الحمقى إن نفوسنا إذا صفت بعلم الباطن استغنينا عن الاعمال الظاهرة بل نستهزئ بهذا القائل المغرور ونقول له يا مسكين أتعتقد ان نفسك اصغي وأزكي من نفس رسول الله ﷺ وقد كان يقوم ليلا يصلى حتى تنتفخ قدماه أو يعتقد انه كان يتنمس به على عائشة ليخيل إليها أن الدين حق وقد كان عالما ببطلانه فان اعتقدت الأول فما احمقك ولا نزيدك عليه وان اعتقدت الثاني فما أكفرك واجحدك ولسنا نناظرك عليه لكنا نقول إذا أخذنا بأسوأ الأحوال وقصرت أدلة عقولنا مثلا عن درك ضلالك وجهلك وعن الاحاطة بصدق رسول الله ﷺ فإنا نرى بدائه عقولنا تقضي بأن الخسران في زمرة محمد ﷺ وموافقته والقناعة بما رضي هو لنفسه اولى من الفوز معك أيها المخذول الجاهل بل المعتوه المخبل فلينظر الآن المنصف في آخر هذا وأوله فآخره يقنع العوام بل العجائز وأوله يفيد البرهان الحقيقي لكل محقق آنس بعلوم الشرع وناهيك بكلام ينتفع به كافة الخلق على اختلاف طبقاتهم في العلم والجهل.
الفصل الثاني في استدلالهم بالأعداد والحروف
هذا فن من الجهالة اختصت به هذه الفرقة من بين الفرق فإن طوائف الضلال مع انشعاب كلامهم وانتشار طرقهم في نظم الشبهات لم تتطلخ طائفة منهم بهذا الجنس واستركوها وعلم عوامهم وجهالهم بالضرورة بطلانها فاجتووها وتشبث بها هؤلاء ولا غرو فالغريق بكل شئ يتمسك والغبي بكل ايهام يتزلزل ويتشكك ونحن نذكر شيئا يسيرا منه ليشكر الناظر فيه ربه على سلامة العقل واعتدال المزاج وصحة الفطرة فإن الانخداع بمثل ذلك لا ينبعث إلا من العته والخبل في العقل.
فقد قالوا ان الثقب على رأس الآدمي سبعة والسموات سبعة والارضون سبع والنجوم سبعة أعني السيارة وأيام الاسبوع سبعة فهذا يدل على أن دور الأئمة يتم بسبعة وزعموا ان الطبائع أربع وان فصول السنة أربعة فهذا يدل على الاصول الأربعة وهي السابق والتالي الإلآهان والناطق والأساس الإمامان. وزعموا ان البروج اثنا عشر فتدل على الحجج الاثنى عشر كما نقلناه في مذهبهم وربما استثاروا من شكل الحيوانات دلالات فقالوا الآدمي على شكل حروف محمد فان رأسه مثل ميم ويداه مبسوطتان كالحاء وعجزه ك الميم ورجلاه ك الدال وبهذا الجنس يتكلمون على شكل الطيور والبهائم وربما تأولوا من الحروف واعدادها فقالوا قد قال النبي ﷺ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها قيل وما حقها قال معرفة حدودها. وزعموا أن حدودها معرفة أسرار حروفها وهي ان لا إله إلا الله أربع كلمات وسبعة فصول وهي قطع لا إله إلا الله وثلاثة جواهر فإن لا حرف يبقى إله وإلا الله فهي ثلاثة جواهر والجملة اثنا عشر حرفا وزعموا ان الكلمات الأربع دالة على المدبرين العلوين السابق والتالي والمدبرين السفليين الناطق والاساس هذه دلالته على الروحانيات فأما على الجسمانيات فانها الطبائع الأربع واما الجواهر الثلاثة فدالة على جبريل وميكائيل وإسرافيل من الروحانيات ومن الجسمانيات على الطول والعرض والعمق إذ بها ترى الاجسام والفصول السبعة تدل من الروحانيات على الانبياء السبعة ومن الجسمانيات على الكواكب السبعة لأنه لو الأنبياء السبعة لما اختلفت الشرائع كما أنه لولا الكواكب السبعة لما اختلفت الأزمنة والحروف الاثنا عشر تدل على الحجج الاثني عشر ( وفي الجسمانيات على البروج الاثني عشر ) وهكذا تصرفوا في قول محمد رسول الله وفي الحروف وفي اوائل السور وأبرزوا ضروبا من الحماقات تضحك المجانين فضلا عن العقلاء وناهيك خزيا بطائفة هذا منهج استدلالهم.
ولسنا نكثر حكاية هذا الجنس عنهم اكتفاء بهذا القدر في تعريف مخازيهم، وهذا فن يعرف بضرورة العقل بطلانه فلا يحتاج إلى إبطاله إلا انا نعلمك في إفحام الغبي والمعاند منهم مسلكين مطالبة ومعارضة
أما المطالبة
فهو أن يقال ومن أين عرفتم هذه الدلالات ولو حكم الإنسان بها لحكم على نفسه بانه من سوء مزاجه أثار عليه الاخلاط فأورث اضغاث الأحلام وقد اضلكم الله إلى هذا الحد حتى لم يستحيوا منها أعرفتم صحتها بضرورة العقل أو نظر أو سماع من إمامكم المعصوم فإن ادعيتم الضرورة باهتم عقولكم واخترعتم ثم لم تسلموا من معارض يدعى انه عرف بالضرورة بطلانه ثم يكون مقامه من تعارض الحق بالفاسد مقام من يعارض الفاسد بالفاسد وان عرفتم بنظر العقل فنظر العقل عندكم باطل لاختلاف العقلاء في نظرهم وإن صدقتم به فأفيدونا وجه النظر وسياقه وما به الاستدلال على هذه الحماقات وان عرفتم ذلك من قول الإمام المعصوم فبينوا ان الناقل عنه معصوم أو بلغ الناقلون عنه حد التواتر ثم صححوا ان الإمام المعصوم لا يخطئ ثم بينوا انه يستحيل ان يفهم ما يعرف بطلانه فلعله خدعكم بهذه الحماقات وهويعلم بطلانها كما زعمتم أن النبي ﷺ خدع الخلق بصفة الجنة والنار وبما يحكي عن الأنبياء من إحياء الموتى وقلب العصا ثعبانا وقد كذب في جميعها وذكرها مع علمه بأنها لم يكن منها شئ وان الناس يفهمون منها على القطع ظواهرها وانه كان يقصد تفهيم الظواهر ويعلم انهم يفهمون ما يفهمهم من الظواهر وهو خلاف الحق ولكن رأى فيه مصلحة فلعل إمامكم المعصوم رأى من المصلحة ان يستهزئ بعقولكم ويضحك من أذقانكم فألقى اليكم هذه الترهات إظهارا لغاية الاستيلاء عليكم والاستعباد لكم وافتخارا بغاية الدهاء والكياسة في التلبيس عليكم فليت شعري بماذا أمنتم الكذب عليه لمصلحة رآها وقد صرحتم بذلك عن النبي ﷺ وهل بينهما فرق إلا أن النبي ﷺ مؤيد بالمعجزة الدالة على صدقه والذي إليه استرواحكم لا معجزة له سوى حماقتكم هذا سبيل المطالبة.
وأما المعارضة
فلسنا نقصد لتعيين الصور ولكن نعلمك طريقا يعم كل ما في العالم من الاشكال والحروف فان كل موجود فهو من الواحد إلى العشرة فما فوقها لا محالة فمهما رأيت شيئا واحدا فاستدل به على محمد ﷺ وإذا رأيت اثنين فقل هو دلالة على الشيخين أبي بكر وعمر وان كان ثلاثة فمحمد ﷺ وابوبكر وعمر إن كان أربعة فالخلفاء الأربعة وان كان خمسة فعلى محمد مع الخلفاء والأربعة وقل اما تعرفون السر ان الثقب على رأس الآدمي خمس ما هو الواحد وهو الفم يدل على النبي محمد ﷺ فانه واحد والعينان والمنخران على الخلفاء الأربعة ونقول اما تعرفون السر في اسم محمد وانه أربعة حروف ما هو فإذا قالوا لا فنقول هو السر الذي لا يطلع عليه إلا ملك مقرب فانه يبنيه على أن اسم خليفته أربعة حروف وهو عتيق دون علي الذي اسمه ثلاثة احرف فإذا وجدت سبعة فاستدل به على سبعة من خلفاء بني أمية مبالغة في إرغامهم وإجلالا لبني العباس عن المعارضة بهم وقل عدد السموات السبع والنجوم والاسبوع دال على معاوية ويزيد ثم مروان ثم عبد الملك ثم الوليد ثم عمر بن عبد العزيز ثم هشام ثم السابع المنتظر وهو الذي يقال له السفياني وهو قول الأموية من الإمامية أو قابلهم بمذهب الراوندية وقل إنه يدل على العباس ثم عبد الله ابن العباس ( ثم علي بن عبد الله ) ثم محمد بن علي ثم إبراهيم ثم أبو العباس السفاح ثم المنصور وكذلك ما تجده من عشرة أو اثنى عشر فعد من خلفاء بني العباس بعددهم ثم انظر هل تجد بين الكلامين فصلا وبه يتبين فساد كلامهم وافتضاحهم وإلزامهم باستدلالهم وهذا الجنس من الكلام لا يليق بالمحصل فيه الإكثار منه فلنعدل عنه إلى غيره.
الباب السادس في الكشف عن تلبيساتهم التي زوقوها بزعمهم في معرض البرهان على إبطال النظر العقلي وإثبات وجوب التعلم من الإمام المعصوم
وطريقنا ان نرتب شبههم على أقصى الإمكان ثم نكشف عن مكمن التلبيس فيها وآخر دعواهم ان العارف بحقائق الأشياء هو المتصدي للإمامة بمصر وانه يجب على كافة الخلق طاعته والتعلم منه لينالوا به سعادة الدنيا والآخرة ودليلهم عليه قولهم ان كل ما يتصور الخبر عنه بنفي وإثبات ففيه حق وباطل والحق واحد والباطل ما يقابله إذ ليس الكل حقا ولا الكل باطلا فهذه مقدمة. ثم تمييز الحق عن الباطل لا بد منه فهو أمر واجب لا يستغنى عنه أحد في صلاح دينه ودنياه فهذه مقدمة ثانية ثم درك الحق لا يخلو اما ان يعرفه الإنسان بنفسه من عقله بنظره دون تعلم أو يعرفه من غيره بتعلم فهذه مقدمة ثالثة وإذا بطلت معرفته بطريق الاستقلال بالنظر وتحكيم العقول فيه وجب التعلم من الغير ضرورة. ثم المعلم إما أن يشترط كونه معصوما من الخطأ والزلل مخصوصا بهذه الخاصية واما ان يجوز التعلم من كل أحد وإذا بطل التعلم من كل أحد أي واحد كان لكثرة القائلين المعلمين وتعارض اقوالهم ثبت وجوب التعلم من شخص مخصوص بالعصمة من سائر الناس فهذه مقدمة رابعة ثم العالم لا يخلو إما أن يجوز خلوه من ذلك المعصوم أو يستحيل خلوه وباطل تجويز خلوه لانه إذ اثبت انه مدرك الحق ففي اخلاء العالم عنه تغطية الحق وحسم السبيل عن إدراكه وفيه فساد أمور الخلق في الدين والدنيا وهو عين الظلم المناقض للحكمة فلا يجوز ذلك من الله سبحانه وهو الحكيم المقدس عن الظلم والقبائح فهذه مقدمة خامسة ثم ذلك المعصوم الذي لا بد من وجوده في العالم لا يخلو اما ان يحل له ان يخفي نفسه فلا يظهر ولا يدعو الخلق إلى الحق أو يجب عليه التصريح وباطل ان يحل له الإخفاء فإنه كتمان للحق وهو ظلم يناقض العصمة فهذه مقدمة سادسة وقد ثبت أن في العالم معصوما مصرحا بهذه الدعوى وبقي النظر في تعيينه فان كان في العالم مدعيان التبس علينا تمييز المحق عن المبطل وان لم يكن إلا مدع واحد في محل الالتباس كان ذلك هو المعصوم قطعيا ولم يفتقر إلى دليل ومعجزة ويكون مثاله ما إذا علم أن في بيت في الدار رجلا هو عالم ثم رأينا في بيت رجلا فإن كان في الدار بيت اخر بقي لنا شك في الذي رأيناه انه ذلك العالم أو غيره فإذاعرفنا أنه لا بيت في الدار سوى هذا البيت علمنا ضرورة انه العالم فكذلك القول في الإمام المعصوم فهذه مقدمة سابعة وقد علم قطعا انه لا أحد في عالم الله يدعي انه الإمام الحق والعارف بأسرار الله في جميع المشكلات النائب عن رسول الله في جميع المعقولات والمشروعات العالم بالتنزيل والتأويل علما قطعيا لا ظنيا إلا المتصدي للأمر بمصر فهذه مقدمة ثامنة.
فإذا هو الإمام المعصوم الذي يجب على كافة الخلق تعلم حقائق الحق وتعرف معاني الشرع منه وهي النتيجة التي كنا نطلبها.
وعند هذا يقولون إن من لطف الله وصنعه مع الخلق ألا يترك أحدا في الخلق يدعي العصمة سوى الإمام الحق إذ لو ظهر مدع آخر لعسر تمييز المحق عن المبطل وضل الخلق فيه فمن هذا لا نرى قط لإمام خصما بل نرى له منكرا كما أن النبي ﷺ لم يكن له خصم قط والخصم هو الذي يقول لست أنت نبيا وإنما أنا النبي والمنكر هو الذي لا يدعي لنفسه وانما ينكر نبوته فهكذا يكون أمر الإمام قالوا واما بنو العباس وان لم ينفك الزمان عن معارضتهم فلم يكن فيهم من يدعي لنفسه العصمة والاطلاع من جهة الله تعالى على حقائق الأمور وأسرار الشرع والاستغناء عن النظر والاجتهاد بالظن فهذه الخاصية هي المطلوبة وقد تفرد بهذه الدعوى عترة رسول الله ﷺ وذريته وصرف الله دواعي الخلق عن معارضتهم في الدعوى لمثلها ليستقر الحق في نصابه وينجلي الشك عن قلوب المؤمنين رحمة من الله ولطفا حتى ان فرض شخص يدعى لنفسه ذلك فلا يذكره إلا في معرض هزل أو مجادلة فأما أن يستمر عليه معتقدا أو يعمل بموجبه فلا.
وهذه مقدمات واضحة لم نهمل من جملتها إلا الدليل على إبطال نظر العقل حيث قلنا الحق اما ان يعرفه الإنسان بنفسه من عقله أو يتعلمه من غيره.
ونحن الآن ندل على بطلان نظر العقل بأدلة عقلية وشرعية وهي خمسة.
أما الأول وهي دلالة عقلية ان من يتبع موجب العقل ويصدقه ففي تصديقه تكذيبه وهو غافل عنه لانه ما من مسئلة نظرية يعتقدها بنظره العقلي إلا وله فيها خصم اعتقد بنظر العقل نقيضها فإن كان العقل حاكما صادقا فقد صدق عقل خصمك أيضا فإن قلت لم يصدق خصمي فقد تناقض كلامك إذا صدقت عقلا وكذبت مثله فان قلت صدق خصمي فخصمك يقول انت كاذب مبطل وان زعمت انه لا عقل لخصمي وانما العقل لي فهذه أيضا دعوى خصمك فبماذا تتميز عنه أبطول اللحية ام ببياض الوجه ام بكثرة السعل أو الحدة في الدعاء وعند هذا يطلقون لسان الاستهزاء والإستخفاف معتقدين ان لهم بكلامهم اليد البيضاء التي لا جواب عنها.
الدلالة الثانية قولهم إذا حاكم مسترشد تشكك في مسئلة شرعية أو عقلية وزعم انه عاجز عن معرفة دليلها فماذا تتقولون له أفتحيلونه على عقله ولعله العامي الجلف الذي لا يعرف أدلة العقول أو هو الذكي الذي ضرب سهام الرأي على حسب امكانه فلم تنكشف له المسئلة وبقي متشككا افتردونه إلى عقله الذي هو معترف بقصوره وهذا محال أو تقولون له تعلم طريق النظر ودليل المسئلة مني فان قلتم ذلك فقد ناقضتم قولكم بإبطال التعليم إذ امرتم بالتعليم وجعلتم التعليم طريقا وهو مذهبنا إلا انكم أبيتم لانفسكم منصب التعليم ولم يستحيوا من خصمكم المعارض لكم المماثل في عقله لعقلكم إن هذا المتعلم يقول قد دعاني إلى التعلم منه خصمك وقد تحيرت في تعيين المعلم أيضا وليس يدعى واحدا منكم العصمة لنفسه ولا له معجزة تميزه ولا هو منفرد بأمر يفارق به غيره فلا أدرى أتبع الفلسفي أو الأشعري أو المعتزلى وأقاويلهم متعارضة وعقولهم متماثلة ولست أجد في نفسي الترجيح بطول اللحية وببياض الوجوه ولا أرى افتراقا إلا فيه إن اتفق فأما العقل والدعوى واغترار كل بنفسه في أنه المحق وصاحبه المبطل كاغترار صاحبه فما أشد تناقض هذا الكلام عند من يعرفه.
الدلالة الثالثة قولهم الوحدة دليل الحق والكثرة دليل الباطل فإنا إذا قلنا كم الخمسة مع الخمسة فالحق واحد وهو أن يقال عشرة والباطل كثير لا حصر له وهو كل ما سوى العشرة مما فوقها أو تحتها والوحدة لازمة مذهب التعليم فانه اجتمع الف الف على هذا الاعتقاد واتحدت كلمتهم ولم يتصور بينهم اختلاف وأهل الرأي لا يزال الاختلاف والكثرة تلازمهم فدل ان الحق في الفرقة التي تلازم الوحدة كلمتها وعليه دل قوله تعالى: {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا}.
الدلالة الرابعة قولهم الناظر ان كان لا يدرك المماثلة بين نفسه وبين خصمه فيسحن الظن بنفسه ويسئ بخصمه فلا غرو فإن هذا الغرور مما يستولي على الخلق وهو شغفهم بآرائهم وجودة عقولهم وان كان ذلك من من أدلة الحماقة وانما العجب أنه لا يدرك المماثلة بين حالتيه وكم رأى نفسه في حالة واحدة وقد تحولت حالته فاعتقد الشئ مدة وحكم بانه الحق الذي يوجبه العقل الصادق ثم يخطر له خاطر فيعتقد نقيضه ويزعم انه الآن تنبه للحق وما كان يعتقد من قبل فخيال انخدع به ويرى نفسه على اعتقاد قاطع في الحالة الثانية تساوي اعتقاده السابق فانه كان قاطعا بمثل قطعه الآن فليت شعري من أين يأمن الانخداع وانه سيتنبه لأمر يتبين به ان ما يعتقده الآن باطل وما من ناظر إلا ويعتقد مثله مرارا ثم لا يزال يعتز آخرا بمعتقده الذي يماثل سائر معتقداته التي تركها وعرف بطلانها بعد التصميم عليها والقطع بها.
الدلالة الخامسة وهي شرعية قولهم قال رسول الله ﷺ ستفترق امتي نيفا وسبعين فرقة الناجية منها واحدة فقيل ومن هم فقال أهل السنة والجماعة فقيل وما السنة والجماعة قال ما أنا الآن عليه وأصحابي قالوا وما كانوا إلا على الاتباع والتعليم في كل ما شجر بينهم وتحكيم الرسول ﷺ فيه لا على اتباع رأيهم وعقولهم فدل ان الحق في الاتباع لا في نظر العقول.
وهذا تحرير أدلتهم على أقوى وجه في الايراد وربما يعجز معظمهم عن الإتقان في تحقيقه إلى هذا الحد.
فنقول وبالله التوفيق الكلام عليه منهجان جملي وتفصلي.
المنهج الأول وهو الجملي
انا نقول هذه العقيدة التي استنتجتموها من ترتيب هذه المقدمات ونظمها بطريق النظر والتأمل فإن ادعيتم معرفتها ضرورة كنتم معاندين ولم يعجز خصومكم عن دعوى الضرورة في معرفتهم بطلان مذهبكم وان ادعوا ذلك كانوا اقوم قيلا عند المنصف وان ادعيتم إدراكها بالنظر في ترتيب هذه المقدمات ونظمها على شكل المقاييس المنتجة فقد اعترفتم بصحة النظر العقلي ويدعى بطلانه فهذا الكلام مفحم له وكاشف عن خزايته أو يقال له عرفت بطلان النظر ضرورة أو نظرا ولا سبيل إلى دعوى الضرورة فان الضروري ما يشترك في معرفته ذوو العقول السليمة كقولنا الكل اعظم من الجزء والاثنان اكبر من الواحد والشئ الواحد لا يكون قديما محدثا والشئ الواحد لا يكون في مكانين وان زعم انه أدرك بطلان النظر بالنظر فقد تناقض كلامه وهذا لا مخرج منه أبد الدهر وهو وارد على كل باطني يدعى معرفة شئ يختص به. فانه اما ان يدعي الضرورة أو النظر أو السماع من معصوم صادق يدعى معرفة صدقه وعصمته أيضا اما ضرورة أو نظرا. ولا سبيل إلى دعوى الضرورة وفي دعوى النظر إبطال عين المذهب فلتتعجب من هذا التناقض البين وغفلة هؤلاء المغرورين عنه.
فإن قال قائل من منكري النظر هذا ينقلب عليكم إذ يقال لكم وبم عرفتم صحة النظر إن ادعيتم الضرورة اقتحمتم مااستبعدتموه وتورطتم في عين ما أنكرتموه وان زعمتم أنا ادركناه نظرا فالنظر الذي به الادراك بم عرفتم صحته والخلاف قائم فيه فان ادعيتم معرفة ذلك بنظر ثالث لزم ذلك في الرابع والخامس إلى غير نهاية قلنا نعم كان هذا الكلام ينقلب إن كانت المعقولات بالموازنات اللفظية وليس الأمر كذلك فلتتأمل دقيقة الفرق فإنا نقول عرفنا كون النظر العقلي دليلا إلى العلم بالمنظور فيه بسلوك طريق النظر والوصول إليه فمن سلكه وصل ومن وصل عرف أن ما سلكه هو الطريق ومن استراب قبل السلوك فيقال طريق رفع هذه الاسترابة السلوك.
ومثاله ما إذا سئلنا عن طريق الكعبة فدللنا على طريق معين فقيل لنا من أين عرفتم كونه طريقا قلنا عرفناه بالسلوك بأنا سلكناه فوصلنا إلى الكعبة فعرفنا كونه طريقا ومثاله الثاني أنا إذا قيل لنا بم عرفتم ان النظر في الأمور الحسابيه من الهندسة والمساحة وغيرها طريق إلى معرفة ما لا يعرف اضطرارا قلنا سلوك طريق الحساب إذ سلكناه فأفادنا علما بالمنظور فيه فعلمنا ان نظر العقل دليل في الحساب وكذلك في العقليات سلكنا الطريق النظرية فوصلنا إلى العلم بالمعقولات فعرفنا أن النظر طريق. فهذا لا تناقض فيه فان قيل وبم عرفتم ان ما وصلتم إليه علم متعلق بالمعلوم على ما هو به بل هو جهل ظننتموه علما قلنا ولو أنكر العلوم الحسابية منكر فماذا يقال له أو ليس يسفه في عقله ويقال له هذا يدل على قلة بصيرتك بالحسابيات فإن الناظر في الهندسة إذا حصر المقدمات ورتبها على الشكل الواجب يحصل العلم بالنتيجة ضرورة على وجه لا يتمارى فيه فهكذا جوابنا في المعقولات فان المقدمات النظرية إذا رتبت على شروطها افادت العلم بالنتيجة على وجه الارض لا يتمارى فيه ويكون العلم المستفاد من المقدمات بعد حصولها ضروريا كالعلم بالمقدمات الضرورية المنتجه له وإن اردنا أن نكشف ذلك لمن قلت بضاعته في العلوم فنضرب له مثالا هندسيا ثم نضرب له مثالا عقليا لينكشف له الغطاء وينجلي عن عقيدته الخفاء. اما المثال الهندسي فهو ان إقليدس رسم في مصنفه في الشكل الأول من المقالة الأولى مثلثا وادعى انه متساوي الاضلاع ولا يعرف ذلك ببديهة العقل ولكنه ادعى انه يعرف بالبرهان نظرا وبرهانه بمقدمات (الأولى) ان الخطوط المستقيمة الخارجة من مركز الدائرة إلى المحيط متساوية من كل جانب وهذه المقدمة ضرورية إذ الدائرة ترسم بالبركار على فتح واحد وانما الخط المستقيم من المركز إلى الدائرة هوفتح البركار وهو واحد في الجوانب. (المقدمة الثانية) إذا تساوت دائرتان بالخطوط المستقيمة من مركزهما إلى محيطهما فالخطوط أيضا متساوية وهذه أيضا ضرورية. (المقدمة الثالثة) أن المساوي للمساوي مساو وهذه أيضا ضرورية ثم الآن نشتغل بالمثلث ونشير إلى خطين منه ونقول إنهما متساويان لانهما خطان مستقيمان خرجا من مركز دائرة إلى محيطها والخط الثالث مثل لاحدهما لانه خرج أيضا من مركز الدائرة إلى محيطها مع ذلك الخط وإذا ساوى أحد الخطين فقد ساوى الآخر فإن المساوي للمساوي مساو فبعد هذا النظر نعلم قطعا تساوي أضلاع المثلث المفروض كما عرف سائر المقدمات مثل قولنا الخطوط المستقيمة من مركز الدائرة إلى المحيط متماثلة وغيرها من المقدمات.
المثال العقلي الإلهي
وهو أنا إذا أردنا أن ندل على واجب الوجود القائم بنفسه المستغني عن غيره الذي منه يستفيد كل موجود وجوده لم ندرك ثبوت موجود واجب الوجود مستغنيا عن غيره بالضرورة بل بالنظر ومعنى النظر هو أنا نقول لا شك في أصل الوجود وانه ثابت فإن من قال لاموجود اصلا في العالم فقد باهت الضرورة والحس فقولنا لا شك في اصل الوجود مقدمة ضرورية ثم نقول والوجود المعترف به من الكل إما واجب وإما جائز فهذه المقدمة أيضا ضرورية فإنها حاصرة بين النفي والإثبات مثل قولنا الموجود إما ان يكون قديما أو حادثا فيكون صدقه ضروريا وهكذا كل تقسيم دائر بين النفي والإثبات ومعناه ان الموجودات إما ان تكون استغنت أو لم تستغن والاستغناء عن السبب هو المراد بالوجوب وعدم الاستغناء هو المراد بالجواز فهذه مقدمة ثالثة ثم نقول ان كان هذا الموجود المعترف به واجبا فقد ثبت واجب الوجود وان كان جائزا فكل جائز مفتقر إلى واجب الوجود ومعنى جوازه أنه أمكن عدمه ووجوده على حد واحد وما هذا وصفه لا يتميز وجوده عن عدمه إلا بمخصص وهذا أيضا ضروري فقد ثبت بهذه المقدمات الضرورية واجب الوجود وصار العلم بعد حصوله ضروريا لا يتمارى فيه فان قيل فيه موضع شك إذ يقول المعترف به جائز ويقول قولكم إنه يفتقر إلى واجب كل جائز وجوده غير مسلم بل يفتقر إلى سبب ثم ذلك السبب يجوز أن يكون جائز الوجود قلنا في تلك المقدمات ما اشتمل على رفع هذا بالقوة فان كل ما ثبت له الجواز فافتقاره إلى سبب ضروري فإن قدر السبب جائزا دخل في الجملة التي سميناها كلا ونحن نعلم بالضرورة ان كل الجائزات تفتقر إلى سبب فإن فرضت السبب جائزا فافرضه داخلا في الجملة واطلب سببه إذ يستحيل ان يسند ذلك جائزا آخر وهكذا إلى غير نهاية فانه يكون عند ذلك حميع الأسباب والمسببات جملة جائزة ووصف الجواز يصدق على آحادها وعلى مجموعها فيفتقر المجموع إلى سبب خارج عن وصف الجواز المخرج وفيه ضرورة إثبات واجب الوجود ثم بعد ذلك نتكلم في صفته ونبين أنه لا يجوز ان يكون واجب الوجود جسما ولا منطبعا في جسم ولا متغيرا ولا متحيزا إلى سائر ما يتبع ذلك ويثبت كل واحد منها بمقدمات لا شك فيها وتكون النتيجة بعد حصولها من المقدمات في الظهور على ذوق المقدمات.
فإن قيل العلوم الحسابية معترف بها لانها ضرورية ولذلك لم يختلف فيها واما النظريات العقلية فان كانت مقدماتها كذلك فلم وقع الاختلاف فيها فوقوع الاختلاف فيها يقطع الامان قلنا هذا باطل من وجهين (أحدهما) أن العلوم الحسابية اختلف فيها تفصيلا وجملة من وجهين أحدهما ان الأوائل قد اختلفوا في كثير من هيئات الفلك ومعرفة مقاديرها وهي مثبتة على مقدمات حسابية ولكن متى كثرت المقدمات وتسلسلت ضعف الذهن عن حفظها فربما تزل واحدة عن الذهن فيغلظ في النتيجة وامكان ذلك لا يشككنا في الطريق نعم الخلاف فيها اندر لانها اظهر وفي العقليات أكثر لانها اخفى واستر ومن النظريات ما ظهر فاتفقوا عليه وهو أن القديم لا يعدم فهذه مسألة نظرية ولم يخالف فيها أحد البته فلا فرق بين الحسابية والعقلية. الثاني ان من حصر مدارك العلوم في الحواس وانكر العلوم النظرية جملة الحسابية وغير الحسابية فخلاف هؤلاء هل يشككنا في علمنا بأن العلوم الحسابية صادقة حقيقة فإن قلتم نعم اتضح ميلكم على الانصاف وان قلتم لا فلم وقع الخلاف فيه فان قلتم خلافه لم يشككنا في المقدمات فلم يشككنا في النتيجة فكذلك خلاف من خالفنا في تفصيل ماعرفناه من الدلالة على ثبوت واجب الوجود لم يشككنا في مقدمات الدليل فلم يشككنا في النتيجة.
والوجه الآخر من الجواب هو أن السوفسطائية أنكروا الضروريات وخالفوا فيها وزعموا انها خيالات لا أصل لها واستدلوا عليه بان أظهرها المحسوسات ولا ثقة بقطع الإنسان بحسه ومهما شاهد انسانا وكلمه فقوله اقطع بحضوره وكلامه فهو خطأ فلعله يراه في المنام فكم من منام يراه الإنسان ويقطع به ولا يتمارى مع نفسه في تحققه ثم ينتبه على الفور فيبين انه لا وجود له حتى يرى في المنام يد نفسه مقطوعة ورأسه مفصولا ويقطع به ولا وجود لما يقطع به ثم خلاف هؤلاء لا يشككنا في الضروريات وكذلك النظريات فانها بعد حصولها من المقدمات تبقى ضرورية لايتمارى فيها كما في الحسابيات.
وهذا كله كلام على من ينكر النظر جملة اما التعليمية فلا يقدرون على إطلاق القول بإبطال النظر جملة فانهم يسوقون الادلة والبراهين على إثبات التعليم ويرتبون المقدمات كما حكيناه فكيف ينكرون ذلك فمن هنا قالوا نظر العقل باطل فيقال وبم عرفتم بطلانه وثبوت التعليم أبنظر أم ضرورة ولا بد أن يقال بنظر ومهما استدل بالخلاف في النظريات على فساد النظريات فقابله بالخلاف من السوفسطائية في الضروريات ولا فرق بين المقامين فإذا قالوا وبم أمنت الخطأ وكم من مرة اعتدت الشئ نظرا ثم بان خلافه فيقال له وبم عرفت حضورك بهذا البلد الذي أنت فيه وكم من كرة اعتقدت نفسك ورأيتها ببلد آخر لم تكن فيه فيم تميز بين النوم واليقظة وبم تأمن على نفسك فلعلك الآن في هذا الكلام نائم فان زعم اني ادرك التفرقة ضرورة فيقال وأنا أدركت التفرقة بين ما يجوز الغلط فيه من المقدمات ومالا يجوز أيضا ضرورة ولا فرق وكذلك كم يغلط الإنسان في الحساب ثم ينتبه وإذا تنبه ادرك التفرقة ضرورة بين حالة الاصابة والخطأ فان قال قائل من الباطنية نحن ننكر النظر جملة وما ذكرتم ليس من النظريات في شئ بل هي مقدمات ضرورية قطعية رتبناها قلنا فأنتم الآن لم تفهموا معنى النظر اذي نقول به فلسنا نقول إلا بمثل ما نظمتموه من المقدمات الضرورية الحقيقية كما سنبينها فكل قياس لم يكن بنظم مقدمات ضرورية أو بنظم مقدمات مستنتجة من ضرورية فلا حجة فيه فهذا هو القياس المعقول وانما ينتظم أبدا من مقدمتين إما مطلقة وإما تقسيمية وقد تسمى حملية وشرطية أما المطلقة فكقولنا العالم حادث وكل حادث فله سبب فهاتان مقدمتان الأولى حسية والثانية ضرورية عقلية ونتجيته ان لحوادث العالم إذا سببا. وأما التقسيمية فهو أنا نقول إذا ثبت ان لحوادث العالم سببافالسبب المفروض اما حادث واما قديم فان بطل كونه حادثا ثبت كونه قديما ثم نبطل كونه حادثا بمثل هذه المقاييس فيثبت بالآخرة ان لوجود العالم سببا قديما فهذا هو النظر المقول به فان كنتم متشككين في صحته فبم تنكرون من يمتنع من قبول مقدماتكم التي نظمتموها ويقول انا متشكك في صحتها فان نسبتموه إلى إنكار الضرورة نسبناكم إلى مثله فيما ادعينا معرفته بالنظر ولا فرق.
هذا هو المنهج الجملي في الرد عليهم إذا أبطلوا نظر العقول وهو الجزم الواجب في إفحامهم فلا ينبغي ان نخوض معهم في التفصيل بل نقتصر على أن نقول لهم كل ما عرفتموه من مذهبكم من صدق الإمام وعصمته وبطلان الرأي ووجوب التعليم بماذا عرفتموه ودعوى الضرورة غير ممكنة فيبقى النظر والسماع وصدق السمع أيضا لا يعرف ضرورة فيبقى النظر وهذا لا مخرج عنه فان قال قائل لا يظن بعاقل يدعي مذهبا ليس ضروريا ثم ينكر النظر فلعلهم يعترفون بالنظر إلا انهم يقولون تعلم طريق النظر واجب فان الإنسان لا يسستقل بنفسه في النظريات. فان أنكرتم ذلك فقد أنكرتم العقول بديهة إذ لم يترشح المدرسون والمعلمون إلا للتعليم فلم تصدوا مع الاستغناء عنهم وان اعترفتم بذلك فقد اعترفتم بوجوب المعلم وان العقول ليس في مجردها غنية فبقي انكم جوزتم التعلم من كل أحد وهم اوجبوا التعلم من معصوم لان مذاهب المعلمين مختلفة ومتعارضة ولا ترجيح للبعض على البعض. قلنا وهذا السؤال أيضا فاسد فانا لا ننكر الحاجة إلى التعلم بل العلوم منقسمة إلى ثلاثة أقسام:
قسم لا يمكن تحصيله إلا بالسماع والتعلم كالإخبار عما مضى من الوقائع ومعجزات الانبياء وما يقع في القيامة وأحوال الجنة والنار فهذا لا يعرف إلا بالسماع من النبي المعصوم أو بالخبر المتواتر عنه فان سمع بقول الآحاد حصل به علم ظني لا يقيني هذا قسم
والقسم الآخر من العلوم النظرية العقلية فليس في الفطرة ما يرشد إلى الأدلة فيه بل لا بد فيه من التعلم لا ليقلد المعلم فيه بل لينبهه المعلم على طريقه ثم يرجع العاقل فيه إلى نفسه فيدركه بنظره وعند هذا فليكن المعلم من كان ولو افسق الخلق واكذبهم فإنا لسنا نقلده بل نتنبه بتنبيهه فلا نحتاج فيه إلى معصوم وهي كالعلوم الحسابية والهندسية لا تعلم بالفطرة وتحتاج إلى المعلم ونستغني عن معلم معصوم بل يتعلم طريق البرهان ويساوي المتعلم المعلم بعد النظر في العقليات عندنا فالحسابيات عندهم وكم من شخص يغلط في الحسابيات ثم يتنبه بالآخرة بعد زمان وذلك لا يشكك في الادلة والبراهين الحسابية ولا يحتمل الافتقار فيها إلى معلم معصوم.
القسم الثالث العلوم الشرعية الفقهية وهو معرفة الحلال والحرام والواجب والندب وأصل هذا العلم السماع من صاحب الشرع والسماع منه يورث العلم إلا ان هذالا يمكن تحصيل العلم القطعي فيه على الإطلاق في حق كل شخص وفي كل واقعة بل لابد من الاكتفاء بالظن فيه ضرورة في طريقين أحدهما في المستمعين فان الخلق في عصر النبي ﷺ انقسموا أى من شاهد فسمع وتحقق وعرف والى من غاب فسمع من المبلغين وآحاد الامراء والولاة فاستفادوا ظنا من قولة الآحاد ولكن وجب عليهم العمل بالظن للضرورة فان النبي ﷺ عجز عن أسماع كل واحد بنفسه من غير واسطة ولم يشترط ان تتواتر عنه كل كلمة في كل واقعة لتعذره والعلم يحصل باحد هذين المسلكين وهو متعذر قطعا. والطرف الثاني في نفس الصورة الفقهية والحوادث الواقعة إذن ما من واقعة إلا وفيها تكليف والوقائع لا حصر لها بل هي في الامكان غير متناهية والنصوص لا تفرض إلا محصورة متناهية ولا يحيط قط ما يتناهى بما لا يتناهى وغاية صاحب الشرع مثلا ان ينص على حكم كل صورة اشتمل عليها تصنيف المصنفين في الفقه إلى عصرنا هذا ولو فعل ذلك واستوفاه كانت الوقائع الممكنة الخارجة عن التصانيف أكثر من المسطورات فيها بل لا نسبة لها اليها فان المسطورات محصورة والممكنات لا حصر لها فكيف يستوفي ما لا يتناهى بالنص فبالضرورة لا بد من تحكيم الظن في التعلق بصيغ العمومات وان كان يحتمل انها اطلقت لإرادة الخصوص إذ عليها أكثر العمومات ولذلك لما بعث رسول الله ﷺ معاذا إلى اليمن وقال له بم تحكم فقال بكتاب الله قال فان لم تجد قال فبسنة رسول الله قال فان لم تجد قال اجتهد رأيي فقال ﷺ الحمد لله الذي وفق رسول رسوله لما يرضاه رسوله فانما رخص له في اجتهاد الرأي لضرورة العجز عن استيعاب النصوص للوقائع.
هذا بيان هذا القسم ولا حاجة فيه إلى إمام معصوم بل لا يغني الإمام المعصوم شيئا فانه لا يزيد على صاحب الشرع وهو لم يغن في كلا الطرفين فلا قدرة على استيعاب الصور بالنصوص ولا قدرة على مشافهة جميع الخلق ولا على تكليفهم اشتراط التواتر في كل ما ينقل عنه عليه السلام فليت شعري معلمهم المعصوم ماذا يغني في هذين الطرفين أيعرف كافة الخلق نصوص أقاويله وهم في أقصى الشرق والغرب بقول آحاد هؤلاء الدعاة ولا عصمة لهم حتى يوثق بهم أو يشترط التواتر عنه في كل كلمة وهو في نفسه محتجب لا يلقاه إلا الاحاد والشواذ هذا لو سلم انه مطلع على الحق بالوحي في كل واقعة كما كان صاحب الشرع فكيف والحال كما نعرفه ويعرفه خواص أشياعه المحدقين به في بلده وولايته.
فقد انكشف بهذا الكلام انهم يلبّسون ويقولون ان قلتم لا حاجة إلى التعليم فقد أنكرتم العادات وان اعترفتم فقد وافقتمونا على إثبات التعليم فيأخذون التعليم لفظا مجملا مسلما ثم يفصلونه بأن فيه اعترافا بوجوب التعلم من المعصوم فقد فهمت أي علم يستغنى فيه عن المعلم واي علم يحتاج فيه إليه وإذا احتيج فما الذي يستفاد من المعلم طريقه ولا يقلد في نفسه فيستغني عن عصمته وما الذي يقلد في نفسه فيحتاج فيه إلى عصمته وان ذلك المعصوم هو النبي ﷺ وان ما يؤخذ منه كيف ينقسم إلى ما يعلم تحقيقا والى ما يظن وان كافة الخلق كيف يضطرون إلى القناعة بالظن في صدق مبلغ الخبر عن صاحب الشرع وفي الحاق غير المنصوص إلى النصوص وإذا ايقنت هذه القاعدة استوليت على كشف تلبيساتهم كلها فان عادتهم ابدا إطلاق مقدمات مهملة بنوا عليها النتيجة الفاسدة كقولهم انكم إذا اعترفتم بالحاجة إلى التعليم فقد اعترفتم بمذهبنا فنقول اعترافنا بالتعلم في النظريات كاعترافكم به في الحسابيات. هذا منهج الكلام الجملي عليهم.
المنهج الثاني في الرد عليهم تفصيلا
وسبيلنا أن نتكلم على كل مقدمة من مقدماتهم الثماني التي نظمناها فنقول.
المقدمة الأولى وهي قولكم إن كل شىء يتكلم فيه بنفي وإثبات ففيه حق وباطل والحق واحد والباطل ما يقابله فهذه مقدمة صادقة لا نعتقد نزاعا فيها ولكن لا يصح منكم استعمالها فانا نقول من الناس من أنكر حقائق الأشياء وزعم انه لا حق ولا باطل وان الأشياء تابعة للإعتقادات فما يعتقد فيه الوجود فهو موجود في حق ذلك المعتقد وما يعتقد فيه العدم فهو معدوم في حق المعتقد وهذه مقالة فرقة من فرق السوفسطائية وربما يقولون الأشياء لا حقيقة لها فنقول هل هذه المقدمة مقدمة يقطعون بها وأنتم ترونها في المنام ولا حقيقة لها فبماذا أمنتم الغلط فيها وكم رأيتم أنفسكم في المنام قاطعين بأمر لا حقيقة له وما الذي آمنكم من اصابة خصومكم وخطئكم ولا نزال نورد عليهم ما يوردونه على أهل النظر للتشكيك فيه فلا يجدون فصلا فان زعموا أنا نعرف ضرورة خطأ من يخالفنا من السوفسطائية ونعلم ضرورة صدق هذه المقدمة قيل لهم فبم تنكرون على أهل النظر إذا ادعو ذلك في مذهبهم وفي تفريقهم بين ما غالطوا فيه وبين مالم يغالطوا فيه وفرقهم بين أنفسهم ومخالفيهم فإن زعموا ان ذلك يفتقر فيه إلى تأمل وما نحن فيه بديهي فنقول والحسابيات يحتاج فيها إلى أدق تأمل فإن غلط في مسئلة عرفتموها من الحساب رجل قصر نظره أو ضعف ذكاؤه فهل يشكككم ذلك في أن العلوم الحسابية صادقة فإن قلتم لا قيل فهكذا حال النظار المحققين إذا خالفهم المخالفون وهذا ينبغي ان يكون عليهم في كل مقام لان تبجحهم الاكثر باختلاف النظار وان ذلك ينبغي ان يسقط الامان وخلافنا لهم لم يسقط امانهم عن مقدماتهم التي نظموها ثم طمعوا مع ذلك ان يسقط اماننا عن النظريات بخلاف المخالف فيها وهذا من الطمع البارد والظن الركيك الذي لا ينخدع بمثله عاقل.
أما المقدمة الثانية وهي قولهم إذا ثبت في كل واقعة حق وباطل فلابد من معرفة الحق فيه فهذه مقدمة كاذبة إذ تسلموها جملة وفيها تفصيل وهذه عادتهم في التلبيس فلا يغفلن عنها المحصل فنقول قول القائل الحق لا بد من معرفته كقول القائل المسئلة لا بد من معرفتها أو المسائل لا بد من معرفتها فيقال هذا خطأ بل المسئلة اسم جنس يتناول ما لا بد من معرفته وما عن معرفته بد فلابد من تفصيل وكذلك الحق بنا غنية عن معرفته في أكثر الأمور فإن جملة التواريخ والأخبار التي كانت وستكون إلى منقرض العالم أو هي كائنة واقعة اليوم في العالم يتكلم فيها بنص وإثبات والحق واحد ولا حاجة بنا إلى معرفته وهذا كقول القائل ملك الروم الآن قائم ام لا والحق أحدهما لا محالة ما تحت قدمي من الارض بعد مجاوزة خمسة اذرع حجر أو تراب وفيه دود ام لا والحق أحدهما لا محالة ومقدار كرة الشمس أو زحل ومسافتهما مائة فرسخ ام لا والحق أحدهما وهكذا مساحات الجبال والبلاد وعدد الحيوانات في البر والبحر وعدد الرمل فهذه كلها فيها حق وباطل ولا حاجة إلى معرفتها بل العلوم المشهورة من النحو والشعر والطب والفلسفة والكلام وغيرها فمنها حق وباطل ولا حاجة بنا إلى أكثر ما قيل فيها بل الذي نسلم انه لا بد من معرفته مسألتان وجود الصانع تعالى وصدق الرسول ﷺ وهذا لا بد منه ثم إذا اثبت صدق الرسول فالباقي يتعلق به تقليدا أو علما بخبر المتواتر أو ظنا بخبر الواحد وذلك من العلوم كاف في الدنيا والآخرة وما عداه مستغنى عنه أما وجود الصانع وصدق الرسول فطريق معرفته النظر في الخلق حتى يستدل به على الخالق وفي المعجزة حتى يستدل بها على صدق الرسول وهذان لا حاجة فيهما إلى معلم معصوم فان الناس فيه قسمان قسم اعتقدوا ذلك تقليدا وسماعا من ابويهم وصمموا عليه العقد قاطعين به وناطقين بقولهم لا اله إلا الله محمد رسول الله ﷺ من غيربحث عن الطرق البرهانية وهؤلاء هم المسلمون حقا وذلك الاعتقاد يكفيهم وليس عليهم طلب طرق البراهين وعرفنا ذلك قطعا من صاحب الشرع فانه كان يقصده اجلاف العرب واغمار أهل السواد والجملة طائفة لو قطعوا ارابا لم يدركوا شيئا من البراهين العقلية بل لا يبين تمييزهم عن البهائم إلا بالنطق وكان يعرض عليهم كلمة الشهادتين ثم يحكم لهم بالايمان ويقنع منهم به وامرهم بالعبادات فعلم قطعا ان الاعتقاد المصمم كاف وان لم يكن عن برهان بل كان عن تقليد وربما كان يتقدم إليه الاعرابي فيحلفه انه رسول الله وانه صادق فيما يقول فيحلف له ويصدقه فيحكم بإسلامه فهؤلاء اعني المقلدين يستغنون عن الإمام المعصوم.
القسم الثاني من اضطرب عليه تقليده إما بتفكر وإما بتشكيك غيره إياه أو بتأمله بأن الخطأ جائز على آرائه فهذا لا ينجيه إلا البرهان القاطع الدال على وجود الصانع وهو النظر في الصنع وعلى صدق الرسول وهو النظر في المعجزة وليت شعري ماذا يغني عنهم إمامهم المعصوم أيقول له اعتقد ان للعالم صانعا وان محمدا ﷺ صادق تقليدا لي من غير دليل فاني الإمام المعصوم أو يذكر له الدليل فينبهه على وجه دلالته فان كان سومه التقليد فمن أي وجه يصدقه بل من اين يعرف عصمته وهو ليس يعرف عصمة صاحبه الذي يزعم انه خليفته بعد درجات كبيرة وان ذكر الدليل افتقر المسترشد إلى ان ينظر في الدليل ويتأمل في ترتيبه ووجه دلالته ام لا فان لم يتأمل فكيف يدرك دون النظر والتأمل وهذه العلوم ليست ضرورية وان تأمل وادرك نتاج المقدمات الضرورية المنتجة المطلوبة بتأمله وخرج به عن حد التقليد هـ فما الفرق بين ان يكون المنبه له على وجه الدلالة ونظم المقدمات هو هذا المشار إليه المعصوم أو داعية أو عالم آخر من علماء الزمان فان كل واحد ليس يدعوه إلى تقليده وانما يقوده إلى مقتضى الدليل ولا يدرك مقتضى الدليل إلا بالتأمل فإذا تأمل وادرك لم يكن مقلدا لمعلمه بل كان كمتعلم للأدلة الحسابية ولا فرق في ذلك بين أفسق الخلق وبين اورعهم كمعلم الحساب فلا يحتاج فيه إلى الورع فضلا عن العصمة لانه ليس مقلدا وانما الدليل هو المتبع فإذا لا يعدو الخلق هذين القسمين فالأول مستغن عن المعصوم والثاني لا يغني عنه المعصوم شيئا فقد بطلت مقدمتان إحداهما أن كل حق فلا بد من معرفته والاخرى انه لا يعرف الحق إلا من معصوم.
فإن قيل لا تكفي معرفة الله ورسوله بل لا بد من معرفة صفات الله ومعرفة الأحكام الشرعية قلنا أما صفات الله تعالى فقسمان قسم لا يمكن معرفة صدق الرسول وبعثته إلا بعد معرفته ككونه عالما وقادرا على الارسال فهذا يعرف عندنا بالأدلة العقلية كما ذكرناه والمعصوم لا يغني لان المعتقد له تقليدا أو سماعا من ابويه مستغن عن المعلم كما سبق والمتردد فيه ماذا يغني عنه المعصوم أفيقول له قلدني في انه تعالى قادر عالم فيقول له كيف أقلدك ولم تسمح نفسي بتقليد محمد بن عبد الله ﷺ وهو صاحب المعجزة وإن ذكر له وجه الدليل اعاد القول فيه إلى ما مضى في اصل وجود الصانع وصدق الرسول من غير فرق. واما الأحكام الشرعية فلا بد لكل واحد من معرفة ما يحتاج إليه في واجباته وهي قسمان.
القسم الأول ما يمكن معرفته قطعا وهو الذي اشتمل عليه نص القرآن وتواتر عنه الخبر من صاحب الشرع كعدد ركعات الصلوات الخمس ومقادير النصب في الزكوات وقوانين العبادات وأركان الحج أو ما اجمعت عليه الأمة فهذا القسم لا حاجة فيه إلى امام معصوم أصلا.
القسم الثاني ما لا يمكن معرفته قطعا بل يتطرق الظن إليه كما كان يجب على الخلق في زمان رسول الله ﷺ في سائر الأقطار. واما صورة لا نص فيها فيحتاج إلى تشبيهها بالنصوص عليه وتقريبها منه بالاجتهاد وهو الذي قال معاذ فيه أجتهد رأيي وكون هذا مظنونا ضروري في الطرفين جميعا إذ لا يمكن شرط التواتر في الكل ولا يمكن استيعاب جميع الصور بالنص فلا يغني المعصوم في هذا شيئا فانه لا يقدر على أن يجعل ما نقله الواحد متواترا بل لو تيقنه لم يقدر على مشافهة كافة الخلق به ولا تكليفهم السماع عنه تواترا فيقلد اشياعه دعاة المعصوم وهم غير معصومين بل يجوز عليهم الخطأ والكذب فنحن نقلد علماء الشرع وهو دعاة محمد ﷺ المؤيد بالمعجزات الباهرة فأي حاجة إلى المعصوم فيه وأما الصورة التي ليست منصوصة فيجتهد فيها الرأي إذ المعصوم لا يغني عنها شيئا فإنه بين ان يعترف بانه أيضا ظان والخطأ جائز في كل ذي ظن ولا يختلف ذلك بالأشخاص فما الذي يميز ظنه من ظن غيره وهو مجوز للخطأعلى نفسه وإن ادعى المعرفة فيه أيدعيها عن وحي أو عن سماع نص فيه أو عن دليل عقلي فإن ادعى تواتر الوحي إليه في كل واقعة فإذا هو مدع للنبوة فيفتقر إلى معجزة كيف ولا يتصور تقدير المعجزة إذ بان لنا أن محمدا ﷺ خاتم الانبياء فإن جوزنا الكذب على محمد في قوله أنا خاتم الانبياءمع إقامة المعجزة فكيف نأمن الكذب هذا المعصوم وإن أقام المعجزة وان ادعى معرفته عن نص بلغه فكيف لا يستحي من دعوى نص صاحب الشرع على وقائع لايتصور حصرها وعدها بل لو عمر الإنسان عمر نوح ولم يشتغل إلا بعد الصور والنصوص عليها لم يستوعب عشر عشرها ففي أي عمر استوعب الرسول ﷺ جميع الصور بالنص فان ادعى المعرفة بدليل عقلي فما اجهله بالفقهيات والعقليات جميعا إذ الشرعيات أمور وضعية اصطلاحية تختلف بأوضاع الانبياء والاعصار والامم كما نرى الشرائع مختلفة فكيف تجوز فيها الادلة العقلية القاطعة وان ادعاها عن دليل عقلي مفيد للنظر فالفقهاء كلهم لهم هذه الرتبة.
فاستبان أن ما ذكروه تلبيس بعيد عن التحقيق وان العامي المنخدع به في غاية الحمق لانهم يلبسون على العوام بان يتبعوا الظن وان الظن لا يغني عن الحق شيئا والفقهيات لا بد فيها من اتباع الظن فهو ضروري كما في التجارات والسياسات وفصل الخصومات للمصالح فان كل الأمور المصلحية تبنى على الظن والمعصوم كيف يغني عن هذا الظن وصاحب الشريعة لم يغن عنه ولم يقدر عليه بل أذن في الاجتهاد وفي الاعتماد على قول آحاد الرواة عنه وفي التمسك بعمومات الألفاظ وكل ذلك ظن عمل به في عصره مع وجوده فكيف يستقبح ذلك بعد وفاته.
فان قيل فإذا اختلف المجتهدون لاختلاف مسالك الظنون فماذا ترون وإن قلتم كل مجتهد مصيب تناقض كلامكم فان خصومكم مهما أصابوا في اعتقادهم يقولون إنكم اخطأتم أفلستم مصيبين إذا فكيف وفي الفرق من يستبيح سفك دمائكم فإن كانوا مصيبين أيضا فنحن في سفك دمائكم ونهب أموالكم مصيبون فلم تنكرون علينا وان قلتم ان المصيب واحد فبم نميز المصيب من المخطئ وكيف نتخلص من خطر الخطأ والظن قلنا فيه رأيان فان قلنا كل مجتهد مصيب لم نتناقض إذ نريد به أنه مصيب حكم الله في حق نفسه ومقلديه إذ حكم الله عليه ان يتبع غالب ظنه في كل واقعة وقد اتبع وهذا حكم الله على خصمه وقولهم انه مصيب إذا في سفك الدم فهو كلام جاهل بالفقهيات فان ما افترق فيه الفرق مما يرى فيه سفك الدماء مسائل قطعية عقلية المصيب فيها واحد والمسائل الظنية الفقهية المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفة ومالك لا تفضي إلى التقاتل وسفك الدماء بل كل فريق يعتقد احترام الفريق الاخر حتى يحكم بانه لا ينقض حكمه إذا قضى به وانه يجب على المخالف الاتباع نعم اختلفوا في انه هل يطلق اسم الخطأ على الفرقة الأخرى في غير إنكار واعتراض ام لا وقولهم ان خصمك يقول انت مخطئ فإن كان هو مصيبا فإذا انت مخطئ قلنا ان قال خصمي انت مخطئ أي أظن خطأك فهو صادق وأنا أيضا صادق في قولي اني مصيب ولا تناقض وان قال اقطع بانك مخطئ فليس مصيبا في هذا القول بل بطلان قول من يقطع بالخطأ في المجتهدات ليس مظنونا بل هو مقطوع به في جملة المسائل القطعية الأصولية فالقول ان المصيب من المجتهدين كلاهما أو أحدهما مسألة اصولية قطعية لا ظنية وقد التبست عليهم الاصوليات بالفقهيات الظنية ومهما كشف الغطاء لم يتناقض الكلام فان قيل فإذا رأيتم كل واحد مصيبا فليجز للمجتهد ان يأخذ بقول خصمه ويعمل به لانه مصيب وليجز للمقلد ان يتبع من شاء من الأئمة المجتهدين قلنا أما اتباع المجتهد لغيره فخطأ فإن حكم الله عليه ان يتبع ظن نفسه وهذا مقطوع به فإذا اتبع ظن غيره فقد أخطأ في مسئلة قطعيه اصولية وعرف ذلك بالاجماع القاطع وأما بخبر المقلدين الأئمة فقد قال به قائلون ولكن المختار عندنا انه يجب ان يقلد من يعتقد انه افضل القوم واعرفهم ومستند اعتقاده إما تقليد سماعي من الأبوين وإما بحث عامي عن أحواله وإما تسامع عن ألسنة الفقهاء وبالجملة يحصل له ظن غالب من هذه المستندات فعليه اتباع ظن نفسه كما على المجتهد اتباع ظن نفسه وهذا ليس بكلي في الشرع لان الشرع يشتمل على مصلحة جزئية في كل مسألة وعلى مصلحة كلية في الجملة أما الجزئية فما يعرف عنها دليل كل حكم وحكمته اما المصلحة الكلية فهي ان يكون كل مكلف تحت قانون معين من تكاليف الشرع في جميع حركاته وأقواله وإعتقاداته فلا يكون كالبهيمة المسيبة تعمل بهواها حتى يرتاض بلجام التقوى وتأديب الشرع وتقسيمه إلى ما يطلقه والى ما يحجر عليه فيه فيقدم حتى يطلق الشرع ويمتنع حيث يمنع ولا يتخذ إلهه هواه ويتبع فيه مناه ومهما خبرنا المقدين في مذاهب الأئمة ليستمد منها أطيبها عنده اضطراب القائلون في حقه فلا يبقى له مرجع إلا شهوته في الاختيار وهو مناقض للغرض الكلي فرأينا أن نحصره في قالب وان نضبطه بضابط وهو رأي شخص واحد لهذا المعنة ولهذا اختلفت قوانين الأنبياء في الاعصار بالإضافة إلى التفصيل ولم تختلف في اصل التكليف ودعوة الخلق عن اتباع الهوى إلى طاعة قانون الشرع فهذا ما نراه مختارا في حق آحاد المقلدين هذا أحد الرأيين وهوان كل مجتهد مصيب ومن رأى أن المصيب واحد فلا تناقض أيضا في كلامه وقوله بم يأمن من إمكان الخطأ قلنا أولا تعارضهم فمن كان مسكنه بعيدا عن رسول الله ﷺ وكان يعول على قول الواحد وكذا من مسكنه بعيد عن معصومكم بينه وبينه البحار الحاجزة والمهامة المهلكة بم يأمن الخطأ على المبلغ وهو غير معصوم فسيقولون يحكم بالظن وليس عليه أكثر من ذلك فهذا جوابنا فإن قلتم إن له طريقا إلى الخلاص من الظن وهو أن يقصد النبي ﷺ فان التوجه إليه من الممكنات فكذا يقصد للإمام المعصوم في كل زمان قلنا وهل يجب قصد ذلك مهما جوز الخطأ فإن قلتم لا فأي فائدة في امكانه وقد جاز له اقتحام متن الخطر فيما جوز فيه الخطأ فإذا جاز ذلك فلا بأس بفوات الامكان كيف ولا يقدر كل زمن مدبر لا مال له على أن يقطع الف فرسخ ليسأل عن مسألة فقهية واقعة كيف ولو قطعها فكيف يزول ظنه بإمامكم المعصوم وان شافهه به إذ لا معجزة له على صدقه فبأي وجه يثق بقوله وكيف يزول ظنه به ثم يقول لا خلاص له عن احتمال الخطأ ولكن لا ضرر عليه وغاية ما في هذا الباب ان يكون في درك الصواب مزية فضيلة والإنسان في جميع مصالحه الدنيوية من التجارة والحرب مع العدو والزراعة يقول على ظنون فلا يقدر على الخلاص من إمكان الخطأ فيه ولا ضرر عليه بل لو أخطأ صريحا في مسألة شرعية فليس عليه ضرر بل الخطأ في تفاصيل الفقهيات معفو عنه شرعا بقوله ﷺ من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله اجر واحد فما هولوا من خطر الخطأ مستحقر في نفسه عند المحصلين من أهل الدين وانما يعظم به الأمر على العوام الغافلين عن أسرار الشرع فليس الخطأ في الفقهيات من المهلكات في الآخرة بل ليس ارتكاب كبيرة موجبا لتخليد العقاب ولا للزومه على وجه لا يقبل العفو أما المجتهدات فلا مأثم على من يخطئ فيها والحنفي يقول يصلي المسافر ركعتين والشافعي يقول يصلي أربعا وكيفما فعل في فالتفاوت قريب ولو قدر فيه خطأ فهو معفو عنه فإنما العبادات مجاهدات ورياضات تكسب النفوس صفاء وتبلغ في الآخرة مقاما محمودا كما أن تكرار المنفعة لما يتعلمه يجعله فقيه النفس ويبلغه رتبة العلماء ومصلحته تختلف بكثرة التكرار وقلته ورفعه صوته فيه وخفضه فإن اخطأ في الاقتصار على التكرار لدرس واحد مرتين وكانت الثلاث أكثر تأثيرا في نفسه في علم الله تعالى أو أخطأ في الثلاث وكان الاقتصار على الاثنين أكثر تأثيرا في صيانته على التبرم المبلد أو أخطأ في خفض الصوت وكان الجهر اوفق لطبعه وللتأثير في تنبيه نفسه أو كان الخفض أدعى له إلى التأمل في كنه معناه لم يكن الخطأ في شئ من ذلك في ليلة أو ليال مؤيسا عن رتبة الإمامة ونيل فقه النفس وهو في جميع ما يخمن ويرتب في مقادير التكرار من حيث الكمية والكيفية والوقت مجتهد فيه وظان وسالك إلى طريق الفوز بمقصوده ما دام مواظبا على الأصل وان كان قد تيقن له الخطأ احيانا في التفاصيل وانما الخطر في التغليط والاعتراض والاغترار بالفطنة الفطرية ظنا بان فيها غنية عن الاجتهاد كما ظن فريق من الباطنية ان نفوسهم زكية مرتاضة مستغنية عن الرياضات بالعبادات الشرعية فاهملوها وتعرضوا بسببها للعقاب الاليم في دار الآخرة فليعتقد المسترشد ان إفضاء المجاهدات الشرعية إلى المقامات المحمودة السنية في دار الآخرة كإفضاء الاجتهاد في ضبط العلوم والمواظبة عليها إلى مقام الأئمة وعند هذا نستحقر ما عظم الباطنية الأمر فيه من خطر الخطأ على المجتهدين في الجهر بالبسملة وتثنية الإقامة وأمثالها فالتفاوت فيه بعد المواظبة على الأصول المشهورة كالتفاوت في الجهر بالتكراراو الخفض به من غيرفرق وكيف وقد نبه الشرع على تمهيد عذر المخطئ فيه كما تواتر ذلك من صاحب الشرع. هذا تمام الكلام على المقدمة الثانية.
وأما المقدمة الثالثة وهي قولهم إذا ثبت وجوب معرفة الحق فلا يخلو إما أن يعرفه الإنسان من نفسه أو من غيره فهذه مقدمة صادقة لا نزاع فيها نعم المجادلة عليها بما يفحم الباطنية ويمنعهم من استعمالها كما ذكرنا في المقدمة الأولى وهي جارية في كل مقدمة صادقة.
وأما المقدمة الرابعة وهي قولهم إذا بطلت معرفته من نفسه بطريق النظر ثبت وجوب التعلم من غيره فهذه صادقة على تقدير بطلان النظر وتسليم معرفة الحق ولكنا لا نسلم بطلان النظر كما سبق وكما سنذكر في إفساد شبههم المزخرفة لإبطال النظر ولا نسلم وجوب معرفة الحق لأن من جملته ما بنا مندوحة عنه والمحتاج إليه معرفة الصانع وصدق الرسول والناس قد اعتقدوها سماعا وتقليدا لابويهم وفي ذلك ما يغنيهم فلا حاجة بهم إلى استئناف تعلم من معلم معصوم فإن قنعوا بالتعليم من الأبوين فنحن نسلم حاجة الصبيان في مبدأ النشوء إلى ذلك ولا ننكره ولا مستروح لهم في هذا التسليم ومن هذه المقدمة قولهم إذا ثبتت الحاجة إلى المعلم فليكن المعلم معصوما وهذا متنازع فيه فإن المعلم أن كان يعلم ويذكر معه الدليل العقلي وينبه على وجه الدلالة ليتأمل المتعلم فيه بمبلغ عقله ويجوز له الثقة بمقتضى عقله بعد تنبيه المعلم فليكن المعلم لو أفسق الخليقة فلم يحتاج إلى عصمته وليس يتلقف المتعلم منه تقليد ما يتلقفه بل هو كالحساب لا بد من معرفة الحق فيه لمصالح المعاملات ولا يعرفه الإنسان من نفسه ويفتقر إلى معلم ولا يحتاج إلى عصمته لانه ليس علما تقليدا بل هو برهاني وان زعمتم أن المتعلم ليس يتعلم بالبرهان والدليل لأن ذلك يدركه بنظر عقله ولا ثقة بعقله مع ضعف عقول الخلق وتفاوتها فلذلك يحتاج إلى معصوم فهذا الآن حماقة لانه إما ان يعرف عصمته ضرورة أو تقليدا ولا سبيل إلى دعوى شئ منه فلا بد ان يعرفه نظرا إذ لا شخص في العالم يعرف عصمته ضرورة أو يوثق بقوله مهما قال أنا معصوم وإذا لم يعرف عصمته كيف يقلده وإذا لم يثق بنظره كيف يعرف عصمته فان كان الأمر كما ذكرتموه فقد وقع الناس عن تعلم الحق وصار ذلك من المستحيلات فإذا قالوا لا بد من تعلم الحق لا بطريق النظر كان كمن يقول لا بد من الجمع بين البياض والسواد لانه ان تعلم من غيره بتأمل دليل المسألة التي يتعلمها كان ناظرا مقتحما خطر الخطأ وإن قلده لكونه معصوما كان مدركا عصمته بالنظر في دليل العصمة وان لم يعتقد العصمة ويعلم ممن كان فقد رجع الأمر بالآخرة إلى ما استبعدوه وهو التعلم ممن لم تعرف عصمته وفيهم كثرة واقوالهم متعارضة كما ذكروه وهذا لا مخلص عنه أبد الدهر.
وأما المقدمة الخامسة وهي قولهم إن العالم لا يخلو إما أن يشتمل على ذلك المعصوم المضطر إليه أو يخلو عنه ولا وجه لتقدير خلو العالم عنه فان ذلك يؤدي إلى تغطية الحق وذلك ظلم لا يليق بالحكمة فهو أيضا مقدمة فاسدة لانا إن سلمنا سائر المقدمات وسلمنا ضرورة الخلق إلى معلم معصوم فنقول لا يستحيل خلو العالم عنه بل عندنا يجوز خلو العالم عن النبي أبدا بل يجوز لله ان يعذب جميع خلقه وان يضطرهم إلى النار فانه بجميع ذلك متصرف في ملكه بحسب إرادته ولا معترض على المالك من حيث العقل في تصرفاته وانما الظلم وضع الشيء في غير موضعه والتصرف في غير ما يستحقه المتصرف وهذا لا يتصور من الله فلعل العالم خال عنه على معنى ان الله لم يخلقه.
فإن قيل مهما قدر الله على ارشاد الخلق إلى سبيل النجاة ونيل السعادات بعثة الرسل ونصب الأئمة ولم يفعل ذلك كان إضرارا بالخلق مع انتفاء المنفعة عن الله تعالى في هذا الإضرار وهو في غاية القبح المناقض لأوصاف الكمال من حكمته وعدله ولا يليق ذلك بالصفات الإلهية قلنا هذا الكلام مختل وغطاء ينخدع به العامي ويستحقره الغواص في العلوم وقد انخدع به طوائف من المعتزلة واستقصاء وجه الرد عليهم في فن الكلام وانا الآن مقتصر على مثال واحد يبين قطعا أن الله تعالى ليس يلزمه في نعوت كماله ان يرعى مصلحة خلقه وهو أنا نفرض ثلاثة من الاطفال مات أحدهم طفلا وبلغ أحدهم مسلما ثم مات وبلغ الآخر وكفر ثم مات فيجازي الله كل أحد بما يستحقه فيكون مقيما للعدل فينزل الذي بلغ وكفر في دركات لظى والذي بلغ واسلم في درجات العلا والذي مات طفلا من غير إسلام ومقاساة عبادة بعد البلوغ في درجة دون درجة الذي بلغ واسلم فيقول الذي مات طفلا يا رب لم اخرتني عن اخي المسلم الذي بلغ ومات ولا يليق بكرمك إلا العدل وقد منعتني من مزايا تلك الرتبة ولو انعمت علي بها لانتفعت بها ولم تضرك فكيف يليق بالعدل ذلك فيقول له بزعم من يدعي الحكمة انه بلغ واسلم وتعب وقاسى شدائد العبادات فكيف يقتضي العدل التسوية بينك وبينه فيقول الطفل يا رب انت الذي احييته وامتنى وكان ينبغي ان تمد حياتي وتبلغني إلى رتبة الاستقلال وتوفقني للآسلام كما وفقته فكان التأخير عنه في الحياة هو الميل عن العدل فيقول له بزعم من يدعي الحكمة كانت مصلحتك في إماتتك في صباك فإنك لو بلغت لكفرت واستوجبت النار فعند ذلك ينادى الكافر الذي مات بعد بلوغه من دركات لظى فيقول يا رب قد عرفت مني أني إذا بلغت كفرت فهلا امتني في صباي فإني قانع بالدرجة النازلة التي انزلت فيها الصبي المتشوق إلى درجات العلا وعند هذا لا يبقى لمن يدعي الحكمة في التسوية إلا الانقطاع عن الجواب والاجتراء وبهذا التفاوت يستبين أن الأمر أجل مما يظنون فان صفات الربوبيه لا توزن بموازين الظنون وان الله يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وبهذا يستبين انه لا يجب بعث نبي ولا نصب امام فقد بطل قولهم انه لا بد أن يشتمل العالم عليه.
وأما المقدمة السادسة وهي قولهم إذا ثبت ان المعصوم موجود في العالم فلا يخلو إما ان يصرح بالدعوى ويدعي العصمة أو يخفيه وباطل اخفاؤه لأن ذلك واجب عليه والكتمان معصية تناقض العصمة فلا بد أن يصرح بها فهذه مقدمة فاسدة لانه لا يبعد إلا يصرح به لكونه محفوفا بالأعداء مستششعرا في نفسه خائفا على روحه فيخفي ذلك تقية وذلك مما اتفقوا على جوازه واليه ذهبت الإمامية باجمعهم وزعموا ان الإمام حي قائم موجود والعصمة حاصلة له ولكنه يتربص تصرم دولة الباطل وانقراض شوكة الاعداء وإنما هو الآن متحصن بجلباب الخفاء حارس نفسه عن الهلاك لصيانة السر عن الإفشاء إلى ان يحضر أوانه وينقرض امام الباطل وزمانه فما جواب هؤلاء الباطنية عن مذهب الإمامية وما الذي يمنع احتمال ذلك فانهم ساعدوهم على جميع مقدماتهم إلا على هذه المقدمة وذلك لما شاهدوا من اختلال حال من وسمه هؤلاء بالعصمة وتحققوا من الأسباب المناقضة للورع والصيانة فاستحيوا من دعوى العصمة لمن يشاهدون من أحواله نقيضها فزعموا ان المعصوم مختف وانا ننتظر ظهوره في اوانه. وعند هذا نقول بم عرفت الباطنية بطلان مذهب الإمامية في هذه القضية فان عرفوها ضرورة فكيف قام الخلاف في الضروريات وان عرفوها نظرا فما الذي اوجب صحة نظرهم دون نظر خصومهم وتزكية عقولهم دون عقولهم أيعرف ذلك بطول اللحى أو ببياض الوجه وهلم جرا إلى عين المسلك الذي نهجوه وهذا لا محيص عنه بحال من الأحوال.
وأما المقدمة السابعة وهي قولهم إذا ثبت ان المعصوم لا بد أن يصرح فإذا لم يكن في العالم إلا مصرح واحد كان هو ذلك المعصوم لانه لا خصم له ولا ثاني له في الدعوى حتى يعسر التمييز فهذه فاسدة من وجهين أحدهما انهم بماذا عرفوا انه لا مدعي للعصمة ولا مصرح بها في أقطار العالم سوى شخص واحد فلعل في أقصى الصين أو في أطراف المغرب من يدعي شيئا من ذلك وانتفاء ذلك مما لا يعرف ضرورة ولا نظرا فان قيل يعرف ذلك ضرورة إذ لو كان لانتشر لان مثل هذا تتوافر الدواعي على نقله قلنا يحتمل انه كان ولم ينتشر إلى بلادنا مع بعد المسافة لان المدعي له ليس يتمكن من ذكره إلا مع سوسه وصاحب سره وحوله جماعة من اعدائه فيفزع من إظهار السر وإفشائه ويرى المصلحة في اخفائه أو هو مفش له ولكن المستمعين له ممنوعون عن الانتشار في البلاد واخبار العباد به لانهم محاصرون من جهة الاعداء مضطرون إلى ملازمة الوطن خوفا من نكاية المستولين عليهم فما الذي يبطل هذا الاحتمال وهو أمر قدر قريبا أو بعيدا فهو ممكن ليس من قبيل المحالات وانتم تدعون القطع فيما توردون فكيف يصفو القطع مع هذا الاحتمال.
الوجه الثاني في إفساد هذه المقدمة هو أنكم ظننتم أنه لا يدعي العصمة في العالم سوى شخص واحد وهو خطأ فإنا بالتواتر نتسامع بمدعيين أحدهما في جيلان فانها لا تنفك قط عن رجل يلقب نفسه بناصر الحق ويدعى لنفسه العصمة وانه نازل منزلة الرسول ويستعبد الحمقى من سكان ذلك القطر إلى حد يقطعهم جوانب الجنة مقدرا بالمساحة ويضايق في بعضهم إلى حد لا يبيع دراعا من الجنة لا بمائة دينار وهم يحملون إليه ذخائر الأموال ويشترون منه مساكن في الجنة فهذا أحد الدعاة فبم عرفتم انه مبطل وإذ قد تعدد المدعي ولا مرجح إذ لا معجزة فلا تظنوا ان الحماقة مقصورة عليكم وان هذه الكلمة لا ينطق بها لسان غيركم بل التعجب من ظنكم ان هذه الحماقة مقصورة عليكم في الحال أكثر من العجب في أصل هذه الحماقة فأما المدعي الثاني فرجل في جزائر البصرة يدعي الربوبيه وقد شرع دينار ورتب قرآنا ونصب رجلا يقال له على بن كحلا وزعم انه بمنزلة محمد ﷺ وانه رسوله إلى الخلق وقد احدق به طائفة من الحمقى زهاء عشرة الاف نفس ولعله يزيد عددهم على عددكم وهو يدعى لنفسه العصمة وما فوقها فما جوابكم عن رجل من الشاباسية يسوق هذه المقدمات إلى هذه المقدمة ثم يقول إذا لم يكن بد من معلم معصوم ولا معجزة للمعصوم وانما يعرف بالدعوى وصاحب الباطنية لا يدعي الربوبيه كيف وصاحب الشاباسية يدعي الربوبيه فأتباعه اولى فان قلتم من يدعي الربوبيه يعرف بطلان قوله ضرورة فالجواب من وجهين أحدهما أنه إنما يدعى ذلك بطريق الحلول ويزعم ان ذلك توارث في نسبهم وقد استمر ذلك في بيتهم عصرا طويلا والمدعي الآن كان جده مدعيا لذلك. والحلول قد ذهب إليه طوائف كثيرة فليس بطلان مذهب الحلولية ضروريا فكيف يكون ضروريا وفيه من الخلاف المشهور ما لا يكاد يخفى حتى مال إلى ذلك طائفة كبيرة من محققي الصوفيه وجماعة من الفلاسفة واليه اشار الحسين بن منصور الحلاج الذي صلب ببغداد حيث كان يقول أنا الحق أنا احق وكان يقرأ في وقت الصلب وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم واليه أشار أبوزيد البسطامي بقوله سبحاني سبحاني ما أعظم شأني وقد سمعت انا شيخا من مشايخ الصوفية تعقد عليه الخناصر ويشار إليه بالأصابع في متانة دين وغزارة علم حكى لي عن شيخه المرموق في الدين والورع انه قال ما تسمعه من أسماء الله الحسنى التي هي تسعة وتسعون كلها يصير وصفا للصوفي السالك بطريقه إلى الله وهو يعد من جملة السائرين إلى الله لا من زمرة الواصلين وكيف ينكر هذا وعليه مذهب النصارى في اتحاد اللاهوت بناسوت عيسى عليه السلام حتى سماه بعضهم إلها وبعضهم ابن الإله وبعضهم قالوا هو نصف الإله واتفقوا على أنه لما قتل انما قتل منه الناسوت دون اللاهوت كيف وقد تخيل جماعة من الروافض ذلك في علي رضي الله عنه وزعموا أنه الإله وكان ذلك في زمانه حتى أمر باحراقهم بالنار فلم يرجعوا وقالوا بهذا يبين صدقنا في قولنا أنه الإله لأن رسول الله ﷺ قال لا يعذب بالنار إلا ربها فبهذا يبين ان بطلان هذا المذهب ليس بضروري ولكنه ضرب من الحماقة ويعرف بطلانه بالنظر العقلي كما يعرف بطلان مذهبهم فإذا قد بطل قولهم لا مدعي للعصمة سوى صاحبنا بل قد ظهر من يدعي العصمة وزيادة.
الوجه الثاني في الجواب عن قولهم ان بطلان مذهبهم معلوم ضرورة ولا فرق بين ما يعرف بطلانه ضرورة وبين ما يعرف بطلانه مشاهدة أو تواترا وعدم العصمة فيمن ادعيتم عصمته معلوم بمشاهدة ما يناقض الشرع من وجوه اولها جمع الأموال واخذ الضرائب والمواصير واستئداء الخراجات الباطلة وهو الأمر المتواتر في جميع الأقطار ثم الترفه في العيش والإستكثار من أسباب الزينة والإسراف في وجوه التجمل واستعمال الثياب الفاخرة من الإبريسم وغيرها وعدالة الشهادة فتحرم بعشر عشر ذلك فكيف العصمة فان أنكروا هذه الأحوال أنكروا ما شاهده خلق كثير من تلك الأقطار وتواتر على سانهم إلى سائر الأمصار ولذلك لا ترى لاحد من أهل تلك البلاد اغترارا وانخداعا بهذه التلبيسات لمشاهدتهم ما يناقضها ومن وجوه حيلهم أنهم لا يبثون الدعوة إلا في بلاد نائية يحتاج المستجيب إلى قطع مسافة شاسعة لو اعترضت له ريبة فيها حتى تدفعه العوائق عن النهضه والرحلة فإنهم لو شاهدوا لانكشف لهم عوار تلك التلبيسات المزخرفة والحيل الملفقة.
أما المقدمة الثانية وهي قولهم إذا بان ان المدعى للعصمة مهما كان واحدا وقع الاستغناء عن الاستدلال على كونه معصوما فصاحبنا إذا هو المدعى للعصمة وحده فإذا هو الإمام المعصوم فهذه مقدمة نكذبهم فيها ولا نسلم ان صاحبهم يدعى لنفسه العصمة فانا لم نسمعه البته ولم يتواتر الينا من لسان من سمعه منه بل انما سمع ذلك من آحاد دعاتهم وليسوا معصومين ولاهم بالغون حد التواتر ولو انهم بلغوا حد التواتر فلا يحصل العلم بقولهم وخبرهم لوجهين أحدهما ان المشافهين لهذه الدعوة من جهة صاحبهم قليل فانه محتجب لا يظهر إلا للخواص ثم لا يشافه بالخطاب إلا خواص الخواص ثم لا يفشي هذه الدعوة إلا مع خاص من جملة خواص الخواص فالذين يسمعون عنه لا يبلغون عدد التواتر وان بلغوا فكلهم إن انتشروا لم يكن في بلدة منهم إلا واحد وأكثر البلاد أيضا يخلو عن آحادهم.
الوجه الثاني أنهم وإن بلغوا حد التواتر فقد فقد شرط التواتر في خبرهم إذ شرط ذلك الخبر إلا يتعلق بواقعة ينتشر التواطؤ فيها من طائفة كبيرة لمصلحة جامعة لهم كما يتعلق بالسياسات فان أهل معسكر واحد قد يجمعهم غرض واحد فيحدثون على التطابق بشئ واحد ولا يورث ذلك العلم ورب واحد أو اثنين يخبر عن أمر فيعلم أنه لا يجمعهما غرض فيحصل له العلم وهؤلاء الدعاة لعلهم قد تواطئوا على هذا الاختراع ليتوصلوا به إلى استتباع العوام واستباحة أموالهم فيتوصلون بها إلى أمالهم وعلى الجملة فحسن الظن بصاحبهم يقتضي تكذيبهم فإنهم لو حدثوا بذلك عن مريض في دار المرضى لاعتقدنا كذبه إلا ان يعتقد الجنون في ذلك المريض إذ لا يدعي عاقل العصمة عن المحرمات وتناول المحظورات مع مشاهدة أهل العلم تناوله لها ومباشرته لها فاقل آثار العقل الحياء عن فضيحة الاجتراء ومن تحلى بغير ما هو فيه وكان ذلك جليا ظاهرا لمن يتأمل فيه استدل به على اختلال عقله فإذا ليس يبين لنا صدقهم في نسبتهم هذه الدعوة إلى صاحبهم وهي مقدمتهم الاخيرة.
فإن قيل لو أنكر الناس في أطراف العالم في عصر رسول الله ﷺ صدق الدعاة من رسول الله وقالوا لانصدقكم في قولكم إن محمدا يدعي الرسالة بل لا يظن بعقله ذلك ماذا كان يقال لهم قلنا بئس ما شبهتم الملائكة بالحدادين إذ لا مساواة فإنه ﷺ كان ظاهرا بنفسه وأشياعه مبرزا للقتال مترددا في الأقطار مظهرا للدعوة على ملأ من الناس غير محتجب ولا متسستر ثم كان يظهر المعجزات الخارقة للعادة فانتشرت دعوته لانتشار خروجه ومقاتلته وانتتشار وجوده وليس الآن في صاحبكم كذلك نعم تواتر وجوده وترشحه مع آبائه للخلافة ودواعهم انهم اولى بها من غيرهم اما دعواه ودعوى من سبق من آبائه العصمة على المعاصي وعن الخطأ والزلل والسهو ومعرفة الحق في جميع أسرار العقليات والشرعيات فلم يظهر ذلك لنا بل لم تظهر دعواه العلم اصلا بفن من الفنون كالفقه أو الكلام أو الفلسفة على الوجه الذي يدعيه آحاد العلماء في البلاد فكيف ظهرت دعواه معرفة أسرار النبوة والاطلاع على علوم الدنيا والآخرة وهذا ما تواطأ على اختراعه توصلا إلى استدراج المستجيب وخداعه.
هذا تمام الرد عليهم في المقدمات تفصيلا مع أن في المنهج الأول المنطوي على الرد عيهم جملة كافية ومقنعا. ولم يبق إلا القول في إفساد أدلتهم المذكورة لإبطال النظر.
أما الدلالة الأولى وهي قولهم من صدق عقله فقد كذبه إذ صدق عقل خصمه وخصمه يصرح بتكذيبه فنقول هذا تخييل باطل من وجوه الأول المعارضة بمثال وهو أنا نقول نحن صدقنا العقول في نظرياتها وانتم صدقتموها في ضرورياتها وخصومكم من السوفسطائية يكذبونكم فيها فإن إقتضى ذلك لزوم الاعتراف بكذب العلوم الضرورية لزمنا من خلافكم الاعتراف بكذب العلوم النظرية فان العقل إن صدق في الضروريات فما بال عقل السوفسطائية كذب وما الفرق بين عقلكم وعقلهم أفتقولون ان ذلك منهم حماقة وسوء مزاج قلنا وكذلك حالكم في إنكار النظريات وهو كمن ينكر الحسابيات من العلوم فانه لا يشككنا في البراهين الحسابية وان كان البليد لا يفهم ومنكر النظر اصلا يجحده ولكن طريقنا معه أن نورد عليه المقدمات وهي ضرورية فإذا أدركها ادرك النتيجة فكذلك خصمنا إذا كذبنا في مسألة من المسائل كإنكار ثبوت واجب الوجود عرضنا عليه مقدمات القياس الدالة عليه وقلنا أتماري في قولنا لا شك في أصل الوجود أو في قولنا ان كل موجود إما جائز واما واجب ام في قولنا ان كان واجبا فقد ثبت واجب الوجود ام في قولنا إن كان جائزا فكل جائز مستند إلى واجب الوجود في آخر الأمر لا محالة وإذا لم يمكنه التشكك في المقدمات لم يمكنه التشكك في النتيجة وانما يختلف الناس فيها لان الفطرة غير كافية في تعريف الترتيب لهذه المقدمات بل لا بد من تعلمها من الافاضل وذلك الفاضل لا بد ان يكون تعلم أكثرها أو إستأثر باستنباط بعضها وهكذا حتى ينتهي الأمر إلى معلم معصوم هو نبي موحى ايه من جهة الله تعالى هكذا تكون العلوم كلها فان زعموا أنكم اعترفتم بالحاجة إلى المعلم ومن لم يعترف فهو معاند للمشاهدة فالافتقار إليه معترف به ولكنه كالافتقار إليه في علم الحساب فانه لا يحتاج فيه إلى معصوم إذ لا تقليد فيه ولكن يحتاج إلى حاسب ينبه على طريق النظر فإذا تننبه المعلم ساوى المعلم في العلم الضروري المستفاد من المقدمات بعضها على بعض ولا شك في أن معلم الحساب أيضا يعلم أكثر مما يعلم وان استقل باستنباط ترتيب البعض وكذا القول في معلم المعلم إلى ان ينتهي مبدأ العلم الحسابي إلى نبي من الانبياء مؤيد بالوحي والمعجزة ولكن بعد إفاضة الله علم الحساب فيما بين الخلق استغنى في تعلمه عن معلم معصوم فكذلك العلوم العقلية النظرية ولا فرق.
الاعتراض الثاني ان يقال لهم أنكرتم من خصومكم تصديق العقل في نظره واخترتم تكذيبه فبماذا تعرفون الحق وتميزون بينه وبين الباطل أبضرورة العقل ولا سبيل إلى دعواها أو بنظره فتضطرون إلى الرجوع إلى النظر فقد صدقتموه إذا بعد تكذيبه فتناقض كلامكم فان قلتم نحن نأخذه من الإمام المعصوم قلنا وبم تعرفون صدقه فان قلتم لانه معصوم قلنا وبم تعرفون عصمته فان قلتم بضرورة العقل لم يخف عليكم خزيكم وعرفتم في الباطن من أنفسكم خلاف ما أظهرتم فان عصمة رسول الله ﷺ مع معجزته لم تعرف بضرورة العقل حتى أنكر رسالته طوائف بل أنكر بعثة الرسل جميع البراهمة وانكر الاكثرون من المسلمين عصمة الانبياء واستدلوا بقوله تعالى: {وعصى آدم ربه فغوى} إلى غير ذلك مما اشتمل القرآن على حكايته من أحوال الانبياء فإذا لم تعرف عصمة صاحب المعجزة ضرورة فكيف تعرف عصمة صاحبكم ضرورة فان قيل نحن نعرفه بالنظر ولكن النظر تعلم منه والنظر ينقسم إلى صحيح وفاسد وتمييز صحيحه على فاسده ممتنع عن كافة الخلق إلا على الإمام الحق فهذا الميزان الموضح للفرقان بين الشبهه والبرهان فقد عرفنا صحة النظر الذي استفدنا منه فاطمأنت نفوسنا إليه بتزكيته وتعليمه قلنا والنظر الذي علمكموه هل افتقرتم في فهمه إلى تأمل ام هو مدرك على البديهة فان ادعيتم البديهة فما أشد جهلكم إذ يرجع حاصله إلى أن معرفة عصمته عرفت بالبديهة وهو كذب صريح وان افتقرتم إلى التأمل فذلك التأمل يعرف بالعقل ام لا ولا بد أن يقال إنه بالعقل فنقول والعقل إذا قضى عند التأمل بقضية فهو صادق ام لا فان قالوا لا فلم صدقوه وان قالوا نعم هو صادق فقد ابطلوا اصل مذهبهم وهو قولهم ان العقول لا سبيل إلى تصديقها فان قيل الإمام يعرف من بواطن أسرار الله أمورا إذا ذكرها حصل للمتعلم عند سماعها علم بديهي ضروري بصدقة ويستغنى به عن تدقيق النظر والتأمل فنقول ورسول الله ﷺ هل عرف ذلك ام لا فان قلتم لا فقد فضلتم الخليفة على الاصل وان قلتم نعم فلم اخفاها وهلا اظهرها وافشاها حتى كانت العقول تضطر على البديهة إلى ذكرها وكانت تتسارع إلى التصديق له في دعاويه ولم ترك طوائف الخلق مضطربين في مغاصات الشبه متعثرين في أذيال الضلالات مجاهدين بأموالهم وانفسهم في نصرة الخيالات الباطلة كيف وانتم إذا تعلمتم من إمامكم ذلك وقدرتم على ذكره حتى يعرف بالبديهة صدقه فتلك الدقيقة لماذا اخفيت ولأي يوم أجلت وكتمان الدين من أكبر الكبائر ثم كيف انقسم المستمعون فنون ضلالكم إلى قائل مستمع وراد ومنخدع ومنتبهه وهلا اسلك الكل في ربقة التصديق والانقياد وعلى الجملة فدعوى مثل هذا الكلام لا تدل إلا على الوقاحة وقلة الحياء والا فنحن بالضرورة نعلم انكم على البديهة لم تدركوا صدق امامكم وعصمته ولكنكم ربما تضطرون في تمشية التلبيس إلى خلع جلباب الحياء وكذلك يفعل الله بذوي الضلال والامراء فنعوذ بالله من سقطة الأغبياء فما هذه الكذبة الصادرة منكم قولة تتقال أو عثرة تقال أو خدعة يسبق اليها الجهال فضلا عن أفاضل الرجال.
الاعتراض الثالث وهو أن نقول للمسترشد مثلا إذا شك في صحة النظر واستدل بالاختلاف المجمل ينبغي ان تعين المسألة التي تشك فيها فان المسائل منقسمة إلى ما لا يمكن ان يعلم بنظر العقل والى ما يمكن ان يعلم علما ظنيا والى ما يعلم علما يقينيا ولا معنى لقبول السؤال المجمل بل لا بد من تعيين المسألة التي فيها الاشكال حتى يكشف الغطاء عنها وينبه السائل على أن المخالف فيها جهل وجه ترتيب المقدمات المنتجة له ونحن لا ندعي الآن المعرفة إلا في مسئلتين احداهما وجودالصانع الواجب الوجود المستغني عن الصانع والمدبر والثانية صدق الرسول ويكفينا في باقي المسائل ان نتلقاها تقليدا من الرسول ﷺ فهذا القدر الذي لا بد منه في الدين وباقي العلوم لا يتعين تحصليها بل الخلق مستغنون عنها وان كان ذلك ممكنا كالعلوم الحسابية والطبية والنجومية والفلسفية وهاتان المسألتان نعرفهما يقينا اما ثبوت واجب الوجود فبالمقدمات التي عرفناها واما صدق الرسول فبمقدمات تماثلها ومن احاط بها لم يشك فيها وعلم غلط المخالف منها كما يعلم غلط المحاسب في الحساب وخصومنا أيضا مضطرون أى معرفة هاتين المسألتين بالنظر والا فقول النبي لا يغني فيهما فيكف يغني فيهما قول المعصوم فإن قيل معرفة صفات الله ومعرفة الشرائع ومعرفة الحشر والنشر كل ذلك لا بد منه فمن اين يعرف قلنا يتعلم من النبي ﷺ المعصوم المؤيد بالمعجزة ونصدقه فيما يخبر عنه كما تقلدون انتم صاحبكم الذي لا عصمة له ولا معجزة فان قيل وبم تفهمون كلامه قلنا بما نفهم به كلامكم هذا في اسئلتكم وتفهمون كلامنا في اجوبتنا وهو معرفة اللغة وموضوع الألفاظ كما تفهمون انتم من المعصوم عندكم فان قيل ففي كلام الرسول وفي القرآن المشكلات والمجملات كحروف أوائل السور والمتشابه كأمر القيامة فمن يطلعكم على تأويله والعقل لا يدل عليه قلنا للآلفاظ الشرعية ثلاثة اقسام ألفاظ صريحة لا يتطرق اليها الاحتمال فلا حاجة فيها إلى معلم بل نفهمها كما تفهمون أنتم كلام المعلم المعصوم إذ لو اقتصر صريح كلام الشارع أى معلم ومؤول لاقتصر صريح كلام المعلم المعصوم إلى مؤول ومعلم آخر ولتسلسل إلى غير نهاية.
الثاني ألفاظ مجملة ومتشابهة كحرووف اوائل السور فمعانيها لا يمكن ان تدرك بالعقل إذ اللغات تعرف بالاصطلاح ولم يسبق اصطلاح من الخلق على حروف التهجي وان الر وحم عسق عبارة عماذا فالمعصوم أيضا لايفهمه وانما يفهم ذلك من الله تعالى إذا بين المراد به على لسان رسوله فيفهم ذلك سماعا وذلك لا يخلو إما أن لم يذكره الرسول لانه لا حاجة إلى معرفته ولم يكلف الخلق به فالمعصوم شريك في انه لا يعرفه إذ لم يسمعه من الرسول وان عرفه وذكره فقد ذكر ما بالخلق مندوحة عن معرفته فانهم لن يكلفوه وان ذكره الرسول فقد اشترك في معرفته من بلغه الخبر متواترا كان أو آحادا وفيه عن ابن عباس وجماعة من المفسرين نقل فإن كان متواترا افاد علما وإلا افاد ظنا والظن فيه كاف بل لا حاجة إلى معرفته فانه لا تكليف فيه واما وقت القيامة فلم يذكره الله تعالى ولا ذكره رسلوه عليه السلام وانما يجب التصديق بأصل القيامة وولا يجب معرفة وقتها بل مصلحة الخلق في إخفائها عنهم ولذلك طوى منهم فالمعصوم من أين عرف ذلك الكلام ولم يذكره الله ولا رسوله ولا مجال لضرورة العقل ولا لنظره في تعيين الوقت ثم لنقدر انه عرف ذلك وزعم انه ﷺ ذكره سرا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وذكره كل امام مع سوسه فأي فائدة للخلق فيه وهو سر لا يجوز ان يذكر إلا مع الأئمة فإن ذكره معصومكم وأفشى هذا السر الذي أمر الله تعالى بكتمانه إذ قال تعالى أكاد اخفيها كان معاندا لله ورسوله وان كان لا يفشيه فكيف يتعلم منه ما لا يجوز تعليمه فدل على أن الأمور العقلية محتاجة إلى التعليم ولكن المعلم أن كان ينبه على طريق النظر فيه فلا يشترط عصمته وان كان يقلد من غير دليل فلا بد أن تعرف بالمعجزة عصمته وهو النبي وناهيك به معلما فلا حاجة إلى غيره.
القسم الثالث الألفاظ التي ليست مجملة ولا صريحة ولكنها ظاهرة فانها تثير ظنا ويكتفى بالظن في ذلك القبيل والفن وسواء كان ذلك في الفقهيات وأمور الآخرة أو صفات الله فليس يجب على الخلق إلا أن يعتقدوا التوحيد والألفاظ فيه صريحة وأن يعتقدوا أنه قادر عليم سميع بصير ليس كمثله شيء وكل ذلك اشتمل القرآن عليه وهو مصرح به أما النظر في كيفية هذه الصفات وحقيقتها وأنها تساوي قدرتنا وعلمنا وبصرنا أم لا فقوله ليس كمثله شيء دال على نفي المماثلة لسائر الموجودات وهذا قد اكتفى من الخلق به فلا حاجة بهم إلى معصوم نعم الناظر فيه والمستدل عليه بالأدلة العقلية قد يتوصل إلى اليقين في بعض ما ينظر فيه وإلى الظن في بعضه ويختلف ذلك باختلاف الذكاء والفطنة واختلاف العوائق والبواعث ومساعدة التوفيق في النظر والعارف يذوق اليقين وإذا تيقن لم يتمار فيه ولم يشككه قصور غيره عن الدرك وربما تضعف نفسه ويشككه خلاف غيره ز كل ذلك لا مضرة له لأنه ليس مأمورا به والمعصوم لا يغنى عنه شيئا لو تابعه فإن محض التقليد لا يكفيه وإن ذكر وجه الدليل فذلك لا يختلف صدوره عن معصوم أو غيره كما سبق.
وأما الدلالة الثانية وهي قو لهم إذا جاءكم مسترشد متحير وسألكم عن العلوم الدينية أفتحيلونه على عقله ليستقل بالنظر وهو عاجز أو تأمرونه باتباعكم في مذهبكم وينازعكم المعتزلى والفلسفي وكذا سائر الفرق فبماذا يتميز مذهب عن مذهب وفرقة عن فرقة فالجواب من وجهين الأول هو أنا نقول لهم لو جاءكم متحير في أصل وجود الصانع وصدق الأنبياء انقلب عليكم هذا الإشكال فماذا تقولون إن ذكرتم دليلا عقليا لم نثق بنظره وإن رددتموه إلى عقله فكمثل فعساكم تشفون غليله بالحوالة على المعصوم فما أبرد هذا الشفاء فإنه يقول قدروني قد جئت مسترشدا في زمان محمد بن عبد الله ومعه معجزته فمعصومكم لا يقدر على معجزة أو قدروا إني شاهدت معصومكم قلب العصا ثعبانا أو أحيا الموتى أو أبرأ الأكمة والأبرص وأنا أشاهده فلا يبين لي صدقه بضرورة العقل ولا أثق بالنظر وكم من أصناف الخلائق شاهدوا ذلك وأنكروه فحمله بعضهم على السحر والمخرقة وبعضهم على غيره فلعلكم تشبعون غصته بان تقولوا له قلد الإمام المعصوم ولا تسأل عن السبب فيقول ولم لا اقلد المخالفين لكم في إنكار النبوة والعصمة وهل بينهما فرق من طول لحية أو بياض وجه إلى غير ذلك مما هذوا به وهذا قلب لو اجتمع أولهم مع آخرهم على الخلاص منه دون الأمر بالتفكر والنظر في الدليل لم يجدوا إليه سبيلا.
الجواب الثاني وهو التحقيق هو أنا نقول للمسترشد ماذا تطلب فإن كنت تطلب العلوم كلها فما اشد فضولك واعظم خطبك وأطول أملك فاشتغل من العلوم ما يهمك وان قال اريد ما يهمني قلنا ولا مهم إلا معرفة الله ورسوله وهذا معنى قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله فهاتان مسألتان يسهل علينا تعليمك اياهما وعند ذلك ذكر له المقدمات الضرورية التي ذكرناها في إثبات واجب الوجود ثم مثلها في دلالة المعجزة على صدق الرسول فإن زعم أن خلاف المخالفين هو الذي يشككني في هذه المعرفة أفأتبعكم أو أتبع مخالفيكم فنقول له لا تتبعنا ولا تتبع مخالفينا فان تعلم طريق التقليد مباح والتقليد في النتيجة غير موثوق به فشكك في أي مقدمة من مقدماتنا أفي قولنا إن أصل الوجود معترف به فان كان كذلك فعلاجك في دار المرضى فإن هذا من سوء المزاج فان من شك في أصل الوجود فقد شك أولا في وجود نفسه وإن قلت لا أشك في هذا بخلاف السوفسطائية قلنا فقد تيقنت مقدمة واحدة فهل تشك في الثانية وهي قولنا ان كان هذا الوجود واجبا فقد ثبت واجب الوجود فنقول هذا أيضا ضروري قلنا فهل تشك في قولنا إن كان جائزا فلا يتخصص أحد طرفي الجواز من الطرف المماثل له إلا بمخصص فهذه أيضا مقدمة ضرورية عند من يدرك معنى اللفظ وإن كان فيه توقف فالتوقف في درك مراد المتكلم من لفظه فان قال نعم لا شك فيه قلنا فذلك المخصص المفتقر إليه إن كان جائزا فالقول في ذلك لا كالقول فيه فيفتقر إلى مخصص غير جائز وهو المراد بواجب الوجود ففيماذا تتشكك فإن قال قد بقي لي شك عرف به بلادته وسوء فهمه وقطع الطمع عن رشده وليس هذا بأول بليد لا يدرك الحقائق فنخليه وهو كمن يطلب علم الحساب فذكرنا له الغوامض من مقدمات الحساب من الشكل (القطاع) الذي هو في آخر كتاب إقليدس فلم يفهمه لبلادته بل في الشكل الأول الذي مضمونه إقامة البراهين على مثلث متساوي الأضلاع فلم يدركه عرفنا ان مزاجه ليس يحتمل هذا العلم الدقيق فليس كل خلقه يحتمل العلوم بل الصناعات والحرف فهذا لا يدل على فساد هذا الأصل فإن قال المسترشد لست أشك في هذه المقدمات ولا في النتيجة ولكن لم يخالفكم من يخالفكم قلنا لجهله ترتيب هذه المقدمات أو لعناده أولبلادته وينكشف الغطاء بأن نشافه واحدا منهم يميل إلى الإنصاف ونراجعه في هذه المقدمات حتى يتبين لك أنه بين أن يفهم ويصف ويعترف أو لا يفهم لبلادته أو يمنعه التعصب والتقليد عن حسن الإصغاء إليه فلا يدركه وعند ذلك يطلع على خطئه وكذلك يصنع به في كل مسألة وينظر فيه إلى ما تحتمله حاله ويقبله ذكاؤه وفطنته ولا يحمله مالا يطيقه بل ربما يقنعه بما يورث له إعتقادا في الحق مصمما فإن أكثر عوام الخلق قنع منهم الشرع بذلك ولا يكشف له عن وجه البراهين فربما لا يفهمها.
وأما الدلالة الثالثة وهي قولهم الوحدة دليل الحق والكثرة دليل الباطل ومذهب التعليم تلزمه الوحدة ومذهبكم تلزمه الكثرة إذ لا تزال الفرقة المخالفة للتعليم يكثر اختلافهم ولا تزال الفرقة ألقابلة للتعليم يتحد طريقهم.
فالجواب من وجوه أحدها المعارضه والاخر الإبطال والثالث التحقيق أما المعارضة فتقول والصائرون إلى الافتقار إلى معلم معصوم اختلفوا في ذلك المعصوم فقالت الإمامية إنه ليس بظاهر وليس يعرف عينه ولكن أخفى نفسه تقية وقال آخرون ليس موجودا ولكنه منتظر الوجود وسيوجد إذا احتمل الزمان إظهار الحق ولو كان يحتمل الزمان إظهاره لوجد فانه لا فائدة في كونه موجودا مع تعذر الإظهار للتقية وقال آخرون في بعض الخلفاء الذين مضوا لسبيلهم إنهم أحياء وسيظهرون في أوانه واختلفوا في تعيينه حتى اعتقد فريق ان الملقب بالحاكم هو حي بعد وقال آخرون ذلك في غيره إلى نوع من الخبط طويل فان قيل هؤلاء جماعة من الحمقى غير معدودين في زمرتنا فإذا ضممتموهم الينا وجمعتم بيننا وبينهم تطرقت الكثرة الينا فلم تجمعون الينا من يخالفنا كما يخالفكم بل الإنصاف أن تنظروا الينا وحدنا ونحن لا تختلف كلمتنا اصلا قلنا ونحن أيضا إذا إعتبرنا وحدنا فنحن لا نخالف أنفسنا وقد يرد هذا الاعتراض لا محالة من يعتقد مذهبا في جميع المسائل لا يخالف نفسه ومعه جماعة من الخلق يوافقونه في معتقده في الجميع فإذا اعتبرتموه مع فرقته ولم تجمعوا اليهم من يخالفهم فبالحماقة والبلادة وقصور النظر ألفيت كلمتهم متحده فلا يدل على أن الحق فيهم فإن قلتم وبم عرفتم حماقة مخالفيكم انقلب ذلك عليكم من مخالفتكم القائلين بوجوب التعليم من المعصوم وإن زعمتم ان القائلين بأن النظر صحيح فرقة واحدة وإن اختلفوا في تفاصيل المذهب قلنا والقائلون بأن الإمام المعصوم لا بد منه فرقة واحدة وإن اختلفوا في التفصيل هذا ولا محيص عنه أبد الدهر.
الجواب الثاني وهو أنا نقول قولكم الوحدة أمارة الحق والكثرة أمارة الباطل باطل في الطرفين فرب واحد باطل ورب كثير لا ينفك عن الحق فإناإذا قلنا العالم حادث أو قديم فالحادث واحد والقديم واحد فقد اشتركا في لزوم الوحدة وانقسما في الحق والباطل وإذا قلنا الخمسة والخمسة عشرة ام لا فقولنا لا نفي واحد كقولنا عشرة إثبات واحد ثم اختلفا فكان أحدهما حقا والآخر باطلا فإن قلتم إن قولكم عشرة لا يمكنكم ان تقسم وتفصل إلا بواحد وقولكم لا يفصل بالتسعة والسبعة وسائر الاعداد ففيه الكثرة قلنا ولزوم الكثرة في مثل هذا التفصيل لا يدل على البطلان فإنا إذا عمدنا إلى جسمين متقاربين قلنا إنهما متساويان ام لا فقولنا متساويان واحد وهو باطل ولا يمكن ان يفصل إلا بواحد وقولنا لا إذ قلنا متفاوتان حق وهو واحد ويقبل التفصيل بما ينقسم إلى الحق والباطل إذ يقال هذا الجسم مفاوت لذلك الجسم أي هو أكبر أو يفسر بأنه أصغر والحق أحدهما والباطل يقابله في كونه واحدا وفي مشاركته في الاندراج تحت لفظ واحد هو حق يدل على أن ما ذكروه تلبيس.
الجواب الثالث عن قولهم إن الكثرة أمارة الباطل فمذهبنا واحد لا كثرة فيه وانما الكثرة في الأشخاص الذين اجتمعوا على مسألة ثم افترقوا في مسائل فلم قابلوا هذا بكثرة في جواب المسألة وهو في قولنا كم الخمسة والخمسة بل ورأيه في المذهب أن يفتي في مسألة واحدة بفتاوي كثيرة متناقضة فعند ذلك يقال الكثرة دليل الباطل ولسنا نفتي في كل مسألة إلا بواحد فإنا نقول الله واحد ومحمد ﷺ رسوله وهو صادق ومؤيد بالمعجزة فهذه فتوى واحدة فلتكن حقا وان كان باطلا فهو موافق لمذهبهم وقولنا ان نظر العقل طريق يوصل إلى درك ما لا يدرك اضطرارا مذهب واحد لا كثرة فيه فليكن حقا كما أن قولنا العلوم الحسابية علوم صادقة قول واحد وكان حقا وليتعجب من ابعادهم في التلبيس إذ أخذوا لفظة الكثرة وهي لفظة مضافة مشتركة تارة يراد بها الكثرة في الأجوبة عن مسألة واحدة كالجواب عن الخمسة والخمسة والسبعة والستة وغيرها وتارة تطلق ويراد كثرة الأشخاص المتفقين في مذهب والمختلفين فيه فرأوا مفارقة الباطل للكثرة المضافة إلى عدد الاجوبة في مسألة واجدة فاستدلوا به على بطلان قول واحد في مسألة واحدة اجتمع عليها جماعة كثيرة اختلفت كلمتهم في مسائل سوى تلك المشكلة لكن هذا وان كان تلبيسا بعيدا عن المحصل فمقصود واضعه التلبيس على العوام وذلك مما يتوقع رواجه فالحيلة على العوام في استدراجهم ليست ممتنعة على جماعة من الحمقى قد ادعوا الربوبيه فكيف تتعسر عن غيرها واما قوله تعالى: {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا} فهو من هذا الطراز في التلبيس فإن المراد به تناقض الكلمات في المتكلم الواحد إذا تناقض كلامه فسد ونحن لم يتناقض كلام الواحد منا في مسألة بل اجتمع طائفة على مسألة وهي إثبات النظر كما اجتمع طائفة على التعليم وإثباته ثم اختلفوا في مسائل اخرى فأين هذا من اختلاف الكلام الواحد.
فإن قيل المتعلمون إذا اجمعوا على التعليم وعلى معلم واحد وأصغوا بأجمعهم إليه لم يكن بينهم خلاف وإن كانوا ألف ألف قلنا والناظرون إن اجمعوا على النظر في الدليل وعلى تعيين دليل واحد في كل مسألة ووقفوا عليها لم يتصور بينهم خلاف فإن قلتم فكم من ناظر في ذلك الدليل بعينه قد خالف قلنا وكم من مصغ إلى معلمكم وقد خالف فان قلتم لانه لم يصدقه في كونه معصوما قلنا ولأن الناظر لم يعرف هذا وجه دلالة الدليل فان قلتم ربما يعرف وجه الدلالة ثم ينكر قلنا هذا لا يتصور إلا عنادا كما يعتقد واحد كون الإمام المعصوم حقا ثم يخالفه فلا يكون ذلك إلا عن عناد ولا فرق بين المسلكين.
وأما الدلالة الرابعة وهي قولهم ان كان لا يدرك الناظر المساواه بينه وبين خصمه في الاعتقاد فلم يدرك المساواه بين حالتيه وكم من مسألة اعتقدها نظرا ثم تغير اعتقاده فيم يعرف ان الثاني ليس كالأول قلنا يعرف ذلك معرفة ضرورية لا يتمارى فيها وهذا معتقدكم أيضا في مثالين ولا كلام أقوى من القلب والمعارضه في مثل هذه المقالات فان عادتهم مد يد الاعتصام إلى إشكالات لا تختص بمذهب فريق فيحيرون عقول العوام به ويخيلون انه من خاصة مذهب مخالفيهم والعامي المسكين متى ينتبه لانقلاب ذلك عليه في مذهبه فنقول هذا القائل اعتقد مذهب التعليم وإبطال النظر تتقليدا سماعا من أبويه أو سمع من الأبوين مذهبا ثم تنبه بعد ذلك لبطلانه فإن قال اعتقدته سماعا من الأبوين قلنا وأولاد النصارى واليهود المجوس وأولاد مخالفيكم في مسألة النظر وقع نشوؤهم على خلاف معتقدكم فبماذا تفرقون به بين أنفسكم وبينهم أبطول اللحى أو سواد الوجوه أم بسبب غيره والتقليد شامل وإن قلتم لا بل اعتقدنا مذهبكم ثم تركنا التقليد وتنبهنا لصحة مذهب التعليم قلنا تنبهتم لبطلان مذهبنا على البديهة أو بنظر العقل فإن كان على البديهة فكيف خفي عليكم البديهي في أول امركم وعلى أبائكم وعلينا ونحن العقلاء وقد طبقنا وجه الارض ذات الطول والعرض وان عرفتم ذلك بنظركم فلم وثقتم بالنظر ولعل حالكم اللاحقة كالحال السابقة فما الفارق فإن قلتم عرفنا من المعلم قلنا إن كان تقليدا فما الفرق بين التقليد للأخير والتقليد للأول وبين تقليدكم وتقليد طوائف المخالفين من اليهود والنصارى والمجوس والمسلمين وان فهمتم بالنظر فما الفرق بينكم وبين سائر النظار وهذا مما لا جواب عنه إلا أن يقال بالضرورة ندرك التفرقة بين ماعلم يقينا لا يمكن فيه الخطأ وبين ما يمكن فهكذا جوابنا.
المثال الثاني إن من غلط في مسألة حسابية ثم تنبه لها هل يتصور ان يزول شكه بعد التنبيه نجيب يعلم انه ليس مخطئا وأن الخطأ غير جائز عليه وانما كان الخطأ فيما تقدم لمقدمة شذت عنه فإن قلتم لا فقد أنكرتم المشاهدة وإن قلتم نعم فبماذا تدرك التفرقة إلا بالضرورة وقد انقلب الإشكال بعينه وكيف تنكر ذلك وقد رأيت من يدعي الذكاء والفطنه في علم الحساب حكم بأن التيامن في القبلة واجب ببلد نيسابور وأنه لا بد من الميل عن محرابها المتفق عليه إلى اليمين واستدل عليه بمقدمة مسلمة وهي ان الشمس تقف وسط السماء على سمت الرأس بمكة في اطول النهار وقت الزوال ثم قال ترى الشمس في اطول النهار وقت الزوال بنيسابور مائلة قليلا إلى يمين المستقبل في محاربها فيعلم انه على سمت رأس الواقف بمكة وأن مكة مائلة إلى اليمين فتابعه على ذلك جماعة من الحساب واعتقدوا ان ذلك هو الواجب بحكم هذا الدليل حتى تنبهوا على محل الغلط فيه وإحلالهم بمقدمة اخرى وهي أن ذلك انما يلزمه لو كان وقت الزوال بنيسابور هو وقت الزوال بمكة وليس كذلك بل يقع بعد ساعة وتكون الشمس قد أخذت إلى صوب المغرب في جانب اليمن عرضا فيرى وقت الزوال مائلا عن قبلة نيسابور لانه ليس وقت الزوال والغروب في جميع المواضع متفقا ويعرف ذلك باختلاف ارتفاع القطبين وانخفاضهما بل باستتارهما وانكشافهما في البقاع المختلفة فهذا الغلط وامثاله في الحساب أفيدل ذلك على أن النظر في الحساب ليس طريقا موصلا إلى معرفة الحق أو يتشكك المتنبه بعدها فيقول لعله شذت عني مقدمة أخرى وأنا غافل عنها كما في الأول هذا لو فتح بابه فهو السفسطة المحضة وندعو ذلك إلى بطلان العلوم والاعتقادات كلها فكيف يبقى معه وجوب التعلم ومعرفة العصمة ومعرفة إبطال النظر.
أما الدلالة الخامسة وهي قولهم ان صاحب الشرع ﷺ قال الناجي من الفرق واحدة وهم أهل السنة والجماعة ثم قال ما أنا الآن عليه وأصحابي فهذا من عجيب الاستدلالات فانهم أنكروا النظر في الأدلة العقلية لاحتمال الخطأ فيه وأخذوا يتمسكون بأخبار الآحاد والزيادات الشاذة فيها فأصل الخبر من قبيل الآحاد وهذه الزيادة شاذة فهو ظن على ظن ثم هو لفظ محتمل من وجوه التأويل ما لا حصر له فإن ما كان عليه هو وأصحابه إن اشترط جميعه في الأقوال والأفعال والحركات والصناعات كان محالا وإن أخذ بعضه فذلك البعض من يعينه ويقدره وكيف يدرك ضبطه وهل يتصور ذلك إلا بظن ضعيف وربما لا يرتضى مثله في الفقهيات مع خفة أمرها فكيف يستدل على القطعيات بمثلها على أنا نقول هم كانوا على اتباع نبي مؤيد بالمعجزة فلستم إذن من الفرقة الناجية فإنكم اتبعتم من ليس هو نبيا ولا مؤيدا بالمعجزة فسيقولون ليس تجب مساواته من كل وجه قلنا فنحن على مساواتهم من كل وجه فإنا نأمر باتباع الكتاب والسنة والاجتهاد عند العجز عن التمسك بهما كما أمر معذا به وكما استمر عليه الصحابة بعد وفاته من المشاورة والاجتهاد في الأمور فالحديث قاض لنا بالنجاة ولكم بالهلاك فإنكم إنحرفتم عن اتباع النبي المعصوم إلى غيره فان قيل ومعاني الكتاب والسنة كيف تفهمونها قلنا قد بينا أنها ثلاثة اقسام صريحة وظاهرة ومجملة وبينا لأن معرفتنا لها كمعرفة سائر الصحابة وكمعرفة من تدعون له العصمة من غير فرق فان قيل وانتم تدعون إلى نظر العقل وما كان هذا من دأب الصحابة قلنا هيهات فإنا ندعو إلى الاتباع وإلى تصديق رسول الله ﷺ في قول لا إله إلا الله محمد رسول الله فمن صدق بذلك سبقا إليه من غير منازعة ومجادلة قنعنا منه كما يقنع رسول الله ﷺ به من أجلاف العرب والناس على ثلاثة أقسام قسم هم العوام المقلدون نشئوا على اعتقاد الحق سماعا من آبائهم فهم مقرون عليه بصحة إسلامهم، الثاني الكفار الذين نشئوا على ضد الحق سماعا عن آبائهم وتقليدا فهم مدعوون عندنا إلى تقليد النبي المعصوم المؤيد بالمعجزة واتباع سنته وكتابه وأنتم تدعونه إلى معصومكم فليت شعري أينا أشبه بصحابة رسول الله ﷺ أمن يدعو إلى النبي المؤيد بالمعجزة أم من يدعو إلى من يدعى العصمة بشهوته من غير معجزة القسم الثالث من فارق حيز المقلدين وعرف ان في التقليد خطر الخطأ فصار لا يقنع به فنحن ندعوه إلى النظر في خلق السموات والأرض ليعرف به الصانع والى التفكر في معجزات النبي ﷺ ليعرف به صدقة وانتم تدعونه إلى تقليد المعصوم وتكذبون نظر العقل وتزخرفونه فليت شعري أي الدعوتين اوفق لدعوة أصحاب رسول الله ﷺ فمتى قالوا للمسترشد المتشكك إياك ونظر العقل وتأمله فإن فيه خطر الخطأ ولذلك اختلف الناظرون. بل عليك ان تقلد ما تسمعه منا من غير بصيرة وتأمل هذا لو صدر من مجنون لضحك منه ولقيل له لم نقلدك ولا نقلد من يكذبك فإذا طوى بساط الدليل المفرق بطريق النظر بينك وبين خصمك ولم يمكن درك التفرقة بالضرورة فبم تميز عن مخالفك المكذب فليت شعري من فتح باب النظر الذي يسوق إلى معرفة الحق متبعا فيه ما اشتمل عليه القرآن من الحث على التدبر والتفكر في الايات وفي القرآن وعجز الخلق عن الإتيان بمثله واستدلاله به هو أقرب إلى موافقة الصحابة وأهل السنة والجماعة أو من يؤيس الخلق عن النظر في الأدلة بالتكذيب حتى لا يبقى للدين عصام يتمسك بنه إلا الدعاوي المتعارضه وهل هذا إلا صنع من يريد ان يطفئ نور الله ويغطي شرع رسول الله صلى اللهس عليه وسلم بسد طريقه المفضى إليه فان قيل فنراكم تميلون تارة إلى الاتباع وتارة إلى النظر قلت هكذا تعتقده ولكنه في حق شخصين فالذين سعدوا بالولادة بين المسلمين فأخذوا الحق تقليدا مستغنون عن النظر وكذا الكفار إذا تيسر لهم تصديق رسول الله ﷺ تقليدا كما كان يتيسر لاجلاف العرب والذي يتشكك ويعرف غرر التقليد فلا بد له من معرفة صدقنا في قولنا لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم بعد هذا قدر على اتباع رسول الله ﷺ ولن يعرف التوحيد والنبوة إلا بالنظر في دليله الذي دل عليه الصحابة ودعا الرسول الخلق به فانه ما دعاهم بالتحكم المحض والقهر المجرد بل بكشف سبل الأدلة. فهذا صورة القول مع كل متشكك وإلا فليبرز الباطني معتقده في حقه وانه كيف ينجو عن شكه إذا حسم عليه باب التأمل والنظر.
فهذا حل هذه الشبهات وهي أرك عند المحصل من أن يفتقر في حلها إلى كل هذا الإطناب ولكن اغترار بعض الخلق به وظهور التلبيس في هذا الزمان يتقاضى هذا الكشف والإيضاح والله تعالى يوفقنا للعلم والعمل والرشد والإرشاد بمنه ولطفه.
الباب السابع في إبطال تمسكهم بالنص في إثبات الإمامة والعصمة
وفيه فصلان.
الفصل الأول في تمسكهم بالنص على الإمامة
وقد عجزت طائفة منهم عن التمسك بطريق النظر لمناقضة ذلك مسلكهم في إبطال نظر العقل وإيجاب الإتباع فعدلوا إلى منهج الإمامية بحيث استدلوا على إمامة علي رضي الله عنه بالنص وزعموا أنها مطردة في عترته فطمع هؤلاء في التمسك بالنص مع مخالفة مذهبهم مذهب الإمامية فزعموا انه عليه السلام نص على علي ونص علي على ولده حتى انتهى إلى الذي هو الآن متصد للإمامة بكونه منصوصا عليه ممن كان قبله وهذا غير ممكن لهذه الفرقة فإنهم بين التعلق فيه بأخبار آحاد لا تورث العلم ولا تفيد اليقين وثلج الصدر بل يحتمل فيه تعمد الكذب تارة والغلط فيه اخرى.
ولمنهج هؤلاء اجتووا طرق النظر في العقليات احترازا عما فيها من الخطأ فكيف يستتب لهم التمسك بأخبار الآحاد فيضطرون إلى دعوى خبر متواتر فيه من صاحب الشرع صلوات الله عليه تجري في الوضوح مجرى الخبر المتواتر في بعثته ودعوته وتحديه بالنبوة وشرعه الصلوات الخمس والحج والصوم وسائر الوقائع المستفيضة ومهما راجع العاقل بصيرته استغنى في معرفة استحالة هذه الدعوى عن مرشد يرشده ويسدد منهجه على وجه الاستحالة كيف وقد استحالت هذه الدعوى وتعذرت على الامامية في دعوى إمامة علي فقط فكيف تستتب لهؤلاء دعوى إمامة صاحبهم مع تضاعف الشغل عليهم وكثرة دعاويهم إلى أن ينساقوا إلى إثبات الإمامة لمن إعتقدوا إمامته اليوم ولكنا مع الاستغناء عن الايضاح لفساد دعواهم ننبه على ما فيه من العسر والاستحالة ونقول مدعي الإمامة اليوم لشخص معين من عترة رسول الله ﷺ يفتقر إلى نص متواتر عن رسول الله على علي رضي الله عنه ينتهي في الوضوح إلى حد الخبر المتواتر عن وجود علي ومعاوية وعمرو بن العاص فإنا بالتواتر عرفنا وجودهم ومهما ادعى تواتر هذا الخبر في زمان رسول الله ﷺ افتقر إلى حد التواتر بعده في كل عصر ينقرض حتى لا يزال النقل متواترا على تناسخ الأعصار وانقراض القرون بحيث يستوي في بلوغ المخبرين حد التواتر طرف الخبر وواسطته وهذا ممتنع يفتقر في كل واحد من علي وأولاده رضي الله عنه إلى يومنا هذا أربعة أمور الأول أن يثبت أنه مات عن ولده ولم يمت أبتر لا ولد له حتى يعرف ولده كما عرف علي رضي الله عنه وتعرف صحة انسابهم كما عرف صحة انساب علي الثاني أن يثبت أن كل واحد منهم نص على ولده قبل وفاته وجعله ولي عهده وعينه من بين سائر أولاده فانتصب للإمامة بتوليته ولم يمت واحد إلا بعد التنصيص والتعيين على ولي عهده الثالث ان ينقل أيضا خبرا متواترا انه ﷺ جعل نص جميع أولاده بمنزلة نصه في وجوب الطاعة ومصادفته لمنظنة الاستحقاق ووقوعه على المستحق للمنصب من جهة الله تعالى حتى لا يتصور وقوع الخطأ لواحد منهم في التعيين الرابع أن ينقل أيضا بقاء العصمة والصلاح للإمامة من وقت نصه على من نص عليه إلى ان توفي هو بعد نصه على غيره فلو انخرمت رتبة من هذه الرتب لم تستمر دعاويهم ولو اثبتوا تواتر نص كل واحد منهم ووجود ولده في العصر الأول فلا يغنيهم حتى يثبتوا تواتره كذلك في سائر الأعصار المتوالية بعده عصرا بعد عصر وهذه أمور لو ثبت التواتر فيها لعلمت كما يعلم وجود الانبياء ووجود الأقطار التي لم تشاهد كالصين وقيروان المغرب ووجود الوقائع كحرب بدر وصفين ولا يشترك الناس في دركه حتى كان لا يقدر أحد على أن يشكك فيه نفسه وليس يخفى أن الأمر في هذه الدعاوى بالضد إذ لو كلف الإنسان ان يتسع لتجويز ما قالوه وإمكانه لم يتمكن بل علم قطعا خلافه فكيف يتصور الطمع في إثباته وكيف يتواقحون على دعواه وقد اختلف القائلون بوجوب الإمام المعصوم في جماعة من الأئمة بزعمهم انه خلف ولدا أو لم يخلف واختلفوا في تعيين الإمامة في بعضهم واختلفوا في ظهوره فقال قائلون الإمام موجود ولكنه ليس يظهر تقية وقال آخرون هوظاهر فكيف خالفهم أصحابهم وان كانوا قد عرفوا ذلك بنص متواتر فكيف قبلوه من الآحاد ان لم يكن متواتر وقول الآحاد لا يورث إلا الظن فاستبان ان ما ذكروه طمع في غير مطمع وفزع إلى غير مفزع ومثالهم في الفرار من مسلك النظر إلى مسلك النص مثال من يميل من البلل إلى الغرق فإن المسلك الأول أقرب إلى التلبيس من هذا المسلك.
فإن قال قائل قد طولتم الأمر عليهم وأحرجتموهم إلى إثبات النص على علي ثم إثبات النص من كل واحد من أعقابه ولدا ولدا ثم صحة نسبه ثم استفاضة هذه الأخبار أولا ووسطا وآخرا وهم يستغنون عن جميع ذلك بخبر واحد وهو أن رسول الله ﷺ قال الإمامة بعدي لعلي وبعده لأولاده لا تخرج من نسبي ولا ينقطع نسبي أصلا ولا يموت واحد منهم قبل توليته العهد لولده. وهذا القدر يكفيهم قلنا نعم يكفيهم هذا القدر إن كان كل ما يخطر بالبال ويوافق شهوة الضلال يمكن اختراعه ونقله متواترا ولكن هذا على هذا الوجه لم يقع ولا نقل ولا إدعى مدع وقوعه معتقدا بالباطل ولا على سبيل العناد فضلا عن أن ينطق به عن الإعتقاد ونقل هذا النص ودعوى التواتر فيه كدعوى من نقل مضاده وهو أن الإمامة ليست لعلي بعدي وإنما هي لابي بكر وانما تكون بعده بالاختيار والشورى وان من ادعى النص أو اختصاص الإمامة بأولاده من سائر قريش فهو كاذب مبطل فكما نعلم أن هذا الخبر لم يكن ولم ينقل لاآحادا ولا تواترا نعلم ذلك فما يناقضه ومهما فتح باب الاختراع اشترك في الاقتدار عليه كل من يحاول اللجاج والنزاع وذلك مما لا يستحله ذوو الدين أصلا.
فإن قال قائل هذه الدعاوي لا تستتب لهؤلاء فهل تستتب للإمامية في دعوى النص على علي رضي الله عنه قلنا لا انما الذي يستتب لهم دعوى ألفاظ محتملة نقلها الآحاد فأما اللفظ الذي هو نص صريح فلا ودعوى التواتر أيضا لا يمكن وتيك الألفاظ كما رووا أنه قال من كنت مولاه فعلي مولاه وقوله أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلى غير ذلك من الألفاظ المحتملة لا تجري مجرى النصوص الصريحة فأما دعوى النص الصريح المتواتر فمحال من وجوه موضع استقصائها في كتاب الإمامة من علم الكلام وليس من غرضنا الآن ولكنا نذكر استحالته بمسلكين أحدهما انه لو كان ذلك متواتر لما شككنا فيه كما لم يشك في وجود علي رضي الله عنه ولا في انتصابه للخلافة بعد رسول الله ﷺ ولا في أمر رسول الله ﷺ بالصلاة والصيام والزكاة والحج فان قوله عليه السلام في التنصيص على الخلافة بعده على ملأ من الناس ليس قولا يستحقر فيستر ولا يتساهل في سماعه فيهمل بل تتوفر الدواعي على اشاعته ولا تسمح النفوس بإخفائه والسكوت عنه ولم تسمح بالسكوت عن أخبار وأحوال تقع دون ذلك في الرتبة فهذا قاطع في بطلان دعواهم الخبر المتواتر وعلى هذه الجملة فلا تتميز دعواهم عن دعوى البكرية حيث قالوا إن النبي ﷺ نص على أبي بكر رضي الله عنه نصا صريحا متواترا ولا عن دعوى الروندية إذ قالوا إنه نص على العباس نصا متواترا وهذه الأقاويل متعارضة لانها لم تعرف ولم تظهر بعد وفاة رسول الله ﷺ عند الخوض في الإمامة. فلا تبقى بعد ذلك ريبة في بطلان هذه الدعوى.
المسلك الثاني أن الذين نازعوا في إمامة أبي بكر وتصدوا للنضال عن علي رضي الله عنهما تمسكوا في نصرته بألفاظ محتملة نقلها آحاد كقوله عليه السلام من كنت مولاه فعلي مولاه وقوله أنت مني بمنزلة هارون من موسى. وكيف سكتوا عن النص المتواتر الذي لا يتطرق التأويل إلى متنه والطعن على سنده ومعلوم ان النفوس في مثل هذه المثارات تضطرب بأقصى الإمكان ولاتتعلق بالشبه إلا عند العجز عن البرهان فهذا أيضا يعرف المنصف ضرورة كذب المخترعين لهذه الأمور وإنما هداهم إلى اختراع دعوى النص المتواتر طائفة من الملحدين أرادو الطعن على الدين وهم الذين لقنوا اليهود أن ينقلوا عن موسى نصا بانه خاتم النبين وانه قال لليهود عليكم بالسبت ما دامت السموات والارضون وكان سسبيلنا في الرد عليهم ان اليهود مع ما جرى عليهم من الذل والإرقاق والسبى للذراري والأولاد وتخريب البلاد وسفك الدماء في طول زمان رسول الله ﷺ كانوا يحتالون بكل حيلة في طمس شريعته وتطفئة نوره ودفع استيلائه فلم لم ينقلوا عن موسى عليه السلام ذلك ولم لم يقولوا له ما جئت إلا بتصديق موسى وانه قال أنا خاتم النبين ومعلوم ان الدواعي تتوافر على نقل مثل ذلك توافرا لا يطاق السكوت معه وقد كان فيهم الأحبار والمتقدمون وكلهم كانوا مضطرين تحت القهر والذل متعطشين إلى دفع حجته بأقصى الجد وهذا بعينه هو الذي يكشف عن اختراع هؤلاء وتهجمهم على الإختلاق والتخرص.
فإن قيل لعله تمسك به المتمسكون إلا أنه اندرس ولم ينقل إلينا قلنا كيف نقل إلينا التمسك بالألفاظ الظاهرة ونقل المنازعة في الإمامة من الأنصار وقول قائلهم أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب والدواعي على نقل النص أوفر ولو جاز فتح هذا الباب لجاز لكل ملحد إذا احتججنا عليه بالقرآن وعجز الخلق عن معارضته وبينا به صدق محمد ﷺ أن يقول لعله عورض ولكنه لم ينقل وتعاطى المسلمون إخفاءه. فإن قيل أنتم مضطرون إلى معرفة هذا الخبر المتواتر ولكنكم تعاندون في إخفائه تعصبا قلنا ولم تنكرون على من يقلب عليكم ويقول انتم تعرفون بطلان ما ينقلون ضرورة ولكنكم تعاندون في الإختراع وبم تنفصلون عن البكرية والروندية إذا ادعوا ذلك في النص على أبي بكر والعباس رضي الله عنهما فإن قيل ألستم تدعون في معجزات الرسول ﷺ انشقاق القمر وكلام الذئب وحنين الجذع وتكثير الطعام القليل إلى غير ذلك مما أنكره كافة الكفار وطوائف من المسلمين ولم يكن خلافهم مانعا لكم من دعوى التواتر قلنا نحن لا ندعي التواتر الذي يوجب العلم الضروري إلا في القرآن أما ما عداه من هذه المعجزات فلو نقلها خلق كثير بلغوا حد التواتر لما تصوروا الشك فيها وانما نقلها جماعة دون تلك الكثرة يعرف صدقهم بضروب من الأدلة النظرية والاستدلال بالقرائن الخالية من رواتيهم ذلك وسكوت الآخرين عن الإنكار إلى غير ذلك من الأمور التي يتوصل إلى استفادة العلم منها عند إمعان النظر فيها بدقيق الفكر ومن أعرض عن النظر في تيك الدلائل والقرائن ولم يتأملها حق التأمل لم يحصل له العلم وأما انتم فلا تقنعون في خبركم بالنقل من عدد دون عدد التواتر ولا بالحاجة فيه إلى النظر والاستدلال والتأمل فانكم تبطلون طرق النظر فلا تستقيم هذه المقابلة منكم فان قيل انشقاق القمر من الآيات العلوية والبراهين السماوية فكيف يتصور ان يختص بمشاهدته عدد دون عدد التواتر قلنا ولو شاهده عدد التواتر كيف كان يتصور التردد فيه والإنكار له وهل ترى أحدا يتردد في وجود مكة ووجود أبي حنيفة والشافعي وسائر المشهورين وهي من الأمور الأرضية وهل ترى أن أحدا يتردد في أن الشمس كانت تطلع في أيام نوح عليه السلام ضربا للمثل فإن ذلك لما كان من الأمور المتواترة لم تتصور الاسترابة فيه يبقى قولكم إنه كيف اختص بمشاهدة انشقاق القمر طائفة فقد قال العلماء الأصوليون المنكرون لالتباس ما يتواتر من الأخبار هذه آية ليلية في وقت كان الناس فيه نياما أو كانوا تحت السقوف والظلال والأستار والمصحرون منهم المنتبهون لا تستحيل عليهم الغفلة في لحظة فيكون ذلك مثل انقضاض كوكب تختص بمشاهدته شرذمة قليلة وذلك ممكن فلم يكن الانشقاق أمرا دائما زمانا طويلا فليس يمتنع أن يختص بمشاهدته من حدق إليه بصره ممن كان حول رسول الله ﷺ حيث احتج على قريش بانشقاق القمر وقال قائلون أيضا يحتمل أن يكون الله تعالى خصص برؤية ذلك من حاج النبي ﷺ في تلك الساعة وناظره حيث قال ﷺ آيتي أنكم ترفعون روؤسكم فترون القمر منشقا وحجب الله أبصار سائر الخلق عن رؤيته بحجاب أو سحاب أو تسليط عقله وصرف داعية النظر لمصلحة الخلق فيه حتى لا يتحدى لنفسه بعض الكذابين في الأمصار فيستدل به على صدق نفسه أو يكون معجزة للنبي ﷺ من وجهين خارقين للعادة أحدهما إظهاره لهم والآخر اخفاؤه عن غيرهم وهذه الاحتمالات ذكرها العلماء حتى قال بعضهم ان انشقاق القمر ثبت بالقرآن وهو قوله تعالى: {اقتربت الساعة وانشق القمر} والكلام فيه طويل وعلى الأحوال كلها فما بلغ حد التواتر لا يتصور التشكك فيه هذه قاعدة معلومة عليها تبنى جميع قواعد الدين ولولاه لما حصلت الثقة بأخبار التواتر ولما عرفنا شيئا من أقوال رسول الله ﷺ إلا بالمشاهدة والكلام في هذا يحتمل الإطناب ولكنه بعيد عن مقصود الكتاب فرأيت الإيجاز فيه أولى.
الفصل الثاني في إبطال قولهم إن الإمام لا بد أن يكون معصوما من الخطأ والزلل والصغائر والكبائر
فنقول لهم وبماذا عرفتم صحة كونه معصوما ووجود عصمته أبضرورة العقل أو بنظره أو سماع خبر متواتر عن رسول الله ﷺ يورث العلم الضروري ولا سبيل إلى دعوى الضرورة ولا إلى دعوى الخبر المتواتر المفيد للعلم الضروري لان كافة الخلق تشترك في دركه وكيف يدعي ذلك وأصل وجود الأمام لا يعرف ضرورة بل نازع منازعون فيه فكيف تعلم عصمته ضرورة وان ادعيتم ذلك بنظر العقل فنظر العقل عندكم باطل وان سمعتم من قول إمامكم أن العصمة واجبة للإمام فلم صدقتموه قبل معرفة عصمته بدليل آخر وكيف يجوز أن تعرف إمامته وعصمته بمجرد قوله.
على أنا نقول أي نظر عرفكم وجوب عصمة الإمام فلا بد من الكشف عنه فإن قيل الدليل عليه وجوب الاتفاق على كون النبي ﷺ معصوما ولم نحكم بوجوب عصمته إلا لأنا بواسطته نعرف الحق ومنه نتلقفه ونستفيده ولو جوزنا عليه الخطأ والمعصية سقطت الثقة بقوله فما من قول يصدر عنه إلا ونتصور أن يقال لعله أخطأ فيه أو تعتمد الكذب فإن المعصية ليست مستحلية عليه وذلك مما لا وجه له فكذلك الإمام منه نلتقي الحق واليه نرجع في المشكلات كما كنا نرجع إلى رسول الله ﷺ فانه خليفته وبه نستضئ في مشكلات التأويل والتنزيل وأحوال القيامة والحشر والنشر. فإن لم تثبت عصمته فكيف يوثق به قلنا مثار غلطكم ظنكم أنا نحتاج إلى الإمام لنستفيد منه العلوم ونصدقه فيها وليس كذلك فإن العلوم منقسمة إلى عقلية وسمعية أما العقلية فتنقسم إلى قطعية وظنية ولكل واحد من القطع والظن مسلك يفضي إليه ويدل عليه وتعلم ذلك ممن يعلمه ولو من افسق الخلق ممكن فانه لا تقليد فيه وانما المتبع وجه الدليل وأما السمعيات فمسندها سماع اما متواتر وإما آحاد والمتواتر تشترك الكافة في دركه ولا فرق بين الإمام وبين غيره والآحاد لا تفيد إلا ظنا سواء كان المبلغ إليه أو المبلغ الإمام أو غيره والعمل بالظن فيما يتعلق بالعمليات واجب شرعا والوصول إلى العلم فيه ليس بشرط ولذلك يجب عندهم تصديق الدعاة المنتشرين في أقطار الأرض مع أنه لا عصمة لهم أصلا وكذلك كان ولاة رسول الله ﷺ في زمانه فإذا لا حاجة إلى عصمة الإمام فإن العلوم يشترك في تحصيلها الكل والإمام لا يولد عالما ولا يوحي إليه ولكنه متعلم وطريق تعلم غيره كتعلمه من غير فرق.
فإن قيل فلماذا نحتاج إلى الإمام إذ كان يستغنى عنه في التعليم قلنا ولماذا يحتاج في كل بلد إلى قاض وهل يدل الاحتياج إليه على أنه لا بد أن يكون معصوما فيقولون انما نحتاج إليه لدفع الخصومات وجمع شتات الأمور وجزم القول في المجتهدات وإقامة حدود الله تعالى واستيفاء حقوقه وصرفها إلى مستحقيها إذ لا سبيل إلى تعطيلها ولا سبيل إلى تفويضها إلى كافة الخلق فيتزاحمون عليها متقاتلين ويتكاسلون عنها متواكلين ومتخاذلين فتعطل الأمور فجملة الدنيا في حق الإمام كبلدة واحدة في حق القاضي فكما يستغنى عن عصمة القاضي في البلد ويحتاج إلى قضائه فكذلك يستغنى عن عصمة الإمام ويحتاج إليه كما يحتاج إلى القضاة ولأمور أخر كلية سياسية من حراسة الإسلام والذب عن بيضته والنضال دون حوزته وحشد العساكر والجنود إلى أهل الطغيان والعناد وتطهير وجه الأرض عن الطغاة والبغاة والساعين في الأرض بالفساد وملاحظة أطراف البلاد بالعين الكالئة حتى إذا ثارت فتنة بادر إلى الأمر بتطفئتها وإذا نبغت نابغة تقدم عى الفور بإزالتها قبل أن تسحكم غائلتها وتستطير في الأرض نائرتها هذا وما يجري مجراه هو الذي يراد لاجله الإمام وذلك يحتاج إلى عدالة وعلم ونجدة وكفاية وصرامة وشرائط آخر سنذكرها في الباب التاسع.
فأما العصمة فيستغنى عنها كما في حق القضاة والولاة فإن منعوا وإدعوا العصمة للقضاة والولاة وكل مترشح لإمر من الأمور من جهة الإمام وهذا ما اعتقده الإمامية حتى اورد عليهم الحارس والمتعسس والبواب ويرتبط بكل واحد منهم أمر فأجابوا بأن هذه الأمور إنا كانت أمورا دينية شرطت العصمة في المتكفلين بها والمنتصب لها بنصب الإمام لا يكون إلا معصوما ونعوذ بالله من اعتقاد مذهب يضطر ناصره والذاب عنه إلى ان يجاحد ما يشاهده ويدركه على البديهة والضرورة فالظلم على طبقات الناس مشاهد من أحوال المتصبين من جهة إمامهم ولا ينفك أورع متدين منهم عن استحلال الأموال المغصوبة باسم الخراج والضريبة من أموال المسلمين العلم بتحريمه ومهما انتهى كلام الخصم إلى مجاحدة الضرورة فلا وجه إلا الكف عنه والاقتصار على تعزيته فيما اصيب به من عقله.
الباب الثامن في الكشف عن فتوى الشرع في حقهم من التفكير وسفك الدم
ومضمون هذا الباب فتاوى فقهية ونحصر مقصوده في فصول أربعة
الفصل الأول في تكفيرهم أو تضليلهم أو تخطئتهم
ومهما سئلنا عن واحد منهم أو عن جماعتهم وقيل لنا هل تحكمون بكفرهم لم نتسارع إلى التكفير إلا بعد السؤال عن معتقدهم ومقالتهم ونراجع المحكوم عليه أو نكشف عن معتقدهم بقول عدول يجوز الاعتماد على شهادتهم فإذا عرفنا حقيقة الحال حكمنا بموجبه.
ولمقالتهم مرتبتان إحداهما توجب التخطئة والتضليل والتبديع والأخرى توجب التكفير والتبري.
فالمرتبة الأولى وهي التي توجب التخطئة والتضليل والتبديع هي أن تصادف عاميا يعتقد أن استحقاق الإمامة في أصل البيت وأن المستحق اليوم المتصدي لها منهم وأن المستحق لها في العصر الأول كأن هو على رضي الله عنه فدفع عنها بغير استحقاق وزعم مع ذلك أن الإمام معصوم عن الخطأ والزلل فانه لا بد أن يكون معصوما ومع ذلك فلا يستحل سفك دمائنا ولا يعتقد كفرنا ولكنه يعتقد فينا أنا أهل البغى زلت بصائرنا عن درك الحق خطأ إذ عدلنا عن اتباعه عنادا ونكدا فهذا الشخص لا يستباح سفك دمه ولا يحكم بكفره لهذه الاقاويل بل يحكم بكونه ضالا مبتدعا فيزجر عن ضلاله وبدعته بما يقتضيه رأي الإمام فأما أن يحكم بكفره ويستباح دمه بهذه المقالات فلا وهذا انما يقتصر على تضليله وتبديعه إذ لم يعتقد شيئا مما حكينا من مذهبهم في الإلهيات وفي أمور الحشر والنشر ولكنه لم يعتقد في جميع ذلك إلا ما نعتقده وانما تميز عنا بالقدرالذي حكيناه الآن فأن قيل هلا كفر تموهم بقولهم أن مستحق الإمامة في الصدر الأول كان عليا دون أبي بكر وعمر ومن بعده وأنه دفع بالباطل وفي ذلك خرق الإجماع أهل الدين قلنا لا ننكر ما فيه من القحوم على خرق الإجماع ولذلك ترقينا من التخطئة المجردة (التي نطلقها ونقتصر عليها في الفروع في بعض المسائل) إلى التضليل والتفسيق والتبديع ولكن لا تنتهي إلى التكفير فلم يبن لنا أن خارق الإجماع كافر بل الخلاف قائم بين المسلمين في أن الحجة هل تقوم بمجرد الإجماع (وقد ذهب النظام وطائفته إلى إنكار الإجماع وأنه لا تقوم به حجة أصلا) فمن التبس عليه هذا الأمر لم نكفره بسببه واقتصرنا على تخطئته وتضليله فأن قيل وهلا كفرتموهم لقولهم أن الإمام معصوم والعصمة عن الخطأ والزلل وصغير المآثم وكبيرها من خاصية النبوة فكأنهم أثبتوا خاصية النبوة لغير النبي ﷺ قلنا هذا لا يوجب الكفر وإنما الموجب له أن يثبت النبوة لغيره بعده وقد ثبت أنه خاتم النبيين أو يثبت لغيره منصب النسخ لشريعته فأما العصمة فليست خاصية النبوة ولا إثباتها كإثبات النبوة فلقد قالت طوائف من أصحابنا العصمة لا تثبت للنبي من الصغائر واستدلوا عليه بقوله تعالى: {وعصى آدم ربه فغوى} وبجملة من حكايات الأنبياء فمن يعتقد في فاسق أنه مطيع ومعصوم عن الفسق لا يزيد على من يعتقد في مطيع أنه فاسق ومنهمك في الفساد ولو اعتقد إنسان في عدل أنه فاسق لم يزد على تخطئة من اعتقد في غير معصوم أنه معصوم كيف يحكم بكفره نعم يحكم بحماقته واعتقاده أمرا يكاد يخالف المشاهد من الأحوال وأمرا لا يدل عليه نظر العقل ولا ضرورته.
فإن قيل فلو اعتقد معتقد فسق أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وطائفة من الصحابة فلم يعتقد كفرهم فهل تحكمون بكفره قلنا لا نحكم بكفره وإنما نحكم بفسقه وضلاله ومخالفته لإجماع الأمة وكيف نحكم بكفره ونحن نعلم أن الله تعالى لم يوجب على من قذف محصنا بالزنا إلا ثمانين جلدة ونعلم أن هذا الحكم يشتمل كافة الخلق ويعمهم على وتيرة واحدة وأنه لو قذف قاذف أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بالزنا لما زاده على إقامة حد الله المنصوص عليه في كتابه ولم يدعوا لأنفسهم التمييز بخاصية في الخروج عن مقتضى العموم فإن قيل فلو صرح مصرح بكفر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ينبغي أن ينزل منزلة من لو كفر شخصا آخر من آحاد المسلمين أو القضاة والأئمة من بعدهم قلنا هكذا نقول فلا يفارق تكفيرهم تكفير غيرهم من آحاد الأمة والقضاة بل أفراد المسلمين المعروفين بالإسلام إلافي شئين أحدهما في مخالفة الإجماع وخرقه فأن مكفر غيرهم ربما لا يكون خارقا لإجماع معتد به الثاني أنه ورد في حقهم من الوعد بالجنة والثناء عليهم والحكم بصحة دينهم وثبات يقينهم وتقدمهم على سائر الخلق أخبار كثيرة فقائل ذلك إن بلغته الأخبار واعتقد مع ذلك كفرهم فهو كافر لا بتكفيره إياهم ولكن بتكذيبه رسول الله ﷺ فمن كذبه بكلمة من أقاويله فهو كافر بالإجماع ومهما قطع النظر عن التكذيب في هذه الأخبار وعن خرق الإجماع نزل تكفيرهم منزله سائر القضاة والأئمة وآحاد المسلمين فإن قيل فما قولكم فيمن يكفر مسلما أهو كافر أم لا قلنا إن كان بعرف أن معتقده التوحيد وتصديق الرسول ﷺ إلى سائر المعتقدات الصحيحة فمهما كفره بهذه المعتقدات فهو كافر لأنه رأى الدين الحق كفرا وباطلا فأما إذا ظن أنه يعتقد تكذيب الرسول أو نفى الصانع أو تثنيته أو شيئا مما يوجب التفكير فكفره بناء على هذا الظن فهو مخطئ في ظنه المخصوص بالشخص صادق في تكفير من يعتقد ما يظن أنه معتقد هذا الشخص وظن الكفر بمسلم ليس بكفر كما أنظن الإسلام بكافر ليس بكفر فمثل هذه الظنون قد تخطئ وتصيب وهو جهل بحال شخص من الأشخاص وليس من شرط دين الرجل أن يعرف إسلام كل مسلم وكفر كل كافر بل ما من شخص يفرض إلا ولو جهله لم يضره في دينه بل إذا آمن شخص بالله ورسوله وواظب على العبادات ولم يسمع باسم أبي بكر وعمر ومات قبل السماع مات مسلما فليس الإيمان بهما من أركان الدين حتى يكون الغلط في صفاتهما موجبا للانسلاخ من الدين وعند هذا ينبغى أن يقبض عنان الكلام فإن الغوص في هذه المغاصة يفضي إلى إشكالات وإثارة تعصبات وربما لا تذعن جميع الأذهان لقبول الحق المؤيد بالبرهان لشدة ما يرسخ فيها من المعتقدات المألوفة التي وقع النشوء عليها والتحق بحكم استمرار الاعتياد بالأخلاق الغريزية التي يتعذر إزالتها وبالجملة لقول فيما يوجب الكفر والتبرى وما لا يوجبه لا يمكن استيفاؤه في أقل من مجلدة وذلك عند إيثار الاختصار فيه فلنقتصر في هذا الكتاب على الغرض المهم.
المرتبة الثانية المقالات الموجبة للتكفير
وهي أن يعتقد ما ذكرناه ويزيد عليه فيعتقد كفرنا واستباحة أموالنا وسفك دمائنا فهذا يوجب التكفير لا محالة لأنهم عرفوا أننا نعتقد أن للعالم صانعا واحدا قادرا عالما مريدا متكلما سميعا بصيرا حيا ليس كمثله شيءوأن رسوله محمد بن عبد الله ﷺ صادق في كل ما جاء به من الحشر والنشر والقيامة والجنة والنار وهذه الاعتقادات هي التي تدور عليها صحة الدين فمن رآها كفرا فهو كافر لا محالة فإن أنصاف إلى هذا شيء مما حكى من معتقداتهم من إثبات إلهين وإنكار الحشر والنشر وجحود الجنة والنار والقيامة فكل واحد من هذه المعتقدات موجب للتكفير صدر منهم أو من غيرهم فأن قيل لو اعتقد معتقد وحدانية الإله ونفى الشرك ولكنه تصرف في أحوال النشر والحشر والجنة والنار بطريق التأويل للتفصيل دون إنكار الأصل بل اعترف بأن الطاعة وموافقة الشرع وكف النفس عن المحرمات والهوى سبب يفضي إلى السعادة وأن الاسترسال على الهوى ومخالفة الشرع فيما أمر ونهى يسوق صاحبه إلى الشقاوة ولكنه زعم أنا لسعادة عبارة عن لذة روحانية تزيد لذتها على اللذة الجسمانية الحاصلة من المطعم والمنكح اللذين تشترك فيهما البهائم وتتعالى عنهما رتبة الملكية وانما تلك السعادة اتصال بالجواهر العقلية الملكية وابتهاج بنيل ذلك الكمال واللذات الجسمانية محتقرة بالإضافة إليها وأنا لشقاوة عبارة عن كون الشخص محجوبا عن ذلك الكمال العظيم محله الرفيع شأنه مع التشوق إليه والشغف به وأن ألم ذلك يستحقر معه ألم النار الجسمانية وأن ما ورد في القرآن مثله ضرب لعوام الحلق لما قصر فهمهم عن درك تلك اللذات فانه لو تعدى النبي في ترغيبه وترهيبه إلى ما ألفوه وتشوقوا إليه وفزعوا منه لم تنبعث دواعيهم للطلب والهرب فذكر من اللذات أشرفها عندهم وهي المدركات بالحواس من الحور والقصور إذ تحظى بها حاسة البصر ومن المطاعم والمناكح إذ لحظى بها القوة الشهوانية وما عند الله لعباده الصالحين خير من جميع ما اعربت عنه العبارات ونبهت عليه ولذلك قال تعالى فيما حكى عنه النبي ﷺ أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وكل ما يدرك من الجسمانيات فقد خطر على قلب بشر أو يمكن إخطاره بالقلب وزعم هذا القائل أن المصلحة الداعية إلى التمثيل للذات والآلام بالمالوف منها عند العوام كالمصلحة في الألفاظ الدالة على التشبيه في صفات الله تعالى وأنه لو كشف لهم الغطاء ووصف لهم جلال الله الذي لا تحيط به الصفات والاسماء وقيل لهم صانع العالم موجود ليس بجوهر ولا عرض ولا جسم ولا هو متصل بالعالم ولا هو منفصل عنه ولا هو داخل فيه ولا خارج عنه وأن الجهات محصورة في ست وأنسائر الجهات فارغة منه وليس شاغلا لواحد منها فلا داخل العالم به مشغول ولا خارج العالم عنه مشغول لبادر الخلق إلى إنكار وجود فإن عقولهم لا تقوى على التصديق بوجود موجود ترده الاوهام والحواس فذكر لهم ما يشير إلى ضروب التمثيل ليرسخ في نفوسهم التصديق باصل الوجود فيسارعون إلى امتثال الأوامر تعظيما له إلى الانزجار عن المعاصي مهابة منه فيمن هذا منهاجه.
قلنا اما القول بالهين فكفر صريح لا يتوقف فيه واما هذا فربما يتوقف فيه الناظر ويقول إذا اعترفوا باصل السعادة والشقاوة وكون الطاعة والمعصية سبيلا اليهما فالنزاع في التفصيل كالنزاع في مقادير الثواب والعقاب وذلك لا يوجب تكفيرا فكذلك النزاع في التفصيل والذي نختاره ونقطع به انه لا يجوز التوقف في تكفير من يعتقد شيئا من ذلك لانه تكذيب صريح لصاحب الشرع ولجميع كلمات القرأن من اولها إلى اخرها فوصف الجنة والنار لم يتفق ذكره مرة واحدة أو مرتين ولا جرى بطريق كناية أو توسع وتجوز بل بألفاظ صريحة لا يتمارى فيها ولا يستراب وأن صاحب الشرع اراد بها المفهوم من ظاهرها فالمصير إلى ما أشار إليه هذا القائل تكذيب وليس بتاويل فهو كفر صريح لا يتوقف فيه اصلا ولذلك نعلم على القطع انه لو صرح مصرح بإنكار الجنة والنار والحور والقصور فيما بين الصحابة لبادروا إلى قتله واعتقدوا ذلك منه تكذيبا لله ولرسوله فإن قيل لعلهم كانوا يفعلون ذلك ويبالغون فيه حسما لباب التصريح به إذ مصلحة العامة تقتضي أن لا يجرى الخطاب معهم إلا بما يليق بافهامهم ويؤثر في نفوسهم واثارة دواعيهم وإذا رفعت عن نفوسهم هذه الظواهر وقصرت عقولهم عن درك اللذات العقلية أنكروا الاصل وجحدوا الثواب والعقاب وسقط عندهم تمييز الطاعة عن العصيان والكفر عن الايمأن قلنا فقد اعترفت باجماع الصحابة على تكفير هذا الرجل وقتله لانه مصرح به ونحن لم نزرد على أن المصرح به كافر نجب قتله وقد وقع الاتفاق عليه وبقى قولكم أن سبب تكفيرهم مراعاة مصلحة العوام وهذا وهم وظن محض لا يعنى عن الحق شيئا بل نعلم قطعا انهم كانوا يعتقدون ذلك تكذيبا لله تعالى ولرسوله وردا لما ورد به الشرع ولم يدفعه العقل فان قيل فهلا سلكتم هذا المسلك في التمثيلات الواردة في صفات الله تعالى من آية الاستواء وحديث النزول ولفظ القدم ووضع الجبار قدمه في النار ولفظ الصورة في قوله عليه السلام أن الله خلق آدم عليه السلام على صورته إلى غير ذلك من أخبار لعلها تزيد على الف وانتم تعلمون أن السلف الصالحين ما كانوا يؤولون هذه الظواهر بل كانوا يجرونها على الظاهر ثم انكم لم تكفروا منكر الظواهر ومؤولها بل اعتقدتم التأويل وصرحتم به قلنا كيف تستتب هذه الموازنة والقرآن مصرح بانه {ليس كمثله شيء} والأخبار الدالة عليه أكثر من أن تحصى ونحن نعلم انه لو صرح مصرح فيما بين الصحابة بأن الله تعالى لا يحويه مكان ولا يحده زمان ولا يماس جسما ولا ينفصل عنه بمسافة مقدرة وغير مقدرة ولا يعرض له انتقال وجيئة وذهاب وحضور وأفول وأنه يستحيل أن يكون من الآفلين والمنتقلين والمتمكنين إلى غير ذلك من نفي صفات التشبيه لرأوا ذلك عين التوحيد والتنزيل ولوأنكر الحور والقصور والأنهار والأشجار والزبانية والنار لعد ذلك من أنواع الكذب والإنكار ولا مساواة بين الدرجتين وقد نبهنا على الفرق في باب الرد عليهم في مذهبهم بوجهين آخرين أحدهما أنالألفاظ الواردة في الحشر والنشر والجنة والنار صريحة لا تأويل لها ولا معدل عنها إلا بتعطيلها وتكذيبها والألفاظ الواردة في مثل الاستواء والصورة وغيرهما كتايات وتوسعات على اللسان تحتمل التأويل في وصفه والآخر ان البراهين العقليه يدفع اعتقاد التشبيه والنزول والحركه والتمكن من المكان وتدل على استحالتها دلاله لا يتمارى فيها ودليل العقل لا يحيل وقوع ما وعد به من الجنه والنار في الآخره بل القدره الأزليه محيطه بها مستوليه عليها وهي أمور ممكنه في نفسها ولا تتقاصر القدرة الأزلية عما له نعت الإمكان في ذاته فكيف يشبه هذا بما ورد من صفات الله تعالى ومساق هذا الكلام يتقاضى بث جملة من أسرار الدين أن شرعنا في استقصائها ورغبنا في كشف غطائها وإذ ورد ذلك معترضا في سياق الكلام غير مقصود في نفسه فلنقتصر على هذا القدر الذي انطوى في هذا الفصل ولنشتغل بما هو الأهم من مقاصد هذا الكتاب وقد بينا في هذا الفصل من يكفر منهم ومن لا يكفر ومن يضل ومن لا يضل.
الفصل الثاني في أحكام من قضي بكفره منهم
والقول الوجيز فيه أنه يسلك مسلك المرتدين في النظر في الدم والمال والنكاح والذبيحة ونفوذ الأقضية وقضاء العبادات أما الأرواح فلا يسلك بهم مسلك الكافر الأصلي إذ يتخير الإمام في الكافر الأصلي بين أربع خصال بين المن والفداء والاسترقاق والقتل ولا يتخير في حق المرتد بل لا سبيل إلى استرقاقهم ولا إلى قبول الجزية منهم ولا إلى المن والفداء وإنما الواجب قتلهم وتطهير وجه الأرض منهم هذا حكم الذين يحكم بكفرهم من الباطنية وليس يختص جواز قتلهم ولا وجوبه بحالة قتالهم بل نغتالهم ونسفك دماءهم فإنهم مهما اشتغلوا بالقتال جاز قتلهم وأن كانوا من الفرقة الأولى التي لم يحكم فيهم بالكفر وهو أنهم عند القتال يلتحقون بأهل البغي والباغي يقتل ما دام مقبلا على القتال وإن كان مسلما إلا أنه إذا أدبر وولى لم يتبع مدبرهم ولم يوقف على جريحهم أما من حكمنا بكفرهم فلا يتوقف في قتلهم إلى تظاهرهم بالقتال وتظاهرهم على النضال.
فان قيل هل يقتل صبيانهم ونساؤهم قلنا أما الصبيان فلا فإنه لا يؤاخذ الصبي وسيأتي حكمهم وأما النسوان فإنا نقتلهم مهما صرحن بالاعتقاد الذي هو كفر على مقتضى ما قررناه فإن المرتدة مقتولة عندنا بعموم قوله ﷺ من بدل دينه فاقتلوه نعم للإمام أن يتبع فيه موجب اجتهاده فإن رأى أن يسلك فيهم مسلك أبي حنيفة ويكف عن قتل النساء فالمسألة في محل الاجتهاد ومهما بلغ صبيانهم عرضنا الإسلام عليهم فإن قبلوا قبل إسلامهم وردت السيوف عن رقابهم إلى قربها وإن أصروا على كفرهم متبعين فيه آباءهم مددنا سيوف الحق إلى رقابهم وسلكنا بهم مسلك المرتدين وأما الأموال فحكمها حكم أموال المرتدين فما وقع الظفر به من غير إيجاف الخيل والركاب فهو فيء كمال المرتد فيصرفه إمام الحق على مصارف الفيء على التفصيل الذي اشتمل عليه قوله تعالى: {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول} الآية وما استولينا عليه بإيجاف خيل وركاب فلا يبعد أن يسلك به مسلك الغنائم حتى يصرف إلى مصارفها كما اشتمل عليه قوله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه} الآية وهذا أحد مسالك الفقهاء في المرتدين وهو أولى ما يقضى به في حق هؤلاءوأن كانت الأقاويل مضطربة فيه.
ومما يتعلق بالمال أنهم إذا ماتوا لا يتوارثون فلا يرث بعضهم بعضا ولا يرثون من المحقين ولا يرث المحق ما لهم إذا كان بينهم قرابة بل ولاية الوراثة منقطعة بين الكفار والمسلمين.
وأما أبضاع نسائهم فإنها محرمة فكما لا يحل نكاح مرتدة لا يحل نكاح باطنية معتقدة لما حكمنا بالتكفير بسببه من المقالات الشنيعة التي فصلناها ولو كانت متدينة ثم تلقفت مذهبهم أنفسخ النكاح في الحال أن كان قبل المسيس ويوقف على انقضاء العدة بعد المسيس فان عادت إلى الدين الحق وانسلخت عن المعتقد الباطل قبل تصرم العدة بقضاء مدتها استمر النكاح على وجهه وأن اصرت واستمرت حتى انقضت المدة وتصرمت العدة تبين أنفساخ النكاح من وقت الردة ومهما تزوج الباطني المحكوم بكفره بامرأة من أهل الحق أو من أهل دينه فالنكاح باطل غير منعقد بل تصرفه في ماله بالبيع وسائر العقود مردود فإن الذي اخترناه في الفتوى الحكم بزوال ملك المرتدين بالردة.
ويتصل بتحريم المناكحة تحريم الذبائح فلا تحل ذبيحة واحد منهم كما لا تحل ذبيحة المجوسي والزنديق فان الذبيحة والمناكحة تتحاذيان فهما محرمتان في حق سائر أصناف الكفار إلا اليهود والنصارى لأن ذلك تخفيف في حقهم لانهم أهل كتاب انزله الله تعالى على نبي صادق ظاهر الصدق مشهور الكتاب. واما اقضية حكامهم فباطلة غير نافذة وشهادتهم مردودة فإن هذه أمور يشترط الإسلام في جميعها فمن حكم بكفره من جملتهم لم تصح منه هذه الأمور بل لا تصح عبادتهم ولا ينعقد صيامهم وصلاتهم ولا يتأدى حجهم وزكاتهم ومهما تابوا وتبرءوا عن معتقداتهم وحكمنا بصحة توبتهم وجب عليهم قضاء جميع العبادات التي فاتت والتي اديت في حالة الكفر كما يجب ذلك على المرتد.
فهذا هو القدر الذي أردنا أن ننبه عليه من جملة أحكامهم.
فإن قيل ولماذا حكمتم بإلحاقهم بالمرتدين والمرتد من التزم بالدين الحق وتطوقه ثم نزع عنه مرتدا ومنكرا له وهؤلاء لم يلزموا الحق قط بل وقع نشوؤهم على هذا المعتقد فهلا ألحقتموهم بالكافر الاصلي قلنا ما ذكرناه واضح في الذين انتحلوا أديانهم وتحولوا اليها معتقدين لها بعد اعتقاد نقيضها أو بعد الانفكاك عنها وأما الذين نشئوا على هذا المعتقد سماعا من آبائهم فهم أولاد المرتدين لأن آباءهم وآباء آبائهم لابد أن يفرض في حقهم تنحل هذا الدين بعد الانفكاك عنه فإنه ليس معتقدا يستند إلى نبي وكتاب منزل كاعتقاد اليهود والنصارى بل هي البدع المحدثة من جهة طوائف من الملحدة والزنادقة في هذه الاعصار القريبة المتراخية وحكم الزنديق أيضا حكم المرتد لا يفارقه في شيء أصلا وانما يبقى النظر في أولاد المرتدين وقد قيل فيهم إنهم أتباع في الردة كأولاد الكفار من أهل الحرب وأهل الذمة وعلى هذا فأن بلغ طولب بالإسلام وإلا قتل ولم يرض منه بالجزية ولا الرق وقيل إنهم كالكفار الأصليين إذ ولدوا على الكفر فإذا بلغوا وآثروا الاستمرار على كفر آبائهم جاز تقريرهم بالجزية وضرب الرق عليهم وقيل إنه يحكم بإسلامهم لأن المرتد مؤاخذ بعلائق الإسلام فإذا بلغ ساكتا فحكم الإسلام يستمرإلى أن يعرض عليه الإسلام فأن نطق به فذاك وأن أظهر كفر أبويه عند ذلك حكمنا بردته في الحال وهذا هو المختار عندنا في صبيان الباطنية فإن علقة من علائق الإسلام كافية للحكم بإسلام الصبيان وعلقة الإسلام باقية على كل مرتد فإنه مؤاخذ بأحكام الإسلام في حال ردته وقد قال ﷺ كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. فيحكم بإسلام هؤلاء ثم إذا بلغوا كشف لهم عن وجه الحق ونهوا عن فضائح مذهب الباطنية وذلك بكشف للمصغى إليه في أوحى ما يقدر وأسرع ما ينتظر فإن أبى إلا دين آبائه فعند ذلك يحكم بردته من وقته ويسلك به مسلك المرتدين.
الفصل الثالث في قبول توبتهم وردها
وقد ألحقنا هؤلاء بالمرتدين في سائر الأحكام وقبول التوبة من المرتد لابد منه بل الأول ألا يبادر إلى قتله إلا بعد استتابته وعرض الإسلام عليه وترغيبه فيه وأما توبة الباطنية وكل زنديق مستتر بالكفر يرى التقية دينا ويعتقد النفاق واظهار خلاف المعتقد عند استشعار الخوف حقا ففي هذا خلاف بين العلماء ذهب ذاهبون إلى قبولها لقوله ﷺ: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. ولأن الشرع إنما بنى الدين على الظاهر فنحن لا نحكم إلا بالظاهر والله يتولى السرائر والدليل عليه أن المكره إذا أسلم تحت ظلال السيوف وهو خائف على روحه نعلم بقرينة حاله انه مضمر غير ما يظهره فنحكم بإسلامه ولا نلتفت إلى المعلوم بالقرائن من سريرته ويدل عليه أيضا ما روي أن أسامة قتل كافرا فسل عليه السيف بعد أن تلفظ بكلمة الإسلام فاشتد ذلك على رسول الله ﷺ فقال أسامة إنما فعل ذلك فرقا من السيف فقال ﷺ: هلا شققت عن قلبه. منبها به على أن البواطن لا تطلع عليها الخلائق وإنما مناط التكليف الأمور الظاهرة ويدل عليه أيضا أن هذا صنف من أصناف الكفار وسائر أصناف الكفار لا يسد عليهم طريق التوبة والرجوع إلى الحق فكذلك هاهنا.
وذهب ذاهبون إلى أنه لا تقبل توبته وزعموا أن هذا الباب لو فتح لم يمكن حسم مادتهم وقمع غائلتهم فإن من سر عقيدتهم التدين بالتقية والاستسرار بالكفر عند استشعار الخوف فلو سلكنا هذا المسلك لم يعجزوا عن النطق بكلمة الحق واظهار التوبة عند الظفر بهم فيلهجون بذلك مظهرين ويستهزئون بأهل الحق مضمرين وأما الخبر فانما ورد في اصناف من الكفار دينهم انه لايجوز التصريح بما يخالفه وأن من التزام الإسلام ظاهرا صار تاركا للتهود والتنصر هذا معتقدهم ولذلك تراهم يقطعون اربا اربا بالسيوف وهم مصرون على كفرهم ولا يسمحون في موافقة المسلمين بكلمة فاما من كان دينه أن النطق بكلمة الإسلام غير ترك لدينه بل دينه أن ذلك عين دينه فكيف نعتقد بتوبته مما هو عين دينه والتصريح به وفاء لشرط دينه كيف يكون تركا للدين.
هذا ما ذكر من الخلاف في قبول توبتهم وقد استقصينا ذلك في كتاب شفاء العليل في اصول الفقه ونحن الآن نقتصر على ذكر ما نختاره في هذه الفرقة التي فيهم الكلام فنقول للنائب من هذه الضلالة أحوال الحالة الأولى أن يتسارع إلى اظهار التوبة واحد منهم من غير قتال ولا ارهاق واضطرار ولكن على سبيل الايثار والاختيار متبرعا به ابتداء من غير خوف واستشعار هذا ينبغي أن يقطع بقبول توبته فإنا أن نظرنا إلى ظاهر كلمته صدقناها موافقة لعين الإسلام وأن نظرنا إلى سريرته كان الغالب أنها على مطابقة اللسان وموافقته فإنا لم نعرف الآن له باعثا على التقية وإنما المباح عندهم إظهار نقيض المعتقد تقية عند تحقيق الخوف فأما في حالة الاختيار فهو من أفحش الكبائر ويعضد ذلك بأمر كلي وهو أنه لا سبيل إلى حسم باب الرشد عليهم فكم من عامي ينخدع بتخيل باطل ويغتر برأي قائل ثم ينتبه من نفسه أو ينبهه منبه لما هو الحق فيؤثر الرجوع إليه والشروع فيه بعد النزوع عنه فلا سبيل إلى حسم مسلك الرشاد على ذوي الضلال والعناد.
الحالة الثانية الذي يسلم تحت ظلال السيوف ولكنه من جملة عوامهم وجهالهم لا من جملة دعاتهم وضلالهم فهذا أيضا تقبل توبته فمن لم يكن مترشحا للدعوة فضرر كفره مقصور عليه في نفسه ومهما أظهر الدين احتمل كونه صادقا في إسراره وإظهاره ولعامي الجاهل يظن أن التلبيس بالأديان والعقائد مثل المواصلات والمعاقدات الاختبارية فيصلها مدة بحكم المصلحة ويقطعها أخرى وباطنه يوافق الظاهر فيما يتعاطاه من التزام وإعراض ولذلك ترى من يسبي من العبيد والإماء من بلاد الكفر إلى دارالإسلام يدينون بدينهم معتقدين وشاكرين لله على ما أتاح لهم من الرشد ورحض عنهم من وضر الكفر والغي ولو سئلوا عن السبب في تبديل الدين وإيثار الحق المبين على الباطل لم يعرفوا له سببا إلا موافقة السادة على وفق مصلحة الحال ثم ذلك يؤثر في باطن عقائدهم كما نرى ونشاهد فإذا عرف أن العامي سريع التقلب فنصدقه في انقلابه إلى الحق كما نصدقه في إضرابه عنه إذا ظهر من معتقده خلاف الحق فإنا بين أن نغضى عن كافر مستسر ولا نقتله بل نتعامى عنه أو نهجم على قتل مسلم ظاهرا أو باطنا أن كان مضمرا لما يظهر وليس في التغاضي عن كفر كافر ليست له دعوه تنتشر وليس فيه شر يتعدى كبير محظور فكم مننا على الكفار وأغضينا عنهم ببذل الدينار فليس ذلك ممتنعا أما اقتحام الخطر في قتل من هو مسلم ظاهرا ويحتمل ان يكون مسلما باطنا احتمالا قويا فمحظور.
الحاله الثالثة أن ننظر بواحد من دعاتهم ممن يعرف منه أنه يعتقد بطلان مذهبه ولكنه ينتحله غير معتقد له ليتوصل إلى استمالة الخلق وصرف وجوههم إلى نفسه طلبا للرياسة وطمعا في حطام الدنيا هذا هو الذي يتقي شره والأمر فيه منوط برأي الإمام ليلاحظ قرائن أحواله ويتفرس من ظاهره في باطنه ويستبين أن ما ذكره يكون إذعانا للحق واعترافا به بعد التحقق والكشف أو هو نفاق وتقية وفي قرائن الأحوال ما يدل عليه والأولى ألا يوجب على الإمام قتله لا محالة ولا أنيحرم قتله بل يفوض إلى اجتهاده فإن غلب على ظنه أنه سالك منهج التقية فيما أداه قتله وأن غلب على ظنه أنه تنبه للحق وظهر له فساد الأقاويل المزخرفة التي كان يدعو اليها قبل توبنه وأغضى عنه في الحال وأن بقيت به ريبة وكل به من يراقب أحواله ويتفقده في بواطن أمره ويحكم فيه بموجب ما يتضح له منه فهذا هو المسلك القصد القريب من الإنصاف والبعيد من التعصب والاعتساف.
الفصل الرابع في حيلة الخروج عن إيمانهم وعهودهم إذا عقدوها على المستجيب
فإن قال لنا قائل ما قولكم في عهودهم ومواثيقهم وأيمانهم المعقودة على المستجيبين هل تنعقد وهل يجوز الحنث فيها أم يجب الحنث أو يحرم وأن حنث الحالف يلزمه بسببه معصية وكفارة أم لا يلزم وكم من شخص عقد عليه العهد وأكدت عليه اليمين فتطوقه اغترارا بتخيلهم ثم لما انكشف له ضلالهم تمنى افتضاحهم والكشف عن عوراتهم ولكن منعته الأيمان المغلظة المؤكدة عليه فالحاجة ماسة إلى تعليم الحيلة في الخروج عن تلك الأيمان فنقول الخلاص من تلك الأيمان ممكن ولها طرق تختلف باختلاف الأحوال والألفاظ.
الأول أن يكون الحالف قد تنبه لخطر اليمين وإمكان اشتماله على تلبيس وخداع فذكر في نفسه عقيب ذلك الاستثناء وهو قوله إن شاء الله فلا ينعقد ولا يمتنع عليه الحنث وإذا حنث لم يلزمه بالحنث حكم أصلا وهذا حكم كل يمين أردف بكلمة الاستثناء كقوله والله لأفعلن كذا أن شاء الله وكقوله أن فعلت كذا فزوجتي طالق إن شاء الله وما جرى مجراه.
الثاني أن يؤدي في يمينه أمرا وينوي خلاف ما يلتمس منه ويضمر خلاف ما يظهر ويكون الإضمار على وجه يحتمله اللفظ فيدبر بينه وبين الله عز وجل فله أن يخالف ظاهر كلامه ويتبع فيه موجب ضميره ونيته فإن قيل الاعتماد في اليمين على نية المستحلف إذ لو عول على نية الحالف واستثنائه لبطلت الأيمان في مجالس القضاة ولم يعجز المحلف بين أيديهم عن إضمار نية وإسرار استثناء وذلك يؤدي إلى إبطال الحقوق. قلنا القياس أن يكون التعويل على نية الحالف واستثنائه فإنه الحالف والمحلف عارض عليه اليمين ولكنه حكم باتباع نية المستحلف مراعاة للحقوق وصيانة لها بحكم الضرورة الداعية إليه وذلك في المحق في التحليف الموافق للشرع وموارد التوقيف فيه فأما المكره ظلما والمخادع عدوانا وغشما فلا ويعتبر أمر الحالف معه في القانون القياسي في الاعتبار بجانب الحالف لأن سبب العدول إلى اعتبار جانب المستحلف شدة الحاجة وأي حاجة بنا إلى تسليط الظلمة على تأكيد اليمين على ضعفاء المسلمين بأنواع الخداع والتلبيس فيجب الرجوع فيه إلى القانون.
الثالث أن ينظر إلى لفظ الحلف فإن قال عليك عهد الله وميثاقه وما أخذ على النبيين والصديقين من العهود وإن أظهرت السر فأنت بريء من الإسلام والمسلمين أو كافر بالله رب العالمين أو جميع أموالك صدقة لا ينعقد بهذه الألفاظ يمين أصلا فإنه أن قال أن فعلت كذا فأنا بريء من الإسلام ومن الله ورسوله لم تكن هذه يمينا لقوله ﷺ من حلف فليحلف بالله أو فليصمت الحلف بالله أن يقول تالله ووالله وما يجري مجراه وقد استقصينا صريح الإيمان في فن الفقه وهذه الألفاظ ليست من جملتها وكذا قوله على عهد الله وميثاقه وما أخذه الله على النبيين فإنه إذا لم يأخذ الله ميثاقهم وعهده لا ينعقد ذلك بقول غيره والله تعالى لم يأخذ ميثاقهم على كتمان سر الكفار والضلال ولا هذا العهد مماثل عهد الله فلا يلزم به شيء وكذلك لو قال الإنسان أن فعلت كذا فأموالي صدقة لا يلزمه شيء إلا أن يقول فلله على إن أتصدق بمالي وهو يمين الغضب واللجاج ويخلصه على الرأي المختار كفارة يمين.
الرابع أن ينظر إلى المحلوف عليه فإن كان لفظ المخلف فيه ما حكيناه في نسخة عهودهم وهو قولهم تكتم سر ولى الله وتنصره ولا تخالفه فليظهر السر مهما اراد ولا يكون حانثا لانه حلف على كتمان سر ولى الله تعالى وقد كتمه وانما الذي افشاه سر عدو الله وكذا قولهم تنصر اقاربه واتباعه فكل ذلك يرجع إلى ولى الله ولا يرجع إلى من قصده المحلف لانه عدو الله لا وليه فاما إذا عين شخصا بالاشارة أو عرفه باسمه الذي يعرف به قال تكتم سرى أو قال تكتم سر فلان ولى الله أو سر هذا الشخص الذي هو ولى الله فقد قال قائل لا يحنث عند افشاء السر نظرا إلى الصفة واعراضا عن الاشارة وقالوا هو كما لو قال بعت منك هذه النعجة والمشار إليه رمكة فإنه لا يصح والمختار عندنا أن الحنث يحصل والاشارة المعرفة المعينة التي لا يتطرق اليها الكذب بحال اعلى واغلب من الوصف المذكور كذبا على وجه الفضول مع الاستغناء وليس هذا كما لو قال والله لأشربن ماء هذه الإداوة ولا ماء فيها أن اليمين لا تعنقد لانه لا وجود لمتعلق اليمين وكذلك لو ترك الاضافة إلى الاداوة وذكر قوله هذا الماء واشار باليد لم ينعقد لفقد المتعلق ها هنا ولو اقتصر على قوله لا يفشى سر هذا الشخص أو سر زيد انعقد وأن سكت عن قوله انه ولى الله ومهما انعقدت اليمين على هذا الوجه فيباح افشاء السر بل يجب افشاء السر ثم تلزم الكفارة كفارة يمين ويكفيه أنيطعم عشرة مساكين كل مسكين مدا من الطعام فإن عجز عن هذا صام ثلاثة أيام وما اهون الخطب في ذلك ولا حاجة إلى التانق في طلب الحيلة للخلاص من هذا القدر فإنه قريب محتمل ثم لا يعصي بالحنث لقوله ﷺ من حلف على يمين فراى غيرها خيرا منها فليات الذي هو خير وليكفر عن يمينه ومن حلف أن يزني ولا يصلي وجب عليه الحنث ولزمته الكفارة فهذا جار مجرى ذلك.
الخامس إذا ترك الحالف النية والاستثناء وترك المحلف لفظ العهد والميثاق ولفظ ولي الله وأتى بأيمان صريحة بالله وبتعليق الطلاق والعتاق في مماليكه الموجودين وزوجاته وفيما سيملك من بعد إلى آخر عمره وعلق بالحنث لزوم مائة حجة وصيام مائة سنة وصلاة الف الف ركعة والتصدق بالف دينار وما جرى هذا المجرى فطريقه في اليمين بالله أن يطعم عشرة مساكين أو يصوم عند العجز كما سبق وهذا أيضا يخلصه عن تعليق الصدقة والحج والصيام والصلاة بالحنث لأنذلك يمين غضب ولحاج لا يلزم الوفاء بموجبه واما تعليق الطلاق والعتق فيما سيملك من النساء والعبيد والاماء فباطل غير منعقد فيلحنث ولينكح من شاء متى شاء إذ لا طلاق قبل نكاح ولا عتاق فبل ملك وإن كان في ملكه رقيق وخاف من عنقه فطريقه أن بيعه من اهله أو من ولده أو من صديقه ثم يفشى السر ثم يستعيده إلى ملكه بالشراء أو الاستيهاب أو بما شاء ولا يعجز أحد عن صديق يثق بصداقته وامانته فيبيعه منه ثم يرده عليه مهما اراد واما زوجته إن حلف بطلاقها فيخالعها بدرهم معها أو مع اجنبي ويفشى السر ثم يجدد نكاحها فيا لحوق الطلاق بعده فإن قبل إن كان قد طلق قبل ذلك تطليقتين ولم تبق له إلا طلقة واحدة وفي الخلع ما يحرمها عليه إلى أن تنكح زوجا غيره فما سبيله قلنا سبيله أن يقول مهما وقع عليك طلاقي فانت طالق قبله ثلا ثا فمهما حنث لا يقع طلاقه وهذه هي اليمين الدائرة التي تخلص من الحنث وتمنع وقوع الطلاق فإن قيل فقد اختلف العلماء في ذلك وربما لا يرتضى المتورع اقتحام شبهة الطلاق قلنا السائل إن كان مقلدا فعليه تقليد المفتي ومتابعته وعهدة الطلاق يختص بتطوقها المفتى دون المقلد وأن كان المفتى مجتهدا فعليه موجب اجتهاده فإن أدى اجتهاده إلى ذلك لم يمنع وقوع الطلاق فهو مخير بين أن يستبدل بها غيرها أو يسكت عن إفشاء سرهم فيترك معتقدهم وليس في السكوت عن إفشاء ما قالوه موافقة لهم في الدين بل الموافقة في أن يعتقد ما اعتقدوه وأن يعرب عن اعتقاده ويدعو إليه فأن صرف ضلالهم ظاهرا وباطنا فليس يلزمه أن ينطق بما سمعه منهم إذ ليس يتعين حكاية الكفر عن كل كافر فهذه طرق الحيل في الخروج عن اليمين وذهب بعض الخائضين في هذا الفن إلى أن الأيمان الصادرة منهم لا تنعقد بحال وهو كلام يصدر عن قلة البصيرة بالأحكام الفقهية وإنما الموافق لتصرف الفقة وأحكام الشرع الذي ذكرناه والسلام.
الباب التاسع في إقامة البراهين الشرعية على أن الإمام القائم بالحق الواجب على الخلق طاعته في عصرنا هذا هو الإمام المستظهر بالله حرس الله ظلاله
والمقصود من هذا الباب بيان إمامته على وفق الشرع وأنه يجب على كافة علماء الدهر الفتوى على البت والقطع بوجوب طاعته على الخلق ونفوذ أقضيته بمنهج الحق وصحة توليته للولاة وتقليده للقضاة وبراءة ذمة المكلفين عند صرف حقوق الله تعالى إليه وأنه خليفة الله على الخلق وأن طاعته على كافة الخلق فرض.
فهذا باب يتعين من حيث الدين صرف العناية إلى تحقيقه وإقامة البرهان على منهج الحق وطريقه فإن الذي يسير إليه الكلام أكثر المصنفين في الإمامة يقتضي ألا نعتقد في عصرنا هذا وفي أعصار منقضية خليفة غير مستجمع لشرائط الإمامة متصف بصفاتهم فتبقى الإمامة معطلة لا قائم بها ويبقى المتصدي لهامتعدياعن شروط الإمامة غير مستحق لها ولا متصف بها وهذا هجوم عظيم على الأحكام الشرعية وتصريح بتعطيلها وإهمالها ويتداعى إلى التصريح بفساد جميع الولايات وبطلان قضاء القضاة وضياع حقوق الله تعالى وحدوده وإهدار الدماء والفروج والأموال والحكم ببطلان الأنكحة الصادرة من القضاة في أقطار الأرض وبقاء حقوق الله تعالى في ذمم الخلق فإن جميع ذلك لا يتأدى على وفق الشرع إلا إذا صدر استيفاؤها من القضاة ومصدر القضاة تولية الإمام فإن بطلت الإمامة بطلت التولية وانحلت ولاية القضاة والتحقوا بآحاد الخلق وامتنعت التصرفات في النفوس والدماء والفروج والأموال وانطوى بساط الشرع بالكلية في هذه المهمات العظيمة فالكشف عن فساد كل مذهب يتداعى إلى هذه العظائم من مهمات الدين وفرائضه إلا أن تقرير ذلك متوعر وترتيبه مع الاحتراز عن التهدف للاشكالات والاعتراضات متعسر ونحن بتوفيق الله نكشف الغطاء عنه فنقول ندعى أن الإمام المستظهر بالله حرس الله أيامه هو الإمام الحق الواجب الطاعة فإن طولنا باقامة البرهان عليه تدرجنا في تحقيقه وتلطفنا في تفهيمه إلى أن يعترف المستريب فيه بالحق ويلوح له وجه الصواب والصدق ونقول لابد من امام في كل عصر ولا مترشح للإمامة سواه فهو الإمام الحق إذا فهذه نتيجة بنيناها على مقدمتين احداهما قولنا لا بد من الإمام والاخرى قولنا لا يترشح للإمامة سواه ففي ايهما النزاع فإن قيل بم تنكرون على من لا يسلم انه لا بد من امام بل يقول لنا غنية عنه قلنا هذا سؤال اتفقنا نحن والباطنية وسائر اصناف المسلمين على بطلانه فإنهم أجمعوا وتطابقوا على أنه لا بد من إمام وإنما نزاعهم في التعيين لا في الأصل ولم يذهب أحد إلى أن الأمام لا يجب نصبه وأنه يستغنى عنه إلا رجل يعرف بعبد الرحمن بن كيسان ولا يستريب محصل في بطلان مذهبه وفساد معتقده وكأننا ننبه المسترشد بمسكين الأول هو أن ابن كيسان مسوق فيما يدعيه باجماع الأمة قاطبة ولقد هجم بما انتحل من المذهب على خرق الاجماع وتضمخ برذيلة العدول عن سنن الاتباع فليلاحظ العصر الأول كيف تسارع الصحابة بعد وفاة رسول الله ﷺ إلى نصب الإمام وعقد البيعة وكيف اعتقدوا ذلك فرضا محتوما وحقا واجبا على الفور والبدار وكيف اجتنبوا فيه التوانى والاستئخار حتى تركوا بسبب الاشتغال به تجهيز رسول الله ﷺ وعلموا انه لو تصرم عليهم لحظة لاامام لهم فربما هجم عليهم حادثة ملمة وارتكبوا في حادثة عظيمة تتشتت فيها الآراء وتختلف متبوعا مطاعا يجمع شتات الآراء لا نخرم النظام وبطل العصام وتداعت بالانفصام عرى الأحكام فلاجل ذلك اثروا البدار إليه ولم يعرجوا في الحال إلا عليه وهذا قاطع في أن نصب الإمام أمر ضروري في حفظ الإسلام.
المسلك الثاني هو أن نقول لا يتمارى متدين في أن الذب عن حوزة الدين والنضال دون بيضته والانتداب لنصرته وحراسته بالمحافظة على نظام أمور جند الإسلام وعدته أمر ضروري واجب لابد منه وان النظام لا يستمر على الدوام إلا بمترصد يكلا الخلق بالعين الساهرة فمهما شرابت فئة للثوران وكشرت عن نابها واشرفت على الاستحكام بادر إلى تطفئتها وحسم غائلتها فانها لو تركت حتى إذا ثارت اشتغل بتطفئتها العوام والطغام والافراد والاحاد لأفضى ذلك إلى التعادي والتضاد وصارت الأمور شورى وبقي الناس فوضى مهملين سدى متهافتين على ورطات الردى مقتحمين فيه مسالك الهوى ومناهج المنى وعند ذلك تتناقض الارادات وتتنازع الشهوات وتفضي بالآخرة إلى استيلاء الرذائل على الفضائل وتوثب الطغام علماء الإسلام والاماثل وتمتد الأيدي إلى الأموال والفروج وأصبحت الأيدي السافلة عالية وليس يخفى ما في ذلك من حل عصام الأمور الدينية والدنيوية فيتبين بهذا للناظر البصير أن الإمام ضرورة الخلق لا غنية لهم عنه في دفع الباطل وتقرير الحق فقد ثبتت هذه المقدمة وهي أن الإمام لا بد منه.
فإن قيل وبم تنكرون على من ينازع في المقدمة الثانية وهي قولكم لا يترشح للإمامة سواه فإن الباطنية يدعون الخلق إلى مترشح لها غير ما إليه دعوتكم فكيف تستنب لكم هذه الدعوى. قلنا لا تنكر دعوى بعض المدعين للإمامة بغير استحقاق ولكنا نقول إذا بطل ما تدعيه الباطنية تعينت الإمامة لم يدعيهاوحصل ما نرومه ونبتغيه فانه إذا لم يكن بد من امام وفاقا وثبت ان الإمامة لا تعدو شخصين وثبت بطلان الإمامة في حق واحد لم تبق ريبة في ثبوتها للثاني والمسالك الدالة على إبطال الإمامة التي تدعيها الباطنية وترجيح الإمامة التي ندعيها أكثر من ان تدخل تحت الحصر فلسنا نسلك فيه مسلك الاستقصاء ولكنا نقتصر على دليلين واقعين قاطعين تقربهما كل عين ويشترك في دركهما الفطن والغبي والمحنك والصبي والمعاند والمنصف والمقتصد والمتعسف.
الأول هو أن عصام شرائط صحة العقيدة وسلامة الدين ولقد حكينا عن مذهب الباطنية وصاحبهم ما اقتضى ادنى درجاته التبديع والتضليل واعلاه التكفير والتبرى وذلك في إثباتهم الهين قديمين على ما اطبق عليه جميع فرقهم.
والثاني في إنكارهم الحشر والنشر والجنة والنار وجملة ما اشتمل عليه وعد القران ووعيده بفنون من التاويلات باطلة وذلك مما نعلم انه لو ذكر شيء منه في زمان رسول الله ﷺ وعصر الصحابة بعده لبادروا إلى حز الرقبة ولم يتماروا انه صريح التكذيب لله ورسوله فمن كذب الله في وحدانيته ولم يصدق بالايات الواردة في التوحيد ولم يصدق بالقيامة والبعث والنشور كيف يصلح ان ينتصب منصب الإمامة وان يناط به عرى الإسلام وهذا المسلك يتحققه الناظر إذا تصفح ثم رجع إلى مذاهبهم التي ذكرناها في إبطالها فيصح له بمجموع النظرين ما ذكرناه من اختلال الدين وفساد العقيدة واني يصلح للإمامة من فيه مثل هذه الرذيلة.
المسلك الثاني ان نسلم جدلا على سبيل التبرع والتقرير لمورد هذا السؤال ان صاحب الباطنية صالح للإمامة بصفاء الاعتقاد وصحة الدين وحصول سائر الشروط فمسلك الترجيح غير منحسم فان الإمامة التي ندعيها اجمع عليها ائمة العصر وعلماء الدهر بل جماهير الخلق واقاليم الارض في أقصى المشرق وفي أقصى المغرب حتى تطوق الطاعة له والانقيادلامره كل من على بسيط الارض الاشر ذمة الباطنية ولو جمع قضهم وقضيضهم وصغيرهم وكبيرهم لم يبلغ عددهم عدد أهل بلدة واحدة من متبعي الإمامة العباسية فكيف إذا قيسوا باهل ناحية أو باهل اقليم أو بكافة من على وجه الارض من منتحلي الإمام أفيتمارى المنصف في أن الغلاة من الباطنية على أهل الحق لو جمع منهم الصغير والكبير لم يبلغ عشر العشير من ناصري هذه الدولة القاهرة ومتبعي هذه العصابة المحقة وإذا كانت الإمامة تقوم بالشوكة وانما تقوى الشوكة بالمظاهرة والمناصرة والكثرة في الاتباع والاشياع وتناصر أهل الاتفاق والاجتماع فهذا اقوى مسلك من مسالك الترجيح وهذا بعد أن اعطيناهم بطريق المسامحة والتبرع صحة دينهم ووجود شروط الإمامة في صاحبهم.
فإن قيل ليس ينكر منكر كثرة هذه العصابة بالاضافة اليهم ولكن الحق لا يتبع الكثرة فان الحق خفى لا يستقل بدركه إلا الاقلون والباطل جلى يبادر إلى الانقياد له الاكثرون وانتم فقد بنيم الترجيح على قيام الشوكة بكثرة الانصار والاشباع وهذا انما يستقيم لو كانت الإمامة في اصلها تنعقد باجتماع الخلق على الطاعة فان ذلك لايرجح عند التجويز والاختلاف بالكثرة وليس الأمر كذلك بل الإمامة انما تنعقد عند الباطنية بالنص والمنصوص عليه محق بويع أو لم يبايع قل مبايعوه أو كثروا والمخالف له مبطل ساعدته دولته فكثر بسببها اتباعه أو لم تساعده فمن أي وجه يصح الاستدلال بكثرة الاتباع قلنا انما يستبين وجه دلالة الكثرة من فهم ماخذ الإمامة وقد بان انها ليست ماخوذة من النص كما قدرناه في الباب السابع ونبهنا على حماقة من يدعى تواتر النص من كل واحد منهم على ولده بل بينا جهل من يدعى ذلك في على رضي الله عنه فان ذلك لو كان لاستدل به على ولم يعجز عن اظهاره ولا رضى به فخو الذي جر العساكر والجنود في زمان معاوية حتى قتل من إبطال الإسلام في تلك المعارك الوف ولم يكترث بقتلهم فما الذي كان نزعه واشياعه عن الاستدلال بنص رسول الله ﷺ وقد بينا ان ذلك يقابله دعوى البكرية في النص على أبي بكر رضي الله عنه ودعوى الروندية في النص على العباس رضي الله عنه فإذا بطل تلقى الإمامة من النص لم يبق إلا الاختيار من أهل الإسلام والاتفاق على التقديم والانقياد وعند ذلك يبين انه مهما وقع الاتفاق على نصب واحد كما اتفقوا في بداية امامة العباسية فمن طمح إلى طلبها لنفسه كان باغيا فانهم لو اختلفوا في مبدأ الأمر وجب الترجيح بالكثرة في ذلك عند تقابل العدد وتقاربهم فكيف إذا اطبق كل من شرقت عليهم الشمس شارقة وغاربة لم يخالفهم إلا فئة معدودة وشرذمة يسيرة لا يؤبه ولا يعبأ بهم لشذوذهم بالاضافة إلى الخلق الكثير والجم الغفير الذين هم في مقابلتهم (ولا عشر العشر من أعشارهم وما هم إلا كالحسوة في البحر الزاخر والموج المتلاطم).
فان قيل وبم تنكرون على من يقول لا ماخذ للإمامة إلا لنص أو الاختيار فإذا بطل الاختيار ثبت النص ويدل على بطلان الاختيار انه لايخلو اما ان يعتبر فيه اجماع كافة الخلق أو اجماع كافه أهل الحل والعقد من جملة الخلق في جميع أقطار الأرض أو يعتبر إجماع أهل البلد الذي يسكنه الإمام ويقدر باجماع عشرة أو خمسة أو عدد مخصوص أو يكتفي بمبايعة شخص واحد وباطل ان يعتبر فيه اجماع كافة الخلق في جميع أقطار الارض فان ذلك غير مكن ولا مقدور لاحد من الأئمة ولا فرض ذلك أيضا في الاعصار الخالية للائمة الماضين وباطل ان تعتبر اجماع جميع أهل الحل والعقد في جميع افطار الارض لان ذلك مما يمتنع أو يتعذر تعذرا يفتقر فيه إلى انتظار مدة عساها تزيد على عمر الإمام فتبقى الأمور في مدة الانتظار مهملة ولانه لما عقدت البيعة لابي بكر رضي الله عنه لم ينتظر انتشار الأخبار إلى سائر الامصار ولا تواتر كنب البيعة من اقاصي الأقطار بل اشتغل بالإمامة وخاض في القيام بموجب الزعامة محتكما في أوامره ونواهيه على الخاصة والعامة وإذا بطل اشتراط اجماع كافة الخلق وكافة أهل الحل والعقد فالتخصيص بعد ذلك تحكم إذ ليس من يشترط باتفاق أهل بلدة بأولى ممن يكتفي بأهل محلة أو قرية أو لم يشترط اتفاق أهل ناحية أو اقليم ومن لا يشترط اجماع أربعين أو خمسة أو أربعة أو اثنين بأولى من غيره من الاعداد وهذه المقدرات قد ذهب إلى التحكم بها ذاهبون بمجرد التشهى من غير مستند فلا يبقى إلا الاكتفاء ببيعة شخص واحد وفي الأشخاص كثرة وأحوالهم متعارضة ولا يترجح شخص على شخص إلا بالعصمة فيجب ان يكون إذا مولى العهد واحد وليكن ذلك الشخص معصوما وهو معتقدنا وعند هذا لا تنفع الكثرة في المخالفين لذلك الواحد المتميز بخاصية عن غيره فإذا لا معتصم في الكثرة التي تعلقتم بها قلنا نعم لا ماخذ للإمامة إلا النص أو الاختيار ونحن نقول مهما بطل النص ثبت الاختيار وقولهم ان الاختيار باطل لانه لايمكن اعتبار كافة الخلق ولا الاكتفاء بواحد ولا التحكم بتقدير عدد معين بين الواحد والكل فهذا جهل بمذهبنا الذي نختاره ونقيم البرهان على صحته والذي نختاره انه يكتفي بشخص واحد يعقد البيعة للامام مهما كان ذلك الواحد مطاعا ذا شوكة لا تطال ومهما كان مال إلى جانب مال بسببه الجماهير ولم يخالفه إلا من لا يكرث بمخالفته فالشخص الواحد المتبوع المطاع الموصوف بهذه الصفة إذا بايع كفى إذ في موافقته الجماهير فان لم يحصل هذا الغرض إلا لشخصين أو ثلاثة فلابد من اتفاقهم وليس المقصود اعيان المبايعين وانما الغرض قيام شوكة الإمام بالاتباع والاشياع وذلك يحصل بكل مستول مطاع ونحن نقول لما بايع عمر ابا بكر رضي الله عنهما انعقدت الإمامة له بمجرد بيعته ولكن لتتابع الايدي إلى البيعة بسبب مبادرته ولو لم يبايعه غير عمر وبقى كافة الخلق مخالفين أو انقسموا انقساما متكافئا لا يتميز فيه غالب عن مغلوب لما انعقدت الإمامة فان شرط ابتداء الانعقاد قيام الشوكة وانصراف القلوب إلى المشايعة ومطابقة البواطن والظواهر على المبايعة فان المقصود الذي طلبنا له الإمام جمع شتات الاراء في مصطدم تعارض الاهواء ولا تتفق الارادات المتنافضة والشهوات المتباينة المتنافرة على متابعة راى واحد إلا إذا ظهرت شوكته وعظمت نجدته وترسخت في النفوس رهبته ومهابته ومدار جميع ذلك على الشوكة ولا تقوم الشوكة إلا بموافقة الاكثرين من معتبري كل زمان.
فإذا بان أن هذا مأخذ الإمامة فليس يتمارى في أن الجهة الشريفة التي ننصرها قد صرف الله وجوه كافة الخلق اليها وجبل قلوبهم على حبها ولذلك قامت الشوكة له في أقطار الارض حتى لو ظهر باغ يظهر خلافا في هذا الجناب الكريم ولو بأقصى الصين أو المغرب لبادروا إلى اختطافه وتطهير وجه الارض منه متقربين إلى الله تعالى.
وقد لاح لك الآن كيف ترقينا من هذه المغاصة المظلمة وكيف دفعنا ما أشكل على جميع جماهير النظار من تعيين المقدار في عدد أهل الأخيار إذا لم نعين له عددا بل اكتفينا بشخص واحد يبايع وحكمنا بانعقاد الإمامة عند بيعته لا لتفرده في عينه ولكن لكون النفوس محموله على متابعة ومبايعة من أذعن هو لطاعته وكان في متابعته قيام قوة الإمام وشوكته وانصراف قلوب الخلائق إلى شخص واحد أو شخصين أو ثلاثة على ما تقتضيه الحال في كل عصر ليس أمرا اختيارا يتوصل إليه بالحيلة البشرية بل هو رزق إلهي يؤتيه الله من يشاء فكانا في الظاهر رددنا تعيين الإمامة إلى اختيار شخص واحد وفي الحقيقة رددناها إلى اختيار الله تعالى ونصبه إلا أنه يظهر اختيار الله عقيب متابعة شخص واحد أو أشخاص وإنما المصحح لعقد الإمامة انصراف قلوب الخلق لطاعته والانقياد له في أمره ونهيه وهذه نعمة وهدية من الله تعالى فإذا أتاحها لعبد من عباده وصرف إلى محبته وجوه أكثر خلقه وكان ذلك من الله تعالى لطفا في اختياره لخلافته وتعيينه للاقتداء بأوامره في تفقد عباده وذلك أمر لا يقدر كل البشر على الاحتيال لتحصيله.
فلينظر الناظر إلى مرتبة الفريقين إذا نسيت الباطنية أنفسها إلى أن نصب الإمام عندهم من الله تعالى وعند خصومهم من العباد ثم لم يقدروا على بيان وجه نسبة ذلك إلى الله تعالى إلا بدعوى الاختراع على رسوله في النص على على ودعوى بقاء ذلك في ذريته بقاء كل خلف لكل واحد ودعوى تنصيصه على أحد أولاده بعد موته إلى ضروب من الدعاوى الباطلة ولما نسبونا إلى أنا ننصب الإمام بشهوتنا واختيارنا ونقموا ذلك منا كشفنا لهم بالآخرة أنا لسنا نقدم إلا من قدمه الله فان الإمامة عندنا تنعقد بالشوكة والشوكة تقوم بالمبايعة والمبايعة لا تحصل إلا بصرف الله تعالى القلوب قهرا إلى الطاعة والموالاة وهذا لا يقدر عليه البشر ويدلك عليه انه لو اجمع خلق كثير لا يحصى عددهم على أن يصرفوا وجوه الخلق وعقائدهم عن الموالاة للإمامة العباسية عموما وعن المشايعة للدولة المستظهرية أيدها الله بالدوام خصوصا لافنوا اعمارهم في الحيل والوسائل وتهيئة الأسباب والوصائل ولم يحصلوا في اخر الأمور إلا على الخيبة والحرمان.
فهذا طريق إقامة البرهان على أن الإمام الحق هو أبا العباس أحمد المستظهر بالله حرس الله ظلاله في هذا العصر ولم يبق الاحسم مطاعن المنكرين في دعواهم اختلال شرائط الإمامة وفوات صفات الأئمة وها نحن نبين وجه الحق فيه في معرض سؤال وجواب.
فإن قال قائل ما ذكرتموه من الترجيح وتعيين هذه الجهة الكريمة لمن يستحق الإمامة انما يستتب إذا أظهر تم وجود شرائط الإمامة وصفات الأئمة ولها شروط كثيرة لا تنعقد دون شروطها بل لو تطرق الخلل إلى شرط من شرائطها امتنع انعقادها ففصلوا الشروط وبينوا تحققها حتى نسلم لكم ثبوت الإمامة ونبطل مذهب القائلين بأن هذا العصر والأعصار الخالية القربية كانت خالية عن الإمام لفقد شروط الإمامة في المترشحين لها.
الجواب إن الذي عده علماء الإسلام من صفات الأئمة وشروط الإمامة تحصرها عشر صفات ست منها خلقية لا تكتسب وأربع منها تكتسب أو يفيد الاكتساب فيها مزيدا فأما الست الخلقية فلا شك في حضورها ولا تتصور المجاحدة في وجودها الأولى البلوغ فلا تنعقد الإمامة لصبي لم يبلغ الثانية العقل فلا تنعقد لمجنون فإن التكليف ملاك الأمر وعصامه ولا تكليف على صبي ومجنون الثالثة الحرية فلا تنعقد الإمامة لرقيق فإن منصب الإمامة يستدعي استغراق الأوقات في مهمات الخلق فكيف ينتدب لها من هو كالمفقود في حق نفسه الموجود لمالك يتصرف تحت تدبيره وتسخيره كيف وفي اشتراط نسب قريش ما يتضمن هذا الشرط إذ ليس يتصور الرق في نسب قريش بحال من الأحوال الرابعة الذكورية فلا تنعقد الإمامة لامرأة وان اتصفت بجميع خلال الكمال وصفات الاستقلال وكيف تترشح امرأة لمنصب الإمامة وليس لها منصب القضاء ولا منصب الشهادة في أكثر الحكومات الخامسة نسب قريش لا بد منه لقوله ﷺ الأئمة من قريش واعتبار هذا مأخوذ من التوقيف ومن اجماع أهل الاعصار الخالية على أن الإمامة ليست إلا في هذا النسب ولذلك لم يتصد لطلب الإمامة غير قرشي في عصر من الاعصار مع شغف الناس بالاستيلاء والاستعلاء وبذلهم غاية الجهد والطاقة في الترقي إلى منصب العلا ولذلك لما هم المخالفون بمصر لطلب هذا الأمر ادعوا أولا لانفسهم الاعتزاء إلى هذا النسب علما منهم بان الخلق متطابقون على اعتقادهم لانحصار الإمامة فيهم السادسة سلامة حاسة السمع والبصر إذ لا يتمكن الاعمى والاصم من تدبير نفسه فكيف يتقلد عهدة العالم ولذلك لم يستصلحا لمنصب القضاء واضاف مصنفون إلى هذا اشتراط السلامة من البرص والجذام والزمانة وقطع الاطراف وسائر العيوب الفاحشة المنفرة وانكره منكرون وقالوا لا حاجة إلى وجود السلامة من هذه الامراض فان التكفل بامور الخلق والقيام بمصالحهم لا تستدعيها ولم يرد من الشارع توقيف وتعبد فيها وليس من غرضنا بيان الصحيح من المذهبين وانما المقصود ان هذه الصفات الست غريزية لا يمكن اكتسابها وهي بجملتها حاضرة حاصلة فلا تثور منها شبهة المعاندة أما الصفات الأربع المكتسبة وهي النجدة والكفاية والعلم والورع فقد اتفقوا على اعتبارها ونحن نبين وجود القدر المشروط لصحة الإمامة في الإمام المستظهر بالله امير المؤمنين ثبت الله دولته وان امامته على وفق الشرع وانه يجب على كل مفت من علماء الدهر ان يفني على القطع بوجوب طاعته على الخلق ونفوذ اقضيته بالحق وبصحة توليته للولاة وتقليده للقضاة وصرف حقوق الله إليه ليصرفها إلى مصارفها وبوجهها إلى مظانها ومواقعها ونتكلم في هذه الصفات الأربع على الترتيب.
القول في الصفة الأولى وهي النجدة
فنقول مراد الأئمة بالنجدة ظهور الشوكة وموفور العدة والاستظهار بالجنود وعقد الالوية والبنود والاستمكان بتضافر الاشياع والاتباع من قمع البغاة والطغاة ومجاهدة الكفرة والعتاة وتطفئة نائرة الفتن وحسم مواد المحن قبل أن يستظهر شررها وينتشر ضررها هذا هو المراد بالنجدة وهي حاصلة لهذه الجهة المقدسة فالشوكة في عصرنا هذا من اصناف الخلائق للترك وقد اسعدهم الله تعالى بموالاته ومحبته حتى انهم يتقربون إلى الله بنصرته وقمع اعداء دولته ويتدينون باعتقاد خلافته وامامته ووجوب طاعته كما يندينون بوجوب أوامر الله وبتصديق رسله في رسالته فهذه نجدة لم يثبت مثلها لغيره فكيف يتمارى في نجدته.
فإن قيل كيف تحصل نجدته بهم وانا نراهم يتهجمون على مخالفة أوامره ونواهيه ويتعدون الحدود المرسومة لهم فيه وانما تحصل الشوكة بمن يتردد تحت الطاعة على حسب الاستطاعة وهؤلاء في حركاتهم لا يترددون إلا خلف شهواتهم وإذا هاج لهم غضب أو حركتهم شهوة أو أوغر صدورهم ضغينة لم يبالوا بالاتباع ولم يعرفوا إلا الرجوع إلى ما جبلوا عليه من طباع السباع فكيف تقوم الشوكة بهم.
قلنا هذا سؤال في غاية الركاكة فإن الطاعة المشروطة في حق الخلق لقيام شوكة الإمام لا تزيد على الطاعة المشروطة على الارقاء والعبيد في حق ساداتهم ولا على الطاعة المفروضة على المكلفين لله ورسوله وأحوال العبيد في طاعة سيدهم وأحوال العباد في طاعة ربهم لا تنفك عن الانقسام إلى موافقة ومخالفة فلما انقسم المكلفون إلى المطيعين والعصاة ولم ينسلخوا به عن اهاب الإسلام ولا انسلوا به عن ربقته ما داموا معتقدين ان الطاعة لله مفروضة وان المخالفة محرمة ومكروهة فهذا حال الجد في الطاعة لصاحب الأمر فانهم وان خالفوا امرا من الأوامر الواجبة الطاعة اعتقدوا المخالفة اساءة والموافقة حسنة ولذلك تراهم لا يغيرون العقيدة عن الموالاة ولو قطعوا إربا وما من شخص يقدر مخالفته في أمر من الأمور إلا وهو بعينه إذا انتهى إلى العتبة الشريفة صفع الأرض خاضعا وعفر خده في التراب متواضعا ووقف وقوف أذل العبيد على بابه وانتهض مائلا على رجليه عند سماع خطابه ولو نبغت نابغة في طرف من أطراف الأرض على معاداة هذه الدولة الزاهرة لم يكن فيهم أحد إلا ويرى النضال دون حوزتها جهادا في سبيل الله نازلا منزلة جهاد الكفار فأية طاعة في عالم الله تزيد على هذه الطاعة وأية شوكة في الدنيا تقابل هذه الشوكة وليت شعري لم لا يتذكر الباطنية عند إيراد هذا السؤال ما جرى لعلي رضي الله عنه من اضطراب الأحوال وتخلف أشياعه عنه في القتال ومخالفتهم لاستصوابه في أكثر الأقوال والأفعال حتى كان لا تنفك خطبة من خطبه عن شكايتهم في الإعراض عنه والاستبداد برأيهم حتى كان يقول لا رأى لمن لا يطاع فإذا كانت تقوم شوكته باتباع الاكثر من اتباعه من انتصاب من انتصب لمخالفته فكيف لا تقوم الشوكة في زماننا هذا والحال على ما ذكرنا فان قيل كان علي رضي الله عنه يتولى الأمر بنفسه ويباشر الحروب ويتبرج للخلق ولا يحتجب عنهم قلنا ومن الذي شرط في الإمامة مباشرة الأمور وتعاطيها بنفسه نعم لا حرج عليه لو باشر بنفسه فإذا استغنى بجنوده وأتباعه عن المقاساة للحرب بنفسه جاز له الاقتصار على مجرد الرأي والتدبير إذا روجع في الأمور القريبة منه ومن قطره والتفويض إلى ذوي الرأي الموثوق ببصيرتهم في الأمور البعيدة عنه وهذا الآن في عصرنا مستغنى عنه فقد سخر الله رجال العالم وأبطالهم لموالاة هذه الحضرة وطاعتها حتى تبددوا في أقطار الدنيا كما نشاهد ونرى فليس وراء هذه الشوكة أمر يشترط وجوده لصحة الإمامة فإن قيل وما بالكم تنظرون إلى هؤلاء ولا تنظرون إلى جنود المخالفين وهم أيضا مستظهرين بشوكة على مخالفة هذه الشوكة قلنا مهما كانت الكثرة من هذا الجانب لم تقدح مخالفة المخ الفين أفترى لم لم ينظر الباطني إلى شوكة معاوية وعدته ومقاومته لعلى بجنوده وأنصاره فكيف لمم يشترط في صحة الإمامة أن تصفو له جوانب الدنيا عن قذى المخالفة ولو شرط هذافي الإمانة لم تنعقد الأمامة لأحد قط من مبدأالامرإلى زماننا هذا فقد اتضح أن المشروط من هذه الصفة موجود وزيادة.
القول في الصفة الثانية وهي الكفاية
ومعناها التهدى لحق المصالح في معضلات الأمور والاطلاع على المسلك المقتصد عند تعارض الشرور كالعقل الذي يميز الخير عن الشر وينصف به الجمهور وإنما العزيز المعون عقل يعرف خير الخيرين وشر الشريرين وذلك أيضا في الأمور العاجلة وهي هينة قريبة وإنما الملتبس عواقب الأمور المخطرة ولن يستقل بها إلا مسدد للتوفيق من جهة الله تعالى ونحن نقول إن هذه الصفة حاصلة فإن أسبابها متوافرة فإنها مهما حصل من غريزة العقل وانفك عن العته والخبل كان الوصول إلى درك عواقب الأمور بطريق الظن والحدس مبنيا على ركنين أحدهما الفكر والتدبير وشرطه الفطنة والذكاء وهذه خصلة تميز فيها المنصور إمامته والمفروض طاعته عن النظراء بمزيد النفاذ والمضاء حتى صار أكابر العقلاء يتعجبون في معضلات الوقائع من رأيه الصائب وعقله الثاقب وتفطنه للدقائق يشذ عن درك المحنكين من ذوي التجارب وهذه صفة غريزية وهي من الله تحفة وهدية.
والركن الثاني الاستضاءة بخاطر ذوى البصائر واستطلاع راى اولى التجارب على طريق المشاورة وهي الخصلة التي أمر الله بها نبيه إذ قال {وشاورهم في الأمر} ثم شرطه أن يكون المستشير مميزا بين المراتب عارفا للمناصب معولا على راى من يوثق بدهائه وكفايته ومضائه وصرامته وشفقته وديانته وهذا هو الركن الاعظم في تدبير الأمور فان الاستبداد بالرأي وان كان من ذوى البصائر مذموم ومحذور وقد وفق الله الإمام بتفويض مقاليد أمره إلى وزيره الذي لم يقطع ثوب الوزارة إلا على قده حتى استظهر بآرائه السديدة في نوائب الزمان ومعضلات الحدثان ومراعاة مصالح الخلق في حفظ نظام الدين والملك وهو الجامع للصفات التي شرطها الشرع والعقل في المدبر والمشير من متانة الدين ونقاية الرأى وممارسة الخطوب ومقاساة الشدائد في طوارق الأيام ورزانة العقل والعطف على الخلق والتلطف بالرعية وبمجموع هذين الامرين يفهم مطلوب الكفاية فان مقصودها اقامة تناظم الأمور الدينية والدنيوية وهذه قضية يستدل على وجودها بمشاهدة الأحوال والافعال فلينظر المنصف كيف عالج معضلات الزمان بحسن رايه لما استاثر الله بروح الإمام المقتدى وامتع كافة الخلق بالإمامة الزاهرة المستظهرية وقد وافق وفاته احداق العساكر بمدينة السلام وازدحام اصناف الجند على حافتها والزمان زمان الفترة والدنيا طافحة بالمحن متموجة بالفتن والسيوف مسلولة في أقطار الارض والاضطراب عام في سائر البلاد لا يسكن فيها اوار الحرب ولا تنفك عن الطعن والضرب وامتدت اطماع الجند إلى الذخائر ففغروا أفواههم نحو الخزائن وكان يتداعى إلى تغيير الضمائر وثور الاحقاد والضغائن فلم يزل بدهائه وذكائه وحسن نظره ورايه مراعيا لنظام الأمر مترددا بين اللطف والعنف حتى انعقدت البيعة وانتشرت الطاعة واذعنت الرقاب واتسقت الأسباب وانطفات الفتن الثائرة وظل ظل الخلافة بحسن تدبيره وبراى وزيره ممدودا واصبح لواء النصر بحسن مساعيه معقودا وطريق الفساد بهيبته مسدودا واضحت الرعايا في رعايته وادعة وصارت عين الحوادث بحسن كلاءته عن مديته السلام هاجعة فليت شعري هل تكسب مثل هذه العظائم إلا بكمال الكفاية ونباهة الحزم والهداية وهل يستدل على كفاية الملوك بشيء سوى انتظام التدبير وحسن الراى في اختيار المشير والوزير فليس يعتبر في صحة الإمامة صفة الكفاية إلا ما يسر الله سبحانه له اضعاف ذلك فليقطع بوجود هذه الشريطة أيضا مضمومة إلى سائر الشرائط.
القول في الصفة الثالثة وهي الورع.
وهذه هي أعز الصفات وأجلها وأولاها بالرعايات وأجدرها وهو وصف ذاتي لا يمكن استعارته ولا الوصل إلى تحصيله من جهة الغير اما النجدة فتحصيلها من الغير لا محالة والهداية وان اعتمدت على غزارة العقل ففوائدها يمكن فيها الاستعارة بطريق المراجعة والاستشارة والعلم أيضا يمكنه تحصيله بالاستفتاء واستطلاع رأى العلماء والورع هو الاساس والاصل وعليه يدور الأمر كله ولا يغني فيه ورع الغير وهو رأس المال ومصدر جملة الخصال ولو اختل هذا والعياذ بالله لم يبق معتصم في تحقيق الإمامة فالحمد لله الذي زين أحوال الإمام الحق المنصور امامته بالورع والتقوى حتى اوفي فيه على الغية القصوى فتميز بمتانة الدين وصفاء العقل واليقين في جماهير الخلفاء حتى ظهر من أحواله منذ تجمل صدر الخلافة بجماله من إفاضة الخيرات والعطف على الرعايا وذوى الحاجات وقطع العمارات التي كانت العادة جارية بالمواظبة عليها كل ذلك اضرابا عن عمارة الدنيا واكبابا على ما ظهر من عمارة الدين هذا مع ما ظهر من سيرته في خاصة حالته من لبس الثياب الخشنة واجتناب الترفه والدعة والمواظبة على العبادات ومهاجرة الشهوات واللذات استحقارا لزخارف الدنيا وتوقيا من ورطات الهوى والتفاتا إلى حسن الماب في العقبى فهو على التحقيق الشاب الذي نشأ في عبادة الله هذا كله في عنفوان السن وغرة من الشباب وبداية الأمر ينبه العقلاء لما سينتهي إليه الحال إذا قارب سن الكمال.
إن الهلال إذا رأيت نموه أيقنت أن سيصير بدرا كاملا
والله تعالى يمده باطول الاعمار وينشر أعلامه في اقاصي الديار.
فان قال قائل كيف تجاسرتم على دعوى التقوى والورع ومن شرطه التجرد عن الأموال حتى لاياخذ قيراطا إلا من حله ولا يدعه إلا في مظنة استحقاقه وقد قال رسول الله ﷺ اتقوا النار ولو بشق تمرة وليس يتم الورع بالمواظبة على الفرائض واجتناب الموبقات والكبائر بل عماد هذا الأمر العدل واجتناب الظلم في طرفي الاعطاء والاخذ فان ادعيتم حصول هذا الشرط نفرت القلوب عن التصديق وان اعترفتم باختلال الأمر فيه انخرم ما ادعيتموه من حصول الورع والتقوى قلنا هذا السؤال نكسر أولا سورته ثم ننبه على سر هو منتهى الانصاف فنقول ان صدر الاعتراض عن باطني فلعله لو راجع صاحبه الذي يواليه واستقرى ما شاهده من هذه الأحوال فيه افتضح في دعاويه وكان الحياء خيرا له مما يورده ويبديه وان صدر السؤال عن أحد علماء العصر الذين يعتقدون خلو الزمان عن الإمام لفقد شرطه فيقال له هون على نفسك فان دعوى وجود هذا الشريط غير مستبعدة فان الأموال المنصبة إلى الخزائن المعمورة أربعة اصناف الصنف الأول ارتفاع المستغلات وهي ماخوذة من أموال موروثة له والصنف الثاني أموال الجزية وهي من اطيب ما يؤخذ والصنف الثالث أموال التركات ولم يعهد منه قط إلى الآن الطمع في تركة تعين لاستحقاقها وارث ومن لا وارث له فمنصبه بيت المال الصنف الرابع أموال الخراج الماخوذة من ارض العراق ومذهب الشافعي وطوائف من العلماء أن أرض العراق وقف وهي من عبادان إلى الموصل طولا ومن القادسية إلى حلوان عرضا انما وقفهخا عمر رضي الله عنه على المسلمين ليكون جميع خراجها منصبا إلى بيت المال ومصالح المسلمين فهذه هي الأموال الماخوذة واخذها جائز ويبقى النظر في مصارفها وهي مع اختلاف جهاتها أربع جهات وفيها تنحصر مصالح الإسلام والمسلمين.
الجهة الأولى المرتزقة من جند الإسلام إذ لابد من كفايتهم واكثرهم في هذا العصر مكفيون بثروتهم واستظهارهم ومقتدرون على كفاية غيرهم ومع ذلك فقد امدهم الراى الشريف النبوي في هذه الأيام مدة مقام العسكر بمدينة السلام بأموال استفرغ فيها الخزائن وافاض عليهم من ضروب التشريفات والإنعام ما يخلد ذكره على مكر الأيام والاعوام.
الجهة الثانية علماء الدين وفقهاء المسلمين القائمون بعلوم الشريعة فانهم حراس الدين بالدليل والبرهان كما ان الجنود حراسه بالسيف والسنان وما من واحد منهم إلا وهو مكفى من جهته برسم وادرار ومخصوص بانعام وايثار والمستحق لهم أيضا على بيت المال قدر الكفاية وهو مبذول لكل من يتشبه باهل العلم فضلا عمن يتلحى بتحقيقه.
الجهة الثالثة محاويج الخلق الذين قصرت بهم ضرورة الحال وطوارق الزمان عن اكتساب قدر الكفاية وليس ينتهى إليه الخبر في حاجة إلا سدها ولا يرتفع إليه قصد ذي فاقة إلا تداركها ومواظبته على الصدقات في نوب متواليات في السر والعلانية كافية جميع الحاجات.
الجهة الرابعة المصالح العامة من عمارة الرباطات والقناطر والمساجد والمدارس فيصرف لا محالة إلى هذه الجهة عند الحاجة قدر من بيت مال المسلمين فلا ترى هذه المواضع في أيامه إلا معمورة وملحوظة بالتعاهد من القوام بها والمتكفلين لها وهذا وجه الدخل والخرج.
ونختم الكلام بما يقطع مادة الخصام وتبين فيه غاية الانصاف فنقول لا يظنن ظان انا نشترط في الإمامة العصمة فان العلماء اختلفوا في حصولها للانبياء والاكثرون على انهم لم يعصموا من الصغائر ولو اعتبرت العصمة من كل زلة لتعذرت الولايات وانعزلت القضاة وبطلت الإمامة وكيف يحكم باشتراط التنقى من كل معصية والاستمرار على سمت التقوى من غير عدول ومعلوم ان الجبلات متقاضية للذات والطباع محرضة على نيل الشهوات والتكاليف يتضمنها من العناء ما يتقاعد عن احتمالها الاقوياء ووساوس الشيطان وهواجس النفس مستحثة على حب العاجلة واستحقار الاجلة والجبلة الإنسانية بالسوء امارة والتقى في ارجوحة الهوى يغلب تارة ويعجز تارة والشيطان ليس يفتر عن الوساوس والزلات تكاد تجرى على الانفاس فكيف يتخلص البشر عن اقتحام محظور والتورط في محظور ولذلك قال الشافعي رضي الله عنه في شرط عدالة الشهادة لايعرف أحد بمحض الطاعة حتى لا يتضمخ بمعصية ولا أحد بمحض المعصية حتى لا يقدم على طاعة ولا ينفك أحد عن تخليط ولكن من غلبت الطاعات في حقه المعاصي وكانت تسووه سيئته وتسره حسنته فهو مقبول الشهادة ولسنا نشترط في عدالة القضاء إلا ما نشترطه في الشهادة ولا نشترط في الإمامة إلا ما نشترطه في القضاء وهذا ذكرناه إذا لج ملاح أو الح ملح ولازم اللدد في تصوير أمر من الأمور لا يوافق ظاهر الشرع وارادته الطعن في الإمامة والقدح فيها عرف ان ذلك غير قادح في اصل الإمامة بحال من الأحوال.
القول في الصفة الرابعة وهي العلم.
فإن قال قائل اتفق راي العلماء على أن الإمامة لا تنعقد إلا لمن نال رتبة الاجتهاد والفتوى في علوم الشرع ولا يمكنكم دعوى وجود هذه الشريطة ولو ادعيتم أن ذلك لا يشترط كان انسلالا عن وفاق العلماء قاطبة فما رأيكم في هذه الصفة.
قلنا لو ذهب ذاهب إلى أن بلوغ درجة الاجتهاد لا يشترط في الإمامة لم يكن في كلامه إلا الاعزاب عن العلماء الماضين والا فليس فيه ما يخالف مقتضى الدليل وسياق النظر فان الشروط التي تدعى للإمامة شرعا لابد من دليل يدل عليها والدليل اما نص من صاحب الشرع واما النظر في المصلحة التي طلبت الإمامة لها ولم يرد النص من شرائط الإمامة في شيء إلا في النسب إذ قال أن الأئمة من قريش فاما ما عداه فانما اخذ من الضرورة والحاجة الماسة في مقصود الإمامة اليها فهذا كما شرطنا العقل والحرية وسلامة الحواس والهداية والنجدة والورع فان هذه الأمور لو قدر عدمها لم ينتظم أمر الإمامة بحال من الأحوال وليست رتبة الاجتهاد مما لا بد منه في الإمامة ضرورة بل الورع الداعي إلى مراجعة أهل العلم فيه كاف فإذا كان المقصود ترتيب الإمامة على وفق الشرع فاى فرق بين ان يعرف حكم الشرع بنظره أو يعرفه باتباع افضل أهل زمانه وإذا جاز للمجتهد ان يعول على قول واحد ويروى له حديثا فيحكم به إماما كان أو قاضيا فما المانع من ان يحكم بما يتفق عليه العلماء في كل واقعة وان اختلف فيتبع فيه قوله الافضل الاعلم ولم لا يكون مكملا بافضل أهل الزمان مقصود العلم كما كمل باقوى أهل الزمان مقصود الشوكة وبادهى أهل الزمان وأكفاهم رأيا ونظرا مقصود الكفاية فلا تزال دولته محفوفة بملك من الملوك قوى يمده بشوكته وكاف من كفاة الزمان يتصدى لوزارته فيمده برايه وهدايته وعالم مقدم في العلوم يفيض ما يلوح من قضايا الشرع في كل واقعة إلى حضرته هذا لو قال به قائل لكان مستمدا من قواطع الادلة والبراهين التى يجوز استعمالها في مظان القطع واليقين فكيف في مواقع الظن والتخمين واكثر مسائل الإمامة واحكامها مسائل فقهية ظنية يحكم فيها بموجب الراى الاغلب وما ذكرته مسلك واضح فيه ولكنى لا اوثر الاعزاب عن الماضين ولا الانحراف عن جادة الأئمة المنقرضين فان الانفراد بالراى والانسلال عن موافقة الجماهير لا ينفك عن اثارة نفرة القلوب لكني استميح مسلكا مقتبسا من كلام الأئمة المذكورين واقول اختلف الناس في أن أهل الاختيار لو عقدوا عقد البيعة للمفضول واعرضوا عن الافضل هل تنعقد الإمامة مع الاتفاق على أن تقديم الافضل عند القدرة واجب متعين ثم ذهب الاكثرون إلى انها إذا عقدت للمفضول مع حضور الافضل انعقدت ولم يجز خلعه لسبب الافضل وانا من هذا انشئ واقول أن رددناها في مبدا التولية بين مجتهد في علوم الشرع وبين متقاصر عنها فيتعين تقديم المجتهد لان اتباع الناظر علم نفسه له مزية رتبة على اتباع علم غيره بالتقليد والمزايا لا سبيل إلى إهمالها مع القدرة على مراعاتها أما إذا انعقدت الإمامة بالبيعة أوتولية العهد لمنفك عن رتبة الاجتهاد وقامت له شوكة واذعنت له الرقاب ومالت إليه القلوب فان خلا الزمان عن قرشي مجتهد يستجمع جميع الشروط وجب الاستمرار على الإمامة المعقودة ان قامت له الشوكة وهذا حكم زماننا وان قدر ضربا للمثل حضور قرشي مجتهد مستجمع للورع والكفاية وجميع شرائط الإمامة واحتاج المسلمون في خلع الأول إلى تعرض لاثارة فتن واضطراب أمور لم يجز لهم خلعه والاستبدال به بل تجب عليهم الطاعة له والحكم بنفوذ ولايته وصحة إمامته لأنا نعلم بأن العلم مزية روعيت في الإمامة تحسينا للأمر وتحصيلا لمزيد المصلحة في الاستقلال بالنظر والاستغناء عن التقليد وان الثمرة المطلوبة من الإمامة تطفئة الفتن الثائرة في تفرق الآراء المتنافرة فكيف يستجيز العاقل تحريك الفتنة وتشويش نظام الأمور وتفويت أصل المصلحة في الحال تشوفا إلى مزيد دقيقة في الفرق بين النظر والتقليد وعند هذا ينبغي أن يقيس الإنسان ما ينال الخلق بسبب عدول الإمام عن النظر إلى تقليد الأئمة بما ينالهم لو تعرضوا لخلعه واستبداله أو حكموا إمامته غير منعقدة وإذا أحسن إيراد هذه المقالة علم أن التفاوت بين اتباع الشرع نظرا واتباعه تقليدا قريب هين وانه لا يجوز أن تخرم بسببه قواعد الإمامة وهذا تقدير تسامحنا به من وجهين أحدهما تقدير قرشي مجتهد مستجمع الصفات متصد لطلب الإمامة وهذا لا وجود له في عصرنا والثاني تقدير اقتدارالخلق على الاستبدال بالإمام والتصرف فيه بالخلع والانتقال وهذا محال في زماننا إذ لو أجمع أهل الدهر وتألبوا على أن يصرفوا الوجوه والقلوب عن الحضرة المقدسة المستظهرية لم يجدوا اليها سبيلا فيتعين على كافة علماء العصر الفتوى بصحة هذه الإمامة وانعقادها بالشرع ولكن بعد هذا شرطان أحدهما أن لا يمضي كل قضية مشكلة إلا بعد استنتاج قرائح العلماء والاستظهار بهم وأن يختار لتقليده عند التباس الأمر واختلاف الكلمة أفضل أهل الزمان واغزرهم علما وقلما تنفك مدينة السلام عن شخص يعترف له بالتقدم في علم الشرع فلا بد من تعرف الشرع في الوقائع منه لينوب ذلك عن الاجتهاد والثاني أن يسعى لتحصيل العلم وحيازة رتبة الاستقلال بعلوم الشرع فإن الإمامة وان كانت صحيحة منعقدة في الحال فخطاب الله تعالى قائم بإيجاب العلم وافتراض تحصيله وإذا ساعدت القدرة عليه لم يكن للتواني فيه عذر لا سيما والسن سن التحصيل وريعان الشباب معين على الغرض والقدر الواجب تحصيله شرعا إذا صرف إليه الهمة الشريفة حصل في قدر يسير من الزمان ولا يليق تطلب غايات الكمال إلا بالحضرة المقدسة الشريفة النبوية المحقوقة بالعز والجلال.
وإذا اتضح في هذا الباب بهذه البراهين اللائحة أن مقتضى أمر الله أن الإمام الحق المستظهر بالله هو المتعين لخلافة الله فما أجدر هذه النعمة أن تقابل بالشكر وإنما الشكر بالعلم وبالعمل وبالمواظبة على ما أودعته في الباب الآخر من الكتاب وعلى الجملة فشكر هذه النعمة ألا يرضي أمير المؤمنين أن يكون لله على وجه الأرض عبد أعبد وأشكر منه كما أن الله تعالى لم يرض أن يكون له على وجه الأرض عبد أعز واكرم من أمير المؤمنين فهذا هو الشكر الموازي لهذه النعمة. والله ولي التوفيق بمنه ولطفه.
الباب العاشر في الوظائف الدينية التي بالمواظبة عليها يدوم استحقاق الإمامة
ومن فرائض الدين على امير المؤمنين زاده الله توفيقا المداومة على مطالعة هذا الباب والاستقصاء على تأمله وتصفحه ومطالبة النفس الكريمة حتى تستمر عليه فإن ساعد التوفيق للمجاهدة في الاقتدار على وظيفة من هذه الوظائف ولو في سنة فهي السعادة القصوى وهذه الوظائف بعضها علمية وبعضها عملية فتقدم العلمية فإن العلم هو الأصل والعمل فرع له إذ العلوم لا حصر لها ولكنا نذكر أربعة أمورهن أمهات وأصول.
الأول أن يعرف أن الإنسان في هذا العالم لم خلق وإلى أي مقصد وجه ولأي مطلب رشح وليس يخفى على ذي بصيرة أن هذه الدار ليست دار مقر وإنما هي دار ممر والناس فيها على صورة المسافرين ومبدأ سفرهم بطون أمهاتهم والدار الآخرة مقصد سفرهم وزمان الحياة مقدار المسافة وسنوه منازله وشهوره فراسخه وأيامه أمياله وأنفاسه خطاه ويصار بهم عبر السفينة براكبها ولكل شخص عند الله عمر مقدر لا يزيد ولا ينقص ولهذا قال عيسى صلوات الله عليه وسلم الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها وقد دعى الخلق إلى لقاء الله في دار السلام وسعادة الأبد فقال الله تعالى: {والله يدعو إلى دار السلام} وهذا السفر لا يفضى إلى المقصد إلا بزاد وهو التقوى ولذلك قال تعالى: {وتزودوا فإن خير الزاد التقوى} فمن لم يتزود في دنياه لآخرته بالمواظبة على العبادة فسيرجع منه عند الموت ما اغتر من جسده وماله فيتحسر حيث لا يغنيه التحسر ويقول {يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين} ويقول {فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل} فحينئذ {لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا} وهذا الإنسان من وجه آخرفي دنياه حارث وعمله حرثه ودنياه محترثه ووقت الموت وقت حصاده ولذلك قال ﷺ الدنيا مزوعة الآخرة وانما البذر هو العمر فمن انقضى عليه نفس من انفاسه ولم يعبد الله فيه بطاعة فهو مغبون لضياع ذلك النفس فإنه لا يعود قط ومثال الإنسان في عمره مثال رجل كان يبيع الثلج وقت الصيف ولم تكن له بضاعة سواه فكان ينادي ويقول ارحموا من رأس ماله يذوب فرأس مال الإنسان عمره الذي هو وقت طاعته وانه ليذوب على الدوام فكلما زاد سنه نقص بقية عمره فزيادته نقصانه على التحقيق ومن لم ينتهز في انفاسه حتى يقتنص بها الطاعات كلها كان مغبونا ولذلك قال ﷺ من استوى يوماه فهو مغبون ومن كان يومه شرا من أمسه فهو ملعون فكل من صرف عمره إلى ديناه فقد خاب سعيه وضاع عمله كما قال تعالى: {من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم} الآية ومن عمل لآخرته فهو الذي أنجح سعيه كما قال تعالى: {ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا}.
الوظيفة الثانية أنه مهما عرف أن زاد السفر إلى الآخرة التقوى فليعلم أن التقوى محلها ومنبعها القلب لقوله ﷺ التقوى ها هنا وأشار إلى صدره وينبغي أن يكون الاجتهاد في إصلاح القلب أولا إذ صلاح الجوارح تابع له لقوله ﷺ إن في بدن ابن آدم لبضعة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب وإصلاح القلب شرطه تقدم تطهيره عليه وطهارته في أن يطهر عن حب الدنيا لقوله ﷺ حب الدنيا رأس كل خطيئة وهذا هو الداء الذي أعجز الخلق ومن ظن أنه يقدر على الجمع بين التنعم في الدنيا والحرص على ترتيب أسبابها وبين سعادة الآخرة فهو مغرور كمن يطمع في الجمع بين الماء والنار لقوله أمير المؤمنين رضي الله عنه الدنيا والآخرة ضرتان مهما أرضيت إحداهما أسخطت الأخرى نعم لو كان الإنسان يشتغل بالدنيا لأجل الدين لا لأجل شهوته كمن يصرف عمره إلى تدبير مصالح الخلق شفقة عليهم أو يصرف بعض أوقاته إلى كسب القوت ونيته في كسب القوت إلى أن يتقوى بتناوله على الطاعة والتقوى فهذا من عين الدين وعلى هذا المنهاج جرى حرص الأنبياء والخلفاء الراشدين في أمور الدنيا ومهما ثبت أن الزاد هو التقوى وأن التقوى شرطها خلو القلب عن حب الدنيا فليكن الجهد في تخليته عن حبها وطريقه أن يعرف الإنسان عيب الدنيا وآفتها ويعرف شرف السعادة في الدار الآخرة وزينتها ويعلم أن في مراعاة الدنيا الحقيرة فوت الآخرة الخطيرة وأقل آفات الدنيا وهي مستيقنة لكل عاقل وجاهل أنها منقضية على القرب وسعادة الآخرة لا آخر لها هذا إذا سلمت الدنيا صافية عن الشوائب والأقذاء خالية عن المؤذيات والمكدرات وهيهات هيهات فلم يسلم أحد في الدنيا من طول الأذى ومقاساة الشدائد ومهما عرف تصرم الدنيا وتأبد السعادة في العقبى فليتأمل أنه لو شغف إنسان بشخص واستهتر به وصار لا يطبق فراقه وخير بين أن يعجل لقاءه ليلة واحدة بين أن يصبر عنه تلك الليلة مجاهدا نفسه ثم يخلى بينه وبينه ألف ليلة فكيف لا يسهل عليه الصبر ليلة واحدة لتوقع التلذذ بمشاهدته ألف ليلة ولو استعجل تلك الليلة وعرض نفسه لعناء المفارقة ألف ليلة لعد سفيها خارجا عن حزب العقلاء فالدنيا معشوقة كلفنا الصبر عنها مدة يسيرة ووعدنا أضعاف هذه اللذات مدة لا آخر لها وترك الألف بالواحد ليس من العقل واختيار الألف على الواحد المعجل ليس بمتعذر على العاقل وعند هذا ينبغي أن يقيس الإنسان أقصى مدة مقامه في الدنيا وهي مائة سنة مثلا ومدة مقامه في الآخرة ولا آخر لها بل لو طلبنا مثالا لطول مدة الأبد لعجزنا عنه إلا أن نقول لو قدرنا الدنيا كلها إلى منتهى السموات ممتلئة بالذرة وقدرنا طائرا يأخذ بمنقاره في كل ألف سنة حبة واحدة فلا يزال يعود حتى لا يبقى من الذرة حبة واحدة فتنقضي هذه المدة وقد بقى من الذرة اضعافها فكيف لا يقدر العاقل إذا حقق على نفسه هذا الأمر على أن يستحقر الدنيا ويتجرد لله تعالى هذا لو قد قدر بقاء العمر مائة سنة وقدرت الدنيا صافية عن الاقذاء فكيف والموت بالمرصاد في كل لحظة والدنيا غير صافية من ضروب التعب والعناء وهذا أمر ينبغي أن يطول التامل فيه حتى يترسخ في القلب ومنه تنبعث التقوى وما لم يظهر للإنسان حقارة الدنيا لا يتصور منه أن يسعى للدار الاخرى وينبغي أن يستعان على معرفة ذلك بالاعتبار بمن سلف من أبناء الدنيا كيف تعبوا فيها ثم ارتحلوا عنها بغير طائل ولم تصحبهم إلا الحسرة والندامة ولقد صدق من قال من الشعراء حيث قال أشد الغم عندي في سرور تيقن عنه صاحبه انتقالا وهذه حال لذات الدنيا.
الوظيفة الثالثة أن معنى خلافة الله على الخلق اصلاح الخلق ولن يقدر على اصلاح أهل الدنيا من لا يقدر على اصلاح أهل بلده ولن يقدر على اصلاح أهل البلد من لايقدر على اصلاح أهل منزله ولا يقدر على اصلاح أهل منزله من لايقدر على اصلاح نفسه ومن لا يقدر على اصلاح نفسه فينبغي أن تقع البداية باصلاح القلب وسياسة النفس ومن لم يصلح نفسه وطمع في اصلاح غيره كان مغرور كما قال الله تعالى: {أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم} وفي الحديث ان الله تعالى قال لعيسى بن مريم عظ نفسك فان اتعظت فعظ الناس والا فاستحي مني ومثال من عجز عن اصلاح نفسه وطمع في اصلاح غيره مثال الاعمى إذا اراد يهدي العميان وذلك لا يستتب له قط وانما يقدر على اصلاح النفس بمعرفة النفس ومثل معرفة الإنسان في بدنه كمثل وال في بلده وجوارحه وحواسه واطرافه بمنزلة صناع وعملة والشرع له كمشير ناصح ووزير مدبر والشهوة فيه كعبد سوء جالب للميرة والطعام والعصب له كصاحب شرطة والعبد الجالب للميرة خبيث ماكر يتمثل للإنسان بصورة الناصح وفي نصحة دبيب العقرب فهو يعارض الوزير في تدبيره ولا يغفل ساعة من منازعته ومعارضته فكان الوالى في مملكته متى استشار في تدبيراته وزيره دون هذا العبد السوء الخبيث وادب صاحب شرطته وجعله مؤتمرا لوزيره وسلطه على هذا العبد الخبيث واتباعه حتى يكون هذا العبد مسوسا لا سائسا ومدبرا لا مدبرا استقام أمر بلده وكذا النفس متى استعانت في تدبيراتها بالشرع والعقل وادبت الحمية والغضب حتى لا يهتاج إلا باشارة الشرع والعقل وسلطته على الشهوة واستتب أمرها والا فسدت واتبعت الهوى ولذات الدنيا كما قال الله تعالى: {ولا تتبع الهوى} الأية وقال تعالى: {أفرأيت من اتخذ إلهه هواه} {وقال} {أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب} وقال تعالى في مدح من عصاها {وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى} الآية وعلى الجملة فينبغي ان يكون العبد طول عمره في مجاهدة غضبه وشهوته ومتشمرا لمخالفتها كما يتشمر لمخالفة اعدائه فانهما عدوان كما قال ﷺ اعدى عدو نفسك التي بين جنبيك ومثال من اشتغل بالتلذذ عندالشهوات والانتقام عند الغضب مثل رجل فارس صياد له فرس وكلب غفل عن صيده واشتغل بتعهد فرسه وطعمة كلبه وضيع فيه جميع وقته فإن شهوة الإنسان كفرسه وغضبه ككلبه فإن كان الفارس حاذقا والفرس مروضا والكلب مؤدبا ومعلما فهو قمين بإدراك حاجته من الصيد ومتى كان الفارس أخرق وفرسه جموحا أو حرونا وكلبه عقورا فلا فرسه ينبعث تحته منقادا ولا كلبه يسترسل باشارته مطيعا فهو قمين أن يعطب فضلا أن يدرك ما طلب ومهما جاهد الإنسان فيها هواه فله ثلاثة أحوال الأول أن يغلبه الهوى فيتبعه ويعرض عن الشرع كما قال تعالى: {أفرأيت من اتخذ إلهه هواه} الثاني أن يغالبه فيقهره مرة ويقهره الهوى أخرى فله أجر المجاهدين وهو المرد بقوله ﷺ جاهدوا هواكم كما تجاهدو أعداءكم الثالث أن يغلب هواه ككثير من الأنبياء وصفوه الأولياء لقوله ﷺ ما من أحد إلا وله شيطان وإن الله قد أعانني على شيطاني حتى ملكته وعلى الجملة فالشيطان يتسلط على الإنسان بحسب وجوده الهوى فيه وإنما مثلت الشهوة بالفرس والغضب بالكلب لأنه لولاهما لما تصورت العبادة المؤدية إلى السعادة الآخرة فإن الإنسان يحتاج في عبادته إلى بدنه ولا قيام إلا بالقوت ولا يقدر على الاقتيات إلا بشهوة وهو محتاج إلى أن يحرس نفسه عن الهلكات بدفعها ولا يدفع المؤذى إلا بداعية الغضب فكأنهما خادمان لبقاء البدن والبدن مركب النفس وبواسطتها يصل إلى العبادة والعبادة طريقه إلى النجاة.
الوظيفة الرابعة أن يعرف أن الإنسان مركب من صفات ملكية وصفات بهيمية فهو حيران بين الملك والبهيمة فمشابهته للملك بالعلم والعبادة والعفة والعدالة والصفات المحمودة ومشابهته للبهائم بالشهوة والغضب والحقد والصفات المذمومة فمن صرف همته إلى العلم والعمل والعبادة فخليق أن يلحق بالملائكة فيسمى ملكا وربانيا كما قال تعالى: {إن هذا إلا ملك كريم} ومن صرف همته إلى إتباع الشهوات واللذات البدنية يأكل كما تأكل البهائم فخليق أن يلحق بالبهائم فيصير إما غمرا كثور وإما شرها كخنزير وإما ضرعا ككلب أو حقودا كجمل أو متكبرا كنمر أو ذا روغان ونفاق كثعلب أو يجمع ذلك فيصير كشيطان مريد وعلى ذلك دل قوله تعالى: {وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت} {وقال} {كالأنعام بل هم أضل} {وقال} {إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون} وهذه الصفات الذميمة تجتمع في الآدمي في هذا العالم وهو في صورة الإنسان فتكون الصفة باطنة والصورة ظاهرة وفي الآخرة تتحد الصورة والصفات فيصور كل شخص بصفته التي كانت غالبة عليه في حياته فمن غلب عليه الشر حشر في صورة خنزير ومن غلب عليه الغضب حشر في صورة سبع ومن غلب عليه الحمق حشر في صورة حمار ومن غلب عليه التكبر حشر بصورة نمر وهكذا جميع الصفات ومن غلب عليه العلم والعمل واستولى بهما على هذه الصفات حشر في صورة الملائكة والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
وهذه الوظائف التي ذكرناها علمية يجب التأمل فيها حتى تتمثل في القلب فتكون نصب العين في كل لحظة وإنما تترسخ هذه العلوم في النفس إذا أكدت بالعمل كما سنذكره في الوظائف العملية بعد.
القول في الوظائف العملية
وهي كثيرة أولاها وهي من الأمور الكلية أن كل من تولى عملا على المسلمين فينبغي أن يحكم نفسه في كل قضية يبرمها فما لا يرتضيه لنفسه لا يرتضيه لغيره فالمؤمنون كنفس واحدة فقد روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال من سره أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فليدركه موته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه وروى أنس بن مالك عن رسول الله ﷺ أنه قال من أصبح وهمه غير الله تعالى فليس من الله في شيء ومن أصبح لا يهتم بالمسلمين فليس من المسلمين.
ومنها أن يكون والى الأمر متعطشا إلى نصيحة العلماء ومتبجحا بها إذا سمعها وشاكرا عليها فقد روى أن أبا عبيدة ومعاذا كتبا إلى عمر رضي الله عنهم أما بعد فإنا عهدناك وشأن نفسك لك مهم وأصبحت وقد وليت بأمر هذه الأمة أسودها وأحمرها يجلس بين يديك الشريف والوضيع والصديق والعدو ولكل حصته من العدل فانظر كيف أنت عند ذلك يا عمر وانا نحذرك مما حذرت الأمم قبلك يوم تعنو فيه الوجوه وتجب فيه القلوب وتقطع فيه الحجة لعز ملك قهرهم جبروته والخلق داخرون له ينتظرون قضاءه ويخافون عقابه وانه ذكر لنا أنه سياتي على الناس زمان يكون اخوان العلانية أعداء السريرة فانا نعوذ بالله ان ينزل كتابنا من قبلك سوى المنزل الذى نزل من قلوبنا وإنا كتبنا اليك نصيحة والسلام فكاتبهما بجوابه وذكر في آخر ما كتب إنكما كتبتما إلى نصيحة فتعهداني منكما بكتاب فإني لا غنى بي عنكما والسلام عليكما.
ومنها ألا يستحقر الوالى انتظار ارباب الحاجات ووقوفهم بالباب في لحظة واحدة فان الاهتمام بأمر المسلمين أهم له وأعود عليه مما هو متشاغل به من نوافل العبادات فضلا عن اتباع الشهوات فقد روى أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه جلس يوما للناس فلما انتصف النهار ضجر ومل فقال للناس مكانكم حتى أعود اليكم فدخل يستريح ساعة فجاء ابنه عبد الملك فاستأذن فدخل عليه فقال يا أمير المؤمنين ما سبب دخولك قال أردت ان استريح ساعة فقال أأمنت أن يأتيك الموت ورعيتك على الباب ينتظرونك وانت محتجب عنهم فقال عمر صدقت فقام من ساعته وخرج إلى الناس.
ومنها أن يترك الوالي للأمر الترفه والتلذذ بالشهوات في المأكولات والملبوسات فقد روى أن عمر رضي الله عنه كتب إلى سلمان الفارسي يستزيره فلما قدم عليه سلمان تلقاه في أصحابه فالتزمه وضمه إليه وصار إلى المدينة فلما خلا به عمر قال له يا أخي هل بلغك مني ما تكرهه فقال لا قال عزمت عليك إن كان بلغك مني ما تكرهه ألا أخبرتني فقال لولا ما عزمت على أولا ما أخبرتك بلغني أنك تجمع بين السمن واللحم على مائدتك وبلغني أن لك حلتين حلة تلبسها مع أهلك وحلة تخرج فيها إلى الناس فقال عمر هل بلغك غير هذا فقال لا فقال أما هذان فقد كفيتهما فلا أعود إليهما
ومنها أن يعلم والي الأمر أن العبادة تيسر للولاة مالا يتيسر لآحاد الرعايا فلتغتنم الولاية لتعبد الله بها وذلك بالتواضع والعدل والنصح للمسلمين والشفقة عليهم فقد روى عن أبي بكر رضي الله عنه وهو على المنبر قال سمعت رسول الله ﷺ يقول الوالي العدل المتواضع ظل الله ورمحه في أرضه فمن نصحه في نفسه وفي عباد الله حشره الله تعالى في وقده يوم لا ظل إلا ظله وفي غشه في نفسه وفي عباد الله خذله الله تعالى يوم القيامة ويرفع للوالي العدل المتواضع في كل يوم وليلة عمل ستين صديقا كلهم عبد مجتهد في نفسه فهذه رتبة عظيمة لا تسلم في كل عصر إلا لواحد وانما تنال هذه الرتبة بالعدل والتواضع وقد روى أبو سعيد الخدرى عن رسول الله ﷺ أنه قال سبعة يظلهم الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه متعلق بالمسجد إذا خرج من حتى يعود إليه ورجلان تحابا في الله فاجتمعا على ذلك وتفرقا عليه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال إلى نفسها فقال أني أخاف الله رب العالمين ورجل تصدق بصدقة وأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه فهذه سبع لا يتصور اجتماعها إلا في أمير المؤمنين وإنما يقدر غيره من الخلق على آحادها دون مجموعها فليجتهد في نيل رتبة لم تدخر إلا له ولن يقوم بها سواه فقد روى أيضا أبو سعيد الخدرى أنه قال إن أحب العباد إلى الله تعالى وأقربهم منه مجلسا إمام عادل وإن أبغض الناس إلى الله وأشدهم عذابا يوم القيامة إمام جائر وقد روى أبو هريرة عن النبي ﷺ قال ثلاثة لا يرد الله لهم دعوة الإمام العادل والصائم حتى يفطر والمظلوم يقول الله وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي لأنتصرن لك ولو بعد حين وقد روى عبد الله بن مسعود أنه قال ﷺ عدل ساعة خير من عبادة سنة وإنما قامت السموات والأرض بالعدل وقد روى عن ابن عباس أنه ﷺ قال والذي نفس محمد بيده إن الوالي العدل ليرفع الله له كل يوم مثل عمل رعيته وصلواته في اليوم تعدل تسعين ألف صلاة. وروى ابن عباس أيضا أنه ﷺ قال الإسلام والسلطان أخوان توأمان لا يصلح أحدهما إلا بصاحبه فالإسلام أس والسلطان حارس فمالا أس له منهدم ومالا حارس له ضائع وقد روى أنس أنه ﷺ قال ما من أحذ أفضل منزلة عند الله من إمام إن قال صدق وإن حكم عدل وإن استرحم رحم والقصد من رواية هذه الأخبار التنبيه على عظم قدر الإمامة وأنها إذا ترتبت بالعدل كانت أعلى العبادات وإنما يعرف العدل من الظلم بالشرع فليكن دين الله وشرع رسول الله ﷺ هو المفزع والمرجع في كل ورد وصدر وتفصيل العدل مما يطول ولعل الوظائف التي تأتي يشتمل عليه طرف منها.
ومنها أن يكون الرفق في جميع الأمور أغلب من الغلطة وأن يوصل كل مستحق إلى حقه فقد روت عائشة رضي الله عنها عن رسول الله ﷺ أنه قال أيما وال ولي فلانا ورفق به رفق به يوم القيامة وروت عائشة أيضا أنه قال اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به ولمن شفق عليهم فأشفق عليه هذا دعاء رسول الله ﷺ وإنه يستجاب لا محالة وقد روى عن زيد بن ثابت أنه قال عند النبي ﷺ نعم الشيء الإمارة فقال ﷺ نعم الشيء الإمارة لمن أخذها بحقها وحلها وبئس الشيء الإمارة لمن أخذها بغير حقها فتكون حسرة عليه يوم القيامة وكل أمير عدل عن الشرع في أحكامه فقد أخذ إمارة بغير حقها.
وروى أبو هريرة عنه ﷺ أنه قال إن بني إسرائيل كان يسوسهم الأنبياء عليهم السلام فكلما هلك نبي قام بني مكانه وإنه لا نبي بعدي وإنه يكون بعدي خلفاء قبل يا رسول الله ما تأمرنا فيهم قال اعطوهم حقهم واسألوا الله تعالى حقكم فإن الله تعالى سائلهم عما استرعاهم هو قد حكى أن هشام ابن عبد الملك قال لأبي حازم وكان من مشايخ الدين كيف النجاة من هذا الأمر يعنى من الإمارة قال ألا تأخذ الدرهم إلا من حله ولا تضعه إلا في حقه قال ومن يطيق ذلك قال من طلب الجنة وهرب من النار.
ومنها أن يكون أهم المقاصد عنده تحصيل مرضاه الخلق ومحبتهم بطريق يوافق الشرع ولا يخالفه فقد روى عوف بن مالك عنه ﷺ أنه قال إن خيار أئمتكم الذين تحبونهم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشر أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنوهم ويلعنوكم قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة إلا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معاصي الله تعالى فليكره ما أتي من معاصي الله تعالى ولا ينزع يدا عن طاعة الله وقد روى عبد الله بن عمر عن النبي ﷺ أنه قال لخليفتي على الناس السمع والطاعة ما استرحموا فرحموا وحكموا فعدلوا وعاهدوا فوفوا ومن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
ومنها أن يعلم أن رضا الخلق لا يحسن تحصيله إلا في موافقة الشرع وأن طاعة الإمام لا تجب على الخلق إلا إذا دعاهم إلى موافقة الشرع كما روى عن محمد بن علي أنه قال إني لا علم قبيلتين تعبدان من دون الله قالوا من هم قال بنو هاشم وبنو أمية أما والله ما نصبوهم ليسجدوا لهم ولا ليصلوا لهم ولكن أطاعوهم واتبعوهم على ما أمدوهم والطاعة عبادة وقد روى ابن عباس أنه ﷺ قال لا تسخطن الله برضا أحد من خلقه ولا تقربوا إلى أحد من الخلق بتباعد من الله إن الله تعالى ليس بينه وبين أحد من خلقه قرابة يعظمهم بها ولا يصرف عن أحد شرا إلا بطاعته واتباع مرضاته واجتناب سخطه وان الله تعالى يعصم من أطاعه ولا يعصم من عصاه ولا يجد الهارب منه مهربا وقد روى عمر بن الحكم أن رسول الله ﷺ بعث سرية وأمر عليهم رجلا من أصحابه فأمر ذلك الرجل عبد الله بن حذاقة وكان ذا دعابة فاوقد نارا وقال ألستم سامعين مطيعين لأميركم قالوا بلى قال عزمت عليكم إلا وقعتم فيها ثم قال إنما كنت ألعب معكم فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال من أمركم من الأمراء بشيء من معصية الله فلا تطيعوه وقد روى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه صعد المنبر بعد وفاة رسول الله ﷺ بسبعة أيام فحمد الله وأثنى عليه وصلى على رسول الله صلى الله عليه ثم قال أيها الناس انكم وليتموني أمركم ولست بخيركم فان أحسنت فأعينوني وإن ضعفت أو عدلت عن الحق فقوموني ولا تخافوا في الله أحدا إن اكيس الكيس التقى وان احمق الحمق الفجور ثم اني أخبركم أني سمعت رسول الله ﷺ وهو يقول في الغار إن الصدق أمانة وإن الكذب خيانة ألا إن الضعيف منكم القوى عندنا حتى يعطي الحق غير متعتع ولا مقهور والقوى هو الضعيف عندنا حتى نأخذ منه الحق طائعا أو كارها ثم قال أطيعونا ما أطعنا الله ورسوله فإذا عصينا الله ورسوله فلا طاعة لنا عليكم فقوموا إلى صلاتكم رحمكم الله وقد روى عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة أنه قال انتهيت إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه وهو جالس في ظل الكعبة والناس حوله مجتمعون فسمعته يقول قام رسول الله ﷺ فقال إنه لم يكن شيء إلا كان حقا على الله أن يدل أمته على ما يعلمه خيرالهم وينذرهم ما يعلمه شرالهم وان أمتكم هذه جعلت عاقبتها في أولها وإلى آخرها سيصيبهم بلاء.
وأمور ينكرونها وتجيء سنه ألفين فيقول المؤمن هذه هذه ثم تنكشف فمن سره منكم أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه موتته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتي إليه ومن تابع إماما وأعطاه صفية قلبه وثمرة فؤاده فليعطه ما استطاع فقلت أناشدك الله أنت سمعته من رسول الله قال سمعت أذناي ووعى قلبي فقلت هذا ابن عمك يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل وان قيل أنفسنا فقال قال الله تعالى: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} الآية قال فجمع يديه فوضعهما على جبهته ثم نكس رأسه فقال أطعه في طاعة الله واعصه في معصية الله. فبهذه الأحاديث يتبين أن الطاعة واجبة للأئمة ولكن في طاعة الله لا في معصيته.
ومنها أن يعرف أن خطر الإمامة عظيم كما أن فوائدها في الدنيا والآخرة عظيمة وأنها إن روعيت على وجهها فهي سعادة وان لم تراع على وجهها فهي شقاوة ليس فوقها شقاوة فقد روى ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه انه أقبل وفي البيت رجال من قريش فأخذ بعضادتي الباب ثم قال الأئمة من قريش ما قاموا فيكم بثلاث ما إن استرحموا رحموا وإن حكموا عدلوا وان قالوا أوفوا ومن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا الصرف النافلة والعدل الفريضة وهذا قول رسول الله ﷺ وما أعظم الخطر في أمر ينتهي إلى ألا يقبل بسببه فريضة ولا نافلة وقد روى أيضا انه ﷺ قال من حكم بين اثنين فجار وظلم فلعنة الله على الظالمين وقد روى أبو هريرة أنه ﷺ قال ثلاثة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة الإمام الكذاب الشيخ الزاني والعائل المزهو وروى الحسن عن رسول الله ﷺ أنه قال يفتح عليكم مشارق الارض ومغاربها وعمالها كلهم في النار إلا من اتقى الله تعالى وأدى الامانة وقد روى عن الحسن أنه قال عاد عبيد الله بن الحسن معقلا في مرضه الذي قبض فيه فقال له معقل إني محدثك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه يقول ما من عبد يستر عنه الله تعالى رعيته يموت يوم يموت غاشا لرعيته إلا حرم الله تعالى عليه الجنة وروى زياد بن أبيه عن رسول الله ﷺ أنه قال من ولى من أمر المسلمين شيئا ولم يحطهم بالنصيحة كما يحوط على أهل بيته فليتبوأ مقعده من النار وقد حكى عن سفيان الثوري أنه عاتب رجلا من إخوانه قد كان هم أن يتلبس بشيء من أمر الولاية فقال يا أبا عبد الله إن على عيالا فقال له لأن تجعل في عنقك مخلاة تسأل على الأبواب خير لك من أن تدخل في شيء من أمور الناس وقد روى معقل بن يسار عنه ﷺ أنه قال رجلان من أمتي لا تنالهما شفاعتي إمام ظلوم غشوم وغال في الدين مارق منه وروى أبو سعيد الخدري أنه ﷺ قال أشد الناس عذابا يوم القيامة إمام جائر وروى عن النبي ﷺ أنه قال خمسة غضب الله تعالى عليهم إن شاء أمضى غضبه عليهم في الدنيا وإلا فمأواهم في الآخرة النار أمير قوم يأخذ حقه من رعيته ولا ينصفهم من نفسه ولا يدفع المظالم عنهم وزعيم قوم يطيعونه فلا يسوي بين الضعيف والقوي ويتكلم بالهوى ورجل لا يأمر أهله وولده بطاعة الله ولا يعلمهم أمور دينهم ولا يبالي ما أخذوا من دنياهم وما تركوا ورجل استأجر أجيرا فيستعمله ولا يوفيه أجره ورجل ظلم امرأة مهرها وقد روى أن عمر بن الخطاب خرج في جنازة ليصلي عليها فلما وضعت فإذا برجل قد سبق إلى الصلاة ثم لما وضع الرجل في قبره تقدم الرجل فوضع يده على التراب وقال اللهم إن تعذبه فربما عصاك وإن ترحمه فإنه فقير إلى رحمتك طوبى لك إن لم تكن أميرا أو عريفا أو كاتبا أو شرطيا أو جابيا قال ثم ذهب الرجل فلم يقدر عليه فأخبر عمر به فقال لعله الخضر ﷺ وروى عن مالك بن دينار أنه قال قرأت في بعض الكتب ما من مظلوم دعا بقلب محترق إلا لم تنته دعوته حتى تصعد بين يدي الله فتنزل العقوبة على من ظلمه أو استطاع أن يأخذ له فلم يأخذ له وروى أبو هريرة أنه ﷺ قال ويل للأمراء ويل للعرفاء ويل للأمناء ليتمنين قوم يوم القيامة أن ذوائبهم كانت معلقة بالثريا يتدلون بين السماء والأرض وأنهم لم يلوا عملا وروى أبو بريدة عنه ﷺ أنه قال لا يؤمر رجل على عشيرة فما فوقهم إلا جئ به يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه فإن كان محسنا فك عنه غله وإن كان مسيئا زيد غلا إلى غله. وهذا الخطر ثابت في أن يفرق الأمير بين نفسه وبين رعيته في الترفه بالمباحات فقد روى أن رسول الله ﷺ جلس يوم بدر في الظل فنزل جبريل فقال يا محمد أنت في الظل وأصحابك في الشمس وروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال ويل لديان أهل الأرض من ديان أهل السماء يوم يلقونه إلا من أمر بالعدل وقضى بالحق ولم يقض بهوى ولا قرابة ولا رهبة ولا رغبة ولكن جعل كتاب الله مرآة بين عينيه وأقل الأمور حاجة الإمام إلى تخويف بحكم السياسة وقد روى ابن عمر أن النبي ﷺ قال من نظر إلى مؤمن نظرة يخيفه بها في غير حق أخافه الله تعالى بها يوم القيامة وروى أنس بن مالك أنه ﷺ قال يؤتى بالولاة يوم القيامة فيقول الرب تعالى أنتم كنتم رعاة غنمي وخزان أرضى فيقول لهم ما حملكم على أن جلدتم فوق ما أمرتم فيقول أي رب غضبت لك فيقول أينبغي لك أن تكون أشد غضبا مني ويقول للآخر ما حملك على أن جلدت دون ما أمرت فيقول أي رب رحمته فيقول أينبغي لك أن تكون أرحم مني خذوا المقصر عن أمري والزائد على أمري فسدوا بهما أركان جهنم وبهذا الحديث يتبين أنه لا ينبغي أن نفزع إلا إلى الشرع وأنه لا شيء أهم للأئمة من معرفة أحكام الشرع وروى عن حذيفة أنه قال ما أنا بمثن على وال خيرا عادلهم وجائرهم فقيل له لم قال سمعت رسول الله ﷺ يقول يؤتى بالولاة يوم القيامة عادلهم وجائرهم فيقفون على الصراط فيوحي الله تعالى إلى الصراط فيزحف بهم زحفه يبقي جائر في حكمه ولا مرتش في قضائه ولا ممكن سمعه لأحد الخصمين مالم يمكن للأخر إلا زالت قدماه سبعين عاما في جهنم وروى أن النبي ﷺ كان يخرج متنكرا يطوف في الافاق يسأل داود فيهم فتعرض له جبريل ﷺ على صورة آدمي فسأله عن سيرته فقال جبريل نعم الرجل داود ونعم السيرة سيرته غير أنه يأكل من بيت مال المسلمين ولا ياكل من كد يده فرجع باكيا متضرعا إلى محرابه يسأل ربه تعالى أن يعلمه صنعة يأكل منها فعلمه صنعة الدروع وألان له الحديد فذلك قوله تعالى: {وعلمناه صنعة لبوس لكم}.
هذا خطر الإمامة وفيها أحاديث كثيرة يطول إحصاؤها وهذا القدر كاف للبصير المعتبر وعلى الجملة فيكفي من معرفة خطرها سيرة عمر رضي الله عنه فأنه كان يتجسس ويتعسس ليلا ليعرف أحوال الناس وكان يقول لو تركت حربه على ضفة الفرات لم بطلا بالهنا فأنا المسئول عنها يوم القيامة ومع ذلك فقد روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال دعوت الله تعالى اثنتى عشرة سنة اللهم أرني عمر بن الخطاب في منامي فرأيته بعد اثنى عشرة سنة كانما اغتسل واشتمل بالازار فقلت يا أمير المؤمين كيف وجدت الله تعالى قال يا أبا عبد الله كم منذ فارقتكم قلت منذ اثنتى عشرة سنه قال كنت في الحساب إلى الآن ولقد كادت تزل سريرتي لولا اني وجدت ربا رحيما فهذه حال عمر ولم يملك من الدنيا سوى درة فليعتبر به.
وقد حكى عن يزدجرد بن شهريار آخر ملوك العجم أنه بعث رسولا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأمره أن ينظر في شمائله فلما دخل المدينة قال أين ملككم قالوا ليس لنا ملك لنا أمير خرج برا فخرج الرجل في أثره فوجده نائما في الشمس ودرته تحت راسه وقد عرق جنبه حتى ابتلت منه الأرض فلما رآه على حالته قال عدلت فأمنت فنمت وصاحبنا جار فخاف فسهر أشهد أن الدين دينكم ولولا أني رسول لأسلمت وسأعود بإذن الله تعالى.
ومنها أن يكون الوالي متعطشا إلى نصيحة علماء الدين متعظا بمواعظ الخلفاء الراشدين ومتصفحا في مواعظ مشايخ الدين للامراء المنقرضين ونحن نورد الآن بعض تلك المواعظ فأنه قد روى ان عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الاشعري أما بعد فإن أسعد الرعاة عند الله من سعدت به رعيته وإن اشقى الرعاة عند الله من شقيت به رعيته وإياك أن ترتع فترتع عمالك فيكون مثلك عند الله مثل بهيمة نظرت إلى خضرة من الأرض فرتعت فيها تبتغي في ذلك السمن وإنما حتفها في سمنها وإنما قال ذلك لأن الوالي مأخوذ بظلم عماله وظلم جميع حواشيه فكل ذلك في جريدته وينسب إليه وقد روى انه أنزل في التوراة على موسى عليه السلام انه ليس على الإمام من ظلم العامل وجوره مالم يبلغه ذلك من ظلمه وجوره فإذا بلغه فاقره شركه في ظلمه وجوره.
وقد روي أن شقيق البلخي دخل على هارون الرشيد فقال له أنت شقيق الزاهد فقال له أما شقيق فنعم واما الزاهد فيقال فقال له عظني فقال له إن الله تعالى أنزلك منزلة الصديق وهو يطلب منك الصدق كما تطلبه منه وأنزلك منزلة الفاروق وهو يطلب منك الفرق بين الحق والباطل كما تطلبه منه وأنزلك منزلة ذي النورين وهو يطلب منك الحياء والكرامة كما تطلبه منه وانزلك منزلة علي بن أبي طالب وهو يطلب منك العلم كما تطلبه منه ثم سكت فقال له زدني قال نعم ان لله دارا سماها جهنم وجعلك بوابا لها واعطاك بيت مال المسلمين وسيفا قاطعا وسوطا موجعا وامرك ان ترد الخلق من هذه الدار بهذه الثلاث فمن أتاك من أهل الحاجة فاعطه من هذا البيت ومن تقدم على نهى الله فأوجعه بهذا السوط ومن قتل نفسا بغير حق فاقتله بهذا السيف بأمر ولى المقتول فإنك إن لم تفعل ذلك فأنت السابق والخلق تابع لك إلى النار قال زدني قال نعم أنت العين والعمال الأنهار إن صفت العين لم يصر كدر الأنهار وإن كدرت العين لم يرج صفاء الأنهار وقد حكى أن هارون الرشيد قصد الفضيل بن عياض ليلا مع العباس في داره فلما وصل إلى بابه سمع قراءته وهو يقرأ {أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون} فقال هارون للعباس إن انتفعنا بشيء فبهذا فدق العباس الباب وقال أجب أمير المؤمنين قال وما يعمل عندي أمير المؤمنين فقال أجب إمامك ففتح الباب وأطفأ سراجه وجلس في وسط البيت في الظلمة فجعل هارون يطوف حتى وقعت عليه يده فقال آه من يد ما ألينها إن نجت من عذاب الله يوم القيامة فجلس وقال يا أمير المؤمنين استعد لجواب الله تعالى يوم القيامة فإنك تحتاج أن تتقدم مع كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة فجعل هارون يبكي فقال العباس اسكت فقد قتلت أمير المؤمنين فقال يا هامان تقتله أنت وأصحابك وتقول لي أنت قتلته فقال هارون ما سماك هامان إلا وجعلني فرعون فقال له هارون هذا مهر والدتي ألف دينار تقبلها مني فقال يا أمير المؤمنين لا جزاك الله إلا جزاءك أقول لك ردها على من أخذتها منه وتقول لى خذها أنت فقام وخرج وقد حكى عن محمد بن كعب القرظى أنه قال عمر بن عبد العزيز صف لى العدل فقال يا أمير المؤمنين كن لصغير المسلمين أبا وللكبير منهم ابنا وللمثل أخا وعاقب كل واحد منهم بقدر ذنبه على قدر جسمه وإياك أن تضرب بغضبك سوطا واحدا فتدخل النار وقد حكى عن الحسن أنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز أما بعد فإن الهول الأعظم ومقطعات الأمور كلهن أمامك لم تقطع منهن شيئا فلذلك فاعدد ومن شرها فاهرب والسلام عليك وقد حكى أن بعض الزهاد دخل على بعض الخلفاء فقال له عظني فقال له يا أمير المؤمنين كنت أسافر الصين فقدمتها مدة وقد أصيب ملكها بسمعه فبكى بكاء شديدا وقال أما إني لست ابكي على البلية النازلة ولكني أبكي لمظلوم على الباب يصرخ فلا يؤذن له ولا أسمع صوته ولكني إن ذهب سمعي فإن بصري لم يذهب نادوا في الناس لا يلبس أحد ثوبا أحمر إلا متظلم ثم كان يركب الفيل في نهاره حتى يرى حمرة بباب المظلومين فهذا يا أمير المؤمنين مشترك بالله تعالى غلبت عليه رأفته ورحمته على المشركين وأنت مؤمن بالله تعالى من أهل بيت نبيه ﷺ كيف لا تغلب رأفتك بالمؤمنين وحكى أيضا أن سليمان بن عبد الملك قدم المدينة وهو يريد مكة فأقام بها أياما فأرشد إلى أبي حازم فدعاه فلما دخل عليه قال له سليمان يا أبا حام ما لنا نكره الموت ونحب الحياة {فقال} لأنكم خربتم آخرتكم وعمرتم الدنيا فكرهتم أن تنقلوا من العمران إلى الخراب فقال يا أبا حازم كيف القدوم على الله تعالى غدا فقال يا أمير المؤمنين أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله واما المسيء فكالآبق يقدم على مولاه فبكى سليمان وقال ليت شعري ما لي عند الله غدا قال أبو حازم اعرض عملك على كتاب الله تعالى حيث يقول إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم قال سليمان فأين رحمة الله قال {قريب من المحسنين} ثم قال سليمان يا أبا حازم أي عباد الله أكرم قال أهل المروءة والتقى قال أي الأعمال أفضل قال أداء الفرائض مع اجتناب المحارم قال فأي الدعاء اسمع قال دعاء المحسن إليه للمحسنين قال فأي الصدقة أزكى قال صدقة على السائل الناس وجهد المقل ليس فيها من ولا أذى قال فأي القول اعدل قال قول الحق عند من يخاف ويرجو قال فأي المؤمنين أكيس قال رجل عمل بطاعة الله تعالى وذكر الناس عليها قال فأي المؤمنين أفسق قال رجل أخطأ في هوى أحبه وهو ظالم باع آخرته بدنيا غيره قال سليمان فما تقول فيما نحن فيه فقال يا أمير المؤمنين أو تعفيني قال لا ولكن نصيحة تلقيها إلي قال يا امير المؤمنين إن آباءك قهروا الناس بالسيف وأخذوا هذا الملك عنوة من غير مشورة من المسلمين ولا رضا أحد حتى قتلوا وقد قتلوا قتلة عظيمة وقد ارتحلوا فلو شعرت ما قالوا وما قيل لهم فقال له رجل من جلسائه بئس ما قلت قال أبو حازم إن الله تعالى أخذ الميثاق على العلماء ليبيننه للناس ولا يكتمونه فقال كيف لنا أن نصلح هذا الفساد فقال أن تأخذه من حله وتضعه في حقه فقال ادع لي قال أبو حازم اللهم إن كان سليمان وليك فيسره لخير الدنيا والآخرة وإن كان عدوك فخذ بناصيته إلى ما تحب وترضى فقال سليمان أوصني قال أوصيك وأوجز عظم ربك ونزهه أن يراك حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك وقد حكى عن أبي قلابة أنه دخل على عمر بن عبد العزيز فقال له يا أبا قلابة عظني فقال يا أمير المؤمنين إنه لم يبق من لدن آدم ﷺ إلى يومنا هذا خليفة غيرك قال له زدني قال أنت أول خليفة يموت قال زدني قال إذا كان الله معك فمن تخاف وإذا كان عليك فمن ترجو قال حسبي. وحكي عن سليمان بن عبد الملك أنه تفكر يوما فقال كيف تكون حالي وقد ترفهت في هذه الدنيا فأرسل إلى أبي حازم وقال تبعث إلى بذلك الذي تفطر عليه بالعشاء فأنفذ إليه شيئا من النخالة المقلية قال أبل هذا بالماء فأفطر به فهو طعامي فبكى سليمان وعمل ذلك في قلبه وصام ثلاثة أيام ما ذاق شيئا حتى فرع بطنه من مأكولاته ثم أفطر في اليوم الثالث بتلك النخالة فقضى أن قارب اهله تلك الليلة فولد له عبد العزيز بن سليمان ومن عبد العزيز عمر فهو واحد زمانه وذلك من بركة تلك النية الصادقة وحكي أنه قيل لعمر بن عبد العزيز ما كان بدء توبتك قال أردت ضرب غلام فقال لي يا عمر اذكر ليلة صحبتها يوم القيامة وحكى أن زاهدا كتب إلى عمر ابن عبد العزيز وقال في كتابه اعتصم بالله يا عمر اعتصام الغريق بما ينجيه من الغرق وليكن دعاؤك دعاء المنقطع المشرف على الهلكة فانك قد أصبحت عظيم الحاجة شديد الاشراف على المعاطب وقد حكي عن هارون الرشيد أنه قال للفضيل عظني قال بلغني أن عمر ابن عبد العزيز شكى إليه بغض عماله فكتب إليه يا أخي اذكر سهر أهل النار في النار مع خلود الأبد بعد النعيم والظلال فإن ذلك يطرد بك إلى ربك نائما ويقظان واياك أن يتصرف بك من عند الله فتكون آخر العهد منقطع الرجاء فلما قرأ الكتاب قدم على عمر فقال له ما أقدمك قال خلع قلبي كتابك لا وليت ولاية حتى ألقى الله تعالى وقد حكى عن إبراهيم بن عبد الله الخراساني أنه قال حججت مع أبي سنة حج الرشيد فإذا نحن بالرشيد وهو واقف حاسر حاف على الحصباء وقد رفع يديه وهو يرتعد ويبكي ويقول يا رب أنت أنت وأنا أنا أنا العواد إلى الذنب وأنت العواد إلى المغفرة اغفر لي فقال لي يا بني انظر إلى جبار الأرض كيف يتضرع إلى جبار السماء وحكى أنه دخل رجل على عبد الملك بن مروان وكان يوصف بحسن العقل والأدب فقال له عظني فقال يا أمير المؤمنين إن للناس في القيامة جولة لا ينجو من غصص مرارتها ومعاينة الردى فيها إلا من أرضى الله بسخط نفسه قال فبكى عبد الملك ابن مروان ثم قال لا جرم لأجعلن هذه الكلمات مثالا نصب عيني ما عشت أبدا وحكى عن عمر بن عبد العزيز أنه قال لأبي حازم عظني قال أضطجع ثم اجعل الموت عند راسك ثم انظر ما تحب أن يكون فيك تلك الساعة فخذ به الآن وما تكره أن يكون فيك تلك الساعة فدعه الآن فلعل الساعة قريبة وحكى أن أعرابيا دخل على سليمان بن عبد الملك فقال له تكلم يا أعرابي فقال يا أمير المؤمنين إني لمكلمك بكلام فاحتمله وان كرهته فإن وراءه ما تحب أن قبلته فقال يا أعرابي إنا لنجود بسعة الاحتمال على من نرجو نصحه ونأمن غشه فقال الأعرابي إنه قد تكنفك رجال أساءوا الاختيار لأنفسهم فابتاعوا دنياهم بدينهم ورضاك بسخط ربهم خافوك في الله ولم يخافوا الله فيك حرب للاحرة سلم للدنيا فلا تأمنهم على ما امتحنك الله عليه فإنهم لن بألوا في الامانة تضييعا وفي الأمة خسفا وعسفا وانت مسئول عما اجترحوا وليسوا بمسئولين عما اجترحت فلا تصلح دنياهم بفساد آخرتك فإن أعظم الناس غبنا من باع آخرته بدنيا غيره فقال سليمان أما أنك يا عرابي قد سللت لسانك وهو اقطع من سيفك قال أجل يا أمير المؤمنين ولكن عليك لا لك وقد حكى أن صالح بن بشير دخل على المهدي وجلس معه على الفراش فقال له المهدي عظني قال أليس قد جلس هذا المجلس أبوك وعمك قبلك قال نعم قال فكانت لهم أعمال ترجولهم بها النجاة من الله تعالى قال نعم قال وأعمال تخاف عليهم بها الهلكة قال نعم قال فانظر ما رجوت لهم فأته وما خفت عليهم فاجتنبه قال قد أبلغت وأوجزت. وقد حكي أن أبا بكرة دخل على معاوية فقال اتق الله يا معاوية واعلم أنك في كل يوم يخرج عنك وفي كل ليلة تأتي عليك لا تزداد من الدنيا إلا بعدا ومن الآخرة الإ قربا وعلى أثرك طالب لا تفوته وقد نصب لك علم لا تجوزه فما أسرع ما يبلغ العلم وما أقرب ما يلحق بك الطالب وما نحن فيه زائل والذي نحن صائرون إليه باق أن خيرا فخير وإن شرا فشر.
ومنها أن تكون العادة الغالبة على والي الأمر العفو والحلم وحسن الخلق وكظم الغيظ مع القدرة فقد حكي أنه حمل إلى أبي جعفر رجل قد جنى جناية فأمر بقتله فقال المبارك بن فضالة وكان حاضرا يا أمير المؤمنين ألا أحدثك حديثا سمعته من الحسن قال وما هو قال سمعت الحسن رحمه الله يقول إذا كان يوم القيامة جمع الناس في صعيد واحد فيقوم مناد ينادي من له عند الله يد فليقم فلا يقوم إلا من عفا فقال خلوا عنه وحكى عن عيسى ابن مريم ﷺ أنه قال ليحيى بن زكريا ﷺ إذا قيل لك ما فيك فأحدث لله شكرا وإذا قيل ما ليس فيك فأحدث لله شكرا أعظم منه إذ تيسرت لك حسنة لم يكن لك فيها عمل وروى أبو هريرة أنه ﷺ قال ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وحكي أن رجلا أتى إلى رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله إن خادمي يسيء ويظلم أفأ ضربه قال تعفو عنه كل يوم سبعين مرة وروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ أنه قال ألا أدلك على خير أخلاق الأولين والآخرين قال قلت بلى يا رسول الله قال تعطي من حرمك وتعفوا عمن ظلمك وتصل من قطعك وروى عن عمر بن عبيد الله أنه قال ثلاث من كن فيه استكمل الإيمان إذا غضب لم يخرجه غضبه إلى الباطل وإذا رضى لم يخرجه رضاه عن الحق وإذا قدر لم يأخذ ما ليس له وقد روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لا يغرنك خلق امرئ حتى يغضب ولا دينه حتى يطمع فانظر على أي جنبيه يقع وقد روى عن علي بن الحسين رضي الله عنهما انه خرج من المسجد فلقيه رجل فسبه فثارت إليه العبيد والموالي فقال علي ابن الحسين مهلا عن الرجل ثم اقبل عليه وقال ما ستر عنك من امرنا لكثير الك حاجة نعينك عليها فاستحيا الرجل ورجع إلى نفسه فألقى أليه خميصة كانت عليه وأمر له بألف درهم فكان الرجل بعد ذلك يقول أشهد انك من أولاد الرسل وقد روى عنه أيضا انه دعا مملوكا له مرتين فلم يجبه ثم اجابه في الثالثة فقال له اما سمعت صوتي قال بلى قال فما بالك لم تجبني قال أمنتك قال الحمد لله الذي جعل مملوكي بحيث يأمنني وقد حكى أنه جاء غلام لأبي ذر بشاة له قد كسر رجلها فقال له أبو ذر من كسر رجل هذه الشاة قال أنا قال ولم فعلت ذلك قال عمدا لأغضبك فتضربني فتأثم قال أبو ذر لأغيظن من حضك على غيظي فأعتقه وروى عنه أنه شتمه رجل فقال يا هذا إن بيني وبين الجنة عقبة فإن أنا جزتها فوالله ما أبالي بقولك وإن قصرت دونها فأنا أهل لأشر مما قلت وروى ابن عباس عن رسول الله ﷺ أنه قال ثلاث من لم تكن فيه واحدة منهن فلا يعتدن بشيء من عمله من لم تكن فيه تقوى تحجزه عن معاصي الله أو حلم يكفه عن السفه أو خلق يعيش به في الناس وثلاث من كان فيه واحدة منهن زوج من الحور العين رجل اؤتمن على أمانة خفية شهية فأداها من مخافة الله تعالى ورجل عفا عن قاتله ورجل قرأ قل هو الله أحد في دبر كل صلاة وثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن أكن خصمه أخصمه رجل أستأجر أجيرا فظلمه ولم يوفه أجره ورجل حلف بي ثم غدر ورجل باع حرا وأكل ثمنه ومن كفل ثلاثة أيتام كان كالذي قام ليله وصام نهاره وعدا وراح شاهرا سيفه في سبيل الله وكنت أنا وهو في الجنة كهاتين وأشار إلى السبابة والوسطى وقد روى عن علي رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال إن الرجل المسلم ليدرك بالحلم درجة الصائم القائم وإنه ليكتب حبارا وما يهلك إلآ أهل بيته وروى ابن عباس عن علي رضي الله عنهما أنه قال أوصاني رسول الله ﷺ حين زوجني فاطمة رضي الله عنها خصوصا دون غيري فكان مما أوصاني به أن قال يا علي لا تغضب وإذا غضبت فاقعد واذكر قدرة الله تعالى على العباد وحلمه عنهم وإذا قيل لك اتق الله فاترك غضبك عنك وأرجع بحلمك وقد روى ابن عباس عنه ﷺ إن لجهنم بابا لا يدخله إلا من شفى غيظه بمعصية الله وروى أن إبليس اللعين ظهر لموسى ﷺ فقال له يا موسى إنك الليلة تناجي ربك ولى إليك حاجة فاقضها وأنا أعلمك خصالا ثلاثا فيهن الدنيا والآخرة فقال له موسى ما هذه الخصال قال إياك والحدة فاني ألعب بالرجل الحديد كما تلعب الصبيان بالكرة (يا موسى اياك والنساء فاني لم أنصب قط فخأ اثبت في نفسي من فخ انصبه بامرأة) يا موسى اياك والشح فإني أفسد على الشحيح الدنيا والآخرة وروى عن رسول الله ﷺ أنه قال من كظم غيظا وهو يقدر على انفاذه ملأه الله ايمانا وأمنا ومن وضع ثوب جمال تواضعا لله وهو يقدر عليه كساه الله تعالى حلة الكرامة وحكي أن ذا القرنين لقى ملكا من الملائكة فقال له علمني عملا أزداد به إيمانا ويقينا فقال لا تغضب فإن الشيطان أقدر ما يكون على ابن آدم إذا غضب وإذا غضبت فرد الغضب بالكظم وسكنه بالتؤدة وإياك والعجلة فإنك إذا عجلت أخطأت حظك وكن سهلا لينا للقريب والبعيد ولا تكن جبارا عنيدا وقد روى أبو هريرة عن النبي ﷺ أنه قال الويل لمن يغضب وينسى غضب الله تعالى عباد الله إياكم والغضب والظلم فإن عقوبتهما شديدة ومن غضب في غير ذات الله جاء يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه وروى أبو هريرة أيضا أن رجلا جاء إلى رسول الله ﷺ وقال يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة قال لا تغضب ولك الجنة قال زدني قال استغفر الله تعالى دبر صلاة العصر سبعين مرة بغفر الله لك ذنب سبعين سنة ليس لي ذنوب سبعين سنة قال فلآمك قال ولا لأمي قال فلأبيك قال ولا لأبي قال فلإخوانك وقد روى عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله وسلم قسم قسما فقال رجل من الأنصار هذه قسمة ما أريد بها وجه الله قال ابن مسعود يا عدو الله لأخبرن رسول الله ﷺ قال فأخبرته فأحمر وجهه وقال رحمة الله على موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر.
وهذا القدر الذي روى من الآثار والأخبار وسير الخلفاء وأئمة الأعصار كاف للمتعظ به وللمصغي إليه في تهذيب (الأخلاق ومعرفة) وظائف الخلافة فالعامل به مستغن عن المزيد والله ولي التوفيق.

تم الكتاب والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين. وقع الفراغ منه يوم السبت لسبعة عشر يوما خلت من شهر ربيع الآخر سنة خمس وستين وستمائة.
نهاية مخطوط جامع القرويين بفاس: نجز بحمد الله تعالى وقوته كتاب المستظهري في فضائح الباطنية على يد الفقير المذنب الراجي عفو ربه أبو الحسن علي بن سعيد بن مسعود التملي اللهم اغفر له ولوالديه ولعشيرته ولجميع المسلمين يوم الجمعة الأول من ربيع الثاني عام واحد وثمانين وتسعمائة بمدينة فاس أدام الله خيرها وعمرها بالإسلام وصلى الله على نبينا وشفيعنا غدا محمد ﷺ وشرف وكرم وعز وعظم.
محتويات
1 الباب الأول في الإعراب عن المنهج الذي استنهجته في هذا الكتاب
1.1 المقام الثاني في التعبير عن المقاصد إطنابا وإيجازا
1.2 المقام الثالث في التقليل والتكثير
2 الباب الثاني في بيان ألقابهم والكشف عن السبب الداعي لهم على نصب هذه الدعوة
2.1 الفصل الأول في ألقابهم التي تداولتها الألسنة على اختلاف الأعصار والأزمنة
2.2 الفصل الثاني في بيان السبب الباعث لهم على نصب هذه الدعوة وإفاضة هذه البدعة
3 الباب الثالث في درجات حيلهم وسبب الاغترار بها مع ظهور فسادها
3.1 الفصل الأول في درجات حيلهم
4 الباب الرابع في نقل مذاهبهم جملة وتفصيلا
4.1 الطرف الأول في معتقدهم في الإلهيات
4.2 الطرف الثاني في بيان معتقدهم في النبوات
4.3 الطرف الثالث بيان معتقدهم في الإمامة
4.4 الطرف الرابع بيان مذهبهم في القيامة والمعاد
4.5 الطرف الخامس في اعتقادهم في التكاليف الشرعية
5 الباب الخامس في إفساد تأويلاتهم للظواهر الجلية واستدلالاتهم بالأمور العددية
5.1 الفصل الأول في تأويلاتهم للظواهر
5.2 الفصل الثاني في استدلالهم بالأعداد والحروف
6 الباب السادس في الكشف عن تلبيساتهم التي زوقوها بزعمهم في معرض البرهان على إبطال النظر العقلي وإثبات وجوب التعلم من الإمام المعصوم
6.1 المنهج الأول وهو الجملي
6.2 المنهج الثاني في الرد عليهم تفصيلا
7 الباب السابع في إبطال تمسكهم بالنص في إثبات الإمامة والعصمة
7.1 الفصل الأول في تمسكهم بالنص على الإمامة
7.2 الفصل الثاني في إبطال قولهم إن الإمام لا بد أن يكون معصوما من الخطأ والزلل والصغائر والكبائر
8 الباب الثامن في الكشف عن فتوى الشرع في حقهم من التفكير وسفك الدم
8.1 الفصل الأول في تكفيرهم أو تضليلهم أو تخطئتهم
8.2 الفصل الثاني في أحكام من قضي بكفره منهم
8.3 الفصل الثالث في قبول توبتهم وردها
8.4 الفصل الرابع في حيلة الخروج عن إيمانهم وعهودهم إذا عقدوها على المستجيب
9 الباب التاسع في إقامة البراهين الشرعية على أن الإمام القائم بالحق الواجب على الخلق طاعته في عصرنا هذا هو الإمام المستظهر بالله حرس الله ظلاله
10 الباب العاشر في الوظائف الدينية التي بالمواظبة عليها يدوم استحقاق الإمامة
========
أيها الولد
اقرأ عن أيها الولد في ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
أيها الولد
للغزالي
أيها الولد المحب
اعلم أيها الولد المحب العزيز أطال الله تعالى بقائك بطاعته وسلك بك سبيل أحباؤه أن منشور النصيحة يكتب من معدن الرسالة عليه الصلاة والسلام إن كان قد بلغك منه نصيحة فأي حاجة لك في نصيحتي ، وإن لم يبلغك فقل لي : ماذا حصلت في هذه السنين الماضية ؟!
أيها الولد
من جملة ما نصح به رسول الله ﷺ أمته قوله " علامة إعراض الله تعالى عن العبد اشتغاله بما لا يعنيه ، وإن امرأ ذهبت ساعة من عمره في غير ما خلق له لجدير أن تطول عليه حسرته ، ومن جاوز الأربعين ، ولم يغلب خيره شره فليتجهز للنار".
وفى هذه النصيحة كفاية لأهل العلم.
أيها الولد
النصيحة سهلٌ ، والمُشْكِلُ قَبولُها ، لأنَّها في مذاقِ متَّبعِي الهوى مرٌّ ؛ إذِ المناهي محبوبةٌ في قلوبِهِم، على الخصوص مَنْ كانَ طالبَ العلمِ الرسميِّ ، مشتغلَ في فضلِ النفسِ ومناقب الدنيا ؛ فإِنَّهُ يَحْسَبُ أَنَّ العِلْمَ المُجَرَّدَ لَهُ وسيلةٌ ، سَيَكُونُ نَجَاتُهُ وَخَلَاصُهُ فِيهِ ، وأَنَّهُ مُسْتَغْن عَنْ العَمَلَ ، و هذا اعْتِقَادُ الفَلَاسِفَةِ. سبحان الله العظيم !! لا يَعْلَمُ هذَا القّدْرَ أَنَّهُ حين حصَّل العلمَ إذا لم يعمل به .. تكون الحُجَّةُ عليه آكدَ ؛ كما قال رسول الله ﷺ : " إنَّ أشدَّ النَّاسِ عَذاباً يومَ القِيامَةِ .. عالمٌ لمْ ينْفَعْهُ اللهُ بِعِلْمِهِ"
وروى : أن الجنيد - رحمه الله - رئى في المنام بعد موته ، فقيل له: ما الخبر يا أبا القاسم؟ قال: طاحت العبارات، وفنيت الإشارات ، وما نفعنا إلا ركعات ركعناها في جوف الليل.
أيها الولد
لا تكنْ مِنَ الأَعْمالِ مُفْلِساً ، ولا مِنَ الأَحْوالِ خَالِياً ، وتَيَقَّنْ أَنَّ العِلْمَ المُجَرَّدَ لا يَأخُذُ بِاليَدِ . مِثَالُهُ : لَوْ كانَ على رَجُلٍ في بَرِّيَّةٍ عَشْرَةُ أَسْيافٍ هِنْدِيَّةٍ مَعَ أَسْلِحَةٍ أُخْرَى ، وَكَاَن الرَّجُلُ شُجَاعاً وأَهْلَ حَرْب ، فَحَمَلَ عَلَيْهِ أَسَدٌ عَظِيمٌ مَهيبٌ فَمَا ظَنُّكَ ؟ هَلْ تَدْفَعُ الأَسْلِحَةُ شَرَّهُ عَنْهُ بِلا اسْتِعْمالِها وضَرْبِها ؟! ومِنَ المَعْلُومِ أَنَّهَا لَا تَدْفَعُ إِلَّا بالتَّحْرِيكِ والضَّرْبِ . فَكَذَا لَوْ قَرأَ رَجُلُ مِائَةَ أَلْفِ مَسْأَلَةٍ عِلْمِيَّةٍ وتَعَلَّمَهَا ولم يَعْمَلْ بِهَا ، لا تُفِيدُهُ إِلَّا بِالعَمَلِ.
ومِثَالُهُ أيضاً : لَوْ كَان لرَجُلٍ حَرَارَةٌ و مَرَضٌ صَفْرَاوِي يَكُونُ عِلاجُهُ بالسَّكَنْجَبِينِ و الكَشكَاب فَلا يَحْصُلُ البُرْءُ إلَّا باسْتِعْمَالِهِمَا.
كَرْ مَيْ دُو هَزَار رِطْل بَيْمايي … تا مَيْ نَخُوري نبا شَدَتْ شيدايي. "ملاحظة : معناه : إن كِلْتَ ألفي رِطْلِ خَمْراً …. لا تكون سكرانَ ومجنونا ما لم تشربها"
أيها الولد
أيها الولد لو قرأت العلم مائة سنة ، وجمعت ألف كتاب ، لا تكون مستعدا لرحمة الله إلا بالعمل لقوله تعالى : "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى" وقوله تعالى " فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا " وقوله "جزاء بما كانوا يكسبون " وقوله "إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات" .
أيها الولد ما لم تعمل لن تجد أجرا.
حكي أن رجلا من بني إسرائيل عبد الله تعالى سبعين سنة ، فأراد الله تعالى أن يجلوه على الملائكة فأرسل الله إليه ملكا يخبره أنه مع تلك العبادة لا يليق به دخول الجنة، فلما بلغه قال العابد : نحن خلقنا للعبادة ، فينبغي لنا أن نعبده . فلما رجع الملك قال الله تعالى: ماذا قال عبدي؟ قال : إلهي ، أنت أعلم بما قال، فقال الله تعالى : إذا هو لم يعرض عن عبادتنا ، فنحن – مع الكرم- لا نعرض عنه، أشهدوا يا ملائكتي أنى قد غفرت له.
وقال الحسن رحمه الله: طلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب.
أيها الولد
عش ما شئت فإنك ميت ، وأحبب من شئت فإنك مفارقه ، وأعمل ما شئت فإنك مجزى به.
أيها الولد
إني رأيت في الإنجيل أن عيسى عليه السلام قال : من ساعة يوضع الميت على الجنازة إلى أن يوضع على شفير القبر يسأل الله بعظمته منه أربعين سؤالا ، أوله : يقول "عبدي طهرت منظر الخلق سنين وما طهرت منظري ساعة".
أيها الولد
العلم بلا عمل جنون ، والعمل بغير علم لا يكون .
أيها الولد
اجعل الهمة في الروح، والهزيمة في النفس ، والموت في البدن ، لأن منزلك القبر وأهل المقابر ينتظرونك في كل لحظة متى تصل إليهم ، إياك إياك أن تصل إليهم بلا زاد . وقال أبو بكر الصديق : هذه الأجساد قفص طيور وإصطبل الدواب ، فتفكر في نفسك من أيهما أنت؟
إن كنت من الطيور العلوية فحين تسمع طنين طبل ربك "أرجعى إلى ربك " تصير صاعدا إلى أن تقعد في أعالي بروج الجنان ، كما قال رسول الله ﷺ : "واهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ ".
والعياذ بالله إن كنت من الدواب كما قال الله تعالى " أولئك كالأنعام بل هم أضل" فلا تأمن انتقالك من زاوية الدار إلى هاوية النار.
وروى أن الحسن البصري رحمه الله تعالى أعطى شربة ماء بارد ، فلما أخذ القدح غشي عليه وسقط من يده ، فلما أفاق قيل له : مالك يا أبا سعيد ؟ قال: ذكرت أمنية أهل النار حيث يقولون لأهل الجنة : " أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله".
أيها الولد
لو كان العلم المجرد كافيا لك ، ولا تحتاج إلى عمل سواه لكان نداء الله تعالى : "هل من سائل ؟ هل من مستغفر ؟ هل من تائب ؟ " ضائعا بلا فائدة .
وروى أن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ذكروا عبد الله بن عمر عند رسول الله ﷺ فقال : " نعم الرجل هو لو كان يصلى بالليل ".
وقال رسول الله ﷺ لرجل من أصحابه : "يا فلان ….لا تكثر النوم بالليل فإن كثرة النوم بالليل تدع صاحبه فقيرا يوم القيامة" .
أيها الولد
"ومن الليل فتهجد به" أمر ، "وبالأسحار هم يستغفرون" شكر ، "والمستغفرون بالأسحار" ذكر.
قال رسول الله ﷺ: " ثلاثة أصوات يحبها الله تعالى صوت الديك ، وصوت الذي يقرأ القرآن ، وصوت المستغفرين بالأسحار " .
وقال سفيان الثوري : ان لله تعالى ريحا تهب بالأسحار تحمل الأذكار والاستغفار إلى الملك الجبار .
وقال أيضا " إذا كان أول الليل ينادى مناد من تحت العرش : ألا ليقم العابدون ، فيقومون ويصلون ما شاء الله ، ثم ينادى مناد في شطر الليل : إلا ليقم القانتون ، فيقومون ويصلون إلى السحر ، فإذا كان السحر ينادى مناد : ألا ليقم المستغفرون ، فيقومون ويستغفرون ، فإذا طلع الفجر ينادى مناد :ألا ليقم الغافلون ، فيقومون من فرشهم كالموتى نشروا من قبورهم.
أيها الولد
روى فى بعض وصايا لقمان الحكيم لابنه أنه قال: يا بنى .. لايكونن الديك أكيس منك، ينادى بالأسحار وأنت نائم.
ولقد أحسن من قال شعرا
لقد هتفت فى جنح ليل حمامة
على فنن وهنا وإنى لنائم
كذبت وبيت الله لو كنت عاشقا
لما سبقتنى بالبكاء الحمائم
وأزعم أنى هائم ذو صبابة
لربى فلا أبكى وتبكى البهائم
أيها الولد
خلاصة العلم : أن تعلم أن الطاعة والعبادة هى؟
اعلم أن الطاعة والعبادة متابعة الشارع فى الأوامر والنواهى بالقول والفعل، يعنى : كل ما تقول وتفعل، وتترك قوله وفعله يكون بأوامر الشرع، كما لو صمت يوم العيد وأيام التشريق تكون عاصيا، أو صليت فى ثوب مغصوب- وان كانت فى صورة عبادة- تأثم.
أيها الولد
ينبغى لك أن يكون قولك وفعلك موافقا للشرع، إذ العلم والعمل بلا اقتداء الشرع ضلالة، وينبغى لك ألا تغتر بشطح الصوفية وطاماتهم، لأن سلوك هذا الطريق يكون بالمجاهدة وقطع شهوة النفس وقتل هواها بسيف الرياضة ، لا بالطامات والترهات.
وأعلم ان اللسان المطلق والقلب المطبق المملوء بالغفلة والشهوة علامة الشقاوة، فإذا لم تقتل النفس بصدق المجاهدة لن يحيى قلبك بأنوار المعرفة .
ولقد وجب على السالك أربعة أمور:
أول الأمر: اعتقاد صحيح لا يكون فيه بدعة.
والثانى: توبة نصوح لا يرجع بعده إلى الذلة.
والثالث: استرضاء الخصوم حتى لا يبقى لأحد عليك حق.
والرابع: تحصيل علم الشريعة قدر ما تؤدى به أوامر الله تعالى.
ثم من العلوم الآخرة ما يكون به النجاة.
قال الشبلى أن الرسول قال: " اعمل لدنياك بقدر مقامك فيها واعمل لآخرتك بقدر بقائك فيها ، واعمل لله بقدر حاجتك إليه، واعمل للنار بقدر صبرك عليها"
أيها الولد
إن حاتم الأصم كان من أصحاب شقيق البلخى رحمة الله تعالى عليهما، فسأله يوما قال : صاحبتنى منذ ثلاثين سنة ما حصلت؟
قال : حصلت ثمانى فوائد من العلم ، وهى تكفينى منه لأنى أرجو خلاصى ونجاتى فيها. فقال شقيق ما هى؟
قال حاتم:
الفائدة الأولى:
أنى نظرت إلى الخلق فرأيت لكل منهم محبوبا ومعشوقا يحبه ويعشقه، وبعض ذلك المحبوب يصاحبه إلى مرض الموت وبعضه يصاحبه إلى شفير القبر، ثم يرجع كله ، ويتركه فريدا وحيدا، ولا يدخل معه فى قبره منهم أحد فتفكرت وقلت: أفضل محبوب المرء ما يدخل معه فى قبره، ويؤنسه فيه، فما وجدته غير الأعمال الصالحة ، فأخذتها محبوبه لى ، لتكون لى سراجا فى قبرى، وتؤنسنى فيه ، ولا تتركنى فريدا.
الفائدة الثانية:
أنى رأيت الخلق يقتدون أهواءاهم، ويبادرون إلى مرادات أنفسهم، فتأملت قوله تعالى ( واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ، فإن الجنه هى المأوى). وتيقنت أن القرآن حق صادق فبادرت إلى خلاف النفس وتشمرت بمجاهدتها ، وما متعتها بهواها ، حتى ارتاضت بطاعة الله تعالى وانقادت.
الفائدة الثالثة:
أنى رأيت كل واحد من الناس يسعى فى جمع حطام الدنيا ، ثم يمسكه قابضا يده عليه فتأملت فى قوله تعالى : ( ما عندكم ينفد وما عند الله باق ) فبذلت محصولى من الدنيا لوجه الله تعالى ففرقته بين المساكينليكون ذخرا لى عند الله تعالى.
الفائدة الرابعة :
أنى رأيت بعض الخلق يظن أن شرفه وعزه فى كثرة الأقوام والعشائر فاعتز بهم. وزعم آخرون أنه فى ثروة الأموال وكثرة الأولاد ، فافتخروا بها. وحسب بعضهم أن العز والشرف فى غصب أموال الناس وظلمهم وسفك دمائهم. واعتقدت طائفة أنه فى اتلاف المال واسرافه وتبذيره، فتأملت قوله تعالى : ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم) فاخترت التقوى واعتقدت أن القرآن حق صادق، وظنهم وحسبانهم كلها باطل زائل.
الفائدة الخامسة :
أنى رأيت الناس يذم بعضهم بعضا ، ويغتاب بعضهم بعضا ، فوجدت أصل ذلك من الحسد فى المال والجاه والعلم، فتأملت فى قوله تعالى : ( نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا) فعلمت أن القسمة كانت من الله تعالى فى الأزل، فما حسدت أحدا ورضيت بقسمة الله تعالى .
الفائدة السادسة :
أنى رأيت الناس يعادى بعضهم بعضا لغرض وسبب ، فتأملت فى قوله تعالى : ( إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا) ، فعلمت أنه لا يجوز عداوة احد غير الشيطان .
الفائدة السابعة :
أنى رأيت كل أحد يسعى بجد ، ويجتهد بمبالغة لطلب القوت والمعاش، بحيث يقع فى شبهة وحرام ويذل نفسه وينقص قدره فتأملت فى قوله تعالى : ( وما من دابه فى الأرض إلا على الله رزقها) فعلمت أن رزقى على الله تعالى وقد ضمنه ، فاشتغلت بعبادته ، وقطعت طمعى عمن سواه .
الفائدة الثامنة :
أنى رأيت كل واحد معتمدا على شىء مخلوق ، بعضهم على الدينار والدرهم ، وبعضهم على المال والملك ، وبعضهم على الحرفة والصناعة ، وبعضهم على مخلوق مثله، فتأملت فى قوله تعالى : ( ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شىء قدرا) ، فتوكلت على الله تعالى فهو حسبى ونعم الوكيل. .
فقال شقيقي : وفقك الله تعالى إنى قد نظرت التوراة والانجيل والزبور والفرقان ، فوجدت الكتب الأربعة تدور على هذه الفوائد الثمانى ، فمن عمل بها كان عاملا بهذه الكتب الأربعة.
أيها الولد
قد علمت من هاتين الحكاتين أنك لا تحتاج إلى تكثير العلم .
إنى أنصحك بأشياء ، اقبلها منى لئلا يكون علمك خصمك يوم القيامة ، تعمل منها ، وتدع منها:
أما اللواتى تدع:
فأحدها: ألا تناظر أحدا فى مسألة ما استطعت لأن فيها آفات كثيرة ، فإثمها أكبر من نفعها. نعم لو وقع مسأله بينك وبين شخص أو قوم وكانت ارادتك فيها أن تظهر الحق ولا يضيع، جاز البحث، لكن لتلك الارادة علامتان:
إحداهما : ألا تفرق بين أن ينكشف الحق على لسانك أو على لسان غيرك. والثانية: أن يكون البحث فى الخلاء، أحب إليك من أن يكون فى الملأ.
والثانى مما تدع: وهو أن تحذر وتحترز من أن تكون واعظا ومذكرا ، لأن آفته كثيرة إلا أن تعمل بما تقول أولا، ثم تعظ به الناس فتفكر فيما قيل لعيسى عليه السلام: يا ابن مريم عظ نفسك ، فان اتعظت فعظ الناس، وإلا فاستح من الله.
والثالث مما تدع: أنه لا تخالط الأمراء والسلاطين ولا ترهم لأن رؤيتهم ومجالستهم ومخالطتهم آفه عظيمة، ولو ابتليت بها دع عنك مدحم وثنائهم، لأن الله تعالى يغضب إذا مدح الفاسق والظالم، ومن دعا لطول بقائهم فقد أحب أن يعصى الله فى أرضه.
والرابع مما تدع: ألا تقبل شيئا من عطايا الأمراء وهداياهم وأن علمت أنها من الحلال ، لأن الطمع منهم يفسد الدين لأنه يتولد منه المداهنة ، ومراعاة جانبهم والموافقة فى ظلمهم ، وهذا كله فساد فى الدين، وأقل مضرته أنك إذا قبلت عطاياهم ، وانتفعت من دنياهم أحببتهم ، ومن أحب أحدا يحب طول عمره ، وبقاءه بالضرورة، وفى محبة بقاء الظالم إرادة فى الظلم على عباد الله تعالى، وإرادة خراب العالم ، فأى شىء يكون أضر من هذا على الدين والعاقبة.
وأما الأمور التى ينبغى لك فعلها:
الأول: أن تجعل معاملتك مع الله تعالى، بحيث لو عامل معك بها عبدك ترضى بها منه، ولا يضيق خاطرك عليه ولا تغضب، والذى لا ترضى به لنفسك من عبدك المجازى فلا ترضى أيضا لله تعالى وهو سيدك الحقيقى.
الثانى: كلما عملت بالناس اجعله كما ترضى لنفسك منهم، لأنه لا يكمل إيمان عبد حتى يحب لسائر الناس ما يحب لنفسه.
الثالث: إذا قرأت العلم أو طالعته ، ينبغى أن يكون علمك علما يصلح قلبك ويزكى نفسك.
أيها الولد
الآن تفكر إلى ما أشرت به فإنك فهم، والكلام الفرد يكفى الكيس.
وأما الدعاء الذى سألت منى فاطلبه من دعوات الصحاح ، واقرا هذا الدعاء فى أوقاتك ، خصوصا فى أعقاب صلواتك:
اللهم إنى أسألك من النعمة تمامها ، ومن العصمة دوامها، ومن الرحمة شمولها، ومن العافية حصولها، ومن العيش أرغده، ومن العمر أسعده ومن الاحسان أتمه ، ومن الانعام أعمه، ومن الفضل أعذبه ، ومن اللطف أقربه. تصنيف: الغزالي
==============
الاقتصاد في الاعتقاد
الاقتصاد في الاعتقاد
أبو حامد الغزالي
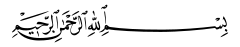
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اجتبى من صفوة عباده عصابة الحق وأهل السنة، وخصهم من بين سائر الفرق بمزايا اللطف والمنة، وأفاض عليهم من نور هدايته ما كشف به عن حقائق الدين، وأنطق ألسنتهم بحجته التي قمع بها ضلال الملحدين، وصفى سرائرهم من وساوس الشياطين، وطهر ضمائرهم عن نزغات الزائغين، وعمر أفئدتهم بأنوار اليقين حتى اهتدوا بها إلى أسرار ما أنزله على لسان نبيه وصفيه محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين، واطلعوا على طريق التلفيق بين مقتضيات الشرائع وموجبات العقول؛ وتحققوا أن لا معاندة بين الشرع المنقول والحق المعقول. وعرفوا أن من ظن من الحشوية وجوب الجمود على التقليد، واتباع الظواهر ما أتوا به إلا من ضعف العقول وقلة البصائر. وإن من تغلغل من الفلاسفة وغلاة المعتزلة في تصرف العقل حتى صادموا به قواطع الشرع، ما أتوا به إلا من خبث الضمائر. فميل أولئك إلى التفريط وميل هؤلاء إلى الافراط، وكلاهما بعيد عن الحزم والاحتياط. بل الواجب المحتوم في قواعد الاعتقاد ملازمة الاقتصاد والاعتماد على الصراط المستقيم؛ فكلا طرفي قصد الأمور ذميم. وأنى يستتب الرشاد لمن يقنع بتقليد
الأثر والخبر، وينكر مناهج البحث والنظر، أو لا يعلم انه لا مستند للشرع إلا قول سيد البشر صلى الله عليه وسلم، وبرهان العقل هو الذي عرف به صدقه فيما أخبر، وكيف يهتدي للصواب من اقتفى محض العقل واقتصر، وما استضاء بنور الشرع ولا استبصر؟ فليت شعري كيف يفزع إلى العقل من حيث يعتريه العي والحصر؟ أو لا يعلم ان العقل قاصر وأن مجاله ضيق منحصر؟ هيهات قد خاب على القطع والبتات وتعثر بأذيال الضلالات من لم يجمع بتأليف الشرع والعقل هذا الشتات. فمثال العقل البصر السليم عن الآفات والاذاء. ومثال القرآن الشمس المنتشرة الضياء. فاخلق بأن يكون طالب الاهتداء. المستغني إذا استغني بأحدهما عن الآخر في غمار الأغبياء، فالمعرض عن العقل مكتفياً بنور القرآن، مثاله المتعرض لنور الشمس مغمضاً للأجفان، فلا فرق بينه وبين العميان. فالعقل مع الشرع نور على نور، والملاحظ بالعين العور لأحدهما على الخصوص متدل بحبل غرور. وسيتضح لك أيها المشوق إلى الاطلاع على قواعد عقائد أهل السنة، المقترح تحقيقها بقواطع الأدلة، أنه لم يستأثر بالتوفيق للجمع بين الشرع والتحقيق فريق سوى هذا الفريق. فاشكر الله تعالى على إقتفائك لآثارهم وانخراطك في سلك نظامهم وعيارهم واختلاطك بفرقتهم؛ فعساك أن تحشر يوم القيامة في زمرتهم. نسأل الله تعالى أن يصفي أسرارنا عن كدورات الضلال، ويغمرها بنور الحقيقة، وأن يخرس ألسنتنا عن النطق بالباطل، وينطقها بالحق والحكمة إنه الكريم الفائض المنة الواسع الرحمة. باب ولنفتح الكلام ببيان اسم الكتاب، وتقسيم المقدمات والفصول والأبواب. أما اسم الكتاب فهو الاقتصاد في الاعتقاد. وأما ترتيبه فهو مشتمل على أربع تمهيدات تجري مجرى التوطئة والمقدمات، وعلى أربع أقطاب تجري مجرى المقاصد والغايات. التمهيد الأول: في بيان أن هذا العلم من المهمات في الدين. التمهيد الثاني: في بيان أنه ليس مهماً لجميع المسلمين بل لطائفة منهم مخصوصين. التمهيد الثالث: في بيان أنه من فروض الكفايات لا من فروض الأعيان. التمهيد الرابع: في تفصيل مناهج الأدلة التي أوردتها في هذا الكتاب. وأما الأقطاب المقصودة فأربعة وجملتها مقصورة على النظر في الله تعالى. فإنا إذا نظرنا في العالم لم ننظر فيه من حيث أنه عالم وجسم وسماء وأرض، بل من حيث
أنه صنع الله سبحانه. وإن نظرنا في النبي عليه السلام لم ننظر فيه من حيث أنه انسان وشريف وعالم وفاضل؛ بل من حيث أنه رسول الله. وان نظرنا في أقواله لم ننظر من حيث أنها أقوال ومخاطبات وتفهيمات؛ بل من حيث أنها تعريفات بواسطته من الله تعالى، فلا نظر إلا في الله ولا مطلوب سوى الله وجميع أطراف هذا العلم يحصرها النظر في ذات الله تعالى وفي صفاته سبحانه وفي أفعاله عز وجل وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاءنا على لسانه من تعريف الله تعالى. فهي إذن أربعة أقطاب: القطب الأول: النظر في ذات الله تعالى. فنبين فيه وجوده وانه قديم وأنه باق وأنه ليس بجوهر ولا جسم ولا عرض ولا محدود بحد ولا هو مخصوص بجهة، وأنه مرئي كما أنه معلوم وأنه واحد؛ فهذه عشرة دعاوى نبينها في هذا القطب. القطب الثاني: في صفات الله تعالى. ونبين فيه أنه حي عالم قادر مريد سميع بصير متكلم وأن له حياة وعلماً وقدرة وإرادة وسمعاً وبصراً وكلاماً، ونذكر أحكام هذه الصفات ولوازمها وما يفترق فيها وما يجتمع فيها من الأحكام، وأن هذه الصفات زائدة على الذات وقديمة وقائمة بالذات ولا يجوز أن يكون شيء من الصفات حادثاً. القطب الثالث: في أفعال الله تعالى. وفيه سبعة دعاوى وهو انه لا يجب على الله تعالى التكليف ولا الخلق ولا الثواب على التكليف ولا رعاية صلاح العباد ولا يستحيل منه تكليف ما لا يطاق ولا يجب عليه العقاب على المعاصي ولا يستحيل منه بعثه الأنبياء عليهم السلام؛ بل يجوز ذلك. وفي مقدمة هذا القطب بيان معنى الواجب والحسن والقبيح. القطب الرابع: في رسل الله، وما جاء على لسان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم من الحشر والنشر والجنة والنار والشفاعة وعذاب القبر والميزان والصراط، وفيه أربعة أبواب: الباب الأول: في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. الباب الثاني: فيما ورد على لسانه من أمور الآخرة. الباب الثالث: في الإمامة وشروطها. الباب الرابع: في بيان القانون في تكفير الفرق المبتدعة.
التمهيد الأول في بيان أن الخوض في هذا العلم مهم في الدين اعلم أن صرف الهمة إلى ما ليس بمهم، وتضييع الزمان بما عنه بد هو غاية الضلال ونهاية الخسران سواء كان المنصرف إليه بالهمة من العلوم أو من الأعمال، فنعوذ بالله من علم لا ينفع. وأهم الأمور لكافة الخلق نيل السعادة الأبدية واجتناب الشقاوة الدائمة، وقد ورد الأنبياء وأخبروا الخلق بأن لله تعالى على عباده حقوقاً ووظائف في أفعالهم وأقوالهم وعقائدهم. وأن من لم ينطق بالصدق لسانه ولم ينطو على الحق ضميره ولم تتزين بالعدل جوارحه فمصيره إلى النار وعاقبته للبوار. ثم لم يقتصروا على مجرد الإخبار بل استشهدوا على صدقهم بأمور غريبة وأفعال عجيبة خارقة للعادات خارجة عن مقدورات البشر، فمن شاهدها أو سمع أحوالها بالأخبار المتواترة سبق إلى عقله إمكان صدقهم، بل غلب على ظنه ذلك بأول السماع قبل أن يمعن النظر في تمييز المعجزات عن عجائب الصناعات. وهذا الظن البديهي أو التجويز الضروري ينزع الطمأنينة عن القلب ويحشوه بالاستشعار والخوف ويهيجه للبحث والافتكار ويسلب عنه الدعة والقرار ويحذره مغبة التساهل والإهمال ويقرر عنده أن الموت آت لا محالة وأن ما بعد الموت منطو عن أبصار الخلق وأن ما أخبر به هؤلاء غير خارج عن حيز الإمكان. فالحزم ترك التواني في الكشف عن حقيقة هذا الأمر. فما هؤلاء مع العجائب التي أظهروها في إمكان صدقهم قبل البحث عن تحقيق قولهم بأقل من شخص واحد يخبرنا عن خروجنا من دارنا ومحل استقرارنا بأن سبعاً من السباع قد دخل الدار فخذ حذرك واحترز منه لنفسك جهدك، فإنا بمجرد السماع إذا رأينا ما أخبرنا عنه في محل الامكان والجواز لم نقدم على الدخول وبالغنا في الاحتراز فالموت هو المستقر والوطن قطعاً، فكيف لا يكون الاحتراز لما بعده مهماً؟ فإذن أهم الممات أن نبحث عن قوله الذي قضى الذهن في بادئ الرأي وسابق النظر بامكانه أهو محال في نفسه على التحقيق أو هو حق لا شك فيه؟ فمن
قوله ان لكم رباً كلفكم حقوقاً وهو يعاقبكم على تركها ويثيبكم على فعلها وقد بعثني رسولاً إليكم لأبين ذلك لكم، فيلزمنا لا محالة أن نعرف أن لنا رباً أم لا. وإن كان فهل يمكن أن يكون حياً متكلماً حتى يأمر وينهى ويكلف ويبعث الرسل، وإن كان متكلماً فهل هو قادر على أن يعاقب ويثيب إذا عصيناه أو أطعناه، وإن كان قادراً فهل هذا الشخص بعينه صادق في قوله أنا الرسول إليكم. فإن اتضح لنا ذلك لزمنا لا محالة، إن كنا عقلاء، أن نأخذ حذرنا وننظر لأنفسنا ونستحقر هذه الدنيا المنقرضة بالاضافة إلى الآخرة الباقية فالعاقل من ينظر لعاقبته ولا يغتر بعاجلته. ومقصود هذا العلم إقامة البرهان على وجود الرب تعالى وصفاته وأفعاله وصدق الرسل كما فصلناه في الفهرست. وكل ذلك مهم لا محيص عنه لعاقل. فإن قلت اني لست منكراً هذا الانبعاث للطلب من نفسي ولكني لست أدري أنه ثمرة الجبلة والطبع وهو مقتضى العقل أو هو موجب الشرع إذ للناس كلام في مدارك الوجوب؛ فهذا انما تعرفه في آخر الكتاب عند تعرضنا لمدارك الوجوب. والاشتغال به الآن فضول بل لا سبيل بعد وقوع الانبعاث إلى الانتهاض لطلب الخلاص. فمثال الملتفت إلى ذلك مثال رجل لدغته حية أو عقرب وهي معاودة اللدغ والرجل قادر على الفرار ولكنه متوقف ليعرف ان الحية جاءته من جانب اليمين أو من جانب اليسار، وذلك من أفعال الأغبياء الجهال نعوذ بالله من الاشتغال بالفضول مع تضييع المهمات والأصول.
التمهيد الثاني في بيان الخوض في هذا العلم وإن كان مهماً فهو في حق بعض الخلق ليس بمهم بل المهم لهم تركه إعلم أن الأدلة التي نحررها في هذا العلم تجري مجرى الأدوية التي يعالج بها مرض القلوب. والطبيب المستعمل لها إن لم يكن حاذقاً ثاقب العقل رصين الرأي كان ما يفسده بدوائه أكثر مما يصلحه. فليعلم المحصل لمضمون هذا الكتاب والمستفيد لهذه العلوم أن الناس أربع فرق: الفرقة الأولى: آمنت بالله وصدقت رسوله واعتقدت الحق وأضمرته واشتغلت إما بعبادة وإما بصناعة؛ فهؤلاء ينبغي أن يتركوا وما هم عليه ولا تحرك عقائدهم بالاستحثاث على تعلم هذا العلم، فإن صاحب الشرع صلوات الله عليه لم يطالب العرب في مخاطبته إياهم بأكثر من التصديق ولم يفرق بين أن يكون ذلك بإيمان وعقد تقليدي أو بيقين برهاني. وهذا مما علم ضرورة من مجاري أحواله في تزكيته إيمان من سبق من أجلاف العرب إلى تصديقه ببحث وبرهان؛ بل بمجرد قرينة ومخيلة سبقت إلى قلوبهم فقادتها إلى الإذعان للحق والانقياد للصدق فهؤلاء مؤمنون حقاً فلا ينبغي أن تشوش عليهم عقائدهم، فإنه إذا تليت عليهم هذه البراهين وما عليها من الاشكالات وحلها لم يؤمن أن تعلق بأفهامهم مشكلة من المشكلات وتستولي عليها ولا تمحى عنها بما يذكر من طرق الحل. ولهذا لم ينقل عن الصحابة الخوض في هذا الفن لا بمباحثة ولا بتدريس ولا تصنيف، بل كان شغلهم بالعبادة والدعوة إليها وحمل الخلق على مراشدهم ومصالحهم في أحوالهم وأعمالهم ومعاشهم فقط. الفرقة الثانية: طائفة مالت عن اعتقاد الحق كالكفرة والمبتدعة. فالجافي الغليظ منهم الضعيف العقل الجامد على التقليد الممتري على الباطل من مبتدأ النشوء إلى كبر السن لا ينفع معه إلا السوط والسيف. فأكثر الكفرة أسلموا تحت ظلال السيوف إذ يفعل الله بالسيف والسنان ما لا يفعل بالبرهان واللسان. وعن هذا إذا استقرأت تواريخ الأخبار لم تصادف ملحمة بين المسلمين والكفار إلا انكشفت عن جماعة من أهل الضلال مالوا إلى الانقياد، ولم تصادف مجمع مناظرة ومجادلة انكشفت إلا عن زيادة إصرار وعناد. ولا تظنن أن هذا الذي ذكرناه غض من منصب العقل وبرهانه
ولكن نور العقل كرامة لا يخص الله بها إلا الآحاد من أوليائه، والغالب على الخلق القصور والاهمال، فهم لقصورهم لا يدركون براهين العقول كما لا تدرك نور الشمس أبصار الخفافيش. فهؤلاء تضر بهم العلوم كما تضر رياح الورد بالجعل. وفي مثل هؤلاء قال الامام الشافعي رحمه الله: فمن منح الجهال علماً أضاعه ... ومن منع المستوجبين فقد ظلم الفرقة الثالثة: طائفة اعتقدوا الحق تقليداً وسماعاً ولكن خصوا في الفطرة بذكاء وفطنة فتنبهوا من أنفسهم لإشكالات تشككهم في عقائدهم وزلزلت عليهم طمأنينتهم، أو قرع سمعهم شبهة من الشبهات وحاكت في صدورهم. فهؤلاء يجب التلطف بهم في معالجتهم باعادة طمأنينتهم وإماطة شكوكهم بما أمكن من الكلام المقنع المقبول عندهم ولو بمجرد إستبعاد وتقبيح أو تلاوة آية أو رواية حديث أو نقل كلام من شخص مشهور عندهم بالفضل. فإذا زال شكه بذلك القدر فلا ينبغي أن يشافه بالأدلة المحررة على مراسم الجدال، فإن ذلك ربما يفتح عليه أبواباً أخر من الإشكالات. فإن كان ذكياً فطناً لم يقنعه إلا كلام يسير على محك التحقيق. فعند ذلك يجوز أن يشافه بالدليل الحقيقي وذلك على حسب الحاجة وفي موضع الاشكال على الخصوص. الفرقة الرابعة: طائفة من أهل الضلال يتفرس فيهم مخائل الذكاء والفطنة ويتوقع منهم قبول الحق بما اعتراهم في عقائدهم من الريبة أو بما يلين قلوبهم لقبول التشكيك بالجبلة والفطرة. فهؤلاء يجب التلطف بهم في استمالتهم إلى الحق وإرشادهم إلى الاعتقاد الصحيح لا في معرض المحاجة والتعصب، فإن ذلك يزيد في دواعي الضلال ويهيج بواعث التمادي والإصرار. وأكثر الجهالات إنما رسخت في قلوب العوام بتعصب جماعة من جهال أهل الحق أظهروا الحق في معرض التحري والادلاء، ونظروا إلى ضعفاء الخصوم بعين التحقير والإزراء. فثارت من بواطنهم دواعي المعاندة والمخالفة ورسخت في نفوسهم الاعتقادات الباطلة وعسر على العلماء المتلطفين محوها مع ظهور فسادها، حتى انتهى التعصب بطائفة إلى أن اعتقدوا أن الحروف التي نظروا بها في الحال بعد السكوت عنها طول العمر قديمة. ولولا استيلاء الشيطان بواسطة العناد والتعصب للأهواء لما وجد مثل هذا الاعتقاد مستقراً في قلب مجنون فضلاً عمن له قلب عاقل. والمجادلة والمعاندة داء محض لا دواء له، فليتحرز المتدين منه جهده وليترك الحقد والضغينة وينظر إلى كافة خلق الله بعين الرحمة، وليستعن بالرفق واللطف في ارشاد من ضل من هذه الأمة، وليتحفظ من النكد الذي يحرك داعية الضلال، وليتحقق أن مهيج داعية الاصرار بالعناد والتعصب معين على الاصرار على البدعة ومطالب بعهده اعانته في القيامة.
التمهيد الثالث في بيان الاشتغال بهذا العلم من فروض الكفايات إعلم أن التبحر في هذا العلم والاشتغال بمجامعه ليس من فروض الأعيان وهو من فروض الكفايات. فأما أنه ليس من فروض الأعيان فقد إتضح لك برهانه في التمهيد الثاني. إذ تبين أنه ليس يجب على كافة الخلق إلا التصديق الجزم وتطهير القلب عن الريب والشك في الإيمان. وإنما تصير إزالة الشك فرض عين في حق من اعتراه الشك. فإن قلت فلم صار من فروض الكفايات وقد ذكرت أن أكثر الفرق يضرهم ذلك ولا ينفعهم؟ فاعلم أنه قد سبق أن ازالة الشكوك في أصول العقائد واجبة، واعتوار الشك غير مستحيل وإن كان لا يقع إلا في الأقل، ثم الدعوة إلى الحق بالبرهان مهمة في الدين. ثم لا يبعد أن يثور مبتدع ويتصدى لإغواء أهل الحق بإفاضة الشبهة فيهم فلا بد ممن يقاوم شبهته بالكشف ويعارض إغواءه بالتقبيح، ولا يمكن ذلك إلا بهذا العلم. ولا تنفك البلاد عن أمثال هذه الوقائع، فوجب أن يكون في كل قطر من الأقطار وصقع من الأصقاع قائم بالحق مشتغل بهذا العلم يقاوم دعاة المبتدعة ويستميل المائلين عن الحق ويصفي قلوب أهل السنة عن عوارض الشبهة. فلو خلا عنه القطر خرج به أهل القطر كافة، كما لو خلا عن الطبيب والفقيه. نعم من أنس من نفسه تعلم الفقه أو الكلام وخلا الصقع عن القائم بهما ولم يتسع زمانه للجمع بينهما واستفتي
في تعيين ما يشتغل به منهما؛ أوجبنا عليه الاشتغال بالفقه فإن الحاجة إليه أعم والوقائع فيه أكثر فلا يستغني أحد في ليله ونهاره عن الاستعانة بالفقه. واعتوار الشكوك المحوجة إلى علم الكلام باد بالإضافة إليه كما أنه لو خلا البلد عن الطبيب والفقيه كان التشاغل بالفقه أهم؛ لأنه يشترك في الحاجة إليه الجماهير والدهماء. فأما الطب فلا يحتاج إليه الأصحاء، والمرضى أقل عدداً بالإضافة إليهم. ثم المريض لا يستغني عن الفقه كما لا يستغني عن الطب وحاجته إلى الطب لحياته الفانية وإلى الفقه لحياته الباقية وشتان بين الحالتين. فإذا نسبت ثمرة الطب إلى ثمرة الفقه علمت ما بين الثمرتين. ويدلك على أن الفقه أهم العلوم اشتغال الصحابة رضي الله عنهم بالبحث عنه في مشاورتهم ومفاوضاتهم. ولا يغرنك ما يهول به من يعظم صناعة الكلام من أنه الأصل والفقه فرع له فإنها كلمة حق ولكنها غير نافعة في هذا المقام، فإن الأصل هو الاعتقاد الصحيح والتصديق الجزم وذلك حاصل بالتقليد والحاجة إلى البرهان ودقائق الجدل نادرة. والطبيب أيضاً قد يلبس فيقول وجودك ثم وجودك ثم وجود بدنك موقوف على صناعتي وحياتك منوطة بي فالحياة والصحة أولاً ثم الاشتغال بالدين ثانياً. ولكن لا يخفى ما تحت هذا الكلام من التمويه وقد نبهنا عليه.
التمهيد الرابع في بيان مناهج الأدلة التي انتهجناها في هذا الكتاب إعلم أن مناهج الأدلة متشعبة وقد أوردنا بعضها في كتاب محك النظر وأشبعنا القول فيها في كتاب معيار العلم. ولكنا في هذا الكتاب نحترز عن الطرق المتغلقة والمسالك الغامضة قصداً للايضاح وميلاً إلى الإيجاز واجتناباً للتطويل. ونقتصر على ثلاثة مناهج: المنهج الأول: السبر والتقسيم وهو ان نحصر الأمر في قسمين ثم يبطل أحدهما فيلزم منه ثبوت الثاني. كقولنا: العالم إما حادث وإما قديم، ومحال أن يكون قديماً فيلزم منه لا محالة أن يكون حادثاً أنه حادث وهذا اللازم هو مطلوبنا وهو علم مقصود إستفدناه من علمين آخرين أحدهما قولنا: العالم إما قديم أو حادث فإن الحكم بهذا الانحصار علم. والثاني: قولنا ومحال أن يكون قديماً فإن هذا علم آخر. والثالث: هو اللازم منهما وهو المطلوب بأنه حادث. وكل علم مطلوب، فلا يمكن أن يستفاد الا من علمين هما أصلان ولا كل أصلين، بل إذا وقع بينهما إزدواج على وجه مخصوص وشرط مخصوص، فإذا وقع الازدواج على شرطه أفاد علماً ثالثاً وهو المطلوب، وهذا الثالث قد نسميه دعوى إذا كان لنا خصم، ونسميه مطلوباً إذا كان لم يكن لنا خصم، لأنه مطلب الناظر ونسميه فائدة وفرعاً بالاضافة إلى
الأصلين فإنه مستفاد منهما. ومهما أقر الخصم بالأصلين يلزمه لا محالة الاقرار بالفرع المستفاد منهما وهو صحة الدعوى. المنهج الثاني: أن نرتب أصلين على وجه آخر مثل قولنا: كل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث وهو أصل، والعالم لا يخلو عن الحوادث فهو أصل آخر، فيلزم منهما صحة دعوانا وهو أن العالم حادث وهو المطلوب فتأمل. هل يتصور أن يقر الخصم بالأصلين ثم يمكنه إنكار صحة الدعوى فتعلم قطعاً أن ذلك محال. المنهج الثالث: أن لا نتعرض لثبوت دعوانا، بل ندعي إستحالة دعوى الخصم بأن نبين أنه مفض إلى المحال وما يفضي إلى المحال فهو محال لا محالة. مثاله: قولنا إن صح قول الخصم أن دورات الفلك لا نهاية لها لزم منه صحة قول القائل أن ما لا نهاية له قد انقضى وفرغ منه، ومعلوم أن هذا اللازم محال فيعلم منه لا محالة أن المفضي إليه محال وهو مذهب الخصم. فههنا أصلان: أحدهما قولنا إن كانت دورات الفلك لا نهاية لها فقد انقضى ما لا نهاية له، فإن الحكم بلزوم إنقضاء ما لا نهاية له - على القول بنفي النهاية عن دورات الفلك - علم ندعيه ونحكم به. ولكن يتصور فيه من الخصم إقراراً وإنكار بأن يقول: لا أسلم أنه يلزم ذلك. والثاني قولنا إن هذا اللازم محال فإنه أيضاً أصل يتصور فيه إنكار بأن يقول: سلمت الأصل الأول ولكن لا أسلم هذا الثاني وهو إستحالة إنقضاء ما لا نهاية له، ولكن لو أقر بالأصلين كان الاقرار بالمعلوم الثالث اللازم منهما واجباً بالضرورة؛ وهو الاقرار باستحالة مذهبه المفضي إلى هذا المحال. فهذه ثلاث مناهج في الاستدلال جلية لا يتصور إنكار حصول العلم منها، والعلم الحاصل هو المطلوب والمدلول، وازدواج الأصلين الملتزمين لهذا العلم هو الدليل. والعلم بوجه لزوم هذا المطلوب من ازدواج الأصلين علم بوجه دلالة الدليل، وفكرك الذي هو عبارة عن إحضارك الأصلين في الذهن وطلبك التفطن لوجه لزوم العلم الثالث من العلمين الأصلين هو النظر؛ فإذن عليك في درك العلم المطلوب وظيفتان؛ إحداهما: إحضار الأصلين في الذهن وهذا يسمى فكراً، والآخر: تشوقك إلى التفطن لوجه لزوم المطلوب من ازدواج الأصلين وهذا يسمى طلباً. فلذلك قال من جرد التفاته إلى الوظيفة الأولى حيث أراد حد النظر أنه الفكر. وقال من جرد التفاته إلى الوظيفة الثانية في حد النظر أنه طلب علم أو غلبة ظن. وقال من التفت إلى الأمرين جميعاً أنه الفكر الذي يطلب به من قام به علماً أو غلبة ظن.
فهكذا ينبغي أن تفهم الدليل والمدلول ووجه الدلالة وحقيقة النظر ودع عنك ما سودت به أوراق كثيرة من تطويلات وترديد عبارات لا تشفي غليل طالب ولا تسكن نهمة متعطش ولن يعرف قدر هذه الكلمات الوجيزة إلا من انصرف خائباً عن مقصده بعد مطالعة تصانيف كثيرة. فإن رجعت الآن في طلب الصحيح إلى ما قيل في حد النظر دل ذلك على انك تخص من هذا الكلام بطائل ولن ترجع منه إلى حاصل، فإنك إذا عرفت أنه ليس ههنا إلا علوم ثلاثة: علمان هما أصلان يترتبان ترتباً مخصوصاً، وعلم ثالث يلزم منهما وليس عليك فيه الا وظيفتان: إحداهما إحضار العلمين في ذهنك، والثانية التفطن لوجه العلم الثالث منهما. والخيرة بعد ذلك اليك في اطلاق لفظ النظر في ان تعبر به عن الفكر الذي هو احضار العلمين، أو عن التشوف الذي هو طلب التفطن لوجه لزوم العلم الثالث، أو عن الأمرين جميعاً، فإن العبارات مباحة والاصطلاحات لا مشاحة فيها. فان قلت غرضي أن أعرف اصطلاح المتكلمين وأنهم عبروا بالنظر عماذا، فاعلم أنك إذا سمعت واحداً يجد النظر بالفكر، وآخر بالطلب، وآخر بالفكر الذي هو يطلب به، لم تسترب في اختلاف اصطلاحاتهم على ثلاثة أوجه. والعجب ممن لا يتفطن هذا ويفرض الكلام في حد النظر. مسألة خلافية: ويستدل بصحة واحد من الحدود وليس يدري أن حظ المعنى المعقول من هذه الأمور لا خلاف فيه وأن الأصطلاح لا معنى للخلاف فيه. وإذا أنت امعنت النظر واهتديت السبيل عرفت قطعاً أن أكثر الأغاليط نشأت من ضلال من طلب المعاني من الألفاظ، ولقد كان من حقه أن يقدر المعاني أولاً ثم ينظر في الألفاظ ثانياً، ويعلم أنها اصطلاحات لا تتغير بها المعقولات. ولكن من حرم التوفيق استدبر الطريق، ونكل عن التحقيق. فإن قلت: إني لا استريب في لزوم صحة الدعوى من هذين الأصلين إذا أقر الخصم بهما على هذا الوجه، ولكن من أين يجب على الخصم الاقرار بهما ومن أين تقتضي هذه الأحوال المسلمة الواجبة التسليم؟ فاعلم أن لها مدارك شتى ولكن الذي نستعمله في هذا الكتاب نجتهد أن لا يعد ستة: الأول منها: الحسيات، أعني المدرك بالمشاهدة الظاهرة والباطنة، مثاله أنا إذا قلنا مثلاً كل حادث فله سبب، وفي العالم حوادث فلا بد لها من سبب. فقولنا: في العالم حوادث، أصل واحد يجب الإقرار به، فإنه يدرك بالمشاهدة الظاهرة حدوث أشخاص الحيوانات والنباتات والغيوم والامطار ومن الأعراض والأصوات
والألوان. وان تخيل أنها منتقلة، فالانتقال حادث ونحن لم ندع إلا حادثاً ولم نعين أن ذلك الحادث جوهر أو عرض أو انتقال أو غيره. وكذلك يعلم بالمشاهدة الباطنة حدوث الآلام والافراح والغموم في قلبه فلا يمكنه انكاره. الثاني: العقل المحض، فإنا إذا قلنا: العالم أما قديم مؤخر، وإما حادث مقدم، وليس وراء القسمين قسم ثالث، وجب الاعتراف به على كل عاقل. مثاله أن
تقول: كل ما لا يسبق الحوادث فهو حادث، والعالم لا يسبق الحوادث فهو حادث، فأحد الأصلين قولنا أن ما لا يسبق الحوادث فهو حادث. ويجب على الخصم الإقرار به، لأن ما لا يسبق الحادث إما أن يكون مع الحادث أو بعده ولا يمكن قسم ثالث، فإن ادعى قسماً ثالثاً كان منكراً لما هو بديهي في العقل، وإن انكر أن ما هو مع الحادث أو بعده ليس بحادث فهو أيضاً منكر للبديهة. الثالث: التواتر، مثاله أنا نقول محمد صلوات الله وسلامه عليه صادق لأن كل من جاء بالمعجزة فهو صادق، وقد جاء هو بالمعجزة فهو إذاً صادق، فإن قيل أنا لا نسلم أنه جاء بالمعجزة فنقول: قد جاءنا بالقرآن والقرآن معجزة، فإذاً قد جاء بالمعجزة. فإن سلم الخصم أحد الأصلين وهو أن القرآن معجزة، أما بالطوع أو بالدليل، وأراد إنكار الأصل الثاني وهو أنه قد جاء بالقرآن، وقال لا أسلم أن القرآن مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم تسليماً، لم يمكنه ذلك لأن التواتر يحصل العلم به كما حصل لنا العلم بوجوده وبدعواه النبوة وبوجود مكة ووجود موسى وعيسى وسائر الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. الرابع: أن يكون الأصل مثبتاً بقياس آخر يستند بدرجة واحدة أو درجات كثيرة إما إلى الحسيات أو العقليات أو المتواترات، فإن ما هو فرع الأصلين يمكن أن يجعل أصلاً في قياس آخر. مثاله أنا بعد أن نفرغ من الدليل على حدوث العالم يمكننا أن نجعل حدوث العالم أصلاً في نظم قياس، مثلاً أن نقول كل حادث فله سبب والعالم حادث فإذا له سبب، فلا يمكنهم انكار كون العالم حادثاً بعد أن اثبتنا بالدليل حدوثه. الخامس: السمعيات، مثاله انا ندعي مثلاً ان المعاصي بمشيئة الله تعالى، ونقول كل كائن فهو بمشيئة الله تعالى والمعاصي كائنة فهي إذاً بمشيئة الله تعالى؛ فأما قولنا هي كائنة فمعلوم وجودها بالحس، وكونها معصية بالشرع، وأما قولنا كل كائن بمشيئة الله تعالى فإذا أنكر الخصم ذلك منعه الشرع مهما كان مقراً بالشرع
أو كان قد أثبت عليه بالدليل فإنا نثبت هذا الأصل بإجماع الأمة على صدق قول القائل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فيكون السمع مانعاً من الانكار. السادس: أن يكون الأصل مأخوذاً من معتقدات الخصم ومسلماته. فإنه وإن لم يقم لنا عليه دليل أو لم يكن حسياً ولا عقلياً، انتفعنا باتخاذه إياه أصلاً في قياسنا وامتنع عليه الإنكار الهادم لمذهبه. وأمثلة هذا مما تكثر فلا حاجة إلى تعيينه. فإن قلت: فهل من فرق بين هذه المدارك في الانتفاع بها في المقاييس النظرية؟ فاعلم أنها متفاوتة في عموم الفائدة، فإن المدارك العقلية والحسية عامة مع كافة الخلق إلا من لا عقل له ولا حس له وكان الأصل معلوماً فالحس الذي فقده كالأصل المعلوم بحاسة البصر إذا استعمل مع الأكمه فإنه لا ينفع، والأكمه إذا كان هو الناظر لم يمكنه أن يتخذ ذلك أصلاً، وكذلك المسموع في حق الأصم. وأما المتواتر فإنه نافع ولكن في حق من تواتر إليه، فأما من لم يتواتر إليه ممن وصل إلينا في الحال من مان بعيد لم تبلغه الدعوة فأردنا أن نبين له بالتواتر أن نبينا وسيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم تسليماً وعلى آله وصحبه تحدى بالقرآن، لم يقدر عليه ما لم يمهله مدة من يتواتر عنده، ورب شيء يتواتر عند قوم دون قوم، فقول الشافعي رحمه الله تعالى في مسألة قتل المسلم بالذمي متواتر عند الفقهاء من أصحابه دون العوام من المقلدين وكم من مذهب له في أحاد المسائل لم يتواتر عند أكثر الفقهاء وأما الأصل المستفاد من قياس آخر فلا ينفع إلا مع من قدر معه ذلك القياس. وأما مسلمات المذاهب فلا تنفع الناظر وإنما تنفع المناظر مع من يعتقد ذلك المذهب. وأما السمعيات فلا تنفع إلا من يثبت السمع عنه، فهذه مدارك علوم هذه الأصول المفيدة بترتيبها ونظمها العلم بالأمور المجهولة المطلوبة وقد فرغنا من التمهيدات فلنشتغل بالأقطاب التي هي مقاصد الكتاب.
القطب الأول في النظر في ذات الله تعالى وفيه عشر دعاوى الدعوى الأولى: وجوده تعالى وتقدس، برهانه أنا نقول كل حادث فلحدوثه سبب، والعالم حادث فيلزم منه إن له سبباً، ونعني بالعالم كل موجود سوى الله تعالى. ونعني بكل موجود سوى الله تعالى الأجسام كلها وأعراضها، وشرح ذلك بالتفصيل أنا لا نشك في أصل الوجود، ثم نعلم أن كل موجود اما متحيزاً أو غير متحيز، وأن كل متحيز إن لم يكن فيه ائتلاف فنسميه جوهراً فرداً، وإن ائتلف إلى غيره سميناه جسماً، وإن غير المتحيز أما أن يستدعي وجوده جسماً يقوم به ونسميه الأعراض، أو لا يستدعيه وهو الله سبحانه وتعالى، فأما ثبوت الأجسام وأعراضها، فمعلوم بالمشاهدة، ولا يلتفت إلى من ينازع في الأعراض وإن طال فيها صياحه وأخذ يلتمس منك دليلاً عليه، فإن شغبه ونزاعه والتماسه وصياحه، وإن لم يكن موجوداً فكيف نشتغل بالجواب عنه والإصغاء إليه، وإن كان موجوداً فهو لا محالة غير جسم المنازع إذ كان جسماً موجوداً من قبل، ولم يكن التنازع موجوداً فقد عرفت أن الجسم والعرض مدركان بالمشاهدة. فإما موجود ليس
بجسم ولا جوهر متحيز ولا عرض فيه فلا يدرك بالحس ونحن ندعي وجوده وندعي أن العالم موجود به، وبقدرته، وهذا يدرك بالدليل لا بالحس، والدليل ما ذكرناه، فلنرجع إلى تحقيقه. فقد جمعنا فيه أصلين فلعل الخصم ينكرهما، فنقول له: في أي الأصلين تنازع؟ فإن قال إنما أنازع في قولك إن كل حادث فله سبب فمن أين عرفت هذا، فنقول: إن هذا الأصل يجب الاقرار به، فإنه أولي ضروري في العقل، ومن يتوقف فيه فإنما يتوقف لأنه ربما لا ينكشف له ما نريده بلفظ الحادث، ولفظ السبب، وإذا فهمهما صدق عقله بالضرورة بأن لكل حادث سبباً، فانا نعني بالحادث ما كان معدوماً ثم صار موجوداً فنقول وجوده قبل أن وجد كان محالاً أو ممكناً، وباطل أن يكون محالاً لأن المحال لا يوجد قط، وإن كان ممكناً فلسنا نعني بالممكن إلا ما يجوز أن يوجد ويجوز أن لا يوجد ولكن لم يكن موجوداً لأنه ليس يجب وجوده لذاته إذ لو وجد وجوده لذاته لكان واجباً لا ممكناً، بل قد افتقر وجوده إلى مرجح لوجوده على العدم حتى يتبدل العدم بالوجود. فإذا كان استمرار عدمه من حيث أنه لا مرجح للوجود على العدم، فمن لم يوجد المرجح لا يوجد الوجود، ونحن لا نريد بالسبب إلا المرجح: والحاصل أن المعدوم المستمر العدم لا يتبدل عدمه بالوجود ما لم يتحقق أمر من الأمور يرجح جانب الوجود على استمرار العدم، وهذا إذا حصل في الذهن معنى لفظه كان العقل مضطراً إلى التصديق به. فهذا بيان اثبات هذا الأصل وهو على التحقيق شرح للفظ الحادث والسبب لاقامة دليل عليه. فإن قيل لم تنكرون على من ينازع في الأصل الثاني، وهو قولكم أن العالم حادث، فنقول: إن هذا الأصل ليس بأولي في العقل، بل نثبته ببرهان منظوم من أصلين آخرين هو أنا نقول إذ قلنا أن العالم حادث أردنا بالعالم الآن، الأجسام والجواهر فقط، فنقول كل جسم فلا يخلو عن الحوادث وكل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث، فيلزم منه أن كل جسم فهو حادث ففي أي الأصلين النزاع؟ فإن قيل لم قيل أن كل جسم أو متحيز فلا يخلو عن الحوادث؟ قلنا: لأنه لا يخلو عن الحركة والسكون وهما حادثان، فإن قيل: ادعيتم وجودهما ثم حدوثهما، فلا نسلم الوجود ولا الحدوث،
قلنا هذا سؤال قد طال الجواب عنه في تصانيف الكلام، وليس يستحق هذا التطويل فإنه لا يصدر قط من مسترشد إذ لا يستريب عاقل قط في ثبوت الأعراض في ذاته من الآلام والأسقام والجوع والعطش وسائر الأحوال، ولا في حدوثها. وكذلك إذا نظرنا إلى أجسام العالم لم نسترب في تبدل الأحوال عليها، وإن تلك التبديلات حادثة، وإن صدر من خصم معاند فلا معنى للاشتغال به، وإن فرض فيه خصم معتقد لما نقوله فهو فرض محال إن كان الخصم عاقلاً، بل الخصم في حدوث العالم الفلاسفة وهم مصرحون بأن أجسام العالم تنقسم إلى السموات، وهي متحركة على الدوام، وآحاد حركاتها حادثة ولكنها دائمة متلاحقة على الاتصال أزلاً وأبداً وإلى العناصر الأربعة التي يحويها مقعر فلك القمر، وهي مشتركة في مادة حاملة لصورها وأعراضها وتلك المادة قديمة والصور والأعراض حادثة متعاقبة عليها أزلاً وأبداً وإن الماء ينقلب بالحرارة هواء، والهواء يستحيل بالحرارة ناراً، وهكذا بقية العناصر، وإنها تمتزج امتزاجات حادثة فتتكون منهما المعادن والنبات والحيوان، فلا تنفك العناصر عن هذه الصور الحادثة ولا تنفك السموات عن الحركات الحادثة أبداً، وإنما ينازعون في قولنا أن ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث، فلا معنى للإطناب في هذا الأصل، ولكنا لإقامة الرسم نقول: الجوهر بالضرورة لا يخلو عن الحركة والسكون، وهما حادثان. أما الحركة فحدوثها محسوس وإن فرض جوهر ساكن كالأرض، ففرض حركته ليس بمحال بل نعلم جوازه بالضرورة، وإذا وقع ذلك الجائز كان حادثاً وكان معدماً للسكون، فيكون السكون أيضاً قبله حادثاً لأن القديم لا ينعدم كما سنذكره في إقامة الدليل على بقاء الله تعالى، وإن أردنا سياق دليل على وجود الحركة زائدة على الجسم، قلنا: إنا إذا قلنا هذا الجوهر متحرك أثبتنا شيئاً سوى الجوهر متحرك أثبتنا شيئاً سوى الجوهر بدليل أنا إذا قلنا هذا الجوهر ليس بمتحرك، صدق قولنا وإن كان الجوهر باقياً ساكناً، فلو كان المفهوم من الحركة عين الجوهر لكان نفيها نفي عين الجوهر. وهكذا يطرد الدليل في إثبات السكون ونفيه، وعلى الجملة. فتكلف الدليل على الواضحات يزيدها غموضاً ولا يفيدها وضوحاً. فإن قيل: فبم عرفتم أنها حادثة فلعلها كانت كامنة فظهرت، قلنا: لو كنا نشتغل في هذا الكتاب بالفضول الخارج عن المقصود لأبطلنا القول بالكمون والظهور في الأعراض رأساً، ولكن ما لا يبطل مقصودنا فلا نشتغل به، بل نقول: الجوهر لا يخلو عن كمون الحركة فيه أو ظهورها، وهما حادثان فقد ثبت أنه لا يخلو عن الحوادث.
فإن قيل: فلعلها انتقلت إليه من موضع آخر، فبم يعرف بطلان القول، بانتقال الأعراض؟ قلنا: قد ذكر في إبطال ذلك أدلة ضعيفة لا نطول الكتاب بنقلها ونقضها، ولكن الصحيح في الكشف عن بطلانه أن نبين أن تجويز ذلك لا يتسع له عقل من لم يذهل عن فهم حقيقة العرض وحقيقة الانتقال، ومن فهم حقيقة العرض تحقق استحالة الانتقال فيه. وبيانه أن الانتقال عبارة أخذت من انتقال الجوهر من حيز إلى حيز، وذلك يثبت في العقل بأن فهم الجوهر وفهم الحيز وفهم اختصاص الجوهر بالحيز زائد على ذات الجوهر، ثم علم أن العرض لا بد له من محل كما لا بد للجوهر من حيز، فتتخيل أن إضافة العرض إلى المحل كإضافة الجوهر إلى الحيز فيسبق منه إلى الوهم إمكان الانتقال عنه، كما في الجوهر، ولو كانت هذه المقايسة صحيحة لكان اختصاص العرض بالمحل كوناً زائداً على ذات العرض والمحل كما كان اختصاص الجوهر بالحيز كوناً زائداً على ذات الجوهر والحيز، ولصار يقوم بالعرض عرض، ثم يفتقر قيام العرض بالعرض إلى إختصاص آخر يزيد على القائم والمقوم به، وهكذا يتسلل ويؤدي إلى أن لا يوجد عرض واحد ما لم توجد أعراض لا نهاية لها، فلنبحث عن السبب الذي لأجله فرق بين اختصاص العرض بالمحل وبين اختصاص الجوهر بالحيز في كون أحد الاختصاصيين زائداً على ذات المختص ودون الآخر، فمنه يتبين الغلط في توهم الانتقال. والسر فيه، أن المحل وإن كان لازماً للعرض كما أن الحيز لازم للجوهر، ولكن بين اللازمين فرق: إذ رب لازم ذاتي للشيء، ورب لازم ليس بذاتي للشيء، وأعني بالذاتي ما يجب ببطلانه بطلان الشيء، فإن بطل الوجود بطل به وجود الشيء، وإن بطل في العقل بطل وجود العلم به في العقل، والحيز ليس ذاتياً للجوهر فإنا نعلم الجسم والجوهر أولاً ثم ننظر بعد ذلك في الحيز، أهو أمر ثابت أم هو أمر موهوم ونتوصل إلى تحقيق ذلك بدليل وندرك الجسم بالحس في المشاهدة من غير دليل. فلذلك لم يكن الحيز المعين مثلاً لجسم زيد ذاتياً لزيد، ولم يلزم من فقد ذلك الحيز وتبدله بطلان جسم زيد، وليس كذلك طول زيد مثلاً لأنه عرض في زيد لا نعقله في
نفسه دون زيد بل نعقل زيداً الطويل، فطول زيد يعلم تابعاً لوجود زيد ويلزم من تقدير عدم زيد بطلان طول زيد، فليس لطول زيد قوام في الوجود وفي العقل دون زيد. فاختصاصه بزيد ذاتي له، أي هو لذاته لا لمعنى زائد عليه هو اختصاص، فإن بطل ذلك الاختصاص بطلت ذاته والانتقال يبطل الاختصاص فتبطل ذاته، إذ ليس اختصاصه بزيد زائداً على ذاته، أعني ذات العرض، بخلاف اختصاص الجوهر بالحيز فإنه زائد عليه فليس في بطلانه، بالانتقال ما يبطل ذاته، ورجع الكلام إلى أن الانتقال يبطل الاختصاص بالمحل، فإن كان الاختصاص زائداً على الذات لم تبطل به الذات، وإن لم يكن معنى زائداً بطلت ببطلانه الذات، فقد انكشف هذا وآل النظر إلى أن اختصاص العرض بمحله لم يكن زائداً على ذات العرض كاختصاص الجوهر بحيزه، وأما العرض فإنه عقل بالجوهر لا بنفسه فذات العرض وكونه للجوهر المعين وليس له ذات سواه. فإذا قدرنا مفارقته لذلك الجوهر المعين فقد قدرنا عدم ذاته، وإنما فرضنا الكلام في الطول لتفهيم المقصود فإنه وإن لم يكن عرضاً ولكنه، عبارة عن كثرة الأجسام في جهة واحدة، ولكنه مقرب لغرضنا إلى الفهم، فإذا فهم فلننقل البيان إلى الأعراض. وهذا التوفيق والتحقيق وإن لم يكن لائقاً بهذا الإيجاز ولكن افتقر إليه لأن ما ذكر فيه غير مقنع ولا شاف. فقد فرغنا من إثبات أحد الأصلين، وهو أن العالم لا يخلو عن الحوادث، فإنه لا يخلو عن الحركة والسكون وهما حادثات وليسا بمنتقلين، مع أن الإطناب ليس في مقابلة خصم معتقد، إذ أجمع الفلاسفة على أن أجسام العالم لا تخلو عن الحوادث، وهم المنكرون لحدوث العالم، فإن قيل: فقد بقي الأصل الثاني وهو قولكم إن ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث فما الدليل عليه؟ قلنا: لأن العالم لو كان قديماً مع أنه لا يخلو عن الحوادث، لثبتت حوادث لا أول لها وللزم أن تكون دورات الفلك غير متناهية الاعداد، وذلك محال لأن كل ما يفضي إلى المحال فهو محال، ونحن نبين أنه يلزم عيه ثلاثة محالات: الأول - أن ذلك لو ثبت لكان قد انقضى ما لا نهاية له، ووقع الفراغ منه وانتهى، ولا فرق بين قولنا انقضى ولا بين قولنا انتهى ولا بين قولنا تناهى، فيلزم أن يقال قد تناهى ما لا يتناهى، ومن المحال البين أن يتناهى ما لا يتناهى وأن ينتهي وينقضي ما لا يتناهى. الثاني - أن دورات الفلك إن لم تكن متناهية فهي إما شفع وإما وتر، وإما لا شفع ولا وتر، وإما شفع ووتر معاً. وهذه الأقسام الأربعة محال؛ فالمفضي إليها
محال إذ يستحيل عدد لا شفع ولا وتر، أو شفع ووتر، فإن الشفع هو الذي ينقسم إلى متساويين كالعشرة مثلاً، والوتر هو أحد الذي لا ينقسم إلى متساويين كالتسعة، وكل عدد مركب من آحاد إما أن ينقسم بمتساويين، أو لا ينقسم بمتساويين، وأما أن يتصف بالانقسام وعدم الانقسام، أو ينفك عنهما جميعاً فهو محال، وباطل أن يكون شفعاً لأن الشفع إنما لا يكون وتراً لأنه يعوزه واحد، فإذا انضاف إليه واحد صار وتراً، فكيف أعوز الذي لا يتناهى واحد؟ ومحال أن يكون وتراً. لأن الوتر يصير شفعاً بواحد، فيبقى وتراً لأنه يعوزه ذلك الواحد، فكيف أعوز الذي لا يتناهى واحد؟ الثالث - أنه يلزم عليه أن يكون عددان، كل واحد منهما لا يتناهى، ثم أن أحدهما أقل من الآخر، ومحال أن يكون ما لا يتناهى أقل مما لا يتناهى لأن الأقل هو الذي يعوزه شيء لو أضيف إليه لصار متساوياً، وما لا يتناهى كيف يعوزه شيء؟ وبيانه أن زحل عندهم يدور في كل ثلاثين سنة دورة واحدة، والشمس في كل سنة دورة واحدة، فيكون عدد دورات زحل مثل ثلث عشر دورات الشمس، إذ الشمس تدور في ثلاثين سنة ثلاثين دورة، وزحل يدور دورة واحدة، والواحد من الثلاثين ثلث عشر. ثم دورات زحل لا نهاية لها وهي أقل من دورات الشمس، إذ يعلم ضرورة أن ثلث عشر الشيء أقل من الشيء، والقمر يدور في السنة اثنتي عشرة مرة، فيكون عدد دورات الشمس مثلاً نصف سدس دورات القمر، وكل واحد لا نهاية له وبعضه أقل من بعض، فذلك من المحال البين. فإن قيل: مقدورات الباري تعالى عندكم لا نهاية لها وكذا معلوماته، والمعلومات أكثر من المقدورات إذ ذات القديم تعالى وصفاته معلومة له وكذا الموجود المستمر الوجود، وليس شيء من ذلك مقدوراً. قلنا نحن: إذا قلنا لا نهاية لمقدوراته، لم نرد به ما نريد بقولنا لا نهاية لمعلوماته بل نريد به أن لله تعالى صفة يعبر عنها بالقدرة، يتأتى بها الايجاد، وهذا الثاني لا ينعدم قط. وليس تحت قولنا - هذا الثأني لا ينعدم - إثبات أشياء فضلاً من أن توصف بأنها متناهية أو غير متناهية، وإنما يقع هذا الغلط لمن ينظر في المعاني من الألفاظ فيرى توازن لفظ المعلومات والمقدورات من حيث التصريف في اللغة، فيظن أن المراد بهما واحد. هيهات لا مناسبة بينهما البتة. ثم تحت قولنا المعلومات لا نهاية لها أيضاً سر يخالف السابق منه إلى الفهم، إذ السابق منه إلى الفهم إثبات أشياء تسمى معلومات لا نهاية لها، وهو محال، بل الأشياء هي الموجودات، وهي متناهية، ولكن بيان ذلك يستدعي تطويلا.
وقد اندفع الإشكال بالكشف عن معنى نفي النهاية عن المقدورات، فالنظر في الطرف الثاني وهو المعلومات مستغنى عنه في دفع الالزام، فقد بانت صحة هذا الأصل بالمنهج الثالث من مناهج الأدلة المذكورة في التمهيد الرابع من الكتاب وعند هذا يعلم وجود الصانع إذ بان القياس الذي ذكرناه، وهو قولنا أن العالم حادث وكل حادث فله سبب فالعالم له سبب. فقد ثبتت هذه الدعوى بهذا المنهج، ولكن بعد لم يظهر لنا إلا موجود السبب، فأما كونه حادثاً أو قديماً وصفاً له فلم يظهر بعد فلنشتغل به. الدعوى الثانية: ندعي أن السبب الذي أثبتناه لوجود العالم قديم فإنه لو كان حادثاً لافتقر إلى سبب آخر، وكذلك السبب الآخر ويتسلسل إما إلى غير نهاية وهو محال، وإما أن ينتهي إلى قديم لا محالة يقف عنده وهو الذي نطلبه ونسميه صانع العالم. ولا بد من الاعتراف به بالضرورة ولا نعني بقولنا قديم إلا أن وجوده غير مسبوق بعدم، فليس تحت لفظ القديم إلا إثبات موجود ونفي عدم سابق. فلا تظنن أن القدم معنى زائد على ذات القديم، فيلزمك أن تقول ذلك المعنى أيضاً قديم بقدم زائد عليه، ويتسلسل القوم إلى غير نهاية. الدعوى الثالثة: ندعي أن صانع العالم مع كونه موجوداً لم يزل فهو باق لا يزال لأن ما ثبت قدمه استحال عدمه. وإنما قلنا ذلك لأنه لو العدم لافتقر عدمه إلى
سبب فإنه طارئ بعد استمرار الوجود في القدم. وقد ذكرنا ان كل طارئ فلا بد له من سبب من حيث انه طارئ لا من حيث أنه موجود، وكما افتقر تبدل العدم بالوجود إلى مرجح للوجود على العدم، فكذلك يفتقر تبدل الوجود بالعدم إلى مرجح للعدم على الوجود، وذلك المرجح إما فاعل بعدم القدرة، أو ضد انقطاع شرط من شروط الوجود. ومحال أن يحال على القدرة؛ إذ لوجود شيء ثابت يجوز أن يصدر عن القدرة، فيكون القادر باستعماله فعل شيئاً والعدم ليس بشيء، فيستحيل أن يكون فعلاً واقعاً بأثر القدرة. فإنا نقول: فاعل العدم هل فعل شيئاً؟ فإن قيل نعم، كان محالاً، لأن النفي ليس بشيء. وإن قال المعتزلي أن المعدوم شيء وذات، فليس ذلك الذات من أثر القدرة، فلا يتصف أن يقول الفعل الواقع بالقدرة فعل ذلك الذات فإنها أزلية، وإنما فعله نفي وجود الذات، ونفي وجود الذات ليس شيئاً، فاذاً ما فعل شيئاً. وإذا صدق قولنا ما فعل شيئاً صدق قولنا أنه لم يستعمل القدرة في أثر البتة، فبقي كما كان ولم يفعل شيئاً. وباطل أن يقال أنه يعدمه ضده لأن الضد إن فرض حادثاً اندفع وجوده بمضادة القديم، وكان ذلك أولى من أن ينقطع به وجود القديم. ومحال أن يكون له ضد قديم كان موجوداً معه في القدم ولم يعدمه وقد أعدمه الآن، وباطل أن يقال انعدم لانعدام شرط وجوده، فإن الشرط إن كان حادثاً استحال أن يكون وجود القديم مشروطاً بحادث، وإن كان قديماً فالكلام في استحالة عدم الشرط كالكلام في استحالة عدم المشروط فلا يتصور عدمه. فإن قيل فبما إذاً تفنى عندكم الجواهر والأعراض؟ قلنا: أما الأعراض فبأنفسها، ونعني بقولنا بأنفسها أن ذواتها لا يتصور لها بقاء. ويفهم المذهب فيه بأن يفرض في الحركة، فإن الأكوان المتعاقبة في أحيان متواصلة لا توصف بأنها حركات إلا بتلاحقها على سبيل دوام التجدد ودوام الانعدام، فإنها إن فرض بقاؤها كانت سكوناً لا حركة، ولا تعقل ذات الحركة ما لم يعقل معها العدم عقيب الوجود. وهذا يفهم في الحركة بغير برهان. وأما الألوان وسائر الأعراض، فإنما تفهم بما ذكرناه من أنه لو بقي لاستحال عدمه بالقدرة وبالضد كما سبق في القديم، ومثل هذا العدم محال في حق الله تعالى فإنا بينا قدمه أولاً واستمرار وجوده فيما لم يزل، فلم يكن من ضرورة وجوده حقيقة فناؤه عقيبه، كما كان من ضرورة وجود الحركة حقيقة أن تفنى عقيب الوجود. وأما الجواهر فانعدامها بان لا تخلق فيها الحركة والسكون فينقطع شرط وجودها فلا يعقل بقاؤها.
الدعوى الرابعة: ندعي أن صانع العالم ليس بجوهر متحيز لأنه قد ثبت قدمه، ولو كان متحيزاً لكان لا يخلو عن الحركة في حيزه أو السكون فيه، وما لا يخلو عن الحوادث، فهو حادث كما سبق. فإن قيل: بم تنكرون على من يسميه جوهراً، ولا يعتقده متحيزاً؟ قلنا العقل عندنا لا يوجب الامتناع من اطلاق الألفاظ وإنما يمنع عنه إما لحق اللغة وإما لحق الشرع. أما حق اللغة فذلك إذا ادعى أنه موافق لوضع اللسان فيبحث عنه، فإن ادعى واضعه له أنه اسمه على الحقيقة، أي واضع اللغة وضعه له، فهو كاذب على اللسان وإن زعم أنه استعاره نظراً إلى المعنى الذي به شارك المستعار منه، فإن صلح للاستعارة لم ينكر عليه بحق اللغة وإن لم يصلح قيل له أخطأت على اللغة ولا يستعظم ذلك إلا بقدر استعظام صنيع من يبعد في الاستعارة، والنظر في ذلك لا يليق بمباحث العقول. وأما حق الشرع وجواز ذلك وتحريمه، فهو بحث فقهي يجب طلبه على الفقهاء إذ لا فرق بين البحث عن جواز اطلاق الألفاظ من غير إرادة معنى فاسد وبين البحث عن جواز الأفعال. وفيه رأيان: أحدهما، أن يقال: لا يطلق اسم في حق الله تعالى إلا بالاذن، وهذا لم يرد فيه إذن فيحرم. وأما أن يقال لا يحرم إلا بالنهي وهذا لم يرد فيه نهي فينظر: فإن كان يوهم خطأ فيجب الاحتراز منه لأن إيهام الخطأ في صفات الله تعالى حرام. وإن لم يوهم خطأ يحكم بتحريمه، فكلا الطريقين محتمل. ثم الايهام يختلف باللغات وعادات الاستعمال فرب لفظ يوهم عند قوم ولا يوهم عند غيرهم. الدعوى الخامسة: ندعي أن صانع العالم ليس بجسم، لأن كل جسم فهو متألف من جوهرين متحيزين، وإذا استحال أن يكون جوهراً استحال أن يكون جسماً، ونحن لا نعني بالجسم إلا هذا. فإن سماه جسماً ولم يرد هذا المعنى كانت المضايقة معه بحق اللغة أو بحق الشرع لا بحق العقل فإن العقل لا يحكم في اطلاق الألفاظ ونظم الحروف والأصوات التي هي اصطلاحات، ولأنه لو كان جسماً لكان مقداراً بمقدار مخصوص ويجوز أن يكون أصغر منه أو أكبر، ولا يترجح أحد الجائزين عن الآخر إلا بمخصص ومرجح، كما سبق، فيفتقر إلى مخصص يتصرف فيه فيقدره بمقدار مخصوص، فيكون مصنوعاً لا صانعاً ومخلوقاً لا خالقاً. الدعوى السادسة: ندعي أن صانع العالم ليس بعرض، لأنا نعني بالعرض ما
يستدعي وجوده ذاتاً تقوم به، وذلك الذات جسم أو جوهر، ومهما كان الجسم واجب الحدوث كان الحال فيه أيضاً حادثاً لا محالة، إذ يبطل انتقال الأعراض، وقد بينا أن صانع العالم قديم فلا يمكن أن يكون عرضاً، وإن فهم من العرض ما هو صفة لشيء من غير أن يكون ذلك الشيء متحيزاً، فنحن لا ننكر وجود هذا فانا نستدل على صفات الله تعالى نعم يرجع النزاع إلى إطلاق اسم الصانع والفاعل، فإن إطلاقه على الذات الموصوفة بالصفات أولى من إطلاقه على الصفات. فإذا قلنا الصانع ليس بصفة، عنينا به أن الصنع مضاف إلى الذات التي تقوم بها الصفات لا إلى الصفات، كما أنا إذا قلنا النجار ليس بعرض ولا صفة، عنينا به أن صنعة النجارة غير مضافة إلى الصفات بل إلى الذات الواجب وصفها بجملة من الصفات حتى يكون صانعاً. فكذا القول في صانع العالم، وإن أراد المنازع بالعرض أمراً غير الحال في الجسم وغير الصفة القائمة بالذات كان الحق في منعه للغة أو الشرع لا للعقل. الدعوى السابعة: ندعي أنه ليس في جهة مخصوصة من الجهات الست، ومن عرف معنى لفظ الجهة ومعنى لفظ الاختصاص فهم قطعاً استحالة الجهات على غير الجواهر والأعراض، إذ الحيز معقول وهو الذي يختص الجوهر به، ولكن الحيز إنما يصير جهة إذا أضيف إلى شيء آخر متحيز. فالجهات ست فوق وأسفل وقدام وخلف ويمين وشمال. فمعنى كون الشيء فوقنا هو أنه في حيز يلي جانب الرأس. ومعنى كونه تحتاً أنه في حيز يلي جانب
الرجل. وكذا سائر الجهات؛ فكل ما قيل قيه أنه في جهة فقد قيل أنه في حيز مع زيادة إضافة. وقولنا الشيء في حيز، يعقل بوجهين أحدهما: أنه يختص به بحيث يمنع مثله من أن يوجد بحيث هو، وهذا هو الجوهر، والآخر أن يكون حالاً في الجوهر فإنه قد يقال إنه بجهة، ولكن بطريق البتيعة للجوهر، فليس كون العرض في جهة ككون الجوهر، بل الجهة للجوهر أولى، وللعرض بطريق التبعية للجوهر، فهذان وجهان معقولان في الاختصاص بالجهة. فإن أراد الخصم أحدهما دل على بطلانه ما دل على بطلان كونه جوهراً أو عرضاً. وإن أراد أمراً غير هذا فهو غير مفهوم فيكون الحق في إطلاق لفظه لم ينفك عن معنى غير مفهوم للغة والشرع لا العقل، فإن قال الخصم إنما أُريد بكونه بجهة معنى سوى هذا فلم ننكره، ونقول له: أما لفظك فإنما ننكره من حيث أنه يوهم المفهوم الظاهر منه وهو ما يعقل الجوهر والعرض وذلك كذب على الله تعالى. وأما مرادك منه فلست أنكره فإن ما لا أفهمه كيف أنكره! وعساك تريد به علمه وقدرته وأنا لا أنكر كونه بجهة على معنى أنه عالم وقادر، فإنك إذا فتحت هذا الباب، وهو أن تريد باللفظ غير ما وضع اللفظ له ويدل عليه في التفاهم لم يكن لما تريد به حصر فلا أنكره ما لم تعرب عن مرادك بما أفهمه من أمر يدل على الحدوث، فإن كان ما يدل على الحدوث فهو في ذاته محال ويدل أيضاً على بطلان القول بالجهة، لأن ذلك يطرق الجواز إليه ويحوجه إلى مخصص يخصصه بأحد وجوه الجواز وذلك من وجهين، أحدهما: أن الجهة التي تختص به لا تختص به لذاته، فإن سائر الجهات متساوية بالاضافة إلى المقابل للجهة، فاختصاصه ببعض الجهات المعينة ليس بواجب لذاته بل هو جائز فيحتاج إلى مخصص يخصصه، ويكون الاختصاص فيه معنى زائداً على ذاته وما يتطرق الجواز إليه استحال قدمه بل القديم عبارة عما هو واجب الوجود من جميع الجهات. فإن قيل اختص بجهة فوق لأنه أشرف الجهات، قلنا أي إنما صارت الجهة جهة فوق بخلقه العالم في هذا الحيز الذي خلقه فيه. فقيل خلق العالم لم يكن فوق ولا تحت أصلاً. إذ هما مشتقان من الرأس والرجل ولم يكن إذ ذاك حيوان فتسمى الجهة التي تلي رأسه فوق والمقابل له تحت. والوجه الثاني أنه لو كان بجهة لكان محاذياً لجسم العالم، وكل محاذ فإما أصغر منه وإما أكبر وإما مساو، وكل ذلك يوجب التقدير بمقدار، وذلك المقدار يجوز في العقل أن يفرض أصغر منه أو أكبر فيحتاج إلى مقدار ومخصص.
فإن قيل: لو كان الاختصاص بالجهة يوجب التقدير لكان العرض مقدراً، قلنا: العرض ليس في جهة بنفسه، بل بتبعيته للجوهر فلا جرم هو أيضاً مقدر بالتبعية. فإنا نعلم أنه لا توجد عشرة أعراض إلا في عشرة جواهر، ولا يتصور أن يكون في عشرين، فتقدير الأعراض عشرة لازم بطريق التبعية لتقدير الجواهر، كما لزم كونه بجهة بطريق التبعية. فإن قيل: فإن لم يكن مخصوصاً بجهة فوق، فما بال الوجوه والأيدي ترفع إلى السماء في الأدعية شرعاً وطبعاً، وما باله صلى الله عليه وسلم قال للجارية التي قصد إعتاقها فأراد أن يستيقن إيمانها أين الله فأشارت إلى السماء فقال إنها مؤمنة؟ فالجواب عن الأول أن هذا يضاهي قول القائل: إن لم يكن الله تعالى في الكعبة وهو بيته فما بالنا نحجه ونزوره، وما بالنا نستقبله في الصلاة؟ وإن لم يكن في الأرض، فما بالنا نتذلل بوضع وجوهنا على الأرض في السجود؟ وهذا هذيان. بل يقال: قصد الشرع من تعبد الخلق بالكعبة في الصلاة ملازمة الثبوت في جهة واحدة، فإن ذلك لا محالة أقرب إلى الخشوع وحضور القلب من التردد على الجهات، ثم لما كانت الجهات متساوية من حيث إمكان الاستقبال خصص الله بقعة مخصوصة بالتشريف والتعظيم وشرفها بالإضافة إلى نفسه واستمال القلوب إليها بتشريفه ليثيب على استقبالها، فكذلك السماء قبلة الدعاء، كما أن البيت قبلة الصلاة، والمعبود بالصلاة والمقصود بالدعاء منزه عن الحلول في البيت والسماء ثم في الاشارة بالدعاء إلى السماء سر لطيف يعز من يتنبه لأمثاله، وهو أن نجاة العبد وفوزه في الآخرة، بأن يتواضع لله تعالى ويعتقد التعظيم لربه، والتواضع والتعظيم عمل القلب، وآلته العقل. والجوارح إنما استعملت لتطهير القلب وتزكيته، فإن القلب خلق خلقه يتأثر بالمواظبة على أعمال الجوارح، كما خلقت الجوارح متأثرة لمعتقدات القلوب، ولما كان المقصود أن يتواضع في نفسه بعقله وقلبه، بأن يعرف قدره ليعرف بخسة رتبته في الوجود لجلال الله تعالى وعلوه، وكان من أعظم الأدلة على خسته الموجبة لتواضعه أنه مخلوق من تراب، كلف أن يضع على التراب، الذي هو أذل الأشياء، وجهه الذي هو أعز الأعضاء، ليستشعر قلبه التواضع بفعل الجبهة في مماستها الأرض، فيكون البدن متواضعاً في جسمه وشخصه وصورته بالوجه الممكن فيه وهو معانقة التراب الوضيع الخسيس ويكون العقل متواضعاً لربه بما
يليق به، وهو معرفة الضعة وسقوط الرتبة وخسة المنزلة عند الالتفات إلى ما خلق منه. فكذلك التعظيم لله تعالى وضيعة على القلب فيها نجاته، وذلك أيضاً ينبغي أن تشترك فيه الجوارح، وبالقدر الذي يمكنه أن تحمل الجوارح، وتعظيم القلب بالإشارة إلى علو الرتبة على طريق المعرفة والاعتقاد وتعظيم الجوارح بالإشارة إلى جهة العلو الذي هو أعلى الجهات وأرفعها في الاعتقادات؛ فإن غاية تعظيم الجارحة استعمالها في الجهات، حتى أن من المعتاد المفهوم في المحاورات أن يفصح الإنسان عن علو رتبة غيره وعظيم ولايته فيقول: أمره في السماء السابعة، وهو إنما ينبه على علو الرتبة ولكن يستعير له علو المكان، وقد يشير برأسه إلى السماء في تعظيم من يريد تعظيم أمره، أي أمره في السماء، أي في العلو وتكون السماء عبارة عن العلو، فانظر كيف تلطف الشرع بقلوب الخلق وجوارحهم في سياقهم إلى تعظيم الله وكيف جهل من قلت بصيرته ولم يلتفت إلا إلى ظواهر الجوارح والأجسام وغفل عن أسرار القلوب واستغنائها في التعظيم عن تقدير الجهات، وظن أن الأصل ما يشار إليه بالجوارح ولم يعرف أن المظنة الأولى لتعظيم القلب وأن تعظيمه باعتقاد علو الرتبة لا باعتقاد علو المكان، وأن الجوارح في ذلك خدم وأتباع يخدمون القلب على الموافقة في التعظيم بقدر الممكن فيها، ولا يمكن في الجوارح إلا الإشارة إلى الجهات، فهذا هو السر في رفع الوجوه إلى السماء عند قصد التعظيم، ويضاف إليه عند الدعاء أمر آخر وهو أن الدعاء لا ينفك عن سؤال نعمة من نعم الله تعالى، وخزائن نعمه السموات، وخزان أرزاقه الملائكة ومقرهم ملكوت السموات وهم الموكلون بالأرزاق. وقد قال الله تعالى: " وفي السماء رزقكم وما توعدون ". والطبع يتقاضى الإقبال بالوجه على الخزانة التي هي مقر الرزق المطلوب، فطلاب الأرزاق من الملوك إذا أخبروا بتفرقة الأرزاق على باب الخزانة مالت وجوههم وقلوبهم إلى جهة الخزانة، وإن لم يعتقدوا أن الملك في الخزانة فهذا هو محرك وجوه أرباب الدين إلى جهة السماء طبعاً وشرعاً. فأما العوام فقد يعتقدون أن معبودهم في السماء، فيكون ذلك أحد أسباب إشاراتهم، تعالى رب الأرباب عما اعتقد الزائغون علواً كبير. وأما حكمه صلوات الله عليه بالإيمان للجارية لما أشارت إلى السماء، فقد انكشف به أيضاً إذ ظهر أن لا سبيل للأخرس إلى تفهم علو المرتبة إلا بالإشارة إلى جهة العلو، فقد كانت خرساء كما حكي، وقد كان يظن بها أنها من عبدة الأوثان، ومن يعتقد اله في بيت الأصنام فاستنطقت عن معتقدها فعرفت بالإشارة إلى السماء أن معبودها ليس في بيوت الأصنام كما يعتقدوه أولئك.
فإن قيل فنفي الجهة يؤدي إلى المحال، وهو إثبات موجود تخلو عنه الجهات الست ويكون لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصلاً به، ولا منفصلاً عنه، وذلك محال، قلنا: مسلم أن كل موجود يقبل الاتصال فوجوده لا متصلاً ولا منفصلاً محال، وإن كان موجود يقبل الاختصاص بالجهة فوجوده مع خلو الجهات الست عنه محال، فإما موجود لا يقبل الاتصال، ولا الاختصاص بالجهة فخلو عن طرفي النقيض غير محال، وهو كقول القائل يستحيل موجود لا يكون عاجزاً ولا قادراً ولا عالماً ولا جاهلاً فإن أحد المتضادين لا يخلو الشيء عنه، فيقال له إن كان ذلك الشيء قابلاً للمتضادين فيستحيل خلوه عنهما وأما الجماد الذي لا يقبل واحداً منهما لأنه فقد شرطهما وهو الحياة، فخلوه عنهما ليس بمحال. فكذلك شرط الاتصال والاختصاص بالجهات التحيز والقيام بالمتحيز. فإذا فقد هذا لم يستحل الخلق عن متضادته فرجع النظر إذاً إلى أن موجوداً ليس بمتحيز، ولا هو في متحيز، بل هو فاقد شرط الاتصال، والاختصاص هل هو محال أم لا؟ فإن زعم الخصم أن ذلك محال وجوده فقد دللنا عليه بأنه مهما بان، أن كل متحيز حادث وأن كل حادث يفتقر إلى فاعل ليس بحادث فقد لزم بالضرورة من هاتين المقدمتين ثبوت موجود ليس بمتحيز. أما الأصلان فقد أتبتناهما وأما الدعوى اللازمة منهما فلا سبيل إلى جحدها مع الإقرار بالأصلين. فإن قال الخصم إن مثل هذا الموجود الذي ساق دليلكم إلى إثباته غير مفهوم، فيقال له ما الذي أردت بقولك غير مفهوم فإن أردت به أنه غير متخيل ولا متصور ولا داخل في الوهم فقد صدقت، فإنه لا يدخل في الوهم والتصور والخيال إلا جسم له لون وقدر، فالمنفك عن اللون والقدر لا يتصوره الخيال، فإن الخيال قد أنس بالمبصرات فلا يتوهم الشيء إلا على وفق مرآه ولا يستطيع أن يتوهم ما لا يوافقه. وإن أراد الخصم أنه ليس بمعقول، أي ليس بمعلوم بدليل العقل فهو محاذ إذا قدمنا الدليل على ثبوته ولا معنى للمعقول إلا ما اضطر العقل إلى الأذعان للتصديق به بموجب الدليل الذي لا يمكن مخالفته. وقد تحقق هذا، فإن قال الخصم فما لا يتصور في الخيال لا وجود له، فلنحكم بأن الخيال لا وجود له في نفسه، فإن الخيال نفسه لا يدخل في الخيال والرؤية لا تدخل في الخيال وكذلك العلم والقدرة، وكذلك الصوت والرائحة ولو كلف الوهم أن يتحقق ذاتاً للصوت لقدر له لوناً ومقداراً وتصوره كذلك. وهكذا جميع أحوال النفس، من الخجل والوجل والفسق والغضب والفرح والحزن والعجب، فمن يدرك بالضرورة هذه الأحوال من نفسه ويسوم خياله أن يتحقق
ذات هذه الأحوال فنجده يقصر عنه إلا بتقدير خطأ ثم ينكر بعد ذلك وجود موجود لا يدخل في خياله فهذا سبيل كشف الغطاء عن المسألة. وقد جاوزنا حد الاختصار ولكن المعتقدات المختصرة في هذا الفن أراها مشتملة على الاطناب في الواضحات والشروع في الزيادات الخارجة عن المهمات مع التساهل في مضايق الاشكالات فرأيت نقل الاطناب من مكان الوضوح، إلى مواقع الغموض أهم وأولى. الدعوى الثامنة: ندعي أن الله تعالى منزه عن أن يوصف بالاستقرار على العرش، فإن كل متمكن على جسم ومستقر عليه مقدر لا محالة فإنه أما أن يكون أكبر منه أو أصغر أو مساوياً وكل ذلك لا يخلو عن التقدير، وأنه لو جاز أن يماسه جسم من هذه الجهة لجاز أن يماسه من سائر الجهات فيصير محاطاً به والخصم لا يعتقد ذلك بحال وهو لازم على مذهبه بالضرورة، وعلى الجملة يستقر على الجسم إلا جسم ولا يحل فيه إلا عرض وقد بان أنه تعالى ليس بجسم ولا عرض، فلا يحتاج إلى إقران هذه الدعوى بإقامة البرهان. فإن قيل فما معنى قوله تعالى: " الرحمن على العرش استوى "؟ وما معنى قوله عليه السلام: " ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا " قلنا الكلام على الظواهر الواردة في هذا الباب طويل ولكن نذكر منهجاً في هذين الظاهرين يرشد إلى ما عداه وهو أنا نقول: الناس في هذا فريقان عوام وعلماء، والذي نراه اللائق بعوام الخلق أن لا يخاض بهم في هذه التأويلات بل ننزع عن عقائدهم كل ما يوجب التشبيه ويدل على الحدوث ونحقق عندهم أنه موجود ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وإذا سألوا عن معاني هذه الآيات زجروا عنها، وقيل ليس هذا بعشكم فادرجوا فلكل علم رجال. ويجاب بما أجاب به مالك بن أنس رضي الله عنه، بعض السلف حيث سئل عن الاستواء، فقال: الاستواء معلوم والكيفية مجهولة، والسؤال عنه بدعة، والايمان به واجب، وهذا لأن عقول العوام لا تتسع لقبول المعقولات ولا إحاطتهم باللغات ولا تتسع لفهم توسيعات العرب في الاستعارات. وأما العلماء فاللائق بهم تعريف ذلك وتفهمه، ولست أقول أن ذلك فرض عين إذ لم يرد به تكليف بل التكليف التنزيه عن كل ما تشبهه بغيره. فأما معاني القرآن، فلم يكلف الأعيان فهم جميعها أصلاً ولكن لسنا نرتضي قول من يقول، أن ذلك من المتشابهات كحروف أوائل السور، فإن حروف أوائل السور ليست موضوعة باصطلاح
سابق للعرب للدلالة على المعاني، ومن نطق بحروف وهن كلمات لم يصطلح عليها، فواجب أن يكون معناه مجهولاً إلا أن يعرف ما أردته، فإذا ذكره صارت تلك الحروف كاللغة المخترعة من جهته. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: " ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا "، فلفظ مفهوم ذكر للتفهم وعلم أنه يسبق إلى الإفهام منه المعنى الذي وضع له أو المعنى الذي يستعار، فكيف يقال إنه متشابه بل هو مخيل معنى خطأ عند الجاهل ومفهم معنى صحيحاً عند العالم، وهو كقوله تعالى: " وهو معكم أينما كنتم ". فإنه يخيل عند الجاهل اجتماعاً مناقصاً لكونه على العرش، وعند العالم يفهم أنه مع الكل بالاحاطة والعلم، وكقوله صلى الله عليه وسلم: " قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن "، فإنه عند الجاهل يخيل عضوين مركبين من اللحم والعظم والعصب مشتملين على الأنامل والأظفار، نابتين من الكف، وعند العالم يدل على المعنى المستعار له دون الموضوع له وهو ما كان الاصبع له، وكان سر الاصبع وروحه وحقيقته وهو القدرة على التقليب كما يشاء، كما دلت المعية عليه في قوله وهو معكم على ما تراد المعية له وهو العلم والاحاطة ولكن من شائع عبارات العرب العبارة بالسبب عن المسبب، واستعارة السبب للمستعار منه وكقوله تعالى: " من تقرَّب إليَّ شبراً تقربت إليه ذراعاً ومن أتاني بمشي أتيته بهرولة " فإن الهرولة عند الجاهل تدل على نقل الأقدام وشدة العدو وكذا الاتيان يدل على القرب في المسافة.؟ وعند العاقل يدل على المعنى المطلوب من قرب المسافة بين الناس وهو قرب الكرامة والانعام وإن معناه أن رحمتي ونعمتي أشد انصباباً إلى عبادي من طاعتهم إلي وهو كما قال: " لقد طال شوق الأبرار إلى لقائي وأنا إلى لقائهم لأشد شوقاً " تعالى الله عما يفهم من معنى لفظ الشوق بالوضع الذي هو نوع ألم وحاجة إلى استراحة، وهو عين النقص ولكن الشوق سبب لقبول المشتاق إليه والإقبال عليه وإفاضة النعمة لديه فعبر به عن المسبب، وكما عبر بالغضب والرضى عن إرادة الثواب والعقاب الذين هما ثمرتا الغضب والرضى ومسبباه في العادة. وكذا لما قال في الحجر الأسود إنه يمين الله في الأرض يظن الجاهل انه أراد به اليمين
المقابل للشمال التي هي عضو مركب من لحم ودم وعظم منقسم بخمسة أصابع، ثم إنه إن فتح بصيرته علم أنه كان على العرش ولا يكون يمينه في الكعبة ثم لا يكون حجراً أسود فيدرك بأدنى مسكة أنه استعير للمصافحة، فإنه يؤمر باستلام الحجر وتقبيله كما يؤمر بتقبيل يمين الملك، فاستعير اللفظ لذلك. والكامل العقل البصير لا تعظم عنده هذه الأمور، بل يفهم معانيها على البديهة، فلنرجع إلى معنى الاستواء والنزول؛ أما الاستواء فهو نسبه للعرش لا محالة، ولا يمكن أن يكون للعرش إليه نسبة إلا بكونه معلوماً، أو مراداً، أو مقدوراً عليه، أو محلاً مثل محل العرض، أو مكاناً مثل مستقر الجسم. ولكن بعض هذه النسبة تستحيل عقلاً وبعضها لا يصلح اللفظ للاستعارة به له، فإن كان في جملة هذه النسبة، مع أنه لا نسبة سواها، نسبة لا يخيلها العقل ولا ينبو عنها اللفظ، فليعلم أنها المراد إما كونه مكاناً أو محلاً، كما كان للجوهر والعرض، إذاً اللفظ يصلح له ولكن العقل يخيله كما سبق، وإما كونه معلوماً ومراداً فالعقل لا يخيله، ولكن اللفظ لا يصلح له، وإما كونه مقدوراً عليه وواقعاً في قبضة القدرة ومسخراً له مع أنه أعظم المقدورات ويصلح الاستيلاء عليه لأن يمتدح به وينبه به على غيره الذي هو دونه في العظم، فهذا مما لا يخيله العقل ويصلح له اللفظ، فأخلق بأن يكون هو المراد قطعاً، أما صلاح اللفظ له فظاهر عند الخبير بلسان العرب، وإنما ينبو عن فهم مثل هذا أفهام المتطفلين على لغة العرب الناظرين إليها من بعد الملتفتين إليها التفات العرب إلى لسان الترك حيث لم يتعلموا منها إلا أوائلها، فمن المستحسن في اللغة أن يقال استوى الأمير على مملكته، حتى قال الشاعر: قد استوى بشير على العراق ... من غير سيف ودم مهراق ولذلك قال بعض السلف رضي الله عنهم: يفهم من قوله تعالى " الرحمن على العرش استوى " ما فهم من قوله تعالى " ثم استوى إلى السماء وهي دخان ". وأما قوله صلى الله عليه وسلم " ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا " فللتأويل فيه مجال من وجهين: أحدهما، في اضافة النزول إليه وأنه مجاز، وبالحقيقة هو مضاف إلى ملك من الملائكة كما قال تعالى " واسأل القرية " والمسؤول بالحقيقة أهل القرية. وهذا أيضاً من المتداول في الألسنة، أعني إضافة أحوال التابع إلى المتبوع، فيقال: ترك الملك على باب البلد، ويراد عسكره، فإن المخبر بنزول الملك على باب البلد قد يقال له هلا خرجت لزيارته فيقول لا، لأنه عرج في طريقه على الصيد ولم ينزل بعد، فلا يقال له فلم نزل الملك والآن تقول لم ينزل بعد؟ فيكون المفهوم
من نزول الملك نزول العسكر، وهذا جلي واضح. والثاني، أن لفظ النزول قد يستعمل للتلطف والتواضع في حق الخلق كما يستعمل الارتفاع للتكبر، يقال فلان رفع رأسه إلى عنان السماء، أي تكبر، ويقال ارتفع إلى أعلى عليين، أي تعظم؛ وإن علا أمره يقال: أمره في السماء السابعة؛ وفي معارضته إذا سقطت رتبته يقال: قد هوى به إلى أسفل السافلين؛ وإذا تواضع وتلطف له تطامن إلى الأرض ونزل إلى أدنى الدرجات. فإذا فهم هذا وعلم أن النزول عن الرتبة بتركها أو سقوطها وفي النزول عن الرتبة بطريق التلطف وترك العقل الذي يقتضيه علو الرتبة وكمال الاستغناء، فبالنظر إلى هذه المعاني الثلاثة التي يتردد اللفظ بينها ما الذي يجوزه العقل؟ أما النزول بطريق الانتقال فقد أحاله العقل كما سبق، فإن ذلك لا يمكن إلا في متحيز، وأما سقوط الرتبة فهو محال لأنه سبحانه قديم بصفاته وجلاله ولا يمكن زوال علوه، وأما النزول بمعنى اللطف والرحمة وترك الفعل اللائق بالاستغناء وعدم المبالاة فهو ممكن، فيتعين التنزيل عليه، وقيل إنه لما نزل قوله تعالى: " رفيع الدرجات ذو العرش " استشعر الصحابة رضوان الله عليهم من مهابة عظيمة واستبعدوا الانبساط في السؤال والدعاء مع ذلك الجلال، فأخبروا أن الله سبحانه وتعالى مع عظمة جلاله وعلو شأنه متلطف بعباده رحيم بهم مستجيب لهم مع الاستغناء إذا دعوه، وكانت استجابة الدعوة نزولاً بالاضافة إلى ما يقتضيه ذلك الجلال من الاستغناء وعدم المبالاة، فعبر عن ذلك بالنزول تشجيعاً لقلوب العباد على المباسطة بالأدعية بل على الركوع والسجود، فإن من يستشعر بقدر طاقته مبادئ جلال الله تعالى استبعد سجوده وركوعه، فإن تقرب العباد كلهم بالاضافة إلى جلال الله سبحانه أحس من تحريك العبد أصبعاً من أصابعه على قصد التقرب إلى ملك من ملوك الأرض، ولو عظم به ملكاً من الملوك لاستحق به التوبيخ، بل من عادة الملوك زجر الأرزال عن الخدمة والسجود بين أيديهم والتقبيل لعتبة دورهم استحقاراً لهم عن الاستخدام وتعاظماً عن استخدام غير الأمراء والأكابر، كما جرت به عادة بعض الخلفاء. فلولا النزول عن مقتضى الجلال باللطف والرحمة والاستجابة لاقتضى ذلك الجلال أن يبهت القلوب عن الفكر، ويخرس الألسنة عن الذكر، ويخمد الجوارح عن الحركة، فمن لاحظ ذلك الجلال وهذا اللطف استبان له على القطع أن عبارة النزول مطابقة للجلال ومطلقة في موضوعها لا على ما فهمه الجهال؛ فإن قيل فلم خصص السماء الدنيا؟ قلنا: هو عبارة عن الدرجة الأخيرة التي لا درجة بعدها، كما يقال سقط إلى
الثرى وارتفع إلى الثريا، على تقدير أن الثريا أعلى الكواكب والثرى أسفل المواضع. فإن قيل: فلم خصص بالليالي، فقال ينزل كل ليلة؟ قلنا: لأن الخلوات مظنة الدعوات والليالي أعدت لذلك، حيث يسكن الخلق وينمحي عن القلوب ذكرهم، ويصفوا لذكر الله تعالى قلب الداعي، فمثل هذا الدعاء هو المرجو الاستجابة لا ما يصدر عن غفلة القلوب عند تزاحم الاشتغال. الدعوى التاسعة: ندعي أن الله سبحانه وتعالى مرئي، خلافاً للمعتزلة، وإنما أوردنا هذه المسألة في القطب الموسوم بالنظر في ذات الله سبحانه وتعالى لأمرين: أحدهما أن ننفي الرؤية عما يلزم على نفي الجهة، فأردنا أن نبين كيف يجمع بين نفي الجهة وإثبات الرؤية. والثاني أنه سبحانه وتعالى عندنا مرئي لوجوده ووجود ذاته، فليس ذلك إلا لذاته، فإنه ليس لفعله ولا لصفة من الصفات، بل كل موجود ذات فواجب أن يكون مرئياً، كما أنه واجب أن يكون معلوماً، ولست أعني به أنه واجب أن يكون معلوماً ومرئياً بالفعل بل بالقوة، أي هو من حيث ذاته له، فإن امتنع وجود الرؤية فلأمر آخر خارج عن ذاته، كما نقول: الماء الذي في النهر مرو، والخمر الذي في الدن مسكر، وليس كذلك لأنه يسكر ويروي عند الشرب ولكن معناه أن ذاته مستعدة لذلك فإذا فهم المراد منه فالنظر في طرفين: أحدهما في الجواز العقلي، والثاني في الوقوع الذي لا سبيل إلى دركه إلا بالشرع، ومهما دل الشرع على وقوعه فقد دل أيضاً لا محالة على جوازه ولكنا ندل بمسلكين واقعين عقليين على جوازه. المسلك الأول، هو أنا نقول أن الباري سبحانه موجود وذات، وله ثبوت وحقيقة، وإنما يخالف سائر الموجودات في استحالة كونه حادثاً أو موصوفاً بما يدل على الحدوث، أو موصوفاً بصفة تناقض صفات الالهية من العلم والقدرة وغيرهما. فكل ما يصح لموجود فهو يصح في حقه تعالى إن لم يدل على الحدوث ولم يناقض صفة من صفاته. والدليل عليه تعلق العلم به؛ فإنه لما لم يؤد إلى تغير في ذاته ولا إلى مناقضة صفاته ولا إلى الدلالة على الحدوث، سوى بينه وبين الأجسام والأعراض في جواز تعلق العلم بذاته وصفاته. والرؤية نوع علم لا يوجب تعلقه بالمرئي تغير صفة ولا يدل على حدوث، فوجب الحكم بها على كل موجود،
فإن قيل: فكونه مرئياً يوجب كونه بجهة وكونه بجهة يوجب كونه عرضاً أو جوهراً وهو محال، ونظم القياس أنه إن كان مرئياً فهو بجهة من الرأي وهذا اللازم محال فالمفضي إلى الرؤية محال. قلنا: أحد الأصلين من هذا القياس مسلم لكم، وهو أن هذا اللازم محال، ولكن الأصل الأول وهو ادعاء هذا اللازم على اعتقاد الرؤية ممنوع. فنقول لم قلتم إنه إن كان مرئياً فهو بجهة من الرأي، أعلمتم ذلك بضرورة، أم بنظر؟ ولا سبيل إلى دعوى الضرورة، وأما النظر فلا بد من بيانه، ومنتهاهم أنهم لم يروا إلى الآن شيئاً إلا وكان بجهة من الرأي مخصوصة، فيقال: وما لم ير فلا يحكم باستحالته، ولو جاز هذا لجاز للمجسم أن يقول إنه تعالى جسم، لأنه فاعل، فإننا لم نر إلى الآن فاعلاً إلا جسماً. أو يقول إن كان فاعلاً وموجوداً فهو إما داخل العالم وإما خارجه، وإما متصل وإما منفصل، ولا تخلو عنه الجهات الست، فإنه لم يعلم موجود إلا وهو كذلك فلا فضل بينكم وبين هؤلاء. وحاصله يرجع إلى الحكم بأن ما شوهد وعلم ينبغي أن لا يعلم غيره إلا على وفقه، وهو كمن يعلم الجسم وينكر العرض ويقول: لو كان موجوداً لكان يختص بحيز ويمنع غيره من الوجود بحيث هو كالجسم. ومنشأ هذا إحالة موجودات اختلاف الموجودات في حقائق الخواص مع الاشتراك في أمور عامة. وذلك بحكم لا أصل له، على أن هؤلاء لا يغفل عن معارضتهم بأن الله يرى نفسه ويرى العالم وهو ليس بجهة من نفسه ولا من العالم، فإذا جاز ذلك فقد بطل هذا الخيال. وهذا مما يعترف به أكثر المعتزلة ولا نخرج عنه لمن اعترف به ومن أنكر منهم فلا يقدر على انكار رؤية الانسان نفسه في المرآة، ومعلوم أنه ليس في مقابلة نفسه فإن زعموا أنه لا يرى نفسه وإنما يرى صورة محاكية لصورته منطبعة في المرآة انطباع النفس في الحائط، فيقال إن هذا ظاهر الاستحالة: فإن من تباعد عن مرآة منصوبة في حائط بقدر ذراعين يرى صورته بعيدة عن جرم المرآة بذراعين، وإن تباعد بثلاثة أذرع فكذلك. فالبعيد عن المرآة بذراعين كيف يكون منطبعاً في المرآة وسمك المرآة ربما لا يزيد على سمك شعيرة؟ فإن كانت الصورة في شيء وراء المرآة فهو محال، إذ ليس وراء المرآة إلا جدار أو هواء أو شخص آخر هو محجوب عنه، وهو لا يراه. وكذا عن يمين المرآة ويسارها وفوقها وتحتها وجهات المرآة الست، وهو يرى صورة بعيدة عن المرآة بذراعين، فلنطلب هذه الصورة من جوانب المرآة: فحيث وجدت فهو المرئي ولا وجود لمثل هذه الصورة المرئية في الأجسام المحيطة بالمرآة إلا في جسم والناظر، فهو المرئي إذاً بالضرورة. وقد تطلب المقابلة والجهة ولا ينبغي
أن تستحقر هذا الإلزام فإنه لا مخرج للمعتزلة عنه، ونحن نعلم بالضرورة أن الانسان لو لم يبصر نفسه قط ولا عرف المرآة وقيل له أن يمكن أن تبصر نفسك في مرآة الحكم بأنه محال، وقال لا يخلو إما أن أرى نفسي وأنا في المرآة فهو محال، أو أرى مثل صورتي في جرم المرآة وهو محال، أو في جرم وراء المرآة وهو محال، أو المرآة في نفسها صورة وللأجسام المحيطة بها جسم صور، ولا تجتمع صورتان في جسم واحد إذ محال أن يكون في جسم واحد صورة إنسان وديد وحائط وإن رأيت نفسي حيث أنا فهو محال، إذ لست في مقابلة نفسي فكيف أرى نفسي، ولا بد بين المقابلة بين الرائي والمرئي وهذا التقسيم صحيح عند المعتزلي ومعلوم أنه باطل، وبطلانه عندنا لقوله إني لست في مقابلة نفسي فلا أراها وإلا فسائر أقسام كلامه صحيحة، فبهذا يستبين ضيق حوصلة هؤلاء عن التصديق بما لم يألفوه ولم تأنس به حواسهم. المسلك الثاني، وهو الكشف البالغ أن تقول إنما أنكر الخصم الرؤية لأنه لم يفهم ما تريده بالرؤية ولم يحصل معناها على التحقيق، وظن أنا نريد بها حالة تساوي الحالة التي يدركها الرأي عند النظر إلى الأجسام والألوان وهيهات! فنحن نعترف باستحالة ذلك في حق الله سبحانه، ولكن ينبغي أن نحصل معنى هذا اللفظ في الموضع المتفق، ونسبكه ثم نحذف منه ما يستحيل في حق الله سبحانه وتعالى، فإن نفي من معانيه معنى لم يستحل في حق الله سبحانه وتعالى وأمكن أن يسمى ذلك المعنى رؤية حقيقة، أثبتناه في حق الله سبحانه وقضينا بأنه مرئي حقيقة، وإن لم يكى إطلاق اسم الرؤية عليه إلا بالمجاز أطلقنا اللفظ عليه بإذن الشرع واعتقدنا المعنى كما دل عليه العقل. وتحصيله، أن الرؤية تدل على معنى له محل وهو العين، وله متعلق وهو اللون والقدر والجسم وسائر المرئيات، فلننظر إلى حقيقة معناه ومحله، وإلى متعلقه ولنتأمل أن الركن من جملتها في إطلاق هذا الاسم ما هو، فنقول: أما المحل فليس بركن في صحة هذه التسمية، فإن الحالة التي ندركها بالعين من المرئي لو أدركناها بالقلب أو بالجبهة مثلاً لكنا نقول قد رأينا الشيء وأبصرناه وصدق كلامنا، فإن العين محل وآلة لا تراد لعينها بل لتحل فيه هذه الحالة، فحيث حلت الحالة تمت الحقيقة وصح الاسم. ولنا أن نقول علمنا بقلبنا أو بدماغنا إن أدركنا الشيء بالقلب، أو بالدماغ إن أدركنا الشيء بالدماغ، وكذلك إن أبصرنا بالقلب أو بالجبهة أو بالعين. وأما المتعلق بعينه فليس ركناً في إطلاق هذا الاسم وثبوت هذه الحقيقة. فإن الرؤية لو كانت رؤية لتعلقها بالسواد لما كان المتعلق بالبياض رؤية، ولو كان لتعلقها
باللون لما كان المتعلق بالحركة رؤية، ولو كان لتعلقها بالعرض لما كان المتعلق بالجسم رؤية، فدل أن خصوص صفات المتعلق ليس ركناً لوجود هذه الحقيقة، وإطلاق هذا الاسم، بل الركن فيه من حيث أنه صفة متعلقة أن يكون لها متعلق موجود؛ أي موجود كان وأي ذات كان. فإذاً الركن الذي الاسم مطلق عليه هو الأمر الثالث وهو حقيقة المعنى من غير التفات إلى محله ومتعلقه، فلنبحث عن الحقيقة ما هي، ولا حقيقة لها إلا أنها نوع إدراك هو كمال ومزيد كشف بالاضافة إلى التخيل، فإنا نرى الصديق مثلاً ثم نغمض العين فتكون صورة الصديق حاضرة في دماغنا على سبيل التخيل والتصور، ولكنا لو فتحنا البصر أدركنا تفرقته ولا ترجع تلك التفرقة إلى إدراك صورة أخرى مخالفة لما كانت في الخيال بل الصورة المبصرة مطابقة للمتخيلة من غير فرق وليس بينهما افتراق، إلا أن هذه الحالة الثانية كالاستكمال لحالة التخيل، وكالكشف لها، فتحدث فيها صورة الصديق عند فتح البصر حدوثاً أوضح وأتم وأكمل من الصورة الجارية في الخيال. والحادثة في البصر بعينها تطابق بيان الصورة الحادثة في الخيال، فإذاً التخيل نوع إدراك على رتبة، ووراءه رتبة أخرى هي أتم منه في الوضوح والكشف، بل هي كالتكميل له، فنسمي هذا الاستكمال بالاضافة إلى الخيال رؤية وإبصاراً، وكذا من الأشياء ما نعلمه ولا نتخيله وهو ذات الله سبحانه وتعالى وصفاته، وكل ما لا صورة له، أي لا لون له ولا قدر مثل القدرة والعلم والعشق والإبصار والخيال؛ فإن هذه أمور نعلمها ولا نتخيلها والعلم بها نوع إدراك فلننظر هل يحيل العقل أن يكون لهذا الادراك مزيد استكمال نسبته إليه نسبة الإبصار إلى التخيل؛ فإن كان ذلك ممكناً سمينا ذلك الكشف والاستكمال بالاضافة إلى العلم رؤية، كما سميناه بالاضافة إلى التخيل رؤية. ومعلوم أن تقدير هذا الاستكمال في الاستيضاح والاستكشاف غير محال في الموجودات المعلومة التي ليست متخيلة كالعلم والقدرة وغيرهما، وكذا في ذات الله سبحانه وصفاته، بل نكاد ندرك ضرورة من الطبع أنه يتقاضى طلب مزيد استيضاح في ذات الله وصفاته وفي ذوات هذه المعاني المعلومة كلها. فنن نقول إن ذلك غير محال فإنه لا محيل له بل العقل دليل على إمكانه بل على استدعاء الطبع له. إلا أن هذا الكمال في الكشف غير مبذول في هذا العالم، والنفس في شغل البدن وكدورة صفائه، فهو مجوب عنه. وكما لا يبعد أن يكون الجفن أو الستر أو سواد ما في العين سبباً بحكم اطراد العادة لامتناع الإبصار للمتخيلات فلا يبعد أن تكون كدورة النفس وتراكم حجب الاشغال بحكم اطراد العادة مانعاً من إبصار المعلومات. فإذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، وزكيت القلوب بالشراب الطهور، وصفيت بأنوع التصفية والتنقية، لم يمتنع أن تشتغل بسببها
لمزيد استكمال واستيضاح في ذات الله سبحانه أو في سائر المعلومات، يكون ارتفاع درجته عن العلم المعهود كارتفاع درجة الإبصار عن التخيل، يعبر عن ذلك بلقاء الله تعالى ومشاهدته أو رؤيته أو إبصاره أو ما شئت من العبارات. فلا مشاحة فيها وبعد إيضاح المعاني. وإذا كان ذلك ممكناً بأن خلقت هذه الحالة في العين، كان اسم الرؤية بحكم وضع اللغة عليه أصدق وخلقه في العين غير مستحيل. كما أن خلقها في القلب غير مستحيل فإذا فهم المراد بما أطلقه أهل الحق من الرؤية، علم أن العقل لا يحيله بل يوجبه، وأن الشرع قد شهد له فلا يبقى للمنازعة وجه إلا على سبيل العناد أو المشاحنة في إطلاق عبارة الرؤية أو القصور عن درك هذه المعاني الدقيقة التي ذكرناها. ولنقتصر في هذا الموجز على هذا القدر. الطرف الثاني في وقوعه شرعاً. وقد دل الشرع على وقوعه ومداركه كثيرة، ولكثرتها يمكن دعوى الإجماع على الأولين في ابتهالهم إلى الله سبحانه في طلب لذة النظر إلى وجهه الكريم. ونعلم قطعاً من عقائدهم أنهم كانوا ينتظرون ذلك وأنهم كانوا قد فهموا جواز انتظار ذلك وسؤاله من الله سبحانه، بقرائن أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجملة من ألفاظه الصريحة التي لا تدخل في الحضر، بالاجماع الذي يدل على خروج المدارك عن الحصر. ومن أقوى ما يدل عليه سؤال موسى صلى الله عليه وسلم أرني أنظر إليك فإنه يستحيل أن يخفى عن نبي من أنبياء الله تعالى انتهى منصبه إلى أن يكلمه الله سبحانه شفاهاً أن يجهل من صفات ذاته تعالى ما عرفه المعتزلة. وهذا معلوم على الضرورة، فإن الجهل بكونه ممتنع الرؤية عند الخصم يوجب التفكير أو التضليل وهو جهل بصفة ذاته لأن استحالتها عندهم لذاته ولأنه ليس بجهة فكيف لم يعرف موسى عليه أفضل الصلاة أنه ليس بجهة، أو كيف عرف أنه ليس بجهة ولم يعرف أن رؤية ما ليس بجهة محال؟ فليت شعري ماذا يضمر الخصم ويقدره من ذهول موسى صلى الله عليه وسلم، أيقدره معتقداً أنه جسم في جهة ذو لون، واتهام الأنبياء صلوات الله سبحانه وتعالى عليهم وسلامه كفر صراح، فإنه تكفير للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن القائل بأن الله سبحانه جسم وعابد الوثن والشمس واحد! أو يقول علم استحالة كونه بجهة، ولكنه لم يعلم أن ما ليس بجهة فلا يرى، وهذا تجهيل للنبي عليه أفضل السلام لأن الخصم يعتقد أن ذلك من الجليات لا من النظريات. فأنت الآن أيها المسترشد مخير من أن تميل إلى تجهيل النبي صلى الله عليه وسلم تسليماً، أو إلى تجهيل المعتزلي، فاختر لنفسك ما أليق بك والسلام. فإن قيل: إن دل هذا لكم فقد دل عليكم، لسؤاله الرؤية في الدنيا ودل عليكم قوله تعالى " لن تراني " ودل قوله سبحانه " لا تدركه الأبصار ".
قلنا: أما سؤاله الرؤية في الدنيا فهو دليل على عدم معرفته بوقوع وقت ما هو جائز في نفسه، والأنبياء كلهم عليهم أفضل السلام لا يعرفون من الغيب إلا ما عرفوا، وهو القليل، فمن أين يبعد أن يدعو النبي عليه أفضل السلام كشف غمة وإزالة بلية وهو يرتجي الإجابة في وقت لم تسبق في علم الله تعالى الإجابة فيه. وهذا من ذلك الفن. وأما قوله سبحانه " لن تراني " فهو دفع لما التمسه، وإنما التمس في الآخرة، فلو قال أرني انظر إليك في الآخرة، فقال لن تراني، لكان ذلك دليلاً على نفي الرؤية، ولكن في حق موسى صلوات الله سبحانه وسلامه عليه في الخصوص لا على العموم. وما كان أيضاً دليلاً على الاستحالة، فكيف وهو جواب عن السؤال في الحال؟ وأما قوله لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به ولا تكتنفه من جوانبه كما تحيط الرؤية بالأجسام، وذلك حق، أو هو عام فأريد بة في الدنيا، وذلك أيضاً حق، وهو ما أراده بقوله سبحانه " لن تراني " في الدنيا. ولنقتصر على هذا القدر في مسألة الرؤية، ولينظر المنصف كيف افترقت الفرق وتحزبت إلى مفرط ومفرط. أما الحشوية فإنهم لم يتمكنوا من فهم موجود إلا في جهة، فأثبتوا الجهة حتى ألزمتهم بالضرورة الجسمية والتقدير والاختصاص بصفات الحدوث. وأما المعتزلة وفانهم نفوا الجهة ولم يتمكنوا من إثبات الرؤية دونها، وخالفوا به قواطع الشرع، وظنوا أن في إثباتها إثبات الجهة، فهؤلاء تغلغلوا في التنزيه محترزين من التشبيه، فأفرطوا. والحشوية أثبتوا الجهة احترازاً من التعطيل فشبهوا، فوقف الله سبحانه أهل السنة للقيام بالحق، فتفطنوا للمسلك القصد وعرفوا أن الجهة منقية لأنها للجسمية تابعة وتتمة، وأن الرؤية ثابتة لأنها رديف العلم وفريقه، وهي تكملة له؛ فانتفاء الجسمية أوجب انتفاء الجهة التي من لوازمها. وثبوت العلم أوجب ثبوت الرؤية التي هي من روادفه وتكملاته ومشاركة له في خاصيته، وهي أنها لا توجب تغييراً في ذات المرئي، بل تتعلق به على ما هو عليه كالعلم. ولا يخفى عن عاقل أن هذا هو الاقتصاد في الاعتقاد. الدعوى العاشرة: ندعي أنه سبحانه واحد. فإن كونه واحداً يرجع إلى ثبوت ذاته ونفي غيره، فليس هو نظر في صفة زائدة على الذات، فوجب ذكره في هذا القطب. فنقول: الواحد قد يطلب ويراد به أنه لا يقبل القسمة، أي لا كمية له ولا جزء
ولا مقدار، والباري تعالى واحد بمعنى سلب الكمية المصححة للقسمة عنه؛ فإنه غير قابل للانقسام. إذ الانقسام لما له كمية، والتقسيم تصرف في كمية بالتفريق والتصغير، وما لا كمية له لا بتصور انقسامه. وقد يطلق ويراد أنه لا نظير له في رتبته كما تقول الشمس واحدة، والباري تعالى أيضاً بهذا المعنى واحد؛ فإنه لا ند له. فأما انه لا ضد له فظاهراً، إذ المفهوم من الضد هو الذي يتعاقب مع الشيء على محل واحد ولا تجامع وما لا محل له فلا ضد له، والباري سبحانه لا محل له فلا ضد له. وأما قولنا لا ند له، نعني به أن ما سواه هو خالقه لا غير، وبرهانه أنه لو قدر له شريك لكان مثله في كل الوجوه أو أرفع منه أو كان دونه. وكل ذلك محال. فالمفضي إليه محال، ووجه استحالة كونه مثله من كل وجه أن كل اثنين هما متغايران، فإن لم يكن تغاير لم تكن الإثنينية معقولة، فإنا لا نعقل سوادين إلا في محلين، أو في محل واحد في وقتين، فيكون أحدهما مفارقاً للآخر ومبايناً له ومغايراً إما في المحل وإما في الوقت، والشيئان تارة يتغايران بتغاير الحد والحقيقة، كتغاير الحركة واللون فإنهما وإن اجتمعا في محل واحد في وقت واحد فهما اثنان، إذ أحدهما مغاير للآخر بحقيقته، فإن استوى اثنان في الحقيقة والحد كالسوادين، فيكون الفرق بينهما إما في المحل أو في الزمان؛ فإن فرض سوادان مثلاً في جوهر واحد في حالة واحدة كان محالاً إذ لم تعرف الاثنينية. ولو جاز أن يقال هما اثنان ولا مغايرة، لجاز أن يشار إلى إنسان واحد ويقال أنه انسانان بل عشرة وكلها متساوية متماثلة في الصفة والمكان وجميع العوارض واللوازم، من غير فرقان، وذلك محال بالضرورة، فإن كان ند الله سبحانه متساوياً له في الحقيقة والصفات استحال وجوده، إذ ليس مغايره بالمكان إذ لا مكان ولا زمان فإنهما قديمان، فإذاً لا فرقان، وإذا ارتفع كل فرق ارتفع العدد بالضرورة، ولزمت الوحدة. ومحال أن يقال يخالفه بكونه أرفع منه. فإن الأرفع هو الإله والإله عبارة عن أجل الموجودات وأرفعها، والآخر المقدر ناقص ليس بالإله. ونحن إنما نمنع العدد في الإله، والإله هو الذي يقال فيه بالقول المطلق أنه أرفع الموجودات وأجلها. وإن كان أدنى منه كان محالاً، لأنه ناقص ونحن نعبر بالاله عن أجل الموجودات فلا يكون الأجل إلا واحداً، وهو الإله ولا يتصور اثنان متساويان في صفات الجلال، إذ يرتفع عند ذلك الافتراق ويبطل العدد كما سبق. فإن قيل: بم تنكرون على من لا ينازعكم في إيجاد من يطلق عليه اسم الإله، مهما كان الإله، عبارة عن أجل الموجودات، ولكنه يقول العالم كله بجملته ليس بمخلوق خالق واحد، بل هو مخلوق خالقين، أحدهما مثلاً خالق السماء والآخر خالق الأرض، أو أحدهما خالق الجمادات والآخر خالق الحيوانات وخالق النبات: فما
المحيل لهذا؟ فإن لم يكن على استحالة هذا دليل، فمن أين ينفعكم قولكم أن اسم الإله لا يطلق على هؤلاء؟ فإن هذا القائل يعبر بالإله عن الخالق، أو يقول أحدهما خالق الخير والآخر خالق الشر، أو أحدهما خالق الجواهر والآخر خالق الأعراض، فلا بد من دليل على استحالة ذلك. فنقول: يدل على استحالة ذلك أن هذه التوزيعات للمخلوقات على الخالقين في تقدير هذا السائل لا تعدو قسمين: إما أن تقتضي تقسيم الجواهر والأعراض جميعاً حتى خلق أحدهما بعض الأجسام والأعراض دون البعض، أو يقال كل الأجسام من واحد وكل الأعراض من واحد، وباطل أن يقال إن بعض الأجسام بخلقها واحد كالسماء مثلاً دون الأرض؛ فإنا نقول خالق السماء هل هو قادر على خلق الأرض أم لا، فإن كان قادراً كقدرته، لم يتميز أحدهما في القدرة عن الآخر، فلا يتميز في المقدور عن الآخر فيكون المقدور بين قادرين ولا تكون نسبته إلى أحدهما بأولى من الآخر، وترجع الاستحالة إلى ما ذكرناه من تقدير تزاحم متماثلين من غير فرق، وهو محال. وإن لم يكن قادراً عليه فهو محال لأن الجواهر متماثلة وأكوانها التي هي اختصاصات بالأحياز متماثلة، والقادر على الشيء قادر على مثله إذ كانت قدرته قديمة بحيث يجوز أن يتعلق بمقدورين وقدرة كل واحد منهما تتعلق بعدة من الأجسام والجواهر، فلم تتقيد بمقدور واحد. وإذا جاوز المقدور الواحد على خلاف القدرة الحادثة، لم يكن بعض الأعداد بأولى من بعض، بل يجب الحكم بنفي النهاية عن مقدوراته ويدخل كل جوهر ممكن وجوده في قدرته. والقاسم الثاني أن يقال: أحدهما يقدر على الجوهر والآخر على الأعراض وهما مختلفان، فلا تجب من القدرة على أحدهما القدرة على الآخر، وهذا محال، لأن العرض لا يستغني عن الجوهر، والجوهر لا يستغني عن العرض، فيكون فعل كل واحد منهما موقوفاً على الآخر، فكيف يخلقه وربما لا يساعده خالق الجوهر على خلق الجوهر عند إرادته لخلق العرض، فيبقى عاجزاً متحيراً والعاجز لا يكون قادراً. وكذلك خالق الجوهر إن أراد خلق الجوهر بما خالفه خالق العرض فيمتنع على الآخر خلق الجوهر فيؤدي ذلك إلى التمانع. فإن قيل: مهما أراد واحد منهما خلق جوهر ساعده الآخر على العرض وكذا بالعكس. قلنا: هذه المساعدة هل هي واجبة لا يتصور في العقل خلافها فإن أوجبتموها فهو تحكم، بل هو أيضاً مبطل للقدرة، فإن خلق الجوهر من واحد كأنه يضطر الآخر إلى خلق العرض، وكذا بالعكس؛ فلا تكون له قدرة على الترك ولا تتحقق القدرة مع
هذا. وعلى الجملة فترك المساعدة إن كان ممكناً فقد تعذر العقل وبطل معنى المقدرة والمساعدة إن كانت واجبة صار الذي لا بد له من مساعدة مضطراً لا قدرة له. فإن قيل. فيكون أحدهما خالق الشر والآخر خالق الخير، قلنا: هذا هوس، لأن الشر ليس شراً لذاته، بل هو من حيث ذاته مساو للخير ومماثل له، والقدرة على الشيء قدرة على مثله، فإن إحراق بدن المسلم بالنار شر، وإحراق بدن الكافر خير ودفع شر، والشخص الواحد إذا تكلم بكلمة الإسلام انقلب الإحراق في حقه شراً، فالقادر على إحراق لحمه بالنار عند سكوته عن كلمة الإيمان لا بد أن يقدر على إحراقه عند النطق بها، لأن نطقه بها صوت ينقضي لا يغير ذات اللحم، ولا ذات النار، ولا ذات الاحتراق، ولا يغلب جنساً فتكون الاحتراقات متماثلة، فيجب تعلق القدرة بالكل ويقتضي ذلك تمانعاً وتزاحماً. وعلى الجملة: كيفما فرض الأمر تولد منه اضطراب وفساد وهو الذي أراد الله سبحانه بقوله " لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا " فلا مزيد على بيان القرآن. ولنختم هذا القطب بالدعوى العاشرة فلم يبق مما يليق بهذا الفن إلا بيان استحالة كونه سبحانه محلاً للحوادث، وسنشير إليه في أثناء الكلام في الصفات رداً على من قال بحدوث العلم والإرادة وغيرهما.
القطب الثاني في الصفات وفيه سبعة دعاوى إذ ندعى أنه سبحانه قادر عالم حي مريد سميع بصير متكلم، فهذه سبعة صفات. ويتشعب عنها نظر في أمرين أحدهما ما به تخص آحاد الصفات، والثاني ما تشترك فيه جميع الصفات. فلنفتح البداية بالقسم الأول وهو اثآت أصل الصفات وشرح خصوص أحكامها. القسم الأول أصل الصفات الصفة الأولى القدرة ندعي أن محدث العالم قادر، لأن العالم فعل محكم مرتب متقن منظوم مشتمل على أنواع من العجائب والآيات، وذلك يدل على القدرة. ونرتب القياس فنقول: كل فعل محكم فهو صادر من فاعل قادر، والعالم فعل محكم فهو إذاً صادر من فاعل قادر، ففي أي الأصلين النزاع؟ فإن قيل فلم قلتم أن العالم فعل محكم، قلنا: عنينا بكونه محكماً ترتبه ونظامه وتناسبه، فمن نظر في أعضاء نفسه الظاهرة والباطنة ظهر له من عجائب الاتقان ما يطول حصره، فهذا أصل تدرك معرفته بالحس والمشاهدة فلا يسع جحده. فإن قيل: فبم عرفتم الأصل الآخر وهو أن كل فعل مرتب محكم ففاعله قادر؟ قلنا: هذا مدركه ضرورة العقل؛ فالعقل يصدق به بغير دليل ولا يقدر العاقل على جحده، ولكنا مع هذا نجرد دليلاً يقطع دابر الجحود والعناد، فنقول: نعني بكونه قادراً أن الفعل الصادر منه لا يخلو إما أن يصدر عنه لذاته أو لزائد عليه، وباطل أن يقال صدر عنه لذاته، إذ لو كان كذلك لكان قديماً مع الذات فدل أنه صدر لزائد على
ذاته، والصفة الزائدة التي بها تهيأ للفعل الموجود نسميها قدرةً، إذ القدرة في وضع اللسان عبارة عن الصفة التي يتهيأ الفعل للفاعل وبها يقع الفعل، فإن قيل ينقلب عليكم هذا في القدرة فإنها قديمة والفعل ليس بقديم، قلنا سيأتي جوابه في أحكام الإرادة فيما يقع الفعل به، وهذا الوصف مما دل عليه التقسيم القاطع الذي ذكرناه. ولسنا نعني بالقدرة إلا هذه الصفة، وقد أثبتناها فلنذكر أحكامها. ومن حكمها أنها متعلقة بجميع المقدورات، وأعني بالمقدورات الممكنات كلها التي لا نهاية لها. ولا يخفى أن الممكنات لا نهاية لها فلا نهاية إذاً للمقدورات، ونعني بقولنا لا نهاية للممكنات أن خلق الحوادث بعد الحوادث لا ينتهي إلى حد يستحيل في العقل حدوث حادث بعده، فالإمكان مستمر أبداً والقدرة واسعة لجميع ذلك، وبرهان هذه الدعوى وهي عموم تعلق القدرة أنه قد ظهر أن صانع كل العالم واحد، فإما أن يكون له بإزاء كل مقدور قدرة والمقدورات لا نهاية لها فتثبت قدرة متعددة لا نهاية لها وهو محال كما سبق في إبطال دورات لا نهاية لها، وإما أن تكون القدرة واحدة كما سبق في إبطال دورات لا نهاية لها، وإما أن تكون القدرة واحدة فيكون تعلقها مع اتحادها بما يتعلق به من الجواهر والأعراض مع اختلافها لأمر تشترك فيه ولا يشترك في أمر سوى الامكان، فيلزم منه أن كل ممكن فهو مقدور لا محالة وواقع بالقدرة. وبالجملة، إذا صدرت منه الجواهر والأعراض استحال أن لا يصدر منه أمثالها، فإن القدرة على الشيء قدرة على مثله إذ لم يمتنع التعدد في المقدور لنسبته إلى الحركات كلها والألوان كلها على وتيرة واحدة فتصلح لخلو حركة بعد حركة على الدوام، وكذا لون بعد لون وجوهر بعد جوهر وهكذا.. وهو الذي عنيناه بقولنا إن قدرته تعالى متعلقة بكل ممكن فإن الإمكان لا ينحصر في عدد. ومناسبة ذات القدرة لا تختص بعدد دون عدد ولا يمكن أن يشار إلى حركة فيقال أنها خارجة عن إمكان تعلق القدرة بها، مع أنها تعلقت بمثلها إذ بالضرورة تعلم أن ما وجب للشيء وجب لمثله ويتشعب عن هذا ثلاثة فروع. الفرع الأول: إن قال قائل هل تقولون أن خلاف المعلوم مقدور؟ قلنا: هذا مما اختلف فيه، ولا يتصور الخلاف فيه إذا حقق وأزيل تعقيد الألفاظ وبيانه أنه قد ثبت أن كل ممكن مقدور وأن المحال ليس بمقدور. فانظر أن خلاف المعلوم محال أو ممكن ولا تعرف ذلك إلا إذا عرفت معنى المحال والممكن وحصلت حقيقتهما وإلا فإن تساهلت في النظر، ربما صدق على خلاف المعلوم أنه محال وأنه ممكن وأنه ليس بمحال، فإذاً صدق أنه محال وأنه ليس بمحال والنقيضان لا يصدفان معاً.
فاعلم أن تحت اللفظ اجمالاً وإنما ينكشف لك ذلك بما أقوله وهو أن العالم مثلاً يصدق عليه أنه واجب وأنه محال وأنه ممكن. أما كونه واجباً فمن حيث أنه إذا فرضت إرادة القديم موجودة وجوداً واجباً كان المراد أيضاً واجباً بالضرورة لا جائزاً، إذ يستحيل عدم المراد مع تحقق الإرادة القديمة وأما كونه محالاً فهو أنه لو قدر عدم تعلق الارادة بايجاده فيكون لا محالة حدوثه محالاً إذ يؤدي إلى حدوث حادث بلا سبب وقد عرف أنه محال. وأما كونه ممكناً فهو أن تنظر إلى ذاته فقط، ولا تعتبر معه لا وجود الإرادة ولا عدمها، فيكون له وصف الإمكان، فإذاً الاعتبارات ثلاثة: الأول أن يشترط فيه وجود الإرادة وتعلقها فهو بهذا الاعتبار واجب. الثاني أن يعتبر فقد الإرادة فهو بهذا الاعتبار محال. الثالث أن نقطع الالتفات عن الإرادة والسبب فلا نعتبر وجوده ولا عدمه ونجرد النظر إلى ذات العالم فيبقى له بهذا الاعتبار الأمر الثالث وهو الإمكان. ونعني به أنه ممكن لذاته، أي إذا لم نشترط غير ذاته كان ممكناً فظهر منه أنه يجوز أن يكون الشيء الواحد ممكناً محالاً، ولكن ممكناً باعتبار ذاته محالاً باعتبار غيره، ولا يجوز أن يكون ممكناً لذاته محالاً لذاته، فهما متناقضان فنرجع إلى خلاف المعلوم فنقول: إذا سبق في علم الله تعالى إماتة زيد صبيحة يوم السبت مثلاً فنقول: خلق الحياة لزيد صبيحة يوم السبت ممكن أم ليس بممكن؟ فالحق فيه أنه ممكن ومحال؛ أي هو ممكن باعتبار ذاته إن قطع الالتفات إلى غيره، ومحال لغيره لا لذاته وذلك إذا اعتبر معه الالتفات إلى تعلق ذاتها وهو ذات العلم، إذ ينقلب جهلاً، ومحال أن ينقلب جهلاً فبان أنه ممكن لذاته محال للزوم استحالة في غيره. فإذا قلنا حياة زيد في هذا الوقت مقدورة، لم نرد به إلا أن الحياة من حيث أنها حياة ليس بمحال، كالجمع بين السواد والبياض. وقدرة الله تعالى من حيث أنها قدرة لا تنبو عن التعلق بخلق الحياة ولا تتقاصر عنه لفتور ولا ضعف ولا سبب في ذات القدرة، وهذان أمران يستحيل إنكارهما، أعني نفي القصور عن ذات القدرة وثبوت الإمكان لذات الحياة من حيث أنها حياة فقط من غير التفات إلى غيرها، والخصم إذا قال غير مقدور على معنى أن وجوده يؤدي إلى استحالة فهو صادق في هذا المعنى، فإنا لسنا ننكره ويبقى النظر في اللفظ هل هو صواب من حيث اللغة إطلاق هذا الاسم عليه أو سلبه، ولا يخفى أن الصواب إطلاق اللفظ فإن الناس يقولون فلان قادر على الحركة والسكون، إن شاء تحرك وإن شاء سكن، ويقولون إن له في كل وقت قدرة على الضدين ويعلمون أن الجاري في علم الله تعالى وقوع أحدهما، فالاطلاقات
شاهدة لما ذكرناه وحظ المعنى فيه ضروري لا سبيل إلى جحده. الفرع الثاني: إن قال قائل إذا ادعيتم عموم القدرة في تعلقها بالممكنات، فما قولكم في مقدورات الحيوان وسائر الأحياء من المخلوقات، أهي مقدورة لله تعالى أم لا؟ فإن قلتم ليست مقدورة، فقد نقضتم قولكم إن تعلق القدرة عام، وإن قلتم إنها مقدورة له لزمكم إثبات مقدور بين قادرين وهو محال، وإنكار كون الإنسان وسائر الحيوان قادراً فهو مناكرة للضرورة ومجاحدة لمطالبات الشريعة، إذ تستحيل المطالبة بما لا قدرة عليه ويستحيل أن يقول الله لعبده ينبغي أن تتعاطى ما هو مقدور لي وأنا مستأثر بالقدرة عليه ولا قدرة لك عليه. فنقول: في الانفصال قد تحزب الناس في هذا أحزاباً؛ فذهبت المجبرة إلى انكار قدرة العبد فلزمها إنكار ضرورة التفرقة بين حركة الرعدة والحركة الاختيارية، ولزمها أيضاً استحالة تكاليف الشرع، وذهبت المعتزلة إلى انكار تعلق قدرة الله تعالى بأفعال العباد من الحيوانات والملائكة والجن والإنس والشياطين وزعمت أن جميع ما يصدر منها من خلق العباد واختراعهم لا قدرة لله تعالى عليها بنفي ولا إيجاب فلزمتها شناعتان عظيمتان: إحداهما انكار ما أطبق عليه السلف رضي الله عنهم من أنه لا خالق إلا الله ولا مخترع سواه، والثانية نسبة الاختراع والخلق إلى قدرة من لا يعلم ما خلقه من الحركات، فإن الحركات التي تصدر من الإنسان وسائر الحيوان لو سئل عن عددها وتفاصيلها ومقاديرها لم يكن عنده خبر منها، بل الصبي كما ينفصل من المهد يدب إلى الثدي باختياره ويمتص، والهرة كما ولدت تدب إلى ثدي أمها وهي مغمضة عينها، والعنكبوت تنسج من البيوت أشكالاً غريبة يتحير المهندس في استدارتها وتوازي أضلاعها وتناسب ترتيبها وبالضرورة تعلم انفكاكها عن العلم بما تعجز المهندسون عن معرفته، والنحل تشكل بيوتها على شكل التسديس فلا يكون فهيا مربع ولا مدور ولا مسبع ولا شكل آخر وذلك لتميز شكل المسدس بخاصية دلت عليها البراهين الهندسية لا توجد في غيرها، وهو مبني على اصول أحدها، أن أحوى الأشكال وأوسعها الشكل المستدير المنفك عن الزوايا الخارجة عن الاستقامة، والثاني، أن الأشكال المستديرة إذا وضعت متراصة بقيت بينها فرج معطلة لا محالة، والثالث، أن أقرب الأشكال القليلة الأضلاع إلى المستديرة في الاحتواء هو شكل المسدس،
والرابع أن كل الأشكال القريبة من المستديرة كالمسبع والمثمن والمخمس إذا وضعت جملة متراصة متجاورة بقيت بينها فرج معطلة ولم تكن متلاصقة، وأما المربعة فإنها متلاصقة ولكنها بعيدة عن احتواء الدوائر لتباعد زواياها عن أوساطها، ولما كان النحل محتاجاً إلى شكل قريب من الدوائر ليكون حاوياً لشخصه فإنه قريب من الاستدارة، وكان محتاجاً لضيق مكانه وكثرة عدده إلى أن لا يضيع موضعاً بفرج تتخلل بين البيوت ولا تتسع لأشخاصها ولم يكن في الأشكال مع خروجها عن النهاية شكل يقرب من الاستدارة وله هذه الخاصية وهو التراص والخلو عن بقاء الفرج بين أعدادها إلا المسدس، فسخرها الله تعالى لاختيار الشكل المسدس في صناعة بيتها؛ فليت شعري أعرف النحل هذه الدقائق التي يقصر عن دركها أكثر عقلاء الإنس أم سخره لنيل ما هو مضطر إليه الخالق المنفرد بالجبروت وهو في الوسط مجري فتقدير الله تعالى يجري عليه وفيه، وهو لا يدريه ولا قدرة له على الامتناع عنه، وإن في صناعات الحيوانات من هذا الجنس عجائب لو أوردت منها طرفاً لامتلأت الصدور من عظمة الله تعالى وجلاله، فتعساً للزائغين عن سبيل الله المغترين بقدرتهم القاصرة ومكنتهم الضعيفة الظانين أنهم مساهمون الله تعالى في الخلق والاختراع وإبداع مثل هذه العجائب والآيات. هيهات هيهات! ذلت المخلوقات وتفرد بالملك والملكوت جبار الأرض والسموات فهذه أنواع الشناعات اللازمة على مذهب المعتزلة فانظر الآن إلى أهل السنة كيف وفقوا للسداد ورشحوا للاقتصاد في الاعتقاد. فقالوا: القول بالجبر محال باطل، والقول بالاختراع اقتحام هائل، وإنما الحق إثبات القدرتين على فعل واحد. والقول بمقدور منسوب إلى قادرين فلا يبقى إلا استبعاد توارد القدرتين على فعل واحد وهذا إنما يبعد إذا كان تعلق القدرتين على وجه واحد، فإن اختلفت القدرتان واختلف وجه تعلقهما فتوارد التعلقين على شيء واحد غير محال كما سنبينه. فإن قيل فما الذي حملكم على اثبات مقدور بين قادرين؟ قلنا: البرهان القاطع على أن الحركة الاختيارية مفارقة للرعدة، وإن فرضت الرعدة مراد للمرتعد ومطلوبة له أيضاً ولا مفارقة إلا بالقدرة، ثم البرهان القاطع على أن كل ممكن تتعلق به قدرة الله تعالى وكل حادث ممكن وفعل العبد حادث فهو إذاً ممكن فإن لم تتعلق به قدرة الله تعالى فهو محال، فإنا نقول: الحركة الاختيارية من حيث أنها حركة حادثة ممكنة مماثلة لحركة الرعدة فيستحيل أن تتعلق قدرة الله تعالى بإحداهما وتقصر عن الأخرى وهي مثلها، بل يلزم عليه محال آخر وهو أن الله
تعالى لو أراد تسكين يد العبد إذا أراد العبد تحريكها فلا يخلو إما أن توجد الحركة والسكون جميعاً أو كلاهما لا يوجد فيؤدي إلى اجتماع الحركة والسكون أو إلى الخلو عنهما، والخلو عنهما مع التناقض يوجب بطلان القدرتين، إذ القدرة ما يحصل بها المقدور عند تحقق الإرادة وقبول المحل، فإن ظن الخصم أن مقدور الله تعالى يترجح لأن قدرته أقوى فهو محال، لأن تعلق القدرة بحركة واحدة لا تفضل تعلق القدرة الأخرى بها، إذ كانت فائدة القدرتين الاختراع وإنما قوته باقتداره على غيره واقتداره على غيره غير مرجح في الحركة التي فيها الكلام، إذ حظ الحركة من كل واحدة من القدرتين أن تصير مخترعة بها والاختراع يتساوى فليس فيه أشد ولا أضعف حتى يكون فيه ترجيح، فإذاً الدليل القاطع على إثبات القدرتين ساقنا إلى إثبات مقدور بين قادرين. فإن قيل: الدليل لا يسوق إلى محال لا يفهم وما ذكرتموه غير مفهوم. قلنا: علينا تفهيمه وهو أنا نقول اختراع الله سبحانه للحركة في العبد معقول دون أن تكون الحركة مقدورة للعبد، فمهما خلق الحركة وخلق معها قدرة عليها كان هو المستبد بالاختراع للقدرة والمقدور جميعاً، فخرج منه أنه منفرد بالاختراع وأن الحركة موجودة وأن المتحرك عليها قادر وبسبب كونه قادراً فارق حاله حال المرتعد فاندفعت الإشكالات كلها. وحاصله أن القادر الواسع القدرة هو قادر على الاختراع للقدرة والمقدور معاً، ولما كان اسم الخالق والمخترع مطلقاً على من أوجد الشيء بقدرته وكانت القدرة والمقدور جميعاً بقدرة الله تعالى، سمي خالقاً ومخترعاً. ولم يكن المقدور مخترعاً بقدرة العبد وإن كان معه فلم يسم خالقاً ولا مخترعاً ووجب أن يطلب لهذا النمط من النسبة اسم آخر مخالف فطلب له اسم الكسب تيمناً بكتاب الله
تعالى، فإنه وجد إطلاق ذلك على أعمال العباد في القرآن وأما اسم الفعل فتردد في إطلاقه ولا مشاحة في الأسامي بعد فهم المعاني. فإن قيل: الشأن في فهم المعنى وما ذكرتموه غير مفهوم، فإن القدرة المخلوقة الحادثة إن لم يكن لها تعلق بالمقدور لم تفهم؛ إذ قدرة لا مقدور لها محال، كعلم لا معلوم له. وإن تعلقت به فلا يعقل تعلق القدرة بالمقدور إلا من حيث التأثير والايجاد وحصول المقدور به. فالنسبة بين المقدور والقدرة نسبة المسبب إلى السبب وهو كونه به، فإذا لم يكن به لم تكن علاقة فلم تكن قدرة، إذ كل ما لا تعلق له فليس بقدرة إذ القدرة من الصفات المتعلقة. قلنا: هي متعلقة، وقولكم أن التعلق مقصور على الوقوع به يبطل بتعلق الارادة والعلم، وإن قلتم أن تعلق القدرة مقصور على الوقوع بها فقط فهو أيضاً باطل، فإن القدرة عندكم تبقى إذا فرضت قبل الفعل، فهل هي متعلقة أم لا؟ فإن قلتم لا فهو محال، وإن قلتم نعم فليس المعني بها وقوع المقدور بها، إذ المقدور بعد لم يقع فلا بد من إثبات نوع آخر من التعلق سوى الموقوع بها، إذ التعلق عند الحدوث يعبر عنه بالوقوع به والتعلق قبل ذلك مخالف له فهو نوع آخر من التعلق، فقولكم إن تعلق القدرة به نمط واحد خطأ وكذلك القادرية القديمة عندهم فإنها متعلقة بالعلم في الأزل وقبل خلق العالم، فقولنا أنها متعلقة صادق وقولنا أن العالم واقع بها كاذب، لأنه لم يقع بعد فلو كانا عبارتين عن معنى واحد لصدق أحدهما حيث يصدق الآخر. فإن قيل: معنى تعلق القدرة قبل وقوع المقدور أن المقدور إذا وقع بها. قلنا: فليس هذا تعلقاً في الحال بل هو انتظار تعلق، فينبغي أن يقال القدرة موجودة وهي صفة لا تعلق لها ولكن ينتظر لها تعلق إذا وقع وقع المقدور بها، وكذا القادرية ويلزم عليه محال، وهو أن الصفة التي لم تكن من المتعلقات صارت من المتعلقات وهو محال. فإن قيل: معناه أنها متهيئة لوقوع المقدور بها. قلنا: ولا معنى للتهيؤ إلا انتظار الوقوع بها، وذلك لا يوجب تعلقاً في الحال. فكما عقل عندكم قدرة موجودة متعلقة بالمقدور والمقدور غير واقع بها عقل عندنا أيضاً قدرة كذلك والمقدور غير واقع بها ولكنه واقع بقدرة الله تعالى، فلم يخالف مذهبنا ههنا مذهبكم إلا في قولنا أنها وقعت بقدرة الله تعالى، فإذا لم يكن من ضرورة وجود القدرة ولا تعلقها بالمقدور وجود المقدور بها؛ فمن أين يستدعي عدم وقوعها بقدرة الله تعالى ووجوده بقدرة الله تعالى لا فضل له على عدمه من حيث انقطاع النسبة عن القدرة الحادثة إذ النسبة، إذا لم تمتنع بعدم المقدور، فكيف تمتنع
بوجود المقدور؟ وكيف ما فرض المقدور موجوداً أو معدوماً فلا بد من قدرة متعلقة لا مقدور لها في الحال. فإن قيل: فقدرة لا يقع بها مقدور، والعجز، بمثابة واحدة، قلنا: إن عنيتم به أن الحالة التي يدركها الإنسان عند وجودها مثل ما يدركها عند العجز في الرعدة فهو مناكرة للضرورة وإن عنيتم أنها بمثابة العجز في أن المقدور لم يقع بها فهو صدق ولكن تسميته عجزاً خطأ وإن كان من حيث القصور إذا نسبت إلى قدرة الله تعالى ظن أنه مثل العجز، وهذا كما أنه لو قيل القدرة قبل الفعل، على أصلهم، مساوية للعجز من حيث أن المقدور غير واقع بها لكان اللفظ منكراً من حيث أنها حالة مدركة يفارق إدراكها في النفس إدراك العجز، فكذلك هذا، ولا فرق وعلى الجملة فلا بد من إثبات قدرتين متفاوتتين، إحداهما أعلى والأخرى بالعجز أشبه مهما أضيفت إلى الأعلى، وأنت بالخيار بين أن تثبت للعبد قدرة توهم نسبة العجز للعبد من وجه، وبين أن تثبت لله سبحانه ذلك تعالى الله عما يقول الزائغون. ولا تستريب إن كنت منصفاً في أن نسبة القصور والعجز بالمخلوقات أولى بل لا يقال أولى لاستحالة ذلك في حق الله تعالى فهذا غاية ما يحتمله هذا المختصر من هذه المسألة. الفرع الثالث: فإن قال قائل: كيف تدعون عموم تعلق القدرة بجملة الحوادث وأكثر ما في العالم من الحركات وغيرها متولدات يتولد بعضها من بعض
بالضرورة، فإن حركة اليد مثلاً بالضرورة تولد حركة الخاتم، وحركة اليد في الماء تولد حركة الماء، وهو مشاهد، والعقل أيضاً يدل عليه إذ لو كانت حركة الماء والخاتم بخلق الله تعالى لجاز أن يخلق حركة اليد دون الخاتم وحركة اليد دون الماء، وهو محال، وكذا في المتولدات مع انشعابها. فنقول: ما لا يفهم لا يمكن التصرف فيه بالرد والقبول، فإن كون المذهب مردوداً أو مقبولاً بعد كونه معقولاً. والمعلوم عندنا من عبارة التولد أن يخرج جسم من جوف جسم كما يخرج الجنين من بطن الأم والنبات من بطن الأرض، وهذا محال في الأعراض؛ إذ ليس لحركة اليد جوف حتى تخرج منه حركة الخاتم ولا هو شيء حاو لأشياء حتى يرشح منه بعض ما فيه، فحركة الخاتم إذا لم تكن كامنة في ذات حركة اليد فما معنى تولدها منها؟ فلا بد من تفهيمه، وإذا لم يكن هذا مفهوماً فقولكم إنه مشاهد حماقة، إذ كونها حادثة معها مشاهد لا غير، فأما كونها متولد منها فغير مشاهد، وقولكم إنه لو كان بخلق الله تعالى لقدر على أن يخلق حركة اليد دون الخاتم وحركة اليد دون الماء فهذا هوس يضاهي قول القائل لو لم يكن العلم متولداً من الإرادة لقدر على أن يخلق الارادة دون العلم أو العلم دون الحياة، ولكن نقول: المحال غير مقدور ووجود المشروط دون الشرط غير معقول، والارادة شرطها العلم والعلم شرطه الحياة وكذلك شرط شغل الجوهر لحيز فراغ ذلك الحيز، فإذا حرك الله تعالى اليد فلا بد أن يشغل بها حيزاً في جوار الحيز الذي كانت فيه، فما لم يفرغه كيف يشغله به؟ ففراغه شرط اشتغاله باليد، إذ لو تحرك ولم يفرغ الحيز من الماء بعدم الماء أو حركته لاجتمع جسمان في حيز واحد وهو محال، فكان خلو أحدهما شرطاً للآخر فتلازما فظن أن أحدهما متولد من الآخر وهو خطأ فأما اللازمات التي ليست شرطاً فعندنا يجوز أن تنفك عن الاقتران بما هو لازم لها، بل لزومه بحكم طرد العادة كاحتراق القطن عند مجاورة النار وحصول البرودة في اليد عند مماسة الثلج، فإن كل ذلك مستمر بجريان سنة الله تعالى، وإلا فالقدرة من حيث ذاتها غير قاصرة عن خلق البرودة في الثلج والمماسة في اليد مع خلق الحرارة في اليد بدلاً عن البرودة. فإذاً ما يراه الخصم متولداً قسمان: أحدهما شرط فلا يتصور فيه إلا الاقتران، والثاني ليس بشرط فيتصور فيه غير الاقتران إذ خرقت العادات. فإن قال قائل لم تدلوا على بطلان التولد ولكن أنكرتم فهمه وهو مفهوم، فإنا لا نريد به ترشح الحركة من الحركة بخروجها من جوفها ولا تولد برودة من برودة الثلج بخروج البرودة من الثلج وانتقالها أو بخروجها من ذات البرودة، بل نعني به
وجود موجود عقيب موجود وكونه موجوداً وحادثاً به فالحادث نسميه متولداً والذي به الحدوث نسميه مولداً وهذه التسمية مفهومة فما الذي يدل على بطلانه؟ قلنا: إذا أقررتم بذلك دل على بطلانه ما دل على بطلان كون القدرة الحادثة موجودة فإنا إذا أحلنا أن نقول حصل مقدور بقدرة حادثة فكيف لا يخيل الحصول بما ليس بقدرة واستحالته راجعة إلى عموم تعلق القدرة، وإن خروجه عن القدرة مبطل لعموم تعلقها وهو محال ثم هو موجب للعجز والتمانع كما سبق. نعم، وعلى المعتزلة القائلين بالتولد مناقضات في تفصيل التولد لا تحصى، كقولهم إن النظر يولد العلم، وتذكره لا يولده إلى غير ذلك مما لا نطول بذكره، فلا معنى للإطناب فيما هو مستغنى عنه، وقد عرفت من جملة هذا أن الحادثات كلها، جواهرها وأعراضها الحادثة منها في ذات الأحياء والجمادات، واقعة بقدرة الله تعالى، وهو المستبد باختراعها، وليس تقع بعض المخلوقات ببعض بل الكل يقع بالقدرة وذلك ما أردنا أن نبين من إثبات صفة القدرة لله تعالى وعموم حكمها وما اتصل بها من الفروع واللوازم. الصفة الثانية العلم ندعي أن الله تعالى عالم بجميع المعلومات الموجودات والمعدومات؛ فإن الموجودات منقسمة إلى قديم وحادث، والقديم ذاته وصفاته ومن علم غيره فهو بذاته وصفاته أعلم، فيجب ضرورة أن يكون بذاته عالماً وصفاته إن ثبت أنه عالم بغيره. ومعلوم أنه عالم بغيره لأن ما ينطلق عليه اسم الغير فهو صنعه المتقن وفعله المحكم المرتب وذلك يدل على قدرته على ما سبق؛ فإن من رأى خطوطاً منظومة تصدر على الاتساق من كاتب ثم استراب في كونه عالماً بصنعة الكتابة كان سفيهاً في استرابته، فإذاً قد ثبت أنه عالم بذاته وبغيره. فإن قيل فهل لمعلوماته نهاية؟ قلنا: لا؛ فإن الموجودات في الحال وإن كانت متناهية فالممكنات في الاستقبال غير متناهية، ونعلم أن الممكنات التي ليست بموجودة أنه سيوجدها أولا يوجدها، فيعلم إذاً ما لا نهاية له بل لو أردنا أن نكثر على شيء واحد وجوهاً من النسب والتقديرات لخرج عن النهاية والله تعالى عالم بجميعها. فإنا نقول مثلاً ضعف الاثنين أربعة، وضعف الأربعة ثمانية، وضعف الثمانية ستة عشر، وهكذا نضعف ضعف الإثنين وضعف ضعف الضعف ولا يتناهى، والإنسان لا يعلم من مراتبها إلا ما يقدره بذهنه، وسينقطع عمره ويبقى من التضعيفات
ما لا يتناهى. فإذاً معرفة أضعاف أضعاف الإثنين، وهو عدد واحد، يخرج عن الحصر وكذلك كل عدد، فكيف غير ذلك من النسب والتقديرات، وهذا العلم مع تعلقه بمعلومات لا نهاية لها واحد كما سيأتي بيانه من بعد مع سائر الصفات. الصفة الثالثة الحياة ندعي أنه تعالى حي وهو معلوم بالضرورة، ولم ينكره أحد ممن اعترف بكونه تعالى عالماً قادراً. فإن كون العالم القادر حياً ضروري إذ لا يعني بالحي إلا ما يشعر بنفسه ويعلم ذاته وغيره، والعالم بجميع المعلومات والقادر على جميع المقدورات كيف لا يكون حياً، وهذا واضح والنظر في صفة الحياة لا يطول. الصفة الرابعة الإرادة ندعي أن الله تعالى مريد لأفعاله وبرهانه أن الفعل الصادر منه مختص بضروب من الجواز لا يتميز بعضها من البعض إلا بمرجح، ولا تكفي ذاته للترجيح، لأن نسبة الذات إلى الضدين واحدة فما الذي خصص أحد الضدين بالوقوع في حال دون حال؟ وكذلك القدرة لا تكفي فيه، إذ نسبة القدرة إلى الضدين واحدة، وكذلك العلم لا يكفي خلافاً للكعبي حيث اكتفى بالعلم عن الإرادة لأن العلم يتبع المعلوم ويتعلق به على ما هو عليه ولا يؤثر فيه ولا يغيره. فإن كان الشيء ممكناً في نفسه مساوياً للممكن الآخر الذي في مقابلته فالعلم يتعلق به على ما هو عليه ولا يجعل أحد الممكنين مرجحاً على الآخر، بل نعقل الممكنين ويعقل تساويهما، والله سبحانه وتعالى يعلم أن وجود العالم في الوقت الذي وجد فيه كان ممكناً، وأن وجوده بعد ذلك وقبل ذلك كان مساوياً له في الإمكان لأن هذه الامكانات متساوية، فحق العلم أن يتعلق بها كما هو عليه فإن اقتضت صفة الإرادة
وقوعه في وقت معين تعلق العلم بتعيين وجوده في ذلك الوقت لعلة تعلق الارادة به فتكون الإرادة للتعيين علة ويكون العلم متعلقاً به تابعاً له غير مؤثر فيه، ولو جاز أن يكتفى بالعلم عن الارادة لاكتفي به عن القدرة، بل كان ذلك يكفي في وجود أفعالنا حتى لا نحتاج إلى الإرادة، إذ يترجح أحد الجانبين بتعلق علم الله تعالى به وكل ذلك محال. فإن قيل: وهذا ينقلب عليكم في نفس الارادة، فإن القدرة كما لا تناسب أحد الضدين فالارادة القديمة أيضاً لا تتعين لأحد الضدين، فاختصاصها بأحد الضدين ينبغي أن يكون بمخصص ويتسلسل ذلك إلى غير نهاية، إذ يقال الذات لا تكفي للحدوث، إذ لو حدث من الذات لكان مع الذات غير متأخر فلا بد من القدرة والقدرة لا تكفي إذ لو كان للقدرة لما اختص بهذا الوقت وما قبله وما بعده في النسبة إلى جواز تعلق القدرة بها على وتيرة، فما الذي خصص هذا الوقت فيحتاج إلى الارادة؟ فيقال: والارادة لا تكفي، فإن الإرادة القديمة عامة التعلق كالقدرة، فنسبتها إلى الأوقات واحدة ونسبتها إلى الضدين واحدة، فإن وقع الحركة مثلاً بدلاً عن السكون لأن الارادة تعلقت بالحركة لا بالسكون. فيقال: وهل كان يمكن أن يتعلق بالسكون؟ فإن قيل: لا، فهو محال؛ وإن قيل: نعم، فهما متساويان؛ أعني الحركة والسكون في مناسبة الإرادة القديمة فما الذي أوجب تخصيص الإرادة القديمة بالحركة دون السكون فيحتاج إلى مخصص ثم يلزم السؤال في مخصص المخصص ويتسلسل إلى غير نهاية.. قلنا: هذا سؤال غير معقول حير عقول الفرق ولم يوفق للحق إلا أهل السنة فالناس فيه أربع فرق:
قائل يقول إن العالم وجد لذات الله سبحانه وتعالى وإنه ليس للذات صفة زائدة البتة، ولما كان الذات قديمة كان العالم قديماً وكانت نسبة العالم إليه كنسبة المعلول إلى العلة، ونسبة النور إلى الشمس، والظل إلى الشخص؛ وهؤلاء هم الفلاسفة. وقائل يقول إن العالم حادث ولكن حدث في الوقت الذي حدث فيه لا قبله ولا بعده لإرادة حادثة حدثت له لا في محل فاقتضت حدوث العالم، وهؤلاء هم المعتزلة. وقائل يقول حدث بإرادة حادثة حدثت في ذاته، وهؤلاء هم القائلون بكونه محلاً للحوادث. وقائل يقول حدث العالم في الوقت الذي تعلقت الارادة القديمة بحدوثه في ذلك الوقت، من غير حدوث إرادة ومن غير تغير صفة القديم، فانظر إلى الفرق وانسب مقام كل واحد إلى الآخر، فإنه لا ينفك فريق عن إشكال لا يمكن حله إلا إشكال أهل السنة فإنه سريع الانحلال. أما الفلاسفة فقد قالوا بقدم العالم، وهو محال، لأن الفعل يستحيل أن يكون قديماً؛ إذ معنى كونه فعلاً أنه لم يكن ثم كان، فإن كان موجوداً مع الله أبداً فكيف يكون فعلاً؟ بل يلزم من ذلك دورات لا نهاية لها على ما سبق، وهو محال من وجوه، ثم إنهم مع اقتحام هذا الإشكال لم يتخلصوا من أصل السؤال وهو أن الإرادة لم تعلقت بالحدوث في وقت مخصوص لا قبله ولا بعده، مع تساوي نسب الأوقات إلى الإرادة، فإنهم إن تخلصوا عن خصوص الوقت لم يتخلصوا عن خصوص الصفات، إذ العالم مخصوص بمقدار مخصوص ووضع مخصوص، وكانت نقايضها ممكنة في العقل، والذات القديمة لا تناسب بعض الممكنات دون بعض، ومن أعظم ما يلزمهم فيه، ولا عذر لهم عنه أمران أوردناهما في كتاب تهافت الفلاسفة ولا محيص لهم عنهما البتة: أحدهما، أن حركات الأفلاك بعضها مشرقية أي من المشرق إلى المغرب، وبعضها مغربية أي من مغرب الشمس إلى المشرق، وكان عكس ذلك في الإمكان مساوياً له، إذ الجهات في الحركات متساوية، فكيف لزم من الذات القديمة أو من دورات الأفلاك وهي قديمة عندهم أن تتعين جهة عن جهة تقابلها وتساويها من كل وجه؟ وهذا لا جواب عنه. الثاني، أن الفلك الأقصى الذي هو الفلك التاسع عندهم المحرك لجميع السماوات بطريق القهر في اليوم والليلة مرة واحدة يتحرك على قطبين شمالي وجنوبي، والقطب عبارة عن النقطتين المتقابلتين على الكرة الثابتتين عند حركة الكرة
على نفسها، والمنطقة عبارة عن دائرة عظيمة على وسط الكرة بعدها من النقطتين واحد. فنقول: جرم الفلك الأقصى متشابه، وما من نقطة إلا ويتصور أن تكون قطباً. فما الذي أوجب تعيين نقطتين من بين سائر النقط التي لا نهاية لها عندهم، فلا بد من وصف زائد على الذات من شأنه تخصيص الشيء عن مثله وليس ذلك إلا الإرادة. وقد استوفينا تحقيق الالتزامين في كتاب التهافت. وأما المعتزلة فقد اقتحموا أمرين شنيعين باطلين: أحدهما، كون الباري تعالى مريداً بإرادة حادثة لا في محل، وإذا لم تكن الإرادة قائمة به فقول القائل إنه مريدها هجر من الكلام، كقوله إنه مريد بإرادة قائمة بغيره. والثاني، أن الإرادة لم حدثت في هذا الوقت على الخصوص، فإن كانت بإرادة أخرى فالسؤال في الإرادة الأخرى لازم، ويتسلسل إلى غير نهاية، وإن كان ليس بإرادة فليحدث العالم في هذا الوقت على الخصوص لا بارادة، فإن افتقار الحادث إلى الارادة لجوازه لا لكونه جسماً أو اسماً أو إرادة أو علماً. والحادثات في هذا متساوية، ثم لم يتخلصوا من الإشكال إذ يقال لهم لم حدثت الإرادة في هذا الوقت على الخصوص ولم حدثت إرادة الحركة دون إرادة السكون، فإن عندهم يحدث لكل حادث إرادة حادثة متعلقة بذلك الحادث فلم لم تحدث إرادة تتعلق بضده؟ وأما الذين ذهبوا إلى حدوث الإرادة في ذاته تعالى لا متعلقة بذلك الحادث فقد دفعوا أحد الإشكالين وهو كونه مريداً بإرادة في غير ذاته ولكن زادوا إشكالاً آخر وهو كونه محلاً للحوادث، وذلك يوجب حدوثه. ثم قد بقيت عليهم بقية الإشكال ولم يتخلصوا من السؤال. وأما أهل الحق فإنهم قالوا إن الحادثات تحدث بإرادة قديمة تعلقت بها فميزتها عن أضدادها المماثلة لها، وقول القائل إنه لم تعلقت بها وأضدادها مثلها في الامكان، هذا سؤال خطأ فإن الإرادة ليست إلا عبارة عن صفة شأنها تمييز الشيء على مثله. فقول القائل لم ميزت الإرادة الشيء عن مثله، كقول القائل لم أوجب العلم انكشاف المعلوم، فيقال: لا معنى للعلم إلا ما أوجب انكشاف المعلوم، فقول القائل لم أوجب الانكشاف كقوله لم كان العلم علماً، ولم كان الممكن ممكناً، والواجب واجباً، وهذا محال؛ لأن العلم علم لذاته وكذا الممكن والواجب وسائر الذوات، فكذلك الإرادة وحقيقتها تمييز الشيء عن مثله.
فقول القائل لم ميزت الشيء عن مثله كقوله لم كانت الإرادة إرادة والقدرة قدرة، وهو محال، وكل فريق مضطر إلى اثبات صفة شأنها تمييز الشيء عن مثله وليس ذلك إلا الإرادة، فكان أقوم الفرق قيلاً وأهداهم سبيلاً من أثبت هذه الصفة ولم يجعلها حادثة، بل قال هي قديمة متعلقة بالأحداث في وقت مخصوص، فكان الحدوث في ذلك الوقت لذلك، وهذا ما لا يستغني عنه فريق من الفرق وبه ينقطع التسلسل في لزوم هذا السؤال. والآن فكما تمهد القول في أصل الإرادة فاعلم انها متعلقة بجميع الحادثات عندنا من حيث أنه ظهر أن كل حادث فمخترع بقدرته، وكل مخترع بالقدرة محتاج إلى ارادة تصرف القدرة إلى المقدور وتخصصها به، فكل مقدور مراد، وكل حادث مقدور، فكل حادث مراد والشر والكفر والمعصية حوادث، فهي إذاً لا محالة مرادة. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فهذا مذهب السلف الصالحين ومعتقد أهل السنة أجمعين وقد قامت عليه البراهين. وأما المعتزلة فإنهم يقولون إن المعاصي كلها والشرور حادثة بغير إرادته، بل هو كاره لها. ومعلوم أن أكثر ما يجري في العالم المعاصي فإذاً ما يكرهه أكثر مما يريده فهو إلى العجز والقصور أقرب بزعمهم، تعالى رب العالمين عن قول الظالمين. فإن قيل: فكيف يأمر بما لا يريد؟ وكيف يريد شيئاً وينهى عنه؟ وكيف يريد الفجور والمعاصي والظلم والقبيح ومريد القبيح سفيه؟ قلنا: إذا كشفنا عن حقيقة الأمر وبينا أنه مباين للإرادة وكشفنا عن القبيح والحسن وبينا أن ذلك يرجع إلى موافقة الأعراض ومخالفتها، وهو سبحانه منزه عن الأعراض فاندفعت هذه الإشكالات وسيأتي ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. الصفة الخامسة والسادسة في السمع والبصر ندعي ان صانع العالم سميع بصير، ويدل عليه الشرع والعقل. أما الشرع فيدل عليه آيات من القرآن كثيرة كقوله " وهو السميع البصير " وكقول إبراهيم عليه السلام لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يعني عنك شيئاً ونعلم أن الدليل غير منقلب عليه في معبوده وأنه كان يعبد سميعاً بصيراً ولا يشاركه في الإلزام. فإن قيل: إنما أريد به العلم. قلنا: إنما تصرف ألفاظ الشارع عن موضوعاتها المفهومة السابقة إلى الأفهام إذا كان يستحيل تقديرها على الموضوع، ولا استحالة في كونه سميعاً بصيراً، بل يجب أن
يكون كذلك، فلا معنى للتحكم بإنكار ما فهمه أهل الإجماع من القرآن. فإن قيل: وجه استالته إنه إن كان سمعه وبصره حادثين كان محلاً للحوادث، وهو محال، وإن كانا قديمين فكيف يسمع صوتاً معدوماً وكيف يرى العالم في الأزل والعالم معدوم والمعدوم لا يرى؟ قلنا: هذا السوال يصدر عن معتزلي أو فلسفي. أما المعتزلي فدفعه هين، فإنه سلم أنه يعلم الحادثات، فنقول: يعلم الله الآن إن العالم كان موجوداً قبل هذا فكيف علم في الأزل أنه يكون موجوداً وهو بعد لم يكن موجوداً؟ فإن جز إثبات صفة تكون عند وجود العالم علما بأنه كائن، وفعله بأنه سيكون وبعده بأنه كان وقبله بأنه سيكون، وهو لا يتغير عبر عنه بالعلم بالعالم والعلمية، جاز ذلك في السمع والسمعية والبصر والبصرية. وإن صدر من فلسفي فهو منكر لكونه عالماً بالحادثات المعينة الداخلة في الماضي والحال والمستقبل، فسبيلنا أن ننقل الكلام إلى العلم ونثبت عليه جواز علم قديم متعلق بالحادثات كما سنذكره، ثم إذا ثبت ذلك في العلم قسنا عليه السمع والبصر. وأما المسلك العقلي، فهو أن نقول: معلوم أن الخالق أكمل من المخلوق، ومعلوم أن البصير أكمل ممن لا يبصر، والسميع أكمل ممن لا يسمع، فيستحيل أن يثبت وصف الكمال للمخلوق ولا نثبته للخالق. وهذان أصلان يوجبان الإقرار بصحة دعوانا ففي أيهما النزاع؟ فإن قيل: النزاع في قولكم واجب أن يكون الخالق أكمل من المخلوق. قلنا: هذا مما يجب الاعتراف به شرعاً وعقلاً، والأمة والعقلاء مجمعون عليه، فلا يصدر هذا السؤال من معتقد. ومن اتسع عقله لقبول قادر يقدر على اختراع ما هو أعلى وأشرف منه فقد انخلع عن غريزة البشرية ونطق لسانه بما ينبو عن قبوله قلبه إن كان يفهم ما يقوله، ولهذا لا نرى عاقلاً يعتقد هذا الاعتقاد. فإن قيل: النزاع في الأصل الثاني، وقو قولكم إن البصير أكمل وإن السمع والبصر كمال. قلنا: هذا أيضاً مدرك ببديهة العقل، فإن العلم كمال والسمع والبصر كمال ثان للعلم، فإنا بينا أنه استكمال للعلم والتخيل، ومن علم شيئاً ولم يره ثم رآه استفاد مزيد كشف وكمال فكيف يقال إن ذلك حاصل للمخلوق وليس بحاصل للخالق أو يقال إن ذلك ليس بكمال، فإن لم يكن كمالاً فهو نقص أو لا هو نقص ولا هو كمال، وجميع هذه الأقسام محال، فظهر ان الحق ما ذكرناه.
فإن قيل: هذا يلزمكم في الإدراك الحاصل بالشم والذوق واللمس لأن فقدها نقصان ووجودها كمال في الإدراك، فليس كمال علم من علم الرائحة ككمال علم من أدرك بالشم، وكذلك بالذوق فأين العلم بالطعوم من إدراكها بالذوق. والجواب إن المحققين من أهل الحق صرحوا بإثبات أنواع الإدراكات مع السمع والبصر والعلم الذي هو كمال في الإدراك دون الأسباب التي هي مقترنة بها في العادة من المماسة والملاقاة، فإن ذلك محال على الله تعالى. كما جوزوا ادراك البصر من غير مقابلة بينه وبين المبصر، وفي طرد هذا القياس دفع هذا السؤال ولا مانع منه ولكن لما لم يرد الشرع إلا بلفظ العلم والسمع والبصر فلم يمكن لنا إطلاق غيره. وأما ما هو نقصان في الإدراك فلا يجوز في حقه تعالى البتة، فإن قيل يجر هذا إلى إثبات التلذذ والتألم، فالخدر الذي لا يتألم بالضرب ناقص، والعنين الذي لا يتلذذ بالجماع ناقص، وكذا فساد الشهوة نقصان، فينبغي أن نثبت في حقه شهوة، قلنا هذه الأمور تدل على الحدوث وهي في أنفسها إذا بحث عنها نقصانات، وهي محوجة إلى أمور توجب الحدوث، فالألم نقصان، ثم هو محوج إلى سبب هو ضرب، والضرب مماسة تجري بين الأجسام، واللذة ترجع إلى زوال الألم إذا حققت أو ترجع إلى درك ما هو محتاج إليه ومشتاق إليه، والشوق والحاجة نقصان، فالموقوف على النقصان ناقص، ومعنى الشهوة طلب الشيء الملائم ولا طلب إلا عند فقد المطلوب ولا لذة إلا عند نيل ما ليس بموجود، وكل ما هو ممكن وجوده لله فهو موجود فليس يفوته شيء حتى يكون بطلبه مشتهياً وبنيله ملتذاً، فلم تتصور هذه الأمور في حقه تعالى وإذا قيل إن فقد التألم والإحساس بالضرب نقصان في حق الخدر، وإن إدراكه كمال وإن سقوط الشهوة من معدته نقصان، وثبوتها كمال أريد به أنه كمال بالإضافة إلى ضده الذي هو مهلك في حقه، فصار كمالاً بالإضافة إلى الهلاك لأن النقصان خير من الهلاك فهو إذاً ليس كمالاً في ذاته بخلاف العلم وهذه الادراكات. الصفة السابعة الكلام ندعي أن صانع العالم متكلم كما أجمع عليه المسلمون، واعلم أن من أراد إثبات الكلام بأن العقل يقضي بجواز كون الخلق مرددين تحت الأمر والنهي وكل صفة جائزة في المخلوقات تستند إلى صفة واجبة في الخالق، فهو في شطط، إذ يقال له: إن أردت جواز كونهم مأمورين من جهة الخلق الذين يتصور منهم الكلام، فمسلم، وإن أردت جوازه على العموم من الخلق والخالق فقد أخذت محل النزاع مسلماً في نفس الدليل وهو غير مسلم، ومن أراد إثبات الكلام بالإجماع أو بقول الرسول فقد سام نفسه خطة خسف لأن الإجماع يستند إلى قول الرسول عليه السلام ومن أنكر كون
الباري متكلماً فبالضرورة ينكر تصور الرسول، إذ معنى الرسول المبلغ لرسالة المرسل، فإن لم يكن للكلام متصور في حق من ادعى أنه مرسل كيف يتصور الرسول؟ ومن قال أنا رسول الأرض أو رسول الجبل إليكم فلا يصغى إليه لاعتقادنا استحالة الكلام والرسالة من الجبل والأرض، ولله المثل الأعلى، ولكن من يعتقد استحالة الكلام في حق الله تعالى استحال منه أن يصدق الرسول إذ المكذب بالكلام لا بد أن يكذب بتبليغ الكلام، والرسالة عبارة عن تبليغ الكلام، والرسول عبارة عن المبلغ، فلعل الأقوم منهج ثالث وهو الذي سلكناه في اثبات السمع والبصر في أن الكلام للحي أما أن يقال هو كمال أو يقال هو نقص، أو يقال لا هو نقص ولا هو كمال، وباطل أن يقال هو نقص أو هو لا نقص ولا كمال فثبت بالضرورة أنه كمال، وكل كمال وجد للمخلوق فهو واجب الوجود للخالق بطريق الأولى كما سبق. فإن قيل: الكلام الذي جعلتموه منشأ نظركم هو كلام الخلق، وذلك إما أن يراد به الأصوات والحروف أو يراد به القدرة على ايجاد الأصوات والحروف في نفس القادر أو يراد به معنى ثالث سواهما، فإن أريد به الأصوات والحروف فهي حوادث ومن الحوادث ما هي كمالات في حقنا ولكن لا يتصور قيامها في ذات الله سبحانه وتعالى، وإن قام بغيره لم يكن هو متكلماً به بل كان المتكلم به المحل الذي قام به؛ وإن أريد به القدرة على خلق الأصوات فهو كمال ولكن المتكلم ليس متكلماً باعتبار قدرته على خلق الأصوات فقط بل باعتبار خلقه للكلام في نفسه، والله تعالى قادر على خلق الأصوات فله كمال القدرة ولكن لا يكون متكلماً به إلا إذا خلق الصوت في نفسه، وهو محال إذ يصير به محلاً للحوادث فاستحال أن يكون متكلماً؛ وإن أريد بالكلام أمر ثالث فليس بمفهوم وإثبات ما لا يفهم محال. قلنا: هذا التقسيم صحيح والسؤال في جميع أقسامه معترف به إلا في إنكار القسم الثالث، فإنا معترفون باستحالة قيام الأصوات بذاته وباستحالة كونه متكلماً بهذا الاعتبار. ولكنا نقول الإنسان يسمى متكلماً باعتبارين أحدهما بالصوت والحرف والآخر بكلام النفس الذي ليس بصوت وحرف، وذلك كمال وهو في حق الله تعالى غير محال، ولا هو دال على الحدوث. ونحن لا نثبت في حق الله تعالى إلا كلام النفس، وكلام النفس لا سبيل إلى إنكاره في حق الإنسان زائداً على القدرة والصوت حتى يقول الانسان زورت البارحة في نفسي كلاماً ويقال في نفس فلان كلام وهو يريد أن ينطق به ويقول الشاعر: لا يعجبنك من أثير خطه ... حتى يكون مع الكلام أصيلا إن الكلام لفي الفؤاد وإنما ... جعل اللسان على الفؤاد دليلاً
وما ينطق به الشعراء يدل على أنه من الجليات التي يشترك كافة الخلق في دركها فكيف ينكر. فإن قيل: كلام النفس بهذا التأويل معترف به ولكنه ليس خارجاً عن العلوم الإدراكات وليس جنساً برأسه البتة، ولكن ما يسميه الناس كلام النفس وحديث النفس هو العلم بنظم الألفاظ والعبارات وتأليف المعاني المعلومة على وجه مخصوص فليس في القلب إلا معاني معلومة وهي العلوم وألفاظ مسموعة هي معلومة بالسماع، وهو أيضاً علم معلوم اللفظ. وينضاف إليه تأليف المعاني والألفاظ على ترتيب. وذلك فعل يسمى فكراً وتسميه القدرة التي عنها يصدر الفعل قوة مفكرة. فإن أثبتم في النفس شيئاً سوى نفس الفكر الذي هو ترتيب الألفاظ والمعاني وتأليفها، وسوى القوة المفكرة التي هي قدرة عليا وسوى العلم بالمعاني مفترقها ومجموعها، وسوى العلم بالألفاظ المرتبة من الحروف مفترقها ومجموعها فقد أثبتم أمراً منكراً لا نعرفه. وإيضاحه أن الكلام إما أمر أو نهي أو خبر أو استخبار. أما الخبر فلفظ يدل على علم في نفس المخبر، فمن علم الشيء وعلم اللفظ الموضوع للدلالة على ذلك الشيء كالضرب مثلاً فإنه معنى معلوم يدرك بالحس، ولفظ الضرب الذي هو مؤلف من الضاد والراء والباء الذي وضعته العرب للدلالة على المعنى المحسوس وهي معرفة أخرى، فكان له قدرة على اكتساب هذه الأصوات بلسانه، وكانت له إرادة للدلالة وإرادة لاكتساب اللفظ ثم منه قوله ضرب ولم يفتقر إلى أمر زائد على هذه الأمور. فكل أمر قدرتموه سوى هذا فنحن نقدر نفيه، ويتم مع ذلك قولك ضرب ويكون خبراً وكلاماً، وأما الاستخبار فهو دلالة على أن في النفس طلب معرفة، وأما الأمر فهو دلالة على أن في النفس طلب فعل المأمور وعلى هذا يقاس النهي وسائر الأقسام من الكلام ولا يعقل أمر آخر خارج عن هذا وهذه الجملة، فبعضها محال عليه كالأصوات وبعضها موجود لله كالارادة والعلم والقدرة، وأما ما عدا هذا فغير مفهوم. والجواب أن الكلام الذي نريده معنى زائد على هذه الجملة ولنذكره في قسم واحد من أقسام الكلام وهو الأمر حتى لا يطول الكلام. فنقول: قول السيد لغلامه قم، لفظ يدل على معنى، والمعنى المدلول عليه في نفسه هو كلام، وليس ذلك شيئاً مما ذكرتموه، ولا حاجة إلى الإطناب في التقسيمات وإنما بتوهم رده ما أراد إلى الأمر أو إلى إرادة الدلالة ومحال أن يقال إنه إرادة الدلالة، لأن الدلالة تستدعي مدلولاً والمدلول غير الدليل وغير إرادة الدلالة، ومحال أن يقال إنه إرادة الآمر.. لأنه قد يأمر وهو لا يريد الامتثال بل يكرهه، كالذي يعتذر
عند السلطان الهام بقتله توبيخاً له على ضرب غلامه، بأنه إنما ضربه لعصيانه، وآيته أنه يأمره بين يدي الملك فيعصيه، فإذا أراد الاحتجاج به وقال للغلام بين يدي الملك قم فإني عازم عليك بأمر جزم لا عذر لك فيه ولا يريد أن تقوم فهو في هذا الوقت آمر بالقيام قطعاً، وهو غير مريد للقيام قطعاً، فالطلب الذي قام بنفسه الذي دل لفظ الأمر عليه هو الكلام وهو غير إرادة القيام وهذا واضح عند المصنف. فإن قيل هذا الشخص ليس بآمر على الحقيقة ولكنه موهم أنه أمر، قلنا: هذا باطل من وجهين: أحدهما، أنه لو لم يكن آمراً لما تمهد عذره عند الملك ولقيل له أنت في هذا الوقت لا يتصور منك الأمر لأن الأمر هو طلب الامتثال ويستحيل أن تريد الآن الامتثال وهو سبب هلاكك، فكيف تطمع في أن تحتج بمعصيتك لأمرك وأنت عاجز عن أمره إذ أنت عاجز عن إرادة ما فيه هلاكك وفي امتثاله هلاكك؟ ولا شك في أنه قادر على الاحتجاج وأن حجته قائمة وممهدة لعذره، وحجته بمعصية الأمر، فلو تصور الأمر مع تحقق كراهة الامتثال لما تصور احتجاج السيد بذلك البتة، وهذا قاطع في نفسه لمن تأمله. والثاني، هو أن هذا الرجل لو حكى الواقعة للمفتيين وحلف بالطلاق الثلاث إني أمرت العبد بالقيام بين يدي الملك بعد جريان عقاب الملك فعصى، لأفتى كل مسلم بأن طلاقه غير واقع وليس للمفتي أن يقول أنا أعلم أن يستحيل أن تريد في مثل هذا الوقت امتثال الغلام وهو سبب هلاكك، والأمر هو إرادة الامتثال فإذا ما أمرت هذا لو قاله المفتي فهو باطل بالاتفاق، فقد انكشف الغطاء ولاح وجود معنى هو مدلول اللفظ زائداً على ما عداه من المعاني، ونحن نسمي ذلك كلاماً وهو جنس مخالف للعلوم والإرادات والاعتقادات، وذلك لا يستحيل ثبوته لله تعالى بل يجب ثبوته فإنه نوع كلام فإذا هو المعني بالكلام القديم. وأما الحروف فهي حادثة وهي دلالات على الكلام والدليل غير المدلول ولا يتصف بصفة المدلول، وإن كانت دلالته ذاتية كالعالم فإنه حادث ويدل على صانع قديم فمن أين يبعد أن تدل حروف حادثة على صفة قديمة مع أن هذه دلالة بالاصطلاح؟ ولما كان كل كلام النفس دقيقاً زل عى ذهن أكثر الضعفاء فلم يثبتوا إلا حروفاً وأصواتاً ويتوجه لهم على هذا المذهب أسئلة واستبعادات نشير إلى بعضها ليستدل بها على طريق الدفع في غيرها. الاستبعاد الأول: قول القائل كيف سمع موسى كلام الله تعالى؛ أسمع صوتاً وحرفاً؟ فإن قلتم ذلك فإذا لم يسمع كلام الله فإن كلام الله ليس بحرف، وإن لم
يسمع حرفاً ولا صوتاً فكيف يسمع ما ليس بحرف ولا صوت؟ قلنا: سمع كلام الله تعالى وهو صفة قديمة قائمة بذات الله تعالى ليس بحرف ولا صوت، فقولكم كيف سمع كلام الله تعالى كلام من لا يفهم المطلوب من سؤال كيف، وإنه ماذا يطلب به وبماذا يمكن جوابه فلتفهم ذلك حتى تعرف استحالة السؤال. فنقول: السمع نوع إدراك، فقول القائل كيف سمع كقول القائل كيف أدركت بحاسة الذوق حلاوة السكر، وهذا السؤال لا سبيل إلى شفائه إلا بوجهين أحدهما أن نسلم سكراً إلى هذا السائل حتى يذوقه ويدرك طعمه وحلاوته، فنقول أدركت أنا كما أدركته أنت الآن وهذا هو الجواب الشافي والتعريف التام. والثاني أن يتعذر ذلك إما لفقد السكر أو لعدم الذوق في السائل للسكر، فنقول: أدركت طعمه كما أدركت أنت حلاوة العسل فيكون هذا جواباً صواباً من وجه وخطأ من وجه. أما وجه كونه صواباً فإنه تعريف بشيء يشبه المسؤول عنه من وجه، وإن كان لا يشبهه من كل الوجوه وهو أصل الحلاوة، فإن طعم العسل يخالف طعم السكر وإن قاربه من بعض الوجوه وهو أصل الحلاوة، وهذا غاية الممكن. فإن لم يكن السائل قد ذاق حلاوة شيء أصلاً تعذر جوابه وتفهيم ما سأل عنه وكان كالعنين يسأل عن لذه الجماع وقط ما أدركه فيمتنع تفهيمه، إلا أن نشبهه له الحالة التي يدركها المجامع بلذة الأكل فيكون خطأ من وجه إذ لذة الجماع والحالة التي يدركها المجامع لا تساوي الحالة التي يدركها الآكل إلا من حيث أن عموم اللذة قد شملها فإن لم يكن قد التذ بشيء قط تعذر أصل الجواب. وكذلك من قال كيف سمع كلام الله تعالى فلا يمكن شفاؤه في السؤال إلا بأن نسمعه كلام الله تعالى القديم وهو متعذر، فإن ذلك من خصائص الكليم عليه السلام، فنحن لا نقدر على إسماعه أو تشبيه ذلك بشيء من مسموعاته وليس في مسموعاته ما يشبه كلام الله تعالى، فإن كل مسموعاته التي ألفها أصوات والأصوات لا تشبه ما ليس بأصوات فيتعذر تفهيمه، بل الأصم لو سأل وقال كيف تسمعون أنتم الأصوات وهو ما سمع قط صوتاً لم نقدر على جوابه، فإنا إن قلنا كما تدرك أنت المبصرات فهو إدراك في الاذن كإدراك البصر في العين كان هذا خطأ، فإن إدراك الأصوات لا يشبه إبصار الألوان، فدل أن هذا السؤال محال بل لو قال القائل كيف يرى رب الأرباب في الآخرة، كان جوابه محالاً لا محالة لأنه يسأل عن كيفية ما لا كيفية له، إذ معنى قول القائل كيف هو أي مثل أي شيء هو مما عرفناه، فإن كان ما يسأل عنه غير مماثل لشيء مما عرفه، كان الجواب محالاً ولم يدل ذلك على عدم ذات الله تعالى، فكذلك تعذر هذا لا يدل على عدم كلام الله تعالى بل ينبغي أن يعتقد أن كلامه سبحانه
صفة قديمة ليس كمثلها شي، كما أن ذاته ذات قديمة ليس كمثلها شيء، وكما ترى ذاته رؤية تخالف رؤية الأجسام والأعراض ولا تشبهها فيسمع كلامه سماعاً يخالف الحروف والأصوات ولا يشبهها. الاستبعاد الثاني: أن يقال كلام الله سبحانه حال في المصاحف أم لا، فإن كان حالاً فكيف حمل القديم في الحادث؟ فإن قلتم لا، فهو خلاف الإجماع، إذ احترام المصحف مجمع عليه حتى حرم على المحدث مسه وليس ذلك إلا لأن فيه كلام الله تعالى. فنقول: كلام الله تعالى مكتوب في المصاحف محفوظ في القلوب مقروء بالألسنة، وأما الكاغد والحبر والكتابة والحروف والأصوات كلها حادثة لأنها أجسام وأعراض في أجسام فكل ذلك حادث. وإن قلنا إنه مكتوب في المصحف، أعني صفة تعالى القديم، لم يلزم أن تكون ذات القديم في المصحف، كما أنا إذا قلنا النار مكتوبة في الكتاب لم يلزم منه أن تكون ذات النار حالة فيه، إذ لو حلت فيه لاحترق المصحف، ومن تكلم بالنار فلو كانت ذات النار بلسانه لاحترق لسانه، فالنار جسم حار وعليه دلالة هي الأصوات المقطعة تقطيعاً يحصل منه النون والألف والراء، فالحار المحرق ذات المدلول عليه لا نفس الدلالة، فكذلك الكلام القديم القائم بذات الله تعالى هو المدلول لا ذات الدليل والحروف أدلة وللأدلة حرمة إذ جعل الشرع لها حرمة فلذلك وجب احترام المصحف لأن فيه دلالة على صفة الله تعالى.
الاستبعاد الثالث: إن القرآن كلام الله تعالى أم لا؟ فإن قلتم لا فقد خرقتم الإجماع، وإن قلتم نعم فما هو سوى الحروف والأصوات، ومعلوم أن قراءة القارئ هي الحروف والأصوات. فنقول: ها هنا ثلاثة ألفاظ: قراءة، ومقروء، وقرآن. أما المقروء فهو كلام الله تعالى، أعني صفته القديمة القائمة بذاته، وأما القراءة: فهي في اللسان عبارة عن فعل القارئ الذي كان ابتدأه بعد أن كان تاركاً له، ولا معنى للحادث إلا أنه ابتدأ بعد أن لم يكن، فإن كان الخصم لا يفهم هذا من الحادث فلنترك لفظ الحادث والمخلوق، ولكن نقول: القراءة فعل ابتدأه القارئ بعد أن لم يكن يفعله وهو محسوس. وأما القرآن، فقد يطلق ويراد به المقروء فإن أريد به ذلك فهو قديم غير مخلوق وهو الذي أراده السلف رضوان الله عليهم بقولهم القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق، أي المقروء بالألسنة، وإن أريد به القراءة التي هي فعل القارئ ففعل القارئ لا يسبق وجود القارئ وما لا يسبق وجود الحادث فهو حادث. وعلى الجملة: من يقول ما أحدثته باختياري من الصوت وتقطيعه وكنت ساكتاً عنه قبله فهو قديم، فلا ينبغي أن يخاطب ويكلف بل ينبغي أن يعلم المسكين أنه ليس يدري ما يقوله، ولا هو يفهم معنى الحرف، ولا هو يعلم معنى الحادث، ولو علمهما لعلم أنه في نفسه إذا كان مخلوقاً كان ما يصدر عنه مخلوقاً، وعلم أن القديم لا ينتقل إلى ذات حادثة. فلنترك التطويل في الجليات فإن قول القائل بسم الله إن لم تكن السين فيه بعد الباء لم يكن قرآناً بل كان خطأ، وإذا كان بعد غيره ومتأخراً عنه فكيف يكون قديماً ونحن نريد بالقديم ما لا يتأخر عن غيره أصلاً. الاستبعاد الرابع: قولهم: أجمعت الأمة على أن القرآن معجزة للرسول عليه السلام وأنه كلام الله تعالى، فإنه سور وآيات ولها مقاطع ومفاتح؟ وكيف يكون للقديم مقاطع ومفاتح؟ وكيف ينقسم بالسور والآيات؟ وكيف يكون القديم معجزة للرسول عليه السلام والمعجزة هي فعل خارق للعادة؟ وكل فعل فهو مخلوق فكيف يكون كلام الله تعالى قديماً؟ قلنا: أتنكرون أن لفظ القرآن مشترك بين القراءة والمقروء أم لا؟ فإن اعترفتم به فكل ما أورده المسلمون من وصف القرآن بما هو قديم، كقولهم القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق، أرادوا به المقروء وكل ما وصفوه به مما لا يحتمله القديم، ككونه سوراً وآيات ولها مقاطع ومفاتح، أرادوا به العبارات الدالة على الصفة القديمة التي هي قراءة، وإذا صار الاسم مشتركاً امتنع التناقض، فالاجماع منعقد على أن لا قديم إلا الله تعالى، والله تعالى يقول حتى عاد كالعرجون القديم. ولكن نقول:
اسم القديم مشترك بين معنيين، فإذا ثبت من وجه لم يستحل نفيه من وجه آخر، فكذا يسمى القرآن وهو جواب عن كل ما يوردونه من الإطلاقات المتناقضة فإن أنكروا كونه مشتركاً، فنقول: أما إطلاقه لإرادة المقروء دل عليه كلام السلف رضي الله عنهم إن القرآن كلام الله سبحانه غير مخلوق، مع علمهم بأنهم وأصواتهم وقراءاتهم وأفعالهم مخلوقة وأما إطلاقه لإرادة القراءة فقد قال الشاعر: ضحوا بأشمط عنوان السجود به ... يقطّع الليل تسبيحاً وقرآنا يعني القراءة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي حسن الترنم بالقرآن والترنم يكون بالقراءة. وقال كافة السلف: القرآن كلام الله غير مخلوق. وقالوا: القرآن معجزة، وهي فعل الله تعالى إذ علموا أن القديم لا يكون معجزاً فبان أنه اسم مشترك. ومن لم يفهم اشتراك اللفظ ظن تناقضاً في هذه الاطلاقات. الاستبعاد الخامس: أن يقال: معلوم أنه لا مسموع الآن إلا الأصوات، وكلام الله مسموع الآن بالإجماع وبدليل قوله تعالى " وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله " فنقول: إن كان الصوت المسموع للمشرك عند الإجارة هو كلام الله تعالى القديم القائم بذاته فأي فضل لموسى عليه السلام في اختصاصه بكونه كليماً لله على المشركين وهم يسمعون؟ ولا يتصور عن هذا جواب إلا أن نقول: مسموع موسى عليه السلام صفة قديمة قائمة بالله تعالى، ومسموع المشرك أصوات دالة على تلك الصفة. وتبين به على القطع الاشتراك إما في اسم الكلام وهو تسمية الدلالات باسم المدلولات، فإن الكلام هو كلام النفس تحقيقاً، ولكن الألفاظ لدلالتها عليه أيضاً تسمى كلاماً كما تسمى علماً؛ إذ يقال سمعت علم فلان وإنما نسمع كلامه الدال على علمه. وأما في اسم المسموع فإن المفهوم المعلوم بسماع غيره قد يسمى مسموعاً، كما يقال: سمعت كلام الأمير على لسان رسوله ومعلوم أن كلام الأمير لا يقوم بلسان رسوله بل المسموع كلام الرسول الدال على كلام الأمير. فهذا ما أردنا أن نذكره في إيضاح مذهب أهل السنة في كلام النفس المعدود من الغوامض، وبقية أحكام الكلام نذكرها عند التعرض لأحكام الصفات.
القسم الثاني من هذا القطب في أحكام الصفات عامة ما يشترك فيها أو يفترق وهي أربعة أحكام الحكم الأول إن الصفات السبعة التي دللنا عليها ليست هي الذات بل هي زائدة على الذات، فصانع العالم تعالى عندنا عالم بعلم وحي بحياة وقادر بقدرة، هكذا في جميع الصفات، وذهبت المعتزلة والفلاسفة إلى إنكار ذلك. وقالوا: القديم ذات واحدة قديمة ولا يجوز إثبات ذوات قديمة متعددة، وإنما الدليل يدل على كونه عالماً قادراً حياً لا على العلم والقدرة والحياة. ولنعين العلم من الصفات حتى لا نحتاج إلى تكرير جميع الصفات، وزعموا أن العلمية حال للذات وليست بصفة، لكن المعتزلة ناقضوا في صفتين إذ قالوا إنه مريد بإرادة زائدة على الذات ومتكلم بكلام هو زائد على الذات، إلا أن الإرادة يخلقها في غير محل والكلام يخلقه في جسم جماد ويكون هو المتكلم به. والفلاسفة طردوا قياسهم في الإرادة. وأما الكلام فإنهم قالوا إنه متكلم بمعنى أنه يخلق في ذات النبي عليه السلام سماع أصوات منظومة، إما في النوم وإما في اليقظة، ولا يكون لتلك الأصوات وجود من خارج البتة، بل في سمع النبي، كما يرى النائم أشخاصاً لا وجود لها، ولكن تحدث صورها في دماغه، وكذلك يسمع أصواتاً لا وجود لها حتى أن الحاضر عند النائم لا يسمع، والنائم قد يسمع، ويهوله الصوت الهائل ويزعجه وينتبه خائفاً مذعوراً. وزعموا أن النبي إذا كان عالي الرتبة في النبوة ينتهي صفاء نفسه إلى أن يرى في اليقظة صوراً عجيبة ويسمع منها أصواتاً منظومة فيحفظها، ومن حواليه لا يرون ولا يسمعون. وهذا المعني عندهم برؤيه الملائكة وسماع القرآن منهم، ومن ليس في الدرجة العالية في النبوة فلا يرى ذلك إلا في المنام. فهذا تفصيل مذاهب الضلال، والغرض إثبات الصفات والبرهان القاطع هو أن من ساعد على أنه تعالى عالم فقد ساعد على أن له علماً، فإن المفهوم من قولنا عالم ومن له علم واحد، فإن العاقل يعقل ذاتاً ويعقلها على حالة وصفة بعد ذلك، فيكون قد عقل صفة وموصوفاً والصفة علم مثلاً. وله عبارتان: إحداهما طويلة وهي أن نقول هذه الذات قد قام بها علم والأخرى وجيزة أوجزت بالتصريف والاشتقاق. وهي أن الذات عالمة كما نشاهد الانسان شخصاً ونشاهد نعلاً ونشاهد دخول رجله في النعل، فله عبارة طويلة
وهو أن نقول هذا الشخص رجله داخلة في نعله أو نقول هو منتعل ولا معنى لكونه منتعلاً إلا أنه ذو نعل وما يظن من أن قيام العلم بالذات يوجب للذات حالة تسمى عالمية، هوس محض، بل العلم هي الحالة، فلا معنى لكونه عالماً إلا كون الذات على صفة وحال تلك الصفة الحال وهي العلم فقط، ولكن من يأخذ المعاني من الألفاظ فلا بد أن يغلط. فإذا تكررت الألفاظ بالاشتقاقات فاشتقاق صفة العالم من لفظ العلم أورث هذا الغلط، فلا ينبغي أن يغتر به. وبهذا يبطل جميع ما قيل وطول من العلة والمعلول وبطلان ذلك جلي بأول العقل لمن لم يتكرر على سمعه ترديد تلك الألفاظ، ومن علق ذلك بفهمه فلا يمكن نزعه منه إلا بكلام طويل لا يحتمله هذا المختصر. والحاصل هو أنا نقول للفلاسفة والمعتزلة: هل المفهوم من قولنا عالم عين المفهوم من قولنا موجوداً وفيه إشارة إلى وجود وزيادة. فإن قالوا لا، فإذاً كل من قال هو موجود عالم، كأنه قال هو موجود وهذا ظاهر الاستحالة، وإذا كان في مفهومه زيادة فتلك الزيادة هل هي مختصة بذات الموجود أم لا؟ فإن قالوا لا فهو محال إذ يخرج به عن أن يكون وصفاً له وإن كان مختصاً بذاته فنحن لا نعني بالعلم إلا ذلك وهي الزيادة المختصة بالذات الموجودة الزائدة على الوجود التي يحسن أن يشتق للموجود بسببه منه اسم العالم، فقد ساعدتم على المعنى وعاد النزاع إلى اللفظ، وإن أردت إيراده على الفلاسفة قلت: مفهوم قولنا قادر مفهوم قولنا عالم أم غيره؟ فإن كان هو ذلك بعينه فكأنا قلنا قادر قادر، فإنه تكرار محض، وإن كان غيره فإذا هو المراد فقد أثبتم مفهومين أحدهما يعبر عنه بالقدرة والآخر بالعلم ورجع الإنكار إلى اللفظ. فإن قيل: قولكم أمر مفهومه عين المفهوم من قولكم آمر وناه ومخبر أو غيره، فإن كان عينه فهو تكرار محض، وإن كان غيره فليكن له كلام هو أمر وآخر هو نهي وآخر هو خبر. وليكن خطاب كل شيء مفارقاً لخطاب غيره. وكذلك مفهوم قولكم إنه عالم بالأعراض أهو عين مفهوم قولكم إنه عالم بالجواهر أو غيره؟ فإن كان عينه فليكن الإنسان العالم بالجوهر عالماً بالعرض بعين ذلك العلم، حتى يتعلق علم واحد بمتعلقات مختلفة لا نهاية لها، وإن كان غيره فليكن لله علوم مختلفة لا نهاية لها وكذلك الكلام والقدرة والإرادة وكل صفة لا نهاية لمتعلقاتها ينبغي أن لا يكون لأعداد تلك الصفة نهاية، وهذا محال، فإن جاز أن تكون صفة واحدة تكون هي الأمر وهي النهي وهي الخبر وتنوب عن هذه المختلفات جاز أن تكون صفة واحدة تنوب عن العلم والقدرة والحياة وسائر الصفات. ثم إذا جاز ذلك جاز أن تكون الذات بنفسها
كافية ويكون فيها معنى القدرة والعلم وسائر الصفات من غير زيادة وعند ذلك يلزم مذهب المعتزلة والفلاسفة. والجواب أن نقول: هذا السؤال يحرك قطباً عظيماً من اشكالات الصفات ولا يليق حلها بالمختصرات. ولكن إذا سبق القلم إلى إيراده فلنرمز إلى مبدأ الطريق في حله، وقد كع عنه أكثر المحصلين وعدلوا إلى التمسك بالكتاب والإجماع، وقالوا هذه الصفات قد ورد الشرع بها، إذ دل الشرع على العلم وفهم منه الواحد لا محالة والزائد على الواحد لم يرد فلا يعتقده. وهذا لا يكاد يشفي فإنه قد ورد بالأمر والنهي والخبر والتوراة والإنجيل والقرآن فما المانع من أن يقال: الأمر غير النهي والقرآن غير التوراة وقد ورد بأنه تعالى يعلم السر والعلانية والظاهر والباطن والرطب واليابس وهلم جرا إلى ما يشتمل القرآن عليه.. فلعل الجواب ما نشير إلى مطلع تحقيقه وهو أن كل فريق من العقلاء مضطر إلى أن يعترف بأن الدليل قد دل على أمر زائد على وجود ذات الصانع سبحانه، وهو الذي يعبر عنه بأنه عالم وقادر وغيره. والاحتمالات فيه ثلاثة: طرفان وواسطة، والاقتصاد أقرب إلى السداد. أما الطرفان فأحدهما في التفريط وهو الاقتصار على ذات واحدة تؤدي جميع هذه المعاني وتنوب عنها كما قالت الفلاسفة. والثاني طرف الإفراط وهو إثبات صفة لا نهاية لآحادها من العلوم والكلام والقدرة، وذلك بحسب عدد متعلقات هذه الصفات؛ وهذا إسراف لا صائر إليه إلا بعض المعتزلة وبعض الكرامية. والرأي الثالث هو القصد والوسط. وهو أن يقال: المختلفات لاختلافها درجات في التقارب والتباعد؛ فرب شيين مختلفين بذاتيهما كاختلاف الحركة والسكون واختلاف القدرة والعلم الجوهر والعرض، ورب شيئين يدخلان تحت حد وحقيقة واحدة ولا يختلفان لذاتيهما وإنما يكون الاختلاف فيهما من جهة تغاير التعلق؛ فليس الاختلاف بين القدرة والعلم كالاختلاف بين العلم بسواد والعلم بسواد آخر أو بياض آخر، ولذلك إذ حددت العلم تجد دخل فيه العلم بالمعلومات كلها، فنقول: الاقتصاد في الاعتقاد أن يقال: كل اختلاف يرجع إلى تباين الذوات بأنفسها فلا يمكن أن يكفي الواحد منها، وينوب عن المختلفات. فوجب أن يكون العلم غير القدرة وكذلك الحياة وكذا الصفات
السبعة، وأن تكون الصفات غير الذات من حيث أن المباينة بين الذات الموصوفة وبين الصفة أشد من المباينة بين الصفتين. وأما العلم بالشيء فلا يخالف العلم بغيره إلا من جهة تعلقه بالمتعلق، فلا يبعد أن تتميز الصفة القديمة بهذه الخاصية وهو أن لا يوجب تباين المتعلقات فيها تبايناً وتعدداً. فإن قيل فليس في هذا قع دابر الإشكال، لأنك إذ اعترفت باختلاف ما بسبب اختلاف المتعلق، فالإشكال قائم، فما لك وللنظر في سبب الاختلاف بعد وجود الاختلاف.. فأقول: غاية الناصر لمذهب معين أن يظهر على القطع ترجيح اعتقاده على اعتقاد غيره، وقد حصل هذا على القطع، إذ لا طريق إلا واحد من هذه الثلاث، أو اختراع رابع لا يعقل. وهذا الواحد إذا قوبل بطرفيه المتقابلين له علم على القطع رجحانه، وإذ لم يكن بد من اعتقاد ولا معتقد إلا هذه الثلاث، وهذا أقرب الثلاث، فيجب اعتقاده وإن بقي ما يحبك في الصدر من اشكال يلزم على هذا. واللازم على غيره أعظم منه وتعليل الإشكال ممكن إما قطعه بالكلية والمنظور فيه هي الصفات القديمة المتعالية عن افهام الخلق فهو أمر ممتنع إلا بتطويل لا يحتمله الكتاب، هذا هو الكلام العام. وأما المعتزلة فإنا نخصهم بالاستفراق بين القدرة والإرادة. ونقول لو جاز أن يكون قادراً بغير قدرة جاز أن يكون مريداً بغير إرادة ولا فرقان بينهما. فإن قيل: هو قادر لنفسه فلذلك كان قادراً على جميع المقدورات ولو كان مريداً لنفسه لكان مريداً لجملة المرادات، وهو محال، لأن المتضادات يمكن إرادتها على البدل لا على الجمع، وأما القدرة فيجوز أن تتعلق بالضدين. والجواب أن نقول: قولوا إنه مريد لنفسه ثم يختص ببعض الحادثات المرادات كما قلتم قادر لنفسه ولا تتعلق قدرته إلا ببعض الحادثات، فإن جملة أفعال الحيوانات والمتولدات خارجة عن قدرته وإرادته جميعاً عندكم، فإذا جاز ذلك في القدرة جاز في الإرادة أيضاً. وأما الفلاسفة فإنهم ناقضوا في الكلام وهو باطل من وجهين. أحدهما قولهم إن الله تعالى متكلم مع انهم لا يثبتون كلام النفس ولا يثبتون الأصوات في الوجود، وإنما يثبتون سماع الصوت بالحلق في اذن النبي من غير صوت من خارج. ولو جاز أن يكون ذلك بما يحدث في دماغ غيره موصوفاً بأنه متكلم لجاز أن يكون موصوفاً بأنه مصوت ومتحرك لوجود الصوت والحركة في غيره، وذلك محال،
والثاني أن ما ذكروه رد للشرع كله؛ فإن ما يدركه النائم خيال لا حقيقة له، فإذا رددت معرفة النبي لكلام الله تعالى إلى التخيل الذي يشبه اضغاث أحلام فلا يثق به النبي ولا يكون ذلك علماً. وبالجملة هؤلاء لا يعتقدون الدين والاسلام وإنما يتجملون بإطلاق عبارات احتراز من السيف والكلام معهم في أصل الفعل، وحدث العالم والقدرة فلا تشتغل معهم بهذه التفصيلات. فإن قيل أفتقولون إن صفات الله تعالى غير الله تعالى؟ قلنا: هذا خطأ فإنا إذا قلنا الله تعالى، فقد دللنا به على الذات مع الصفات لا على الذات بمجردها، إذ اسم الله تعالى لا يصدق على ذات قد أخلوها عن صفات الالهية، كما لا يقال الفقه غير الفقيه ويد زيد غير زيد ويد النجار غير النجار، لأن بعض الداخل في الاسم لا يكون عين الداخل في الاسم، فيد زيد ليس هو زيد ولا هو غير زيد بل كلا اللفظين محال، وهكذا كل بعض فليس غير الكل ولا هو بعينه الكل، فلو قيل الفقه غير الانسان فهو تجوز ولا يجوز أن يقال غير الفقيه، فإن الانسان لا يدل على صفة الفقه، فلا جرم يجوز أن يقال الصفة غير الذات التي تقوم بها الصفة، كما يقال العرض القائم بالجوهر هو غير الجوهر على معنى ان مفهوم اسمه غير مفهوم اسم الآخر، وهذا حصر جائز بشرطين: أحدهما، أن لا يمنع الشرع من اطلاقه، وهذا مختص بالله تعالى، والثاني، أن لا يفهم من الغير ما يجوز وجوده دون الذي هو غيره بالإضافات إليه، فإنه إن فهم ذلك لم يمكن أن يقال سواد زيد غير زيد، لأنه لا يوجد دون زيد، قد انكشف بهذا ما هو حظ المعنى وما هو حظ اللفظ فلا معنى للتطويل في الجليات. الحكم الثاني في الصفات: ندعي أن هذه الصفات كلها قائمة بذاته لا يجوز أن يقوم شيء منها بغير ذاته، سواء كان في محل أو لم يكن في محل. وأما المعتزلة فإنهم حكموا بأن الإرادة لا تقوم بذاته تعالى، فإنها حادثة وليس هو محلاً للحوادث، ولا يقوم بمحل آخر لأنه يؤدي إلى أن يكون ذلك المحل هو المريد به، فهي توجد لا في محل، وزعموا أن الكلام لا يقوم بذاته لأنه حادث ولكن يقوم بجسم هو جماد حتى لا يكون هو المتكلم به، بل المتكلم به هو الله سبحانه، أما البرهان على أن الصفات ينبغي أن تقوم بالذات فهو عند من فهم ما قدمناه مستغنى عنه، فإن الدليل لما دل على وجود الصانع سبحانه دل بعده على أن الصانع
تعالى بصفة كذا ولا نعني بأنه تعالى على صفة كذا، إلا أنه تعالى على تلك الصفة، ولا فرق بين كونه على تلك الصفة وبين قيام الصفة بذاته. وقد بينا أن مفهوم قولنا عالم واحد وبذاته تعالى علم واحد، كمفهوم قولنا مريد، وقامت بذاته تعالى إرادة واحدة، ومفهوم قولنا لم تقم بذاته إرادة وليس بمريد واحد. فتسميته الذات مريدة بإرادة لم تقم به كتسميته متحركاً بحركة لم تقم به. وإذا لم تقم الارادة بة فسواء كانت موجودة أو معدومة فقول القائل إنه مريد لفظ خطأ، لا معنى له، وهكذا المتكلم، فإنه متكلم باعتبار كونه محلاً للكلام، إذ لا فرق بين قولنا هو متكلم وبين قولنا قام الكلام به، ولا فرق بين قولنا ليس بمتكلم وقولنا لم يقم بذاته كلام، كما في كونه مصوتاً ومتحركاً. فإن صدق على الله تعالى قولنا لم يقم بذاته كلام صدق قولنا ليس بمتكلم لأنهما عبارتان عن معنى واحد. والعجب من قولهم إن الإرادة توجد لا في محل، فإن جاز وجود صفة من الصفات لا في محل فليجز وجود العلم والقدرة والسواد والحركة، بل الكلام فلم قالوا يخلق الأصوات في محل فلتخلق في غير محل. وإن لم يعقل الصوت إلا في محل لأنه عرض وصفة فكذا الارادة. ولو عكس هذا لقيل إنه خلق كلاماً لا في محل وخلق إرادة في محل لكان العكس كالطرد. ولكن لما كان أول المخلوقات يحتاج إلى الإرادة، والمحل مخلوق، لم يمكنهم تقدير محل الارادة موجوداً قبل الإرادة؛ فإنه لا محل قبل الإرادة إلا ذات الله تعالى ولم يجعلوه محلاً للحوادث. ومن جعله محلاً للحوادث أقرب حال منهم فإن استحالة وجود إرادة في غير محل، واستحالة كونه مريداً بإرادة لا تقوم به، واستحالة حدوث إرادة حادثة به بلا إرادة تدرك ببديهة العقل أو نظره الجلي فهذه ثلاثة استحالات جلية. واما استحالة كونه محلاً للحوادث فلا يدرك إلا بنظر دقيق كما سنذكر. الحكم الثالث إن الصفات كلها قديمة، فإنها إن كانت حادثة كان القديم سبحانه محلاً للحوادث، وهو محال. أو كان يتصف بصفة لا تقوم به وذلك أظهر استحالة، كما سبق، ولم يذهب أحد إلى حدوث الحياة والقدرة وإنما اعتقدوا ذلك في العلم بالحوادث وفي الإرادة وفي الكلام ونحن نستدل على استحالة كونه محلاً للحوادث من ثلاثة أوجه: الدليل الأول: إن كل حادث فهو جائز الوجود، والقديم الأزلي واجب الوجود، ولو تطرق الجواز إلى صفاته لكان ذلك مناقضاً لوجوب وجوده فإن الجواز والوجوب يتناقضان. فكل ما هو واجب الذات فمن المحال أن يكون جائز
الصفات وهذا واضح بنفسه. الدليل الثاني: وهو الأقوى، أنه لو قدر حلول حادث بذاته لكان لا يخلو إما أن يرتقي الوهم إلى حادث يستحيل قبله حادث، أو لا يرتقي إليه، بل كان حادث، فيجوز أن يكون قبله حادث، فإن لم يرتق الوهم إليه لزم جواز اتصافه بالحوادث أبداً، ولزم منه حوادث لا أول لها. وقد قام الدليل على استحالته. وهذا القسم ما ذهب إليه أحد من العقلاء وإن ارتقى الوهم إلى حادث استحال قبله حدوث حادث فتلك الاستحالة لقبول الحادث في ذاته، لا تخلو إما أن تكون لذاته أو لزائد عليه. وباطل أن يكون لزائد عليه، فإن كل زائد يفرض ممكن تقدير عدمه، فيلزم منه تواصل الحوادث أبداً وهو محال، فلم يبق إلا أن استحالته من حيث أن واجب الوجود يكون على صفة يستحيل معها قبول الحوادث لذاته. فإذا كان ذلك مستحيلاً في ذاته أزلاً. فإن ذلك يبقى فيما لا يزال لأنه لذاته لا يقبل اللون باتفاق العقلاء. ولم يجز أن تتغير تلك الاستحالة إلى الجواز فكذلك سائر الحوادث. فإن قيل: هذا يبطل يحدث العالم، فإنه كان ممكناً قبل حدوثه ولم يكن الوهم يرتقي إلى وقت يستحيل حدوثه قبله ومع ذلك يستحيل حدوثه أزلاً ولم يستحل على الجملة حدوثه. قلنا هذا الإلزام فاسد؛ فإنا لم نحل إثبات ذات تنبو عن قبول حادث لكونها واجبة الوجود، ثم تتقلب إلى جواز قبول الحوادث. والعالم ليس له ذات قبل الحدوث موصوفة بأنها قابلة للحدوث أو غير قابلة حتى ينقلب إلى قبول جواز الحدوث، فيلزم ذلك على مساق دليلنا، نعم، يلزم ذلك المعتزلة حيث قالوا للعالم ذات في العدم قديمة، قابلة للحدوث، يطرأ عليها الحدوث بعد أن لم يكن، فأما على أصلنا فغير لازم، وإنما الذي نقوله في العالم أنه فعل وقدم الفعل محال، لأن القديم لا يكون فعلاً. الدليل الثالث: هو أنا نقول: إذا قدرنا قيام حادث بذاته فهو قبل ذلك إما أن يتصف بضد ذلك الحادث أو بالانفكاك عن ذلك الحادث. وذلك الضد أو ذلك الانفكاك إن كان قديماً استحال بطلانه وزواله لأن القديم لا يعدم وإن كان حادثاً كان قبله حادث لا محالة، وكذا قبل ذلك الحادث حادث يؤدي إلى حوادث لا أول لها وهو محال، ويتضح ذلك بأن تفرض في صفة معينة كالكلام مثلاً، فإن الكرامية قالوا إنه في الأزل متكلم، على معنى أنه قادر على خلق الكلام في ذاته. ومهما أحدث شيئاً في غير ذاته أحدث في ذاته قوله كن ولا بد أن يكون قبل إحداث هذا
القول ساكتاً، ويكون سكوته قديماً. وإذا قال جهم أنه يحدث في ذاته علماً فلا بد أن يكون قبله غافلاً وتكون غفلته قديمة. فنقول: السكوت القديم والغفلة القديمة يستحيل بطلانهما لما سبق من الدليل على استحالة عدم القديم. فإن قيل السكوت ليس بشيء إنما يرجع إلى عدم الكلام، والغفلة ترجع إلى عدم العلم والجهل وأضداده، فإذا وجد الكلام لم يبطل شيء إذ لم يكن شيء إلا الذات القديمة، وهي باقية، ولكن انضاف إليها موجود آخر وهو الكلام والعلم. فأما أن يقال: انعدم شيء فلان ويتنزل ذلك منزلة وجود العالم، فإنه يبطل العدم القديم ولكن العدم ليس بشيء حتى يوصف بالقدم ويقدر بطلانه. والواجب من وجهين أحدهما أن قول القائل السكوت هو عدم الكلام وليس بصفة والغفلة عدم العلم وليست بصفة، كقوله البياض هو عدم السواد وسائر الألوان وليس بلون. والسكون هو عدم الحركة وليس بعرض، وذلك محال. والدليل الذي دل على استحالته بعينه يدل على استحالة هذا، والخصوم في هذه المسألة معترفون بأن السكون وصف زائد على عدم الحركة، فإن كل من يدعي أن السكون هو عدم الحركة لا يقدر على اثبات حدوث العالم. فظهور الحركة بعد السكون إذاً دل على حدوث المتحرك، فكذلك ظهور الكلام بعد السكوت يدل على حدوث المتكلم، من غير فرق. إذ المسلك الذي به يعرف كون السكون معنى هو مضاد للحركة بعينه يعرف به كون السكوت معنى يضاد الكلام، وكون الغفلة معنى يضاد العلم، وهو أنا إذا أدركنا تفرقة بين حالتي الذات الساكنة والمتحركة فإن الذات مدركة على الحالتين. والتفرقة مدركة بين الحالتين ولا نرجع التفرقة إلى زوال أمر وحدوث أمر فإن الشيء لا يفارق نفسه، فدل ذلك على أن كل قابل للشيء فلا يخلو عنه، أو عن ضده وهذا مطرد في الكلام، وفي العلم. ولا يلزم على هذا الفرق بين وجود العلم وعدمه، فإن ذلك لا
يوجب ذاتين. فإنه لم تدرك في الحالتين ذات واحدة يطرأ عليها الوجود بل لا ذات للعالم قبل الحدوث، والقديم ذات قبل حدوث الكلام، علم على وجه مخالف للوجه الذي علم عليه بعد حدوث الكلام، يعبر عن ذلك الوجه بالسكوت وعن هذا بالكلام، فهما وجهان مختلفان أدركت عليهما ذات مستمرة الوجود في الحالتين وللذات هيئة وصفة وحالة بكونه ساكتاً، كما أن له هيئة بكونه متكلماً، وكما له هيئة بكونه ساكتاً ومتحركاً وأبيض وأسود وهذه الموازنة مطابقة لا مخرج منها. الوجه الثاني في الانفصال هو أن يسلم أيضاً أن السكوت ليس بمعنى، وإنما يرجع ذلك إلى ذات منفكة عن الكلام، فالانفكاك عن الكلام حال للمنفك لا محالة ينعدم بطريان الكلام، فحال الانفكاك تسمى عدماً أو وجوداً أو صفة أو هيئة، فقد انتفى الكلام والمنتفي قديم. وقد ذكرنا أن القديم لا ينتفي سواء كان ذاتاً أو حالاً أو صفة، وليست الاستحالة لكونه ذاتاً فقط بل لكونه قديماً، ولا يلزم عدم العالم، فإنه انتفى مع القديم لأن عدم العالم ليس بذات ولا حصل منه حال لذات حتى يقدر تغيرها وتبدلها على الذات والفرق بينهما ظاهر. فإن قيل الأعراض كثيرة والخصم لا يدعي كون الباري محل حدوث شيء منها كالألوان والآلام واللذات وغيرها، وإنما الكلام في الصفات السبعة التي ذكرتموها ولا نزاع من جملتها في الحياة والقدرة، وإنما النزاع في ثلاثة: في القدرة والإرادة والعلم، وفي معنى العلم السمع والبصر عند من يثبتهما. وهذه الصفات الثلاثة لا بد أن تكون حادثة، ثم يستحيل أن تقوم بغيره، لأنه لا يكون متصفاً بها فيجب أن تقوم بذاته فيلزم منه كونه محلاً للحوادث. أما العلم بالحوادث فقد ذهب جهم إلى أنها علوم حادثة وذلك لأن الله تعالى الآن عالم بأن العالم كان قد وجد قبل هذا، وهو في الأزل إن كان عالماً بأنه كان قد وجد كان هذا جهلاً لا علماً، وإذا لم يكن عالماً بأنه قد وجد كان جهلاً لا علماً، وإذا لم يكن عالماً وهو الآن عالم فقد ظهر حدوث العلم بأن العالم كان قد وجد قبل هذا. وهكذا القول في كل حادث. وأما الإرادة فلا بد من حدوثها فإنها لو كانت قديمة لكان المراد معها. فإن القدرة والارادة مهما تمتا وارتفعت العوائق منها وجب حصول المراد، فكيف يتأخر المراد عن الإرادة والقدرة من غير عائق؟ فلهذا قالت المعتزلة بحدوث إرادة في غير محل وقالت الكرامية بحدوثها في ذاته وربما عبروا عنه بأنه يخلق ايجاداً في ذاته عند وجود كل موجود وهذا راجع إلى الارادة.
وأما الكلام فكيف يكون قديماً وفيه إخبار عما مضى، فكيف قال في الأزل " إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه " ولم يكن قد خلق نوحاً بعد، وكيف قال في الأزل لموسى " فاخلع نعليك " ولم يخلق بعد موسى، فكيف أمر ونهى من غير مأمور ولا منهي. وإذا كان ذلك محالاً ثم علم بالضرورة أنه آمر وناه، واستحال ذلك في القدم، علم قطعاً أنه صار آمراً ناهياً بعد أن لم يكن، فلا معنى لكونه محلاً للحوادث إلا هذا. والجواب أنا نقول: مهما حللنا الشبهة في هذه الصفات الثلاثة انتهض منه دليل مستقل على إبطال كونه محلاً للحوادث، إذ لم يذهب إليه ذاهب إلا بسبب هذه الشبهة، وإذا انكشف كان القول بها باطلاً كالقول بأنه محل للألوان وغيرها مما لا يدل دليل على الاتصاف بها. فنقول: الباري تعالى في الأزل علم بوجود العالم في وقت وجوده وهذا العلم صفة واحدة مقتضاها في الأزل العلم بأن العالم يكون من بعد، وعند الوجود العلم بأنه كائن وبعده العلم بأنه كان، وهذه الأحوال تتعاقب على العالم ويكون مكشوفاً لله تعالى تلك الصفة وهي لم تتغير. وإنما المتغير أحوال العالم، وإيضاحه بمثال وهو أنا إذا فرضنا للواحد منا علماً بقدوم زيد عند طلوع الشمس وحصل له هذا العلم قبل طلوع الشمس ولم ينعدم بل بقي ولم يخلق له علم آخر عند طلوع الشمس فما حال هذا الشخص عند الطلوع،. أيكون عالماً بقدوم زيد أو غير عالم؟ ومحال أن يكون غير عالم لأنه قدر بقاء العلم بالقدوم عند الطلوع، وقد علم الآن الطلوع فيلزمه بالضرورة أن يكون عالماً بالقدوم، فلو دام عند انقضاء الطلوع فلا بد أن يكون عالماً بأن كان قد قدم والعلم الواحد أفاد الاحاطة بأنه سيكون وإنه كائن وأنه قد كان فهكذا ينبغي أن يفهم علم الله القديم الموجب بالاحاطة بالحوادث، وعلى هذا ينبغي أن يقال السمع والبصر، فإن كل واحد منهما صفة يتصف بها المرئي والمسموع عند الوجود من غير حدوث تلك الصفة ولا حدوث أمر فيها، وإنما الحادث المسموع والمرئي. والدليل القاطع على هذا هو أن الاختلاف بين الأحوال شيء واحد في انقسامه إلى الذي كان ويكون وهو كائن لا يزيد على الاختلاف بين الذوات المختلفة. ومعلوم أن العلم لا يتعدد بتعدد الذوات فكيف يتعدد بتعدد أحوال ذات واحدة. وإذا كان علم واحد يفيد الإحاطة بذوات مختلفة متباينة فمن أين يستحيل أن يكون علم واحد يفيد إحاطة بأحوال ذات واحدة بالاضافة إلى الماضي والمستقبل، ولا شك أن جهماً ينفي النهاية عن معلومات الله تعالى ثم لا يثبت علوماً لا نهاية لها فيلزمه أن يعترف بعلم واحد يتعلق بمعلومات مختلفة فكيف يستبعد ذلك في أحوال معلوم واحد يحققه أنه لو حدث له علم بكل حادث لكان ذلك العلم لا يخلو إما أن
يكون معلوماً أو غير معلوم، فإن لم يكن معلوماً فهو محال، لأنه حادث، وإن جاز حادث لا يعلمه مع أنه في ذاته أولى بأن يكون متضحاً له فبان يجوز ألا يعلم الحوادث المباينة لذاته أولى، وإن كان معلوماً فإما أن يفتقر إلى علم آخر وكذلك العلم يفتقر إلى علوم أخر لا نهاية لها، وذلك محال. وإما أن يعلم الحادث والعلم بالحادث نفس ذلك العلم فتكون ذات العلم واحدة ولها معلومان: أحدهما ذات، والآخر ذات الحادث، فيلزم منه لا محالة تجويز علم واحد يتعلق بمعلومين مختلفين فكيف لا يجوز علم واحد يتعلق بأحوال معلوم واحد مع اتحاد العلم وتنزهه عن التغير، وهذا لا مخرج منه؛ فأما الإرادة فقد ذكرنا أن حدوثها بغير إرادة أخرى محال، وحدوثها بإرادة بتسلسل إلى غير نهاية، وإن تعلق الإرادة القديمة بالأحداث غير محال. ويستحيل أن تتعلق الإرادة بالقديم فلم يكن العالم قديماً لأن الإرادة تعلقت باحداثه لا بوجوده في القدم. وقد سبق إيضاح ذلك. وكذلك الكرامي إذا قال يحدث في ذاته إيجاداً في حال حدوث العالم بذلك يحصل حدوث العالم في ذلك الوقت، فيحتاج إلى مخصص آخر فيلزمهم في الإيجاد ما لزم المعتزلة في الإرادة الحادثة، ومن قال منهم إن ذلك الإيجاد هو قوله كن، وهو صوت، فهو محال من ثلاثة أوجه، أحدها: استحالة قيام الصوت بذاته، والآخر: أن قوله كن حادث أيضاً، فإن حدث من غير أن يقول له كن فليحدث العالم من غير أن يقال له كن، فإن افتقر قوله كن في أن يكون، إلى قول آخر، افتقر القول الآخر إلى ثالث، والثالث إلى رابع، ويتسلسل إلى غير نهاية. ثم لا ينبغي أن يناظر من انتهى عقله إلى أن يقول يحدث في ذاته بعدد كل حادث في كل وقت، قوله كن فيجتمع آلاف آلاف أصوات في كل لحظة. ومعلوم أن النون والكاف لا يمكن النطق بهما في وقت واحد بل ينبغي أن تكون النون بعد الكاف لأن الجمع بين الحرفين محال وإن جمع ولم يرتب لم يكن قولاً مفهوماً ولا كلاماً، وكما يستحيل الجمع بين حرفين مختلفين فكذلك بين حرفين متماثلين، ولا يعقل في أوان ألف ألف كاف كما لا يعقل الكاف والنون فهؤلاء حقهم أن يسترزقوا الله عقلاً وهو أهم لهم من الاشتغال بالنظر. والثالث: أن قوله كن خطاب مع العالم في حالة العدم أو في حالة الوجود، فإن كان في حالة العدم فالمعدوم لا يفهم الخطاب، فكيف يمتثل بأن يتكون بقوله كن؟ وإن كان في حالة الوجود فالكائن كيف يقال له كن؟ فانظر ماذا يفعل الله تعالى بمن ضل عن سبيله فقد انتهى ركاكة عقله إلى أن لا يفهم المعني بقوله تعالى " إذا أردناه أن نقول له كن فيكون " وأنه كناية عن نفاذ القدرة وكمالها حتى انجر بهم إلى هذه المخازي، نعوذ بالله من الخزي والفضيحة يوم الفزع الأكبر يوم تكشف الضمائر وتبلى السرائر فيكشف إذ ذاك ستر الله عن خبائث الجهال، ويقال للجاهل الذي اعتقد في الله تعالى وفي صفاته غير الرأي السديد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. انتهى عقله إلى أن يقول يحدث في ذاته بعدد كل حادث في كل وقت، قوله كن فيجتمع آلاف آلاف أصوات في كل لحظة. ومعلوم أن النون والكاف لا يمكن النطق بهما في وقت واحد بل ينبغي أن تكون النون بعد الكاف لأن الجمع بين الحرفين محال وإن جمع ولم يرتب لم يكن قولاً مفهوماً ولا كلاماً، وكما يستحيل الجمع بين حرفين مختلفين فكذلك بين حرفين متماثلين، ولا يعقل في أوان ألف ألف كاف كما لا يعقل الكاف والنون فهؤلاء حقهم أن يسترزقوا الله عقلاً وهو أهم لهم من الاشتغال بالنظر. والثالث: أن قوله كن خطاب مع العالم في حالة العدم أو في حالة الوجود، فإن كان في حالة العدم فالمعدوم لا يفهم الخطاب، فكيف يمتثل بأن يتكون بقوله كن؟ وإن كان في حالة الوجود فالكائن كيف يقال له كن؟ فانظر ماذا يفعل الله تعالى
بمن ضل عن سبيله فقد انتهى ركاكة عقله إلى أن لا يفهم المعني بقوله تعالى " إذا أردناه أن نقول له كن فيكون " وأنه كناية عن نفاذ القدرة وكمالها حتى انجر بهم إلى هذه المخازي، نعوذ بالله من الخزي والفضيحة يوم الفزع الأكبر يوم تكشف الضمائر وتبلى السرائر فيكشف إذ ذاك ستر الله عن خبائث الجهال، ويقال للجاهل الذي اعتقد في الله تعالى وفي صفاته غير الرأي السديد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وأما الكلام فهو قديم، وما استبعدوه من قوله تعالى " فاخلع نعليك " ومن قوله تعالى " إنا أرسلنا نوحاً " استبعاد مستنده تقديرهم الكلام صوتاً وهو محال فيه، وليس بمحال إذ فهم كلام النفس. فإنا نقول يقوم بذات الله تعالى خبر عن إرسال نوح العبارة عنه قبل إرساله: إنا نرسله، وبعد إرساله: إنا أرسلنا، واللفظ يختلف باختلاف الأحوال والمعنى القائم بذاته تعالى لا يختلف، فإن حقيقته أنه خبر متعلق بمخبر ذلك الخبر هو إرسال نوح في الوقت المعلوم وذلك لا يختلف باختلاف الأحوال كما سبق في العلم، وكذلك قوله اخلع نعليك لفظة تدل على الأمر والأمر اقتضاء وطلب يقوم بذات الأمر وليس شرط قيامه به أن يكون المأمور موجوداً ولكن يجوز أن يقوم بذاته قبل وجود المأمور، فإذا وجد المأمور كان مأموراً بذلك الاقتضاء بعينه من غير تحدد اقتضاء آخر. وكم من شخص ليس له ولد ويقوم بذاته اقتضاء طلب العلم منه على تقدير وجوده، إذ يقدر في نفسه أن يقول لولده اطلب العلم وهذا الاقتضاء يتنجز في نفسه على تقدير الوجود، فلو وجد الولد وخلق له عقل وخلق له علم بما في نفس الأب من غير تقدير صياغة لفظ مسموع، وقدر بقاء ذلك الاقتضاء على وجوده لعلم الابن أنه مأمور من جهة الأب بطلب العلم في غير استئناف اقتضاء متجدد في النفس، بل يبقى ذلك الاقتضاء نعم العادة جارية بأن الابن لا يحدث له علم إلا بلفظ يدل على الاقتضاء الباطن، فيكون قوله بلسانه أطلب العلم، دلالة على الاقتضاء الذي في ذاته سواء حدث في الوقت أو كان قديماً بذاته قبل وجود ولده. فهكذا ينبغي أن يفهم قيام الأمر بذات الله تعالى فتكون الألفاظ الدالة عليه حادثة والمدلول قديماً ووجود ذلك المدلول لا يستدعي وجود المأمور بل تصور وجوده مهما كان المأمور مقدر الوجود، فإن كان مستحيل الوجود ربما لا يتصور وجود الاقتضاء ممن يعلم استحالة وجوده. فلذلك لا نقول إن الله تعالى يقوم بذاته اقتضاء فعل ممن يستحيل وجوده، بل ممن علم وجوده، وذلك غير محال. فإن قيل أفتقولون إن الله تعالى في الأزل آمر وناه، فإن قلتم أنه آمر فكيف يكون آمر لا مأمور له؟ وإن قلتم لا فقد صار آمراً بعد أن لم يكن.
قلنا: واختلف الأصحاب في جواب هذا، والمختار أن تقول هذا نظر يتعلق أحد طرفيه بالمعنى والآخر بإطلاق الاسم من حيث اللغة. فأما حظ المعنى فقد انكشف وهو أن الاقتضاء القديم معقول وإن كان سابقاً على وجود المأمور كما في حق الولد ينبغي أن يقال اسم الأمر ينطلق عليه بعد فهم المأمور ووجوده أم ينطلق عليه قبله؟ وهذا أمر لفظي لا ينبغي للناظر أن يشتغل بأمثاله، ولكن الحق أنه يجوز اطلاقه عليه كما جوزوا تسمية الله تعالى قادراً قبل وجود المقدور، ولم يستبعدوا قادراً ليس له مقدور موجود بل قالوا القادر يستدعي مقدوراً معلوماً لا موجوداً فكذلك الآمر يستدعي مأموراً معلوماً موجوداً والمعدوم معلوم الوجود قبل الوجود، بل يستدعي الأمر مأموراً به كما يستدعي مأموراً ويستدعي آمراً أيضاً والمأمور به يكون معدوماً ولا يقال إنه كيف يكون آمر من غير مأمور به، بل يقال له مأمور به هو معلوم وليس يشترط كونه موجوداً، بل يشترط كونه معدوماً بل من أمر ولده على سبيل الوصية بأمر ثم توفي فأتى الولد بما أوصي به يقال امتثل أمر والده والأمر معدوم والأمر في نفسه معدوم ونحن مع هذا نطلق اسم امتثال الأمر، فإذا لم يستبعد كون المأمور ممتثلاً للأمر ولا وجود للأمر ولا للآمر ولم يستبعد كون الأمر أمراً قبل وجود المأمور به، فمن أين يستدعي وجود المأمور؟ فقد انكشف من هذا حظ اللفظ والمعنى جميعاً ولا نظر إلا فيهما. فهذا ما أردنا أن نذكره في استحالة كونه محلاً للحوادث إجمالاً وتفصيلاً. الحكم الرابع إن الأسامي المشتقة لله تعالى من هذه الصفات السبعة صادقة عليه أزلاً وأبداً، فهو في القدم كان حياً قادراً عالماً سميعاً بصيراً متكلماً، وأما ما يشتق له من الأفعال كالرازق والخالق والمعز والمذل فقد اختلف في أنه يصدق في الأزل أم لا. وهذا إذا كشف الغطاء عنه تبين استحالة الخلاف فيه. والقول الجامع أن الأسامي التي يسمى بها الله تعالى أربعة: الأول: أن لا يدل إلا على ذاته كالموجود، وهذا صادق أزلاً وأبداً. الثاني: ما يدل على الذات مع زيادة سلب كالقديم، فإنه يدل على وجود غير مسبوق بعدم أزلاً، والباقي فإنه يدل على الوجود وسلب العدم عنه آخراً وكالواحد فإنه يدل على الوجود وسلب الشريك، وكالغنى فإنه يدل على الوجود وسلب الحاجة فهذا أيضاً يصدق أزلاً وأبداً لأن ما يسلب عنه يسلب لذاته فيلازم الذات على الدوام.
الثالث: ما يدل على الوجود وصفة زائدة من صفات المعنى كالحي والقادر والمتكلم والمريد والسميع والبصير والعالم وما يرجع إلى هذه الصفات السبعة كالآمر والناهي والخبير ونظائره، فذلك أيضاً يصدق عليه أزلاً وأبداً عند من يعتقد قدم جميع الصفات. الرابع: ما يدل على الوجود مع إضافة إلى فعل من أفعاله كالجواد والرزاق والخالق والمعز والمذل وأمثاله، وهذا مختلف فيه، فقال قوم هو صادق أزلاً إذ لو لم يصدق لكان اتصافه به موجباً للتغير وقال قوم لا يصدق إذ لا خلق في الأزل فكيف خالقاً. والكاشف للغطاء عن هذا أن السيف في الغمد يسمى صارماً وعند حصول القطع به وفي تلك الحالة على الاقتران يسمى صارماً، وهما بمعنيين مختلفين، فهو في الغمد صارم بالقوة وعند حصول القطع صارم بالفعل وكذلك الماء في الكوز يسمى مروياً وعند الشرب يسمى مروياً وهما إطلاقان مختلفان فمعنى تسمية السيف في الغمد صارماً أن الصفة التي يحصل بها القطع في الحال لقصور في ذات السيف وحدته واستعداده بل لأمر آخر وراء ذاته. فبالمعنى الذي يسمى السيف في الغمد صارماً يصدق اسم الخالق على الله تعالى في الأزل فإن الخلق إذ أجري بالفعل لم يكن لتجدد أمر في الذات لم يكن، بل كل ما يشترط لتحقيق الفعل موجود في الأزل. وبالمعنى الذي يطلق حالة مباشرة القطع للسيف اسم الصارم لا يصدق في الأزل فهذا حظ المعنى. فقد ظهر أن من قال إنه لا يصدق في الأزل هذا الاسم فهو محق وأراد به المعنى الثاني، ومن قال يصدق في الأزل فهو محق وأراد به المعنى الأول. وإذا كشف الغطاء على هذا الوجه ارتفع الخلاف. فهذا تمام ما أردنا ذكره في قطب الصفات وقد اشتمل على سبعة دعاو، وتفرع عن صفة القدرة ثلاثة فروع، وعن صفة الكلام خمسة استبعادات، واجتمع من الأحكام المشتركة بين الصفات أربعة أحكام، فكان المجموع قريباً من عشرين دعوى هي أصول الدعاوى وإن كان تنبني كل دعوى على دعاوى بها يتوصل إلى اثباتها فلنشتغل بالقطب الثالث من الكتاب إن شاء الله تعالى.
القطب الثالث في أفعال الله تعالى وجملة أفعال جائزة لا يوصف شيء منها بالوجوب وندعي في هذا القطب سبعة أمور: ندعي أنه يجوز لله تعالى أن لا يكلف عباده، وأنه يجوز أن يكلفهم ما لا يطاق، وأنه يجوز منه إيلام العباد بغير عوض وجناية؛ وأنه لا يجب رعاية الأصلح لهم، وأنه لا يجب عليه ثواب الطاعة وعقاب المعصية، وأن العبد لا يجب عليه شيء بالعقل بل بالشرع، وأنه لا يجب على الله بعثه الرسل، وأنه لو بعث لم يكن قبيحاً ولا محالاً بل أمكن اظهار صدقهم بالمعجزة، وجملة هذه الدعاوى تنبني على البحث عن معنى الواجب والحسن والقبيح، ولقد خاض الخائضون فيه وطولوا القول في أن العقل هل يحسن ويقبح وهل يوجب. وإنما كثر الخبط لأنهم لم يحصلوا معنى هذه الألفاظ واختلافات الاصطلاحات فيها وكيف تخاطب خصمان في أن العقل واجب وهما بعد لم يفهما معنى الواجب، فهما محصلاً متفقاً عليه بينهما، فلنقدم البحث عن الاصطلاحات ولا بد من الوقوف على معنى ستة ألفاظ وهي: الواجب، والحسن، والقبيح، والعبث، والسفه، والحكمة؛ فإن هذه الألفاظ مشتركة ومثار الأغاليط إجمالها، والوجه في أمثال هذه المباحث أن نطرح الألفاظ ونحصل المعاني في العقل بعبارات أخرى ثم نلتفت إلى الألفاظ المبحوث عنها وننظر إلى تفاوت الاصطلاحات فيها، فنقول: أما الواجب فإنه يطلق على فعل لا محالة، ويطلق على القديم إنه واجب، وعلى الشمس إذا غربت إنها واجبة، وليس من غرضنا. وليس يخفى أن الفعل الذي لا يترجح فعله على تركه ولا يكون صدوره من صاحبه أولى من تركه لا يسمى واجباً وإن ترجح وكان أولاً لا يسميه أيضاً بكل ترجيح بل لا بد من خصوص ترجيح. ومعلوم أن الفعل قد يكون بحيث يعلم أنه يعلم أنه نستعقب تركه ضرراً، أو يتوهم، وذلك الضرر إما عاجل في الدنيا وإما آجل في العاقبة، وهو إما قريب محتمل وإما عظيم لا يطاق مثله. فانقسام الفعل ووجوه ترجحه لهذه الأقسام ثابت في العقل من غير لفظ
فلنرجع إلى اللفظ فنقول: معلوم أن ما فيه ضرر قريب محتمل لا يسمى واجباً؛ إذ العطشان إذا لم يبادر إلى شرب الماء تضرر تضرراً قريباً ولا يقال إن الشرب عليه واجب. ومعلوم أن ما لا ضرر فيه أصلاً ولكن في فعله فائدة لا يسمى واجباً، فإن التجارة واكتساب المال والنوافل فيه فائدة ولا يسمى واجباً، بل المخصوص باسم الواجب ما في تركه ضرر ظاهر فإن كان ذلك في العاقبة أعني الآخرة، وعرف بالشرع فنحن نسميه واجباً، وإن كان ذلك في الدنيا وعرف بالعقل فقد يسمى أيضاً ذلك واجباً، فإن من لا يعتقد الشرع قد يقول واجب على الجائع الذي يموت من الجوع أن يأكل إذا وجد الخبز ونعني بوجوب الأكل ترجح فعله على تركه بما يتعلق من الضرر بتركه، ولسنا نحرم هذا الاصطلاح بالشرع فإن الاصطلاحات مباحة لا حجر فيها للشرع ولا للعقل، وإنما تمنع منه اللغة إذا لم يكن على وفق الموضوع المعروف فقد تحصلنا على معنيين للواجب ورجع كلاهما إلى التعرض للضرر وكان أحدهما أعم لا يختص بالآخرة، والآخر أخص وهو اصطلاحنا، وقد يطلق الواجب بمعنى ثالث وهو الذي يؤدي عدم وقوعه إلى أمر محال، كما يقال: ما علم وقوعه فوقوعه واجب، ومعناه أنه إن لم يقع يؤدي إلى أن ينقلب العلم جهلاً وذلك محال، فيكون معنى وجوبه أن ضده محال، فليسم هذا المعنى الثالث الواجب. وأما الحسن فحظ المعنى منه أن الفعل في حق الفاعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام أحدها أن توافقه أي تلائم غرضه، والثاني أن ينافر غرضه، والثالث أن لا يكون له في فعله ولا في تركه غرض. وهذا الانقسام ثابت في العقل؛ فالذي يوافق الفاعل يسمى حسناً في حقه ولا معنى لحسنه إلا موافقته لغرضه، والذي ينافي غرضه يسمى قبيحاً ولا معنى لقبحه إلا منافاته لغرضه، والذي لا ينافي ولا يوافق يسمى عبثاً أي لا فائدة فيه أصلاً، وفاعل العبث يسمى عابثاً وربما يسمى سفيهاً، وفاعل القبيح أعني الفعل الذي ينضر به يسمى سفيهاً واسم السفيه أصدق منه على العابث، وهذا كله إذا لم يلتفت إلى غير الفاعل أو لم يرتبط الفعل بغرض غير الفاعل، فإن ارتبط بغير الفاعل وكان موافقاً لغرضه سمي حسناً في حق من وافقه وإن كان منافياً سمي قبيحاً، وإن كان موافقاً لشخص دون شخص سمي في حق أحدهما حسناً وفي حق الآخر قبيحاً إذ اسم القبيح والحسن بأن الموافقة والمخالفة، وهما أمران إضافيان، مختلفان بالأشخاص ويختلف في حق شخص واحد بالأحوال ويختلف في حال واحد بالأعراض؛ فرب فعل يوافق الشخص من وجه ويخالفه من وجه فيكون حسناً من وجه قبيحاً من وجه، فمن لا ديانة له
يستحسن الزنا بزوجة الغير ويعد الظفر بها نعمة ويستقبح فعل الذي يكشف عررته ويسميه غمازاً قبيح الفعل والمتدين يسميه محتسباً حسن الفعل، وكل بحسب غرضه يطلق اسم الحسن والقبح بل يقتل ملك من الملوك فيستحسن فعل القاتل جميع أعدائه ويستقبحه جميع أوليائه، بل هذا القاتل في الحسن المخصوص جار، ففي الطباع ما خلق مايلاً من الألوان الحسان إلى السمرة، فصاحبه يستحسن الأسمر ويعشقه، والذي خلق مايلاً إلى البياض المشرب بالحمرة يستقبحه ويستكرهه ويسفه عقل المستحسن المستهتر به؛ فبهذا يتبين على القطع أن الحسن والقبيح عبارتان عن الخلق كلهم عن أمرين إضافيين يختلفان بالإضافات عن صفات الذوات التي لا تختلف بالإضافة. فلا جرم جاز أن يكون الشيء حسناً في حق زيد قبيحاً في حق عمرو ولا يجوز أن يكون الشيء أسود في حق زيد أبيض في حق عمرو لما لم تكن الألوان من الأوصاف الإضافية؛ فإذا فهمت المعنى فافهم أن الاصطلاح في لفظ الحسن أيضاً ثلاثة: فقائل يطلقه على كل ما يوافق الغرض عاجلاً كان أو آجلاً؛ وقائل يخصص بما يوافق الغرض في الآخر وهو الذي حسنه الشرع أي حث عليه ووعد بالثواب عليه وهو اصطلاح أصحابنا، والقبيح عند كل فريق ما يقابل الحسن، فالأول أعم وهذا أخص، وبهذا الاصطلاح قد يسمي بعض من لا يتحاشى فعل الله تعالى قبيحاً إذ كان لا يوافق غرضهم، ولذلك تراهم يسبون الفلك والدهر ويقولون خرف الفلك وما أقبح أفعاله ويعلمون إن الفاعل خالق الفلك؛ ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر، فإن الله هو الدهر؛ وفيه اصطلاح ثالث إذ قد يقال فعل الله تعالى حسن كيف كان مع إنه لا غرض في حقه؛ ويكون معناه أنه لا تبعة عليه فيه ولا لائمة وأنه فاعل في ملكه الذي لا يساهم فيه ما يشاء. وأما الحكمة فتطلق على معنيين: أحدهما الاحاطة المجردة بنظم الأمور ومعانيها الدقيقة والجليلة والحكم عليها بأنها كيف ينبغي أن تكون حتى تتم منها الغاية المطلوبة بها، والثاني أن تنضاف إليه القدرة على إيجاد الترتيب والنظام واتقانه وإحكامه
فيقال حكيم من الحكمة، وهو نوع من العلم، ويقال حكيم من الأحكام وهو نوع من الفعل، فقد اتضح لك معنى هذه الألفاظ في الأصل ولكن ههنا ثلاث غلطات للوهم يستفاد من الوقوف عليها الخلاص من إشكالات تغتر بها طوائف كثيرة: الغلطة الأولى: أن الإنسان قد يطلق اسم القبيح على ما يخالف غرضه وإن كان يوافق غرض غيره، ولكنه لا يلتفت إلى الغير، فكل طبع مشغوف بنفسه ومستحقر ما عداه ولذلك يحكم على الفعل مطلقاً بأنه قبيح وقد يقول أنه قبيح في عينه، وسببه أنه قبيح في حقه بمعنى أنه مخالف لغرضه، ولكن أغراضه كأنه كل العالم في حقه فيتوهم أن المخالف لحقه مخالف في نفسه، فيضيف القبح إلى ذات الشيء ويحكم بالاطلاق؛ فهو مصيب في أصل الاسقباح ولكنه مخطيء في حكمه بالقبح على الاطلاق؛ وفي إضافة القبح إلى ذات الشيء ومنشؤه غفلته عن الالتفات إلى غيره، بل عن الالتفات إلى بعض أحوال نفسه، فإنه قد يستحسن في بعض أحواله غير ما يستقبحه مهما انقلب موافقاً لغرضه. الغلطة الثانية فيه: أن ما هو مخالف للأغراض في جميع الأحوال إلا في حالة نادرة، فقد يحكم الإنسان عليه مطلقاً بأنه قبيح لذهوله عن الحالة النادرة ورسوخ غالب الأحوال في نفسه واستيلائه على ذكره، فيقضي مثلاً على الكذب بأنه قبيح مطلقاً في كل حال وأن قبحه لأنه كذب لذاته فقط لا لمعنى زائد، وسبب ذلك غفلته عن ارتباط مصالح كثيرة بالكذب في بعض الأحوال، ولكن لو وقعت تلك الحالة ربما نفر طبعه عن استحسان الكذب لكثرة إلفه باستقباحه، وذلك لأن الطبع ينفر عنه من أول الصبا بطريق التأديب والاستصلاح، ويلقي إليه أن الكذب قبيح في نفسه وأنه لا ينبغي أن يكذب قط، فهو قبيح ولكن بشرط يلازمه في أكثر الأوقات وإنما يقع نادراً، فلذلك لا ينبه على ذلك الشرط ويغرس في طبعه قبحه والتنفير عنه مطلقاً. الغلطة الثالثة: سبق الوهم إلى العكس، فإن ما رئي مقروناً بالشيء يظن أن الشيء أيضاً لا محالة يكون مقروناً به مطلقاً ولا يدري أن الأخص أبداً يكون مقروناً بالأعم، وأما الأعم فلا يلزم أن يكون مقروناً بالأخص. ومثاله ما يقال من أن السليم، أعني الذي نهشته الحية، يخاف من الحبل المبرقش اللون، وهو كما قيل، وسببه أنه أدرك المؤذي وهو متصور بصورة حبل مبرقش، فإذا أدرك الحبل سبق الوهم إلى العكس وحكم بأنه مؤذ فينفر الطبع تابعاً للوهم والخيال وإن كان العقل مكذباً به، بل الانسان قد ينفر عن أكل الخبيض الأصفر لشبهه بالعذرة، فيكاد يتقيأ عند قول القائل إنه عذرة، يتعذر عليه تناوله مع كون العقل مكذباً به، وذلك لسبق الوهم إلى العكس فإنه أدرك المستقذر رطباً أضفر فإذا رأى الرطب الأصفر حكم بأنه
مستقذر، بل في الطبع ما هو أعظم من هذا فإن الأسامي التي تطلق عليها الهنود والزنوج لما كان يقترن قبح المسمى به يؤثر في الطبع ويبلغ إلى حد لو سمى به أجمل الأتراك والروم لنفر الطبع عنه، لأنه أدرك الوهم القبيح مقروناً بهذا الاسم فيحكم بالعكس، فإذا أدرك الأسم حكم بالقبح على المسمى ونفر الطبع. وهذا مع وضوحه للعقل فلا ينبغي أن يغفل عنه لأن إقدام الخلق وإحجامهم في أقوالهم وعقائدهم وأفعالهم تابع لمثل هذه الأوهام. وأما اتباع العقل الصرف فلا يقوى عليه إلا أولياء الله تعالى الذين أراهم الله الحق حقاً وقواهم على اتباعه، وإن أردت أن تجرب هذا في الاعتقادات فأورد على فهم العامي المعتزلي مسألة معقولة جلية فيسارع إلى قبولها، فلو قلت له إنه مذهب الأشعري رضي الله عنه لنفر وامتنع عن القبول وانقلب مكذباً بعين ما صدق به مهما كان سيء الظن بالأشعري، إذ كان قبح ذلك في نفسه منذ الصبا. وكذلك تقرر أمراً معقولاً عند العامي الأشعري ثم تقول له إن هذا قول المعتزلي فينفر عن قبوله بعد التصديق ويعود لي التكذيب. ولست أقول هذا طبع العوام بل طبع أكثر من رأيته من المتوسمين باسم العلم؛ فإنهم لم يفارقوا العوام في أصل التقليد بل أضافوا إلى تقليد المذهب تقليد الدليل فهم في نظرهم لا يطلبون الحق بل يطلبون طريق الحيلة في نصرة ما اعتقدوه حقاً بالسماع والتقليد، فإن صادفوا في نظرهم ما يؤكد عقائدهم قالوا قد ظفرنا بالدليل، وإن ظهر لهم ما يضعف مذهبهم قالوا قد عرضت لنا شبهة، فيضعون الاعتقاد المتلقف بالتقليد أصلاً وينبزون بالشبهة كل ما يخالفه، وبالدليل كلى ما يوافقه، وإنما الحق ضده؛ وهو أن لا يعتقد شيئاً أصلاً وينظر إلى الدليل ويسمي مقتضاه حقاً ونقيضه باطلاً وكل ذلك منشؤه الاستحسان والاستقباح بتقديم الإلفه والتخلق بأخلاق منذ الصبا. فإذا وقفت على هذه المثارات سهل عليك دفع الاشكالات. فإن قيل: فقد رجع كلامكم إلى أن الحسن والقبيح يرجعان إلى الموافقة والمخالفة للأغراض، ونحن نرى العاقل يستحسن ما لا فائدة له فيه ويستقبح ما له فيه فائدة. أما الاستحسان فمن رأى إنساناً أو حيواناً مشرفاً على الهلاك استحسن إنقاذه ولو بشربة ماء معأنه ربما لا يعتقد الشرع ولا يتوقع منه غرضاً في الدنيا ولا هو بمرآى من الناس حتى ينتظر عليه ثناء بل يمكن أن يقدر انتفاء كل غرض ومع ذلك يرجح جهة الانقاذ على جهة الاهمال بتحسين هذا وتقبيح ذلك. وأما الذي يستقبح مع الأغراض، كالذي يحمل على كلمة الكفر بالسيف والشرع قد رخص له في اطلاقها، فإنه قد يستحسن منه الصبر على السيف وترك النطق به. أو الذي لا يعتقد الشرع وحمل بالسيف على نقض عهد، ولا ضرر عليه في نقضه وفي
الوفاء به هلاكه، فإنه يستحسن الوفاء بالعهد والامتناع من النقض. فبان أن الحسن والقبح معنى سوى ما ذكرتموه. والجواب أن في الوقوف على الغلطات المذكورة ما يشفي هذا الغليل. أما ترجيح الانقاذ على الاهمال في حق من لا يعتقد الشرع فهو دفع للأذى الذي يلحق الانسان في رقة الجنسية، وهو طبع يستحيل الانفكاك عنه. ولأن الانسان يقدر نفسه في تلك البلية ويقدر غيره قادراً على انقاذه مع الإعراض عنه، ويجد من نفسه استقباح ذلك فيعود عليه ويقدر ذلك من المشرف على الهلاك في حق نفسه فينفره طبعه عما يعتقده من أن المشرف على الهلاك في حقه، فيندفع ذلك عن نفسه بالانقاذ، فإن فرض ذلك في بهيمة لا يتوهم استقباحها أو فرض في شخص لا رقة فيه ولا رحمة فهذا مجال تصوره، إذ الانسان لا ينفك عنه فإن فرض على الاستحالة فيبقى أمر آخر وهو الثناء بحسن الخلق والشفقة على الخلق، فإن فرض حيث لا يعلمه أحد فهو ممكن أن يعلمه، فإن فرض في موضع يستحيل أن يعلم فيبقى أيضاً ترجيح في نفسه وميل يضاهي نفرة طبع السليم عن الخبل، وذلك أنه رأى الثناء مقروناً بمثل هذا الفعل على الاطراد، وهو يميل إلى الثناء فيميل إلى المقرون به. وإن علم بعقله عدم الثناء. كما إنه لما رأى الأذى مقروناً بصورة الخبل. وطبعه ينفر عن الأذى فينفر عن المقرون به، وإن علم بعقله عدم الأذى بل الطبع إذا رأى من يعشقه في موضع وطال معه أنسه فيه فإنه يحس من نفسه تفرقة بين ذلك الموضع وحيطانه وبين سائر المواضع ولذلك قال الشاعر: تصوره، إذ الانسان لا ينفك عنه فإن فرض على الاستحالة فيبقى أمر آخر وهو الثناء بحسن الخلق والشفقة على الخلق، فإن فرض حيث لا يعلمه أحد فهو ممكن أن يعلمه، فإن فرض في موضع يستحيل أن يعلم فيبقى أيضاً ترجيح في نفسه وميل يضاهي نفرة طبع السليم عن الخبل، وذلك أنه رأى الثناء مقروناً بمثل هذا الفعل على الاطراد، وهو يميل إلى الثناء فيميل إلى المقرون به. وإن علم بعقله عدم الثناء. كما إنه لما رأى الأذى مقروناً بصورة الخبل. وطبعه ينفر عن الأذى فينفر عن المقرون به، وإن علم بعقله عدم الأذى بل الطبع إذا رأى من يعشقه في موضع وطال معه أنسه فيه فإنه يحس من نفسه تفرقة بين ذلك الموضع وحيطانه وبين سائر المواضع ولذلك قال الشاعر: أمر على جدار ديار ليلى ... أقبل ذا الجدار وذا الجدارا وما تلك الديار شغفن قلبي ... ولكن حب من سكن الديارا وقال ابن الرومي منبهاً على سبب حب الناس الأوطان ونعم ما قال: وحبّب أوطان الرجال إليهم ... مآرب قضاها الشباب هنالكا إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم ... عهود الصبا فيها فحنوا لذلكا وإذا تتبع الانسان الأخلاق والعادات رأى شواهد هذا خارجة عن الحصر، فهذا هو السبب الذي هو غلط المغترين بظاهر الأمور، الذاهلين عن أسرار أخلاق النفوس، الجاهلين بأن هذا الميل وأمثاله يرجع إلى طاعة النفس بحكم الفطرة والطبع بمجرد الوهم. والخيال الذي هو غلط يحكم العقل ولكن خلقت قوى النفس مطيعة للأوهام والتخيلات بحكم اجراء العادات، حتى إذا تخيل الإنسان طعاماً طيباً بالتذكر أو بالرؤية سال في الحال لعابه وتحلبت أشداقه، وذلك بطاعة القوة التي سخرها الله تعالى لإفاضة اللعاب المعين على المضغ للتخيل والوهم، فإن شأنها أن تنبعث بحسب التخيل وإن
كان الشخص عالماً بأنه ليس يريد الإقدام على الأكل بصوم أو بسبب آخر وكذلك يتخيل الصورة الجميلة التي يشتهي مجامعتها، فكما ثبت ذلك في الخيال انبعثت القوة الناشرة لآلة الفعل وساقت الرياح إلى تجاويف الأعصاب وملأتها، وثارت القوة المأمورة بصب المذي الرطب المعين على الوقاع، وذلك كله مع التحقيق بحكم العقل للامتناع عن الفعل في ذلك الوقت. ولكن الله تعالى خلق هذه القوى بحكم طرد العادة مطيعة مسخرة تحت حكم الخيال، والوهم ساعد العقل الوهم أو لم يساعده، فهذا وأمثاله منشأ الغلط في سبب ترجيح أحد جانبي الفعل على الآخر. وكل ذلك راجع إلى الأغراض، فأما النطق بكلمة الكفر وإن كان كذلك فلا يستقبحه العاقل تحت السيف البتة بل ربما يستقبح الاصرار، فإن استحسن الاصرار فله سببان: أحدهما، اعتقاده أن الثواب على الصبر والاستسلام أكثر، والآخر، ما ينتظر من من الثناء عليه بصلابته في الدين، فكم من شجاع يمتطي متن الخطر ويتهجم على عدد يعلم أنه لا يطيقهم ويستحقر ما يناله بما يعتاضه عنه من لذة الثناء والحمد بعد موته وكذلك الامتناع عن نقض العهد بسببه ثناء الخلق على من يفي بالعهد، وتواصيهم به على مر الأوقات لما فيها من مصالح الناس. فإن قدر حيث لا ينتظر ثناء فسببه حكم الوهم من حيث أنه لم يزل مقروناً بالثناء الذي هو لذيذ، والمقرون باللذيذ لذيذ، كما أن المقرون بالمكروه مكروه كما سبق في الأمثلة، فهذا ما يحتمله هذا المختصر من بث أسرار هذا الفصل، وإنما يعرف قدره من طال في المعقولات نظره، وقد استفدنا بهذه المقدمة إيجاز الكلام في الدعاوى فلنرجع إليها. الدعوى الأولى: ندعي أنه يجوز لله تعالى أن لا يخلق الخلق، وإذا خلق فلم يكن ذلك واجباً عليه، وإذا خلقهم فله أن لا يكلفهم، وإذا كلفهم فلم يكن ذلك واجباً عليه. وقالت طائفة من المعتزلة يجب عليه الخلق والتكليف واجب، غير مفهوم؛ فإنا بينا أن المفهوم عندنا من لفظ الواجب ما ينال تاركه ضرر، إما عاجلاً وإما آجلاً، أو ما يكون نقيضه محال، والضرر محال في حق الله تعالى. وليس في ترك التكليف وترك الخلق لزوم محال، إلا أن يقال كان يؤدي ذلك إلى خلاف ما سبق به العلم في الأزل وما سبقت به المشيئة في الأزل، فهذا حق وهو بهذا التأويل واجب، فإن الإرادة
إذا فرضت موجودة، أو العلم إذا فرض متعلقاً بالشيء، كان حصول المراد والمعلوم واجباً لا محالة. فإن قيل: إنما يجب عليه ذلك لفائدة الخلق لا لفائدة ترجع إلى الخالق سبحانه وتعالى، قلنا: الكلام في قولكم لفائدة الخلق للتعليل، والحكم المعلل هو الوجوب، ونحن نطالبكم بتفهيم الحكم فلا يعنيكم ذكر العلة؛ فما معنى قولكم إنه يجب لفائدة الخلق وما معنى الوجوب ونحن لا نفهم من الوجوب إلا المعاني الثلاثة، وهي منعدمة، فإن أردتم معنى رابعاً ففسروه أولاً ثم اذكروا علته، فإنا ربما لا ننكر أن للخلق في الخلق فائدة، وكذا في التكليف، ولكن ما فيه فائدة غيره لم يجب عليه إذا لم يكن له فائدة في فائدة غيره. وهذا لا مخرج عنه أبداً، على أنا نقول إنما يستقيم هذا الكلام في الخلق لا في التكليف، ولا يستقيم في هذا الخلق الموجود بل في أن يخلقهم في الجنة متنعمين، من غير هم وضرر وغم وألم، وأما هذا الخلق الموجود فالعقلاء كلهم قد تمنوا العدم، وقال بعضهم: ليتني كنت نسياً منسياً، وقال آخر ليتني لم أك شيئاً، وقال آخر ليتني كنت تبنة رفعها من الأرض، قال آخر يشير إلى طائر ليتني كنت ذلك الطائر. وهذا قول الأنبياء والأولياء وهم العقلاء، فبعضهم يتمنى عدم الخلق وبعضهم يتمنى عدم التكليف بأن يكون جماداً أو طائراً، فليت شعري كيف يستجيز العاقل في أن يقول: للخلق في التكليف فائدة وإنما معنى الفائدة نفي الكلفة، والتكليف في عينه إلزام كلفة وهو ألم، وإن نظر إلى الثواب فهو الفائدة، وكان قادراً على إيصاله إليهم بغير تكليف، فإن قيل: الثواب إذا كان باستحقاق كان ألذ وأوقع من أن يكون بالامتنان والابتداء، والجواب: أن الاستعاذة بالله تعالى من عقل ينتهي إلى التكبر على الله عز وجل والترفع من احتمال منته وتقدير اللذة في الخروج من نعمته أولى من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم؛ وليت شعري كيف يعد من العقلاء من يخطر بباله مثل هذه الوساوس، ومن يستثقل المقام أبد الآباد في الجنة من غير تقدم تعب وتكليف أخس من أن يناظر أو يخاطب. هذا لو سلم أن الثواب بعد التكليف يكون مستحقاً، وسنبين نقيضه. ثم ليت شعري الطاعة التي بها يستحق الثواب من أين وجدها العبد؟ وهل لها سبب سوى وجوده وقدرته وإرادته وصحة أعضائه وحضور أسبابه؟ وهل لكل ذلك مصدر إلا فضل الله ونعمته؛ فنعوذ بالله من الانخلاع عن غريزة العقل بالكلية، فإن هذا الكلام من هذا النمط، فينبغي أن يسترزق الله تعالى عقلاً لصاحبه ولا يشتغل بمناظرته.
الدعوى الثانية: إن لله تعالى أن يكلف العباد ما يطيقونه وما لا يطيقونه، وذهب المعتزلة إلى انكار ذلك، ومعتقد أهل السنة أن التكليف له حقيقة في نفسه وهو أنه كلام وله مصدر وهو المكلف، ولا شرط فيه إلا كونه متكلماً، وله مورد وهو المكلف وشرطه أن يكون فاهماً للكلام فلا يسمى الكلام مع الجماد والمجنون خطاباً ولا تكليفاً، والتكليف نوع خطاب وله متعلق وهو المكلف به وشرطه أن يكون مفهوماً فقط، وأما كونه ممكناً فليس بشرط لتحقيق الكلام فإن التكليف كلام، فإذا صدر ممن يفهم مع من يفهم فيما يفهم وكان المخاطب دون المخاطب سمي تكليفاً، وإن كان مثله سمي التماساً، وإن كان فوقه سمي دعاء وسؤالاً، فالاقتضاء في ذاته واحد وهذه الأسامي تختلف عليه باختلاف النسبة، وبرهان جواز ذلك أن استحالته لا تخلو إما أن تكون لامتناع تصور ذاته، كاجتماع السواد والبياض، أو كان لأجل الاستقباح، وباطل أن يكون امتناعه لذاته، فإن السواد والبياض لا يمكن أن يفرض مجتمعاً، وفرض هذا ممكن إذ التكليف لا يخلو إما أن يكون لفظاً وهو مذهب الخصم وليس بمستحيل أن يقول الرجل لعبده الزمن قم، فهو على مذهبهم أظهر وأما نحن فإنا نعتقد أنه اقتضاء يقوم بالنفس. وكما يتصور أن يقوم اقتضاء القيام بالنفس من قادر فيتصور ذلك من عاجز بل ربما يقوم ذلك بنفسه من قادر ثم يبقى ذلك الاقتضاء ونظر الزمانة والسيد لا يدري. ويكون الاقتضاء قائماً بذاته وهو اقتضاء قائم من عاجز في علم الله تعالى، وإن لم يكن معلوماً عند المقتضي فإن علمه لا يحيل بقاء الاقتضاء مع العلم بالعجز عن الوفاء وباطل أن يقال بطلان ذلك من جهة الاستحسان، فإن كلامنا في حق الله تعالى، وذلك باطل في حقه لتنزهه عن الأغراض ورجوع ذلك إلى الأغراض. أما الانسان العاقل المضبوط بغالب الأمر فقد يستقبح ذلك وليس ما يستقبح من العبد يستقبح من الله تعالى. فإن قيل: فهو مما لا فائدة فيه وما لا فائدة فيه فهو عبث والعبث على الله تعالى محال. قلنا: هذه ثلاث دعاوى: الأولى: إنه لا فائدة فيه، ولا نسلم، فلعل فيه فائدة لعباد اطلع الله عليها. وليست الفائدة هي الامتثال والثواب عليه بل ربما يكون في إظهار الأمر وما يتبعه من اعتقاد التكليف فائدة، فقد ينسخ الأمر قبل الامتثال كما أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده ثم نسخه قبل الامتثال، وأمر أبا جهل بالايمان وأخبر أنه لا يؤمن وخلاف خبره محال.
الدعوى الثانية: إن ما لا فائدة فيه فهو عبث، فهذا تكرير عبارة؛ فإنا بينا أنه لا يراد بالعبث إلا ما لا فائدة فيه فإن أريد به غيره فهو غير مفهوم. الدعوى الثالثة: إن العبث على الله تعالى محال، وهذا فيه تلبيس، لأن لأن العبث عبارة عن فعل لا فائدة فيه ممن يتعرض للفوائد، فمن لا يتعرض لها فتسميته عابثاً مجاز محض لا حقيقة له يضاهي قول القائل الريح عابثة بتحيكها الأشجار إذ لا فائدة لها فيه، ويضاهي قول القائل الجدار غافل أي هو خال عن العلم والجهل وهذا باطل لأن الغافل يطلق على القابل للجهل والعلم إذا خلا عنهما، فاطلاقهما على الذي لا يقبل العلم مجاز لا أصل له، وكذلك اطلاق اسم العابث على الله تعالى واطلاق العبث على أفعاله سبحانه وتعالى، والدليل الثاني في المسألة، ولا محيص لأحد عنه، أن الله تعالى كلف أبا جهل أن يؤمن وعلم أنه لا يؤمن، وأخبر عنه بأنه لا يؤمن، فكأنه أمر بأن يؤمن بأنه لا يؤمن، إذ كان من قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لا يؤمن وكان هو مأموراً بتصديقه، فقد قيل له صدق بأنك لا تصدق، وهذا محال. وتحقيقه أن خلاف المعلوم محال وقوعه ولكن ليس محالاً لذاته، بل هو محال لغيره، والمحال لغيره في امتناع الوقوع كالمحال لذاته، ومن قال إن الكفار الذين لم يؤمنوا ما كانوا مأمورين بالايمان فقد جحد الشرع، ومن قال كان الايمان منهم متصوراً مع علم الله سبحانه وتعالى بأنه لا يقع، فقد اضطر كل فريق إلى القول بتصور الأمر بما لا يتصور امتثاله، ولا يغني عن هذا قول القائل إنه كان مقدوراً عليه وكان للكافر عليه قدرة، أما على مثلنا فلا قدرة قبل الفعل ولم تكن لهم قدرة إلا على الكفر الذي صدر منهم، وأما عند المعتزلة فلا يمتنع وجود القدرة ولكن القدرة غير كافية لوقوع المقدور بل له شرط كالارادة وغيرها، ومن شروطه أن لا ينقلب علم الله تعالى جهلاً. والقدرة لا تراد لعينها بل لتيسيير الفعل بها، فكيف يتيسر فعل يؤدي إلى انقلاب العلم جهلاً؟ فاستبان أن هذا واقع في ثبوت التكليف بما هو محال لغيره، فكذا يقاس عليه ما هو محال لذاته إذ لا فرق بينهما في إمكان التلفظ ولا في تصور الاقتضاء ولا في الاستقباح والاستحسان. الدعوى الثالثة: ندعي أن الله تعالى قادر على إيلام الحيوان البريء عن الجنايات ولا يلزم عليه ثواب. وقالت المعتزلة إن ذلك محال لأنه قبيح، ولذلك لزمهم المصير إلى أن كل بقة وبرغوث أو ذي بعرة أو صدمة فإن الله عز وجل يجب عليه أن يحشره ويثيبه عليه
بثواب، وذهب ذاهبون إلى أن أرواحها تعود بالتناسخ إلى أبدان أُخر وينالها من اللذة ما يقابل تعبها؛ وهذا مذهب لا يخفى فساده، ولكنا نقول: أما إيلام البريء عن الجناية من الحيوان والأطفال والمجانين فمقدور بما هو مشاهد محسوس، فيبقى قول الخصم إن ذلك يوجب عليه الحشر والثواب بعد ذلك فيعود إلى معنى الواجب، وقد بان استحالته في حق الله تعالى، وإن فسروه بمعنى رابع فهو غير مفهوم، وإن زعموا أن تركه يناقض كونه حكيماً فنقول: إن الحكمة إن اريد بها العلم بنظام الأمور والقدرة على ترتيبها كما سبق فليس في هذا ما يناقضه، وإن أريد بها أمراً آخر فليس يجب له عندنا من الحكم إلا ما ذكرناه، وما وراء ذلك لفظ لا معنى له. فإن قيل فيؤدي إلى أن يكون ظالماً وقد قال: " وما ربك بظلام للعبيد " قلنا: الظلم منفي عنه بطريق السلب المحض كما تسلب الغفلة عن الجدار والعبث عن الريح، فإن الظلم إنما يتصور ممن يمكن أن يصادف فعله ملك غيره، ولا يتصور ذلك في حق الله تعالى أو يمكن أن يكون عليه أمر فيخالف فعله أمر غيره، ولا يتصور من الانسان أن يكون ظالماً لما في ملك نفسه بكل ما يفعله إلا إذا خالف أمر الشرع فيكون ظالماً بهذا المعنى، فمن لا يتصور منه أن يتصرف في ملك غيره ولا يتصور منه أن يكون تحت أمر غيره كان الظلم مسلوباً عنه لفقد شرطه المصحح له لا لفقده في نفسه، فلتفهم هذه الدقيقة فإنها مزلة القدم، فإن فسر الظلم بمعنى سوى ذلك فهو غير مفهوم ولا يتكلم فيه بنفي ولا إثبات. الدعوى الرابعة: ندعي أنه لا يجب عليه رعاية الأصلح لعباده، بل له أن يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد، خلافاً للمعتزلة فإنهم حجروا على الله تعالى في أفعاله وأوجبوا عليه رعاية الأصلح. ويدل على بطلان ذلك ما دل على نفي الوجوب على الله تعالى كما سبق وتدل عليه المشاهدة والوجود، فإنا نريهم من أفعال الله تعالى ما يلزمهم الاعتراف به بأنه لا صلاح للعبيد فيه، فإنا نفرض ثلاثة أطفال مات أحدهم وهو مسلم في الصبا، وبلغ الآخر وأسلم ومات مسلماً بالغاً، وبلغ الثالث كافراً ومات على الكفر، فإن العدل عندهم أن يخلد الكافر البالغ في النار، وأن يكون للبالغ المسلم في الجنة رتبة فوق رتبة الصبي المسلم، فإذا قال الصبي المسلم: يا رب لم حططت رتبتي عن رتبته؟ فيقول: لأنه بلغ فأطاعني وأنت لم تطعني بالعبادات بعد البلوغ، فيقول: يا رب لأنك
أمتني قبل البلوغ فكان صلاحي في أن تمدني بالحياة حتى أبلغ فأطيع فأنال رتبته فلم حرمتني هذه الرتبة أبد الآبدين وكنت قادراً على أن توصلني لها؟ فلا يكون له جواب إلا أن يقول: علمت أنك لو بلغت لعصيت وما أطعت وتعرضت لعقابي وسخطي فرأيت هذه الرتبة النازلة أولى بك وأصلح لك من العقوبة، فينادي الكافر البالغ من الهاوية ويقول: يا رب أو ما علمت أني إذا بلغت كفرت فلو أمتني في الصبا وأنزلتني في تلك المنزلة النازلة لكان أحب إلي من تخليد النار وأصلح لي، فلم أحييتني وكان الموت خيراً لي؟ فلا يبقى له جواب البتة، ومعلوم أن هذه الأقسام الثلاثة موجودة، وبه يظهر على القطع أن الأصلح للعباد كلهم ليس بواجب ولا هو موجود. الدعوى الخامسة: ندعي أن الله تعالى إذا كلف العباد فأطاعوه لم يجب عليه الثواب، بل إن شاء أثابهم وإن شاء عاقبهم وإن شاء أعدمهم ولم يحشرهم، ولا يبالي لو غفر لجميع الكافرين وعاقب جميع المؤمنين، ولا يستحيل ذلك في نفسه ولا يناقض صفة من صفات الإلهية، وهذا لأن التكليف تصرف في عبيده ومماليكه، أما الثواب ففعل آخر على سبيل الابتداء، وكونه واجباً بالمعاني الثلاثة غير مفهوم ولا معنى للحسن والقبيح، وإن أريد له معنى آخر فليس بمفهوم إلا أن يقال إنه يصير وعده كذباً وهو محال، ونحن نعتقد الوجوب بهذا المعنى ولا ننكره. فإن قيل: التكليف مع القدرة على الثواب وترك الثواب قبيح، قلنا: إن عنيتم بالقبح أنه مخالف غرض المكلف فقد تعالى المكلف وتقدس عن الأغراض، وإن عنيتم به أنه مخالف غرض المكلف مسلم لكن ما هو قبيح عند المكلف لم يمتنع عليه فعله إذا كان القبيح والحسن عنده وفي حقه بمثابة واحدة. على أنا لو نزلنا على فاسد معتقدهم فلا نسلم أن من يستخدم عبده يجب عليه في العادة ثواب، لأن الثواب يكون عوضاً عن العمل فتبطل فائدة الرق وحق على العبد أن يخدم مولاه لأنه عبده، فإن كان لأجل عوض فليس ذلك خدمة، ومن العجائب قولهم: إنه يجب الشكر على العباد لأنهم عباد، قضاءً لحق نعمته، ثم يجب عليه الثواب على الشكر وهذا محال؛ لأن المستحق إذا وفى لم يلزمه فيه عوض، ولو جاز ذلك للزم على الثواب شكر مجدد وعلى هذا الشكر ثواب مجدد ويتسلسل إلى غير نهاية، ولم يزل العبد والرب كل واحد منهما أبداً مقيداً بحق الآخر، وهو محال. وأفحش من هذا قولهم: إن كل من كفر فيجب على الله تعالى أن يعاقبه أبداً ويخلده في النار، بل كل من قارف كبيرة ومات قبل التوبة يخلد في النار،
وهذا جهل بالكرم والمروءة والعقل والعادة والشرع وجميع الأمور، فإنا نقول: العبادة قاضية والعقول مشيرة إلى أن التجاوز والصفح أحسن من العقوبة، والانتقام وثناء الناس على العافي أكثر من ثنائهم للمنتقم، واستحسانهم للعفو أشد، فكيف يستقبح العفو والإنعام ويستحسن طول الانتقام! ثم هذا في حق من أذته الجناية وغضت من قدره المعصية، والله تعالى يستوي في حقه الكفر والايمان والطاعات والعصيان فهما في حق إلاهيته وجلاله سيان، ثم كيف يستحسن أن سلك طريق المجازاة واستحسن ذلك تأييد العقاب خالداً مخلداً في مقابلته العصيان بكلمة واحدة في لحظة. ومن انتهى عقله في الاستحسان إلى هذا الحد كانت دار المرضى أليق به من مجامع العلماء. على أنا نقول: لو سلك سالك ضد هذا الطريق بعينه كان أقوم قيلا وأجرى على قانون الاستحسان والاستقباح الذي تقضي به الأوهام والخيالات كما سبق، وهو أن نقول: الانسان يقبح منه أن يعاقب على جناية سبقت وجناية تداركها إلا لوجهين: أحدهما، أن يكون في العقوبة زجر ورعاية مصلحة في المستقبل فيحسن ذلك خيفة من فوات غرض في المستقبل، فإن لم يكن فيه مصلحة في المستقبل أصلاً فالعقوبة بمجرد المجازاة على ما سبق قبيح لأنه لا فائدة فيه للمعاقب ولا لأحد سواه، والجاني متأذ به ودفع الأذى عنه أحسن، وإنما يحسن الأذى لفائدة ولا فائدة، وما مضى فلا تدارك له فهو في غاية القبح. والوجه الثاني، أن نقول: إنه إذا تأذى المجني عليه واشتد غيظه فذلك الغيظ مؤلم وشفاء الغيظ مريح من الألم، والألم بالجاني أليق، ومهما عاقب الجاني زال منه ألم الغيظ واختص بالجاني فهو أولى، فهذا أيضاً له وجه ما وإن كان دليلاً على نقصان العقل وغلبة الغضب عليه. فأما إيجاب العقاب حيث لا يتعلق بمصلحة في المستقبل لأحد في عالم الله تعالى ولا فيه دفع أذى عن المجني عليه ففي غاية القبح، فهذا أقوم من قول من يقول إن ترك العقاب في غاية القبح، والكل باطل واتباع الموجب الأوهام التي وقعت بتوهم الأغراض، والله تعالى متقدس عنها ولكنا أردنا معارضة الفاسد ليتبين به بطلان خيالهم. الدعوى السادسة: ندعي أنه لو لم يرد الشرع لما كان يجب على العباد معرفة الله تعالى وشكر نعمته، خلافاً للمعتزلة، حيث قالوا إن العقل بمجرده موجب، وبرهانه أن نقول: العقل يوجب النظر وطلب المعرفة لفائدة مرتبة عليه أو مع الاعتراف بأن وجوده وعدمه
في حق الفوائد عاجلاً وآجلاً بمثابة واحدة، فإن قلتم: يقتضي بالوجوب مع الاعتراف بأنه لا فائدة فيه قطعاً عاجلاً وآجلاً فهذا حكم الجهل لا حكم العقل، فإن العقل لا يأمل بالعبث، وكلما هو خال عن الفوائد كلها فهو عبث، وإن كان لفائدة فلا يخلو إما أن ترجع إلى المعبود تعالى وتقدس عن الفوائد، وإن رجعت إلى العبد فلا يخلو أن يكون في الحال أو في المآل، أما في الحال فهو تعب لا فائدة فيه وأما في المآل فالمتوقع الثواب. ومن أين علمتم أنه يثاب على فعله بل ربما يعاقب على فعله، فالحكم عليه بالثواب حماقة لا أصل لها.. فإن قيل: يخطر بباله أن له رباً إن شكره أثابه وأنعم عليه وإن كفر أنعمه عاقبه عليه، ولا يخطر بباله البتة جواز العقوبة على الشكر والاحتزاز عن الضرر الموهوم في قضية العقل كالاحتراز عن العلوم. قلنا: نحن لا ننكر أن العاقل يستحثه طبعه عن الاحتراز من الضرر موهوماً ومعلوماً، فلا يمنع من إطلاق اسم الايجاب على هذا الاستحثاث فإن الاصطلاحات لا مشاحة فيها، ولكن الكلام في ترجيح جهة الفعل على جهة الترك في تقرير الثواب بالعقاب مع العلم بأن الشكر وتركه في حق الله تعالى سيان لا كالواحد منا فإنه يرتاح بالشكر والثناء ويهتز له ويستلذه ويتآلم بالكفران ويتأذى به، فإذا ظهر استواء الأمرين في حق الله تعالى فالترجيح لأحد الجانبين محال، بل ربما يخطر بباله نقيضه وهو أنه يعاقب على الشكر لوجهين: أحدهما، أن اشتغاله به تصرف في فكره وقلبه باتعابه صرفه عن الملاذ والشهوات وهو عبد مربوب خلق له شهوة ومكن من الشهوات، فلعل المقصود أن يشتغل بلذات نفسه واستيفاء نعم الله تعالى وأن لا يتعب نفسه فيما لا فائدة لله فيه فهذا الاحتمال أظهر. الثاني، أن يقيس نفسه على من يشكر ملكاً من الملوك بأن يبحث عن صفاته وأخلاقه ومكانه وموضع نومه مع أهله وجميع أسراره الباطنة مجازاة على إنعامه عليه، فيقال له أنت بهذا الشكر مستحق لحز الرقبة، فما لك ولهذا الفضول ومن أنت حتى تبحث عن أسرار الملوك وصفاتهم وأفعالهم وأخلاقهم، ولماذا لا تشتغل بما يهمك، فالذي يطلب معرفة معرفة الله تعالى كأنه إن تعرف دقائق صفات الله تعالى وأفعاله وحكمته وأسراره في أفعاله وكل ذلك مما لا يؤهل له إلا من له منصب فمن أين عرف العبد أنه مستحق لهذا المنصب؟ فاستبان أن ما أخذهم أنهام رسخت منهم من العادات، تعارضها أمثالها ولا محيص عنها. فإن قيل: فإن لم يكن مدركاً لوجوب مقتضى العقول أدى ذلك إلى إفحام
الرسول، فإنه إذا جاء بالمعجزة وقال انظروا فيها، فللمخاطب أن يقول إن لم يكن النظر واجباً فلا اقدم عليه وإن كان واجباً فيستحيل أن يكون مدركه العقل، والعقل لا يوجب، ويستحيل أن يكون مدركه الشرع، والشرع لا يثبت إلا بالنظر في المعجزة ولا يجب النظر قبل ثبوت الشرع فيؤدي إلى أن لا يظهر صحة النبوة أصلاً. والجواب أن هذا السؤال مصدره الجهل بحقيقة الوجوب، وقد بينا أن معنى الوجوب ترجيح جانب الفعل على الترك بدفع ضرر موهوم في الترك أو معلوم، وإذا كان هذا هو الوجوب فالموجب هو المرجح وهو الله تعالى، فإنه إذا ناط العقاب بترك النظر ترجح فعله على تركه، ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه واجب مرجح بترجح الله تعالى في ربطه العقاب بأحدهما. وأما المدرك فعبارة عن جهة معرفة الوجوب لا عن نفس الوجوب، وليس شرط الواجب أن يكون وجوبه معلوماً، بل أن يكون علمه متمكناً لمن أراده. فيقول النبي إن الكفر سم مهلك والإيمان شفاء مسعد بأن جعل الله تعالى أحدهما مسعداً والآخر مهلكاً، ولست أوجب عليك شيئاً، فزن الايجاب هو الترجيح والمرجح هو الله تعالى وإنما أنا مخبر عن كونه سم ومرشد لك إلى طريق تعرف به صدقي وهو النظر في المعجزة، فإن سلكت الطريق عرفت ونجوت؛ وإن تركت هلكت. ومثاله مثال طبيب انتهى إلى مريض وهو متردد بين دوائين موضوعين بين يديه، فقال له أما هذا فلا تتناوله فإنه لهلك للحيوان وأنت قادر على معرفته بأن تطعمه هذا السنور فيموت على الفور فيظهر لك ما قلته. وأما هذا ففيه شفاؤك وأنت قادر على معرفته بالتجربات وهو إن تشربه فتشفى فلا فرق في حقي ولا في حق أُستاذي بين أن يهلك أو يشفى فإن أُستاذي غني عن بقائك وأنا أيضاً كذلك، فعند هذا لو قال المريض هذا يجب علي بالعقل أو بقولك وما لم يظهر لي هذا لم أشتغل بالتجربة كان مهلكاً نفسه ولم يكن عليه ضرر، فكذلك النبي قد أخبره الله تعالى بأن الطاعة شفاء والمعصية داء وأن الإيمان مسعد والكفر مهلك وأخبره بأنه غني عن العالمين سعدوا أم شقوا فإنما شأن الرسول أن يبلغ ويرشد إلى طريقة المعرفة وينصرف، فمن نظر فلنفسه ومن قصر فعليها، وهذا واضح. فإن قيل: فقد رجع الأمر إلى أن العقل هو الموجب من حيث أنه بسماع كلامه ودعواه يتوقع عقاباً فيحمله العقل على الحذر ولا يحصل إلا بالنظر فيوجب عليه النظر، قلنا: الحق الذي يكشف الغطاء في هذا من غير اتباع وهم وتقليد أمر هو أن الوجوب كما بأن عبارة عن نوع رجحان في الفعل، والموجب هو الله تعالى لأنه هو المرجح، والرسول مخبر عن الترجيح، والمعجزة دليل على صدقه في الخبر، والنظر
سبب في معرفة الصدق، والعقل آلة النظر والفهم معنى الخبر، والطبع مستحث على الحذر بعد فهم المحذور بالعقل، فلا بد من طبع يخالفه العقوبة للدعوة ويوافقه الثواب الموعود ليكون مستحثاً، ولكن لا يستحث ما لم يفهم المحذور ولم يقدره ظناً أو علماً، ولا يفهم إلا بالعقل والعقل لا يفهم الترجيح بنفسه بل بسماعه من الرسول، والرسول لا يرجح الفعل على الترك بنفسه بل الله هو المرجح والرسول مخبر، وصدق الرسول لا يظهر بنفسه بل المعجز، والمعجزة لا تدل ما لم ينظر فيها، والنظر بالعقل، فإذاً قد انكشفت المعاني، والصحيح في الألفاظ أن يقال: الوجوب هو الرجحان والموجب هو الله تعالى، والمخبر هو الرسول، المعرف للمحذور وصدق الرسول هو العقل، والمستحث على سلوك سبب الخلاص وهو الطبع، وكذلك ينبغي أن يفهم الحق في هذه المسألة ولا يلتفت إلى الكلام المعتاد الذي لا يشفي الغليل ولا يزيل الغموض. لفهم معنى الخبر، والطبع مستحث على الحذر بعد فهم المحذور بالعقل، فلا بد من طبع يخالفه العقوبة للدعوة ويوافقه الثواب الموعود ليكون مستحثاً، ولكن لا يستحث ما لم يفهم المحذور ولم يقدره ظناً أو علماً، ولا يفهم إلا بالعقل والعقل لا يفهم الترجيح بنفسه بل بسماعه من الرسول، والرسول لا يرجح الفعل على الترك بنفسه بل الله هو المرجح والرسول مخبر، وصدق الرسول لا يظهر بنفسه بل المعجز، والمعجزة لا تدل ما لم ينظر فيها، والنظر بالعقل، فإذاً قد انكشفت المعاني، والصحيح في الألفاظ أن يقال: الوجوب هو الرجحان والموجب هو الله تعالى، والمخبر هو الرسول، المعرف للمحذور وصدق الرسول هو العقل، والمستحث على سلوك سبب الخلاص وهو الطبع، وكذلك ينبغي أن يفهم الحق في هذه المسألة ولا يلتفت إلى الكلام المعتاد الذي لا يشفي الغليل ولا يزيل الغموض. الدعوى السابعة: ندعي أن بعثة الأنبياء جائز، وليس بمحال ولا واجب، وقالت المعتزلة إنه واجب، وقد سبق وجه الرد عليهم. وقالت البراهمة إنه محال، وبرهان الجواز أنه مهما قام الدليل على أن الله تعالى متكلم وقام الدليل على أنه قادر لا يعجز على أن يدل على كلام النفس بخلق ألفاظ وأصوات ورقوم أو غيرها من الدلالات، وقد قام دليل على جواز إرسال الرسل، فإنا لسنا نعني به إلا أن يقوم بذات الله تعالى خبر عن الأمر النافع في الآخرة والأمر الضار بحكم إجراء العادة، ويصدر منه فعل هو دلالة الشخص على ذلك الخبر وعلى أمره بتبليغ الخبر، ويصدر منه فعل خارق للعادة مقروناً
بدعوى ذلك الشخص الرسالة، فليس شيء من ذلك محالاً لذاته، فإنه يرجع إلى كلام النفس وإلى اختراع ما هو دلالة على الكلام وما هو مصدق للرسول وإن حكم باستحالة ذلك من حيث الاستقباح والاستحسان، فقد استأصلنا هذا الأصل في حق الله تعالى ثم لا يمكن أن يدعي قبح إرسال الرسول على قانون الاستقباح، فالمعتزلة مع المصير إلى ذلك لم يستقبحوا هذا فليس إدراك قبحه ولا إدراك امتناعه في ذاته ضرورياً فلا بد من ذكر سببه. وغاية ما هو به ثلاثة شبه: الأولى: قولهم: إنه لو بعث النبي بما تقتضيه العقول ففي العقول غنية عنه وبعثة الرسول عبث، وذلك وعلى الله محال، وإن بعث بما يخالف العقول استحال التصديق والقبول. الثانية: إنه يستحيل العبث لأنه يستحيل تعريف صدقه، لأن الله تعالى لو شافه الخلق بتصديقه وكلمهم جهاراً فلا حاجة إلى رسول، وإن لم يشافه به فغايته الدلالة على صدقه بفعل خارق للعادة، ولا يتميز ذلك عن السحر والطلسمات وعجائب الخواص وهي خارقة للعادات عند من لا يعرفها، وإذا استويا في خرق العادة لم يؤمن ذلك فلا يحصل العلم بالتصديق. الثالثة: إنه إن عرف تمييزها عن السحر والطلسمات والتخيلات فمن أين يعرف الصدق؟ ولعل الله تعالى أراد إضلالنا وإغواءنا بتصديقه ولعل كل ما قال النبي إنه مسعد فهو مشقي، وكلما قال مشقي فهو مسعد، ولكن الله أراد أن يسوقنا إلى الهلاك ويغوينا بقول الرسول، فإن الإضلال والإغواء غير محال على الله تعالى عندكم، إذ العقل لا يحسن ولا يقبح؛ وهذه أقوى شبهة ينبغي أن يجادل بها المعتزلي عند رومه إلزام القول بتقبيح العقل، إذ يقول: إن لم يكن الاغواء قبيحاً فلا يعرف صدق الرسل قط ولا يعلم أنه ليس باضلال. والجواب أن نقول: أما الشبهة الأولى فضعيفة؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم يرد مخبراً بما لا تشتغل العقول بمعرفته، ولكن تستقل بفهمه إذا عرف، فإن العقل لا يرشد إلى النافع والضار من الأعمال والأقوال والأخلاق والعقائد، ولا يفرق بين المشقى والمسعد، كما لا يستقل بدرك خواص الأدوية والعقاقير، ولكنه إذا عرف فهم وصدق وانتفع بالسماع فيجتنب الهلاك ويقصد المسعد، كما ينتفع بقول الطبيب في معرفة الداء والدواء، ثم كما يعرف صدق الطبيب بقرائن الأحوال وأمور أُخر، فكذلك يستدل على صدق الرسول عليه السلام بمعجزات وقرائن وحالات فلا فرق. فأما الشبهة الثانية، وهو عدم تمييز المعجزة عن السحر والتخيل، فليس كذلك. فإن أحداً من العقلاء لم يجوز انتهاء السحر إلى إحياء الموتى، وقلب العصا ثعباناً،
وفلق القمر، وشق البحر، وإبراء الأكمه والأبرص، وأمثال ذلك. والقول الوجيز إن هذا القائل إن ادعى أن كل مقدور لله تعالى فهو ممكن تحصيله بالسحر فهو قول معلوم الاستحالة بالضرورة، وإن فرق بين فعل قوم وفعل قوم فقد تصور تصديق الرسول بما يعلم أنه ليس من السحر ويبقى النظر بعده في أعيان الرسل عليهم السلام وآحاد المعجزات وأن ما أظهروه من جنس ما يمكن تحصيله بالسحر أم لا، ومهما وقع الشك فيه لم يحصل التصديق به ما لم يتحد به النبي على ملأ من أكابر السحرة ولم يمهلهم مدة المعارضة ولم يعجزوا عنه، وليس الآن من غرضنا آحاد المعجزات. وأما الشبهة الثالثة، وهو تصور الإغواء من الله تعالى والتشكيك لسبب ذلك، فنقول: مهما علم وجه دلالة المعجزة على صدق النبي، علم أن ذلك مأمون عليه، وذلك بأن يعرف الرسالة ومعناها ويعرف وجه الدلالة فنقول: لو تحدى إنسان بين يدي ملك على جنده أنه رسول الملك إليهم وأن الملك أوجب طاعته عليهم في قسمة الأرزاق والاقطاعات، فطالبوه بالبرهان والملك ساكت، فقال: أيها الملك إن كنت صادقاً في ما ادعيته فصدقني بأن تقوم على سريرك ثلاث مرات على التوالي وتقعد على خلاف عادتك؛ فقام الملك عقيب التماسه على التوالي ثلاث مرات ثم قعد، حصل للحاضرين على ضروري بأنه رسول الملك قبل أن يخطر ببالهم أن هذا الملك من عادته الإغواء أم يستحيل في حقه ذلك. بل لو قال الملك صدقت وقد جعلت رسولاً ووكيلاً لعلم أنه وكيل ورسول، فإذا خالف العادة بفعله كان ذلك كقوله أنت رسولي، وهذا ابتداءً نصب وتولية وتفويض، ولا يتصور الكذب في التفويض وإنما يتصور في الإخبار، والعلم يكون هذا تصديقاً وتفويضاً ضرورياً، ولذلك لم ينكر أحد صدق الأنبياء من هذه الجهة، بل أنكروا كون ما جاء به الأنبياء خارقاً للعادة وحملوه على السحر والتلبيس أو أنكروا وجود رب متكلم آمر ناه مصدق مرسل، فأما من اعترف بجميع ذلك واعترف بكون المعجزة فعل الله تعالى حصل له العلم الضروري بالتصديق. فإن قيل: فهب أنهم رأوا الله تعالى بأعينهم وسمعوه بآذانهم وهو يقول هذا رسولي ليخبركم بطريق سعادتكم وشقاوتكم، فما الذي يؤمنكم أنه أغوى الرسول والمرسل إليه وأخبر عن المشقى بأنه مسعد وعن المسعد بأنه مشقى فإن ذلك غير محال إذا لم تقولوا بتقبيح العقول؟ بل لو قدر عدم الرسول ولكن قال الله تعالى شفاهاً وعياناً ومشاهدة: نجاتكم في الصوم والصلاة والزكاة وهلاككم في تركها، فبم نعلم صدقه؟ فلعله يلبس علينا ليغوينا ويهلكنا، فإن الكذب عندكم ليس قبيحاً لعينه وإن كان قبيحاً فلا يمتنع على الله تعالى ما هو قبيح وظلم، وما فيه فيه هلاك الخلق أجمعين.
والجواب: إن الكذب مأمون عليه، فإنه إنما يكون في الكلام وكلام الله تعالى ليس بصوت ولا حرف حتى يتطرق إليه التلبيس بل هو معنى قائم بنفسه سبحانه، فكل ما يعلمه الإنسان يقوم بذاته خبر عن معلومه على وفق علمه ولا يتصور الكذب فيه، وكذلك في حق الله تعالى. وعلى الجملة: الكذب في كلام النفس محال وفي ذلك الأمن عما قالوه. وقد اتضح بهذا أن الفعل مهما علم أنه فعل الله تعالى وأنه خارج عن مقدور البشر واقترن بدعوى النبوة حصل العلم الضروري بالصدق وكان الشك من حيث الشك في أنه مقدور البشر أم لا، فأما بعد معرفته كونه من فعل الله تعالى لا يبقى للشك مجال أصلاً البتة. فإن قيل فهل تجوزون الكرامات؟ قلنا: اختلف الناس فيه، والحق ذلك جائز فإنه يرجع إلى خرق الله تعالى العادة بدعاء إنسان أو عند حاجته وذلك مما لا يستحيل في نفسه لأنه ممكن، ولا يؤدي إلى محال آخر، فإنه لا يؤدي إلى بطلان المعجزة لأن الكرامة عبارة عما يظهر من غير اقتران التحدي به، فإن كان مع التحدي فإنا نسميه معجزة ويدل بالضرورة على صدق المتحدي؛ وإن لم تكن دعوى فقد يجوز ظهور ذلك على يد فاسق لأنه مقدور في نفسه؛ فإن قيل: فهل من المقدور إظهار معجزة على يد كاذب؟ قلنا: المعجزة مقرونة بالتحدي منه سبحانه نازلة منزلة قوله صدقت وأنت رسول، وتصديق الكاذب محال لذاته وكل من قال له أنت رسولي صار رسولاً وخرج عن كونه كاذباً، فالجمع بين كونه كاذباً وبين ما ينزل منزلة قوله أنت رسولي محال لأن معنى كونه كاذباً أنه ما قيل له أنت رسولي، ومعنى المعجزة أنه قيل له أنت رسولي؛ فإن فعل الملك على ما ضربنا من المثال كقوله أنت رسولي بالضرورة، فاستبان أن هذا غير مقدور لأنه محال والمحال لا قدرة عليه. فهذا تمام هذا القطب ولنشرع في إثبات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإثبات ما اخبر هو عنه والله أعلم.
القطب الرابع إثبات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإثبات ما أخبر هو عنه وفيه أربعة أبواب: الباب الأول: في اثبات نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. الباب الثاني: في بيان إن ما جاء به من الحشر والنشر والصراط والميزان وعذاب القبر حق، وفيه مقدمة وفصلان. الباب الثالث: فيه نظر في ثلاثة أطراف. الباب الرابع: في بيان من يجب تكفيره من الفرق ومن لا يجب، والاشارة إلى القوانين التي ينبغي أن يعول عليها في التكفير، وبه اختتام الكتاب.
الباب الأول في اثبات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإنما نفتقر إلى إثبات نبوته، على الخصوص، وعلى ثلاثة فرق: الفرقة الأولى، العيسوية: حيث ذهبوا إلى أنه رسول إلى العرب فقط لا إلى غيرهم، وهذا ظاهر البطلان فإنهم اعترفوا بكونه رسولاً حقاً، ومعلوم أن الرسول لا يكذب، وقد ادعى هو أنه رسول مبعوث إلى الثقلين، وبعث رسوله إلى كسرى وقيصر وسائر ملوك العجم وتواتر ذلك منه فما قالوه محال متناقض. الفرقة الثانية، اليهود: فإنهم انكروا صدقه لا بخصوص نظر فيه وفي معجزاته، بل زعموا أنه لا نبي بعد موسى عليه السلام، فأنكروا نبوة محمد وعيسى عليهما السلام. فينبغي أن تثبت عليهم نبوة عيسى لأنه ربما يقصر فهمهم عن درك إعجاز القرآن ولا يقصرون عن درك إعجاز إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص فيقال لهم ما الذي حملكم على التفريق بين من يستدل على صدقه بإحياء الموتى وبين من يستدل بقلب العصا ثعباناً؟ ولا يجدون إليه سبيلاً البتة، إلا أنهم ضلوا بشبهتين: إحداهما، قولهم: النسخ محال في نفسه لأنه يدل على البدء والتغيير وذلك محال على الله تعالى، والثانية لفهم بعض الملحدة أن يقولوا: قد قال موسى عليه السلام: عليكم بديني ما دامت السموات والأرض، وإنه قال إني خاتم الأنبياء. أما الشبهة الأولى فبطلانها بفهم النسخ، وهو عبارة عن الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت المشروط استمراره بعد لحقوق خطاب يرفعه، وليس من المحال أن يقول السيد لعبده قم مطلقاً، ولا يبين له مدة القيام، وهو يعلم أن القيام مقتضى منه إلى وقت بقاء مصلحته في القيام، ويعلم مدة مصلحته ولكن لا ينبه عليها، ويفهم العبد أنه مأمور بالقيام مطلقاً وأن الواجب الاستمرار عليه أبداً إلا أن يخاطبه السيد بالقعود؛ فإذا خاطبه بالقعود قعد ولم يتوهم بالسيد أنه بدا له أو ظهرت له مصلحة كان لا يعرفها، والآن قد عرفها، بل يجوز أن يكون قد عرف مدة مصلحة القيام وعرف أن الصلاح في أن لا ينبه العبد عليها ويطلق الأمر له إطلاقاً حتى يستمر على الامتثال، ثم إذا تغيرت مصلحته أمره بالقعود، فهكذا ينبغي أن يفهم اختلاف
أحكام الشرائع. فإن ورود النبي ليس بناسخ لشرع من قبله بمجرد بعثته، ولا في معظم الأحكام، ولكن في بعض الأحكام كتغير قبلة وتحليل محرم وغير ذلك، وهذه المصالح تختلف بالأعصار والأحوال فليس فيه ما يدل على التغير ولا على الاستبانة بعد الجهل ولا على التناقض. ثم هذا إنما يستمر لليهود إذ لو اعتقدوا أنه لم يكن شريعة من لدن آدم إلى زمن موسى لم ينكروا وجود نوح وإبراهيم وشرعهما، ولا يتميزون فيه عمن ينكر نبوة موسى وشرعه وكل ذلك إنكار ما علم على القطع بالتواتر. وأما الشبهة الثانية فسخيفة من وجهين. أحدهما، أنه لو صح ما قالوه عن موسى لما ظهرت المعجزات على يد عيسى، فإن ذلك تصديق بالضرورة، فكيف يصدق الله بالمعجزة من يكذب موسى وهو أيضاً مصدق له، أفتنكرون معجزة عيسى وجوداً أو تنكرون إحياء الموتى دليلاً على صدق المتحدي؟ فإن أنكروا شيئاً منهم لزمهم في شرع موسى لزوماً لا يجدون عنه محيصاً، وإذا اعترفوا به لزمهم تكذيب من نقل إليهم من موسى عليه السلام قوله إني خاتم الأنبياء. والثاني: أن هذه الشبهة إنما لقنوها بعد بعثة نبينا محمد عليه السلام وبعد وفاته، ولو كانت صحيحة لاحتج اليهود بها وقد حملوا بالسيف على الاسلام، وكان رسولنا عليه السلام مصدقاً بموسى عليه السلام وحاكماً على اليهود بالتوراة في حكم الرجم وغيره، فلا عرض عليه من التوارة ذلك، وما الذي صرفهم عنه ومعلوم قطعاً أن اليهود لم يحتجوا به لأن ذلك لو كان لكان مفحماً لا جواب عنه ولتواتر نقله، ومعلوم أنهم لم يتركوه مع القدرة عليه ولقد كانوا يحرصون على الطعن في شرعه بكل ممكن حمايةً لدمائهم وأموالهم ونسائهم، فإذا ثبت عليهم نبوة عيسى أثبتنا نبوة نبينا عليه السلام بما نثبتها على النصارى. الفرقة الثالثة، وهم يجوزون النسخ ولكنهم ينكرون نبوة نبينا من حيث أنهم ينكرون معجزته في القرآن. وفي إثبات نبوته بالمعجزة طريقتان: الطريقة الأولى، التمسك بالقرآن، فإنا نقول: لا معنى للمعجزة إلا ما يقترن بتحدي النبي عند استشهاده على صدقه على وجه يعجز الخلق عن معارضته، وتحديه على العرب مع شغفهم بالفصاحة وإغراقهم فيها متواتر، وعدم المعارضة معلوم، إذ لو كان لظهر، فإن أرذل الشعراء لما تحدوا بشعرهم وعورضوا ظهرت المعارضات والمناقضات الجارية بينهم، فإذاً لا يمكن إنكار تحديه بالقرآن ولا يمكن إنكار اقتدار العرب على طريق الفصاحة ولا يمكن انكار حرصهم على دفع نبوته بكل ممكن حماية لدينهم ودمهم ومالهم وتخلصاً من سطوة المسلمين وقهرهم، ولا يمكن إنكار عجزهم
لأنهم لو قدروا لفعلوا، فإن العادة قاضية بالضرورة بأن القادر على دفع الهلاك عن نفسه يشتغل بدفعه، ولو فعلوا لظهر ذلك ونقل. فهذه مقدمات بعضها بالتواتر وبعضها بجاري العادات وكل ذلك مما يورث اليقين فلا حاجة إلى التطويل. وبمثل هذا الطريق تثبت نبوة عيسى ولا يقدر النصراني على إنكار شيء من ذلك؛ فإنه يمكن أن يقابل بعيسى فينكر تحديه بالنبوة أو استشهاده باحياء الموتى أو وجود إحياء الموتى أو عدم المعارضة أو يقال عورض ولم يظهر، وكل ذلك مجاحدات لا يقدر عليها المعترف بأصل النبوات، فإن قيل: ما وجه إعجاز القرآن؟ قلنا الجزالة والفصاحة مع النظم العجيب والمنهاج الخارج عن مناهج كلام العرب في خطبهم وأشعارهم وسائر صنوف كلامهم، والجمع بين هذا النظم وهذه الجزالة معجز خارج عن مقدور البشر، نعم ربما يرى للعرب أشعار وخطب حكم فيها بالجزالة، وربما ينقل عن بعض من قصد المعارضة مراعاة هذا النظم بعد تعلمه من القرآن، ولكن من غير جزالة بل مع ركاكة كما يحكى عن ترهات مسيلمة الكذاب حيث قال: الفيل وما أدراك ما الفيل له ذنب وثيل وخرطوم طويل. فهذا وأمثاله ربما يقدر عليه مع ركاكة يستغثها الفصحاء ويستهزؤون بها، وأما جزالة القرآن فقد قضى كافة العرب منها العجب ولم ينقل عن واحد منهم تشبث بطعن في فصاحته، فهذا إذاً معجز وخارج عن مقدور البشر من هذين الوجهين، أعني من اجتماع هذين الوجهين، فإن قيل: لعل العرب اشتغلت بالمحاربة والقتال فلم تعرج على معارضة القرآن ولو قصدت لقدرت عليه، أو منعتها العوائق عن الاشتغال به، والجواب أن ما ذكروه هوس، فإن دفع تحدي المتحدي بنظم كلام أهون من الدفع بالسيف مع ما جرى على العرب من المسلمين بالأسر والقتل والسبي وشن الغارات، ثم ما ذكروه غير دافع غرضنا، فإن انصرافهم عن المعارضة لم يكن إلا بصرف من الله تعالى، والصرف عن المقدور المعتاد من أعظم المعجزات، فلو قال نبي آية صدقي أني في هذا اليوم أحرك أصبعي ولا يقدر أحد من البشر على معارضتي، فلم يعارضه أحد في ذلك اليوم، ثبت صدقه، وكان فقد قدرتهم على الحركة مع سلامة الأعضاء من أعظم المعجزات. وإن فرض وجود القدرة ففقد داعيتهم وصرفهم عن المعارضة من أعظم المعجزات، مهما كانت حاجتهم ماسةً إلى الدفع باستيلاء النبي على رقابهم وأموالهم، وذلك كله معلوم على الضرورة. فهذا طريق تقدير نبوته على النصارى، ومهما تشبثوا بانكار شيء من هذه الأمور الجليلة فلا تشتغل إلا بمعارضتهم بمثله في معجزات عيسى عليه السلام.
الطريقة الثانية: أن تثبت نبوته بجملة من الأفعال الخارقة للعادات التي ظهرت عليه، كانشقاق القمر، ونطق العجماء، وتفجر الماء من بين أصابعه، وتسبيح الحصى في كفه، وتكثير الطعام القليل، وغيره من خوارق العادات، وكل ذلك دليل على صدقه. فإن قيل: آحاد هذه الوقائع لم يبلغ نقلها مبلغ التواتر. قلنا: ذلك أيضاً إن سلم فلا يقدح في العرض مهما كان المجموع بالغاً مبلغ التواتر، وهذا كما أن شجاعة علي رضوان الله عليه وسخاوة حاتم معلومان بالضرورة على القطع تواتراً، وآحاد تلك الوقائع لم تثبت تواتراً، ولكن يعلم من مجموع الآحاد على القطع ثبوت صفة الشجاعة والسخاوة، فكذلك هذه الأحوال العجيبة بالغة جملتها مبلغ التواتر، لا يستريب فيها مسلم أصلاً. فإن قال قائل من النصارى: هذه الأمور لم تتواتر عندي لا جملتها ولا آحادها. فيقال: ولو انحاز يهودي إلى قطر من الأقطار ولم يخالط النصارى وزعم أنه لم تتواتر عنده معجزات عيسى، وإن تواترت فعلى لسان النصارى وهم مهتمون به، فبماذا ينفصلون عنه؟ ولا انفصال عنه إلا أن يقال: ينبغي أن يخالط القوم الذين تواتر ذلك بينهم حتى يتواتر ذلك إليك، فإن الأصم لا تتواتر عنده الأخبار، وكذا المتصامم، فهذا أيضاً عذرنا عند إنكار واحد منهم التواتر على هذا الوجه.
الباب الثاني في بيان وجوب التصديق بأمور ورد بها الشرع وقضى بجوازها العقل وفيه مقدمة وفصلان، أما المقدمة: فهو أن ما لا يعلم بالضرورة ينقسم إلى ما يعلم بدليل العقل دون الشرع، وإلى ما يعلم بالشرع دون العقل، وإلى ما يعلم بهما. أما المعلوم بدليل العقل دون الشرع فهو حدث العالم ووجود المحدث وقدرته وعلمه وارادته، فإن كل ذلك ما لم يثبت لم يثبت الشرع، إذ الشرع يبنى على الكلام فإن لم يثبت كلام النفس لم يثبت الشرع. فكل ما يتقدم في الرتبة على كلام النفس يستحيل إثباته بكلام النفس وما يستند إليه ونفس الكلام أيضاً فيما اخترناه لا يمكن اثباته بالشرع. ومن المحققين من تكلف ذلك وادعاه كما سبقت الاشارة إليه. وأما المعلوم بمجرد السمع فتخصيص أحد الجائزين بالوقوع فإن ذلك من موافق العقول، وإنما يعرف من الله تعالى بوحي والهام ونحن نعلم من الوحي إليه بسماع كالحشر والنشر والثواب والعقاب وأمثالهما، وأما المعلوم بهما فكل ما هو واقع في مجال العقل ومتأخر في الرتبة عن إثبات كلام الله تعالى كمسألة الرؤية وانفراد الله تعالى بخلق الحركات والأغراض كلها وما يجري هذا المجرى، ثم كلما ورد السمع به ينظر، فإن كان العقل مجوزاً له وجب التصديق به قطعاً إن كانت الأدلة السمعية قاطعة في متنها ومستندها لا يتطرق إليها احتمال، وجب التصديق بها ظناً إن كانت ظنية، فإن وجوب التصديق باللسان والقلب عمل يبنى على الأدلة الظنية كسائر الأعمال فنحن نعلم قطعاً إنكار الصحابة على من يدعي كون العبد خالقاً لشيء من الأشياء وعرض من الأعراض، وكانوا ينكرون ذلك بمجرد قوله تعالى " خالق كل شيء " ومعلوم أنه عام قابل للتخصيص فلا يكون عمومه إلا مظنوناً، إنما صارت المسألة قطعية بالبحث على الطرق العقلية التي ذكرناها، ونعلم أنهم كانوا ينكرون ذلك قبل البحث عن الطرق العقلية ولا ينبغي أن يعتقد بهم أنهم لم يلتفتوا إلى المدارك الظنية إلا في الفقهيات بل اعتبروها أيضاً في التصديقات الاعتقادية والقولية.
وأما ما قضى العقل باستحالته فيجب فيه تأويل ما ورد السمع به ولا يتصور أن يشمل السمع على قاطع مخالف للمعقول، وظواهر أحاديث التشبيه أكثرها غير صحيحة، والصحيح منها ليس بقاطع بل هو قابل للتأويل، فإن توقف العقل في شيء من ذلك فلم يقض فيه باستحالة ولا جواز وجب التصديق أيضاً لأدلة السمع فيكفي في وجوب التصديق انفكاك العقل عن القضاء بالإحالة، وليس يشترط اشتماله على القضاء لتجويز، وبين الرتبتين فرق ربما يزل ذهن البليد حتى لا يدرك الفرق بين قول القائل: اعلم أن الأمر جائز، وبين قوله: لا أدري إنه محال أم جائز، وبينهما ما بين السماء والأرض، إذ الأول جائز على الله تعالى والثاني غير جائز، فإن الأول معرفة بالجواز والثاني عدم معرفة بالاحالة، ووجوب التصديق جائز في القسمين جميعاً فهذه هي المقدمة. أما الفصل الأول ففي بيان قضاء العقل بما جاء الشرع به من الحشر والنشر وعذاب القبر والصراط والميزان أما الحشر فيعنى به إعادة الخلق وقد دلت عليه القواطع الشرعية، وهو ممكن بدليل الابتداء. فإن الاعادة خلق ثان ولا فرق بينه وبين الابتداء وإنما يسمى إعادة بالاضافة إلى الابتداء السابق، والقادر على الانشاء والابتداء قادر على الاعادة وهو المعني بقوله: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة فإن قيل فماذا تقولون: أتعدم الجواهر والأعراض ثم يعادان جميعاً، أو تعدم الأعراض دون الجواهر وإنما تعاد الأعراض؟ قلنا: كل ذلك ممكن وليس في الشرع دليل قاطع على تعيين أحد هذه الممكنات. وأحد الوجهين أن تنعدم الأعراض ويبقى جسم الانسان متصوراً بصورة التراب مثلاً، فتكون قد زالت منه الحياة واللون والرطوبة والتركيب والهيئة وجملة من الأعراض، ويكون معنى إعادتها أن تعاد إليها تلك الأعراض بعينها وتعاد إليها أمثالها، فإن العرض عندنا لا يبقى والحياة عرض والموجود عندنا في كل ساعة عرض آخر، والانسان هو ذلك الانسان باعتبار جسمه فإنه واحد لا باعتبار أعراضه، فإن كل عرض يتجدد هو غير الآخر، فليس من شرط الإعادة فرض إعادة الأعراض، وإنما ذكرنا هذا لمصير بعض الأصحاب إلى استحالة إعادة الأعراض، وذلك باطل، ولكن القول في إبطاله يطول ولا حاجة إليه في غرضنا هذا. والوجه الآخر أن تعدم الأجسام أيضاً ثم تعاد الأجسام بأن تخترع. مرة ثانية،
فإن قيل: فيم يتميز المعاد عن مثل الأول؟ وما معنى قولكم أن المعاد هو عين الأول ولم يبق للمعدوم عين حتى تعاد؟ قلنا: المعدوم منقسم في علم الله إلى ما سبق له وجود وإلى ما لم يسبق له وجود، كما أن العدم في الأزل ينقسم إلى ما سيكون له وجود وإلى ما علم الله تعالى أنه لا يوجد؛ فهذا الانقسام في علم الله لا سبيل إلى انكاره، والعلم شامل والقدرة واسعة، فمعنى الإعادة أن نبذل بالوجود العدم الذي سبق له الوجود، ومعنى المثل أن يخترع الوجود لعدم لم يسبق له وجود، فهذا معنى الإعادة، ومهما قدر الجسم باقياً ورد الأمر إلى تجديد أعراض تماثل الأول حصل تصديق الشرع ووقع الخلاص عن إشكال الإعادة وتمييز المعاد عن المثل، وقد أطنبنا في هذه المسألة في كتاب التهافت، وسلكنا في إبطال مذهبهم تقرير بقاء النفس التي هي غير متحيز عندهم وتقدير عود تدبيرها إلى البدن سواء كان ذلك البدن هو عين جسم الانسان أو غيره، وذلك إلزام لا يوافق ما نعتقده؛ فإن ذلك الكتاب مصنف لابطال مذهبهم لا لاثبات المذهب الحق، ولكنهم لما قدروا أن الانسان هو ما هو باعتبار نفسه وأن اشتغاله بتدبير كالعارض له والبدن آلة لهم، ألزمناهم بعد اعتقادهم بقاء النفس وجوب التصديق بالاعادة وذلك برجوع النفس إلى تدبير بدن من الأبدان، والنظر الآن في تحقيق هذا الفصل ينجر إلى البحث عن الروح والنفس والحياة وحقائقها، ولا تحتمل المعتقدات التغلغل إلى هذه الغايات في المعقولات، فما ذكرناه كاف في بيان الاقتصاد في الاعتقاد للتصديق بما جاء به الشرع، وأما عذاب القبر فقد دلت عليه قواطع الشرع إذ تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم بالاستعاذة منه في الأدعية واشتهر قوله عند المرور بقبرين: إنهما ليعذبان ودل عليه قوله تعالى " وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدواً وعشياً " الآية، وهو ممكن، فيجب التصديق به. ووجه إمكانه ظاهر، وإنما تنكره المعتزلة من حيث يقولون إنا نرى شخص الميت مشاهدة وهو غير معذب وإن الميت ربما تفترسه السباع وتأكله، وهذا هوس؛ أما
مشاهدة الشخص فهو مشاهدة لظواهر الجسم والمدرك للعقاب جزء من القلب أو من الباطن كيف كان وليس من ضرورة العذاب ظهور حركة في ظاهر البدن، بل الناظر إلى ظاهر النائم لا يشاهد ما يدركه النائم من اللذة عند الاحتلام ومن الألم عند تخيل الضرب وغيره، ولو انتبه النائم وأخبر عن مشاهداته وآلامه ولذاته من لم يجر له عهد بالنوم لبادر إلى الانكار اغتراراً بسكون ظاهر جسمه، كمشاهدة إنكار المعتزلة لعذاب القبر وأما الذي تأكله السباع فغاية ما في الباب أن يكون بطن السبع قبراً، فاعادة الحياة إلى جزء يدرك العذاب ممكن، فما كل متألم يدرك الألم من جميع بدنه، وأما سؤال منكر ونكير فحق، والتصديق به واجب لورود الشرع به وامكانه، فإن ذلك لا يستدعي منهما إلا تفهيماً بصوت أو بغير صوت، ولا يستدعي منه إلا فهماً، ولا يستدعي الفهم إلا حياة، والإنسان لا يفهم بجميع بدنه بل بجزء من باطن قلبه، واحياء جزء يفهم السؤال ويجيب ممكن مقدور عليه، فيبقى قول القائل إنا نرى الميت ولا نشاهد منكراً ونكيراً ولا نسمع صوتهما في السؤال ولا صوت الميت في الجواب، فهذا يلزمه منه أن ينكر مشاهدة النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام وسماعه كلامه وسماع جبريل جوابه ولا يستطيع مصدق الشرع أن ينكر ذلك، إذ ليس فيه إلا أن الله تعالى خلق له سماعاً لذلك الصوت ومشاهدة لذلك الشخص، ولم يخلق للحاضرين عنده ولا لعائشة رضي الله تعالى عنها وقد كانت تكون عنده حاضرة في وقت ظهور بركات الوحي، فانكار هذا مصدره الإلحاد وإنكار سعة القدرة، وقد فرغنا عن إبطاله ويلزم منه أيضاً إنكار ما يشاهده النائم ويسمعه من الأصوات الهائلة المزعجة، ولولا التجربة لبادر إلى الانكار كل من سمع من النائم حكاية أحواله، فتعساً لمن ضاقت حوصلته عن تقدير اتساع القدرة لهذه الأمور المستحقرة بالاضافة إلى خلق السموات والأرض وما بينهما، مع ما فيهما من العجائب. والسبب الذي ينفر طباع أهل الضلال عن التصديق بهذه الأمور بعينه منفر عن التصديق بخلق الانسان من نطفة قذرة مع ما فيه من العجائب والآيات أولاً أن المشاهدة تضطره إلى التصديق فإذاً ما لا برهان على إحالته لا ينبغي أن ينكر بمجرد الاستبعاد. والإنسان لا يفهم بجميع بدنه بل بجزء من باطن قلبه، واحياء جزء يفهم السؤال ويجيب ممكن مقدور عليه، فيبقى قول القائل إنا نرى الميت ولا نشاهد منكراً ونكيراً ولا نسمع صوتهما في السؤال ولا صوت الميت في الجواب، فهذا يلزمه منه أن ينكر مشاهدة النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام وسماعه كلامه وسماع جبريل جوابه ولا يستطيع مصدق الشرع أن ينكر ذلك، إذ ليس فيه إلا أن الله تعالى خلق له سماعاً لذلك الصوت ومشاهدة لذلك الشخص، ولم يخلق للحاضرين عنده ولا لعائشة رضي الله تعالى عنها وقد كانت تكون عنده حاضرة في وقت ظهور بركات الوحي، فانكار هذا مصدره الإلحاد وإنكار سعة القدرة، وقد فرغنا عن إبطاله ويلزم منه أيضاً إنكار ما يشاهده النائم ويسمعه من الأصوات الهائلة المزعجة، ولولا التجربة لبادر إلى الانكار كل من سمع من النائم حكاية أحواله، فتعساً لمن ضاقت حوصلته عن تقدير اتساع القدرة لهذه الأمور المستحقرة بالاضافة إلى خلق السموات والأرض وما بينهما، مع ما فيهما من العجائب. والسبب الذي ينفر طباع أهل الضلال عن التصديق بهذه الأمور بعينه منفر عن التصديق بخلق الانسان من نطفة قذرة مع ما فيه من العجائب والآيات أولاً أن المشاهدة تضطره إلى التصديق فإذاً ما لا برهان على إحالته لا ينبغي أن ينكر بمجرد الاستبعاد. وأما الميزان فهو أيضاً حق وقد دلت عليه قواطع السمع، وهو ممكن فوجب التصديق به. فإن قيل: كيف توزن الأعمال وهي أعراض وقد انعدمت، والمعدوم لا يوزن؟ وإن قدرت إعادتها وخلقها في جسم الميزان كان محالاً لاستحالة إعادة الأعراض. ثم كيف تخلق حركة يد الانسان وهي طاعته في جسم الميزان؟ أيتحرك بها الميزان فيكون ذلك حركة الميزان لا حركة يد الانسان أم لا تتحرك فتكون الحركة قد فاتت بجسم
ليس هو متحركاً بها، وهو محال؟ ثم إن تحرك فيتفاوت من الميزان بقدر طول الحركات وكثرتها لا بقدر مراتب الأجور، فرب حركة بجرء من البدن يزيد إثمها على حركة جميع البدن فراسخ فهذا محال. فنقول: قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا فقال: " توزن صحائف الأعمال فإن الكرام الكاتبين يكتبون الأعمال في صحائف هي أجسام، فإذا وضعت في الميزان خلق الله تعالى في كفتها ميلاً بقدر رتبة الطاعات وهو على ما يشاء قدير ". فإن قيل: فأي فائدة في هذا؟ وما معنى المحاسبة؟ قلنا: لا نطلب لفعل الله تعالى فائدة: " لا يسأل عما يفعل وهو يسألون ". تم قد دللنا على هذا. ثم أي بعد في أن تكون الفائدة فيه أن يشاهد العبد مقدار أعماله ويعلم أنه مجزي بها بالعدل أو يتجاوز عنه باللطف، ومن يعزم على معاقبة وكيله بجنايته في أمواله أو يعزم على الإبراء فمن أين يبعد أن يعرفه مقدار جنايته بأوضح الطرق ليعلم أنه في عقوبته عادل وفي التجاوز عنه متفضل. هذا إن طلبت الفائدة لأفعال الله تعالى، وقد سبق بطلان ذلك. وأما الصراط فهو أيضاً حق، والتصديق به واجب، لأنه ممكن. فإنه عبارة عن جسر ممدود على متن جهنم يرده الخلق كافة، فإذا توافوا عليه قيل للملائكة " وقفوهم إنهم مسؤولون " فإن قيل: كيف يمكن ذلك وفيما روى أدق من الشعر وأحد من السيف، فكيف يمكن المرور عليه؟ قلنا هذا إن صدر ممن ينكر قدرة الله تعالى، فالكلام معه في إثبات عموم قدرته وقد فرغنا عنها. وإن صدر من معترف بالقدرة فليس المشي على هذا بأعجب من المشي في الهواء، والرب تعالى قادر على خلق قدرة عليه، ومعناه أن يخلق له قدرة المشي على الهواء ولا يخلق في ذاته هوياً إلى أسفل، ولا في الهواء انحراف، فإذا أمكن هذا في الهواء فالصراط أثبت من الهواء بكل حال. الفصل الثاني: في الاعتذار عن الإخلال بفصول شحنت بها المعتقدات فرأيت الإعراض عن ذكرها أولى لأن المعتقدات المختصرة حقها أن لا تشتمل إلا على المهم الذي لا بد منه في صحة الاعتقاد.
أما الأمور التي لا حاجة إلى إخطارها بالبال، وإن خطرت بالبال فلا معصية في عدم معرفتها وعدم العلم بأحكامها، فالخوض فيها بحث عن حقائق الأمور وهي غير لائقة بما يراد منه تهذيب الاعتقاد، وذلك الفن تحصره ثلاثة فنون: عقلي، ولفظي، وفقهي. أما العقلي، فالبحث عن القدرة الحادثة أنها تتعلق بالضدين أم لا، وتتعلق بالمختلفات أم لا، وهل يجوز قدرة حادثة تتعلق بفعل مباين لمحل القدرة وأمثال له. وأما اللفظي فكالبحث عن المسمى باسم الرزق ما هو، ولفظ التوفيق والخذلان والايمان ما حدودها ومسبباتها. وأما الفقهي فكالبحث عن الأمر بالمعروف متى يجب، وعن التوبة ما حكمها، إلى نظائر ذلك. وكل ذلك ليس بمهم في الدين، بل المهم أن ينفي الانسان الشك عن نفسه في ذات الله تعالى، على القدر الذي حقق في القطب الأول، وفي صفاته وأحكامها كما حقق في القطب الثاني، وفي أفعاله بأن يعتقد فيها الجواز دون الوجوب كما في القطب الثالث، وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يعرف صدقه ويصدقه في كل ما جاء به كما ذكرناه في القطب الرابع، وما خرج عن هذا فغير مهم. ونحن نورد من كل فن مما أهملناه مسألة ليعرف بها نظائرها ويحقق خروجها عن المهمات المقصودات في المعتقدات. أما المسألة الأولى العقلية: فكاختلاف الناس في أن من قتل هل يقال إنه مات بأجله؟ ولو قدر عدم قتله هل كان يجب موته أم لا؟ وهذا فن من العلم لا يضر تركه، ولكنا نشير إلى طريق الكشف فيه. فنقول: كل شيئين لا ارتباط لأحدهما بالآخر، ثم اقترنا في الوجود، فليس يلزم من تقدير نفي أحدهما انتفاء الآخر. فلو مات زيد وعمرو معاً ثم قدرنا عدم موت زيد لم يلزم منه لا عدم موت عمرو ولا وجود موته، وكذلك إذا مات زيد عند كسوف القمر مثلاً، فلو قدرنا عدم الموت لم يلزم عدم الكسوف بالضرورة، ولو قدرنا عدم الكسوف لم يلزم عدم الموت إذ لا ارتباط لأحدهما بالآخر، فأما الشيئان اللذان بينهما علاقة وارتباط فهما ثلاثة أقسام: أحدها: أن تكون العلاقة متكافئة كالعلاقة بين اليمين والشمال والفوق والتحت، فهذا مما يلزم فقد أحدهما عند تقدير فقد الآخر لأنهما من المتضايفان
التي لا يتقوم حقيقة أحدهما إلا مع الآخر. الثاني: أن لا يكون على التكافؤ، لكن لأحدهما رتبة التقدم كالشرط مع المشروط. ومعلوم أنه يلزم عدم الشرط، فإذا رأينا علم الشخص مع حياته وإرادته مع علمه فيلزم لا محالة من تقدير انتفاء الحياة انتفاء العلم، ومن تقدير انتفاء العلم انتفاء الارادة، ويعبر عن هذا بالشرط وهو الذي لا بد منه لوجود الشيء ولكن ليس وجود الشيء به بل عنه ومعه. الثالث: العلاقة التي بين العلة والمعلول. ويلزم من تقدير عدم العلة عدم المعلول إن لم يكن للمعلول إلا علة واحدة، وإن تصور أن تكون له علة أخرى فيلزم من تقدير نفي كل العلل نفي المعلول، ولا يلزم من تقدير نفي علة بعينها نفي المعلول مطلقاً، بل يلزم نفي معلول تلك العلة على الخصوص. فإذا تمهد هذا المعنى رجعنا إلى القتل والموت؛ فالقتل عبارة عن حز الرقبة وهو راجع إلى أعراض هي حركات في يد الضارب والسيف وأعراض هي افتراقات في أجزاء رقبة المضروب، وقد اقترن بها عرض آخر وهو الموت، فإن لم يكن بين الحز والموت ارتباط لم يلزم من تقدير نفي الحز نفي الموت فإنهما شيئان مخلوقان معاً على الاقتران بحكم إجراء العادة لا ارتباط لأحدهما بآخر، فهو كالمقترنين اللذين لم تجر العادة باقترانهما وإن كان الحز علة الموت ومولده، وإن لم تكن علة سواه لزم من انتفائه انتفاء الموت، ولكن لا خلاف في أن للموت عللاً من أمراض وأسباب باطنة سوى الحز عند القائلين بالعلل، فلا يلزم من نفي الحز نفي الموت مطلقاً ما لم يقدر مع ذلك إنتفاء سائر العلل، فنرجع إلى غرضنا فنقول: من اعتقد من أهل السنة أن الله مستبد بالاختراع بلا تولد، ولا يكون مخلوق علة مخلوق، فنقول: الموت أمر استبد الرب تعالى باختراعه مع الحز، فلا يجب من تقدير عدم الحز عدم الموت وهو الحق؛ ومن اعتقد كونه علة وانضاف إليه مشاهدته صحة الجسم وعدم مهلك من خارج اعتقد أنه لو انتفى الحز وليس ثم علة أخرى وجب انتفاء المعلول لانتفاء جميع العلل، وهذا الاعتقاد صحيح لو صح اعتقاد التعليل وحصر العلل فيما عرف انتفاؤه فإذاً هذه المسألة يطول النزاع فيها، ولم يشعر أكثر الخائضين فيها بمثارها فينبغي أن نطلب هذا من القانون الذي ذكرناه في عموم قدرة الله تعالى وإبطال التولد. ويبنى على هذا أن منق تل ينبغي أن يقال إنه مات بأجله لأن الأجل عبارة عن الوقت الذي خلق الله تعالى فيه موته سواء كان معه حز رقبة أو كسوف قمر أو نزول مطر أو لم يكن، لأن كل هذه عندنا مقترنات وليست مؤثرات ولكن اقتران بعضها
يتكرر بالعادة، وبعضها لا يتكرر، فأما من جعل الموت سبباً طبيعياً من الفطرة وزعم أن كل مزاج فله رتبة معلومة في القوة إذا خليت ونفسها تمادت إلى منتها مدتها، ولو فسدت على سبيل الاحترام كان ذلك استعجالاً، بالإضافة إلى مقتضى طباعها، والأجل عبارة عن المدة الطبيعية، كما يقال الحائط مثلاً يبقى مائة سنة بقدر إحكام بنائه، ويمكن أن يهدم بالفأس في الحال، والأجل يعبر به عن مدته التي له بذاته وقوته، فيلزم من ذلك أن يقال إذا هدم بالفأس لم ينهدم بأجله وإن لم يتعرض له من خارج حتى انحطت أجزاؤه فيقال انهدم بأجله، فهذا اللفظ ينبيء على ذلك الأصل. المسألة الثانية وهي اللفظية: فكاختلافهم في أن الايمان هل يزيد وينقص أم هو على رتبة واحدة. وهذا الاختلاف منشؤه الجهل بكون الاسم مشتركاً، أعني اسم الايمان، وإذا فصل مسميات هذا اللفظ ارتفع الخلاف. وهو مشترك بين ثلاثة معان: إذ قد يعبر به عن التصديق اليقين البرهاني، وقد يعبر به عن الاعتقاد التقليدي إذا كان جزماً، وقد يعبر به عن تصديق معه العمل بموجب التصديق ودليل اطلاقه على الأول أن من عرف الله تعالى بالدليل ومات عقيب معرفته فإنا نحكم بأنه مات مؤمناً. ودليل اطلاقه على التصديق التقليدي أن جماهير العرب كانوا يصدقون رسول الله تعالى صلى الله عليه وسلم بمجرد إحسانه إليهم وتلطفه بهم ونظرهم في قوانين أحواله من غير نظر في أدلة الواحدانية ووجه دلالة المعجزة، وكان يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيمانهم وقد قال تعالى " وما أنت بمؤمن لنا " أي بمصدق، ولم يفرق بين تصديق وتصديق، ودليل إطلاقه على الفعل، قوله عليه السلام: لا يزني الزاني وهو مؤمن حين يزني وقوله عليه السلام: الايمان بضعة وسبعون باباً أدناها إماطة الأذى عن الطريق فنرجع إلى المقصود ونقول: إن أطلق الإيمان بمعنى التصديق البرهاني لم يتصور زيادته ولا نقصانه، بل اليقين إن حصل بكماله فلا مزيد عليه. وإن لم يحصل بكماله فليس بيقين، وهي خطة واحدة ولا يتصور فيها زيادة ونقصان إلا أن يراد به زيادة وضوح أي زيادة طمأنينة النفس إليه بأن النفس تطمئن إلى اليقينيات النظرية في الابتداء إلى حل ما، فإذا تواردت الأدلة على شيء واحد أفاد بظاهر الأدلة زيادة طمأنينة. وكل من مارس العلوم أدرك تفاوتاً في طمأنينية نفسه إلى العلم الضروري،
وهو العلم بأن الاثنين أكثر من الواحد وإلى العلم يحدث العالم وإن محدثه واحد، ثم يدرك أيضاً تفرقة بين آحاد المسائل بكثرة أدلتها وقلتها. فالتفاوت في طمأنينية النفس مشاهد لكل ناظر من باطنه، فإذا فسرت الزيادة به لم يمنعه أيضاً في هذا التصديق. أما إذا أطلق بمعنى التصديق التقليدي فذلك لا سبيل إلى جحد التفاوت فيه؛ فإنا ندرك بالمشاهدة من حال اليهودي في تصميمه على عقده ومن حال النصراني والمسلم تفاوتاً، حتى أن الواحد منهم لا يؤثر في نفسه وحل عقد لمبه التهويلات والتخويفات ولا التحقيقات العلمية ولا التخيلات الإقناعية، والواحد منهم مع كونه جازماً في اعتقاده تكون نفسه أطوع لقبول اليقين، وذلك لأن الاعتقاد على القلب مثل عقدة ليس فيها انشراح وبرد يقين. والعقدة تختلف في شدتها وضعفها فلا ينكر هذا التفاوت منصف وإنما ينكره الذين سمعوا من العلوم والاعتقادات أساميها ولم يدركوا من أنفسهم ذوقها، ولم يلاحظوا اختلاف أحوالهم وأحوال غيرهم فيها. وأما إذا أطلق بالمعنى الثالث وهو العمل مع التصديق، فلا يخفى بطرق التفاوت إلى نفس العمل، وهل يتطرق بسبب المواظبة على العمل تفاوت إلى نفس التصديق، هذا فيه نظر، وترك المداهنة في مثل هذا المقام أولى والحق أحق ما قيل. فأقول: إن المواظبة على الطاعات لها تأثير في تأكيد طمأنينة النفس إلى الاعتقاد التقليدي ورسوخه في النفس، وهذا أمر لا يعرفه إلا من سبر أحوال نفسه وراقبها في وقت المواظبة على الطاعة وفي وقت الفترة ولاحظ تفاوت الحال في باطنه، فإنه يزداد بسبب المواظبة على العمل أنسة لمعتقداته، ويتأكد به طمأنينته، حتى أن المعتقد الذي طالت منه المواظبة على العمل بموجب اعتقاده أعصا نفساً على المحاول تغييره وتشكيكه ممن لم تطل مواظبته، بل العادات تقضي بها، فإن من يعتقد الرحمة في قلبه على يتيم فإن أقدم على مسح رأسه وتفقد أمره صادف في قلبه عند ممارسة العمل بموجب الرحمة زيادة تأكيد في الرحمة، ومن يتواضع بقلبه لغيره فإذا عمل بموجبه ساجداً له أو مقبلاً يده ازداد التعظيم والتواضع في قلبه ولذلك تعبدنا بالمواظبة على أفعال هي مقتضى تعظيم القلب من الركوع والسجود ليزداد بسببها تعظيم القلوب، فهذه أمور يجحدها المتحذلقون في الكلام الذين أدركوا ترتيب العلم بسماع الألفاظ ولم يدركوها بذوق النظر. فهذه حقيقة المسألة، ومن هذا الخبر اختلافهم في معنى الرزق. وقول المعتزلة: إن ذلك مخصوص بما يملكه الإنسان حتى ألزموا أنه لا رزق لله تعال على البهائم، فربما قالوا هو مما لم يحرم تناوله، فقيل لهم فالظلمة ماتوا وقد عاشوا عمرهم لم يرزقوا، وقد قال أصحابنا إنه
عبارة عن المنتفع به كيف كان، ثم هو منقسم إلى حلال وحرام، ثم طولوا في حد الرزق وحد النعمة وتضييع الوقت بهذا وأمثاله دأب من لا يميز بين المهم وغيره ولا يعرف قدر بقية عمره، وإنه لا قيمة له فينبغي أن يضيع العمر إلا بالمهم وبين يدي الأنظار أمور مشكلة البحث عنها أهم من البحث عن موجب الألفاظ ومقتضى الإطلاقات، فنسأل الله أن يوفقنا للاشتغال لما يعنينا. المسألة الثالثة الفقهية: فمثل اختلافهم في أن الفاسق هل له أن يحتسب؟ وهذا نظر فقهي، فمن أين يليق بالكلام ثم بالمختصرات. ولكنا نقول الحق أن له أن يحتسب وسبيله التدرج في التصوير؛ وهو أن نقول: هل يشترط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كون الآمر والناهي معصوماً عن الصغائر والكبائر جميعاً؟ فإن شرط ذلك كان خرقاً للاجماع، فإن عصمة الأنبياء عن الكبائر إنما عرفت شرعاً، وعن الصغائر مختلف فيها، فمتى يوجد في الدنيا معصوم؟ وإن قلتم إن ذلك لا يشترط حتى يجوز للابس الحرير مثلاً وهو عاص به أن يمنع من الزنى وشرب الخمر، فنقول: وهل لشارب الخمر أن يحتسب على الكافر ويمنعه من الكفر ويقاتله عليه؟ فإن قالوا لا، خرقوا الاجماع إذ جنود المسلمين لم تزل مشتملة على العصاة والمطيعين ولم يمنعوا من الغزو لا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عصر الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، فإن قالوا نعم، فنقول: شارب الخمر هل له أن يمنع من القتل أم لا؟ فإن قيل لا، قلنا: فما الفرق بين هذا وبين لابس الحرير إذا منع من الخمر والزاني إذا منع من الكفر؟ وكما أن الكبيرة فوق الصغيرة فالكبائر أيضاً متفاوتة، فإن قالوا نعم، وضبطوا ذلك بأن المقدم على شيء لا يمنع من مثله ولا فيما دونه وله أن يمنع مما فوقه، فهذا الحكم لا مستند له إذ الزنى فوق الشرب ولا يبعد أن يزني ويمنع من الشراب ويمنع منه، ربما يشرب ويمنع غلمانه وأصحابه من الشرب، ويقول: ترك ذلك واجب عليكم وعلي والأمر بترك المحرم واجب علي مع الترك فلي أن أتقرب بأحد الواجبين، ولم يلزمني مع ترك أحدهما ترك الآخر، فإذن كما يجوز أن يترك الآمر بترك الشرب وهو بتركه يجوز أن يشرب ويأمر بالترك فهما واجبان فلا يلزم بترك أحدهما ترك الآخر.
فإن قيل: فيلزم على هذا أمور شنيعة وهو أن يزني الرجل بامرأة مكرهاً إياها على التمكين، فإن قال لها في أثناء الزنى عند كشفها وجهها باختيارها لا تكشفي وجهك فاني لست محرماً لك، والكشف لغير المحرم حرام، وأنت مكرهة على الزنى مختارة في كشف الوجه فأمنعك من هذا، فلا شك من أن هذه حسبة باردة شنيعة لا يصير إليها عاقل؛ وكذلك قوله إن الواجب علي شيئان العمل والأمر للغير، وأنا أتعاطى أحدهما وإن تركت الثاني كقوله: إن الواجب علي الوضوء دون الصلاة وأنا أصلي وإن تركت الوضوء، والمسنون في حقي الصوم والتسحر وأنا أتسحر وإن تركت الصوم، وذلك محال، لأن السحور للصوم والوضوء للصلاة، وكل واحد شرط الآخر وهو متقدم في الرتبة على المشروط، فكذلك نفس المرء مقدمة على غيره، فليهذب نفسه أولا ثم غيره أما إذا أهمل نفسه واشتغل بغيره كان ذلك عكس الترتيب الواجب، بخلاف ما إذا هذب نفسه وترك الحسبة وتهذيب غيره، فإن ذلك معصية ولكنه لا تناقض فيه. وكذلك الكافر ليس له ولاية الدعوة إلى الاسلام ما لم يسلم هو بنفسه، فلو قال الواجب علي شيئان ولي أن أترك أحدهما دون الثاني لم يكن منه، والجواب أن حسبة الزاني بالمرأة عليها ومنعها من كشفها وجهها جائزة عندنا، وقولكم إن هذه حسبة باردة شنيعة فليس الكلام في أنها حارة أو باردة مستلذة أو مستبشعة، بل الكلام في أنها حق أو باطل وكم من حق مستبرد مستثقل وكم من باطل مستحلى مستعذب، فالحق غير اللذيذ والباطل غير الشنيع، والبرهان القاطع فيه هو أنا نقول: قوله لها لا تكشفي وجهك فإنه حرام، ومنعه إياها بالعمل قول وفعل، وهذا القول والفعل إما أن يقال هو حرام أو يقال واجب أو يقال هو مباح، فإن قلتم إنه واجب فهو المقصود، وإن قلتم إنه مباح فله أن يفعل ما هو مباح، وإن قلتم إنه حرام فما مستند تحريمه؟ وقد كان هذا واجباً قبل اشتغاله بالزنى فمن أين يصير الواجب حراماً باقتحامه محرماً، وليس في قوله الأخير صدق عن الشرع بأنه حرام، وليس في فعله إلا المنع من اتحاد ما هو حرام، والقول بتحريم واحد منهما محال. ولسنا نعني بقولنا للفاسق ولاية الحسبة إلا أن قوله حق وفعله ليس بحرام، وليس هذا كالصلاة والوضوء فإن الصلاة هي المأمور بها وشرطها الوضوء، فهي بغير وضوء معصية وليست بصلاة، بل تخرج عن كونها صلاة وهذا القول لم يخرج عن كونه حقاً ولا الفعل خرج عن كونه منعاً من الحرام، وكذلك السحور عبارة عن الاستعانة على الصوم بتقديم الطعام ولا تعقل الاستعانة من غير العزم على ايجاد المستعان عليه. وأما قولكم أن تهذيبه نفسه أيضاً شرط لتهذيبه غيره، فهذا محل النزاع. فمن أين عرفتم ذلك؟ ولو قال قائل: تهذيب نفسه عن المعاصي شرط للغير ومنع الكفار، وتهذيبه نفسه عن الصغائر شرط للمنع عن الكبائر كان قوله مثل قولكم، وهو خرق للاجماع. وأما الكافر فإن حمل كافراً آخر بالسيف على الإسلام فلا يمنعه منه، ويقول عليه أن يقول لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأن يأمر غيره به ولم يثبت أن قوله شرط لأمره، فله أن يقول وأن يأمر وإن لم ينطق. فهذا غور هذه المسألة، وإنما أردنا إيرادها لتعلم أن أمثال هذه المسائل لا تليق بفن الكلام ولا سيما بالمعتقدات المختصرة والله أعلم بالصواب. يجاد المستعان عليه. وأما قولكم أن تهذيبه نفسه أيضاً شرط لتهذيبه غيره، فهذا محل النزاع. فمن أين عرفتم ذلك؟ ولو قال قائل: تهذيب نفسه عن المعاصي شرط للغير ومنع الكفار، وتهذيبه نفسه عن
الصغائر شرط للمنع عن الكبائر كان قوله مثل قولكم، وهو خرق للاجماع. وأما الكافر فإن حمل كافراً آخر بالسيف على الإسلام فلا يمنعه منه، ويقول عليه أن يقول لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأن يأمر غيره به ولم يثبت أن قوله شرط لأمره، فله أن يقول وأن يأمر وإن لم ينطق. فهذا غور هذه المسألة، وإنما أردنا إيرادها لتعلم أن أمثال هذه المسائل لا تليق بفن الكلام ولا سيما بالمعتقدات المختصرة والله أعلم بالصواب.
الباب الثالث في الامامة النظر في الإمامة أيضاً ليس من المهمات، وليس أيضاً من فن المعقولات فيها من الفقهيات، ثم إنها مثار للتعصبات والمعرض عن الخوض فيها أسلم من الخائض بل وإن أصاب، فكيف إذا أخطأ! ولكن إذا جرى الرسم باختتام المعتقدات به أردنا أن نسلك المنهج المعتاد فإن القلوب عن المنهج المخالف للمألوف شديدة النفار، ولكنا نوجز القول فيه ونقول: النظر فيه يدور على ثلاثة أطراف: الطرف الأول: في بيان وجوب نصب الإمام. ولا ينبغي أن تظن أن وجوب ذلك مأخوذ من العقل، فإنا بينا أن الوجوب يؤخذ من الشرع إلا أن يفسر الواجب بالفعل الذي فيه فائدة وفي تركه أدنى مضرة، وعند ذلك لا ينكر وجوب نصب الإمام لما فيه من الفوائد ودفع المضار في الدنيا، ولكنا نقيم البرهان القطعي الشرعي على وجوبه ولسنا نكتفي بما فيه من إجماع الأمة، بل ننبه على مستند الإجماع ونقول: نظام أمر الدين مقصود لصاحب الشرع عليه السلام قطعاً، وهذه مقدمة قطعية لا يتصور النزاع فيها، ونضيف إليها مقدمة أخرى وهو أنه لا يحصل نظام الدين إلا بإمام مطاع فيحصل من المقدمتين صحة الدعوى وهو وجوب نصب الإمام. فإن قيل: المقدمة الأخيرة غير مسلمة وهو أن نظام الدين لا يحصل إلا بإمام مطاع، فدلوا عليها. فنقول: البرهان عيه أن نظام الدين لا يحصل إلا بنظام الدنيا، ونظام الدنيا لا يحصل إلا بإمام مطاع، فهاتان مقدمتان ففي أيهما النزاع؟ فإن قيل لم قلتم إن نظام الدين لا يحصل إلا بنظام الدنيا، بل لا يحصل إلا بخراب الدنيا، فإن الدين والدنيا ضدان والاشتغال بعمارة أحدهما خراب الآخر، قلنا: هذا كلام من لا يفهم ما نريده بالدنيا الآن، فإنه لفظ مشترك قد يطلق على فضول التنعم والتلذذ والزيادة على الحاجة والضرورة، وقد يطلق على جميع ما هو محتاج إليه قبل الموت. وأحدهما ضد الدين والآخر شرطه، وهكذا يغلط من لا يميز
بين معاني الألفاظ المشتركة. فنقول: نظام الدين بالمعرفة والعبادة لا يتوصل إليهما إلا بصحة البدن وبقاء الحياة وسلامة قدر الحاجات من الكسوة والمسكن والأقوات، والأمن هو آخر الآفات، ولعمري من أصبح آمناً في سربه معافى في بدنه وله قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، وليس يأمن الإنسان على روحه وبدنه وماله ومسكنه وقوته في جميع الأحوال بل في بعضها، فلا ينتظم الدين إلا بتحقيق الأمن على هذه المهمات الضرورية، وإلا فمن كان جميع أوقاته مستغرقاً بحراسة نفسه من سيوف الظلمة وطلب قوته من وجوه الغلبة، متى يتفرغ للعلم والعمل وهما وسيلتاه إلى سعادة الآخرة، فإذن بان نظام الدنيا، أعني مقادير الحاجة شرط لنظام الدين. وأما المقدمة الثانية وهو أن الدنيا والأمن على الأنفس والأموال لا ينتظم إلا بسلطان مطاع فتشهد له مشاهدة أوقات الفتن بموت السلاطين والأئمة، وإن ذلك لو دام ولم يتدارك بنصب سلطان آخر مطاع دام الهرج وعم السيف وشمل القحط وهلكت المواشي وبطلت الصناعات، وكان كل غلب سلب ولم يتفرغ أحد للعبادة والعلم إن بقي حياً، والأكثرون يهلكون تحت ظلال السيوف، ولهذا قيل: الدين والسلطان توأمان، ولهذا قيل: الدين أس والسلطان حارس وما لا أس له فمهدوم وما لا حارس له فضائع. وعلى الجملة لا يتمارى العاقل في أن الخلق على اختلاف طبقاتهم وما هم عليه من تشتت الأهواء وتباين الآراء لو خلوا وراءهم ولمي كن رأي مطاع يجمع شتاتهم لهلكوا من عند آخرهم، وهذا داء لا علاج له إلا بسلطان قاهر مطاع يجمع شتات الآراء، فبان أن السلطان ضروري في نظام الدنيا، ونام الدنيا ضروري في نظام الدين، ونظام الدين ضروري في الفوز بسعادة الآخرة وهو مقصود الأنبياء قطعاً، فكان وجوب نصب الإمام من ضروريات الشرع الذي لا سبيل إلى تركه فاعلم ذلك. الطرف الثاني: في بيان من يتعين من سائر الخلق لأن ينصب إماماً. فنقول: ليس يخفى أن التنصيص على واحد نجعله إماماً بالتشهي غير ممكن، فلا بد له من تميز بخاصية يفارق سائر الخلق بهذا، فتلك خاصية في نفسه وخاصية من جهة غيره. أما من نفسه فأن يكون أهلاً لتدبير الخلق وحملهم على مراشدهم. وذلك بالكفاية والعلم والورع، وبالجملة خصائص القضاة تشترط فيه مع زيادة نسب قريش؛ وعلم هذا الشرط الرابع بالسمع حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش فهذا تميزه عن أكثر الخلق ولكن ربما يجتمع في قريش جماعة موصوفون بهذه الصفة فلا بد من خاصية أخرى
تميزه، وليس ذلك إلا التولية أو التفويض من غيره، فإنما يتعين للإمامة مهما وجدت التولية في حقه على الخصوص من دون غيره، فيبقى الآن النظر في صفة المولى فإن ذلك لا يسلم لكل أحد بل لا بد فيه من خاصية وذلك لا يصدر إلا من أحد ثلاثة: إما التنصيص من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، وإما التنصيص من جهة إمام العصر بأن يعين لولاية العهد شخصاً معيناً من أولاده أو سائر قريش، وإما التفويض من رجل ذي شوكة يقتضي انقياده وتفويضه متابعة الآخرين ومبادرتهم إلى المبايعة، وذلك قد يسلم في بعض الأعصار لشخص واحد مرموق في نفسه مرزوق بالمتابعة مسؤول على الكافة، ففي بيعته وتفويضه كفاية عن تفويض غيره لأن المقصود أن يجتمع شتات الآراء لشخص مطاع وقد صار الإمام بمبايعة هذا المطاع مطاعاً، وقد لا يتفق ذلك لشخص واحد بل لشخصين أو ثلاثة أو جماعة فلا بد من اجتماعهم وبيعتهم واتفاقهم على التفويض حتى تتم الطاعة. بل أقول: لو لم يكن بعد وفاة الإمام الاقرشي واحد مطاع متبع فنهض بالإمامة وتولاها بنفسه ونشأ بشوكته وتشاغل بها واستتبع كافة الخلق بشوكته وكفايته وكان موصوفاً بصفات الأئمة فقد انعقدت إمامته ووجبت طاعته، فإنه تعين بحكم شوكته وكفايته، وفي منازعته إثارة الفتن إلا أن من هذا حاله فلا يعجز أيضاً عن أخذ البيعة من أكابر الزمان وأهل الحل والعقد، وذلك أبعد من الشبهة فلذلك لا يتفق مثل هذا في العادة إلا عن بيعة وتفويض. فإن قيل: فإن كان المقصود حصول ذي رأي مطاع يجمع شتات الآراء ويمنع الخلق من المحاربة والقتال ويحملهم على مصالح المعاش والمعاد، فلو انتهض لهذا الأمر من فيه الشروط كلها سوى شروط القضاء ولكنه مع ذلك يراجع العلماء ويعمل بقولهم فماذا ترون فيه، أيجب خلعه ومخالفته أم تجب طاعته؟ قلنا: الذي نراه ونقطع أنه يجب خلعه إن قدر على أن يستبدل عنه من هو موصوف بجميع الشروط من غير إثارة فتنة وتهييج قتال، وإن لم يكن ذلك إلا بتحريك قتال وجبت طاعته وحكم بإمامته لأن ما يفوتنا من المصارفة بين كونه عالماً بنفسه أو مستفتياً من غيره دون ما يفوتنا بتقليد غيره إذا افتقرنا إلى تهييج فتنة لا ندري عاقبتها. وربما يؤدي ذلك إلى هلاك النفوس والأموال، وزيادة صفة العلم إنما تراعى مزية وتتمة للمصالح فلا يجوز أن يعطل أصل المصالح في التشوق إلى مزاياها وتكملاتها، وهذه مسائل فقهية فيلون المستعبد لمخالفته المشهود على نفسه استبعاده ولينزل من غلوائه فالأمر أهون مما يظنه، وقد استقضينا تحقيق هذا المعنى في الكتاب الملقب بالمستظهري المصنف في الرد على الباطنية،
فإن قيل فإن تسامحتم بخصلة العلم لزمكم التسامح بخصلة العدالة وغير ذلك من الخصال، قلنا: ليست هذه مسامحة عن الاختيار ولكن الضرورات تبيح المحظوارت، فنحن نعلم أن تناول الميتة محظور ولكن الموت أشد منه، فليت شعري من لا يساعد على هذا ويقضي ببطلان الإمامة في عصرنا لفوات شروطها وهو عاجز عن الاستبدال بالمتصدي لها بل هو فاقد للمتصف بشروطها، فأي أحواله أحسن: أن يقول القضاة معزولون والولايات باطلة والأنكحة غير منعقدة وجميع تصرفات الولاة في أقطار العالم غير نافذة، وإنما الخلق كلهم مقدمون على الحرام، أو أن يقول الإمامة منعقدة والتصرفات والولايات نافذة بحكم الحال والاضطرار، فهو بين ثلاثة أمور إما أن يمنع الناس من الأنكحة والتصرفات المنوطة بالقضاة وهو مستحيل ومؤدي إلى تعطيل المعايش كلها ويفضي إلى تشتيت الآراء ومهلك للجماهير والدهماء أو يقول إنهم يقدمون على الأنكحة والتصرفات ولكنهم مقدمون على الحرام، إلا أنه لا يحكم بفسقهم ومعصيتهم لضرورة الحال، وإما أن نقول يحكم بانعقاد الإمامة مع فوات شروطها لضرورة الحال ومعلوم أن البعيد مع الأبعد قريب، وأهون الشرين خير بالاضافة، ويجب على العاقل اختياره، فهذا تحقيق هذا الفصل وفيه غنية عند البصير عن التطويل ولكن من لم يفهم حقيقة الشيء وعلته وإنما يثبت بطول الألفة في سمعه فلا تزال النفرة عن نقيضه في طبعه إذ فطام الضعفاء عن المألوف شديد عجز عنه الأنبياء فكيف غيرهم. أبعد قريب، وأهون الشرين خير بالاضافة، ويجب على العاقل اختياره، فهذا تحقيق هذا الفصل وفيه غنية عند البصير عن التطويل ولكن من لم يفهم حقيقة الشيء وعلته وإنما يثبت بطول الألفة في سمعه فلا تزال النفرة عن نقيضه في طبعه إذ فطام الضعفاء عن المألوف شديد عجز عنه الأنبياء فكيف غيرهم. فإن قيل: فهلا قلتم إن التنصيص واجب من النبي والخليفة كي يقطع ذلك دابر الاختلاف كما قالت بعض الإمامية إذ ادعوا أنه واجب، قلنا: لأنه لو كان واجباً لنص عليه الرسول عليه السلام، ولم ينص هو ولم ينص عمر أيضاً بل ثبتت إمامة أبو بكر وإمامة عثمان وإمامة علي رضي الله عنهم بالتفويض، فلا تلتفت إلى تجاهل من يدعي أنه صلى الله عليه وسلم نص على علي لقطع النزاع ولكن الصحابة كابروا النص وكتموه، فأمثال ذلك يعارض بمثله ويقال: بم تنكرون على من قال إنه نص على أبي بكر فأجمع الصحابة على موافقته النص ومتابعته، وهو أقرب من تقدير مكابرتهم النص وكتمانه، ثم إنما يتخيل وجوب ذلك لتعذر قطع الاختلاف وليس ذلك بمعتذر، فإن البيعة تقطع مادة الاختلاف والدليل عليه عدم الاختلاف في زمان أبي بكر وعثمان رضي الله عنهم، وقد توليا البيعة، وكثرته في زمان علي رضي الله عنه ومعتقد الإمامية أنه تولى بالنص.
الطرف الثالث: في شرح عقيدة أهل السنة في الصحابة والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. اعلم أن للناس في الصحابة والخلفاء إسراف في أطراف؛ فمن مبالغ في الثناء حتى يدعي العصمة للأئمة، ومنهم متهجم على الطعن بطلق اللسان بذم الصحابة. فلا تكونن من الفريقين واسلك طريق الاقتصاد في الاعتقاد. واعلم أن كتاب الله مشتمل على الثناء على المهاجرين والأنصار وتواترت الأخبار بتزكية النبي صلى الله عليه وسلم إياهم بألفاظ مختلفة، كقوله أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وكقوله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم وما من واحد إلا وورد عليه ثناء خاص في حقه يطول نقله، فينبغي أن تستصحب هذا الاعتقاد في حقهم ولا تسيء الظن بهم كما يحكى عن أحوال تخالف مقتضى حسن الظن، فأكثر ما ينقل مخترع بالتعصب في حقهم ولا أصل له وما ثبت نقله فالتأويل متطرق إليه ولم يجز ما لا يتسع العقل لتجويز الخطأ والسهو فيه، وحمل أفعالهم على قصد الخير وإن لم يصيبوه. والمشهور من قتال معاوية مع علي ومسير عائشه رضي الله عنهم إلى البصرة والظن بعائشة أنها كانت تطلب تطفئة الفتنة ولكن خرج الأمر من الضبط، فأواخر الأمور لا تبقى على وفق طلب أوائلها، بل تنسل عن الضبط، والظن بمعاوية أنه كان على تأويل وظن فيما كان يتعاطاه وما يحكى سوى هذا من روايات الآحاد فالصحيح منه مختلط بالباطل والاختلاف أكثره اختراعات الروافض والخوارج وأرباب الفضول الخائضون في هذه الفنون. فينبغي أن تلازم الإنكار في كل ما لم يثبت، وما ثبت فيستنبط له تأويلاً. فما تعذر عليك فقل: لعل له تأويلاً وعذراً لم أطلع عليه. واعلم أنك في هذا المقام بين أن تسيء الظن بمسلم وتطعن عليه وتكون كاذباً أو تحسن الظن به وتكف لسانك عن الطعن وأنت مخطئ مثلاً، والخطأ في حسن الظن بالمسلم أسلم من الصواب بالطعن فيهم، فلو سكت إنسان مثلاً عن لعن ابليس أو لعن أبي جهل أو أبي لهب أو من شئت من الأشرار طول عمره لم يضره السكوت، ولو هفا هفوة بالطعن في مسلم بما هو بريء عند الله تعالى منه فقد تعرض
للهلاك، بل أكثر ما يعلم في الناس لا يحل النطق به لتعظيم الشرع الزجر عن الغيبة، مع أنه إخبار عما هو متحقق في المغتاب. فمن يلاحظ هذه الفصول ولم يكن في طبعه ميل إلى الفضول آثر ملازمته السكوت وحسن الظن بكافة المسلمين وإطلاق اللسان بالثناء على جميع السلف الصالحين. هذا حكم الصحابة عامة. فأما الخلفاء الراشدون فهم أفضل من غيرهم، وترتيبهم في الفضل عند أهل السنة كترتيبهم في الإمامة، وهذا لمكان أن قولنا فلان أفضل من فلان أن معناه إن محله عند الله تعالى في الآخرة أرفع، وهذا غيب لا يطلع عليه إلا الله ورسوله إن أطلعه عليه، ولا يمكن أن يدعي نصوص قاطعة من صاحب الشرع متواترة مقتضية للفضيلة على هذا الترتيب، بل المنقول الثناء على جميعهم. واستنباط حكم الترجيحات في الفضل من دقائق ثنائه عليهم رمي في عماية واقتحام أمر آخر أغنانا الله عنه، ويعرف الفضل عند الله تعالى بالأعمال مشكل أيضاً وغايته رجم ظن، فكم من شخص متحرم الظاهر وهو عند الله بمكان ليس في قلبه وخلق خفي في باطنه، وكم من مزين بالعبادات الظاهرة وهو في سخط الله لخبث مستكن في باطنه فلا مطلع على السرائر إلا الله تعالى. ولكن إذا ثبت أنه لا يعرف الفضل إلا بالوحي ولا يعرف من النبي إلا بالسماع وأولى الناس بالسماع ما يدل على تفاوت الفضائل الصحابة الملازمون لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وهم قد أجمعوا على تقديم أبي بكر، ثم نص أبو بكر على عمر، ثم أجمعوا بعده على عثمان، ثم على علي رضي الله عنهم. وليس يظن منهم الخيانة في دين الله تعالى لغرض من الأغراض، وكان إجماعهم على ذلك من أحسن ما يستدل به على مراتبهم في الفضل، ومن هذا اعتقد أهل السنة هذا الترتيب في الفضل ثم بحثوا عن الأخبار فوجدوا فيها ما عرف به مستند الصحابة وأهل الإجماع في هذا الترتيب. فهذا ما أردنا أن نقتصر عليه من أحكام الإمامة والله أعلم وأحكم.
الباب الرابع بيان من يجب تكفيره من الفرق اعلم أن للفرق في هذا مبالغات وتعصبات، فربما انتهى بعض الطوائف إلى تكفير كل فرقة سوى الفرقة التي يعزى إليها، فإذا أردت أن تعرف سبيل الحق فيه فاعلم قبل كل شيء أن هذه مسألة فقهية، أعني الحكم بتكفير من قال قولاً وتعاطى فعلاً، فإنها تارة تكون معلومة بأدلة سمعية وتارة تكون مظنونة بالاجتهاد، ولا مجال لدليل العقل فيها البتة، ولا يمكن تفهيم هذا إلا بعد تفهيم قولنا: إن هذا الشخص كافر والكشف عن معناه، وذلك يرجع إلى الإخبار عن مستقره في الدار الآخرة وأنه في النار على التأبيد، وعن حكمه في الدنيا وأنه لا يجب القصاص بقتله ولا يمكن من نكاح مسلمة ولا عصمة لدمه وماله، إلى غير ذلك من الأحكام، وفيه أيضاً إخبار عن قول صادر منه وهو كذب، أو اعتقاد وهو جهل، ويجوز أن يعرف بأدلة العقل كون القول كذباً وكون الاعتقاد جهلاً، ولكن كون هذا الكذب والجهل موجباً للتكفير أمر آخر، ومعناه كونه مسلطاً على سفك دمه وأخذ أمواله، ومعنى كونه مسلطاً على سفك دمه وأخذ أمواله ومبيحاً لإطلاق القول بأنه مخلد في النار؛ وهذه الأمور شرعية ويجوز عندنا أن يرد الشرع بأن الكذاب أو الجاهل أو المكذب مخلد في الجنة وغير مكترث بكفره، وإن ماله ودمه معصوم ويجوز أن يرد بالعكس أيضاً نعم ليس يجور أن يرد بأن الكذب صدق وأن الجهل علم، وذلك ليس هو المطلوب بهذه المسألة بل المطلوب أن هذا الجهل والكذب هل جعله الشرع سبباً لإبطال عصمته والحكم بأنه مخلد في النار؟ وهو كنظرنا في أن الصبي إذا تكلم بكلمتي الشهادة فهو كافر بعد أو مسلم؟ أي هذا اللفظ الذي صدر منه وهو صدق، والاعتقاد الذي وجد في قلبه وهو حق، هل جعله الشرع سبباً لعصمة دمه وماله أم لا؟ وهذا إلى الشرع. فأما وصف قوله بأنه كذب أو اعتقاده بأنه جهل، فليس إلى الشرع، فإذاً معرفة الكذب والجهل يجوز أن يكون عقلياً وأما معرفة كونه كافر أو مسلماً فليس إلا شرعياً، بل هو كنظرنا في الفقه في أن هذا الشخص رقيق أو حر، ومعناه أن السبب الذي جرى هل نصبه الشرع مبطلاً
لشهادته وولايته ومزيلاً لأملاكه ومسقطاً للقصاص عن سيده المستولي عليه، إذا قتله، فيكون كل ذلك طلباً لأحكام شرعية لا يطلب دليلها إلا من الشرع. ويجوز الفتوى في ذلك بالقطع مرة وبالظن والاجتهاد أخرى، فإذا تقرر هذا الأصل فقد قررنا في أصول الفقه وفروعه أن كل حكم شرعي يدعيه مدع فإما أن يعرفه بأصل من أصول الشرع من إجماع أو نقل أو بقياس على أصل، وكذلك كون الشخص كافراً إما أن يدرك بأصل أو بقياس على ذلك الأصل، والأصل المقطوع به أن كل من كذب محمداً صلى الله عليه وسلم فهو كافر أي مخلد في النار بعد الموت، ومستباح الدم والمال في الحياة، إلى جملة الأحكام. إلا أن التكذيب على مراتب. الرتبة الأولى: تكذيب اليهود والنصارى وأهل الملل كلهم من المجوس وعبدة الأوثان وغيرهم، فتكفيرهم منصوص عليه في الكتاب ومجمع عليه بين الأمة، وهو الأصل وما عداه كالملحق به. الرتبة الثانية: تكذيب البراهمة المنكرين لأصل النبوات، والدهرية المنكرين لصانع العالم. وهذا ملحق بالمنصوص بطريق الأولى، لأن هؤلاء كذبوه وكذبوا غيره من الأنبياء، أعني البراهمة، فكانوا بالتكفير أولى من النصارى واليهود، والدهرية أولى بالتكفير من البراهمة لأنهم أضافوا إلى تكذيب الأنبياء إنكار المرسل ومن ضرورة إنكار النبوة، ويلتحق بهذه الرتبة كل من قال قولاً لا تثبت النبوة في أصلها أو نبوة نبينا محمد على الخصوص إلا بعد بطلان قوله. الرتبة الثالثة: الذين يصدقون بالصانع والنبوة ويصدقون النبي، ولكن يعتقدون أموراً تخالف نصوص الشرع ولكن يقولون أن النبي محق، وما قصد بما ذكره إلا صلاح الخلق ولكن لم يقدر على التصريح بالحق لكلال أفهام الخلق عن دركه، وهؤلاء هم الفلاسفة. ويجب القطع بتكفيرهم في ثلاثة مسائل وهي: إنكارهم لحشر الأجساد والتعذيب بالنار، والتنعيم في الجنة بالحور بالعين والمأكول والمشروب والملبوس. والأخرى: قولهم إن الله لا يعلم الجزئيات وتفصيل الحوادث وإنما يعلم الكليات، وإنما الجزئيات تعلمها الملائكة السماوية.
والثالثة: قولهم إن العالم قديم وإن الله تعالى متقدم على العالم بالرتبة مثل تقدم العلة على المعلول، وإلا فلم تر في الوجود إلا متساويين. وهؤلاء إذا أوردوا عليهم آيات القرآن زعموا أن اللذات العقلية تقصر الأفهام عن دركها، فمثل لهم ذلك باللذات الحسية وهذا كفر صريح، والقول به إبطال لفائدة الشرائع وسد لباب الاهتداء بنور القرآن واستبعاد للرشد من قول الرسل، فإنه إذا جاز عليهم الكذب لأجل المصالح بطلت الثقة بأقوالهم فما من قول يصدر عنهم إلا ويتصور أن يكون كذباً، وإنما قالوا ذلك لمصلحة. فإن قيل: فلم قلتم مع ذلك بأنهم كفرة؟ قلنا لأنه عرف قطعاً من الشرع أن من كذب رسول الله فهو كافر وهؤلاء مكذبون ثم معالمون للكذب بمعاذير فاسدة وذلك لا يخرج الكلام عن كونه كذباً. الرتبة الرابعة: المعتزلة والمشبهة والفرق كلها سوى الفلاسفة، وهم الذين يصدقون ولا يجوزون الكذب لمصلحة وغير مصلحة، ولا يشتغلون بالتعليل لمصلحة الكذب بل بالتأويل ولكنهم مخطئون في التأويل، فهؤلاء أمرهم في محل الاجتهاد. والذي ينبغي أن يميل المحصل إليه الاحتراز من التكفير ما وجد إليه سبيلاً. فإن استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة المصرحين بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله خطأ، والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وهذه الفرق منقسمون إلى مسرفين وغلاة، وإلى مقتصدين بالإضافة إليهم، ثم المجتهد يرى تكفيرهم وقد يكون ظنه في بعض المسائل وعلى بعض الفرق أظهر.
وتفصيل آحاد تلك المسائل يطول ثم يثير الفتن والأحقاد، فإن أكثر الخائضين في هذا إنما يحركهم التعصب واتباع تكفير المكذب للرسول، وهؤلاء ليسوا مكذبين أصلاً ولم يثبت لنا أن الخطأ في التأويل موجب للتكفير، فلا بد من دليل عليه، وثبت أن العصمة مستفادة من قول لا إله إلا الله قطعاً، فلا يدفع ذلك إلا بقاطع. وهذا القدر كاف في التنبيه على أن إسراف من بالغ في التكفير ليس عن برهان فإن البرهان إما أصل أو قياس على أصل، والأصل هو التكذيب الصريح ومن ليس بمكذب فليس في معنى الكذب أصلاً فيبقى تحت عموم العصمة بكلمة الشهادة. الرتبة الخامسة: من ترك التكذيب الصريح ولكن ينكر أصلاً من أصول الشرعيات المعلومة بالتواتر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقول القائل: الصلوات الخمس غير واجبة، فإذا قرئ عليه القرآن والأخبار قال: لست أعلم صدر هذا من رسول الله، فلعله غلط وتحريف. وكمن يقول: أنا معترف بوجوب الحج ولكن لا أدري أين مكة وأين الكعبة، ولا أدري أن البلد الذي تستقبله الناس ويحجونه هل هي البلد التي حجها النبي عليه السلام ووصفها القرآن. فهذا أيضاً ينبغي أن يحكم بكفره لأنه مكذب ولكنه محترز عن التصريح، وإلا فالمتواترات تشترك في دركها العوام والخواص وليس بطلان ما يقوله كبطلان مذهب المعتزلة فإن ذلك يختص لدركه اؤلوا البصائر من النظار إلا أن يكون هذا الشخص قريب العهد بالاسلام ولم يتواتر عنده بعد هذه الأمور فيمهله إلى أن يتواتر عنده، ولسنا نكفره لأنه أنكر أمراً معلوماً بالتواتر، وإنه لو أنكر غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم المتواترة أو أنكر نكاحه حفصة بنت عمر، أو أنكر وجود أبي بكر وخلافته لم يلزم تكفيره لأنه ليس تكذيباً في أصل من أصول الدين مما يجب التصديق به بخلاف الحج والصلاة وأركان الإسلام، ولسنا نكفره بمخالفة الاجماع، فإن لنا نظرة في تكفير النظام المنكر لأصل الاجماع، لأن الشبه كثيرة في كون الاجماع حجة قاطعة وإنما الاجماع عبارة عن التطابق على رأي نظري وهذا الذي نحن فيه تطابق على الأخبار غير محسوس، وتطابق العدد الكبير على الأخبار غير محسوس على سبيل التواتر الموجب للعلم الضروري، وتطابق أهل الحق والعقد على رأي واحد نظري لا يوجب العلم إلا من جهة الشرع ولذلك لا يجوز أن يستدل على حدوث العالم بتواتر الأخبار من النظار الذين حكموا به، بل لا تواتر إلا في المحسوسات.
الرتبة السادسة: أن لا يصرح بالتكذيب ولا يكذب أيضاً أمراً معلوماً على القطع بالتواتر من أصول الدين ولكن منكر ما علم صحته إلا الاجماع، فأما التواتر فلا يشهد له كالنظام مثلاً، إذ أنكر كون الاجماع حجة قاطعة في أصله. وقال: ليس يدل على استحالة الخطأ على أهل الاجماع دليل عقلي قطعي ولا شرعي متواتر لا يحتمل التأويل، فكلما تستشهد به من الأخبار والآيات له تأويل بزعمه، وهو في قوله خارق لإجماع التابعين؛ فإنا نعلم إجماعهم على أن ما أجمع عليه الصحابة حق مقطوع به لا يمكن خلافه فقد أنكر الإجماع وخرق الإجماع وهذا في محل الاجتهاد، ولي فيه نظر، إذ الاشكالات كثيرة في وجه كون الاجماع حجة فيكاد يكون ذلك الممهد للعذر ولكن لو فتح هذا الباب انجر إلى أمور شنيعة وهو أن قائلاً لو قال: يجوز أن يبعث رسول بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيبعد التوقف في تكفيره ومستند استحالة ذلك عند البحث تستمد من الاجماع لا محالة فإن العقل لا يحيله وما نقل فيه من قوله: لا نبي بعدي ومن قوله تعالى: خاتم النبيين فلا يعجز هذا القائل عن تأويله فيقول: خاتم النبيين أراد به أولي العزم من الرسل، فإن قالوا النبيين عام، فلا يبعد تخصيص العام. وقوله لا نبي بعدي لم يرد به الرسول، وفرق بين النبي والرسول والنبي أعلى رتبة من الرسول إلى غير ذلك من أنواع الهذيان. فهذا وأمثاله لا يمكن أن ندعي استحالته من حيث مجرد اللفظ فإنا في تأويل ظواهر التشبيه قضينا باحتمالات أبعد من هذه ولم يكن ذلك مبطلاً للنصوص، ولكن الرد على هذا القائل أن الأمة فهمت بالإجماع من هذا اللفظ ومن قرائن أحواله أنه أفهم عدم نبي بعده أبداً وعدم رسول الله أبداً وأنه ليس فيه تأويل ولا تخصيص فمنكر هذا لا يكون إلا منكر الإجماع، وعند هذا يتفرع مسائل متقاربة مشتبكة يفتقر كل واحد منها إلى نظر، والمجتهد في جميع ذلك يحكم بموجب ظنه يقيناً وإثباتاً والغرض الآن تحرير معاقد الأصول التي ياتي عليها التكفير وقد نرجع إلى هذه المراتب السلتة ولا يعترض فرع إلا ويندرج تحت رتبة من هذه الرتب، فالمقصود التأصيل دون التفصيل. فإن قيل: السجود بين يدي الصنم كفر، وهو فعل مجرد لا يدخل تحت هذه الروابط، فهل هو أصل آخر؟ قلنا: لا، فإن الكفر في اعتقاده تعظيم الصنم، وذلك تكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم
والقرآن ولكن يعرف اعتقاده تعظيم الصنم تارة بتصريح لفظه، وتارةً بالإشارة إن كان أخرساً، وتارة بفعل يدل عليه دلالة قاطعة كالسجود حيث لا يحتمل أن يكون السجود لله وإنما الصنم بين يديه كالحائط وهو غافل عنه أو غير معتقد تعظيمه، وذلك يعرف بالقرائن. وهذا كنظرنا أن الكافر إذا صلى بجماعتنا هل يحكم باسلامه، أي هل يستدل على اعتقاد التصديق؟ فليس هذا إذن نظراً خارجاً عما ذكرناه. ولنقتصر على هذا القدر في تعريف مدارك التكفير وإنما أوردناه من حيث أن الفقهاء لم يتعرضوا له والمتكلمون لم ينظروا فيه نظراً فقهياً، إذ لم يكن ذلك من فنهم، ولم ينبه بعضهم بها لقرب المسألة من الفقهيات، لأن النظر في الأسباب الموجبة للتكفير من حيث أنها أكاذيب وجهالات نظر عقلي، ولكن النظر من حيث أن تلك الجهالات مقتضية بطلان العصمة وإنما الخلود في النار نظر فقهي وهو المطلوب. ولنختم الكتاب بهذا، فقد أظهرنا الاقتصاد في الاعتقاد وحذفنا الحشو والفضول المستغنى عنه، الخارج من أمهات العقائد، وقواعدها، واقتصرنا من أدلة ما أوردناه على الجلي الواضح الذي لا تقصر أكثر الأفهام عن دركه، فنسأل الله تعالى ألا يجعله وبالاً علينا، وأن يضعه في ميزان الصالحات إذا ردت إلينا أعمالنا، والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً آمين.
==========
المنقذ من الضلال
المنقذ من الضلال
الإمام أبي حامد الغزالي
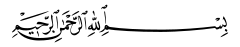
الحمد لله الذي يفتتح بحمده كل رسالة ومقالة ، والصلاة على محمد المصطفى صاحب النبوة والرسالة ، وعلى آله وأصحابـه الهادين من الضلالة.
أما بعد: فقد سألتني أيها الأخ في الدين ، أن أبثّ إليك غاية العلوم وأسرارها ، وغائلة المذاهب وأغوارها ، وأحكي لك ما قاسيته في استخلاص الحق من بين اضطراب الفرق ، مع تباين المسالك والطرق ، وما استجرأت عليه من الارتفاع عن حضيض التقليد ، إلى يفَاعٍ الاستفسار ، وما استفدته أولاً من علم الكلام ، وما اجَتَوْيـُته ثانياً من طرق أهل التعليم القاصرين لَدرك الحق على تقليد الإمام ، وما ازدريته ثالثاً من طرق التفلسف ، وما ارتضيته آخراً من طريقة التصوف ، وما انجلى لي في تضاعيف تفتيشي عن أقاويل الخلق ، من لباب الحق ، وما صرفني عن نشر العلم ببغداد ، مع كثرة الطلبة ، وما دعاني إلى معاودته بنيْسابورَ بعد طول المدة ، فابتدرت لإجابتك إلى مطلبك ، بعد الوقوف على صدق رغبتك ، وقلت مستعيناً بالله ومتوكلاً عليه ، ومستوثقاً منه ، وملتجئاً إليه:
اعلموا - أحسن الله ( تعالى ) إرشادكم ، وألاَنَ للحق قيادكم - أن اختلاف الخلق في الأديان والملل ، ثم اختلاف الأئمة في المذاهب ، على كثرة الفرق وتباين الطرق ، بحر عميق غرق فيه الأكثرون ، وما نجا منه إلا الأقلون ، وكل فريق يزعم أنه الناجي ، و ﴿ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾ [الروم: 32] هو الذي وعدنا بـه سيد المرسلين ، صلوات الله عليه ، وهو الصادق الصدوق حيث قال: « ستفترق أمتي ثلاثاً وسبعين فرقة الناجية منـها واحدة » فقد كان ما وعد أن يكون.
ولم أزل في عنفوان شبابي ( وريعان عمري ) ، منذ راهقت البلوغ قبل بلوغ العشرين إلى الآن ، وقد أناف السن على الخمسين ، أقتحم لجّة هذا البحر العميق ، وأخوض غَمرَتهُ خَوْضَ الجَسُور ، لا خَوْضَ الجبان الحذور ، وأتوغل في كل مظلمة ، وأتـهجّم على كل مشكلة ، وأتقحم كل ورطة ، وأتفحص عن عقيدة كل فرقة ، وأستكشف أسرار مذهب كل طائفة ؛ لأميز بين مُحق ومبطل ، ومتسنن ومبتدع ، لا أغادر باطنيًّا إلا وأحب أن أطلع على باطنيته ، ولا ظاهريّاً إلا وأريد أن أعلم حاصل ظاهريته ، ولا فلسفياً إلا وأقصد الوقوف على كنـه فلسفته ، ولا متكلماً إلا وأجتهد في الإطلاع على غاية كلامه ومجادلته ، ولا صوفياً إلا وأحرص على العثور على سر صوفيته ، ولا متعبداً إلا وأترصد ما يرجع إليه حاصل عبادته ، ولا زنديقاً معطلاً إلا وأتجسس وراءه للتنبه لأسباب جرأته في تعطيله وزندقته. وقد كان التعطش إلى درك حقائق الأمور دأبي وديدني من أول أمري وريعان عمري ، غريزة وفطرة من الله وضُعتا في جِبِلَّتي ، لا باختياري وحيلتي ، حتى انحلت عني رابطة التقليد وانكسرت علي العقائد الموروثة على قرب عهد سن الصبا ؛ إذ رأيت صبيان النصارى لا يكون لهم نشوءٌ إلا على التنصُر ، وصبيان اليهود لا نشوء لهم إلا على التهود ، وصبيان المسلمين لا نشوء لهم إلا على الإسلام. وسمعت الحديث المروي عن رسول الله ﷺ حيث قال : « كل مولودٍ يولدُ على الفطرةِ فأبواهُ يُهودأنه وينُصرأنه ويُمجِّسَأنه »
فتحرك باطني إلى ( طلب ) حقيقة الفطرة الأصلية ، وحقيقة العقائد العارضة بتقليد الوالدين والأستاذين ، والتمييز بين هذه التقليدات ، وأوائلها تلقينات ، وفي تمييز الحق منها عن الباطل اختلافات ، فقلت في نفسي:أولاً إنما مطلوبي العلم بحقائق الأمور ، فلا بُد من طلب حقيقة العلم ما هي؟ فظهر لي أن العلم اليقيني هو الذي ينكشف فيه المعلوم انكشافاً لا يبقى معه ريب ، ولا يقارنه إمكان الغلط والوهم ، ولا يتسع القلب لتقدير ذلك ؛ بل الأمان من الخطأ ينبغي أنا يكون مقارناً لليقين مقارنة لو تحدى بإظهار بطلأنه مثلاً من يقلب الحجر ذهباً والعصا ثعباناً ، لم يورث ذلك شكاً وإنكاراً ؛ فإني إذا علمت أن العشرة أكثر من الثلاثة ، فلو قال لي قائل: لا ، بل الثلاثة أكثر [ من العشرة ] بدليل أني أقلب هذه العصا ثعباناً ، وقلبها ، وشاهدت ذلك منه ، لم أشك بسببه في معرفتي ، ولم يحصل لي منه إلا التعجب من كيفية قدرته عليه! فأما الشك فيما علمته ، فلا. ثم علمت أن كل ما لا أعلمه على هذا الوجه ولا أتيقنه هذا النوع من اليقين ، فهو علم لا ثقة به ولا أمان معه ، وكل علم لا أمان معه ، فليس بعلم يقيني.
محتويات
1 مَدَاخِلُ السَفْسَطة وجَحْد العُلوم
2 القَولُ في أصْنَافِ الطَّالبْين
2.1 عِلْمُ الكَلاَم: مَقْصُوده وحَاصِله
2.2 الفَلسْفَة
2.3 القَولُ ِفي مَذْهَبِ التَّعلِيم وغَائِلَته
2.4 طرُق الصُّوفِيَّة
3 حَقيقَة النُبُوَّة: واضطِرار كَافةِ الخَلق إليهَا
4 سَبَب نشر العِلْم بعَدْ الإعرَاضِ عَنـه
مَدَاخِلُ السَفْسَطة وجَحْد العُلوم
ثم فتشت عن علومي فوجدت نفسي عاطلاً من علم موصوف بـهذه الصفة إلا في الحسيات والضروريات. فقلت: الآن بعد حصول اليأس ، لا مطمع في اقتباس المشكلات إلا من الجليَّات ، وهي الحسيات والضروريات ، فلا بد من إحكامها أولاً لأتيقن أن ثقتي بالمحسوسات ، وأماني من الغلط في الضروريات ، من جنس أماني الذي كان من قَبلُ في التقليديات ، ومن جنس أمان أكثر الخلق في النظريات ، أم هو أمان محققٌ لا غدر فيه ولا غائلة له؟ فأقبلت بجد بليغ أتأمل المحسوسات والضروريات ، وأنظر هل يمكنني أن أشكك نفسي فيها ، فانتهي بي طول التشكك إلى أن لم تسمح نفسي بتسليم الأمان في المحسوسات أيضاً ، وأخذت تتسع للشك فيها وتقول : من أين الثقة بالمحسوسات ، وأقواها حاسة البصر؟ وهي تنظر إلى الظل فتراه واقفاً غير متحرك ، وتحكم بنفي الحركة ، ثم ، بالتجربة والمشاهدة ، بعد ساعة ، تعرف أنه متحرك وأنه لم يتحرك دفعة ( واحدة ) بغتة ، بل على التدريج ذرة ذرة ، حتى لم يكن له حالة وقوف. وتنظر إلى الكوكب فتراه صغيراً في مقدار دينار ، ثم الأدلة الهندسية تدل على أنه أكبر من الأرض في المقدار. وهذا وأمثاله من المحسوسات يحكم فيها حاكم الحس بأحكامه ، ويكذبـه حاكم العقل ويخونـه تكذيباً لا سبيل إلى مدافعته.
فقلت: قد بطلت الثقة بالمحسوسات أيضاً ، فلعله لا ثقة إلا بالعقليات التي هي من الأوليات ، كقولنا: العشرة أكثر من الثلاثة ، والنفي والإثبات لا يجتمعان في الشيء الواحد ، والشيء الواحد لا يكون حادثاً قديماً ، موجوداً معدوماً ، واجباً محالاً. فقالت المحسوسات: بم تأمن أن تكون ثقتك بالعقليات كثقتك بالمحسوسات ، وقد كنت واثقاً بي ، فجاء حاكم العقل فكذبني ، ولولا حاكم العقل لكنت تستمر على تصديقي ، فلعل وراء إدراك العقل حاكماً آخر ، إذا تجلى ، كذب العقل في حكمه ، كما تجلى حاكم العقل فكذب الحس في حكمه ، وعدم تجلي ذلك الإدراك ، لا يدل على استحالته. فتوقفت النفس في جواب ذلك قليلاً ، وأيدت إشكالها بالمنام ، وقالت: أما تراك تعتقد في النوم أموراً ، وتتخيل أحوالاً ، وتعتقد لها ثباتاً واستقراراً ، ولا تشك في تلك الحالة فيها ، ثم تستيقظ فتعلم أنه لم يكن لجميع متخيلاتك ومعتقداتك أصل وطائل ؛ فبم تأمن أن يكون جميع ما تعتقده في يقظتك بحس أو عقل هو حق بالإضافة إلى حالتك [ التي أنت فيها ] ؛ لكن يمكن أن تطرأ عليك حالة تكون نسبتها إلى يقظتك ، كنسبة يقظتك إلى منامك ، وتكون يقظتك نوماً بالإضافة إليها! فإذا وردت تلك الحالة تيقنت أن جميع ما توهمت بعقلك خيالات لا حاصل لها ، ولعل تلك الحالة ما تدعيه الصوفية أنـها حالتهم ؛ إذ يزعمون أنـهم يشاهدون في أحوالهم التي ( لهم ) ، إذا غاصوا في أنفسهم ، وغابوا عن حواسهم ، أحوالاً لا توافق هذه المعقولات. ولعل تلك الحالة هي الموت ، إذ قال رسول الله ﷺ: « الناسُ نيامٌ فإذا ماتوا انتبـهوا »
فلعل الحياة الدنيا نوم بالإضافة إلى الآخرة. فإذا مات ظهرت له الأشياء على خلاف ما يشاهده الآن ، ويقال له عند ذلك: ﴿ فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴾ [ق: 22]
فلما خطرت لي هذه الخواطر وانقدحت في النفس ، حاولت لذلك علاجاً فلم يتيسر ، إذ لم يكن دفعه إلا بالدليل ، ولم يمكن نصب دليل إلا من تركيب العلوم الأولية ، فإذا لم تكن مسلمة لم يمكن تركيب الدليل. فأعضل هذا الداء ، ودام قريباً من شهرين أنا فيهما على مذهب السفسطة بحكم الحال ، لا بحكم النطق والمقال ، حتى شفى الله تعالى من ذلك المرض ، وعادت النفس إلى الصحة والاعتدال ، ورجعت الضروريات العقلية مقبولة موثوقاً بـها على أمن ويقين ؛ ولم يكن ذلك بنظم دليل وترتيب كلام ، بل بنور قذفه الله تعالى في الصدر وذلك النور هو مفتاح أكثر المعارف ، فمن ظن أن الكشف موقوف على الأدلة المحررة فقد ضيق رحمة الله [ تعالى ] الواسعة ؛ ولما سئل رسول الله ﷺ عن ( الشرح ) ومعناه في قوله تعالى: ﴿ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ﴾ [الأنعام: 125]
قال: « هو نور يقذفه الله تعالى في القلب » فقيل: (وما علامته ؟) قال: « التجافي عن دار الغُرُورِ والإنابة إلى دارِ الخُلُود » . وهو الذي قال ﷺ فيه: « إن الله تعالى خلق الخلقَ في ظُلْمةٍ ثم رشَّ عليهمْ من نُورهِ »
فمن ذلك النور ينبغي أن يطلب الكشف ، وذلك النور ينبجس من الجود الإلهي في بعض الأحايين ، ويجب الترصد له كما قال ﷺ: « إن لربكم في أيامِ دهركم نفحاتٌ ألا فتعرضُوا لها » والمقصود من هذه الحكايات أن يعمل كمال الجد في الطلب ، حتى ينتهي إلى طلب ما لا يطلب. فإن الأوليات ليست مطلوبة ، فأنـها حاضرة. والحاضر إذا طلب فقد واختفى. ومن طلب ما لا يطلب ، فلا يتهم بالتقصير في طلب ما يطلب.
القَولُ في أصْنَافِ الطَّالبْين
ولما شفاني الله من هذا المرض بفضله وسعة جوده ، أنحصرت أصناف الطالبين عندي في أربع فرق:
المتكلمون: وهم يدَّعون أنـهم أهل الرأي والنظر.
الباطنية: وهم يزعمون أنـهم أصحاب التعليم والمخصوصون بالاقتباس من الإمام المعصوم.
الفلاسفة: وهم يزعمون أنـهم أهل المنطق والبرهان.
الصوفية: وهم يدعون أنـهم خواص الحضرة وأهل المشاهدة والمكاشفة.
فقلت في نفسي : الحق لا يعدو هذه الأصناف الأربعة ، فهؤلاء هم السالكون سبل طلب الحق ، فإن شذَّ الحق عنهم ، فلا يبقى في درك الحق مطمع ، إذ لا مطمع في الرجوع إلى التقليد بعد مفارقته ؛ و( من ) شرط المقلد أن لا يعلم أنه مقلد ، فإذا علم ذلك انكسرت زجاجة تقليده ، وهو شعب لا يرأب ، وشعث لا يلم بالتلفيق والتأليف ، إلا أن يذاب بالنار ، ويستأنف له صنعة أخرى مستجدة. فابتدرت لسلوك هذه الطرق ، واستقصاء ما عند هذه الفرق. مبتدئاً بعلم الكلام. ومثنياً بطريق الفلسفة ، ومثلثاً بتعلم الباطنية ، ومربعاً بطريق الصوفية.
* *
عِلْمُ الكَلاَم: مَقْصُوده وحَاصِله
ثم إني ابتدأت بعلم الكلام ، فحصَّلته وعقلته ، وطالعت كتب المحققين منهم ، وصنفت فيه ما أردت أن أصنف ، فصادفته علماً وافياً بمقصوده ، غير وافٍ بمقصودي ؛ وإنما المقصود منه حفظ عقيدة أهل السنة [ على أهل السنة ] وحراستها عن تشويش أهل البدعة. فقد ألقى الله ( تعالى ) إلى عباده على لسان رسوله عقيدة هي الحق ، على ما فيه صلاح دينهم ودنياهم ، كما نطق بمعرفته القرآن والأخبار ، ثم ألقى الشيطان في وساوس المبتدعة أموراً مخالفة للسنة ، فلهجوا بـها وكادوا يشوشون عقيدة الحق على أهلها. فأنشأ الله تعالى طائفة المتكلمين ، وحرك دواعيهم لنصرة السنة بكلام مرتب ، يكشف عن تلبيسات أهل البدع المحدثة ، على خلاف السنة المأثورة ؛ فمنه نشأ علم الكلام وأهله. ولقد قام طائفة منهم بما ندبـهم الله ( تعالى ) إليه ، فأحسنوا الذب عن السنة ، والنضال عن العقيدة المتلقاة بالقبول من النبوة ، والتغيير في وجه ما أحدث من البدعة ؛ ولكنهم اعتمدوا في ذلك على مقدمات تسلموها من خصومهم ، واضطرهم إلى تسليمها: إما التقليد ، أو إجماع الأمة ، أو مجرد القبول من القرآن والأخبار. وكان أكثر خوضهم في استخراج مناقضات الخصوم ، ومؤاخذتهم بلوازم مسلماتهم. وهذا قليل النفع في حق من لا يسلم سوى الضروريات شيئاً ( أصلاً ) ، فلم يكن الكلام في حقي كافياً ، ولا لدائي الذي كنت أشكوه شافياً. نعم ، لما نشأت صنعة الكلام وكثر الخوض فيه وطالت المدة ، تشوق المتكلمون إلى محاولة الذبّ ( عن السنة ) بالبحث عن حقائق الأمور ، وخاضوا في البحث عن الجواهر والأعراض وأحكامها. ولكن لما لم يكن ذلك مقصود علمهم ، لم يبلغ كلامهم فيه الغاية القصوى ، فلم يحصل منه ما يمحق بالكلية ظلمات الحيرة في اختلافات الخلق ؛ ولا أبعدُ أن يكون قد حصل ذلك لغيري! بل لست أشك في حصول ذلك لطائفة ولكن حصولاً مشوباً بالتقليد في بعض الأمور التي ليست من الأوليات! والغرض الآن حكاية حالي ، لا الإنكار على من استشفى به ، فإن أدوية الشفاء تختلف باختلاف الداء. وكم من دواء ينتفع به مريض ويستضر بـه آخر!
* *
الفَلسْفَة
· محصولها. · المذموم منها وما لا يذم. · وما يكفر به قائلة وما لا يكفر به. · وما يبتدع فيه وما لا يبتدع. · وبيان ما سرقه الفلاسفة من كلام أهل الحق. · وبيان ما مزجوه بكلام أهل الحق لترويج باطلهم في درج ذلك. · وكيفية عدم قبول البشر وحصول نفرة النفوس من ذلك الحق الممزوج بالباطل. · وكيفية استخلاص الحق الخالص من الزيف والبهرج من جملة كلامهم. ثم إني ابتدأت ، بعد الفراغ من علم الكلام ، بعلم الفلسفة وعلمت يقيناً ، أنه لا يقف على فساد نوع من العلوم ، من لا يقف على منتهى ذلك العلم ، حتى يساوي أعلمهم في أصل [ ذلك ] العلم ، ثم يزيد عليه ويجاوز درجته ، فيطلع على ما لم يطلع عليه صاحب العلم من غور وغائله ، وإذا ذاك يمكن أن يكون ما يدعيه من فساده حقّاً. ولم أر أحداً من علماء الإسلام صرف عنايته وهمته إلى ذلك. ولم يكن في كتب (( المتكلمين )) من كلامهم ، حيث اشتغلوا بالرد عليهم ، إلا كلمات معقدة مبددة ، ظاهرة التناقض والفساد ، لا يظن الاغترار بـها بعاقل عامي ، فضلاً عمن يدعي دقائق العلوم. فعلمت أن رد المذهب قبل فهمه والإطلاع على كنهه رمى في عماية ، فشمرت عن ساق الجد ، في تحصيل ذلك العلم من الكتب ، بمجرد المطالعة من غير استعانة بأستاذ ، وأقبلت على ذلك في أوقات فراغي من التصنيف والتدريس في العلوم الشرعية ، وأنا ممنو بالتدريس والإفادة لثلاثمائة نفر من الطلبة ببغداد. فأطلعني الله سبحأنه [ وتعالى ] بمجرد المطالعة في هذه الأوقات المختلسة ، على منتهى علومهم في أقل من سنتين. ثم لم أزل أواظب على التفكر فيه بعد فهمه قريباً من سنة ، أعاوده وأردده وأتفقد غوائله وأغواره ، حتى اطَّلعت على ما فيه من خداع وتلبيس ، وتحقيق وتخييل ، اطلاعاً لم أشك فيه. فاسمع الآن حكايتهم وحكاية حاصل علومهم ؛ فإني رأيتهم أصنافاً ، ورأيت علومهم أقساماً ؛ وهم على كثرة أصنافهم يلزمهم وصمة الكفر والإلحاد ، وإن كان بين القدماء منهم والأقدمين ، وبين الأواخر منهم والأوائل ، تفاوت عظيم في البعد عن الحق والقرب منه. * * *
أَصْناَف الفَلاَسِفةَ وشُمول وَصْمَة الكُفِر َكافَّتهمُ اعلم: أنـهم ، على كثرة فرقهم واختلاف مذاهبـهم ، ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: الدهريون ، والطبيعيون ، والإلهيون. الصنف الأول: الدهريون:- وهم طائفة من الأقدمين جحدوا الصانع المدبر ، العالم القادر ، وزعموا أن العالم لم يزل موجوداً كذلك بنفسه بلا صانع ، ولم يزل الحيوان من النطفة ، والنطفة من الحيوان ، كذلك كان ، وكذلك يكون أبداً وهؤلاء هم الزنادقة. والصنف الثاني: الطبيعيون:- وهم قوم أكثروا بحثهم عن عالم الطبيعة ، وعن عجائب الحيوان والنبات ، وأكثروا الخوض في علم تشريح أعضاء الحيوانات ، فرأوا فيها من عجائب صنع الله تعالى وبدائع حكمته ، مما اضطروا معه إلى الاعتراف بفاطر حكيم ، مطلع على غايات الأمور ومقاصدها. ولا يطالع التشريح وعجائب منافع الأعضاء مطالع ، إلا ويحصل له هذا العلم الضروري بكمال تدبير الباني لبنية الحيوان ؛ لا سيما بنية الإنسان. إلا أن هؤلاء ، لكثرة بحثهم عن الطبيعة ، ظهر عندهم - لاعتدال المزاج - تأثير عظيم في قوام قوى الحيوان بـه. فظنوا أن القوة العاقلة من الإنسان تابعة لمزاجه أيضاً ، وأنـها تبطل ببطلان مزاجه فتنعدم . ثم إذا انعدمت ، فلا يعقل إعادة المعدوم كما زعموا. فذهبوا إلى أن النفس تموت ولا تعود ، فجحدوا الآخرة ، وأنكروا الجنة والنار ، [ والحشر والنشر ] ، والقيامة والحساب ، فلم يبق عندهم للطاعة ثواب ، ولا للمعصية عقاب ، فانحل عنهم اللجام وأنـهمكوا في الشهوات أنـهماك الأنعام. وهؤلاء أيضاً زنادقة لأن أصل الإيمان هو الإيمان بالله واليوم الآخر. وهؤلاء جحدوا اليوم الآخر ، وإن آمنوا بالله وصفاته. والصنف الثالث: الإلهيون :- وهم المتأخرون منهم ، [ مثل ]: سقراط ، وهو أستاذ أفلاطون ، وأفلاطون أستاذ أرسطاطاليس ، وأرسطاطاليس هو الذي رتب [ لهم ] المنطق ، وهذَّب لهم العلوم ، وحرّر لهم ما لم يكن محرراً من قبلُ ، وأنضَجَ لهم ما كان فِجّاً من علومهم ، وهم بجملتهم ردوا على الصنفين الأولين من الدهرية والطبيعية ، وأوردوا في الكشف عن فضائحهم ما أغنوا بـه غيرهم. (( وكفى الله المؤمنين القتال )) بتقاتلهم. ثم رد أرسطاطاليس على أفلاطون وسقراط ، ومن كان قبلهم من الإلهيين ، ردّاً لم يقصر فيه حتى تبرأ عن جميعهم ؛ إلا أنه استبقى أيضاً من رذائل كفرهم وبدعتهم بقايا لم يوفق للنـزوع عنها ، فوجب تكفيرهم ، وتكفير شيعتهم من المتفلسفة الإسلاميين ، كابن سينا والفارابي و غيرهم . على أنه لم يقم بنقل علم أرسطاطاليس أحد من متفلسفة الإسلاميين كقيام هذين الرجلين. وما نقله غيرهما ليس يخلو من تخبيط وتخليط يتشوش فيه قلب المطالع حتى لا يفهم. وما لا يُفهم كيف يُرد أو يقبل؟ ومجموع ما صح عندنا من فلسفة أرسطاطاليس ، بحسب نقل هذين الرجلين ، ينحصر في ثلاثة أقسام: - 1. قسم يجب التفكير به. 2. وقسم يجب التبديع به. 3. وقسم لا يجب إنكاره أصلاً فلنفصله .
* *
أَقْسَامِ عُلومِهم أعلم: أن علومهم - بالنسبة إلى الغرض الذي نطلبه - ستة أقسام: رياضية ، ومنطقية ، وطبيعية ، وإلهية ، وسياسية ، وخلقية. 1 - أما الرياضية: فتتعلق بعلم الحساب والهندسة وعلم هيئة العالم ، وليس يتعلق شيء منها بالأمور الدينية نفياً وإثباتاً ، بل هي أمور برهانية لا سبيل إلى مجاحدته بعد فهمها ومعرفتها. وقد تولدت منها آفتان: احداهما الأولى: ان من ينظر فيها يتعجب من دقائقها ومن ظهور براهينها ، فيحسن بسبب ذلك اعتقاده في الفلاسفة ، ويحسب أن جميع علومهم في الوضوح [ وفي ] وثاقة البرهان كهذا العلم. ثم يكون قد سمع من كفرهم وتعطيلهم وتـهاونـهم بالشرع ما تناولته الألسن فيكفر بالتقليد المحض ويقول: لو كان الدين حقاً لما اختفى على هؤلاء مع تدقيقهم في هذا العلم! فإذا عرف بالتسامع كفرهم وجحدهم استدل على أن الحق هو الجحد والإنكار للدين. وكم رأيت ممن يضل عن الحق بـهذا العذر ولا مستند له سواه! وإذا قيل له: الحاذق في صناعة واحدة ليس يلزم أن يكون حاذقاً في كل صناعة ، فلا يلزم أن يكون الحاذق في الفقه والكلام حاذقاً في الطب ، ولا أن يكون الجاهل بالعقليات جاهلاً بالنحو ، بل لكل صناعة أهل بلغوا فيها [ رتبة ] البراعة والسبق. وإن كان الحمق والجهل ( قد ) يلزمهم في غيرها. فكلام الأوائل في الرياضيات برهاني ، وفي الإلهيات تخميني ؛ لا يعرف ذلك إلا من جرّبه وخاض فيه. فهذا إذا قرر على هذا الذي ألحَدَ بالتقليد ، لم يقع منه موقع القبول ، بل تحمله غلبة الهوى ، والشهوة الباطلة ، وحب التكايس ، على أن يصر على تحسين الظن بـهم في العلوم كلها. فهذه آفة عظيمة لأجلها يجب زجر كل من يخوض في تلك العلوم ، فأنها وإن لم تتعلق بأمر الدين ، ولكن لما كانت من مبادئ علومهم ، سرى إليه شرهم وشؤمهم ، فقل من يخوض فيها إلا وينخلع من الدين وينحل عن رأسه لجام التقوى. الآفة الثانية: نشأت من صديق للإسلام جاهل ، ظن أن الدين ينبغي أن ينصر بإنكار كل علم منسوب إليهم: فأنكر جميع علومهم وادعى جهلهم فيها ، حتى أنكر قولهم في الكسوف والخسوف ، وزعم أن ما قالوه على خلاف الشرع. فلما قرع ذلك سمع من عرف ذلك بالبرهان القاطع ، لم يشك في برهأنه ، ولكن اعتقد أن الإسلام مبني على الجهل وإنكار البرهان القاطع ، فيزداد للفلسفة حبّاً وللإسلام بغضاً. ولقد عظم على الدين جناية من ظن أن الإسلام ينصر بإنكار هذه العلوم ، وليس في الشرع تعرض لهذه العلوم بالنفي والإثبات ، ولا في هذه العلوم تعرض للأمور الدينية. وقوله صلى الله عليه وسلّم: (( إن الشمس والقمر آيتان من آياتِ الله تعالى لا ينخسفانِ لموتِ أحدٍ ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله تعالى وإلى الصلاة )) . وليس في هذا ما يوجب إنكار علم الحساب المعرف بمسير الشمس والقمر واجتماعهما أو مقابلهما على وجه مخصوص. أما قوله ( عليه السلام ): (( لكن الله إذا تجلى لشيءْ خضع لهُ )) فليس توجد هذه الزيادة في الصحاح أصلاً. فهذا حكم الرياضيات وآفتها. 2 – وأما المنطقيات: فلا يتعلق شيء منها بالدين نفياً وإثباتاً ، بل هي النظر في طرق الأدلة والمقاييس وشروط مقدمات البرهان وكيفية تركيبها ، وشروط الحد الصحيح وكيفية ترتيبه. وأن العلم إما تصور وسبيل معرفته الحد ، وإما تصديق وسبيل معرفته البرهان ؛ وليس في هذا ما ينبغي أن ينكر ، بل هو ( من ) جنس ما ذكره المتكلمون وأهل النظر في الأدلة ، وإنما يفارقونـهم بالعبارات والاصطلاحات ، بزيادة الاستقصاء في التعريفات والتشعيبات ، ومثال كلامهم فيها قولهم: إذا ثبت أن كل (( أ )) (( ب )) لزم أن بعض (( ب )) (( أ )) أي إذا ثبت أن كل إنسان حيوان ، لزم أن بعض الحيوان إنسان. ويعبرون عن هذا بأنه الموجبة الكلية تنعكس موجبة جزئية. وأي تعلق لهذا بمهمات الدين حتى يجحد وينكر؟ فإذا أنكر لم يحصل من إنكاره عند أهل المنطق إلا سوء الاعتقاد في عقل المنكر ، بل في دينه الذي يزعم أنه موقوف على مثل هذا الإنكار. نعم ، لهم نوع من الظلم في هذا العلم ، وهو أنـهم يجمعون للبرهان شروطاً يعلم أنها تورث اليقين لا محالة ، لكنهم عند الانتهاء إلى المقاصد الدينية ما أمكنهم الوفاء بتلك الشروط ، بل تساهلوا غاية التساهل ، وربما ينظر في المنطق أيضاً من يستحسنه ويراه واضحاً ، فيظن أن ما ينقل عنهم من الكفريات مؤيد بمثل تلك البراهين ، فاستعجل بالكفر قبل الانتهاء إلى العلوم الإلهية. فهذه الآفة أيضاً متطرقة إليه. 3 - وأما ( علم ) الطبيعيات: فهو بحث عن عالم السماوات وكواكبها وما تحتها من الأجسام المفردة: كالماء والهواء والتراب والنار ، وعن الأجسام المركبة: كالحيوان والنبات والمعادن ، وعن أسباب تغيرها واستحالتها وامتزاجها. وذلك يضاهي بحث الطب عن جسم الإنسان وأعضائه الرئيسة والخادمة ، وأسباب استحالة مزاجه. وكما ليس من شرط الدين إنكار علم الطب ، فليس من شرطه أيضاً إنكار ذلك العلم ، إلا في مسائل معينة ، ذكرناها في كتاب (( تـهافت الفلاسفة )). وما عداها مما يجب المخالفة فيها ؛ فعند التأمل يتبين أنها مندرجة تحتها ، وأصل جملتها: أن تعلم أن الطبيعة مسخرة لله تعالى ، لا تعمل بنفسها ، بل هي مستعملة من جهة فاطرها. والشمس والقمر والنجوم والطبائع مسخرات بأمره لا فعل لشيءٍ منها بذاته عن ذاته . 4 – وأما الإلهيات: ففيها أكثر أغاليطهم ، فما قدروا على الوفاء بالبرهان على ما شرطوه في المنطق ، ولذلك كثر الاختلاف بينهم فيها. ولقد قرب مذهب أرسطاطاليس فيها من مذاهب الإسلاميين ، على ما نقله الفارابي وابن سينا. ولكن مجموع ما غلطوا فيه يرجع إلى عشرين أصلاً ، يجب تكفيرهم في ثلاثة منها ، وتبديعهم في سبعة عشر. ولإبطال مذهبهم في هذه المسائل العشرين ، صنفنا كتاب ( التهافت ). أما المسائل الثلاث ، فقد خالفوا فيها كافة الإسلاميين وذلك في قولهم: 1 - إن الأجساد لا تحشر ، وإنما المثاب والمعاقَب هي الأرواح المجردة ، ( والمثوبات ) والعقوبات روحانية لا جسمانية ؛ ولقد صدقوا في إثبات الروحانية ، فأنها ثابتة أيضاً ، ولكن كذبوا في إنكار الجسمانية ، وكفروا بالشريعة فيما نطقوا به. 2 - ومن ذلك قولهم: (( إن الله تعالى يعلم الكليات دون الجزئيات )) ؛ وهذا أيضاً كفر صريح ، بل الحق أنه: (( لا يعزب عنـه مثقال ذرةٍ في السمواتِ ولا في الأرضِ )).(سبأ: 3) 3 - ومن ذلك قولهم بقدم العالم وأزليته فلم يذهب أحد من المسلمين إلى شيء من هذه المسائل. وأما ما وراء ذلك من نفيهم الصفات ، وقولهم إنه عالم بالذات ، لا بعلم زائد (على الذات) وما يجري مجراه ، فمذهبهم فيها قريب من مذهب المعتزلة ولا يجب تكفير المعتزلة بمثل ذلك. وقد ذكرنا في كتاب (( فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة )) ما يتبين به فساد رأي من يتسارع إلى التكفير في كل ما يخالف مذهبه. 4 - وأما السياسيات: فجميع كلامهم فيها يرجع إلى الحكم المصلحية المتعلقة بالأمور الدنيوية ( والإيالة ) السلطانية ، وإنما أخذوها من كتب الله المنـزلة على الأنبياء ، ومن الحكم المأثورة عن سلف الأنبياء [ عليهم السلام ]. 5 - وأما الخلقية: فجميع كلامهم ( فيها ) يرجع إلى حصر صفات النفس وأخلاقها ، وذكر أجناسها وأنواعها وكيفية معالجتها ومجاهدتها ، وإنما أخذوها من كلام الصوفية ، وهم المتألهون المواظبون على ذكر الله تعالى ، وعلى مخالفة الهوى وسلوك الطريق إلى الله تعالى بالإعراض عن ملاذِّ الدنيا. وقد انكشف لهم في مجاهدتهم من أخلاق النفس وعيوبـها ، وآفات أعمالها ما صرحوا بـها ، فأخذها الفلاسفة ومزجوها بكلامهم ، توسلاً بالتجمل بـها إلى ترويج باطلهم. ولقد كان في عصرهم ، بل في كل عصر ، جماعة من المتأهلين ، لا يُخلي الله [ سبحانه ] العالم عنهم ، فأنـهم أوتاد الأرض ، ببركاتـهم تنـزل الرحمة على أهل الأرض كما ورد في الخبر حيث قال صلى الله عليه وسلّم: (( بـهم تمطرون وبـهم ترزقون ومنـهم كان أصحاب الكهف )) . وكانوا في سالف الأزمنة ، على ما نطق بـه القرآن ، فتولد من مزجهم كلام النبوة وكلام الصوفية بكتبهم آفتان: آفة في حق القابل وآفة في حق الراد: 1 - أما الآفة التي في حق الراد فعظيمة: إذ ظنت طائفة من الضعفاء أن ذلك الكلام إذا كان مُدوَّناً في كتبهم ، وممزوجاً بباطلهم ، ينبغي أن يُهجر ولا يُذكر بل يُنكر على [ كل ] من يذكره ، إذ لم يسمعوه أولاً إلا منهم ، فسبق إلى عقولهم الضعيفة أنه باطل ، لأن قائله مُبطل ؛ كالذي يسمع من النصراني قوله: (( لا إله إلا الله عيسى رسول الله )) فينكره ويقول: (( هذا كلام النصارى )) ولا يتوقف ريثما يتأمل أن النصراني كافر باعتبار هذا القول ، أو باعتبار إنكاره نبوة محمد عليه الصلاة والسلام!؟ فإن لم يكن كافراً إلا باعتبار إنكاره ، فلا ينبغي أن يخالف في غير ما هو به كافر مما هو حق في نفسه ، وإن كان أيضاً حقاً عنده. وهذه عادة ضعفاء العقول ، يعرفون الحق بالرجال ، لا الرجال بالحق. والعاقل يقتدي بسيد العقلاء علي ، رضي الله عنه حيث قال: (( لا تعرف الحق بالرجال ( بل ) اعرف الحق تعرف أهله )) و ( العارف ) العاقل يعرف الحق ، ثم ينظر في نفس القول: فإن كان حقاً ، قبله سواء كان قائله مبطلاً أو محقاً ؛ بل ربما يحرص على انتزاع الحق من أقاويل أهل الضلال ، عالماً بأن معدن الذهب الرغام. ولا بأس على الصراف إن أدخل يده في كيس القلاب ، وانتزع الإبريز الخالص من الزيف والبهرج ، مهما كان واثقاً ببصيرته ؛ وانما يزجر عن معاملة القلاب القرويُّ ، دون الصيرفي ( البصير ) ؛ ويمنع من ساحل البحر الأخرقُ ، دون السباح الحاذق ؛ ويُصد عن مس الحية الصبي دون المعزِّم البارع. ولعمري! لما غلب على أكثر الخلق ظنهم بأنفسهم الحذاقة والبراعة ، وكمال العقل ( وتمام الآلة ) في تمييز الحق عن ( الباطل ، والهدى عن ) الضلالة ، وجب حسم الباب في زجر الكافة عن مطالعة كتب أهل الضلال ما أمكن ، إذ لا يسلمون عن الآفة الثانية التي سنذكرها ( أصلاً ) وإن سلموا عن ( هذه ) الآفة التي ذكرناها. ولقد اعترض على بعض الكلمات المبثوثة في تصانيفنا في أسرار علوم الدين ، طائفة من الذين لم تستحكم في العلوم سرائرهم ، ولم تنفتح إلى أقصى غايات المذاهب بصائرهم ، وزعمت أن تلك الكلمات من كلام الأوائل ، مع أن بعضها من مولدات الخواطر - ولا يبعد أن يقع الحافر على الحافر - وبعضها يوجد في الكتب الشرعية ، وأكثرها موجود معناه في كتب الصوفية. وهب أنها لم توجد إلا في كتبهم ، فإذا كان ذلك الكلام معقولاً في نفسه ، مؤيداً بالبرهان ، ولم يكن على مخالفة الكتاب والسنة ، فلمَ ينبغي أن يهجر ويترك؟ فلو فتحنا هذا الباب ، وتطرقنا إلى أن يهجر كل حق سبق إليه خاطر مبطل ، للزمنا أن نـهجر كثيراً من الحق ، ولزمنا أن نـهجر جملة آيات من آيات القرآن وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلّم وحكايات السلف وكلمات الحكماء والصوفية ، لأن صاحب كتاب (( إخوان الصفا )) أوردها في كتابـه مستشهداً بـها ومستدرجاً قلوب الحمقى بواسطتها إلى باطله ؛ ويتداعى ذلك إلى أن يستخرج المبطلون الحق من أيدينا بإيداعهم إياه كتبهم. وأقل درجات العالم: أن يتميز عن العامي الغُمر ، فلا يعاف العسل ، وإن وجده في محجمة الحجَّام ، ويتحقق أن المحجمة لا تغير ذات العسل ، فإن نفرة الطبع عنه مبنية على جهل عامي منشؤه أن المحجمة ، إنما صنعت للدم المستقذَر ، فيظن أن الدم مستقذر لكونه في المحجمة ، ولا يدري أنه مستقذر لصفة في ذاته ؛ فإذا عدمت ( هذه ) الصفة في العسل فكونـه في ظرفه لا يكسبه تلك الصفة ، فلا ينبغي أن يوجب له الاستقذار ، وهذا وهم باطل ، وهو غالب على أكثر الخلق. فإذا نسبت الكلام وأسندته إلى قائل حسن فيه اعتقادهم ، قبلوه وإن كان باطلاً ؛ وإن أسندته إلى من ساء فيه اعتقادهم ردوه وإن كان حقاً. فأبداً يعرفون الحق بالرجال ولا يعرفون الرجال بالحق ، وهو غاية الضلال! هذه آفة الرد. 2 - والآفة الثانية آفة القبول: فإن من نظر في كتبهم (( كإخوان الصفا )) وغيره ، فرأى ما مزجوه بكلامهم من الحكم النبوية ، والكلمات الصوفية ، ربما استحسنها وقبلها ، وحسن اعتقاده فيها ، فيسارع إلى قبول باطلهم الممزوج بـه ، لحسن ظن حصل فيما رآه واستحسنه ، وذلك نوع استدراج إلى الباطل. ولأجل هذه الآفة يجب الزجر عن مطالعة كتبهم لما فيها من الغدر والخطر. وكما يجب صون من لا يحسن السباحة على مزالق الشطوط ، يجب صون الخلق عن مطالعة تلك الكتب. وكما يجب صون الصبيان عن مس الحيَّات ، يجب صون الأسماع عن مختلط الكلمات وكما يجب على المعزِّم أن لا يمس الحية بين يدي ولده الطفل ، إذا علم أن سيقتدي به ويظن أنه مثله ، بل يجب عليه أن يحذّره [ منه ] ، بأن يحذر هو [ في ] نفسه [ ولا يمسها ] بين يديه ، فكذلك يجب على العالم الراسخ مثله. وكما أن المعزِّم الحاذق إذا أخذ الحية وميز بين الترياق والسم ، واستخرج منها الترياق وأبطل السم فليس له أن يشح بالترياق على المحتاج إليه. وكذا الصراف الناقد البصير إذا أدخل يده في كيس القَلاّب ، وأخرج منه الإبريز الخالص ، واطّرح الزيف والبهرج ، فليس له أن يشح بالجيد المرضي على من يحتاج إليه ؛ فكذلك العالم. وكما أن المحتاج إلى الترياق ، إذا اشمأزت نفسه منه ، حيث علم أنه مستخرج من الحية التي هي مركز السم [ وجب تعريفه ] ، والفقير المضطر إلى المال ، إذا نفر عن قبول الذهب المستخرج من كيس القلاّب ، وجب تنبيهه على أن نفرته جهل محض ، هو سبب حرمأنه الفائدة التي هي مطلبه ، وتحتم تعريفه أن قرب الجوار بين الزيف والجيد لا يجعل الجيد زيفاً ، كما لا يجعل الزيف جيداً ، فكذلك قرب الجوار بين الحق الباطل ، لا يجعل الحق باطلاً ، كما لا يجعل الباطل حقاً. فهذا ( مقدار ) ما أردنا ذكره من آفة الفلسفة وغائلتها.
* *
القَولُ ِفي مَذْهَبِ التَّعلِيم وغَائِلَته
ثم إني لما فرغت من علم الفلسفة وتحصيله وتفهمه وتزييف ما يزيف منه ، علمت أن ذلك أيضاً غير وافٍ بكمال الغرض ، وأن العقل ليس مستقلاً بالإحاطة بجميع المطالب ، ولا كاشفاً للغطاء عن جميع المعضلات. وكان قد نبغت نابغة التعليمية ، وشاع بني الخلق تحدثهم بمعرفة معنى الأمور من جهة الإمام المعصوم القائم بالحق ، فعنّ لي أن أبحث في مقالاتـهم ، لأطّلع على ما في كنانتهم. ثم اتفق أن ورد عليّ أمر جازم من حضرة الخلافة ، بتصنيف كتاب يكشف [ عن ] حقيقة مذهبهم. فلم يسعني مدافعته وصار ذلك مستحثاً من خارج ، ضميمة للباعث من الباطن ، فابتدأت بطلب كتبهم وجمع مقالاتـهم. وكذلك قد بلغني بعض كلماتـهم المستحدثة التي ولدتـها خواطر أهل العصر ، لا على المنهاج المعهود من سلفهم. فجمعت تلك الكلمات ، ( ورتبتها ) ترتيباً محكماً مقارناً للتحقيق ، واستوفيت الجواب عنها ، حتى أنكر بعض أهل الحق ( مني ) مبالغتي في تقرير حجتهم ، فقال: (( هذا سعي لهم ، فأنـهم كانوا يعجزون عن نصرة مذهبهم بـمثل هذه الشبهات لولا تحقيقك لها ، وترتيبك إياها )). وهذا الإنكار من وجه حق ، فقد أنكر أحمد بن حنبل على الحارث المحاسبي ( رحمهما الله ) ، تصنيفه في الرد على المعتزلة ؛ فقال الحارث: (( الرد على البدعة فرض)) فقال أحمد: (( نعم ، ولكن حكيت شبهتهم أولاً ثم أجبت عنها ؛ فبمَ تأمن أن يطالع الشبهة من يعلق ذلك بفهمه ، ولا يلتفت إلى الجواب ، أو ينظر في الجواب ولا يفهم كنهه؟ )). وما ذكره أحمد بن حنبل حق ، ولكن في شبهة ( لم تنتشر ) ولم تشتهر. فأما إذا انتشرت ، فالجواب عنها واجب ولا يمكن الجواب [ عنها ] إلا بعد الحكاية. نعم ، ينبغي أن لا يتكلف لهم شبهة لم [ يتكلفوها ] ؛ ولم أتكلف أنا ذلك ، بل كنت قد سمعت تلك الشبهة من واحد من أصحابي المختلفين إلي ، بعد أن كان قد التحق بـهم ؛ وانتحل مذهبـهم ، وحكى أنـهم يضحكون على تصانيف المصنفين في الرد عليهم ، بأنـهم لم يفهموا بعد حجتهم. ثم ذكر تلك الحجة وحكاها عنهم ، فلم أرض لنفسي أن يظن في الغفلة عن اصل حجتهم ، فلذلك أوردتـها ، ولا أن يظن بي أني - وإن سمعتها – لم أفهمها فلذلك قررتها. والمقصود ، أني قررت شبهتهم إلى أقصى الإمكان ، ثم أظهرت فسادها [ بغاية البرهان ]. والحاصل: أنه لا حاصل عند هؤلاء ، ولا طائل لكلامهم. ولولا سوء نصرة الصديق الجاهل ، لما انتهت تلك البدعة - مع ضعفها - إلى هذه الدرجة ؛ ولكن شدة التعصب ، دعت الذابين عن الحق إلى تطويل النـزاع معهم في مقدمات كلامهم ، وإلى مجاحدتـهم في كل ما نطقوا به ، فجاحدوهم في دعواهم: (( الحاجة إلى التعليم والمعلم. )) وفي دعواهم أنه: (( لا يصلح كل معلم ، بل لا بد من معلم معصوم. )) وظهرت حجتهم في إظهار الحاجة إلى التعليم والمعلم ، وضعف قول المنكرين في مقابلته ، فاغتر بذلك جماعة وظنوا أن ذلك من قوة مذهبهم وضعف مذهب المخالفين لهم ، ولم يفهموا أن ذلك لضعف ناصر الحق وجعله بطريقه ؛ بل الصواب الاعتراف بالحاجة إلى المعلم ، وأنه لا بد وأن يكون ( المعلم ) معصوماً ، ولكن معلمنا المعصوم ( هو ) محمد صلى الله عليه وسلّم فإذا قالوا: (( هو ميت )) ، فنقول: (( ومعلمكم غائب )) ، فإذا قالوا: (( معلمنا قد علم الدعاة وبثهم في البلاد ، وهو ينتظر مراجعتهم إن اختلفوا أو أشكل عليهم مشكل )). فنقول: (( ومعلمنا قد علم الدعاة وبثهم في البلاد وأكمل التعليم إذ قال الله تعالى: (( اليوم أكملتُ لكم دينكم [ وأتممتُ عليكمْ نعمتي ] )) (المائدة: 3) وبعد كمال التعليم لا يضر موت المعلم كما لا يضر غيبته. فبقي قولهم: (( كيف تحكمون فيما لم تسمعوه؟ أبالنص ولم تسمعوه ، أم بالإجتهاد والرأي وهو مظنة الخلاف؟ )) فنقول: (( نفعل ما فعله معاذ إذ بعثه رسول الله عليه [ الصلاة ] والسلام إلى اليمن: أن نحكم بالنص ، عند وجود النص وبالإجتهاد عند عدمه . ( بل ) كما يفعله دعاتهم إذا بعدوا عن الإمام إلى أقاصي البلاد ، إذ لا يمكنـه أن يحكم بالنص فإن النصوص المتناهية لا تستوعب الوقائع الغير المتناهية ، ولا يمكنـه الرجوع في كل واقعة إلى بلدة الإمام ، وأن يقطع المسافة ويرجع فيكون المستفتي قد مات ، وفات الانتفاع بالرجوع. فمن أشكلت عليه القبلة ليس له طريق إلا أن يصلي بالاجتهاد ، إذ لو سافر إلى بلدة الإمام لمعرفة القبلة ، فيفوت وقت الصلاة. فإذن جازت الصلاة إلى غير القبلة بناء على الظن. ويقال: (( إن المخطيء في الاجتهاد له أجرٌ واحدٌ وللمُصيبِ أجران )) . فكذلك في جميع المجتهدات ، وكذلك أمر صرف الزكاة إلى الفقير ، فربما يظنـه فقيراً باجتهاده وهو غني باطناً بإخفائه ماله ، فلا يكون مؤاخذاً بـه وإن أخطأ ، لأنه لم يؤاخذ إلا بموجب ظنه. فإن قال: (( ظن مخالفهِ كظنه )) فأقول: (( هو مأمور باتباع ظن نفسه ، كالمجتهد في القبلة يتبع ظنه وإن خالفه غيره. )) فإن قال: (( فالمقلد يتبع أبا حنيفة والشافعي ( رحمهما الله ) أم غيرهما. )) فأقول: (( فالمقلد في القبلة عند الاشتباه ، في معرفة الأفضل الأعلم بدلائل القبلة ، فيتبع ذلك الاجتهاد ؛ فكذلك في المذاهب. )) فردّ الخلق إلى الاجتهاد - ضرورة - الأنبياءُ والأئمة مع العلم بأنـهم ( قد ) يخطئون ، بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: (( أنا أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر )) . أي أنا أحكم بغالب الظن الحاصل من قول الشهود ، وربما أخطأوا فيه. ولا سبيل إلى الأمن من الخطأ للأنبياء في مثل هذه المجتهدات ، فيكف يطمع في ذلك؟ ولهم ها هنا سؤالان: أحدهما قولهم: (( هذا وإن صح في المجتهدات فلا يصح في قواعد العقائد ، إذ المخطئ فيه غير معذور ، فكيف السبيل إليه؟ )) فأقول: (( قواعد العقائد يشتمل عليها الكتاب والسنة ؛ وما وراء ذلك من التفصيل ، والمتنازع فيه ، يعرف الحق فيه بالوزن بالقسطاس المستقيم. وهي الموازين التي ذكرها الله ( تعالى ) في كتابه ، وهي خمسة ذكرتـها في كتاب (( القسطاس المستقيم )). فإن قال: (( خصومك يخالفونك في ذلك الميزان. )) فأقول: (( لا يتصور أن يفهم ذلك الميزان ثم يخالف فيه [ إذ لا يخالف فيه ] أهل التعليم ، لأني استخرجته من القرآن وتعلمته منه ، ولا يخالف فيه أهل المنطق ، لأنه موافق لما شرطوه في المنطق ، وغير مخالف له ؛ ولا يخالف فيه المتكلم لأنه موافق لما يذكره في أدلة النظريات ، وبه يعرف الحق في الكلاميات. )) فإن قال: (( فإن كان في يدك مثل هذا الميزان فلمَ لا ترفع الخلاف بين الخلق؟ )) فأقول: (( لو أصغوا إلي لرفعت الخلاف بينهم ؛ وذكرت طريق رفع الخلاف في كتاب (( القسطاس المستقيم )) ، فتأمله لتعلم أنه حق وأنه يرفع الخلاف قطعاً لو أصغوا ولا يصغون [ إليه ] بأجمعهم! بل قد أصغى إلي طائفة ، فرفعت الخلاف بينهم. وإمامك يريد رفع الخلاف بينهم مع عدم إصغائهم ، فلمَ لم يرفع إلى الآن؟ ولمَ لم يرفع علي رضي الله عنـه ، وهو رأس الأئمة؟ أو يدعي أنه يقدر على حمل كافتهم على الإصغاء قهراً ، فلمَ لم يحملهم إلى الآن؟ ولأي يوم أجله؟ وهل حصل بين الخلق بسبب دعوته إلا زيادة خلاف وزيادة مخالف؟ نعم! كان يخشى من الخلاف نوع الضرر لا ينتهي إلى سفك الدماء ، وتخريب البلاد وأيتام الأولاد ، وقطع الطرق ، والإغارة على الأموال. وقد حدث في العالم من بركات رفعكم الخلاف [ من الخلاف ] ما لم يكن بمثله عهد. )) فإن قال: (( ادعيت أنك ترفع الخلاف بين الخلق ولكن المتحير بين المذاهب المتعارضة ، والاختلافات المتقابلة ، لم يلزمه الإصغاء إليك دون خصمك ، وأكثر الخصوم يخالفونك ، ولا فرق بينك وبينهم. )) وهذا هو سؤالهم الثاني فأقول: (( هذا أولاً ينقلب عليك ، فإنك إذا دعوت هذا المتحير إلى نفسك فيقول المتحير ، بما صرت أولى من مخالفيك ، وأكثر أهل العلم يخالفونك؟ فليت شعري! بماذا تجيب ، أتجيب بأن تقول: إمامي منصوص عليه؟ فمن يصدقك في دعوى النص ، وهو لم يسمع النص من الرسول؟ وإنما يسمع دعواك مع تطابق أهل العلم على اختراعك وتكذيبك. ثم هب أنه سلم لك النص ، فإن كان متحيراً في أصل النبوة ، فقال: هب أن إمامك يدلي بمعجزة عيسى عليه السلام فيقول: الدليل على صدقي أني أحيي أباك ، فأحياه ، فناطقني بأنه محق ، فبماذا أعلم صدقه؟ ولم يعلم كافة الخلق صدق عيسى عليه السلام بـهذه المعجزة ، بل عليه من الأسئلة المشكلة ما لا يدفع إلا بدقيق النظر العقلي ؛ والنظر العقلي لا يوثق به عندك ، ولا يعرف دلالة المعجزة على الصدق ما لم يعرف السحر والتمييز بينه وبين المعجزة ، وما لم يعرف أن الله لا يضل عباده. - وسؤال الإضلال وعسر [ تحرير ] الجواب عنه مشهور- فبماذا تدفع جميع ذلك؟ ولم يكن إمامك أولى بالمتابعة من مخالفه! )) فيرجع إلى الأدلة النظرية التي ينكرها ، وخصمه يدلي بمثل تلك الأدلة وأوضح منها. وهذا السؤال قد انقلب عليهم انقلاباً عظيما ، لو اجتمع أولهم وآخرهم على أن يجيبوا عنه جواباً لم يقدروا عليه. وإنما نشأ الفساد من جماعة من الضعفة ناظروهم ، فلم يشتغلوا بالقلب ، بل بالجواب. وذلك مما يطول فيه الكلام ، وما لا يسبق سريعاً إلى الإفهام ، فلا يصلح للإفحام. فإن قال قائل: (( فهذا هو القلب ، فهل عنه جواب؟ )) فأقول: (( نعم! جوابه أن المتحير لو قال: أنا متحير ، ولم يعين المسألة التي هو متحير فيها ، يقال له: أنت كمريض يقول: أنا مريض ولا يعين مرضه ، ويطلب علاجه. فيقال له: ليس في الوجود علاج للمرض المطلق ، بل لمرض معين: من صداع أو إسهال أو غيرهما. فكذلك المتحير ينبغي أن يعين ما هو متحير فيه ؛ فإن عين المسألة عرّفته الحق فيها بالوزن بالموازين الخمسة ، التي لا يفهمها أحد إلا ويعترف بأنه الميزان الحق ، الذي يوثق بكل ما يوزن به ، فيفهم الميزان ، ويفهم منه أيضاً صحة الوزن ، كما يفهم متعلم علم الحساب نفس الحساب ، وكون المحاسب المعلم عالماً بالحساب وصادقاً فيه )). وقد أوضحت ذلك في كتاب (( القسطاس المستقيم )) في مقدار عشرين ورقة ؛ فليتأمل. وليس المقصود الآن بيان فساد مذهبهم ، فقد ذكرت ذلك في كتاب (( المستظهري )) أولاً ؛ وفي كتاب (( حجة الحق )) ثانياً ، وهو جواب كلام لهم عُرض علي ببغداد ؛ وفي كتاب (( مفصل الخلاف )) الذي هو اثنا عشر فصلاً ثالثاً ؛ وهو جواب كلام عُرض علي بـهمدان ؛ وفي كتاب (( الدرج )) المرقوم (( بالجداول )) رابعاً ، وهو من ركيك كلامهم الذي عُرض علي بطوس ؛ وفي كتاب (( القسطاس المستقيم )) خامساً ، وهو كتاب مستقل بنفسه مقصوده بيان ميزان العلوم وإظهار الاستغناء عن الامام [ المعصوم ] لمن أحاط به. بل المقصود أن هؤلاء ليس معهم شيء من الشفاء المنجي من ظلمات الآراء ، بل هم ، مع عجزهم عن إقامة البرهان على تعيين الإمام ، طال ما جاريناهم فصدقناهم في الحاجة إلى التعليم وإلى المعلم المعصوم وأنه الذي عينوه ، ثم سألناهم عن العلم الذي تعلموه من هذا المعصوم وعرضنا عليهم إشكالات فلم يفهموها ، فضلاً عن القيام بحلّها! فلما عجزوا أحالوا [ على ] الإمام الغائب ، وقالوا: (( ( أنه ) لا بد من السفر إليه. )) والعجب أنـهم ضيعوا عمرهم في طلب المعلم وفي التبجح بالظفر به ، ولم يتعلموا منه شيئاً أصلاً ، كالمتضمّخ بالنجاسة ، يتعب في طلب الماء حتى إذا وجده لم يستعمله ، وبقي متضمخاً بالخبائث. ومنهم من ادعى شيئاً من علمهم ، فكان حاصل ما ذكره شيئاً من ركيك فلسفة فيثاغورس: وهو رجل من قدماء الأوائل ، ومذهبـه أرك مذاهب الفلسفة ، وقد رد عليه أرسطاطاليس ، بل استركَّ كلامه واسترذله ، وهو المحكي في كتاب (( إخوان الصفا )) ، وهو على التحقيق حشو الفلسفة. فالعجب ممن يتعب طول العمر في تحصيل العلم ثم يقنع بمثل ذلك العلم الركيك المستغث ، ويظن بأنه ظفر بأقصى مقاصد العلوم! فهؤلاء أيضاً جربناهم وسبرنا ظاهرهم وباطنهم ؛ فرجع حاصلهم إلى استدراج العوام ، وضعفاء العقول ببيان الحاجة إلى المعلم ، ومجادلتهم في إنكارهم الحاجة إلى التعليم بكلام قوي مفحم ، حتى إذا ساعدهم على الحاجة إلى المعلم مساعد ، وقال: (( هات علمه وأفدنا من تعليمه! )) وقف وقال: (( الآن إذا سلمت لي هذا فاطلبه ، فإنما غرضَي هذا القدر فقط. )) إذ علم أنه لو زاد على ذلك لافتضح ولعجز عن حل أدنى الإشكالات ، بل عجز عن فهمه ، فضلاً عن جوابـه. فهذه حقيقة حالهم فأخبرهم تَقْلُهم فلما خبرناهم نفضنا اليد عنهم ( أيضاً ).
* *
طرُق الصُّوفِيَّة
ثم إني ، لما فرغت من هذه العلوم ، أقبلت بـهمتي على طريق الصوفية وعلمت أن طريقتهم إنما تتم بعلم وعمل ؛ وكان حاصل علومهم قطع عقبات النفس. والتنـزه عن أخلاقها المذمومة وصفاتها الخبيثة ، حتى يتوصل ( بـها ) إلى تخلية القلب عن غير الله ( تعالى ) وتحليته بذكر الله. وكان العلم أيسر عليّ من العمل. فابتدأت بتحصيل علمهم من مطالعة كتبهم مثل: (( قوت القلوب )) لأبي طالب المكي ( رحمه الله ) وكتب (( الحارث المحاسبي )) ، والمتفرقات المأثورة عن ((الجنيد)) و (( الشبلي )) و (( أبي يزيد البسطامي )) [ قدس الله أرواحهم ] ، وغيرهم من المشايخ ؛ حتى اطلعت على كنه مقاصدهم العلمية ، وحصلت ما يمكن أن يحصل من طريقهم بالتعلم والسماع. فظهر لي أن أخص خواصهم ، ما لا يمكن الوصول إليه بالتعلم بل بالذوق والحال وتبدل الصفات. وكم من الفرق بين أن تعلم حد الصحة وحد الشبع وأسبابـهما وشروطهما ، وبين أن تكون صحيحاً وشبعان؟ وبين أن تعرف حد السكر ، وأنه عبارة عن حالة تحصل من استيلاء أبخرة تتصاعد من المعدة على معادن الفكر ، وبين أن تكون سكران! بل السكران لا يعرف حدّ السكر وعِلمه وهو سكران وما معه من علمه شيء! والصَّاحي يعرف حدّ السُكر واركأنه ومَا معه من السكر شيء. والطبيب في حالة المرض يعرف حدّ الصحة وأسبابـها وأدويتها ، وهو فاقد الصحة. فكذلك فرقٌ بين أن تعرف حقيقة الزهد وشروطه وأسبابه ، وبين أن تكون حالك الزهد وعزوف النفس عن الدنيا! فعلمت يقيناً أنـهم أرباب الأحوال ، لا أصحاب الأقوال. وأن ما يمكن تحصيله بطريق العلم فقد حصلته ، ولم يبقَ إلا ما لا سبيل إليه بالسماع والتعلم ، بل بالذوق والسلوك. وكان ( قد ) حصل معي - من العلوم التي مارستها والمسالك التي سلكتها ، في التفتيش عن صنفي العلوم الشرعية والعقلية- إيمانٌ يقينيٌ بالله تعالى ، وبالنبُوّة وباليوم الآخر. فهذه الأصول الثلاثة من الإيمان كانت قد رسخت في نفسي ، لا بدليل معين محرر بل بأسبابٍ وقرائن وتجارب لا تدخل تحت الحصر تفاصيلُها. وكان قد ظهر عندي أنه لا مطمع ( لي ) في سعادة الآخرة إلا بالتقوى ، وكف النفس عن الهوى ، وأن رأس ذلك كله ، قطعُ علاقة القلب عن الدنيا بالتجافي عن دار الغرور ، والإنابة إلى دار الخلود ، والإقبال بكُنه الهمة على الله تعالى. وأن ذلك لا يتم إلا بالإعراض عن الجاه والمال ، والهرب من الشواغل والعلائق. ثم لاحظت أحوالي ؛ فإذا أنا منغمس في العلائق ، وقد أحدقت بي من الجوانب ؛ ولاحظت أعمالي – وأحسنها التدريس والتعليم - فإذا أنا فيها مقبل على علوم غير مهمة ولا نافعة في طريق الآخرة. ثم تفكرت في نيتي في التدريس فإذا هي غير خالصة لوجه الله تعالى ، بل باعثها ومحركها طلب الجاه وانتشار الصيت ؛ فتيقنت أني على شفا جُرُف هار ، وأني قد أشفيت على النار ، إن لم أشتغل بتلافي الأحوال. فلم أزل أتفكر فيه مدة ، وأنا بعدُ على مقام الاختيار ، أصمم العزم على الخروج من بغداد ومفارقة تلك الأحوال يوماً ، وأحل العزم يوماً ، وأقدم فيه رجلاً وأؤخر عنه أخرى. لا تصدق لي رغبة في طلب الآخرة بكرة ، إلا ويحمل عليها جند الشهوة حملة فيفترها عشية. فصارت شهوات الدنيا تجاذبني بسلاسلها إلى المقام ، ومنادي الإيمان ينادي: الرحيل! الرحيل! فلم يبق من العمر إلا قليل ، وبين يديك السفر الطويل ، وجميع ما أنت فيه من العلم والعمل رياء وتخييل! فإن لم تستعد الآن للآخرة فمتى تستعد؟ وإن لم تقطع الآن [ هذه العلائق ] فمتى تقطع؟ فعند ذلك تنبعث الداعية ، وينجزم العزم على الهرب والفرار. ثم يعود الشيطان ويقول: (( هذه حال عارضة ، إياك أن تطاوعها ، فأنـها سريعة الزوال ؛ فإن أذعنت لها وتركت هذا الجاه العريض ، والشأن المنظوم الخالي عن التكدير والتنغيص ، والأمر المسلم الصافي عن منازعة الخصوم ، ربما التفتت إليه نفسك ، ولا يتيسر لك المعاودة. )) فلم أزل أتردد بين تجاذب شهوات الدنيا ، ودواعي الآخرة ، قريباً من ستة أشهر أولها رجب سنة ثمان وثمانين وأربع مائة. وفي هذا الشهر جاوز الأمر حد الاختيار إلى الاضطرار ، إذ أقفل الله على لساني حتى اعتقل عن التدريس ، فكنت أجاهد نفسي أن أدرس يوماً واحداً تطييباً لقلوب المختلفة [ إلي ] ، فكان لا ينطق لساني بكلمة [ واحدة ] ولا أستطيعها البتة ، حتى أورثت هذه العقلة في اللسان حزناً في القلب ، بطلت معه قوة الهضم ومراءة الطعام والشراب: فكان لا ينساغ لي ثريد ، ولا تنهضم ( لي ) لقمة ؛ وتعدى إلى ضعف القوى ، حتى قطع الأطباء طمعهم من العلاج وقالوا: (( هذا أمر نـزل بالقلب ، ومنه سرى إلى المزاج ، فلا سبيل إليه بالعلاج ، إلا بأن يتروح السر عن الهم الملم )). ثم لما أحسست بعجزي ، وسقط بالكلية اختياري ، التجأت إلى الله تعالى التجاء المضطر الذي لا حيلة له ، فأجابني الذي (( يجيب المضطر إذا دعاه )) ، وسهل على قلبي الإعراض عن الجاه والمال ( والأهل والولد والأصحاب ) ، وأظهرت عزم الخروج إلى مكة وأنا أدبّر في نفسي سفر الشام حذراً أن يطلع الخليفة وجملة الأصحاب على عزمي على المقام في الشام ؛ فتلطفت بلطائف الحيل في الخروج من بغداد على عزم أن لا أعاودها أبداً. واستهدفت لأئمة أهل العراق كافة ، إذ لم يكن فيهم من يجوز أن يكون للإعراض عما كنت فيه سبب دينيّ ، إذ ظنوا أن ذلك هو المنصب الأعلى في الدين ، وكان ذلك مبلغهم من العلم. ثم ارتبك الناس في الاستنباطات ، وظن من بعُد عن العراق ، أن ذلك كان لاستشعار من جهة الولاة ؛ ( وأما من قرب من الولاة ) : كان يشاهد إلحاحهم في التعلق بي والانكباب عليَّ ، وإعراضي عنهم ، وعن الالتفات إلى قولهم ، فيقولون: (( هذا أمر سماوي ، وليس له سبب إلا عين أصابت أهل الإسلام وزمرة أهل العلم )). ففارقت بغداد ، وفرقت ما كان معي من المال ، ولم أدخر إلا قدر الكفاف ، وقوت الأطفال ، ترخصاً بأن مال العراق مرصد للمصالح ، ولكونه وقفاً على المسلمين. فلم أر في العالم مالاً يأخذه العالم لعياله أصلح منه. ثم دخلت الشام ، وأقمت به قريباً من سنتين لا شغل لي إلا العزلة والخلوة ؛ والرياضة والمجاهدة ، اشتغالاً بتزكية النفس ، وتـهذيب الأخلاق ، وتصفية القلب لذكر الله ( تعالى ) ، كما كنت حصلته من كتب الصوفية. فكنت أعتكف مدة في مسجد دمشق ، أصعد منارة المسجد طول النهار ، وأغلق بابـها على نفسي. ثم رحلت منها إلى بيت المقدس ، أدخل كل يوم الصخرة ، وأغلق بابـها على نفسي. ثم تحركت فيَّ داعية فريضة الحج ، والاستمداد من بركات مكة والمدينة. وزيارة رسول الله ﷺ بعد الفراغ من زيارة الخليل صلوات الله وسلامه عليه ؛ فسرت إلى الحجاز. ثم جذبتني الهمم ، ودعوات الأطفال إلى الوطن ، فعاودته بعد أن كنت أبعد الخلق عن الرجوع إليه. فآثرت العزلة [ به ] أيضاً حرصاً على الخلوة ، وتصفية القلب للذكر. وكانت حوادث الزمان ، ومهمات العيال ، وضرورات المعاش ، تغير فيَّ وجه المراد ، وتشوش صفوة الخلوة. وكان لا يصفو [ لي ] الحال إلا في أقوات متفرقة. لكني مع ذلك لا أقطع طمعي منها ، فتدفعني عنها العوائق ، وأعود إليها. ودمت على ذلك مقدار عشر سنين ؛ وانكشفت لي في أثناء هذه الخلوات أمور لا يمكن إحصاؤها واستقصاؤها ، والقدر الذي أذكره لينتفع به: إني علمت يقيناً أن الصوفية هم السالكون لطريق الله ( تعالى ) خاصة ، وأن سيرتهم أحسن السير ، وطريقهم أصوب الطرق ، وأخلاقهم أزكى الأخلاق. بل لو جُمع عقل العقلاء ، وحكمة الحكماء ، وعلم الواقفين على أسرار الشرع من العلماء ، ليغيروا شيئاً من سيرهم وأخلاقهم ، ويبدلوه بما هو خير منه ، لم يجدوا إليه سبيلاً. فإن جميع حركاتـهم وسكناتـهم ، في ظاهرهم وباطنهم ، مقتبسة من ( نور ) مشكاة النبوة ؛ وليس وراء نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به. وبالجملة ، فماذا يقول القائلون في طريقة ، طهارتـها - وهي أول شروطها - تطهير القلب بالكلية عما سوى الله ( تعالى ) ، ومفتاحها الجاري منها مجرى التحريم من الصلاة ، استغراق القلب بالكلية بذكر الله ، وآخرها الفناء بالكلية في الله؟ وهذا آخرها بالإضافة إلى ما يكاد يدخل تحت الاختيار والكسب من أوائلها. وهي على التحقيق أول الطريقة ، وما قبل ذلك كالدهليز للسالك إليه. ومن أول الطريقة تبتدئ المكاشفات ( والمشاهدات ) ، حتى أنـهم في يقظتهم يشاهدون الملائكة ، وأرواح الأنبياء ويسمعون منهم أصواتاً ويقتبسون منهم فوائد. ثم يترقى الحال من مشاهدة الصور والأمثال ، إلى درجات يضيق عنها نطاق النطق ، فلا يحاول معبر أن يعبر عنها إلا اشتمل لفظه على خطأ صريح لا يمكنه الاحتراز عنه. وعلى الجملة. ينتهي الأمر إلى قرب يكاد يتخيل منه طائفة الحلول ، وطائفة الاتحاد ، وطائفة الوصول ، وكل ذلك خطأ. وقد بينا وجه الخطأ فيه في كتاب (( المقصد الأسنى )) ؛ بل الذي لابسته تلك الحالة لا ينبغي أن يزيد على أن يقول : وكان ما كان مما لستُ أذكره فظنَّ خيراً ولا تسأل عن الخبرِ! وبالجملة ، فمن لم يرزق منه شيئاً بالذوق ، فليس يدرك من حقيقة النبوة إلا الاسم ، وكرامات الأولياء ، [ هي ] على التحقيق ، بدايات الأنبياء ، وكان ذلك أول حال رسول الله ﷺ ، حين أقبل إلى جبل (( حراء )) ، حيث كان يخلو فيه بربه ويتعبد ، حتى قالت العرب : (( إن محمداً عشق ربه!)). وهذه حالة ، يتحققها بالذوق من يسلك سبيلها. فمن لم يرزق الذوق ، فيتيقنها بالتجربة والتسامع ، إن أكثر معهم الصحبة ، حتى يفهم ذلك بقرائن الأحوال يقيناً. ومن جالسهم ، استفاد منهم هذا الإيمان. فهم القوم لا يشقى جليسهم. ومن لم يرزق صحبتهم ، فليعلم إمكان ذلك يقيناً بشواهد البرهان ، على ما ذكرناه في كتاب (( عجائب القلب )) من كتب (( إحياء علوم الدين )). والتحقيق بالبرهان علم ، وملابسة عين تلك الحالة ذوق ، والقبول من التسامع والتجربة بحسن الظن إيمان. فهذه ثلاث درجات : (( يرفعِ الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجاتٍ )) (المجادلة: 58: 11) ووراء هؤلاء قوم جهال ، هم المنكرون لأصل ذلك ، المتعجبون من هذا الكلام ، يستمعون ويسخرون ، ويقولون : العجب ! أنـهم كيف يهذون ! وفهيم قال الله تعالى : (( ومنـهم من يستمع إليكَ حتى إذا خرجوا من عِندك قالوا للذين أُوتوا العلم ماذا قال آنفاً أولئك الذين طبع الله على قلوبـهم واتبعوا أهواءهم )) ( فأصمهُم وأعمى أبصارهم ) (محمد : 47: 16) ومما بان لي بالضرورة من ممارسة طريقتهم ، (( حقيقة النبوة وخاصيتها )). ولا بد من التنبيه على أصلها لشدة مسيس الحاجة إليها.
حَقيقَة النُبُوَّة: واضطِرار كَافةِ الخَلق إليهَا
اعلم: أن جوهر الإنسان في أصل الفطرة ، خلق خالياً ساذجاً لا خبر معه من عوالم الله ( تعالى )! والعوالم كثيرة لا يحصيها إلا الله تعالى كما قال: (( وما يعلم جنودُ ربك إلا هو )) (المدثر : 74: 31) وإنما خبره من العوالم بواسطة الإدراك ، وكل إدراك من الإدراكات خلق ليطلع الإنسان به على عالم من الموجودات ، ونعني بالعوالم ، أجناس الموجودات. فأول ما يخلق في الإنسان حاسة اللمس ، فيدرك بـها أجناساً من الموجودات: كالحرارة ، والبرودة ، والرطوبة واليبوسة ، واللين والخشونة ، وغيرها. واللمس قاصر عن الألوان والأصوات قطعاً ، بل هي كالمعدوم في حق اللمس. ثم تخلق له [ حاسة ] البصر ، فيدرك بـها الألوان والأشكال ، وهو أوسع عوالم المحسوسات. ثم ينفخ فيه السمع ، فيسمع الأصوات والنغمات. ثم يخلق له الذوق. وكذلك إلى أن يجاوز عالم المحسوسات ، فيخلق فيه التمييز ، وهو قريب من سبع سنين ، وهو طور آخر من أطوار وجوده : فيدرك فيه أموراً زائدة على ( عالم ) المحسوسات ، لا يوجد منها شيء في عالم الحس. ثم يترقى إلى طور آخر ، فيخلق له العقل ، فيدرك الواجبات والجائزات والمستحيلات ، وأموراً لا توجد في الأطوار التي قبله. ووراء العقل طور آخر تنفتح فيه عين أخرى يبصر بـها الغيب وما سيكون في المستقبل ، وأموراً أُخر ، العقل معزول عنها كعزل قوة التمييز عن إدراك المعقولات وكعزل قوة الحس عن مدركات التمييز. وكما أن المميز لو عرضت عليه مدركات العقل لأباها واستبعدها ، فكذلك بعض العقلاء أبوا مدركات النبوة واستبعدوها ، وذلك عين الجهل : إذ لا مستند لهم إلا أنه طور لم يبلغه ولم يوجد في حقه ، فيظن أنه غير موجود في نفسه. والأكمه ، لو لم يعلم بالتواتر والتسامع الألوان والأشكال وحكي له ذلك ابتداءً ، لم يفهمها ولم يقرّ بـها. وقد قرب الله تعالى على خلقه بأن أعطاهم نموذجاً من خاصية النبوة ، وهو النوم : إذ النائم يدرك ما سيكون من الغيب ، إما صريحاً وإما في كسوة مثال يكشف عنـه التعبير. وهذا لو لم يجربه الإنسان من نفسه - وقيل له: (( إن من الناس من يسقط مغشياً عليه كالميت ، ويزول ( عنه ) إحساسه وسمعه وبصره فيدرك الغيب. )) – لأنكره ، وأقام البرهان على استحالته ، وقال: (( القوى الحساسة أسباب الإدراك ، فمن لا يدرك الأشياء مع وجودها وحضورها ، فبأن لا يدرك مع ركودها أولى وأحق. )) وهذا نوع قياس يكذبه الوجود والمشاهدة. فكما أن العقل طور من أطوار الآدمي ، يحصل فيه عين يبصر بـها أنواعاً من المعقولات ، والحواس معزولة عنها ، فالنبوة أيضاً عبارة عن طور يحصل فيه عين لها نور يظهر في نورها الغيب ، وأمور لا يدركها العقل. والشك في النبوة ، إما أن يقع: في إمكأنـها ، أو في وجودها ووقوعها ، أو في حصولها لشخص معين. ودليل إمكأنـها وجودها. ودليل وجودها وجود معارف في العالم لا يتصور أن تنال بالعقل ، كعلم الطب والنجوم ؛ فإن من بحث عنها علم بالضرورة أنها لا تدرك إلا بإلهام إلهي وتوفيق من جهة الله ( تعالى ) ، ولا سبيل إليها بالتجربة. فمن الأحكام النجومية ما لا يقع إلا في كل ألف سنة مرة ، فكيف ينال ذلك بالتجربة ؟ وكذلك خواص الأدوية. فتبين بـهذا البرهان أن في الإمكان وجود طريق لإدراك هذه الأمور التي لا يدركها العقل - وهو المراد بالنبوة - لا أن النبوة عبارة عنها فقط ، بل إدراك هذا الجنس الخارج عن مدركات العقل إحدى خواص النبوة ، ولها خواص كثيرة سواها. وما ذكرنا ، فقطرة من بحرها ؛ إنما ذكرناها لأن معك أُنموذجاً منها ، وهو مدركاتك في النوم ؛ ومعك علوم من جنسها في الطب والنجوم ، وهي معجزات الأنبياء ( عليهم الصلاة والسلام ) ، ولا سبيل إليها للعقلاء ببضاعة العقل أصلاً. وأما ما عدا هذا من خواص النبوة ، فإنما يدرك بالذوق ، من سلوك طريق التصوف ؛ لأن هذا إنما فهمته بأنموذج رزقته وهو النوم ، ولولاه لما صدقت به. فإن كان للنبي خاصة ليس لك منها أنموذج ، ولا تفهمها أصلاً ، فكيف تصدق بـها ؟ وإنما التصديق بعد الفهم: وذلك الأنموذج يحصل في أوائل طريق التصوف فيحصل به نوع من الذوق بالقدر الحاصل ونوع من التصديق بما لم يحصل بالقياس ( إليه ). فهذه الخاصية الواحدة تكفيك للإيمان بأصل النبوة. فإن وقع لك الشك في شخص معين ، أنه نبي أم لا ، فلا يحصل اليقين إلا بمعرفة أحواله ، إما بالمشاهدة ، أو بالتواتر والتسامع ؛ فإنك إذا عرفت الطب والفقه ، يمكنك أن تعرف الفقهاء والأطباء بمشاهدة أحوالهم ، وسماع أقوالهم ، وإن لم تشاهدهم ؛ ولا تعجز أيضاً عن معرفة كون الشافعي ( رحمه الله ) فقيهاً ، وكون جالينوس طبيباً ، معرفة بالحقيقة لا بالتقليد عن الغير ، [ بل ] بأن تتعلم شيئاً من الفقه والطب وتطالع كتبهما وتصانيفهما ، فيحصل لك علم ضروري بحالهما. فكذلك إذا فهمت معنى النبوة فأكثرت النظر في القرآن والأخبار ، يحصل لك العلم الضروري بكونه ﷺ على أعلى درجات النبوة ، وأعضد ذلك بتجربة ما قاله في العبادات وتأثيرها في تصفية القلوب ، وكيف صدق ﷺ في قوله: (( من عمل بما علم ورثهُ الله علم ما لم يعلم )) وكيف صدق في قوله:
(( من أعان ظالماً سلطهُ الله عليهِ )) وكيف صدق في قوله:
(( من اصبح وهُمُومُهُ همٌّ واحدٌ كفاه الله ( تعالى ) هُمُومَ الدنيا والآخرةِ )) . فإذا جربت ذلك في ألف وألفين وآلاف ، حصل لك علم ضروري لا تتمارى فيه. فمن هذا الطريق اطلب اليقين بالنبوة ، لا من قلب العصا ثعباناً ، وشق القمر ، فإن ذلك إذا نظرت إليه وحده ، ولم تنضم إليه القرائن الكثيرة الخارجة عن الحصر ، وربما ظننت أنه سحر وتخييل ، وأنه من الله تعالى إضلال فأنه (( يُضِلُّ من يَشَاءُ ويَهدي من يشاءُ )) (فاطر:8). وترد عليك أسئلة المعجزات ، فإذا كان مستند إيمانك إلى كلام منظوم في وجه دلالة المعجزة ، فينجزم إيمانك بكلام مرتب في وجه الإشكال والشبهة عليها ، فليكن مثل هذه الخوارق إحدى الدلائل والقرائن في جملة نظرك ، حتى يحصل لك علم ضروري لا يمكنك ذكر مستنده على التعيين كالذي يخبره جماعة بخبر متواتر لا يمكنه أن يذكر أن اليقين مستفاد من قول واحد معين ، بل من حيث لا يدري ، ولا يخرج عن جملة ذلك ولا بتعيين الآحاد. فهذا هو الإيمان القوي العلمي. وأما الذوق فهو كالمشاهدة والأخذ باليد ، ولا يوجد إلا في طريق الصوفية. فهذا القدر من حقيقة النبوة ، كاف في الغرض الذي أقصده الآن ، وسأذكر وجه الحاجة إليه.
سَبَب نشر العِلْم بعَدْ الإعرَاضِ عَنـه
ثم إني ، لما واظبت على العزلة والخلوة قريباً من عشر سنين ، بان لي في أثناء ذلك على الضرورة من أسباب لا أحصيها ، مرة بالذوق ، ومرة بالعلم البرهاني ، ومرة بالقبول الإيماني : أن الإنسان خلق من بدن وقلب - وأعني بالقلب حقيقة روحه التي هي محل معرفة الله ، دون اللحم والدم الذي يشارك فيه الميت والبهيمة - ، وأن البدن له صحة بـها سعادته ومرض فيه هلاكه ؛ وأن القلب كذلك له صحة وسلامة ، ولا ينجو (( إلا من أتى الله بقلب سليم )) (الشعراء:89) ؛ وله مرض فيه هلاكه الأبدي الأخروي ، كما قال تعالى : (( في قلوبـهم مرضٌ )) (البقرة:10) وأن الجهل بالله سم مهلك ؛ وأن معصية الله ، بمتابعة الهوى ، داؤه الممرض ، وأن معرفة الله تعالى ترياقه المحيي ، وطاعته بمخالفة الهوى ، دواؤه الشافي ؛ وأنه لا سبيل إلى معالجتة بازالة مرضه وكسب صحته ، الا بأدوية ؛ كما لا سبيل إلى معالجة البدن إلا بذلك. وكما أن أدوية البدن تؤثر في كسب الصحة بخاصية فيها ، لا يدركها العقلاء ببضاعة العقل ، بل يجب فيها تقليد الأطباء الذين أخذوها من الأنبياء ، الذين اطلعوا بخاصية النبوة على خواص الأشياء ، فكذلك بان لي ، على الضرورة ، بأن أدوية العبادات بحدودها ومقاديرها المحدودة المقدرة من جهة الأنبياء ، لا يدرك وجه تأثيرها ببضاعة عقل العقلاء ، بل يجب فيها تقليد الأنبياء الذين أدركوا تلك الخواص بنور النبوة ، لا ببضاعة العقل. وكما أن الأدوية تركب من ( أخلاط مختلفة ) النوع والمقدار وبعضها ضعف البعض في الوزن والمقدار ، فلا يخلو اختلاف مقاديرها عن سر هو من قبيل الخواص ، فكذلك العبادات التي هي أدوية داء القلوب ، مركبة من أفعال مختلفة النوع والمقدار ، حتى أن السجود ضعف الركوع ، وصلاة الصبح نصف صلاة العصر في المقدار ؛ ولا يخلو عن سر من الاسرار ، هو من قبيل الخواص التي لا يطلع عليها الا بنور النبوة. ولقد تحامق وتجاهل جداً من أراد أن يستنبط ، بطريق العقل ، لها حكمة ، أو ظن أنـها ذكرت على الاتفاق ، لا عن سر إلهي فيها ، يقتضيها بطريق الخاصية. وكما أن في الأدوية أصولاً هي أركأنـها ، وزوائد هي متمماتها ، لكل واحد منها خصوص تأثير في أعمال أصولها ، كذلك النوافل والسنن متممات لتكميل آثار أركان العبادات. وعلى الجملة : فالأنبياء عليهم السلام أطباء أمراض القلوب ، وإنما فائدة العقل وتصرفه أن عرّفنا ذلك وشهد للنبوة بالتصديق ولنفسه بالعجز عن درك ما يدرك بعين النبوة ، وأخذ بأيدينا وسلمنا ( إليها ) تسليم العميان إلى القائدين ، وتسليم المرضى المتحيرين إلى الأطباء المشفقين. فإلى ههنا مجرى العقل ومخطاه وهو معزول عما بعد ذلك ، إلا عن تفهم ما يلقيه الطبيب إليه. فهذه أمور عرفناها بالضرورة الجارية مجرى المشاهدة ، في مدة الخلوة والعزلة. ثم رأينا فتور الاعتقادات في أصل النبوة ، ثم في حقيقة النبوة ، ثم في العمل بما شرحته النبوة ، وتحققنا شيوع ذلك بين الخلق ؛ فنظرت إلى أسباب فتور الخلق ، وضعف إيمأنـهم ، فإذا هي أربعة : 1 - سبب من الخائضين في علم الفلسفة ؛ 2 - وسبب من الخائضين في طريق التصوف ؛ 3 - وسبب من المنتسبين إلى دعوى التعليم ؛ 4- وسبب من معاملة الموسومين بالعلم فيما بين الناس. فإني تتبعت مدةً آحاد الخلق ، أسألُ من أن يقصر منهم في متابعة الشرع ( واسأله ) عن شبهته وأبحث عن عقيدته وسره وقلت له: (( ما لك تقصر فيها فإن كنت تؤمن بالآخرة ولست تستعد لها وتبيعها بالدنيا ، فهذه حماقة! فإنك لا تبيع الاثنين بواحد ، فكيف تبيع ما لا نـهاية له بأيام معدودة؟ وإن كنت لا تؤمن ، فأنت كافر! فدبر نفسك في طلب الإيمان ، وانظر ما سبب كفرك الخفي الذي هو مذهبك باطناً ، وهو سبب جرأتك ظاهراً ، وإن كنت لا تصرح به تجملاً بالإيمان وتشرفاً بذكر الشرع ! )). فقائل يقول: (( إن هذا أمر لو وجبت المحافظة عليه ، لكان العلماء أجدر بذلك ؛ وفلان من المشاهير بين الفضلاء لا يصلي ، وفلان يشرب الخمر ، وفلان يأكل أموال الأوقاف وأموال اليتامى ، وفلان يأكل إدرار السلطان ولا يحترز عن الحرام ، وفلان يأخذ الرشوة على القضاء والشهادة ! وهلم جراً إلى أمثاله. )) وقائل ثان: يدعي ( علم ) التصوف ، ويزعم أنه قد بلغ مبلغاً ترقّى عن الحاجة إلى العبادة!. وقائل ثالث: يتعلل بشبهة أخرى من شبهات أهل الإباحة! وهؤلاء هم الذين ضلوا عن التصوف. وقائل رابع لقي أهل التعليم فيقول: (( الحق مشكل ، والطريق إليه متعسر ، والاختلاف فيه كثير ، وليس بعض المذاهب أولى من بعض ، وأدلة العقول متعارضة ، فلا ثقة برأي أهل الرأي ، والداعي إلى التعليم متحكم لا حجة له ، فكيف أدع اليقين بالشك ؟ )). وقائل خامس يقول: (( لست أفعل هذا تقليداً ، ولكني قرأت علم الفلسفة وأدركت حقيقة النبوة ، وإن حاصلها يرجع إلى الحكمة والمصلحة ، وأن المقصود من تعبداتـها: ضبط عوام الخلق وتقييدهم عن التقاتل والتنازع والاسترسال في الشهوات ، فما أنا من العوام الجهال حتى أدخل في حجر التكليف ، وإنما أنا من الحكماء أتبع الحكمة وأنا بصير بـها ، مستغن فيها عن التقليد ! )). هذا منتهى إيمان من قرأ ( مذهب ) فلسفة الإلهيين منهم ؛ وتعلم ذلك من كتب ابن سينا وأبي نصر الفارابي. وهؤلاء هم المتجملون بالإسلام. وربما ترى الواحد منهم يقرأ القرآن ، ويحضر الجماعات والصلوات ، ويعظم الشريعة بلسأنه ، ولكنه مع ذلك لا يترك شرب الخمر ، وأنواعاً من الفسق والفجور! وإذا قيل له: ((إن كانت النبوة غير صحيحة ، فلم تصلي ؟ )) فربما يقول: (( لرياضة الجسد ، ولعادة أهل البلد ، وحفظ المال والولد! )). وربما قال: ((الشريعة صحيحة ، والنبوة حق! )) فيقال: (( فلمَ تشرب الخمر؟ )) فيقول: (( إنما نـهي عن الخمر لأنـها تورث العداوة والبغضاء ، وأنا بحكمتي محترز عن ذلك ، وإني أقصد به تشحيذ خاطري.)) حتى أن ابن سينا ذكر في وصية له كتب فيها: أنه عاهد الله تعالى على كذا وكذا ، وأن يعظم الأوضاع الشرعية ، ولا يقصر في العبادات الدينية ، ولا يشرب تلهياً بل تداوياً وتشافياً ؛ فكان منتهى حالته في صفاء الإيمان ، والتزام العبادات ، أن استثنى شرب الخمر لغرض التشافي. فهذا إيمان من يدعي الإيمان منهم. وقد انخدع بـهم جماعة ، وزادهم انخداعاً ضعف اعتراض المعترضين عليهم ، إذ اعترضوا بمجاهدة علم الهندسة والمنطق ، وغير ذلك مما هو ضروري لهم ، على ما بينا علته من قبل. فلما رأيت أصناف الخلق قد ضعف إيـمأنـهم إلى هذا الحد بـهذه الأسباب ، ورأيت نفسي ملبة بكشف هذه الشبهة ، حتى كان إفضاح هؤلاء أيسر عندي من شربة ماء ، لكثرة خوضي في علومهم [ وطرقهم ] - أعني [ طرق ] الصوفية والفلاسفة والتعليمية والمتوسمين من العلماء- ، انقدح في نفسي أن ذلك متعين في هذا الوقت ، محتوم. فماذا تغنيك الخلوة والعزلة ، وقد عم الداء ، ومرض الأطباء ، وأشرف الخلق على الهلاك؟ ثم قلت في نفسي: (( متى تشتغل أنت بكشف هذه الغمة ومصادمة هذه الظلمة ، والزمان زمان الفترة ، والدور دور الباطل ، ولو اشتغلت بدعوة الخلق ، عن طرقهم إلى الحق ، لعاداك أهل الزمان بأجمعهم ، وأنـَّى تقاومهم فكيف تعايشهم ، ولا يتم ذلك إلا بزمان مساعد ، وسلطان متدين قاهر؟ )) فترخصت بيني وبين الله تعالى بالاستمرار على العزلة تعللاً بالعجز عن إظهار الحق بالحجة. فقدر الله تعالى أن حرك داعية سلطان الوقت من نفسه ، لا بتحريك من خارج. فأمر أمر إلزام بالنهوض إلى نيسابور ، لتدارك هذه الفترة. وبلغ الإلزام حداً كان ينتهي ، لو أصررت على الخلاف ، إلى حد الوحشة. فخطر لي أن سبب الرخصة قد ضعف ، فلا ينبغي أن يكون باعثك على ملازمة العزلة الكسل والاستراحة ، وطلب عز النفس وصونها عن أذى الخلق ، ولم ترخص لنفسك عُسْرَ معاناة الخلق ، والله سبحأنه وتعالى يقول: (( بسم الله الرحمن الرحيم: الم. أحَسِبَ الناسُ أن يُتركوا أن يقولوا آمناً وهم لا يُفَتَنونَ ولقد فتنّا الذينَ من قبلهم )) الآية (العنكبوت: 1-3 ) ويقول عز وجل لرسوله وهو أعز خلقه: (( ولقدَ كُذّبَتْ رُسلٌ من قبلكَ فصَبروا على ما كُذّبوا وأُوذوا ، حتى أتاهم نصرُنا ؛ ولا مبَدّلَ لكلماتِ الله ، ولقد جاءك من نبأ المرسلين )) ( الأنعام:34 ) ويقول عز وجل: (( بسم الله الرحمن الرحيم : يس والقرآن الحكيم... )) إلى قوله (( إنما تنذرُ من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيبِ )). ( يس:1-11 ) فشاورت في ذلك جماعة من أرباب القلوب والمشاهدات ، فاتفقوا على الإشارة بترك العزلة ، والخروج من الزاوية ؛ وانضاف إلى ذلك منامات من الصالحين كثيرة متواترة ، تشهد بأن هذه الحركة مبدأ خير ورشد قدّرها الله سبحأنه على رأس هذه المائة ؛ فاستحكم الرجاء ، وغلب حسن الظنّ بسبب هذه الشهادات وقد وعد الله سبحأنه بإحياء دينه على رأس كل مائة. ويسّر الله تعالى الحركة إلى نيسابور ، للقيام بـهذا المهم في ذي القعدة ، سن تسع وتسعين وأربع مائة. وكان الخروج من بغداد في ذي القعدة سنة ثمان وثمانين وأربع مائة. وبلغت مدة العزلة إحدى عشر سنة. وهذه حركة قدّرها الله تعالى ، ( وهي ) من عجائب تقديراته التي لم يكن لها انقداح في القلب في هذه العزلة ، كما لم يكن الخروج من بغداد ، والنـزوع عن تلك الأحوال مما خطر إمكأنه أصلاً بالبال ؛ والله تعالى مقلب القلوب والأحوال و (( قلب المؤمن بين إصبعين من أصابعِ الرحمن )) . وأنا أعلم أني ، وإن رجعت إلى نشر العلم ، فما رجعت! فإن الرجوع عَودٌ إلى ما كان ، وكنت في ذلك الزمان أنشر العلم الذي به يكتسب الجاه ، وأدعو إليه بقولي وعملي ، وكان ذلك قصدي ونيتي. وأما الآن فأدعو إلى العلم الذي به يُترك الجاه ، ويعرف بـه سقوط رتبة الجاه. هذا هو الآن نيتي وقصدي وأمنيتي ؛ يعلم الله ذلك مني ؛ وأنا أبغي أن أصلح نفسي وغيري ، ولست أدري أأصِل مرادي أم أُخترم دون غرضي؟ ولكني اؤمن إيمان يقين ومشاهدة أنه لا حول ولا قوة إلا بالله ( العلي العظيم ) ؛ وأني لم أتحرك ، لكنه حركني ؛ وإني لم أعمل ، لكنه استعملني ؛ فأسأله أن يصلحني أولاً ، ثم يُصلح بي ، ويهديني ، ثم يهدي بي ؛ وأن يريني الحق حقاً ، ويرزقني اتباعه ، ويريني الباطل باطلاً ، ويرزقني اجتنابه.
* *
ونعود الآن إلى ما ذكرناه من أسباب ضعف الإيمان بذكر طريق إرشادهم وإنقاذهم من مهالكهم: أما الذين ادعوا الحيرة بما سمعوه من أهل التعليم ، فعلاجهم ما ذكرناه في كتاب (( القسطاس المستقيم )) ولا نطول بذكره ( في ) هذه الرسالة. وأما ما توهمه أهل الإباحة ، فقد حصرنا شبههم في سبعة أنواع وكشفناها في كتاب (( كيمياء السعادة )). وأما من فسد إيمأنه بطريق الفلسفة ، حتى أنكر أصل النبوة ، فقد ذكرنا حقيقة النبوة ووجودها بالضرورة ، بدليل وجود ( علم ) خواص الأدوية والنجوم وغيرهما. وإنما قدمنا هذه المقدمة لأجل ذلك. وأنـما أوردنا الدليل من خواص الطب والنجوم ، لأنه من نفس علمهم. ونحن نبين لكل عالم بفن من العلوم ، كالنجوم والطب والطبيعة والسحر والطلسمات ، مثلاً من نفس علمه ، برهان النبوة. وأما من أثبت النبوة بلسأنه ، وسوى أوضاع الشرع على الحكمة ، فهو على التحقيق كافر بالنبوة ، وإنما هو مؤمن بحكم له طالع مخصوص ، يقتضي طالعه أن يكون متبوعاً ؛ وليس هذا من النبوة في شيء. بل الإيمان بالنبوة: أن يقر بإثبات طور وراء العقل ، تنفتح فيه عين يدرك بـها مدركات خاصة ، والعقل معزول عنها ، كعزل السمع عن إدراك الألوان ، والبصر عن إدراك الأصوات ، وجميع الحواس عن إدراك المعقولات. فإن لم يجوّز هذا ، فقد أقمنا البرهان على إمكأنه ، بل على وجوده. وإن جوز هذا ، فقد أثبت ، أن ههنا أموراً تسمى خواص ، لا يدور تصرف العقل حواليها أصلاً ، بل يكاد العقل يكذبـها ويقضي باستحالتها. فإن وزن دانق من الأفيون ، سم قاتل لأنه يجمد الدم في العروق لفرط برودته. والذي يدعي علم الطبيعة ، يزعم أنه ما يبرد من المركبات ، إنما يبرد بعنصري الماء والتراب ؛ فهما العنصران الباردان. ومعلوم أن أرطالاً من الماء والتراب لا يبلغ تبريدها في الباطن إلى هذا الحد. فلو أخبر طبيعي بـهذا ولم يجربـه ، لقال: (( هذا محال ، والدليل على استحالته أن فيه نارية وهوائية ، والهوائية والنارية لا تزيدها برودة ؛ فنقدر الكل ماء وتراباً ، فلا يوجب هذا الإفراط في التبريد. فإن انضم إليه حارّان فبأن لا يوجب ذلك أولى. )) ويقدر هذا برهاناً! وأكثر براهين الفلاسفة في الطبيعيات والإلهيات ، مبني على هذا الجنس! فأنـهم تصوروا الأمور على قدر ما وجدوه وعقلوه ، وما لم يألفوه قدروا استحالته ، ولو لم تكن الرُؤْيا الصادقة مألوفة ، وادعى مدعٍ ، أنه عند ركود الحواس ، يعلم الغيب ، لأنكره المتصفون بمثل هذه العقول. ولو قيل لواحد: هل يجوز أن يكون في الدنيا شيء ، هو بمقدار حبة ، يوضع في بلدة فيأكل تلك البلدة بجملتها ثم يأكل نفسه فلا يُبقي [ شيئاً ] من البلدة وما فيها ، ولا يبقى هو نفسه؟ )) لقال: (( هذا لمحال وهو من جملة الخرافات! )) وهذه حالة النار ، ينكرها من لم يرَ النار إذا سمعها. وأكثر [ إنكار ] عجائب الآخرة هو من هذا القبيل. فنقول للطبيعي: (( قد اضطررت إلى أن تقول : في الأفيون خاصية في التبريد ، ليست على قياس المعقول بالطبيعة. فلمَ لا يجوز أن يكون في الأوضاع الشرعية من الخواص ، في مداواة القلوب وتصفيتها ، ما لا يدرك بالحكمة العقلية ، بل لا يبصر ذلك إلا بعين النبوة؟ )) بل قد اعترفوا بخواص هي أعجب من هذا فيما أوردوه في كتبهم ، وهي من الخواص العجيبة المجربة في معالجة الحامل التي عسر عليها الطلق ، بـهذا الشكل: 4 9 2 د ط ب 3 5 7 ج هـ ز 8 1 6 ح ا و
يكتب على خرقتين لم يصبهما ماء ، وتنظر إليهما الحامل بعينها ، وتضعهما تحت قدميها ، فيسرع الولد في الحال إلى الخروج. وقد أقروا بإمكان ذلك وأوردوه في (( عجائب الخواص )) ؛ وهو شكل فيه تسعة بيوت ، يرقم فيها رقوم مخصوصة ، يكون مجموع ما في جدول واحد خمسة عشر ، قرأته في طول الشكل أو في عرضه أو على التأريب .
فيا ليت شعري! من يصدق بذلك ، ثم لا يتسع عقله للتصديق ، بأن تقدير صلاة الصبح بركعتين ، والظهر بأربع ، والمغرب بثلاث ، هو لخواص غير معلومة بنظر الحكمة؟ وسببها اختلاف هذه الأوقات. وإنما تدرك هذه الخواص بنور النبوة. والعجب أنـَّا لو غيرنا العبارة إلى عبارة المنجمين ، لعقلوا اختلاف هذه الأوقات ، فنقول: (( أليس يختلف الحكم في الطالع ، بأن تكون الشمس في وسط السماء ، أو في الطالع ، أو في الغارب ، حتى يبنوا على هذا في تسييراتـهم اختلاف العلاج ، وتفاوت الأعمار والآجال ، ولا فرق بين الزوال وبين كون الشمس في وسط السماء ، ولا بين المغرب وبين كون الشمس في الغارب ، فهل لتصديق ذلك سبب؟ )) إلا أن ذلك يسمعه بعبارة منجم ، لعله جرب كذبه مائة مرة. ولا يزال يعاود تصديقه ، حتى لو قال المنجم [ له ]: (( إذا كانت الشمس في وسط السماء ، ونظر إليها الكوكب الفلاني ، والطالع هو البرج الفلاني ، فلبست ثوباً جديداً في ذلك الوقت قتلت في ذلك الثوب! )) فأنه لا يلبس الثوب في ذلك الوقت ، وربما يقاسي فيه البرد الشديد ، وربما سمعه من منجم وقد عرف كذبـه مرات!. فليت شعري! من يتسع عقله لقبول هذه البدائع ويضطر إلى الاعتراف بأنـها خواص -معرفتها معجزة لبعض الأنبياء- فيكف ينكر مثل ذلك ، فيما يسمعه من قول نبي صادق مؤيد بالمعجزات ، لم يعرف قط بالكذب! ( ولم لا يتسع لإمكأنه! ). فإن أنكر فلسفي إمكان هذه الخواص في أعداد الركعات ، ورمي الجمار ، وعدد أركان الحج ، وسائر تعبدات الشرع ، لم يجد بينها وبين خواص الأدوية والنجوم فرقاً أصلاً. فإن قال: (( قد جربت شيئاً من النجوم وشيئاً من الطب ، فوجدت بعضه صادقاً ، فانقدح في نفسي تصديقه وسقط من قلبي استبعاده ونفرته ؛ وهذا لم أجربه ، فبم أعلم وجوده وتحقيقه؟ )) وإن أقررت بإمكأنه ، فأقول: (( إنك لا تقتصر على تصديق ما جربته بل سمعت أخبار المجربين وقلدتـهم ، فاسمع أقوال الأنبياء فقد جربوا وشاهدوا الحق في جميع ما ورد بـه الشرع ، واسلك سبيلهم تدرك بالمشاهدة بعض ذلك.)) على أني أقول: (( وإن لم تجربه ، فيقضي عقلك بوجوب التصديق والإتباع قطعاً. فإنا لو فرضنا رجلاً بلغ وعقل ولم يجرب ( المرض ) ، فمرض ، وله والد مشفق حاذق بالطب ، يسمع دعواه في معرفة الطب منذ عقل ، فعجن له والده دواء ، فقال: (( هذا يصلح لمرضك ويشفيك من سقمك. )) فماذا يقتضيه عقله ، إن كان الدواء مراً كريه المذاق ، أن يتناول؟ أوَ يَكذب ويقول: (( أنا [ لا ] أعقل مناسبة هذا الدواء لتحصيل الشفاء ، ولم أجربه! )) فلا شك أنك تستحمقه إن فعل ذلك! وكذلك يستحمقك أهل البصائر في توقفك! فإن قلت: (( فبَم أعرف شفقة النبي ﷺ ومعرفته بـهذا الطب؟ )) فأقول: (( وبم عرفت [ شفقة أبيك ] وليس ذلك أمراً محسوساً؟ بل عرفتها بقرائن أحواله وشواهد أعماله في مصادره وموارده علماً ضرورياً لا تتمارى فيه. )) ومن نظر في أقوال رسول الله ﷺ ، وما ورد من الأخبار في اهتمامه بإرشاد الخلق ، وتلطفه في جرّ الناس بأنواع الرفق واللطف ، إلى تحسين الأخلاق وإصلاح ذات البين ، وبالجملة إلى ما يصلح به دينهم ودنياهم ، حصل له علم ضروري ، بأن شفقته ﷺ على أمته أعظم من شفقة الوالد على ولده. وإذا نظر إلى عجائب ما ظهر عليه من الأفعال ، وإلى عجائب الغيب الذي أخبر عنه القرآن على لسأنه وفي الأخبار ، وإلى ما ذكره في آخر الزمان ، فظهر ذلك كما ذكره ، علم علماً ضرورياً أنه بلغ الطور الذي وراء العقل ، وانفتحت له العين التي ينكشف منها الغيب الذي لا يدركه إلا الخواص ، والأمور التي لا يدركها العقل. فهذا هو منهاج تحصيل العلم الضروري بتصديق النبي ﷺ . فجرب وتأمل القرآن وطالع الأخبار ، تعرف ذلك بالعيان. وهذا القدر يكفي في تنبيه المتفلسفة ، ذكرناه لشدة الحاجة إليه في هذا الزمان.
وأما السبب الرابع - وهو ضعف الإيمان بسبب سيرة العلماء- فيداوي هذا المرض بثلاثة أمور: أحدها: أن تقول: (( إن العالم الذي تزعم أنه يأكل الحرام ومعرفته بتحريم ذلك الحرام كمعرفتك بتحريم الخمر [ ولحم الخنـزير ] والربا ، بل بتحريم الغيبة والكذب والنميمة ، وأنت تعرف ذلك وتفعله ، لا لعدم إيمانك بأنه معصية ، بل لشهوتك الغالبة عليك ؛ فشهوته كشهوتك ، وقد غلبته كما غلبتك ، فعلمه بمسائل وراء هذا يتميز به عنك ، لا يناسب زيادة زجر عن هذا المحظور المعين. (( وكم من مؤمن بالطب لا يصبر عن الفاكهة وعن الماء البارد ، وإن زجره الطبيب عنه! ولا يدل ذلك على أنه غير ضار ، أو على ان الإيمان بالطب غير صحيح ، فهذا محمل هفوات العلماء. )) الثاني: أن يقال للعامي: (( ينبغي أن تعتقد أن العالم اتخذ علمه ذخراً لنفسه في الآخرة ، ويظن أن علمه ينجيه ، ويكون شفيعاً له حتى يتساهل معه في أعماله ، لفضيلة علمه. وإن جاز أن يكون زيادة حجة عليه ، فهو يجوز أن يكون زيادة درجة له ، وهو ممكن. فهو ، وإن ترك العمل ، يدلي بالعلم. وأما أنت أيها العامي! إذا نظرت إليه وتركت العمل وأنت عن العلم عاطل ، فتهلك بسوء عملك ولا شفيع لك! )) الثالث: وهو الحقيقة ، أن العالم الحقيقي ، لا يقارف معصية إلا على سبيل الهفوة ، ولا يكون مصراً على المعاصي أصلاً. إذ العلم الحقيقي ما يعرّف أن المعصية سمٌ مهلك ، وأن الآخرة خير من الدنيا. ومن عرَف ذلك ، لا يبيع الخير بما هو أدنى [ منه ]. وهذا العلم لا يحصل بأنواع العلوم التي يشتغل بـها أكثر الناس. فلذلك لا يزيدهم ذلك العلم إلا جرأة على معصية الله تعالى. وأما العلم الحقيقي ، فيزيد صاحبه خشية وخوفاً [ ورجاءً ] ، وذلك يحول بينه وبين المعاصي إلا الهفوات التي لا ينفك عنها البشر في الفترات ، وذلك لا يدل على ضعف الإيمان. فالمؤمن مفتنٌ توّابٌ ، وهو بعيدٌ عن الإصرار والإكباب.
* *
هذا ما أردت أن أذكره في ذم الفلسفة والتعليم وآفاتـهما وآفات من أنكر عليهما ، لا بطريقه. نسأل الله العظيم أن يجعلنا ممن آثره واجتباه ، وأرشده إلى الحق وهداه ، وألهمه ذكره حتى لا ينساه ، وعصمه عن شر نفسه حتى لم يؤثر عليه سواه ، واستخلصه لنفسه حتى لا يعبد إلا إياه.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبـه وسلم.
تم كتاب "المنقذ من الضلال والموصل إلى رب العزة والجلال" لحجة الإسلام الغزالي رضي الله عنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى المصطفين من عباده وإمائه.
=====
معيار العلم في فن المنطق
معيار العلم في فن المنطق
أبو حامد الغزالي
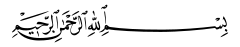
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما. اللهم أرنا الحق حقا ووفقنا إلى اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وأعنا على اجتنابه. آمين. اعلم وتحقق أيها المقصور على درك العلوم حرصه وإرادته الممدود نحو أسرار الحقائق العقلية همته، المصروف، عن زخارف الدنيا ونيل لذاتها الحقيرة سعيه وكده، الموقوف على درك السعادة بالعلم والعبادة جده وجهده، بعد حمد الله الذي يقدم على كل أمر ذي بال حمده، والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسوله وعبده. إن الباعث على تحرير هذا الكتاب الملقب بمعيار العلم غرضان مهمان: أحدهما تفهيم طرق الفكر والنظر، وتنوير مسالك الأقيسة والعبر؛ فإن العلوم النظرية لما لم تكن بالفطرة والغريزة مبذولة وموهوبة كانت لا محالة مستحصلة مطلوبة، وليس كل طالب يحسن الطلب، ويهتدي إلى طريق المطلب، ولا كل سالك يهتدي إلى الإستكمال، ويأمن الإغترار بالوقوف دون ذروة الكمال ولا كل ظان الوصول إلى شاكلة الصواب آمن من الإنخداع بلا مع السراب. فلما كثر في المعقولات مزلة الأقدام، ومثارات الضلال، ولم تنفك مرآة العقل عما يكدرها من تخليطات الأوهام وتلبيسات الخيال، رتبنا هذا الكتاب معيارا للنظر والإعتبار، وميزانا للبحث والإفتكار، وصيقلا للذهن، ومشحذا لقوة الفكر والعقل، فيكون بالنسبة إلى أدلة العقول كالعروض بالنسبة إلى الشعر،
والنحو بالإضافة إلى الإعراب. إذ كما لا يعرف منزحف الشعر عن موزونه إلا بميزان العروض ولا يميز صواب الإعراب عن خطئه إلا بمحك النحو، كذلك لا يفرق بين فاسد الدليل وقويمه وصحيحه وسقيمه إلا بهذا الكتاب. فكل نظر لا يتزن بهذا الميزان ولا يعيار بهذا المعيار فاعلم أنه فاسد العيار غير مأمون الغوائل والأغوار. والباعث الثاني الإطلاع على ما أودعناه كتاب تهافت الفلاسفة، فإنا ناظرناهم بلغتهم وخاطبناهم على حكم اصطلاحاتهم التي تواطأوا عليها في المنطق وفي هذا الكتاب تنكشف معاني تلك الإصطلاحات؛ فهذا اخص الباعثين والأول أعمهما وأهمهما. أما كونه أهم فلا يخفى عليك وجهه، وأما كونه أعم فمن حيث يشمل جدواه جميع العلوم النظرية: العقلية منها والفقهية، فإنا سنعرفك أن النظر في الفقهيات لا يباين النظر في العقليات، في ترتيبه وشروطه وعياره، بل في مآخذ المقدمات فقط. ولما كانت الهمم في عصرنا مائلة من العلوم إلى الفقه بل مقصورة عليه حتى حدانا ذلك إلى أن صنفنا في طرق المناظرة فيها مأخذ الخلاف أولا، ولباب النظر ثانيا، وتحصين المآخذ ثالثا، وكتاب المبادي والغايات رابعا، وهو الغاية القصوى في البحث الجاري على منهاج النظر العقلي في ترتيبه وشروطه، وأن فارقه في مقدماته
رغبنا ذلك أيضا في أن نورد في منهاج الكلام في هذا الكتاب أمثلة فقهية فتشمل فائدته وتعم سائر الأصناف جدواء وعائدته. ولعل الناظر بالعين العوراء نظر الطعن والإزراءِ، ينكر انحرافنا عن العادات في تفهيم العقليات القطعية، بالأمثلة الفقهية الظنية فليكف عن غلوائه في طعنه وإزرائه، وليشهد على نفسه بالجهل بصناعة التمثيل وفائدتها، فإنها لم توضع إلا لتفهيم الأمر الخفي بما هو الأعرف عند المخاطب المسترشد، ليقيس مجهوله إلى ما هو معلوم عنده فيستقر المجهول في نفسه. فإن كان الخطاب مع نجار لا يحسن إلا النجر وكيفية استعمال آلاته، وجب على مرشده ألا يضرب له المثل إلا من صناعة النجارة، ليكون ذلك أسبق إلى فهمه وأقرب إلى مناسبة عقله وكما لا يحسن إرشاد المتعلم إلا بلغته لا يحسن إيصال المعقول إلى فهمه إلا بأمثلة هي أثبت في معرفته؛ فقد عرفناك غاية هذا الكتاب وغرضه تعريفا مجملا فلنزد له شرحا وإيضاحا لشدة حاجة النظار إلى هذا الكتاب. لعلك تقول أيها المنخدع بما عندك من العلوم الذهنية المستهتر بما يسوق إليه البراهين العقلية، ما هذا التفخيم والتعظيم وأي حاجة بالعاقل إلى معيار وميزان، فالعقل هو القسطاس المستقيم والمعيار القويم، فلا يحتاج العاقل بعد كمال عقله إلى تسديد وتقويم، فلتتئد ولتتثبت فيما تستخف به من غوائل الطرق العقلية، ولتتحقق قبل كل شيء أن فيك
حاكما حسيا وحاكما وهميا وحاكما عقليا، والمصيب من هؤلاء الحكام هو الحاكم العقلي، والنفس في أول الفطرة أشد إذعانا وإنقيادا للقبول من الحاكم الحسي والوهمي، لأنهما سبقا في أول الفطرة إلى النفس وفاتحاها بالإحتكام عليها، فألفت احتكامهما وأنست بهما قبل أن أدركها الحاكم العقلي، فاشتد عليها الفطام عن مألوفها والإنقياد لما هو كالغريب من مناسبة جبلتها، فلا تزال تخالف حاكم العقل وتكذبه وتوافق حاكم الحس والوهم وتصدقهما إلى أن تضبط بالحيلة التي سنشرحها في الكتاب. وإن أردت أن تعرف مصداق ما تقوله في تخرص هذين الحاكمين واختلالهما، فانظر إلى حاكم الحس كيف يحكم إذا نظرت إلى الشمس عليها بأنها في عرض مجر، وفي الكواكب بأنها كالدانير المنثورة على بساط أزرق، وفي الظل الواقع على الأرض للأشخاص المنتصبة بأنه واقف بل على شكل الصبي في مبدأ نشئه بأنه واقف، وكيف عرف العقل ببراهين لم يقدر الحس على المنازعة فيها، إن قرص الشمس أكبر من كرة الأرض بأضعاف مضاعفة، وكذلك الكواكب، وكيف هدانا إلى أن الظل الذي نراه واقفا هو متحرك على الدوام لا يفتر، وأن طول الصبي في مدة النشء غير واقف بل هو في النمو على الدوام والإستمرار، ومترق إلى الزيادة ترقيا خفي التدريج يكل الحس عن دركه ويشهد العقل به.
وأغاليط الحس من هذا الجنس تكثر فلا تطمع في استقصائها، واقنع بهذه النبذة اليسيرة من أنبائه لتطلع به على أغوائه. وأما الحاكم الوهمي فلا تغفل عن تكذيبه بموجود لا إشارة إلى جهته. وأما الحاكم الوهمي فلا تغفل عن تكذيبه بموجود لا إشارة إلى جهته، وإنكاره شيئا لا يناسب أجسام العالم بانفصال واتصال، ولا يوصف بأنه داخل العالم ولا خارجه. ولولا كفاية العقل شر الوهم في تضليله هذا لرسخ في نفوس العلماء من الإعتقادات الفاسدة في خالق الأرض والسماءن مارسخ في قلوب العوام والأغبياء. ولا نفتقر إلى هذا الأبعاد في تمثيل تضليله وتخييله، فإنه يكذب فيما هو أقرب إلى المحسوسات مما ذكرناه، لأنك إن عرضت عليه جسما واحدا فيه حركة وطعم ولون ورائحة واقترحت عليه أن يصدق بوجود ذلك في محل واحد على سبيل الإجتماع، كاع عن قبوله وتخيل أن بعض ذلك مضام للبعض ومجاور له. وقدر التصاق كل واحد بالآخر في مثال ستر رقيق ينطبق على ستر آخر، ولم يمكن في جبلته أن يفهم تعدده المكان، فإن الوهم إنما يأخذ من الحس، والحس في غاية الأمر يدرك التعدد والتباين بتباين المكان أو الزمان؛ فإذا رفعا جميعا عسر عليه التصديق بأعداد متغايرة بالصفة والحقيقة حالة فيما هو في حيز واحد. فهذا وأمثاله من أغاليط الوهم يخرج عن حد الإحصاء والحصر، والله تعالى هوالمشكور على ما وهب من العقل الهادي من الضلالة، المنجي عن ظلمات الجهالة، المخلص بضياء البرهان، عن ظلمات وساوس الشيطان. فإن أردت مزيد إستظهار في الإحاطة بخيانة هذين الحاكمين، فدونك وإستقراء ما ورد في الشرع من نسبة هذه التمويهات إلى الشيطان وتسميتها وسواسا
وإحالتها عليه، وتسمية ضياء العقل هداية ونورا ونسبته إلى الله تعالى وملائكته في قوله (الله نُورُ السَمَواتِ وَالأَرض) ولما كان مظنة الوهم والخيال الماغ وهما منبعا الوسواس، قال أبو بكر رحمة الله عليه لمن كان يقيم الحد على بعض الجناة: اضرب الرأس فإن الشيطان في الرأس، ولما كانت الوساوس الخيالية والوهمية ملتصقة بالقوة المفكرة التصاقا يقل من يستقل بالخلاص منها حتى كان ذلك كامتزاج الدم بلحومنا وأعضائنا، قال صلى الله عليه وسلم: {إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم} وإذا لاحظت بعين العقل هذه الأسرار التي نبهتك عليها استيقنت شدة حاجتك إلى تدبير حيلة في الخلاص عن ضلال هذين الحاكمين. فإن قلت: فما الحيلة في الإحتياط مع ما وصفتمونه من شدة الرباط بهذه المغويات؛ فتأمل لطف حيل العقل فيه فإنه استدرج الحس والوهم إلى أمور يساعدانه على دركها من المشاهدات الموافقة للموهوم والمعقول، وأخذ منها مقدمات يساعده الوهم عليها ورتبها ترتيبا لا ينازع فيه، واستنتج منها بالضرورة نتيجة لم يسع الوهم التكذيب بها، إذ كانت مأخوذة من الأمور التي لا يتخلف الوهم والعقل عن القضاء بها، وهي العلوم التي لم يختلف فيها الناس من الضروريات والحسيات وأستسلمها من الحس والوهم وارتهنها منهما، فصدقا بأن النتيجة اللازمة منها صادقة حقيقة، ثم نقلها العقل بعينها على ترتيبها إلى ما ينازع الوهم فيه وأخرى منها نتائج. فلما كذب الوهم بها وامتنع عن قبولها هان على العقل مؤونته، فإن المقدمات التي وضعها كان الوهم يصدق بها على الترتيب الذي رتبه لانتاج النتيجة، فكأن الوهم قد سلم لزوم النتيجة منها فتحقق الناظر أن آباء الوهم عن قبول النتيجة بعد
التصديق بالمقدمات، والتصديق بصحة الترتيب المنتج لقصور في طباعه وجبلته عن درك هذه النتيجة، لا لكون هذه النتيجة كاذبة لأن ترتيب المقدمات منقول من موضع ساعد الوهم على التصديق بها، فإذن غرضنا في هذا الكتاب أن نأخذ من المحسوسات والضروريات الجبلية معيارا للنظر، حتى إذا نقلناه إلى الغوامض لم نشك في صدق ما يلزم منها. ولعلك الآن تقول: فإن تم للنظار ما ذكرتموه فلم اختلفوا في المعقولات، وهلا اتفقوا عليها اتفاقهم على النظريات الهندسية والحسابية التي يساعد الوهم العقل فيها؟ فجوابك من وجهين: أحدهما أن ما ذكرناه أحد مثارات الضلال لا كلها، ووراء ذلك في النظر في العقليات عقبات مخطرة يعز في العقلاء من يتخطاها فيسلم منها. وإذا أحطت بمجامع شروط البرهان المنتج لليقين، لم تستبعد أن تقصر قوة أكثر البشر عن درك حقائق المعقولات الخفية. الثاني: ان القضايا الوهمية لما انقسمت إل ما يصدق وإلى ما يكذب وكانت الكاذبة منها شديدة الشبه بالصادقة، اعترض فيها قضايا إعتاض على النفس تمييزها عن الكاذبة، ولم يقو عليها إلا من أيده الله بتوفيقه وأكرمه بسلوك منهاج الحق بطريقه، فانقسمت العقليات إلى ما هان دركها على الأكثر، وإلى ما استعصى على عقول الجماهير إلا على الشذاذ من أولياء الله تعالى المؤيدين بنور الحق الذين لا تسمح الإعصار الطويلة بوجود الآحاد منهم، فضلا عن العدد الكثير الجم.
ولعلك الآن تحسب نفسك واحدا من غمار الناس فتتلو على نفسك سورة اليأس، وتزعم أني متى أكون واحد الدهر، فريد العصر، مؤيدا بنور الحق متخلصا عن نزغات الشيطان مستوليا على وصفته من شروط البرهان؛ فالركون إلى الدعة أولى بي والقناعة بالإعتقاد الموروث من الآباء أسلم لي من أن أركب متن الخطر ولست أثق بنيل قاصية الوطر، فيقال في مثالك، إن خطر هذا ببالك: ما أنت إلا كإنسان لاحظ رتبة سلطان الزمان وما ساعده من الشوكة والعدة والنجدة والثروة والأشياع والأتباع، والأمر المتبع المطاع، واستبعد أن ينال رتبته أو يقارب درجته، والأمر المتبع المطاع، واستبعد أن ينال رتبته أو يقارب درجته، ولكن اقتدر أن ينال رتبة الوزارة أو رتبة الرئاسة أو منزلة أخرى دونها فقال: الصواب لي بعد العجز عن الغاية القصوى، والذروة العليا التي هي درجة سلطان الدنيا أن أقنع بصناعة الكنس التي هي صناعة آبائي، فالكناس ليس يعجز عن خبز يتناوله وثوب يستره إقتداء بقول الشاعر: دع المكارم لا ترحل لبغيتها ... واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي وهذا الخسيس القاصر النظر، لو أنعم الفكر وتأمل واعتبر علم أن بين درجة الكناس والسلطان منازل فلا كل من يعجز عن الدرجات العلي ينبغي أن يقنع بالدركات السفلى، بل إذا انتهض مترقيا عن رتبة الخساسة، فما يترقى إليه بالإضافة إلى ما يترقى عنه رياسة - فهكذا ينبغي أن تعتقد درجات السعادة بين العلماء، فما منا إلا له مقام معلوم لا يتعداه، وطور محدود لا يتخطاه، ولكن ينبغي أن يشوف إلى أقصى
مرقاه، وأن يخرج من القوة إلى الفعل كل ما تحتمله قواه. فإن قلت: إني فهمت الآن شدة الحاجة إلى هذا الكتاب بما أوضحته من التحقيق، ثم اشتدت رغبتي بما أوردته من التشويق، واتضح لي غايته وثمرته فأوضح لي مضمونه. فاعلم أن مضمونه تعليم كيفية الإنتقال من الصور الحاصلة في ذهنك إلى الأمور الغائبة عنك. فإن هذا الإنتقال له هيئة وترتيب إذا روعيت أفضت إلى المطلوب، وإن أهملت قصرت عن المطلوب، والصواب من هيئته وترتيبه شديد الشبه بما ليس بصواب. فمضمون هذا العلم على سبيل الإجمال هذا، وأما على سبيل التفصيل فهو أن المطلوب هو العلم، والعلم ينقسم إلى العلم بذوات الأشياء، كعلمك بالإنسان والشجر والسماء وغير ذلك. ويسمى هذا العلم تصورا، وغلى العلم بنسبة هذه الذوات المتصورة بعضها إلى بعض إما بالسلب أو بالإيجاب، كقولك الإنسان حيوان والإنسان ليس بحجر، فإنك تفهم الإنسان والحجر فهما تصوريا لذاتهما، ثم تحكم بأن أحدهما مسلوب عن الآخر أو ثابت له، ويسمى هذا تصديقا لأنه يتطرق إليه التصديق والتكذيب.
فالبحث النظري بالطالب إما أن يتجه إلى تصو أو إلى تصديق، والموصل إلى التصور يسمى قولا شارحا فمنه حد ومنه رسم، والموصل إلى التصديق يسمى حجة فمنه قياس ومنه استقراء وغيره. ومضمون هذا الكتاب تعريف مبادىء القول الشارح لما أريد تصوره حدا كان أو رسما، وتعريف مبادىء الحجة الموصلة إلى التصديق قياسا كانت أوغيره مع لا تنبيه على شروط صحتها ومثار الغلط فيهما. فإن قلت: كيف يجهل الإنسان العلم التصوري حتى يفتقر إلى الحد؟ قلنا بأن يسمع الإنسان إسما لا يفهم معناه كمن قال: ما الخلاء وما الملاء وما الملك وما الشيطان وما العقار؟ فتقول: العقار هو الخمر، فإن لم يفهمه باسمه المعروف أفهمه بحده. وقيل: إن الخمر شراب معتصر من العنب مسكر، فيحصل له علم تصوري بذات الخمر. وأما العلم التصديقي فبأن يجهل الإنسان مثلا أن للعالم صانعا، فيقول: هل للعالم صانع؟ فتقول: نعم للعالم صانع. وتعرفه صدق ذلك بالحجة والبرهان على ما سنوضحه، فهذا مضمون الكتاب.
وإن أردت أن تعلم فهرست الأبواب. فاعلم أنا قسمنا القول في مدارك العلوم إلى كتب أربعة: كتاب مقدمات القياس، وكتاب القياس، وكتاب الحد، وكتاب أقسام الوجود وأحكامه.
الكتاب الأول في مقدمات القياس، ولنذكر مقدمة يعرف بها وجه إنقسام النظر في القياس إلى أدنى وإلى أقصى فنقول: المطلب الأقصى في هذا القسم هو البرهان المحصل للعلم اليقيني والبرهان نوع من القياس إذ القياس إسم عام، والبرهان إسم خاص لنوع منه، والقياس لا ينتظم إلا بمقدمتين، وكل مقمدة لا تنتظم إلا بمخبر عنه يسمى موضوعا وخبر يسمى محمولا، وكل موضوع أو محمول يذكر في قضية فهو لفظ نيدل لا محالة على معنى، فالقياس مركب، وكل ناظر في شيء مركب، فطريقه أن يحلل المركب إلى المفردات ويبتدىء بالنظر في الآحاد، ثم في المركب، فلزم من النظر في القياس النظر فيما ينحل إليه القياس من المقدماتنومن النظر في المقدمات النظر في المحمولن والموضوع اللذين منهما تتألف المقدمات، ومن النظر في المحمول والموضوع النظر في الألفاظ والمعاني المفردة التي بها يتم المحمول والموضوع،
ولزم من النظر في المقدمات النظر في شروطها؛ فإن كل مركب من مادة وصورة يجب النظر في مادته وصورته. وما هذا إلا كمن يريد بناء بيت فحقه أن يهتم بإفراز المواد التي منها يتركب كاللبن والطين والخشب، ثم يشتغل بالتنصوير وكيفية التنضيد والتركيب؛ فكذلك النظر في القياس، فهذا بيان الحاجة إلى هذه الأقسام، ولنأخذ بعده في المقصود.
الفن الأول: من كتاب مقدمات في دلالة الألفاظ وبيان وجوه دلالتهاونسبتها إلى المعاني وبيانه بسبعة تقسيمات: القسمة الأولى: أن نقول: الألفاظ تدل على المعاني من ثلاثة أوجه متباينة: الوجه الأول الدلالة من حيث المطابقة كالإسم الموضوع بإزاء الشي، وذلك كدلالة لفظ الحائط على الحائط. والآخر أن تكون بطريق التضمن وذلك كدلالة لفظ البيت على الحائط ودلالة لفظ الإنسان على الحيوان، وكذلك دلالة كل وصف أخص على الوصف الأعم الجوهري. الثالث: الدلالة بطريق الإلتزام والإستتباع كدلالة لفظ السقف على الحائط؛ فإنه مستتبع له إستتباع الرفيق اللازم الخارج عن ذاته، ودلالة الإنسان على قابل صنعة الخياطة وتعلمها، والمعتبر في التعريفات دلالة المطابقة والتضمن. فأما دلالة الإلتزام فلا لأنها ما وضعها واضع اللغة بخلافهما، لأن المدلول فيها غير محدود ولا محصور، إذ لوازم الأشياء ولوازم لوازمها لا تنضبط ولا تنحصر فيؤدي إلى أن يكون اللفظ دليلا على مالا يتناهى من المعاني وهو محال.
القسمة الثانية: للفظ بالنسبة إلى عموم المعنى وخصوصه، واللفظ ينقسم إلى جزئي وكلي، والجزئي ما يمنع نفس تصور معناه عن وقوع الشركة في مفهومه، كقولك زيد وهذا الشجر وهذا الفرس، فإن المتصور من لفظ زيد شخص معين لا يشاركه غيره في كونه مفهوما من لفظ زيد. والكلي هو الذي لا يمنع نفس تصور معناه عن وقوع الشركة فيه، فإن امتنع امتنع بسبب خارج عن نفس مفهومه ومقتضى لفظه، كقولك الإنسان والفرس والشجر وهي أسماء الأجناس والأنواع والمعاني الكلية العامة، وهو جار في لغة العرب في كل إسم أدخل عليه الألف واللام لا في معرض الحوالة على معلوم معين سابق، كالرجل فهو إسم جنس، فإنك قد تطلق وتريد به رجلا معينا عرفه المخاطب من قبل، فتقول: أقبل الرجل فتكون الألف واللام فيه للتعريف أي الرجل الذي جاءني من قبل. فإذا لم تكن مثل هذه القرينة، كان إسم الرجل إسما كليا يشترك في الإندراج تحته كل شخص من أشخاص الرجال.
فإن قلت: فإذا قلنا الشكل الكروي المحيط بإثني عشر برجا فذلك، ولم يكن في الوجود شكل بهذه الصفة غلا واحد فكيف يكون الإسم كليا والمسمى واحد، وقد دخل الألف واللام المقتضى لإستغراق الجن عليه؟ فيقال لك: إن هذا كلي لأنا لسنا نشترط أن يكون الداخل تحته موجودا بالفعل، بل يجوز أن يكون موجودا بالقوة والإمكان، ولو قدر وجوده لكان داخلا فيه لا محالة، وهو قبل الوجود داخل لا كإسم زيد فإنه يمتنع وقوع الشركة فيه بالفعل والقوة جميعا. فإن قلت: فإذا قلنا الإله الحق هكذا فكيف يكون هذا كليا ويمنع وقوع الشركة فيه بالفعل والقوة جميعا، وكذلك قولنا: الشمس على أصل من لا يجوز وجود شمس أخرى فإنه يتعين الداخل تحته تعين شخص زيد في التصور من لفظ زيد؟ فيقال لك: اللفظ كلي وإمتناع وقوع الشركة فيه ليس لنفس مفهوم اللفظ وموضوعه بل لمعنى خارج عنه، وهو إستحالة وجود إلهين للعالم، ولم نشترط في كون اللفظ كليا إلا أن لا يمنع من وقوع الشركة فيه نفس مفهوم اللفظ وموضوعه، فقد حصل لك من السؤالين وجوابهما أن الكلي ثلاثة أقسام: قسم توجد فيه الشركة بالفعل كقولنا الإنسان إذا كانت الأشخاص منه موجودة، وقسم توجد الشركة فيه بالقوة كقولنا الإنسان إذا اتفق إن لم يبق في الوجود إلا شخص واحد، والكرة المحيطة بإثني عشر برجا إذ ليس في الوجود غلا واحد، وقسم لا شركة فيه لا بالفعل ولا بالقوة كالإله، وهو مع ذلك كلي لأن المنع ليس هو من موضوع لالفظ ومحموله بخلاف لفظ زيد.
فائدة فقهية قد اختلف الأصوليون في أن الإسم المفرد إذا اتصل به الألف واللام هل يقتضي الإستغراق، وهل ينزل منزلة العموم كقول القائل الدينار أفضل من الدرهم والرجل خير من المرأة، فظن الظانون أنه من حيث كونه اسما فردا لا يقتضي الإستغراق لمجرده، ولكن فهم العموم بقرينة التسعير وقرينة التفضيل للذكر على الأنثى، إنما هو لعلمنا بنقصان الدرهمية عن الدينارية ونقصان الأنوثة عن الذكورة. وأنت إذا تأملت ما ذكرناه في تحقيق معنى الكلي، فهمت زلل هؤلاء بجهلهم أن اللفظ الكي يقتضي الإستغراق بمجرده ولا يحتاج إلى قرينة زائدة فيه. فإن قلت: ومن أين وقع لهم هذا الغلط؟ فستفهم ذلك من القسمة الثالثة. القسمة الثالثة في بيان رتبة الألفاظ من مراتب الوجود إعلم أن المراتب فيما نقصده أربعة واللفظ في الرتبة الثالثة، فإن للشيء وجودا في الأعيان ثم في الأذهان، ثم في الألفاظ ثم في الكتابة. فالكتابة دالة على اللفظ واللفظ دال على المعنى الذي في النفس، والذي في النفس هو مثال الموجود في الأعيان،
فما لم يكن للشيء ثبوت في نفسه لم يرتسم في النفس مثاله. ومهما ارتسم في النفس مثاله فهو العلم به، إذ لا معنى للعلم إلا مثال يحصل في النفس مطابق لما هو مثال له في الحس وهو المعلوم، وما لم يظهر هذا الأثر في النفس لا ينتظم لفظ يدل به على ذلك الأثر، وما لم ينتظم اللفظ الذي ترتب فيه الأصوات والحروف لا ترتسم كتابة للدلالة عليه. والوجود في الأعيان دالتان بالوضع والإصطلاح. وعند هذا نقول: من زعم أن الإسم المفرد لا يقتضي الإستغراق ظن انه موضوع بإزاء الموجود في الأعيان فإنها أشخاص معينة إذ الدينار الموجود شخص معين، فإن جمعت أشخاص سميت دنانير، ولم يعرف أن الدينار الشخصي المعين يرتسم منهفي النفس أثر هو مثاله وعلم به وتصور له، وذلك المثال يطابق ذلك الشخص وسائر اشخاص الدنانير الموجودة والممكن وجوها، فتكون الصورة الثابتة في النفس من حيث مطابقتها لكل دينار يفرض صورة كلية لا شخصية؛
فإن اعتقدت أن إسم الدينار دليل على الأثر في النفس لا على المؤثر وذلك الأثر كلي، كان الإسم كليا لا محالة، وما قدمناه من الترتيب يعرفك أن الألفاظ لها دلالات على في النفوس، وما في النفوس مثال لما في الأعيان وسيأتي مزيد للعاني الكلية المرتسمة في النفوس بسبب مشاهدة الأشخاص الجزئية في كتاب أحكام الوجود ولواحقه. القسمة الرابعة للفظ قسمته من حيث إفراده وتركيبه اعلم أن اللفظ ينقسم إلى مفرد ومركب، والمركب ينقسم إلى مركب ناقص وغلى مركب تام، فهي ثلاثة أقسام: الأول هو المفرد وهو الذي لا يراد بالجزء منه دلالة على شيء أصلا حين هو جزؤه كقولك عيسى وإنسان، فإن جزئي عيسى وهما " عي وسا " وجزئي إنسان وهما " إن وسان " مايراد بشيء منهما الدلالة على شيء أصلا. فإن قلت: فما قولك في عبد الملك؟ فاعلم أنه أيضا مفرد إذا جعلته إسما علما كقولك زيد، وعند ذلك لا تريد بعبد دلالة على معنى ولا بالملك دلالة على معنى. فكل منهما من حيث هو جزؤه لا يدل على شيء فيكونان كأجزاء
إسم زيد وهما إسمان في الصورة جعلا إسما واحدا كبعلبك ومعد يكرب، فإن اتفق أن يكون المسمة به عبدا للملك تحقيقا فيكون هذا الإسم مطلقا عليه من وجهين: احدهما في تعريف ذاته فيكون الإسم مطلقا عليه من وجهين: أحدهما في تعريف ذاته فيكون الإسم مفرادا، والآخر في تعيف صفته في عبودية الملك فيكون قولك عبد الملك وصفا له فيكون مركبا لا مفردا، فافهم هذه الدقائق فإن مثار الأغاليط في النظريات تنشأ من إهمالها. والمركب التام هو الذي كل لفظ منه يدل على معنى والمجموع بدل دلالة تامة بحيث يصح السكوت عليه، فيكون من إسمين ويكون من إسم وفعل. والمنطقي يسمى الفعل كلمة والمركب الناقص بخلافه. فقولك: زيد يمشي والناطق حيوان؛ مركب تام، وقولك: في الدار أو انسان؛ مركب ناقص لأنه مركب من إسم وأداة لا من إسمين ولامن إسم وفعل، فإن مجرد قولك " زيد في " أو " زيد لا " لا يدل على المعنى الذي يراد الدلالة عليه في المحاورة ما لم يقل زيد في الدار أو زيد لا يظلم، فإنه بذلك الإقتران والتتميم يدل دلالة تامة بحيث يصح السكوت عليه.
القسمة الخامسة للفظ المفرد في نفسه اللفظ إما إسم أو فعل أو حرف. ولنذكر حدّ كل واحد على شرط المنطقيين لتنكشف أقسامه، فنقول: الإسم صوت دال بتواطؤ مجرد عن الزمان والجزء من أجزائه لا يدل على إنفراده ويدل على معنى محصل، ولما كان الحد، مكربا من الجنس والفصول وتذكر الفصول للاحترازات، كان قولنا صوت جنسا، وقولنا دال فصلا يفصله عن العطاس والنحنحنة والسعال وأمثالها، وقولنا بتواطؤ يفصله عن نباح الكلبح فإنه صوت دال على ورود وارد لكن لا بتواطؤ، وقولنا مجرد عن الزمان نحو قولنا يقوم وقام وسيقوم، فإن كل واحد صوت دال بتواطؤ، وقولنا الجزء من أجزائه لا يدل على إنفراده احترازا عن المركب التام كقولنا زيد حيوان، فإن هذا يسمى خبرا وقولا لا إسما، وقولنا يدل على معنى محصل احترازا عن الأسماء التي ليست محصلة كقولنا لا إنسان، فإنه محصل احترازا عن الأسماء التي ليست محصلة كقولنا لا إنسان، فإنه لا يسمى إسما مع وجود جميع أجزاء الحد فيه سوى هذا الإحتراز. فإن قولنا لا إنسان قد يدل على الحجر والسماء والبقر، وبالجملة على كل شيء ليس بإنسان
فليس له معنى محصل، إنما هو دليل على نفي الإنسان لا على إثبات شيء. وأما الفعل وهو الكلمة فإنه صوت دال بتواطؤ على الوجه الذي ذكرناه في الإسم، إنما يباينه في أنه يدل على معنى وقوعه في زمان كقولنا قام ويقوم، وليس يكفي في كونه فعلا أن يدل على الزمان فحسب؛ فإن قولنا أمس واليوم وغدا وعام أول ومضرب الناقة ومقدم الحاج يدل على الزمان، وليس بفعل، حيث أن الفعل يدل على معنى وزمان يقع فيه المعنى فيكون الفعل أبدا دليلا على معنى محمول على غيره، فإذن الفرق بين الإسم والفعل تضمن معنى الزمان فقط. وأما الحرف وهو الأداة فهو كل ما يدل على معنى لا يمكن أن يفهم بنفسه ما لم يقدر اقتران غيره به، مثل من وعلى وما أشبه ذلك. وقد أوجز هذه الحدود فقيل في الإسم: إنه لفظ مفرد يدل على معنى من غير أن يدل على زمان وجود ذلك المعنى من الأزمنة الثلاثة، ثم منه ما هو محصل كزيد ومنه ما هو غير محصل، كما إذا اقترن به حرف سلب فقيل لا إنسان. والكلمة هي لفظة مفردة تدل على معنى وعلى الزمان الذي ذلك المعنى موجود فيه لموضوع ما غير معين، والحرف أو الأداة ما لا يدل على معنى باقترانه بغيره.
القسم السادسة في نسبة الألفاظ إلى المعاني إعلم أن الألفاظ من المعاني على أربعة منازل: المشتركة والمتواطئة والمترادفة والمتزايلة. أما المشتركة فهي اللفظ الواحد الذي يطلق على موجودات مختلفة بالحد والحقيقة إطلاقا متساويا كالعين تطلق على العين الباصرة، وينبوع الماء وقرص الشمس وهذه مختلفة الحدود والحقائق. وأما المتواطئة فهي التي تدل على أعيان متعددة بمعنى واحد مشترك بينها، كدلالة إسم الإنسان على زيد وعمرو، ودلالة إسم الحيوان على الإنسان والفرس والطير لأنها متشاركة في معنى الحيوانية والإسم بإزاء ذلك المعنى المشترك المتواطىء، بخلاف العين الباصرة وينبوع الماء. وأما المترادفة: فهي الأسماء المختلفة الدالة على معنى يندرج تحت حد واحد كالخمر والراح والعقار؛ فإن المسمة بهذه يجمعه حد واحد وهو المائع المسكر المعتصر من العنب والأسامي مترادفة عليه. وأما المتزايلة: فهي الأسماء المتباينة التي ليس بينها شيء من هذه النسب كالفرس والذهب والثياب؛ فإنها ألفاظ مختلفة تدل على معان مختلفة بالحد والحقيقة، والمشترك ينبغي أن يجتنب إستعامله في المخاطبات فضلا عن البراهين، وأما المتواطئة فتستعلم في الجميع لا سيما البراهين.
إرشاد إلى مزلة قدم في الفرق بين المشتركة والمتواطئة والتباس إحداهما بالأخرى فإن المشتركة في الإسم هي المختلفان في المعنى المتفقان في الإسم، حيث لا يكونبينهما إتفاق وتشابه في المعنى البتة، وتقابلها المتواطئة وهي المشتركان في الحد والرسم المتساويان فيه بحيث لا يكون الإسم لأحدهما بمعنى إلا وهو للآخر بذلك المعنى، فلا يتفاوتان بالأولى والأحرى والتقدم والتأخر والشدة والضعف كإسم الإنسان لزيد وعمرو، وإسم الحيوان للفرس والثور؛ وربما يدل إسم واحد على شيئين بمعنى واحد في نفسه، ولكن يختلف ذلك المعنى بينهما من جهة أخرى ولنسميه إسما مشككا، وقد لا يكون المعنى واحدا ولكن يكون بينهما مشابهة ولنسمه متشابها. أما الأول فالكالوجود للموجودات؛ فإنه معنى واحد في الحقيقة ولكن يختلف بالإضافة إلى المسميات، فإنه للجوهر قبل ما هو للعرض ولبعض الأعراض قبله لبعض آخر، فهذا بالتقدم والتأخر. وأما المقول بالأولى والأحرى فالكالوجود أيضا فإنه لبعض الأشياء من ذاته ولبعضها من غره، وما له الوجود من ذاته أولى وأحرى بالإسم، واما المقول بالشدة والضعف فيتصور فيما يقبل الشدة والضعف كالبياض للعاج والثلج، فإنه لا يقال عليهما بالتواطؤ المطلق المتساوي بل أحدهما أشد فيه من الآخر.
أما الحيوان لزيد وعمرو، والفرس والثور فلا يتطرق إليه شيء من هذا التفاوت بحال، فقد ظهر بهذا الفرق انه قسم آخر، والمشكك قد يكون مطلقا كما سبق، وقد يكون بحسب النسبة إلى مبدأ واحد كقولنا طبي للكتاب والمبضع والدواء، أو لانتسابه إلى غاية واحدة كقولنا صحي للدواء والرياضة والفصد. وقد يكون إلى مبدأ وغاية واحدة كقولنا لجميع الأشياء أنها الإلهية. وأما الذي لا يجمعهما معنى واحد، ولكن بينهما تشابه ما كالإنسان على صورة متشكلة من الطين بصورة الإنسان وعلى الإنسان الحقيقي، فليس هذا بالتواطؤ إذ يخلفان بالحد فحد هذا حيوان ناطق مائت، وحد ذلك شكل صناعي يحاكي به صورة حيوان ناطق مائت؛ وكذلك القائمة للحيوان وللسرير حده في أحدهما أنه عضو طبيعي يقوم عليه الحيوان ويمشي به، وفي الآخر أنه جسم صناعي مسدير في أسفل السرير ليقله ولكن نجد بينهما شبها في شكل أو حال. ومثل هذا الإسم يكون موضوعا في أحدهما وضعا متقدما ويكون منقولا إلى الآخر، فإن أضيف إليهما سمي متشابه الإسم، وإن أضيف إلى المتقدم منهما سمي موضوعا، وإن أضيف إلى الأخير سمي منقولا؛ ثم هذا الضرب من التشابه على ثلاثة أقسام: الأول أن يكون في صفة قارة ذاتية كصورة الإنسان. والثاني أن يكون في صفة إضافية غير ذاتية كإسم المبدأ لطرف الخط والعلة.
والثالث أن يكون التشابه جاريا في أمر بعيد كالكلب لنجم مخصوص ولحيوان، إذ لا تشابه بينهما إلا في أمر بعيد مستعار لأن النجم رئي كالتابع للصورة التي كالإنسان، ثم وجد الكلب أتبع الحيوانات للإنسان فسمي باسمه. ومثل هذا ينبغي أن يلحق بالمشترك المحض، فإنه لا عبرة بمثل هذا الإشتباه فقد صارت الأسامي بهذه القسمة ستة: متباينة، ومترادفة، ومتواطئة، ومشتركة، ومشككة، ومتشابهة؛ لأن العقل إذا قسم الشيء إلى ستة أقسام فيحتاج إلى ست عبارات في التفهيم. إرشاد إلى مزلة قدم المتباينات ولا يخفى أن الموضوعات إذ تباينت مع تباين الحدود فالأسامي متباينة متزايلة كالفرس والحجر، ولكن قد يتحد الموضوع ويتعدد الإسم بحسب اختلاف إعتبارات، فيظن أنها مترادفة ولا تكون كذلك؛ فمن ذلك أن يكون أحد الإسمين له من حيث موضوعه، والآخر من حيث له وصفن كقولنا سيف وصارم؛ فإن الصارم دل على موضوع موصوف بصفة الحدة بخلاف السيف، ومن ذلك أن يدل كل واحد على وصف للموضوع الواحد كالصارم والمهند، فإن
أحدهما يدل على حدته والآخر على نسبته، ومن ذلك أن يكون أحدهما بسبب وصف، والآخر بسبب وصف الوصف كالناطق والفصيح. ومن المتباينة المشتق والمنسوب مع المشتق منه والمنسوب إليه كالنحو والنحوي، والحديد والحداد، والمال والمتمول، والعدل والعادل، فإن العادل لو سمي عدلا كما سميت العدالة عدلا كان ذلك من قبيل ما يقال باشتباه افسم، ولكن غيرت الصيغة وبقيت المادة والمعنى الأول زيد فيه ما دل على زيادة المعنى فسمي مشتقا. القسمة السابعة للف المطلق بالإشتراك على مختلفات إعلم أن اللفظ المطلق على معان مختلفة ثلاثة أقسام: مستعارة ومنقولة ومخصوصة باسم باسم المشترك. أما المستعارة فهي أن يكون إسم دالا على ذات الشيء بالوضع ودائما من أول الوضع إلى الآن، ولكن يلقب به في بعض الأحوال لا على الدوام شيء آخر لمناسبته للأول على وجه من وجوه المناسبات، من غير أن يجعل ذاتيا للثاني وثابتا عليه ومنقولا إليه
كلفظ الأم، فإنه موضوع للوالدة ويستعار للأرض يقال إنها أم البشر، بل ينقل إلى العناصر الأربعة فتسمى أمهات على معنى أنها أصول. والأم أيضا أصل للولد فهذه المعاني التي استعير لها لفظ الأم لها أسماء خاصة بها. وإنما تسمى بهذه الأسامي في بعض الأحوال على طريق الإستعارة، وخصص باسم المستعار لأن العارية لاتدوم وهذا أيضا يستعار في بعض الأحوال. وأما المنقول فهو أن ينقل الإسم عن موضوعه إلى معنى آخر ويجعل إسما له ثابتا دائما، ويستعمل أيضا في الأول فيصير مشتركا بينهما كإسم الصلاة والحج ولفظ الكافر والفاسق، وهذا يفارق المستعار بأنه صار ثابتا في المنقول إليه دائما ويفارق المخصوص باسم المشترك بأن المشترك هو الذي وضع بالوضع الأول مشتركا للمعنيين لا على أنه استحقه أحد المسميين، ثم نقل عنه إلى غيره إذ ليس لشيء من ينبوع الماء والدينار وقرص الشمس والعضو الباصر سبق إلى استحقاق إسم العين، بل وضع للكل وضعا متساويا بخلاف المستعار والمنقول. والمستعار ينبغي أن يجتنب في البراهين دون المواعظ والخطابيات والشعر، بل هي أبلغ باستعماله فيها. وأما المنقول فيستعمل في العلوم كلها لمسيس الحاجة إليها إذ واضع اللغة لما لم يتحقق عنده جميع المعاني لم يفردها بالأسامي، فاضطر غيره إلى النقل. فالجوهر وضعه واضع اللغة لحجر يعرفه الصيرفي والمتكلم نقله إلى معنى حصله في نفسه، وهو أحد أقسام الموجودات وهذا مما يكثر إستعماله في العلوم والصناعات. وأما المشتركة فلا يؤتى بها في البراهين خاصة ولا في الخطابيات إلا إذا كانت معها قرينة،
وهي أيضا أقسام: فمنها ما يقع في أحوال الصيغة كالإسم الذي يتحد فيه بناء الفاعل والمفعول نحو المختار فإنك تقول زيد مختار والعلم مختار، وأحدهما بمعنى الفاعل، والآخر بمعنى المفعول وكالمضطر وأشباهه. ومنها ما يقع على عدة أمور متشابهو في الظاهر مختلفة في الحقيقة لا يكاد يوقف على وجه مخالفتها كالحي الذي يطلق على الله وعلى الإنسان وعلى النبات والنور الذي يطلق على المدرك بالبصر المضاد للظلام، وعلى العقل الهادي إلى غوامض الأمور. فإن قال قائل: فما مثال المستعار؟ قلنا: مثاله استعارة أطراف الحيوان لغير الحيوان كقولهم: رأس المال، وجه النهار، عين الماء، حاجب الشمس، أنف الجبل، ريق المزن، يد الدهر، جناح الطريق، كبد السماء، وكقولهم: بيه سمع الأرض وبصرها، وكقولهم: أيد للشر ناجذيه، ودارت رحى الحرب، وشابت مفارق الجبال، وكقولهم: الشيب عنوان الموت، والرشوة رشا الحاجة، العيال سوس المال، الوحدة قبر الحي، الإرجاف زند الفتنة، الشمس قطيفة مباحة للمساحين. ومن إستعارات القرآن: (وَأَنّهُ في أُم الكِتابِ لِتُنذِرَ بِهِ أُمَّ القُرى وَمَن حَولَها) (وَاخفِض لَهُمَا جُناحَ الذُلِّ مِنَ الرَحمَة) (وَالصُبحِ إِذا تَنَفَس)) (فَأذاقَها الله لِباسَ الجُوعِ وَالخَوفِ) (كُلَّما أَوقَدوا نَاراً لِلحَربِ أَطفَأَها الله) (أَحاطَ بِهِم سُرادِقُها) (فَما بَكَت عَلَيهِمُ السماء والأرض) (واشتعل الرأس شيبا) (فصب عليهم ربك سوط عذاب) (ولما سكت عن موسى الغضب) ونظائره مما يكثر، وهذه الإستعارات بنوع مناسبة بين المستعار والمستعار منه،
فإن قيل: فما معنى المجاز؟ قلنا قد يراد به المستعار فالمعنى أنه قد تجوز عن وضعه، وقد يراد به ما يقتضي الحقيقة، وفي الإطلاق خلافه كقوله: (وأسأل القرية) إذ المسؤول بالحقيقة أهل القرية لا نفس القرية؛ فهذه أمور لفظية من أهملها ولم يحكمها في مبدأ نظره كثر غلطه ولم يدر من أين أتى.
الفن الثاني في مفردات المعاني الموجودة ونسبة بعضها إلى بعض والفرق بين هذا الفن والذي قبله أن الأول نظر في اللفظ من حيث يدل على المعاني - وهذا نظر في المعنى من حيث هو ثابت في نفسه، وإن كان يدل عليه باللفظ إذ لا يمكن تعريف المعاني إلا بذكر الألفاظ. ويتضح الغرض من هذا الفن بأنواع من القسمة. القسمة الأولى في نسبة الموجودات إلى مدراكنا فليعلم أن نظرنا في حصر الموجودات وحقائقها وهي منقسمة إلى محسوسة وإلى معلومة بالإستدلال لا تباشر ذاته بشيء من لاحواس، فالمحسوسات هي المدركات بالحواس لخمس كالألوان، ويتبعها معرفة الشكال والمقادير وذلك بحاسة البصر، وكالأصوات بالسمع، وكالطعوم
بالذوق، والروائح بالشم، والخشونة والملاسة، واللين والصلابة، والبرودة والحرارة، والرطوبة واليبوسة بحاسة اللمس، فهذه الأمور ولواحقها تباشر بالحس أي تتعلق بها القوة المدركة من الحواس في ذاتها. ومنها ما يعلم وجوده ويستدل عليه بآثاره ولا تدركه الحواس الخمس: السمع والبصر والشم والذوق واللمس، ولا تناله. ومثاله هذه الحواس نفسها فإن معنى أي واحدة منها هي القوة المدركة، والقوة المدركة لا تحس بحاسة من الحواس، ولا يدركها الخيال أيضا. وكذلك القدرة والعلم والإردادة بل الخوف والخجل والعشق والغضب، وسائر هذه الصفات نعرفها من غيرنا معرفة يقينية بنوع من الإستدلال لا بتعلق شيء من حواسنا بها. فمن كتب بين أيدينا عرفنا قطعا قدرته وعلمه بنوع من الكتابة وإرادته إستدلالا بفعله، ويقيننا الحاصل بوجود هذه المعاني كيقيننا الحاصل بحركات يده المحسوسة وانتظام سواد الحروف على البياض، إن كان هذا مبصرا وتلك المعاني غير مبصرة بل أكثر الموجودات معلوم بالإستدلال عليها بآثارها ولا تحس، فلا ينبغي أن يعظم عندك الإحساس وتظن أن العلم المحقق هو الإحساس والتخيل وأن ما لا يتخيل لا حقيقة له، فإنك لو طالبت نفسك بالنظر إلى ذات القدرة والعلم وجدت الخيال يتصرف فيه بتشكيل وتلوين وتقدير، وأنت تعلم أن تصرف الخيال خطأ وأن حقيقة القدرة المستدل عليها بالفعل أمر مقدس عن الشكل واللون والتحيز والقدر، ولا ينبغي أن تنك دلالة العقل على أمور يأباها الخيال. وننبهك الآن على منشأ هذا الإلتباس؛ فتأمل أن المدركات الأول للإنسان في مبدأ فطرته حواسه فكانت مستولية عليه،
ثم الأغلب من جملتها الأبصار الذي يدرك الألوان بالقصد الأول والأشكال على سبيل الإستتباع، ثم الخيال يتصرف في المحسوسات وأكثر تصرفه في المبصرات فيركب من المرئيات أشكالا مختلفة آحادها مرئية، والتركيب من جهته، فإنك تقدر أن تتخيل فرسا له راس إنسان وطائرا له رأس فرس، ولكن لا يمكن أن تصور آحادا سوى ما شاهدته البتة حتى أنك لو أردت أن تتخيل فاكهة لم تشاهد لها نظيرا لم تقدر عليه، وإنما غايتك أن تأخذ شيئا مما شاهدته فتغير لونه مثلا كتفاحة سوداء، فإنك قد رأيت شكل التفاحة والسواد فركبتهما أو ثمرة كبيرة مثل بطيخة، فلا تزال تركب من آحاد ما شاهدت لأن الخيال يتبع الإبصار ولكنه يقدر على التركيب والتفصيل فقط، ولا يزال الخيال متحركا في التركيب والتفصيل مستوليا عليك بذلكن فمهما حصل لك معلوم بالإستدلال انبعث الخيال محدقا نظره نحوه طالبا حقيقة الأشياء عنده، ولا حقيقة عنده إلا للون أو الشكل فيطلب الشكل واللون، وهو ما يدركه البصر من الموجودات حتى لو تأملت في ذات الرائحة تأملا خياليا طلب الخيال للرائحة ولونا ووضعا وقدرا، كاذبا فيه وجاريا على مقتضى جبلته. والعجب أنك إذ تأملت في شكل متلون لم يطلب الخيال منه طعمه ورائحته وهما حظا الشم والذوق، وإذا تأملت في ذات الطعم والرائحة طلب الخيال حظ البصر وهو اللون والشكل، مع أن الخيال يتصرف في مدركات الحواس الخمس جميعا ولكن لما كان ألفه لمدركات البصر أشد وأكثر، صار طلبه لحظ البصر أغلب وأبلغ. فإذا عرضت على نفسك عملك بصانع العالم وأنه موجود لا في جهة، طلب الخيال له لونا وقدر له قربا وبعدا واتصالا بالعالم وانفصالا إلى غير ذلك مما شاهده في الأشكال المتلونة، ولم يطلب له طعما ورائحة. ولا فرق بين الطعم والرائحة واللون والشكل، فالكل من مدركات الحواس. فإذا عرفت إنقسام الموجودات
إلى محسوسات وإلى معلومات بالعقل ولا تباشر بالحس والخيال، فاعرض عن الخيال رأسا وعوّل على مقتضى العقل فيه، فقد ظهر لك إنقسام الموجود إلى محسوس وغيره. ؟؟؟ القسمة الثانية للموجودات باعتبار نسبه ؟؟؟ بعضها إلى بعض بالعموم والخصوص إعلم أن معنى من المعاني الموجودة، وحقيقة من الحقائق الثابتة إذا نسبتها إلى غيرها من تلك المعاني والحقائق، وجدتها بالإضافة إليه إما أعم وإما أخص وإما مساويا، وإما أعم من وجه وأخص من وجه، فإنك إذا أضفت الإنسان إلى الحيوان وجدته أخص منه، وإن أضفت الحيوان إلى الإنسان وجدته أعم منه، وإن أضفت الحيوان إلى الحساس وجدته مساويا له لا أعم ولا أخص، وإن نسبت الأبيض إلى الحيوان وجدته أعم من وجه فإنه يشمل الجص والكافور وجملة من الجمادات، وأخص من وجه فإنه يقصر عن تناول الغراب والزنوج وجملة من الحيوانات. فإذن جملة الحقائق تناسبها بهذا الإعتبار لا تعدو هذه الوجوه الأربعة، فقس على ما ذكرناه ما لم نذكره.
؟ القسمة الثالثة للموجودات تنقسم إلى موجودات شخصية معينة وتسمى أعيانا إعلم أن الموجودات تنقسم إلى موجودات شخصية معينة وتسمى أعيانا وأشخاصا وجزئيات، وإلى أمور غير متعينة وتسمى الكليات والأمور العامة. فأما الأعيان الشخصية فهي الأمور المدركة أولا بالحواس كزيد وعمرون وهذا الفرس وهذه الشجرة وهذه السماء وهذا الكوكب وأمثالها، وكذا هذا البياض وهذه القدرة، فإن التعين يدخل على الأعراض والجواهر جميعا. ثم هذه الأشخاص كزيد وهذا الفرس وهذه الشجرة وهذا البياض لا تشترك في أعيانها، إذ عين هذا الشخص ليس هو عين الشخص الآخر، إلا أنها تتشابه بأمور كتشابه هذه الثلاثة في الجسمية وتشابه الفرس والإنسان دون الشجر في الحيوانية، فما به التشابه للأشياء يسمة الكليات والأمور العامة، وقد يتشابه زيد وعمرو بعد التشابه في الجسمية والحيوانية والإنسانية في الطول والبياض أيضا، فيكون الطول الذي به التشابه وكذا البياض أمرا عاما شاملا لهما شمولا واحدا، لا على أن بياض هذا هو بياض ذاك وطول هذا طول ذاك بعينه، ولكن على معنى سنبه عليه عند تحقيقنا لمعنى الكلي وثبوته في العقل، وهو من أدق ما ينبغي أن يدرك في المعقولات. ؟
القسمة الرابعة في نسبة بعض المعاني إلى بعض إعلم أنك تقول: هذا الإنسان أبيض وهذا الإنسان حيوان، وهذا الإنسان ولدته أنثى، فقد حملت عليه البياض والحيوانية والولادة وجعلته موصوفا بهذه الأوصاق الثلاثة، ونسبة هذه الثلاثة إليه متفاوتة: فإن البياض يتصور ان يبطل من الإنسان ويبقى إنسانا فليس وجوده شرطا لإنسانيته ولنسم هذا عرضيا مفارقا. وأما الحيوانية فضرورية للإنسان، فإنك إن لم تفهم الحيوان وامتنعت عن فهمه لم تفهم الإنسان بل مهما فهمت الإنسان فقد فهمت حيوانا مخصوصا، فكانت الحيوانية داخلة في مفهومك بالضرورة ويلقب هذا بلقب آخر للتمييز وهو الذاتي المقوم. وأما كونه مولودا من أنثى وكونه متلونا مثلا فليس نسبته إليه كنسبة الحيوانيةن إذ يجوزن أن يحصل في العقل معنى الإنسان بحده وحقيقته مع الغفلة عن كونه مولودا، أو مع اعتقاد أنه ليس بمولود خطأ، فليس من شرط فهم الإنسان الإمتناع عن اعتقاد كونه غير مولود، ومن شرطه الإمتناع عن اعتقاد كونه غير حيوان.
وأما تميزه عن البياض فهو أن البياض قد يفارق وكونه مولودا لا يفارقه قط، وكذلك كونه متلونا بالجملة لا يفارقه وإن فارقه كونه أبيض على الخصوص، فالمتلونية ليست داخلة في ماهية الإنسان دخول الحيوانية، فلنخصص هذا القسم بلقب وهو اللازم؛ فإن الذاتي المقوم وإن كان أيضا لازما ولكن له خاصية التقويم، فيخصص إسم اللازم بهذا القسم. فقد استفدت من هذا التحقيق إنّ كلّ معنى ينسب إلى شيء، فإما أن يكون ذاتيا له مقوما لذاته أي قوام ذاته به، وإما ان يكون غير ذاتي مقوم ولكنه لازم غير مفارق، وأما أن يكون لا ذاتيا ولا لازما ولكن عرضيا. ولعلك تقول: الفرق بين العرضي المفارق وبين الذاتي واضح ولكن الفرق بين الذاتي المقوم وبين اللازم الذي ليس بمقوم ربما يشكل فهل لك معيار يرجع إليه؟ فنقول: المتكلمون سموا اللوازم توابع الذات وربما سموها توابع الحدوث، حتى زعمت منهم أن توابع الحدوث لا تتعلق بها قدرة القادر، ولكنها تتبع الحدوث وربما مثلوا ذلك بتحيز ولسنا نخوض فيه، والغرض إظهار معيار لإدراك الفرق بين الذاتي واللازم وله معياران: الأول أن كل ما يلزم ولا يرتفع في الوجود إن أمكن أن يرتفع بالوهم
والتقدير وبقي الشيء معه مفهوما فهو لازم، فأنا نفهم كون الإنسان إنسانا وكون الجسم جسما وإن رفعنا من وهمنا كون الإنسان إنسانا وكون الجسم جسما وإن رفعنا من وهمنا اعتقاد كونهما مخلوقين مثلا وكونهما مخلوقين لازم لهما، ولو رفعنا من وهمنا كون الإنسان حيوانا لم نقدر على فهم الإنسان. فمن ضرورة فهم الإنسان أن لا يسلب الحيوانية وليس من ضرورته أن لا يسلب المخلوقية، فإذن ما لا يرتفع في الوجود والوهم جميعا فهو ذاتي، وما يرفع في الوجود والوهم فهوعرضي، وما يقبل الإرتفاع في الوهم دون الوجود فهو لازم غير ذاتي، إلا أن هذا المعيار مع أنه كثير النفع في أغلب المواضع غير مطرد في الجميع فإن من اللوازم ما هو ظاهر اللزوم للشيء، بحيث لا يقدر على رفعه في الوهم أيضا، فإن الإنسان يلازمه كونه متلونا ملازمة ظاهرة لا يقدر الإنسان على رفعه في الوهم وهو لازم لا ذاتي، ولذلك إذا حددنا الإنسان لم يدخل فيه التلون مع أن الحد لا يخلو عن جميع الذاتيات المقومة كما سيأتي في كتاب الحدود. وكذلك كون كل عدد إما مساو لغيره أو مفاوت فإنه لازم ليس بذاتي، وربما لا يقدر الإنسان على رفعه في الوهم، نعم من اللوازم ما يقدر على رفعه ككون المثلث مساوي الزوايا القائمتين فإنه لازم لا يعرف لزومه للمثلث بغير وسط بل بوسط، فلم يكن هذا مطردا فنعدل إلى المعيار الثاني عند العجز عن الأول ونقول: إن كل معنى إذا أحضرته في الذهن مع الشيء الذي شككت في أنه لازم له أو ذاتي، فإن لم يمكنك أن تفهم ذات الشيء إلا أن يكون قد فهمت له ذلك المعنى أولا، مساوية لقائمتين فهو كالحيوان وانسان
فإنك إذا فهمت ما الإنسان وما الحيوان فلا تفهم الإنسان إلا وقد فهمت أولا أنه حيوان فاعلم أنه ذاتي. وإن أمكنك أن تفه ذات الشيء دون أن تفهم المعنى أو أمكنك الغفلة عن المعنى بالتقدير، فاعلم أنه غير ذاتي. ثم إن كان يرتفع وجوده إما سريعا كالقيام والقعود للإنسان أو بطيئا شابا فاعلم أنه عرضي مفارق، وإن كان لا يفارقه أصلا ككون الزوايا من المثلث لازم، ورب لازم للشخص كأزرق العين أو أسود البشرة في الزنجي، فهو لا يفارق في الوجود للإنسان الزنجي فهو بالإضافة إلى ذلك الشخص لا يبعد أن يسمى لازما، وإن كان لزومه بالإتفاق لا بالضرورة في الجنس إذ يمكن وجود إنسان ليس كذلك، ولو أمكنت حيلة في إزالة زرقة العين وسواد البشرة لبقي هذا الإنسان إنسانا، ولو قدرت حيلة لإخراج زوايا المثلث عن كونها مساوية لقائمتين لم يبق المثلث وبطل وجوده، فلتدرك هذه الدقيقة في الفرق بين اللازم الضروري وبين اللازم الوجودي.
القسمة الخامسة للذاتي في نفسه وللعرضي في نفسه لما كان المقوم مخصوصا باسم الذاتي في اصطلاح النظار صار ما يقابله يسمى عرضيا، مفارقا كان أو لازما، فيقال عرضي لازم وعرضي مفارق؛ فالعرضي بهذا المعنى وهو الذي ليس بمقوم ينقسم بالإضافة إلى ماهو عرضي له إلى ما يعمه وغيره وإلى ما يختص به ولا يوجد لغيره فيسمى خاصة، سواء كان لازما أو لم يكن وسواء كان ما نسب إليه نوعا أخيرا أو لم يكن، وسواء عم جميع ذلك الجنس أو وجد لبعضه كالمشي والأكل، فإنه بالإضافة إلى الحيوان خاصة، إذ لا يوجد لغير الحيوان، وإن كان لا يوجد كل وقت للحيوان فإن أضفته إلى الإنسان كان عرضا عاما، وكذلك الصهيل للفرس والضحك للإنسان من الخواص، فما ليس مخصوصا بما نسب إليه بل وجد له ولغيره سمي عرضا عاما، ولا تظن أنانريد بالعرض ما نريد بالعرض الذي يقابل الجوهر، فإن هذا العرض قد يكون جوهرا كالأبيض للإنسان، فإن معنى الأبيض هنا جوهر ذو بياض ومدلول اللفظ جوهر لا كالبياض، فإنه عرض فلا تغفل عن هذه الدقيقة فتغلط فينقسم العرضي قسمة أخرى إلى ما يسمى أعراضا ذاتية
وإلى ما لا يسمى ذاتية، فإن الموجود يتحرك والجسم يتحرك والإنسان يتحرك، ولكنا نقول الموجود ليس يتحرك لكونه موجودا بل لمعنى أخص منه وهو الجسمية، والإنسان لا تعتريه الحركة لأنه إنسان بل لمعنى أعم منه وهو كونه جسما، فإذن الحركة من الأعراض الذاتية للجسم أي تلحقه وتعتريه من حيث أنه جسم لا لمعنى أعم منه ولا أخص منه بل لذاته، والصحة والسقم يوسف بكل منهما الحيوان وهو من الأعراض الذاتية للحيوان، إذ لا يلحقه لمعنى أعم منه فإنه لا يعتريه من حيث أنه موجود أو جسم، ولا لما هو أخص منه لأنه لا يعتريه من حيث أنه فرس أو ثور أو إنسان، بل لما هو أعم منها وهو كونه حيوانا. وكذلك الزوجية والفردية للعدد فما يجري هذا المجرى يسمى أعراضا ذاتية، فلا ينبغي أن يلتبس عليك الذاتي بالمعنى الأول وهو المقوم بالذاتي بالمعنى الثاني وهوغير مقوم، فهذه قسمة العرضي. أما الذاتي المقوم فينقسم إلى ما لا يوجد شيء أعم منه وهو داخل في الماهية، أي يمكن
أن يذكر في جواب ما هو ويسمى جنسا وإلى ما يوجد أعم منه دون ما هو أخص منه، ويمكن أن يذكر في جواب ما هو ويسمى نوعا وإلى ما يذكر في جواب أي شيء هو ويسمى فصلا. فإذن إنقسم الذاتي إلى الجنس والنوع والفصل، والعرضي إلى الخاصة والعرض العام بالقسمة المذكورة، فتكون الجملة خمسة، فإذن الكليات بهذا الإعتبار خمسة ويسميها المنطقيون الخمسة المفردة، والأقسام الثلاثة للذاتي فيها مواضع إشتباه فلنوردها في معرض الأسئلة. فإن قال قائل: إذا كان الأعم من الذاتيات يسمى جنسا، والأخص يسمى نوعا، فالذي هو بين الأخص والأعم كالحيوان الذي هو بين الجسم، فإنه أعم من الحيوان وبين الإنسان فإنه أخص من الحيوان ما إسمه؟ قلناك هذا يسمى نوعا بالإضافة إلى ما فوقه وجنسا بالإضافة إلى ما تحته. فإن قلت: فإسم النوع للمتوسط وللنوع الأخير الذي هو الإنسان بالتواطؤ أو بإشتراك الإسم؟ فاعلم أنه بالإشتراك، فإن الإنسان يسمى نوعا بمعنى أنه لا يقبل التقسيم بعد ذلك إلا بالشخص والعدد كزيد وعمرو، أو بالأحوال العرضية كالطويل والقصير وغيره. وأما الحيوان فتسميته نوعا بمعنى آخر وهو أنه يوجد ذاتي أعم منه، والإنسان سمي نوعا بمعنى أنه لا يوجد ذاتي أخص منه، بل كل ما أوردته مما هو أخص فهو عرضي لا ذاتي فهما معنيان متباينان.
فإن قال قائل: فالموجود والشيء أعم من الجسم والحيوان فهل تسمونه جنسا؟ قلنا: لا حجر في التسميات والإصطلاحات بعد فهم المعاني، والأولى في الإصطلاحات النزول على عادة من سبق من النظار، وقد خصصوا إسم الجنس بمعنى داخل في الماهية يجوز أن يجاب به عن سؤال السائل عن الماهية، فيذكر في جواب ما هو، وإذا أشير إلى الشيء وقيل ما هو، لم يحسن ان يقال أنه موجود أو شيء بل الوجود كالعرضي بالإضافة إلى الماهية المعقولة، إذ يجوز أن تحصل ماهية الشيء في العقل مع الشك في أن تلك الماهية هل لها وجود في الأعيان أم لا، فإن ماهية المثلث أنه شكل يحيط به ثلاثة أضلاع، ويجوز أن يحصل في نفوسنا هذه الماهية ولا يكون للمثلث وجود، ولو كان الوجود داخلا في الماهية مقوما لحقيقة الذات لما تصور فهم المثلث وحصول ماهيته في العقل مع عدمه، فكمالا يتصور أن تحصل صورة الإنسان وحده في العقل إلا أن يكون كونه موجودا حاضرا في العقل، إن كان الوجود مقوما للذات كالحيوانية للإنسان والشكلية للمثلث، وليس الأمر كذلك. وعلى الجملة وجود الشيء أما في الأعيان فيستدعي حضور جميع الذاتيات المقومة، وأما في الأذهان وهو مثال الوجود في الأعيان مطابق له وهو معنى العلم إذ لا معنى للعلم بالشيء إلا بثبوت صورة الشيء وحقيقته ومثاله في النفس، كما تثبت صورة الشيء في المرآة مثلا إلا أن المرآة لا تثبت فيها إلا أمثلة المحسوسات، والنفس مرآة تثبت فيها أمثلة المعقولات فيستدعي حضور
جميع الذاتيات المقومة مرة أخرى. فإن قال قائل: فقد عرفت الفرق بين الجنس وبين ما هو عام عام عمومالجنس وليس بجنس، فبماذا يعرف الفرق بين الفصل والنوع؟ قلنا: الفصل ذاتي لا يذكر في جواب ما هو بل يذكر في جواب أي شيء هو، فإنه يشار إلى الخمر فيقال: ماهو؟ فيذكر في الجواب: شراب؛ فلا يحسن بعده أن يقال: ما هو؟ بل: أي شراب هو؟ فيقال: مسكر؛ فالمسكر فصل أي يفصله عن غيره وهو الذي يسميه الفقهاء احترازا، إلا أن الإحتراز قد يكون بالذاتي وقد يكون بغير الذاتي، وقد يخصص إسم الفصل عند الإطلاق بالذاتي. فلو قيل: أي شيء هو؟ وأجيب بأنه أحمر يقذف بالزبد، فربما انفصل به عن غيره وحصل به الإحتراز ولكن يكون ذلك فصلا غير ذاتي. وأما المسكر ففصل ذاتي للشراب وكذلك الناطق للحيوان. وعلى الجملة الجنس والفصل عبارة عن الحقيقة نفسها تفصيلا كقولك شراب مسكر وحيوان ناطق؛ والنوع عبارة عنها إجمالا كقولك إنسان وفرس وجمل سواء النوع الإضافي والحقيقي، والفصل عبارة عن شيء ذي حقيقة كقولك ناطق وحساس ومسكر أي شيء ذو نطق وذو حس وذو إسكار، فكان الشيء الذي ورد عليه الوصف بذو وما بعدها لم يذكر بالفصول القائلة ناطق وحساس ومسكر. وسيأتي لهذا مزيد بيان في كتاب الحد الموصل إلى تصور الأشياء، إذ لا يتم الحدّ إلا بذكر الجنس والفصل.
القسمة السادسة في أصناف الحقائق المذكورة في جواب السائل عن الماهية إعلم أن قول القائل في الشيء ما هو طلب لماهية الشيء، ومن عرف الماهية وذكرها فقد أجاب. والماهية إنما تتحقق بمجموع الذاتيات المقومة للشيء، فينبغي أن يذكر المجيب جميع الذاتيات المقومة للشيء حتى يكون مجيبا، وذلك بذكر حده فلو ترك بعض الذاتيات لم يتم جوابه. فإذا أشار إلى خمر وقال ما هو؟ فقولك شراب ليس بجواب مطابق لأنك أخللت ببعض الذاتيات وأتيت بما هو الأعم، بل ينبغي أن تذكر المسكر. وإذا أشار إلى إنسان وقال: ما هو؟ قتقول: إنه إنسان؛ فإن قال: ما هو الإنسان؟ فجوابك: إنه حيوان ناطق مائت؛ وهو تمام حده، والمقصود إنه يجب أن تذكر ما يعمه وغيره وما يخصه، لأن الشيء هو بإجتماع ذلك وبه تتحصل ذاته، فإذا ثبت هذا الأصل فالمذكور في جواب ما هو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أحدها هو بالخصوصية المطلقة وذلك بذكر الحد لتعريف ماهية الشيء المذكور كما إذا قيل لك: ما الخمر؟ فتقول: شراب مسكر معتصر من العنب، وهذا يختص بالخمر ويطابقه ويساويه فلا هو أعم منه ولا هو أخص منه، بل ينعكس كل واحد منهما على الآخر وهو مع المساواة جامع لجميع الذاتيات المقومة من الجنس والفصول، وهكذا نسبة كل حد لشيء إلى إسمه.
الثاني ما هو بالشركة المطلقة مثل ما إذا سئلت عن جماعة فيها فرس وإنسان وثور: ماهي؟ فعند ذلك لا يحسن إلا أن تقول حيوان؛ فأما الأعم من ذلك وهوالجسم فليس تمام الماهية المشتركة بينها، بل هو جزء الماهية فإن الجسم جزء من ماهية الحيوان، إذ الحيوان هو جسم ذو نفس حساس متحرك، هذا حده وإنما الإنسان والفرس ونحوه أخص دلالة مما يشمل الجملة، وقد جعل الجملة كشيء واحد فأخص ماهية مشتركة لها الحيوان. الثالث ما يصلح أن يذكر على الخصوصية والشركة جميعا، فإنك إذا سئلت عن جماعة هم زيد وعمرو وخالد: ما هم؟ كان الذي يصلح أن يجاب به على الشرط المذكور: إنهم أناس. وكذلك إذا سئل عن زيد وحده: ما هو؟ لا أن يقال: من هو؟ كان الجواب الصحيح: إنه إنسان، لأن الذي يفضل في زيد على كونه إنسانا من كونه طويلا أبيض ابن فلان، أو كونه رجلا أو إمرأة أو صحيحا أو سقيما أو كاتبا أوعالما أو جاهلا، كل ذلك أعراض ولوازم لحقته لأمور اقترنت به في أول خلقته أو طرأت عليه بعد نشوه، ولا يمتنع علينا أن نقدر أضدادها بل زوالها منه، ويكون هو ذلك الإنسان بعينه. وليس كذلك نسبة الحيوانية إلى الإنسانية، ولا نسبة الإنسانية إلى الحيوانية، إذ لا يمكن أن يقال قد اقترن به في رحم أمه سبب جعله إنسانا لو لم يكن لكان فرسا أو حيوانا آخر، وهو ذلك الحيوان بعينه، بل إن لم يكن إنسانالم يكن أصلا حيوانا لا ذاك بعينه ولا غيره، فإذن هو الذاتي الأخير وهوالذي يسمى نوعا أخيرا. فإن قال قائل: لم لا يجوز في القسم الثاني أن يقال حساس ومتحرك بالإرادة بدل الحيوان وهو ذاتي مساو للحيوان؟ قلنا: ذلك غير سديد على الشرط المطلوب، لأن المفهوم من الحساس والمتحرك على سبيل المطابقة هو مجرد أنه شيء له قوة حس أو حركة، كما أن مفهوم الأبيض أنه شيء له بياض؛
فأما ما ذلك الشيء وما حقيقة ذاته فغير داخل في مفهوم هذه الألفاظ إلا على سبيل الإلتزام حتى لا يعلم من اللفظ بل من طريق عقلي يدل على أن هذا لا يتصور إلا لجسم ذي نفس. فإذا سئل عن جسم: ما هو؟ فقلت: أبيض؛ لم تكن مجيبا وإن كنا نعلم من وجه آخر أن البياض لا يحل إلا جسما، ولكن نقول دلالة الأبيض على الجسم بطريق الإلتزام، وقد قدمنا أن المعتبر في دلالة الألفاظ طريق المطابقة والتضمن، ولذلك لا يجوز الجواب عن الماهية بالخواص البعيدة وإن كانت تدل بطريق الإلتزام فلا يحسن أن يقال في جواب من يسأل عنماهية الإنسان أنه الضحاك، وأن كان يدل بطريق الإلتزام. فإن قال قائل: قد ادعيتم أن الماهية مهما حضرت في العقل كان جميع أجزائها حاضرا، وليس كذلك، فإنا إذا علمنا الحادث فإنما نعلم شيئا واحدا مع أن أجزاء ذاته كثيرة، إذ معناه وجود بعد العدم ففيه العلم بالوجود وبعدم ذلك الوجود، وبكون العدم سابقا، وكون الوجود متأخرا وفيه العلم بالتقدم والتأخر وفيه العلم بالزمان لا محالة، فهذه المعلومات كلها لا بد من حضورها في الذهن حتى يتم أجزاء حد الحادث والناظر في الحادث لا تخطر له هذه التفاصيل وهو عالم به. فالجواب أن جميع الذاتيات المقومة للماهية لا بد أن تدخل مع الماهية في التصور، ولكن قد لا تخطر بالبال مفصلة فكثير من المعلومات لا تخطر بالبال مفصلة، ولكنها إذا اخطرت تمثلت وعلم أنها كانت حاصلة، فإن العالم بالحادث أن لم يكن عالما بهذه الأجزاء وقدر أنه لم يعلم إلا الحادث ثم قيل له: هل علمت وجودا أو عدما أو تقدما أو تأخرا؟ فلو قال: ما علمت؛ كان كاذبا فيه.
ومن عرف الإنسان فقيل له: هل عرفت حيوانا أوجسما أو حساسا أو شيئا ذا طول وعرض وعمق وهو حد الجسم؟ فقال: ما عرفته؛ كان كاذبا. فنفهم من هذا أن هذه المعاني معلومة حاضرة في الذهن إلا أنها لا تتفصل غلا إذا أخطرت مفصلة، وإذا فصلت علم أن المعاني كانت معلومة من قبل؛ فافهم هذا فإنه دقيق في نفسه فقد نبهنا على مثارين للشبهة في هذه القسم بصيغة السؤال والجواب. تكملة لهذه الجملة برسوم المفردات الخمس وترتيبها أما الرسوم الجارية مجرى الحدود فالجنس يرسم بأنه كلي يحمل على أشياء مختلفة الذوات والحقائق في جواب ما هو، والفصل يرسم بأنه كلي يحمل على الشيء في جواب أي شيء هو في جوهره. والنوع بأحد المعنيين يرسم بأنه كلي يحمل على أشياء لا تختلف إلا بالعدد في جواب ما هو وبالمعنىالثاني يرسم بأنه كلي يحمل عليه الجنس وعلى غيره حملا ذاتيا، والخاصة ترسم بأنها كلية تحمل على ما تحت حقيقة واحدة فقط حملا غير ذاتي،
والعرض العام يرسم بأنه كلي يطلق على حقائق مختلفة. ثم إعلم أن هذه الذاتيات التي هي أجناس وأنواع تترتب متصاعدة إلى أن تنتهي إلى جنس الأجناس، وهو الجنس العالم الذي ليس فوقه جنس وتترتب متنازلة حتى تنحط إلى النوع الأخير الذي إن نزلت منه انتهت والأعراض، ولا بد من انتهاء الجنس العالي في التنازل إلى نوع أخير إذ ليس يخرج عن النهاية، ولا بد من إرتفاع النوع الأخير في التصاعد إلى جنس عال لا يمكن مجاوزته إلا بذكر العوارض واللوازم. فأما الذاتيات فتنتهي لا محالة والأنواع الأخيرة كثيرة، والأجناس العالية التي هي أعلى الأجناس زعم المنطقيون أنها عشرة: واحد جوهر وتسعة أعراض وهي: (الكم والكيف والمضاف والين ومتى والوضع وله وأن يفعل وأن ينفعل) فالجوهر مثل قولنا إنسان وحيوان وجسم، والكم مثل قولنا ذو ذراع وذو ثلاثة أذرع، والكيف مثل قولنا أبيض واسود، والمضاف مثل قولنا ضعف ونصف وابن واب، والاين مثل قولنا في السوق وفي الدار، ومتى مثل قولنا في زمان كذا ووقت كذا، والوضع مثل قولنا متكىء وجالس، وأن يفعل مثل قولنا يحرق ويقطع، وأن ينفعل مثل قولنا يحترق ويتقطع، وله مثل قولنا متنعل ومتطلس ومتسلح.
وقد تجتمع هذه العشرة في شخص واحد في سياق كلام واحد كما تقول أن الفقيه الفلاني الطويل الأسمر ابن فلان الجالس في بيته في سنة كذا يعلم ويتعلم وهو متطلس. فهذه أجناس الموجودات والألفاظ الدالة عليها بواسطة آثارها في النفس، أعني ثبوت صورها في النفس وهي العلم بها فلا معلوم إلا وهو داخل في هذه الأقسام، ولا لفظ إلا وهو دال على شيء من هذه الأقسام. فأما الأعم من جميعها فهو الموجودة، وقد ذكرنا أنه ليس جنسا وينقسم بالقسمة الأولى إلى الجوهر والعرض، والعرض ينقسم إلى هذه الأقسام التسعة، فيكون المجموع عشرة، ولهذا مزيد تفصيل وتحقيق سيساق إليك في كتاب أقسام الوجود وأحكامه، فإنه بحث عن إنقسام الموجودات، والله أعلم.
؟؟ الفن الثاني في تركيب المعاني المفردة إعلم أن المعاني إذا ركبت حصل منها أصناف كالإستفهام والإلتماس والتمني والترجي والتعجب والخبر. وغرضنا من جملة ذلك الصنف الأخير وهو الخبر، لأن مطلبنا البراهين المرشدة إلىالعلوم وهي نوع من القياس المركب من المقدمات التي كل مقدمة منها خبر واحد يسمى قضية. والخبر هو الذي يقال لقائله أنه صادق أو كاذب فيه بالذات لا بالعرض وبه يحصل الإحتراز عن سائر الأقسام إذ المستفهم عما يعلمه قد يقال له لا تكذب، فإنه يعرض به إلى التباس الأمر عليه. وكذلك من يقول يا زيد ويريد غيره لأن8هـ يعتقد أن زيدا في الدار، فإذا قيل له لا تكذب لم يكن ذلك تكذيبا في النداء بل في خبر اندرج تحت النداء ضمنا، فإذا نظرنا في هذا الفن في القضية وبيانها بذكر أحكامها وأقسامها:؟ القسمة الأولى: إن القضية باعتبار ذاتها تنقسمب إلى جزئين مفردين: أحدهما خبر والآخر مخبر عنه
كقولك زيد قائم، فإن زيدا مخبر عنه والقائم خبر، وكقولك العالم حادث، فالعالم مخبر عنه والحادث خبر وقد جرت عادة المنطقيين بتسمية الخبر محمولا والمخبر عنه موضوعا، فلننزل على اصطلاحهم فلا مشاحة في الألفاظ. ثم إذا قلنا الشكل محمول على المثلث، فإن كل مثلث شكل فلسنا نعني به أن حقيقة المثلث حقيقة الشكل، ولكن معناه أن الشيء الذي يقال له مثلث فهو بعينه يقال له شكل، سواء كان حقيقة ذلك الشيء كونه مثلنا أو كونه شكلا أو كونه أمرا ثالثا، فإنا إذا أشرنا إلى إنسان وقلنا هذا الأبيض طويل، فحقيقة المشار إليه كونه إنسانا لا هذا الموضوع وهو الأبيض ولا هذا المحمول وهو الطويل. وإذا قلنا هذا الإنسان أبيض فالموضوع هو الحقيقة فإذن لسنا نعني بالمحمول إلا القدر الذي ذكرناه من غير اشتراط، فالنفهم حقيقته فهذا أقل ما تنقسم إليه القضية الحملية. والقضايا باعتبار وجوه تركيبها ثلاثة أصناف: الأول الحملي وهو الذي حكم فيه بأن معنى محمول على معنى أو ليس بمحمول عليه كقولنا: العالم حادث - العالم ليس بحادث؛ فالعالم موضوع والحادث محمول يسلب مرة ويثبت أخرى. وقولنا: ليس هو حرف سلب، إذا زيد على مجرد ذكر ذات الموضوع والمحمول صار المحمول مسلوبا عن الموضوع. الصنف الثاني ما يسمى شرطيا متصلا كقولنا: إن كان العالم حادثا فله محدث، سمي شرطيا لأنه شرط وجود المقدم لوجود التالي بكلمة الشرط، وهو أن وإذا وما يقوم مقامهما. فقولنا: إن كان العالم حادثا يسمى مقدما،
وقولنا: فله محدث، يسمى تاليا، وهو الذي قرن به حرف الجزاء الموازي للشرط. والتالي يجري مجرى المحمول ولكن يفارق من وجه، وهو أن المحمول ربما يرجع في الحقيقة إلى نفس الموضوع، ولا يكون شيئا مفارقا له ولا متصلا به على سبيل اللزوم والتبعية، كقولنا الإنسان حيوان والحيوان محمول وليس مفارقا ولا ملازما تابعا. وأما قولنا فله محدث فهو شيء آخر لزم اتصاله وأقرانه بوصف الحدوث، لا إنه يرجع إلى نفس العالم والشرطية المتصلة إذا حللتها رجعت بعد حذف حرفي الجزاء والشرط منها إلى حمليتين، ثم ترجع كل حملية إلى محمول مفرد وموضوع مفرد، فالشرطية أكثر تركيبا لا محالة إذ لا تنحل في أول الأمر إلى البسائط، بل تنحل إلى الحمليات أولا ثم إلى البسائط ثانيا. ؟ الصنف الثالث: ما يسمى شرطيا منفصلا كقولنا العالم إما حادث وإما قديم، فهما قضيتان حمليتان جمعتا وجعلت إحداهما لازمة الإتصال ولأجله سمي منفصلا. والمتكلمون يسمون هذا سبرا وتقسيما. ثم هذا المنفصل قد يكون محصورا في جزئين كما ذكرنا، وقد يكون في ثلاثة أو أكثر كقولنا هذاالعدد إما مثل هذا العدد أو أقل أو أكثر، فهو مع كونه ذا ثلاثة محصور. وربما تكثر الأجزاء بحيث لا يكون داخلا في الحصر كقولنا هذا إما أسود أو أبيض وفلان إما بمكة أو ببغداد.
ثم ينقسم إلى ثلاثة أقسام الأول ما يمنع الجمع والخلو جميعا كقولنا العالم إما حادث أو قديم، فإنه يمنع إجتماع القدم والحدوث والخلو من أحدهما أي لا يجوز كلاهما، ويجب أحدهما لا محالة. والثاني ما يمنع الجمع دون الخلو. كما إذا قال قائل هذا حيوان وشجر، فتقول هو إما حيوان وإما شجر أي لا يجمتعان جميعا وإن جاز إن يخلو عنهما بأن يكون حمارا مثلا. والثالث: مايمنع الخلو ولا يمنع الجمع كما إذا أخذت بدل أحد الجزئين لازمه لا نفسه، بأن قلت مثلا إما أن يكون زيد في البحر وأما ألا يغرقن فإن هذا يمنع الخلو ولا يمنع الجمع إذ يجوز أن يكون في البحر ولا يغرق، ولا يجوز أن يخلو من أحد القسمين، وسببه أنك أخذت نفي الغرق الذي هو لازم كونه في البر وهو أعم منه، فإن الذي في البحر وإما أن يكون في البر، فكان يمتنع به الجمع والخلو جميعا، ولكن عدم الغرق لازم لكونه في البر ثم ليس مساويا بل هو أعم فلم يبعد أن يتناول كونه في البحر فيؤدي إلى الإجتماع. فهذه أمور متشابهة لا بد من تحقيق الفرق بينها، فلا معنى لنظر العقل إلا درك انقسام الأمور المتشابهة في الظاهر، ودرك إجتماع الأمور المفترقة في الظاهر، فإن الأشياء تختلف في أمور وتشترك في أمور، وإنما شأن العقل أن يميز بين مايشترك فيه وما يفترق فيه، وذلك بهذه التقسيمات التي نحن في سياقها، فهذا وجه قسمة القضايا باعتبار أجزائها في الحل والتركيب إلى أصنافها من الحمل والإتصال والإنفصال.
؟ القسمة الثانية للقضية باعتبار نسبة محمولها إلى موضوعها بنفي أو إثبات إعلم أن كل قضية من هذه الأصناف الثلاثة تنقسم إلى سالبة وموجبة، ونعني بهما النافية والمثبتة، فالإيجاب الحملي مثل قولنا الإنسان حيوان، ومعناه أن الشيء الذي نفرضه في الذهن إنسانا، سواء كان موجودا أو لم يكن موجودا، يجب أن نفرضه حيوانا ونحكم عليه بأنه حيوان من غير زيادة وقت وحال، بل على ما يعم الموقت ومقابله والمقيد ومقابله، بل قولنا إنه حيوان في كل حال أو حيوان في بعض الأحوال كلامان متصلان بزيادتين على مطلق قولنا أنه حيوان، هذا ما اللفظ صريح فيه وإن كان لا يبعد أن يسبق إلى الفهم العموم بحكم العادة، لا سيما إذا انضمت إليه قرينة حال الموضوع. وأما السلب الحملي فهو مثل قولنا الإنسان ليس بحيوان. وأما الإيجاب المتصل فهو مثل قولنا إن كان العالم حادثا فله محدث، والسلب ما يسلب هذا اللزوم، والإتصال كقولنا ليس إن كان العالم حادثا فله محدث. والإيجاب المنفصل مثل قولنا هذا العدد إمامساو لذلك العدد أو مفاوت له، والسلب ما يسلب هذا الإتصال وهو قولنا ليس هذا العدد إما مساويا لذلك العدد أو مفاوتا له.
ومقصود هذا التقسيم منع الخلو فالسلب له هوالذي يسلب منع الخلو ويشير إلى إمكانه. فإن قال قائل: قولنا زيد غير بصير سالبة أو موجبة؛ فإن كانت موجبة فما الفرق بينه وبين قولنا زيد ليس بصيرا؛ وإن كانت سالبة فما الفرق بينه وبين قولنا زيد ليس بصيرا؛ وإن كانت سالبة فما الفرق بينه وبين قولنا زيد أعمى وهي موجبة: ولا معنى لقولنا غير بصير إلا معنى هذا الإيجاب، ولذلك لا يتبين في الفارسية فرق بين قولنا: زيد كوراست " وبين قولنا " زيد نابيناست " وكذا قولنا " زيد نادانست " إذ المفهوم منه أنه جاهل والصيغة صيغة النفي. قلنا: هنا موضع مزلة قدم والإعتناء ببيانه واجب، فإن من لا يميز بين السالب والموجب كثر غلطه في البراهين، فإنا سنبين أن القياس لا ينتظم من مقدمتين سالبتين بل لا بد أن يكون إحداهما موجبة حتى ينتج. ومن القضايا ما صيغتها صيغة السلب ومعناها معنى الإيجاب فلا بد من تحقيقها؛ فنقول: قولنا زيد غير بصير قضية موجبة كترجمته بالفارسية، وكأن الغير مع البصير جعلا شيئا واحدا وعبر به عن الأعمى، فالغير بصير بجملته معنى واحدا يوجب مرة فيقال زيد غير بصير، ويسلب أخرى فيقال زيد ليس غير بصير، ولنخصص هذا الجنس من الموجبة باسم آخر، وهو المعدولة أو غير المحصلة وكأنها عدل بها عن قانونها فابرزت في صيغة سلب وهي إيجاب، وتصير حرف السلب مع المسلوب ككلمة واحدة كثير في الفارسية، مثل " نادان ونابينا وناتوان " بدل عن الأعمى والجاهل والعاجز. وإمارة كونها موجبة في الفارسية إنها تردف بصيغة الإثباتت، فيقال فلان: " نابيناست " وإذا سلبت قيل " بينانيست " فيكون الحكم بصيغة السلب، وكانت المطابقة بين اللفظ والمعنى في اللغة تقتضي ثلاثة ألفاظ في كل قضية: واحد للموضوع وواحد للمحمول، وواحد لربط المحمول بالموضوع كما في الفارسية، مثل " نادان ونابينا وناتوان " بدل عن الأعمى والجاهل والعاجز. وإمارة كونها موجبة في الفارسية إنها تردف بصيغة الإثبات، فيقال فلان " نابيناست "
وإذا سلبت قيل " بينانيست " فيكون الحكم بصيغة السلب، وكانت المطابقة بين اللفظ والمعنى في اللغة تقتضي ثلاثة ألفاظ في كل قضية: واحد للموضوع وواحد للمحمول، وواحد لربط المحمول بالموضوع كما في الفارسية، لكن في اللغة العربية اقتصر كثيرا على لفظين فقيل ملا زيد بصير، والأصل أن يقال زيد هو بصير بزيادة حرف الرابطة، فإذا قدم حرف الرابطة على غير فقيل زيد هو غير بصير، صار زيد من جانب موضوعا وغير بضير من جانب آخر محمولا، ولفظ هو متخلل بيهما رابطال لأحدهما بالآخر فيكون إيجابا؛ فإن أردت السلب قلت زيد ليس هو بين السلب والمحمول، وكذلك تقول زيد ليس هو غير بصير فتكون الرابطة قبل أجزاء المحمول متصلة به، فهذا وجه التنبيه على هذه الدقيقة. فإن قيل: فقولنا غير بصير وقولنا أعمى متساويان، أو أحدهما أعم من الآخر.
قلنا: هذا يختلف باللغات، وربما يظن أن قولنا غير بصير أعم حتى يصح أن يوصف به الجماد، وأما الأعمى فلا يمكن أن يوصف به إلا من يمكن أن يكون له البصر، وبيان ذلك محال على اللغة، فلا يخلط بالفن الذي نحن بصدده وإنما غرضنا تمييز السلب عن الإيجاب، فإن الإيجاب لا يمكن إلا على ثابت متمثل في وجود أو وهم. وأما النفي فيصح عن غير الثابت سواء كان كونه غير ثابت واجبا أو غير واجب. القسمة الثالثة للقضية باعتبار عموم موضعها أو خصوصه إعلم أن موضوع القضايا إما شخصي فتكون شخصية كقولنا زيد كاتب زيد ليس بكاتب، وإما كلي فتكون كلية، والكلية إما مهملة كقولنا الإنسان في خسر الإنسان في خسر. وسميناها مهملة لأنه لم يتبين فيها وجود المحمول لكية الموضوع أو لبعضه، وإما محصورة وهي التي بين فيها أن الحكم لكله كقولنا كل إنسان حيوان، أو ذكر إنه لبعضه كقولنا بعض الحيوان إنسان، فإذن القضية بهذا الإعتبار أربعة: شخصيةن ومهملة، ومحصورة كلية، ومحصورة جزئية.
والقضية تقسم إلى هذه الأقسام، سالبة كانت أو موجبة، شرطية كانت أو حملية، متصلة كانت الشرطية أو منفصلة، واللفظ الحاصر يسمى سورا كقولنا في الموجبة الكلية كل إنسان حيوان، وقولنا في الموجبة الجزئية بعض الحيوان إنسان، وكقولنا في السالبة الكلية لا واحد من الناس بحجر، وكقولنا في السالبة الجزئية ليس بعض الناس كاتبا، أو ليس كل إنسان كاتب، فإن فحواهما واحد. فإن قلت: فالألف واللام إذا كانتا للاستغراق فقول القائل الإنسان في خسر كلية فكيف سميناها مهملة؟ فاعلم أنه إن ثبت ذلك في لغة العرب وجب طلب المهمل من لغة أخرى، وإن لم يثبت فهو مهمل إذ يحتمل الكل ويحتمل الجزء، وتكون قوة المهمل قوة الجزئي لأنه بالضرورة يشتمل عليه. وأما العموم فمشكوك فيه، وليس من ضرورة ما يصدق جزئيا إلا يصدق كليا، فليحذر عن المهملات في الأقيسة إذا كان المطلوب منها نتيجة كلية، كما يقول الفقيه مثلا المكيل ربوي والجص مكيل
فكان ربويا، فيقال قولك المكيل مهمل، فإن أردت الكل فممنوع وإن أردت به الجزء فينتج أن بعض المكيل ربوي، فإذا قلت بعض المكيل ربوي والجص مكيل فكان ربويا، لم يلزمه النتيجة إذ يحتمل أن يكون من البعض الآخر الذي ليس بربوي. فإن قلت: فكيف يكون الحصر والإهمال في الشرطيات فافهم أنك مهما قلت كلما كان الشيء حادثا أو قديما، فقد حصرت الحصر الكلي الموجب. وإذا قلت ليس البتة إذا كان الشيء موجودا فهو في جهة وليس البتة إذا كان البيع صحيحا فهو لازم، فقد سلبت الإتصال وحصرت. وسائر نظائر هذا يمكنك قياسها عليه. القسمة الرابعة للقضية باعتبار جهة نسبة المحمول إلى الموضوع بالوجوب أو الجواز أو الإمتناع إعلم أن المحمول في القضية لا يخلو إما أن تكون نسبته إلى الموضوع نسبة الضروري الوجود في نفس الأمر، كقولك
الإنسان حيوان، فإن الحيوان محمول على الإنسان ونسبته إليه نسبة الضروري الوجود، وأما أن يكون نسبته إليه نسبة الضروري العدم كقولنا الإنسان حجر فإن الحجرية محمولة، ونسبتها إلى الإنسان نسبة الضروري العد، وأما ألا يكون ضروريا لا وجوده ولا عدمه كقولنا الإنسان كاتب الإنسان ليس بكاتب، ولنسم هذه النسبة مادة الحمل، فالمادة ثلاثة: الوجوب والإمكان والإمتناع. والقضية بهذا الإعتبار أما مطلقة وإما مقيدة، والمقيدة ما نص فيها بأن المحمول للموضوع ضروري أو ممكن أو موجود على الدوام لا بالضرورة. والمطلق ما لم يتعرض فيه إلى شيء من ذلك، فإن هذه الأمور زائدة على ما يقتضيه مجرد الحمل، والقضية الضرورية تنقسم إلى ما لا شرط فيه كقولنا الله حي، فإنه لم يزل ولا يزال كذلك، وإلى ما شرط فيه وجود الموضوع كقولنا الإنسان حي، فإنه ما دام موجودا فهو كذلك، فوجود الموضوع مشروط فيه ولا يفارق هذا المشروط الضروري الأول في جهة الضرورة، وإنما يفارق في دوام الموضوع لذاته أزلا وأبدا ووجوب وجوده لنفس حقيقته، ولنسم هذا بالضروري المطلق. فأما الضروري المشروط فثلاثة: الأول ما يشترط فيه دوام وجود الموضوع ما تقدم.
الثاني ما شرط فيه دوام كون الموضوع موصوفا بعنوانه كقولنا كل متحرك متغير، فإنه متغير ما دام متحركا لا مادام ذات المتحرك موجودا فحسب. والفرق بين هذا وبين قولنا الإنسان حي إن الشرط في ذات الإنسان، والشرط ههنا ليس هو ذات المتحرك فقط، بل ذات المتحرك بصفة تلحق الذات وهو وهو كونه متحركا فإن المتحرك له ذات وجوهر من كونه فرسا أو سماء أو ما شئت أن تسميه ويلحقه إنه متحرك، وذاك الذات هو غير المتحرك، وليس الإنسان كذلك. الثالث ما يشترط فيه وقت مخصوص إما معين أو غير معين، فإن قولنا القمر بالضرورة منخسف مقيد بوقت معين، وهو وقت وقوعه في ظل الأرض محجوبا بذلك عن ضوء الشمس، وقولنا الإنسان بالضرورة متنفس فمعناه أنه في بعض الأوقات، وذلك الوقت غير متعين. فإن قال قائل: وهل يتصور دائم غير ضروري؟ قلنا: نعم. أما في الأشخاص فظاهر كالزنجي، فإنك قد تقول أنه أسود البشرة ما دام موجود البشرة وليس السواد لبشرته ضروريا ولكنه قد اتفق وجوده لها على الدوام، ولنسم هذه القضية وجودية. وأما في الكليات فكقولنا كل كوكب إما شارق أو غارب،
فإنه في كل ساعة كذلك وليس ذلك ضروريا في وجود ذاته إذ ليس كالحيوان للإنسان، فافهم. القسمة الخامسة للقضية باعتبار نقيضها إعلم أن فهم النقيض في القضية تمس إليه الحاجة في النظر، فربما لا يدل البرهان على شيء ولكن يدل على إبطال نقيضه، فيكون كأنه قد دل عليهي. وربما يوضع في مقدمات القياس شيء فلا يعرف وجه دلالته، ما لم يرد إلى نقيضه، فإذا لم يكن النقيض معلوما لم تحصل هذه الفوائد، وربما يظن أن معرفة ذلك ظاهرة وليس كذلك، فإن التساهل فيه مثار الغلط في أكثر النظريات. والقضيتان المتناقضتان هما المختلفتان بالإيجاب والسلب، على وجه يقتضي لذاته أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة، فإنا إذا قلنا العالم حادث وكان صادقا كان قولنا العالم ليس بحادث كاذبا، وكذا قولنا قديم إذا عنينا بالقديم نفي الحادث؛ فمهما دلننا على أحدهما فقد دللنا على الآخر، ومهما قلنا أحدهما فكأنا قد قلنا الآخر،
فهما متلازمان على هذا الوجه ولكن للتناقض شروط ثمانية، فإذا لم تراع الشروط لم يحصل التناقض: الأول أن تكون إحدى القضيتين سالبة والأخرى موجبة، كقولنا العالم حادث، العالم ليس بحادث، فإنا إن قلنا العالم حادث العالم حادث، فلا يتناقضان. الثاني: أن يكون موضوع المقدمتين واحدا فإذا تعدد لم يتناقضا، كقولنا العالم حادث والباري ليس بحادث، فإنهما لا يتناقضان وإنما يشكل هذا في لفظ مشترك، فإنا نقول العين أصفر، العين ليس بأصفر، ونريد بأحدهما الدينار وبالآخر العضو الباصر. ونقول في الفقه: " الصغيرة مولى عليها في بعضها " الصغيرة ليس مولى عليها في بعضها ونريد بإحداهما الثيب وبالأخرى البكر على منهاج إرادة الخاص بالعام، ويكون الموضوع متعددا فلا يحصل التناقض. الثالث: أن يكون المحمول واحدا، فإن قولنا الإنسان مخلوق، الإنسان ليس بحجر لا يتناقضات، ويشكل ذلك في المحمول المشترك، كقولنا المكره على القتل مختار والمكره على القتل ليس بمختار ولكنه مضطر، ولا يتناقضان فإن المختار يطلق على معنيين مختلفين فهو مشترك، فقد يراد به القادر على الترك وقد يراد به الذي يقدم على الشيء لشهوته وانبعاث داعية من ذاته. ومهما كان اللفظ مشتركا كان الموضوع أو المحمول أكثر من واحد
في الحقيقة، وفي الظاهر يظن أنه واحد، والعبرة للحقيقة لا لظاهر اللفظ. الرابع: ألا يكون المحمول في جزئين مختلفين من الموضوع كقولنا النوبي أبيض، النوبي ليس بأبيض أي هو أبيض الأسنان وليس بأبيض البشرة. وفي الفقه نقول " السارق مقطوع ليس بمقطوع " أي مقطوع اليد ليس بمقطوع الرجل والأنف. الخامس: ألا يختلف ما إليه الإضافة في المضافات، كقولنا الأربعة نصف الأربعة ليست نصفا أي هي نصف الثمانية وليست نصف العشرة، فلا تناقض. وكذلك قولنا زيد أب زيد ليس بأب، أي أب لعمرو، وليس بأب لخالد. وفي الفقه نقول " المرأة مولى عليها المرأة ليس مولى عليها " أي مولى عليها في البضع لا في المال، وقد يضاف إلى البضع كلاهما ولا تناقض من جهة اشتراك لفظ المحمول، فإن أبا حنيفة يقول: مولى عليها إذ يتولى الولي نكاحها شرعا استحبابا أو إيجابا، وليس مولى عليها أي تستقل بنفسها ولا تجبر على العقد. وهذه المعاني يجب مراعاتها لا للنقيض فقط، ولكن لجميع أنواع القياس أيضا. وعلى ذلك فقول بعض فقهاء الشافعية: المرأة مولى عليها فلا تلي أمر نفسها، نتيجة غير لازمة فإن أبا حنيفة يقول:
قولكم أنها مولى عليها أن أردتم به أنها لا تلي أمر نفسها أو الولي يجبرها، فهذا عين المطلوب في محل النزاع، فجعله مقدمة في القياس مصادرة وأن أريد به أن الولي يتولى عقدها استحبابا او إيجابا، فلا يلزم من هذا إلا ينعقد عقدها إذا تعاطته على خلاف الإستحباب. السادس ألا يكون نسبة المحمول إلى الموضوع على جهتين مختلفتين، كقولنا الماء في الكوز مرو مطهر وليس بمرو ولا مطهر، ونريد أنه مرو بالقوة وليس بمرو بالفعل، ولإختلاف جهة الحمل لم يتناقض الحكمان ومن ذلك قوله تعالى: (وَما رَميتَ إِذ رَمَيتَ وَلَكِنَّ الله رَمَى) وهو نفي للرمي وإثبات له، ولكن ليست جهة النفي جهة الإثبات فلم يتناقضا، وهذا أيضا مما يغلط كثيرا في الفقهيات. السابع: ألا يكون في زمانين مختلفة كقولنا الصبي له أسنان، ونعني به بعد الفطام، والصبي لا أسنان له ونعني به في أول الأمر. ونقول في الفقه: الخمر كانت حراما، نعني به في الأعصار السابقة، وكانت حلالا، ونعني به قبل نزول التحريم. وبالجملة ينبغي ألا تخالف إحدى القضيتين الأخرى إلا في الكيف فقط، فتسلب إحداهما ما أوجبته الأخرى على الوجه الذي أوجبته. وعن الموضوع الذي وضعه بعينه على ذلك النحو وفي ذلك الوقت
وبتلك الجهة فإذا ذاك يقتسمان الصدق والكذب، فإن تخلف شرط جاز أن يشتركا في الصدق أو في الكذب. الثامن: وهذا في القضية التي موضوعها كلي على الخصوص، فإنه يزيد في التي موضوعها كلي أن يختلف القضيتان بالجزئية والكلية مع الإختلاف في السلب والإيجاب، حتى يلزم التناقض لا محالة، وإلا أمكن أن يصدقا جميعا كالجزئيتين في مادة الإمكان مثل قولنا بعض الناس كاتب بعض الناس ليس بكاتب، وربما كذبتا جميعا كالكليتين في مادة الإمكان كقولنا كل إنسان كاتب وليس واحد من الناس كاتبا؛ فالتناقض إنما يتم في المحصورات بعد الشروط التي ذكرناها إن كانت إحدى القضيتين كلية والأخرى جزئيتين في مادة الإمكان مثل قولنا بعض الناس كاتب بعض الناس ليس بكاتب، وربما كذبتا جميعا كالكليتين في مادة الإمكان كقولنا كل إنسان كاتب وليس واحد من الناس كاتبا؛ فالتناقض إنما يتم في المحصورات بعد الشروط التي ذكرناها إن كانت إحدى القضيتين كلية والأخرى جزئية، ليكون تناقضها ضروريا ولنمتحن المواد كلها ولنضع الموجبة أولا كلية فنقول: كل إنسان حيوان، ليس بعض الناس بحيوان؛ كل إنسان كاتب، ليس بعض الناس بكاتب؛ كل إنسان حجر، ليس بعض الناس بحجر؛ فنجد لا محالة إحدى القضيتين صادقة والأخرى كاذبة. ولنمتحن السالبة الكلية فنقول: ليس واحد من الناس حيوانا، بعض الناس حيوان؛ ليس واحد من الناس بحجر، بعض الناس حجر؛ ليس واحد من الناس بحجر، بعض الناس حجر؛ ليس واحد من الناس بكاتب، بعض الناس كاتب؛ فبالضرورة يقتسمان الصدق والكذب في جميع المواد. فإن قيل: فالكليتان في مادة الوجوب والإمتناع أيضا يقتسمان الصدق والكذب
قلنا: نعم ولكن لا يعرف ذلك إلا بعد معرفة نسبة المحمول إلى الموضوع إنه ضروري أم لا. وإذا راعيت الشرط الذي ذكرناه علمت التناقض قطعا، وإن لم تعرف تلك النسبة فإنه كيفما كان الأمر يلزم التناقض. القسمة السادسة للقضية باعتبار عكسها إعلم أنا نعني بالعكس إن يجعل المحمول من القضية موضوعا والموضوع محمولا مع حفظ الكيفية وبقاء الصدق بحاله، فإن لم يبق الصدق سمي إنقلابا لا إنعكاسا والقضايا في عنصرها أربعة: الأولى السالبة الكلية وتنعكس مثل نفسها بالضرورة فإنك تقول لا إنسان واحد طائر ويلزم أنه لا طائر واحد إنسان، ونقول لا طاعة واحدة معصية فيلزم أنه لا معصية واحدة طاعة، ولزوم هذا ظاهر ولكن تحريره إنه إن لم يلزم أنه لا طائر واحد إنسان، فإنما لا يلزم لأنه يمكن أن يكون بعض الطائر إنسانا، فإن أمكن ذلك بطل قولنا
لا إنسان واحد طائر لأن ذلك الطائر يكون إنسانا، فيكون ذلك الإنسان طائرا فيرتفع الصدق من قولنا لا إنسان واحد طائر، وقد وضعتها صادقة. والثانية الموجبة الكلية وتنعكس موجبة جزئية، فقولنا كل لإنسان حيوان ينعكس إلى أن بعض الحيوان إنسان، ولا ينعكس كليا لأن المحمول وهو الحيوان يمكن أن يكون أعم من الموضوع، فيفضل طرف منه عن الموضوع الذي هو الإنسان في مثالنا، فلا يمكن أن يقال كل حيوان إنسان إذ من الحيوانات غير الإنسان كالفرس ونحوه من سائر الأنواع الأخرى. والثالثة السالبة الجزئية، وهي لا تنعكس أصلا، فإنا نقول حيوان ما ليس بإنسان فهو صادق وعكسه إنسان ما ليس بحيوان غير صادق، ولا قولنا كل إنسان ليس بحيوان يصح أن يكون عكسا لهذه، فلا تنعكس لا إلى كلية ولا إلى جزئية. والرابعة الموجبة الجزئية
وتنعكس مثل نفسها أعني موجبة جزئية، فقولنا بعض الناس كاتب يلزم منه أن بعض الكاتب إنسان. فإن قلت: إنه يلزم منه إن كل كاتب إنسان؛ فاعلم إن ذلك ليس يلزم من الإيجاب الجزئي من حيث أنه إيجاب جزئي، بل من حيث عرفت من خارج إنه لا كاتب سوى الإنسان، وإلا فمن الموجبة الجزئية مالا يصدق انعكاسه كليا إذ تقول بعض الإنسان أبيض ولا يمكنك أن تقول كل أبيض إنسان، بل اللازم بعض الأبيض إنسان ولأجل كون الأمثلة مغلطة في ذلك عدل المنطقيون من الأمثلة المكشوفة إلى المبهمات وأعلموها بالحروف المعجمة وجعلوا المحمول معرفا بالباء والموضوع بالألف، وقالوا كل " اب " أي هما شيئان مبهمان مختلفان سميناهما بهذين الإسمين، فيلزم منه بعض (ب ا) فقولنا لا شيء من (اب) يلزم منه بعض (ب أ) وإيضاح ذلك بين فلسنا نطنب. وإنما افتقرنا إلى معرفة العكس، فإن
بعض المقاييس يظهر وجه انتاجها بالعكس، وربما ينتج القياس شيئا ومطلوبنا عكسه، فيستبين بهذا أنه مهما أنتج القياس لنا سالبة كلية فقد أنتج أيضا عكسها، وكذا في سائر الأقسام، والله أعلم بالصواب.
كتاب القياس إعلم انا إذا فرغنا من مقدمات القياس وهو بيان المعاني المفردة ووجوه دلالة الألفاظ عليها، وكيفية تأليف المعاني بالتركيب الخبري المشتمل على الموضوع والمحمول المسمة قضية وأحكامها وأقسامها، فجدير بنا أن نخوض في بيان القياس فإنه التركيب الثاني، لأنه نظر في تركيب القضايا ليصير قياسا كما كان الأول نظرا في تركيب المعاني ليصير قضية. وهذا هوالتركيب الواجب في المركبات. فباني البيت ينبغي له أن يعى أولا للجمع بين المفردات اعني الماء والتراب والتبن، فيجمعها على شكل مخصوص ليصير لبنا ثم يجمع اللبنات فيركبها والتبن، فيجمعها على شكل مخصوص ليصير لبنا ثم يجمع اللبنات فيركبها تركيبا ثانيا؛ كذلك ينبغي أن يكون صنيع الناظر في كل مركب، وكما أن اللبن لا يصير لبنا إلا بمادة وصورة، المادة التراب وما فيه، والصورة هو التربيع الحاصل بحصره في قالبه، كذلك القياس المركب له مادة وصورة، الحاصل بحصره في قالبه، المادة التراب وما فيه، والصورة هو الرتبيع الحاصل بحصره في قالبه، كذلك القياس المركب له مادة وصورة، المادة هي المقدمات اليقينية الصادقة فلا بد من طلبها ومعرفة مداركها، والصورة هي تأليف المقدمات على نوع من الترتيب مخصوص ولا بد من معرفته؛ فانقسم النظر فيه إلى أربعة فنون: المادة والصورة والمغلطات في القياس، وفصول متفرقة هي من اللواحق.
النظر الأول في صورة القياس والقياس أحد أنواع الحجج، والحجة هي التي يؤتى بها في إثبات ما تمس الحاجة إلى إثباته من العلوم التصديقية، وهي ثلاثة أقسام: قياس وإستقراء وتمثيل. والقياس أربعة أنواع: حملي وشرطي متصل وشرطي منفصل وقياس خلف، ولنسم الجميع أصناف الحجة. وحد القياس أنه قول مؤلف إذا سلم ما أورد فيه من القضايا لزم عنه لذاته قول آخر إضطرارا وإذا أوردت القضايا في الحجة سميت عند ذلك مقدمات. وتسمى قضايا قبل الوضع كما أن القول اللازم عنه يسمى قبل اللزوم مطلوبا وبعد اللزوم نتيجة. وليس من شرط في أن يسمى قياسا أن يكون مسلم القضايا بل من شرطه أن يكون بحيث إذا سلمت قضاياه لزم منها النتيجة، وربما تكون القضايا غير واجبة التسليم ونحن نسميه قياسا لكوه بحيث لو سلم للزمت النتيجة، وربما تكون القضايا غير واجبة التسليم ونحن نسميه قياسا لكونه بحيث لو سلم للزمت النتيجة. فلنبدأ بالحملي من أنواع القياس والحجج. الصنف الأول القياس الحملي الذي قد يسمى قياسا اقترانيا وقد يسمى جزميا وهو مركب من مقدمتين مثل قولنا
كل جسم مؤلف، وكل مؤلف محدث فيلزم منه أن كل جسم محدث؛ فهذا القياس مركب من مقدمتين وكل مقدمة تشتمل على موضوع ومحمول، فيكون مجموع الآحاد التي تنحل إليه هذه المقدمات أربعة، إلا أن واحدا منها يتكرر، فالمجموع إذن ثلاثة وهو أقل ما ينحل إليه قياس، إذ أقل مايلتئم منه القياس مقدمتان، وأقل ما ينتظم منه المقدمة معنيان: أحدهما موضوع والآخر محمول. ولا بد أن يكون واحد مكررا مشتركا في المقدمتين، فإنه إن لم يكن كذلك تباينت المقدمتان ولم تتكلم في المقدمة الثانية عن الجسم ولا عن المؤلف، بل قلت مثلا كل إنسان حيوان لم تلزم نتيجة من المقدمتين. فإذا عرفت انقسام كل قياس إلى ثلاثة أمور مفردة فاعلم أن هذه المفردات تسمى حدودا، ولكل واحد من الحدود الثلاث إسم مفرد ليتميز عن غيره. أما الحد المشترك فيسمى الحد الأوسط، وأما الآخران فيسمى أحدهما الحد الأكبر والآخر الأصغر. والأصغر هو الذي يكون موضوعا في النتيجة، والأكبر هو الذي يكون محمولا فيها. وإنما سمي أكبر لأنه يمكن أن يكون أعم من الموضوع وإن أمكن أن يكون مساويا. وأما الموضوع فلا يتصور أن يكون أعم من المحمول، وإذا وضع كذلك كان الحكم كاذبا كقولك كل حيوان إنسان، فإنه كاذب وعكسه صادق.
ثم لما مست الحاجة إلى تعريف المقدمتين باسمين ولم يمكن أن يشتق إسمهما من الحد الأوسط، والجسم هو الأصغر، والمحدث هو الحد الأكبر. وقولنا كل جسم مؤلف هي المقدمة الصغرى، وقولنا كل مؤلف محدث هي المقدمة الكبرى، واللازم عنه هو التقاء الحدين الواقعين على الطرفين وهو المطلوب أولا والنتيجة آخرا، وهو قولنا فكل جسم محدث؛ ومثاله من الفقه: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، فكل مسكر حرام، فالمسكر والخمر والحرام حدود القياس، والخمر هو الحد الأوسط،
والمسكر هوالحد الأصغر، والحرام هوالحد الأكبر. وقولنا كل خمر حرام هي المقدمة الكبرى، فهذه قسمة للقياس باعتبار أجزائه المفردة. القسمة الثانية لهذا القياس باعتبار كيفية وضع الحد الأوسط عند الطرفين الآخرين وهذه الكيفية تسمى شكلا. والحد الأوسط إما أن يكون محمولا في إحدى المقدمتين موضوعا في الأخرى كما أوردناه من المثال، فيسمى شكلا أولا، وإما أن يكون محمولا في المقدمتين جميعا ويسمى الشكل الثاني، وإما أن يكون موضوعا فيهما ويسمى الشكل الثالث. الشكل الأول مثاله ما أوردناه، وحصول النتيجة منه بين، وحاصله يرجع إلى أن الحكم علىالمحمول حكم على الموضوع بالضرورة، فمهما حكم على الجسم بالمؤلف فكل حكم يثبت للمؤلف فقد ثبت لا محالة للجسم، فإن الجسم داخل في المؤلف،
وإذا ثبت الحكم بالحدوث على المؤلف فقد ثبت بالضرورة على الجسم. وإنما احتيج إلى هذا من حيث أن الحكم بالحدوث على الجسم قد لا يكون بينا بنفسه، ولكن يكون الحكم به على المؤلف بيتنا بنفسه والحكم بالمؤلف على الجسم أيضا بينا، فيتعدى الحكم الذي ليس بينا للجسم إليه بواسطة المؤلف الذي هو بين له، فيكون الوسط سبب التقاء الطرفين وهو تعدي الحكم إلى المحكوم عليه. ومهما عرفت أن الحكم على المحمول حكم على الموضوع، فلا فرق بين أن يكون الموضوع جزئيا أو كليا، ولا أن يكون المحمول سالبا أو موجبا، فإنك لو أبدلت قولك كل جسم مؤلف بقولك بعض الموجود مؤلف لزم من قياسك أن بعض الموجود محدث. ولو أبدلت قولك كل مؤلف محدث بقولك كل مؤلف محدث ليس بأزلي، تعدى نفي الأزلية أيضا إلى موضوع المؤلف، كما تعدى إثبات الحدوث من غير فرق؛ فيكون المنتج من هذا الشكل بحسب هذا الإعتبار أربع تركيبات:؟؟ الأول موجبتان كليتان كما سبق. الثاني جوجبتان والصغرى جزئية، كما إذا أبدلت قولك كل جسم مؤلف بقولك بعض الموجودات مؤلف.
الثالث موجبة كلية صغرى وسالبة كلية كبرى، وهو أن تبدل قولك محدث بقولك ليس بأزلي. الرابع موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى وهو أن تبدل الصغرى بالجزئية والكبرى بالسالبة، فتقول مثلا موجود ما مؤلف ولا مؤلف واحد أزلي. فأما ما عدا هذه التركيبات فلا تنتج أصلا لأنك إن فرضت سالبتين فقط لا ينتظم منهما قياس، لأن الحد الأوسط إذا سلبته عن شيء فالحكم عليه بالنفي أو بالإثبات لا يتعدى إلى المسلوب عنه، لأن السلب أوجب المباينة والثابت على المسلوب لا يتعدى إلى المسلوب عنه، فإنك إن قلت لا إنسان واحد حجر ولا حجر واحد طائر فلا إنسان واحد طائر، فيرى هذه النتيجة صادقة، وليس صدقها لازما عن هذا القياس فإنك لو قلت لا إنسان واحد بياض ولا بياض واحد حيوان فلا إنسان واحد حيوان، لم تكن النتيجة صادقة. والشكل هو ذلك الشكل بعينه،
ولكن إذا سلبت الإتصال بين البياض والإنسان - لا أن بين الأبيض والإنسان مباينة - فالحكم على البياض لا يتعدى إلى الإنسان بحال، فإذن لا بد أن يكون في كل قياس موجبة أو ما في حكمها وإن كانت الصيغة صيغة السلب مثلا. ولكن في هذا الشكل على الخصوص يشترك أن تكون الصغرى موجبة ليثبت الحد الأوسط للأصغر، فيكون الحكم على الأوسط حكما على الأصغر، ويجب أن تكون الكبرى كلية حتى ينطوي تحت الأكبر الحد الأصغر لعمومه جميع ما يدخل في الأوسط، فإنك إذا قلت كل إنسان حيوان وبعض الحيوان فرس، فلا يلزم أن يكون كل إنسان فرس، بل إن حكمت على الحيوان بحكم كلي ككونه جسما فقلت وكل حيوان جسم، تعدى ذلك إلى الأصغر وهو الإنسان. ولما كانت الأمثلة المفصلة ربما غلطت الناظر عدل المنطقيون إلى وضع المعاني المختلفة المبهمة، وعبروا عنها بالحروف المعجمة ووضعوا بدل الجسم والمؤلف المحدث في المثال الذي أوردناه الألف والباء والجيم، وهي أوائل حروف أبجد، ووضعوا الجيم الذي هو الثالث حدا أصغر محكوما عليه، والباء حدا اوسط يحكم به على الجيم، والألف حدا أكبر يحكم به على الباء ليتعدى إلى الجيم فقالوا: كل ج ب وكل (ب ا) فكل جيم ألف،
وكذا سائر الضروب. وأنت إذا أحطت بالمعاني التي حصلناها لم تعجز عن ضرب المثال من الفقهيات والعقليات المفصلة أو المبهمة. ؟ الشكل الثاني وهو ما كان الحد الأوسط فيه محمولا على الطرفين، لكن إنما ينتج إذا كان محمولا على أحدهما بالسلب وعلى الآخر بالإيجاب، فيشترط اختلاف المقدمتين في الكيفية أعني في السلب والإيجاب ثم لا تكون النتيجة إلا سالبة، وإذا تحقق ذلك فوجه إنتاجه إنك إذا وجدت شيئين ثم وجدت شيئا ثالثا محمولا على أحد الشيشئين بالإيجاب وعلى الآخر بالسلب، فيعلم التباين بين الشيئين بالضرورة، فإنهما لو لم يتباينا لكان يكون أحدهما محمولا على الآخر ولكان الحكم على المحمول حكما على الموضوع، كما سبق في الشكل الآخر، فإذن كل شيئين هذا صفتهما فهما متباينان أي يسلب هذا عن ذاك وذاك عن هذا؛ وتنتظم في هذا الشكل أيضا أربع تركيبات: الأول أن تقول كل جسم مؤلف كما سبق في الأول، ولكن تعكس المقدمة الثانية السالبة من ذلك الشكل، فتقول ولا أزلي واحد مؤلف بدل قولك
ولا مؤلف واحد أزلين فيلزم ما لزم منه لأنا قد قدمنا أن السالبة الكلية تنعكس كنفسها، فلا فرق بين قولك لا مؤلف واحد أزلي، فيلزم ما لزم منه لأنا قد قدمنا أن السالبة الكلية تنعكس كنفسها، فلا فرق بين قولك لا مؤلف واحد أزلي، وهو المذكور في الشكل الأول، وبين قولك ولا أزلي واحد مؤلف، فينتج هذا أنه لا جسم واحد أزلي ومحصله المباينة بين الجسم والأزلي، إذ وجد المؤلف محمولا على أحدهما مسلوبا على الآخر، فدل ذلك على التباين بالطريق الذي ذكرناه مجملا. وتفصيله أن تنعكس المقدمة الكبرى فيرجع إلى الشكل الأول، وإنما سميت هذه مقاييس الشكل الثاني لأنه يحتاج في بيانها إلى الرد للشكل الأول. الضرب الثاني هذا هو بعينه ولكن المقدمة الصغرى جزئية، وهو قولك موجود ما مؤلف ولا أزلي واحد مؤلف، فإذن موجود ما ليس بأزلي وبيانه بعكس المقدمة الكبرى كما سبق. وأما الثالث والرابع فإن تكون الصغرى سالبة إما جزئية وإما كلية وتكون الكبرى موجبة، ولا يمكن تفهيم ذلك بما ضربناه مثلا للشكل الأول إذ لم تكن فيه مقدمة صغرى إلا موجبة، إذ كان هذا شرطا في ذلك الشكل فنغير المثال ونقول:
مثال الضرب الثالث قولك: لا جسم واحد منفك عن الأعراض وكل أزلي منفك عن الأعراض، فإذن لا جسم واحد أزلي فالقياس مؤلف من كليتين صغراهما سالبة وكبراهما موجبة، والنتيجة سالبة كلية والحد الأوسط هو المنفك عن الأعراض، فإنه محمول على الجسم بالسلب وعلى الأزلي بالإيجاب، فأوجب التباين وبيانه بعكس الصغرى فإنها سالبة كلية تنعكس مثل نفسها، وإذا عكست صار المحمول موضوعا وعاد إلى الشكل الأول الذي الحد المشترك فيه موضوع لإحدى المقدمتين محمول للأخرى. الضرب الرابع هو الثالث بعينه لكن الصغرى سالبة جزئية كقولك: موجود ما ليس بجسم وكل متحرك جسم، فبعض الموجودات ليس بمتحرك. ولما كانت السالبة جزئية وهي لا تنعكس لم يمكن أن يرد هذا الضرب إلى الأول بطريق العكس، لكن يرد بطريق الإفتراض، وهو أن تحول هذا الجزئي كليا فإذا كان موجود ما ليس بجسم فقد حصل أن بعض الموجودات ليس بجسم، فلنفرضه سوادا مثلا فنقول
كل سواد ليس بجسم فيصير كالضرب الثالث من هذا الشكل، وكان قد رجع الثالث إلى الشكل الأول بالعكس، فكذا هذا فالمنتج إذن من هذا الشكل هذه التركيبات الأربع وما عداها فلا، إذ لا ينتج سالبتان ولا موجبتان في هذا الشكل ينتجان لأن كل شيئين وجد شيء واحد محمولا عليهما لم يوجب ذلك بينهما، لا إتصالا ولا تباينا، إذ الحيوان يوجد محمولا على الفرس والإنسان، ولا يوجب كون الإنسان فرسا وهو الإتصال. ويوجد محمولا على الكاتب والإنسان ولا يوجب بينهما تباينا حتى لا يكون الإنسان كاتبا والكاتب إنسانا، فإذن لهذا الشكل شرطان: أحدهما أن يختلفا أعني المقدمتين في الكيفية، والآخر أن تكون الكبرى كلية كما في الشكل الأول. ؟؟ الشكل الثالث هو أن يكون الحد المشترك موضوعا في المقدمتين وهذا يوجب نتيجة جزئية، فإنك مهما وجدت شيئا واحدا ثم وجدا شيئين كليهما يحملان على ذلك الشيء الواحد، فبين المحمولين اتصال والتقاء لا محالة على ذلك الواحد، فيمكن لا محالة أن يحمل كل واحد منهما على بعض الآخر بكل حال إن لم يمكن حمله على كله، فلذلك كانت النتيجة جزئية، فإنك حال إن لم يمكن حمله على كله،
فلذلك كانت النتيجة جزئية، فإنك مهما وجدت إنسانا ما وهو شيء واحد، يحمل عليه الجسم والكاتب فإنك مهما وجدت إنسانا ما هو شيء واحد يحمل عليه الجسم والكاتب دل ذلك على أن بين الجسم والكاتب اتصال، حتى يمكن أن يقال لبعض الأجسام كاتب ولبعض الكاتب جسم. وإن كان الكل كذلك ولكن الجزئية لازمة بكل حال وهذا طريق كاف في التفهيم، ولكن نتبع العادة في التفصيل ببيان الأضرب والتعريف بوجه لزوم النتيجة بالرد إلى الشكل الأول، وينتظم في هذا الشكل ستة أضرب منتجة: الضرب الأول من موجبتين كليتين كقولك كل متحرك جسم وكل متحرك محدث، فبعض الجسم بالضرورة محدث، وبيانه بعكس الصغرى فانها تنعكس جزئية ويصير قولنا كل متحرك محدث فيلزم بعض الجسم محدث لرجوعه إلى الشكل الأول، فإنه مهما عكست مقدمة واحدة صار الموضوع محمولا، وقد كان موضوعا للمقدمة الثانية، فيصير الحد الأوسط
محمولا لاحداهما موضوعا للأخرى. الضرب الثاني من كليتين كبراهما سالبة كقولك كل أزلي فاعل ولا أزلي واحد جسم، فيلزم منه ليس كل فاعل جسما لأنه يرجع إلى الأول بعكس الصغرى، وتلزم منه هذه النتيجة بعينها فتقول فاعل ما أزلي ولا أزلي واحد جسم فليس كل فاعل جسما. الضرب الثالث موجبتان صغراهما جزئية ينتج موجبة جزئية، كقولك جسم ما فاعل وكل جسم مؤلف فيلزم فاعل ما مؤلف، وبيانه بعكس الصغرى وضم العكس إلى الكبرى، فيرتد إلى الشكل الأول وتلزم النتيجة، إذ تقول فاعل ما جسم وكل جسم مؤلف فيلزم فاعل ما مؤلف.
الضرب الرابع موجبتان والكبرى جزئية ينتج موجبة جزئية، مثاله كل جسم محدث وجسم ما متحرك، فيلزم محدث ما متحرك وذلك بعكس الكبرى وجعلها صغرى، فيرجع إلى الأول ثم عكس النتيجة ليخرج لنا عين نتيجتنا، فتقول متحرك ما جسم وكل جسم محدث، فيلزم أن متحركا ما محدث وتنعكس إلى عين النتيجة الأولى وهي محدث ما متحرك، فهذا قد تبين لك أنه إنما يحقق بعكسين أحدهما عكس المقدمة والآخر عكس النتيجة. الضرب الخامس يأتلف من مقدمتين مختلفتين في الكمية والكيفية جميعا صغراهما موجبة جزئية وكبراهما سالبة كلية ينتج جزئية سالبة، ومثاله قولك جسم ما فاعل ولا جسم واحد أزلي، فيلزم ليس كل فاعل أزليا
لأن الصغرى تنعكس إلى قولك فاعل ما جسم، فتضم إلى الكبرى القائلة ولا جسم واحد أزلي فتلزم هذه النتيجة بعينها من الشكل الأول البين بنفسه. الضرب السادس من مقدمتين مختلفتين أيضا في الكمية. والكيفية، صغراهما كلية موجبة وكبراهما سالبة جزئية، مثاله كل جسم محدث وجسم ما ليس بمتحرك، فيلزم محدث ما ليس بمتحرك ولا يمكن بيانه بالعكس؛ لأن الجزئية السالبة لا تنعكس والكلية الموجبة إذا انعكست صارت جزئية، ولا قياس من جزئيتين، فبيانه ليرجع إلى الشكل الأول بتحويل الجزئية إلى كلية بالإفتراض، بأن نفرض ذلك البعض الذي ليس بمتحرك أعني بعض الجسم جبلا، ونقول لا جبل واحد متحرك، وينضاف إليه كل جبل جسم وهو صدق الوصف العنواني على ذات الموضوع، فتأخذ هذه صغرى وتضيف إليها صغرى هذا الضرب، هكذا:
كل جبل جسم وكل جسم محدث، فيلزم كل جبل محدث من أول الأول. ثم تضم هذه النتيجة إلى أولى قضيتي الإفتراض، أعني قولك لا جبل واحد متحرك لينتج من الضرب الثاني من هذا الشكل أن بعض المحدث ليس بمتحرك، وقد ذكرنا أنه يرجع إلى الشكل الأول بعكس الصغرى، فيكون هذا الضرب السادس إنما يرجع إلى الشكل الأول بمرتبتين، فهذه مقاييس هذا الشكل، وله شرطان: أحدهما أن تكون الصغرى موجبة أو في حكمها. والآخر أن تكون إحداهما كلية أيهما كانت، إذ لا ينتظم قياس من جزئيتين على الإطلاق، فإذن المنتج من التأليفات أربعة عشر تأليفا: أربعة من الشكل الأول، وأربعة من الثاني، وستة من الثالث، وذلك بعد إسقاط المهملات فإنها في قوة الجزئية، وما عدا ذلك فليس بمنتج ولا فائدة لتفصيل ما لا انتاج له ومن أراد الإرتياض بتفصيله قدر عليه إذا تأمل فيه. فإن قيل: فكم عدد الإفتراضات الممكنة في ذه الأشكال؟ قلنا: ثمانية وأربعون اقترانا في كل شكل ستة عشر، وذلك لأن المقدمتين المقترنتين
إما كليتان أو جزئيتان او إحدهما كلية والأخرى جزئية، وعلى كل حال فهما إما موجبتان أو سالبتان أو واحدة موجبة والأخرى سالبة فهذه ستة عشر اقترانا ناتجة من ضرب أربع في أربع، وهي جارية في الأشكال الثلاثة، فتكون الجملة أخيرا ثمانية وأربعين، والمنتج أربعة عشر إقترانا فيبقى أربعة وثلاثين. فإن قيل: فما خواص الأشكال؟ قلنا: أما الذي يعمل كل شكل فهوإنه لا بد في اقترانها من موجبة وكلية، فلا قياس عن سالبتين ولا عن جزئيتين. وأما خاصية الشكل الأول فإما في وسطه وهو أن يكون محمولا في المقدمة الأولى موضوعا في الثانية، وإما في نتائجه وهو أن ينتج المطالب الأربعة وهي: الأيجاب الكلي، والسلب الكلي، والإيجاب الجزئي، والسلب الجزئي. والخاصية الحقيقية التي لا يشاركه فيها شكل من الأشكال
أنه لا يكون فيها (أي مقدماته) سالبة جزئية. وأما الشكل الثاني فخاصيته في وسطه أن يكون محمولا على الطرفين، وفي مقدماته ألا يتشابها في الكيفية بل تكون أبدا إحداهما سالبة والأخرى موجبة، وأما في الإنتاج فهو أنه لا ينتج موجبة أصلا بل لا ينتج إلا السالب. وأما الشكل الثالث فخاصيته في الوسط أن يكون موضوعا للطرفين، وفي المقدمات أن تكون الصغرى موجبة وأخص خواصه أنه يجوز أن تكون الكبرى منه جزئية. وأما في الإنتاج فهي أن الجزئية هي اللازمة منه دون الكلية. فإن قيل: فلم سمي ذلك أولا وذاك ثانيا وهذا ثالثا؟ قلنا: سمي ذلك أولا لأنه بين الإنتاج وإنما يظهر الإنتاج فيما عداه بالرد إليه أما بالعكس أو بالإفتراض، وإنما كان ذاك ثانيا وهذا ثالثا لأن الثاني ينتج الكلي، والثالث إنما ينتج الجزئي، والكلي أشرف من الجزئي، فكان واليا لما هو أشرف باطلاق، وإنما كان الكلى أشرف لأن المطالب العلمية المحصلة للنفس كمالا إنسانيا مورثا للنجاة والسعادة إنما هي الكليات والجزئيات، إن أفادت علما فبالعرض.
فإن قيل: فهل لكم في تمثيل المقاييس الأربعة عشر أمثلة فقهية لتكون أقرب إلى فهم الفقهاء؟ قلنا: نعم نفعل ذلك ونكتب فوق كل مقدمة يحتاج لردها إلى الأول بعكس أو افتراض أنه بعكس أو بفرض، ونكتب على الطرف أنه إلى أي قياس يرجع إن شاء الله تعالى، وهذه هي الأمثلة: أمثلة الشكل الأول 1 - كل مسكر خمر - وكل خمر حرام - فكل مسكر حرام. 2 - كل مسكر خمر - ولا خمر واحد حلال - فلا مسكر واحد حلال. 3 - بعض الأشربة خمر - وكل خمر حرام - فبعض الأشربة حرام. 4 - بعض الأشربة خمر - ولا خمر واحد حلال - فليس كل شراب حلالا. أمثلة الشكل الثاني 1 - يرجع إلى الضرب الثاني من الأول: كل ثوب فهو مذروع - ولا ربوي واحد مذروع. بعكس هذه فلا ثوب واحد ربوي.
2 - يرجع إلى الضرب الثاني من الأول أيضا: لا ربوي واحد مذروع، بعكس هذه وجعلها صغرى ثم عكس النتيجة وكل ثوب فهو مذروع فلا ربوي واحد ثوب. 3 - يرجع إلى الضرب الرابع من الأول أيضا: متمول ما ليس بربوي " بالإفتراض " وكل مطعوم ربوي، فمتمول ما ليس بمطعوم. 4 - أمثلة الشكل الثالث 1 - يرجع إلى الضرب الثالث من الأول: كل مطعوم ربوي، بعكس هذه وكل مطعوم مكيل فبعض الربوي مكيل. 2 - يرجع إلى رابع الأول: كل ثوب متمول، بعكس هذه، ولا ثوب واحد ربوي، فليس كل متمول ربويا.
3 - يرجع إلى ثالث الأول: مطعوم ما مكيل، بعكس هذه، وكل مطعوم ربوي، فمكيل ما ربوي. 4 - يرجع إلى ثالث الأول: كل مطعوم ربوي، ومطعوم ما مكيل، بعكس هذه وجعلها صغرى ثم عكس النتيجة، فربوي ما مكيل. 5 - يرجع إلى رابع الأول: مذروع ما متمول، بعكس هذه ولا مذروع واحد ربوي، فليس كل متمول ربويا. 6 - يرجع إلى رابع الأول: كل منقول متمول ومنقول ما ليس بربوي " بالإفتراض " فليس كل متمول ربويا. 7 - هذا ما أردنا شرحه من أمثلة القياسات الحملية وأقسامها؛ ولنخض في الصنف الثاني. ؟ الشرطي المتصل يتركب من مقدمتين: إحداهما مركبة من قضيتين قرن بهما صيغة شرط، والأخرى حملية واحدة هي المذكورة في المقدمة الأولى بعينها أو نقيضها، ويقرن بها كلمة الإستثناء،
مثاله: إن كان العالم حادثا فله صانع. مركب من قضيتين حمليتين قرن بهما حرف الشرط وهو قولنا أن، وقولنا: لكن العالم حادث، قضية واحدة حملية قرن بها حرف الإستثناء، وقولنا: فله صانع، نتيجة وهذا مما يكثر نفعه في العقليات والفقهيات، فإنا نقول إن كان هذا النكاح صحيحا فهو مفيد للحل، لكنه صحيح فإذن هو مفيد للحل، وإن كان الوتر يؤدي على الراحلة فهو نفل، لكنه يؤدي على الراحلة فهو إذن نفل. والمقدمة الثانية لهذا القياس إستثناء لإحدى قضيتي المقدمة الأولى أما المقدم أو التالي، والإستثناء إما أن يكون لعين التالي أو لنقيضه أو لعين المقدم او لنقيضه،
والمنتج منه إثنان وهو عين المقدم ونقيض التالي. وأما عين التالي ونقيض المقدم فلا ينتجان، وبيانه إنا نقول إن كان الشخص الذي ظهر عن بعد إنسانا فهو حيوان، لكنه إنسان فليس يخفى أنه يلزم كونه حيوانا، وهذا إستثناء عين المقدم ونقول لكنه ليس بحيوان، وهذا إستثناء نقيض التالي، فيلزم إنه ليس بإنسان ولزوم هذا أدق مدركا وهو أن يعرف أنه إذا لم يكن حيوانا لم يكن إنسانا، إذ لو كان إنسانا لكان حيوانا كما شرطناه في الأول، ويدرك ذلك بأدنى تأمل. فأما إستثناء نقيض المقدم، وهو أنه ليس بإنسان، فلا ينتج لا نقيض التالي وهو أنه ليس بحيوان، إذ ربما يكون فرسا، ولا عين التالي وهو أنه حيوان فربما يكون حجرا.
وكذلك نقول إن كان هذا المصلي محدثا فصلاته باطلة، لكنه محدث فيلزم بطلان الصلاة، لكن الصلاة ليست باطلة وهو نقيض التالي، فيلزم أنه ليس بمحدث وهو نقيض المقدم، لكنه ليس بمحدث وهو نقيض المقدم فلا يلزم - صحة الصلاة ولا بطلانها. لكن الصلاة باطلة، وهو عين التالي، فلا يلزم لا كونه محدثا ولا كونه متطهرا، وإنما ينتج إستثناء عين التالي ونقيض المقدم، إذا ثبت أن التالي مساو للمقدم لا أعم منه ولا أخص، كقولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لكن الشمس طالعة فالنهار موجود، لكن الشمس غير طالعة فالنهار ليس بموجود، لكن النهار موجود فالشمس طالعة، لكن النهار غير موجود فالشمس غير طالعة.
واعلم أنه يتطرق إلى مقدمات هذا القياس أيضا السلب والإيجاب فإنك تقول: إن كان الإله ليس بواحد فالعالم ليس بمنتظم، لكن العالم منتظم فالإله واحد. وقد يكون المقدم أقاويل كثيرة والتالي يلزم الجملة كقولك: إن كان العلم الواحد لا ينقسم وكان كل ما لا ينقسم لا يقوم بمحل منقسم، وكان كل جسم منقسما وكان العلم حالا في النفس، فالنفس إذن ليست بجسم، لكن المقدمات نابتة ذاتية فالتالي وهو أن النفس ليست بجسم لازم، وكذلك قد يكون المقدم واحدا والتالي قضايا كثيرة إن صح إسلام الصبي فهو إما فرض وإما مباح وإما نفل، ولا يمكن شيء من هذه الأقسام فلا يمكن الصحة. وفي العقليات نقول إن كان النفس قبل البدن موجودة فيه إما كثيرة وإما واحدة، ولا يمكن لا هذا ولا ذاك فلا يمكن أن تكون قبل البدن موجودة، فهذه ضروب الشرطيات المتصلة، والله أعلم.
الصنف الثالث الشرطي المنفصل وهو الذي تسميه الفقهاء والمتكلمون السبر والتقسيم، ومثاله قولنا: العالم إما قديم وإما محدث، لكنه محدث فهو إذن ليس بقديم. فقولنا إما قديم وإما محدث مقدمه واحدة، وقولنا لكنه محدث مقدمة أخرى هي إستثناء إحدى قضيتي المقدمة الأولى بعينها، فانتج نقيض اآخر وينتج فيه أربعة إستثناءات، فإنك تقول لكن العالم محدث فيلزم عنه أنه ليس بقديم، أو تقول لكنه قديم فيلزم أنه ليس بمحدث،
أو لكنه ليس بقديم فيلزم أنه محدث وهو إستثناء النقيض، أو تقول لكنه ليس بمحدث، أو تقول لكنه ليس بمحدث فيلزم منه أنه قديم؛ فاستثناء عين إحداهما ينتج نقيض الآخر، واستثناء نقيض إحداهما ينتج الآخر. وهذا فيما لو اقتصرت أجزاء التعاند على اثنين، فإن كانت ثلاثا نأو أكثر ولكنها تامة العناد، فاستثناء عين واحدة ينتج نقيض الآخرين، كقولك لكنه مساو فيلزم أنه ليس أقل ولا أكثر، واستثناء نقيض واحدة لا ينتج إلا انحصار الحق في الجزءين الآخرين، كقولك لكنه ليس مساويا، فيلزم أن يكون إما أقل أو أكثر، فإن استثنيت نقيض الإثنين تعين الثالث، فإما إذا لم تكن الأقسام تامة العناد كقولك: هذا أما أبيض وإما أسود، أو زيد أما بالحجاز أو بالعراق،
فاستثناء عين الواحد ينتج نقيض الآخر، كقولك لكنه بالحجاز أو بالعراق، فاستثناء عين الواحد ينتج نقيض الآخر، كقولك لكنه بالحجاز أو لكنه أسود، فينتج نقيض سائر الأقسام؛ فإما استثناء نقيض الواحد فلا ينتج لا عين الآخر ولا نقيضه، فإنه لا حاصر في الأقسام، فقولنا ليس بالحجاز لا يوجب أن يكون في العراق، ولا ألا يكون به إلا إذا بان بطلان سائر الأقسام بدليل آخر، فعند ذلك يصير الباقي ظاهر الحصر تام العناد، ولا يحتاج هذا إلى مثال في الفقة فإن كثيرا نظر الفقهاء على السبر والتقسيم يدور. ولكن لا يشترط في الفقهيات الحصر القطعي بل الظني فيه كالقطعي في غيره. الصنف الرابع في قياس الخلف وصورته صورة القياس الحملي، ولكن إذا كانت المقدمتان صادقتين سمي قياسا مستقيما، وإن كانت إحدى المقدمتين ظاهرة الصدق والأخرى كاذبة أو مشكوكا فيها وأنتج نتيجة بينة الكذب ليستدل بها على أن المقدمة كاذبة، سمي قياس خلف. ومثال ذلك قولنا في الفقه: " كل ما هو فرض فلا يؤدي على الراحلة " والوتر فرض
فإذن لا يؤدي على الراحلة، وهذه النتيجة كاذبة ولا تصدر إلا من قياس في مقدماتها مقدمة كاذبة، ولكن قولنا كل واجب فلا يؤدي على الراحلة مقدمة ظاهرة الصدق، فبقي أن الكذب في قولنا أن الوتر فرض فيكون نقيضه، وهو أنه ليس بفرض، صادقا وهو المطلوب من المسألة ونظيره من العقليات قولنا: كل ما هو أزلي فلا يكون مؤلفا، والعالم أزلي فإذن لا يكون مؤلفا، لكن النتيجة ظاهرة الكذب ففي المقدمات كاذبة. وقولنا الأزلي ليس بمؤلف ظاهر الصدق، فينحصر الكذب في قولنا العالم أزلي، فإذن نقيضه وهو أن العالم ليس بأزلي صدق، وهو المطلوب؛ فطريق هذا القياس أن تأخذ مذهب الخصم وتجعله مقدمة، وتضيف إليها مقدمة أخرى ظاهرة الصدق، فينتج من القياس نتيجة ظاهرة الكذب، فتبين أن ذلك لوجود كاذبة في المقدمات.
ويجوز أن يسمى هذا قياس الخلف، لأنك ترجع من النتيجة إلىالخلف، فتأخذ مطلوبك من المقدمة التي خلفتها كأنها مسلمة ويجوز أن يسمى قياس الخلف لأن الخلف هو الكذب المناقض للصدق، وقد أدرجت في المقدمات كاذبة في معرض الصدق، ولا مشاحة في التسمية بعد فهم المعنى. الصنف الخامس الإستقراء هو أن تتصفح جزئيات كثيرة داخلة تحت معنى كلي، حتى إذا وجدت حكما في تلك الجزئيات حكمت على ذلك الكلي به. ومثاله في العقليات أن يقول قائل: فاعل العالم جسم، فيقال له:؟ فيقول له: لم؟ فيقول: لأن كل فاعل جسم، فيقال له: لم؟ فيقول تصفحت أصناف الفاعلين من خياط وبناء وإسكاف ونجار ونساج وغيرهم فوجدت كل واحد منهم جسما، فعلمت أن الجسمية حكم ملازم للفاعلية، فحكمت على كل فاعل به. وهذا الضرب من الإستدلال غير منتفع به في هذا المطلوب، فإنا نقول: هل تصفحت في جملة ذلك فاعل العالم؟ فإن تصفحته ووجدته جسما فقد عرفت المطلوب قبل أن تتصفح الإسكاف والبناء ونحوهما، فاشتغالك به إشتغال بما لا يعنيك، وإن لم تتصفح فاعل العالم ولم تعلم حاله فلم حكمت بأن كل فاعل جسم؟ وقد تصفحت بعض الفاعلين ولا يلزم منه غلا أن بعض الفاعلين جسم،
وإنما يلزم أن كل فاعل جسم إذا تصفحت الجميع تصفحا لا يشذ عنه شيء، وعند ذلك يكون المطلوب أحد أجزاء المتصفح فلا يعرف بمقدمة تبنى على التصفح. وإن قال: لم اتصفح الجميع ولكن الأكثر، قلنا: فلم لا يجوز أن يكون الكل جسما إلا واحدا، وإذا احتمل ذلك لم يحصل اليقين به، ولكن يحصل الظن، ولذلك يكتفي به في الفقهيات في أول النظر، بل يكتفي بالتمثيل على ما سيأتي، وهو حكم من جزئي واحد على جزئي آخر. والحكم المنقول ثلاثة: أما حكم من كلي على جزئي وهو الصحيح اللازم وهو القياس الصحيح الذي قدمناه، وأما حكم من جزئي واحد على جزئي واحد كاعتبار الغائب بالشاهد وهو التمثيل وسيأتي، وأما حكم من جزئيات كثيرة على جزئي واحد وهو الإستقراء وهو أقوى من التمثيل.
ومثال الإستقراء في الفقه قولنا: الوتر لو كان فرضا لما أدي على الراحلة، ويستدل به كما سبق في قياس الخلف فيقال: ولم عرفتم أن الفرض لا يؤدي على الراحلة؟ قلنا: باستقراء جزئيات الفرض من الرواتب وغيرها كصلاة الجنازة والمنذورة والقضاء وغيرها، وكذلك يقول الحنفي " الوقف لا يلزم في الحياة لأنه لو لزم لما اتبع شرط الواقف، فيقال له: ولم قلت أن كل لازم فلا يتبع فيه شرط العاقد؟ فيقول: قد استقريت جزئيات التصرفات اللازمة من البيع والنكاح والعتق والخلع وغيرها، ومن جوز التمسك بالتمثيل المجرد الذي لا مناسبة فيه يلزمه هذا، بل إذا كثرت الأصول قوي الظن، ومهما ازدادت الأصول الشاهدة أعني الجزئيات اختلافا كان الظن أقوى فيه، حتى إذا قلنا مسح الراس وظيفة أصلية في الوضوء فيستحب فيه التكرار فقيل: لم؟ فقلنا استقرينا ذلك من غسل الوجه واليدين وغسل الرجلين، ولم يكن معنا إلا مجرد هذا الإستقراء. وقال الحنفي: مسح فلا يكرر، فقيل: لم؟ فقال: استقريت مسح التيمم ومسح الخف كان ظنه أقوى لدلالة جزئين مختلفين عليه. وأما الأعضاء الثلاثة في الوضوء ففي حكم شاهد واحد لتجانسها، وهي كشهادة الوجه واليد اليمنى واليسرى في التيمم.
فإن قيل: فلم لا يقال للفقيه إستقراؤك غير كامل فإنك لم تتصفح محل الخلاف؟ فالجواب: أن قصور الإستقراء عن الكمال أوجب قصور الإعتقاد الحاصل عن اليقين، ولم يوجب بقاء الإحتمال على التعادل كما كان، بل رجح بالظن أحد الإحتمالين، والظن في الفقه كاف وإثبات الواحد على وفق الجزئيات الكثيرة أغلب من كونه مستثنى على الندور، فإذا لم يكن لنا دليل على أن الوتر واجب وأن الوقف لازم، ورأينا جواز أدائه على الراحلة ولا عهد به في فرض ووجوب اتباع شرط الواقف، ولا عهد به في تصرف لازم صار منع الغرضية ومنع اللزوم أغلب على الظن وأرجح من نقيضه، وإمكان الخلاف لا يمنع الظن ولا سبيل إلى جحد الإمكان مهما لم يكن الإستقراء تاما، ولا يكفي في تمام الإستقراء أن تتصفح ما وجدته شاهدا على الحكم إذا أمكن أن ينتقل عنه شيء، كما لو حكم إنسان بأن كل حيوان يحرك عند المضغ فكه الأسفل لأنه إستقرى أصناف الحيوانات الكثيرة، ولكنه لما لم يشاهد جميع الحيوانات لم يأمن أن يكون في البحر حيوان هو التمساح يحرك عن المضغ فكه الأعلى - على ما قيل - وإذا حكم بأن كل حيوان سوى الإنسان، فنزوانه على الأنثى من وراء بلا تقابل الوجهين لم يأمن أن يكون سفاد القنفد وهو من الحيوانات على المقابلة لكنه لم يشاهده، فإذن حصل من هذا أن الإستقراء التام يفيد الظن، فإذن لا ينتفع بالإستقراء مهما وقع خلاف في بعض الجزئيات فلا يفيد الإستقراء علما كليا بثبوت الحكم للمعنى الجامع للجزئيات، حتى يجعل ذلك مقدمة في قياس آخر لا في إثبات الحكم لبعض الجزئيات، كما إذا قلنا: كل حركة في زمان
وكل ما هو في زمان فهو محدث فالحركة محدثة، وأثبتنا قولنا كل حركة في زمان باستقراء أنواع الحركة من سباحة وطيران ومشي وغيرها. فإما إذا أردنا أن نثبت أن السباحة في زمان بهذا الإستقراء لم يكن تاما والضبط أن القضية التي عرفت بالإستقراء ان أثبت لمحمولها حكما ليتعدى إلى موضوعها فلا بأس، وأن نقل محمولها إلى بعض جزئيات موضوعها لم يجز إذ تدخل النتيجة في نفس الإستقراء فيسقط فائدة القياس. فإذا كان مطلبنا مثلا أن نبين أن القوة العقلية المدركة للمعقولات هل هي منطبعة في جسم أم لا؟ فقلنا: ليست منطبعة في جسم لأنها تدرك نفسها والقوى المنطبعة في الأجسام لا تدرك نفسها. فيقال: ولم؟ قلت: عن القوى المنطبعة في الأجسام لا تدرك نفسها. فقلنا تصفحنا القوى المدركة من الآدمي كقوة البصر والسمع والشم والذوق واللمس والخيال والوهم فرأيناها لا تدرك نفسها؟ فيقال: هل تصفحت في جملة ذلك القوة العقلية؟ فإن تصفحتها فقد عرفتها قبل هذا الدليل فلا تحتاج إلى هذا الدليل، وإن لم تعرفها بل هي المطلوب فلم تتصفح الكل بل تصفحت البعض فلم حكمت علىالكل بهذا الحكم؟ ومن أين يبعد أن تكون القوى المنطبعة كلها لا تدرك نفسها إلا واحدة، فيكون حكم واحدة منها بخلاف حكم الجملة وهو ممكن كما ذكرناه في مثال التمساح والقنفد، وفي مثال من يدعي أن صانع العالم جسم، بل من ليس له سمع ولا بصر ربما يحكم بأن الحس لا يدرك الشيء إلا بالإتصال بذلك الشيء، بدليل الذوق واللمس والشم، فلو يجري ذلك في
البصر والسمع كان مخطئا إذ يقال: لم يستحيل أن تنقسم الحواس إلى ما يفتقر فيه إلى الإتصال بالمحسوس وإلى ما لا يفتقر؟ وإذا جاز الإنقسام جاز أن يعتدل القسمان وجاز ان يكون الأكثر في أحد القسمين، ولا يبقى في القسم الآخر إلا واحد، فهذا لا يورث يقينا إنما يحرك ظنا، وربما يقنع اقناعا يسبق الإعتقاد إلى قبوله ويستمر عليه. ؟ الصنف السادس التمثيل وهو الذي تسميه الفقهاء قياسا، ويسميه المتكلمون رد الغائب إلى الشاهد، ومعناه أن يوجد حكم في جزئي معين واحد فينقل حكمه إلى جزئي آخر يشابهه بوجه ما، ومثاله في العقليات أن نقول: السماء حادث لأنه جسم قياسا على النبات والحيوان، وهذه الأجسام التي يشاهد حدوثها، وهذا غير سديد ما لم يمكن أن يتبين أن النبات كان حادثا لأنه جسم، وإن جسميته هي الحد الأوسط للحدوث، فإن ثبت ذلك فقد عرفت أن الحيوان حادث لأن الجسم حادث، فهو حكم كلي وينتظم منه قياس على هيئة الشكل الأول، وهو أن السماء جسم وكل جسم حادث، فينتج أن السماء حادث
فيكون نقل الحكم من كلي إلى جزئي داخلا تحته، وهو صحيح، وسقط أثر الشاهد المعين وكان ذكر الحيوان فضلة في الكلام كما إذا قيل لإنسان: لم ركبت البحر؟ فقال: لاستغني، فقيل له: ولم قلت إذا ركبت البحر استغنيت؟ فقال: لأن ذلك اليهودي ركب البحر فاستغنى، فيقال: وأنت لست بيهودي فلا يلزم من ثبوت الحكم فيه ثبوت الحكم فيك، فلا يخلصه إلا أن يقول: هو لم يستغن لأنه يهودي بل لأنه ركب البحر تاجرا، فنقول: إذن فذكر اليهودي حشو بل طريقك أن تقول: كل من ركب البحر أيسر، فأنا أيضا أركب البحر لأوسر، ويسقط أثر اليهودي، فاذن لا خير في رد الغائب إلى الشاهد إلا بشرط مهما تحقق سقط أثر الشاهد المعين. ثم في هذا الشرط موضع غلط أيضا فربما يكون المعنى الجامع مما يظهر أثره وغناه في الحكم، فيظن انه صالح ولا يكون صالحا لأن الحكم لا يلزمه بمجرده بل لكونه على حال خفي، وأعيان الشواهد تشتمل على صفات خفية فلذلك يجب إطراح الشاهد المعين، فإنك تقول السماء حادث لأنه مقارن للحوادث كالحيوان، فيجب عليك إطراح ذكر الحيوان لأنه يقال لك الحيوان حادث بمجرد كونه مقارنا للحوادث فقط، فاطرح الحيوان وقل كل مقارن للحوادث حادث
والسماء مقارن فكان حادثا، وعند ذلك ربما يمنع الخصم المقدمة الكبرى فلا يسلم أن كل مقارن للحوادث حادث إلا على وجه مخصوص وأن جوزت إن الموجب للحدوث كونه مقارنا على وجه مخصوص وإن جوزت إن الموجب للحدوث كونه مقارنا على وجه مخصوص فلعل ذلك الوجه وأنت لا تدريه موجود في الحيوان لا في السماء، فإن عرفت ذلك الوجه وأنت لا تدريه موجود في الحيوان لا في السماء، فإن عرفت ذلك فابرزه واضفه إلى المقارن واجعله مقدمة كلية، وقل كل مقارن للحوادث بصفة كذا فهو حادث، والسماء مقارن بصفة كذا فهو إذن حادث، فعلى جميع الأحوال لا فائدة في تعيين شاهد معين في العقليات ليقاس عليه؛ ومن هذا القبيل قولك: الله عالم بعلم لا بنفسه لأنه لو كان عالما بعلم قياسا على الإنسان، فيقال: ولم قلت أن ما ينسب للإنسان ينسب لله؟ فتقول: لأن العلة جامعة، فيقال: العلة كونه إنسانا عالما أو كونه عالما فقط فإن كان كونه إنسانا عالما فلا يلزم في حق الله مثله، وإن كانت كونه عالما فقط فاطرح الإنسان وقل: كل عالم فهوعالم بعلم والباري عالم فهو عالم بعلم، وعند ذلك إنما ينازع في قولك كل عالم فهو عالم بعلم، فإن ذلك إن لم يكن أوليا لزمك أن تبينه بقياس آخر لا محالة.
فإن قيل: فهل يمكن إثبات كون المعنى الجامع علة للحكم بأن نرى أن الحكم أجزاء العلة وشروطها، ولا يوجد بوجود ذلك البعض، فمهما ارتفع الحياة ارتفع الإنسان ومهما وجدت لم يلزم وجود الإنسان، بل ربما يوجد الفرس أو غيره ولكن الأمر بالضد من هذا، وهو أنه مهما وجد الحكم دل على وجود المعنى الجامع، فإما أن يدل وجود المعنى على وجود الحكم بمجرد كون الحكم مرتفعا بارتفاعه فلا، فمهما وجد الإنسان فقد وجدت الحياة، ومهما وجدت صحة الصلاة فقد وجد الشرط وهو الطهارة، ومهما وجدت الطهارة لم يلزم وجود الصلاة. فإن قيل: فما ذكرتموه في إبطال منفعة الشاهد في رد الغائب غليه مقطوع به، فكيف يظن بالمتكلمين مع كثرتهموسلامة عقولهم الغفلة عن ذلك؟ قلنا: معتقد الصحة في رد الغائب إلى الشاهد إما محقق يرجع عند المطالبة إلى ما ذكرناه، وإنما يذكر الشاهد المعين لتنبيه السامع على القضية الكلية به فيقول الإنسان عالم بعلم لا بنفسهس، منبها به على أن العالم لا يعقل من معناه شيء سوى أنه ذو علم فيذكر الإنسان تبنيها، وأما قاصر عن بلوغ ذروة التحقيق وهذا ربما ظن ان في ذكر الشاهد المعين دليلا، ومنشأ ظنه أمران: أحدهما أن من رأى البناء فاعلا وجسما ربما أطلق أن الفاعل جسم والفاعل بالألف واللام يوهم الإستغراق، خصوصا في لغة العرب، وهو من المهملات والمهملات قد يتسامح بها فيؤخذ على أنه قضية كلية، فيظن أنها كلية
وينظم قياسا ويقول: الفاعل جسم، وصانع العالم فاعل فهو جسم؛ وكذلك ربما نظر ناظر إلى البر فيراه مطعوما وربويا فيقول المطعوم ربوي ويبني عليه قوله أن السفرجل مطعوم فهو إذن ربوي، لإلتباس قوله المطعوم بقوله كل مطعوم، فالمحقق إذا سمعه فصل وقال قولك المطعوم عنيت به كل مطعوم أو بعضه، فإن قلت بعضه فلعل السفرجل من البعض الآخر، وإن قلت كله فمن أين عرفت ذلك، فإن قلت من البر فليس كل المطعومات، فإذا رأيته ربويا لم يلزم منه إلا أن كل البر ربوي والسفرجل ليس ببر، أو بعض المطعوم ربوي فلا يلزم منه بعض آخر، وكذا في قوله الفاعل جسم يقال له كل الفاعلين أو بعضهم على ما تقرر فلا حاجة إلى الإعادة؟ ثانيهما هو أنه ربما يستقري أصنافا كثيرة من الفاعلين حتى لا يبقى عنده فاعل آخر فيرى أنه استقرى كل الفاعلين، ويطلق القول بأن
كل فاعل فهو جسم وكان الحق أن يقول كل فاعل شاهدته وتصفحته فهو جسم، فيقال له: لم تشاهد فاعل العالم ولا يمكن الحكم عليه ولكن ألغي قوله شاهدت، وكذا يتصفح البر والشعير وسائر المطعومات الموزونة والمكيلة ويعبر عنها بالكل، وينظم في ذهنه قياسا على هيئة الشكل الأول، وهو أن كل مطعوم فأما بر أو شعير أو غيرهما، وكل بر وكل شعير أو غيرهما فهو ربوي، فإذن كل مطعوم ربوي، ثم يقول: والسفرجل مطعوم فهو ربوي، فيكون هذا منشأ غلطه وإلا فالحق ما قدمناه. ولا ينبغي أن تضيع الحق المعقول، خوفا من مخالفة العادات المشهورة، بل المشهورات أكثر ما تكون مدخولة، ولكن مداخلها دقيقة لا يتنبه لها إلا الأقلون. وعلى الجملة لا ينبغي أن تعرف الحق بالرجال، بل ينبغي أن تعرف الرجال بالحق فتعرف إلى الحق أولا، فمن سلكه فاعلم أنه محق. فأما أن تعتقد في شخص أنه محق أولا ثم تعرف الحق به، فهذا ضلال اليهود والنصارى وسائر المقلدين، أعاذك الله وإيانا منه؛ هذا كله في إبطال التمثيل في العقليات، فأما في الفقهيات، فالجزئي المعين يجوز أن ينقل حكمه إلى جزئي آخر باشتراكهما فيب وصف، وذلك الوصف المشترك إنما يوجب الإشتراك في الحكم إذا دل عليه وإداتها الجملية قبل التفصيل ستة: الأول، وهو أعلاها: أن يشير صاحب الحكم، وهو المشرع إليه، كقوله في الهرة: إنها من الطوافين عليكم، عند ذكر العفو عن سؤرها، فيقاس عليها الفأرة بجامع الطواف،
وإن افترقتا في أن هذه تنفر وتلك تأنس، وإن هذه فأرة وتيك هرة، ولكن الإشتراك فثي وصف أضيف إليه الحكم أحرى باقتضاء الإشتراك فيه (في الحكم) من الإفتراق في وصف لم يتعرض له في اقتضاء الإفتراق. وكذا قوله في بيع الرطب بالتمر: أينقص الرطب إذا جف؟ فقيل: نعم. فقال: فلا تبيعوا. فهو إذن أضاف بطلان البيع في الرطب إلى النقصان المتوقع، فيقاس عليه العنب للإشتراك في توقع النقصان. ولا يمنع جريان السؤال في الرطب عن الحاق العنب به، وإن كان هذا عنبا، وذلك رطبا، لأن هذا الإفتراق افتراق في الإسم والصورة والشرع، كثير الإلتفات إلى المعاني، قليل الإلتفات إلى الصور والأسامي. فعادة الشرع ترجح في ظننا التشريك في الحكم، عند الإشتراك في المضاف إليه ذلك الحكم، وتحقيق الظن في هذا دقيق، وموضع إستقصائه الفقه. الثاني: أن يكون ما فيه الإجتماع مناسبا للحكم، كقولنا: النبيذ مسكر فيحرم كالخمر. فإذا قيل: لم قلتم: المسكر يحرم؟ قلناك لأنه يزيل العقل، الذي هو الهادي إلى الحق، وبه يتم التكليف؛ فهذا مناسب للنظر في المصالح فيقال: لا يمتنع ان يكون الشرع قد راعى سكر ما يعتصر من العنب على الخصوص تعبدا، أو أثبت التحريم لا لعلة السكر، بل تعبدا في خمر العنب من غير التفات إلى السكر، فكم من الأحكام التي هي تعبدية غير معقولة، فيقول: نعم هذا غير ممتنع،
ولكن الأكثر في عادة الشرع اتباع المصالح. فكون هذا من قبيل الأكثر أغلب على الظن من كونه من قبيل النادر. الثالث: أن يبين للوصف الجامع تأثيرا في موضع من غير مناسبة، كما يقول الحنفي في اليتيمة أنها صغيرة، ويولى عليها كغير اليتيمة، فيقال: فلم عللت الولاية بالصغر؟ فيقول: لأن الصغر قد ظهر أثره بالإتفاق في غير اليتيمة وفي الإبن. وقدر أن الوصف غير مناسب حتى يستمر المثال، فلا ينبغي أن يقال هذه يتيمة وتيك ليست بيتيمة؛ فيقال: الإفتراق في هذا لا يقاوم الإشتراك في وصف الصغر، وقد ظهر تأثيره في موضع، واليتم لم يظهر تاثيره بالإتفاق في موضع، نعم لو ثبت أن اليتيم لا يولي عليه في المال لتقاوم الكلام. ولو قيل: ظهر أثر اليتم أيضا في دفع الولاية في موضع، كما ظهر أثر الصغر في موضع، فعند ذلك يحتاج إلى الترجيح. وإن شئت مثلت هذا القسم بقياس العنب على الرطب، وإجتماعهما في توقع النقصان. ويقدر أن ذلك لم يعرف بإضافة لفظية من الشارع، بل عرف باتفاق من الفريقين حتى لا يلتحق بمثال الإضافة. الرابع: أن يكون ما فيه الإشتراك غير معدود ولا مفصل لأنه الأكثر، وما فيه الإفتراق شيئا واحدا، ويعلم أن جنس المعنى الذي فيه الإفتراق، لا مدخل له في هذا الحكم، مهما التفت إلى الشرع كقوله: من أعتق شقصا له من عبد، قوّم عليه الباقي. فإنا نقيس الأمة عليه، لا لأنا عرفنا إجتماعهما في معنى مخيل أومؤثر أو مضاف إليه الحكم بلفظه، لأنه لم يبن لنا بعد المعنى المخيل فيه، ولا لأنا رأيناهما متقاربين فقط. فإنه لو وقع النظر في ولاية النكاح، وبان أن الأمة تجبر على النكاح، فلا يتبين لنا أن العبد في معناه. والقرب من الجانبين على وتيرة واحدة،
ولكن إذا التفتنا إلى عادة الشرع، علمنا قطعا أنه ليس يتغير حكم الرق والعتق بالذكورة والأنوثة، كما لا يتغير بالسواد والبياض، والطول والقصر، والزمان والمكان وأمثالها. الخامس: هو الرابع بعينه، غلا أن ما فيه الإفتراق لا يعلم يقينا أنه لا مدخل له في الحكم، بل يظن ظنا ظاهرا، وذلك كقياسنا إضافة العتق إلى جزء معين على إضافته إلى نصف شائع، وقياس الطلاق المضاف إلى جزء معين على المضاف، إلى نصف شائع فأنا نقول: السبب هو السبب، والحكم هو الحكم، والإجتماع شامل إلا في شيء واحد هو أن هذا معين مشار إليه، وذلك شائع. وإذا كان التصرف لا يقتصر على المضاف إليه، فيبعد أن يكون لا مكان الإشارة وعدمه مدخل في هذا الحكم، وهذا ظن ظاهر ولكن خلافه ممكن؛ فإن الشرع جعل الجزء الشائع. محلا لبعض التصرفات، ولم يجعل المعين محلا أصلا، فلا بعد في أن يجعل ما هو محل لبعض التصرفات محلا لإضافة هذا التصرف، فصار النظر بهذا الإحتمال ظنيا. وقد اختلف المجتهدون في قبول ذلك، وعندي أن في هذا الجنس ما يجوز الحكم به، ولكن يتطرق إلى مبالغ الظن، الحاصل منه تفاوت غير محدود ولا محصور، ويختلف بالوقائع والأحكام، والأمر موكول إلى المجتهد، فإن من غلب أحد ظنيه جاز له الحكم به. السادس: أن يكون المعنى الجامع أمرا معينا متحدا، وما فيه الإفتراق أيضا أمرا معينا أو أمورا معينة، ولم يكن للجامع مناسبة وتأثير، إلا أنه إن كان الجامع موهما أن المعنى المصلحي - الخفي، الملحوظ بعين الإعتبار من جهة الشرع، مودع في طيه، وإنطواؤه على ذلك المعنى، الذي هو المقتضي للحكم عند الله، أغلب من إحتواء المعنى الذي فيه المفارقة، كان الحكم بالإشتراك لذلك أولى من الحكم بالإفتراق.
مثاله قولنا: الوضوء طهارة حكمية عن حدث، فتفتقر إلى النية كالتيمم، فقد اشتركا في هذا وافترقا في أن ذاك طهارة بالماء دون التيمم، وتشبهه إزالة النجاسة. وقولنا: ظهارة حكمية جمع التيمم وأخرج إزالة النجاسة. ونحن نقول: المقتضي للنية في علم الله تعالى معنى خفي عنا، ومقارنته بكونه طهارة حكمية يعتد به موجبا في حال موجبها، أغلب من كونه مقرونا بكونه طهارة بالتراب، فيصير إلحاق الوضوء به أغلب على الظن من قطعة عنه؛ وهذا أيضا مما اختلف فيه. والرأي عندنا أن ذلك مما يتصور أن يفيد رجحان ظن على ظن، فهو موكول إلى المجتهد. ولم يبن لنا من سيرة الصحابة، في إلحاق غير المنصوص بالمنصوص، إلا إعتبار أغلب الظنون. ولا ضوابط بعد ذلك في تفصيل مدارك الظنون، بل كل مايضبط به تحكم، وربما يغلط في نصرة هذا الجنس فيقال: الوضوء قربة، ويذكر وجه مناسبة القربة للنية، وهو ترك لهذا الطريق بالعدول إلى الإضافة. وربما يغلط في نصرة جانبهم فيقال: هذه طهارة بالماء والماء مطهر بنفسه، كما أنه مروي بنفسه، ويدعى مناسبة فيكون عدولا عن الفرق الشبهي، كما أن ما ذكرناه عدول عن الجمع الشبهي. وإسم الشبه، في اصطلاح أكثر الفقهاء، مخصوص بالتشبيه بمثل هذه الأوصافن الذي لا يمكن اثباته بالمدارك السابقة، وإن كان غير التعليق بالمخيل تشبيها، ولكن خصصت العبارة اللفظية به لأنه ليس فيه إلا شبه، كما خصصوا المفهوم بفحوى الخطاب، مع أن المنظوم أيضا له مفهوم، ولكن ليس للفحوى منظوم، بل مجرد المفهوم فلقب به.
ولما رأينا التعويل على أمثال هذا الوصف الذي لا يظهر مناسبته جائزا بمجرد الظن. والظنون تختلف بأحوال المجتهدين، حتى أن شيئا واحدا يحرك ظن مجتهد، وهو بعينه لا يحرك ظن الآخر، ولم يكن له في الجدال معيار يرجع إليه المتنازعانن رأينا أن الواجب في إصطلاح المتناظرين ما اصطلح عليه السلف من مشايخ الفقه، دون ما أحدثه من بعدهم ممن ادعى التحقيق في الفقه، من المطالبة بإثبات العلة بمناسبة أو تأثير أو إخالة، بل رأينا أن يقتصر المعترض على سؤال المعلل بأن قياسك من أي قبيل؟ فإن كان من قبيل المناسب أو المؤثر أو سائر الجهات، وأنت تظن أنه ينطوي على المعنى المبهم، فلست أطالبك ولكن أقابلك للجمع، صلح مثله للفرق. وبهذا السؤال يفتضح المعلل في قياسه الذي قدّره، إن كان معناه الجامع طردا محضا، لا يناسب ولا يوهم الإشتمال على مناسب مبهم. وإن كان ما يقابل السائل به طردا محضا لا يوهم أمرا، فعلى المعلل أن يرجح جانبه، كما إذا فرق بين التيمم والوضوء، بأن التيمم على عضوين، وهذا على أربعة أعضاء، فإن هذا مما يعلم أنه لا يمكن أن يكون لمثله مدخل في الحكم، لا بنفسه ولا باستصحاب معنى له مدخل بطريق الإشتمال عليه، مع إبهامه بخلاف قولنا أنه طهارة حكمية، فهذا طريق النظر في الفقهيات. ولقد خاض في الفقه من أصحاب الرأي، من سدى أطرافا من العقليات ولم يخمرها، وأخذ يبطل أكثر أنواع هذه الأقيسة، ويقتصر منها على المؤثر، ويوجه المطالبة العقلية على كل ما يتمسك به في الفقه. وعندما ينتهي إلى نصرة مذهبه في التفصيل، يعجز عن تقريره على الشرط الذي وضعه في التأصيل، فيحتحال لنصرة الطرديات الردية بضروب من الخيالات الفاسدة، ويلقبها بالمؤثر،
وليس يتنبه لركاكة تيك الخيالات الفاسدة، ولا يرجع فينتبه لفساد الأصل الذي وضعه، فدعاه إلى الإقتصار في إثبات الحكم على طريق المؤثر أو المناسب، ولا يزال يتخبط، والرد عليه في تفصيل ما أورده في المسائل يشتمل عليه كتبنا المصنفة في خلافات الفقه، سيما: كتاب تحصين المأخذ، وكتاب المبادي والغايات. والغرض الآن من ذكره أن الإستقصاء الذي ذكرناه في العقليات، ينبغي أن يترك في الققهيات رأسا؛ فخلط ذلك الطريق السالك إلى طلب اليقين بالطريق السالك إلى طلب الظن صنيع من سدى من الطرفين طرفا، ولم يستقل بهما، بل ينبغي أن تعلم أن اليقين في النظريات أعز الأشياء وجودا، وأما الظن فأسهلها منالا وأيسرها حصولا. فالظنون المعتبرة في الفقهيات هو المرجح الذي يتيسر به عند التردد بين أمرين: إقدام أو إحجام؛ فإن إقدام الناس في طرق التجارات وإمساك السلع تربصا بها، أو بيعها خوفا من نقصان سعرها، بل في سلوك أحد الطريقين في أسفارهم، بل في كل فعل يتردد الإنسان فيه بين جهتين على ظن؛ فإنه إذا تردد العاقل بين أمرين، واعتدلا عنده في غرضه، لم يتيسر له الإختيار، إلا أن يترجح أحدهما، بأن يراه أصلح بمخيلة أو دلالة؛ فالقدر الذي يرجح أحد الجانبين ظن له، والفقهيات كلها نظر من المجتهدين في إصلاح الخلق. وهذه الظنون وأمثالها تقتنص بأدنى مخيلة وأقل قرينة، وعليه إتكال العقلاء كلهم في إقدامهم وإحجامهم على الأمور المخطرة في الدنيا، وذلك القدر كاف في الفقهيات، والمضايقة والإستقصاء فيه يشوش مقصوده بل يبطله، كما أن الإستقصاء في التجارات، ضربا للمثل، يفوت مقصود التجارة. وإذا قيل للرجل: سافر لتربح، فيقول: وبم أعلم أني إذا سافرت ربحت؟
فيقال: اعتبر بفلان وذالان. فيقول: ويقابلهما فلان وفلان وقد ماتا في الطريق أو قتلا أو قطع عليهما الطريق! فيقال: ولكن الذين ربحوا أكثر ممن خسروا أو قتلوا: فيقول: فما المانع من أن أكون من جملة من يخسر أو يقتل أو يموت؟ وماذا ينفعني ربح غيري إذا كنت من هؤلاء؟ فهذا استقصاء لطلب اليقين، والمعتبر له لا يتجر ولا يربح، وبعد مثل هذا الرجل موسوسوا أو جبانا، ويحكم عليه بأن التاجر الجبان لا يربح، فهذا مثال الإستقصاء في الفقهيات، وهو هوس محض وخرق، كما أن ترك الإستقصاء في العقليات جهل محض، فليؤخذ كل شيء من مأخذه، فليس الخرق في الإستقصاء في موضع تركه، بأقل من الحمق في تركه بموضع وجوبه، والله أعلم. الصنف السابع في الأقيسة المركبة والناقصة إعلم أن الألفاظ القياسية المستعملة في المخاطبات والتعليمات، وفي الكتب والتصنيفات، لا تكون ملخصة في غالب الأمر على الوجه الذي فصلناه، بل تكون مائلة عنه إما بنقصان، وإما بزيادة، وإما بتركيب وخلط جنس بجنس، فلا ينبغي أن يلتبس عليك الأمر، فتظن أن المائل عما ذكرناه ليس بقياس، بل ينبغي أن يكون عين عقلك مقصورة على المعنى، وموجهة إليه لا إلى الأشكال اللفظية،
فكل قول أمكن أن يحصل مقصوده، ويرد إلى ما ذكرناه من القياس، فقوته قوة قياس، وهو حجة، وإن لم يكن تأليفه ما قدمناه، إلا أنه إذا تؤمل وامتحن لمتحصل منه نتيجة، فليس بحجة. أما المائل للنقصان فبأن نترك إحدى المقدمتين أو النتيجة. أما ترك المقدمة الكبرى فمثاله قولك: هذان متساويان لأنهما قد ساويا شيئا واحدا، فقد ذكرت المقدمة الصغرى والنتيجة، وتركت الكبرى وهي قولك: والأشياء المساوية لشيء واحد متساوية، وبه تمام القياس، ولكن قد تتركب لوضوحها، وعلى هذا أكثر الأقيسة في الكتب والمخاطبات. وقد تترك الكبرى إذا قصد التلبيس ليبقى الكذب خفيا فيه، ولو صرح به لتنبه المخاطب لمحل الكذب. مثاله قولك: هذا الشخص في هذه القلعة خائن، سيسلم القلعة لأني رأيته يتكلم مع العدو، وتمام القياس أن تضيف إليه: أن كل من يتكلم مع العدو فهو خائن، وهذا يتكلم معه، فهو إذن خائن، ولكن لو صرحت بالكبرى ظهر موضع الكذب، ولم يسلم أن كل ما يتكلم مع العدو فهو خائن. وهذا مما يكثر استعماله نفي القياسات الفقهية. وأما ترك المقدمة الصغرى فمثاله قولك:
اتق مكيدة هذا. فيقال: لم؟ فتقول: لأن الحساد يكايدون. فتترك الصغرى وهو قولك: هذا حاسد، وذلك إنما يكون عند ظهور الحسدن منه. وهو كقولك: هذا يقطع لأن السارق يقطع، وتترك الصغرى، ويحسن ذلك إذا اشتهر بالسرقة عند المخاطب. وعلى هذا أكثر مخاطبة الفقهاء لا سيمافي كتب المذهب، وذلك حذرا من التطويل. ولكن في النظريات ينبغي أن يفصل حتى يعرف مكان الغلط. وأما المائل بالتركيب والخلط، فهو أن يطوى في سياق كلام تسوقه إلى نتيجة واحدة مقدمات مختلفة، أي حملية وشرطية منفصلة ومتصلة. مثاله قولك: العالم إما أن يكون قديما، وإما أن يكون محدثا، فإن كان قديما فهو ليس بمقارن للحوادث لكنه مقارن للحوادث من قبل أنه جسم، والجسم إن لم يكن مقارنا للحوادث يكون خاليا منها، والخالي من الحوادث ليس بمؤلف ولا يمكن أن يتحرك، فإذن العالم محدث؛ فهذا القياس مركب من شرطي منفصل ومن شرطي متصل،
ومن جزمي على طريق الخلف ومن جزمي مستقيم، فتأمل أمثال ذلك فإنه كثير الورود في المناظرات والمخاطبات التعليمية. ومن جملة التركيبات ما تترك فيه النتائج الواضحة وبعض المقدمات، ويذكر من كل قياس مقدمة واحدة، وتترتب بعضها على بعض وتساق إلى نتيجة واحدة كقولنا: كل جسم مؤلف، وكل مؤلف فمقارن لعرض لا ينفك عنه، وكل عرض فحادث، وكل مقارن لحادث فلا يتقدم عليه، وكل ما لا يتقدم عليه فوجوده معه، وكل ما وجوده معه فهو حادث، فإذن العالم حادث. وكل واحدة من هذه المقدمات تمامها بقياس كامل، حذفت نتائجها وما ظهر من مقمدماتها وسيقت لغرض واحد. وإلا فكان ينبغي أن يقول: كل جسم مؤلف، وكل مؤلف فمقارن لعرض لا ينفك عنه، مقدمة أخرى، وهو أن كل مقارن لعرض لا ينفك عنه. فإذن كل جسم فمقارن لعرض لا ينفك عنه، ثم يبتدىء ويضيف إليه مقدمة أخرى وهو أن كل مقارن لعرض لا ينفك عنه فهو مقارن لحادث، ثم يشتغل بما بعده على الترتيب، ولكن أغنى وضوح هذه النتائج عن التصريح بها. وربما تجري في المخاطبات كلمات لها نتائج، لكن تترك تلك النتائج إما لظهورها
وإما لأنها لا تقصد للإحتجاج، بل تذكر المقدمات تعريفا لها في أنفسها. إعتمادا على قبول المخاطب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " يموت المرء على ما عاش عليه، ويحشر على ما مات عليه " وهاتان مقدمتان نتيجتهما أن المرء يحشر علىماعاش عليه، فحالة الحياة هي الحد الأصغر، وحالة الممات هي الحد الأوسط. ومهما ساوت حالة الحشر حالة الموت، وساوت حالة الموت حالة الحياة، فقد ساوت حالة الحشر حالة الحياة. والمقصود من سياق الكلام تنبيه الخلق على أن الدنيا مزرعة الآخرة، ومنها التزود. ومن لم يكتسب السعادة وهو في الدنيا فلا سبيل له إلى اكتسابها بعد موته، فمن كان في هذه أعمى فهو عند الموت أعمى، أعني عمى البصيرة عن درك الحق والعياذ بالله. ومن كان عند الموت أعمى فهو عند الحشر أعمى كذلك، بل هو أضل سبيلا إذ ما دام الإنسان في الدنيا فله أمل في الطلب، وبعد الموت قد تحقق اليأس. والمقصود أن الكلمات الجارية في المحاورات كلها أقيسة محرفة غيرت تأليفاتها للتسهيل، فلا ينبغي أن يغفل الإنسان عنها بالنظر إلى الصور، بل ينبغي أن لا يلاحظ إلا الحقائق المعقولة دون الألفاظ المنقولة.
؟ النظر الثاني من كتاب القياس في مادة القياس قد ذكرنا ان كل مركب فهو متألف من شيئين: أحدهما كالمادة الجارية منه مجرى الخشب من السرير. والثاني كالصورة الجارية منه مجرى صورة السرير من السرير. وقد تكلمنا على صورة القياس وتركيبه ووجوه تأليفه بما يقنع، فلنتكلم في مادته، ومادته هي العلوم، لكن لا كل علم بل العلم التصديقي دون العلم التصوري، وإنما العلم التصوري مادة الحد، والعلم التصديقي هو العلم بنسبة ذوات الحقائق بعضها إلى بعض بالإيجاب أو السلب، ولا كل تصديقي بل التصديقي الصادق في نفسه، ولا كل صادق بل الصادق اليقينيز فرب شيء في نفسه صادق عند الله وليس يقينا عند الناظر، فلا يصلح أن يكون عنده مادة للقياس الذي يطلب به استنتاج اليقين، ولا كل يقيني بل اليقيني الكلي، أعني أنه يكون كذلك في كل حال. ومهما قلنا مواد القياس هي المقدمات كان ذلك مجازا من وجه، إن المقدمة عبارة عن نطق باللسان يشتمل على محمول وموضوع،
ومادة القياس هي العلم الذي لفظ الموضوع والمحمول دالان عليه لا اللفظ بل الموضوع والمحمول هي العلوم الثابتة في النفس دون الألفاظ، ولكن لا يمكن التفهيم إلا باللفظ، والمادة الحقيقية هي التي تنتهي إليه في الدرجة الرابعة بعد ثلاثة قشور: القشر الأول هو الصور المرقومة بالكتابة. الثاني هو النطق، فإنه الأصوات المرتبة التي هي مدلول الكتابة ودالة على الحديث الذي في النفس. الثالث: هو حديث النفس الذي هو علم بتريب الحروف ونظم الكلام، إما منطوقا به وإما مكتوبا. والرابع: وهو اللباب، هو العلم القائم بالنفس الذي حقيقته ترجع إلى انتقاش النفس بمثال مطابق للمعلوم؛ فهذه العلوم هي مواد القياس وعسر تجريدها في النفس دون نظم الألفاظ بحديث النفس لا ينبغي أن يخيل إليك الإتحاد بين العلم والحديث، فإن الكاتب أيضا قد يعسر عليه تصور معنى إلا أن يتمثل له رقوم الكتابة الدالة على الشيء، حتى إذا تفكر في الجدار تصور عنده لفظ الجدار مكتوبا. ولكن لما كان العلم بالجدار غير موقوف على معرفة أصل الكتابة لم يشكل عليه أن هذا مقارن لازم للعلم لا عنه، وكذلك يتصور أن إنسانا يعلم علوما كثيرة وهو لا يعرف اللغات فلا يكون في نفسه حديث نفس، أعني إشتغالا بترتيب الألفاظ، فإذن العلوم الحقيقية التصديقية هي مواد القياس، فإنها إذا احضرت في الذهن على ترتيب مخصوص استعدت النفس لأن يحدث فيها العلم بالنتيجة
من عند الله تعالى، فإذن مهما قلنا مواد القياس المقدمات اليقينية فلا تفهم منه إلا ما ذكرناه. ثم كما ان صورة الإستدارة والنقش للدينار زائد على مادة الدينار، فإن المادة للدينار هي الذهب الإبريز، فكذا في القياس، وكما أن الذهب الذي هو مادة الدينار له أربعة أحوال: أعلاها أن يكون ذهبا خالصا ابريزا لا غش فيه أصلا. والثانية أن يكون ذهبا مقاربا لا في غاية رتبته العليا، ولا كذلك الذهب الإبريز الخالص. والثالثة: أن يكون ذهبا كثير الغش لاختلاط النقرة والنحاس به. والرابعة: أن لا يكون ذهبا أصلا بل يكون جنسا على حدة مشبها بالذهب؛ فكذلك الإعتقادات التي هي مواد الأقيسة قد تكون اعتقادا مقاربا لليقين مقبولا عند الكافة في الظاهر، لا يشعر الذهن بإمكان نقيضه على القور بل بدقيق الفكر، فيسمى القياس المؤلف منه جدليا إذ يصلح لمناظرات الخصوم وقد يكون إعتقادا بحيث لا يقع به تصديق جزم، ولكن غالب ظن وقناعة نفس مع خطور نقيضه بالبال أو قبول النفس لنقيضه إن أخطر بالبال، وإن وقعت الغفلة عنه في أكثر الاحوال،
ويسمى القياس المؤلف منه خطابيا إذ يصلح لللإيراد في التعليمات والمخاطبات، وقد يكون تارة مشبها باليقين أو بالمشهور المقارب لليقين في الظاهر وليس بالحقيقة كذلك، وهو الجهل المحض، ويسمى القياس المؤلف منه مغالطيا وسوفسطائيا إذ لا يقصد بذلك إلا المغالطة والسفسطة، وهو إبطال الحقائق؛ فهذه أربعة مراتب لا بد من تمييز البعض منها عن البعض. وأما الخامس الذي يسمى قياسا شعريا فليس يدخل في غرضنا فإنه لا يذكرلإفادة علم أو ظن، بل المخاطب قد يعلم حقيقته، وإنما يذكر لترغيب أو تنفير أوتسخية أو تبخيل أو ترهيب أو تشجيع، وله تأثير في النفس، وذلك كنفرة الطبع عن الحلو الأصفر إذا شبه بالعذرة حتى يتعذر في الحال تناولها وإن علم كذب قائله، وعليه تمويل صناعة الشعر، وبه تشبث أكثر المتشدقين من الوعاظ، فإنهم يستعملون في النثر صناعة الشعر، ومثاله أن من يريد أن يحمل غيره على التهور ويصرفه عن الحزم يلقب الحزم بالجبن ويقبحه، ويذم صاحبه فيقول: يرى الجبناء أن الجبن حزم ... وتلك خديعة النفس اللئيم فتنبسط نفس المتوقف إلى التهجيم بذلك. وكقوله: إن لم أمت تحت السيوف مكرما ... أمت وأقاسي الذل غير مكرم
وكذلك إذا أراد التسخية أطنب في مدح السخي وشبهه بما يعلم انه لا يشبهه، ولكن يؤثر في نفسه كقوله:؟؟ وكذلك إذا أراد التسخية اطنب في مدح السخي وشبهه بما يعلم أنه لا يشبهه، ولكن يؤثر في نفسه كقوله: هو البحر من أي الجوانب جئته ... فلجته المعروف والجود ساحله تعوّد بسط الكف حتى لو أنه ... دعاها لقبض لم تطعه أنامله تراه إذا ما جئته متهللا ... كأنك تعطيه الذي أنت سائله ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله آمله وهذه الكلمات كلها أحاديث يعلم حقيقة كذبها، ولكنها تؤثر في النفس تأثيرا عجيبا لا ينكر. وإذ ليس يتعلق هذا الجنس بغرضنا فلنهجر الأطناب فيه ولنرجع إلى الأقسام الأربعة، وإذ قد قبحنا حال الشعر فلا ينبغي أن نتظن أن كل شعر باطل، فإن من الشعر لحكمة، وإن من البيان لسحرا، وقد يدرج الحق في وزن الشعر فلا يخرج عن كونه حقا كقول الشاعر في تهجين البخل ومن ينفق الساعات في جمع ماله ... مخافة فقر فالذي فعل الفقر. فهذا كلام حق صادق ومؤثر في النفس، والوزن اللطيف والنظم الخفيف يروجه ويزيد وقعه في النفس، فلا تنظر إلى صورة الشعر ولاحظ المعاني في الأمور كلها لتكون على الصراط المستقيم. ولنرجع إلى الغرض فنقول: المقدمات تنقسم إلى يقينيات صادقة واجبة القبول وإلى غيرها. وللقسم الأول باعتبار المدرك أربعة أصناف: الصنف الأول: ألأوليات العقلية المحضة، وهي قضايا تحدث في الإنسان من جهة قوته العقلية المجردة من غير معنى زائد عليها يوجب التصديق بها،
ولكن ذوات البسائط إذا حصلت في الذهن إما لمعونة الحس أو الخيال أو وجه آخر وجعلتها القوة المفكرة قضية بأن نسبت أحدها إلى الآخر بسلب أو إيجاب، صدق بها الذهن إضطرارا من غير أن يشعر بأنه من أين استفاد هذا التصديق، بل يقدر كأنه كان عالما به على الدوام كقولنا: إن الإثنين أكثر من الواحد، والثلاثة مع الثلاثة ستة، وان الشيء الواحد لا يكون قديما وحديثا معا، وأن السلب والإيجاب معا لا يصدقان في شيء واحد فقط إلى نظائره. وهذا الجنس من العلوم لا يتوقف الذهن في التصديق به إلا على تصور البسائط، أعني الحدود والذوات المفردة، فمهما تصور الذوات وتفطن للتركيب لم يتوقف في التصديق، وربما يحتاج توقف حتى يتفطن لمعنى الحادث والقديم، ولكن بعد معرفتهما لا يتوقف في الحكم بالتصديق. الصنف الثاني المحسوسات كقولنا: القمر مستدير والشمس منيرة والكواكب كثيرة والكافور أبيض والفحم أسود والنار حارة والثلج بارد، فإن العقل المجرد إذا لم يقترن بالحواس لم يقض بهذه القضايا، وإنما أدركها بواسطة الحواس، وهذه أوليات حسية. ومن هذا القبيل علمنا بأن لنا فكرا وخوفا وغضبا وشهوة وإدراكا وإحساسا، فإن ذلك انكشف للنفس أيضا بمساعدة قوى باطنة، فكأنه يقع متأخرا عن القضايا التي صدق بها العقل من غير حاجة إلى قوة أخرى سوى العقل.
ولا شكل في صدق المحسوسات إذا استثنيت أمور عارضة، مثل ضعف الحس وبعد المحسوس وكثافة الوسائط. الصنف الثالث المجربات وهي أمور وقع التصديق بها من الحس بمعاونة قياس خفي، كحكمنا بأن الضرب مؤلم للحيوان، والقطع مؤلم، وجز الرقبة مهلك، والسقمونيا مسهل، والخبز مشبع، والماء مرو، والنار محرقة؛ فإنالحس أدرك الموت مع جز الرقبة، وعرف التألم عند القطع بهيئات في المضروب، وتكرر ذلك على الذكر فتأكد منه عقد قوي لا يشك فيه، وليس علينا ذكر السبب في حصول اليقين بعد أن عرفنا أنه يقيني،
وربما أوجبت التجربة قضاء جزميا وربما أوجبت قضاء أكثريا، ولا تخلو عن قوة قياسية خفية تخالط المشاهداتن وهي أنه لو كان هذا الأمر اتفاقيا أوعرضيا غير لازم لما استمر في الأكثر من غير اختلاف، حتى إذا لم يوجد ذلك اللازم استبعدت النفس تأخره عنه وعدته نادرا، وطلبت له سببا عارضا مانعا. وإذا اجتمع هذا الإحساس متكررا مرة بعد أخرى، ولا ينضبط عدد
المرات كما لا ينضبط عدد المخبرين في التواتر، فإن كل واقعة ههنا مثل شاهد مخبر، وانضم إليه القياس الذي ذكرناه أذعنت النفس للتصديق. فإن قال قائل: كيف تعتقدون هذا يقينا، والمتكلمون شكوا فيه وقالوا: ليس الجز سببا للموت، ولا الأكل سببا للشبع، ولا النار علة للإحراق،
ولكن الله تعالى يخلق الإحتراق والموت والشبع عند جريان هذه الأمور لا بها؟ قلنا: قد نبهنا على غور هذا الفصل وحقيقته في كتاب تهافت الفلاسفة. والقدر المحتاج إليه الآن أن المتكلم إذا اخبره بأن ولده جزت رقبته لم يشك في موته، وليس في العقلاء من يشك فيه، وهو معترف بحصول الموت وباحث عن وجه الإقتران. وأما النظر في أنه هل هو لزوم ضروري ليس في الإمكان تغييره أو هو بحكم جريان سنة الله تعالى لنفوذ مشيئته الأزلية، التي لا تحتمل التبديل والتغيير، فهو نظر في وجه الإقتران لا في نفس الإقتران، فليفهم هذا وليعلم أن التشكك في موت من جزت رقبته وسواس مجرد، وأن اعتقاد موته يقين لا يستراب فيه، ومن قبيل المجربات الحدسيات، وهي قضايا مبدأ الحكم بها حدس من النفس يقع لصفاء الذهن وقوته وتوليه الشهادة لأمور، فتذعن النفس لقبوله والتصديق له بحيث لا يقدر على التشكك فيه، ولكن لو نازع فيه منازع معتقدا أو معاندا لم يمكن أن يعرف به ما لم يقو حدسه ولم يتول الإعتقاد الذي تولاه ذو الحدس القوي، وذلك مثل قضائنا بأن نور القمر مستفاد من للشمس، وأن انعكاس شعاعه إلى العالم يضاهي انعكاس شعاع المرآة إلى سائر الأجسام التي تقابله، وذلك لإختلاف تشكله عند اختلاف نسبته من الشمس قربا وبعدا وتوسطا. ومن تأمل شواهد ذلك لم يبق له فيه ريبة وفيه من القياس ما في المجربات، فإن هذه الإختلافات لو كانت بالإتفاق أو بأمر خارج سوى الشمس لما استمرت على نمط واحد على طول الزمن،
ومن مارس العلوم يحصل لهمن هذا الجنس على طريق الحدس والإعتبار قضايا كثيرة لا يمكنه إقامة البرهان عليها، ولا يمكنه أن يشك فيها، ولا يمكنه أن يشرك فيها غيره بالتعليم، إلا أن يدل الطالب على الطريق الذي سلكه واستنهجه، حتى إذا تولى السلوك بنفسه أفضاه ذلك السلوك إلى ذلك الإعتقاد وإن كان ذهنه في القوة والصفاء على رتبة الكمال. ولمثل هذا لا يمكن افحام كل مجادل بكلام مسكت، فلا ينبغي أن تطمع في القدرة على المجادلة في كل حق، فمن الإعتقادات اليقينية ما لا نقدر على تعريفه غيرنا بطريق البرهان إلا إذا شاركنا في ممارسته ليشاركنا في العلوم المستفادة منه، وفي مثل هذا المقام يقال: من لم يذق لم يعرف، ومن لم يصل لم يدرك. الصنف الرابع القضايا التي عرفت لا بفنسها بل بوسط ولكن لا يعزب عن الذهن أوساطها، بل مهما احضر جزئي المطلوب حضر التصديق به لحضور الوسط معه كقولنا: الإثنان ثلث الستة، فإن هذا معلوم بوسط وهو أن كل منقسم ثلاثة أقسام متساوية، فأحد الأقسام ثلث والستة تنقسم بالإثنينات ثلاثة أقسام متساوية، فالإثنان إذن ثلث الستة، ولكن هذا الوسط لا يعزب عن الذهن لمقلة هذا العدد وتعود الإنسان التأمل فيه، حتى لو قيل لك: الإثنان والعشرون هي هي ثلث ستة وستين؟ لم تبادر إليه مبادرتك إلى الحكم بأن الإثنين ثلث الستة، بل ربما افتقرت نإلى أن تقسم الستة والستين على ثلاثة،
فإذا انقسمت وحصل أن كل قسم إثنان وعشرون عرفت أن ذلك ثلثه، وهكذا كلما كثر الحساب؛ فهذا وإن كان معلوما برأي ثاني لا بالرأي الأول ولكنه ليس يحتاج فيه إلى تأمل، فهو جار مجرى الأوليات فيصلح لأن يكون من مواد الأقيسة. بل القضايا التي هي نتائج أقيسة ألفت من مقدمات هي من الأصناف الثلاثة السابقة تصلح أن تكون مواد أقيسة ومقدماتها. ؟ القسم الثاني المقدمات التي ليست يقينية ولا تصلح للبراهين، وهي نوعان: نوع يصلح للظنيات الفقهية، ونوع لا يصلح لذلك أيضا. النوع الأول وهو الصالح للفقهيات دون اليقينيات وهي ثلاثة أصناف: مشهورات ومقبولات ومظنونات. الصنف الأول المشهورات مثل حكمنا بحسن إفشاء السلام، وإطعام الطعام وصلة الأرحام وملازمة الصدق في الكلام ومراعاة العدل في القضايا والأحكام، وحكمنا بقبح إيذاء الإنسان وقتل الحيوان ووضع البهتان ورضاء الأزواج بفجور النسوان ومقابلة النعمة بالكفران والطغيان، وهذه قضايا لو خلي الإنسان وعقله المجرد ووهمه وحسه، لما قضى الذهن به قضاء بمجرد العقل والحس، ولكن إنما قضى بها لأسباب عارضة أكدت في النفس هذه القضايا وأثبتتها؛ وهي خمسة: أولها رقة القلب بحكم الغريزة وذلك في حق أكثر الناس حتى سبق إلى وهم قوم أن ذبح الحيوان قبيح عقلا، ولولا أن سياءة الشرع صرفت الناس
عن ذلك إلى تحسين الذبح وجعله قربنا، لعم هذا الإعتقاد أكثر الناس. ومن هذا أشكل على المعتزلة وأكثر الفرق وجه العدل في إيلام البهائم بالذبح والمجانين بالمرض، وزعموا بحكم رقة طباعهم أن ذلك قبيح، فمنهم من اعتذر بانها ستعوض عليها بعد الحشر في الدار الآخرة. ولم ينتبه هؤلاء لقبح صفع الملك ضعيفا ليعطيه رغيفا، مهما قدر على إعطائه دون الصفع، واعتذر فرق بأنها عقوبات على جنايات قارفوها وهم محكلفون وردوا بطريق التناسخ بعد الموت إلى هذه القوالب ليعذبوا فيها، ولم يعلموا أن عقوبة منلا يعرف أنه معاقب فينزجر بسببه قبيح. وإن زعموا أنها تعرف كونها معاقبة على جنايات سبقت كان لها قوة مفكرة، ويلزم عليه تجويز معرفة الذبان والديدان حقائق الأمور وجميع العلوم الهندسية والفلسفية، وهو مناكرة للمحسوس، ثم مهما لم يكن للمعاقب غرض في إنتقام أو تشفي أو دفع ضر في
المستقبل أو لم يكن للمعاقب مصلحة فهو أيضا قبيح، والله قادر على إفاضة النعم على الخلق من غير إيلام، ومن غير تكليف وإلزام، فايذاؤهم بالتكليف أولا وبالعقوبة آخرا أحرى بأن يكون قبيحا مما ذكروه، وجعلوه قبيحا من إيلام البريء عن الجنايات. السبب الثاني ما جبل عليه الإنسان من الحمية والأنفة، ولأجله يحكم باستقباح الرضا بفجور امرأته، ويظن أن هذا حكم ضروري للعقل مع أن جماعة من الناس يتعودون إجارة أزواجهم ليألفوا ذلك ولا ينفروا عنه، بل جميع الزناة يستحسنون الفجور بمرأة الغير ولا يستقبحونه لموافقة شهواتهم، ويستقبحون من ينبه الأزواج عليه ويعرفهم فعل الزناة، ويزعمون أن ذلك غمز وسعاية ونميمة، وهو في غاية القبح. وأهل الصلاح يقولون: هو خيانة وترك الأمانة؛ فتتناقض أحكامهم في الحسن والقبح ويزعمون أنها قضايا العقل، وإنما منشأها هذه الأخلاق التي جبل الإنسان عليها. السبب الثالث محبة التسالم والتصالح والتعاون على المعايش، ولذلك يحسن عندهم التودد بإفشاء السلام وإطعام الطعام ويقبح لديهم السب والتنفير ومقابلة النعمة بالكفران وأمثاله،
ولولا ميلهم إلى أمور تنهض هذه الأسباب وسائل إليها أو صوارف عنها، لما قضت العقول بفطرتها في هذه الأمور بحسن ولا قبح، ولذلك نرى جماعة لا يحبون التسالم ويميلون إلى التغالب، فألذ الأشياء وأحسنها عندهم الغارة والنهب والقتل والفتك. السبب الرابع التأديبات الشرعية لإصلاح الناس، فإنها لكونها تكررت على الأسماع منذ الصبا بلسان الآباء والمعلمين ووقع النشء عليها، رسخت تلك الإعتقادات رسوخا أدى إلى الظن بأنها عقلية كحسن الركوع والسجود والتقرب بذبح البهائم وإراقة دمائها، وهذه الأمور لو غوفص بها العاقل الذي لم يؤدب بقبولها منذ الصبا لكان مجرد عقله لا يقضي بحسن ولا بقبح، ولكن حسنت بتحسين الشرع فاذعن الوهم لقبولها بالتأديب منذ الصبا. السبب الخامس الإستقراء للجزئيات الكثيرة، فإن الشيء متى وجد مقرونا بالشيء في أكثر أحواله ظن أنه ملازم له على الإطلاق، كما يحكم على إفشاء السلام بالحسن مطلقا، لأنه يحسن في أكثر الأحوال ويذهل عن قبحه في وقت قضاء الحاجة، ويحكم على الصدق بالحسن لوجوده موافقا للأغراض مرغوبا في أكثر الأحوالن ويغفل عن قبحه ممن سئل عن مكان نبي أو ولي ليجده السائل فيقتله، بل ربما اعتقد قبح الكذب حينئذ بإخفاء المحل المصادفة الكذب مقرونا بالقبح في أكثر الأحوال. فهذه الأسباب وأمثالها علل قضاء النفس بهذه القضايا وليست هذه القضايا صادقة كلها ولا كاذنبةكلها، ولكن المقصود أن ما هو صادق منها فليس بين الصدق عند العقل بيانا أوليا، بل يفتقر في تحقيق صدقه إلى نظر وإن كان محمودا عند العقل الأول، والصادق غير المحمود، والكاذب غير الشنيع. ورب شنيع حق، ورب محمود كاذب،
وقد يكون المحمود صادقا لكن بشرط دقيق لا يتفطن أكثر الناس له، فيؤخذ على الإطلاق مع أنه لا يكون صادقا إلا مع ذلك الشرط كقولنا: الصدق حسن، وليس كذلك مطلقا بل بشروط، ولفقد بعض الشروط قبح الصدق الذي هو تعريف لموضع النبي المقصود قتله إلى غير ذلك من نظائره. ومهما أردت أن تعرف الفرق بين هذه القضايا المشهورات وبين الأوليات العقلية، فأعرض قولنا: قتل الإنسان قبيح وإنقاذه من الهلاك جميل، على عقلك بعد أن تقدر كأنك حصلت في الدنيا دفعة بالغا عاقلا، ولم تسمع قط تأديبا ولم تعاشر أمة ولم تعهد ترتيبا وسياسة، لكنك شاهدت المحسوسات وأخذت منها الخيالات، فيمكنك التشكيك في هذه المقدمات أو التوقف فيها ولا يمكنك التوقف في قولنا أن السلب والإيجاب لا يصدقان في حال واحدة، وأن الإثنين أكثر من الواحد، فإذن هذه المقدمات لما كانت قريبة من الصدق محتملة الكذب لم تصلح للبراهين التي يطلب منها اليقين وصلحت للفقهيات. الصنف الثاني المقبولات وهي أمور إعتقدناها بتصديق من أخبرنا بها من جماعة ينقص عددهم عن عدد التواتر، أو شخص واحد تميز عن غيره بعدالة ظاهرة أوعلم وافر، كالذي قبلناه من آبائنا وأستاذينا وأئمتنا واستمررنا على إعتقاد، وكأخبار الآحاد في الشرع، فهي تصلح للمقاييس الفقهية دون البراهين العقلية، ولها في إثارة الظن مراتب لا تكاد تخفي؛ فليس المستفيض في الكتب
الصحاح من الأحاديث كالذي ينقله الواحد، ولا ما ينقله أحد الخلفاء الراشدين كما ينقله غيره، ودرجات الظن فيه لا تحصى. الصنف الثالث المظنونات وهي أمور يقع التصديق بها لا على الثبات بل مع خطور إمكان نقيضها بالبال، ولكن النفس إليها أميل كقولنا: إن فلانا إنما يخرج بالليل لريبة، فإن النفس تميل إليه ميلا يبنى عليه التدبير للأفعال، وهي مع ذلك تشعر بإمكان نقيضه، والمشهورات والمقبولات إذا اعتبرت من حيث يشعر بنقيضها في بعض الأحوال، فيجوز أن تسمى مظنونة، وكم من مشهور في بادىء الرأي يورث اعتقادا، فإن تأملته وتعقبته عاد ذلك الإذعان لقبوله ظنا أو تكذيبا كقول القائل: ينبغي أن يمنع من ظلمه وينصر المظلوم عليه، وهو المراد بالحديث المعقول فيه، فإنه سئل عن ذلك فقيل: كيف ينصر الظالم؟ فقال: نصرته أن تمنعه من ظلمه. النوع الثاني ما لا يصلح للطقعيات ولا للظنيات بل لا يصلح إلا للتلبيس والمغالطة، وهي المشبهات أي المشبهة للأقسام الماضية في الظاهر ولا تكون منها، وهي ثلاثة أقسام: الأول الوهميات الصرفة وهي قضايا يقضي بها الوهم الإنساني قضاء جزما
بريا عن مقارنة ريب وشك، كحكمة في إبتداء فطرته بإستحالة وجود موجود لا إشارة إلى جهته، وأن موجودا قائما بنفسه لا يتصل بالعالم ولا ينفصل عنه، ولا يكون داخل العالم ولا خارجه محال، وهذا يشبه الأوليات العقلية مثل القضاء بان الشخص الواحد لا يكون في مكانين في آن واحد، والواحد أقل من الإثنين، وهي أقوى من المشهورات التي مثلناها بأن العدل جميل والجور قبيح، وهي مع هذه القوة كاذبة مهما كانت في أمور متقدمة على المحسوسات أو أعم منها، لأن الوهم إنس بالمحسوسات فيقضي لغير المحسوس بمثل ما ألفه في المحسوس. وعرف كونه كاذبا من مقدمات يصدق الوهم بآحادها لكن لا يذعن للنتيجة، إذ ليس في قوة الوهم إدراك مثلها وهذا أقوى المقدمات الكاذبة، فإن الفطرة الوهمية تحكم بها حسب حكمها في الأوليات العقلية، ولذلك إذا كانت الوهميات في المحسوسات كانت صادقة يقينية وصح الإعتماد عليها كالإعتماد على العقليات المحضة وعلى الحسيات. القسم الثاني ما يشبه المظنونات وإذا بحث عنه أمحى الظن كقول القائل: ينبغي أن تنصر أخاك ظالما كان أو مظلوما، وهو أيضا يشبه المشهورات. وقد يكون ما يشبه المشهورات أو المظنونات مما يتوافق عليه الخصمان في المناظرات من المسلمات، إما على سبيل الوضع وإما على سبيل الإعتقاد، ولكن إذا تكرر تسليمها على أسماع الحاضرين يأنسون بها وتميل نفوسهم
إلى الإذعان لها أكثر من الميل إلى التكذيب، فيعتقد أن ذلك الميل ظن لأن معنى الظن ميل في الإعتقاد، ولكنه ميل بسبب كإعتقادك أن من يخرج بالليل فيخرج لريبة، فإن ميل النفس إلى هذه التهمة لسبب. ولو كرر على سمع جماعة أن الأزرق الأشقر مثلا لا يكون إلا خائنا خبيثا فإذا رأوه كان ميل نفسهم إلى إعتقاد بل خيال محض بسبب بسبب السماع. ولذا قيل: من يسمع يخل. فبين هذا وبين الظنون المحقق فرق ويقرب من هذا المخيلات وهي تشبيه الشيء بشيء، مستقبح او مستحسن لمشاركته إياه في وصف ليس هو سبب القبح والحسن، فتميل النفس بسببه ميلا وليس ذلك من الظن في شيء، وهذا مع أنه أخس الرتب يحرك الناس إلى أكثر الأفعال، وعنه تصدر أكثر التصرفات من الخلق إقداما وإحجاما، وهي المقدمات الشعرية التي ذكرناها، فلا ترى عاقلا ينفك عن التأثر به حتى إن المرأة التي يخطبها الرجل إذا ذكر أن إسمها إسم بعض الهنود أو السودان المستقبحين نفر الطبع عنها لقبح الإسم، فيقاوم هذا الخيال الجمال ويورث محبة ما، وحتى إن علم الحساب والمنطق الذي ليس فيه تعرض للمذاهب بنفي ولا إثبات إذا قيل أنه من علوم الفلاسفة الملحدين، نفر طباع أهل الدين عنه، وهذا الميل والنفرة الصادران عن هذا الجنس ليسا بظن ولا علم، فلا يصلح ما يثيرهما أن يجعل مقدمة لا في القطعيات ولا في الظنيات والفقهيات.
ما يثيرهما ان يجعل مقدمة، لا فى القطعيات ولا فى الظنيات، والفقهيات. القسم الثالث الأغاليط الواقعة إما من لفظ المغلط أو من معنى اللفظ، كما يحصل من مقدمة صادقة في مسمة باسم مشترك فينقله الذهن عن ذلك المسمة إلى مسمى آخر بذلك الإسم عينه، حيث يدق وجه الإشتراك، كالنور إذا أخذ تارة لمعنى الضوء المبصر، وأخرى بالمعنى المراد من قوله تعالى: (الله نُورُ السَمَواتِ والأَرض) . وكذلك قد يكون من الذهول عن موضع وقف في الكلام كقوله تعالى: (وَما يَعلَمُ تَأويلَهُ إِلاّ الله وَالراسِخُونَ في العِلمِ يَقولُونَ آَمَنّا بِهِ) . فإذا أهمل الوقف على الله انعطف عليه قولهوالراسخون في العلم وحصلت مقدمة كاذبة. وقد يكون بالذهول عن الأعراب كقوله تعالى: (إِنّ الله بَريء مِنَ المُشرِكينَ ورَسُولُهُ) . فبالغفلة عن إعراب اللام من قوله ورسوله، ربما يقرأها القارىء بالكسر وتحصل مقدمة كاذبة ونظائر ذلك من حيث اللفظ كثير. وأما من حيث المعنى فمنها ما يحصل من تخيل العكس، فإنا إذا قلنا: كل قود فسببه عمد، فيظن أن كل عمد فهو سبب قود، فإن العمد رؤى ملازما للقود فظن أن القود أيضا ملازم للعمد، وهذا الجنس سباق إلى الفهم، ولا يزال الإنسان مع عدم التنبه لأصله ينخدع به ويسبق إلى تخيله من حيث لا يدري إلى أن ينبه عليه. ومنها ما سببه تنزيل لازم الشيء منزلة الشيء حتى إذا حكم على شيء بحكم ظن أنه يصح على لازمه، فإذا قيل: الصلاة طاعة وكل صلاة تفتقر إلى نية، ظن
أن كل طاعة تفتقر إلى نية من حيث ان الطاعة لازمة للصلاة وليس كذلك، فإن أصل الإيمان ومعرفة الله تعالى طاعة، ويستحيل إفتقارها إلى نية لأن نية التقرب إلى المعبود لا تتقدم على معرفة المعبود، وهذا أيضا كثير التغليط في العقليات والفقهيات، وأسباب الأغاليط مما يعسر إحصاؤها، وفيما ذكرناه تنبيه على ما لم نذكره. فإذن مجموع ما ذكرناه من أصناف هذه المقدمات التي سميناها عشرة: أربعة من القسم الأول وثلاثة من القسم الثاني، وهي مواد الفقهيات، وثلاثة من القسم الأخير وقد ذكرنا حكمها. فإن قال قائل: فبماذا تخالف العقليات الفقهيات؟ قلنا: لا مخالفة بينهما في صورة القياس وإنما يتخالفان في المادة ولا في كل مادة، بل ما يصلح أن يكون مقدمة في العقليات يصلح للفقهيات، ولكن قد يصلح للفقهيات ما لا يصلح للعقليات كالظنيات، وقد يؤخذ ما لا يصلح لهما جميعا كالمشبهات والمغلطات كما يتخالفان في كيفية ما به تصير المقدمة كلية، فإن المقدمات الجزئية في الفقه يتسامح بجعلها كلية، وإنما يدرك ذلك من أقوال صاحب الشرع وأفعاله، وأقوال أهل الإجماع وأقوال آحاد الصحابة أن رؤى ذلك من العقليات ما هو صريح في لفظه بين في طريقه، كالفظ الصريح المسموع من الشارع أو المنقول بطريق التواتر، فإن المتواتر كالمسموع.
فقوله: (ثَلاثَةَ أيامٍ في الحَجِّ وَسَبعَةٍ إذا رَجَعتُم) صريح في لفظه أعني كونه عشرة بين في طريقه، أعني أن القرآن متواتر وقد يكون بينا في طريقه ظاهرا في لفظه كالمراد من قوله: إذا رجعتم. وقد يكون صريحا في لفظه غير بين في طريقه كالنص الذي ينقله الآحاد من لفظ صاحب الشرع، وقد يكون عادما للقوتين كالظاهر الذي ينقله الآحاد. وجملة الألفاظ الشرعية في القضية الكلية والجزئية أربعة أقسام: الأول كلية أريد بها كلية كقوله كل مسكر حرام. الثاني جزئية بقيت جزئية كقوله في الذهب والإبريسم " هذان حرامان على ذكور أمتي " فإنه بقي مختصا بالذكور ولم يتعد إلى الإناث. والثالث كلية أريد بها جزئية كقوله: في سائمة الغنم زكاة، أريد بها ما بلغ نصابا. وقوله: (وَالسارِقُ وَالسارِقَةُ فاقطَعَوا أَيديَهُما) . المراد به بعض السارقين، فإذا أردنا أن نجعل هذه كلية ضممنا إليها الأوصاف التي بان إعتبارها فيه، وقلنا مثلا: كل من سرق نصابا كاملا من حرز مثله لا شبهة له فيه قطع. والنباش أو الذي يسرق الأشياء الرطبة مثلا بهذه الصفة فيقطع؛
هذا هو العادة. والصواب عندنا في مراسم جدل الفقه ان لا يفعل ذلك مهما وجد عموم لفظ، بل يتعلق بعموم اللفظ ويطالب الخصم بالمخصص، وما يدعي من ان الخصوص قد يتطرق إلىالعموم فليس مانعا من التمسك بالعموم على إصطلاح الفقهاء، وإذا اصطلحوا على هذا فالتمسك به أولى من إيراده في شكل قياس، لأنهم ليسوا يقبلون تخصيص العلة. ومهما قلت: كل من سرق نصابا كاملا من حرز مثله قطع، منع الخصم وقال: أهملت وصفا وهو أن لا يكون المسروق رطبا فما الذي عرفك أن هذا غير معتبر، فلا يبقى لك إلا أن تعود إلى العموم وتقول: هوالأصل. ومن زاد وصفا فعلهي الدليل، فإذن التمسك بالعموم أولى إذا وجد. والرابع هو الجزئي الذي أريد به الكلي، فإنا كما نعبر بالعام عن الخاص فنقول: ليس في الأصدقاء خير، ونريد به بعضهم كذلك قد يطلق الخاص ونريد به العام كقوله تعالى: (وَمِنهُم مَن إِن تَأمَنهُ بِدينارِ لا يُؤَدِهِ إليك) فإنه يراد به سائر أنواع أمواله. وكقوله: (وَمَن يَعمَل مِثقالَ ذَرَةٍ خَيراً يَرَه) فيعبر بالقليل عن الكثير، وكقوله تعالى: (وَلا تَقُل لَهُما أُفٍّ) فعبر عن كل ما فيه التبرم به. وكقوله تعالى: (وَلا تَأكلُوا أَموالَكُم بَينَكُم بِالباطِل
وَلا تَأكُلوا أَموال اليَتامى ظُلماً) . والمراد هو الإتلاف الذي أعم من الأكل، ولكن عبر بالأكل عنه. وكقول الشافعي: إذا نهشته حية أو عقرباء فإن كانت من حيات مصر أوعقارب نصيبين وجب القصاص. وليس غرضه التخصيص بل كل ما يكون قاتلا في الغالب، ولكن ذكر المشهور وعبر به عن الكل، فإذا ورد من هذا الجنس لفظ خاص ألغينا خصوصه وأخذنا المعنى الكلي المراد به وقلنا: كل تبرم بالوالدين فهو حرام، وكل إتلاف لمال اليتامى حرام؛ فيحصل معنا مقدمة كلية. فإن قيل: فالمعلوم بواقعة مخصوصة هل هو قضية كلية يفتقر تخصيصها إلى دليل أم هو جزئية فيفتقر تعميمها إلى دليل، وذلك كقوله للأعرابي: (اعتق رقبة) لما قال جامعت في نهار رمضان، وكرجمه ماعزا لما زنى، فهل ينزل ذلك منزلة قوله: كل من زنى فارجموه وكل من جامع أهله في نهار رمضان فليعتق رقبة؟ قلنا: هو كقولك: كل موصوف بصفة ماعز إذا زنى فارجموه، ولك موصوف بصفة الأعرابي إذا هلك وأهلك بجماع أهله في نهار رمضان فليعتق رقبو. ثم صفة الجماع هو الذي وصفه السائل والمعتبر من صفات الأعرابي ما عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم
حتى نزل ترك الإستفصال مع إمكان الإشكال منزلة عموم المقال، حتى إن لم يعرف أنه كان حرا أو عبدا كان هذا كالعوم في حق الحر والعبد، وإن عرف كونه حرا فالعبد ينبغي أن يتكلف الحاقه بان يظهر أنه لا يؤثر الرق بدفع موجبات العبادات، وإنما نزلنا هذا منزلة العام لأنه قد قال حكمي في الواحد حكمي في الجماعة. ولو كنا عرفنا من عاداته أنه يخصص كل شخص بحكم يخالف الآخر لما أقمنا هذا مقام العام، كمن يعلم من أصحاب الظواهر أن المراد بالجزئيات المذكورة في الربويات نفس تلك الجزئيات، ولهذا مزيد تفصيل لا يحتمله هذا الكتاب. وقد بينا عند النظر في صورة القياس، إن الحكم الخاص الجزئي إنما يجعل كليا بستة طرق، وهو بيان أن ما به الإفتراق ليس بمؤثر، وإن ما به الإجتماع هو المناسب أو المؤثر ليكون مناطا، وهو أبلغ في الكشف عن الغرض، وذلك لأن من الجزئيات ما يعلم أن المراد منها كلي، ومنها ما لا يعلم ذلك كمن لم يعلم من أصحاب الظواهر أن المراد بالجزئيات الست المذكورة في الربويات أمر أعم منها، وعرف كافة النظار أن المراد بالبر ليس هو البر بل معنى أعم منه، إذ بقي ربا البر بعد الطحن إذ صار دقيقا وفارقه إسم البر، فعلم أن المراد به وصف عام كلي اشترك فيه الدقيق والبر، ولكن الكلي العام قد يعرف بالبديهة من غير تأمل، كمعرفتنا بان المحرم هو التبرم العام دون التأفف الخاص، وقد يشك فيه كالبر، فإن الدقيق والبر يشتركان في كليات مثل الطعم والإقتيات والكيل والمالية، وإذا وقع الشك فيه لم يمكن إثباته إلا بأحد الطرق الستة التي ذكرناها، والله أعلم.
؟ النظر الثالث في المغلطات في القياس وفيه فصول ؟ الفصل الأول في حصر مثارات الغلط. إعلم أن المقدمات القياسية إذا ترتبت من حيث صورتها على ضرب منتج من الأشكال الثلاثة، وتفصلت منها الحدود الثلاثة أولا، وهي الأجزاء الأولى، إذ تميزت المقدمتان وهي الأجزاء الثواني، وكانت المقدمات صادقة وغير النتيجة واعرف منها، كان اللازم منها بالضرورة حقا لا ريب فيه، والذي لا يحصل منه الحق فإنما لا يحصل لخلل في هذه الجهات التي ذكرناها، إما لخروجه عن الأشكال أو لخروجه عن الضروب المنتجة منها، أو لعدم التمايز في الحدود أو في المقدمات أو لإدراج النتيجة في المقدمات فلا تكون غيرها، أو لأن النتيجة تكون متقدمة على إحدى المقدمات في المعرفة فلا تكون المقدمة أعرف من النتيجة فهذه سبع مثارات؛ فلنشرح كل واحد بمثال حتى يتيسر الإحتراز عنه فنقول: المثار الأول: أن لا تكون على شكل من الأشكال الثلاثة، بأن لا يكون من الحدود حد مشترك
إما موضوع فيهما أو محمول أوموضوع لأحدهما محول للآخر، فإذا انتفى الإشتراك حقيقة ولفظا لم يغلط الذهن فيه، فإن ذلك يظهر وإنما يغلط إذا وجد ما هو مشترك لفظا مع إختلاف المعنى، ولذلك وجب تحقيق القول في الألفاظ المشتركة لا سيما ما يشتبه منها بالمتواطئة، ويعسر فيها درك الفرق، وهو مثار عظيم للأغاليط. وقد ذكرنا تفصيل ذلك على الإيجاز في كتاب مقدمات القياس، إلا أنا لم نذكر ثم إلا الألفاظ التي لا يتحد معناها، وقد يكون الإشتراك سببه النظم والترتيب للألفاظ لا نفس الألفاظ ونحن نذكر من أمثلتها أربعة: ؟ الأول: ما ينشأ من مواضع الوقف والإبتداء كما ذكرنا من قوله تعالى: (إِلاّ الله وَالرَاسِخونَ في العِلم) إذ له معنيان مختلفان، فيطلق أمثاله في إحدى المقدمتين بمعنى وفي الثاني بمعنى آخر، فيبطل الحد المشترك ويظن أن ثم حد مشترك. ؟ الثاني: تردد الضمائر بين أشياء متعددة تحتمل الإنصراف إليها كقولك: كل ما علمه العاقل فهو كما علمه، والعاقل يعمل الحجر فهو كالحجر، فإن قولك: فهو متردد بين أن يكون راجعا إلى العاقل أو إلى المعقول، ويسلم في المقدمة على أنه راجع إلى المعقول، ويلبس في النتيجة فيخيل رجوعه إلى العاقل.
الثالث تردد الحروف الناسقة بين معنيين تصدق في أحدهما وتكذب في الآخر كقوله: الخمسة زوج وفرد، وهو صادق فيظن أنه يصدق قولنا أنه زوج وفرد معا، وسببه إشتباه دلالة الواو فإنه يدل على جمع الأجزاء، إذ تقول الإنسان عظم ولحم أي فيه عظم ولحم، ويدل على جمع الأوصاف كقولنا: الإنسان عظم ولحم أي فيه عظم ولحم، ويدل على جمع الأوصاف كقولنا: الإنسان حي وجسم، فإذن يصدق ما ذكرناه في الخمسة بطريق جمع الأجزاء لا بطريق جمع الصفات، واللفظ كاللفظ. الرابع تردد الصفة بين أن تكون صفة للموضوع وصفة للمحمول المذكور قبله، فإنا قد نقول: زيد بصير أي ليس بضرير. وتقول: زيد طبيب. وإذا نظمنا فقلنا زيد طبيب بصير، ظن أنه بصير في الطب، وهذه الألفاظ تصدق مفرقة وتصدق مجموعة على أحد التأويلين دون الآخر، وأمثال ذلك مما يكثر ويرتفع به شكل القياس من حيث لا يعرف وفيما ذكرناه غنية.
المثال الثاني ألا يكون على ضرب منتج من جملة ضروب الأشكال الثلاثة. مثاله قولك: قليل من الناس كاتب وكل عاقل، فقليل من الناس عاقل. وهذه النتيجة صادقة إن لم ترد بإثبات القليل نفي الكثير، فإن الكثير إذا كان عاقلا ففيه القليل، وإن أريد به أن القليل فقط هو كاتب وعاقل، اختلط نظم القياسس، إذ كان قوله قليل منالناس كاتب يشتمل على مقدمتين بالقوة: إحداهم بعض الناس كاتب، والأخرى إن ذلك البعض قليل، فهما محمولان على البعض. وقد حكم في المقدمة الثانية على أحد المحمولين وهو الكاتب دون الثاني فاختلط النظم، وكذلك إذا قلت: ممتنع أن يكون الإنسان حجرا، وممتنع أن يكون الحجر حيوانا، فممتنع أن يكون الإنسان حيوانا، لأن هذا الضرب ألف من سالبتين غير فيهما اللفظ السلبي، إذ قولك ممتنع أن يكون الإنسان حجرا
معناه لا إنسان واحد حجر، بل هذا القدر كاف لنفي النتيجة، فإن صغرى الشكل الأول مهما لم تكن موجبة لم ينتج أصلا، وإنما تكثر هذه الأغاليط إذا تشبث الذهن بالألفاظ دون أن يحصل المعاني بحقائقها. المثار الثالث: إلا تكون الحدود الثلاثة، وهي الأجزاء الأولى متمايزة متكاملة كقولك: كل إنسان بشرن وكل بشر حيوان، فكل إنسان حيوان. وقولك: كل خمر عقار، وكل عقار مسكر، فكل خمر مسكر. فإن الحد الأوسط هوالحد الأصغر بعينه، وإنما تعدد اللفظ. وهذا من إستعمال الألفاظ المترادفة وهي التي تختلف حروفها وتتساوى حدود معانيها المفهومة، وقد ذكرناها فليحترز منها أيضا. المثار الرابع: ألا تكون الأجزاء الثواني وهي المقدمات متفاضلة، وذلك لا يتفق في الألفاظ المفردة البسيطة إذ يظهر فيها محل الغلط، ولكن يتفق في الألفاظ المركبة، وكم من لفظ مركب يؤدي معنى قوته قوة الواحد أو يمكن أن يدل عليه بلفظ واحد، كما تقول:
الإنسان يمشي. ثم يمكنك أن تبدل لفظ الموضوع بالحيوان الناطق، ولفظ يمشي بأنه ينتقل بنقل قدميه من موضع إلى آخر حتى يطول اللفظ، ويمكنك أن تعين التلبيس فيه. ومن هذا القبيل قولنا: كل ما علمه المسلم، فهو كما علمه، والمسلم يعلم الكافر فهو إذن كالكافر، وهذه المقدمات متمايزة الحدود في الوضع ولكن الخلل في الإتساق، فإنه ترك التصريح بتفصيله، وإلا فقولك ما علمه المسلم موضوع، وقولك فهو كما علمه محمول، ولكن تردد معنى قولك هو، وقد يكون بحيث لا يتميز في الوضع بل يكون فيه جزء يحتمل أن يكون من الموضوع، وأن يكون من المحمول، فإنك تقول: زيد الطويل أبيض، فالمحمول هو الأبيض فقط، والطويل من الموضوع، ويمكن أن يذكر الطويل بصيغة الذي فيرجع إلى زيد بان تقول زيد الذي هو طويل أبيض؛ وإن قلت: زيد طويل أبيض، صار الطويل جزءا من المحمول، وإذا لم يذكر الذي يكون بحيث يحتمل أنيراد به الذي وألا يراد كما تقول الإنسانية من حيث هي إنسانية خاصة أو عامة،
فيحتمل أن يكون الموضوع الإنسانية المجردة والمحمول الخاصة، ويحتمل أن يكون الموضوع الإنسانية فحسب والمحمول الخاصة من حيث هي إنسانية، إذا لو قلت الإنسانية خاصة أو عامة لأخبرت عن شيء واحد. فإذا قلت: الإنسانية من حيث هي إنسانية خاصة أو عامة، أخبرت عن شيئين وكل خبر فهو محمول. ولهذا لو قلت: الإنسانية ليست من حيث هي إنسانية خاصة ولا عامة، صدق. ولو قلت: الإنسانية ليست خاصة ولا عامة، كذب ويفهم الفرق بينهما عند ذكرنا المعنى الكلي في أحكام الوجود، فيتشعب من هذه التركيبات المختلفة أغاليط يعسر حلها على حذاق النظار فضلا عن الظاهريين، ولا تخلص عن مكامن الغلط إلا بتوفيق الله فليستوفق الله تعالى الناظر في هذه العقبات حتى يسلم عن ظلماتها. المثار الخامس: أن تكون المقدمة كاذبة، وذلك لا يخلو غما أن يكون لإلتباس المعنى، فإن لم يكن ثم شيء من هذه الأسباب لم يذعن الذهن له ولم يصدق به، فليس كلام إلا فيما يغلط فيه العقلاء. فأما من يصدق بكل ما يسمع فهو فاسد المزاج، عسر كما إذا اشتركت لفظتان في معنى، وبينهما إفتراق في معنى دقيق، فيظن أن الحكم الذي ألفي صادقا على أحدهما على الآخر، ويقع الذهول عما فيه الإفتراق من زيادة معنى أو نقصانه مع اتحاد
المسمى، وذلك مما يكثر كلفظ الستر والخدر. ولا يقال خدر إلا إذا كان مشتملا على جاريةن وإلا فهو ستر، وكالبكاء والعويل ولا يقال عويل إلا إذا كان معه رفع صوت وإلا فهو بكاء، وقد يظن تساويهما، وكذا الثرى والتراب فإن الثرى هوالتراب ولكن بشرط النداوة، وكذلك المأذق والمضيق فإن المأذق هو المضيق ولكن لا يقال إلا في مواضع الحرب، وكذا الآبق والهارب فإن الآبق هو الهارب ولكن مع مزيد معنى في الهارب، وهو أن يكون من كد وخوف، فغن لم يكن سبب منفر فيسمى هاربا لا آبقا؛ وكما لا يقال لماء الفم رضاب إلا ما دام في الفم فإذا فارقه فهو بزاق، ولا يقال للشجاع كمي إلا إذا كان شاكي السلاح وإلا فهو بطل، ولا يقال للشمس الغزالة إلا عند إرتفاع النهار؛ فهذه الألفاظ متماثلة في الأصل وفيها نوع تفاوت، وقد يظن أن الحكم على أحدها حكم على الآخر فيصدق به لهذا السبب. وأما السبب المعنوي للتغليط فهو أن تكون المقدمة صادقة في البعض لا في الكل، فتؤخذ على أنها كلية وتصدق ويقع الذهول عن شرط صدقها، وأكثرها من سبق الوهم إلى العكس، فإنا إذا قلنا: " كل قود فبعمد وكل رجم فبزنا " فيظن أن كل عمد ففيه قود وإن كل زنا ففيه رجم، وهذا كثير التغليط لمن لم يتحفظ عنه، والذي يصدق في البعض دون الكل قد يكون بحيث يصدق في بعض
الموضوع كقولنا: الحيوان مكلف؛ فإنه يصدق في الإنسان دون غيره، وقد يصدق في كل الموضوع ولكن في بعض الأحوال كقولنا الإنسان مكلف، فإنه لا يصدق في حالة الصبا والجنون، وقد يصدق في بعض الأوقات كقولنا المكلف يلزمه الصلاة، فإنه لا يصدق في وقت الضحى إذ لا يجب فيه صلاة، وقد يصدق بشرط خفي كقولنا: المكلف يحرم عليه شرب الخمر، فإنه بشرط ألا يكون مكرها فيترك الشرط؛ وكذلك قولك: إذا قتل مظلوما هو مثل من قتل؛ وهو صحيح بشرط، أعني ألا يكون القاتل أبا والقتيل إبنا. فهذه الأمور لما كانت تصدق في الأكثر ولا تنتهض كلية صادقة إلا إذا قيدت بالشرط، فربما يذعن الذهن للتصديق ويسلمها على إنها كلية صادقة فيلزم منها نتائج كاذبة. المثار السادس: ان لا تكون المقدمات غير النتيجة فتصادر على المطلوب في المقدمات من حيث لا تدري، كقولك: إن المرأة مولى عليها فلا تلي عقد النكاح، وإذا طولبت بمعنى كونها مولى عليها ربما لم تتمكن من إظهار معنى سوى ما فيه النزاع.
وكذلك قول القائل: يصح التطوع بنية تنشأ نهارا لأنه صوم عين، وإذا طولب بتحقيق معنى كونه صومعين لم يستغن عن أن يجعل النتيجة جزءا منه، إذ يقال له: ما معنى كونه صوم عين؟ فيقول: إنه يصلح للتطوع. فيقال: وبهذا لا يثبت التعين إذ يصلح كل يوم قبل طلوع الفجر للقضاء، ولا يقال صوم عين. وإن قال: معناه أنه لا يصلح لغير التطوع، يقال: وبهذا لا يثبت التعين فإن الليل لا يصلح لغير التطوع، ولا يقال له عين فيضطر إلى ان يجمع بين المعنيين ويقول: معناه أنه يصلح للتطوع ولا يصلح لغيره فيقال: قوله يصلح للتطوع هو الحكم المطلوب علمه، فكيف جعله جزءا من العلة والعلة ينبغي أن تتقوم ذاتها دون الحكم؟ ثم يترتب عليها الحكم فيكون الحكم غير العلة، ونظائر هذا في العقليات تكثر فلذلك لم نذكره. المثار السابع: أن لا تكون المقدمات اعرف من النتيجة، بل تكون إما مساوية لها في المعرفة كالمتشايفات، وذلك من ينازع في كون زيد ابنا لعمرو فيقول: الدليل على أن زيدا ابن لعمرو وهو أن عمرا أبا لزيد، وهذا محال لأنهما يعلمان معا ولا يعلم أحدهما بالآخر، وكذلك من يثبت أن وصفا من الأوصاف علم بقوله: الدليل عليه أن المحل الذي قام به عالم. وهو هوس إذ لا يعلم كون المحل عالما إلا مع العلم يكون الحال في المحل علما.
وقد تكون المقدمة متأخرة في المعرفة عن النتيجة فيكون قياسا دوريان وأمثلته في العقليات كثيرة، وأما في الفقهيات فكأن يقول الحنفيك تبطل صلاة المتيمم إذا وجد الماء في خلالها لأنه قدر على الإستعمال، وكل من قدر على استعمال الماء لزمه، ومن يلزمه استعمال الماء فلا يجوز له ان يصلي بالتيمم، فيجعل القدرة على افستعمال حدا أوسط وبطلان الصلاة نتيجة فيقال: إن أردت به القدرة حسا فيبطل بما لو وجده مملوكا للغير، وإن أردت به القدرة شرعا فيقال: ما دامت الصلاة قائمة يحرم عليه الأفعال الكثيرة، فيحرم الإستعمال، فالقدرة شرعا تحصل ببطلان الصلاة، فالبطلان منتج للقدرة والقدرة سابقة عليه سبق العلة على المعلول، أعني بالذات لا بالزمان، فكيف جعل المتأخر في الرتبة علة لما هو متقدم في الرتبة وهو البطلان؟ فهذه مثارات الغلط وقد حصرناها في سبعة أقسام، ويتشعب كل قسم إلى وجوه كثيرة لا يمكن إحصاؤها. فإن قيل: فهذه مغلطات كثيرة فمن الذي يتخلص منها؟ قلنا: هذه المغلطات كلها لا تجتمع في كل قياس بل يكون مثار الغلط في كل قياس محصورا والإحتياط فيه ممكن، وكل من راعى الحدود الثلاثة وحصلها في ذهنه معاني لا ألفاظا، ثم حمل البعض على البعض وجعلها مقدمتين، وراعى توابع الحمل كما ذكرنا في شروط التناقض، وراعى شكل القياس علم قطعا أن النتيجة اللازمة حق لازم، فإن لم يثق به فليعاود المقدمات ووجه التصديق وشكل القياس وحدوده
مرة أو مرتين، كما يصنع الحساب في حسابه الذي يرتبه إذ يعاوده مرة أو مرتين، فإن فعل ذلك ولم تحصل له الثقة والطمأنينة إذ يعاوده مرة أو مرتين، فإن فعل ذلك ولم تحصل له الثقة والطمأنينة فليهجر النظر وليقنع بالتقليد، فلكل عمل رجال، وكل ميسر لما خلق له. الفصل الثاني في بيان خيال السوفسطانية فإن قال قائل: إذا كانت المقدمات ضرورية صادقة والعقول مشتملة عليها، وهذا الترتيب الذي ذكرتموه في صورة القياس أيضا واضح، فمن أين وقع للسوفسطائية إنكار العلوم والقول بتكافؤ الأدلة؟ أو من أين ثارت الإختلافات بين الناس في المعقولات؟ قلنا: أما وقوع الخلاف فلقصور أكثر الأفهام عن الشروط التي ذكرناها، ومن يتأملها لم يتعجب من مخالفة المخالف فيها، لا سيما وأدلة العقول تنساق إلى نتائج لا يذعن الوهم لها، بل يكذب بها لا كالعلوم الحسابية، فإن الوهم والعقل يتعاونان فيها، ثم من لا يعرف الأمور الحسابية يعرف أنه لا يعرفها، وإن غلط فيها، فلا يدوم غلطه بل يمكن إزالته على القرب. واما العلوم العقلية فليس كذلك، ثم من السوفسطائية من أنكر العلوم الأولية والحسية، كعلمنا بأن الإثنين أكثر من الواحد، وكعلمنا بوجودنا وأن الشيء الواحد إما أن يكون قديما او حادثا،
فهؤلاء دخلهم الخلل من سوء المزاج وفساد الذهن بكثرة التحير في النظريات. وأما الذين سلموا الضروريات وزعموا أن الأدلة متكافئة في النظريات فإنما حملهم عليه ما رأوا من تناقض أدلة فرق المتكلمين، وما اعتراهم في بعض المسائل من شبه وإشكالات عسر عليهم حلها، فظنوا أنها لا حل لها أصلا، ولم يحملوا ذلك على قصور نظرهم وضلالهم وقلة درايتهم بطريق النظر، ولم يتحققوا شرائط النظر كما قدمناه، ونحن نذكر جملة من خيالاتهم ونحلها ليعرف أن القصور ممن ليس يحسن حل الشبه، وإلا فكل أمر إما أن يعرف وجوده ويتحقق أو يعرف عدمه ويتحقق، أو يعلم أنه من جنس ما ليس للبشر معرفته ويتحقق ذلك أيضا، ومثارات خيالهم ثلاثة أقسام: الأول: ما يرجع إلى صورة القياس؛ فمنها قول القائل: إن من أظهر ما ذكرتموه قولكم أن السالبة الكلية تنعكس مثل نفسها، فإذا قلنا لا إنسان واحد حجر واحد إنسان، وتظنون أن هذا ضروري لا يتصور أنيختلف، وهو خطأ إذ حكم الحس به في موضع فظن أنه صادق في كل موضع. فإنا نقول: لا حائط واحد في وتد ولا نقول لا وتد واحد في حائط، ونقول: لا دن واحد في شراب، ولا نقول: لا شراب واحد دن، فنقول: نحن ادعينا أن ذات المحمول مهما عكس على ذات الموضوع بعينه اقتضى ما ذكرناه
كما نقول: لا دن واحد شراب فلا جرم يلزم بالضرورة إنه لا شراب واحد دن، لأن المباينة إذا وقعت فلا جرم يلزم بالضرورة إنه لا شراب واحد دن، لأن المباينة وقعت بين شيئين كلية كانت من الجانبين، إذ لو فرض الإتصال في البعض كذبت كون المباينة كلية، وهذا المثال لم يعكس على وجهه ولم يحصل المعنيات اللذان المباينة بينهما، فإذا حصل لزم العكس، فإنا إذا قلنا: لا حائط واحد في الوتد، فالمحمول قولنا في الوتد لامجرد الوتد، فإذا وقعت المباينة بين الحائط وبين الشيء الذي قدرناه في الوتد فعكسه لازم، وهو أن كل ما هو في الوتد فليس بحائط، فلا جرم نقول: لا شيء واحد مما هو في الوتد حائط ولا شيء واحد مما هو في الشراب دن، وحل هذا إنما يعسر على من يتلقى هذه الأمور من اللفظ لا من المعنى. وأكثر الأذهان يعسر عليها درك مجردات المعاني من غير التفات إلى الألفاظ. ومنها قول القائل: ادعيتم أن الموجبة الكلية تنعكس موجبة جزئية،
حتى إذا صح قولنا كل إنسان حيوان صح قولنا لا محالة بعض الحيوان إنسان. وليس كذلك فإنا نقول: كل شيخ قد كان شابا ولا نقول بعض الشبان قد كان شيخا، وكل خبز فقد كان برا ولا نقول بعض البر قد كان خبزا فنقول: مثار الغلط ترك الشرط في العكس، فإنه إذا أدخل بين الموضوع والمحمول قولنا قد كان، فإما أن يراعي في العكس وإما أن يلغى من كلتا القضيتين، فإن الغي هذا كذبت المقدمتان جميعا، وهو أن نقول كل شيخ حدث وكل حدث شيخ، وهو موضوع ومحمول مجرد، فإذا قلت: كل شيخ فقد كان شابا فعكسه بعض من كان شابا شيخ، وذلك مما يلزم لا محالة أن صدق الأول، فمن لم يتفطن لمثل هذه الأمور يضل فيحكم بلزوم الضلال في نفسه ويظن إلاّ طريق إلى معرفة الحق.
ومنها تشككهم في الشكل الأول وقولهم: أنكم ادعيتم كونه منتجا وقول القائل الإنسان وحده ضحاك وكل ضحاك حي فالإنسان وحده حي، فالنتيجة خطأ والشكل هو الشكل الأول فإنهما موجبتان كليتان، وإن جعلت قولنا الإنسان وحده ضحاك جزئية، جاز أن تكون هي الصغرى، ولا يشترط في الشكل الأول إلا كون الكبرى كلية فنقول منشأ الغلط ان قوله وحده لم يراع في المقدمة الثانية وأعيد في النتيجة، ولا يشترد في الشكل الأول إلا كون الكبرى كلية فنقول منشأ الغلط أن قوله وحده لم يراع في المقدمة الثانية وأعيد في النتيجة، فينبغي الإيعاد أيضا في النتيجة حتى يلزم أن الإنسان حي، أو يعاد في المقدمة الثانية حتى تصير كاذبة فيقال والضحاك وحده حي، فإن معنى قولنا الإنسان وحده ضحاك أن الإنسان دون غيره ضحاك، فهما على التحقيق مقدمتان: إحداهما أن الإنسان ضحاك، والأخرى أن غير الإنسان ليس بضحاك. فإذا قلت: والضحاك حي، حكمت على محمول إحدى المقدمتين، وهي قولك
الإنسان ضحاك وتركت الحكم على محمول المقدمة الثانية، وهي قولنا غير الإنسان ليس بضحاك، فإذا اقتصرت في إحدى المقدمتين على شيء فاقتصر في النتيجة عليه وقل الإنسان حي ولا تقل وحده، لأن الحكم يتعدى من الحد الأوسط إلى الأصغر مهما حكمت على الأوسط، والأوسط ههنا هو الضحاك مثبتا للإنسان منفيا عن غيره، فالحكم الذي على الضحاك ينبغي أن يكون محمول على جزئيه جميعا ولم تتعرض في المقدمة الثانية التي تذكر فيها محمول الأوسط للجزء الثاني من الأوسط؛ فمن أمثال هذا تضل الأذهان الضعيفة، والإنسان إذا تعذر عليه شيء لم تسمح نفسه بأن يحيل على عجز نفسه، فيظن أنه ممتنع في ذاته ويحكم بأن النظر ليس طريقا موصلا إلى اليقين وهو خطأ. ومنها قولهم: الإثنان ربع الثمانية، والثمانية ربع الإثنين والثلاثين، فالإثنان ربع الإثنين والثلاثين، وهذا من إهمال شرط الحمل في الإضافيات، وسببه ظاهر إذ نتيجة هذا أن الإثنين ربع ربع الإثنين والثلاثين، ثم إن صحت مقدمة أخرى وهي أن ربع الربع ربع، صح ما ذكروه.
وإذا قلنا: زيد مثل عمرو وعمرو مثل خالد، لم يلزم أن يكون زيد مثل خالد بل اللازم أن زيدا مثلا مثل مثل خالد، فإن صح لنا مقدمة أخرى وهي أن مثل المثل مثل، فعند ذلك تصح النتيجة فقد أهملوا مقدمة لا بد منها وهي كاذبة فليحترز عن مثله. ومنها قولهم: ممتنع أن يكون الإنسان حجرا وممتنع أن يكون الحجر حيان فممتنع ان يكون الإنسان حيا. وقد ذكرنا وجه الغلط فيه، وإنهما سالبتان لا ينتجان وضعا بصفة افيجاب، وكما أن الموجبة قد تظن سالبة في قولنا زيد غير بصير، فكذلك السالبة تظن موجبة في قولنا ممتنع أن يكون الإنسان حجرا؛ وكل ذلك لملاحظة الألفاظ دون تحقيق المعاني. ومنها قولهم: العظم لا في شيء من الكبد، والكبد في كل إنسان فالعظم لا في شيء من الإنسان، والنتيجة خطأ، فإذا تأملت هذا عرفت مثار الغلط فيه من الطريق الذي ذكرناه
وكذلك يتشكك في الشكل الثاني والثالث بأمثال ذلك، وبعد تعريف الطريق لا حاجة إلى تكثير الأمثلة؛ فهذه هي الشكوك في صورة القياس. القسم الثاني في الشكوك التي سببها الغلط في المقدمات. فمنها أنهم يقولون نرى أقيسة متناقضة، ولو كان القياس صحيحا لما تناقض موجبها. مثاله: من ادعى أن القوة المدبرة من الإنسان في القلب استدل عليه بأني وجدت الملك المدبر يتوطن وسط مملكته والقلب في وسط البدن. ومن ادعى أنهاف ي الدماغ استدل بأني وجدت أعالي الشيء أصفى وأحسن من أسافله والدماغ أعلى من القلب. ومثاله أيضا قول القائل: إن الرحيم لا يؤلم البريء عن الجناية، والله أرحم الراحمين فإذن لا يؤلم برئيا عن الجناية، وهذه النتيجة كاذبة إذ نرى أن الله تعالى يؤلم الحيوانات والبهائم والمجانين من غير جناية منهم، فنشك في قولنا أنه أرحم الراحمين، أو في قولن أن الريحم لا يؤلم من غير فائدة، مع القدرة على ترك الإيلام. ومثاله أيضا قول القائل: التنفس فعل إرادي كالمشي لا كالنبض، لأنا نقدر على الإمتناع منه؛ وقائل آخر يقول:
ليس بإرادي إذ لو كان إراديا لماكنا نتنفس في النوم ولكنا نقدر على الإمتناع منه في كل وقت أردنا كالمشي، ونحن لا نقدر على إمساك النفس في كل وقت فتناقض النتيجتان. ومثاله أيضا قولنا: أن كل موجود فأما متصل بالعالم وإما منفصل، وما ليس بمتصل ولا منفصل فليس بموجود، فهذا أولي. وقد ادعى جماعة بأقيسة مشهورة وأنتم منهم أن صانع العالم ليس داخل العالم ولا خارجه، فكيف يوثق بالقياس؟ وكذلك ادعى قوم أن الجوهر لا يتناهى في التجزي، ونحن نعلم ان كل ما له طرفان وهو محصور بينهما فهو متناهي، وكل جسم فله طرفان وهومحصور بينهما فهو إذن متناهي. وادعى قوم أنه يتناهى إلى جزء لا ينقسم، ونحن نعلم أن كل جوهر بين جوهرين فإنه يلاقي أحدهما بغير ما يلاقي به الآخر، فإذن فيه شيئان متغايران وهذا القياس أيضا قطعي كالأول بلا فرق ومثاله أيضا ما نعمل بالضرورة من أن الثقيل لا يقف في الهواء، وقد قال جماعة أن الأرض واقفة في الهواء والهواء محيط بها
والناس معتمدون عليها من الجوانب، حتى أن الواقفين على نقطتين متقابلتين من كرة الأرض تتقابل أخمص أقدامهما، ونحن بالضرورة نعلم ذلك؛ فهذا وأمثاله يدل على أن المقاييس ليست تورث الثقة واليقين، فنقول كما أن الأول شك نشأ من الجهل بصورة القياس فهذا نشأ من الجهل بمادة القياس، وهي المقدمات الصادقة اليقينية والفرق بينها وبين غيرها. فمهما سلم ما لا يجب أن يسلم لزم منه لا محالة نتائج متناقضة. فأما الأول من هذه الأمثلة فهو قياس ألف من مقدمات وعظيمة خطابية، إذ أخذ فيه شيء واحد ووجد على وجه فحكم به على الجميع. ونحن قد بينا ان الحكم على الجميع بجزئيات كثيرة ممتنع فكيف الحكم بجزئي واحد، بل إذا كثرت الجزئيات لم تفد إلا الظن، ثم لا يزال يزداد الظن قوة بكثرة الأمثلة ولكن لا ينتهي إلى العلم. وأما الثاني فمؤلف من مقدمات مشهورة جدلية سلم بعضها من حيث استبشع نقيضها، إما لما فيه من مخالفة الجماهير وإما لما فيه من مخالفة ظاهر لفظ القرآن، وكم من إنسان يسلم الشيء لأنه يستقبح منعه أو لأنه ينفر وهمه عن قبول نقيضه، وقد نبهنا على هذا في المقدمات. وموضع المنع فيه وصف الله بالرحمة على الوجه الظاهر الذي فهمه العامة، والله تعالى مقدس عنه، بل لفظ الرحمة والغضب مؤول في حقه كلفظ النزول والمجيء وغيرها، فإذا أخذ بالظاهر وسلم لا عن تحقيق لزمت النتيجة الكاذبة،
وكونه رحيما بالمعنى الذي تفهمه العامة مقدمة ليست أولية، وليس يدل عليها قياس بالشرط المذكور، فمحل الغلط ترك التأويل في مجل وجوبه، وعلىهذا ترى تناقض أكثر أقيسة المتكلمين، فإنهم ألفوها من مقدمات مسلمة لأجل الشهرة أو لتواضع المتعصبين لنصرة المذاهب عليها من غير برهان، ومن غير كونها أولية واجبة التسليم. وأما الثالث فاليقين والصحيح انه فعل إرادي، وقول من قال: لو كان إراديا لما كان يحصل في النوم ولكنه يحصل فيه فليس بإرادي، فهو شرطي متصل إستثنى فيه نقيض التالي واستنتج نقيض المقدم، فصورة القياس صحيحة ولكن لزوم التالي للمقدم غير مسلم، فإن الفعل الإرادي قد يحصل في النوم فكم من نائم يمشي خطوات مرتبة ويتكلم بكلمات منظومة، وقوله: لو كان إراديا لقدر على الإمتناع منه في كل وقت، فغير مسلم بل يأكل الإنسان ويبول بالإرادة ولا يقدر على الإمتناع في كل وقت، لكن يقدر علىالإمتناع في الجملة لا مقيدا بكل وقت، فإن قيد بكل وقت كان كاذبا ولم يسلم لزوم التالي للمقدم. وأما الرابع وهو أن كل موجود فأما متصل بالعالم أو منفصل، فهي مقدمة وهمية ذكرنا وجه الغلط فيها وميزنا الوهميات، وبينا أنها لا تصلح أن تجعل مقدمات في البراهين، وهو منشأ الضلال أيضا في مسألة الجزء الذي لا يتجزأ ولكن ذكر الموضع الذي يغلط الوهم فيه طويل يستقصى في كتاب غير هذا الكتاب. وأما الخامس وهووقوف الأرض في الهواء فلا استحالة فيه، وقول القائل: كل ثقيل فمائل إلى أسفل،
والأرض ثقيلى فينبغي أن تميل إلى أسفل، ومن ذلك يلزم أن تخرق الهواء ولا تقف، غلط منشأه إهمال لفظ الأسفل وأنه ما معناه، فغن الأسفل يقابله أعلى فلا بد من جهتين متقابلتين، وتقابل الجهتين إما أن يكون بالإضافة إلى رأس الآدمي ورجله حتى لو لم يكن آدمي لم يكن أسفل ولا أعلى ولو انتكس آدمي لصار جهة الأسفل أعلى وهو محال، وإما أن يكون الأسفل هو أبعد المواضع عن الفلك المحيط وهنوالمركز، والأعلى هو أقرب المواضع إلى المحيط، فإن صح هذا فالأرض إذا كانت في المركز فهي في أسفل سافلين، فلا يتصور أن تنتقل لأن أسفل سافلين غاية البعد عن المحيط وهوالمركز، ومهما جاوزت المركز في أي جانب كان، فارقت الأسفل إلى جهة الأعلى، فإن كان المعنى بالأسفل هذا فما ذكروه ليس بمحال، وأن كان المعنى بالأعلى والأسفل ما يحاذي جهة رأسنا وقدمنا فما ذكروه محالن فتأمل جدا حد الأسفل حتى يتبين لك أحد الأمرين، وإنما تعرف ذلك بالنظر في حقيقة الجهة وأنها بم تتحد أطرافها المتقابلة، ولا يمكن شرحه في هذا الكتاب. فإذن هذه الأغاليط نشأت من تسليم مقدمات ليست واجبة التسليم، ومثاراتها قد جرى التنبيه عليها، فليقس بما ذكرناه ما لم نذكره. القسم الثالث: شكوك تتعلق
بالنتيجة من وجه وبالمقدمة من وجه. منها قولهم: هذه النتائج إن حصلت من المقدمات فالمقدمات بماذا تحصل، وإن حصلت من مقدمات أخرى وجب التسلسل إلى غير النهاية وهو محال، وإن كانت حصلت من المقدمات التي تفتقر إلى مقدمات فهل هي علوم حاصلة في ذهننا منذ خلقنا، أو حصلت بعد أن لم تكن؟ فإن كانت حاصلة منذ خلقنا فكيف كانت حاصلة ولا نشعر بها، إذ ينقضي على الإنسان أطول عمره ولا يخطر بباله أن الأشياء المساوية لشيء واحد متساوية، فكيف يكون العلم بكونها متساوية حاصلا في ذهنه، وهو غافل عنه؟ وإن لم تكن حاصلة فينا أول الأمر ثم حدثت فكيف حدث علم لم يكن بغير اكتساب، وتقدم مقدمة يحصل بها وكل علم مكتسب فلا يمكن إلا بعلم قد سبق ويؤدي إلى التسلسل؟ قلناك كل علم مكتسب فبعلم قد سبق اكتسب، إذ العلم إما تصور أو تصديق، والتصور بالحد وأجزاء الحد ينبغي أن تعلم قبل الحد، فماذا ينفع قولنا في تحديد الخمر: إنه شراب مسكر معتصر من العنب لمن لا يعرف الشراب والمسكر والعنب والمعتصر؟ فالعلم بهذه الأجزاء سابق، ثم هي أيضا إن عرفت بالتحديد وجب أن يتقدمها علم بأجزاء الحد ويتسلسل، ولكن ينتهي إلى تصورات هي أوائل عرفت بالمشاهد بحس باطن أو ظاهر من غير تحديد، وعليها ينقطع. وكذلك التصديق بالنتيجة فإنه يستدعي تقدم العلم بالمقدمات لا محالة، وكذا المقدمات إلى ان يرتقي إلى أوائل حصل التصديق بها لا بالبرهان،
فيبقى قولهم: إن تلك الأوائل كيف كانت موجودة فينا ولا نشعر بها أو كيف حصلت بعد أن لم تكن من غير اكتساب ومتى حصلت؟ فنقول: تيك العلوم غير حاصلة بالفعل فينا في كل حال، ولكن إذا تمت غريزة العقل فتيك العلوم بالقوة لا بالفعل، ومعناه أن عندنا قوة تدرك الكليات المفردات بإعانة من الحس الظاهر والباطن، وقوة مفكرة حادثة للنفس شأنها التركيب والتحليل وتقدر على نسبة المفردات بعضها إلى بعض، وعندنا قوة تدرك ما أوقعت القوة المفكرة النسبة بنيهما من المفردات والنسبة بينهما بالسلب والإيجاب، فتدرك القديم والحادث وتنسب أحدهما إلى الآخر، فتسبق القوة العاقلة إلى الحكم بالسلب، وهو أن القديم لا يكون حادثا، وتنسب الحيوان إلى الإنسان فتقضي بأن النسبة بينهما الإيجاب، وهو أن الإنسان حيوان. وهذه القوة تدرك بعض هذه النسب من غير وسط، ولا تدرك بعضها فتتوقف إلى الوسط، كما تدرك العالم والحادث والنسبة بينهما، فلا تقضي بالسلب كما قضت بين القديم والحادث، ولا يالإيجاب كما قضت في الحيوان والإنسان، بل تتوقف إلى طلب وسط وهو أن تعرف انه لا يفارق الحوادث فلا يسبقها، وإن ما لا يسبق الحوادث فهو حادث. فإن قيل: فهذه التصديقات قسمتموها إلى ما يعرف بوسط وإلى ما يعرف معرفة اولية بغير وسط، ولكن هذه التصديقات يسبقها التصورات لا محالة، إذ لا يعلم أن
العالم حادث من لم يعلم الحادث مفردا والعالم مفردا، ولا يعلم الحادث إلا من علم وجودا مسبوقا بعدم، ولا يعلم الوجود المسبوق بعدم من لا يعلم العدم والوجود والتقدم والتأخر، وإن التقدم هنا هو للعدم والتأخر للوجود؛ فهذه المفردات لا بد من معرفتها، وإما مدركها فغن كان هذا الحس فالحس لا يدرك إلا شخصا واحدا فينبغي أن لا يكون التصديق إلا في شخص واحد، فإذا رأى شخصا وجملته اعظم من جزئه فلم يحكم بأن كل شخص فكله أعظم من جزئه، وهو لم يشاهد بحسه إلا شخصا معينا، فليحكخم على ذلك الشخص المعين وليتوقف في سائر الأشخاص إلى المشاهدة، وإن حكم على العموم بان كل فهو أعظم من الجزء، فمن أين له هذا الحكم وحسه لم يدرك إلا شخصا جزئيا؟ قلنا الكليات معقولة لا محسوسة والجزئيات محسوسة لا معقولة، والأحكام الكلية للعقل على الكليات المعقولة، وينكشف هذا بالفرق بين المعقول والمحسوس، فإن الإنسان معقول وهو محسوس يشاهد في شخص زيد مثلا، ونعني بكونه مدركا من وجهين أن الإنسان المحسوس قط لا يتصور أن يحس إلا مقرونا بلون مخصوص وقدر مخصوص ووضع مخصوص وقرب او بعد مخصوص، وهذه الأمور عرضية مقارنة للإنسانية ليست ذاتية فيها، فإنها لو تبدلت لكان الإنسان هو ذلك الإنسان. فأما الإنسان المعقول فهو إنسان فقط، يشترك فيه الطويل والقصير
والقريب والبعيد والأسود والبيض والأصغر والأكبر إشتراكا واحدا، فإذن عندك قوة يحضرها الإنسان مقترنا بامور غريبة عن الإنسانية، ولا يتصور أن تحضرها إلامقرونة بهذه الأمور الغريبة فتسمى تلك القوة حسا وخيالا، وعندك قوة أخرى يحضرها الإنسان مجردا عن الأمور الغريبة، وإن فرضت أضدادها لم تؤثر فيه وتسمى تلك قوة عاقلة، فقد ظهر لك أن بين إدراك الحس للشخص المعين الذي تكتنفه أعراض غريبة لا تدخل في ماهيته، وبين إدراك العقل بمجرد ماهية الشيء غير مقرون بما هو غريب عنه، غاية التباعد والأحكام الكلية على الماهية الكلية المجردة عن المواد والأعراض الغريبة. فإنقيل: وكيف حصل بمشاهدة شخص جزئي علم كلي؟ وكيف أعان الحس على تحصيل ما ليس بمحسوس؟ قلنا: الحس يؤدي إلى القوة الخيالية مثل المحسوسات وصورها حتى يرى الإنسان شيئا، ويغمض عينيه فيصادف صورة الشيء حاضرة عنده على طبق المشاهد، حتى كأنه ينظر إليه بالقوة الخيالية غير قوةالحس، وليست هذه القوة لكل الحيوانات بل من الحيوانات ما تغيب صورة المحسوس عنه بغيبة المحسوس، وإنما بقاء هذه الصور بالقوة الحافظة لما انطبع في الخيال، إذ ليس يحفظ الشيء ما يقبله بالقوة التي تقبله إذ الماء يقبل النقش ولا يحفظه، والشمع يقبل ويحفظ، فالقبول بالرطوبة والحفظ باليبوسة. ثم هذه المثالات والصور إذا حصلت في القوة الخيالية، فالقوة الخيالية
تطالعها ولا تطالع المحسوسات الخارجة، فإذا طالعتها وجدت عندها مثلا صورة شجرة وحيوان وحجر، فتجدها متفقة في الجسمية ومختلفة في الحيوانية، فتميز ما فيه الإتفاق وهو الجسمية وتجعله كليا واحدا، فتعقل الجسم المطلق وتأخذ ما فيه الإختلاف وهوالحيوانية وتجعله كليات اخرى مجردة عن غيرها من القرائن، ثم تعرف ما هو ذاتي وماهوغريب فتعلم أن الجسمية للحيوان ذاتي، إذ لو انعدم لانعدم ذاته، وأن البياض للحيوان ليس كذلك فيتميز عندها الذاتي من غير الذاتي والأعم عن الأخص، وتكون تلك مبادي التصورات النوعية؛ فهذه المفردات الكلية حاصلة بسبب الإحساس وليست محسوسة، ولا يتعجب من أن يحصل مع الإحساس ما ليس بمحسوس، فإن هذا موجود للبهائم إذ الفارة تميز السنور وتدركه بالحس وتعرف عداوته لها، والسخلة تدرك موافقة أمها لها فتتبعها. والعداوة او الموافقة ليست بمحسوس بل هي مدرك قوة عند الحيوان تسمى الوهم أو المميز، وهي للحيوان كالعقل من الجزئيات الخيالية مفردات كلية تناسب الخيال من وجه وتفارق من وجه،
وسنبين وجه مناسبته له ومفارقته في كتاب أحكام الوجود وأقسامه. وحاصل الكلام أن العلوم الأول بالمفردات تصورا وبما لها من النسب تصديقا، تحدث في النفس من الله تعالى أو من ملك من ملائكته عند حصول قوة العقل للنفس، وعند حصول مثل المحسوسات في الخيال ومطالعته لها، والقوة العقلية كأنها القوة الباصرة في العين ورؤية الجزئيات الخيالية كتحديق البصر إلى الأجسام المتلونة، وإشراق نور الملك على النفوس البشرية يضاهي إشراق نور السراج على الأجسام المتلونة أو إشراق نور الشمس عليها، وحصول العلم بنسبة تلك المفردات يضاهي حصول الأبصار بائتلاف ألوان الأجسام، ولذلك شبه الله تعالى هذا النور على طريق ضرب مثال محسوس بمشكاة فيها مصباح، وإن بان لك أن النفس جوهر قائم بنفسه ليس بجسم ولا هو منطبع في جسم كان قوله تعالى: (زيتونَةٍ لا شَرقِيَةٍ وَلا غَربِيَة) موافقة لحقيقته في براءته عن الجهات كلها، وإن لم يبين لك ذلك بطريق النظر فيكون تأويل هذا مثيل على وجه آخر. والمقصود من هذا كله أن يتضح لك وجه حصول العلوم الأولية تصورا وتصديقا، فإن معرفة ذلك من أهم الأمور وإياه قصدنا، وإن أوردناه في معرض إبطال السفسطة فهذا مدخل واحد من مداخل المتشككين وأهل الحيرة وقد كشفناه. ومنها قولهم: أن الطريق الذي ذكرتموه في الإنتاج لا ينتفع به، لأن من علم المقدمات على شرطكم فقد عرف النتيجة مع تلك المقدمات، بل في المقدمات عين النتيجة، فإن من عرف أن الإنسان حيوان
وأن الحيوان جسم، فيكون قد عرف في جملة ذلك أن الإنسان جسم، فلا يكون العلم بكونه جمسا علما زائدا مستفادا من هذه المقدمات. قلنا: العلم بالنتيجة علم ثابت زائد على العلم بالمقدمتين. وأما مثال الإنسان والحيوان فلا نورده إلا للمثال المحض، وإنما ينتفع بهب فيما يمكن أن يكون مطلوبا مشكلا، وليس هذا من هذا الجنس بل يمكن أن لا يتبين للإنسان النتيجة، وإن كان كل واحدة من المقدمتين بينة عنده فقد يعلم الإنسان أن كل جسم مؤلف، وأن كل مؤلف حادث، وهو مع ذلك غافل عن نسبة الحدوث إلى الجسم، وأن الجسم حادث فنسبة الحدوث إلى الجسم غير نسبة الحدوث إلى المؤلف، وغير نسبة المؤلف إلى الجسم بل هو علم حادث يحصل عند حصول المقدمتين وإحضارهما معا في الذهن، مع توجه النفس نحو طلب النتيجة.
فإن قال قائل: إذا عرفت ان كل اثنين زوج فهذا الذي في يدي زوج أم لا؟ فإن قلت: لا أدري فقد بطل دعواك بأن كل إثنين زوج، فإنه إثنان ولم تعرف أنه زوج، وإن قلت أعرفه فما هو؟ قلنا: قد يجاب عن هذا بأن من قال
أن كل اثنين زوج فيعني به أن كل إثنين نعرفه إثنين فهو زوج، وما في يدك لم نعرف أنه إثنان. وهذا الجواب فاسد بل كل إثنين فهو في نفسه زوج، سواء عرفناه أو لم نعرفه، لكن الجواب أن نقول: إن كان ما في يدك إثنين فهو زوج. فإن قلت: فهل هو إثنان فأقول: لا أدري. وهذا الجهل لا يضاد قولي إن كل اثنين زوج، بل ضده أن أقول: كل إثنين ليس بزوج أو بعض الإثنين ليس بزوج. فإذن ينبغي أن نتعرف أنه هل هو بزوج أو بعض الإثنين ليس بزوج. فإذن ينبغي أن نتعرف أنه هل هو إثنان، فإن عرفنا أنه إثنان علمنا انه زوج، وأخطرنا ذلك بالبال ويتصور أن تغفل عن النتيجة مع حضور المقدمتين، فكم من شخص ينظر إلى بغلة منتفخة البطن فيظن أنها حامل. ولو قيل له: أما تعلم أن هذه بغلة؟ فيقول: نعم. ولو قيل له: أما تعلم أن البغل لا يحمل؟ لقال: نعم. فلو قيل: فلم غفلت عن النتيجة وظننت ضدها؟ فيقول: لأني كنت غافلا عن تأليف المقدمتين وإحضارهما جميعا في الذهن متوجها إلى طلب
النتيجة؛ فقد انكشف بهذا أن النتيجة، وإن كانت داخلة تحت المقدمات بالقوة
دخول الجزئيات تحت الكليات، فهي علم زائد عليها بالفعل. ومنها قول بعض المتشككين: أنك لو طلبت بالتأمل علما فذلك العلم تعرفه أم لا، فإن عرفته فلم تطلبه وإن لم تعرفه فإن حصلته فمن أين تعلم أنه مطلوبك؟ وهل أنت إلا كمن يطلب عبدا آبقا لا يعرفه فإن وجده لم يعرف أنه هو أم لا؟ فنقول: العلم الذي نطلبه نعرفه من وجه ونجهله من وجه إذ نعرفه بالتصور بالفعل ونعرفه بالتصديق بالقوة، ونريد أن نعرفه بالتصديق بالفعل، فإنا إذا طلبنا العلم بأن العالم حادث فنعلم الحدوث والعالم بالتصور، وإنا قادرون على التصديق به إن ظهر حد أوسط بين العالم والحدوث، كمقارنة الحوادث أو غيرها؛ فإنا نعلم أن المقارن للحوادث حادث، فإن علمنا ان العالم مقارن للحوادث علمنا بالفعل أنه حادث، وإذا علمناه عرفنا أنه مطلوبنا إذ لو لم نعرفه بالتصور من قبل لما عرفنا أنه المطلوب، ولو كنا نصدق به بالفعل لما كنا نطلبه كالعبد الآبق نعرفه بالتصور والتخيل من وجه ونجهل مكانه، فإذا أدركه الحس في مكانه دفعة علمنا أنه المطلوب، ولو لم نكن نعرفه لما عرفناه عند الظفر به، فلو عرفناه من كل وجه أي عرفنا مكانه لما طلبناه؛ فهذا ما أردنا أن نورده من الشبه المشككة المحيرة للسوفسطائية، ولم يكن الغرض في إيراده مناظرتهم بل الكشف عن هذه الدقائق. فإن
طالب اليقين بمسالك البراهين ينتفع بمعرفتها غاية الإنتفاع، وإلا فالسوفسطائي كيف يناظر ومناظرته في نفسه إعتراف بطريق النظر، ولا ينبغي أن يتعجب من إعتقاد السفسطة والحيرة مع وضوح المعقولات، فإن ذلك لا يتفق إلا على الندور لمصاب في عقله بآفة؛ فإنا نشاهد جماعة من أرباب المذاهب هم السوفسطائية والناس غافلون عنهم، فكل من يناظر في إيجاب التقليد أو إبطال النظر سوفسطائي في الزجر عن النظر لا مستند لهم، إلا أن العقول لا ثقة بها والإختلاف فيها كثيرة، فسلوك طريق الأمن وهو التقليد أولى. فإذا قيل لهم: فهل قلدتم صدق نبيكم وتميزون بينه وبين الكاذب أم تقليدكم كتقليد اليهود والنصارى، فإن كان كتقليدهم فقد جوزتم كونكم مبطلين وهذا كفر عندكم، وإن لم تجوزوه فتعرفونه بالضرورة أو بنظر العقل، فإن عرفتموه بالنظر فقد أثبتم النظر. وقد اختلف الناس في هذا النظر وهو تصديق الأنبياء كمااختلفوا في سائر النظريات. وفي إثبات صدق الأنبياء بالمعجزات من الأغوار والأغماض ما لا يكاد يخفى على النظار، وبهذا الإعتقاد صاروا أخس رتبة من السوفسطائي فإنهم مثبتون بإنكار النظر ونافون إذ أثبتوا النظر في معرفة صدق النبي. وأما السوفسطائي فقد طرد قياسه في إنكار المعرفة الكلية، ومن هذا الجنس باطنية الزمان فإنهم خدعوا بكثرة الإختلافات بين النظار، ودعوا إلى اعتقاد بطلان نظر العقل ثم دعوا إلى تقليد أمامهم المعصوم. وإذا قيل لهم: بماذا عرفتم عصمة أمامكم وليس يمكن دعوى الضرورة فيه؟ دعوا فيه إلى أنواع من النظر يشترك إستعمالها في الظنيات، ولا تعرض على الإثنين إلا ويختلفان فيها، ولا يستدلون بكونه نظريا واقعا في محل الإختلاف على بطلانه،
ويحكمون على سائر النظريات بالبطلان لتطرق الخلاف فيها، وهذا وأمثاله سبب آفات تصيب العقل فيجري مجرى الجنون، ولكن لا يسمى جنونا والجنون فنون، والذين ينخدعون بأمثال هذه الخيالات هم أخس من أن نشتغل بمناظرتهم؛ فلنقتصر على ما ذكرناه في بيان أسباب الحيرة، والله اعلم.
؟ النظر الرابع في لواحق القياس وهي فصول متفرقة بمعرفتها تتم معرفة البراهين فصل في الفرق بين قياس العلة وقياس الدلالة إعلم أن الحد الأوسط إن كان علة للحد الأكبر سماه الفقهاء قياس العلة، وسماه المنطقيون برهان اللم أي ذكر ما يجاب به عن لم، وإن لم يكن علة سماه الفقهاء قياس الدلالة. والمنطقيون سموه برهان اأن أي هو دليل على أن الحد الأكبر موجود للأصغر من غير بيان علته. ومثال قياس العلة من المحسوسات قولك: هذه الخشبة محترقة لأنها أصابتها النار، وهذا الإنسان شبعان لأنه أكل الآن. وقياس الدلالة عكسه وهو أن يستدل بالنتيجة على المنتج فنقول: هذا شبعان فإذا هو قريب العهد بالأكل، وهذه المرأة ذات لبن فهي قريبة العهد بالولادة.
ومثاله من الفقه قولك: هذه عين نجسة فإذن لا تصح الصلاة معها، وقياس الدلالة عكسه وهو أن نقول هذه عين لا تصح الصلاة معها فإذن هي نجسة. وبالجملة الإستدلال بالنتيجة على المنتج يدل على وجوده فقط لا على علته، فإنا نستدل بحدوث العالم على وجود المحدث، وبوجود الكتابة المنظومة على علم الكاتب، ونجعل الكتابة حدا أوسط والعلم حدا أكبر، ونقول كل من كتب منظوما فهو عالم بالكتابة، والكتابة ليست علة للعلم بل العلم أولى بأن نقدر عليته. وكذلك إذا تلازمت نتيجتان بعلة واحدة جاز أن يستدل بإحدى النتيجتين على الأخرى فيكون قياس دلالة. ومثاله من الفقه قولنا: إن الزنا لا يوجب المحرمية فلا يوجب حرمة النكاح، فإن تحريم النكاح وحل النظر متلازمان، وهما نتيجتان للوطء المقتضي لحرمة المصاهرة، فإذا ثبت تلازمهما لعلة واحدة دل وجود إحداهما على وجود الأخرى، فإن اختلف شرطهما لم يمكن الإستدلال لإحتمال افتراقهما في الشرط، وكما انقسم قياس الدلالة إلى نوعين فقياس العلة أيضا ينقسم إلى قسمين: الأول: ما يكون الأوسط فيه علة للنتيجة ولا يكون علة لوجود الأكبر في نفسه، كقولنا:
كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم، فكل إنسان جسم. فالإنسان إنما كان جسما من قبل أنه حيوان والجسمية أولا للحيوان، ثم بسببه للإنسان، فإذا الحيوان علة لحمل الجسم على الإنسان لا لوجود الجسمية، فإن الجسمية تتقدم بالذات في ترتيب الأنواع والأجناس على الحيوان. واعلم أن ما ثبت للنوع من حمل الجنس عليه، وكذا جنس الجنس، وكذا الفصول والحود واللوازم إنما تكون من جهة الجنس، ويكون الجنس علة في حمله على النوع لا في وجود ذات المحمول أعني محمول النتيجة. والقسم الثاني: ما يكون علة لوجود الحد الأكبر على الإطلاق لا كهذا المثال، وقد لا يكون على الإطلاق كالشيء الذي له علل متعددة، فإن آحاد العلل لا يمكن أن تجعل علة للحد الأكبر مطلقا، بل هي علة في وقت مخصوص ومحل مخصوص، ومثاله في الفقه؛ إن العدوان علة للتأثيم على الإطلاق، والزنا علة للرجم على الإطلاق، والردة ليست علة للقتل على الإطلاق، فإن القتل يجب على سبيل القصاص وغيره، ولكن تكون علة للقتل في حق شخص مخصوص، وذلك لا يخرجه عن كونه قياس العلة. ؟ فصل في بيان اليقين البرهان الحقيقي ما يفيد شيئا لا يتصور تغيره، ويكون ذلك بحسب مقدمات البرهان فإنها تكون يقينية أبدية، لا تستحيل ولا تتغير أبدا، وأعني بذلك أن الشيء لا يتغير
وأن غفل إنسان عنه كقولنا: الكل أعظم من الجزء والأشياء المساوية لشيء واحد متساوية وأمثالها، فالنتيجة الحاصلة منها أيضا تكون يقينية، والعلم اليقيني هو أن تعرف أن الشيء بصفة كذا مقترنا بالتصديق بأنه لا يمكن ان لا يكون كذا، فإنك لو أخطرت ببالك إمكان الخطأ فيه والذهول عنه لم ينقدح ذلك في نفسك أصلا، فإن إقترن به تجوز الخطأ وإمكانه فليس بيقيني؛ فهكذا ينبغي أن تعرف نتائج البرهان، فإن عرفته معرفة على حد قولنا فقيل لك خلافه حكاية عن أعظم خلق الله مرتبة وأجلهم في النظر والعقليات درجة، وأورث ذلك عندك احتمالا، فليس اليقين تاما، بل لو نقل عن نبي صادق نقيضه فينبغي أن يقطع بكذب الناقل أو بتأويل اللفظ المسموع عنه، ولا يخطر ببالك إمكان الصدق، فإن لم يقبل التأويل فشك في نبوة من حكى عنه بخلاف ماعقلت إن كان ما عقلته يقينا فإن شككت في صدقه لم يكن يقينك تاما. فإن قلت: ربما ظهر لي برهان صدقة ثم سمعت منه ما يناقض برهانا قامعندي. فأقول: وجود هذا يستحيل كقول القائل لو تناقضت الأخبار المتواترة فما السبيل فيها كما لو تواتر وجود مكة وعدمها؟ فهذا محال، فالتناقض في البراهين الجامعة للشروط التي ذكرناها محال، فإن رأيتها متناقضة فاعلم أن أحدهما أو كلاهما لم يتحقق فيه الشروط المذكورة فتفقد مظان الغلط والمثارات السبع التي فصلناها، وأكثر الغلط يكون في المبادرة إلى تسليم مقدمات البرهان على أنها أولية ولا تكون أولية، بل ربما تكون محمودة مشهورة أو وهمية،
ولا ينبغي أن تسلم المقدمات ما لم يكن اليقين فيها على الحد الذي وصفناه. وكما يظن فيما ليست أولية أنها أولية فقد يظن بالأوليات أنها ليست أولية فيشكك فيها، ولا يتشكك في الأوليات إلا بزوال الذهن عن الفطرة السليمة، لمخالطة بعض المتكلمين المتعصبين للمذاهب الفاسدة بمجاحدة الجليات حتى تأنس النفس بسماعها فيشك في اليقيني، كما أنه قد يتكرر على سمعه ما ليس يقينا من المحمودات فتذعن للتصديق به وتظن أنه يقيني بكثرة سماعه، وهذا أعظم مثارات الغلط ويعز في العقلاء من يحسن الإحتراز من الإغترار به. فإن قلت فمثل هذا اليقين عزيز يقل وجوده فتقل به المقدمات. قلنا: ما يتساعد فيه الوهم والعقل من الحسابيات والهندسيات والحسيات كثير، فيكثر فيها مثل هذه اليقينيات، وكذا المعقولات التي لا تحاذيها الوهميات فأما العقليات الصرفة المتعلقة بالنظر في الإلهيات ففيها بعض مثل هذه اليقينيات، ولا يبلغ اليقين فيها إلى الحد الذي ذكرناه إلا بطول ممارسة العقليات، وفطام العقل عن الوهميات والحسيات وإيناسها بالعقليات المحضة، وكلما كان النظر فيها أكثر والجد في طلبها أتم كانت المعارف فيها إلى حد اليقين التام أقرب، ثم من طالت ممارسته وحصلت له ملكة بتلك المعارف لا يقدر على إفحام الخصم فيه ولا يقدر على تنزيل المسترشد منزلة نفسه، بمجرد ذكر ما عنده إلا بأن يرشده إلى أن يسلك مسلكه في ممارسة العلوم وطول التأمل حتى يصل إلى ما وصل إليه إن كان صحيح الحدس ثاقب العقل صافي الذكاء، وإن فارقه في الذكاء أو في الحدس أو تولي الإعتبار الذي تولاه لم يصل إلى ما وصل إليه، وعند ذلك يقابل ما يحكيه عن نفسه بالإنكار ويشتغل بالتهجين والإستبعاد، وسبيل العارف البصير أن يعرض عنه صفحا بل لا يبث إليه أسرار ما عنده، فإن ذلك أسلم لجانبه وأقطع لشغب الجهال، فما كل ما يرى يقال بل صدور الأحرار قبور الأسرار.
فصل في أمهات المطالب إعلم أن المطلوبات من العلوم بالسؤال عنها أربعة أقسام بسبب إنتساب كل واحد إلى الصيغة التي بها يسأل عنه: الأول: مطلب " هل " وهذا السؤال أعني صيغة هل، يتوجه نحو طلب وجود الشيء في نفسه كقولنا: الله موجود وهل الخلاء موجود؟ أو نحو وجود صفة أو حال لشيء كقولنا: هل الله مريد وهل العالم حادث؟ فيسمى الأول مطلب هل مطلقا والثاني مطلب هل مقيدا. والثاني: مطلب " ما " ويعرف به التصور دون التصديق، وذلك إما بحسب الإسم كقولك: ما الخلاء وما عنقاء مغرب؟ أي ما الذي تريد باسمه؟ وهذا يتقدم كل مطلب فإن من لم يفهم معنى العالم والحدوث لا يمكن أن يسأل: هل العالم موجود؟ ومن لم يتصور معنى الدال لا يمكنه أن يسأله عن وجود. وإما أن يكون الطلب بحسب حقيقة الذات كقولك: ما الإنسان وما العقار؟
وأنت تطلب به حده إذا عرفت أن المراد باسم العقار هو الخمر، وهذا يتأخر عن مطلب " هل " فإن من لا يعتقد للخمر وجودا لا يسأل عن حده. والثالث: مطلب " لم " وهو طلب العلة لجواب هل كقولك: لم كان العالم حادثا؟ وهو إما طلب علة التصديق كقولك: لم قلت أن الله موجود؟ فإنه لا يطلب العلة في وجوده بل العلة في وقوع التصديق بوجوده، وهو برهان الآن بلغة المنطقيين، وقياس الدلالة بلغة المتكلمين، وإما طلب علة الوجود كقولك لم حدث العالم؟ فنقول: لإرادة محدثة. والرابع مطلب: " أي " وهو الذي يطلب به تميز الشيء عما عداه، فهذه أمهات المطالب والأسئلة. فأما مطلب " أين ومتى وكيف " فليست من الأمهات فإنها داخلة بالقوة تحت مطلب " هل " المقيد إن وقع التفطن له بالسؤال بصيغة هل، وإن لم يقع كانت مطالب خارجة عما عددناها. فصل في بيان معنى الذاتي والأولي أما الذاتي فيطلق على وجهين: أحدهما أن يكون المحمول مأخوذا في حد الموضوع مقوما له داخلا في حقيقة كقولنا: الإنسان حيوان، فيقالك الحيوان ذاتي للإنسان أي هو مقوم له كما سبق بيانه.
وإما أن يكون الموضوع مأخوذا في حد المحمول كقولنا: بعض الحيوان إنسانن فإن المحمول هو الإنسان ههنا لا الحيوان، والإنسان لا يؤخذ في حد الحيوان بل الحيوان يؤخذ في حد الإنسان، فكل شيئين لا يؤخذ أحدهما في حد الآخر فليس أحدهما ذاتيا للآخر. وقد يمثل بالفطوسة في الأنف فإنه ذاتي للأنف بالمعنى الأخير، إذ لا يمكن تحديد الفطوسة إلا بذكر الأنف في حده. وأما الأولى فإنه يقال أيضا على وجهين: أحدهما ما هو أولي في العقل أي لا يحتاج في معرفته إلى وسط كقولنا: الإثنان أكثر من الواحد. والثاني أن يكون بحيث لا يمكن إيجاب المحمول أو سلبه على معنى آخر أعم من الموضوع؟ فإذا قلنا: الإنسان يمرض ويصح، لم يكن أوليا له بهذا المعنى إذ يقال على ما هو أعم منه وهو الحيوان: نعم هو للحيوان أولى، لأنه لا يقال على ما هو أعم منه، وهو الجسم؛ وكذلك قبول الإنتقال للحيوان ليس بأولى إذ يقال على ماهو أعم منه وهو الجسم، فإنه لو إرتفع الحيوان بقي قبول الإنتقال، ولو ارتفع الجسم لم يبق. فصل فيما يلتئم به أمر البراهين وهي ثلاثة: مبادي وموضوعات ومسائل. فالموضوعات نعني بها ما يبرهن فيها،
والمسائل ما يبرهن عليها، والمبادي ما يبرهن بها. والمراد بالمبادي المقدمات، وقد ذكرناها. وأما الموضوعات فهي الأمور التي توضع في العلوم وتطلب أعراضها الذاتية، أعني الذاتية بالمعنى الثاني من المعنيين المذكورين، ولكل علم موضوع: فموضوع الهندسة المقدار، وموضوع الحساب العدد، وموضوع لنحو لغة العرب منجهة ما يختلف إعرابها، وموضوع الفقه أفعال المكلفين من جهة ما ينهى عنها أو يؤمر بها أو يباح أو يندب أو يكره، وموضوع أصول الفقه أحكام الشرع، أعني الوجوب والحظر والإباحة من جهة ما تدرك به من أدلتها، وموضوع المنطق تمييز المعقولات وتلخيص المعاني. وأما المسائل فهي القضايا الخاصة بكل علم، التي يطلب المعرفة في العلوم بأحد طرفيها: إما النفي وإما الإثبات كقولنا في الحساب: هذا العدد إمازوج او فرد، وفي الهندسة: هذا المقدار مساو أو مباين، وفي الفقه: هذا الفعل حلال أوحرام أو واجب،
وفي العلم الإلهي: هذا الموجود قديم أو حادث وهذا الموجود له سبب أو ليس له سبب. والمقصود أن محمول المسائل إن كان مطلوبا بالنظر فلا يجوز أن يكون ذاتيا للموضوع بالمعنى الأول، لأنه إذا كان كذلك كان معلوما قبل العلم بالموضوع، فإن الحيوان الذي هو ذاتي للإنسان بمعنى أنه وجد في حده لا يجوز أن يكون مطلوبا فغن من عرف الإنسان فقد عرف كونه حيوانا قبله لا محالة، فإن أجزاء الحد يتقدم العلم بها على العلم بالمحدود، ولكن الذاتي بالمعنى الثاني وهو المطلوب، وأما كل محمول ليس المعنى الثاني ولا بالمعنى الأول فإنه يسمى غريبا كقولنا في الهندسة عند النظر في الخطوط: هذا الخط حسن أو قبيح، لأن الحسن والقبح لا يؤخذ في حد الخط ولا الخط في حده، بل الذاتي لذاته مستقيم أو منحني وأمثاله. وكذا قولنا في الطب: هذا الجرح مستدير أو مربع، فإنه محمول غريب للجرح إذ لا يؤخذ واحد منهما في حد الآخر، وإنما هو ذاتي للأشكال. وقد يكون المحمول ذاتيا للموضوع بالمعنى الثاني، ولكن يكون غريبا بالإضافة إلى العلم الذي يستعمل فيه كقولنا في الفقه: هذه الحركة سريعة أو بطيئة، فإن السرعة والبطء ذاتي للحركة، ولكن إنما يطلب في العلم الطبيعي، والمطلوب في الفقه ذاتي آخر وهو كونه واجبا أو محظورا أو مباحا. وإذا قلنا في العلم الطبيعي: هذا الفعل حلال أو حرام
كان غريبا من العلم. فإن قيل: فهل يجوز أن يكون المحمول في المقدمتين ذاتيا بالمعنى الأول؟ قلنا: لا، لأنه إن كان كذلك تكون النتيجة معلومة، فإذا قلنا: الإنسان حيوان والحيوان جسم فالإنسان جسم، كان العلم بالنتيجة غير مطلوب فإن منعرف الإنسان فقد عرف جميع أجزاء حده وهو الجسم والحيوان. نعم لا يبعد أن لا يكون كل واحد ذاتيا بالمعنى الثاني، بل إن كان أحدهما ذاتيا بالمعنى الثاني كفى، سواء كان هي الصغرى أو الكبرى. فإن قيل: فلم قلتم أن الذاتي بالمعنى الأول لا يكون مطلوبا، ونحن نطلب العلم بأن النفس جوهر أم لا، والجوهرية للنفس ذاتية إذ منعرف النفس فيعرف كونه جوهرا إن كان جوهرا؟ قلنا: من عرف النفس لم يتصور منه طلب كونه جوهرا، إذ معرفة جوهريته سابقة على المعرفة به، لكنا إذا طلبنا أن النفس جوهر أم لا لم يكن عرفنا من النفس إلا أمرا عارضا له وهو المحرك والمدرك، ويكون ذلك مثل الأبيض للثلج، والمطلوب جنس المعروض له وهو غير مقوم لماهية العارض، أعني الجوهرية ليس مقوما للمدرك والمحرك تقويم الذاتيات، وكذلك كلما حصل عندنا خياله أو إسمه لا حقيقته، أمكن أن نطلب جنس ذلك حصل لنا إسمه أو خياله، فأما على غير هذا الوجه فلا يمكن.
فصل في حل شبهة في القياس الدوري فإن قال قائل: فلم قضيتم ببطلان البرهان الدوري؟ ومعلوم أنه إذا سأل الإنسان عن الأسباب والمسببات على ما أجرى الله سنته بإرتباط البعض منها بالبعض ففيها ما يرجع بالدور إلى الأول إذ يقال: لم كان السحاب؟ فيقال: لأنه كان بخارا فكثف وانعقد. فقيل: لم كان البخار؟ فيقال: لأن الأرض كانت ندية فأثر الحر فيها فتبخرت أجزاء الرطوبة وتصعدت. فقيل: ولم كانت الأرض ندية؟ فقيل: لأنه كان مطر. فقيل: ولم كان المطر؟ فقيل: لأنه كان سحاب. فرجع بالدور إلى السحاب فكأنه قيل: لم كان السحاب؟ فقلت: لأنه كان سحاب. والدوري باطل سواء كان الحد المتكرر تخلله واسطة أو وسائط، أو لم يتخلل فنقول: ليس هذا هو الدوري الباطل، إنما الباطل أن يؤخذ الشيء في بيان نفسه بعينه بأن يقال: لم كان هذا السحاب؛ فيعلل بما يرجع بالآخرة إلى التعليل بهذا السحاب بعينه؛ فأما أن يرجع إلى التعليل بسحاب آخر فالعلة غير المعلول بالعدد، إلا أنه مساو له في النوع، ولا يبعد أن يكون سحاب بعينه علة لسحاب آخر بواسطة ترطيب الأرض، ثم تصعد البخار ثم انعقاده سحابا آخر.
فصل فيما يقوم فيه البرهان الحقيقي إعلم أن البرهان الحقيقي ما يفيد اليقين الضروري الدائم الأبدي الذي يستحيل تغييره كعلمك بان العالم حادث وأن له صانعا، وأمثال ذلك مما يستحيل ان يكون بخلافه على الأبد، إذ يستحيل أن يحضرنا زمان نحكم فيه على العالم بالقدم أوعلى الصانع بالنفي. فأما الأشياء المتغيرة التي ليس فيها يقين دائم فهي جميع الجزئيات التي في العالم الأرضي وأقربها إلى الثبات الجبال، وإذا قلت: هذا الجبل ارتفاعه كذا، لم يكن الحاصل علما أبديا لأن المقدمة الصغرى ليس اليقين فيها دائما، إذ ارتفاع الجبل يتصور تغيره، وكذا عمق البحار ومواضيع الجزائر، فهذه أمور لا تبقى فكيف علمك يكون زيد في الدار. وأمثال ذلك مما يتعلق بالأحوال الإنسانية العارضة لا كقولنا:
الإنسان حيوان والحيوان جسم والإنسان لا يكون في مكانين في حالة واحدة، وأمثال ذلك فإن هذه يقينيات دائمية أبدية لا يتطرق إليها التغير حتى قال بعض المتكلمين: العلم من جنس الجهل، وأراد به هذا الجنس من العلم. فإنك إذا علمت بالتواتر مثلا أن زيدا في الدار، فلو فرض دوام هذا الإعتقاد في نفسك وخروج زيد لكان هذا الإعتقاد بعينه قد صار جهلا، وهذاالجنس لا يتصور في اليقينيات الدائمة. فإن قيل: هل يتصور إقامة البرهان على ما يكن وقوعه أكثريا أو اتفاقيا؟ قلنا: أما الأكثري من الحدود الكبرى فلها لا محالة علل اكثيرة، فتلك العلل إذا جعلت حدودا وسطى أفادت علما وظنا غالبا. أما العلم فبكونه أكثريا غالبا فإنا إذا عرفنا من مجاري سنة الله تعالى أن اللحية إنما تخرج لاستحصاف البشرة ومتانة النجار، فإن عرفنا بكبر السن استحصاف البشرة ومتانة النجار حكمنا بخروج اللحية أي حكمنا بأن الغالب الخروج، وأن جهة الخروج غالبة على الجهة الأخرى، وهذا يقيني فإن ما يقع غالبا فلمرجح لا محالة، ولكن بشرط خفي لا يطلع عليه، ويكون فوات ذلك الشرط نادرا، ولذلك نحكم حكما يقينيا بأن من تزوج امرأة شابة ووطئها، فالغالب أن يكون له ولد، ولكن وجود الولد بعينه مظنون وكون الوجود غالبا على الجملة مقطوعبه، ولذلك نحكم في الفقهيات الظنية بأن العمل عند ظهور الظن واجب قطعا، فيكون العمل مظنونا ووجود الحكم مظنونا، ولكن وجوب العمل قطعي
إذ علم بدليل قطعي إقامة الشرع غالب الظن مقام اليقين في حق وجوب العمل، فكون الحكم مظنونا لم يمنعنا من القطع بما قطعنا به. وأما الأمور الإتفاقية كعثور الإنسان في مشيه على كنز فمهما لا يمكن أن يحصل به ظن ولا علم، إذ لو أمكن تحصل ظن بوجوده لصار غالبا أكثريا وخرج عن كونه إتفاقيا فقط. نعم يمكن إقامة البرهان على كونه اتفاقيا فقط، وقد اصطلح المنطقيون على تخصيص إسم البرهان بما ينتج اليقين الكلي الدايم الضروري، فإن لم تساعدهم على هذا الإصطلاح أمكنك أن تسمي جميع العلوم الحقيقية برهانية إذا جمعت المقدمات الشروط التي مضت، وأن ساعدتهم على هذا، فالبرهاني من العلوم العلم بالله وصفاته وبجميع الأمور الأزلية التي لا تتغير كقولنا: الإثنان أكثر من الواحد؛ فإن هذا صادق في الأزل، والأبد والعلم بهيئة السموات والكواكب وإبعادها ومقاديرها وكيفية مسيرها يكون برهانيا عند من رأى أنها أزلية لا تتغير، ولا تكون برهانية عند أهل الحق الذين يرون أن السموات كالأرضيات في جواز تطرق التغير إليها. وأما ما يختلف بالبقاع والأقطار كالعلوم اللغوية والسياسية إذ يختلف بالإعصار والملل، وكالأوضاع الفقهية الشرعية من تفصيل الحلال والحرام فلا يخفى أنها لا تكون من البرهانيات على هذا الإصطلاح. والفلاسفى يزعمون أن السعادة الأخروية لا معنى لها إلا بلوغ النفس كمالها الذي يمكن أن يكون لها، وإن كمالها في العلوم لا في الشهوات،
ولما كانت النفس باقية أبدا كانت نجاتها وسعادتها في علوم صادقة أبدا كالعلم بالله وصفاته وملائكته، وترتيب الموجودات وتسلسل الأسباب والمسببات. فأما العلوم التي ليست يقينية دائمة فإن طلبت لم تطلب لذاتها، بل للتوصل بها إلى غيرها، وهذا محل لا ينكشف إلا بنظر طويل، لا يحتمل هذا الكتاب استقصاؤه بل محل بيانه العلوم المفصلة. فصل في أقسام العلة العلة تطلق على أربعة معاني: الأول ما منه بذاته الحركة وهو السبب في وجود الشيء كالنجار للكرسي والأب للصبي. الثاني المادة وما لا بد من وجوده لوجود الشيء مثل الخشب للكرسي ودم الطمث والنطفة للصبي. والثالث الصورة وهي تمام كل شيء وقد تسمى علة صورية كصورة السرير من السرير وصورة البيت للبيت. الرابع الغاية الباعثة أولا المطلوب وجودها آخرا كالكن للبيت والصلوح للجلوس من السرير. واعلم أن كل واحد من هذه يقع حدودا وسطى في البراهين إذ يمكن أن يذكر كل واحد في جواب لم. أما مبدأ الحركة فمثاله من المعقولات أن يقال: لم حارب الأمير فلانا؟ فيقال: لأنه نهب ولايته،
فالنهب مبدأ الحركة. ويقال: لم اقتل فلانا؟ فيقال: لانه أكرهه السلطان عليه. ومثاله من الفقه أن يقال: لم قتل هذا الشخص؟ فيقال: لأنه زنى أوارتد، فيكون الزنا مبدأ هذا الأمر وهو الذي تسميه الفقهاء في الأكثر سببا، وأما المادة فمثالها من المعقول أني قال: لم يموت الإنسان؟ فتقول: لأنه مركب من أمور متنافرة من الحرارة والرطوبة والبرودة واليبوسة المتنازعة المتنافرة. ومثاله من الفقه أن يقال: لم انفسخ القراض والوكالة بالموت والإغماء؟ فتقول: لأنه عقد ضعيف جائز لا لزوم له، وهذه علة ماديةإذ يرد الفسخ على العقد ورود الموت على الإنسان عند جريان سبب هومبدأ الأمر في الموت والفسخ جميعا. وأما الصورة فبها قوام الشيء إذ السرير سرير بصورته لا بخشبه، والإنسان إنسان بصورته لا بجسمه، والأشياء هيآتها بالصور لا بالمواد، فلا يخفى كون القوام بها فإنه إذا قيلك لم صارت هذه النطفة إنسانا وهذا الخشب سريرا؟
فيقال: بحصول صورة الإنسانية وحصول صورة السريرية. وأما الغاية التي لأجلها الشيء فمثالها من المعقول أن يقال: لم عرضت الأضراس؟ فيقال: لأنها يراد بها الطحن. ولم قاتلوا الطبقة الفلانية؟ فيقال: ليسترقوهم. وفي الفقه يقال: لم قتل الزاني والمرتد والقاتل؟ فيقال: للزجر عن الفواحش. وهذه العلل الأربع تجتمع في كل ما له علة، وكذا في الأحكام الفقهية، والفقهاء ربما سموا المادة محلا والفاعل الذي هو كالنجار والأب أهلا، والغاية حكما، فإذا فرض النكاح فالزوج أهل والبضع محل والحل غاية وصيغة العقد كأنها الصورة، وما لم تجتمع هذه الأمور لا يتم للنكاح وجود، ولذلك قيل: النكاح الذي لا يفيد الحل لا وجود له، وكذا البيع الذي لا يفيد الملك فإن وجود الغاية لا بد منه، وكونها معقولا باعثا شرط قبل الوجود،
وكونها موجودة بالفعل واجب بعد الوجود، ومهما قدر الفاعل والمادة موجودا لم يلزم وجود الشيء في كل حال كالنجار والخشب والأب والنطفة والبايع والمبيع، ومهما وجدت الغاية بالفعل لزم وجود الشيء كالحل في النكاح والصلوح للإكتنان والجلوس في البيت، والشيء بهذه الجهات الأربع يختلف في هذا المعنى، ثم كل واحدة من هذه العلل إما بعيدة كإسلام المرأة للزوج عند ملك الزوج نصف الصداق، فإنه علة الصداق، والصداق هوالعلة القريبة للتسليم، وإما بالقوة كالإسكار للخمر قبل الشرب، وإما بالفعل كما في حال الشرب، وإما خاصة كالزنا للرجم، وإما عامة كالجناية للرجم أو العقوبة، وأما بالذات وهو المسمى علة عند الفقهاء كالزنا للرجم، وإما بالعرض كالإحصان له وهو الذي يسمى شرطا، فإن الرجم لا يجب إلا بالإحصان، وهي خصال كمال ولكن يعمل عمل العلة عنده، كما لو أرسلت الدعامة من تحت السقف فنزل فيقال نزوله بعلة الثقل، ولكن عند إشالة الدعامة فإن للهوى شرطا، وهو فراغ جهة الأسفل عن جسم صلب لا ينخرق. وأمثلة هذا في المعقولات كثيرة، فلذلك اقتصرنا على الأمثلة الفقهية، والمقصود أن المعلل في الفقه والمعقول إذا توجهت المطالبة عليه بالعلة، ينبغي أن يذكر العلة الخاصة القريبة التي بالفعل حتى تقطع المطالبة بلم، وإلا فيكون الطلب قائما.
كتاب الحد والنظر في هذا الكتاب يحصره فنان: الأول فيما يجري من الحد يجري القوانين الكلية. والثاني في الحدود المفصلة. الفن الأول في قوانين الحدود وفيه فصول الأول في بيان الحاجة إلى الحد، وقد قدمنا أن العلم قسمان: أحدهما علم بذوات الأشياء ويسمى تصورا. والثاني: علم بنسبة تلك الذوات بعضها إلى بعضها بسلب أو إيجاب ويسمى تصديقا. وأن الوصول إلى التصديق بالحجة والوصول إلى التصور التام بالحد، فإن الأشياء الموجودة تنقسم إلى أعيان شخصية كزيد ومكة وهذه الشجرة، وغلى أمور كلية كالإنسان والبلد والشجر والبر والخمر، وقد عرفت الفرق بين الكلي والجزئي؛ وغرضنا في الكليات إذ هي المستعمل في البراهين، والكلي تارة يفهم فهما جمليا كالمفهوم من مجرد إسم الجملة وسائر الأسماء والألقاب للأنواع والأجناس،
وقد يفهم فهما مخلصا مفصلا محيطا بجميع الذاتيا التي بها قوام الشيء، متميزا عنغيره في الذهن تميزا تاما، ينعكس على الإسم وينعكس عليه الإسم كما يفهم من قولنا شراب مسكر معتصر من العنب، وحيوان ناطق مايت، وجسم ذو نفس حساس متحرك بالإرادة متغذي؛ فإن هذه الحدود يفهم بها الخمر والإنسان والحيوان، فهما أشد تلخيصا وتفصيلا وتحقيقا وتمييزا مما يفهم من مجرد أساميها، وما يفهم الشيء هذا الضرب من التفهيم يسمى حدا، كما أن ما يفهم الضرب الأول من التفهيم يسمى إسما ولقبا. والفهم الحاصل من التحديد يسمى علما مخلصا مفصلا، والعلم الحاصل بمجرد الإسم يسمى علما جمليان وقد يفهم الشيء مما يتميز به عن غيره بحيث ينعكس على إسمه وينعكس الإسم عليه، ويتميز لا بالصفات الذاتية المقومة التي هي الأجناس والأنواع والفصول، بل بالعوارض والخواص فيسمى ذلك رسما كقولنا في تمييز الإنسان عن غيره: إنه الحيوان الماشي برجلين، العريض الأظفار، الضحاك، فإن هذا يميزه عن غيره كالحد، وكقولك في الخمر: إنه المائع المستحيل في الدن الذي يقذف بالزبد إلى غير ذلك من العوارض التي إذا جمعت لم توجد إلا للخمر،
وهذا إذا كان أعم من الشيء المحدود بأن يترك بعض الإحترازات سمي رسما ناقصا، كما أن الحد إذا ترك فيه بعض الفصول الذاتية فيكون سمي حدا ناقصا، ورب شيء يعسر الوقوف على جميع ذاتياته أولا يلفى لها عبارة فيعدل إلى الإحترازات العرضية بدلا عن الفصول الذاتية فيكون رسما مميزا، قائما مقام الحد في التمييز فقط لا في تفهيم جميع الذاتيات؛ والمخلصون إنما يطلبون منالحد تصور كنه الشيء وتمثل حقيقته في نفوسهم، لا لمجرد التمييزن ولكن مهما حصل التصور بكماله تبعه التمييز، ومن يطلب التمييز المجرد يقتنع بالرسم فقد عرفت ما ينتهي إليه تأثير الإسم والحد والرسم في تفهيم الأشياء، وعرفت إنقسام تصور الأشياء إلى تصور له بمعرفة ذاتياته المفصلة وإلى تصور له بمعرفة أعراضه، وإن كل واحد منهما قد يكون تاما مساويا للإسم في طرفي الحمل، وقد يكون ناقصا فيكون أعم من الإسم. واعلم أن أنفع الرسوم في تعريف الأشياء أن يوضع فيه الجنس القريب أصلا ثم تذكر الأعراض الخاصة المشهورة فصولا، فإن الخاصة الخفية إذا ذكرت لم تفد التعريف على العموم، فمهما قلت في رسم المثلث إنه الشكل الذي زواياه تساوي قائمتين لم تكن رسمته إلا للمهندس، فإذن الحد قول دال على ماهية الشيء، والرسم وهو القول المؤلف من أعراض الشيء وخواصه التي تخصه جملتها بالإجتماع وتساويه.
الفصل الثاني في مادة الحد وصورته قد قدمنا أن كل مؤلف فله مادة وصورة كما في القياس، ومادة الحد الأجناس والأنواع والفصول، وقد ذكرناها في كتاب مقدمات القياس. وأما صورته وهيئته فهو أن يراعى فيه إيراد الجنس الأقرب ويردف بالفصول الذاتية كلها، فلا يترك منها شيءس، ونعني بإيراد الجنس القريب أن لا نقول في حد الإنسان " جسم ناطق مائت، وإن كان ذلك مساويا للمطلوب بل نقول: حيوان، فإن الحيوان متوسط بين الجسم والإنسان، فهو أقرب إلى المطلوب من الجسم، ولانقول في حد الخمر: إنه مائع مسكر، بل نقول: شراب مسكر؛ فإنه أخص من المائع وأقرب منه إلى الخمر، وكذلك ينبغي أن يورد جميع الفصول الذاتية على الترتيب، وإن كان التمييز يحصل ببعض الفصول. وإذا سئل عن حد الحيوان فقال: جسم ذو نفس حساس له بعد متحرك بالإرادة،
فقد أتى بجميع الفصول ولو ترك ما بعد الحساس لكان التمييز حاصلا به، ولكن لا يكون قد تصور الحيوان بكمال ذاتياته، والحد عنوان المحدود فينبغي أن يكون مساويا له في المعنى، فإن نقص بعض هذه الفصول سمي حدا ناقصا، وإن كان التمييز حاصلا به وكان مطردا منعكسا في طريق الحمل، ومهما ذكر الجنس القريب وأتى بجميع الفصول الذاتية فلا ينبغي أن يزيد عليه. ومهما عرفت هذه الشروط في صورة الحد ومادته عرفت ان الشيء الواحد لا يكون له إلا حد واحد، وأنه لا يحتمل الإيجاز والتطويل، لأن إيجازه بحذف بعض الفصول وهو نقصان، وتطويله بذكر حد الجنس القريب بدل الجنس بكقولك في حد الإنسان: إنه جسم ذو نفس حساس متحرك بالإرادة ناطق مائت، فذكر حد الحيوان بدل الحيوان وهو فضول يستغنى عنه، فإن المقصود إن يشتمل الحد على جميع ذاتيات الشيء إما بالقوة وإما بالفعل. ومهما ذكر الحيوان فقد اشتمل على الحساس والمتحرك والجسم بالقوة أي على طريق التضمن، وكذلك قد يوجد الحد للشيء الذي هو مركب من صورة ومادة بذكر أحدهما كما يقال في حد الغضب: إنه غليان دم القلب، وهذا ذكر المادة، ويقال: إنه طلب الإنتقام، وهذا هو ذكر الصورة بل الحد التام أن يقال
هو غليان دم القلب لطلب الإنتقام. فإن قيل: فلو سهى ساهي او تعمد متعمد فطول الحد بذكر حد الجنس القريب بدل الجنس القريب، أوزاد على بعض الفصول الذاتية شيئا من الأعراض واللوازمن او نقص بعض الفصول فهل يفوت مقصود الحد كما يفوت مقصود القياس بالخطأ في صورته؟ قلنا: الناظرون إلى ظواهر الأمور ربما يستعظمون الأمر في مثل هذا الخطأ، والأمر أهون مما يظنون مهما لاحظ الإنسان مقصود الحد، لأن المقصود تصور الشيء بجميع مقوماته مع مراعاة الترتيب بمعرفة الأعم والأخص، بإيراد الأعم أولا وإردافه بالأخص الجاري مجرى الفصول، وإذا حفظ ذلك فقد حصل العلم التصوري المفصل المطلوب. أما النقصان بترك بعض الفصول فإنه نقصان في التصور. وأما زيادة بعض الأعراض فلا يقدح فيما حصل من التصور الكامل، وقد ينتفع به في بعض المواضع في زيادة الكشف والإيضاح. وأما إبدال الذاتيات باللوازم والعرضيات فذلك قادح في كمال التصور، فليعلم مبلغ تأثير كل واحد في المقصود، ولا ينبغي أن يجمد الإنسان على الرسم المعتاد المألوف في كل أمره وينسى غرضه المطلوب، فأذن مهما عرف جميع الذاتيات على الترتيب حصل المقصود، وأن زيد شيء من الأعراض أو أخذ حد الجنس القريب بدل الجنس. الفصل الثالث في ترتيب طلب الحد بالسؤال، والسائل عن الشيء بقوله: ما هو؟ لا يسأل إلا بعد الفراغ عن مطلب هل، كما أن السائل بلم لا يسأل إلا بعد الفراغ عن مطلب هل، فإن سأل عن الشيء قبل اعتقاد وجوده وقال: ما هو؟ رجع إلى طلب
شرح الإسم، كقول القائل: ما الخلا وما الكيميا؟ وهو لا يعتقد لهما وجودا، فإذا اعتقد الوجود كان الطلب متوجها إلى تصور الشيء في ذاته. وترتيبه أن يقول ما هو مشيرا إلى نخلة مثلا، فإذا أجاب المسؤول بالجنس القريب وقال شجرة، لم يقنع السائل به بل قرن بما ذكره صيغة أي وقال: أي شجرة هي؟ فإذا قال هي شجرة تثمر الرطب، فقد بلغ المقصود وانقطع السؤال إلا إذا لم يفهم معنى الرطب أو الشجر، فيعدل إلى صيغة ما ويقول: ما الرطب وما الشجر؟ فيذكر له جنسه وفصله فيقول: الشجر نبات قائم على ساق، فإن قال: ما الساق؟ فيذكر جنسه وفصله ويقول: هو جسم مغتذى نامي، فإن قال: ما الجسم؟ فيقول هو الممتد في الأقطار الثلاثة أي هو الطويل العريض العميق، وهكذا إلى أن ينقطع السؤال. فإن قيل: فمتى ينقطع؟ فإن تسلسل إلى غير نهاية فهو محال، وإن تعين توقفه فهو تحكم. فنقول: لا يتسلل إلى غير نهاية بل ينتهي إلى أجناس وفصول تكون معلومة للسائل لا محالة، فإن تجاهل أبدا لم يمكن تعريفه بالحد لأن كل تعريف وتعرف فيستدعي معرفة سابقة، فلم يعرف صورة الشيء بالحد إلا من عرف أجزاء الحد من الجنس والفصل قبله، إما بنفسه لوضوحه وإما بتحديد آخر أن يرتقي إلى أوائل عرفت بنفسها، كما أن كل تعلم تصديقي بالحجة فبعلم قد سبق لمقدمات هي أولية لم تعرف
بالقياس أو عرفت بالقياس، ولكن تنتهي بالآخرة إلى الأوليات، فآخر الحد يجري مجرى مقدمات القياس من غير فرق. والمقصود من هذا أن الحد يتركب لا محالة من جنس الشيء وفصله الذاتي ولا معنى له سواه، وما ليس له فصل وجنس فليس له حد، ولذلك إذا سئلنا عن حد الموجود لم نقد عليه، إلا أن يراد شرح الإسم فيترجم بعبارة أخرى عجمية أو تبدل في العربية بشيء، ولا يكون ذلك حدا بل هو ذكر إسم بدل إسم آخر مرادف له، فإذا سئلنا عن حد الخمر فقلنا: العقار، وعن حد العلم فقلنا: هو المعرفة، وعن حد الحركة فقلنا: هو النقلة، لم يكن حدا بل كان تكرار للأشياء المترادفة، ومن أحب أن يسميه حدا فلا حرج في الإطلاقات، ونحن نعني بالحد ما يحصل في النفس صورة موازية للمحدود مطابقة لجميع فصوله الذاتية. وإنما راعينا الفصول الذاتية لأن الشيء قد ينفصل عن غيره بالعرض الذي لا يقوم ذاته إنفصال الثوب الأحمر عن الأسود، وقد ينفصل بلازم لا يفارق إنفصال القار بالسواد عن الثلج وإنفصال الغراب عن الببغاء، وقد ينفصل بالذات إنفصال الثوب عن السيف وإنفصال ثوب من ابريسم عن درهم من قطن، ومن يسال عن ماهية الثوب طالبا حده فإنما يطلب الأمور التي بها قوام ثوبيته، لأنا لا نقوم الثوبية من اللون والطول والعرض فجوابه بما لا يقوم ذات الثوب مخل بالسؤال، فقد عرفت ان الحد مركب من الجنس والفصل، وأن ما لا يدخل تحت جنس حتى ينفصل عنه بفصل ما لا حدله مثل ما يذكر في معرض رسم أو شرح اسم، فتسميته حدا مخالف للتسمية التي اصطلحنا عليها فيكون الحد مشتركا له ولما ذكرناه.
؟؟ الفصل الرابع في أقسام ما يطلق عليه إسم الحد. والحد يطلق بالتشكيك على خمسة أشياء: الأول الحد الشارح لمعنى الإسم، ولا يلتفت فيه إلى وجود الشيء وعدمه، بل ربما يكون مشكوكا. ونذكر الحد ثم إن ظهر وجوده عرف أن الحد لم يكن بحسب الإسم المجرد وشرحه، بل هو عنوان الذات وشرحه. الثاني بحسب الذات وهو نتيجة برهان. والثالث ما هو بحسب الذات وهو مبدأ برهان. والرابع ما هو بحسب الذات. والحد التام الجامع لما هو مبدأ برهان ونتيجة برهان، كما إذا سئلت عن حد الكسوف فقلت امحاء ضوء القمر لتوسط الأرض بينه وبين الشمس، فامحاء ضوء القمر هونتيجة برهان وتوسط الأرض المبدأ، فغنك في معرض البرهان تقول: متى توسطت الأرض فانمحى النور فيكون التوسط حدا أوسط فهو مبدأ برهان، وإلا انمحى حد أكبر فهونتيجة برهان، ولذلك يتداخل البرهان والحد، فإن العلل الذاتية من هذا الجنس تدخل في حدود الأشياء كما تدخل في براهينها، فكل ما له علة فلا بد من ذكر علته الذاتية في حده لتتم صورة ذاته، وقد تدخل العلل الأربعة في حد الشيء الذي له العلل الأربعة كقوله في حد القادوم: إنه ىلة صناعية من حديد، شكله كذا يقطع به الخشب نحتا؛
فقولك: آله، جنس وصناعية تدل على المبدأ الفاعل، والشكل يدل على الصورة، والحديد يدل على المادة، والنحت على الغاية، والشكل يدل على الصورة، والحديد يدل على المادة، والنحت على الغاية، وبه الإحتراز عن المثقب والمنشار إذ لا ينحت بهما. وقد يقتصر في الحد على نتيجة البرهان إذا حصل التمييز بها فيقال: حد الكسوف انمحاء ضوء القمر، فيسمى هذا حدا هو نتيجة برهان وإن اقتصر على العلة وقال: الكسوف هو توسط الأرض بين القمر وبين الشمس، وحصل به التمييز قيل حد مبدأ برهان، والحد التام المركب منهما. ؟ القسم الخامس ما هو حد لأمور ليس لها علل وأسباب، ولو كان لها علل لكانت عللها غير داخلة في جواهرها كتحديد النقطة، والوحدة والحد، فإن الوحدة يذكر لها تعريف وليس للوحدة سبب، والحد يحد فإنه قول دال على ماهية الشيء، وللقول سبب فإنه حادث لا محالة لعلة لكن مسببه ليس ذاتيا له كانحاء ضوء القمر في الكسوف، فهذا الخامس ليس بمجرد شرح الإسم فقط، ولا هو مبدأ برهان، ولا هو مركب منهما؛ فهذه أقسام ما يطلق عليه إسم الحد، وقد يسمى الرسم حدا على أنه مميز فيكون ذلك وجها سادسا.
؟ الفصل الخامس في أن الحد لا يقتنص بالبرهان ولا يمكن إثباته به عند النزاع، لأنه إن أتيت بالبرهان افتقرت إلى حد أوسط مثل أن يقال مثلا: حد العلم المعرفة، فيقال: لم؟ فنقول: لأن كل علم اعتقاد، وكل اعتقاد معرفة، والمعرفة أكبر، وينبغي أن يكون الأوسط مساويا للطرفين إذ الحد هكذا يكون، وهذا محال لأن الأوسط عند ذلك له حالتان، وهما أن يكون حدا للأصغر أو رسما أو خاصة. الحالة الأولى أن يكون حدا وهو باطل من وجهين: أحدهما أن الشيء الواحد لا يكون له حدان تامان لأن الحد ما يجمع من الجنس والفصل، وذلك لا يقبل التبديل ويكون الموضوع حدا أوسط هو الأكبر بعينه لا غيره، وأن غايره في اللفظ وإن كان مغايرا له في الحقيقة لم يكن حدا للأصغر. الثاني أن الأوسط بم عرف كونه حدا للأصغر، فإن عرف بحد آخر فالسؤال قائم في ذلك الآخر، وذلك إما أن يتسلسل إلى غير نهاية وهو محال، وإما أن يعرف بلا وسط فليعرف الأول بلا وسط إذا أمكن معرفة الحد بغير وسط. الحالة الثانية أن لا يكون الأوسط حدا للأصغر بل كان رسما أو خاصة وهو باطل من وجهين:
أحدهما إن ما ليس بحد ولا هو ذاتي مقوم كيف صار أعرف من الذاتي المقوم، وكيف يتصور أن تعرف من الإنسان أنه ضحاك أو ماش ولا يعرف أنه جسم وحيوان. الثاني أن الأكبر بهذا الأوسط إن كان محمولا مطلقا وليس بحد فليس يلزم منه إلا كونه محمولا للأصغر، ولا يلزمه كونه حدا، وإن كان حدا فهو محال إذ حد الخاصية والعرض لا يكون حد موضوع الخاصية والعرض، فليس حد الضاحك هوبعينه حد الإنسان، وإن قيل: إنه محمول على الأوسط على معنى انه حد موضوعه، فهذه مصادرة على المطلوب، فقد تبين أن الحد لا يكتسب بالبرهان. فإن قيل: بماذا يكتسب وما طريقه؟ قلنا: طريقه التركيب وهو أن نأخذ شخصا من أشخاص المطلوب حده بحيث لا ينقسم، وننظر من أي جنس من جملة المقولات العشر، فنأخذ جميع المحمولات المقومة لها التي في ذلك الجنس ولا يلتفت إلى العرض واللازم، بل يقتصر على المقومات ثم يحذف منها ماتكرر ويقتصر من جملتها على الأخير القريب، وتضيف إليه الفصل فإن وجدناه مساويا للمحدود من وجهين فهو الحدن ونعني بأحد الوجهين الطرد والعكس، والتساوي مع الإسم في الحمل. فمهما ثبت الحد انطلق الإسم، ومهما انطلق الإسم حصل الحد. ونعني بالوجه الثاني المساواة في المعنى، وهو أن يكون دالا على كمال حقيقة الذات لا يشذ منها شيء، فكم من ذاتي متميز ترك بعض فصوله فلا يقوم ذكره في النفس صورة للمحدود مطابقة لكمال ذاته، وهذا مطلوب الحدود، وقد ذكرنا وجه ذلك. ومثال طلب الحد إنا إذا سئلنا عن حد الخمر فنشير إلى خمر معينة ونجمع صفاته المحمولة عليه، فنراه أحمر يقذف بالزبد، فهذا عرضي فنطرحه ونراه ذات رائحة حادة ومرطبا للشرب، وهذا لازم فنطرحه
ونراه جسما أو مائعا وسيالا وشرابا مسكرا ومعتصرا من العنب، وهذه ذاتيات فلا تقول: جسم مائع سيال شراب لأن المائع يغني عن الجسم، فإنه جسم مخصوص والمائع أخص منه، ولا تقول مائع لأن الشراب يغني عنه ويتضمنه وهو أخص وأقربن فتأخذ الجنس الأقرب المتضمن لجميع الذاتيات العامة وهو شراب، فنراه مساويا لغيره من الأشربة فتفصله عنه بفصل ذاتي لا عرضي كقولنا: مسكر يحفظ في الدن أو مثله، فيجتمع لنا شراب مسكر فتنظر هل يساوي الإسم في طرفي الحمل، فإن ساواه فتنظر هل تركنا فصلا آخر ذاتيا لا تتم ذاته إلا به فإن وجد معنا ضممناه إليه كما إذا وجدنا في حد الحيوان إنه جسم ذو نفس حساس، وهو يساوي الإسم في الحمل، ولكن ثم فصل آخر ذاتي وهو المتحرك بالإرادة فينبغي أن تضيفه إليه؛ فهذا طريق تحصيل الحدود لا طريق سواه. ؟ الفصل السادس مثارات الغلط في الحدود وهي ثلاثة: أحدها في الجنس، والآخر في الفصل، والثالث مشترك. المثار الأول الجنس وهي من وجوه:
فمنها أن يوضع الفصل بدل الجنس فيقال في العشق إنه إفراط المحبة، وإنما هو المحبة المفرطة فالمحبة جنس والإفراط فصل. ومنها أن توضع المادة مكان الجنس كقولك للسيف: إنه حديد يقطع، وللكرسي: إنه خشب يجلس عليه. ومنها أن تؤخذ الهيولي مكان الجنس كقولنا للرماد: إنه خشب محترق، فإنه ليس خشبا في الحال بل كان خشبا بخلاف الخشب من السرير فإنه موجود فيه على أنه مادة، وليس موجودا في الرماد، ولكن كان فصار شيئا آخر بتبدل صورته الذاتية، وهو الذي أردنا بالهيولي، ولك أن تعبر عنه بعبارة أخرى إن استبشعت هذه العبارة. ومنها أن تؤخذ الأجزاء بدل الجنس فيقال في حد العشرة، إنه خمسة وخمسة أو ستة وأربعة أو ثلاث وسبعة وأمثالها، وليس كذلك قولنا في الحيوان إنه جسم ونفس، لأن كون الجسم نفسا ما يرجع إلى فصل ذاتي له، فإن النفس صورة وكمال للجسم ولا كالخمسة للخمسة الأخرى. ومنها أن توضع الملكة مكان القوة كقولنا: العفيف هو القوي على إجتناب اللذات الشهوانية، وليس كذلك إذ الفاجر أيضا يقوى ولكنه يفعل، ولكن يكون ترك اللذات للعفيف بالملكة الراسخة وللفاجر بالقوة. وقد تشتبه الملكة بالقوة، وكقولك:
إن القادر على الظلم هو الذي من شأنه وطباعه النزوع إلى انتزاع ما ليس له من يد غيره، فقد وضع الملكة مكان القوة لأن القادر على الظلم قد يكون عادلا لا ينزع طبعه إلىالظلم. ومنها ان يوضع النوع بدل الجنس فيقال: الشر هو ظلم الناس، والظلم أحد أنواع الشر، والشر جنس عام يتناول غير الظلم. المثار الثاني من جهة الفصل وذلك بان يوضع ما هو جنس مكان الفصل، أو ما هو خاصة أو لازم او عرضي مكان الفصل، وكثيرا ما يتفق ذلك والإحتراز عنه عسر جدا. المثار الثالث ما مشترك وهو على وجوه: فمنها أن يعرف الشيء بما هو أخفى منه كمن يحد النار بأنه جسم شبيه بالنفس والنفس أخفى من النار، أو يحده بما هو مثله في المعرفة كتحديد الضد بالضد مثل قولك الزوج ما ليس بفرد، ثم تقول الفرد ما ليس بزوج، أو تقول الزوج ما يزيد على الفرد بواحد، ثم تقول الفرد ما ينقص عن الزوج بواحد،
وكذا إذا أخذ المضاف في حد المضاف. فتقول: العلم ما يكون الذات به عالما. ثم تقول: العالم منقام به العلم والمتضايفين يعلمان معا، ولا يعلم أحدهما بالآخر بل مع الآخر. فمن جهل العلم جهل العالم، ومن جهل الأب جهل الإبن، فمن القبيح أن يقال للسائل الذي يقول: ما الأب من له ابن، فإنه يقول: لو عرفت الإبن لعرفت الأب بل ينبغي أن يقال: الأب حيوان يوجد آخر من نوعه من نطفته من حيث هو كذلك، فلا يكون فيه تعريف الشيء بنفسه ولا حوالته على ما هو مثله في الجهالة. ومنها ان يعرف الشيء بنفسه أو بما هومتأخر عنه في المعرفة كقولك للشمس: كوكب يطلع نهارا، ولايمكن تعريف النهار إلا بالشمس، فإن معناه زمان طلوع الشمس فهو تابع للشمس فكيف يعرف؟ وكقولك في الكيفية: أن الكيفية ما بها تقع المشابهة وخلافها، ولا يمكن تعريف المشابهة إلا بأنها إتفاق في الكيفية، وربما يخالف المساواة فإنها إتفاق في الكمية، وتخالف المشاكلة فإنها اتفاق في النوع؛ فهذا وأمثاله مما يجب مراقبته في الحدود حتى لا يتطرق إليه الخطأ بإغفاله، وكان أمثلة هذا مما يخرج عن الحصر، وفيما ذكرنا تنبيه على الجنس.
؟؟؟ الفصل السابع في استقصاء الحد على القوة البشرية إلا عند غاية التشمير والجهد. فمن عرف ما ذكرناه في مثارات الإشتباه في الحد، عرف أن القوة البشرية لا تقوى على التحفظ عن كل ذلك إلا على الندور، وهي كثيرة وأعصاها على الذهن أربعة أمور: أحدها أنا شرطنا أن نأخذ الجنس الأقرب، ومن أين للطالب أن لا يغفل عنه فيأخذ جنسا يظن أنه أقرب، وربما يوجد ما هو أقرب منه فيحد الخمر بأنه مائع مسكر، ويذهل عن الشراب الذي هو تحته، وهو أقرب منه، ويحد الإنسان بأنه جسم ناطق مايت ويغفل عن الحيوان وأمثاله. الثاني أنا إذا شرطنا أن تكون الفصول كلها ذاتية واللازم الذي لا يفارق في الوجود، والوهم مشتبه بالذاتي غاية الإشتباه، ودرك ذلك من أغمض الأمور فمن أين له أنلا يغفل فيأخذ لازخما بدل الفصل فيظن أنه ذاتي. الثالث أنه إذا شرطنا أن نأتي بجميع الفصول الذاتية حتى لا نخل بواحد، ومن أين نأمن من شذوذ واحد عنه لا سيما إذا وجد فصلا حصل به التمييز والمساواة للإسم في الحمل، كالجسم ذي النفس الحساس في مساواته لفظ الحيوان مع إغفال التحرك بالإرادة، وهذا من أغمض ما يدرك. الرابع ان الفصل مقوم للنوع ومقسم للجنس، وإذا لم يراع شرط التقسيم
أخذ في القسمة فصولا ليست أولية للجنس، وهو عسير غير مرضي في الحد، فإن الجسم كما ينقسم إلىالنامي وغير النامي انقساما بفصل ذاتي، فكذلك ينقسم إلى الحساس وغير الحساس وإلى الناطق وغير الناطق، ولكن مهما قيل الجسم ينقسم إلى ناطق وغير ناطق، فقد قسم بما ليس الفصل القاسم أوليا، بل ينبغي أن ينقسم أولا إلى النامي وغير النامي، ثم النامي ينقسم إلى الحيوان وغير الحيوان؛ ثم الحيوان إلى الناطق وغير. وكذلك الحيوان ينقسم إلى ذي رجلين وإلى ذي أرجل، ولكن هذا التقسيم ليس بفصول أولية، بل ينبغي أن يقسم لاحيوان إلىماشي وغير ماشي، ثم الماشي ينقسمب إلى ذي رجلين أو أرجل، إذ الحيوان لم يستعد للرجلين والأرجل باعتبار كونه حيوانا بل باعتبار كونه ماشيا، واستعد لكونه ماشيا باعتبار كونه حيوانا، فرعاية الترتيب في هذه الأمور شرط للوفاء بصناعة الحدود، وهو في غاية
العسر، ولذلك لما عسر ذلك اكتفى المتكلمون بالمميز فقالوا: " الحد هو القول الجامع المانع " ولم يشترطوا فيه إلا التمييز فيلزم عليه الإكتفاء بذكر الخواص فيقال في حد الفرس: إنه الصهال، وفي الإنسان: إنه الضحاك وفي الكلب: إنه النباح. وذلك في غاية البعد عن غرض التعرف لذات المحدود. ولأجل عسر التحديد رأينا ان نورد جملة من الحدود المعلومة المحررة في الفن الثاني من كتاب الحد، وقد وقع الفراغ عن الفن الأول بحمد الله سبحانه وتعالى.
الفن الثاني في الحدود المفصلة اعلم أن الأشياء التي يمكن تحديدها لا نهاية لها، لأن العلوم التصديقية غير متناهية، وهي تابعة للتصورية، فأقل ما يشتمل عليه التصديقي تصوران، وعلىالجملة فكل ما له إسم يمكن تحرير حده أو رسمه أو شرح اسمه، وإذا لم يكن في الإستقصاء مطمع فالأولى الإقتصار على القوانين المعرفة لطريقه، وقد حصل ذلك بالفن الأول، ولكن أوردنا حدودا مفصلة لفائدتين: إحداهما أن تحصل الدربة بكيفية تحرير الحد وتأليفه، فإن الإمتحان والممارسة للشيء تفيد لفائدتين: إحداهما أن تحصل الدربة بكيفية تحرير الحد وتأليفه، فإن الإمتحان والممارسة للشيء تفيد قوة عليه لا محالة. والثاني أن يقع الإطلاع على معاني أسماء أطلقها الفلاسفة، وقد أوردناها في كتاب تهافت الفلاسفة إذ لم يمكن مناظرتهم إلا بلغتهم وعلى حكم إصطلاحهم، وإذا لم يفهم ما أرادوه لا يمكن مناظرتهم إلا بلغتهم وعلى حكم إصطلاحهم، وإذا لم يفهمما أرادوه لا يمكن مناظرتهم، فقد أوردنا حدود ألفاظ أطلقوها في الإلهيات والطبيعيات وشيئا قليلا من الرياضيات، فليؤخذ هذه الحدود على أنها شرح للإسم، فإن قام البرهان على أن ما شرحوه هو كما شرحوه اعتقد حدا، وإلا اعتقد شرحا للإسم كما نقول: حدّ الجن حيوان هوائي ناطق مشف الجرم، من شأنه أن يتشكل بأشكال مختلفة،
فيكون هذا شرحا للغسم في تفاهم الناس. فأما وجود هذا الشيء على هذا الوجه فيعرف بالبرهان، فإن دل على وجوده كان حدا بحسب الذات، وإن لم يدل عليه بل دل على أن الجن المراد في الشرع الموصوف بوصفه أمر آخر، أخذ هذا شرحا للإسم في تفاهم الناس، وكما نقول في حد الخلا: إنه بعد يمكن ان يفرض فيه أبعاد ثلاثة، قائم لا في مادة، من شأنه أن يملأه جسم ويخلو عنه. وربما يدل الدليل على أن ذلك محال وجوده، فيؤخذ على انه شرح للإسم في إطلاق النظار. وإنما قدمنا هذه المقدمة لتعلم أن ما نورده من الحدود شرحا لما أراده الفلاسفة بالإطلاق، لا حكم بأن ماذكروه هو ما ذكروه، فإن ذلك ربما يتوقف على النظر في موجب البرهان عليه. والمستعمل في الإلهيات خمسة عشر لفظا وهو: الباري تعالى المسمة بلسانهم المبدأ الأول، والعقل، والنفس، والعقل الكلي، وعقل الكل، والنفس الكلية، ونفس الكل، والملك، والعلة، والمعلول، والإبداع، والخلق، والأحداث، والقديم. أما الباري عز وجل فزعموا أنه لا حد له ولا رسم له، لأنه لا جنس له ولا فصل له ولا عوارض تلحقه. والحد يلتئم بالجنس والفصل والرسم بالجنس والعوارض الفاصلة، وكل ذلك تركيب ولكن له قول يشرح اسمه، وهو أنه
الموجود الواجب الوجود الذي لا يمكن أن يكون وجوده من غيره، ولا يكون وجود لسواه إلا فايضا عن وجوده وحاصلا به إما بواسطة أو بغير واسطة، ويتبع هذا الشرح أنه الموجود الذي لا يتكثر لا بالعدد ولا بالمقدار ولا بأجزاء القوام كتكثر الجسم بالصورة والهيولي، ولا بأجزاء الحد كتكثر الإنسان بالحيوانية والنطق، ولابأجزاء الإضافة ولا يتغير لا في الذات ولا في لواحق الذات، وما ذكروه يشتمل على نفي الصفات ونفي الكثرة فيها، وذلك مما يخالفون فيه، فهذا شرح إسم الباري والمبدأ الأول عندهم. وأما العقل فهو إسم مشترك تطلقه الجماهير والفلاسفة والمتكلمون على وجوه مختلفة لمعان مختلفة، والمشترك لا يكون له حد جامع. أما الجماهير فيطلقونه على ثلاثة أوجه: الأول يراد به صحة الفطرة الأولى في الناس، فيقال لمن صحت فطرته الأولى: إنه عاقل، فيكون حده إنه قوة بها يجود التمييز بين الأمور القبيحة والحسنة. الثاني يراد به ما يكتسبه الإنسان بالتجارب من الأحكام الكلية، فيكون حده إنه معاني مجتمعة في الذهن تكون مقدمات يستنبط بها المصالح والأغراض. الثالث معنى آخر يرجع إلى وقار الإنسان وهيئته، ويكون حده إنه هيئة محمودة للإنسان في حركاته وسكناته وهيآته وكلامه واختياره، ولهذا الإشتراك يتنازع الناس في تسمية الشخص الواحد عاقلا
فيقول واحد: هذا عاقل، ويعني به صحة الغريزة، ويقول الآخر: ليس بعاقل ويعني به عدم التجارب وهو المعنى الثاني. وأما الفلاسفة فاسم العقل عندهم مشترك يدل على ثمانية معاني مختلفة: العقل الذي يريده المتكلمون، والعقل النظري، والعقل العملي، والعقل الهيولاني، والعقل بالملكة، والعقل بالفعل، والعقل المستفاد، والعقل الفعال. فأما الأول فهو الذي ذكره أرسطاليس في كتاب البرهان وفرق بينه وبين العلم، ومعنى هذا العقل هو التصورات والتصديقات الحاصلة للنفس بالفطرة، والعلم ما يحصل للنفس بالإكتساب، ففرقوا بين المكتب والفطري فيسمى أحدهما عقلا والآخر علما، وهو اصطلاح محض. وهذا المعنى هو الذي حد المتكلمون العقل به إذ قال القاضي أبو بكر الباقلاني في حد العقل: إنه علم ضروري بجواز الجائزات واستحالة المستحيلات، كالعلم باستحالة كون الشيء الواحد قديما وحديثا، واستحالة المستحيلات كالعلم باستحالة كون الشيء الواحد قديما وحديثا، واستحال كون الشخص الواحد في مكانين. وأما سائر العقول فذكرها الفلاسفة في كتاب النفس. أما العقل النظري فهي قوة للنفس تقبل ماهيات الأمور الكلية من جهة ما هي كلية،
وهي احتراز عن الحس الذي لا يقبل إلا الأمور الجزئية وكذا الخيال، وكأن هذا هو المراد بصحة الفطرة الأصلية عند الجماهير كما سبق. وأما العقل العملي فقوة للنفس هي مبدأ التحريك للقوة الشوقية إلى ما تختاره من الجزئيات، لأجل غاية مظنونة أو معلومة، وهذه قوة محركة ليس من جنس العلوم، وإنما سميت عقلية لأنها مؤتمرة للعقل مطيعة لإشاراته بالطبع، فكم من عاقل يعرف أنه مستضر باتباع شهواته، ولكنه يعجز عن المخالفة للشهوة لا لقصور في عقله النظري بل لفتور هذه القوة التي سميت العقل العملي، وإنما تقوى هذه القوة بالرياضة والمجاهدة والمواظبة على مخالفة الشهوات. ثم للقوة النظرية أربعة أحوال: الأولى أن لا يكون لها شيء من المعلومات حاصلة، وذلك للصبي الصغير، ولكن فيه مجرد الإستعداد فيسمى هذا عقلا هيولانيا. الثانية أن ينتهي الصبي إلى حد التمييز فيصير ما كان بالقوة البعيدة بالقوة القريبة، فإنه مهما عرض عليه الضروريات وجد نفسه مصدقا بها، لا كالصبي الذي هو ابن مهد، وهذا يسمى العقل بالملكة. الرابعة: العقل المستفاد، وهو أن تكون تلك المعلومات حاضرة في ذهنه وهو يطالعها ويلابس التأمل فيها، وهو العلم الموجود بالفعل الحاضر؛ فحد العقل الهيولاني أنه قوة للنفس مستعدة لقبول ماهيات الأشياء مجردة عن المواد، وبها يفارق الصبي الفرس وسائر الحيوانات لا بعلم حاضر ولا بقوة قريبة من العلم، وحد العقل بالملكة أنه استكمال العقل الهيولاني حتى يصير بالقوة القريبة من الفعل،
وحد العقل بالفعل إنه إستكمال للنفس بصور ما أي صور معقولة حتى متى شاء عقلها أو أحضرها بالفعل، وحد العقل المستفاد أنه ماهية مجردة عن المادة مرتسمة في النفس على سبيل الحصول من خارج. وأما العقول الفعالة فهو نمط آخر، والمراد بالعقل الفعال كل ما هية مجردة عن المادة أصلا، فحد العقل الفعال أما من جهة ما هوعقل إنه جوهري صوري ذاته ماهية مجردة في ذاتها، لا بتجريد غيرها لها عن المادة وعن علائق المادة، بل هي ماهية كلية موجودة، فاما من جهة ما هو فعال فإنه جوهر بالصفة المذكورةن من شأنه أن يخرج العقل الهيولاني من القوة إلى الفعل بإشرافه عليه، وليس المراد بالجوهر المتحيز كما يريده المتكلمون، بل ما هو قائم بنفسه لا في موضوع، والصوري احتراز عن الجسم وما في المواد. وقولهم " لا بتجريد غيره " احتراز عن المعقولات المرتسمة في النفس من أشخاص الماديات، فإنها مجردة بتجريد العقل إياها لا بتجردها في ذاتها. والعقل الفعال لمخرج لنفوس الآدميين في العلوم من القوة إلى العقل نسبته إلى المعقولات، والقوة العاقلة نسبة الشمس إلى المبصرات والقوة الباصرة، إذ بها يخرج الأبصار من القوة إلى الفعل، وقد يسمون هذه العقول الملائكة، وفي وجود جوهر على هذا الوجه يخالفهم المتكلمون، إذ لا وجود لقائم بنفسه ليس بمتحيز عندهم إلا الله وحده. والملائكة أجسام لطيفة متحيزة عند أكثرهم،
وتصحيح ذلك بطريق البرهان وماذكرناه شرح الإسم. وأما النفس فهو عندهم اسم مشترك يقع على معنى يشترك فيه الإنسان والحيوان والنبات، وعلى معنى آخر يشترك فيه الإنسان والملائكة السماوية عندهم، فحد النفس بالمعنى الأول عندهم أنه كمال جسم طبيعي آلي ذي حياة بالقوة، وحد النفس بالمعنى الآخر انه جوهر غير جسم، هو كمال أول للجسم محرك له بالإختيار عن مبدأ نطقي أي عقلي بالفعل أو بالقوة، فالذي بالقوة هو فصل النفس الإنسانية والذي بالفعل هو فصل أو خاصة للنفس الملكية. وشرح الحد الأول أن حبة البذر إذا طرحت في الأرض فاستعدت للنمو والإغتذاء فقد تغيرت عما كان عليه قبل طرحه في الأرض، وذلك بحدوث صفة فيه لو لم تكن لما استعد لقبولهما من واهب الصور، وهو الله تعالى وملائكته، فتلك الصفة كمال له فلذلك قيل في الحد: إنه كمال أول الجسم، ووضع ذلك موضع الجنس، وهذا يشترك فيه البذر والنطفة للحيوان والإنسان. فالنفس صورة بالقياس إلى المادة الممتزجة، إذ هي منطبعة في المادة وهي قوة بالقياس إلى فعلها. وكمال بالقياس إلى النوع النباتي والحيواني ودلالة الكمال اتم من دلالة القوة والصورة، فلذلك عبر به في محل الجنس، والطبيعي احتراز عن الصناعي، فإن صور الصناعات أيضا كمال فيها، والآلي إحتراز عن القوى التي في العناصر الأربعة، فإنها تفعل لا بآلات
بل بذواتها، والقوى النفسانية فعلها بآلات فيها، فغنها تفعل لا بآلات بل بذواتها، والقوى النفسانية فعلها بآلات فيها. وقولهم " ذو حياة بالقوة " فصل آخر أي من شأنه أن يحيا بالنشو ويبقى بالغذاء، وربما يحيا بإحساس وحركة هما في قوته. وقولهم " كمال أول الإحتراز بالأول عن قوة التحريك والإحساس " فإنه أيضا كمال للجسم لكنه ليس كمالا أولا يقع ثانيا لوجود الكمال الذي هو نفس. وأما نفس الإنسان والإفلاك فليست منطبعة في الجسم، ولكنها كمال الجسم على معنى أن الجسم يتحرك به عن إختيار عقلي. أما الأفلاك فعلى الدوام بالفعل، وأما الإنسان فقد يكون بالقوة تحريكه. وأما العقلي الكلي وعقل الكل والنفس الكلي ونفس الكل، فبيانه أن الموجودات عندهم ثلاثة أقسام: أجسام وهي أخسها، وعقول فعالة وهي أشرفها لبراءتها عن المادة وعلاقة المادة، حتى أنها لا تحرك المواد أيضا غلا بالشوق، وأوسطها النفوس وهي التي تنفعل من العقل وتفعل في الأجسام، وهي واسطة، ويعنون بالملائكة السماوية نفوس الأفلاك فإنها حية عندهم وبالملائكة المقربين العقول الفعالة. والعقل الكلي يعنون به المعنى المعقول المقول على كثيرين مختلفين بالعدد من العقول التي لإشخاص الناس، ولا وجود لها في القوام بل في التصور، فإنك إذا قلت الإنسان الكلي أشرت به إلى المعنى المعقول من الإنسان الموجود في سائر الأشخاص، الذي هو للعقل صورة واحدة تطابق سائر أشخاص الناس، ولا وجود لإنسانية واحدة هي إنسانية زيد، وهي بعينها إنسانية عمرو، ولكن في العقل تحصل صورة الإنسان من شخص زيد مثلا، ويطابق سائر أشخاص الناس كلهم فيسمى ذلك الإنسانية الكلية،
فهذا ما يعنون بالعقل الكلي. وأما عقل الكل فيطلق على معنيين: أحدهما وهو الأوفق للفظ أن يراد بالكل جملة العالم، فعقل الكل على هذا المعنى بمعنى شرح اسمه أنه جملة الذوات المجردة عن المادة، من جميع الجهات التي لا تتحرك لا بالذات ولا بالعرض، ولا تحرك إلا بالشوق، وآخر رتبة هذه الجملة هي العقل الفعال المخرج للنفس الإنسانية في العلوم العقلية من القوة إلى الفعل، وهذه الجملة هي مبادي الكل بعد المبدأ الأول. والمبدأ الأول هو مبدع الكل، وأما الكل بالمعنى الثاني فهو الجرم الأقصى، أعني الفلك التاسع الذي يدور في اليوم والليلة مرة فيتحرك كل ما هو حشوه من السموات كلها، فيقال لجرمه جرم الكل، ولحركته حركة الكل، وهو أعظم المخلوقات، وهو المراد بالعرش عندهم. فعقل الكل بهذا المعنى هو جوهر يجرد عن المادة من كل الجهات، وهو المحرك لحركة الكل على سبيل التشويق لنفسه ووجوده أول وجود مستفاد عن الأول، ويزعمون أنه المراد بقوله عليه الصلاة والسلام: " أول ما خلق الله العقل فقال له أقبل فاقبل " الحديث إلى آخره. وأما النفس الكلي فالمراد به المعنى المعقول المقول على كثيرين مختلفين في العدد، في جواب ما هو التي كل واحدة منها نفس خاصة لشخص، كما ذكرنا في العقل الكلي. ونفس الكل على قياس عقل الكل جملة الجواهر الغير الجسمانية التي هي كمالات مدبرة للأجسام السماوية المحركة لها على سبيل الإختيار العقلي. ونسبة نفس الكل إلى عقل الكل كنسبة أنفسنا إلى العقل الفعال.
ونفس الكل هو مبدأ قريب لوجود الأجسام الطبيعية ومرتبته في نيل الوجود بعد مرتبة عقل الكل، ووجوده فايض عن وجوده. وحد الملك أنه جوهر بسيط ذو حياة ونطق عقلي غير مائت، هو واسطة بين الباري عز وجل. والأجسام الأرضية فمنه عقلي ومنه نفسي؛ هذا حده عندهم. وحد العلة عندهم أنها كل ذات وجود ذات آخر إنما هو بالفعل من وجود هذا الفعل ووجود هذا بالفعل ليس من وجود ذلك بالفعل. وأما المعلول هو كل ذات وجوده بالفعل من وجود غيره، ووجود ذلك الغير ليس من وجوده، ومعنى قولنا من وجوده غير معنى قولنا مع وجودهن فإن معنى قولنا من وجوده هوأن يكون الذات باعتبار نفسها ممكنة الوجود، وإنما يجب وجودها بالفعل لا من ذاتها، بل لأن ذاتا أخرى موجودة بالفعل يلزم عنها وجوب هذا الذات، ويكون لها في نفسها بشرط عدم العلة الإمتناع. وأما قولنا مع وجوده فهو أن يكون كل واحد من الذاتين فرض موجودا لزم أن يعلم أن الآخر موجود، وإذا فرض مرفوعا لزم أن الآخر مرفوع،
والعلة والمعلول معا بمعنى هذين اللزومين، وإن كان بين وجهي اللزومين اختلاف لأن أحدهما، وهو المعلول، إذا فرض موجودا لزم ان يكون الآخر قد كان موجودا حتى وجد هذا. وأما الآخر، وهو العلة فإذا فرض موجودا حتى وجد هذا. وأما الآخر وهو العلة فإذا فرض موجودا لزم أن يتبع وجوده وجود المعلول، وإذا كان المعلول مرفوعا لزم أن يحكم ان العلة كانت أولا مرفوعة حتى رفع، لا أن رفع المعلول أوجب رفع العلةن وأما العلة فإذا رفعناها وجب رفع المعلول بإيجاب رفع العلة. حد الإبداع هو اسم مشترك لمفهومين: أحدهما تأسيس الشيء لا عن مادة ولا بواسطة شيء، والمفهوم الثاني ان يكون للشيء وجود مطلق عن سبب بلا متوسط، وله في ذاته ان لا يكون موجودا، وقد أفقد الذي له في ذاته إفقادا تاما. وبهذا المفهوم العقل الأول مبدع في كل حال لأنه ليس وجوده من ذاته، فله من ذاته العدم، وقد أفقد ذلك إفقادا تاما. وحد الخلق هو إسم مشترك، فقد يقال خلق لإفادة وجود حاصل عن مادة وصورة كيف كان؟ وقد يقال: خلق لهذا المعنى الثاني لكن بطريق الإختراع من غير سبق مادة فيها قوة وجوده وإمكانه. حد الأحداث هو إسم مشترك يطلق على وجهين: أحدهما زماني، ومعنى الأحداث الزماني الإيجاد للشيء بعد أن لم يكن له وجود في زمان سابق، ومعنى الأحداث الغير الزماني هو إفادة الشيء وجودا، وذلك الشيء
ليس له في ذاته ذلك الوجود، لا بحسب زمان دون زمان بل بحسب كل زمان. حد القدم والقدم يقال على وجوه، يقال قدم بالقياس، وقدم مطلق، والقدم بالقياس هو شيء زمانه في الماضي أكثر من زمان شيء آخر، فهو قدم بالقياس إليه. وأما القدم المطلق فهو أيضا على وجهين يقال بحسب الزمان وبحسب الذات، فأما الذي بحسب الزمان فهو الشيء الذي وجد في زمان ماض غير متناه. وأما القديم بحسب الزمان هو الذي ليس له وجود زماني وهو موجود للملائكة والسموات وجملة أصول العالم عندهم. والقديم بحسب الذات هو الذي ليس له مبدأ علي، أي ليس له علة، وليس ذلك إلا الباري عز وجل.
القسم الثالث هو المستعمل في الطبيعيات ونذكر منها خمسة وخمسين لفظا وهي: الصورة، والهيولي، والموضوع، والمحمول، والمادة، والعنصر، والأسطقس، والركن، والطبيعة، والطبع، والجسم، والجوهر، والعرض، والنار، والهواء، والماء، والأرض، والعالم، والفلك، والكوكب، والشمس، والقمر، والحركة، والدهر، والزمان، والآن، والمكان، والخلا، والملا، والعدم، والسكون، والسرعة، والبطء، والإعتماد، والميل، والخفة، والثقل، والحرارة، والرطوبة، والبرودة، واليبوسة، والخشن، والملس، والصلب، واللين، والرخو، والمشف، والتخلخل، والإجتماع، والتجانس، والمداخل، والمتصل، والإتحاد، والتتالي، والتوالي.
حد الصورة: واسم الصورة مشترك بين ستة معان: الأول هو النوع يطلق ويراد به النوع الذي تحت الجنس، وحده بهذا المعنى حد النوع، وقد سبق في مقدمات كتاب القياس. الثاني الكمال الذي به يستكمل النوع استكماله الثاني فإنه يسمى صورة، وحده بهذا المعنى كل موجود في الشىء لا كجزء منه، ولا يصح قوامه دونه ولأجله وجد الشيء مثل العلوم والفضائل في الإنسان. الثالث ماهية الشيء كيف كان قد يسمى صورة، فحده بهذا المعنى، كل موجود في الشيء لا كجزء منه، ولا يصح قوامه دونه كيف كان. الرابع الحقيقة التي تقوم المحل بها، وحدّه بهذا المعنى أنه الموجود في شيء آخر لا كجزء منه ولا يصح وجودها مفارقا له، لكن وجوده هو بالفعل حاصل له مثل صورة الماء في هيولي الماء، إنما يقوم بالفعل بصورة الماء أو بصورة أخرى حكمها حكم سورة الماء، والصورة التي تقابل بالهيولي هي هذه الصورة. الخامس الصورة التي تقوم النوع يسمى صورة، وحده بهذا المعنى أنه الموجود في شيء لا كجزء منه نولا يصح قوامه مفارقا له، ولا يصح قوام ما فيه دونه، إلا أن النوع الطبيعي يحصل به كصورة الإنسانية والحيوانية في الجسم الطبيعي الموضوع له. السادس الكمال المفارق وقد يسمى صورة مثل النفس للإنسان، وحده بهذا المعنى أنه جزء غير جسماني مفارق يتم به، وبجزء جسماني نوع طبيعي. حد الهيولي إما الهيولي المطلقة فهي جوهر وجوده بالفعل، إنما يحصل بقبوله الصورة الجسمانية كقوة قابلة للصورة، وليس له في ذاته صورة إلا بمعنى القوة، وهو الآن عندهم قسم الجسم المنقسم بالقسمة المعنوية، لست أول بالقسمة الكمية المقدارية إلى الصورة والهيولي، والقول في إثبات ذلك طويل ودقيق،
وقد يقال هيولي لكل شيء من شأنه أني قبل كمالا وأمرا ما ليس فيه، فيكون بالقياس إلى ما ليس فيه هيولي وبالقياس إلى ما فيه موضوع، فمادة السرير موضوع لصورة السرير، هيولي الصورة الرمادية التي تحصل بالإحتراق. الموضوع قد يقال لكل شيء من شأنه أن يكون له كمال ما، وكان ذلك الكمال حاضرا، وهو الموضوع له، ويقال موضوع لكل محل متقوم بذاته مقوم لمايحله، كما يقال هيولي للمحل الغير المتقوم بذاته بل بما يحله، ويقال موضوع لكل معنى بسلب أو إيجاب وهو الذي يقابل بالمحمول. المادة قد يقال إسما مرادفا للهيولي، ويقال مادة لكل موضوع يقبل الكمال بإجتماعه إلى غيره، ووروده عليه يسيرا مثل المني والدم لصورة الحيوان، فربما كان ما يجامعه من نوعه وربما لم يكن من نوعه. العنصر إسم للأصل الأول في الموضوعات، فيقال عنصر للمحل الأول الذي باستحالته يقبل صورا تتنوع بها الكائنات الحاصلة منه، إما مطلقا وهو العقل الأول، وإما بشرط الجسمية وهوالمحل الأول من الأجسام التي تتكون عنه سائر الأجسام الكائنة لقبوله صورها. الأسطقس هوالجسم الأول الذي باجتماعه إلى أجسام أول مخالفة له في النوع يقال له أسطقس، فلذلك قيل إنه آخر ما ينتهي غليه تحليل الأجسام، فلا توجد عند الإنقسام إليه قسمة إلا إلى أجزاء متشابهة. الركن هو جوهر بسيط، وهو جزء ذاتي للعالم مثل الأفلاك والعناصر، فالشيء بالقياس إلى العالم ركن وبالقياس إلى ما يتركب منه اسطقس، وبالقياس إلى ما تكون عنه عنصر، سواء كان كونه عنه بالتركيب والإستحالة
معا أو بالإستحالة المجردة عنه، فإن الهواء عنصر السحاب بتكاثفه، وليس اسطقسا له، وهو اسطقس وعنصر للنبات. والفلك هو ركن وليس باسطقس ولا عنصر لصورة، ولصورته موضوع، وليس له عنصر مهما عني بالموضوع محل لأمر هو فيه بالفعل ولم يعن به محل متقدم. وهذه الأسماء التي هي الهيولي والموضوع والعنصر والمادة والأسطقس والركن قد يستعمل على سبيل الترادف، فيبدل بعضها مكان بعض بطريق المسامحة، حيث يعرف المراد بالقرينة. الطبيعة مبدأ أول بالذات لحركة الشيء وكمال ذاتي للشيء، فالحجر إذا هوى إلى أسفل فليس يهوي لكونه جسما بل لمعنى آخر يفارقه سائر الأجسام فيه، فهو معنى به يفارق النار التي تميل إلى فوق، وذلك المعنى مبدأ لهذا النوع من الحركة ويسمى طبيعية. وقد يسمى نفس الحركة طبيعة فيقال طبيعة الحجر الهوى. وقد يقال طبيعة للعنصر والصورة الذاتية. والأطباء يطلقون لفظ الطبيعة على المزاج وعلى الحرارة الغريزيةن وعلى هيئات الأعضاء وعلى الحركات وعلى النباتية، ولكل واحد حد آخر ليس يتعلق الغرض به، فلذلك اقتصرنا على الأول. الطبع هو كل هيئة يستكمل بها نوع من الأنواع، فعليه كانت أو انفعالية، وكأنها أعم من الطبيعة، وقد يكون الشيء عن الطبيعة وليس بالطبع مثل الأصبع الزائدة، ويشبه أن يكون هو بالطبع بحسب الطبيعة الشخصية، وليست بالطبع بحسب الطبيعة الكلية، ولعموم الطبع للفعل والإنفعال كان أعم من الطبيعة التي هي مبدأ فعلي. الجسم إسم مشترك قد يطلق على المسمى به من حيث أنه متصل محدود ممسوح في أبعاد ثلاثة بالقوة؛ أعني أنه ممسوح بالقوة وإن لم يكن بالفعل.
وقد يقال جسم لصورة يمكن أن يعرض فيها أبعاد كيف نسبت طولا وعرضا وعمقا، ذات حدود متعينة، وهذا يفارق الأول في أنه لو لم يشترط كون الجملة محدودا ممسوحا بالقوة أو بالفعل، أو اعتقد أن أجسام العالم لا نهاية لها، لكا كل جزء منها يسمى جسما بهذا الإعتبار، والفرق بين الكم وهذه الصورة أن قطعة من الماء ولاشمع كلما بدلت أشكالها تبدلت فيها الأبعاد المحدودة الممسوحة، ولم يبق واحد منها بعينه واحدا بالعدد، وبقيت الصورة القابلة لهذه الأحوال واحدة بالعدد من غير تبدل. والصورة القابلة لهذه الأحوال هي جسمية، وكذلك إذا تكاثف الجسم مثلا كانقلاب الهواء بالتكاثف سحابا أو ماء، أو تخلخل مثلا الجمد لما يستحيل صورته الجسمية، واستحال أبعاده ومقداره، ولهذا يظهر الفرق بين الصورة الجسمية التي هي من باب الكم، وبين الصورة التي هي من باب الجوهر. الجوهر إسم مشترك يقال جوهر لذات كل كالإنسان، أو كالبياض فيقال جوهر البياض وذاته، ويقال جوهر لكل موجود، وذاته لا يحتاج في الوجود إلى ذات اخرى تقارنها حتى يكون بالفعل، وهو معنى قولهم الجوهر قائم بنفسه، ويقال جوهر لما كان بهذه الصفة وكان من شأنه أن يقبل الأضداد بتعاقبها عليه، ويقال جوهر لكل ذات وجوده ليس في موضوع، وعليه اصطلاح الفلاسفة القدماء. وقد سبق الفرق بين الموضوع والمحل فيكون معنى قولهم الموجود لا في موضوع الموجود غير مقارن الوجود لمحل قائم بنفسه مقوم له، ولا بأس بأن يكون في محل لا يتقوم المحل دونه بالفعل، فإنه وإن كان في محل فليس في موضوع،
فكل موجود إن كان كالبياض والحرارة والحركة والعلم فهو جوهر بالمعنى الأول، والمبدأ الأول جوهر بالمعاني كلها إلا بالوجه الثالث وهو تعاقب الأضداد. نعم قد يتحاشى عن إطلاق لفظ الجوهر عليه تأدبا من حيث الشرع. والهيولي جوهر بالمعنى الرابع والثالث، وليس جوهرا بالمعنى الثاني، والصورة جوهر بالمعنى الرابع وليس جوهرا بالمعنى الثاني والثالث، والمتكلمون يخصصون إسم الجوهر بالجوهر الفرد المتحيز الذي لا ينقسم ويسمون المنقسم جسما لا جوهران وبحكم ذلك يمتنعون عن إطلاق إسم الجوهر على المبدأ عز وجل، والمشاحة في الأسماء بعد إيضاح المعاني دأب ذوي القصور. العرض غسم مشترك فيقال لكل موجود في محل عرض، ويقال عرض لكل موجود في موضوع، ويقال عرض للمعنى الكلي المفرد المحمول على كثيرين حملا غير مقوم، وهو العرض الذي قابلناه بالذاتي في كتاب مقدمات القياس. ويقال عرض لكل معنى موجود للشيء خارج عن طبعه، ويقال عرض لكل معنى يحمل على الشيء لأجل وجوده في آخر يفارقه، ويقال عرض لكل معنى وجوده في أول الأمر لا يكون؛ فالصورة عرض بالمعنى الأول فقط، وهو الذي يعنيه المتكلم إذا ما قابله بالجوهر والأبيض، أي الشيء ذو البياض الذي يحمل على الثلج والجص والكافور ليس هو عرضا بالوجه الأول والثاني، وهو عرض بالوجه الثالث، وذلك لأن هذا الأبيض الذي هو نوع محمول غير مقوم، وهو جوهر ليس في موضوع ولا محل، فالبياض هو الحال في محل وموضوع، والبياض لا يحمل على الثلج
فلا ثلج بياضن بل يقال أبيض، ومعناه انه شيء ذو أبيض فلا يكون هذا حملا مقوما. وحركة الحجر إلى أسفل عرض بالوجه الأول والثاني والثالث، وليس عرضا بالوجه الرابع والخامس والسادس، بل حركته إلى فوق عرض بجميع هذه الوجوه، وحركة القاعد في السفينة عرض بالوجه السادس والرابع. الفلك عندهم جسم بسيط كري غير قابل للكون والفساد، متحرك بالطبع على الوسط مشتمل عليه. الكوكب جسم بسيط كري، مكانه الطبيعي نفس الفلك، من شأنه أن يكون غير قابل للكون والفساد متحرك على الوسط غير مشتمل عليه. الشمس كوكب هو أعظم الكواكب كلها جرما وأشدها ضوءا، ومكانه الطبيعي في الكرة الرابعة. القمر هو كوكب مكانه الطبيعي في الأسفل، من شأنه أن يقبل النور من الشمس على أشكال مختلفة ولونه الذاتي إلى السواد. النار جسم بسيط طباعة أن يكون حارا يابسا متحركا بالطبع عن الوسط، يستقر تحت كرة القمر. الهواء جرم بسيط طباعه أن يكون حارا رطبا مشفا لطيفا، متحركا إلى المكان الذي تحت كرة النار فوق كرة الأرض. الماء جرم بسيط طباعه أن يكون باردا رطبا مشفا، متحركا إلى المكان الذي تحت كرة الهواء وفوق الأرض. الأرض جسم بسيط طباعه أن يكون باردا يابسا، متحركا إلى الوسط نازلا فيه. العالم هو مجموع الأجسام الطبيعية البسيطة كلها
ويقال عالمالكل جملة موجودات متجانسة، كقولهم عالم الطبيعة وعالم النفس وعالم العقل. الحركة كمال أول بالقوة من جهة ما هو بالقوة، وإن شئت قلت هو خروج من القوة إلى الفعل لا في آن واحد، كل تغير عندهم يسمى حركة. واما حركة الكل فهو حركة الجرم الأقصى على الوسط مشتملة على جميع الحركات التي على الوسط وأسرع منها. الدهر هوالمعنى المعقول من إضافة الثبات إلى النفس في الزمان كله. الزمان هومقدار الحركة موسوم من جهة التقدم والتأخر. الآن هو ظرف يشترك فيه الماضي والمستقبل من الزمان، وقد يقال أن الزمان صغير المقدار عن الوهم متصل بالآن الحقيقي من جنسه. المكان هو السطح الباطن من الجوهر الحاوي المماس للسطح الظاهر من الجسم المحوي. وقد يقال مكان للسطح الأسفل الذي يستقر عليه شيء، يقله، ويقال مكان بمعنىثالث إلا أنه غير موجود، وهو أبعاد متناهية كأبعاد المتمكن يدخل فيها أبعاد المتمكن، وإن كان يجوز أن يلفى من غير متمكن كان هو الخلا، وإن كان لا يجوز إلا أن يشغلها جسم موجود فيه فليس بخلا. الخلا بعد يمكن أن يفرض فيه أبعاد ثلاثة قوائم لا في مادة، من شأنه أن يملأه جسم وان يخلو عنه، ومهما لم يكن هذا موجودا كان هذا الحد شرحا للإسم. الملا هو جسم من جهة ما تمانع أبعاده دخول جسم آخر فيه. العدم الذي هو أحد المبادي للحوادث هو ان لا يكون في شيء ذات شيء، من شأنه أن يقبله ويكون فيه.
السكون هو عدم الحركة فيما من شأنه أن يتحرك بأن يكون هو في حالة واحدة من الكم والكيف والأين والوضع زمانا، فيوجد عليه في آنين. السرعة كون الحركة قاطعة لمسافة طويلة في زمان قصير. البطء والميل هو كيفية بها يكون الجسم مدافعا لما يمنعه عن الحركة إلى جهته. الخفة قوة طبيعية يتحرك بها الجسم عن الوسط بالطبع. الثقل قوة طبيعية يتحرك بها الجسم إلى الوسط بالطبع. الحرارة كيفية فعلية محركة لما تكون فيه إلى فوق لأحداثها الخفة، فيعترض ان تجمع المتجانسات وتفرق المخلتفات، وتحدث تخلخلا من باب الكيف في الكيفي، وتكاثفا من باب الوضع فيه بتحليله وتصعيده اللطيف. البرودة كيفية فعلية يفعل بين المتجانسات وغير المتجانسات، بحصرها الأجسام بتقليصها وعقدها اللذين من باب الكيف. الرطوبة كيفية انفعالية بها يقبل الجسم الحصر والتشكيل الغريب بسهولة، ولا يحفظ ذلك بل يرجع إلى شكل نفسه ووضعه الذي بحسب حركة جرمه في الطبع. اليبوسة كيفية انفعالية لجسم عسير الحصر والتشكيل الغريب عسر الترك والعود إلى شكله الطبيعي. الخشن هو جرم سطحه ينقسم إلى أجزاء مختلفة الوضع. الأملس هو جرم سطحه ينقسم إلى أجزاء متساوية الوضع. الصلب هو الجرم الذي لا يقبل دفع سطحه إلى داخل إلا بعسر. اللين هو الجرم الذي يقبل ذلك. الرخو جرم ليس سريع الإنفصال المشف جرم ليس له في ذاته لون، ومن شأنه يرى بتوسطه ماوراءه.
التخلخل اسم مشترك يقال تخلخل لحركة الجسم من مقدار إلى مقدار أكبر، يلزمه أن يصير قوامه أرق. ويقال تخلخل لكيفية هذا القوام. ويقال تخلخل لحركة أجزاء الجسم عن تقارب بينها إلى تباعد فيتخللها جرم أرق منها، وهذه حركة في الوضع والأول في الكم. ويقال تخلخل لنفس وضع أجزاء هذا، ويفهم حد التكاثف من حد التخلخل، ويعلم أنه مشترك يقع على أربعة معان مقابلة لتلك المعانيي: واحدة منها حركة في الكم، والآخر كيفية، والثالث حركة في الوضع، والرابع وضع. الإجتماع وجود أشياء كثيرة يعمها معنى واحد، والإفتراق مقابله. المتجانسان هما اللذان لهما تشابه معا في الوضع، وليس يجوز أن يقع بينهما ذو وضع. المداخل هو الذي يلاقي الآخر بكلية حتى يكفيهما مكان واحد. المتصل إسم مشترك يقال لثلاثة معان: أحدها هو الذي يقال له متصل في نفسه الذي هو فصل من فصول الكم، وحدّه أنه ما من شأنه أن يوجد بين أجزائه حد مشترك، ورسمه أنه القابل للإنقسام بغير نهاية. والثاني والثالث هما بمعنى المتصل،
وأولهما من عوارض الكم المتصل بالمعنى الأول من جهة ما هو كم متصل، وهو أن المتصلين هما اللذان نهايتاهما واحدة، والثالث شركة في الوضع ولكن مع وضع، وذلك أن كل ما نهايته ونهاية شيء آخر واحد بالفعل يقال إنه متصل، مثل خطي زاوية. والمعنى الثالث هو من عوارض الكم المتصل من جهة ما هو في مادة، وهو أن المتصلين بهذا المعنى هما اللذان نهاية كل واحد منهما ملازم لنهاية الآخر في الحركة، وإن كان غيره بالفعل مثل إتصال الأعضاء بعضها ببعض وإتصال الرباطات بالعظام. وبالجملة كل مماس ملازم عسير القبول للإنفصال الذي هو مقابل للماسة. الإتحاد إسم مشترك، فيقال إتحاد لإشتراك أشياء فيمحمول واحد ذاتي أو عرضي، مثل اتحاد الكافور والثلج في البياض، والإنسان والثور في الحيوانية. ويقال إتحاد لإشتراك محمولات في موضوع واحدن مثل اتحاد الطعم والرائحة في التفاح. ويقال اتحاد لإجتماع الموضوع والمحمول في ذات واحدة كجزئي الإنسان من البدن والنفس ويقال اتحاد لإجتماع أجسام كثيرة إما بالتتالي كالمائدة، وإما بالجنس كالكرسي والسرير، وإما باتصال كأعضاء الحيوان، وأحق هذا الباب بإسم الإتحاد هو حصول جسم واحد بالعدد من إجتماع أجسام كثيرة لبطلان خصوصياتها، لأجل إرتفاع حدودها المنفردة وبطلان إستقلالها بالإتصال. التتالي هو كون شيء بعد شيء بالقياس إلى مبدأ محدود، وليس بينهما شيء من بابهما.
القسم الثالث ما يستعمل في الرياضيات، ولما لم نتكلم في كتاب تهافت الفلاسفة على الرياضيات اقتصرنا من هذه الألفاظ على قدر يسير، وقد يدخل بعضها في الإلهيات والطبيعيات في الأمثلة والإستشهادات، وهي ست ألفاظ: النهاية، وما لا نهاية، والنقطة، والخط، والسطح، والبعد. النهاية هي غاية ما يصير الشيء ذو الكمية إلى حيث لا يوجد وراءه شيء منه. ما لا نهاية له هو كم ذو أجزاء كثيرة، بحيث لا يوجد شيء خارج عنه وهومن نوعه، وبيحث لا ينقضي. النقطة ذات غير منقسمة، ولها وضع وهي نهاية الخط. الخط هو مقدار لا يقبل الإنقسام إلا من جهة واحدة وهو نهاية السطح. السطح مقدار يمكن أن يحدث فيه قسمان متقاطعان على قوائم، وهو نهاية الجسم. البعد هو كل ما يكون بين نهايتين غير متلاقيتين ويمكن الإشارة إلى جهته، ومن شأنه أنه يتوهم أيضا فيه نهايات من نوع تينك النهايتين، والفرق بين البعد والمقادير الثلاثة أنه قد يكون بعد خطي من غير خط، وبعد سطحي من غير سطح. مثاله أنه إذا فرض في جسم لا إنفصال في داخله نقطتان كان بينهما بعد ولم يكن بينهما خط.
وكذلك إذا توهم فيه خطان متقابلان كان بينهما بعد ولم يكن بينهما سطح، لأنه إنما يكون بينهما سطح إذا انفصل بالفعل بأحد وجوه الإنفصال، وإنما يكون فيه خط إذا كان فيه سطح، ففرق إذا بين الطول والخط وبين العرض والسطح، لأن البعد الذي بين النقطتين المذكورتين هو طول وليس بخط، والبعد بين الخطين المذكورين هو عرض وليس بسطح، وإن كان كل خط ذا طول، وكل سطح ذا عرض وقد نجز غرضنا من كتاب الحد قانونا وتفصيلا.
كتاب أقسام الوجود وأحكامه
مقصود هذا الكتاب البحث عن أقسام الوجود، اعني الأقسام الكلية والبحث عن عوارضها الذاتية التي تلحقها من حيث الوجود، وهو المراد بأحكامه وقد سبق الفرق بين العوارض الذاتية والتي ليست بذاتية، ولواحق الشيء أعني محمولاته تنقسم إلى ما يوجد شيء أخص منه، وإلى ما لا يوجد شيء أخص منه، فالذي يوجد ما هو أخص منه ينقسم، فمنه فصول منه أعراض ذاتية، وقد سبق الفرق بينهما. وبالفصول ينقسم الشيء إلى أنواعه، وبالأعراض ينقسم إلى اختلاف أحواله، وقد سبق الفرق بين الفصول وبين الأعراض العامة، وإنقسام الوجود إلى الأقسام العشرة التي واحد منها جوهر وتسعة أعراض كما سبق، جملتها يشبه الإنقسام بالفصول وإن لم تكن بالحقيقة كذلك، إذ ذكرنا في تحقيق الفصل ودخوله في الماهية ما يخرج هذه الأمور عن الفصول، كما خرج الوجود والشيء عن الأجناس، وذلك بحكم ما سبق من الإصطلاح.
وانقسامه إلى ما هو بالقوة والفعلن وإلى الواحد والكثير والمتقدم والمتأخر والعام والخاص والكلي والجزئي، والقديم والحادث والتام والناقص والعلة والمعلول، والواجب والممكن وما يجري مجراها، يشبه الإنقسام بالعوارض الذاتية، فإن هذه الأمور لا تلحق الموجود لأمر أعم منه إذ لا أعم من الوجود، ولا لأمر أخص منه كالحركة فإنها تلحق الموجود من حيث كونه جسما لا من حيث كونه موجودا. ومقصودنا من النظر في هذا ينقسم إلى فنين: (الفن الأول) في أقسام الوجود وهي عشرة أنواع في أنفسها، ثم يكون أمرها في النفس أعني العلم بها أيضا عشرة متباينة، فإن العلم معناه مثال مطابق للمعلوم كالصورة والنقش الذي هو مثال الشيء، فيكون لها عشر عبارات إذ الألفاظ تابعة للآثار الثابتة في النفس المطابقة
للأشياء الخارجية، وتلك الألفاظ هي: الجوهر والكم والكيف والمضاف والأين، ومتى والوضع وله وأنيفعل وأن ينفعل. فهذه العبارات أوردها المنطقيون، ونحن نكشف معنى كل واحد منها، وبعد الإحاطة بالمعنى فلا مشاحة في الألفاظ. القول في الجوهر إعلم أن الموجود ينقسم بنوع من القسمة إلى الجوهر والعرض، وإسم كل من الجوهر والعرض مشترك كما سبق، ولكنا نعني الآن من جملتها شيئا واحدا فنريد بالجوهر الموجود لا في موضوع، ونريد بالموضوع المحل القريب الذي يقوم بنفسه لا بتقويم الشيء الحال فيه كاللون في الإنسان بل في الجسم، فغن ماهية الجسم لا تتقومب اللون بل اللون عارض يلحق بعد قوام ماهية الجسم بذاته، لا كصورة المائية في الماء، فإنها إذا فارقت عند إنقلاب الماء هواء، كان المفارق ما تتبدل الماهية بسببه لا كالحرارة والبرودة إذا فارقت الماء، فإن الماهية لا تبدل فإنا إذا سئلنا عن الحار والبارد: ما هو؟ قلنا: هو ماء. وإذا سئلنا عن الهواء لم نقل إنه ماء.
وإن أوردنا ثم وقلنا ماء حار أو بارد ولم نورد ههنا فنقول ماء قد تخلخل وانتشر، فإن صورة المائية قد زالت. والمتكلمون أيضا يسمون هذا أيضا عرضا، فإنهم يعنون بالعرض ما هو في محل، وهذه الصورة في محل والإصطلاح لا ينبغي أن ينازع فيه، فلكل فريق أن يصطلح في تخصيص العرض بما يريد، ولكن لا يمكن إنكار الفرق بين الحرارة بالنسبة إلى الماء التي تزول عند البرودة، وبين صورةالمائية التي تزول عند إنقلابه هواءن فإن الزائل ههنا يبدل المذكور في جواب ما هو والزائل لثم لا يبدله. والجوهر على إصطلاح المتكلمين عبارة عما ليس في محل، فصورة عندهم جوهر والمعنى المشترك بين الماء والهواء إذا استحال الماء هواء يسمى عندهم أيضا جوهرا وهو الهيولي، فإذا فهم معنى الموضوع، فالفرق بينه وبين المحمول إن الجوهر ينقسم إلى مال يس في الموضوع، ولا يمكن أن يكون محمولا، وإلى ما ليس في موضوع، ويمكن حمله على موضوع. والأول هو الجوهر الشخصي كزيد وعمرو. والثاني هو الجواهر الكلية كالإنسان والجسم والحيوان، فإنا نشير إلى موضوع مثل زيد ونحمل هذه الجواهر عليه، وتقول زيد إنسان وحيوان وجسم، فيكون المحمول جوهرا لا عرضا غلا أنه محمول عرف ذات الموضوع، وليس خارجا عن ذاته، لا كالعرض إذا حمل على الجوهر فإنه يعرف به شيء خارج عن ذاته، لا كالعرض إذا حمل على الجوهر فإنه يعرف به شيء خارج عن ذات الموضوع، إذ البياض يحملعلى الجوهر وهو خارج عن ذات الجوهر، ولذلك لا يحد هذا الموضوع بحد المحمول، إذ تقول في حد البياض: إنه لو يفرق البصر ولا يحد الموضوع.
وأما الإنسان والحيوان والجسم ونظائرها فنحملها على شخص زيد، ويحد هذه الجواهر بحد، وهو بعينه حد الموضوع، إذ نقول لزيد: إنه حيوان ناطق مائت، او هو جسم ذو نفس حساس متحرك بالإرادة؛ فبهذا يتهيأ الفرق بين الجواهر الكلية والجواهر الجزئية. وأما الأعراض فجملتها في موضوع، ولكنها تنقسم إلى ما يقال علىموضوع بطريق الحمل عليه، وإلى ما لا يحمل على موضوع، فالمحمول على موضوع هي الأعراض الكلية كاللون مثلا، فإنه يحمل على البياض والسواد وغيره، فيقال: البياض لون والسواد لون. وأما الأعراض الشخصية فلايمكن حملها ككتابة زيد وبياض شخص، إذ لا يمكن أن يحمل على شىء حتى يقال هو كتابة زيد أو بياض شخص، وإذا قلت زيد كاتب أو أبيض لم يكن ذلك حملا للبياض بل معناه هو ذو كتابة. ومهما قلنا هو ذو إنسان لم يكن الإنسان محمولا، وكذا إذا ذو بياض، فإذا الشيء إنما يمكن أن يكون محمولا باعتبار كونه كليا، عرضيا كان أو جوهرا. وسيأتي حقيقة معنىالكلي في أحكام الوجود. فإن قيل: فالجوهر الكلي أولى بمعنى الجوهرية أم الشخصي؟ قلنا: الجوهر الكلي على ما سيأتي قوامه بالشخصيات، إذ لولاها لم تكن
الكليات موجودةن فالشخص في الرتبة متقدم عليه، لكن الشخص في صيرورته معقولا يفتقر إلى الكلي ولا يفتقر ف يالوجود إليه، وتحقيق هذا عند بيان معنى الكلي. فإن قيل: فما أقسام الجوهر؟ قلنا: إذا أريد بهذا الجوهر القائم لا في محل فقط أو القائم لا في موضوع انقسم إلى جسم، أعني إلى متحيز وغير متحيز، والجسم ينقسم إلى مغتذ وغير مغتذ. والمغتذي ينقسم إلى حيوان وإلى غير حيوان. والحيوان ينقسم إلى ناطق وغير ناطق، وهذا تدخل فيه الحيوانات كلها على اختلاف أصنافها، وينفصل كل نوع بفصل يخصه وإن كنا لا نشعر به. وغير المغتذي يدخل فيه السماء والواكب والعناصر الأربعة والمعادن كلها؛ فهذه أقسام الجواهر. وذهب أكثر المتكلمين أن الجواهر المتحيزة كلها جنس واحد، وإنما تختلف بأعراضها، إذ للجسم ماهية واحدة وهو كونه متحيزا مؤتلفا، فكونه حيا معناه قيام العلم والحياة به. والفلاسفة يقولون: إن هذه الجواهر مختلفة في أنفسها بإختلاف حدودها،
وإن الصفات المقومات لها هيئات للأشياء التي بتبدل ماهيتها يتبدل جواب ما هو، ويوجب اختلافا في تحقيق الذات وتحقيق الحق في هذين المذهبين ليس من غرضنا، بل الغرض بيان معنى الجوهر وأقسامه. وقد حان القول في الكمية والمقدار. اعلم أن الكم عرض، وهو عبارة عن المعنى الذي يقبل التجزؤ والمساواة والتفاوت لذاته، فالمساواة والتفاوت والتجزؤ من لواحق الكم، فإن لحق غيره فبواسطته لا من حيث ذات ذلك الغير، وهو ينقسم إلى الكم المتصل والمنفصل. أما المتصل فهو كل مقدار يوجد لأجزائه حد مشترك يتلاقى عنده طرفاه، كالنقطة للخط والخط للسطح، والآن الفاصل، للزمان الماضي والمستقبل. والمتصل ينقسم إلى ذي وضع وإلى ما ليس بذي وضع، وذو الوضع هو الذي لأجزائه اتصال وثبات وتساوق في الوجود معا، بحيث يمكن أن يشار إلى كل واحد منهما أنه أين هو من الآخر، فمن ذلك ما يقبل القسمة في جهة واحدة فقط كالخط،
ومنه ما يقبل في جهتين متقاطعتين على قوائم وهو السطح، ومنه ما يقبل في جميعها على قوائم وهو الجسم. والمكان أيضا ذو وضع لأنه السطح الباطن من لحاوي فإنه يحيط بالمحوي فهو مكانه. وفريق يقولون: مكان الماء من الآنية الفضا الذي يقدر خلاء صرفا لو فارقه الماء ولم يخلفه غيره، وهذا أيضا عند القائل من جملة الكم المتصل فإنه مقدار يقبل الإنقسام والمساواة والتفاوت. وأما الزمان فهو مقدار الحركة إلا أنه ليس له وضع، إذ لا وجود لأجزائه معا، وإن كان له إتصال إذ ماضيه ومستقبله يتحدان بطرف الآن. وأما المنفصل فهو الذي لا يوجد لأجزائه لا بالقوة ولا بالفعل شيء مشترك يتلاقى عنده طرفاه كالعدد والقول، فإن العشرة مثلا لا إتصال لبعض أجزائها بالبعض، فلو جعلت خمسة من جانب وخمسة من جانب لم يكن بينهما حد مشترك يجري مجرى النقطة من الخط والآن من الزمان، والأقاويل أيضا من جملة ما يتعلق بالكمية فإن كل ما يمكن أن يقدر ببعض أجزائه فهو ذو أقدار، إذ العشرة يقدرها الواحد بعشر مرات والإثنين بخمسة، وما من عدد إلا ويقدر ببعض أجزائهن وكذلك الزمان فإن الساعة تقدر الليل والنهار، والنهار والليل يقدر بهما الشهر، وبالشهر السنة. وهذه الأمور تجريمجرى الأذرع من الأطوال، فكذلك الأقاويل تقدر ببعض أجزائها، كما يقدر في العروض إذ به تعرف الموازنة والمساواة والوحدة والتفاوت، فهذه أقسام الكمية.
القول في الكيفية والمعني بها الهيئات التي بها يحاب عن سؤال السائل عن آحاد الأشخاص إذا قال كيف هو، واحترزنا بالأشخاص عنالفصول فغن ذلك يذكر في السؤال عن المميز للشيء بأي شيء هو. وبالجملة هي عبارة عن كل هيئة قارة في الجسم لا يوجب اعتبار وجودها فيه نسبة للجسم إلى خارج، ولا نسبة واقعة في أجزائه. وهذان الفصلان للإحتراز عن الإضافة والوضع كما سيأتي. ثم هذه الكيفية تنقسم إلى ما يختص بالكم من جهة ما هو كم كالتربيع للسطح، والإستقامة للخط والفردية للعدد وكذا الزوجية. وأما الذي لا يختص بالكم فينقسم إلى المحسوس وغير المحسوس. أما المحسوس فهو الذي ينفعل عنه المحسوس أي يحدث فيها آثارا منها، كاللون والطعوم والحرارة والبرودة وغير ذلك مما يؤثر في الحواس الخمس، فما يكون من جملة ذلك راسخا يسمى كيفيات إنفعالية كصفرة الذهب وحلاوة العسل. وما كان سريع الزوال كحمرة الخجل وصفرة الوجل يسمى إنفعالا. وأما غير المحسوس فينقسم إلى الإستعداد لأمر آخر،
وإلى كمال لا يكون إستعدادا لغيره. أما الإستعداد فالذي للمقاومة والإنفعال يسمى قوة طبيعية كالمصحاحية والصلابة وقوة المذكرة والمصارعة، وإن كان استعدادا لعسر الفعل وسهولة الإنفعال سمي ضعفا يعني نفي القوة كالممراضية واللين. وفرق بين الصحة وبين المصحاحية، فإن المصحاح قد لا يكون صحيحا والممراض قد يكون صحيحا. وأما الكمالات التي لا يمكن أن تكون إستعدادا لكمال آخر وتكون غير محسوسة بذاتها كالعلم والصحة، فما كان منها سريع الزوال سمي حالات كغضب الحليم ومرض المصحاح، وما كان ثابتا سمي ملكة كالعلم والصحة، أعني العلم الثابت بطول الممارسة دون علوم الشادي التي هي معرضة للزوال، فإن العلم كيفية للنفس غير محسوسة. القول في الإضافة وهو المعنى الذي وجوده بالقياس إلى شيء آخر ليس له وجود غيره البتة، كالأبوة بالقياس إلى البنوة لا كالأب، فإن له وجودا يخصه كالإنسانية مثلا، وتميز هذا المعنى عن الكيف والكم لا خفاء به
فهذا أصله. وأما أقسامه فإنه ينقسم بحسب سائر المقولات التي تعرض فيها الإضافة، فإنها تعرض للجواهر والأعراض، فإن عرضت للجوهر حدث منه الأب والإبن والمولى والعبد ونظيرها، وإن عرضت في الكم حدث منه الصغير والكبير والقليل والكثير والنصف والضعف ونظيره، وإن عرضت في الكيفية كانت منه الملكة والحال والحس والمحسوس والعلم والمعلوم، وإن عرضت في الأين ظهر منه فوق وأسفل وقدام وتحت ويمين وشمال، وإذا عرضت في المتى حصل منه السريع والبطيء والمتقدم والمتأخر، وكذلك باقي المقولات.
وتنقسم بنحو آخر من القسمة إلى ما يختلف فيه إسم المتضايفين: كالأب والإبن والموالى والعبد، وإلى ما يتوافق فيهما الإسمب: كالأخ مع الأخ والصديق والجار، وإلى ما يختلف بناء الإسم مع اتحاد ما منه الإشتقاق: كالمالك والمملوك والعالم والمعلوم والحاس والمحسوس. ومهما لم يوجد المضاف من حيث هو مضاف سقطت الإضافة، فإن الأب إنسان، فهو باعتبار كونه إنسانا غير مضاف بل الدال على إضافته لفظ الأب. وأمارة اللفظ الدال على الإضافة التكافؤ من الجانبين، فإن الأب أب للإبن، والإبن ابن للأب. ولو قيل: الأب أب للإنسان لم يمكن ان يقال: الإنسان إنسان للأب. وإذا قيل: السكان سكان لذي السكان، أمكنك أن تقول: وذو السكان هو ذر سكان بالسكان، مهما لم يكن لذي السكان وهو أحد المضايفين إسما خاصا، كما تقول لليد يد لذي اليد، وذو اليد ذو يد باليد. فلو قلنا: السكان سكان للذورق، لم ينقلب لأنه ليس لكل ذورق سكان، فيكون المضاف إليه غير مذكور فيه اللفظ الدال على الإضافة.
وإذا قلت: اليد يد الإنسان، لم يمكن أن تقول: الإنسان إنسان لليد، بل ينبغي أن يقال: اليد لذي اليد حتى ينقلب بطريق التكافؤ. ومن شرائد هذا التكافؤ ان يراعة إتحاد جهة الإضافة، حتى أن يؤخذ جميعا بالفعل أو جميعا بالقوة، وإلا ظن تقدم احدهما على الآخر. ومن خواص الإضافة أنه إذا عرف أحد المضافين محصلا به عرف الآخر أيضا كذلك، فيكون وجود أحدهما مع وجود الآخر لا قبله ولا بعده، وربما يظن أن العلم والمعلوم ليسا متساويين بل المعلوم متقدم على العلم، وليس كذلك بل العلم مثال للمعلوم بكونه معلوما مع كون العلمف ي نفسه ومع كون الذات عالما بلا ترتيب، إلاّ أن يوحد المعلوم والمحسوس معلوما ومحسوسا بالقوة لا بالفعل، فيكون متقدما على العلم بالفعل، ولا يكون متقدما على العلم بالقوة. القول في الأين والمراد به نسبة الجوهر إلى مكانه الذي هو فيه، كقولك في جواب أين زيد: إنه في السوق او في الدار، ولسنا نعني به أن الأين البيت بل المفهوم من قولنا في البيت هو العرض له ولكل جسم أين، ولكن بعضها بين كما للإنسان واحد العالم، وبعضها يعلم على تأويل كما لجملة العالم، فإنه له أين على تأويل، فكل جسم له أين خاص قريب واينات مشتركة تشتمل عليه بعضها أصغر
من بعض وأقرب إلى الأول، مثل زيد وهو في البيت، فإن أينه القريب مقعد الهواء المحيط به الملاقى لسطح بدنه ثم البلد ثم المعمور من الأرض ولذلك يقال: هو في البيت وفي البلد وفي المعمور وفي الأرض وفي العالم. وأما أنواع الإين فمنها ما هو أين بذاته، ومنها ما هو أين مضاف، فالذي هو أين بذاته كقولنافي الدار وفي السوق، وما هو أين بالإضافة فهو مثل فوق وأسفل ويمنة ويسرة وحول ووسط، وما بين وما يلي وعند ومع وعلى وما أشبه ذلك، ولكن لا يكون للجسم أين مضاف ما لم يكن له أين بذاته، فما كان فوق فلا بد وأن يكون له أين بذاته، إن كان معنى كونه فوق فوقية مكانية. القول في متى وهو نسبة الشيء إلى الزمان المحدود الذي يساوق وجوده، وتنطبق نهاياته على نهاية وجوده أو زمان محدود يكون هذا الزمان جزءا منه. وبالجملة فما يقال في جواب متى والزمان المحدود هو الذي حد بحسب بعده من الآن، أما في الماضي أو المستقبل وذلك إما باسم مشهور كقولك أمس وأول من أمس وغدا والعام القابل وإلى مائة سنة وإما بحادث معلوم البعد من الآن كقولك على عهد الصحابة ووقت الهجرة، والزمان المحدود إما أول وإما ثان له؛
فزمانه الأول هو الذي يغلف وجوده وانطبق عليه غير منفصل عنه، وزمانه الثاني هوالزمان المحدود الأعظم الذي نهاية الأول جزء منه، مثل أن يكون الحرب في ست ساعات من يوم من شهر من سنة، فتلك الساعات الست هي الزمان الأول المطابق، واليوم والشهر والسنة أزمنة ثوان يضاف إليها باعتبار كون زمانه جزءا منها فيقال: وقع الحرب في السنة الفلانية ومساوقة الزمان لوجود الشيء غير تقدم الزمان له، فإنا نعني بالمساوق المنطبق، وذلك قد يكون بنهايات الزمان الذي ينقسم والمقدار جواب للسائل عن ذلك بكم، كما يقال: كم عاش فلان؟ فيقال: مائة سنة؛ فالزمان مقدار، وإذا قيل: كم دامت الحرب؟ فيقال: سنة؛ فهذا مطابق لا مقدم، فقد يكون المطابق ممتدا ولكن ليس من شرطه الإمتداد، ومن شرط الزمان المقدم الإمتداد والإنقسام. القول في الوضع وهو عبارة عن كون الجسم بحيث يكون لأجزائه بعضها إلى بعض نسبة بالإنحراف والموازاة والجهات وأجزاء المكان، إن كان في مكان يقله كالقيام والقعود والإضطجاع والإنبطاح، فإن هذا الإختلاف يرجع إلى تغاير نسبة الأعضاء إذ الساق يبعد من الفخذ في الإنتصاب وفي القعود قد تضاما، وإذا مد رجليه مستلقيا فوضع أجزائه كوضعه إذا انتصب، ولكن بالإضافة
إلى الجهة والمكان يختلف إذ كان الرأس في القيام فوق الساق وليس ذلك عند الإستلقاء، ومهما مشى الإنسان فالوضع لا يتغير عليه والمكان يتغير، فليس الوضع هو تبدل المكان. والوضع قد يكون للجسم بالإضافة إلى ذاته كأجزاء الإنسان، فغنه لو لم يكن جسم غيره لكان وضع أجزائه معقولا، وقد يكون بالإضافة إلى جسم آخر وذلك في أينه الذي يثب له بالإضافة من فوق وتحت ويمين ووسط وغيرها. ولما كانت الأمكنة ضربين: ضرب بالذات وضرب بالإضافة، صارالوضع أيضا ضربين، لكن لا يكون للشيء وضع بالإضافة ما لم يكن له وضع بذاته. ولما كان المكان الذي بذاته لا بالإضافة ضربين: ضرب هو للجسم أول خاص، وضرب هو ثان ومشترك له ولغيره، صار له وضعه أحيانا بالقياس إلى مكان الأول الخاص وأحيانا إلى مكانه الثاني المشترك له ولغيره وآفاقه، إذ لكل إنسان موضع من القطبين مثلا زمن الآفاق، ولكل جزء من السماء وضع من أجزاء الأرض في كل حالة من الأحوال، وبحركته يبدل في الوضع فقط لا في المكان. القول في العرض الذي يعبر عنه بله وقد يسمى الجده. ولما مثل هذا بالمنتعل والمتسلح والمنطلس فلا يتحصل له معنى سوى أنه نسبة الجسم إلى الجسم المنطبق على جميع بسيطه
أوعلى بعضه، إذا كان المنطبق ينتقل بانتقال المحاد به المنطبق عليه، ثم منه ما هو طبيعي كالجلد للحيوان والخف للسلحفاة، ومنها ماهو إرادي كالقميص للإنسان. وأما الماء في الإناء فليس من هذا القبيل، لأن الإناء ينتقل بانتقال الماء، بل هو بالعكس فلا تدخل تلك النسبة في هذه المقولات بل في مقولة الاين؛ والله أعلم. القول في أن يفعل ومعناه نسبة الجوهر إلى أمر موجود منه في غيره غير باقي الذات، بل لا يزال يتجدد كالتسخين والتحديد والقطع، فإن البرودة والسخونة والإنقطاع الحاصلة بالثلج والنار والأشياء الحارة في غيرها لها نسبة إلى أسبابها، عند من اعتقد أسبابا في الوجود، فتلك النسبة من جانب السبب يعر عنه بأن يفعل إذا قال يسخن ويبرد، ومعنى يسخن يفعل السخونة، ومعنى يبرد يفعل البرودة؛ فهذه النسبة هي التي عبر عنها بهذه العبارات، وقد يعتقد معتقد أن تسمية ذلك فعلا مجازا إذ كان يرى الفعل مجازا في كل من لا اختيار له، ولكن لا ينك رمع ذلك نسبة لأجلها يصدق قوله سخنته النار، فتلك النسبة جنس من الأعراض عبر عنه بالفعل أو بغيره، فلا مضايقة في العبارات. القول في الإنفعال وهو نبة الجوهر المتغير إلى السبب المغير، فإن كل منفعل فعن فاعل، وكل متسخن ومتبرد فعن مسخن ومبرد بحكم العادة المطردة عند أهل الحق،
وبحكم ضرورة الجبلة عند المعتزلة والفلاسفة. والإنفعال على الجملة تغير، والتغير قد يكون من كيفية إلى كيفية مثل تصير الشعر من السواد إلى البياض، فغنه غيره الكبر على التدريج وصيره من السواد إلى البياض، فإنه غيّره الكبر على التدريج وصيره من السواد إلى البياض قليلا قليلا بالتدريج، ومثل تصير الماء من البرودة إلى الحرارة، فإنه حين ما يتسخن الماء يحسر عنه البرودة قليلا قليلا، وتحدث فيه الحرارة قليلا قليلا على الإتصال إلا أن ينقطع سلوكه، فيقف فهو في كل وقفة على حالة واحدة تفارق ما قبلها وما بعدها، فليست حالته مستقرة في وقت السلوك. وعلى الجملة لا فرق بين قولك ينفعل وبين قولك يتغير. وأنواع التغير كثيرة وهي أنواع الإنفعال بعينه؛ فهذه هي الأجناس العالية للموجودات كلها، وقد جرى الرسم بحصرها في هذه العشرة؛ فإن قيل: فهذا الحصر أخذ تقليدا من المتقدمين أو عليه برهان؟ قلنا: التقليد شأن العميان، ومقصود هذا الكتاب أن تتهذب به طرق البرهان، فكيف يقنع فيه بالتقليد بل هو ثابت بالبرهان ووجهه أن هذا الحصر فيه ثلاث دعاوي: إحداهما أن هذه العشرة موجودة وهذا معلوم بمشاهدة العقل والحس كما فصلناه. والآخر إنه ليس في الوجود شيء خارج عنها وعرف ذلك بل إن كل ما أدركه العقل ليس يخلو من جوهر أو عرض، وكل جوهر ينطلق عليه عبارة أو يختلج به خاطر فممكن إدراجه تحت هذه الجملة وأما أنه ليس بممكن أن يقتصر على تسعة فطريق معرفته أن تعرف تباين هذه الأقسام بما ذكرناه اختلافها، فيتم العلم بهذه الدعوى بهذه الجملة.
نعم لا يبعد ان يتشكك ناظر في وجه مباينة قسم لقسم حتى يلتبس عليه وجه الفرق بين الإضافة المحضة وبين النسبة إلى المكان أو نسبة الإنفعال، لأن هذه الأمور فيها أيضا نسبة، ولكن فيها وراء النسبة شيء، ولكن إذا أمعن النظر ظهر له التباين كما لا يبعد أن يتشكك في عرض من الأعراض أنه من قبيل هذا القسم أو ذاك، كما يتشكك ناظر في الفرق بين نسبة الجوهر إلى مكانه، وبين نسبته إلى جوهر بطريق المجازاة، وذلك إنما يعرض من حيث يكون إسم صفة ويكون كونه في المكان من حيث هو مضاف، ولا يوجد له إسم يدل عليه من حيث تلكلاصفة بغير إضافة حتى يتكلف، فيوضع له إسم الاين ويوضع للوقوع فيالزمان إسم متى، فمهما كان إسمه الدال عليه منحيث هو مضاف هو الذي جعل إسمه الدال عليه من حيث هو صفة إعترض هذا الشك، ويكون هذا تقصير من واضع الأسامي، وكذلك قد يعرض في هذا أن يكون إسم جنس يدل عليه من حيث هي مضافة، فيظن أن الجنس إضافة، ويتعجب أن الجنس كيف يكون من مقولة المضاف، ويكون النوع من مقولة أخرى، وسببه ما ذكرنا. وأن تشكك في التكاثف والتخلخل أنه من مقولة الكيفية أو من مقولة الوضع وأنتشأ الشك من إشتراك الإسم ههنا، فإن التخلخل أن نتباعد أجزاء الجسم بعضها من بعض لتخللها أجسام غريبة من هذا أوغيره، والتكاثف معناه تقارب أجزائه بالتلبد حتى ينعصر ما فيه من هواء فيسيل من خلله فتتقارب أجزاؤه وتتماس.
؟؟؟ الفن الثاني ؟ في انقسام الوجود بأعراضه الذاتية إلى أصنافه وأحواله مثل كونه مبدأ وعلة ومعلولا، وانقسامه إلى ما هو بالقوة وما هو بالفعل وإلى القديم والحادث والقبل والبعد والمتقدم والمتأخر، والكلي والجزئي والتام والناقص والواحد والكثير والواجب والممكن، فإن هذه العوارض تثبت للموجود من حيث هو موجود، لا من حيث أنه شيء آخر أخص منه ككونه جسما أو عرضا أو غيرهما. ؟ القول في الإنقسام إلى العلة والمعلول ؟؟؟؟؟؟ واتصال الموجود بكونه مبدأ وعلة والمبدأ إسم لما يكون قد استتم وجوده في نفسه إما عن ذاته وإما عن غيره، ثم يحصل منه وجود شيء آخر يتقوم به، ويسمى هذا علة بالإضافة إلى ما هو مبدأ له، ثم لا يخلو
إما أن يكون؟ كالجزء من المعلول مثل الخشب وصورة السرير للسرير أو لا يكون كالجزء، فالذي يكون كالجزء قد لا يجب عن وجوده وجود المعلول بالفعل، ويسمى عنصرا وهو كالخشب للسرير، وقد يجب عن وجوده لا محالة وجود المعلول بالفعل وهو صورة السرير، ويسمى العنصر علة قابلية والصورة علة صورية، والذي ليس كالجزء ينقسم إلى مباين للمعلول وإلى ملاق. والملاقي ينقسم إلى ما يكتسب صفة من المعلول فينعت به، وهو كالموضوع للعرض إذ يقال الموضوع حار وبارد وأسود وأبيض، وإلى ما يكون بالعكس منه، وهو أن يكون المعلول يكتسب النعت من العلة فينعت المعلول بالعلة، وهو كصورة المائية للمادة المشتركة بين الماء والهواء عند الإستحالة. وقد يسمى ذلك المشترك هيولي، ولا مشاحة في إطلاق هذا الإسم وإبداله. وأما المباين فينقسم إلى ما منه الوجود وليس الوجود لاجله، وهو العلة الفاعلية كالنجار للسرير، وإلى ما لأجله وجود المعلول وهو العلة الغائية كالصلوح للجلوس للكرسي والسرير. والعلة الأولى هي الغاية، فلولاها لما صار النجار نجارا، وكونها علة سابقة سائر العلل إذ بها صارت العلل علالا ووجودها متأخرا عن وجود الكل، وإنما المتقدم عليتها،
والعلة أبدا أشرف من القابل لأن الفاعل مفيد والقابل مستفيد. ثم العلة قد تكوهن بالذات وقد تكون بالعرض، وقد تكون بالقوة وقد تكون بالفعل، وقد تكون قريبة وقد تكون بعيدة، وقد سبقت أمثلتها. القول في الإنقسام إلى ما هو بالقوة وإلى ما هو بالفعل الموجود قد يقال أنه بالفعل وقد يقال أنه بالقوة، وإسم القوة قد يطلق على معنى آخر فيلتبس بالقوة التي تقابل بالفعل، فليقدم بيانها إذ يقال قوة مبدأ التغيير إما في المنفعل وهو القوة الإنفعالية، وإما في الفاعل وهو القوة الفعلية. ويقال لما به يجوز من الشيء فعل أو انفعال وما به يصير الشيء مقوما للآخر،
ولما به يصير الشيء متغيرا أو ثابتا، فإن التغير لا يخلو من الضعف، وقوة المنفعل قد تكون محدودة متوجهة نحو شيء واحد معين، كقوة الماء على قبول الشكل دون حفظه، بخلاف الشمع الذي فيه قوة القبول والحفظ جميعا. وقد يكون في الشيء قوة إنفعالية بالإضافة إلى الضدين، كقبول الشمع للتسخين والتبريد، وكذلك قوة الفاعل تتوجه إلى شيء واحد متعينن كقوة النار على الإحراق فقط، وقد تتوجه نحو أشياء كثيرة كقوة المختاربن على الأمور المختلفة، وقد يكون في الشيء لأمور ولكن بعضها يتوسط البعض كقوة القطن على قبول صورة الغزل والثوبية، وقد يسهو الناظر في لفظ القوة ويلتبس عليه القوة بهذا المعنى بالقوة التي تذكر بإزاء الفعل، والفرق بينهما ظاهر من أوجه: الأول: أن القوة التي بإزاء الفعل تنتهي مهما صار الشيء بالفعل، والقوة الأخرى تبقى موجودة في حالة كونها فاعلة. الثاني: أن القوة الفاعلة لا يوصف بها إلا المبدأ المحرك، والقوة الثانية يوصف بها في الأكثر الأمر المنفعل. الثالث هو أن الفعل الذي بإزاء القوة الأخرى يوصف بها كل شيء من قبيل الموجودات الحاصلة، وإن كان انفعالا أو حالا لا فعلا ولا إنفعالا. فإن قيل: قولكم أن الشيء بالقوة لا بالفعل يرجع حاصله إلى الإستعداد للشيء، وقبول المحل له وهذا مفهوم،
وأما لاقوة الأخرى التي هي فاعلة كقوة النار على الإحراق وهذا مفهوم، وأما القوة الأخرى التي هي فاعلة كقوة النار على الإحراق كيف يعترف بها من يرى أن النار لا تحرق، وإنما الله تعالى يخلق الإحراق عند وقوع اللقاء بين القطن والنار مثلا، بحكم إجراء الله تعالى العادة. قلنا: غرضنا لما ذكرنا شرح معنىالإسم لا تحقيق وجود المسمى، وقد نبهنا على وجه تحقيق الحق فيه في كتاب تهافت الفلاسفة والغرض أن لا يلتبس إحداهما بالأخرى إذا استعملهما معتقد ذلك. القول في إنقسام الموجود إلى القديم وإلى الحادث والقبل والبعد أما القديم فهو إسم مشترك بين القديم بحسب الذات وبين القديم بحسب الزمان، فالذي بحسب الزمان هو الذي لا أول لزمان وجوده، وأما الذي بحسب الذات فهو الذي ليس لذاته مبدأ وعلة هو به موجود، والمشهور الحقيقي هو الأول، والثاني كأنه مستعار من الأول، وكأنه مجاز، وهو من إصطلاح الفلاسفة، وبهذا الإشتراك يشترك الحادث أيضا، فالحادث بحسب الزمان هو الذي لزمان وجوده إبتداء، وبحسب الذات هو الذي لذاته مبدأ هي به موجودة. والعالم عند الفلاسفة حادث بالمعنى الثاني قديم بالمعنى الأول،
وصانع العالم قديم على التأويلين جميعا، وتسميتهم العالم حادثا بتأولهم مجاز محض، إذ المفهوم الكائن بعد إن لم يكن، والعالم عندهم ليس كائنا بعد إن لم يكن. ومن تأويلاتهم قولهم: إن للعالم نسبة إلى طبيعة الوجود ونسبة إلى العدم، والوجود حاصل له لا من ذاته بل من غيره، وإذا قدرنا عدم ذلك الغير لكان له من ذاته العدم وما للشيء من ذاته قبل ما للشيء من غيره قبلية بالذات، فالعدم له قبل الوجود؛ فهذا هو التأويل وهو تكلف من الكلام في اطلاق اللفظ، وليس ينكر عليهم تركهم لفظ
(الحادث) حتى يتكلفوا لانفسهم وجها فى اطلاق اللفظ، بل ينكر عليهم ترك اعتقاد محل الحدوث، وإن وجود العالم ليس مسبوقا بعدم، وإذا لم يعتقد ذلك فالأسامي لا تغني ولا مشاحة فيها، والعجب أنهم يقولون: إنا باعتقاد حدوث العالم أولى؛ فإنا نقول: المعلول حادث في كل زمان، فوصف الحدوث له ثابت عندهم الدهر كله، وعندكم في حالة واحدة، وإن كان المفهوم من الحدوث ما ذكروه فهو أحق به إلا أن المفهوم من الحدوث ما ذكرناه، وقد نفوه وأطلقوا اللفظ على أمر آخر يستمر في جميع الأزمنة، وطريق بطلانه ذكرناه في تهافت الفلاسفة. وأما القبل فإنه إسم مشترك في محاورات النظار والجماهير، إذ يطلق وتراد القبلية بالطبع كما يقال الواحد قبل الإثنين، وذلك في كل شيء لا يمكن أن يوجد الآخر إلا وهو موجود، ويوجد هو وليس الآخر بموجود، فما يمكن وجوده دون الآخر فهو قبل الآخر، وذلك الآخر، قد يقال له بعد وكأنه مستعار ومجاز، بل القبلية الظاهرة المشهورة هي القبلية الزمانية، وأمرها ظاهر، ويقال قبل للتقدم في المرتبة كتقدم الجنس على النوع بالإضافة إلىالجنس الأعلى، وقد يكون بالنسبة إلى شيء معين كما يقال الصف الأول قبل الصف الثاني، إذا صار المحراب هو المنسوب، ولو نسب إلى باب المسجد ربما كان الصف الأخير موصوفا بالقبلية، وقد يقال قبل بالشرف كما يقال محمد صلى الله عليه وسلم قبل موسى، وقبل أبي بكر وعمر وقد يقال قبل للعلة بالإضافة إلى المعلول مع أنهما في الزمان معا وفي كونهما بالقوة أو بالفعل يتساويان، ولكن من حيث أن لأحدهما الوجود غير
مستفاد من الآخر ووجود الآخر مستفاد منه فهو متقدم عليه، وإذا تأملت حال المتقدم في جميع هذه المعاني رجع إلى ان المتقدم هو الذي له الوصف الذي للمتأخر بكل حال، وليس للمتأخر ذلك إلا وهو موجود للمتقدم. ؟ القول في إنقسام الموجود إلى الكلي والجزئي إعلم أن الكلي إسم مشترك ينطلق على معنيين، هو باحدهما موجود في الأعيان، وبالمعنى الثاني موجود في الأذهان لا في الأعيان. أما الأول فهو للشيء المأخوذ على الإطلاق منغير اعتبار ضم غيره إليه، واعتبار تجريده من غيره بل من غير التفات إلى أنه واحد، فإن الإنسان مثلا معقول بأنه حقيقة ما والزم شيء للإنسانية وأشده التصاقا به كونه واحدا أو كثيرا، إذ لا يتصور إلا كذلك، ولكن العقل قادر على أن يعتبر الإنسانية المطلقة من غير التفات إلى أنها واحدة أو أكثر، فإن الإنسان بما هو إنسان شيء وبما هو واحد أو أكثر، وذلك له بالقوة أم بالفعل شيء آخر، فإن الإنسان إنسان بلا شرط آخر البتة، ثم العموم أو الخصوص شرط زائد على ما هو إنسان، والوحدة والكثرة كذلك، فإن من علم الإنسان فقد علم أمرا واحدا ومن علم أن الإنسان المعلوم له وحدة فقد علم شيئين أحدهما الإنسان
والآخر الوحدة، وكذلك إذا علم الكثرة، وكذا إذا علم الخصوص والعموم، فكل ذلك زائد على المعلوم، وليس ذلك إذا فرضت هذه الأحوال بالفعل فقط بل هو كذلك، وإن فرضت بالقوة فإنك تفرض بالقوة الإنسان المطلق من غير التفات إلى الوحدة والكثرة، وتفرض الوحدة والكثرة بعده فيكون في اعتبارك إنسانية وإضافة ما للإنسانية إلى الوحدة أو الكثرة، وفرض الوحدة والكثرة زائد على أصل الإنسانية. نعم الكثرة والوحدة تلزم الإنسانية في الوجود لا محالة، وليس كل ما يلزم الشيء فهو له في ذاته، فنحن نعلم أن الإنسانية بما هي إنسانية واحدة أو كثيرة، ففرق بين قولنا: إن الإنسانية لا توجد وله إحدى الحالتين، وبين قولنا: إحدى الحالتين له بما هو إنسانية. وليس نقيض قولنا أن الإنسانية بما هي إنسانية واحدة أن الإنسانية بما هي إنسانية كثيرة، بل نقيضها أن الإنسانية ليست بما هي إنسانية واحدة، وإذا كان كذلك جاز أن توجد واحدة أو كثيرة، ولكن لا بما هي إنسانية، فالكلي قد يراد به الإنسانية المطلقة الخالية عن إشتراط الوحدة أو الكثرة قد يراد به الإنسانية المطلقة الخالية عن اشتراط الوحدة أو الكثرة أو غير ذلك من لواحقها المنفكة عن كل اعتبار، سوى الإنسانية بالنفي والإثبات جميعا، وفرق بين قولنا: إنسانية بلا شرط آخر، وبين قولنا: إنسانية بشرط أن لا يكون معه غيره،
لأن الأخير فيه زيادة اشتراط نفي، والأول نعني به الإطلاق الذي هو منقطع البتة عما وراء الإنسانية نفيا كان أو إثباتا، فالكلي بهذا المعنى موجود في الأعيان فإن وجود الوحدة أو الكثرة او غير ذلك من اللواحق مع الإنسان، وإن لم يكن بما هو إنسانية، إذ لا تخرج الإنسانية عنها في الوجود، فإن لكل موجود مع غيره لا في ذاته وجودا يخصه، وانضمام غيره إليه لا يوجب نفي وجوده من حيث ذاته وجودا يخصه، وانضمام غيره إليه لا يوجب نفي وجوده من حيث ذاته، فالإنسانية عند الإعتبار موجودة بالفعل في آحاد الناس محمول على كل واحد، لا على أنه واحد بالذات ولا على انه كثير، فإن ذلك ليس بما هو إنسانية. والمعنى الثاني للكلي هو الإنسانية مثلا بشرط أنه مقولة بوجه من الوجوه المقولية على كثيرين، وهذا غير موجود في الأعيان، إذ يستحيل وجود شيء واحد بعينه يكون محمولا على كل واحد من الآحاد في وقت واحد معين. وذلك لأن الإنسان الذي اكتنفته الأعراض المخصصة لشخص زيد لمتكتنفه أعراض عمرو، حتى تكون تلك الإنسانية بعينها موجودة في عمرو، يكون هو ذلك في العدد بعينه، وربما يكتنفهما أعراض متعاندة، ولكن هذا المعبر عنه موجود في الأذهان على معنى أنه إذا سبق إلى الحس شخص زيد، حدث في النفس أثر، وهو انطباع صورة الإنسانية فيه، وهو لا يعلم، وهذه الصورة المأخوذة من الإنسانية المجردة من غير التفات إلى العوارض المخصصة لو أضيفت إلى إنسانية عمرو لطابقته، علىمعنى أنه لو ظهر للحس فرس بعده يحدث في النفس أثر آخر، ولو ظهر عمرو لم يتجدد في نفس أثر بل سائر أشخاص الناس في ذلك مستوية، سواء الأشخاص الموجودة والتي
يمكن وجودها، لأنه استوت نسبته إلى الكل فسمي كليا بهذا الإعتبار، إذ نسبته إلى كل واحد واحدة، فلهذه الصورة نسبة إلى أحد الأشخاص وغيرها واحدة كان مثال مطابقها كذلك، لهذا قيل إنه كلي، ونسبته إلى النفس وإلى سائر الصور المرتسمة في النفس؛ وهذا هو الذي أشكل على المتكلمين وعبروا عنه بالحال، واختلفوا في إثباته ونفيه وقال قوم ليس بموجود ولا معدوم، وأنكره قوم وأشكل عليهم الإفتراق والإشتراك بين الأسماء إذ السواد والبياض يشتركان في اللونية ويفترقان في شيء فيفكيف يكون مافيه الإفتراق وما فيه الإشتراك واحدا؟ ومنشأ ذلك سوء فهم بعضم عن اعتقاد شيء له وجود في النفس لا وجود لهمن خارج، إذا ثبت في النفس صورة كلية، وليس في الوجود كونها كلية بهذا الإعتبار بل هو ثابت في الأعيان بالإعتبار الأول، ومعنى كليتها التماثل دون الإتحاد في الإنسانية الموجودة لزيد والإنسانية الموجودة لعمرو في كونها إنسانية بالعدد. وأما مثاله في النفس العاقل للانسانية فمطابق له ولإنسانيته زيد وعمرو مطابقة واحدة، والصورة في نفسها واحدة ومع وحدتها مطابقة للكثرة، كأنها بالإضافة إليه أيضا واحدة، أعني تلك الكثرة؛ فهذا تحقيق معنى الكلي، وهو من أغمض ما يدرك وأهم ما يطلب إذ جميع المعقولات فرع لتحقيق هذه المعاني فلا بد من تبيينها.
وأما التام والناقص فليس المراد بهما الجزئي والكلي، بل التام يراد به الذي يوجد له جميع ما من شأنه أن يوجد، وليس مما يمكن أن يوجد له إلا وهو موجود له إما في كمال الوجود وإما في القوة الفعليةن وإما في القوة الإنفعالية وإما في الكمية. والناقص مايقابل التام الكامل. القول في الإنقسام إلى الواحد والكثير ولواحقهما إعلم أن الواحد إسم للشيء الذي لا يقبل القسمة من الجهة التي قيل له أنه واحد، ولكن الجهات التي يمتنع بسببها الإنقسام وتثبت الوحدة بالإضافة إلهيا كثيرة. فمنها ما لا ينقسم في الجنس فيكون واحدا في الجنس كقولنا: الفرس والإنسان واحد في الحيوانية، إذ لا إختلاف بينهما إلا في العدد وفي لنوع والعوارض. أما الحيوانية فليس بينهما فيها اختلاف وإنقسام. ومنها ما لا ينقسم في النوع كقولك: الجاهل والعالم واحد بالنوع أي بالإنسانية. ومنها ما ينقسم بالعرض العام كقولنا:
الغراب والفار واحد في السواد. ومنها ما لا ينقسم بالمناسبة كقولنا: نسبة الملك إلى المدينةن ونسبة العقل إلى النفس واحدة. ومنها ما لا ينقسم في الموضوع كقولنا: النامي والذابل واحد في الموضوع، وكذلك تجتمع رائحة التفاح وطعمه ولونه في موضوع واحد فيقال: هذه الأشياء واحدة أي في الموضوع لا بكل وجه. ومنها ما لا ينقسم معناه في العدد أو ينقسم إلى أعداد مشتركة في شيء كالرأس، فإنه واحد من الشخص أي ينقسم إلى أجزاء يكون لها معنى الرأس ومنها ما لا ينقسم بالحد أي لا توجد حقيقته لغيره وليس له نظير في كمال ذاته، كما يقال الشمس واحد وأحق الأشياء باسم الواحد واحد بالعدد. ثم ينقسم إلى ما فيه كثرة بالفعل ويكون واحدا بالتركيب والإجتماع كالبيت الواحد مثلا، وإلى ما لا كثرة فيه بالفعل ولكن فيه كثرة بالقوة لا بالفعل كالجسم من حيث هو جسم أي ذو صورة جسمية اتصالية، وإلى ما لا كثرة فيه لا بالفعل ولا بالقوة وهنو كل جوهر واحد ليس بجسم عند الفلاسفة، وذات الأول الحق كذلك بالإتفاق، ويثبت هذا للجوهر الواحد الفرد المتحيز عند المتكلمين فإنه لا ينقسم لا بالقوة ولا بالفعل، وهو واحد بالعدد. والذي يقبل القسمة لا بالقوة ولا بالفعل هو الأحق باسم الواحد، فالمعنى المفهوم من الكثرة على مقابلة الوحدة في كل رتبة، والكثير على الإطلاق على مقابلة الواحد على الإطلاق، وهو ما يوجد فيه
واحد وليس واحدا من جهة ما هو فيه، أي يوجد فيه واحد ليس هو وحدة فيه، وهو الذي يجاب عنه بالحساب. وقد يكون الكثير كثيرا بالإضافة والإتحاد في الكيفية يسمى مشابهة، وفي الكمية يسمى مساواةن وفي الجنس يسمى مجانسة، وفي النوع يسمى مشاكلة، والإتحاد في الأطراف يسمى مطابقة، فيخرج من هذا بيان معنى الواحد بالجنس والواحد بالنوع، والواحد بالعدد والواحد بالعرض والواحد بالمساواة، فجملة النسب للواحد هي التشابه والمساواة والمطابقة والمجانسة والمشاكلة، وأنواع الكثير مقابلات لذلك. القول في إنقسام الوجود إلى الممكن والواجب اعلم أن الممكن إسم مشترك يطلق على معان: الأول وهو الإصلاح العامي التعبير به عما ليس بممتنع الوجودن وعلى هذا يدخل الواجب الوجود فيه، ويكون الأول الحق ممكن الوجود، أي ليس محال الوجود،
وتكون الأشياء بهذا الإعتبار قسمين: ممتنع وممكن أي ممتنع وما ليس بممتنع، ويدخل فيه الجائز والواجب. الثاني الوضع الخاصي وهو أن يراد به سلب الضرورة في الوجود والعدم جميعا، وهو الذي لا استحالة في وجوده ولا في عدمه، وخرج الواجب عنه، ويكون المذكور بهذا الإعتبار ثلاثة: ممتنع وجوده أي ضروري عدمه، وواجب وجوده أي ضروري وجوده، وشيء لا ضروري في وجوده ولا في عدمه، بل نسبته إليهما واحدة، وهو المراد بالممكن. الثالث أن يعبر عن ممكن لا ضرورة في وجوده بحال من الأحوال، وهو أخص من الذي سبق وذلك كالكتابة للإنسان لا كالتغيير للمتحرك، فإنه ضروري في حال كونه متحركا، ولا كالكسوف للقمر فإنه ضروري عند توسط الأرض بينه وبين الشمس، فيصير الأعداد على هذا الوضع أربعة: واجب وممكن وموجود له ضرورة وموجود لا ضرورة له البتة. الرابع أن يخصص الشيء المعدوم في الحال الذي لا يستحيل وجوده في الإستقبال فيقال له ممكن أي له الوجود بالقوة لا بالفعل، وعلى هذا لا يقال العالم في حال وجوده ممكن بل يقال كان قبل الوجوب ممكنا. وأما الواجب الوجود فهو الذي متى فرض معدوما غير موجود لزم منه محال، ثم الواجب وجوده ينقسم إلى ما هو واجب لذاته
وإلى ما هنو واجب لغيره لا لذاته. أما الواجب لذاته فهوالذي فرض عدمه محال لذاته لا بفرض شيء آخر به محالا فرض عدمه، فالعالم واجب الوجود مهما فرضنا المشيئة الأزلية متعلقى بوجوده، ولكن صار الوجوب له من المشيئة لا من ذاته والوجوب لله من ذاته لا من غيره، وعلى الجملة كل ما حصل وجوبه بوجوده واجب بسبب وجود سببه لا محالة وأنه ما دام ممكن الوجود لا يترجح وجوده على عدمه، ولما تساوى الوجود والعدم بقي في العدم غير موجود، فقد صح وجوده لوجوب وجوده لمصادفة علته كمال ما به صار علة لوجوده. ومن هذا تتضح أمور كثيرة: أحدهما أنه يستحيل فرض شيء هو واجب الوجود بذاته ويبقى وجوبه فلا يكون وجوب وجوده بغيره، ويكون ذلك الغير فضله. الثاني أن كل ما هوواجب الوجود بغيره فهو ممكن الوجود بذاته، لأنه إما أن يكون باعتبار ذاته ممكن الوجود أو واجب الوجود أو ممتنع الوجود، والقسمان الأخيران باطلان إذ لو كان ممتنع الوجود بذاته لما تصور له وجود بغيره، ولو كان واجب الوجود بذاته. لما كان واجب الوجود بغيرة، لما سبق
فثبت انة ممكن الوجود بذاتة. والحاصل أن كل ممكن بذاته فهو واجب بغيره، فالممكن أن اعتبرت علته وقدر وجودها كان واجب الوجود، وإن قدر عدم علته كان ممتنع الوجود، وإن لم يلتفت إلى علته لا باعتبار العدم ولا باعتبار الوجود كان له في ذاته المعنى الثالث، وهو الإمكان، فإذن كل ممكن فهو ممتنع وواجب أي ممتنع عند تقدير عدم العلة، فيكون ممتنعا بغيره لا لذاته أو ممكنا من حيث ذاته إذا لم تعتبر معه علته نفيا وإثباتا، وليس الجمع بين هذه الأمور متناقضا، بل نزيد عيه فنقول: الممتنع أيضا منقسم إلى ممتنع لذاته وإلى ممتنع لغيره، فإجتماع السواد والبياض ممتنع لذاته، وكون السلب والإثبات في شيء واحد صادقا ممتنعا لذاته، وفرض القيامة اليوم، وقد علم الله تعالى أنه لا يقيمها اليوم مستحيل، ولكن لا لذاته كاستحالة الجمع بين البياض والسواد، ولكن لسبق علم الله بأنه لا يكون وإستحالة كون العلم جهلا، فكان امتناعه لغيره لا لذاته. الثالث أنه لا يجوز أن يكون شيئان كل واحد منهما واجب الوجود لصاحبه،
لأن ما يجب لغيره فله علة أقدم منه تقدما بالذات لا بالزمان، ويستحيل أن يكون المتقدم بالذات متأخرا بالذات، وهو من حيث أنه علة يجب أن يتقدم بالذات، وهو من حيث أنه معلول يجب أن يتأخر، وذلك محال إذ يلزم منه أن يكون الشيء قبل ما هو قبله بالذات. الرابع أن واجب الوجود بذاته لا بد أن يكون واجب الوجود من جميع جهاته، حتى لا يكون محلا للحوادث ولا متغيرا، فلا يكون له إرادة منتظرة ولا علم منتظر، ولا صفة من الصفات منتظرة عن وجوده، بل كل ما يمكن أن يكون له فيجب أن يكون حاضرا بذاته متأخرا عن ذاته لازما يمكن أن يكون له ولا يكون له، فإنما يكون حيث يكون لعلة وتنتفي، وحيث ينتفي بعدم ذلك العلة فيكون وجوده في حالتي عدم تلك الصفة ووجودها متعلقا بأمر خارج منه، إما نفي وإما اثبات حتى يستحيل خلوه عنه، فلا يكون واجب الوجود بذاته بل يستحيل ذاته إلا مع نفي تلك الصفة أو وجودها. ويشترط بحالة الوجود وجود العلة، وبحال العدم إما عدم تلك العلة أو وجود علة معدومة، فلا تخلو ذاتها عن اشتراط شيء غير ذاتها لتصور ذلك بباقي ما فسرنا به واجب الوجود. هذا ما أردنا أن نذكر من أحكام الوجود وأقسامه ولنقبض عنان البيان عند هذا فإنه خوض في التفصيل، وليس وضع هذا الكتاب لبيان تفاصيل الأمور بل لبيان طريق تعرف حقائق الأمور، وتمهيد قانون النظر وتثقيف معيار العلم ليميز بينه وبين الخيال والظن القريبين منه.
وإذا كانت السعادة في الدنيا والآخرة لا تنال إلا بالعلم والعمل، وكان يشتبه العلم الحقيقي بما لا حقيقة له، وافتقر بسببه إلى معيار فكذلك يشتبه العمل الصالح النافع في الآخرة بغيره، فيفتقر إلى ميزان تدرك به حقيته. فلنصنف كتابا في ميوان العمل كما صنفناه في معيارالعلم، ولنفرد ذلك الكتاب بنفسه ليتجرد لهمن لا رغبة له في هذا الكتاب. والله يوفق متأمل الكتابين للنظر إليهما بعين العقل لا بعين التقليد، إنه ولي التأييد والتسديد. آمين.
======
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق